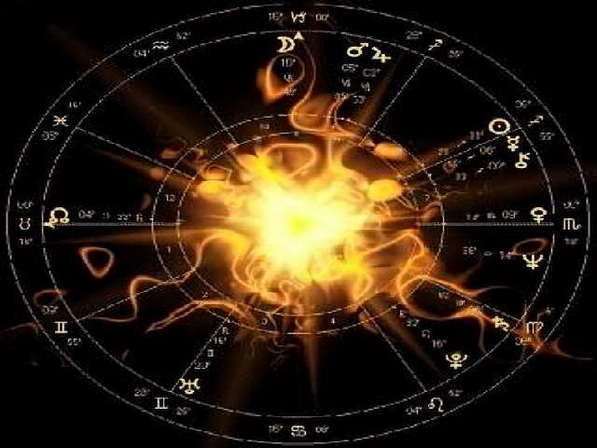‘الشبِّيحة’ يختطفون محمود درويش
أمجد ناصر
التمثيل شيء والحياة شيء آخر. هذا نعرفه. يمكن للتمثيل أن يكون تنقيحاً لأخطاء الحياة. أن يكون تعويضاً، أو حتى اختلاقاً لما لم يحدث. في التمثيل (على الشاشة أو خشبة المسرح) كلُّ هذا ممكن. لكن أن يكون التمثيل ‘سلبطة’ و’تشّبيحاً’ فهذا، قطعاً، أسوأ التمثيل، بيد أن الاساءة تبلغ حدود الجناية عندما تكون هذه الحياة التي ‘يتسلّبط’ عليها ‘التمثيل’، برعونةٍ فائقةٍ، لمّا تزل بيننا بحضورها المادي والمعنوي الكثيف.
هذا ما حصل لمحمود درويش على يد ‘الشبّيح’ فراس ابراهيم.
منذ اطلالته الاولى في مسلسل ‘في حضرة الغياب’ (المقتبس من عنوان كتاب لدرويش) يطلق هذا الممثل السيىء النار بين عيني محمود درويش ويرديه صريعاً. يموت درويش أمامنا على الشاشة قبل أن ينطق جملة واحدة، يموت ما إن تطالعنا البلادة الطافحة من وجه ممثل ‘شبّيح’ٍ بامتياز. لا يموت درويش بنبلٍ، كما فعل في سفرته الأخيرة إلى الموت، ولكنه يموت ببلادة، بلا حد أدنى من الذكاء الذي كان خصلةً فارقة تتموَّج على جبينه. وهذه أسوأ الميتات. إنها جناية معلنة يُقدم عليها المدعو فراس ابراهيم بحق درويش ليس لأنه لا يشبهه (شكلاً)، وليس لأنه حطَّم شعره بأخطائه اللغوية ورخاوته الايقاعية، ولا لأنه يفبّرك (مع كاتب المسلسل) حياة لم تكن حياة درويش تماماً، بل لأنه، بالدرجة الأولى، ممثل سيىء في نص أسوأ.
لم يكن أحمد زكي يشبه جمال عبد الناصر ولكنه استطاع أن يقنعنا أنه عبد الناصر رغم التباعد الواضح في المظهر الخارجي للرجلين. الممثل الجيد قادر، رغم تباعد الشبه بينه وبين من ‘يمثّل’ شخصه، على أن يسبر غور الشخصية ويقدم ظاهرها وباطنها للمشاهدين. هذا ما يسمى في التمثيل بـ ‘التقمّص’. إنه مذهب تمثيلي شائع ينسب، كما هو معروف، إلى المخرج الروسي ستانسلافسكي. هنا يذهب الممثل الى ما وراء جلد الشخصية. يدخل الى أعماقها، ولا يتم ذلك إلا بمعايشتها، إلاّ بالحلول التام فيها. الظاهر، في التمثيل، سهل. أقصد الشكل، لكنَّ الأصعب هو الباطن. هذا يحتاج أولاُ: موهبة تمثيلية. ثانياً: معرفة بما وراء وجه الشخصية. لا يملك المدعو فراس ابراهيم تلك الموهبة ولا هو قادر، بالتالي، على تقديم شخصية محمود درويش ذات الشهرة العلنية الطاغية من جهة والمتكتمة، بل أكاد أقول المكتنفة بالأسرار، من جهة ثانية. لمحمود درويش، كما يعرف أصدقاؤه، أكثر من وجه. كان له أكثر من دور في القضية الفلسطينية لا تختصر، فقط، بالقصيدة. وله في الحياة، عموماً، أكثر من دور لا يختصر بالنساء. وله حضور في القصيدة لا يشبه، دائماً، حضوره في حياته الشخصية. الشعر والشاعر ليسا شيئاً واحداً. رغم تسرّب نُتّفٍ من حياة الشاعر في قصيدته، رغم أن القصيدة من لحم الشاعر ودمه وأعصابه وقلبه ودماغه، رغم أنها تشبه الولادة إلا أنها ليست نسخة كربونية من منتجها. فالقصيدة ليست سيرة حتى وهي تتضمن شظايا سيرية، ليست بطاقة هوية رغم أنها تحمل دي أن آيه شاعرها. من يكتبون الشعر، بل من يعرفون الشعر، يعلمون أن القصيدة قد تكون حلم الشاعر، قد تكون الحياة التي لم يعشها، بل قد تكون المثال الذي يصبو إليه ولا يتحقق في حياته الواقعية. هكذا يخفق مسعى كل الذين يبحثون عن تطابق تام بين القصيدة والشاعر. فمن كتب قصيدة ‘أحنُّ إلى خبز أمي’ هو نفسه الذي لم ترد أمه في شعره، متعينة، إلا في قصيدة متأخرة له بعنوان ‘تعاليم حورية’. ما أقصده بهذا الكلام هو خطأ ‘ترجمة’ القصيدة. أي تحويلها إلى سيرة وخلق تناظر بينها وبين الشاعر، فكيف إذا كانت تلك ‘الترجمة’ ركيكة، بائسة، وعديمة الخيال كما بدت في مسلسل ‘في حضرة الغياب’.
‘ ‘ ‘
أكاد أجزم أنَّ من كتب مسلسل ‘في حضرة الغياب’ (وهو سيناريست فلسطيني سوري يقال إنه جيد في ‘كاره’ يدعى حسن .م يوسف) لم يلتق درويش، وجهاً لوجه، أو على انفراد، مرة واحدة. فلو أن جلسة واحدة جمعت بينهما لما ارتكب تلك الجناية بحق شخص محمود درويش. فصاحب ‘لماذا تركت الحصان وحيدا’ لا يقرأ شعره، في بهو فندق، لـ ‘معجب’ أو ‘معجبة’. نحن، من نعتبر أنفسنا أصدقاء درويش، لم يفعل ذلك معنا. كنا نتحدث عن الشعر بالتأكيد، كان يبدي رأيه في عمل واحد منا، أو يسألنا عن رأينا في آخر عمل له، ولكنه لم يكن يستل ديوانه ويقرأ شعره ‘على الطالع والنازل’. فهو لم يكن من الذين يحولون اللقاءات الاجتماعية والصداقية الى أمسية شعرية. أجزم أن ذلك، بالذات، كان يستثير مخزونه، الوفير، من السخرية التي قد تكون جارحة أحياناً. هناك أصدقاء له يطلعون على قصائده قبل أن تنشر ولكنه لا يقرأ لهم على سبيل نيل الاعجاب أو حتى الاستمزاج، فكيف يفعل ذلك أمام عاشق محبط يطارد حبيبة واقعة في حب رجل آخر: درويش؟ من يعرف محمود درويش يعلم أن القصيدة عنده عمل كتابيٌّ بالدرجة الأولى. وليست القاء. ليست مثلا يضرب. ليست تطريباً ايقاعياً. يقرأ دوريش، كما نعرف، قصيدته أمام الجمهور. إنه، على الأغلب، أكثر شاعر عربي فعل ذلك. لكنه، رغم مئات المرات التي قرأ فيها شعراً أمام جمهور، كان يستصعب تلك المهمة. كان يعرف أنه لا بدَّ أن يقرأ في جمهرة من الناس لأسباب عديدة، من بينها ‘واجبه’ كشاعر ارتبط في ذهن كثيرين، على نحو عضوي، بقضية كبيرة، ومنها اختباره لعملية التلقي ذاتها، لكنه كان يقرأ ما يريد. وغالباً ما كان يقرأ جديده. مع ذلك تظل القراءة فعلاً لاحقاً على الكتابة. ومن يعرف درويش يعلم، أيضاً، أنه كان يعكف على قصيدته كما لو كانت عملاً مختبرياً، فبقدر ما كان الضغط كبيراً على قصيدته كي تستجيب للراهن كانت تتفلَّت، بقدر ما تستطيع، من راهنية هذا الراهن وإكراهاته، وتحلِّق، باندفاعةٍ ايقاعية، غنائية، متلاطمة الجوانب، في الاسطوري والواقعي والميتافزيقي.
لذلك بدت لي قراءات درويش أمام معجبين في هذا المسلسل البائس مثيرة للأسى فضلاً عن أنها بعيدة، كل البعد، عن شخصية درويش التي يتصدى لها.
ولكن ماذا عن تلك القراءة نفسها؟
يتملك الواحد منا غضب شديد عندما يسمع هذا الممثل الرديء، الذي أبى إلا أن يرتكب حياة واحد من أكثر الشعراء العرب كارزمية، وهو يقرأ قصائد دوريش بوصفه محمود درويش. يا للمهزلة. يا للفارق الفلكيِّ. فلا نبرته تشبه نبرة دوريش ولا لغته الجسدية (التمثيلية) تشبه لغة درويش الجسدية، ولا حضوره الباهت، بل البليد، يقترب من حضور درويش الآسر، المسيطر، المتوتر، المنفرد والمحتشد، على المنبر.
‘ ‘ ‘
محمود درويش ليس قديساً. ليس معصوماً عن النقد. ليس فوق التحليل والتشريح. ولست أرغب، هنا، في أن أسبغ عليه ما ليس فيه. انزعاجي من هذا العمل التلفزيوني يتعلق، أساساً وقبل أي شيء آخر، بالرداءة التي عُرضت فيها ‘حياته’، أو ما ظن القائمون على المسلسل أنها حياته. فقد كان بالامكان عمل مسلسل جيد عن حياة درويش، بما لها وما عليها، رغم حداثة رحليه. فالأمر لا يتعلق، بقرب رحليه أو بعده، فهناك من صُنِعَتْ مسلسلات (أو أفلام) عن حياتهم وهم أحياء يرزقون ولكن الأمر يتعلق، أولاً وأخيراً، بالأهلية. بالكفاءة. بالقدرة على صنع سردية درامية ذكية، متقنة، وقبل ذلك، مقنعة لحياة دوريش شخصاً وشاعراً وصانعاً، مع قلة قليلة، الهوية الأعمق للفلسطينيين. كيف يمكن لنا أن نصدِّق أن ما نراه ‘في حضرة الغياب’ هو محمود درويش الذي بمقدور أي متصفح لليوتيوب أن يراه، ذكياً، متألقاً، لماحاً، في عشرات المقابلات التلفزيونية والقراءات الشعرية؟
عتبي، مثل كثير من أصدقاء محمود درويش، على أخيه أحمد الذي أجاز، باسم العائلة، هذه المهزلة (رغم أن درويش أكبر من أن يكون إرثاً حصرياً لعائلة). عتبي أكبر على مرسيل خليفة صديق محمود ومغني قصائده الذي قبل أن يكون طرفاً في هذا ‘العدوان الثلاثي’ (بحسب تعبير حسن خضر) على شاعر الأرض والجرح والأمل. كان ينبغي منع المدعو فراس ابراهيم، بكلِّ السبل، من ارتكاب حياة محمود درويش، فليس هكذا يتقزَّم، أمام أعيننا، من كان طويلاً ونحيلاً ‘كشهرٍ من العشق’ أو أكثر.
القدس العربي