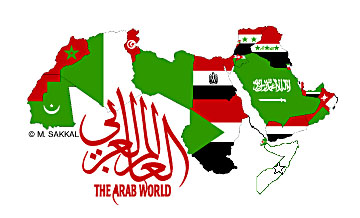المعتقل السياسي

ماجد حبو*
“الحلقة الأولى”
مقدمة لابد منها
لم يكن المعتقل السياسي استطالة عضوية للحياة السياسية في سورية كما كان عليه الحال في مطلع السبعينات ونهاية الثمانينات. علماً بأنه ارتبطت أسماء لمعتقلات بفترات هامة من تاريخ سورية الحديث مع بداية عهد الاستقلال وما سبقها بقليل أيام الانتداب الفرنسي مثل قلعة أرواد، سجن هنانو، سجن القلعة…الخ
ومع بداية عهد الاستقلال تعددت أشكال القمع السياسي من نفي، إقامة جبرية، حرمان من الحقوق السياسية بل والمدنية في بعض الأحيان. وصولاً إلى الحالة الأقصى ألا وهي المعتقل.
ولكن المعتقل بالعموم كان يشكل حالة استثنائية شاذة بالمعنى الزمني حيث كانت أطول فترة اعتقال سياسي هي فترة الوحدة السورية المصرية –حوالي السنتين وثمانية أشهر.
هكذا كان يأتي المعتقل حالة شلل لعناصر القوى الفاعلة على الأرض “الأحزاب السياسية” في لحظة الصراع الدائر، وليس حالة إلغاء كامل كما حدث وتم مع وصول “حافظ الأسد” الى رأس السلطة في سورية عبر انقلاب “أسود-أبيض” على التوالي حيث أعاد رسم ملامح الحياة السياسية في سورية وخلط الأوراق ليخلق واقع جديد بصم الحياة السياسية في سورية ببصمة ماتزال سارية المفعول حتى اللحظة. وإن اختلفت مؤخراً عبر سلطة “الابن” من حيث الكمية وليس النوعية.
توضيح في السياق
منذ اللحظة الأولى لوصول الأسد “الأب” (وهنا لإنتاج لاعادة التسمية فحديثنا يدور في مرحلة سلطة الأب وصولاً إلى الابن في مرحلة سيأتي تعريفها). إلى السلطة سعى جاهداً لاعادة ترتيب الأحزاب السياسية بما تمثله من واقع موضوعي هو بشكل أو بآخر انعكاس لواقع محدد وموصوف على الأرض “المجتمع”.
إن الشرعية التي ابتدعها لنفسه هي “الحركة التصحيحية” طالت أولاً الحزب الحاكم “حزب البعث” امتدت لتشمل كل ما استطاعت يده أن تطالها من القوى السياسية الفاعلة في سورية: شيوعيين، ناصريين، قوميين.
من الجدير التنويه إليه بأن حافظ الأسد لم يكن شخصاً خارقاً أو ساحراً أو إلهاً حتى يستطيع أن يخرق كل هذه القوى السياسية والأحزاب ذات التاريخ السياسي والنضالي، ولكنه واقع موضوعي حملته الظروف مثلما حملت حافظ الأسد إلي السلطة كممثل أبرز للبرجوازية الصغيرة ذات التذبذبات والتطلعات الثورية حيناً والرجعية حيناً آخر، أي بمعنى أصح القوى الأكثر عجزاً عن حل المشكلات والمعضلات للواقع السياسي المعقد.
هكذا بدأ الفرز بين القوى الثورية والإصلاحية منها، داخل البيت الواحد كل على حدة. فالشيوعيون منهم من دخل “الجيهة الوطنية التقدمية” ومنهم من بقي في الخارج كذلك الحال بالنسبة للناصريين أو القوميون منهم.
هكذا مُهدت الأرضية السياسية أمام الأسد ما بين “مناصرين، معارضين” ولكنه في النهاية استطاع شق وحدة الصف لأغلب القوى السياسية التي كانت موجودة حين ذاك.
المخاض الأول
جاء الاختبار الأول لسلطة الأسد عبر “أحداث الدستور” عام 1972 والذي مثلته رأس حربة القوى الدينية “السنية”في حماه –والتي بقيت خارج مراهنة الأسد على استمالة بعض أطرافها- واستطاع الأسد الخروج من المحنة الأولى بضربة أمنية قمعية شرسة ناجحة وإن بقيت جمرتها تحت الرماد تخفي النار الكامنة.
وقتها لم يتأسس بعد لحالة المعتقل السياسي وإن كانت بدايتها قد بدأت مع “القيادة القديمة” وإن لم تتوضح معالمها بعد.
المخاض الثاني
كانت الأحداث اللبنانية “الحرب الأهلية” وما رافق ذلك من دخول الجيش السوري إلي لبنان لنجدة “أولاً” القوى اليمينية الانعزالية، وضرب المشروع الوطني الثوري للحركة الوطنية اللبنانية في مطلع عام 1976 وما رافق ذلك من انشقاقات لمواقف القوى السياسية في سورية ما بين مؤيد معلن “أو مضمر” أو معارض واضح صريح، ودوماً كان المعتقل هو الوسيلة الأوفر بل الأوحد في معالجة من لم يوافق.
كل هذه الأحداث بالإضافة إلي الأحداث السياسية اليومية لم يدفع بالمعتقل إلى الصدارة كما حدث وصار عليه الحال بعد ذلك، فلقد كان المعتقل كما سبق وأشرت حالة استثنائية شاذة زمنياً كما حدث عام 1977 إبان زيارة نيكسون الرئيس الأميركي إلي سورية، حيث تم توقيفي مع مجموعة كبيرة من اليساريين كإجراء أمني احترازي لم يستمر سوى لستة أيام مع “فركة إذن” كانت مألوفة في الحياة السياسية السورية آنذاك .
الانفجار
كما سبق الإشارة إليه بأن الأسد أبقى القوى الدينية خارج مراهناته السياسية بل الأنكى من ذلك سعى إلى تعزيز نفوذها “جزئياً، أوكلياً” لمواجهة ما كان يعتقد “صادقاً” بأن مقتله سيأتي عبر القوى السياسية ذات التوجهات اليسارية أو القومية منها.
وهكذا كان أن خرج من عباءته مارداً لم يحسب له الحساب الكافي ليزلزل الأرض تحت أقدامه عبر تنظيم -الاخوان المسلمين- بشقيه السياسي “والذي سعى الأسد إلى مغازلته في كثير من الأحيان وخصوصاً الفصيل الدمشقي”والعسكري منه والذي نشأ ونما “تحت الأرض” بعيداً عن أعين البصاصين والعسس.
ففي الوقت الذي كانت فيه جدران المعتقلات تحمل شعارات الماركسيين “الخارجين عن القانون” أو الناصريين “الراديكاليين” أو القوميين “العفنين-بعث العراق” كانت القوى الدينية عبر ممثلها الأبرز “الاخوان المسلمين” تستغل المساجد التي سعى الأسد إلى تكاثرها بشكل سرطاني محاولة منه لاسترضائها، بل حتى المدارس بعد انتهاء الدوام الرسمي إلى تنظيم نفسها وتعزيز إمكانياتها لتفجر ما يمكن وصفه بأبشع جريمة إنسانية منظمة بحق مجتمع ما بالتشارك مع السلطة –وإن دفعت ثمن ذلك فيما بعد من كوادرها وخيرة مناضليها-.
مجزرة
لقد كانت أحد أمسيات الشهر الخامس 1979 في مدينة حلب وبالتحديد في منطقة “الراموسة” والمكان “مدرسة المدفعية” هي البداية الفعلية لكل ماسبق وما سيتبع ذلك من أحداث رسمت خريطة الحياة السياسية في سورية وبالتحديد “المعتقل” موضوع حديثنا.
فمع الرصاصة الأولى من مسدسه الخاص “للنقيب ابراهيم اليوسف” باتجاه رأس “عريف دورة المتقدمين للطلاب الضباط” كانت البداية وما تبع ذلك من مجزرة يعجز الحديث عن وصفها حيث كان ضحيتها أكثر من 75 طالباً متقدماً “سنة ثالثة” في كلية مدرسة المدفعية للضباط.
هكذا دخل المعتقل الحياة السياسية في سورية مع تحول نوعي امتد من حالة التوقيف القسري بدون ضوابط أو قوانين ليشمل حالات التصفية والإعدامات التعسفية بدون أي محاكمات شكلية كانت أو فعلية.
حقل الإعدام
حتى هذه اللحظة ماتزال صرخات الطالب الضابط المتقدم “لم يتح لي معرفة اسمه لأسباب أمنية” تدوي في أذني عندما كنت اؤدي الخدمة الإلزامية في مدرسة المدفعية عندما اقتيدت كل الدورات والمتدربين إلى “حقل الرمي” لمشاهدة إعدام ذلك “الطـالب الضـابط” وذلك لسبب “وجيه جداً” بأن النقـيب ابراهيم اليـوسف – و الذي كان قائداً آنذاك “لدورة الطلاب المتقدمين” منحه إجازة لمدة ثلاثة أيام قبل تنفيذ المجزرة المشؤومة تلك، وبأن زوجة النقيب ابراهيم اليوسف تعرفت على صورة ذلك الطالب الضابط وبأنه كان قد زارهم في منزلهم ذات مرة.
هكذا اكتملت فصول المحاكمة لتمتزج صرخاته المدوية وهو يصرخ “بريء بريء” مع طلقات الرصاص التي اخترقت جسده الشاب، ثم لتأتي طلقة الرحمة من قائد فصيل الإعدام ليتطاير دماغه أمام عيني راسماً أبشع ما يمكن وصفه للمصير الإنساني.
ولاكتمال المهزلة تأتي الأحداث فارضة نفسها بعد أربع سنوات من تقاطع تحقيقات متشابكة واكتمال الملف الأمني ليتضح “آسفاً” بأن ذلك “الطالب الضابط” كان بريئاً ويعاد الاعتبار إليه وتنفى عنه التهمة التي وجهت إليه من محكمة عسكرية ميدانية شكلت خصيصاً من قائد مدرسة المدفعية آنذاك “العميد علي غانم” ورئيس فرع التدريب “العقيد أديب أكرم” ونائب رئيس المدرسة “العقيد محمد الخلف” وهكذا ارتاحت جثة ذلك البريء الممزقة بالرصاصات الحاقدة في مثواها الأخير.
ساحات الإعدام
اتسعت دائرة ساحات الإعدام بعد ذلك لتنتقل إلى غرف التعذيب ثم إلى الزنزانات بل أكثر من ذلك إلى صفوف المدارس الابتدائية التي تم صرف طلابها وحرمانهم من الدراسة بحجة الأوضاع الأمنية المتدهورة لتتحول إلى ساحات محاكمة ميدانية ما أنزل الله بها من سلطان، وفي الغرف المجاورة تتم عمليات الإعدام. بل إن أعرق المواقع الأثرية في حلب “قلعة حلب” تحولت إلى مقبرة جماعية لأجساد “مذنبين وأبرياء” طالتهم المحاكم الميدانية والتي كان يديرها “محمد نور الموالدي” والذي كوفأ بعد ذلك على أتعابه باحتلاله منصب محافظ حلب نفسها.
المحرق السياسي
لقد كان ذلك السيف مسلطاً على رقبة “الاخوان المسلمين” على نفس الدرجة التي طالت القوى السياسية الأخرى مع فارق كمي “يكاد لا يلحظ أحياناً”.
فالخارطة السياسية وقتذاك كان محرقها الموقف من الأحداث الجارية “أي بمعنى الموقف من – الاخوان المسلمين- من جهة – والنظام “السلطة” من جهة أخرى”.
وهكذا استفاد حافظ الأسد من ما زرعه عام 1972 من استحداثه “تفريخه” “للجبهة الوطنية التقدمية”.
فالشيوعيون ومن كان منهم مؤمناً وعاد الى (ربه) “حافظ الأسد” يدخل الى جنته ويكون من عباده الصالحين “خالد بكداش” فلهم الأمان.
أما من تكبر وتجبر على نعمة (ربه) أي “المكتب السياسي –رياض الترك” فلهم عذاب أليم. فالمعتقل هو مثواه الأخير يمضي فيه خالداً مخلداً “15 سنة على أقل تقدير”.
ولا تخلو سجلات الأجهزة الأمنية أو منظمات حقوق الإنسان من حالات اعدامات تمت تحت التعذيب الوحشي للشيوعيين “أبو نيروز، محمد عبود…”.
كانت “جريمة المكتب السياسي” بأنهم اعتبروا – وذلك في بيان صدر في الشهر الثالث عام 1980 باسم التجمع الوطني الديمقراطي والذي ضم فيما ضم “الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي، حزب الاتحاد الاشتراكي العربي –جمال الأتاسي،حزب العمال الثوري، حزب الاشتراكيين العرب، حزب البعث لديمقراطي” بأن ما يحدث في سورية من تحرك شعبي .
وهكذا بدت من وجهة نظرهم بأن تحرك “الاخوان المسلمين” هو “تحرك شعبي” يجب …الخ.
أمّا ما دعا نفسه باسم حزب العمل الشيوعي “حسب تعبير الدكتور هشام وفائي” ولهذا الأخير قصة تستحق السرد: ففي مطلع 1985 وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات على اعتقالي بتهمة ذلك الحزب أياه، نقلت إلى “مشفى الرازي” بحلب والذي كان يرأسه الدكتور الوفائي –والذي تحولت إدارته إلى مكتب تابع للأجهزة الأمنية لاستكمال ماينقص من مستلزمات الموقف الأمني المتأزم- فكل حالات الموت والتي كانت تتم تحت التعذيب كان يتم استصدار تصاريح طبية كاملة الأهلية موقعة باسم الدكتور “وفائي” بأن حالة الوفاة تمت بصورة طبيعية “لانتهاء الأجل،أو لمشيئة الله” وكان أن كوفئ الدكتور المذكور بأن تم تعيينه بعد ذلك وزيراً للصحة “في الجمهورية العربية السورية”.
وبالعودة إلى الحادثة التي تمت معي شخصياً حيث كنت أعاني من مرض “خاص بالمعتقلين السياسيين –الناسور-” استلزم عملاً جراحياً، ولما كان محظوراً علينا كمعتقلين سياسيين أن نخاطب أحداً،أو أن نعطي أسماءنا. فقد تقدم مني صبيحة أحد الأيام رجل أربعيني يحمل بيده “عصا” على طريقة “الحكماء” وتتبعه حاشية لا تقل عن الثلاثين شخصا،ً تقدم مني قائلاً:
– ما اسمك؟؟
نظرت إلى العنصر الأمني المرافق لي لاستجلاء الموقف، حيث إنني غير مصرح لي بالحديث مع أحد، ولما لم أحصل على النتيجة المرجوة اجتهدت بالاجابة اختصاراً للموقف..
– أنا سجين سياسي!
– سياسي!!؟ هاآ..من أي حزب أنت؟؟
نظرت ثانية إلى المرافق الأمني والذي بدا متشاغلاً بالنظر إلى حذائه.
– أنا شيوعي.
– بعرف أنت شيوعي. بس من أي حزب؟؟
– أنا من حزب العمل الشيوعي.
صرخ متعجباً وهو يلتفت حوله ليُشهد كل من معه على حماقتي وفداحة جرمي.
– لك شو يا!! صرتولي حزب هلأ ؟؟ما طول عمركن اسمكن رابطة العمل الشيوعي هلا صايرلي حزب يا، شو كل واحد بدو يعمل حزب بهالبلد ؟؟! فلتانة الشغله يعني؟؟!!
أدركت أنني أمام شخص لا يمكن إلا أن يكون على دراية أمنية وسياسية على مستوى غير عادي، ومما زاد من إدراكي هذا حالة القرف التي بدت واضحة على وجهي والتي على ما يبدو كانت واضحة للعيان لذلك بادرني قائلاً:
– لك شايف شلون نحنا هالبعثيين أحسن منكن. لك عم نعالجكن ونطببكن وأنتوا ما بتبين فيكن؟؟!!
فما كان مني إلا أن بادرته بالجواب قائلاً :
– الحق مو عليّ. الحق عالجلاد اللي كان عم يضربني، كان لازم يبعتني لعندك جثة حتى تطلعلي تصريح وفاة طبيعية وتريح راسك من كلامي الوقح.
هذا الموقف الطبي الإنساني للدكتور “وفائي” لم يكن محصوراً بشخصي “الكريم” بل امتد ليشمل الحالات الأكثر إنسانية من الرفاق، وما العمليات الجراحية التي أجريت للرفيق “فراس يونس” لزرع قطع لحمية كاملة أنتزعت من إليته لتسد الفراغات الهائلة لباطن قدميه، إلا دليل لا يحتاج إلى أية برهان على كفائة وإنسانية الدكتور المذكور أعلاه.
كل ذلك جاء نتيجة مباشرة “للغباء السياسي التاريخي-لحزب العمل الشيوعي” من اعتباره إن “الموقف السياسي المطلوب هو إيجاد البديل الثالث لما هو قائم –من نظام ديكتاتوري من جهة، ولحركة رجعية ممثلة بالاخوان المسلمين من جهة أخرى”.
وقتها لم يعي هذا الحزب مثل الكثيرين غيره بأنه “وإن كان ذو نزوعات وطنية لأفراده فهو يخدم مصالح الامبريالية” كما جاء في تصريح خاص بالرفيق “دانيال نعمه” عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري –خالد بكداش- وقتها.
وهكذا كان أن ضمت جدران الزنزانات كل من حزب العمل الشيوعي، التجمع الوطني الديمقراطي، حزب البعث “الموالي للعراق، العدو “القديم-الجديد” بالاضافة طبعاً وأساساً لعناصر تنظيم الاخوان المسلمين والذين نجوا من طلقات الإعدام في المرحلة الأولى لتواجههم مراحل ومراحل، بالاضافة إلى كل من هب ودب “من الشعب السوري” ومنح نفسه دقيقة واحدة من السهو عن حالة الخوف التي احتلت فكره ووجدانه وصرّح بما يعتمل في داخله.
وقتها كانت النسبة المئوية للمعتقلين السياسيين في سورية متواضعة جداً، ففي الوقت الذي كان فيه عدد سكان سورية 14 مليون كان عدد المعتقلين السياسيين في السجون السورية عدا حالات التصفية والإعدام أكثر من 14 ألف معتقل سياسي –نسبة مئوية تكاد لا تذكر مقارنة بعمر الشعوب “واحد بالألف” ذلك في مطلع 1984 .
ولنا تكملة من داخل المعتقل.
ماجد حبو 2001
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مواطن سوري ( معتقل سياسي سابق أمضى في السجن 14 عاماً ).
شهادة 2
كانت ليلة الجمعة الموافق لـ 18/3/1983 ليلة استثنائية بكل المقاييس، وقتها كانت مدينة حلب تودع رداءها الشتائي وتتهيأ لربيعها المقبل مع الثمار الأولى لاشجار “الاراسييا”. كانت ليلة ما تزال تخبئ من شتائها بضع غيمات تحاول أن تغسل بها سماء شوارع حلب من رائحة الرصاص، بينما الخوف جاثم في العيون، والقبور مازالت طرية، والنساء ما زلن يندبن آباء وأزواجا “حديثي الموت” .
كانت رائحة الموت تعبق في المدينة .
آه ما أجملك يا حلب ! أنثى كاملة الاكتمال!
حلب! جسد ذكورى صلب…
حلب … عذراء فضت بكارتها بعصا غليظة!
لم تنتحب! لملمت أطرافها، ودماؤها ما زالت ساخنة تنظر بعين حزينة كسيرة لقادم… سيربت على شعرها ويعيد “عشقها للحرية… والطعام اللذيذ… والغناء العذب”.
سيعيد لابنائها فطرة بداوتهم … ورقة مدينتهم.
حلب… يا إلهي كم أحببناك… وكم سنحبك.
كانت رائحة الموت تتسلل من نافذة ذلك القطار القادم من الشمال، “الحسكة”، وفى زاوية من إحدى عرباته تكومت على نفسي مع حقيبة صغيرة معلقة على الكتف بعد أن ودعت أما تعودت المشي خلفي في كل مرة احصل فيها على إجازة أسبوعية خميس وجمعة من الخدمة الإلزامية في “سجن المدفعية في حلب “، عفوا اقصد “مدرسة المدفعية في حلب”.
في هذه المرة مشت أمي ورائي طويلا وكأنها بحدسها “الإلهي” تخمن بأن زيارتي لن تتكرر قريبا ، بل ستطول لتمتد نحو أربعة عشر عاما فقط حتى أستطيع أن أعود إلى تلك المدينة الهادئة البسيطة.
أربعة عشر عاما حتى يحتويني ذلك المنزل الجديد والذي انتقلت إليه العائلة بعد اعتقالي بحوالي سنتين بسبب قدم المنزل القديم الذي شهد صرختي الأولى، لاعود بعد ذلك إلى أسرة محطمة تمزقت أوصالها بعد أن تمزقت أجساد أفرادها.
فبدءا من أخى الأكبر والذي لم يستطع الفكاك من مطارة الأجهزة الأمنية له والضغط عليه لمعرفة كل ما يمكن معرفته عن أصدقائي ورفاقي، كما حدث للكثيرين من رفاقي في المعتقل، فاختار أخيرا المنفى الطوعى واحتوته شوارع أوروبا كرقم آخر لمهاجري الجنوب ولكن هذه المرة ليس لأسباب اقتصادية.
مرورا بوالدتي التي انهد حيلها وهى تواجه في كل مرة تستطيع فيها زيارتي وهي تحمل كل ما تحلم به أم لابنها المعتقل عساها أن تقدم شيئا من روحها مع وجبة الطعام يحمل طعم ملوحة دموعها .لقد كانت طوابير الذل والمهانة التي تواجه اهالي المعتقلين وهم ينتظرون “الفرج” بزيارة قصيرة لا تتجاوز الدقائق العشر وعلى اكثر من شبك عازل، تحمل اكثر من معنى البشارة التي عاشتها “مريم العذراء” وجبريل ينقل إليها النبأ الإلهي الموعود.
تقول:- آنا اخماتوفا عن تلك الطوابير التي جمعت اهالي المعتقلين – بتصرف-
لم اكن لاعرفهم من قبل
لكن البريق الصادر من العيون المعتمة
كان اكثر من حبل السرة لي.
وهكذا كان أن أصيبت أمي وفى السنة الثامنة لاعتقالي بتهتك غضروفي لأربع فقرات في الظهر كجزاء بسيط على طوابير الانتظار، لكن ذلك لن يحول دون زيارتها لي ولستة أعوام أخرى وهى محملة بالأمل ما يكفى لقارة بكاملها.
فنتازيا
يملؤني توق عارم لإعادة ترتيب الزمان ، فالعبث الذي دمر شطرا كبيرا من شبابنا، والزمن الذي ترك بصمته على ذاكرتنا وأجسادنا كان زمنا مجنونا… لا منطق له ولا ذاكرة.
كان زمنا قاتلا ، غدارا ، مخاتلا .
كان زمن العسف ، والانفلات المجنون للغرائز الحيوانية… كان زمنا دمويا .
أشبه بأب سكير ينهال بالسوط على أبنائه في سورة سكر عارم … نكرهه ونحبه.
نكرهه لأنه سكير … خارج الزمن والمنطق .
ونحبه لأنه جبار … لأنه أبونا ….
كان ذلك الزمن زماننا …
أحببناه إلى درجة الاستشهاد … عشقناه إلى درجة القتل !!!
يا الله ما كان من أجمله زمن !!!
ولانه زمني … زماننا جميعا … سأعيد ترتيبه … سأرجع له منطقه ودورته الطبيعية .
انه لنا … انه نحن- المنفيين خارج الزمن- فمن حقنا أن نعيد تشكيله.
ولان- المنفى خارج الزمن فإن “المعتقل” لا يفقد حريته في اللحظة التي اعتقل فيها بل يستردها في اللحظة التي ينالها.
لذلك ستكون اللحظات التي كنا فيها قاب قوسين أو آدني هي اللحظات الأكثر حساسية وأهمية بالنسبة لنا -نحن المعتقلين.
المساومة
ماجد حبو
المساومة
يبدو العنوان ذو دلالة تجارية تتعلق بالبيع والشراء لوهلة الأولى , لكن النظام البعثي في ظل الأسد/ الأب والابن/ أستعار التعبير وغير من مضمونة بما يتناسب والوصفة الأمنية له , الرحمة لروح / جورج أور ويل / .
والتعبير بحد ذاته دارج ومعروف ومتداول في الحياة السياسية السورية ” عهد بالدم ” كما جرى العمل به مطلع الثمانينات, لكن له دلالات ومعاني أخرى في شكله الأمني, وخصوصا في أقبية المعتقلات والسجون والفروع الأمنية.
تبدأ رحلة الاعتقال بالتعذيب الجسدي / فقط تعذيب بدون أية موجبات / ثم يلي ذلك مرحلة التحقيق وتقوم على انتزاع اكبر كمية من المعلومات المطلوبة وبالتعذيب أيضا , ثم تأتي المرحلة التي نحن بصدد ها , المساومة :
بعد أن تسريح الأجساد قليلا ولم تسكن بعد !!! تعرض المساومة , والتي تقوم أساسا عن التراجع عما أنت علية من قناعات , أو التنصل من الهيئات أو الأحزاب التي تنتمي لها , باعتبارك عاقا وتنوي الهداية , وذلك من خلال التعاون – مخبر – مع الأجهزة الأمنية الحارسة للوطن والمواطن !!
والمساومة هذه لها شروطها وظروفها , فهي مترافقة بالعموم مع الضغط السياسي والأمني للمعتقلين السياسيين , وبحسب الظروف السياسية العامة التي تعيشها البلد .
فالمعتقل الذي تعرض لإذلال جسدي ونفسي يصعب وصفة وبشروط غير متكافئة بالمطلق يكون أمام اختيار اقل ما فيه إهانة لروحة وجسده وقيمة , وبالتالي تفقد الكلمة / المساومة / معناها .
فأنت لست في وضع يسمح لك بالعرض والطلب – حسب التعبير التجاري – بل الموافقة أو الرفض, كما انك لست في وارد فرض صيغ أخرى اقل مذلة, فحريتك مقابل كرامتك !!.
إن ما يعيشه المواطن السوري اليوم وفي ظل الهجمة الأمنية الوحشية المستشرية تضع حريته في مهب المزاج الأمني المتقلب من سيئ إلى أسوأ وبشروط مساومات تصل إلى حد الوجود الفيزيائي .
ثمة تقنية سورية بامتياز للمساومة وهي – الرهينة – فالمطلوب اعتقاله والمتواري عن الأنظار يتم اعتقال احد أفراد أسرته ومساومته على تسليم نفسه .
وفكرة المساومة ليست حكراً على النظام تجاه الشعب ,بل تمتد لتشمل السياسة الإقليمية منها أو الدولية , فالموقف السوري – النظام – من المقاومة بكل أشكالها هي لتحسين شروط مساومته مع المشاريع المطروحة في المنطقة , وليس موقف مبدئي نابع عن قناعة سياسية أو وطنية وكذا الحال مع الدول ذات الشروط الخاصة / تسليم أوجلان , التسليم بلواء اسكندر ون / في شروط التسوية مع النظام التركي , المشاركة في – حلف الباطن , حارس للحدود العراقية – في التسوية مع المشروع الأمريكي , حالة الجبهة السورية – الجولان – مع الكيان الإسرائيلي .
هذه العقلية التي تقوم على المساومة بكل شيء وفق صيغة القوي وما يفرضه من شروط , هي ما يحكم سلوك النظام تجاه شعبة بأشكال مختلفة حسب الطلب .
وبالعودة إلى المساومة الأمنية للمعتقلين السياسيين فكانت تتلخص بثلاث شروط :
– الانسحاب السياسي للمعتقل من الحزب أو الهيئة التنظيمية التي ينضوي تحتها المعتقل.
– عدم مزاولة أي شكل من العمل السياسي .
– التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية وفق شروطها الخاصة – بالتعبير العامي , مخبر – مراجعة الأجهزة الأمنية كل 15 يوم أوحين الطلب .
وهي شروط تقل أو تزيد حسب الظروف والحاجة ومقتضيات المرحلة وحسب الجهة السياسية التي ينتمي لها المعتقل , ففي ظروف المد الديني تشمل المساومة القوى اليسارية فقط … وهلم جرا .
وثمة أشكال من المساومات ما قام البعض منها على الخديعة , حيث كان المطلوب فقط وثيقة خطية موقعة من المعتقل لتبرز الأجهزة الأمنية قوتها وشدة بأسها أمام المواطن والنظام الحاكم كأصلح شكل معمول به في الحياة العامة في سورية .
وأحيانا ما كانت الخديعة تأخذ شكلا دراميا مع البعض : حيث يتم الموافقة على الشروط الكاملة للمساومة , بينما يستمر اعتقاله والاستفادة من خدماته داخل المعتقل وبشروط مزرية مذلة .
وللمساومة حكاية ظريفة ومؤلمة بنفس الوقت حدثت في السنة الثالثة أو الرابعة من عمر الاعتقال الذي دام بما يكفي ليدرك المرء وبسرعة خارقة تفاهة وعقم مثل هكذا محاولات بائسة ورخيصة لنيل الحرية مقابل فقدان الكرامة.
كنت معتقل لصالح فرع الأمن السياسي بحلب في مطلع الثمانينات بتهمة الانتماء إلى الوطن وفق صيغة غير رسمية ومحظورة وفق العرف الأمني الذي مازال معمولا به لحد الساعة – مع المزيد من التعميم في الوقت الراهن – كان يرأس الفرع وقتها العميد – نديم عكاش – وكان رئيس فرع التحقيق – الرائد عبد الكريم سلامة – ولهذا الأخير حكاية يستحق السرد :عبد الكريم سلامة رجل أربعيني متين البنية تبدو ملامحه الحيادية الخارجية لا تعكس داخله المضطربة , فهو شخص ضيق الصدر, وقليل الصبر, أو بالأدق يمكن الاعتقاد بأنه يعاني خللاً ما في آلية عمل وظيفة الدماغ لديه, فأنت على يقين مطلق بعد أكثر من دقيقتين بأن دماغ هذا الرجل يرسل إشاراته فقط إلى أطرافه الأربع ” لكمات بالأيدي, رفسات بالأرجل ” ما عدا ذلك ليس ثمة عمل آخر لذلك الدماغ, تدخل مكتبه بالزوايا السداسية. مكتب بستة جدران , تقريباً في منتصف الغرفة تتوسط طاولة مكتب ضخمة نوعاً ما, لكن الملفت للانتباه التقسيم الافتراضي الواضح للطاولة فأكثر من نصفها مرصوف بالمنفضات المتنوعة الأحجام والأشكال والمواد, فهناك المنفضة الحديدية, المنفضة الزجاجية, المنفضة الحجرية….الخ, منفضة على شكل كلب, أخرى على شكل جسد امرأة مستلقية, وأخريات كثيرات.
حدث أن دخلت مكتبه للمرة الأولى بعد اعتقالي بحوالي ستة أيام, جرى خلالها التحقيق الترافق مع التعذيب, وفي النهاية توجه المحقق نحوي قائلاً:
– وقع هون ولك حيوان!!!
– على شو بدي وقع؟؟؟
– على أقوالك يا خرا ..!!!
– بقدر أقرأ شو المكتوب بالأوراق؟
كانت رفسة إلى حنكي أسرع من إجابته: بدك تقرأ شو ياسافل؟؟؟
ومع تخلصي من كسور الأسنان التي رافقت الرفسة قلت دامياً:
– بس أنا ما بعرف شو مكتوب!!!
انتهى الحوار عند ذلك الحد, واستمرت المشاهد صامته بعد ذلك بتعذيب متواصل وفي نهاية كل جولة يقدم الأوراق نفسها, وبلغة صامته تحفظها العيون الخائفة فقط كان يأتي الجواب نفسه, وهلم جرا مع جولة جديدة من التعذيب.
استمر الصمت لمدة ثلاثة أيام حتى عاد الحوار من طرف واحد للمشهد:
– جهز حالك ولاك!!! وهكذا دخلت لأول مرة إلى ذلك المكتب ذو الجدران الستة رفع الرائد عبد الكريم سلامة ” كما علمت فيما بعد باسمه ودوره الوظيفي ” رأسه بتثاقل وبعينين فارغتين من أي معنى جاء صوته عميقاً وكأنما يصدر من شخص آخر:
– ليش ما بدك توقع على إفادتك يا منيك!!!
الصمت كان جداري الأول والأخير, وبتواضع ذليل حركت رأسي قليلاً نحو اليمين ثم إلى الأمام بإشارة لا تحمل أية معنى أو دلالة , كانت كافية لأن تطير إحدى المنافض من فوق المكتب لتوقف حركة رأسي قبل إكمال دورتها الكاملة.
كان من السرعة وشدة المهارة بحيث أنك تحتاج إلى تكرار المحاولة لأكثر من مرة حتى تصل إلى القدرة على تفادي إحداهما, تخليت وللحظة بأنه لا شك يتدرب على ذلك خارج الدوام الرسمي حتى حاز على تلك المهارة.
– تعا وقع على إفادتك يا سافل!!!
وهذه المرة أيضاً كان الصمت جوابي!!!
فجأة تغيرت ملامحه قليلاً وعاد إلى هدوء لا يتناسب والحالة. ملامح أكثر من بريئة ونظرات حيادية, وشفاه غير مزمومة.
– ما بدك توقع؟؟!! إيه … لآيري !!!
هكذا وبهدوء وبدون أي ضجيج انتهت المقبلة.
أما المرة الثانية التي تشرفت بمقابلة ذلك الكائن فكانت في السنة الرابعة من الاعتقال, والظروف لسنا في وارد الحديث عنها, ربما لمرة أخرى, تشرفنا جميعاً ” جميع المعتقلين ” لواحدة من أطرف المساومات في تاريخ الاعتقال السياسي: حيث تم إدخالنا واحداً تلو الأخر وبسرعة قياسية خارقة, كان عبد الكريم سلامة خلف طاولة المكتب ينظر في قائمة الأسماء أمامه, لم يحدث أن رفع رأسه مطلقاً وكأنه مشدود إلى ذلك بقوى خارقة, لم ألحظ وجهه في تلك المرة, لم أعاين تلك العيون الخالية من التعبير
– شو أسمك ولاك؟؟؟
– فلان الفلاني…..سيدي!!!
– بتتعاون معنا ولاك؟؟؟
– كلا سيدي!!!
– انقلع…..!!!
التالي: -شو اسمك ولاك؟؟؟
– علان العلاني….سيدي!!!!
– بتتعاون معنا ولاك؟؟؟
– نعم سيدي!!!
– انقلع!!!
وكل مساومة وأنتم بخير….