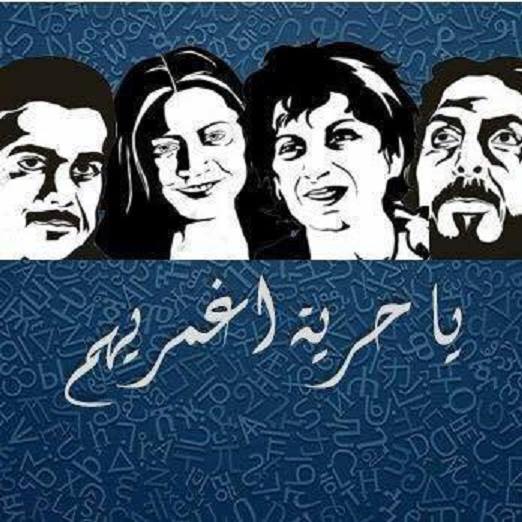المـوت الضـروري لـسـميـر قصيـر

ياسين الحاج صالح
على موعد مع الأستاذ غسان تويني، قصدنا، سمير قصير وانا، مبنى جريدة “النهار” الجديد في ساحة الشهداء. بعد ترجلنا من سيارته، واصل سمير كلاما عن الدولة الأمنية في لبنان. مازحته بالقول إني أجد في كلام اللبنانيين عن الدولة الأمنية غير قليل من الدلع! إذا كان لبنان دولة أمنية فماذا تكون سوريا؟!
التقينا الصحافي الكبير في مكتبه الأنيق الذي لم يكن قد ألفه بعد. تضاحك سمير وهو يروي لرئيس تحرير “النهار” ما نسبته إلى مفهوم الدولة الأمنية في لبنان من غنج (كانت هذه كلمته، استخدمت انا كلمة دلع)! تذكر الأستاذ غسان بضعة شهور أمضاها سجينا في لبنان في الخمسينات، خافضا من أهميتها قياسا إلى أزمنة السجن السورية في الربع الأخير من القرن العشرين.
كان ذلك في آب 2004. تسعة شهور وقتل سمير. لم يقتل لبضعة شهور. سافر جميعاً وتركنا وحيدين.
كتابة حافة الهاوية
نختزن، نحن السوريين، رصيدا هائلا من الشعور بانعدام الأمن، غرسته في أعماقنا تجارب صادمة مديدة. نعتبر أنفسنا مقياسا للا أمن (ربما ينافسنا العراقيون) ونحسد من يحظى ولو بالقليل منه. الأشياء الخطرة التي تثير لدينا منعكس اللاأمن كثيرة جدا. الكتابة فعل امني. الكلام فعل أمني. وكان فتح دكان حلاقة والعزاء بميت أفعالا امنية كما ذكّرتنا قائمة من 67 فعلا أعلن عن نزع الصفة الأمنية عنها أخيرا. السجناء السياسيون السابقون اجساد أمنية مشحونة بالخطر. في معسكر التدريب العسكري الصيفي الذي تلى خروجي من السجن بشهور قليلة هرب زملاء جامعيون مني كما يبتعد المرء عن مجذوم، أو ربما يهرب من سيارة مفخخة. لا ألومهم، مخالطتهم لي قد تغري “الأمن” باستخدامهم عيونا عليّ. بابتعادهم عني يبتعدون عن الشر ويغنّون له.
تطورت لدينا بفضل تلك التجارب حساسية أمنية شديدة. صرنا أرهف حسا للتغيرات الأمنية العاطفية، لاقتصاد الأمن العاطفي. حين نعتقل أو تساء معاملة بعضنا نقلق وننقبض بسبب نقص الحب والأمن. مثل رخوي يتكور في قوقعته حين يدهمه خطر خارجي. قبل خمس سنوات أطلقنا اسم “ربيع دمشق” على تحسن محدود في فرصنا في التجمع والتعبير الآمنين. اعتبرناه مكسبا مهما. نمت وتكاثفت الروابط بيننا بعد طول شح وتقاصر. احببنا انفسنا وبعضنا، ولو أتيح لنا الوقت لأحببنا حكّامنا. لكنهم لم يتركوا لنا فرصة. لا شأن لهم بالحب.
ابتهاجنا الغر ذاك يشير إلى ضعفنا وانسحاقنا، إلى عوزنا للحب واللطف. “ربيع دمشق” بالكامل اسم لشعورنا بشيء من الأمن بعد طول افتقاد له. هذا ما لا يدركه كثيرون. لا يدركون ما يبعثه انحسار الخوف المقيم في النفس من حب وحبور وتفاؤل، أو ما يثيره جلاء الانقباض عن النفس من انبساط وجذل.
كتب كثيرون منا كما كتبت، يا سمير. لم نكتب لأننا شجعان مثلك، بل للتمتع بحدودنا الآمنة الجديدة. مثل الطفل الذي ينام مع حذائه الجديد، كنا نداعب شعورنا بالأمن بمداعبة الخطر ذاته. مردود الأمن أكبر حين يكون نجاة من خطر أكبر، أو تمرسا بملاعبة خطر أكبر.
بعضنا يمارس كتابة حافة الهاوية، إن صح القول. يتمتع بالكتابة على الحدود، بمداعبة الخطوط الحمر. في ذلك تطلب شديد للأمن يصدر عن شعور دفين بانعدامه. نكرر التجارب الخطرة للسيطرة على خوفنا. نكتب مرة بعد مرة بعد مرة للتحرر من القلق.
لا نتحرر. تغدو الكتابة لعبة أمن وخطر لا مهرب منها. إدمان أمن. هذا أيضا ما لا يراه اصدقاء كثيرون لنا في سوريا ولبنان. يظنوننا شجعانا. لسنا كذلك. نكتب على حافة الخطر لأننا خائفون. نتدرب بالكتابة على مغالبة خوفنا.
تطبيع الفظيع
تتحدثون عن الدولة الأمنية يا سمير؟ مغنجون! كان في تعليقي شيء من الرغبة في انتزاع الاعتراف بما عانينا. لكن نقدنا ينطوي كذلك على تواطؤ منا مع الشرط الوحشي الذي وجدنا أنفسنا فيه. كي نتحمل الفظاعة كان لا بد من ان نخفف حساسيتنا حيال الفظيع. ومن هذه الحساسية المبلدة عمدا صدر حكمي بالدلع على لبناني سوري فلسطيني كان يتكلم على الدولة الأمنية- وكان اسمه سمير قصير. الدلع لا يقول شيئا عن الدولة الأمنية لديكم. يقول أشياء عن نظيرتها، وامها، لدينا. مفهومنا للدولة الأمنية يمثل تجاربنا الراعفة ومريعة معها، تجارب لا نفلح في تحملها دون درجة من الخضوع لها.
لا يعرف كثيرون ماذا جرى لنا. نحن أيضا لا نعرف. كنا محتاجين إلى عدم معرفة الفظيع كي نتحمله. كنا محتاجين إلى تطبيع وضعنا كي نتعايش معه. بتطبيعه، بإخراج المهانة والتعذيب من الشاذ إلى الطبيعي، كنا نخرجه من الإحساس ومن المعرفة. نرفع عتبة الشعور بالظلم والمهانة كي نتحمل ما دونها. من رفضوا التطبيع والتعود انتحروا. لم يتحرروا من الهوان دون التحرر من الحياة ذاتها: طاروا. لكن من تقبلوهما هانوا وتدنت سيادتهم على حياتهم. بحثنا عن تسويات بين الانتحار والهوان. عثرنا ولم نعثر. بين الحياة والحرية فضلنا الأولى، فصرنا عبيدا. تسنى أحيانا، ولم يتسنّ غالب الأحيان، لجدلية السيد والعبد أن تعمل. لا يزال العبيد عاجزين عن تحرير اسيادهم و… أنفسهم. فهي لا تعمل من تلقاء ذاتها. تحتاج إلى شيء مختلف عن السيد والعبد معا: العمل وإمكانية السيادة على الذات والعالم عبر العمل. هذا قلما يكون متاحا لدينا. السلطة كل شيء، العمل لا شيء.
لم نبدأ بالشعور في اي حضيض سحيق كنا إلا في السنوات الأخيرة. من دهشة الناس حيال القصص التي يسمعون منا صرنا ندرك هول ما كنا فيه. دهشتهم أعادت تربيتنا. استبطنّا استنكارهم للوحشية كما قد يستبطن الطفل اشمئزاز والديه من القذارة او نفورهم من الأذى. استعدنا شيئا فشيئا شعورنا بالعدالة، فهالنا الظلم الفادح الذي اصابنا. انخفضت عتبة الشعور بالظلم وحققنا درجة بسيطة من الارتقاء الأخلاقي. الطغيان يحمي نفسه بخفض الشعور الاخلاقي عند ضحاياه، بتعطيل قدرتهم على الاستنكار والاعتراض. وبالخصوص بجعل نفسه جزءا من نظام الطبيعة ذاتها. اليوم لا يزال حسنا بالعدل والظلم مثلوما. فالناس لا يحكمون على امر بأنه ظالم إلا بقدر ما يستطيعون استنكاره والاحتجاج عليه وتغييره، إن حوّرنا، يا سمير، فكرة شيخنا ماركس. نعجز عن تغيير الأحوال فنجنح، صونا لكرامتنا، إلى اعتبارها عادلة وطبيعية. ولا نستطيع الاحتجاج على الدولة الأمنية بغير صوت خافت، فنعتبر من يستطيعون الاحتجاج مدللين مغنجين. على أن احتجاجنا هذا، ولو خافتا، دليل على أن مرحلة الدولة الأمنية أخذت تنطوي بالمعنى التاريخي.
بالمعنى التاريخي؟ كان ماركس يفكر بكل الأشياء على خلفية التاريخ. لم نعد نفعل. صبرنا نفد. ولم يعد يعزّينا ان الدولة الأمنية تحفر قبرها بيدها، وأن أجهزتها بالذات ستكون حجر الطاحون الذي تحمله في عنقها ليغرقها في نهر التاريخ. صرنا أكثر انانية. نفكر في مقياس العمر الإنساني. نخشى مما تنتجه الغيريات وعقائد الخلاص و”المعاني التاريخية” من سلطات وحشية.
الطنط والوحش
في سجن تدمر كان عناصر الشرطة العسكرية المدربون على القسوة، المنتخبون لذلك المحبس الحزين، يعيّروننا بأننا طنطات. تعرف ما معنى طنط يا سمير؟ في اللغة العسكرية والعقيدية السورية، الطنط هو الفتى الدلوع الناعم الذي لا يتحمل المصاعب. غنوج. مشكوك في رجولته أيضا. كان في اعتراضنا على النظام الأمني غنج لا يطاق ووقاحة لا تحتمل. وما يثير الاحتقار أكثر اننا كنا نحتج عليه ونريد تغييره، والعالم، بالحبر والورق والكلمات. ليس غير الطنطات يفعلون ذلك! هل تتخيل يا سمير هذه الطنطية الثورية التي تريد تغيير العالم؟
نقيض الطنط هو “الرجّال” (أو القبضاي أو الوحش)، الذكر الخشن، الفحل، الذي يحتقر النعومة والنساء والرهافة والرقة. بصورة متناقضة كانت صفتنا الطنطية تسوّغ تعذيبنا الذي يفترض ان يساهم في تخشيننا وتأهيلنا تأهيلا وطنيا صحيحا. نعذب لأننا طنطات وكي نتطهر من طنطيتنا في الوقت نفسه. “الرجالية” أو القبضاوية جزء من التأهيل الوطني.
الطنط لا يقتل نملة، ولا يتحمل رؤية الدم. القبضاي يقتل، الدم جزء من عالمه الطبيعي. وحش! الوحش كلمة مديح ما بعدها مديح لعناصر “سرايا الدفاع” التي كان يقودها السيد رفعت الأسد قبل حلها عام 1984. الوحوش يربّون على الفتك بالضعفاء واحتقار الألم واقتحام الأخطار. يروون متفاخرين ما فعلوه في ملاعب الدم.
الطنط أيضا هو ابن المدينة، الغني، الماكر، الألعبان. الرجّال القبضاي هو ابن القرية، القاسي، الذي يتحمل كل شيء. ابن المدينة سياسي وتاجر، ليبيرالي وبراغماتي، من تلقاء ذاته. الريفي عقيدي ومبدئي وثوري وفلاح ابن فلاح أو ابن بدوي تكوينيا. وإذا كان يكره شيئا فهو التاجر. فهذا يستغله ويستغفله معا، ويمثل كل ما ليس هو وما لا يستطيع أن يكون. البلاد السورية تحت الحكم القبضاوي منذ عام 1963.
الطنط والرجّال مدركان اساسيان في إيديولوجيا الحكم السوري، البعثي. لكن الحال مثل ذلك أو قريب منه في العقائد الشيوعية والناصرية والإسلامية. المناضل الشيوعي ينبغي أن يكون صلبا فولاذيا. ربما قرأت يا سمير روايتي “كيف سقينا الفولاذ؟” و”قصيدة تربوية”: نشيدان للصلابة والقسوة. والعبوس: المناضل كثير التقطيب قليل الضحك. في ايامنا الأولى في السجن، وبعد تجربة التحقيق الراضة، ازدرى منير ذو الثمانية عشر عاما، نعومته المفترضة. صار ينام على بلاط المهجع كي يروض جسده و”يقهر نفسه”. طوال سنوات سمّيناه: منير قاهر النفس.
العقيدتان الناصرية والإسلامية تعليان كذلك من قيم الخشونة والصلابة والجهاد (مع تثقيل وزن المكون العضلي وتخفيف الروحي في الجهاد، على غرار أخينا أبو مصعب). في مصر الناصرية أيضا كان سجناء سياسيون يمضون اكثر من المدة التي قضت بها المحاكم. هل يعني ذلك، يا سمير، أن بنية أنظمتنا أسوأ من عدالتها هي نفسها؟
كان ثمة درجة من التهافت في معارضتنا: نعارض نظاما قبضاويا بإيديولوجيات وثقافة سياسية قبضاوية. كانت حساسيتنا أخذت تتغير والحق يقال. لكنها عملية لم تكتمل وقتها ولا اليوم. “عالم أكثر مدنية” كما كتبت لي في إهداء كتابك: “عسكر على مين؟” هو عالم بلا قبضايات، ولا تغريه القبضاوية. بل إن عالماً أكثر مدنية هو عالم طنطي، مغناج. عالم بلا جيوش ولا حروب. الجيوش والحروب هي مصانع القبضايات والوحوش والعقائد القبضاوية.
الطهر المميت
الطنطية ليست إيديولوجية احد، إنها النسخة السلبية للرجّالية القبضاوية. وهي اختراع مسجل باسم الأخيرة. الشيء الذي تقصيه وتتطهر منه كي تنتج الهوية الضافية المطلوبة. سمير، في أواخر عام 1979، وفي المؤتمر السابع لحزب البعث، اقترح السيد رفعت الأسد “إنشاء معسكرات تدريبية بغرض تخضير الصحراء وتصحيح المسار الوطني للخاطئين وطنياً، ويدعى إلى هذه المعسكرات كل من تحكم عليه المحاكم الشعبية التي تمتلك سلطة قانون التطهير الوطني”. قانون التطهير الوطني هو اقتراح من قائد سرايا الدفاع ذاته “يطال كل منحرف عن المسار الوطني ممن يعتنق أي مبادئ هدامة تمس الفكر القومي أو السلامة الوطنية”. بعد 7 شهور فقط حمّر الصحراء التدمرية، بدل ان يخضّرها، بدماء ألف من “الخاطئين وطنيا”.
مستعرضا “أطر الجريمة وأساليب قمعها واجتثاثها بشكل ثوري عملي أصيل”، أبدع الرجل وقتها نظرية تدعو أن يكون العقل الأمني سريا كي لا تعرف نقاط ضعفه وتستبق تحركاته، سمّاها نظرية “سرية العقل الأمني”.
كان معنيا بإحاطة أمن الأقوياء بسياج من السرية، تاركا الضعفاء منكشفين تحت رحمة اللامتوقع. وفقا لهذه النظرية “العمل الأمني فن مقدس لعقل مستنير”. وربما من باب تدعيم السرية هذه اقترح أن يحصر “سكن القياديين في حي معين فيتهيأ لهم خلال هذا السكن وسط من الصداقات المتآلفة والهيبة العالية والأمن الكامل لأن شدة الاختلاط وبمستويات مختلفة متنافرة تجعل الرفيق معرضاً للانزلاقات التي يدبرها المتسللون والمفسدون والمخربون”.
متأكد أن أول كلمة ستخطر في بالك، يا سمير، هي: فاشي! لا علاقة لي! إنها كلمتك أنت! للشهداء فوائد كثيرة يا سمير؛ من أنبلها اننا “نعترف عليهم” ونلصق بهم، امام المحققين، سوء أفعالنا ومناهضتنا لأهداف ثوراتنا المجيدة وانتمائنا لتنظيمات سرية تهدف الى قلب أنظمة حكمنا الوديعة. من نسّبك الى التنظيم؟ سمير! من تعرف من أعضاء التنظيم؟ سمير وهيثم ومنير ورضا…! من قال فاشي؟ سمير! لم لم تبلغ عنه؟ مات، صار وراء التبليغ! يغيب الشهداء ليخففوا عذاب رفاقهم الأحياء.
كما هي عادة الثورات جميعا يُطرد الثوار أو يُقتلون وتطبّق برامجهم. أخفقت ثورة قادئ السرايا، لكن برنامجه طُبّق ونظرياته مورست. ولا ريب أنك عرفت قبل سفرك الأخير أنه يخطط للعودة إلى البلاد من اجل “حماية الوحدة الوطنية”… بلا زيادة أو نقصان!
الباقي بديهي: القبضاوية عقيدة تطهير، ارتباطها بالشمولية متواتر وأكيد. لا فرق بين تطهير الطنطات أو “الخاطئين وطنياً” وتطهير المرضى والمشوهين في المانيا الهتلرية. حملات التطهير الستالينية كانت تستند الى مبدأ مماثل: خونة، رجعيون، مائعون. الميوعة خصوصا صفة لا يطيقها الستاليني الصلب. رفعت كان يطالب بـ: “عزل المرضى قومياً ووطنياً بأمراض شتى من مثل الانتماء إلى الهرطقة الدينية أو التشبث بأفكار مستوردة أو مشبوهة والمريض بالتعصب القبلي أو العشائري أو العائلي… إلخ وتخليص المجتمع الصحيح من أوبئتهم وأمراضهم”.
“مرضى وطنيا وقوميا”؟ هل قلتَ فاشي؟ الافكار المستوردة من لوازم نقاء العرق وصفاء الهوية وطهر الحزب و”تخليص المجتمع”. القبائل والعشائر والعوائل شوائب قديمة. المجتمع هوية أو ذات. الكمالة هي نظرية المؤامرة والبارانويا، وموتك! الطهارة تقتضي!