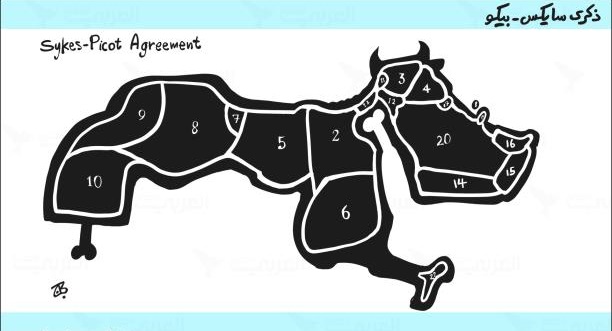أزمة الهوية السورية/ آزاد نبي

هيّمن الخطاب العسكري على عموم الحياة المدنية والسياسية في المجتمع السوري، إزاء عنف آلة النظام وعنف المعارضة المضاد طوال ثلاث سنوات من الاحتجاج السلمي المنادي بالتغيير الديمقراطي والحرية، تلته أقسى مشاهد العنف والاحتراب الداخلي، وأطاح بالتعايش والسلم الأهليين عبر تفتيت النسيج السوري المتماسك نسبياً، وانحلاله إلى فئويات منقسمة ومرهونة لإرادة ووصاية الخارج، ما شكل انزياحاً للثورة الوطنية الشعبية المتمدنة، وإقحامها بطابع الصراع القبليّ والجهويّ، وبدا واضحاً ان غياب هذا الجامع الوطني العام قادنا مجدداً إلى أزمة الهوية أو مأزق الانتماء والذات.
باتساق عموم الأنظمة والأحزاب السياسية الشمولية القومية منها والدينية والاشتراكية، أبدى النظام السياسي السوري نزعة مفرطة في التسلّط والسطوة، تتكئ على نمط أيديولوجي يقوم على التماهي بين مفهوم الدولة والمجتمع والحزب الحاكم، هو الأكثر انغلاقاً وانسداداً أمام المشاركة الشعبية الفعلية في الحياة المدنية والسياسية، والأكثر اكتساحاً واجتثاثاً في تغييب الهوية الوطنية، حيث صادر الشرعية القانونية والسياسية للمجتمع السوري وتوج نفسه ناطقاً بلسانه، وأصبحت مزاولة العمل والنشاط السياسي حكراً عليه، باعتباره الحامي الوحيد للمصلحة الوطنية، والضامن الذي يحفظ سلامة وأمن النظام السياسي والاجتماعي من البؤس والتفسخ طبقاً لنظرية ‘الممانعة’. ولم يكتف فقط بهذا السحق للممارسة السياسية التي تستند الى موقف النقيض منه، تكشف مثالبه أو تصحح مساره، بل اقتلع الشعور والانتماء الفردي في المجتمع السياسي وقلّص دوره كجزء فاعل ومساهم، واجتاح البيئة التي تشكل له حيزاً يعبر فيه، عندما بادر إلى عسكرة الحياة والسياسة والثقافة، كما هو الحال في التغلب على أي إرادة لا تخضع أو تنصاع للمطرقة العسكرية.. كل هذا التمحيق في الوعي السياسي الآخر عكس عملياً ركونه إلى إنتاج مفهوم نظري مشوّه فرضه على الكيان السياسي، صاحبه إلغاء وتغييب مطلق ومقصود لعموم الدلالات التاريخية والثقافية الثابتة، وإزالة عموم الفروقات والاختلافات الموجودة في القاع الأهلي طبقاً لمفهوم كوزمولوجي زائف، تجلى في أسمى معاييره بالعروبة المقدّسة، الممتنعة عن الإفراز من المضمون الأيديولوجي في خطابه التقليدي، إلى حد ابتذالها وتحقيرها بمفهوم القطرية المجزأة عوضاً عن الوطنية الشاملة، التي (الأخيرة) تتموضع على تعارض ونقيض مستدام مع الأولى، ولن تستقر أو تكتمل ما لم تبلغ محتواها في توحيد الأمة العربية وجمع شتاتها، فهي بحال من الأحوال ظرفية وعابرة، وعليه نفهم لماذا حول نظام الأسد الشعب السوري إلى الشعب العربي السوري أو الجمهورية السورية إلى الجمهورية المدرجة في خانة العروبة. بهذا المعنى يبدو غياب الحالة الوطنية في سورية تحصيل حاصل لا جدل فيها، إذ أنها نتاج أوهام وخدع أيديولوجية تتخطى الإرادة العامة والمصلحة الشعبية وتوظفها في الجانب المضاد، فهي في الأساس كامنة وقائمة في هوية محصورة ومبددة، ترغم الجميع على الانعزال والتفرقة والتوجس. فضلاً عن التضليل والزيف الطويل الممارس بغية اكتساب شرعية البقاء والاستمرار. هذا التمييع والتبديد للهوية السورية بالطابع القومي المؤدلج، فرض تباعداً على الأنساق الدينية والطائفية المتنوعة أيضاً، على اختلاف فرقها ومذاهبها، ليس من قبيل الاحتواء والانصهار، إنما بالالتفاف والمماهاة مع العامل القومي المحكوم بوعي ثنائي الأممية (العروبة والإسلام) ذي فحوى منغلق على انخراط الآخر في مجتمع سياسي حقيقي، ومدعاة تجاوز التعاقد والتعارض في المجتمع المدني، حتى أصبح العامل الديني موصوفا متلازما ولاحقا للنسق الثنائي الأممية، الذي يتناقض بوضوح مع طبيعة التكوين القائم على التعدد والتلون، ولا يستقيم مع الهوية في جوهرها الفردي والاجتماعي ولا يعبر عن حريَّتها وخصوصيتها، كذلك لا ينسجم مع العلاقة التاريخية التي تؤسس على مبدأ التماثل والمساواة والعدالة الاجتماعية، بالتالي لا يعدو كونه استغلالاً مضمراً لمظهر من مظاهر كسب تأييد الأكثرية على الأقلية وسلخها عن محيطها الوطني العام، أمام التهديد القادم من تسلّط الأكثرية، هكذا سعى النظام السياسي السوري إلى الثبات في دائرة المركز وأي تهديد بأفوله وزواله هو تهديد للنسيج الاجتماعي بأسره، وبوجوده فقط يقترن ويتحقق التوازن الاجتماعي.
هذا التصور كرس الإشكالية التاريخية المزروعة أمام المجتمع السياسي السوري المركب والركيك في بنيته غير المستقرة، وأمام العقل الجمعي القاصر والمنغلق، من هنا ينبغي النظر إلى الواقع السياسي في سياق الممكنات الحالية، ليس بإعادة النموذج البعثي أو تكرار تجربة أشد إخفاقاً وانتكاساً مما سبق، إنما من خلال إعادة تركيب البنية المجتمعية على مبدأ الحق والواجب وتشكيل الكيان السياسي طبقاً لشروطها الأخلاقية والاجتماعية المتوازنة والمتكاملة، بما يضمن عدم تناقضها بنيوياً، وينبغي الرهان على تحديد الهوية السورية وفقاً لدلالاتها الراهنة، على قاعدة التعدد والمساواة والإنصاف، يكفل بعدم تقويض الكيان الاجتماعي على حساب ولادة جمهورية جديدة مقبلة على التفكك والانقسام، تسودها عصبيات بدائية وتغدو تمهيداً لاستبداد وتطرف آخر. إن الدرّس الرئيس الذي يمكن استخلاصه من تجارب الحروب الأهلية نتيجة القهر والكبت السياسي الطويل على مر عقود، هو في الأصل عائد إلى عوامل التفاضل والهيمنة وانعدام العدالة الاجتماعية والقانون الناظم، ومن الخطأ الاعتقاد ان ثمة جماعة اثنية أو مذهبية أو دينية أو حتى حزبية ستخضع أو تستسلم لأخرى إزاء تهميشها وإقصائها وتجريدها من حقوقها السياسية تحت ذرائع واهية، هذا وهم، وفي المحصلة العنف يمهد لعنف مضاد، ومن نافل القوّل إن العربي السوري مثلاً لا يتفوق على الكردي السوري بانتمائه ولا أكثر منه حرصاً على إنجاز نظام ديمقراطي حداثي، فكما هو الانتماء العرقي مقدس للأول فإنه أكثر قداسة للآخر.
المأزق السوري لم يعد محصوراً فقط بوجود نظام شرس متغطرس يفتقد إلى أدنى معايير أخلاقية إنسانية، متوحش على المدنيين ويعيث بمؤسسات الدولة فساداً، أو بضرورة الإطاحة بأجهزته العسكرية والأمنية الصلبة وتهديمها، ثمة خلل في هذا التصور، الذي لا يستوي على الإحاطة المعرفية الكلية والشاملة بجوهر المأزق، ولا ينكفئ منظرو هذا الاتجاه عن تناول الأزمة السورية من منظور متعال أحادي الجانب، متمثل في تغافل تحديد الركيزة والأساس الذي يستوجب أن تبنى عليه طبيعة المجتمع المدني وشروط تماسكه واستقراره، وطبيعة الهوية الوطنية القادمة، إن التأكيد على استقلالية المجتمع المدني ونبذ الخلط بينه وبين سلطة سياسية قادمة تصون وتحترم هذا الحق المدني، وبين الحق السياسي للجماعة البشرية المستقلة بكينونتها السياسية (عرقيةمذهبية) بوصفها جزءا من الهوية السورية لا يحتاج إلى تفويض أو تخويل من سلطة دستورية، كما تتحجج به رموز المعارضة السياسية، نظراً لوجود هذا الانتماء الأزلي والواقع التاريخي المديد السابق على الجغرافية المتحولة طبقاً لظروفها الآنية، فالعربي السوري ما هو بأكثر أصالة ونقاء من الكردي السوري ولا المسيحي السوري أقل أصالة ونقاء من المسلم السوري. ما يتعين عليه البدء أولاً هو الإقرار بتعددية الشعب السوري التي مهدت لقيام هذا الكيان الاجتماعي واستقلاله الذاتي، قبل الخوض في تكوين إطار الدولة العام، هذا الاعتقاد هو المنبع لضرورة الوعي بالشروط المعرفية والوطنية الرئيسية والمهمة لتأسيس السلطة السياسية وتحديد صلاحيتها والحد من سلطتها وتعسفها، ومنه تنبثق الهوية السورية الأنسب وملامح النظام الديمقراطي المنشود، بتعبير آخر، إن تحديد طبيعة الدولة السورية تنبثق وتتولد قياساً إلى البنية المجتمعية بأنساقها العرقية والدينية والمذهبية المتعددة، وهذه الدولة لن تتبلور كينونتها ما لم تبلغ إلى احتواء وتأطير شامل وكامل لهذا الوجود المجتمعي بحيث يميز بين الهوية العامة للدولة والهوية الذاتية للجماعة الإثنية المعينة، ذلكم هو الشرط الأساس للحفاظ على ديمومتها وكينونتها. ومن المهم الإشارة الى إن الهوية نتاج وعي بالحرية والاستقلال بتعبير جاد الجباعي، إنه بمعنى من المعاني معرفة الذات وتعريفها وترجمتها في صياغة جملة علاقات مع سائر جماعات تحمل ذوات مختلفة في إطار اتفاق وتفاهم على تعايش سليم في ظل مجتمع أخلاقي جامع قوامه المواطنة والحرية الذاتية، يتساوى فيه الجميع في الحق والواجب.
خلاصة القول، لا وجود لهوية مقدسة وواحدة لسورية في ظل عدمية الاعتراف بهوية شعبها الذاتية المتنوعة، وما أن تتحقق شروط هذه الأخيرة الذاتية حينها يتعيّن علينا القول إن سورية أصبحت لكل السوريين.
‘ كاتب سوري
القدس العربي