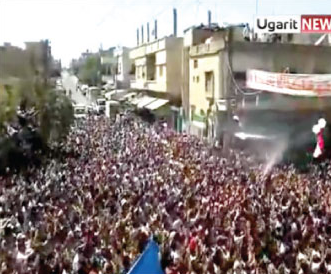مقومات الإصلاح الديني المنشود/ سمير حمدي
منذ اندلاع الثورات العربية، تصاعد الجدل بشأن علاقة الديني بالسياسي، خصوصاً مع ظهور جماعاتٍ تتبنى خطابات دينية متشددة، وطائفية في أحيان كثيرة، حولت ماهية الصراع الأصلي من حالته الأولى، بوصفه محاولة لإطاحة أنظمة الاستبداد، وبناء تصور جديد لكيانات سياسيةٍ قائمةٍ على بسط الحريات والإيمان بالتعددية، وهو ما أعاد طرح السؤال عن أهمية تطوير الخطاب الديني والإصلاحات الضرورية التي يمكن إنجازها في هذا السياق.
ويمكن القول إن فكرة الإصلاح الديني، في إطارها الإسلامي، ظلت تتكرر طوال فترات تاريخ الإسلام، تحت مقولة التجديد “إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها”، غير أنها، في صورها الكثيرة، اتخذت ميسماً واحداً، يمكن اختصاره في ما يلي:
ـ أمثَلة الماضي، والتماهي المتخيل معه.
ـ الدعوة إلى العودة إلى الدين، في صورته الأكثر صفاء ونقاء، باعتبار أن كل الأزمات إنما هي نتاج الزيغ عن هذه الصورة الأولى المفترضة.
ـ التصور المعكوس للزمان التاريخي، بحيث كلما ابتعدنا عن الأصل، ازداد الفساد، وفقدنا الصورة المثلى التي تأسست لحظة انبجاس الدعوة.
ـ الانتصار للتدين الشكلي ولحرفية النص على حساب منطق التأويل والاجتهاد والانفتاح على التجارب الإنسانية المغايرة.
ومن هذا المنطلق، ظلت المقولات الأساسية للدين حاضرة وبقوة، تفعل فعلها في الخطاب الديني بما فيه الخطاب “التجديدي” (مقولات دار الإسلام ودار الحرب، الولاء والبراء، الكفر والإيمان)، وقد زاد الطارئ الخارجي ممثلاً في الاستعمار، في تكثيف هذه المقولات، ومنحها شحنة إيديولوجية عنيفة، وظفتها حتى الأطراف غير المتدينة في المعركة من أجل التحرير. وبظهور دولة ما بعد الاستقلال، تصاعدت أزمة الخطاب الديني في ظل تبني الأنظمة الحاكمة مقولات هذا الخطاب، في تبرير ممارساتها السلطوية، أو في مواجهة خصومها (سواء أطراف المعارضة العلمانية أو أنصار التيارات الإسلامية)، وهو أمر جعل إعادة النظر في طبيعة الإصلاح الديني المنشود مطلباً ملحاً في إطار المعركة الإصلاحية الشاملة (سياسياً واقتصادياً واجتماعياً) ما بعد الثورات العربية.
إن كل خطاب ديني هو، في النهاية، قائم على جملة من البنى المركزية التي لا يمكن نفيها، أو الادعاء أنها قابلة للإلغاء أو النسخ. وعلى هذا الأساس، يمكن القول، مع إيريك فروم، “إن ديناً بعينه طالما هو قادر على تحريك السلوك، ليس مجرد مجموعة معتقدات وشرائع، لكنه إيمان مغروس بجذوره في البناء الخاص للشخصية الفردية، وطالما هو دين جماعة من البشر، فإن له جذوراً في الشخصية الاجتماعية أيضاً”، ما يعني أن أي إصلاح ديني حقيقي لا ينبغي أن يرتبط، بأي صورة، بالمطالبة بإلغاء المقولات الرئيسية للدين، أو الدعوة إلى إبعاد النصوص الأساسية التي يقوم عليها. ذلك إنه من غير الممكن عقلاً، وأيضاً، من واقع التجربة، أن تتخلى العقائد عن نصوصها المؤسِسة، بل إن كل محاولة لمصادمتها بصورة فجة لن تثير إلا مزيداً من ردود الأفعال المتشنجة، وتزيد من الالتفاف حول أنصار الخطاب الأشد تشدداً، فالإصلاح الديني يتم، أولاً وأساساً، على مستوى العقول (إصلاح التعليم ونشر الثقافة التنويرية العقلانية )، وثانياً على مستوى الممارسة وأدوات التأويل، فليس المطلوب نفي الدين، أو حشره في الزاوية، وإنما التأسيس لتصورٍ، يتم فيه التمايز بين المجالين، الديني والسياسي، وأعتقد أن كثيرين ممن يتصورون أنهم أعداء هذا الفصل وهذا التمايز سيقبلون به، إن تأكدوا أن القيمة الحاكمة والمرجعية النهائية للمجتمع، وضمن ذلك مؤسسات صنع القرار، هي القيمة المطلقة (الحرية ،العدالة ،المساواة)، وليس لصالح فئةٍ، أو مجموعةٍ، أو طبقة. ومن هنا، نكتشف مدى التواشج بين الإصلاحين، الديني والسياسي، لأنه ثمة فرق كبير بين فصل الدين عن الدولة وهيمنة الدولة على الدين.
فالممارسة اليومية، حتى لدى أكثر الجماعات تديناً، هي، في جوهرها، ممارسة علمانية، حتى وإن اتخذت لبوساً دينياً، فأي جماعة إنسانية، مهما بلغ تدينها، بما في ذلك المسلمون، لابد أن تتعامل، في أحيانٍ كثيرة، مع الزمان والمكان والطبيعة والجسد، من خلال إجراءات زمنية صارمة، تراعي فيها المصلحة ومنطق التوازن بين بؤر النفوذ المختلفة في المجتمع. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن الإصلاح الديني المنشود ينبغي أن يتسم بما يلي:
أولاً: ليس المطلوب نفي المقولات الرئيسية للدين (بما فيها التكفير)، لأنه أمر غير ممكن، وإنما ينبغي التركيز على الفصل بين ما هو مجال للاعتقاد وما هو مجال للممارسة التي تخضع للقانون ولسلطة الدولة التي يُؤسس لها المجتمع ضمن توافق معين.
ثانياً: ما هو ديني قد يتحول إلى مشكلة إذا أقصيناه، وأحس المتدين أنه محاصر، وما تكشف عنه التجربة أن الخطاب الديني يمكنه أن يغذي أشكال الصراع، ويدفعها إلى مداها الأقصى، إذا لم يُمنح الفرصة، ليظل جزءاً من الحراك الاجتماعي، ولكن، ضمن ضوابط تمنع عنه التوظيف السياسي من السلطة أو المعارضة، على حدٍ سواء.
ثالثاً: ينبغي رفع القداسة عن الممارسة الإنسانية مهما كانت، ومن باب أولى الفعل السياسي، ما يعني أن لا أحد في وسعه الادعاء أنه مخول للحديث باسم الدين.
رابعاً: لا ينبغي أن يُطرح الإصلاح الديني بمعزل عن الإصلاح الشامل لكل المجالات، ففي أحيان كثيرة، يكون الإغراق في التدين نتاجاً لحيف اجتماعي، أو لظلم سياسي، يشعر به قسم من المجتمع، ما يدفعه نحو المقدس، بحثاً عن العدل، والتماساً للإنصاف، وتحرراً من الظلم، وإن بصورة لاواقعية.
ولا يمكن أن يتجرد الإنسان من الحاجة إلى التدين، وقد تكون إحدى مميزاته الأكثر التصاقاً به، أما تمظهراتها فهي، على حد سواء “الدافع إلى المنجزات الأكثر خصباً وروعة والجرائم الأكثر إيلاماً”، كما يقول جيل غاستون غرانجي. وبالنظر إلى ما يكتسيه التدين من أهمية، فإن قضايا الإصلاح الديني تظل مطروحة وبشدة، ولا يمكن حلها إلا بنوع من التوافق الضروري بين الأطراف الفاعلة لبناء عقد اجتماعي جديد، يتولى ضبط مجال ما هو ديني وما هو سياسي، ويضع الأمور في نصابها، وهذه قضايا ينبغي حسمها، اليوم قبل الغد، لأنها لم تعد تحتمل التأجيل.
العربي الجديد