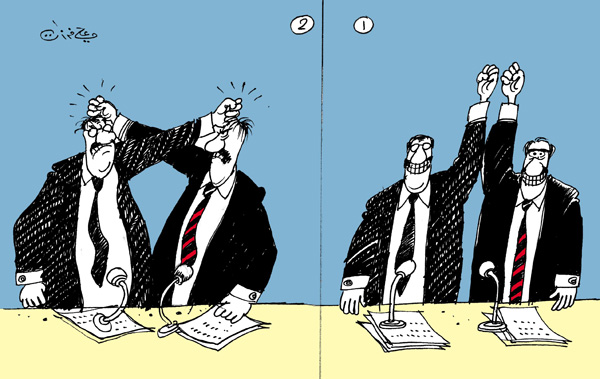بين ماضٍ عاثر ومستقبل حائر/ فاروق مردم بك

ما زال في العالم العربي يساريّون سعداء، يستضيئون بأنوار «الماركسيّة – اللينينيّة»، وفيه يساريّون قدماء، ارتدَّ نصفهم إلى ليبيراليّة «مجتمع – مدنيّة» باهتة، والنصف الثاني إلى أصوليّة قوميّة و/ أو دينيّة، تتّخذ من «الممانعة» شعاراً. يقف اليساريّ المُعاند بعيداً عن هؤلاء وعن أولئك، متأمّلاً في عالمٍ عجيبٍ لا يكفي لفهمه وتغييره ما تعلّمه في الكتب، ولا ما استخلصه من تجاربه السابقة. وينتابه الأسى كلّما أطلّ من حاضره على ماضٍ بات أطلالاً، يحفظ منه في القلب تضحيات أجيالٍ من المناضلين، وعلى مستقبلٍ غامضٍ لا يتبيّن له منه إلّا أنّ عدوّه اللدود، الرأسماليّة، سيزداد فيه توحّشاً وتخريباً لعلاقة الإنسان بالإنسان، والإنسان بالطبيعة.
يعرف اليساريّ المعاند أنّ اليسار في العالم بأسره، وليس في العالم العربيّ وحده، يتخبّط في أزمةٍ عميقة الجذور، احتدّت بعد انهيار الانظمة «الاشتراكيّة» وتغوّل الليبيراليّة في ثوبها الجديد وهيمنة إيديولوجيّتها في الثقافة والحياة اليوميّة. ويُدرك أنّ يساريّته تقتضي منه أن يقسو على نفسه وأن يسعى إلى استكشاف أصول هذه الأزمة، على الأقلّ خلال السنوات الثلاثين التي تبعت الحرب العالميّة الثانية، وشُبّه فيها لليسار الشيوعي حيثما وُجد أنّه موعودٌ بحصادٍ قريب، ولليسار الاشتراكي-الديموقراطي في البلدان الصناعيّة الغنيّة أنّه قادرٌ على «ترشيد» الرأسماليّة إلى الأبد.
*****
انتهت الحرب بانتصار الاتّحاد السوفييتي، الذي بسط سيطرته على أوروبا الشرقيّة، وانتصرت الثورة الصينيّة بعد سنواتٍ طويلة من النضال الضاري، وامتدّ نفوذ الشيوعيّين في أوروبا الغربيّة بفضل مشاركتهم الشجاعة في مقاومة الاحتلال النازي والفاشيّة، وازدهرت حركات التحرّر الوطني في العالم الثالث ودفعتها الحرب الباردة إلى التحالف أو إلى التعامل الإيجابي مع «المعسكر الاشتراكي الصديق». مع ذلك، مَنْ مِنَ الشيوعيّين، ما عدا السعداء البلهاء منهم، يُنكر في أيّامنا أنّ «الدودة كانت تنخر التُفّاحة»؟ غير أنّ سجلّ الرأسماليّة الدمويّ، في عقر دارها وفي المستعمرات والمحميّات، منع أسلافهم من مساءلة التجارب «الاشتراكيّة» الفعليّة، منذ ثورة أكتوبر في روسيا، والتحرّي عمّا إذا كانت تتوافق مع ما يعتقدون أنّه منطلق نضالهم وغايته البعيدة، والاطّلاع على الأدبيّات اليساريّة المُعارضة التي اقتصر بعضها على مُحاكمة البيروقراطيّة الستالينيّة والتنديد بجرائمها (الأدبيّات التروتسكيّة)، وشمل بعضها في نقده اللينينيّة، ومعها التروتسكيّة ومُجمل الثورة البلشفيّة (الأدبيّات المجالسيّة والفوضويّة-النقابيّة، ومجموعة «اشتراكيّة أو بربريّة»، إلخ). منعتهم أيضاً شبكة العلاقات الرفاقيّة الحميمة التي كانت تربط بين الشيوعيّين، خصوصاً في الضواحي العمّاليّة الأوروبيّة، وانتظامهم في نقاباتٍ واتّحاداتٍ نسائية وشبابيّة ورياضيّة وثقافيّة، بحيث كانوا يُشكّلون مجتمعاً بديلاً يحكمه الحزب وتُقام فيه شعائر «الماركسيّة-اللينينيّة» كما سنّها الرفاق السوفييت. ولم يُسفر انشقاق مُثقّفين شيوعيّين لامعين في أوروبا عن أحزابهم على أثر قمع الانتفاضة المجريّة في تشرين الثاني 1956، ولا فضحُ جرائم ستالين بصورةٍ رسميّة قبل ذلك ببضعة شهور، في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي، ولا الوجهة الاستقلاليّة عن موسكو التي بدأ الحزب الشيوعي الإيطالي بانتهاجها على استحياء، عن وعيٍ جديد بطبيعة الأنظمة «الاشتراكيّة» القائمة وبضرورة «فكّ الارتباط» بينها وبين اليوتوبيا الشيوعيّة.
وربّما كان الصراع الصيني – السوفييتي الذي استفحل في الستّينات هو العامل الرئيس في البدء بالمساءلة على نطاق واسع نسبيّاً، إذ أنّه أنهى الأحاديّة القطبيّة في الحركة الشيوعيّة وفتح الباب على مصراعيه للسجال بين مُختلف التيّارات الماركسيّة – وهو ما لم يحدث إلّا في حدودٍ ضيّقة جدّاً بعد انشقاق يوغوسلافيا في 1948.
كان الوضع العالمي بين مدٍّ وجزر، خلافاً لما كان يُقال عن «غلبة ريح الشرق على ريح الغرب»: خاضت الولايات المتّحدة حرباً استعماريّة في الهند الصينيّة هزّت المُجتمع الأميركي نفسه ومُنيت فيها بهزيمةٍ شنيعة. اشتدَّ ساعدُ النقابات العمّاليّة في الدول الصناعيّة. تمرّد الطلّاب في القارّات الخمس. نشأت حركات نسويّة من نوعٍ جديد. انتعش الفكر الماركسي النقدي مُتحرّراً من سطوة الأحزاب الشيوعيّة ولغتها الخشبيّة. وفي الوقت نفسه، نجحت الولايات المُتّحدة في تشديد الخناق على كوبا، وتمّت برعايتها سلسلةٌ من الانقلابات العسكريّة الفاشيّة في البرازيل وإندونيسيا والأرجنتين واليونان، وسحقت إسرائيل الجيوش العربيّة في حربٍ كارثيّة ما زلنا نعاني من آثارها القريبة والبعيدة، احتلالاً واستبداداً «أبديّاً» وتطرّفاً دينيّاً. وللأسباب القديمة نفسها بقي للاتّحاد السوفييتي أنصارٌ متحمّسون في العالم، وبالأخصّ في العالم الثالث، باعتباره «قلعة الاشتراكيّة» ونصير حركات التحرّر الوطني في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينيّة، على الرغم من أزمته الداخليّة المُتفاقمة التي تجلّت في عزل خروتشوف وتولّي بيروقراطيّين أكثر رماديّة منه، من أمثال بريجنيف وسوسلوف، قيادة الحزب والدولة، وعلى الرغم أيضاً من تصاعد احتجاجات المُثقّفين الروس، والتململ في «الديموقراطيّات الشعبيّة». ومن يقرأ اليوم تنظيرات هؤلاء القادة يعجبْ من قدرتها، على هشاشتها، إقناع الملايين بأنّ الاتّحاد السوفييتي كان آنذاك في طور الانتقال من الاشتراكيّة إلى الشيوعيّة، أو بنظريّتهم البائسة عن طريق التطوّر غير الرأسماليّة التي تحضّ الشيوعيّين في العالم الثالث على دعم «البورجوازيّات الصغيرة الراديكاليّة» (أي، في أغلب الأحيان، العسكرتاريا الانقلابيّة)، حتّى الاندماج في أحزابها أو الانتظام في «جبهاتٍ وطنيّة» تُحدّ من استقلاليّتها السياسيّة والتنظيميّة. وحين سحقت جيوش حلف وارسو ربيع براغ، في خريف 1968، قضى القادة السوفييت بأنفسهم أمام شعبهم على أيّ أملٍ بإصلاحٍ داخليّ في بلادهم وفي «الديموقراطيّات الشعبيّة»، وتحفّظت أحزابٌ شيوعيّة أوروبيّة (دون أن تقطع حبل السرّة مع موسكو، ودون أن تُعيد النظر جذريّاً في مرتكزاتها الفكريّة وبُناها التنظيميّة). ولعلّ الولاء المطلق لموسكو انحصر منذ تلك السنة في الغالبيّة الغالبة من أحزاب العالم الثالث التي نسبت كلّ خروجٍ على الأرثوذكسيّة السوفييتيّة إمّا إلى المؤامرات الامبرياليّة، وإمّا إلى «مرض الطفولة اليساريّ». ولم تكن الصين أسعد حظاً في ثورتها الثقافيّة التي بدت من بعيد لفئة من الماركسيّين الحالمين، حتّى الذين كانوا يستهجنون عبادة شخصيّة ماو، تمرّداً جماهيريّاً على بيروقراطيّة الحزب ودرءً لخطر انبعاث الرأسماليّة، وكانت في حقيقتها صراعاً على السلطة بين ماو وخصومه، مهَّدَ بالفعل بعد وفاة ماو وصعود نجم دنغ شياو بينغ منذ 1978، للانعطاف الرأسمالي الحاسم في غضون الثمانينات.
استمرّ خداع الذات في القطّاع الأوسع من الحركة الشيوعيّة العالميّة طوال السبعينات. أقنعت نفسها أنّها بخيرٍ عميمٍ: ألمْ تُهزمْ الولايات المُتّحدة في الهند الصينيّة (1975) وإيران ونيكاراغوا (1979)؟ ألم يُثبتْ الاتّحاد السوفييتي أنّه قادرٌ على مُجابهتها في الغرب والشرق حين نشر صواريخ س س 20 في أوروبا الشرقيّة (1977) أو حين غزا أفغانستان (1979)؟ ألم تهزّ الأزمة الماليّة والاقتصاديّة الطاحنة، منذ الطفرة النفطيّة الأولى (1973)، أركان النظام الرأسماليّ العالميّ؟ أليس هذا دليلاً على تفوّق الاقتصاد الاشتراكي الذي لا تناله الأزمات؟ حَجَبَ هذا العمى العقائدي عن جُمهور الشيوعيّين رؤية ميزان القوى العالميّ على حقيقته، بوجهيه الاستراتيجي والإيديولوجي، وخصوصاً انحسار الهيمنة الفكريّة اليساريّة، الماركسيّة على وجه التحديد، في صفوف جيل 1968 ونكوصه منذ مُنتصف السبعينات إلى فردانيّةٍ مطلقة، وتفشّي الفكر المعادي عداءً جذريّاً لكلّ ما يمتّ بصلةٍ إلى الشيوعيّة والاشتراكيّة واليسار والتغيير الثوري، مُحتجّاً بالأحداث الدوليّة الجارية، مثل مذابح الخمير الحمر في كمبوديا وهجرة ملايين الفيتناميّين بعد سقوط سايغون وانفضاح جرائم الثورة الثقافيّة في الصين، ومستغلّاً الضجّة الإعلاميّة غير المسبوقة التي أثارها كتاب سولجنيتسين «أرخبيل الغولاغ» وما تلاه من شهاداتٍ فاجعة عن الاتّحاد السوفييتي منذ نشأته. وابتدأ كثيرون من قُدامى الستالينيّين وأنصاف الستالينيّين بالانعطاف عن مجرى تاريخهم، وبتحميل لينين، وقبله ماركس، وقبله كلّ الحركات الثوريّة في التاريخ، وزرَ جرائم ستالين.
تأكّد هذا النهج في الثمانينات، موازياً مسيرة تاتشر وريغان الظافرة، إلى ما بعد انهيار جدار برلين (1989) وسقوط الأنظمة «الاشتراكيّة» بعشرين سنة. سارعت شعوب أوروبا الشرقيّة التي عانت الويلات من هذه الأنظمة إلى تبنّي الرأسماليّة والتغنّي بمحاسنها، واقتنعت شعوب أوروبا الغربيّة بأنّ أوضاعها مهما ساءت أفضل لها من نعيم الاشتراكيّة، وهيمنت الإيديولوجيّا النيوليبراليّة بلا مُنازع باسم «انعدام البديل» و«نهاية التاريخ»، ولأنّنا «محكومون بالعيش في هذا العالم كما هو».
شاعَ في هذه الأثناء وما زال شائعاً في النقاش العام مُصطلح «الشموليّة» بهدف المساواة بين الشيوعيّة والنازيّة وردّهما قسراً إلى أصلٍ واحد، بل ذهب مؤرّخون ألمان إلى أنّ الشيوعيّة أمّ النازيّة وأُنموذجها الأعلى، واحتُفي بصخبٍ بإنجازهم التاريخيّ الفذّ (1986 – 1989). انتشر في الكتب والصحف مديح الاستعمار والهزء من «دموع الإنسان الأبيض» المُدافع عن حقوق الشعوب المُستعمَرة، واشتُهرت على نطاقٍ واسع، في أثناء الاحتفال بالذكرى المئتين للثورة الفرنسيّة (1989)، وعُمّمت على جميع الثورات السابقة واللاحقة، نظريّة المؤرّخ الفرنسي فرنسوا فوري القائلة بانّ الثورة كانت منذ بدايتها، من حيث منابعها الفكريّة وشخصيّة المُحرّضين عليها وسياقها التاريخي على السواء، تحمل جرثومة الإرهاب والشموليّة. واستمرت الحملة على كلّ دعوةٍ مُعادية للرأسماليّة، أو حتّى على كلّ نزعة إصلاحيّة جدّيّة، إلى أن أدّت الأزمة المصرفيّة العالميّة في 2007 و«النجاحات» الباهرة التي حقّقتها الرأسماليّة الماليّة المُعولمة في جميع الميادين – الركود الاقتصادي، انخفاض مُعدّل النموّ، البطالة البنيويّة، بؤس المرافق العامّة، توسّع الهوّة بين الطبقات الاجتماعيّة، تعطيل الخيارات الديموقراطيّة وتسفيه السياسة – إلى إقناع أصحاب نظريّة «نهاية التاريخ» بأنّ التاريخ لا نهاية له. وكان من أبدع سخرياته في السنين الأخيرة، دهشةُ الذين دفنوا ماركس وأهالوا عليه التراب حين اكتشفوا أنّ جُثّته ما زالت تتحرّك!
*****
لنعدْ إلى «السنوات الثلاثين المجيدة» التي تُعتبر عصر الاشتراكيّة-الديموقراطيّة الذهبي. والاشتراكيّة -الديموقراطيّة المعنيّة هنا هي التيّار الذي ازدهر في أوروبا على أساس التوفيق في إطار المؤسّسات الديموقراطيّة الليبراليّة بين العمل ورأس المال، وبين المجتمع والدولة، مؤكّداً أولويّة السياسة على الاقتصاد، والخيارات الجماعيّة على آليّة السوق والمصالح الخاصّة. كان برنامجه يتضمّن السعي إلى توفير فرص العمل للجميع، والمواءمة بين الأجور والأسعار، والضمان الاجتماعي، وتطوير الخدمات العامّة، ونظاماً ضريبيّاً تصاعديّاً، وقانوناً للعمل يحفظ حقوق العُمّال. ولمّا كانت الأحزاب الشيوعيّة ونقابات العُمّال في أوج قوّتها، وإنتاجيّةُ العمل في ازدياد، وكان معّدل النموّ مرتفعاً، فقد أمكن تحقيق جوانب عدّة من هذا البرنامج لا تتعارض مع مصالح الرأسماليّة الصناعيّة العليا لأنّها تُوسِّع لها السوق الداخليّة وتمنحها مظهراً «تقدّميّاً». واقتصر الخلاف في غضون هذه السنوات بين اليمين المعتدل واليسار الإصلاحي على نقاطٍ فرعيّة تتعلّق بحدود الرقابة الإداريّة وليس بمبدأ تدخّل الدولة في الحياة الاقتصاديّة، واتّفقا غالباً في الانتماء إلى المُعسكر الغربيّ وفي الدفاع عن مصالحه الاستعماريّة، واختلفا حيناً في أمور السياسة الخارجية الأُخرى. ولكنّ ظروف السبعينات (اختلال النظام الاقتصادي العالمي، فشل الحلول الكينزية التقليديّة، صعود الفكر الليبيرالي) دفعت بقسمٍ من الاشتراكيّين-الديموقراطيّين إلى الإلحاح على ضرورة «التخلّص من مفاهيم الماضي وأوهامه» وتطعيم برنامجهم بتدابير ليبراليّة. وما زالت عمليّة التطعيم مستمرةً حتّى أمّحى، أو كاد يمّحي، آخر ما كان يُميّز اليسار الإصلاحي عن اليمين.
تولّى الاشتراكيّون السلطة مرّاتٍ عديدة في أغلب دول أوروبا الغربيّة في الثمانينات وبعدها، أي في الوقت الذي كانوا فيه عاجزين عن تطبيق الشقّ الاجتماعي من برنامجهم القديم، وتحوّلوا شيئاً فشيئاً إلى ما سمّي «الليبراليّة الاجتماعيّة» في مُحاولةٍ يائسة للتوفيق بين جموح الرأسماليّة المعولمة ومطالب ناخبيهم، واضطرّوا عمليّاً في كلّ مكان إلى التراجع عن وعودهم الانتخابيّة، وأوّلها المحافظة على أهمّ المكاسب الاجتماعيّة التي تحقّقت في أيّام «الدولة المعطاء». حرّروا الأسواق الماليّة، خضعوا لإملاءات نقابات أرباب العمل من دون أيّ مُقابل يُرجى من طرفها، خصخصوا مؤسّسات القطّاع العامّ أو رخّصوا بفتح رأسمالها للشركات الخاصّة، سرّحوا ألوف العاملين في المرافق العامّة (المدارس والمستشفيات والبريد والنقل)، خفّضوا سقف التأمينات الاجتماعيّة (الضمان الصحّي والتقاعد والبطالة والعلاوات العائليّة)، وامتثلوا دائماً لقواعد الاتّحاد الأوروبيّ الصارمة التي تورّطوا خطوةً خطوة بالالتزام بها على الرغم من أنّها تنفي صراحةً حقّ الحكومات الأوروبيّة في تقرير سياساتها الاقتصاديّة والماليّة والضريبيّة والنقديّة. ليس إذاً من المُستغرب اليوم أن تختلط النخب الاشتراكيّة بالنخب اليمينيّة، في الوظائف الرسميّة العليا وفي إدارة أعمال الشركات الكبرى، ولا أن تعتمد الأحزاب الاشتراكيّة أكثر فأكثر على تأييد الطبقات الوسطى المدينيّة، المُتنوّرة ثقافيّاً والتقدّميّة مُجتمعيّاً، بعد أن انصرفت عنها الطبقات الشعبيّة، كما انصرفت من قبل عن الشيوعيّين، واتّجهت جهة اليمين المُتطرّف.
لا يُنكر الاشتراكيّون الأُصلاء في أوروبا أنّ «ترشيد» الرأسماليّة في طورها الجديد لا يقلّ طوباويّة عن حلم الإطاحة بها، وأنّه بات من المستحيل حلّ التناقض بين الاستمرار في رفع القيود عن حركة رؤوس الأموال، وفقاً للالتزامات الإقليميّة والدوليّة القائمة، وبقاء «الدولة الاجتماعيّة»، ولو منقوصةً. ويُدركون أنّ أقصى ما يُمكنهم تحقيقه إذا نجحوا في الانتخابات، باستثناء تلبية مطالب أرباب العمل المُتجدّدة، هو بعض الإصلاحات المُجتمعيّة التي لا يختلف عليها اليسار جوهريّاً مع اليمين الليبيرالي. ولذا تبدو القطيعة المرجوّة مع المنهج السائد، حتّى في حدودها الدنيا، بعيدة المنال: لا تستطيعها دولةٌ ما بمُفردها، كما بيّنته تجربة اليونان الرهيبة، ولم تظهر في الأفق أيّ إشارةٍ إلى أنّ الحكومات الليبراليّة أو «الليبرالية الاجتماعيّة» على استعدادٍ، نظراً إلى الأزمات الماليّة المُتتابعة، للتخلّي عن أرثوذوكسيتها النيوليبراليّة وتقييد حريّة الرأسماليّة الماليّة والشركات العملاقة المُتعدّدة الجنسيّة، ولنْ تظهرْ ما لم ينطلقْ حراكٌ جماهيريّ طويل النَفَس تقوده قوىً يساريّة جذريّة مُتحرّرة من إرث الماضي الثقيل.
*****
لا يعني التحرّر من هذا الإرث مُحاولة الكتابة على صفحةٍ بيضاء، فهي عقيمةٌ حتماً، بل الكتابة بحرّيّةٍ فوق ما كتبه من قبل مُفكّرون عظام، ديموقراطيّون وشيوعيّون وفوضويّون، أصابوا وأخطأوا. هو أوّلاً في نبذ المنظومة الساذجة، المُريحة والقاتلة، المسمّاة «الماركسيّة-اللينينيّة» ومقولاتها الإيمانيّة: «حتميّة التاريخ» التي قال بها ماركس حيناً ونفاها حيناً، وما تفرّع عنها من اعتبار «الماديّة التاريخيّة» علماً مُنزّهاً عن الخطأ يتلخّص في أولويّة القوى المُنتجة على علاقات الإنتاج، والبنية التحتيّة على البنية الفوقيّة، وفي تحميل البروليتاريا الصناعيّة، ثمّ حزبها الطليعي، مهمّة إنجاز الوعد الخلاصيّ بتحرير الإنسانيّة. ويعني التحرّرُ من إرث الماضي، ثانياً، تخيّلَ نقيضٍ للرأسماليّة والملكيّة الخاصّة لوسائل الإنتاج غير رأسماليّة الدولة، ومعنىً للتقدّم غير استنفاد خيرات الطبيعة، تسعى البشريّة بموجبه إلى الأفضل وليس إلى الأكثر. وهو ثالثاً وأخيراً في الجُرأة على طرح جميع الأسئلة الإشكاليّة، وإن استعصت الإجابة عنها بصورةٍ مُرضية: من هي القوى الاجتماعيّة المُهيّأة فعلاً لمُقاومة العولمة النيوليبراليّة وتصّور عولمةٍ بديلة في زمن انكماش الطبقة العاملة وطغيان الفردانيّة والسباق المحموم على البضائع الاستهلاكيّة وانقراض السياسة؟ من هو الفاعل الثوري القادر على توحيد النضالات الفرعيّة (الاقتصاديّة، الديموقراطيّة، البيئيّة، النسويّة، إلخ) إذا لم يكن حزباً سياسيّاً بالمعنى الشائع؟ وإذا كان حزباً فكيف يُعرّف نفسه بعد أن تعهّرت جميع المُصطلحات اليساريّة على يد أصحابها؟ وهل يستطيع تنظيم صفوفه في ظروف النضال السرّي على غير شاكلة الحزب الطليعي بمفهومه اللينيني القديم؟ وإذا كان ينبذ العنف، خشية اعتماده منهجاً دائماً في الممارسة السياسيّة على غرار ما انزلقت إليه جميع الثورات السابقة، فمن يضمن له إذا انتصر، أو حتّى إذا حقّق بعض النجاح، تسليم خصومه بهزيمتهم، وكيف يُجابه عنفَ الثورة المضادّة؟ ويختصر هذه الأسئلة في نهاية المطاف هذا السؤال المُمضّ: كيف يُمكن أن يُصبح الضروريّ ممكناً؟
قد يُقال، وسيُقال: أين نحن في العالم العربي من التفكير في ما هو أكثر من قليلٍ من الحياة؟ أليس كلام يساريّك المُعاند الحزين على اليمين واليسار، والليبيراليّة والشيوعيّة، وفهم العالم وتغييره، ترفاً فكريّاً في عصر بشّار الأسد وداعش، وتفكّك المُجتمعات، وانشغال الأمّة بما جرى قبل مئات السنين في سقيفة بني ساعدة؟
وقد يُجيب، وسيُجيب: إنّ النظام العالميّ الذي ينبغي فهمه وتغييره يتحمّل جزءاً (على الأقلّ) من المسؤوليّة عن إنتاج بشّار الأسد وداعش، وهو الذي يُعيد إنتاجهما، وهو الذي سيخلق في مستقبل الأيّام من شبههما أربعين، وهو الذي يسيرُ بالبشريّة كلّها إلى كارثةٍ مُعلنة.
وقد يُضيف، في الهامش: ولا شيءَ يؤكّد الحاجة إلى يسارٍ قويّ، جذريٍّ، مُتحرّر، أكثر من المصير الذي آلت إليه الانتفاضات العربيّة.
موقع الجمهورية