تصميم لدراسة عن غرامشي/ ريجيس دوبريه
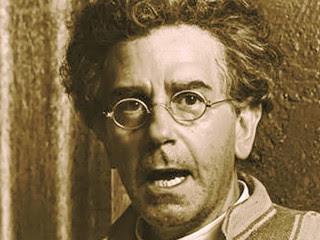
1
إنّ “تاريخيّة” Historicism غرامشي قابلة للارتداد ضدّه؛ بمعنى أنه ينطبق عليه – هو أيضاً – تحليل، يبيّن الحدود التاريخية لفكره. وبالتأكيد، يستحيل فَهْم غرامشي خارج إطاره التاريخي المخصوص، أو معزولاً عن التيارات الفكرية التي تصدّى لها.
1- استهدف غرامشي – أساساً – نقد النزعة الميكانيكية في الحركة “الاشتراكية – الديمقراطية” وعند بوخارين. وقد رأى في هذه النزعة شكلاً من أشكال القدرية Fatalism، واعتبرها خلطاً بين علم الطبيعة وعلم التاريخ (وهذا ما يفسّر معارضته لإنجلز، وللنزعة العلمية).
ما هو الخطر الرئيس [المحدق بالماركسية] بنظر غرامشي؟ ما هي عملية الخلط الرئيسة التي حدّد غرامشي موقفه بالنضال ضدّها، والارتباط بها، داعياً إلى التمييز بينها وبين الماركسية؟ إن تعيين خصوصية عقيدة أو نظرية ما – أي جوهرها – أمر، لا يمكن الاضطلاع به، على نحو مجرّد؛ ذلك أنه عملية فعل وردّ فعل. أن نعرِّف يعني أن نميِّز، أن نعزل موضوعاً ما عن محيطه التاريخي، عن نسبه، وعن علاقاته الحميمة. يشرع غرامشي في تعيين طبيعة الماركسية بتمييزها عن النزعة المادّيّة الميكانيكية التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر؛ أي أنه يخوض معركة. ولذا؛ فقد اتسم نشاطه النظري بالسمة السجالية، بالدرجة الأولى؛ كما أن نشاطه العلمي – بوصفه مناضلاً [شيوعياً] – كان يرتكز على هذا النشاط النظري. ويخطئ كل مَن يحاول “تبرئة” بعض صيغ غرامشي النظرية – مهما تكن هذه الصيغ مثيرة للدهشة والاستغراب – بالقول إنها ناجمة عن دوره كمناضل عملي (..). الواقع أن كل تحليل نظري – في جوهره – تحليل سجالي؛ أي أنه شكل من أشكال النقد “الملتزم”. إن ماركس ذاته يبني كتابه رأس المال على نقد الاقتصاد السياسي؛ إذ ينطلق من السجال ضدّ سميث وريكاردو وساي. لكن الطريف في غرامشي أنه لا يُخفي “التزامه”، ولا يدّعي السعي وراء “موضوعية” مدرسية، أو أكاديمية، أو “علمية”. بل يُسلِّم نظرياً بضرورة المساجلة العلنية.
2- في مساجلته هذه، ينطلق غرامشي من كروتشي وسوريل ودي مان (أي يستعين بهؤلاء المفكّرين). لكنه يبالغ في أهمّيّتهم، وخاصة بالنسبة لكروتشي. غير أن هذه المبالغة، بنظرنا، هي – أيضاً – سمة تاريخية، وعلامة من علامات العصر [عصر غرامشي].
2
رغم هذه التحفظّات، يبقى فضل غرامشي الكبير [على الفكر الماركسي] في كونه اعتمد وحدة النظرية مع الممارسة كمحور، وكمركز ارتباط استراتيجي لتحليلاته؛ وعارض بشدة أية محاولة للفصل بينهما. وغرامشي هو ذلك المفكر الذي يتساءل – باستمرار – عن كيفية تحقيق الانتقال من النظرية إلى التاريخ. وما من مناضل أصيل، يسعى لممارسة عمل ثوري فعلي، إلا ويواجه هذه المسألة – مسألة تحقيق اللحمة بين التاريخ والفلسفة.
وتتبدّى مسألة تحقيق هذه اللحمة على الأصعدة التالية:
1- الصعيد الثوري – السياسي: تحقيق الوحدة بين “العفوية” و”القيادة الواعية” (حركة المجالس العمّالية في تورينو)؛ العلاقة بين الحزب والجماهير، وبين القيادة والقاعدة (…) الحزب = التثقيف = المثقّف الجماعي (الحزب، “بوصفه” مثقّفاً جماعياً)؛ وهنا نفي النفي، ذلك أن الموقف هو فعلاً الفرد([2]).
2- الصعيد النظري: “قد يحدث أن تتعارض النظرية المعاصرة مع المشاعر العفوية للجماهير”. ولكن “هذا التعارض هو تعارض كمّيّ، وليس تعارضاً نوعياً”. المهمة هنا تحقيق ارتباط الماركسية بالحكمة الشعبية، فتستوعبها، وتتجاوزها، في آن معاً.
3- الصعيد الثقافي: يمكن تقييم “المثقّفين” اعتماداً على مقدرتهم على – أو عجزهم عن – أن يرتبطوا بالجماهير الصاعدة. فإذا تمكّنوا من ذلك، كانوا مثقّفين “عضويين”؛ وإلا، فهم مثقّفون اصطناعيون، ومزيّفون.
4- الصعيد الفني: مسألة الأدب الشعبي: كيف يتحقّق الارتباط بين الأدب والشعب؟ كيف يمكن وضع أدب النخبة بمتناول الشعب والأمة؟ هذان السؤالان يفسّران اهتمام غرامشي الدقيق بواقع الأمة التاريخي؛ هذا الاهتمام الذي لا يمكن عزله عن الاهتمام النظري. تُولَد الماركسية [في أمة ما] عبر عملية تلقيح تاريخية عميقة الجذور؛ بحيث تأتي تكملة لتراث قائم، وتجسّد هذا التراث على نحو ملموس. لذا؛ يتوجب على الماركسية أن “تترجم” عيانية الحياة في قالب نظري (ذلك أن “نظرة مدرسية أو أكاديمية للتاريخ والسياسة ليست إلا تعبيراً عن موقف استكاني” – غرامشي – وهذا حُكم صحيح تاريخياً). ترجمة الحكمة الشعبية إلى فلسفة، واستيعاب الفلسفة (الماركسية) داخل الحكمة الشعبية – هاتان هما القاعدتان الرئيستان لفكر غرامشي. أي أن غرامشي يطرح مسألة الانتقال من الواحدة للأخرى- ويفهم هذا الانتقال على أنه عملية ترجمة واستيعاب معاً.
3
إننا نملك أسبقية تاريخية واضحة على غرامشي. ذلك أنه لم يُقدَّر له أن يشهد “انتقال” الماركسية (وتحوّلها) إلى مجتمع تاريخ عَيني. فما كان بمقدوره أن يُقيّم نتائج هذا “الانتقال” بالنسبة للماركسية وللمجتمع الروسي. أما نحن؛ فقد واكبنا تجربة تاريخية فذّة طوال نصف قرن. وهذا ما يخوّلنا أن نسأل: ما الذي يحدث لنظرية ما عندما تتحوّل إلى إيديولوجية رسمية في عدد من البلدان؟ وما الذي يحدث لثقافة معينة عندما تستوعب نظرية “علمية”؟.
لا بد لنا هنا من ملاحظة حول الماركسيين. لم تُفكِّر الماركسية – بعد – بعملية تجسيدها تاريخياً. فخلال السنوات الخمسين الأخيرة، أمست الاشتراكية واقعاً تاريخياً واجتماعياً وثقافياً، بالنسبة لثلث سكان الكرة الأرضية المتواجدين في “البلدان ذات النُّظُم الاشتراكية”، أو في ما كان يُسمّى سابقاً “المعسكر الاشتراكي”. وتشكّل هذه السنوات الخمسون تاريخاً ذا حصيلة معينة. وبما أنه تاريخ مركّب، فلا بد من أن تكون حصيلته مركّبة هي أيضاً؛ إذ ليست هذه الحصيلة تعبيراً سطحياً عن مبدأ بسيط؛ فثمّة أصعدة مختلفة، وتباينات وتناقضات اقتصادية وثقافية وسياسية بين هذه الأصعدة، في داخل كل بلد [اشتراكي]، وبين البلدان ذاتها. ولكنْ؛ إذا كان الواقع مركّباً، فهذا يعني أنه لا بد له من تحليل مركّب؛ ولا يعني – إطلاقاً – أنه يمكن الاستغناء عن كل تحليل.
وهذا ما لم يحصل بعد. إن هذا “الإنجاز” الاشتراكي (هذه المحصلة التاريخية المركّبة) لم يصبح – بعد – موضوع تحليل ماركسي. وذلك لأسباب عديدة:
1- ليست الماركسية أداة تحليل للاشتراكية، وإنما هي أداة تحليل للنظام الرأسمالي. وتتبدّى هذه الثغرة في الحقل الاقتصادي؛ حيث يئس علماءُ الاقتصاد والماركسيون المنكبّون على نبش المراجع في فكر ماركس (نقد برنامج غوتا، البيان الشيوعي، المراسلات، إلخ).
2- إن الضرورات التاريخية للنضال أعطت الأولوية لمهمة الدفاع على مهمة المعرفة. لا بد – أولاً بأول – من الدفاع عن المعسكر الاشتراكي ضدّ خصومه ومهاجميه لوقاية البروليتاريا من مهاوي الشك واليأس. ومن هنا؛ تتولّد التبريرات بدلاً من التحليلات. فيتعذّر اتخاذ موقف متجرّد. ذلك أن تحليلاً مُنزَّهاً لا بد له من إثبات وجود تناقضات داخل الاشتراكية – تناقضات تدّعي الشيوعية – بوصفها إيديولوجية جماهيرية – أنها قد اختفت.
3- إن مثل هذا التحليل لا بد له من الاستعانة بمفاهيم غير أرثوذكسية مثل “الحضارة” و”الثقافة”، وما شابه.
4- تخلُّف الوعي – والعلم كذلك – عن مواكبة العمليات التي تشكّل موضوع هذا الوعي، وذاك العلم.
(4)
غرامشي فيلسوفٌ ومؤرّخٌ، في آن معاً (وهذا قول صحيح حتّى بالنسبة لكمّيّة ما أنتجه؛ إذ ترك عدداً متساوياً من الكتابات الفلسفية والتاريخية). لكنه ليس مؤرّخاً للفلسفة – فذلك يفترض أن للفلسفة تاريخاً خاصاً بها، يمكن إدراكه من داخل الفلسفة نفسها (وهذه مقولة مثالية مضادّة لاتجاه فكر غرامشي)، ولا هو فيلسوف للتاريخ – إذ إن ذلك يفترض تذويب التاريخ في غائية فلسفية ما (وتلك – أيضاً – مقولة مضادة لاتجاه فكره). المسألة التي يواجهها كامنة في واو العطف هذه؛ ذلك أن غرامشي يقف عند الحدّ الفاصل بين العلاقة والتمايز. فبدلاً من أن يعتبر أن العلاقة (بين الفلسفة والتاريخ) قائمة ومستمرّة، ينظر إليها كمسألة، أو كعدّة مسائل متجدّدة باستمرار، ومخصوصة و”تاريخية”. التاريخ بوصفه مسألة تبحث عن حلّ – ذلك هو مركزة القوة في فكر غرامشي. أما نقطة الضعف عنده – أو بالأحرى الانحراف “التاريخي” Historicist الذي عانى منه – فتظهر عندما يعالج التاريخ على أنه يحوي في داخله حلاً لمسألته، على أنه مسألة تحلّ نفسها بنفسها. “البشرية لا تطرح على نفسها – أبداً – إلا تلك المسائل التي تقدر على حلّها، إلا تلك المسألة التي باتت شروط حلها متوافرة…” (ماركس) – تلك هي اللازمة التي تتكرّر باستمرار عند غرامشي. هنا ترد بعض الشكوك: لماذا وكيف لا يمكن اعتبار “التاريخية” مجرّد مذهب، يقول بنسبية الظاهر التاريخية؟ وتظهر بعض الثغرات: ما هي الشروط التي تسمح بانبثاق العلم؟ ولماذا يظهر العلم أصلاً؟ وثمّة بالإضافة لكل ذلك حدّ موضوعي تاريخي، يضيف على بعض نصوص غرامشي قدرته على استثارة المشاعر (دون أن ينتقص من قيمتها – فهي تبقى شواهد أمل تاريخي، وعلامات استدلال عليه)، وهي النصوص التي تتوقّع – والتي ترجو من “تحوّل” النظرية إلى ممارسة – ولادة حضارة وثقافة جديدتين، وسيادة نمط حياة ومجموعة من القِيَم تختلف جذرياً عن تلك التي كانت سائدة في ظل الرأسمالية؛ تلك القيم التي فقدت تماسكها العضوي، وأصيبت بالانحلال والازدواجية. والواقع أن التاريخ خيّب آمال غرامشي هذه في أوروبا (أي في الاتحاد السوفييتي، والديمقراطيات الشعبية). والواجب الذي يمليه علينا – الآن – التزامنا بفكر غرامشي هو البحث عن أسباب خيبة الأمل هذه وأشكالها ونتائجها. نقول “الواجب الذي يمليه علينا التزامنا بفكر غرامشي”؛ لأن المسألة تتعلق بأوروبا، بالدرجة الأولى، ويقع حلّها على عاتق العمّال والمثقّفين في إيطاليا وفرنسا. والحقيقة أن بعض الشروط السياسية للاضطلاع بهذه المهمة باتت متوافرة، وخاصة في إيطاليا. إلا أن الدينامية الموضوعية للسجال النظري (بما يتضمن من هجمات مضادة) ستدفع بالنقد إلى الانحراف نحو اليمين – أي نحو “التحريفية”- بالقدر الذي يستعين فيه بنقاط استدلال من أوروبا وحدها. أما إذا استعان – في الطرف المقابل – بنقاط استدلال مُستجرّة من أساطير العالم الثالث وحدها – واكتفى بما يرد إليه من خارج أوروبا – فسوف يتّجه هذا النقد – آنذاك – وجهة “يسارية” رومانسية مجرّدة، مقلوعة الجذور، ومفتقرة إلى نقاط ارتكاز في الواقع. هل يمكن تفادي الخيار بين هذين الاحتمالين؟ هل يمكن تفادي سوء الفَهْم بين موقفين مغلوطين (موقف يمينٍ، هو الموقف الأكثر شيوعاً، وموقفٍ يساريٍّ، تحمله أقلّيّات معزولة)، كلاهما منحرف بما فيه الكفاية؛ بحيث يبرّر الآخر، ويمدّه بسبب وجوده؟ إذا استند حكمنا على الأحداث – على ما يجري في روما أو باريس- يصعب علينا الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب.
(أعني بـ”الواقع” الظواهر التي يجري تناولها من منظار نقدي، الظواهر التي تحدّدت شروط إمكانها الفعلية. إن مأساة “أيار 1968” تكمن في أنها تلعب – بالنسبة لليسار المتطرف – الدور ذاته الذي لعبه “تموز 1936” بالنسبة للإصلاحية الشيوعية: دور الأسطورة التبريرية، ودور الترسّب لسنوات من الأوهام([3]). أما الجديد – بالمقارنة مع ما جرى عام 1936 -؛ فهو السرعة التي حقّقت فيها هذه الظاهرة (أحداث أيار 1968) الانتقال من التاريخ إلى الأسطورة، من الواقع إلى الرمز. ويعود ذلك – طبعاً – إلى التقدّم الذي أحرزتْه الرأسمالية في مجال القدرة على استيعاب أولئك الذين ينافسونها على السلطة – وذلك عن طريق الكُتُب، والصحافة، والأفلام، والمسرحيات، وما شابه. لكن أحداث “أيار 1968” قد تمكّنت – بالدرجة الأولى – من تلبية حاجة حقيقية، حاجة عظيمة مكبوتة، تستشعرها المجموعات الثورية (ويستشعرها – إلى حدّ أقل – المجتمع بأسره، على أنها حاجة، يجب رفضها ونبذها). وهذه الحاجة هي – بالتحديد – الحاجة إلى الأسطورة، إلى أسطورة محلية، تُولَد من داخل الرأسمالية. ولنتذكر – هنا – أن كل أسطورة – بوصفها مطلقاً – تعبِّر عن عملية بتر نسبية (مع الأوضاع القائمة). وقد تولّدت هذه الحاجة عن البون الشاسع الناجم عن التفاوت بين تاريخ مباشر، محلي، باهت، إصلاحي، ورتيب، من جهة، وبين رياح الثورة العاصفة (على أوروبا) من الصين وفيتنام وكوبا (وهذه الرياح قوة ثورية مدمّرة، لكنها تبقى بعيدة عن أوروبا، تصل إليها عبر عدد من الوسائط) من جهة أخرى؛ دون أن يستطيع هذان الصعيدان الالتقاء في زمان ومكان واحد. هكذا مُلئ البون بما بدا وكأنه واقع فعلي: الأساطير المتولّدة من أحداث “أيار 1968”. وأشبعت الحاجة السالفة الذِّكْر لمدّة عشرين سنة).
*مقدمة كتاب “قضايا المادية التاريخية” لأنطوان غرامشي، ترجمة فواز طرابلسي، سيصدر قريبًا عن “منشورات المتوسط”/ ميلانو/ إيطاليا
[1]) مترجم عن مجلة “نيو ليفت رفيو” عدد 59، كانون الثاني – شباط 1970. الهلالان العاديان من وضع المؤلف، أما الهلالان “المستقيمان”؛ فمن وضع المترجم لإيضاح بعض الجمل.
[2]) راجع الأمير الحديث: ترجمة قيس الشامي وزاهي شرفان، دار الطليعة بيروت 1970.
[3]) أحداث أيار 1968 هي الانتفاضة الطلابية – العمّالية في فرنسا. وأحداث تموز 1936 هي مجيء “الجبهة الشعبية” للحكم في فرنسا، بقيادة ليون بلوم، ودعم الحزب الشيوعي (المترجم).
ضفة ثالثة

