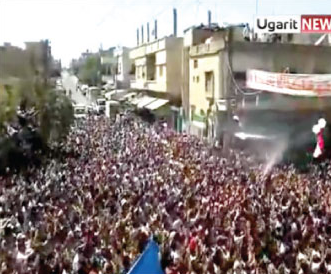حول نجاح الثورات العربية
خالد الحروب
هناك أكثر من مقاربة يمكن النظر من خلالها لسيرورات الثورات العربية ومآلاتها وما ستقود المجتمعات إليه. ومن هذه المقاربات تلك التي تنشغل باللحظة الراهنة وتداعيات نتائج ما بعد الثورة في كل بلد من البلدان التي نجحت فيها، ومنها أيضا تلك التي تموضع التحول الكبير الذي حققته هذه الثورات ضمن سياق تاريخي عريض. أو بكلمة أخرى هناك المنظور قصير الأمد والمنظور طويل الأمد وكلاهما يمتلك شرعيته الخاصة به ولا يمكن دحض منطلقاته. الأمد القصير هو ما يهم الشعوب التي عانت من قمع الديكتاتوريات وسياساتها المدمرة على المجتمع والاقتصاد وما نتج عنها من تفاقم الفقر ومعدلات البطالة وتجذر للفساد. وما يريده الأفراد من الثورة وفور أن تـُنجز وتسقط النظام السابق يتمثل في إزالة كل أنواع الظلم عنهم، وتحقيق الحدود الدنيا من مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية وتوفير فرص العمل. ولكن الواقع الذي يصدمهم ويصدم الجميع أيضاً في بلدان ما بعد الثورات يقول إنه من العسير جداً، إن لم يكن من شبه المستحيل، تحقيق ما تأمله الشرائح الغالبة من المجتمعات بالسرعة التي تتطلع إليها تلك الشرائح. وهناك عدد واضح من الأسباب خلف ذلك ولكن أهمها اثنان: الأول، أن المعضلات التي خلقتها وراكمتها أنظمة الاستبداد على مدار عقود طويلة أصبحت بنيوية وضاربة الجذور ومتمأسسة في المجتمع بشكل يجعل من المستحيل حلها في فترات زمنية قصيرة تقاس بالسنة أو عدة سنوات، والثاني هو أن شكل النظام السياسي لم يستقر بعد في كل بلدان الثورات وثمة مشوار طويل لابد من قطعه على طريق تأسيس البنية التحتية السياسية والتشريعية لمثل هذا النظام بما في ذلك صوغ دساتير، وتنظيم انتخابات، وتشكيل حكومات جديدة، وتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي، وسوى ذلك من تحديات ثقيلة الوطأة والنوع. ومعنى ذلك أن التغيير المنشود سوف يأخذ زمناً طويلاً وبطئياً ولا يستجيب للرغبات الشعبية العارمة والمُستعجلة، ويتولد عن هذا انتشار الإحباط في أوساط الأفراد الذين شاركوا في الثورة، وفقدانهم الثقة بما أنتجته الثورات.
وذلك كله على المدى القصير والمستعجل، وأخذه في الاعتبار ضروري ولا يمكن التغاضي عنه. بيد أن الصورة لا تكتمل إلا إن نظرنا إلى هذه الثورات من منظور طويل الأمد ووضعناها في سياق التحولات الكبرى التاريخية التي تنخرط فيها البلدان والمجتمعات وتنتقل بها وعبرها من مرحلة إلى أخرى -مثل مرحلة التحرر من الاستعمار مثلًا ودخول حقبة الاستقلال، أو مرحلة توحد كيانين، أو انفصال كيان معين، أو تغيير إيديولوجية نظام من اليمين إلى اليسار أو بالعكس وهكذا. ففي كل واحد من هذه التحولات الجذرية تحتاج المجتمعات إلى مدى زمني طويل كي تلمس آثار التغيير الكلي على مستوى الأفراد.
وفي المجمل العام يمكن القول إن الثورة، أي ثورة، عندما تقوم ضد وضع فاسد وتدميري للمجتمع والدولة الذي تقوم فيه وتنجح في تغييره فإنها تحقق على الفور الشوط الأول من النجاح، أو لنقل نصف النجاح المأمول من قبل الشعب الذي ناصر الثورة، وهو التخلص من النظام الفاسد وهدمه. ولكن وبطبيعة الحال يتبقى النصف الثاني من النجاح وهو بناء نظام بديل فعال وصحي وأفضل وقائم على القيم التي كانت غائبة في النظام المنقضي: الحرية، العدالة، الكرامة، والتعددية. وهذا النصف الثاني هو التحدي الحقيقي والنجاح الحقيقي. وعلى ذلك لا يمكن عمليّاً أو موضوعيّاً الحكم بنجاح أو فشل أي ثورة على المدى الطويل إلا بعد منحها فترة زمنية معقولة تحاول فيها إنجاز مهمة البناء. وإطلاق الأحكام أو التقييمات على أي ثورة من منظور المدى قصير الأمد فيه إجحاف كبير. وتاريخ الثورات العديدة والكبرى في العالم يشير إلى ذات الدرس وهو عدم إمكانية النجاح في بناء نظام بديل على المدى القصير.
إن أهمية الثورة الموجهة ضد الطغيان والديكتاتورية تكمن في موضعتها الجماعة البشرية المعينة وكيانها السياسي في مسار التسيُّس الطبيعي الميّال إلى الحرية واحترام الأفراد والإقرار بالتعدديات التي تنطوي عليها تلك الجماعة والاعتراف بها على قاعدة المساواة التامة. ويعني ذلك في ما يعنيه صوغ دستور جديد يكرس مفهوم المواطنة على حساب كل الولاءات الأخرى، القبلية والطائفية والدينية والجهوية، وترجمة ذلك على شكل قوانين وتشريعات وقضاء مستقل يضمن خضوع الجميع لحكم القانون. ثم رعاية نظام سياسي يقوم على الديمقراطية والتعددية والتداول سلميّاً على السلطة. وفي العصر الحديث والمرحلة التي وصلت إليها البشرية ليس هناك شكل للنظام السياسي يضمن الحقوق الدنيا للأفراد ويخلق فضاءً للمساواة والحرية والإبداع ويدافع عن كرامة الناس الجماعية والفردية إلا النظام الديمقراطي التعددي. وكلما كان المكون الليبرالي في هذا النظام متوفراً وكبيراً وموجهاً كلما تحققت تلك القيم بشكل أسرع وأكثر رسوخاً. وتحتاج هذه النقطة إلى توقف خاص بها، أي علاقة الديمقراطية بالليبرالية.
هناك نظم تتبنى الديمقراطية ولكن من دون أي مكون ليبرالي أو بخليط من مكونات ليبرالية وغير ليبرالية (مثل إيران، وباكستان، وإسرائيل). وفي هذه الحالة تحقق الديمقراطية درجات ملحوظة من الحرية والتعددية، ولكنها تكون حرية وتعددية مقصورة على فئة أو فئات محددة من الشعب، فيما تحرم بقية الفئات من نفس درجات الحرية. ومعنى ذلك وجود تمييز بالتعريف وبالقانون ضد شرائح من الشعب لا تتمتع بنفس الحقوق التي تتوفر للفئة المتغلبة (في إيران مثلا الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات مقصورة على من يثبت تدينه وفق ما تراه لجنة خاصة، بما يحرم العلمانيين، وربما طوائف غير شيعية من المشاركة. وفي إسرائيل الديمقراطية مقصورة من ناحية عملية وتطبيقية على «يهود اسرائيل» فيما تواجه الأقلية الفلسطينية تمييزاً عنصريّاً في القوانين والتشريعات). ومعنى ذلك أن البلدان قد تصل إلى صيغ من الأنظمة السياسية تتبنى فيها الديمقراطية والانتخابات ولكن ليس بالضرورة أن تكون ليبرالية ومكتملة من ناحية الحقوق الفردية، وهذا في الواقع هو التحدي، والتخوف، الأكبر الذي يواجه بلدان الثورات العربية، أي تخليق أنظمة ديمقراطية غير ليبرالية. وأمام هذه البلدان نموذجان متحققان على الأرض يمكن التعلم من تجاربهما بكونهما بلدان إسلاميان تتشابه بناهما الاجتماعية والدينية والسياسية مع البلدان العربية، وهما إيران وتركيا. في الأولى ديمقراطية دينية غير ليبرالية، وفي الأخرى ديمقراطية ليبرالية.
الاتحاد