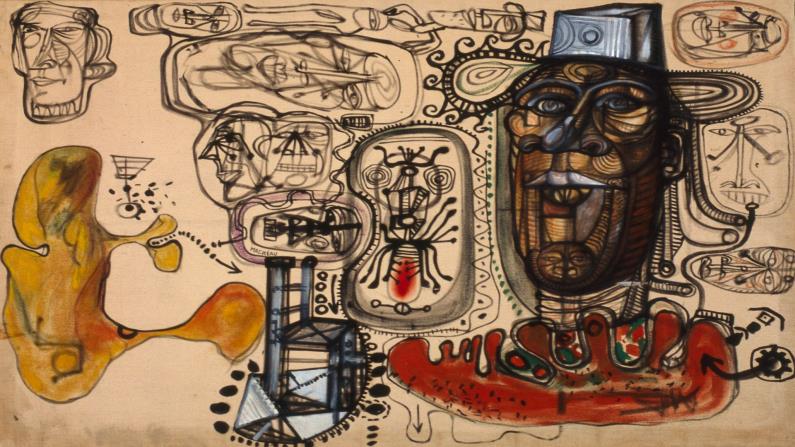حين لامس النسيم جلدي العاري/ تهامة الجندي

لبيروت القديمة سبع بوابات، كانت تحّرسها سبع عائلات، ثم أُضيفت البوابة الثامنة، وكانت تكفيني واحدة فقط، حتى ألوذ بها من جحيمي، ومن بلاد تسقط فوق رأسي. ابتعدّتُ عن العوائل والطوائف كعادتي، فتحّتُ باب الثقافة، ومشيّتُ على رصيف المرفأ الجديد، أنتظر مصادفات الحياة، وأتأمل فضاء انتظاري. من أين أبدأ رحلتي؟ كنت خائفة ومتردّدة، لكني على يقين، لن أخرج أبدا كما دخلت.
وأنا أقف عن بعد، أدخن لفافتي، واستطلع المكان والبشر، استهوتني ألوان الطيف، وأغراني أن وسط الثقافة لطيف، لا يكترث لألقاب التفّخيم والتبّجيل، ومن السهل أن أتبادل الابتسامة والحديث مع الجميع. كانوا يتحلّقون في دوائر صغيرة، يشربون النبيذ، وجوههم حلوة، أجسامهم رشيقة، مظهرهم بسيط وأنيق، وكنت أقرأهم، أتابع محاضراتهم وعروضهم الفنية، وتدهشني خلطتهم السحّرية، قدرتهم على كسر ثالوث التحريم. ومع الوقت اعتدّتُ عربّيتهم المهجّنة باللغات الأجنبية، عشقت إيقاع لهجتهم البيضاء، وتمنيت لو أصير واحدة منهم، يتجرؤون ما شاءوا على ساستهم، من دون أن يختفوا في الزنازين، أو يتشرّدوا في أصقاع الأرض.
لبيروت فصولها الصريحة، وأواخر الربيع بدتْ لي، أجمل عاصمة رأيتها في حياتي. تفتّحتْ ورودها، أشّرقتْ أشجارها، واستلقى اللؤلؤ على بحرها، وكنت تعلّمت أن أصل جهاتها، وأقضي أوقاتي في قلبها الدافئ، أنظرُ إليها، وتسّري الفتنة في داخلي، أحدّق في عينيها، وأنسى تعبي، أقبل هوائها، وأهمس حبيبتي. ما سرّ هذا الغرام؟ وانتبهت أني لأول مرة منذ زمن بعيد، أحس أني طليقة في الأمكنة العامة، لم أعد أمّقتُ وحدتي، ولم تعد تجعلني أشعر بالغربة، أو تجّبرني أن أستسلم لعزلتي. النساء هنا يشّغلن الفضاء، ويتحكمّن بآدابه، وتقدم اللبّنانية في السن، لا يُغلق عليها الباب، يدفعها إلى المزيد من تدليل نفسها، والاهتمام بالشأن العام.
صار شُغلي الشاغل، أن أراقب النساء وابتسم، حتى ظنّ البعض أن لي ميولي المثّلية، ولست كذلك، كنت أنظر إلى المرأة اللبنانية، واستكشف في مراياها نقصي. شعرت أنها الوحيدة من بيننا نحن العربيات، التي تعيش حياتها في العلن، تعّرفُ ماذا تريد، وكيف تعبّر عن ذاتها، وتملي حقوقها على الجميع.
قبل ذلك كانت فظائع اعتقال السّوريات، واختطافهنّ في بلدي، جعلتني ارتعد خوفا من الاغتصاب، وأنا أقّطع حواجز الأمن، أو أسير وحدي، مع أني كنت أطأ خمسيني. قصصّتُ شعري الطويل بيديّ، ولم اعد أصّبغه إلا نادرا، تجنبت وضع معاجين الترطيب، أو مواد التجميل على وجهي، أهملت مظهري، وغالبا ما كنت ارتدي بيجامتي الفضّفاضة، وأقبع كئيبة في بيت أمي.
دخلت لبنان مع دخولي سن اليأس في شتاء 2013، وكنت أشعر أني كتلة من الحطام في داخلي، ومن الخارج أقبح امرأة في التاريخ، لن أجد من ينظر في وجهي، ويمنحني فرصة للعمل أو الحياة، وبعكس توقعاتي أهدتني بيروت كامل فرحي. استأجرتُ غرفتي في سكن مشترك للبنات بحي «المزرعة»، وبعد شهر بدأت أنشر مقالاتي في جريدة «المستقبل»، ثم انتقلت إلى شقتي المسّتقلة في «الرملة البيضاء».
شرطي المرور يوقف لي السيّر، وبعد شهر يتبعني، ويقول: «بدي احكيكِ». سائق السرفيس يحدثني عن الجمال السوري. أسأل صاحب المطعم، إن كان لديه شيء من الحلوى، ويجيبني: «مافي حلو إلا عيونِك». يتبعني الشاب الجميل بسيارته الفخمة، ويدعوني لشرب القهوة، أقول له: أنا بعمر أمك، ويردّ «شو خصّ العمر؟». كنت أتفاجأ ولا أصدق، أتجاهل الإطراء، وأرفض العروض وأنا أقهقه، لكن تودّد الرجل اللبناني إليّ، كان على قلبي أحلى من العسل. نفضّتُ عني الغبار، نزعّتُ بنطالي الطويل، وارتديت الفساتين القصيرة، بعد أن هجرتها ربع قرن، وحين كان النسيم يلّمس جلّدي العاري، وتتغلغل الشمس في مسامي، كنت أشعر بأنوثتي تستيقظ.
لبيروت أسماء كثيرة، أقّربها إلى روحي «المدينة الإلهة»، وأسميها في قلبي «ثورة الأرّز» يتعرض ناشطوها للاغتيال منذ عشرة أعوام، ويتابعون حراكهم السلمي في وجه الموت. أفراد لكل منهم طبعه ومشروعه الخاص، يجمعهم هاجس إعمار لبنان وحق المواطنة، ويشكلون تيارا له أثره وثقله. يدعمون ثورتنا، ويلحّون على خروج قتلتهم من أراضينا، وابتسمت لي النجوم، حين التقيت بعضهم منذ يوم نزوحي الأول. كانوا البلد الذي سحرني، وآزرني، أهداني عيوني الجديدة، وسألتُ نفسي، لماذا أتماهى بوقائع وأسماء لا علاقة لي بها، حتى أكتب أني أمّقت حكم الأسد. قاطعّتُ قلمي الرصين، ونقدي الحصيف، تحديّتُ كوابحي، وبدأت أسّرد مشاعري، وأسخر من مفارقاتي، شجعوني، ولم أعد أخشى أحدا، أو أخجل من شيء.
لم أعد أكتب عن الأحداث، صرّتُ أكتب حدثي في قلبها، وحين أضع موادي على مكتب مديري، ويثني عليها، يخبرني من أُعّجبَ بمقالتي السابقة، وكم بلغ عدد القراء الذين فتحوها على موقع الصحيفة. كنت أنظر إليه غير مصدّقة، ابتسم، وأشعر أن أجنحة بيضاء، تنّبت على ساعدي. لن أنسى لطفه ودعمه لي، كان يفهم صمتي، ويديرني في الوجهة التي أريد. قبله كنت أمشي على رأسي، وبقربه تعلمّتُ أن أقف على قدميّ، ونزولا عند رغبته بدأت أخطُّ أولى صفحات حياتي. استُقبلتْ بانتباه لم أتوقّعه، وصار معارفي في المنابر الأخرى يطلبونها، وكتبتها حتى تعبّتُ، وشعرت أني أكاد أفقدها.
حياتي الفقيرة، المسّروقة، المحّروقة، المهّتوكة، مثل حيوات أغلب السوريين، لم تكن استعادتها سهلة عليّ، تعودّتُ أن أطّمسها، لأحمي نفسي، وكان عليّ أن أرتق ثقوب ذاكرتي، وأرمّم مناطقها التالفة، أدخل دهاليزي ببطء، وأنكأ جراحي، جرحا بعد جرح، أنبش أسراري، وأبكي وأنا أحرّرها، وأبصر على الأوراق خيبتي، والألم يصرخ في أعماقي. كنت امرأة من ورق، تنمّق تجارب الآخرين، وفي بيروت كتبت حكايتي، ووجدّتني أحيا، وأجذب القراء بجرأتي، أنا الإعلامية، السورية، المهّملة، التي اقتصرت معارضتي على الصمت والمقاطعة، وكنت أموت خوفا، أن يسحبني الأمن من سريري، بعد كل زلة لسان.
لبيروت أكثر من وجه، وأنا عرفت فتّنتها وحرّماني. كنت أسكن في حيّ يطلّ على البحر، وتطلّ من مبانيه العالية وشوارعه المضاءة فنون العمارة والتخطيط. حدائق منسّقة، واجهات زجاجية كبيرة ومتاجر فخمة تعكس حياة الأثرياء، لكن بنايتي القديمة كالمومياء، تقابل حاويات القمامة، وتشرف على ثُكّنة عسكرية. تنخر الرطوبة أرضها وجدرانها وتمديداتها الصحية، وتشكو انقطاع التيار الكهربائي في غير مواعيده المحدّدة، ولم يكن في بناية الأحلام موّلدة خاصة للنور، أسوة بباقي البنايات من حولها.
منزلي حديث الترميم، في الدور الثامن، بغرفة واحدة وحمام صغير. فرشتّه من «الأوزاعي»، كافحت صراصيره التي اقتحمتْ عليّ خصوصيتي، لكن مياهه المالحة، الصدئة، أعيتْ شعري وجلدي وملابسي. أكتب على حضني، أغسل بيدي، وأستلقي بأناة على سريري، حتى لا يسّقط بي. يغزو سمعي رشق الرصاص، وأحيانا تصلني أصوات ضحك وسبابّ وضرب، هل هو عنف جسدي، أم جنسي؟ الله أعلم، لا أنام، ولا أجرؤ أن أفتح بابي. وكنت أدفع لقاء رفاهي ستمئة دولار في الشهر، وتدفع لي هيئة الأمم ثلاثين دولارا ثمن طعامي.
معارفي كثيرون، لكني لم أعثر على رفيق دربي، ولم أعقد صداقاتي العميقة مع المثقفين اللبنانيين، كنت أجد الأعذار وأختفي، إن تقرّب أحد مني، ربما لأني أفضّل رشف قهوتي على جلسات الخمّر والطعام، أو أن دخلي القليل، الذي لم يتجاوز الثمانمئة دولار، جعلني أكتفي بعلاقتي الناعمة مع الفضاء.
شارع الحمرا جمعني بزميلي القديم، فرحّت به، وصرّنا نتواعد. لم يكن مفتونا مثلي ببلد النزوح، كان يتوجّس من الجميع، ويحذّرني أن مقالاتي وضعتني في دائرة الخطر، وحين انتبهتُ أن زميلي لا يحمل بيده سوى صحيفة «الأخبار»، وله علاقاته بأشخاص موالين لحزب الله، كنت أودّع هدأتي في بيروت.
انتهى عامي الأول باغتيال محمد شطحّ، واستقبلت الجديد بالتفجيرات، وحوادث الاعتداء على الناشطين السوريين. وما إن انتصف الربيع، حتى شعرت أن هناك من يتعقّبني، وأن عاصمة أحلامي تغلق أبوابها في وجهي. لم أعد أكثر الخروج من منزلي، ولم أعد أشتهي الكتابة، وعادت الشكوك والمخاوف تسّرح وتمّرح في رأسي، تركتها أمانة عند «حالش» و»داعش»، وهربت.
صوفيا (بلغاريا)
المستقبل