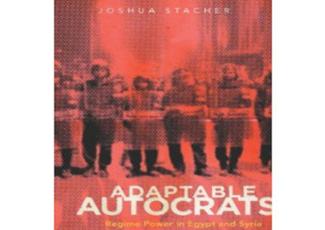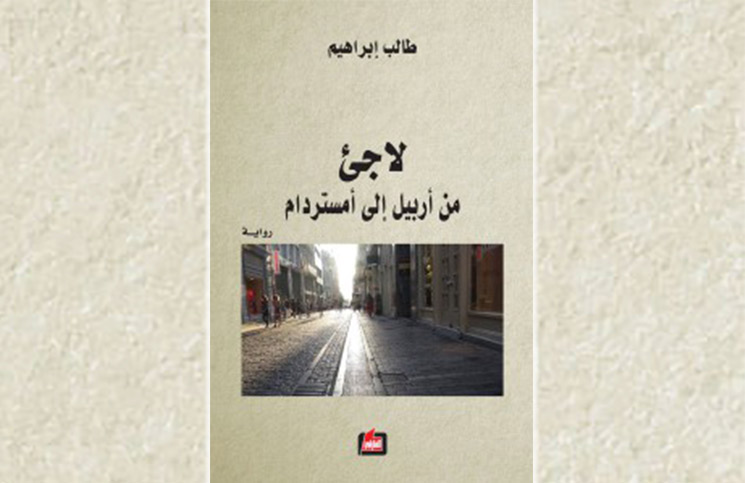خطاب العدالة في الكتب السلطانية/ شمس الدين الكيلاني

عنوان الكتاب: خطاب العدالة في الكتب السلطانية
المؤلف: إبراهيم القادري بوتشيش
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة/ بيروت
السنة: 2014
عدد الصفحات: 86 صفحة
يضع بوتشيش[1] هدفًا لبحثه فتح ملفّ خطاب العدالة في كتب الآداب السلطانية، بوصفه مثّل حلقة من حلقات تاريخ الأفكار السياسية في المجال الإسلامي، وبلور سياسة عملية امتزج فيها الديني بالسياسي. فكانت “العدالة” عنوانًا لمسعى حاول فيه كاتب السلطان التوفيق بين الديني والسياسي، أو تسخير الديني للسياسي. فيعترف بوتشيش بصعوبة المهمة التي أعدّ نفسه لها؛ فللوصول إلى مقاصده، أمامه الكثير من الصعوبات المنهجية والتشريحية والتنقيبية “خصوصًا أنّ كثرة النصوص السلطانية وتعدّد أبواب ’العدل‘ و’الشورى‘ في ثنايا الكتب السلطانية لا يعنيان أنّ تلك النصوص تتضمن كلّ ما يصبو إليه الباحث من توفُّر ضوابط وآليات تتحكم في تشريح موضوع العدالة أو تشبع فضوله الفكري في الحصول على أجوبة دقيقة عند البحث فيها”[2].
مقدمات في التفكير في الأدب السلطاني
قبل الدخول في تلافيف تفكير بوتشيش في “خطاب العدالة السلطاني”، علينا إلقاء نظره تاريخية على عوامل نشأة هذا الأدب في الزمن الوسيط، ولنلقي نظرة أخرى على ما كُتب عن هذا الأدب في الدراسات العربية الحديثة، لنرى على ضوء ذلك، ما أضافه بوتشيش من جديد على هذا التأليف المعاصر، من خلال دراسته مفهوم العدالة فيه.
في تاريخ النشأة وظروفها
وُلد الأدب السلطاني من رحم التقسيم أو التوزيع الوظيفي الذي حدث بين أرباب القلم في السلطة في المجال العربي الإسلامي. فسجّل الواقع التاريخي ذلك التمييز أولًا، ثم الاستقلال ثانيًا بين أحكام السياسة وأحكام الشريعة. فسجّل الفقيه اعتراضاته، وذلك لأنّ الفقهاء لم ييأسوا من استعادة الشريعة، في حين كان همّ المجتمع الحصول على سياسة عادلة وحسب (التي هي المقصد النظري الأسمى لكاتب الآداب السلطانية)، بخاصة بعد أن انفصلت، في مرحلة متقدمة من عمر الدولة العباسية، المؤسسة السياسية عن المؤسسة الدينية تدريجيًا إلى أن اكتمل ذلك مع انفصال الخلافة عن السلطنة. وحدث “تمايز بين مجالين أحدهما سياسي والآخر ديني، ولكلٍ منهما أربابه”[3].
نظر ابن خلدون إلى هذا النموذج السلطوي بوصفه شكلًا بدائيًا للسلطة. ورآه ابن المقفع “لعب ساعة ودمار دهر”. أمّا الماوردي فلم يعره اهتمامًا كبيرًا؛ فهو عنده شكل مدني من أشكال فساد السلطة السياسية. أمّا النوع الثاني من الملك فهو مُلك الحزم، أو مُلك القوة، أو مُلك السياسة، فإنّهم أخذوه على محمل الجد. “والجديد في المسألة” أنّ الماوردي وابن خلدون وهما ينتسبان إلى مجال الفقه، بينما كان ابن المقفع مؤلفًا في الآداب السلطانية، كانا “لا يستنكران” هذا الشكل (=مُلك السياسة) ناظرين في ذلك إلى الدولة السلطانية في ديار الإسلام منذ القرن الرابع الهجري على أنّها صورة عن هذا النموذج[4].
اهتم أحمد محمد سالم صاحب كتاب “دولة السلطان” بالتعرُّف إلى الدوافع السيكولوجية والثقافية التي وقفت وراء التأليف في “الآداب السلطانية”، وهيّأت لها حضورها في الثقافة العربية السياسية. فرأى أنّه كان لها دورها في التسويغ الأيديولوجي لعلاقة الاستبداد؛ فبقدر ما اقتنع سالم بأنّ الهمّ الأساسي لهذا الأدب هو ترسيخ ثقافة الرضوخ لأحكام السلطان، ولم تعر التمسك بأحكام الشريعة وبالقيم الملتصقة بها اهتمامًا؛ فلا يوجد فرق كبير لدى كاتب السلطان بين الرجوع إلى أرسطو أو حكمة عمر. فتتلاقى الثقافات في جسد التأليف السلطاني[5]. ونظر الجابري إلى ابن المقفع على أنّه “أوَّل من دشن القول في ’الأيديولوجية السلطانية‘ في الثقافة العربية الإسلامية”[6]. ووصف ابن خلدون (ت808هـ) معاني السلطة في المجال الإسلامي، فقال: “إن الخلافة قد وُجدت بدون المُلك أولاً ثم التبست معانيهما واختلطت. ثم انفرد المُلك حيثُ افترقت عصبيّته عن عصبية الخلافة”[7]. ورأى كمال عبد اللطيف، بدوره، أنّ ميلاد هذا الأدب يرتبط تاريخيًا بالتحوّل الكبير الذي أعقب العهد الراشدي، فـ”كان انتقال الخلافة إلى ملك في العصر الأموي (41-132هـ/661-750م) بمثابة إعلام واضح على الانقلاب السياسي الأعظم في تاريخ الإسلام. وقد ساهم هذا الانقلاب في تهيئة إمكانيات نشوء وتبلور خطابات سياسية مواكبة له، وذلك بهدف تبرير أعمال الملك”[8]. وحدّد خالد زيادة، في السياق نفسه، تاريخيًا واجتماعيًا، نشوء طبقة كتّاب الديوان في بداية العهد الأموي، من أفراد غير عرب، واحتفظت بهذه الخصوصية لأجيال مديدة… فمنذ سالم كاتب ديوان هشام بن عبد الملك، وعبد الحميد الكاتب كاتب مروان بن محمد، وابن المقفع، أُرسيت قواعد كتابته ذات الطابع الفني المتخصص”[9]. لذا منح كاتب السلطان دورًا متعاظمًا، فالخطاب الذي يقدّمه يكشف “عن الدور غير المباشر والحاسم الذي لعبه، ليس بصفته ناصحًا للسلطان فحسب، ولكنّه خلال مشاركته في مشروع السلطة”[10]. فلقد غدا من الممكن التمييز بين نمطين من نماذج الآداب السلطانية التي ظهرت في القرن الخامس الهجري؛ بين مؤلفات الغزالي والطرطوشي وابن حداد، ونظام الملك، والتي مازالت تتمسك بالقواعد الفقهية وبحلم الخلافة، ويمكن أن نطلق عليها “الاتجاه السياسي الفقهي”، ونماذج أخرى تحرّرت من الفقه، وكُتبت خلال القرنين السادس والسابع الهجريَين، وطغى عليها الطابع المصلحي المدني، والانشغال بموضوعات “مرايا الأمراء”، واقتنعت بسرد النصائح والطرائف المسلّية للسلطان.
- بين الفقيه وكاتب الآداب السلطانية
مع الزمن، اعترف الفقيه بتحوّل سلطة “الخلافة” بعد العهد الراشدي، وبازدياد الطابع المدني لطبيعتها وسلوكها. فعمل على المواءمة بين تعلّقه الوجداني بنموذج الخلافة الراشدية وتعامله مع الواقع الفعلي للسلطة كي يستطيع التكيّف مع أحوال الزمان. أمّا كاتب السلطان، مؤلف الآداب السلطانية، فاتّخذ السلطان مثالًا له واستبعد من تمثلاته طوبى الخلافة. أقرَّ الماوردي وابن خلدون ضمنيًا بالشرعية النسبية لهذا الشكل من السلطان، وذلك ليأسهما من استرجاع نموذج الخلافة الراشدية[11].
انطلق مؤلف الآداب السلطانية من اعترافه النهائي بشرعية السلطنة والسلطان، بينما واجه الفقيه بروز ظاهرة المُلك القائم على المصلحة من زاوية الاعتراف الصريح بها، لكن مع الاعتراف بنقص شرعيتها، مع حنين لا يتوقف لنموذج الخلافة. لهذا أشار ابن المقفع (145هـ) إلى ثلاثة أشكال ممكنة للملك: مُلك الدين، ومُلك الحزم، ومُلك الهوى. والأخير لديه أسوأ أشكال المُلك، “فملك الهوى لعب ساعة ومار دهر”[12]. وحدّد الماوردي بدوره ثلاثة أشكال أو تأسيسات ممكنة للملك تقابل نماذج ابن المقفع: تأسيس الدين، وتأسيس القوة، وتأسيس المال. كما تحدّث ابن خلدون وشارحه ابن الأزرق عن ثلاثة أنواع للملك: الملك الديني، والملك الطبيعي، والملك السياسي. أمّا الأشكال “السلبية” لهذه النماذج من السلطة عند المؤلفين الثلاثة هؤلاء، فهي عند ابن المقفع: ملك الهوى، وعند ابن خلدون: الملك الطبيعي، وعند الماوردي: تأسيس المال. واختار الثلاثة، اعترافًا منهم بالأمر الواقع، الملك السياسي القائم على القوة (الماوردي)، والملك السياسي (ابن خلدون)، وملك الحزم (ابن المقفع).
وكان لهذا التأليف السلطاني سوقه الرائجة ومجاله التداولي. فلاحظ العروي أنّ الآداب السلطانية تؤلف جزءًا كبيرًا من التأليف العربي الإسلامي، منذ أواسط القرن الثالث الهجري تختلف في محتواها وأهدافها عن مدونات الفقه؛ فـ”هناك ظاهرة تميّز كتب الآداب السلطانية وهي وفرة الاستشهاد بحوادث تاريخ الفرس وأقوال حكماء اليونان. إنّ الفقهاء لا يعادلون أبدًا بين الشرع والعدل الإنساني لأنّ السنّة أعلى من ناموس العقل، في حين أنّ مؤلفي الآداب لا يكادون يميزون بين شرع النبي وعدل أنوشروان وعقل سقراط”[13]. ووصفها بـ “الواقعية”، لأنّ الآداب السلطانية “لا تُميِّز بين شرع النبي وعدل أنوشروان وعقل أرسطو”[14]. كما وصفها الجابري أيضًا بأنّ “قوامها ثلاثة أنماط من السلوك يؤسسها جميعًا مبدأ “إنزال الناس منازلهم: الترفع على العامة والنفور منها، والانبساط مع (الخاصة) وبناء المعاملة معها على المجاملة والتوادد، والانصياع التام لـ(السلطان) والسير على طاعته وتقدير الأمور على هواه”[15]. وقد أشار عز الدين العلام إلى أنّ الباحثين العرب المعاصرين أجمعوا على “أن الآداب السلطانية تقوم على تصور ’عملي‘ للمجال السياسي وأنّ هدفها الأسمى يتمثل في تقوية السلطة ودوام الملك”[16]. ويذهب علام أبعد من ذلك حين يرجِّح فكرة أنّ الآداب السلطانية تشكّل في وحدة منطقها وموضوعها خطابًا واحدًا، تجعل من شخصية المؤلف بلا معنى أو ضرورة فالمؤلف السلطاني “يكتب وفق قواعد محددة سلفًا. ولا نعثر لذاتيته على أيّ صدى في موضوعية النوع الذي يكتب فيه… يظل مجرد حامل النوع”[17].
أسئلة الكاتب والكتاب
يضع بوتشيش أمامه ثلاثة أسئلة يطلُّ فيها على مفهوم العدالة في خطاب هذه الآداب، والمرجعيات التي ترجع إليها، كما يتساءل عن موقع حقوق الإنسان في متنها علّه يجد بذورًا أو نوًى لهذه الحقوق. ويختار أربعة نصوص تأسيسية من هذه الآداب لينكبّ عليها في بحثه: “نصيحة الملوك” لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، و”التبر المسبوك في نصيحة الملوك” للإمام الغزالي، و”الإشارة في تدبير الإمارة” لأبي بكر المرادي الحضرمي، و”الشهب اللامعة في السياسة النافعة” لأبي القاسم بن رضوان المالقي. وطالما أنّ خطاب العدالة يقوم على أضلاع ثلاثة (المخاطِب، الكاتب/ الناصح)، والمُخاطَب (السلطان/ الذي به تصلح الأمة أو تتعثّر)، وموضوع الخطاب (العدل الذي تتمحور حوله النصائح والإرشادات)، فالمؤلف يعاين مواقع هذه الأضلاع الثلاثة وفحواها في سيرة العلاقة بين السلطان ورعيته وسبل تحكيم العدل بها التي يصبح مضمونها، بموجب إحالات هذه الآداب ودلالاتها، مسؤولية الحاكم (الراعي) وطاعة الرعية.
حاول المؤلف ترتيب أفكاره حول ثلاثة محاور أساسية: توضيح معنى العدالة في الآداب السلطانية، ثم العودة إلى مرجعيات المؤسسة لخطاب العدالة في الآداب السلطانية، وثالثًا التقصّي عن بذور حقوق الإنسان فيها. ويختم بحثه بمحاولة قراءة مؤثرات الآداب السلطانية في فكرنا وتجربتنا السياسية الراهنة.
- العدالة في الآداب السلطانية
تُلازم المؤلف الحيرة في توضيح معنى العدالة المتداولة في خطاب كاتب السلطان؛ فيرى أنّ مصطلح العدالة يدور حوله العديد من المفاهيم الملتبسة، وهو أمر يُرجعه إلى تعدد المرجعيات واختلافها، والمفهوم اللغوي للعدالة الذي يحيل إلى معاني الوسطية والتوازن والمساواة يعجز عن توضيحها؛ فالمعنى اللغوي لا يعكس “جميع التلوينات والملابسات التي اكتنفت مفهوم العدالة بفعل تأثير العوامل السياسية والاجتماعية والأيديولوجية التي أكسبته معاني عامة وفضفاضة” (بوتشيش، ص13). فإذا اتخذ مفهوم العدالة عند البعض معنى المروِّض للنزعات الطبيعية وكبح جماحها، ورأى آخرون أنّ الإسلام أكسبه معانيَ مجتمعية كبيرة تصدرت جميع القيم الدينية والإنسانية إلى درجة أنّ العدل اقترن فيه بأسماء الله الحسنى، فإنّه في الآداب السلطانية اكتسب معانيَ تسهم في تعزيز هيبة السلطان، إلى حدّ أنّ هذه الآداب حوّلت الدين إلى أداة لخدمة الطاعة له، فتركَّز اهتمام كاتب السلطان على توظيف نصوص العدالة لتبرير الخضوع للسلطان، لأنّ الكاتب السلطاني لم يهتم أصلًا بالمفاهيم أو بإنتاج نظرية معرفية في العدالة، بقدر ما كان يهتم بتوظيف نصوص العدالة لتبرير السلطة الحاكمة والدفاع عن استمرارية الدولة واستقرارها (ص 16). غير أنّ هذا لا يدفع بوتشيش لليأس، فيحاول الحفر في تلافيف القصص والأخبار التي يمتلئ بها الأدب السلطاني، علّه يجد مبتغاه. فتلك النصوص موجَّهة للسلطان محاباةً ومداراةً، فتتحوّل العدالة إلى استدرار عطف السلطان على الرعية، فالبشر عدوانيون يحتاجون إلى من يملك العزم على ردع الظالم وإنصاف المظلوم، ويحقق بذلك التوازن اللازم لاستمرار الاجتماع البشري، “وبذلك تكون الدائرة السلطانية هي الرحم الذي ولد منه المفهوم” (ص 18). لذا تبدو العدالة بهذا المفهوم السلطاني عرجاء تقوم على تجاهل الطرف المحكوم، والذي يزيد من ثقل هذا التفسير أنّ المسألة برمّتها هي مسؤولية السلطان وحسب، وهو في الوقت نفسه، غير مُلزَم بها. فيستشهد بقول ابن رضوان “ليس فوق السلطان العادل منزلة إلَّا نبيّ مرسل”.
- المرجعيات المؤسسة لمفهوم العدالة في الآداب السلطانية
يتفق بوتشيش مع الباحثين الآخرين في تأكيده أنّ الترويج للنظرية السلطانية للعدالة اقتضى تنوّع مرجعيات الآداب السلطانية. فإذا كان العهد الراشدي “قد شهد دورة العدالة، فإنّ ’الشرعية لمن غلب‘ ظلّت هي المهيمنة على المجتمع الإسلامي في مساره التاريخي” (ص 28). ويعيدنا المؤلف، في هذا السياق، إلى المفهوم الاستشراقي: الاستبداد الآسيوي، ونمط الإنتاج الآسيوي، فيقول إنّ الآداب ركَّزت على النص القرآني والحديث، في الوقت الذي نصَّت فيه “على أن السلطان مُكلَّف بحراسة الدين في المجتمع، مستلهمة نموذج ملوك الأنظمة الاستبدادية في نمط الإنتاج الآسيوي” (ص 29).
وعلى الرغم من الطابع الدهري لمنظومة قواعد الأدب السلطاني، فهي لم تتوقف عن توظيف الدين “لإسباغ الشرعية على عدالة السلطان” والمقدس في خدمة الدنيوي، ولم تقتصر على توظيف النص الديني، بل اتكأت على ما هبَّ ودبَّ من نصوص مُستقاة من الثقافات الأخرى: يونانية وهندية وفارسية، واقتبست من تجارب الفرس وحكمة اليونان وعقل الهنود، فيطيب لابن رضوان القول “واتفق حكماء العرب والعجم”، إذ سعى كاتب السلطان إلى “تكييف خطاب العدالة السلطاني مع إجماع مفكري المجتمع الإنساني”، مستخدمًا بهذه الاقتباسات المتنوعة “إلى تبرير استبداد الدولة السلطانية بعد تحول الخلافة إلى ملك عضوض” (ص 33)، إضافةً إلى لجوئه إلى تجارب الأمم التاريخية وتوظيف تاريخ “الآخر” في محكيّاته ونوادره؛ فيقدّم المؤلف مثالًا على ذلك الماوردي في كتاب “نصيحة الملوك” الذي استعان فيه بنوادر آل ساسان وإصغائهم لتظلُّم رعيتهم. وأشار إلى إسهاب الأدب السلطاني في إعلاء شأن السلطان ورفعته، يظهر ذلك جليًا لديه في وصفه أبّهة مجلس السلطان، وفي الطقوس المرعيّة التي تحفل بالرموز التي تجعل مجلسه مسرحًا للهيمنة والانقياد لعظمة السلطان ومكانته، يظهر فيه السلطان كالرأس والرعية في موقع الجسد. فلا يتردد الماوردي في القول: “إن الله جعل الملوك خلفاء في بلاده وأمناء على عباده ومنفذي أحكامه في خلقه”. فيذهب المؤلف إلى القول “إن هذه المماثلة بين الله والخليفة، التي بدأت منذ العصر الأموي واشتدت في العصر العباسي وأصبحت جزءًا من الذهنية الإسلامية شيعتها وسنّتها، هي أطروحة مناقضة لمبدأ العدالة، لأنها تنزه السلطان من كل خطأ” (ص 48). فيستنتج أنّه قد ترتب على ذلك، تضييق مساحة حرية التعبير والنقد، والاتجاه نحو القبول باستبداد السلطان. والخلاصة التي يصل إليها المؤلف هي أنّ كاتب السلطان حاول أن يرسِّخ فكرة “الحاكم المستبد العادل”. فلا تقوم عدالة السلطان كما سطرتها الآداب السلطانية على التعاقد أو على التراضي، بل على مبدأ الغلبة والقوة. وتحفل نصوص الآداب السلطانية بالصور الموحية بالخوف. ولإبراز طبيعة السلطان الجبارة التي لا ينفع معها سوى التذلل لتؤسس بذلك لثقافة الخوف، وبأنّ الطاعة هي الطريقة المثلى لعلاقة الراعي بالرعية، فيصبح من الطبيعي أن يُنظر إلى الطاعة بوصفها قيمة وفضيلة، ولا سيما أنّ الآداب السلطانية تُبرِز السلطان في صورة أبٍ للرعية، وأنّها أرفع منازل السعادة، يقول ابن رضوان: إذا “عدل السلطان كان له الأجر، وعلى الرعية الشكر، وإذا جار كان عليه الأصر وعلى الرعية الصبر”.
- حقوق الإنسان في الآداب السلطانية
يرى المؤلف أنّ العدالة في مفهوم الآداب السلطانية تنطلق من تمثُّل هرمي للمجتمع يحتل السلطان رأس الهرم والعامة في الأسفل، ويتدرج ما بينهما بقية الفئات الاجتماعية بدءًا من الحاشية والأعوان في الأعلى، وكلّ فئة لها نصيب متدرج من العدالة. ما يعني “أننا نواجه تعددًا في مستويات تطبيق العدالة” (ص 60)، فينصح الماوردي السلطان بـ”مراعاة مراتب الناس”. لذا يتوصل المؤلف إلى نتيجة مفادها “أنّ صورة العدالة التي رسمتها ريشة مؤلفي الآداب السلطانية هي صورة مائعة تنطق بالفئوية والطبقية وعدم المساواة بين فئات المجتمع، ويؤسسها مبدأ ’أنزل الناس منازلهم‘..” (ص 62). غير أنّ المؤلف يستدرك ليبين لنا أنّه على الرغم من تواطؤ كاتب السلطان مع مولاه، فهناك “ضوابط” أو حقوق كما يقول المؤلف، “نصح” هذا الكاتب سلطانه ليراعيها من أجل ثبات المُلك وتحسين تدبير دولته ولرضى الجماعة. ويذكر من هذه الحقوق (الضوابط): الحق في الطعام واللباس، والحماية من الضرب والإهانة والقتل من دون حق، وحماية المال، وحراسة الدين، وسدّ الحاجة، والإنصاف في التقاضي، ودخول المتظلم أبواب السلطان (ص 66-67). لهذا يبدو للمؤلف أنّ المراجعة الشاملة لسلبيات التراث العربي الإسلامي، ومنه فكرة العدالة، أصبحت مطلبًا ملحًّا للدخول في دولة الحرية والمواطنة.
في الختام
استفاد بوتشيش من الدراسات السابقة التي تناولت الآداب السلطانية في التحليل والنقد. وهذا يبدو جليًا في المراجع التي عاد إليها: من دراسات رضوان السيد، إلى كتابات العروي، مرورًا بالجابري وكمال عبد اللطيف، وعز الدين علام، وبنسعيد العلوي، ومحمد أحمد سالم. وإلى جانب ذلك، كان واضحًا في ترتيب أفكاره وأسئلته، فجعل بحثه يدور حول أسئلة ثلاثة رئيسة، جعلها جسرًا يعبر فيه أبواب الآداب السلطانية وأروقتها. وقد أثمر في تعريف قارئه بمنطق هذه الآداب وموضوعاتها. ولم يخْف في خاتمة بحثه محاولته توظيف استنتاجاته لوصل ما بين منطق هذه الآداب وما اتسمت به الحالة السياسية العربية من استبداد، ذاهبًا في ذلك مذهب عبد اللطيف[18] وسالم، ويُقارب ذلك بحذر؛ فيقول “وعلى الرغم من وعينا بخطورة الإسقاط التاريخي والتغيرات التي طرأت على زمنية الفكر العربي وَسيطِه وحاضره، فإنّ الواقع العربي يشهد على استمرار الآداب السلطانية في تخصيب الفكر العربي المعاصر”. ويختم بالقول “أما صورة السلطان بوصفه ’خليفة الله في الأرض‘ فلا تزال حاضرة وإن بصيغ مضمرة” (ص 68-69). غير أنّ هذا الإسقاط يغمط مسؤولية رجال الحاضر ونسائه عمّا بدا للمؤلف من رضوخٍ لمعاني الاستبداد في الآداب السلطانية من جهة، ولتنوّع التجربة السياسية والثقافة العربية منذ ما يُعرف بعصر النهضة إلى ثورات الربيع التي أعلت من شعاري الحرية ومواجهة “الذلّ”. كما يُخفي دور المنظومات الفكرية المعاصرة وفي مقدمتها “الماركسية السوفياتية والصينية” في ترسيخ نظم فكرية وتجارب سياسية في بلادنا، إضافةً إلى الأفكار الفاشيّة الوافدة في الثلاثينيات، فضلًا عن تأثير الفكر القومي العربي في وعي شبابنا وعقولهم، في طوره الراديكالي الأيديولوجي، والذي ترافق مع الأنظمة (القومية التقدمية)، خلال ثلاثة عقود، على حساب فكرة العروبة الليبرالية الدستورية. كما أنّ علينا ألّا ننسى تلك الفترات التي كانت فيها الليبرالية والمؤسسات الدستورية تبدو واعدة في حياتنا الفكرية وتجربتنا السياسية. حينها، كان صوت أمثال طه حسين الليبرالي لا يعلو عليه صوت في سوق التداول الثقافي العربي.
[1] د. إبراهيم القادري بوتشيش، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة مولاي إسماعيل في مكناس في المغرب.
[2] إبراهيم القادري بوتشيش، خطاب العدالة في الكتب السلطانية (الدوحة/بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014)، ص 7 -8 .
[3] رضوان السيد، الجماعة والمجتمع والدولة: سلطة الأيديولوجيا في المجال السياسي العربي الإسلامي (بيروت: دار الكتاب العربي، 1997)، ص 405.
[4] المرجع نفسه، ص 399. عربي عام
[5] أحمد محمد سالم، دولة السلطان، جذور التسلط والاستبداد في التجربة الإسلامية (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2012)، ص 54 وما بعدها.
[6] محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته، ط4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2000)، ص 367.
[7] عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، عبد الله محمد الدرويش(محقق)، (دمشق: دار يعرب، 2004) ج1، ص 390.
[8] كمال عبد اللطيف، في الاستبداد: بحث في التراث الإسلامي (بيروت: منتدى المعارف، 2011)، ص 69.
[9] خالد زيادة، الكاتب والسلطان، من الفقيه إلى المثقف (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2013)، ص 15.
[10] زيادة، ص 14.
[11] السيد، ص 399.
[12] ابن المقفع، الأدب الكبير (آثار ابن المقفع )، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1989)، ص 250.
[13] عبد الله العروي، مفهوم الدولة، ط2 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1983)، ص 105.
[14] المرجع نفسه، ص 94.
[15] الجابري، ص 342.
[16] عز الدين علام، الآداب السلطانية (الكويت: عالم المعرفة 324 – المجلس الوطني للثقافة والفنون دار الآداب، 2006)، ص 14.
[17] المرجع نفسه، ص 93.
[18] عبد اللطيف، (ص 316): “ففي أغلب الدول العربية الإسلامية لا تزال علاقة الحاكمين بالمحكومين، تتم بتوسط لغة الآداب السلطانية، ولا تزال السلطة تنظر إلى نفسها من نفس زاوية نظر الحاكم السلطاني”.
باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في وحدة الدراسات السورية المعاصرة. له العديد من الدراسات الثقافية والسياسية، منها صورة أوربا عند العرب في العصر الوسيط، وصورة الشعوب السوداء في الثقافة العربية، وصورة شعوب الشرق الأقصى في الثقافة العربية، وتحولات في مواقف النخب السورية من لبنان1920 -2011، والشيخ محمد عبده، والإسلام وأوروبا المسيحية القرن 11-16، والعود الأبدي، والعديد من الدراسات الأخرى.
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات