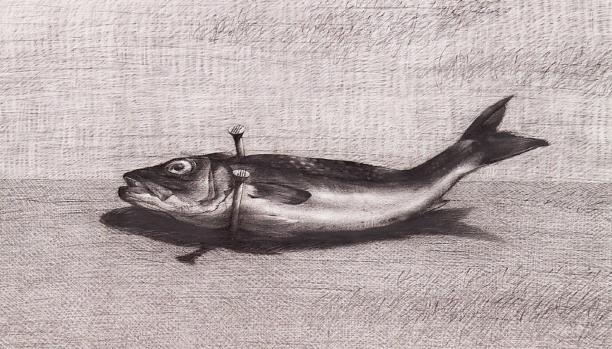رسائل حول “اليسار”

رسالة إلى الأصدقاء في “الجمهوريّة” حازم صاغية
ما دفعني إلى كتابة هذه الملاحظات النقديّة لـ «الجمهوريّة» إحساسي بأنّ لي سهماً فيها، إذ يربطني بقضيّتها وبأشخاصها من الروابط ما يجعلني شريكاً في نجاحهم، كما في فشلهم.
و«الجمهوريّة»، بعد كلّ حساب، علّمتنا أشياء عدّة عن سوريّا، وحدَّت من مجهولاتنا الكثيرة بها وبتفكيرها. كذلك، ومن خلال نصوص أدبيّة وشهادات شخصيّة مؤثّرة، أعطت تلك المأساة بعض لحمها وشحمها وزادت في منظوريّتها. لكنّها، مع هذا، كان يسعها، في ما أظنّ، أن تفعل أكثر ممّا فعلت لو أنّها صبّت كلّ الشقّ المهدور من جهدها في الموضوع السوريّ ذاته، وما يتّصل به على نحو مباشر لا يقبل التكهّن. وما أقصده بالشقّ المهدور هذا الاستحضار، بسبب وبلا سبب، لـ«اليسار»، وهذا التقليب لأوجهه وصولاً إلى الانشغال بتأويلات الغرامشيّة وتطبيقاتها في الهند.
وفي هذا جميعاً ما يذكّر بالتنقيب عن الذهب في الوسط الأميركيّ. ذاك أنّ اليسار المذكور، وهو ما يضاعف الاستغراب، يقف بنسبة 90 بالمئة، إن لم يكن أكثر، في صفّ بشّار الأسد. فكأنّ «الجمهوريّة»، في هذا الجانب من اهتمامها، تشبه ما ترويه الحكاية المتداولة عن ذاك العاشق لابنة الملك الذي لا يكفّ عن ضرب المواعيد ليوم زفافهما، فيما الملك وابنته غافلان تماماً عن المسألة.
مثل هذا التعلّق العاطفيّ من طرف واحد نجد له أشكالاً كثيرة. فبين اللبنانيّين، مثلاً لا حصراً، من يكرهون حزب الله فيما لا تزال «المقاومة» عزيزة على قلوبهم، يظنّون أنّ الحزب سلبهم إيّاها وأنّهم مصرّون على استعادتها منه وتجديد الاستحواذ عليها. وهكذا يمضي الزمن مكرّساً التماهي بين الحزب والمقاومة، ومعزّزاً شوكة استبدادهما الواحد، بينما الآخرون غارقون في الأحاجي والمماحكات اللفظيّة التي تتوهّم تأصيل الهجين، والكشف عن «طبيعة فعليّة» مفترضة لظاهر عَرَضيّ ومزغول.
وفي لعبة كهذه يقيم الولاء المتوارث لسلفٍ فكريٍّ صالحٍ استدخلناه فينا على هيئة عشق ذوبانيّ في محبوب اقترنَ بغيرنا، وأنجبَ أبناءً ربّاهم كي يكونوا محاربين شرسين ضدّنا. لكنْ هل يعقل أن تكون المقاومة التي «زوّرها» حزب الله أقلّ من مجيدة وعظيمة في ذاتها الجوهريّة، التي لا تُرى بميكروسكوب ولا بتليسكوب؟
واقع الأمر، ومن دون أن يُفهم الكلام على أنّه تزكية لـ«يمين» ما، عملاً بتضادّ بسيط تمليه الثنائيّات، فإنّ السياسيّ الغربيّ الأبرز في دعم الثورة السوريّة كان الجمهوريّ «اليمينيّ» جون ماكّين، وبدوره كان المحافظ «اليمينيّ» ديفيد كاميرون، ولا يزال، متقدّماً في موقفه من الشأن السوريّ على العمّاليّ «اليساريّ» جيريمي كوربن الذي يُعتبر أكثر يساريّة من سابقيه في قيادة حزبه. أمّا الأميركيّ بيرني ساندرز، الذي تشابه حالُه في الحزب الديمقراطيّ الأميركيّ حالَ كوربن في الحزب البريطانيّ، فيصحّ فيه، هنا أيضاً، ما يصحّ في زميله العمّاليّ.
ومرّة أخرى، ليس المقصود أنّ «اليمين» يدعم الثورة السوريّة، بدليل اصطفاف حركاته المتطرّفة وراء بشّار الأسد على نحو لا تتميّز فيه عن اصطفاف الحركات «اليساريّة». فما تُدافعُ عنه هذه الأسطر أنّ المسألة برمّتها، مسألة اليمين واليسار، ليست راهنةً في ما خصّ الموضوع السوريّ، ولا يبدو الموضوع السوريّ راهناً في ما خصّها.
وقد يصرّ واحدنا على المضيّ في إسباغ المعاني النبيلة على «اليسار»، وقد يوجد من يفعل الشيء نفسه في ما خصّ «اليمين». لكنّ تلك الثنائيّة باتت من المسائل المُشكَلة والمعقّدة تعقيد المفهومين في زمننا، وآخر الأدلّة الكثيرة الاستفتاء البريطانيّ، حيث لم تَحُلْ مصيريّة موضوعه دون إمّحاء الفوارق القديمة لصالح فوارق أخرى جعلت البريطانيّين «حزبين»، واحداً لمغادرة أوروبا وآخر للبقاء فيها، وكلّ منهما يضمّ «يساريّين» و«يمينيّين».
وفي الحالات جميعاً يمكن القول إنّ موضوعة الاستبداد والحرّيّة، وهي لبّ الثورة السوريّة في ما أظنّ، ليست موضوعة يساريّة بأيّ معنىً كان لليسار. فهو، أكان في طوره الكلاسيكيّ الأوروبيّ الأوّل، أم في طوره الشعبويّ العالمثالثيّ الثاني، ليس أكثر المراجع صلاحاً للاستشارة والاستنارة في ما خصّ الصراع بين الاستبداد والحرّيّة. ذاك أنّ الطور الأوّل، الطبقيّ، حيث تربّعت في الصدارة «ديكتاتوريّة البروليتاريا» قبل أن يعزّزها لينين بنظريّة الحزب الطليعيّ في «ما العمل؟»، لم تملك في هذا المضمار سوى التأسيس لدزينةٍ من الأنظمة كلّها استبداديّة وساحقة للحرّيّة. أمّا الطور الثاني، القوميّ، فهو حيث رُسِمَ نظام كنظام الأسد، مدعوم دائماً من الصديق السوفياتيّ الصدوق ومن أحزابٍ وجبهاتٍ لا حصر لها كلّها «تمثّل الطبقة العاملة»، واحداً من عيون الأنظمة الوطنيّة التي تتصدّى للإمبرياليّة.
ولقائلٍ أن يقول إنّ اليسار المرتجى هو ذاك الذي ابتدأ مع مدرسة فرانكفورت وتوّجته، بعد انقطاع، محاولات تعيد النظر في أنظمة الرقابة والعقاب وفي المؤسّسات القاعديّة للمجتمع الرأسماليّ. لكنّ السؤال يبقى وجيهاً حول صلة الموضوعات والمشاغل المثارة هنا بما يثيره المجتمع السوريّ وثورته من موضوعات ومشاغل. والتحفّظ نفسه يصحّ على حركات اليسار ما بعد الشيوعيّ، أكان لجهة «سيريزا» اليونانيّ الذي يتخبّط في هموم المديونيّة وعلاجها، أم لجهة «بوديموس» الاسبانيّ الذي عمل بعض أبرز قادته مستشارين لهوغو شافيز.
ويُخشى، والحال هذه، أن يكون النقد اليساريّ لنظام الأسد، هو النقد الأشدّ تماسكاً والأشدّ تطابقاً مع ذاته النافية لموضوعة الحرّيّة والاستبداد. قصدت ذاك الذي يعتبر خطيئة النظام الأساسيّة اعتناقه النيوليبراليّة الاقتصاديّة. أمّا السنوات الفاصلة بين 1963 و2005 فلم يَشُبها من الشوائب ما يستحقّ الذكر، اللهمّ ما خلا الهنات الهيّنات التي يستدعيها بناء المجتمع الاشتراكيّ، كتعطيل السياسة والإفراط في توسيع السجون وبناء أقبية التعذيب.
وأيضاً قد يقول قائلٌ إنّ ما يعنيه باليسار هو ما لم يُطبّق حتّى اليوم، إذ اليسار الحقيقيّ والصائب لم يُطبّق بتاتاً. وهنا تُرفع درجة الوله من طرف واحد إلى سويّة ما يقوله مؤمنو الدين عن إيمانهم، الذي لم يجد في آلاف السنوات ومئات التجارب وعشرات البلدان ما يوفّر له التربة الصالحة للنموّ والتحوّل نموذجاً يُقتدى به.
وفي ظنّي أنّ موقفاً إمبرياليّاً جدّيّاً يضغط على الأسد، بل يزيحه، كان ليفعلَ أضعاف ما تفعله النظريّات، مُريحاً الأصدقاء في «الجمهوريّة» وسواهم من بذل الجهد المهدور في تجويد اليسار، ومسرّعاً انتقالهم إلى وعي آخر أشدّ اقتصاداً وقصديّة في اهتماماته، وأقلّ إعاقة بأثقال الأزمنة التي خلت. إلاّ أنّ الولايات المتّحدة في عهد أوباما كانت، لسوء حظّنا وحظّ سوريّا، أقلّ إمبرياليّةً وتدخّليّةً ممّا كانت يساريّةً مضبوطةً بتقليد الانكفاء عن التدخّل في العالم، ممّا يُعتبر الدائمُ الشباب والنضارة نعّوم تشومسكي نبيّه الملهم.
وأهمّ ممّا عداه، في النهاية، أنّ نظام الأسد، وعلمكم بهذا يفوق علمي، إنّما جعل المعرفة بسوريّا أقرب إلى القاع الصفصف. فبجسمه المترهّل جلس عقداً بعد عقد على تاريخها واجتماعها وطبقاتها وثقافاتها وأديانها وطوائفها ومناطقها وإثنيّاتها، وكلّ ما يتحرّك فيها. ومعرفة سوريّا، والتأمّل في مستقبلها واحتمالاته المفتوحة اليوم على مصراعيها، مهمّة عظمى تستحقّ أن تُصرف الجهود كلّها فيها وعليها، لا سيّما جهودكم وجهود أمثالكم القادرين على أن يخرجوا من الغطس بلؤلؤ ثمين.
موقع الجمهورية
“الجمهورية” بوصفها يساراً/ كرم نشار
بعث العزيز حازم صاغية رسالة إلى مجموعة الجمهورية قبل أسبوعين، ضمنّها ملاحظات نقدية تتعلق باستحضار المجموعة لـ«اليسار»، «بسبب أو بدون سبب» حسب قوله. وإذ أناقشُ الآن بعض النقاط التي استوقفتني في الرسالة هذه، إن من حيث اختلافي الواضح معها أو تساؤلي عن النهايات المنطقية لفحواها، لا بد أن أعترف أولاً أني أشعر بمزيج من التهيب والاعتزاز. التهيب لأني بشكل أو بآخر بصدد الرد على واحد من أهم كتاب المشرق العربي في ربع القرن الأخير وأكثرهم إثارة للجدل، والاعتزاز لأن «الجمهورية» على يفاعة تجربتها وعدم انتظام إنتاجها تماماً، باتت هي أيضاً مثار جدل ونقاش، ومنصةً تتجاوزُ في تغطيتها وتأثيرها والتفاعل معها الإطارَ السوري.
والحال أن العلاقة بين «الجمهورية» والشأن السوري، والذي يجد حازم أننا لا يجب أن «نهدر» الوقت بعيداً عنه، هي أول ما استوقفني في رسالته. فالكاتب المخضرم الذي يأخذ علينا اهتمامنا بمفكرين يساريين من أمثال غرامشي وتشومسكي، لا يقترح علينا بالمقابل الالتفات إلى مفكرين ليبراليين أو محافظين، أو الانفتاح على كتًاب ابتعدوا عن الاصطفاف الإيديولوجي برمته، بل يتمنى علينا التركيز على الموضوع السوري و«ما يتصل به بشكل مباشر لا يقبل التكهن». وهو حتى عندما يسلّم جدلاً بيسارٍ مختلفٍ انبثق عن الماركسية الغربية ومدرسة فرانكفورت، فإنه يعود ليشيح النظر عنه بدعوى عدم ارتباطه بالمجتمع السوري ومشاغله. لذلك وقبل أن نخوض في فهمنا لليسار وأسباب استحضارنا له، يبدو من الضروري أن ندافع أولاً عن فهمنا لطبيعة عمل «الجمهورية»: لسنا ولا نريد أن نكون منصةً تختص بالشأن السوري فقط، وتنتج عنها الشهادات الأولية والتحليلات المحلية، بل أيضاً وبالتوازي نافذةً سوريةً وعربيةً تطلّ على العالم وتشارك في نقاشاته الفكرية والسياسية الكبرى. لا نريد الغرق في «الاستثناء السوري»، ولا قبول أنه من الترف لشعبٍ محطمٍ مثلنا أن ينظر بعيداً، ليتعلم من الهند واسبانيا والأرجنتين وعنها، وأن يفكر عميقاً ويناقش قضايا نظرية وكونية كما يفعل أصحاب الاهتمام في نيويورك ولندن وباريس، وبيروت، دون حاجة إلى التبرير الدائم أو التوطئة المحلية المباشرة. سوريا، على فداحة مأساتها، جزءٌ من هذا العالم، والسعيُ من أجل فهمها وتغييرها لا يمكن أن ينفصل عن السعي لفهم وتغيير العالم، ولذلك، وقبل أي اصطفاف فكري أو سياسي، تبقى «الجمهورية» ملتزمةً بالحفاظ على جانب كوني في هويتها وعملها.
ولأن حازم لا يقارب «الجمهورية» على أرضيةٍ فكريةٍ كونية، بل بالنظر دوماً إلى موقعنا كسوريين معارضين لبشار الأسد، فهو يتجاوز أيضاً في حديثه عن اليسار أي تمييز بين المعرفي والسياسي. وبذلك يصبح الحديث عمّا يمكن أن نتعلمه من كلام غرامشي وتلاميذه الهنود عن الانتفاضات الريفية مساوياً للغزل بجيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني، ويغدو البحث فيما يقوله تشومسكي عن الأخلاق الكونية والنسبوية الثقافية صنواً لتبني ترشيح برني ساندرز في الانتخابات التمهيدية الأمريكية! وبحسب هذا المنطق، ولأن 90 % من اليسار اليوم يقف في صف بشار الأسد، ربما يجب علينا أيضاً ألّا ننخرط في أي نوع من أنواع التحليل الطبقي للمجتمعات، وأن نتجاهل الأثر الهائل للماركسية وتفرعاتها على العلوم السياسية والاجتماعية خلال القرنين الماضيين، وأن نرفض قراءة أريك هوبزباوم في التاريخ، ووالتر بينامين في النقد الثقافي، وبدر شاكر السياب في الشعر العربي!
مقاربةٌ سياسويةٌ كهذه لا تظلم «الجمهورية» فقط، فتضعها في موقع العاشق لمعسكر سياسي لم تنشر الجمهورية بخصوصه إلا النقد والإدانة، بل تبدو وكأنها تتوقع من «الجمهورية» أيضاً عزل نفسها بشكل واضح عن أدوات ونقاشات معرفية لم تعد اليوم حكراً على قدامى الماركسيين، بل يتداولها الليبراليون كما اليساريون، وأنبياء الأصالة كما رواد ما بعد الحداثة. فإما أن حازم يستكثر علينا النقاشات الفكرية كما الشطحات الكوزموبوليتية، وإما أنه يريد بالفعل أن يأخذَ الفكريَ بجريرة السياسي، فيشابه دون أن يقصد الممانعينَ في تجريمهم الطويل لأي اهتمام بالمسألة اليهودية والنتاج المعرفي اليهودي بحجة العداء لإسرائيل، والإسلاميينَ في توجسهم من مجمل العلوم الاجتماعية والإنسانية بوصفها رجساً علمانياً أو وحياً من شياطين الغرب الصليبي!
لكن لبَّ المشكلة في رسالة حازم لا تكمن في مقاربته لـ«الجمهورية» كمنبرٍ سوريٍ حصراً، ولا في تجاهله للفرق بين الاهتمام الفكري والغزل السياسي في مقاربتنا نحن لمسألة اليسار، بل في عزله للثورة السورية عن سياقها الاجتماعي أولاً، واعتباره أن النقاش القِيّمي القابع في الأساس وراء كلمات قد تكون متقادمة وفضفاضة وشديدة الإشكالية في بعض السياقات كـ«اليسار» و«اليمين»، بات هو أيضاً متقادماً وبلا معنى. فمن خلال هاتين الخطوتين سيبدو بالفعل وكأن الثورة السورية و«اليسار» ينتميان إلى كوكبين مختلفين، وأن استحضار اليسار في موقع كـ«الجمهورية» ليس إلا إقحاماً يُنتجه «ولاء متوارث لسلف فكري صالح».
لكن الواقع، بالنسبة لكاتب هذه السطور وزملائه في «الجمهورية»، يكاد يكون العكس تماماً! فحساسيتنا اليسارية تبلورت بشكل أساسي من خلال التفاعل مع وقائع الثورة السورية. ذلك أن حازم عندما يقول محقاً إن موضوعة الاستبداد والحرية هي لبُّ الثورة السورية، يُغفلُ أن الموضوعة هذه ارتبطت منذ اللحظة الأولى، أقلّه على صعيد النقاش السوري-السوري، بسؤال: «حرية من تحديداً؟»، وأن هذا السؤال لم يكن يحيل فقط إلى تناقضات المجتمع السوري الطائفية، بل والطبقية منها أيضاً، وبشكلٍ فاقعٍ وصلَ ذروته مع مقولة «ثورة أبو شحاطة»، وتساؤل كثيرٍ من أبناء الطبقات الوسطى والعليا من مختلف الطوائف فيما إذا كان أبناء الأرياف والأحياء الفقيرة يعرفون معنى الحرية، أو يستحقونها أصلاً! وفي الواقع، إن كان هناك من صدمة أخلاقية شخصية أساسية ارتبطت في ذهن الكاتب بالثورة بالسورية، فهي أن نُخباً مدينية -دمشقية وحلبية بشكل أساسي- دأبت في الماضي على انتقاد النظام وتمني الخلاص منه، كشفت منذ آذار عام 2011 عن ترسانة فكرية حداثوية شديدة النخبوية ناصبَت الثورة العداء بسبب هويتها الطبقية تحديداً، وذهبت بهذا إما إلى موقعٍ فاشيٍ ينادي بسحق «العراعير» المتخلفين وتسوية قُراهم بالأرض، أو إلى موقعٍ محايدٍ لا يستطيعُ تأييدَ ثورةٍ يقودها فلاحون بسطاء.
قد يبدو السياق الاجتماعي للثورة السورية هامشياً بعد خمس سنوات من الصراع، سيما للمعنيين بشكل أساسي بالجانب الإقليمي والدولي للمسألة السورية، لكنه لا يزال يتفاعل بقوة تحت رماد الحرب، ويبقى مرشحاً للعودة بقوة مع توضح شكل الحل السياسي القادم. ومن خلال هذا السياق تحديداً، ومع اصطفافات الثورة خلال عامي 2011 و2012، باتَ واضحاً لكثيرين منّا -ولم نكن منخرطين أو معنيين لا بالأممية الثالثة ولا الرابعة- أن قضية الحرية في سوريا، ليس في جانبها الفردي القائم على عدم التدخل في الحيز الخاص بل في جانبها الجمهوري القائم على امتلاك الشعب للمجال السياسي العام، لا يمكن فصلها أبداً عن قضية المساواة بمعناها السياسي والإنساني الأعمق، وأن النضال من أجل ديمقراطية حقيقية في بلد فقير وطرفي مثل سوريا هو في واقعه دفاعٌ عن الأهلية السياسية والقيمة البشرية لأكثرية الناس من فقراء ومهمشين، وأن الانتصار لهؤلاء، الذين هم قادة الثورة ومادتها وأكثر من ضحى لأجلها، لا يكون إلا بالنضال ضد تراتبيات السلطة والمال والثقافة والجغرافيا التي تعمل بنيوياً، في سوريا كما في كل العالم، للحدِّ من مكانهم ومكانتهم وقدرتهم على الفعل في المجال العام، الآن، وبشكل أشرس وأكثر وضوحاً بعد نهاية الحرب وبداية إعادة الإعمار وعودة الحكم المركزي.
ألا تحمل هذه العِبَر طابعاً يسارياً ما؟ ألا يمكن ترجمتها بشكل سياسي، ودون إقحام اقتباساتٍ من ماركس وتروتسكي، إلى تيار ديمقراطي اجتماعي يلتزم بشكل واضح بالمصالح السياسية والاقتصادية للفئات الأوسع والأكثر تضرراً من الحرب السورية، ويرى النضالَ ضد الاستبداد في معناه الأعمق نضالاً من أجل العدالة الاجتماعية، والنضالَ من أجل العدالة الاجتماعية نضالاً ضد الاستبداد؟ ألا يمكننا البناء على هذه العِبَر معرفياً أيضاً فنضع الثورة مثلاً في إطار كوني مقارن بوصفها ثورة ريفية، بدلاً من التوقف فقط عند تفاصيلها المحلية؟ ألا يمكننا أن نحاول مثلاً فهم بنى السيطرة التي تدفع بفقراء العلويين للموت من أجل الأسد حتى اليوم بدلاً من رد القضية فقط إلى الانهيار المديد لمجتمعاتنا، أو أن نتفاعل مع قضايا التحرر الديني والجندري والجنساني الحاضرة لدنيا اليوم، دون الوقوع في فخ النخبوية؟ لا أرى في هذا ولا ذاك هلوسة يسارية طهرانية، ولا إقحاماً لأفكار غريبة وبعيدة عن الواقع السوري.
هل من الغريب جداً أن يدفعنا اهتمامنا بالمساواة كما بالحرية، وإيماننا بنُبلِ السعي نحو العدالة الاجتماعية، إلى التساؤل عن مصائر ونقاشات هذا التيار السياسي والفكري العريض والمتنوع، الذي لم يؤسس لأنظمة يسارية كما في روسيا وأوروبا الشرقية وبعض بلدان العالم الثالث، ولم يتوقف على مدى ما يقارب القرنين من الزمن عن التأزم والتفكك وإعادة التشكل، كما أنه لم يتوقف أيضاً عن الدفع بمفاهيم المشاركة السياسية إلى مداها الأقصى، والتأسيس لمفاهيم الحقوق الاجتماعية بحدها الأدنى ونقد بنى السلطة واللامساواة على اختلاف أنواعها، والنضال ضد الفاشية والعنصرية والاستعمار. هذا التيار العريض والمتنوع، والذي شمل ديمقراطيين ثوريين ونقابيين واشتراكيين وأناركيين وتروتسكيين وماركسيين غربيين و«تقدميين» أمريكيين حتى الحرب العالمية الثانية، ومن ثم توسعَ بعدها ليشمل في الستينات تيارات واسعة في حركة الحقوق المدنية وحقوق المثليين والنسوية الجذرية، وليقود في السبعينات معارك ضارية ضد الديكتاتورية في هند أنديرا غاندي كما في أميركا اللاتينية.
لا يمكن فهم بعض أبسط معالم الديمقراطية الليبرالية في العالم اليوم، ولا السير خطوة في بحر الأنثربولوجيا وعلم الاجتماع والتاريخ والنقد الأدبي والنظرية السياسية، دون فهم أفكار هذا التيار التي بدأت دوماً هامشية وجنونية. هذا التيار، أقلّه في أعراف التسميات في اللغة الانكليزية، هو أيضاً جزءٌ من «اليسار»، والبحثُ في تاريخ الفكر العربي الحديث يظهر حضوره هنا أيضاً، من يوسف يزبك إلى اسماعيل مظهر، ومن سلامة موسى إلى رئيف خوري.
لا يعني ما تقدَّم أن هذا التيار العريض هو «اليسار الحقيقي» كما سيعتقد البعض أني أقول -لا أؤمن أن هناك يساراً حقيقياً كما لا أؤمن أن هناك إسلاماً حقيقياً- لكنه بلا شك حقيقةٌ واقعةٌ في التاريخ، وأخذه في الحسبان كان سيصعّب على حازم جوهرةَ اليسار بوصفه متنافياً مع الحرية. أما أني أُسبغُ على هذا التيار معنىً نبيلاً (دون أن أتغاضى عن أزماته وتناقضاته)، فهذا صحيحٌ بلا شك، ولكن ما الضير في ذلك تماماً؟ ألا يُفترضُ أن نتموضع سياسياً حسب قناعاتنا القيمية، أي حسب ما نرى فيه سعياً نبيلاً إلى الحياة الجيدة؟ ألا تبدو بعض أفضل نقاشات المجالس البرلمانية في العالم وأشهر نصوص المحاكم الدستورية وكأنها نقاشات فلسفية في معنى الحرية ومعنى المساواة ومعنى التقدم؟ وكيف تتناقض هذه القيم في حين وتتقاطع في أحيان أخرى؟
وفي الواقع، إن إمعنا النظر في مقالاتها، لم يكن حديث «الجمهورية» عن «اليسار» يوماً بغرض «تجويد» الكلمة بحد ذاتها، بل للبحث في مآلات تيار فكري وسياسي ارتبط اسمه بقيمٍ تحملها «الجمهورية»، وباستطاعتنا في كل الأحوال تجاوز الكلمة كلها دون أن نتجاوز حاجتنا إلى النقاش عن القيم ومآلاتها! هل المساواة، برأي حازم، تتنافى دوماً وأبداً مع الحرية؟ وهل الصراع مع استبدادنا المحلي يتطلب القبول بنهائية النظام الليبرالي العالمي وكماله؟ نعم هناك في الليبرالية السياسية ما لا يمكن التفريط به أو التعالي عليه -قد يكون هذا هو الدرس الأساسي والأهم الذي خلص إليه جيل حازم- ولكن لأن الحرية لا تتموضع إلا اجتماعياً، ولأن جوانب جديدة لها تتكشف باستمرارٍ مع الزمن، فإن تعميقها في الواقع لم يأتِ خلال القرنين الماضيين إلا من خلال تفاعل الليبرالية مع نقدها اليساري الديمقراطي. أما القول إنه، وبحجة عدم إنجاز الليبرالية، فإن علينا ألَّا ننصت لأي نقدٍ لها، فهذا لا يُتَرجَم عملياً إلا انعزالاً عن العالم أو تحالفاً مع من يسبغون على الليبرالية هوية حضارية جامدة، أي مع الغرب المحافظ.
أخيراً، يبقى القول إنه إن كان الموقف السياسي للآخرين من الثورة السورية هو المعيار الوحيد الصحيح لتموضع السوريين من مؤيدي الثورة سياسياً وفكرياً وقيمياً، فربما يجب أن نصبح جميعاً من حملة لواء الإسلام السني المحافظ، قبل أن نلتفت إلى تفاصيل فكر جون ماكين السياسي. إذا كان العزيز حازم مستعداً للنظر في الأولى، فله مني وعدٌ أن أنظر في الثانية.
موقع الجمهورية
تعقيب على كرم نشار/ حازم صاغية
في ردّه على رسالتي إلى «الجمهوريّة»، كرّمني كرم نشّار باهتمامه وبسخائه. أقول هذا جادّاً، على نحو أريده أن يوازي جدّيّة كرم ورِفعة أخلاقه.
مع ذلك أظنُّ أنّ الصديق العزيز إنّما ناقش ما لم أقله أكثر ممّا ناقش ما قلته. وهذا ما يسهّله، في حالات مشابهة، أن تُبنى للمردود عليه صفات ومواصفات متفاوتة المصدر والدقّة، تقصّرُ المسافة الفاصلة بين قول وآخر. وأستميحُ كرم والقارئ عذراً إن أقحمتُ ما هو شخصيّ في موضوع عامّ: فلقد كتبت في حياتي عشرات المقالات ضدّ النيوليبراليّة وريغان وثاتشر ودبليو بوش وحروبه، والأرشيف حَكَمنا في هذا، وكنت أتلقّى في المقابل مئات الشتائم بوصفي أحد وكلاء ريغان وربعه وأبنائه في منطقة الشرق الأوسط. وفي ظنّي أنّ الكثير من «النقاشات» في هذه المنطقة من العالم إنّما يجافي ما يقال ليركّز على صورة مرسومة سلفاً للقائل. وربّما كان العنصر الأفعل في رسم الصورة هذه مدى مغايرة المردود عليه للإجماعات التي سيّدتها أنظمة الاستبداد العسكريّ والتي هي، لا سواها، إجماعات المركّب القوميّ – اليساريّ إيّاها، حيث ينام الخادع والمخدوع في سرير واحد، وإن كان كلّ منهما يحلم بما لا يحلم به الآخر.
على أيّ حال، وبما أنّني قلتُ في الرسالة ما قلته، فسأغتنم الفرصة هنا للإشارة إلى ما لم أقله ممّا قوّلني إيّاه كرم.
فأنا لم «أستكثر على السوريّين النقاشات الفكريّة» (معقول يا عزيزي كرم!) ولم أقل إنّ عليهم الانحصار في «الاستثناء السوريّ»، ولا أظنّ، بالمناسبة، أنّ ذاك «الاستثناء» استثناء. وكيف يكون ذلك فيما الشاغل السوريّ اليوم أحد أهمّ الشواغل العالميّة، ومرآةً لشعوب المشرق العربيّ في تراكيبها الاجتماعيّة كما في عموم تناقضاتها.
أمّا لماذا لم «أقترح بالمقابل» نوع الاهتمامات الفكريّة التي أراها مفيدة للشأن السوريّ وما يتّصل به، فهذا لأنّني لا أراني المرجعَ المُخوّلَ لأن «أقترح»! فإذا ألحَّ كرم وشدّني من قميصي، اقترحتُ عليه الأدبيّات الجمهوريّة والدستوريّة التي تعلِّم كيف يَحكم الحاكم، وكيف تكون صلته بالمحكوم، وكيف تُفصل السلطات، وكذلك ركاماً من الأعمال الميدانيّة وغير الميدانيّة التي يمتدّ نطاقها من الإسلام إلى العصبيّات، ومن الأرياف إلى المدن. أمّا الشقّ الأوّل من «اقتراحي» فهو ما تدور حوله السياسة وعلم السياسة ممّا نحن محرومون منه، وأمّا الشقّ الثاني فهو ما قد يعصم من الوقوع في «يساريّة الكامبوس» التي يتوقّف أثرها بمجرّد أن تغادر القَدم بوّابة الجامعة (بل يبدو أنّ لها أثراً وحيداً هو تعزيز الذرائع الشعبويّة لدونالد ترامب وأمثاله ضدّ «النخبويّة» و«ديكتاتوريّة الصواب السياسيّ»).
لكنْ يبدو أنّنا هنا مختلفان حول مسألة أخرى ذات وجهين: وجهٌ يتّصل بمدى الانفصال بين السياسيّ والفكريّ، حيث أتمنّاه أن يكون أقصر ممّا يراه كرم، وأكثر قابليّة للتوظيف النفعيّ والعمليّ، ووجهٌ آخر يتعلّق بالمراحل والمرحليّة التي (وهذا اعتراف) لا أستطيع للحظة واحدة أن أرى الأمور في معزلٍ عنها.
وأنا لم أقل بتاتاً بتجاهل الأثر الفكريّ للماركسيّة والتحليل الطبقيّ بحجّة «أنّ 90 % من اليسار اليوم يقف في صفّ بشّار». أمّا أن أكون قد طالبت برفض «قراءة أريك هوبزباوم في التاريخ، ووالتر بينامين في النقد الثقافيّ، وبدر شاكر السياب في الشعر العربي!»، فهذا ما يرسمني في هيئة معاكسة تماماً لكلّ ما كتبت منذ عشرات السنين، والذي بسببه نالني من النقد القوميّ والدينيّ والمحلّيّ والأبرشيّ ما نالني. لهذا أظنّ أنّ التشبيه بمن يطالبون بتحريم العلوم الاجتماعيّة «بوصفها رجساً علمانياً أو وحياً من شياطين الغرب الصليبيّ!» هو ممّا كان يُستحسن بكرم تفاديه، ولا يزال.
مع هذا فإنّ موقف أكثر من 90 بالمئة ليس مجرّد صدفة بريئة، إذ هؤلاء، أو بعضهم الكثير، جاؤوا من كتب قرأوها وأفكار فكّروها وتصوّرات أرادوا فرضها على الواقع تستقرّ كلّها في منظومة فكريّة يصعب على من هم أقلّ من 10 بالمئة أن ينتزعوا شرعيّتها منهم. وإلى ذلك، يبقى مُحيّراً ذاك الاهتمام الفائض لبعض الأوساط بالكتابات اليساريّة الغربيّة فيما تخلو المكتبة العربيّة من مراجع معتبرة عن قيام الجمهوريّات واشتغال الديموقراطيّات، كما عن تجارب بلدان تمتدّ من بلجيكا إلى كندا، ومن سويسرا إلى يوغوسلافيا السابقة، في تعايش الجماعات الدينيّة والإثنيّة أو تنابذها ممّا تضجّ بمثله منطقتنا وشعوبنا. فحين نكتب ونترجم في نقد الديموقراطيّة الليبراليّة أكثر ممّا في التعريف بها، بل من دون التعريف بها، تتّسع طريق الحيرة لتغدو جادة عريضة: فالجهد هنا يقع على لا شيء في واقعنا، أمّا إذا كان هدفه نظريّاً بحتاً فلا أظنّ أنّ في وسع منطقتنا، المعقّمة من التجارب الديموقراطيّة، أن تضيف ما يُعتدّ به على هذا الصعيد (آمل ألاّ يتّهمني كرم بالعنصريّة عملاً ببعض تعاليم يسار الكامبوس).
لكنّني أغامرُ بالقول إنّ ثمّة ما قد يساهم، حين نلقي نظرة ثانية أهدأ، في تبديد هذه الحيرة: فلئن كان شيوع «العلم السوفييتيّ» يفسّر بعض ذاك الاهتمام الفائض إبّان الحرب الباردة، فإنّ سوق الأفكار العالميّة، لا سيّما منها المسيطرة على بعض الجامعات الغربيّة، هي ما يخلق راهناً هذا الجاذب في بعض أوساطنا المهتمّة بتلك السوق. وهو ما نرى مثيلاً له في عالم الفنّ السائد اليوم، وفي تطلّبه لبعض ما لا يتّصل من قريب أو بعيد بأيّ سوق محلّيّة خارج الولايات المتّحدة وأوروبا الغربيّة.
وهذا، مرّةً أخرى، ليس دعوة لـ«الانغلاق» على قضايانا، وإن كان ينطوي على شيء من الاحتجاج على اختلال النسب في متابعاتنا. وما يمعن في تسييس احتجاج كهذا أنّ نظاماً كنظام الأسد، أو كنظام صدّام قبله، ساهم في نشر أو ترجمة أعمال لا تبقي ولا تذر في نقد الديمقراطيّة الليبراليّة ومساوئها، تماماً كما كانت تفعل تلك الأنظمة حين كانت تنشر بعض عيون الفكر اليساريّ في العالم، من دون أن تتهيّب استضافة ندوات للتفقّه في أمورٍ كتلك.
أمّا خاتمة مقالة كرم، حيث نسب إليّ اعتبار الموقف السياسيّ من الثورة السوريّة «المعيار الوحيد الصحيح لتموضع السوريّين من مؤيّدي الثورة سياسيّاً وفكريّاً وقيميّاً»، فهذا بالضبط ما ساجلت ضدّه غير مرّة، مباشرة أو مداورة، منتقداً النظر الحصريّ إلى العالم وما يشهده من موقع وطنيّ محدّد، أكان سوريّاً أم فلسطينيّاً أم لبنانيّاً أم غير ذلك. مع هذا أتمسّك باعتقادي أنّ في «الجمهوريّة» طاقات تملك قدرات تحويليّة في الواقع السوريّ (مع أنّ أصحابها لا يقيمون في بيروت!)، ينبغي ألاّ تضيع في دروبٍ التفافيّةٍ شديدة الطول والتعرّج، أشكُّ كثيراً في أن توصل إلى ما يُراد الوصول إليه. فإذا ما «استكثرَ» عليّ كرم هذا «التدخّل في الشأن السوريّ»، والله أعلم، كففتُ عن إبداء هذا الاعتقاد لكي أحتفظَ بصداقته، واحتفظتُ بقناعتي سرّاً لنفسي.
والحال أنّ همّي في تلك الرسالة لم يكن موضوعة اليمين واليسار، ولا الأثر الفكريّ للماركسيّة والتحليل الطبقيّ. وأزعمُ أنّني لا أغفل عن ذاك الأثر، كما لا أتنكّر لذاك التحليل، وإن كنت أدّعي ضرورة إرفاق الأخذ به بأبعاد أخرى ليست الماركسيّة دائماً مرجعها الأفضل، خصوصاً حين يتّصل الأمر ببلداننا حيث يتعايش حدّ أقصى من الواقع الطبقيّ وحدّ أدنى من الوعي الطبقيّ. وهنا أفتح هلالين لأقول إنّ برهنة كرم على أهميّة التحليل الطبقيّ باستخدام «بنى السيطرة التي تدفع بفقراء العلويين للموت من أجل الأسد» ليست أفضل الحجج على ما أراده، وقد يكون «الانهيار المديد لمجتمعاتنا» حجّةً أفضل.
ولعلم كرم، فأنا واحدٌ ممّن تؤرّقهم ثنائيّة الحرّيّة والمساواة، إلاّ أنّني موقن، ووراءنا من التجارب ما يقف في صفٍّ طويل، أنّ الافتتاح بالحرّيّة مرشّحٌ للإفضاء إلى المساواة أكثر كثيراً من قدرة المساواة، بوصفها المدخل، على الإفضاء إلى الحرّيّة.
وهنا ينطبق على المساواة ما ينطبق على المسائل الثقافيّة والمجتمعيّة، من تحرّر المرأة إلى الإصلاح الدينيّ. فهذه جميعاً لا تُخاض معركتها ويكون خوضها مجدياً إن لم يحصل ذلك في مناخ من حرّيّة المواطنين في سعيهم الحياتيّ، وإلاّ فما معنى النقد الذي يُوجّه لنزعة ثقافيّة (وقد يُوجّه لنزعة اقتصاديّة) تغضّ النظر عن ثنائيّ الاستبداد والحرّيّة؟ وهل هي صدفة أن تستطيع أنظمة كالنظام السوريّ الاستحواذ على شعارات تمتدّ من الاشتراكيّة إلى تحرير المرأة، ومن العلمنة إلى تحرير فلسطين، فيما هي تتبرّأ من قيمة الحرّيّة (التي ما إن قاربها الطيّب الذكر ميشيل عفلق وجعلها أقنوماً حتّى نبّهنا إلى أنّها «حرّيّة الأمّة» و«الشعب»، لكنّها حكماً ليست حرّيّة الأفراد).
ولا أخفيك، يا عزيزي كرم، شكّي العميق في الذهاب بعيداً مع أيٍّ من النزعتين الاقتصاديّة والثقافيّة – المجتمعيّة، من دون أن يكون ذلك شكّاً بفضائلهما المبدئيّة. لكنْ يتراءى لي، فيما شعوبنا غير متّفقة على الوطن هويّةً وحدوداً واسماً وعلاقةً بين الحاكم والمحكوم، أنّ الذهاب بعيداً مع أيّ من هاتين النزعتين هو كمثل ممارسة كرة القدم من دون رسم الملعب. وقد يجوز القول إنّ تاريخنا الحديث هو لعبٌ من دون ملعب، لعبٌ درجنا على تسميته سياسةً وفكراً سياسيّاً، فسهّل للبعض أن يصيروا طغاة ويتوارثوا الطغيان، وجعل بعضاً آخر، جيلاً بعد جيل، يمتهن فجيعة الخسارة المتواصلة وأعمال «النقد الذاتيّ بعد الهزيمة».
وأمّا «فكر جون ماكّين» فهذا ما أتركه لجلسة اسطنبوليّة، أو بيروتيّة، يتعتعنا فيها ما سبقَ أن تعتع الشعراء، نروح فيها نتحدّث عن الراحل غرامشي في الهند حتّى يطلع الفجر.
موقع الجمهورية