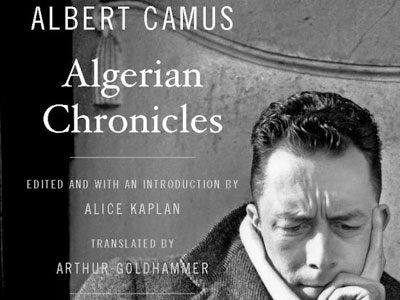سكان الـ”فايسبوك” وسحره النجومي
محمد أبي سمرا
“كتاب الوجوه” و”الصور” الافتراضية، الـ”فايسبوك”، صنع فضاءً جديداً للتعبير الفني والتواصل الشبكي في علانية عامة جديدة لا متناهية. كتب أحدهم على صفحته عبارة لافتة في دلالاتها: على الـ”فايسبوك” عليك أن تظهر وجهك لا عقلك. انطلاقاً من هذه العبارة وبناءً على مراقبة جزئية متقطعة لأشكال من التعبير الفني في هذا الفضاء، هنا بعض من ملامح جزئية للوجوه التي يصنعها لأنفسهم سكّانه المداومون.
لا شك في أن جهازي الكومبيوتر والهاتف المحمول، الفرديين والشخصيين، قد غيّرا حياة البشر اليومية، عاداتهم وعلاقاتهم وأشكال تواصلهم وثقافتهم، وبدّلا صلتهم بالعالم والوقت والمكان والمسافات واللغة والعمل، كما صلتهم بحياتهم العامة والخاصة وبذواتهم الفردية أو الشخصية. فالعمل اليومي غير اليدوي أو العضلي، أي الذهني، وكذلك التواصل والحصول على معلومات، لم تعد ممكنة من دون استعمال هذين الجهازين، إلا في دوائر محددة تضيق يوماً بعد يوم وتصير هامشية وشبه معزولة. حتى التسلية وأوقات الفراغ واللقاءات والحياة الخاصة، أمست مرتبطة بما يؤمّنه الكومبيوتر والهاتف الشخصي من خدمات في هذه المجالات. تزايدت الأوقات التي يمضيها الأفراد أمام شاسة “اللابتوب” في العمل والبيوت، فيما الهاتف المحمول في أيديهم، أو إلى جانبهم على طاولة المكتب وقرب أسرّتهم. صارت عادة إضاءة الشاشة الالكترونية وتصفّحها فور يقظتهم الصباحية، وبعد وصولهم إلى أماكن عملهم وعودتهم منها إلى البيوت، من طقوس دورة حياتهم اليومية.
صفحة الشاعرة المصرية
أمس، فيما كنت أقلّب صفحات الـ”فايسبوك”، استوقفتني صفحة الشاعرة المصرية المقيمة في المانيا، إيمان مرسال، فعلمتُ ان مجموعة شعرية جديدة لها تشاركت دار للنشر في القاهرة وبيروت على إصدارها، وقرأتُ على صفحة الشاعرة إحدى قصائد المجموعة. لشدة ما أعجبتني القصيدة أرسلتُها الكترونيا إلى عدد من الأصدقاء على الـ”فايسبوك”. قبل هذا، لم أكن قد قرأت شيئاً لمرسال التي كان صديق مصري قد حدّثني عنها في زيارته بيروت قبل ايام، فاتصلتُ به بواسطة “السكايب” وحدثته عن مفاجأتي بما قرأت. علمتُ منه أن نسخاً ورقية من المجموعة الشعرية غير متوافرة بعد في بيروت، فبادر فوراً إلى إرسال نسخة منها على بريدي الالكتروني. بعد قراءتي بعضاً من قصائد المجموعة، عدت إلى صفحة الشاعرة على الـ”فايسبوك، فقرأت لها هذه التدوينة: “إنه عيد الحب: انا في لوبيانا سلوفينيا. إنني مراد في برلين. مايكل حبيبي وابني يوسف في كندا. أخويا محمد في بيروت. بابا والأسرة في مصر. طبعاً أصحابي منثورين في الكرة الأرضية من اسبانيا الى سلطنة عمان، ومن المكسيك الى الهند… لو نزلت دلوقت (الآن) إلى الشارع ووقعت في غرام أي أحد ما شفتوش قبل كدة، يبقى مفهوم تماماً… صح؟”. 170 شخصاً قرأوا هذه العبارات، و33 آخرون علّقوا عليها: من أين، من أيّ بلادٍ، من أيّ مكان في هذا العالم؟
هل من صلة؟
إسمه “العالم الافتراضي”، كما شاعت عبارة “الحرب التلفزيونية” أو “الافتراضية” أيام الحروب الاميركية والدولية على أفغانستان والعراق. فوق أفغانستان واليمن لا تزال طائرات من دون طيارين تجوب السماء وتقصف الكترونياً أهدافاً “إرهابية”، وكثيراً ما تصيب مدنيين. وكان جندي أميركي في قاعدة عسكرية في شمال الولايات المتحدة، قد كتب أخيراً مذكراته أو يومياته عن تشغيله تلك الطائرات وتوجيهها إلكترونياً من القاعدة لقصف أهدافٍ في أفغانستان. منال نحاس في بيروت ترجمت اليوميات ملخصةً عن إحدى الصحف الاميركية، ونشرها ملحق “صحافة العالم” الأسبوعي في صحيفة “الحياة” اللندنية والبيروتية. مروع وأليم ما كتبه الجندي الأميركي: من على شاشته الإلكترونية في قاعدته العسكرية شمال أميركا، كان يبصبص على علاقات حميمة بين رجال ونساء ينامون على سطوح بيوتهم صيفاً في إحدى قرى أفغانستان. إنهم بشر أليفون، ويتحابّون، كتب في يومياته، ووصف بعضاً من مشاهد حياتهم اليومية المتقشفة. لكنه بضغطة واحدة على أحد أزرار جهازه الإلكتروني، أبصر على الشاشة أمامه أحشاء من وصفهم، مبقورة، وأعضاءهم ممزقة على درب في القرية الأفغانية. روّعه المشهد وآلمه، بعدما كان قبل هنيهات يحادث زميله في القاعدة بكلمات لئيمة باردة، قاسية وسافلة وعديمة المشاعر الانسانية، عن أولئك الأفغان الذين كان يشاهدهم في أوضاع حميمة على سطح بيتهم. دماؤهم وأحشاؤهم وأعضاؤهم على الطريق، أخرجت المشهد من برودته الافتراضية المحايدة على الشاشة الإلكترونية، فصُعِقَ الجندي وأُصيب بحالٍ من السويداء النفسية والأخلاقية، حملته على انهاء خدمته في القاعدة العسكرية، وعلى زيارات متكررة لعيادة طبيب نفسي.
هل من صلة ما بين ما كتبته إيمان مرسال على صفحتها في الـ”فايسبوك” وما كتبه الجندي الأميركي في يومياته ورسائله الى والدته؟
أخيراً تجرأتُ
كتبتُ جملتين أو ثلاثاً “شخصية”، “خاصة” و”حميمة”، على صفحتي في الـ”فايسبوك”: فجأةً، وسريعاً، قرأها عشرات، وبعضهم علّق عليها. وبرغم مضي حوالى أكثر من سنة على مبادرة إبنتي الى إنشاء صفحتي هذه وحضّي على استعمالها، ونشرها مقالاتي الصحافية عليها، وبرغم تكاثر أصدقائي الـ”الفايسبوكيين” الى ما يزيد على ألفين، وتصفحي صفحات بعضهم وكتاباتهم وتعليقاتهم في أوقات متباعدة، فاتني أن انتبه انتباهاً واضحاً الى أن لهذا الفضاء التواصلي والتفاعلي وجهاً جديداً مستقلاً وقائماً بذاته ومنقطعاً عن سائر دوائر التواصل والتعبير الأخرى. ما نبّهني الى هذا الوجه هو ذلك الاستقبال التفاعلي الكثيف والجديد عليَّ، الذي حظيت به الجمل أو الشذرات “الشخصية” و”الحميمة” التي كتبتُها على صفحتي. وإذ أطلعتُ إحدى الصديقات على مفاجأتي، قالت ما معناه إن مبادرتي الى كتابة تلك الجمل هي خطوة أولى لدخولي عالم الـ”فايسبوك” الفعلي الذي أقيم خارجه أو على ضفافه متصفحاً غائباً خلف نشري مقالاتي الصحافية على صفحتي فيه، فلا تحظى تلك المقالات بسوى قارئين أو ثلاثة، وأربعة على الأكثر.
في الوقت نفسه قرأتُ للصديق المؤرخ الاجتماعي أحمد بيضون تعليقاً على صفحته في الـ”فايسبوك” يدعو فيه الى التفكير في استعمالاته بناءً على تنبهه الى أن بيتاً من العتابا استغرقت كتابته على صفحته دقائق قليلة، حظي بـ28 “لايكاً”، بينما لم تحظَ مقالة فكرية صحافية عن كتاب قرأه، وصرف جهد يومين في كتابتها ونشرها على الصفحة نفسها، بأكثر من 7 “لايكات”. هذا ما حمله على الإقرار بغلبة “التسلية” وريادتها على سواها من وجوه استعمال الـ”فايسبوك”. تعقيباً على ملاحظة بيضون الاختبارية هذه، كتب أحمد سويسي عبارة شديدة الكثافة والدلالة في كشفها: في الـ”فايسبوك” عليك أن تظهر وجهك، لا عقلك. العبارة هذه ذكّرتني بأن أحمد بيضون نفسه كان قد كتب قبل أشهر على صفحته جملة – شذرة حظيت بعشراتٍ كثيرة من “اللايكات”: “لن أشفى من دمار حلب”.
هذه الملاحظات وسواها من مثيلاتها تقود الى التأمل في عالم الـ”فايسبوك” وفي أشكال التعبير والتواصل والتفاعل التي تنعقد فيه وتحظى بالمتابعة والاستجابة وتستدعي القراءة والتعليق أكثر من غيرها من الأنواع التعبيرية الأخرى في دوائر العلانية العامة، الإعلامية المرئية والمسموعة والكتابية. فعالم الـ”فايسبوك” الفعلي يستدعي اشتقاق حقل ونوع جديدين من التعبير والتخاطب والتفاعل، ركيزتُها وقِوامُها شخصنة القول، ذاتيته وحميميته وآنيته، في الكشف السريع، الكثيف أو الخاطف، عن أحوال النفس والوجود والعالم والحوادث والتجارب. كأن تكتب، مثلاً – على غرار عبارة أحمد بيضون عن مرضه بدمار حلب – عبارة من نوع: “لم أعد أقوى على العيش وحيداً، لم أعد قادراً على العيش مع أحد”. أو: “سيان عندي إذا كان الله أو الشيطان أو أنا أو القدر قد فعل ما فعل”. أو: “من لا تقوى على أن تملك من الدنيا حتى ثيابها”. مثل هذه العبارات – الشذرات، أو الخواطر التي تقترب من الفن الشعري الآني، وسواها من أشكال التعبير الفني البصري التشكيلي، كالتجهيز والفوتوشوب، ومن الحملات الدعوية الاحتجاجية، السياسية والاجتماعية وما يتعلق منها بقضايا المجتمع المدني، هي على الأرجح ركن عالم الـ”فايسبوك” الفعلي الأوسع استجابة وتفاعلاً في الوقت الراهن.
سكّان الـ”فايسبوك”
الحق أن تصفحي الأولي مجموعة ايمان مرسال الشعرية الأخيرة، أوحى إليَّ بأن عالم الـ”فايسبوك” حاضر في فضائها، بل في عنوانها: “حتى أتخلى عن فكرة البيوت”. فما يكمن في جذر هذه الفكرة، بل ما تفصح عنه وتدعو اليه وترغبه، لم يكن وارداً ظهوره وقوله على هذا النحو، قبل انبثاق عالم أو فضاء الـ”فايسبوك” التواصلي الافتراضي المشرّع على الغارب من دون حدود، والمتحرر من حدَّي الزمان والمكان، والباعث على انسياب الشخص الفرد، المعلوم والمجهول في وقت واحد، انسياباً أو إنخلاعاً وجودياً حراً لا يقيده بيت وزمان ومكان. قد تكون العبارة الأفصح في الدلالة على هذه الحال وتكثيفها، هي عبارة “سكّان الـ”فايسبوك”. هؤلاء السكّان لم يكن متوافراً لهم أن يُفصحوا عن أحوالهم ومشاعرهم على النحو الذي أفصحت عنه مرسال على صفحتها في عيد الحب، لولا سكنهم في ذلك العالم الإفتراضي السيّال المترامي الأرجاء، الذي يضع الشخص الفرد – في كل مكان وزمان، في البيوت والمطارات والسيارات ومكاتب العمل والمقاهي، وفي كل وقت من النهار والليل – في مواجهة ذاته والتأمل في احوالها وعلاقاتها وتجاربها، وفي انسيابها اللامتناهي في العالم وتحت أنظار آخرين كثيرين، معلومين ومجهولين في وقت واحد.
لكن، اذا كانت كتابة شذرات سريعة وآنية على صفحة الصداقة الافتراضية الالكترونية، تختلف جذرياً في طقوسها وفي ما تستدعيه، عما تستدعيه الكتابة بالقلم على الورقة وطقوسها، فإن تلك الصفحة تستدعي، ربما، نوعاً، بل انواعاً من التعبير يشبه سحرها، في وجه من الوجوه، ذلك السحر التعبيري الذي كان يبعثه في النفس التراسل الوجداني، العاطفي والغرامي، في بدايات اكتشاف البريد وتشغيله عبر العالم. هل نتذكر في هذا السياق، التراسل الغرامي ما بين مي زيادة وجبران خليل جبران، من دون ان يلتقيا؟ وكانت افلام سينمائية كثيرة قد صوّرت ذلك السحر الذي يبعثه التراسل وانتظار ساعي البريد، قبل اكتشاف الكهرباء، وشيوع استعمالها، حينما كان كتّاب الرسائل ينزوون منفردين في غرف شحيحة الاضاءة وسط اشباح من الظلال، حيث تفيض نفوسهم بمكنوناتها، فيما هم يستحضرون اطياف مَن يدبجون اليهم رسائلهم في تلك العزلة المنقطعة عن العالم والمتصلة طيفياً بالغائب الفرد المحدد او المعلوم، لكن البعيد مسافات يكتنفها الغموض والمجهول.
فنّانون ونجوم
هذه الكتابة التجريبية عن سكّان الـ”فايسبوك” وسحره واشكال التعبير التي يستدعيها، لا تنتمي الى عالمه، بل هي صنيعة كتابة سابقة عليه في استغراقها البطيء في مقاربة ما يكتبه سكّانه وينشئونه من اشكال تعبير بصري تشكيلي على صفحاتهم فيه. وقد يكون جائزاً تسمية هؤلاء السكان المدمنين بأنهم فنانو الـ”فايسبوك” ونجومه. الفن الذي يبتكره هؤلاء ويختبرونه، هو فن جديد في القول والتعبير والتواصل، ووليد دائرة جديدة للعلانية العامة، لم تكن متوافرة قبل ابتكار برنامج الكتروني للتواصل الاجتماعي الشبكي عبر الانترنت سمّاه مبتكره الاميركي الشاب “فايسبوك”، اي ما يمكن ترجمته الى العربية بـ”كتاب الوجوه” او “كتاب الصور”. وقد سبق هذا الابتكار وضع عالم الاجتماع الاميركي الفرنسي الاصل مانويل كاستل نظريته عن “المجتمع الشبكي” الجديد الناشئ عن ثورة الاتصالات الحديثة التي بدأت تغير الاطر الزمانية والمكانية للعلاقات الاجتماعية، وتنشئ ما يسمّيه هذا العالم “الفضاء اللازمني واللامكاني” لتلك العلاقات. “كتاب الوجوه” أو “كتاب الصور”، جاء تطبيقاً عملياً او حسياً لتلك العلاقات الشبكية المتفلتة من اطر الزمان والمكان في مجال التعبير والتواصل الفرديين والشخصيين. مثل كل اكتشاف جديد يوضع في التداول العام، بدأ الـ”فايسبوك” يشق طريقه الى جمهور مستعمليه، بوصفه فضاء جديداً لبث… ماذا؟
في اوروبا بدأت تظهر دراسات وابحاث ميكروسوسيولوجية وثقافية عن عالم الـ”فايسبوك”. هنا، في مجتمعاتنا العربية، لم يجر الانتباه الفعلي والعملي لهذا الفضاء التواصلي، الا في اثناء الثورات العربية في نهاية العام 2010، فانجذبت اليه فئات واسعة من الطبقات الاجتماعية كافة، وخصوصا الفئات الشابة وسواها من الكتّاب والمثقفين الذين فاجأتهم الثورات وحملتهم على دخول ذلك الفضاء لأسباب شتى، منها الرغبة في اكتشافه والتعرف إلى ما يدور على صفحاته للاطلاع على دوره وفاعليته في الحدث التاريخي الكبير. لكن كعادتنا مع الظواهر الجديدة التي نستقبلها ونشرع في الانخراط فيها و”توطينها” على مثال استقبالنا ما سبق من مظاهر الحداثة وسلعها وقيمها، لا يبدو ان استعمال الـ”فايسبوك” حظي باستطلاعات ودراسات وابحاث تبيّن وجوه استعماله ودوره واساليب التعبير الجديدة الناشئة في فضائه، وصولا الى رصد التحولات والتغيرات التي أحدثها في العلاقات الاجتماعية وفي علاقات الافراد في ما بينهم وبالفضاء الاجتماعي العام. وقد يكون الأهم والأكثر صعوبة ربما، هو التعرف الى ما أدخله هذا الفضاء التواصلي من تغيرات في شخصيات الافراد ورغباتهم واهوائهم وامكاناتهم التعبيرية، وفي صورتهم عن انفسهم وعن الآخرين الاقربين والأبعدين.
قد تأكل الوجوه – الأقنعة أصحابها!
من تتبع سريع، متقطع وجزئي، يبدو ان هنالك فئة من “الفسابكة” (وفق اشتقاق احمد بيضون) وجدت في الفضاء الجديد ملاذاً ومسكناً ومتنفساً فردياً رحباً وحراً لرغبات وأهواء وعلاقات واشكال تعبير وتواصل في علانية عامة شبكية جديدة، لم تكن الأطر والمؤسسات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاعلامية وعلاقاتها القائمة، تتيح لها الظهور، بل كانت تستبعدها وتخنقها. ذلك ان تلك الاطر والمؤسسات الغارقة اصلاً في خواء واستنقاع مديدين، شأن حال مجتمعاتنا وثقافتها وقيمها وجماعاتها وسلطاتها، جعلت الاستبعاد والخنق والعصبويات المغلقة، والمراءاة والمراتب والهويات العضوية الثابتة والمتكلسة، والعداء للجديد… في مثابة دين اجتماعي وثقافي وسياسي وأمني قاهر وساحق. هذا كله ما قامت الثورات الراهنة ضده لتقويضه والخروج عليه خروجاً شبكياً مفاجئاً تصدرته الفئات الشابة، من دون تنظيم ولا قيادة، الا ذلك التنظيم الشبكي الافتراضي الذي اتاحته الشبكة الالكترونية العنكبوتية، وخصوصاً في تونس ومصر.
لكن الثورات هذه ليست عصا موسى السحرية، بل هي مخاض متواصل، على ما هي الحال في تونس ومصر وسوريا واليمن، على الاقل. وسط هذا المخاض لا يزال الـ”فايسبوك” حاضراً وفاعلاً، لكن حضوره وفاعليته يتشظيان ويتناسلان في اتجاهات لا تحصى. من هذه الاتجاهات استعماله فضاء ذاتيا وشخصياً للتعبير الفني الحر عن احوال النفس والتجارب، في علانية عامة مستقلة وقائمة بذاتها، ومنفصلة عن الأطر والمؤسسات الثقافية والفنية والإعلامية التقليدية، بفضاءاتها ومراتبها ومعاييرها السائدة في المنتديات والصحافة والتلفزيون. الفن الـ”فايسبوكي” الناشئ هذا، يخلط، بل يهجّن اشكال التعبير المختلفة، من شعر ونثر وتصوير وتجهيز وتأمل فلسفي وفكري في الوجود والعالم والذات والآخر والعلاقات، على نحو جديد ينبتُّ شذرات آنية سريعة، متقطعة ومتقلِّبة وقلقة وعلى غير هدى ومثال سابق، بل يكاد يقترب من الفوضى والهذيان على المعنى الفني، وليس العيادي النفسي. كأن سكّان “كتاب الوجوه” او “الصور” هذا، فنانيه ونجومه المداومين، ابتكروا حرية جديدة، لا حسيب ولا رقيب عليها الا من انفسهم واهوائهم ورغباتهم الشخصية المركّبة التي تولد على الشاشة راعفةً طازجة. بل هي حرية فنية وتعبيرية شبه غريزية وحدسية وتجريبية، قدر ما تصنع لأصحابها وجوهاً جديدة، تصنع لهم ايضاً اقنعة في ذلك الفضاء الشبكي المترامي الارجاء. فصناعة الوجوه والصور عن الذات، ليست شيئاً آخر غير صناعة الاقنعة، لكن على المعنى الفني، وليس للاختباء خلفها والتزين بها واستعراضها على طريقة الاستعراض المشهدي والدعائي للأزياء والسلع، والدعوي للجماعات والهويات، بل للذهاب بعيداً وعميقاً في تجربة شِقاق النفس وقلقها واضطرابها، ولاشتقاق اساليب جديدة في التعبير والتواصل. لكن هذا كله، مثل كل اختبار وتجربة جديدين، لا يخلو من المجازفات ومسراتها وآلامها.
فقد تأكل الوجوه – الاقنعة الجديدة وكثرتها، صاحبها، وتفصله عن الواقع وحس الواقع، ثم تدخله في تيه وضياع صوفيين ومنتشيين وآسرين قد يؤديان الى عدم القدرة على امتلاك النفس، والى التدمير الذاتي. ومتى كان طلب الحرية والسير في ركابها وصناعتها في كل لحظة ومن دون حدود، خلواً من الخوض في سحر العتمة والمجهول بلا دليل؟!
النهار