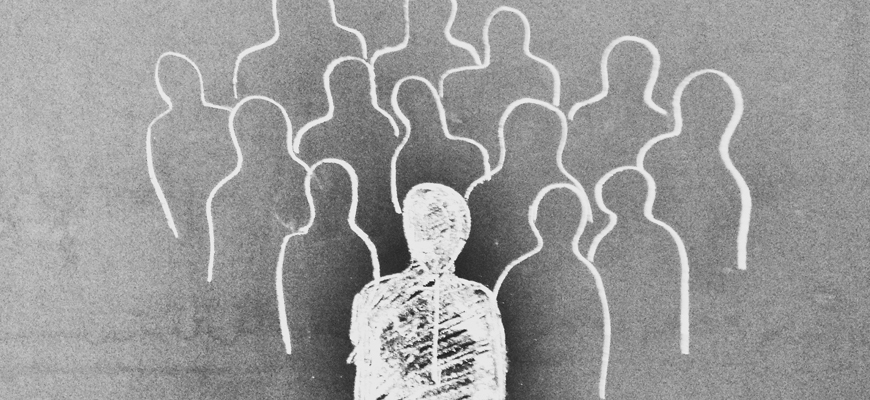قضية الردة في الفكر الاسلامي الحديث/ آمال القرامي

لقد خرجت المجتمعات الإسلامية من قرون الانحطاط واهنة الفكر فقيرة الوجدان، مسلوبة الإرادة، فاقدة لمعنى الحرية والكرامة، خالية من أي نظام تربوي متماسك قادر على بناء الإنسان والسمو به بصفته حجر الزاوية في تشكيل المجتمع.
ومن البيّن أن الإنسان الذي بشّر القرآن بميلاده إنسان متفوّق بحقوقه على الإنسان السابق. إذ ثمة ترقية حقيقية للشخص البشري بالقياس إلى وضعه في الجزيرة العربية قبل الإسلام. ولكن الممارسة التاريخية أثبتت عكس ذلك، إذ سرعان ما تحالف الساسة مع “العلماء” ليجمدوا مفهوم الإنسان. فأصبح الإنسان “الشرعي”، أو “الكامل” هو ذاك الذي يمتثل لمقولاتهم وأصبح هناك إنسانٌ ونصفُ إنسان. وشيئًا فشيئًا تم التنازل عن مبدأ المسؤولية الفردية لفائدة المجامع الفقهية، وخنقت مبادرات الفعل وتم الحجر على حرية التعبير والتعددية الإيديولوجية.
وهكذا توصل المجتمع إلى صهر الفرد في بوتقته مستعملًا في ذلك آليات الضغط مثل الإكراه والإقصاء. وأضحى من حق الفئة “المهتدية” أن تمارس الوصاية على الآخرين، وبالخصوص على الفئة “الضالة” بدعوى الحرص على إعادتها إلى الصواب.
إن المجتمع الذي يوفر للفرد منظومة يقينية سكونية لا يتصور إمكانية انفصاله عنها ويعسر عليه أن يدمج من لا يحمل مميزات الجماعة في المجموعة. ويشق عليه أيضًا أن يعترف بالفرد الحرّ المريد، لأنه في نظره عنصر مزعج غير منسجم مع النسق. وإذا ما بالغ هذا الفرد في ممارسة حريته بدحض المصادرات، وتقويض الأنماط التقليدية للمعرفة، فإن المجموعة تتكفّل بسحقه، لأنه في نظرها خائن لا عهد له ولا ميثاق، كافر، زنديق مرتدّ، ملحد. وبالطبع خضع لنظامها وآمن بمسلماتها.
ولا يخفى أن انعدام التوازن في منظومات القيم التي تحرك المجتمعات الإسلامية علاقة وطيدة بجدلية السياسي والديني. فليست الدولة الحديثة مقرًا للحريات الفردية والجماعية، لأنها عجزت عن تحقيق القيم التي أصبحت جزءًا من تراث الإنسانية أي حقوق الإنسان. كما أن الدولة الحديثة ليست ساحة حيادية من الناحية الفكرية والعقائدية. إذ سعت مثل غيرها من الأطراف إلى احتكار الدين واعتباره جزءًا أساسيًا من شرعيتها. وليست هذه كل العوامل المؤدية إلى إجهاض محاولات الملاءمة بين القيم الدينية الأساسية ومتطلبات الواقع، إذ نجد عاملًا آخر يتمثّل في عسر تقبّل المجتمعات الإسلامية لهذا الخطاب الجديد، وذلك للاختلاف القائم بينها، وهو اختلاف راجع إلى تفاوت مستوى الوعي، ودرجات التطور الحاصلة على مختلف المستويات.
” إن التحديات المفروضة على العالم الإسلامي اليوم، تفرض عليه إعادة تأسيس نظرته إلى الكون، وإلى الإنسان. فلقد أثبتت العلوم الحديثة أن النفس ليست روحًا مقدسة، ولا هي غريزة مدنسة، بل هي مجموعة من العلاقات المعقدة والتوازنات التي يمكن أن تنهار، وان يعاد إصلاحها. ومن ثمة ينبغي تفهّم تقلبها في الوعي والشعور، واللاشعور، والسلوك، والذهن والعصاب، وغيرها من العوامل.
وبيّن علم النفس أن الإيمان يتطابق مع دوافع الرغبة الأكثر استعصاءً على الكبح، ومع مضامين الذاكرة الأكثر تعقيدًا، ومع تصورات المخيال، ومع إلحاحات العقل الأكثر صرامة. وهذا بدوره يدفع الإنسان المعاصر إلى الإقرار بأن عملية اعتناق دين ما، ليست كحجر المنجنيق يذهب أمامه ولا يرجع وراءه، إنما الإيمان حصيلة تجربة مكابدة ومعاناة. وهو ينوس بين السكون والاضطراب، الزيادة والنقصان.
أما علم الاجتماع فقد أثبت أن “المرتد” هو ذاك الذي يعتبره الناس “لقيطًا”، غير أنه لا يختلف في بنيته وحقيقته عن أي طفل شرعي آخر، ولكن ما يجعله غير شرعي هو الاختيار الذي تبناه. وهو اختيار غير مقبول حسب الذهن الإقصائي الوثوقي الذي ينبذ النسبية ولا يقبل حوارًا، ولا قولًا، ولا انتكاسًا عنه، ولا ارتباكًا حول حجره الصلب.
العربي الجديد