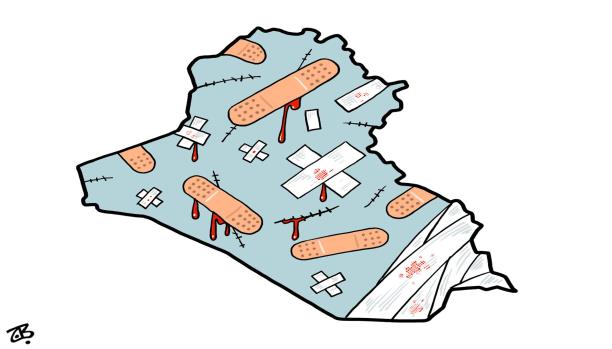شاهد عصر، والعصر ليس الآن
حسين سليمان
في عام 1982 طُوقت مدن كثيرة في سورية، منها بلدة الميادين التي تبعد نصف ساعة عن دير الزور المحافظة، هذه البلدة المعزولة آنذاك قبل اكتشاف النفط وقبل نموها وازدهارها العشوائي كانت كأنها عجوز تحوك ملابسها بحزن على شاطئ الفرات.
وحيدة تتحامل على القهر والإهمال بنبل كبير يستمد قوته من التاريخ الذي تختزنه وأمثالها من المدن القديمة والتي كانت بالأصل مهد حضارات شامخة ومنبت أوائل الجماعات البشرية المتحضرة. هذه البلدة لم تدرك معنى الجيوش والأمن، كما أدركته المدن الكبيرة، ولم تدخل في معمعمة الاحزاب والسياسات الرجراجة السرابية بل كانت صريحة مباشرة في أفعالها وأقوالها. وهي طبيعة البعد والعيش بين أحضان البراري يدفعها نحو ذلك وعي البداهة الأولى. وهو ما كنت ألمسه كل مرة أمر بها أو أزورها لا تشبه إلا الخرافة والسحر الموغل في القدم يخلقهما الخيال البدئي. لم أكن أتصور أن مثل هذه البلدة سوف يطوقها الجيش السوري والقوات الخاصة التي كانت تحرق الأخضر والأشجار والنساء والبلاد التي لا تنفذ تعاليم الرضوخ للنظام وتحولها كلها إلى يباس ورماد للاعتبار أنه: إلى الأبـد يا سكان سورية فاحذروا.
في تلك الأثناء أحسست بفظاعة الطغيان الذي حل بالبلاد، ومرت به على سبيل المثال مدينة حماة الخالدة. كانت هذه المدينة التي تتوسط طريق المسافرين من حلب الى دمشق وتمر بها باصات النقل مسرعة ـ في ذلك الوقت، تتمهل سيارات النقل وهي تمر منها لأنها تمر من بين الأشلاء والدماء والتهدمات التي لم يفعلها سونامي اليابان او الفليبين بل فعلتها يد الانسان الجشع المتسلط جاحد الخلق وناكر ديمومة الحياة. ولقد كانت هناك تحولات عواطف قد ولدت نتيجة ما حدث ونمت بصمت داخل الإنسان السوري، في تلك المرحلة الأبدية للحكم، وبدت تلك التحولات نائمة لا تعرف طريقها إلى الخروج والإفصاح، خرساء صماء، لكن قولها الكامن قال الكثير من خلال تلاقي العيون واستجابات اللغة الخفية. وكنت ألمس ثورة الغضب لدى أهل حماة وحلب وإدلب وجسر الشغور والمحافظات الشرقية والجزيرة السورية إلا أن هذا الغضب لم يكن ليصل إلى الميادين التي كانت، بلغتي وترجمتي لها، بلدة رمادية قد حرقها الزمن منذ أمد، وانتهى أهلها من ثورات الغضب تلك، وراح ينعم بالحكمة والفنون النفسية التي تريح الإنسان الذي فقد كل متع الحياة. في تلك الأثناء كانت الحياة النفسية في بلدة الميادين لا تمت الى القرن العشرين بصلة بل تعود إلى قرنين على الأقل، وهذا لا يعني أنها كانت متخلفة عقليا فهي المدينة التي أنجبت العلامة محمود المشوح والذي لم يتسن لي طيلة حياتي الثقافية مقابلة ما يشبهه.
لم يصل الغضب إلى بلدة الميادين كما وصل إلى بقية المدن السورية، لكن ما حدث في البلدان السورية مر بها، وكانت كما الجسر الذي يعبر الهاربون منه إلى العراق. ولهذا السبب تحركت مشاة وقوافل جنود كان الاجدى بها البقاء على الجبهة كي توقف على الأقل إسرائيل عند حدودها فلا تتمادى في إذلال سورية من خرق أجوائها ولا إنزال طائرات مسؤوليها في تل أبيب دون أن ينبس النظام السوري ببنت شفة. وطوقت هذه البلدة بمدرعات وأسلحة وعناصر وثقل كبير كما الكوابيس لم أدرك تماما ماذا يعني حين طوقوا هذه البلدة. بالنسبة لي كان هناك انتهاك للخيال واغتصاب جبري للذي بنته هذه البلدة في أعماقي ورحت تقريبا أفطن إلى أن التطويق لم يكن لها بل للتاريخ الذي تعلمته برمته، وهنا لا أسوغ بطرائق ما، لتقبل جهلي بحركة الحياة وصيرورة الحكم المتسلط الجبار لكن كي أشير إلى أن المعنى الذي تخلفه الجيوش حين تدخل مدنها شبيه بالمعنى الذي يخلفه مغتصب نساء البيت حين يداهم الأسرة وضح النهار وليس هناك قوة لرده إلا الموت، حتى الموت لا يبعد ذلك المغتصب المدجج بالسلاح فهو هولاكو معاصر آخر.
إن قتل آلاف مؤلفة أو قتل آحاد هو القتل الذي ينفي الحياة ويفتح الأذرع للموت ويدفع للتلاقي مع الجبروت كي تعود عجلة الحياة تقف وإلى الخلف تتهشم المعاني التي جاهدت الإنسانية والأديان من أجلها طيلة الأزمنة الماضية. كان من بين الضحايا أحد الأصدقاء، وهم كثر، وما زالت صورته أمامي كيف يمشي في الطريق ويتقدم نحوهم، شبه صوفي، ليس من سكان هذا العالم، قد خلق عالمه الرحب الداخلي، مليء بالحب – وهنا قول للذين يجهلون مدى ضراوة هذه التحولات (الاضطرابات) الكبرى، احذروا يا من تملكون قلوبا كبيرة. تظنون أن الذي يجابهكم ويحمل السلاح ضدكم سيدرك كيف تنبض قلوبكم بالمحبة… فهو لا يعرف سوى القتل حتى لو ناديتم: سلمية سلمية!
لم يكن آنذاك تصوير ولا صور ولا فيس بوك، كان كل شيء يدفن مع الأعضاء البشرية في مدافن بعيدة، في براري لا تزورها الرياح ومجهولة الموقع. ويخلف الدفن المجهول والغياب الدائم حالا ً لا يمكن استيعابه، فما زالت أم الصديق تنفي موته بعد مرور عشرين عاما حتى وفاتها تقول: سيعود ورأيته في المنام يعود ويطرق بابي – حال الأم التي فقدت ما خلقت من أجله.
لقد أنهكت الشعوب العربية وتحملت ما لم تحمله الجبال وكانت برأيي الثورة القاصمة الكبرى هي ثورة ميدان التحرير، ولن أقول الثورة المصرية بل ميدان كل العرب (التحرير) لأن ما جرى لم يكن في مصر أو تونس بل كان في عقل كل عربي وفي قلب كل عربي، في كل بيت. وهنا بعد انتصار شباب ميدان التحرير انقلبت الموازين التي جرى العالم العربي لأمد عليها وما سيحصل اليوم والغد هو الامتداد وفتح الجسور للقاء مرة أخرى مع الأمل الذي كاد أن يغيب وكما نرى فإنه ـ كما يقال – وصلنا إلى القاع ولن يكون هناك انحدار أعمق، وسوف يكون طريق في اتجاه آخر نحو الأعلى والضياء لمن لا تراه العيون يفتح الشقوق والنوافذ آن لها أن تتفجر بقوة النفوس الثائرة التي تقول للمتسلطين: هكذا أيها المتسلطون جاء الزمن، وجاءت الهداية.
القدس العربي