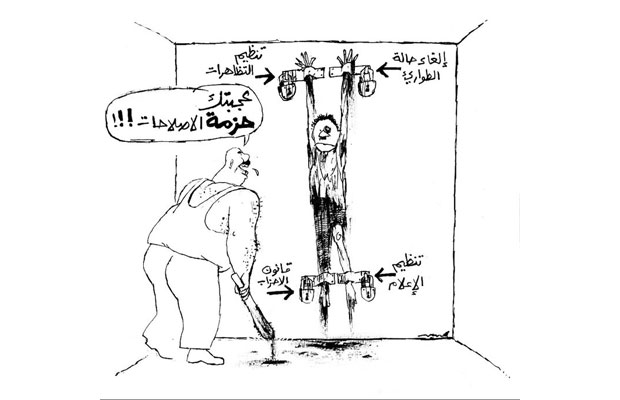عن أزمة القدس –مقالات مختارة-

ما الحدث اليوم بشأن القدس؟
ليس الحدث اعتراف الرئيس الأميركي وإدارته بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وما ينطوي عليه ذلك من استهتار بالشعب الفلسطيني، وارتباطه بالمدينة التي تشغل مكانة مركزية في الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وفي الوجدان الإسلامي والمسيحي. ليس هذا هو الحدث، فقد كان هذا مضمراً في انحيازٍ بنيويٍ مديدٍ للإدارات الأميركية والنظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية إلى دولة قامت جوهرياً على التطهير العرقي، وتقوم اليوم على التمييز العنصري. الحدثُ بالأحرى هو تجرّدُ القوى القائدة في النظام الدولي من أي ادعاءات عداليّة أو سلاميّة، ولو كانت شكلية، على نحو يطوي عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية البائسة، ويجعل من تناثر الفلسطينيين الحالي في معازل مقطعة الأوصال نهاية كفاحهم.
في سورية المجاورة حيث حضور النظام الدولي مباشرٌ أكثر اليوم، يظهر المصير الفلسطيني على حقيقته. يظهر في صورة حماية دولية للحكم الأسدي في مجلس الأمن على نحو يذكر بحماية إسرائيل، في صورة إبادة فيزيائية للثائرين السوريين تستأنف الإبادة السياسية لعموم السكان على نحو يذكر بالإبادة السياسية للفسطيينيين في أرضهم، في صورة احتكار أسدي إسرائيلي لأسلحة الدمار الشامل وسلاح الطيران، في صورة ترتيب للبشر في مراتب تستحق بعضها السيادة والاعتماد من النظام الدولي، وتحوز القدرة المستمرة على القتل وتُعفَى من أي قانون، ثم جماعات بشرية هائمة على وجهها، لا يُعتَرَفُ لمعاناتها بأي معنى، وتُجَرَّدُ من أي حقوق وتُتهم في إنسانيتها ذاتها وفي حقها في الحياة.
لقد جَرَت فلسطنة السوريين على هذا النحو طوال سنوات ما بعد الثورة مع تمتع الإسرائيلي المحلي، دولة الأسديين، بحصانة تامة وإفلات مكفول دولياً من العقاب، على الأقل منذ الصفقة الكيماوية في أيلول 2013. ويبدو أن هذا النجاح الباهر يُغري اليوم بقطع الطريق في الاتجاه المعاكس، وتخصيص الفلسطينيين ذاتهم بمعاملة سورية، تنكر عليهم المعنى وليس الوطن وحده، على نحوٍ مُتَضَمّنٍ في قرار ترامب. ليس هذا القرار مسلكَ رئيسٍ طائش، على ما قد يفضّل البعض إقناع أنفسهم، وربما يأملون مجيء رئيس أميركي «عاقل» بعده، يراعي المظاهر أكثر من الملياردير الصفيق، بل هو مرتبط بتحولات بنيوية في النظام الدولي، تسير في اتجاه مضاد للديموقراطية في كل مكان، وتقلّ حساسيتها حيال العنصرية، حتى أن اليمين الأوروبي، بَشَّرَ في مظاهرة في بولونيا قبل أيام بهولوكوست جديد يستهدف المسلمين هذه المرة.
لقد كانت سورية طوال ما يقترب من 7 سنوات حقل تجارب لبعض هذا التحولات المضادة للثورة والديموقراطية. وخلال هذه السنوات الطوال صارت المذابح بما في ذلك بأسلحة الدمار الشامل سياسة دولية مقبولة، ومثلها صناعة تعذيبٍ وقتلٍ في السجون والمقار الأمنية. ومنذ الآن يوفر حقل التجارب السوري سوابق يمكن للقوى الدولية النافذة الاستناد إليها لقتل الفائضين من البشر وتجريب أسلحة جديدة، على ما تباهى مسؤولون روس بخصوص سورية. فإذا انتفض الفسطينيون اليوم كان محتملاً أكثر من أي وقت سبق أن ينالوا مصيراً سورياً، يستند إلى السابقة الأسدية وتحولات النظام الدولي الرجعية.
هذه التحولات البنيوية هي ما يستحق النظر إليه والتفكير فيه، والعمل على بناء سياسات تحررية في مواجهته، وليس خطابات الممانعة الكاذبة والمزايدة والمراوغة، التي تصدر تكوينياً عن اعتبار عموم السكان في بلداننا غافلين جهلة، يمكن الضحك عليهم بخطابات غوغائيين مثل حسن نصر الله، تقول لهم إن آلامهم وكرامتهم لا أهمية لها، وإن المهم هو ما يقرره متعصبون تابعون من أمثاله. وأسوأ الردّ على كذب الممانعة هو خطابُ الممانعة المعكوسة، الذي يردُّ على مزايدة الممانعة بمناقصةٍ مستمرة، تتشكك في جدوى أي كفاح ومعناه، ولا تكفّ عن لوم الضحايا على لاعقلانيتهم، بل قلّة عقلهم. هاتان مساحتان للتضليل حصراً. الحقيقة في مكان آخر: في وقائع الإبادة السياسة والفيزيائية الجارية في سورية، في تجريد الفلسطينيين من بعدٍ معنويٍ ورمزيٍ فائق الأهمية في وطنيتهم، بعد طرد أكثرهم من وطنهم والتمييز العنصري ضد الباقين، ثم في التواطؤ بين أطقم محلية من بلداننا مع احتلالات وقوى دولية تزداد عنصرية.
فإن كان من واقعة إضافية تدلّ على فلسطنة السوريين اليوم، فهي «عملية السلام» السورية التي تستنسخ سابقتها الفلسطينية التعيسة، وتتجاوزها إسفافاً وغطرسة وخداعاً. فلا يُعرَفُ إن كانت هذه العملية تجري في جنيف أم في أستانة أو في سوتشي، ويجري علانية تصنيع معارضين داجنين مُصمَّمين لعدم معارضة المحتلين والقاتل المحلي العامل في خدمتهم في شيء، ويُتهم بالتطرف من يدافعون عن قيم الثورة وصوتٍ للفقراء والمحرومين في مستقبل بلدهم. لا تَعِدُ هذه العملية عموم السوريين بغير مواطنة من الدرجة الثانية في بلدهم، وتؤسس في واقع الأمر لنظام إسرائيلي في البلد الواقع تحت احتلالات متعددة، وفي واجهتها حكم وراثي سلالي قام تاريخه على المجازر. ما بعد السلام السوري المزعوم هو نظام غيتوات وتمييز عنصري، وليس بحال سورية جديدة مستقرة، ولا حتى سورية القديمة الأسدية.
ما يمكن استخلاصه من وضع قضية فلسطين اليوم، ومصير الثورات العربية، هو الحاجة إلى جيل ثوري جديد وتفكير وممارسات تحررية جديدة، تطوي صفحة الممانعة والممانعة المعكوسة، وتؤسِّسُ السياسة على امتلاك عموم السكان لبلدانهم وتقرير مصيرهم. هذا ما يمكن أن يكون الحدث المضاد، التحرري.
موقع الجمهورية
في قضية القدس/ سلامة كيلة
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعترافه بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية، وقرَّر نقل السفارة الأميركية إليها. وكانت روسيا قد اعترفت بها عاصمة للدولة الصهيونية، على الرغم من أنها “عدَّلت” من موقفها بعد الاعتراف الأميركي بأن أكدت أن “القدس الغربية” هي عاصمة الدولة الصهيونية، والشرقية عاصمة “الدولة الفلسطينية”. وقد استثار الموقف الأميركي كثيرا من ردود الفعل، والحراك، والرفض. ليس من العرب، شعوبا فقط، بل كذلك من الدول الرأسمالية التي لمست خطر هذه الخطوة، وأيضاً من شعوب عديدة العالم، لكن ذلك كله لم يغيّر شيئاً مما حدث، حيث يبدو أن ترامب يريد فرض “الأمر الواقع”، لكي يكون كل حديث عن تفاوض و”سلام” متجاوزاً واقع أن القدس هي عاصمة الدولة الصهيونية.
بالطبع، لن يغيّر كل الحراك الذي حدث، على الرغم من أهميته، من واقع أن أميركا اعترفت بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية، وأنه لن يؤدي إلى تغيير جدّي (مع أهميته كما أشرت)، حيث إن الخطوة الأميركية مرتبطة بمنظور إلى وضع المنطقة يبدأ بفرض الوجود الفعلي للدولة الصهيونية، وبتفوّقها على مجمل المنطقة. ولا شك في أن المنظور الأميركي الذي يظهر مع مرحلة ترامب ينطلق من فرض الأمر الواقع، ومن أن الدولة الصهيونية مركزية في المنطقة، على الرغم من أن الاهتمام الأكبر بات لمنطقة جنوب شرق آسيا، وللخطر الصيني. لكن يبدو أن أميركا ترامب تريد أن تطمئن لوضع الدولة الصهيونية وهي تبتعد قليلاً، بحيث تصبح جزءاً “طبيعياً” من المنطقة، ويجري الاعتراف بها على هذا الأساس.
هنا لا يمكن فصل ما جرى بخصوص القدس عن “صفقة القرن” التي جرى ترويجها منذ مدة، والتي تعني إعادة ترتيب المنطقة بما يضمن بقاء الدولة الصهيونية، وبقاء قدرتها المتفوّقة، وضمان هيمنتها. وإذا كانت أميركا تفعل ذلك، فلا شك في أن روسيا ليست بعيدة عن ذلك، لهذا أقرَّت بأن القدس هي عاصمة الدولة الصهيونية، وإنْ كانت قد أردفت إلى تحديد أنها تقصد القدس الغربية. وبهذا، ما يبدو واضحاً هو الإقرار بأن القدس هي عاصمة الدولة الصهيونية، وهو الأمر الذي يعني الإقرار بالوجود الصهيوني ذاته.
وإذا كان قد ظهر أن العرب، في مختلف بلدانهم، يرفضون هذا الأمر، وأنه حتى الدول الإمبريالية لا توافق السياسة الأميركية في هذا الأمر، فإن المسألة لم تتعدّ الرفض والاحتجاج، والتذمر، ولم يكن رد فعل النظم العربية في مستوى ما جرى. على العكس، يبدو أن الأمر تعدّى ذلك للمشاركة في ترتيب مشترك مع الدولة الصهيونية.
ماذا يعني ذلك كله غير أن الوضع الفسطيني بات يحتاج معالجة مختلفة عما كان يحدث طوال عقود من ردود الفعل التي لم تثمر شيئاً غير إظهار “النيات الحسنة”، من الشعوب، والتغطية على الموقف الفعلي من النظم؟ هذا ما يحدث، حيث لم تعد “النيات الحسنة” تفيد، ولم تعد التغطية تنطلي على أحد، بعد أن باتت الأمور تسير نحو تحقيق ما باتت تسمى “صفقة القرن” التي هي في جوهرها مصالحة مع الدولة الصهيونية، وتحقيق لتحالف “إستراتيجي” بين النظم وهذه الدولة. بمعنى أن الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية هو مقدمة لصفقةٍ أوسع، تفرض هذه الدول مركز سيطرةٍ على المنطقة، والأمر هنا لا يتعلق بفرضٍ بالقوة، بل بقبولٍ بهذه السيطرة، وميل إلى تحقيق تحالف “تحت السيطرة”.
لا يغامر ترامب بلا حسابات، على الرغم من أن ما قام به هو مغامرة، فهو يعرف أن نظماً باتت مستعدة لـ “التحالف” مع الدولة الصهيونية، ولتقديم كل الخدمات التي تحتاجها، وهو ما سيظهر حين البدء بـ “إنجاز” صفقة القرن هذه التي تلفظ بها حكام عرب عديدون. والمرحلة المقبلة هي مرحلة قبول النظم العربية بالدولة الصهيونية حليفا، ولهذا لا بد من تطوير صراع الشعوب، أولاً ضد النظم ذاتها من المحيط إلى الخليج.
العربي الجديد
إلا الحرية/ علي العبدالله
على رغم الارتياح الذي أشاعه موقف الشعوب العربية والإسلامية الرافض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، والذي عكس استمرار التأييد الشعبي للحق الفلسطيني، فانه قد بعث في الوقت ذاته هواجس ومخاوف كبيرة من عودة هذه الشعوب إلى الوقوع في حبائل أنظمة القهر والاستبداد التي ستسعى، عبر عملية تلبيس وتدليس خبيثة والعزف على مكانة القدس وفلسطين، إلى إعادتها إلى حالة الخضوع والتماهي مع شعار «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة» السيئ الذكر من جديد، وإعادتها إلى مربع الذل والهوان، بعد أن شمت نسيم الحرية وذاقت طعم الكرامة بكسرها جدار الخوف ورفضها استمرار سياسة القهر والتسلط، بذريعة مواجهة الخطر الخارجي قبل التفرغ لمواجهة المشكلات الداخلية، التي لا تشكل أولوية مصيرية ووجودية كما هو حال الخطر الخارجي، من طريق القبول بسلطتها وأنظمتها.
لا شك في أن للقدس وفلسطين مكانة خاصــــة فـــــي وجدان هذه الشعوب، وقد سبــــق وعبّرت عن ذلك في مناسبات كثيرة خــلال مراحل الصراع مع المشروع الصهيوني وقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين حيث تدفق المتطوعون من معظــــم البلاد العربية والإسلامية للمشاركة في معركة الدفــاع عن الحق الفلسطيني وتحـــرير الأرض من المحتلين والمغتصبين، كثيرون منهم جاؤوا سيراً على الأقدام آلاف الكيلـومترات، وقد استمر هذا التأييد بأشكال عدة طوال عقود الصراع الماضية آخذاً صوراً كثيرة من التطوع في صفوف فصائل الثورة الفلسطينية إلى جمع التبرعات إلى التظاهر كلما حصل جديد في ملف القضية.
غيـــر أنه لا يمكـــــن أن يتسق تأييد الشعب الفلسطيني والتعاطف مع معاناته ودعمه في نضاله من أجل حقوقه، وهو نضال من أجل الحرية والكرامة بالأساس، مع هدر حرية وكرامة شعب عربي أو مسلم بإخضاعه لأنظمة القهر والاستبداد ومطالبته بغض الطرف عن تسلطها وهيمنتها ودوسها على حريات مواطنيها واستهتارها بكرامتهم وافتئاتها على حقوقهم بحجة تمكينها من مواجهة الخطر الخارجي، فالحرية قيمة مطلقة وكلية، قيمة لا تقبل القسمة أو الاستثناء أو الاستنساب. فالذي يطالب بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والكرامة يجب أن يكون حراً وكريماً في وطنه، وهذا يبدأ من التسليم بأنهما حق له هو بالضرورة وإلا فلا معنى لإيمانه بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والكرامة وتحركه للدفاع عن هذا الحق وهو يتخلى عن حقه فيهما ويهدره بتنازله عنهما ثمناً لتأييد الشعب الفلسطيني. ثم إن نصرة الشعب الفلسطيني لن تكون متاحة أو ممكنة ما لم يكن الساعي لها والقائم بها حراً بذاته، محفوظ الكرامة ومصون الحقوق في وطنه.
ذكرت كتب التاريخ السياسي واقعة سؤال إمبراطور ألمانيا لمستشاره هل يغزو فرنسا أم يغزو السلطنة العثمانية؟ فأجابه المستشار إجابة غدت درسا في علم السياسة، قال: إنك إن غزوت فرنسا فسوف تهزمها بسهولة لان جيشها ضعيف، لكنك لن تستطيع الاستقرار فيها طويلاً لأن شعبها الذي خبر طعم الحرية لن يرضى باحتلالك بلده، وانك إن غزوت السلطنة العثمانية فإنك ستواجه جيشاً قوياً ستحتاج إلى الكثير حتى تهزمه، لكنك إن هزمته فانك ستنعم بسيطرة هادئة ومريحة لأن الشعب فيها استمرأ القهر والتسلط لذا لن يشعر بالفرق بين تسلطين ولن يعبأ بمن تسلط عليه. الإجابة ذاتها قالها الإمام محمد عبده عندما سئل عن سر هزيمة جيش عرابي المخزية أمام الجيش الإنكليزي في معركة التل الكبير على رغم أنه لم يكن قليل العدد أو العدة، حيث قال: «لقد عاش المصريون تحت نير القهر والاستبداد خمساً وسبعين سنة استمرأوا فيها الذل والمهانة ففقدوا الإحساس بعزة النفس والكبرياء الوطني فهانت عليهم أنفسهم وبلادهم لذا لم يجدوا في الهزيمة مضاضة».
لا ريب في أن لفلسطين، كل فلسطين، أهمية عربية وإسلامية، لاعتبارات دينية وتاريخية، ناهيك عن اعتبارات وطنية وقومية في ضوء طبيعة المشروع الصهيوني وأهدافه الاستعمارية وخططه العدوانية، لذا يمكن أن يكون للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته ثمن باهظ تقبل الشعوب العربية والإسلامية دفعه برضا، إلا الحرية.
* كاتب سوري
الحياة
بوتين وإيران يجنيان ثمار قرار ترامب بشأن القدس/ بكر صدقي
لم يكن قرار ترامب بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، قراراً ارتجالياً للرئيس الأمريكي المشكوك بصلاحيته لمنصبه. فقبل كل شيء هناك قانون أصدره الكونغرس، منذ نحو عقدين من السنوات، لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، تم تجميده على مدى ولايات الرؤساء السابقين، من أجل عدم خسارة الحلفاء العرب للولايات المتحدة. كان تحويل هذا القانون إلى واقع مطبق يتطلب حصول تقدم في عملية التسوية الإسرائيلية ـ الفلسطينية، بما يتيح للولايات المتحدة نقل السفارة في شروط ملائمة.
لم تتحقق هذه الشروط الملائمة، ولا يبدو أنها في سبيلها إلى التحقق، في إطار التسوية المذكورة، لكنها تحققت في إطار آخر لم يكن يخطر على بال أحد إلى ما قبل سنوات قليلة. ويمكن تلخيصه في النتائج الكارثية التي انتهت إليها ثورات الربيع العربي بسبب التدخل الإيراني الفظ من جهة، وصعود السلفية الجهادية في بيئة الخراب الذي حققته أنظمة دموية تمسكت بالحكم رغم أنف شعوبها، ومثالها الأبرز نظام بشار الكيماوي في دمشق، من جهة أخرى. وساهم ما يسمى بالمجتمع الدولي بقسط كبير في تحقق هذا الخراب، بقبوله الضمني أو المعلن بالحروب التي أطلقتها تلك الأنظمة ضد شعوبها، كما بالتدخلات الإيرانية في جوارها الإقليمي.
وقد أدت مجموع الديناميات المذكورة إلى بروز صراع إقليمي ذي مظهر مذهبي سني ـ شيعي، على حساب الصراع الافتراضي العربي ـ الإسرائيلي. وأدى خراب بلدان كسوريا والعراق واليمن وليبيا، ومصر بطريقة مختلفة، إلى إضعاف كامل الطوق العربي المحيط بإسرائيل، بصورة متوازية مع الضعف الفلسطيني الذاتي بسبب انقساماته الداخلية والنفوذ الإيراني في بعض مكوناته السياسية.. ليوفر مجموع هذه التطورات البيئة المثالية لتحويل قرار الكونغرس المجمد بشأن القدس إلى واقع متحقق بتوقيع رئيس للولايات المتحدة عوّد الرأي العام على قرارات صادمة وفضائحية ما كان لأي رئيس أمريكي آخر أن يتخذها بجرة قلم كما فعل ترامب.
ولكن، برغم كل الشروط «الملائمة» المذكورة أعلاه، يبقى أن لقرار ترامب تداعيات لا يمكن اعتبارها تصب في مصلحة الولايات المتحدة، وإن كانت تصب في مصلحة إسرائيل بصورة تامة. من المحتمل أن الجولة «الرشيقة» التي قادت الرئيس الروسي، في يوم واحد، إلى سوريا ومصر وتركيا، ما كان لها أن تتمتع ببريق النجاح لولا أنها جاءت بعد قرار ترامب بشأن القدس بأيام قليلة. ففي القاعدة الجوية الروسية في حميميم استقبل «ضيفه» الكيماوي بطريقة مذلة لهذا الأخير، وأعلن عن قراره بسحب قسم من قواته الجوية والبرية من سوريا، مع الإبقاء على القاعدتين العسكريتين في طرطوس وحميميم. وذلك تتويجاً لـ»النصر» الذي سبق وأعلن عن تحقيقه «على الإرهاب» في سوريا بعد سيطرة قوات تابعه السوري على البوكمال قرب الحدود العراقية.
فإذا أضفنا هذه الزيارة المفاجئة إلى ما يجري في جنيف من مفاوضات بلا مفاوضات، مع تهديد الممثل الأممي ستيفان دي مستورا لوفد المعارضة باستبدال مسار سوتشي الروسي بمسار جنيف الأممي، أمكن القول أن بوتين المسلح بتفاهماته مع إدارة ترامب بشأن الصراع السوري، قد أمسك بمصير سوريا بصورة متفردة، بما يجعل روسيا نداً للولايات المتحدة كما كان يحلم بوتين منذ صعوده إلى السلطة في روسيا.
وما يعزز من صورة هذه الندية المشتهاة، العلاقات الطيبة التي باتت تربط روسيا بجميع دول المنطقة تقريباً، من إسرائيل إلى دول الخليج ومصر، إضافة إلى تركيا وإيران. مع تركيا وإيران بصورة خاصة، أنشأ بوتين تعاوناً ثلاثياً بشأن سوريا في مسار آستانة، ويستعد لنقل محادثات السلام المفترضة في جنيف، تحت إشراف الأمم المتحدة، إلى سوتشي بإشراف الثلاثي الروسي ـ الإيراني ـ التركي. أما في مصر فقد اتفق مع حكومة السيسي على إنشاء مفاعل نووي، إضافة إلى عقود تسلح. وفي أنقرة يسعى بوتين إلى تذليل آخر العقبات أمام التئام «مؤتمر الحوار الوطني» (الشعوب السورية سابقاً) وذلك بتفهم هواجس القيادة التركية بشأن تمثيل كرد سوريا في المؤتمر. إضافة إلى صفقة صواريخ إس 400 الروسية التي باتت أقرب إلى التوقيع النهائي بشأنها.
هذه بعض وجوه «قصة نجاح» بوتين التي برزت في جولته الثلاثية السريعة وشملت كلاً من حميميم والقاهرة وأنقرة. لكن وجهاً آخر لهذه الجولة يتمثل في الموقف الروسي من قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يسعى إلى تسويقه انطلاقاً من تركيا التي سيجتمع فيها قادة الدول الإسلامية، الأربعاء، للتباحث حول موضوع القدس. وهكذا أتيح لبوتين أن يقدم روسيا بوصفها أقرب إلى تطلعات الدول العربية والإسلامية بخصوص القضية الفلسطينية، بالمقارنة مع الموقف الأمريكي الذي طوى بالقرار الأخير حول القدس، عملياً، أي إمكانية للاستمرار كوسيط في عملية السلام المفترضة.
ما هي الجهات الأخرى التي استفادت من قرار ترامب بشأن القدس، إضافة إلى روسيا؟
التيار السلفي الجهادي الذي من المحتمل أن يكسب المزيد من الأنصار لدعاواه العدمية، و»محور الممانعة» المزعومة بقيادة نظام ولي الفقيه في إيران. فهذا المحور الذي فقد الكثير من مبررات ممانعته المفترضة، بعد خوضه في وحول الصراعات المذهبية في العراق وسوريا واليمن، سيسعى الآن إلى استعادة شيء من دعاواه بمناسبة حدث القدس. ولكن إذا نظرنا إلى ردة فعل حسن نصر الله، أبرز الأصوات الملعلعة لهذا المحور، سيظهر أن استعادة زخم الخطاب الممانع لن يكون بهذه البساطة. فهو يدعو إلى مواجهة القرار الأمريكي بالجهاد الافتراضي عبر تويتر وفيسبوك!
٭ كاتب سوري
القدس العربي
حكايتي مع فلسطين/ هنادي الخطيب
قبل ٢٣ عاماً قطع التلفزيون السوري بثه وأعلن عن مجزرة داخل الحرم الإبراهيمي في فلسطين.
قبل ٢٣ عاماً كنت بعمر يريد أن يراهق، ولكن فلسطين كانت تحتلني ولا تترك مساحة في قلبي تكفي لممارسة شغب المراهقة.
قبل ٢٣ عاماً، وفي يوم ٢٥ شباط (فبراير) وقف المستوطن الإسرائيلي باروخ غولدشتاين خلف أحد أعمدة المسجد وانتظر حتى سجد المصلون وفتح نيران سلاحه الرشاش عليهم وهم سجود، واخترقت شظايا القنابل والرصاص رؤوس المصلين ورقابهم وظهورهم.
قبل ٢٣ عاماً، أنا الفتاة السورية، لم أستطع فهم ما حدث في الحرم، فسقطت في دوامة القهر والغضب والحزن والبكاء، وتجاهلت خزانة ثيابي لمدة شهر، وغرقت في اللون الأسود حداداً على شهداء الحرم الإبراهيمي.
بعد سنوات، رويت لصديقي الفلسطيني السوري قصتي مع الحرم الإبراهيمي. ربما كنت من حيث لا أدري، أحاول أن أقنعه بأن قصتي مع فلسطين لا تزال مستمرة، وانتظرت رد فعله الذي أتى بارداً لدرجة أصابت علاقتي معه بصقيع فوري.
اليوم وبعد ٢٣ عاماً من تلك المجزرة وبعد ٧ سنوات من المجازر في سورية، فهمت سبب برودة جوابه، ضحكت بسخرية من ثيابي السوداء التي ارتديتها شهراً كاملاً… لم يكن صديقي متبلد المشاعر (كما ظننت حينها). كان فلسطينياً خَبِرَ اللجوء، وعاش المذابح البعيدة عنه مكانياً والقريبة من قلبه إلى حد الموت.
صديقي كان فلسطينياً يعيش حقيقة اللاوطن، حقيقة أنه حي والآخرون يموتون، حقيقة أن ثمة متحدثين وخطباء، من كل عروش السلطة العربية، يتنقلون من شاشة إلى أخرى، يتكلمون باسم فلسطين والفلسطينيين، وحقيقة أنهم بمعظمهم تجار قضية وسلطة، حقيقة أن قضيته ماتت لدى العالم وماتت لدى فلسطينيين، وتكاد أن تموت في قلبه هو، حقيقة أن الضحية ترفع مقام أشخاص تفرجوا عليها وهي تحتضر وأشاحوا بوجوههم للجهة الثانية.
اليوم أنا السورية، أخاف أن أتحدث عن فلسطين فيهزأ مني الآخرون، أخاف أن أعبر عن غضبي من قرار الكاوبوي البرتقالي ترامب حـــول القدس، فيمطرني بعض السوريين بوابل من التوبيخ والسخرية: «فكري بأهلك أولاً».
هل فعلاً ما زال الديكتاتور يعيش في عقول بعضنا، لدرجة امتلاك جرأة السخرية من موت آخرين، وجرأة توبيخ المتفاعلين مع فلسطين.
نحن هنا، ونحن نحن، من سمعنا محمود درويش وتدافعنا في دمشق لحضور أمسيته الشعرية المخصصة لفلسطين، وحفظنا جملة مظفر النواب «القدس عروس عروبتكم»، نحن نحــن، قتلَنا بشار الأسد، ارتكب مذابحه بدم بارد أمام العالم وعلى الهواء مباشرة، ونحن نحن من عاش فلسطينيون بيننا دأبنا على نسيان أنهم فلسطينيو الأصل لأنهم كانوا معــنا سوريين، خذلنا بعضهم ومات كثيرون منهم معنا وبيننا في وطننا ووطنهم، نحن نحـــن اليوم نفخر بتبلدنا تجاه عروس العروبة، ونتفنن بإظهار قوة كاذبة، ولكن أي قوة تلك؟
القوة التي انتصر فيها بشار الأسد علينا، فجعلنا سكارى بقدرتنا على مشاهدة موت الآخرين واغتصاب قدسنا من دون أن نهتز، وحــولنا إلى أصنام نتغنى بألمنا ونتجاهل ألم الآخرين. لسنا نحن من نشتم بعضنا على وسائل التواصل الاجتماعي ونستخف بما حدث ويحدث وسيحدث في فلسطين، إنه الديكتاتور داخلنا، ذلك المتبلد الساخر.
اليوم أرى صور فلسطين منذ يوم احتلالها حتى اليوم فأحسد الفلسطينيين. ثمة من التقط الثورة والشجاعة والحب والقهر والإصرار بكاميرته، ثمة من كتب شعراً حفظناه عن ظهر قلب، ثمة من غنى القدس فأبكى أجيالاً كاملة. هل أحب الفلسطينيون بلادهم أكثر منا؟ مقارنة عاطفية، ينتفض عليها قلبي: السؤال ليس: هل أحبوا فلسطين أكثر مما أحببنا سورية؟ هنا لا مجال للمقارنة، كل الناس تحب أرضها وأهلها، لكن في سورية وبعد سنة أو سنتين من انطلاق ثورة الحق السوري ضد الطاغية الأسدي، وبعد أن سرقوا الثورة إلى شاشات الفضائيات ورايات الطوائف والأمراء، وألبسوها عمائم سوداء وبيضاء، وبعد أن سرقوا كل صوت نخبوي ومثقف، أو عزلوه في الدهاليز، لم تعد صورة المعتدي واضحة عند الناس، والتبس الحق بالباطل. بتنا نخشى أن نصرخ، فنرى أنفسنا مع ذاك المعارض الذي لم يتوقف عن الصراخ منذ سبع سنوات على الشاشات. بتنا نخشى أن نستعين بالله فنرى أنفسنا خلف راية أمير إسلاموي يسترزق باسم الإسلام والطوائف. بتنا نخشى أن نفكر فيمطرنا ذلك المثقف النخبوي من برجه المزيف بوابل من الفلسفات. أصبحنا نريد إنقاذ سوريتنا ووطنيتنا وإسلامنا ومسيحيتنا وعروبتنا وكرديتنا من أسواق البورصات والمزايدات. إنه عصر الفايسبوك والإعلام الفوضوي. لن أقع في فخ مقارنة عذابات السوريين بعذابات الفلسطينيين، فمقارنة الجرح بجرح غير عادل، والتقليل من ألم باستحضار ألم آخر هو عبث حقيقي.
* كاتبة سورية
الحياة
القدس كمدينة والقدس كقضيّة/ حازم صاغية
في قرار دونالد ترامب الأخير حول مدينة القدس، حضرت جوانب مهمّة وغاب جانب لا يقلّ أهميّة.
حضر الظلم الذي يتعرّض له الفلسطينيّون، ولا عقلانيّة عقل ترامب السياسيّ، وتوسّعيّة الكيان الإسرائيليّ وعنجهيّته. ما غاب هو أنّ القدس مدينة أخرى تعدّديّة التكوين من مدن المشرق والشرق. ولئن تعدّدت الأسباب، وكثرت السكاكين القاتلة واختلفت، بقي الموت واحداً في ما خصّ هذه المدن.
فبالأمس شهدنا ما حصل للموصل وللرقّة، وكذلك لكركوك، التي هي كرديّة وتركمانيّة وعربيّة في الوقت نفسه. وقبيل ذلك، كانت مدينة حلب تنشطر إلى نصفين شرقيّ وغربيّ، بما يدمّرها كنسيج مدينيّ كان ذات مرّة واحداً، كما كان كوزموبوليتيّاً.
ولا تزال الرضوض والندوب ظاهرة على وجه بيروت وروحها، وعلى ضعف التواصل بين شطريها الشرقيّ والغربيّ الذي بدأ مع الحرب أواسط السبعينات. أمّا الإسكندريّة فمنذ تمكّن النظام العسكريّ من مصر في الخمسينات، جرى تجفيفها من التعدّد الذي عُرفت به. وحين يقال اليوم «تهويد القدس» يأتي التعبير بعيداً في دلالته التعيسة هذه، أي في الإفقار والمصادرة اللذين يضربان التركيب السكّانيّ والثقافيّ مثلما يصيبان تاريخ المدينة المتعدّد الطبقات.
ولئن راج في الآونة الأخيرة الكلام عن «انهيار الدول والأوطان»، أو «ضياعها»، فإنّ ما يبدو اليوم هو الانتقال إلى محطّة أخرى أشدّ تفصيلاً وداخليّةً، هي انهيار المدن أو ضياعها. وهذا بدوره من نتائج الاستبداد والأحاديّة وفرض اللون الحصريّ لجماعة بعينها، أكانت قوميّة أو دينيّة أو غير ذلك، فإمّا الإذعان للون وهويّة واحدين أو الدمار.
وإذا وضعنا جانباً الحميّة الدينيّة والقوميّة، تساوى في هذه النتيجة ما يفعله عرب وأكراد وإسرائيليّون وسواهم من شعوب المنطقة وجماعاتها.
إنّ واقع المدن ورسم مستقبلها لا يقرّرهما نصّ دينيّ أو أسطورة إثنيّة يعطيان الأولويّة والحصريّة لشعب ما، أو لجماعة ما، على حساب الحياة نفسها بسيولتها وكثرتها. لكنْ للأسف، فهذا ما يحدث الآن، وسريعاً ما سيغدو جزءاً من الماضي، نتعامل معه كأنّه الواقع المعطى الذي لا يرقى الشكّ إليه.
يكفي أن نقارن ما يحصل راهناً بما سبق أن أكّده مؤرّخون للبحر الأبيض المتوسّط وحضاراته، بوصفها كثيرة التراكم والاستمراريّة، قليلة الانقطاع. أمّا اليوم فيحصل في تاريخنا انقطاع ربّما كان غير مسبوق في مداه ونطاقه، وفي كارثيّته بالتالي. إنّنا نغدو بلا مدن وبلا بلدان.
وهذا فيما يمارس النظام الإيرانيّ بدوره ما أسماه الزميل حازم الأمين «لعباً بأصل الأشياء في المنطقة»، على شكل إزاحة لجماعات من مواضعها، وربط وفكّ لبلدان هذا الإقليم. أمّا أحد تابعيه، السيّد قيس الخزعلي قائد «عصائب أهل الحقّ» العراقيّة، فيكون الشتوة الأولى التي تهبط علينا من جرّاء الطرح المعهود لمسألة القدس بوصفها قضيّة لا بوصفها مدينة وسكّاناً، وبوصفها خلطة تخلط كلّ شيء بكلّ شيء آخر. وقس على قيس من خراب عميم مرفق بكلام يعرف أصحابه أنّه لا يعني شيئاً ولا يؤدّي إلى شيء، وإلاّ هل كان لوزير خارجيّة لبنان السيّد جبران باسيل أن يطالب بعقوبات على أميركا!
الحياة
قرار ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
في قطيعة مع سبعة عقود من السياسة الأميركية نحو القدس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري اعتراف إدارته بالقدس عاصمةً لإسرائيل، كما وجّه وزارة الخارجية لـ “بدء التحضيرات لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس”. وكان الكونغرس الأميركي قد تبنى بأغلبية كبيرة من الحزبين “قانون سفارة القدس” عام 1995، ونص على ضرورة نقل السفارة الأميركية إلى القدس في سقفٍ زمني لا يتجاوز 31 أيار/ مايو 1999. إلا أن ذلك القانون تضمن بندًا يسمح للرئيس الأميركي بتوقيع إعفاء مدة ستة أشهر إذا رأى أنه ضروري لـ “حماية المصالح الأمنية القومية الأميركية” . ومنذ إدارة الرئيس بيل كلينتون، والإدارات الأميركية المتعاقبة توُقّع الإعفاء تلقائيًا كل ستة أشهر، على الرغم من أنهم كانوا قد وعدوا بوصفهم مرشحين بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
أهم عناصر القرار
تضمّن قرار ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لدولة الاحتلال الإسرائيلي المحاور التالية:
القدس عاصمة لإسرائيل
بحسب ترامب، فإن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو “الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله”. ومع ذلك فقد حرص في خطابه على تأكيد أنّ إعلانه هذا لا ينبغي أن يمس بقضايا الوضع النهائي . وبحسب رسالة بعثتها الخارجية الأميركية إلى سفاراتها في العواصم
“حسب ترامب، فإن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو “الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله”
الأوروبية، فقد طلب من الدبلوماسيين الأميركيين التوضيح للمسؤولين الأوروبيين “أن القدس ما زالت قضية من قضايا الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأنه يجب على الطرفين تقرير أبعاد سيادة إسرائيل في القدس خلال مفاوضاتهم” . وهو ما أكده وزير الخارجية ريكس تيلرسون مرةً أخرى بقوله إن الرئيس “كان واضحًا للغاية أن الوضع النهائي (بالنسبة إلى القدس) بما في ذلك الحدود سيترك للتفاوض واتخاذ القرار بين الطرفين” ، وذلك في إشارة ضمنية إلى أنه يمكن تقسيم المدينة إلى عاصمتين إذا توافق الطرفان. وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الغربية عام 1948، وأعلنتها عاصمة لها عام 1949، في خطوة رفضها المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، ثم احتلت القدس الشرقية عام 1967. وتنص القرارات الدولية على أن القدس الشرقية التي تقع ضمن حدودها الأماكن المقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين، أرضٌ محتلة، وهي الجزء الذي يريده الفلسطينيون عاصمةً لدولتهم، وترفض إسرائيل ذلك.
وعلى الرغم من محاولة الإدارة الأميركية التقليل من خطورة القرار، فما لم يقله ترامب ولا مسؤولو إدارته هو أنّ إسرائيل ترفض منذ عام 1967 الاعتراف بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية. كما أنّ ترامب برر قراره إعلان القدس عاصمة لإسرائيل بأنه يطبّق القانون الذي أصدره الكونغرس عام 1995. وينص هذا القانون على أنّ مدينة القدس “يجب أن تبقى موحدة”، و”ينبغي الاعتراف بها عاصمةً لدولة إسرائيل”، ومن هنا، يصبح أيّ حديث عن أنّ قرار ترامب لا يتضمن مصادرة لحق الفلسطينيين في مناقشة قضايا الوضع النهائي، ومن ضمنها القدس، في المفاوضات، ذرٌ للرماد في العيون، خصوصًا أنّ التقارير التي تنشر عن ملامح إطار لحل يعمل عليه فريق صهر الرئيس، جاريد كوشنر، إما أنّها تستبعد القدس الشرقية من الحل، وإمّا أنّها تدعو إلى تأجيل بحثها لسنوات قادمة، حتى لو قامت دولة فلسطينية.
نقل السفارة إلى القدس
وقع تأجيل النقل المباشر للسفارة مدة ستة أشهر أخرى، على أساس أنّ ذلك يستغرق وقتًا حتى يتم “توظيف المهندسين المعماريين والمهندسين الآخرين والمخططين لتكون السفارة الجديدة بمنزلة إشادة رائعة بالسلام عند اكتمالها”، على الرغم من أنّ قرار ترامب يأمر وزارة الخارجية بـ “بدء التحضيرات لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس”. وبحسب تيلرسون، فإنّ “نقل السفارة لن يحدث هذا العام ولا العام المقبل على الأرجح، لكن الرئيس يريدنا أن نبدأ في عملية ملموسة عندما نكون قادرين على ذلك” . وبغض النظر عن موعد نقل السفارة فعليًا، فإنّ ترامب بقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتوجيهه للخارجية ببدء تحضيرات نقل السفارة، يكون قد أنهى، عمليًا، سياسةً اتّبعها أسلافه الثلاثة، على مدى أكثر من عشرين عامًا، بتأجيل قرار النقل إلى أن يتم التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
الالتزام بالسلام وحل الدولتين وفق مواصفات إسرائيل
حرص ترامب في خطابه على تأكيد التزام إدارته “القوي بتسهيل التوصل إلى اتفاق دائم للسلام”. ولأول مرة منذ وصوله إلى الرئاسة يعلن ترامب دعمه حل الدولتين، غير أنّ دعمه هنا جاء مشروطًا بموافقة الطرفين “وستدعم الولايات المتحدة حل الدولتين إذا وافق عليه كلا الطرفين”. وهو ما يعيد المفاوضات إلى مربعها الأول، فهو يمنح حق الفيتو لإسرائيل التي ترفض الاعتراف بدولة فلسطينية بناءً على قرارات الشرعية الدولية .
دوافع ترامب وحساباته
لم يكن قرار ترامب بخصوص القدس محل توافق بين مستشاريه الرئيسين؛ ففي حين عارضه وزيرَا الخارجية، تيلرسون، والدفاع، جيمس ماتيس، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية
“ما لم يقله ترامب ولا مسؤولو إدارته هو أنّ إسرائيل ترفض منذ عام 1967 الاعتراف بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية”
الأميركية (سي آي إيه)، مايك بومبيو، فقد أيّده كلّ من نائب الرئيس، مايك بينس، والسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هالي، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان. كما أيده أيضًا، صهره ومستشاره جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات.
تتمثل حجج معارضي هذا القرار في أنه قد يمثّل تهديدًا للمصالح الأميركية في المنطقتين العربية والإسلامية، كما أنه قد يضعف الرعاية الأميركية للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية ويفشل أي مقترحات للسلام تعمل عليها، وربما يفجرها عبر الانجرار إلى جولة جديدة من العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن أنه قد يوتر علاقات الولايات المتحدة بحلفائها من العرب والمسلمين، بل قد يساهم في عزل أميركا دبلوماسيًا، حتى بين حلفائها من الأوروبيين . في المقابل، جادل الطرف المؤيد للقرار بأن إعلانًا من هذا النوع سيعزز صدقية ترامب بين الإسرائيليين، وبناءً عليه، يُمَكِّنُه من المناورة مع حكومة نتنياهو اليمينية في حال طرحت الإدارة الأميركية إطارًا لاتفاق نهائي مع الفلسطينيين .
ولكن، ما الأسباب الحقيقية التي دفعت ترامب إلى المضي قدمًا في إعلان قراره بخصوص القدس، على الرغم من معارضة كبار مستشاريه في مجلس الأمن القومي؟ حاول ترامب أن يضع قراره في إطار الالتزام بالقانون الذي أقره الكونغرس عام 1995 حول نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. ولم يتردد في اللمز من قناة الرؤساء الثلاثة قبله من أنهم كانت تنقصهم الشجاعة لعدم تفعيلهم هذا القانون. كما أن الموضوع بالنسبة إلى ترامب يتعلق بوعدٍ قطعه على نفسه بوصفه مرشحًا. وبناءً عليه، فإنه لا بد من الوفاء به، وذلك على عكس من سبقه من رؤساء، “ففي حين جعل الرؤساء السابقون من هذا الأمر وعدًا رئيسًا في حملاتهم، فإنهم لم يفوا به. وأنا اليوم أفي به”. هنا يبرز بعدٌ شخصي في قرار ترامب، فهو لم ينفذ أيًا من وعوده الانتخابية تقريبًا، ما يتناقض مع ميله إلى الظهور بمظهر الرئيس القوي الذي يتخذ قرارات لا يجرؤ غيره على اتخاذها، والذي وجد في قضية فلسطين تحديدًا فرصةً لممارسة هذا الميل. لكن هناك أيضًا رغبته في إرضاء جمهوره ومحازبيه وقاعدة دعمه الانتخابية؛ وفي مقدمتها:
إرضاء اللوبي الصهيوني في أميركا
في آذار/ مارس 2016، ألقى ترامب خطابًا أمام لجنة الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية (إيباك)، الذراع الطولَى للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، تعهّد فيه بنقل “السفارة
“لم يكن قرار ترامب بخصوص القدس محل توافق بين مستشاريه الرئيسي”
الأميركية إلى العاصمة الأبدية للشعب اليهودي، القدس” . وبحسب تقارير مختلفة، فإنه بعد ذلك الخطاب انحاز الملياردير اليهودي، شيلدون أديلسون، مالك الكازينوهات الشهير (الذي أطلق اسمه على حيٍ في القدس الشرقية بعد الاحتلال مباشرةً)، والداعم للجمهوريين، إلى دعم حملة ترامب للرئاسة، وتبرّع بمبلغ عشرين مليون دولار إلى إحدى اللجان السياسية الانتخابية المؤيدة لترامب، ثم تبرع مرةً أخرى بقيمة مليون ونصف المليون دولار لتنظيم مؤتمر الحزب الجمهوري الذي أعلن ترامب رسميًا مرشحًا رئاسيًا له. ومنذ انتخاب ترامب رئيسًا، لم يتوقف أديلسون عن تذكيره بوعده، ولم يخف تذمّره عندما خضع ترامب لضغوط مستشاريه في حزيران/ يونيو الماضي، وقرّر توقيع إعفاء نقل السفارة . وبحسب وسائل إعلام أميركية، فقد دخل ترامب فجأةً إلى اجتماع كبار مستشاريه لشؤون الأمن القومي، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، حين كانوا يناقشون موضوع تأجيل نقل السفارة مرةً أخرى من عدمه، وأبدى إصرارًا على ضرورة أن يقدموا له خيارًا يسمح له بالإيفاء بوعده الانتخابي، وهو ما تم بالشكل الذي صدر على الرغم من تحذيرات وزيرَي الدفاع والخارجية.
إرضاء الجماعات الإنجيلية
يمثل الإنجيليون نحو 25% من الشعب الأميركي، وصوّت نحو 80% من البيض منهم لمصلحة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة . وتمثل قضية نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس إحدى أولويات تلك الكتلة التصويتية، بل إنّ كثيرًا من جماعاتهم ضغط على ترامب للتعجيل بقرار نقل السفارة وإعلان القدس عاصمةً لإسرائيل . وبالنسبة إلى الإنجيليين، فإن قضية نقل السفارة لا تتعلق بأمر سياسي، بقدر ما هي تحقيق لنبوءة تمهد الطريق لعودة المسيح في الطريق إلى معركة نهاية التاريخ التي يفترض أن تقع في سهل “مجيدو” بحسب الأسطورة، وسوف يقبل اليهود “المسيح” مخلّصًا لهم بعد أن رفضوه من قبل . ومن الأرجح أنّ رجل الأعمال ترامب لا يؤمن بهذه العقيدة، إلا أنه ليس في وارد إغضاب هذه الكتلة الانتخابية الكبيرة المؤيدة له.
خلاصة
جاء قرار ترامب الأخير بمنزلة تعبير عن انتصار أنانيته واعتباراته السياسية الداخلية على مقاربة عقلانية وواقعية للسياسة الخارجية . كما أنه يمثل انتصارًا للمعسكر اليميني المتطرّف في إدارته الذي تقوم حساباته على أن الفلسطينيين سوف يبتعدون عن طاولة المفاوضات فترةً، ولكنهم لن يلبثوا أن يعودوا إليها ضمن الوقائع الجديدة، كما فعلوا كل مرة ، وهو ما يعني أن الرهان سيكون عمليًا على إرادة المقاومة لدى الشعب والقيادة الفلسطينيَين، ومدى قدرتهما على الصمود في وجه الضغوط الأميركية، والعربية أيضًا، والإصرار على موقفهما بأنّ الولايات المتحدة لم تعد وسيطًا مؤهلًا لرعاية العملية السلمية، والبحث في خيارات أخرى بعد ثبوت فشل خيار المفاوضات. يأتي هذا في ضوء تسريبات عن أنّ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مارس ضغوطًا شديدة على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال زيارته الأخيرة للسعودية لقبول المقترح الذي طرحه جاريد كوشنر عن “تأسيس ’كيان فلسطيني‘ في غزة وثلاث مناطق إدارية في الضفة الغربية في المنطقة (أ) والمنطقة (ب) و10 في المئة من المنطقة (ج)، التي تضم مستوطنات يهودية”، بحيث تبقى هذه المستوطنات على حالها، ويسقط الفلسطينيون حق العودة وتظل إسرائيل مسؤولة عن الحدود . وبهذا المعنى يكون إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل استكمالًا لجهود القضاء على طموحات الفلسطينيين في إنشاء دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي احتلت عام 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية، وهي في حد ذاتها تسوية تاريخية قبلها الفلسطينيون
العربي الجديد
اختبار القدس: أخطاء ترامب فرصة لإيران والتطرّف/ عبدالوهاب بدرخان
لا تشاؤم مفتعلٌ ولا تثبيط للعزائم ولا دعوة الى الاستسلام، لكن العرب مقبلون على خسارة اختبار القدس، بل لعلهم خسروه فعلاً. هذا هو الواقع بكل بشاعته وفجاجته وآلامه. ولم يبقَ لهم سوى الحدّ من الخسائر، إنْ استطاعوا، فقد رأوها آتية، ولعلهم استدرجوها من دون أن يتقصّدوا ذلك. وفي اجتماع وزراء الخارجية العرب ظهر التباين في المواقف بين فئات من العرب: الهاجسون بالتهديد الإيراني، والمخصّبون بالخطاب الإيراني، والمنشغلون بجبالٍ من المآزق والهموم الداخلية، والمعوّلون على الولايات المتحدة ولا يستطيعون مواجهتها، والمراهنون على أدوار أوروبية أو روسية – أو حتى إيرانية- مع علمهم بأن أميركا لبّت منذ تسعينات القرن الماضي شرطاً إسرائيلياً جرّفت بموجبه كل الأدوار الأخرى أو تستخدمها صُوَريّاً عند الضرورة كديكورات للإيحاء بأن «المجتمع الدولي» يبارك سياساتها، أي سياسات إسرائيل.
سقطت المطالبات بـ «المقاطعة» لأن الدول التي تجرّأت وأقدمت عليها سابقاً، بإشهار «سلاح النفط» وغيره، دفعت أو بالأحرى دفّعتها أميركا الثمن. وسقطت خيارات المقاطعة السياسية لأنها، وإنْ بدت ممكنة وتمّ اتّباعها فعلاً، لا تحول دون أن تكمل أميركا وإسرائيل ما بدأتاه من تصفيةٍ مبرمجة للقضية الفلسطينية، التي لم تعد منذ زمن «قضية العرب المركزية»، لا بقرار اتخذه العرب بإرادتهم وكامل وعيهم، بل لأن «قضــــايا» كثــيرة طرأت وأشعرتهم بالأخطار ذاتها التي عانت منها فلسطين وشعبها. والأكثــر واقعية أن العرب وجدوا أن القضية الفلسطينية منذ تذرّع بها صدّام حسين لغزو الكويت ومنذ تأبطها زعيم «القاعدة» لشرعنة إرهابه لم تعد صالحة للتوظيف والاستخدام في الحفاظ على الأنظمة، وأنهم منذ تخلّوا مجبرين عن خيار الحرب وأدخلوا القضية في نفق المفاوضات، آملين بـ «حل سلمي» يطوون به صفحتها، باتوا يدركون الآن أنهم لم يحسنوا إدارة الحرب ولا أجادوا إدارة معركة السلام، وليس خافياً أنهم مدعوون الآن الى إدارة الضعف والعجز بالتنازلات، حتى لو كانت تتعلّق بالقدس التي لطالما توارثوا التثاقف في شأن أهميتها التاريخية ورمزيتها الدينية وهويتها العربية وكونها تختصر في ذاتها قضية فلسطين، بل كرامة العرب…
كل ذلك لم يتغيّر. كان صحيحاً وسيبقى. إلا أن مبدأ «الضرورات تبيح المحظورات» أصبح عنواناً للتفلّت واللامبالاة واستسهال التهاون وتسهيله على الآخر في الموقع المعادي. ومع ذلك، لمَن يتعجّلون التخفف من أعباء فلسطين والفلسطينيين، وقد أصبحت لديهم «قضاياهم»، لا بدّ أن يتذكّروا أن الأنواء والعواصف والمخازي التي مرّت بها هذه القضية هي التي قادت المنطقة العربية الى ما تشهده اليوم، لأنها بلغة العصر وقوانينه الأممية قضية شعب يريد التخلّص من الاحتلال/ الاستعباد/ الاستبداد ويطمح الى حريته وتحصيل حقوقه والعيش بكرامة. وعليهم بالتالي أن يحذروا تعجّلهم وتهافتهم، لا لشيء إلا لأنه قد يرتد عليهم في «قضاياهم» نفسها، فمَن يضمن «ألاعيب الأمم» وتقلّبات المصالح. نعم، لا أحد يتوقّع من العربي المنكوب في سورية واليمن والعراق وليبيا، أو المأزوم في لبنان، أن يتناسى مآسيه ومعاناته ليقدّم عليها أي قضية، لكنه يدرك في أعماقه أنه إذا سُحق الحق في مكان فإنه لن يدرك حقوقه ولن يحقّق أيّاً من طموحاته أبداً. ولا يعني ذلك سوى أن الغلبة ستبقى سموم المشاريع والخطط الخارجية وأمراضها طالما أنها ترتع في الانكشاف العربي المفتوح أمامها ولا مناعة عربية ذاتية تصدّها، سواء كانت إسرائيلية أو إيرانية أو أميركية، ولا فارق بينها، فمهما تصادمت اليوم في الظاهر لا يمكن التكهّن في مآلاتها المستقبلية ما دامت متوافقة في جوهرها على الاستثمار في الضعف العربي.
من الطبيعي الاحتجاج والسخط والغضب، لأن قرار دونالد ترامب طعنة لا يمكن قبولها بأي ذريعة كانت. ومن الممكن طبعاً جلد الذات أو التباري بالنخوة والإقدام. لكن هذه لن تصنع سياسة عربية قادرة على مواجهة عدوان أميركي- إسرائيلي يستشعره كل عربي إن لم يكن بوجدانه وكينونته فبعقله، خصوصاً أن جهداً مضنياً بُذل لتكوين اقتناع جماعي بأن المسألة الفلسطينية، بما فيها القدس، في كنف تفاوضٍ و «عملية سلام» قالت ثلاث إدارات أميركية سابقة إنها في صلب استراتيجيتها. لكن العرب خُدعوا كثيراً وطويلاً ولم يعترفوا بذلك، وبالطبع لم يتصارحوا ولا صارحوا شعوبهم بل بلعوا كل الخدع، وراحوا يتفرجون على الخيارات تتضاءل في أيديهم. فما العمل إذا كانت أميركا تتجاهل التزاماتها المكتوبة لهم أو تنقلب عليها ولا تلتزم سوى ما تتعهّده لإسرائيل؟ وما العمل إذا كانت أميركا حوّلت «عملية السلام» من شراكة الى فخّ للعرب؟ طرحوا مبادرة السلام العربية ولم تقبلها إسرائيل ولا أميركا، وقد يكونون وجدوا في «الشرعية الدولية» ملاذاً وسبيلاً، لكن ترامب أسقطها لتوّه، فهو يريد «الحلّ» أو بالأحرى «اللاحلّ» الإسرائيلي، الذي لا يمكن تمريره بتطويع القوانين بل يُفرض فرضاً خارج أي مرجعيات أو شرعية دولية.
عملياً، يعيد ترامب القضية الى التصوّر الليكودي الأساسي، الى ما قبل المفاهيم التي وضعها مؤتمر مدريد وحاولت اتفاقات اوسلو أن تطبّقها لكنها تركت فيها ثغراً كثيرة. فالإسرائيليون كانوا ولا يزالون يعملون على وضع دائم للأراضي الفلسطينية، قوامه مناطق حكم ذاتي مقطّعة الأوصال والمقوّمات، ولا ترابط بينها يؤهّلها لأن تطالب بالتحوّل الى دولة ذات حدود وسيادة محترمتين. أي أن تكون مناطق يديرها الاحتلال، متحكّماً بأمنها ومواردها واقتصادها. يتبنّى ترامب، إذاً، مشروعاً لشرعنة نهائية للاحتلال، فلا تكون هناك مشكلة استيطان، ولا حقٌّ بالعودة أو حقوق أو حتى تعويضات للاجئين، بل لا يكون هناك اعترافٌ بشعب له حقوق أساسية مطلوب منه أن يستسلم ويتنازل عنها. هذا ما يراد استغلال أحوال العرب وأزماتهم الداخلية واستفراد الشعب الفلسطيني لفرضه عليه، فإمّا أن يقبله أو يتحمّل النتائج بالقتل والتدمير وبالحصار والتجويع.
كل ذلك لا يصنع حلّاً سلمياً ولا حتى تسوية جديرة بهذه التسمية بل مشروع احتلال متجدّد لن يجد ترامب وبنيامين نتانياهو فلسطينياً واحداً يتحمّل مسؤوليته مهما بلغت الضغوط عليه. والواقع أن الرئيس الأميركي، الذي يدير ديبلوماسيته بانحياز أعمى للمتعصّبين من ناخبيه، ولو تطلّب منه ذلك الاستهتار بمسألة كالقدس، يخطو سريعاً بسياسته الخارجية نحو شريعة الغاب فيما هو يعتقد أنه يقوم بـ «التجديد» والخروج من الأطر التقليدية. لذلك لم يعد أحد يتصوّر أنه قادر على طرح أي خطة أو مبادرة للسلام، سواء أوفد نائبه مايك بنس أو مبعوثَيه جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات. والسبب واضح هو أنه أقدم على الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ليس تنفيذاً لوعد انتخابي فحسب بل أيضاً عقاباً للجانب الفلسطيني الذي رفض أطروحات المبعوثَين. لم يكن أسلافه من الرؤساء أقل انحيازاً منه لإسرائيل لكنهم كانوا يميّزون بين الممكن واللامعقول، وبين تهوّرات السياسة وضوابطها.
اللامعقول أن يقدم ترامب على خطوة يعرف مسبقاً أنها متهورة، وإلّا فلماذا توعز خارجيته لإسرائيل بأن تقتصد في الاحتفال بها. اللامعقول أن يقدّم هديّة مجانية الى إيران التي يعرف مستشاروه أن التصيّد في أخطاء الأعداء والخصوم أبرز نقاط قوّتها، ولم يجفّ بعد حبر استراتيجيته لمواجهة نفــــوذها. اللامعقول كذلك أن يضرب بعرض الحائط كل ما يبذل في إطار المكافحة الفكرية للتطرّف والإرهاب، فيما المنطقة لم تستفق بعد من تجربة قاسية ومدمّرة مع تنظـــيم «داعش» ولا تنقصها الجمـــاعات والتنظـــيـــمات المرتبطة بإيران المتأهبة الآن لإنعاش «المقاومة» وقد استمدّت مشروعية أضاعتها في مستنقعات الحرب السورية، ولمعاودة توظيف المحنة الفلسطينية، استغلالاً وتشويهاً، في مشروعها التخريبي. كان يمكن «التجديد» الترامبي أن يطرح بقوة خطة خلّاقة للقدس كنواة للسلام القائم على تعايش الأديان، لكن تعصّبه جنح به الى خطوة بالغة التطرّف، مانحاً إيران أفضل فرصة لإدامة الفوضى الإقليمية بجعل القضية الفلسطينية صراعاً دينياً.
* كاتب وصحافي لبناني
الحياة
ترامب يطرد نفسه من الشرق الأوسط/ دلال البزري
لم تكن الولايات المتحدة محبوبة الجماهير العربية يوماً. دعمها الثابت لإسرائيل سبب جوهري. ولكنها حاولت في السبعينيات، مع رئيسها الديمقراطي، جيمي كارتر، أن تلعب دور “الوسيط النزيه” بين العرب وإسرائيل، فأثمرت هذه السياسة اتفاقية السلام بين أنور السادات ومناحيم بيغن، واتفاقية أوسلو؛ والاثنتان تتوقعان مفاوضاتٍ حول الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حكما ذاتياً أو دولتين، ومن ضمن هذه الأراضي مدينة القدس. دونالد ترامب لم يتّبع خطى جيمي كارتر، ولا قبله على كل حال جورج بوش وباراك أوباما. الأول غزا العراق، فأفسح المجال لإيران، من دون قصد ربما، كي تهيمن عليه. أما الثاني، أوباما، فامتنع عن فعل أي شيء في سورية، فوضع رقاب سورية تحت رحمة إيران أولاً، ثم روسيا؛ فنسف بذلك سنواتٍ من المفاوضات السرية وشبه السرية بين إسرائيل ونظام الأسد، بـ”رعاية” أميركية. واضحٌ أنه مهما اختلف الرؤساء الأميركيون بطبائعهم، فإن الخط البياني الذي سلكوه، في العقدين الأخيرين، هو الانسحاب التدريجي من دور “الوسيط النزيه”، بين الإسرائيليين والعرب، وبين العرب أنفسهم، الذين لا يحبون بعضهم، أصلاً. ترامب يجسد ربما واحدةً من مراحل هذا الانسحاب، وأكثرها إثارة، فالرئيس التلفزيوني يلعب دور الشرير، الأحمق. ولكنه في الواقع ضعيف، من ضعف أميركا نفسها؛ في عصر بداية تراجعها، تصبو إلى الانطواء على نفسها. كل الصخب الملازم للسنة الأولى من رئاسة ترامب، كل الصلافة والنفخ في الذات، كأنهما للتمويه عن هذا الانسحاب ليس كـ”وسيط نزيه” وكصاحبة أقوى الأسلحة، وبالتالي، أكثر الاستراتيجيات تماسكاً وتوافقا مع هذا السلاح. أو هكذا يُفترض.
انظر ماذا أنجز ترامب طوال السنة المنصرمة: سحب أميركا من “يونسكو”، من منظمة التجارة العالمية، من اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، من اتفاقية المناخ، من اتفاقية السلاح النووي مع إيران، العزلة من المهاجرين الجدد، ومن أقرب الجيران، المكسيك، ومشروع الحائط الخرافي بينهما. ثم أخيراً، نفض الأيادي من دور “الوسيط النزيه”، وتقديم القدس إلى الإسرائيليين على طبق من القنابل.
بوتين عكس ترامب تماماً: بوجهٍ لا تشوبه حماقةٌ أو هياج، اعترف في الربيع الماضي بالقدس
“في خضم الغضب، نسينا أن القدس ليست إسلامية فقط، إنما مسيحية، قبل أن تكون إسلامية بستة قرون”
عاصمة لإسرائيل، من دون ان يأمر بنقل سفارته إليها، ومن دون أن يرسم الحدود التي يقصد. هكذا، بهدوء ومن دون مسرح، ولا إضاءة. دور بوتين شبه جاهز. وراثته دور “الوسيط النزيه” لها بشائر: أبو مازن اتصل به ليتوسَّط بينه وبين ترامب، ويثنيه عن قراره المتعلق القدس. صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين التقى وزير الخارجية الروسي، ناقلا الرسالة نفسها من أبو مازن. وروسيا، الفخورة بوضوح إستراتيجيتها، بثبات تحالفاتها، بصفتها “صديقة الشعوب”، الموروثة عن الاتحاد السوفييتي، سوف تتابع خطاها الحثيثة لبلوغ هذا الدور، وتصبح هي الوسيط بين العرب وإسرائيل، بعدما صار لها قواعد دائمة ويد طولى على اللاعبين الإقليميين، الحلفاء منهم والمتنافسين. ويطلّ من نافذة فلسطين أيضاً، رأسٌ صيني جديد، مكتوب له أيضاً دور “وسيط” ما… سيكون خجولاً وديعاً في البداية؛ ثم بخطىً دؤوبة، قد يبلغ دوره، ويتنازع مع روسيا مستقبلاً حول أحقيته بهذا الدور، أو حجمه، كوسيط آخر في الصراع العربي الإسرائيلي.
قرار ترامب حول القدس موجّه موضوعياً ضد العرب أنفسهم. “موضوعياً” أقول. أما ذاتياً، أما إعجابه ببعض عربنا، فهذا شأنٌ آخر، له علاقة بمهنته مقاولا، وبذوقه التلفزيوني. ولكن العرب، كما نعلم نحن عن أنفسنا، بين منهارين نازحين ومقتولين، باختصار، ضائعين. حاجة حكامهم إلى أميركا، وبعضهم لإسرائيل، تجعلهم يتصرفون مثل ترامب تماماً: يطلقون الرصاص على أرجلهم، كلما اعتقدوا بأنهم فازوا بغنيمة دور. والحاجة هذه من فوضى أولوياتهم، ونزاعاتهم في ما بينهم، أو من انعدام التوافق بين أولوياتهم وأولويات المجتمع الذي يستقتلون ليبقوا حكاماً عليه. حتى مبادرة السلام للملك عبد الله عام 2002، الداعية إلى دولتين والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، حتى هذه المبادرة التي وُصفت حينها بـأنها “متواضعة”، لم يتمكنوا من فرض احترام بنودها. وكأنهم أرادوا تصديق سلاح المليشيات الإيرانية، والممانعين معها، بأنه موجَّه ضد إسرائيل. وتصديق أهازيجهم التي تتغنّى باحتلالهم سورية والعراق عبر هذه المليشيات، هو معبرها نحو فلسطين… فتخلّوا عن أنفسهم، بعد التخلّي عن حقوق شعوبهم.
الآن المحور الممانع نفسه: قرار ترامب “فرصة تاريخية”، يصدح الممانعون. ولكن لحظة، “تاريخية” بأي معنى؟ إسرائيل أحرزت نقلة نوعية، أخيرا، في ضرباتها الجوية لسورية. بعدما كانت تستهدف المخازن وقوافل السلاح، صارت الآن تقصف، يومياً تقريباً، منشآتٍ إيرانية، تابعة لحزب الله. وإيران وأسلحتها واقعة على الحدود السورية الفلسطينية (الإسرائيلية). وبما أن محور الممانعة انتصر على الإرهاب، كما يردّد ليل نهار؛ بما “أن طريق القدس يمر بالزبداني والقلمون”، أو بأية بلدة سورية ذاقت الأمرّين من سلاحه، فاحتلها… فمن المنطقي، بتعبويته “الكفاحية”، أن تكون تلك “اللحظة التاريخية” هي التي سيطلق فيها صواريخه لتدمر إسرائيل، فتحقّق ما يلهج لسانه “وفلسطيناه..!”.
ولكن لا شيء من ذلك كله. كان حسن نصر الله أكثر من عادي في ردَّيه على قرار ترامب؛ وإن اعتمد الصراخ في ردّه الثاني. قدّم اقتراحات كلاسكية، تنديدا، تظاهرات، تغريدات، سفراء، طرد السفراء.. إلخ. أي ما تقوم به عادة الجماهير المؤيدة، ولكن ضمن شرطين: تظاهرة منفردة ينظمها حزب الله، ودعوة الفلسطينيين كي يقرروا ماذا يريدون… “ونحن وراءهم” و”شهداء بالملايين”! اقتراحات هي دون حزبٍ يملك عشرات آلاف من الصواريخ، يجيب على كل من يسأله عنها، إنها من أجل تحرير فلسطين… وبهذا أهدى نصر الله لكلمنْجية “المقاومة”، فرصاً هائلة لـ”تفجير غضبهم”، بالفرحة من “استفاقة الحقد على أميركا”، وصرخة “الموت لأميركا”؛ بحمل السكاكين وتقطيع أوصال كل إسرائيلي أو خائن أو مطبّع، بالتأكيد على صحة نظرية “المقاومة”، الخالدة، من أن المفاوضات مع اسرائيل مؤداها الفشل، وبأن “المقاومة هي السبيل الوحيد”، وفورة العواطف المهتاجة التي لا ترى أمامها، المنْتشية بغضبها، دليلها للنضال، الذي وجد، أخيراً، سبباً ليتفجر، على الساحة الفيسبوكية… اصرخوا! اغضبوا!… ولكن تحت سقف مضبوط مدروس. في سلوكٍ باتَ بافلوفياً مقنّناً. آخر تجلياته، المضحكة، وزير الخارجية اللبناني، العنصري، الكاره للفلسطينيين، وللسوريين، حليف حزب الله، الذي ارتدى لبوس الزعامة العربية الغابرة، بنسختها القذّافية، البالية، وخرق جدار جامعة الدول العربية عندما أطرب مندوبيها الناعسين، بنشيد الصمود والتصدي: “في لبنان، لا نتهرَّب من قدرنا في المقاومة والمواجهة حتى الشهادة”.
السوريون هم أكثر الشعوب العربية احتكاكاً بالاحتلال الإيراني، المدعوم روسياً. والفلسطينيون
“إنها قضية جيوسياسية ثقافية، دينية، روحية، ثقيلة على أكتاف ديانة إبراهيمية واحدة”
هم أكثر الشعوب العربية احتكاكاً بالاحتلال الإسرائيلي، المدعوم أميركياً، المضبوط روسياً. وخلفهما شعوب عربية أخذت نصيبا وافراً من الأجنبي، ومن دعمه ما تسمى “أنظمتنا”. الأولويات تختلط بين الشعبين، وتتعقد. والفراغ يعمّر دنياهم؛ فراغ الغضب، والتظاهر والبوستات. يكبر هذا الفراغ كلما صُبَّ بباطون الصراخ… وسط هذا الفراغ، كيف يمكن للشعبين، أصحاب القضايا المختلفة، أن يتحولوا إلى أصحاب قضية واحدة؟ لا أولويات تتنافس في ما بينها؟ ما هو الجهد المطلوب لبلوغ هذه الغاية.. بعد “فلسْطنة” السوريين، وتحويلهم إلى شعب منكوب؟
وفي خضم هذا الغضب، نسينا أن القدس ليست إسلامية فقط، إنما مسيحية، قبل أن تكون إسلامية بستة قرون. على تلالها، حمل السيد المسيح صليبه، وكانت جلْجلته، وفيها دُفن، وبُعث من جديد. فاحتوت كنيسة القيامة على ضريحه. وربما “التوجهات” الإعلامية الغربية أسقطتها تماما عن أجندتها، فحذوْنا حذوها. وسط غبار الصراخ، لم ننتبه أيضاً إلى أن كنسية القيامة، أي القدس، كانت هدفاً للحملات الصليبية، بدءاً من القرن الثاني عشر؛ وكان شعارها “تحرير قبر يسوع”. وإن نزاعاً نشبَ بين روسيا الأرثوذكسية وفرنسا الكاثوليكية في القرن التاسع عشر، حول القدس، فاشتعلت بينهما حرب، في شبه جزيرة القرم. في مسألة القدس تحديداً، ليست القيادة الإسلامية مثمرة، ولا موثوقة. إنها قضية جيوسياسية ثقافية، دينية، روحية، ثقيلة على أكتاف ديانة إبراهيمية واحدة. مسجد الأقصى ليس، في قلب المسيحي المؤمن، شرقيا أو غربيا، أعزّ من كنيسة القيامة. القداسة تتساوى بين الرمزين بالديانتين. والسؤال البديهي: لماذا لا ينهض المسيحيون من أجلها؟ ما هي الكوابح الثقافية- الدينية الحائلة دون ذلك؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2017
العربي الجديد
هكذا كان وهكذا سيكون/ إلياس خوري
الرهان الأمريكي ـ الإسرائيلي هو أن الاحتجاج الذي اجتاح مدن فلسطين وبعض المدن العربية، في إثر إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، هو مجرد رد فعل عاطفي سرعان ما يتبدد. وقد بدأ الأمريكيون محاولة ذر الرماد في الأعين عبر تصريحات تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي في باريس، عن أن نقل السفارة سيستغرق وقتًا، كما أن الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد مسألة حدود مدينة القدس الإسرائيلية!
يجب أخذ هذا الرهان بجدية، فالأمريكيون والإسرائيليون يراهنون على الضعف العربي من جهة، والصراع السعودي ـ الايراني من جهة ثانية، وهما مسألتان قادرتان على عزل الاحتجاج الفلسطيني وإطفاء جذوته مع الوقت، خصوصًا أن هذا الاحتجاج لا يرفع مطالب ملموسة تبني إطاره الثابت.
الفلسطينيون يعيشون ردة فعل عاطفية، والعاطفة لا تقدم سوى «فشة خلق» آنية، وليست إطارا صالحًا يمكن البناء عليه. فالوضع الراهن في مناطق السلطتين الفلسطينيتين، قادر على استيعاب الغضب الشعبي وتنفيسه. ومثلما بقيت انتفاضة السكاكين خارج همّ السلطة، ما سمح لإسرائيل بإطفائها، فإن الغضب الشعبي من أجل القدس، قد يجري التحايل عليه ووأده.
والتحايل له وجهان:
الأول؛ هو شراء الوهم الأمريكي مرة أخرى والدعوة إلى انتظار مشروع ترامب وصفقة القرن الموعودة، وحجة أصحاب هذا الرأي هي أن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، يسمح للإدارة الأمريكية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل العودة إلى المفاوضات، والقبول بحل الدولتين!
الثاني؛ هو الغرق في جدال لا معنى له حول ضرورة حل السلطة الفلسطينية الآن. هذا الجدال سيقود إلى نتيجة واحدة، هي ارتفاع وتيرة تخويف الفلسطينيين من الفوضى التي ستعم بعد حل السلطة، ما سيقود إلى واقع من التفكك سيسمح لإسرائيل بالتلاعب بحرب أهلية فلسطينية مدمرة.
النقاش يجب أن يدور خارج هذين الافتراضين، يتمثل في رفض شراء الوقت الذي تعرضه أمريكا على الفلسطينيين اليوم، والبدء في مسار نضال جديد، شعاره هو الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس بلا قيد ولا شرط، وهذا يعني تفكيك المستعمرات الإسرائيلية بشكل كامل. وهذا الشعار لا يكتمل إلا عبر ربطه بشعار المساواة ورفض دولة الأبارتهايد الإسرائيلية.
أما قضية بقاء السلطة أو حلها أو إنشاء سلطة شعبية بديلة، فهي مسألة يجب أن تترك للنضال الفلسطيني الجديد كي يبلور معالمها.
يقودنا هذا الطرح إلى البحث في كيفية تحويل هبة الغضب المقدسية إلى مسار مستمر وطويل النّفَس. لا أريد استخدام تعبير انتفاضة ثالثة، برغم أنه تعبير ملائم، فالانتفاضة هي فعل بداية جديدة وليست تكرارا لما سبقها.
في البداية يجب تأكيد أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ليس مطلوبا الآن لأنه يهدد بتحويل الهبة الشعبية إلى حرب غير متكافئة، هذا لا يعني أن الصواريخ والأعمال الفدائية يجب طي صفحتها بشكل نهائي.
أن لا يكون العمل المسلح مطلوبا اليوم، لا يعني أنه لن يكون مطلوبا في المستقبل.
ما العمل إذا؟
في شهر كانون الثاني/ يناير 2013 قامت مجموعة من مناضلات ومناضلي اللجان الشعبية الفلسطينية باحتلال قطعة أرض في منطقة E1، وهي منطقة قررت إسرائيل مصادرتها من أجل الاستيطان. بنىـ الشابات والشبان فوق هذه الأرض قرية من الخيام أطلقوا عليها اسم قرية باب الشمس. وللذين لا يعرفون أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية المطلة على القدس، نشير الى أن بناء مستعمرات في هذه المنطقة، سوف يعني اتمام العزل الكامل للمدينة عن الضفة الغربية. ومع استيطان هذه المنطقة المحاذية لمستعمرة معاليه ادوميم، تكون إسرائيل قد سيطرت على القدس بشكل كامل، كما تكون قد شطرت الضفة الى نصفين.
يومها بدا العمل الذي قامت به اللجان الشعبية طليعيًا، ومحاولة «أدبية» من أجل ملامسة الحلم، لكن هذا العمل حمل بذور نقل موضوع المقاومة الشعبية من ردّات الأفعال إلى الفعل المباشر.
مبادرة باب الشمس أجهضت يومها، لأنها كانت تشكل عقبة أمام استراتيجية التفاوض من أجل التفاوض ونيل الرضا الأمريكي التي كانت تتّبعها السلطة.
أثبت التفاوض والانتظار، بعد القرار الترامبي، أنه لا يجدي، كما أن انتظار الدعم العربي كان وهمًا، ولم يقد إلا الى تآكل القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي صار كرة تتقاذفها أقدام الصراعات الإقليمية.
الغضب الشعبي مؤهل بأن يتحول إلى انتفاضة كبرى تعيد تأكيد القرار الوطني المستقل، شرط أن يمتلك طليعة مبادرة ومستعدة للنضال بنَفَس طويل من أجل بناء لحظة اشتباك يومي مع جيش الاحتلال. القيام باحتلال المناطق المهددة بالاستيطان والثبات فيها والصمود السلمي أمام آلة الاحتلال الوحشية، وهو أحد الخيارات الممكنة، التي ستعلن أن شرارة الهبة الشعبية الفلسطينية لن تنطفئ، وأن فلسطين تستعد لبناء ثورة حريتها من جديد.
أعلم أن المناضلين الفلسطينيين قادرون على تشكيل قيادة موحدة تتجاوز الفصائلية وتكون مهمتها بناء قرى فلسطينية للمقاومة على الأراضي المهددة بالاستيطان، وأن هذه القرى الرمزية قادرة على إبقاء جذوة الهبة الشعبية مشتعلة.
إن الانتقال من هبة شعبية إلى انتفاضة شاملة ليس مستحيلا، وهذا ممكن، شرط أن تستوعب الطليعة الثورية أن مهمتها ليست تكرار تجربتيها في الانتفاضتين السابقتين، بل بناء أطر جديدة تقطع مع الجو الاستسلامي من جهة، وتخلق مناخات المواجهة اليومية مع الاحتلال من جهة ثانية.
النضال الفلسطيني يحتاج إلى تجديد جذري في لغته وأطره، وهذا ممكن اليوم، لأنه سيكون تتويجا لثلاث لحظات:
انتفاضة السكاكين المجهضة، وهبة الأقصى في مواجهة البوابات الإلكترونية، واستعادة لغة الاشتباك التي تعمدت بدماء باسل الأعرج.
تخيّلوا معي قرى للحرية تنبت كل يوم وتشتبك مع الاحتلال وتصمد ثم تهدم وتبنى من جديد، وتواكبها حالة استنفار شعبية يومية، ومظاهرات، وأنشطة مختلفة تقودها لجان شعبية.
هذا مجرد اقتراح، وأنا متأكد من أن المخيلة الشعبية قادرة على استنباط عشرات الاقتراحات التي يستعيد من خلالها الفلسطينيات والفلسطينيون إرادتهم وحقهم في مقاومة الاحتلال.
وحدها المقاومة تستطيع إخراج فلسطين من الاحتلال والانحلال.
هكذا كان وهكذا سيكون.
القدس العربي
موسم القدس الذي لا يُفوّت/ حازم صاغية
غريب أن يدين الممانعون الأكثر راديكاليّة إعلان دونالد ترامب الأخير. فهم، كما يُفترض، لا يعترفون بوجود إسرائيل نفسه، ويرفضون بشدّة كلّ مصالحة معها. إنّهم لا يقرّون بها، وبأن تكون لها أصلاً عاصمة، سيّان أكانت تلّ أبيب أو القدس أو أيّ مكان آخر.
في المقابل، من يعترض على نقل السفارة إلى القدس يقول ضمناً إنّه يعترف بوجود دولة إسرائيل ويريد أن تنشأ إلى جانبها دولة فلسطين. إنّه يدين احتلال 1967 وتشريعه وجعل القدس عاصمة له. بالنسبة إلى المعترض هذا، هناك إقرار بإسرائيل وعاصمتها تلّ أبيب، وبنهائيّة ما حصل في 15 أيّار (مايو) 1948. هناك انسجام مع القرارات الدوليّة ومطالبة بتطبيقها.
الممانعون الأشدّ راديكاليّة، لو كانوا منسجمين مع أنفسهم لما رأوا في القرار الأميركيّ الأخير أيّ حدث جديد يستحقّ الإدانة والهيجان. تبعاً لموقعهم الفكريّ، الحدث الوحيد الذي يستحقّ هذه التسمية هو قيام إسرائيل في 1948. النقيض التاريخيّ لهذا الحدث ليس سوى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. هذا هو المنطق المتماسك والصادق لممانع راديكاليّ.
لماذا إذاً غضب هؤلاء وصخبوا؟
أغلب الظنّ أنّهم وجدوا فرصة لإحداث الغضب والسخط، وللظهور بمظهر الغاضب والصاخب، وفرصة كهذه ينبغي ألّا تُفوّت. ذاك أنّ كلّ استقرار ملعون، وكلّ احتكام إلى السياسة بشع، وكلّ رفع لدرجة التعبئة والاستقطاب محمود ومطلوب. يصحّ هذا في أيّ زمان وأيّ مكان.
وهم أيضاً وجدوا في حماقة دونالد ترامب فرصة أخرى: شتم أميركا وسياستها من جهة، وإحراج خصومهم المحليّين والإقليميّين، لا سيّما سلطة رام الله، من جهة أخرى. هذان أيضاً هدفان لا يُفوّتان.
هذه الأهداف تشبه، بطبيعتها السلبيّة، جوهر السياسة الإيرانيّة في المنطقة: حدّ أقصى من المشكلات وحدّ أدنى من الحلول. مُصغّر هذا النهج وتمثيله، ما عبّر عنه السيّد قيس الخزعلي في زيارته الفوريّة إلى الحدود اللبنانيّة – الإسرائيليّة. الاستثمار في تلك الأهداف جاء مباشراً وصريحاً من جانب «حزب الله» و «عصائب أهل الحقّ» التي قد «تستعيد» قرية في العراق أو في سوريّة. أمّا القدس!
ولأنّ لا معنى يتعدّى الصخب والضجيج في حركة الممانعين الراديكاليّين، ولأنّ قضيّتهم مزغولة من أساسها، حقّ للسيّد جبران باسيل، في خطابه في مؤتمر وزراء الخارجيّة العرب، أن يستثمر فيها أيضاً استثماراً مباشراً. الزميل مهنّد الحاج علي بدا له الموقف الرسميّ اللبنانيّ، في ضوء خطاب باسيل، «أقرب إلى حركة الجهاد الإسلاميّ الملتزمة بالكفاح المسلّح نهجاً أبديّاً». ولم لا؟ لقد تحدّث رئيس الديبلوماسيّة اللبنانيّة، على طريقة «البهورة» اللبنانيّة التي يلخّصها الشعار التافه «لا أحد يزايد علينا». إنّه التجسيد الصريح لذاك الفارق الكبير بين الموقف من «قضيّة فلسطين المقدّسة» والموقف من الفلسطينيّين في لبنان. وهذا موسم للمزايدات والمناقصات لا يُفوّت.
الحياة
قرار ترمب بشأن القدس وعواقبه/ ريتشارد ن. هاس
بعد مرور 50 عاما على الحرب التي دامت ستة أيام (يوينو/حزيران 1967)، ما زالت تداعيات هذه الحرب تحدد مستقبل الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية. فقد انجلت عن احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة والقدس، بالإضافة إلى شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان.
وفي ذلك الوقت، ظن العالم أن هذه النتيجة العسكرية مؤقتة. وقد اعتُمد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، وهو القرار الذي كان يُعد خلفية للحل الدبلوماسي لمشكلة الفلسطينيين الذين “لا دولة لهم”، بعد خمسة أشهر من انتهاء الحرب. ولكن، كما هو الحال في كثير من الأحيان، ما بدأ بشكل مؤقت قد استمر.
وبذلك قد أعلن الرئيس دونالد ترمب مؤخرا عن قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة لم تتخذ موقفا حول الوضع النهائي للقدس بما في ذلك “الحدود المُعينة للسيادة الإسرائيلية” هناك. وأوضح الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستؤيد حلا يُرضي الدولتين إذا وافق عليه الطرفان. وقد اختار عدم البدء في نقل السفارة الأميركية من تل أبيب، على الرغم أنه كان بإمكانه إعادة تسمية القنصلية الأميركية في القدس.
إن محاولة تغيير سياسة الولايات المتحدة لم تقنع الكثيرين. استبشر معظم الإسرائيليين خيرا بالموقف الأميركي الجديد، لكن معظم الناس في العالم العربي وخارجه أصيبوا بخيبة أمل وإحباط.
لماذا اختار ترمب هذه الفترة لإقرار هذا الإعلان؟ إنها مسألة تخمين فقط ؟ أشار الرئيس إلى أن ذلك كان مجرد اعتراف بالواقع وأن فشل سياسة أسلافه في القيام بذلك لم يحقق أي مزايا دبلوماسية. هذا صحيح، على الرغم من أن سبب فشل الدبلوماسية على مدى عقود لم يكن له علاقة بالسياسة الأميركية تجاه القدس، بل كان له علاقة بالانقسامات بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتباينات في المواقف بين الجانبين.
وقد نسب آخرون الإعلان الأميركي إلى السياسة الداخلية الأميركية، وهو استنتاج يؤيده فشل الولايات المتحدة في المطالبة بأي شيء من إسرائيل (على سبيل المثال، وقف بناء المستوطنات) أو تقديم أي شيء للفلسطينيين (على سبيل المثال، دعم مطالبتهم بتحرير القدس). وعلى الرغم من أن القرار قد أثار العديد من ردود الفعل العنيفة، فإنه يعتبر فرصة ضائعة أكثر من الأزمة التي خلقها.
لقد أثار هذا البيان الكثير من الجدل، وقد تكون له عواقب وخيمة، والدليل على ذلك أن إدارة ترمب قد أمضت جزءا كبيرا من سنتها الأولى باحثة عن خطة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد يؤدي هذا الإعلان إلى إضعاف إمكانيات هذه الخطة المحدودة أصلا.
ويبدو أن إدارة ترمب ترغب في إعطاء دول أخرى، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، دورا محوريا في صنع السلام. إن هذا النهج يدل على الرأي القائل بأن السعودية والحكومات العربية الأخرى أكثر اهتماما بتهديد إيران من أي شيء له علاقة مع إسرائيل. ونتيجة لذلك، فهم مستعدون لوضع عدائهم الطويل الأمد تجاه إسرائيل جانبا، وهي دولة تشاطرها إلى حد كبير نفس وجهة النظر إزاء إيران.
ومن شأن إحراز تقدم في القضية الإسرائيلية الفلسطينية أن يخلق سياقا سياسيا في البلدان العربية يسمح لها بالقيام بذلك. إن الأمل في إدارة ترمب يكمن في استخدام السعوديين لمواردهم المالية لإقناع الفلسطينيين بالموافقة على تحقيق السلام مع إسرائيل حسب شروط ستقبلها إسرائيل.
والمشكلة هي أن الخطة الوحيدة التي من المرجح أن توافق عليها الحكومة الإسرائيلية ستقدم للفلسطينيين أقل بكثير مما طالبوا به تاريخيا. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يقرر القادة الفلسطينيون رفض التوقيع على خطة ستعمل على إحباط الكثيرين من شعبهم وتركهم عرضة لحركة حماس وجماعات “متطرفة” أخرى.
قد يكون السعوديون مترددون في اشتراكهم في خطة يعتبرها الكثيرون بمثابة خيانة. وتتمثل الأولوية القصوى للقيادة السعودية الجديدة، بزعامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز السلطة وذلك من خلال الجهود التي يقوم به الأمير لمحاربة الفساد في المملكة وإتباع سياسة خارجية وطنية معادية لإيران.
ولكن لا يسير أي تكتيك منهما وفقا للخطة. وتتعرض جهود مكافحة الفساد، رغم أنها شعبية حتى الآن، لخطر التشويه من خلال ملاحقة انتقائية للجناة (مما يوحي بأن المسألة تتعلق بالسلطة أكثر من الإصلاح) وتقارير عن نمط الحياة الخاصة لولي العهد. وأصبح من غير الممكن فصل الجهود المناهضة لإيران عن الحرب في اليمن والحرج الدبلوماسي في لبنان وقطر. وفي الوقت نفسه، أثبتت الخطط الطموحة لإصلاح البلاد أنها سهلة التصميم لكن صعبة التنفيذ، ومن المؤكد أنها ستبعد العناصر الأكثر تحفظا.
إن مشكلة ترمب وجاريد كوشنر، صهره الذي يقود السياسة الأميركية في هذه المنطقة، هي أنه من المرجح أن تثبت السعودية أنها ليست شريكا دبلوماسيا قويا عكس ما كان يعتقد البيت الأبيض. وإذا كان ولي العهد الجديد قلقا إزاء وضعه السياسي الداخلي فاٍنه سيتردد في الوقوف جنبا إلى جنب مع رئيس أميركي يعتبره قريبا جدا من إسرائيل التي ترفض تلبية المطالب الفلسطينية البسيطة لإقامة دولة.
كل ذلك يعيدنا إلى قضية القدس. قال ترمب إن الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل “خطوة طال انتظارها لدفع عملية السلام إلى الأمام والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق دائم”. ويبدو أن المزيد من الإجراءات ستظهر أن إعلان ترمب سيكون له تأثير معاكس.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2017
ترامب حين يطيح «الصفقة الكبرى» و… إستراتيجيته!/ جورج سمعان
قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تحول كبير في السياسة الأميركية. الخطوة خالفت قرارات دولية، خصوصاً القرارين 242 و338 اللذين يعتبران الأراضي التي احتلتها الدولة العبرية عام 1967 وبينها القدس الشرقية أراضي محتلة. وشكلت خروجاً غير مألوف على النهج الديبلوماسي الذي اعتمدته واشنطن طوال عقود. كان العالم ينتظر عناوين «الصفقة الكبرى» التي عمل لها الفريق الخاص للرئيس نحو ثمانية أشهر. وكان ترامب وعد بأنه سيكون الرئيس الذي سيرسي السلام، وأنه يعتقد بامتلاكه القدرة على القيام بذلك. لكنه بعد تبنيه موقف بنيامين نتانياهو واليمين المتطرف، لن يكون بمقدوره أن يقدم نفسه وسيطاً عادلاً أو نزيهاً وصادقاً. ولن يكون بإمكانه أن يقنع الفلسطينيين والعرب بالاتفاق الذي يعد لإرساء السلام، أياً كان هذا الاتفاق. بالطبع لم يكن أحد يعتقد بأنه سينحاز إلى الموقف العربي بخلاف ما كان عليه جميع من سبقوه إلى البيت الأبيض، منذ نشوء الدولة العبرية. ولم يكن أحد يعتقد أصلاً بأن الولايات المتحدة وسيط محايد ونزيه. جل ما في الأمر أنها تمتلك 99 في المئة من أوراق الحل، على ما كان يقول الرئيس الراحل أنور السادات. أي أنها ربما وحدها تمتلك القدرة على إقناع تل أبيب وحتى الضغط عليها عند الحاجة. لكنها لم تفعل ذلك. بل كانت ولا تزال توفر لها كل أنواع الدعم الاقتصادي والعسكري لتحفظ لها مرتبة التفوق. وكانت ولا تزال إحدى ركائز إستراتيجيتها في الشرق الأوسط، بل في مقدم بقية المصالح القومية الأميركية من الطاقة وغيرها.
كان الجميع ينتظر أن تطرح إدارة ترامب مشروعها للسلام، بعدما رزع المنطقة ذهاباً وغياباً، فريقه المؤلف من صهره جاريد كوشنير ومبعوثه جيسون غرينبلات وسفيره إلى تل أبيب ديفيد فريدمان. وعقد هؤلاء لقاءات طويلة مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وأطراف عربية أخرى معنية بالتسوية. ذلك أن الإدارة الأميركية رأت وجوب إشراك أكبر قدر من القوى في المنطقة من أجل توفير غطاء لما ستقدم عليه، أو لما ستقدمه السلطة من تنازلات لا بد منها لتمرير الاتفاق المنتظر. وذكرت «نيويورك تايمز» قبل بضعة أيام أن الإدارة تضع العناوين العريضة لهذا الاتفاق. وتوقعت أن يتخذ البيت الأبيض خطوات عملية ويدرس مواقف من القضايا الجوهرية للصراع. ولم يكن أحد يتوقع أن يلجأ الرئيس ترامب إلى مثل هذا القرار الكبير، خصوصاً أنه هدد بإقفال مكتب التمثيل الفلسطيني لكنه أرجأ الأمر. وساد الاعتقاد بأن تهديده نوع من ممارسة ضغوط على السلطة التي بدا واضحاً أنها لم تكن في وارد الموافقة على جملة من تفاصيل مشروع الاتفاق التي قدمت إليها، خصوصاً في ما يتعلق بمستقبل القدس الشرقية التي لم يشر إليها القرار الرئاسي الأميركي. وقد حاول المسؤولون الأميركيون تهدئة الأصوات العربية والإسلامية والدولية الغاضبة التي دانت موقف ترامب بالقول إن بلادهم «لم تتخذ موقفاً من حدود القدس ولا تدعم أي تغييرات على الترتيبات المتعلقة بالأماكن المقدسة»، على حد ما صرحت به المندوبة إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي. وترامب نفسه أوضح أن الحدود سيتم تحديدها بناء على التفاوض بين الجانبين مع الاحتفاظ بالوضع القائم في الأماكن المقدسة. لكن هذه المواقف تظل بلا معنى ما دام أن كل الإدارات الأميركية كانت تعترض قولاً على الاستيطان سواء في القدس أو الضفة، لكنها لم تفعل شيئاً لوقفه، على رغم اعترافها بأنه عقبة أساس بوجه أي تسوية!
منح القرار المستوطنين دعماً لم يكونوا يحلمون به. فهم يرون إلى ذاك الاعتراف، كما يخشى كثيرون، بوصفه ينتهي بجعل القدس عاصمة لإسرائيل، شاملاً المدينة كلها. عندها كيف يمكن الرئيس ترامب أن يتوقع امكان تسويق أي اتفاق سواء في أوساط الفلسطينيين أو العرب والمسلمين، فضلاً عن أن القانون الدولي يعتبر المدينة محتلة. أبعد من ذلك إن هذا الاعتراف طاول مصير القضية الكبرى في الصراع، في حين أن ثلاثة عقود من المفاوضات المتقطعة لم تتوصل إلى حل قضايا أقل أهمية. لقد وجه الرئيس ترامب ضربة قاسية إلى الصفقة التي كان يروج لها فريقه. مثلما طوى صفحة طويلة من الديبلوماسية الأميركية المتأنية، وإن على انحياز إلى جانب إسرائيل. سقطت ورقة التين التي كانت إلى الآن تغطي الموقف الأميركي الحقيقي. ولم تعد الولايات المتحدة وسيطاً مقبولاً أو نزيهاً أو مؤهلاً لأداء دور يؤتمن على القرارات الدولية. بالطبع يسهل القول إن الرئيس وفريقه المعني بحل الصراع كشفا حقيقة موقفهما العقائدي المؤيد للدولة العبرية. ويسهل القول إن هذا الفريق ليس متمرساً ولا يعرف دقائق الصراع وتفاصيله وتاريخه… وإلا لما صدر مثل هذا الاعتراف المفاجأة. فهل تخلى سيد البيت الأبيض عن مشروعه للسلام نتيجة تعقيدات وعقبات ويريد تحميل الفلسطينيين المسؤولية ومعاقبتهم تالياً؟
لا شيء يوحي حتى الآن بأن الرئيس ترامب قد تخلى عن مشروعه لإتفاق سلام. ولعله يعتقد بأن الظروف تسمح له بفرض صفقة كبيرة. وبأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيخلف ضغوطاً نفسية وسياسية على السلطة ويرغمها ربما على تقديم تنازلات. ويمكن والحال هذه وصف هذه الخطوة بأنها ابتزاز للفلسطينيين، بعدما تراجعت قضيتهم في العقد الأخير إلى آخر سلم اهتمامات العالم العربي للأسباب المعروفة. ولا يبقى أي شيء من الصدقية لتصريحات كوشنير بأن الإدارة تعمل على حل يأتي من المنطقة وليس مفروضاً. قرار ترامب عملية فرض قسري، ما دام أنه ينحاز صراحة إلى الجانب الإسرائيلي من دون مراعاة لما تمثل المدينة من رمزية تاريخية ودينية لمئات الملايين من البشر. ومن دون الاهتمام باستقرار دول عربية حليفة تقيم بين حدين متقابلين لا يرحمان، لكنها لا يمكن أن تسكت عن تجاوزه المحظور في كل السياسات الدولية.
الحقيقة أن الأوضاع التي يجتازها العالم العربي سهلت على الرئيس ترامب اتخاذ مثل هذا القرار الذي تحاشاه الرؤساء السابقون. ولا حاجة إلى ذكر ما يعانيه عدد من الدول العربية من حروب ومآسٍ وويلات جعلت كل دولة بل كل مكون في هذه الدولة أو تلك ينشغل بمصيره ومستقبله. فضلاً عن تهاوي النظام الإقليمي وتسابق دول الجوار إلى التمدد والسيطرة والهيمنة، وتأجج الصراع المذهبي. كلها عوامل أضعفت جامعتهم والحد الأدنى من التضامن وأسباب القوة والأمن القومي عموماً. انهارت جيوش وانشغلت أخرى بمحاربة حركات الإرهاب. ولا جدال في أن إسرائيل كانت المستفيد الأكبر من مشهد الخراب الذي يعم الإقليم، ومن تهاوي الدول الوطنية. ولكن على رغم كل هذه الظروف التي أتاحت لترامب أن يتباهى بأنه نفذ وعداً من وعوده الانتخابية، بينما أسلافه الثلاثة تقاعسوا ونكثوا بوعودهم، فإن المساس بوضع القدس ألّب العالم على قراره. فلا تزال المدينة رمزاً جامعاً للعالمين العربي والإسلامي وللعالم المسيحي أيضاً. وهو بهذا القرار المتهور لم يعتبر من الماضي القريب جداً عندما هبّ العالم بوجه نتانياهو ودفعه إلى التراجع عن زرع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى. ولا يمكن ترامب، مهما بدت حاجة الفلسطينيين إلى دور أميركا، أو بالأحرى بدوا عاجزين عن مواجهتها، أن يبدل بقراره هوية المدينة المحتلة، أو أن يفرض وقائع جديدة على الأرض. لقد جازف بوضع المصالح الأميركية في دائرة الخطر والاستهداف. وصب مزيداً من الزيت على النيران المشتعلة في الإقليم. لم يسقط صدقية بلاده فحسب، بل أسقط كل العناوين الإستراتيجية التي نادى بها منذ دخوله البيت الأبيض ولم يكمل بعد عامه الأول. رفع محاربة الإرهاب ومواجهة إيران أولوية الأولويات. ويخشى كثيرون أن يؤجج الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مشاعر المتشددين إذا كان كل العالم الإسلامي تنادى إلى المواجهة. ودعا إمام الأزهر إلى انتفاضة ثالثة في الأراضي المحتلة. في حين أن طهران التي طالما اتهمها خصومها بأنه تتوكأ على القضية الفلسطينية ومعاداة أميركا وإسرائيل سترفع سقف خطابها السياسي ولغة التهديد والوعيد لتقول إنها كانت على حق في مواجهة المشروع الأميركي – الإسرائيلي.
والحقيقة أيضاً أن الرئيس ترامب يقفز إلى الخارج قفزات بهلوانية كلما اقترب طوق القضاء الذي يواصل النظر في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، من عنقه. وهو بهذا القرار لا يحوّل الأنظار نحو القضية الكبرى في الصراع العربي- الإسرائيلي فحسب بل يحاول أيضاً تقديم طوق نجاة إلى نتانياهو المتهم بقضايا فساد. ويأمل الرئيس الأميركي بأن يبادله رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتحرك في أوساط اليهود الأميركيين لعله يساعد في الخلاص من التحقيقات التي دخلت داره وتطاول أهل بيته ومساعديه.
الحياة
القدس العربية حكاية أمويّة… فزنكيّة… فمهدويّة؟/ وسام سعادة
القدس العربية هي في الأساس حكاية أموية. اختارها معاوية ابن ابي سفيان كي يبايع له بالخلافة والملك في تموز/يوليو 661 ميلادية. بويع على «جبل الهيكل»، في المكان الذي سيشمل بعد ذلك بـ»الحرم القدسي»، ثم كانت له زيارة إلى كنيسة القيامة وقبر مريم. أغلب الظن أنه اتبع سياسة دينية تأليفية بين مشارب الإبراهيمية المختلفة. والأهمّ: كان يمنّي النفس بالفتح الاعظم في زمانه: القسطنطينية. رؤية ابنه يتوج امبراطوراً عليها. ما كان لتوريث العرش من تسويغ الا بهذا. وعلى هذا الاساس سارت العرب لفرض الحصار الاول على القسطنطينية، في حملة 674-678. فشلها هو الذي أدى إلى القطع النهائي بين الإسلام المبكر وبين المسيحية، وصيرورتهما ديانتين مستقلتين عن بعضهما البعض.
أسند الأمويّون مشروعية ملكهم على تعظيم بيت المقدس. ظلّ خلفاؤهم يبحثون إحتمال إتخاذها عاصمة. تعظيمهم لها كان خياراً نقيضاً لما فعله الإمبراطور جوستنيانوس في القرن الذي سبق، حين أنهى فترة من المداولات البيزنطية حول إعادة بناء هيكل سليمان، وقرّر، في سياق سياسة قمعية له ضدّ اليهود تبتغي تنصيرهم بالقوة، أن يبني بديلاً عن الهيكل في القسطنطينية، وليس في القدس، من خلال كنيسة «أيا صوفيا»، وأنّ يهمّش تماماً الموقع المشار إليه تقليدياً على أنّه «جبل الهيكل» في القدس، التي كان الرومان قد دمّروها في سياق «حروب اليهود»، وبنوا مدينة بديلة في مكانها تدعى «ايليا كابيتولينا».
وقبل صعود نجم الأمويين، كانت القدس مسرحاً لهذه الحرب الأهلية المشرقية الكبرى التي دارت في سياق المواجهة الحربية الشاملة بين الفرس الساسانيين وبين الروم 602-628.
القدس التي أهملها البيزنطيون، مع جوستنيانوس، تحوّلت إلى أبرز عناوين الحرب الدينية في ذلك الوقت، وكانت بين مسيحيات مختلفة قبل كل شيء آخر، ذلك أنّ المسيحية النسطورية كانت في طريقها إلى أن تتحول إلى ديانة البلاط الساساني، وكانت زوجة الشاهنشاه خوسرو الثاني نفسها، شيرين، مسيحية نسطورية. مع هذا، استعان القائد الساساني شاهربراز، النسطوري هو أيضاً، بيهود طبرية لإحتلال القدس عام 614، وقام نوع من الحكم الإحيائي اليهودي عليها، بقيادة نحميا بن هوشيل، لثلاث سنوات، قبل أن يقرّر الفرس أنفسهم بعثرة هذه التجربة عام 617، وتسليم القدس تماماً للنساطرة، والتخلص من نحميا، الذي كان يعتبر بين أتباعه بمثابة المخلّص، و»المشيحا بن يوسف».
وحين تمكّن الروم من الساسانيين في خاتمة هذه الحرب الكبرى، وخرّبوا عاصمتهم على دجلة، المدائن (تقريباً بغداد حالياً)، استعادوا بيت المقدس، وأعادوا إليها ذخائر المسيح، ومنع اليهود من الدخول إلى المدينة، واستمرّت هذه الحال لسنوات معدودات، ذلك أنّه، وبخلاف المتداول من نماذج لـ»العهدة العمرية» فقد تمكّن اليهود من إعادة الإقامة في القدس، وفي محاذاة للحرم القدسي، بل ظلّ بإمكانهم مشاركة المسلمين في الصلاة ضمن هذا الحرم، طيلة الفترة الأموية الأولى، إلى أن منع ذلك الخليفة عمر بن عبد العزيز عام 720، فاستعاضوا عن ذلك بالأسوار الخارجية للحرم، وخصوصاً الحائط الغربي، و»كنيس المغارة».
لم تكن الحال كذلك في بدايات العصر الأموي، يوم كان الإسلام المبكر لم يقطع تماماً بعد مع الديانتين الإبراهيميتين الأخريين، بل يطرح نفسه كتجديد يشملهما. حرص معاوية الذي أحاط نفسه بمستشارين مسيحيين أن لا يسمع للمسيحيين حين كانوا يستعدونه على اليهود، أو لليهود حين كانوا يستعدونه على المسيحيين.
الأمر سيتبدّل مع فشل الحملة الأموية الأولى لفتح القسطنطينية. أدّى فشلها للإنكفاء، والإصرار مع ذلك على التوريث ليزيد، رغم عدم تحقق الانجاز الذي على اساسه كان يفترض التوريث: تتويجه في بيزنطية. بعد عامين من فشل هذه الحملة، حصل التوريث، من دون شرطه السابق (صيرورة السلالة الاموية سيدة على الامبراطورية الرومانية، التي نسميها بيزنطية). أدى حصوله بهذا الشكل الى تراجع الحكم الاموي، وانكفائه الى بلاد الشام، وصعود خلافة عبد الله ابن الزبير في المدينة، وسيطرة الزبيريين على معظم شبه الجزيرة العربية وأقسام من العراق وفارس، وحتى مصر، وكان كيانهم هذا الأوّل في سكّ قطع نقدية عليها ذكر اسم الرسول.
تهاوى السفيانيون في هذه المعمعة، وصعد المروانيون، المنفيون في الاساس من الحجاز الى الشام بسبب السيطرة الزبيرية. بخلاف الخطاب المزدوج دينياً للسفيانيين، قاد المروانيون الصراع مع الزبيريين على انه صراع على التركة المحمدية. سكوا هم ايضا المسكوكات التي عليها اسم محمد. لكنهم، في زمن لم تكن فيه الطريق الى مكة سالكة اخذوا يعظمون من شأن القدس، ويبنون مسجد قبة الصخرة، وينظمون الحج «المؤقت» اليها، بل ان المساجد التي بنيت في فترة عبد الملك بن مروان كانت وجهتها الى القدس وليس الى مكة، على ما كشفه الحفر الاركيولوجي، وفقا لما تذكرنا به فرنسواز ميشو في كتابها المرجعي عن «بدايات الإسلام». ومن القطع النقدية في زمن عبد الملك، واحدة عليها نقش «محمد رسول الله» مع رسم يفترض أنه للخليفة من جانب، ونقش عليه اسمي «ايليا» (الإسم الروماني للقدس، ايليا كابيتولينا، الذي اعتمده العرب لفترة)، وعلى يمينه اسم الولاية: فلسطين.
مع المروانيين صار الصراع دينيا مع الروم، وليس صراعا على مركز الامبراطورية كما كانت الحال مع معاوية. وهكذا، حين عادت العرب لحصار القسطنطينية عام 717، في زمن سليمان بن عبد الملك (الذي اختار هو أيضاً القدس لمبايعته)، وبجيش يقوده مسلمة بن عبد الملك، كانت الانتظارات في هذه المعركة دينية واخروية بامتياز، وآمن الروم بان ايقونة العذراء مريم هي التي أنقذتهم.
المسكوت عنه اليوم، إلى حد كبير، أنّه بعد سقوط خلافة بني أميّة في دمشق، تراجعت مكانة القدس في المخيال الإسلاميّ، بل تعامل العباسيّون معها بريبة وتشكيك من أن يكون وراءها «نوستالجيا أموية»، حالها في ذلك كحال دمشق. مع العباسيين، تطوّرت المؤسسة الفقهية الرسمية على قاعدة متحفظة ومحترزة تجاه الإهتمام التي استمرت بيت المقدس تحظى به في الإسلام الشعبي ولدى الصوفية، من خلال التقليد السرديّ المعروف بإسم «فضائل القدس» و»فضائل أهل الشام»، ويقوم في الأساس على عدد كبير من الأحاديث المروية عن النبي عن أهمية القدس ودمشق، وهي أحاديث كان يجري التعامل معها في كثير من الأحيان من جانب المؤسسة الفقهية الرسمية على أنّها من «الإسرائيليات».
التبدّل حدث مع غزوات الفرنجة، وليس مباشرة. بل بعد أقل من قرن بقليل على احتلالهم لها، يوم حظي استرجاع بيت المقدس بهالة دينية خلاصية، من داخل الإسلام السنّي، المقترن بالتصوّف بشكل واثق هذه المرة، من خلال نور الدين زنكي. فقط مع نور الدين استعادت القدس مكانتها الإرتكازية في الوعي الديني، التي كانت لها في العصر الأمويّ، والذي لعب العبّاسيون دوراً كبيراً في مواجهته.
ليس صحيحاً اليوم أننا في غنى عن إعادة السؤال عن تجديد المغزى الديني – الحضاريّ للقدس في المخيال العربي الإسلاميّ المعاصر. فالمقاربة «الوضعية – الناسوتية» لمسألتها تقوم على المكابرة إلى حد كبير، ومشكلتها توازي مشكلة اختزال كل شيء في البعد الديني. لكن المفارقة اليوم، أنّه في لحظة يقرّر فيها دونالد ترامب استفزاز مشاعر العرب والمسلمين إلى أبعد حد، في موضوع القدس، تنقسم المقاربات العربية، بين تلك المكتفية بالحيز الناسوتي «العلماني» للمسألة، أو المستثمرة في التوليفة «الإسلامية – المسيحية» (اثنان ضد ثالث)، وبين تلك المتمحورة حول معجزة الإسراء، في غفلة عن قدس معاوية وعبد الملك، وإلى حد ما عن قدس نور الدين زنكي.. يقابل ذلك إزدهار «مذهبي» للمرويات المهدوية التي نجدها في «كتاب الفتن» لنعيم بن حماد المروزي، عن «خروج المهدي من مكة إلى بيت المقدس»، وحول تحديد القدس بأنها المكان الذي سيتقاتل فيه المهدي والسفياني، «يؤتى بالسفياني أسيراً فيأمر به فيذبح على باب الرجة، ثم تباع نساؤهم على درج دمشق».
كاتب لبناني
القدس العربي
أين اختفت الدول العربية؟
أردوغان يقرأ خريطة الشرق الأوسط جيدا ويعرف أن القادة العرب لا يسارعون إلى الوقوف مع الفلسطينيين
صحف عبرية
في خطاب استمر نحو ستين دقيقة، ناشد أبو مازن قادة الدول العربية والإسلامية التجنّد للكفاح من أجل القدس ردًا على تصريح ترامب. وبمناسبة استغلال المنصة التي وضعها تحت تصرف الضيف، الرئيس التركي أردوغان، أغدق رئيس السلطة الفلسطينية على سامعيه (معظمهم لا يعرفون العربية على الإطلاق، وشوهد بعضهم في البث الحي والمباشر وهم منشغلون بأجهزتهم الخلوية) تنديدات ضد الولايات المتحدة. وأعلن أنه سيطلب من مجلس الأمن في الأمم المتحدة قرارا يُلغي تصريح ترامب وهدّد بأنه من دون القدس عاصمة فلسطين «لن يكون سلام في المنطقة ولن يكون سلام عالمي».
هل بالفعل؟ لِمَ كان أردوغان مطالبا باستضافة منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع طارئ في أعقاب التصريح الرئاسي؟ ليس هذا فقط، لأنه رئيس المنظمة. فأردوغان يقرأ خريطة الشرق الأوسط جيدًا، ويرى أن قادة الدول العربية لا يسارعون إلى الوقوف إلى يمين الفلسطينيين بشكل تلقائي. صحيح أنهم نددوا بالتصريح وأوضحوا أنه خطر، وأنهم لن يتنازلوا عن القدس، ولكن أردوغان، ويخيّل أن أبا مازن أيضا، يعرفان جيدا أن هذه ضريبة لفظية.
ولِمَ؟ لأن استعراضا خاطفا يبين الريح الجديدة التي تهب في غير قليل من الدول العربية. فالشرخ السنّي ـ الشيعي، القائم في المنطقة بشكل تقليدي وتعاظم في عصر الربيع العربي، وإلى جانبه تهديدات الجهاد العالمي بالمس بكل من لا يؤمن بطريقه، غيرا سلّم أولويات الدول الوطنية العربية. فهذه تسعى قبل كل شيء لتحقيق استقرارها السياسي الداخلي وبعد ذلك شق طريقها الكفاحي ضد الأعداء الخارجيين.
ليس مصادفة أن اقترح رئيس الأركان آيزنكوت على السعودية التعاون الاستخباري في المقابلة مع موقع الإنترنت السعودي قبل نحو شهر. وعلى أية حال، فهو يعرف أن له أذنًا صاغية في الرياض. أردوغان وأبو مازن يعرفان أيضا. وإذا لم يكن هذا بكافٍ، فإن وفدا من نحو 30 شخصا من البحرين يزور إسرائيل هذه الأيام ويحمل معه رسالة سلام من الحاكم القائم في العاصمة المنامة.
هذه بالطبع مجرد مؤشرات على التغيير الذي يجد تعبيره في الأشهر الأخيرة في التفكيرات المتجددة عن طبيعة العلاقات مع إسرائيل في عواصم عربية أخرى أيضا. هذا تعبير علني عن المزاج في دوائر في النظام والنخبة في عدد غير قليل من الدول العربية، والذي يسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية ولا يرى في حل المشكلة الفلسطينية شرطا ضروريا للتطبيع بالمعنى الدارج في الغرب.
كل من يشرح لِمَ لا تتجند الدول العربية التي تعانق الرئيس الفلسطيني على نحو متواصل، استضافة اجتماع طارئ تطلق فيه خطابات حماسية ضد الصهاينة. فما هو الحل المفضل؟ أردوغان يرتب الأمور. وهكذا فإن رئيس دولة ليست عربية يستضيف الاجتماع ورؤساء الدول العربية (باستثناء الملك عبدالله الأردني، الذي ألقى كلمة قصيرة) اكتفوا بإرسال مستوى متدن نسبيا إلى الاجتماع. كل هذا كي يقولوا من دون أن يصرحوا «فقراء مدينتي أولى».
إضافة إلى ذلك، فإن محاولات إثارة الخواطر على أساس ديني، في الوقت الذي يشدد فيه أبو مازن نفسه على أن هذا صراع على الأرض، ليس فيها ما يكفي كي يمس المصالح المتحققة بقدر غير قليل بفضل العلاقات الهادئة مع القدس أيضا.
محاضر في دائرة الشرق الأوسط في جامعة أريئيل وخبير في الشؤون العربية
غادي حيتمن*
معاريف 14/12/2017
القدس العربي،
القدس التي فقدناها قبل خمسين سنة (على الأقل)/ ناصر الرباط
بعد خمسين سنة من احتلالها بالكامل إثر حرب ١٩٦٧، اعترفت الولايات المتحدة الأميركية بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل. لم يكن في الأمر مفاجأة، بل هو تحصيل حاصل. فالولايات المتحدة لم تكف يوماً عن دعم إسرائيل وتبرير أفعالها وإجهاض أية محاولة لإدانتها في كل ما يخص قضمها لما احتلته قبل خمسين سنة مما تبقى من فلسطين في أيدي العرب وضمه لأراضيها وسلطتها السيادية والقانونية. وما كان تقاعس الولايات المتحدة عن الاعتراف بالقدس كلها عاصمة لإسرائيل إلا نوعاً من الديبلوماسية الفارغة ومحاولة للحفاظ على مهزلة السلام والتطبيع ودور الولايات المتحدة كوسيط محايد في هاتين العمليتين. وهي ليست كذلك طبعاً، والكل عارف ومدرك لهذا منذ مبادرة روجرز عام ١٩٧٠ حتى زيارات جاريد كوشنر الأخيرة للأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
كل ما احتاجه الأمر هو وصول رئيس جلف، تحريضي، عديم اللباقة، وأخرق، ذي صوت عال وجاذبية دعائية كدونالد ترامب لكي يوقف مهزلة عدم توقيع الرئيس على قرار النقل، كاعتراف بكون القدس عاصمة إسرائيل، والذي أصدره الكونغرس في تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٩٥، أي قبل إثنين وعشرين عاماً. كل ما أمكن الرؤساء الذين تعاقبوا على كرسي الرئاسة خلال هذه السنين فعله لحفظ ماء الوجه والتقيد بقرار الكونغرس الملزم هو تأجيل تطبيقه مدة ستة أشهر قابلة للتجديد بحجة عدم ملاءمته للسياسة الخارجية الأميركية، التي هي قانوناً من صلاحيات الرئيس، أي أن الحجة هي في تقرير مصادر السلطة وليس في عدم أخلاقية أو قانونية القرار نفسه.
العقدة إذن ليست في سياسة الولايات المتحدة، وهي مشرعة ومعروفة. بل العقدة هي في الحكومات العربية، والإسلامية أيضاً بما أنها كذلك مشاركة في المطالبة بإسلامية القدس إن لم يكن بعروبتها، وهي التي لم تفعل شيئاً يذكر لتغيير هذا الواقع على رغم مرور خمسين سنة على حصوله و٢٢ سنة على اعتراف الولايات المتحدة بوقوعه، أي أيضاً بواقعيته، على حد التعبير المحكم لزياد الرحباني.
خمسون سنة مرت على هزيمة 5 حزيران (يونيو) ومئة سنة على وعد بلفور وسبعون على إنشاء إسرائيل، والعرب ــ وليس الفلسطينيون فقط الذين وإن كانوا المتضررين الأول من مأساة فلسطين إلا أن القضية أكبر منهم وتخص العرب بمجملهم ــ ما زالوا لا يعرفون كيف يتعاملون مع نتائجها أو يتقوا رواسبها. في البداية كان الكل يكابر ويصر على تسمية الهزيمة نكسة علماً أن الأحداث التي تتالت بعد ١٩٦٧ أثبتت أنها كانت فعلاً هزيمة في العمق لفكرة الأمة العربية الحديثة وترجماتها المختلفة على الأرض. ثم بعد الانشطار المزري لفكرة وحدة القرار والمصير العربيين إثر حرب أيلول (سبتمبر) ١٩٧٠ وحرب لبنان الأهلية عام ١٩٧٥ وتوقيع مصر على اتفاق السلام المنفصل مع إسرائيل عام 1978، تحولت القضية إلى عبء على العرب وبدأ البعض يصر على تحميلها بالمطلق للفلسطينيين، الذين ارتكبت قيادتهم الطائشة خطأ استعداء العرب الداعمين مرات عدة، من الأردن عام ١٩٧٠ إلى الكويت عام ١٩٩٠.
وخطأ القبول بالانفراد في التفتيش عن حل، أدى بطبيعة الحال إلى اتفاقيات أوسلو الغبية والمجحفة عامي ١٩٩٣ و١٩٩٥، التي ما زال الفلسطينيون حتى اليوم يعانون من قصر نظر وتهور قيادتهم بقبولها كما من تجاهلها التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب الفلسطيني ولم يزل يقدمها. واليوم نجد السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمتين الأكبر اللتين يفترض فيهما تمثيل العرب والمسلمين، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي (مع اسمها الجديد)، عاجزين حتى عن إدانة قرار ترامب إدانة صريحة.
الحال المزرية التي وصلت إليها قضية فلسطين، ومركزية القدس بالنسبة إليها، هي نتيجة تراكمات متطاولة لقرارات جاهلة ومتسرعة وأحياناً نابعة من مصلحة آنية وضيقة، ارتكبها العرب والفلسطينيون تخصيصاً لمدة خمسين عاماً، جاءت لتتوضع على أخطاء ارتكبوها منذ ظهور الحركة الصهيونية وبيان مطامعها في أرض فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر. لكن اللوم على تلك الأخطاء المبكرة مخفف لأنه نظري واستعادي، فالعرب المشارقة لم يكونوا واعين تماماً بمعنى الوطنية والانتماء للأرض في ظل الأمبراطورية العثمانية المتأخرة والمتفسخة، وهم فوجئوا بالاستعمار الغربي ينزل عليهم ويقسم بلادهم ويضرب آمالهم في نهاية الحرب العالمية الأولى، مما عطل النمو الطبيعي للحركات الوطنية وشتت طاقاتها. أما بعد ظهور الحكومات الوطنية «التقدمية» في الخمسينات والستينات فبات لومها مبرراً ومنطقياً بسبب تقاعسها وتخاذلها وعدم جديتها في التخطيط لاستعادة فلسطين أو الحفاظ على ما تبقى منها، ولعبها على أكثر من حبل ثم كذبها وتبجحها واستغلالها للقضية الفلسطينية في صراعاتها الداخلية والإقليمية، وفي النهاية تخليها المزري عن القضية وعن الشعب الفلسطيني.
ثم أتى قرار الرئيس ترامب لكي يثبت أن القضية فعلاً قد انطفأ بريقها في العالمين العربي والإسلامي، فالتهديد والوعيد الذي لاكه بعض الزعماء العرب لم يترجم إلى أي خطوة عملية على أرض الواقع، لا في فلسطين المجتزأة ولا في بقية العالمين العربي والإسلامي.
ما الحل إذن؟ لا أقصد من سؤالي هذا إطلاق الإدانات والمطالبات للمجتمع الدولي بالتحرك أو اجترار الخطب الحماسية وقرع نذير الجهاد والدعوة إلى تحرير القدس التي فقدناها تباعاً منذ كفت أن تكون مدينتنا المهملة لكي تصبح قضيتنا المهدورة. فلهذا الميدان كماته المبرزون الذين لن يعدموا وسيلة للضجيج والهدير أو التباكي واللطم، ولو أنهم حقيقة أصبحوا مملين فوق ماهم غير مجدين. ما أود أن أطرحه هنا هو مقاومة فقدان الذاكرة ونسيان فلسطين ونسيان قصة سقوطها وسقوط القدس بتفاصيلها ولاعبيها وألاعيبهم والمستفيدين منها والخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية والعقائدية لكل هذه التفاصيل. فكما ذكرنا الكاتب الأوروغوايي الراحل إدواردو غاليانو صاحب الكتاب النقدي الرائع «شرايين أميركا اللاتينية المفتوحة» في سياق آخر: النسيان هو آفة العالم، ونحن ننسى دائماً ونتعود على الواقع الجديد ونتقبله. والنسيان أيضاً، وفقاً لغاليانو، هو أداة مالكي القصص التي تنسج ذاكرة الشعوب وتحركها، والأرض التي تعيش الشعوب عليها ومصادر الثروة فيها، وهم يعتمدون على النسيان الجمعي المبرمج أكثر من أي أداة أخرى للسيطرة على الناس وتحوير ذاكرتهم دوماً بما يوافق هواهم ومخططاتهم. والذاكرة، بالتالي، واحدة من أمضى أسلحة المقاومة وأكثرها جدوى بوصفها البؤرة التي تتجمع فيها كل التعبيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية والحضارية لتعوض الناس الفقدان الحقيقي الذي أصاب هويتهم وأرضهم وتراثهم، وتشحن قدرتهم على مواجهة التحدي والحفاظ على الإحساس بالذات والتخطيط للمستقبل. وقد قضى اليهود قرابة الألفي سنة في الشتات معرضين لكل أنواع الاضطهاد والتمييز وهم يذكرون القدس في كل صلواتهم. وهاهم اليوم أسيادها. ولعل في ذلك لنا عبرة.
* كاتب سوري وأستاذ العمارة في جامعة أم أي تي.
الحياة
في السؤال عن استعصاء الانتفاضة الثالثة/ ماجد كيالي
قصة إبراهيم أبو ثريا (29 سنة)، من مخيم الشاطئ للاجئين في غزة، المقطوع الساقين، نتيجة تعرضه لقذيفة إسرائيلية إبان الحرب الأولى التي شنّتها إسرائيل على القطاع (2008)، هي ذاتها قصة فلسطينيي غزة، بل وقصّة الفلسطينيين كلهم في مواجهة إسرائيل، إذ قضى أبو ثريا (يوم الجمعة الماضي)، المُقعد، في الاحتجاجات الحاصلة على خطوط التماس بين القطاع وإسرائيل، كتعبير عن رفض الفلسطينيين قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو يلوّح بعلم فلسطين بيد وشارة النصر بيده الأخرى، نتيجة رصاصة أطلقها قناص إسرائيلي يحتمي بأبراج مراقبة عالية وبسواتر وحواجز وأسلاك كهربائية.
القصة هنا، أو بالأحرى المأساة، تجسّد، أو تكثّف، حال الفلسطينيين، حيث ضعف الإمكانات وقوة الحق، وحيث العيش بين حدّي الشلل والأمل، فهذه هي حال غزة، التي تكابد الحصار المشدّد، منذ عشرة أعوام، تخلّلتها ثلاث حروب مدمرة (2008 – 2012 – 2014)، وهذه هي حال الفلسطينيين عموماً، إزاء إسرائيل، بغضّ النظر عن الشعارات الحماسية والرغبات الذاتية.
لنلاحظ هنا أن الرجل لا يستطيع أن يفعل شيئاً مؤذياً لإسرائيل، من الناحية المادية، لكنه فقط يستطيع أن يذكّرها كل يوم بوجوده، ووجود شعبه، وتالياً أن يشعرها بمسؤولياتها عن مأساته، وأن يعرّفها بهويته، وبعلمه، وأن يشعرها بالأمل الكامن في قلبه بتلويحه بإصبعي يده بإشارة النصر. في المقابل، فإن إسرائيل، من هذا الموقع، تبدو بعيدة، وغير مرئية، ومحصنة بسواتر وحواجز وجدران، ومدججة بترسانة من الأسلحة، فيما الإسرائيليون يعرفون ولا يبالون، في غالبيتهم، فهم لا يتأثرون بما يُجرى، كأنه يحصل في مكان آخر، بعيد، لا سيما أنه لا يغير شيئاً من مسارات حياتهم، فيما جيشهم يقوم بالمهمة بالطائرات وقذائف الدبابات والمدفعية، وبالصواريخ، وبرصاص الأسلحة الرشاشة، وفق الوضع على الأرض.
في هذا الإطار، تجدر ملاحظة أن الوضع اختلف كثيراً عنه في الانتفاضة الأولى، وحتى في الثانية، ففي الأولى (1987 إلى 1993)، كان ثمة تداخل كبير بين مجتمعي الفلسطينيين والإسرائيليين، في الجغرافيا والديموغرافيا، وفي السياسة والاقتصاد والأمن، لذا فعندما حدثت الانتفاضة أثرت كثيراً في المجتمع والدولة الإسرائيليين، واستطاعت أن تؤثر في المزاج العام الإسرائيلي، وأن تثير التناقضات في صفوف الإسرائيليين، الأمر الذي نتج منه تراجع حزب «ليكود»، وتزايد وزن التيارات المؤيدة لتسوية مع الفلسطينيين، وهو ما تم حله في اتفاق أوسلو (1993)، الناقص والمجحف، الذي حل مشكلة لإسرائيل ولم يحل أية مشكلة للفلسطينيين. هكذا ففي الانتفاضة الثانية حدث مثل ذلك التأثير، ولكن في شكل مختلف، فتلك الانتفاضة التي غلب عليها طابع العمليات المسلحة، وضمنها العمليات التفجيرية، التي أوجعت الإسرائيليين، وحّدتهم في مواجهة الفلسطينيين، ما نتج منه إعادة احتلال مناطق السلطة، وتعزز مكانة التيارات اليمينية القومية والدينية في إسرائيل، فضلاً عن أنها غطت على بطش إسرائيل بهم، وسهلت لها التملص من التزاماتها المنصوص عنها في اتفاق أوسلو.
بيد أن أهم تغيّرات حصلت بعد الانتفاضة الثانية، ويجدر تفحص تأثيراتها وتداعياتها على كفاح الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل، تمثلت في الجوانب المهمة الآتية:
أولاً: عزل القدس عن الضفة، من خلال تعزيز الأنشطة الاستيطانية فيها، والحد من قدرة فلسطينيي الضفة على الوصول إليها (عبر إقامة الحواجز العسكرية وتحديد الفئات العمرية)، ومن خلال إنهاء وجود السلطة الفلسطينية فيها، بإغلاق «بيت الشرق»، وكل الجمعيات أو المؤسسات التي تتبع لها.
ثانياً: قيام إسرائيل ببناء الجدار الفاصل، منذ عام 2002، الذي وضعت عبره كل المدن والتجمعات الفلسطينية داخل معازل، مع جدران عالية، كما قامت ببناء جسور وأنفاق وطرق التفافية خاصة بالمستوطنين، وهي في كل ذلك استطاعت تخفيف احتكاك الفلسطينيين بالإسرائيليين في الضفة (مستوطنين وعسكريين)، إلى أقصى حد ممكن، وفقاً لشعار: «نحن هنا وهم هناك»، بحيث لم يعد الإسرائيليون يرون الفلسطينيين، كأن كل جماعة منهم تعيش في بلد آخر، وهو الأمر الذي جعل من انتفاضات الفلسطينيين، أو تظاهراتهم واعتصاماتهم وكل أشكال التعبير عن غضبهم وعصيانهم، كحرق الدواليب، مثلاً، غير مرئية ولا تصل إلى مسامع الإسرائيليين، لا في مناطق 1948 ولا في الضفة.
ثالثاً: ما حصل في الضفة حصل في غزة أيضاً، إذ قامت إسرائيل بانسحاب أحادي بالخروج منها، تماماً كما خرجت من مدن الضفة، بمعنى أنها استعاضت عن الاحتلال بمجرد حصار القطاع من كل الجوانب، وترك حوالى مليوني فلسطيني فيه لتدبّر أمورهم، في منطقة نادرة الموارد، ومرتهنة لإسرائيل في مجال إمدادات الكهرباء والمياه والطاقة، وذات اعتمادية عالية على المعابر الإسرائيلية في المواد التموينية، لا سيما مع الإغلاق المستمر لمعبر رفح. هكذا بات ما يُجرى في القطاع كأنه يُجرى في بلد آخر، أو قارة أخرى، مع احتفاظ الجيش الإسرائيلي بسياسة «اليد الطويلة» لضرب غزة، بين فترة وأخرى، وهو ما حدث في ثلاث حروب في غضون سبعة أعوام (بين 2007 و2014).
ولعل كل ما تقدم يفسّر أن الهبّة الشعبية الحاصلة، وكما حصل في هبّة تموز (يوليو) الماضية (والهبات المتفرقة منذ العام 2014) أتت على شكل اشتباكات محدودة في نقاط تماس المدن الفلسطينية مع المواقع العسكرية الإسرائيلية، وعند المعابر، وهو ما يحصل عند معبر قلنديا، الواصل بين القدس ورام الله، وعند مسجد بلال (أو قبر راحيل) في بيت لحم، والنقطة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل، وعند الحدود بين غزة وإسرائيل، وهو ما يفسر أن أكثر نقاط الاحتكاك والاشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي في القدس الشرقية.
رابعاً: هناك جانب آخر تفترض ملاحظته، على نحو جيد هنا، هو الواقع السياسي والمجتمعي الجديد الناجم عن قيام السلطة الفلسطينية، فثمة حوالى ربع مليون من الفلسطينيين يعيشون من دخلهم كموظفين في أجهزتها الإدارية والخدمية والأمنية، والذي يأتي من الدول المانحة لعملية «السلام»، وهؤلاء ترى غالبيتهم في الواقع القائم نمط حياة من الصعب تغييره، لا سيما في الظروف العربية والدولية الراهنة، وغير المواتية. فوق ذلك، ثمة أيضاً العقيدة التي نشأت عليها الأجهزة الأمنية، التي ترى أن وظيفتها منع، أو كبح أي حراك شعبي ضد إسرائيل، كما حصل في مرات عديدة، باعتبارها له نوعاً من تحدي السلطة الفلسطينية ذاتها.
خامساً: يفاقم من كل ما تقدم تحول الحركة الوطنية الفلسطينية من حركة تحرر إلى سلطة، وانتهاج القيادة الفلسطينية خياراً أحادياً يتمثل في المفاوضة من أجل إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، على رغم مرور ربع نحو ربع قرن على إفلاس هذا الخيار، كما تمثل في اتفاق أوسلو، وتقويض إسرائيل إياه، بتهربها من التزاماته. والمعنى أن غياب قيادة حركة تحرر وطني، وترهل البنى الوطنية الفلسطينية يجعلان من قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة أمراً في غاية الصعوبة، أو يحتاج إلى ظروف فلسطينية وعربية ودولية أخرى.
هكذا، وباختصار، يمكن القول إن الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الثالثة لا تحتاج الى إذن من أحد حتى تأتي، وأنها بالتأكيد لن تأتي بكبسة زر، ولا بدعوة من هذا الفصيل أو ذاك، ولا من هذا القيادي أو غيره، وإنما هي تحتاج إلى الظروف الذاتية والموضوعية المناسبة.
والقصد أن تعذّر انتفاضة ثالثة لا يقلل من الأهمية الكفاحية للهبات الشعبية المتفرقة، على رغم محدوديتها في الزمان والمكان والوسائل، ولا يقلل من الروح الوطنية للفلسطينيين، ولا من استعدادهم الدائم للتضحية في سبيل حقوقهم، ولكنه يفيد بأن الفلسطينيين الذين اجترحوا الانتفاضة الشعبية الأولى، التي كانت الأكثر تعبيراً وتمثلاً لخبراتهم النضالية، ولإمكاناتهم، وللواقع المحيط بهم، هم الأكثر قدرة على تحديد ما يمكنهم فعله، بمعزل عن استدعاء هذا الفصيل أو ذاك لانتفاضة ثالثة، وبغض النظر عن الروح الشعاراتية والرغبوية المهيمنة في خطابات قادة الفصائل، بين فترة وأخرى، وفق المناسبة.
لذا، ربما الأجدى دراسة أوضاع الفلسطينيين والتحولات السياسية والاجتماعية والثقافية الجارية عندهم، والعمل على تعزيز صمودهم وتطوير كياناتهم (المنظمة والسلطة والفصائل وغيرها من كيانات جمعية)، ودراسة الأشكال الأكثر جدوى لإحداث تأثيرات تخدم كفاحهم بين الإسرائيليين، وكل ذلك بدلاً من مجرد تمنّي انتفاضة ثالثة طال استدعاؤها، والتهديد بها، بالشعارات والخطابات، من دون فعل شيء مناسب من الناحية العملية.
* كاتب فلسطيني
الحياة
هل تستخدم موسكو خطأ ترامب في القدس؟/ رائد جبر
قرار دونالد ترامب حول القدس، منح موسكو فرصة ذهبية جديدة للإفادة من الأخطاء الأميركية في المنطقة. لكنها ليست على عجلة من أمرها. بل تراقب بدقة ردود الفعل الإقليمية والدولية، وتعمل على ترتيب أولوياتها.
اللهجة الروسية تصاعدت تدريجاً، بالتوازي مع اتساع درجة الاستياء حيال القرار الأميركي خصوصاً بعد استخدام واشنطن حق النقض لتعطيل مشروع القرار العربي في مجلس الأمن.
بدأ رد الفعل الروسي منتقداً التصرّف الآحادي لواشنطن، مع الحرص على التذكير بأن موسكو اعترفت منذ نيسان (إبريل) الماضي بالشطر الغربي من القدس عاصمة لإسرائيل، والشطر الشرقي عاصمة للدولة الفلسطينية التي يجب أن تقوم على أساس القرارات الدولية وبنتيجة مفاوضات مباشرة تسفر عن «توافقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين». ثم انتقل إلى التحذير من تداعيات القرار الخطرة على الاستقرار في المنطقة.
الموقف لا يختلف كثيراً في جوهره عن المطالب العربية المعلنة. لكن التمهل الروسي بدا واضحاً في تجنب إطلاق مبادرات رداً على القرار الأميركي، على رغم دعوات أوساط برلمانية وديبلوماسية اعتبرت الفرصة مواتية لموسكو لتعزيز نفوذها في المنطقة، والإفادة من مدخل مهم يوسع الحضور الروسي إقليمياً بدلاً من اعتماده شبه الكامل على نتائج التدخل العسكري المباشر في سورية.
من الطبيعي أن قرار ترامب حفّز كثيرين في روسيا لإحياء الفكرة التي دافع عنها رئيس الوزراء السابق يفغيني بريماكوف خلال عقدين، بأن المسألة الفلسطينية هي البوابة الأهم إلى المنطقة. انعكس ذلك في حرص موسكو الدائم على تأكيد ثبات موقفها حيال ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تفضي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
لكن الحسابات الروسية الحالية تأخذ في الاعتبار التوازنات الدقيقة التي نجحت موسكو في إدارتها حتى الآن على المستوى الإقليمي لتلبية أغراض تدخلها في سورية. بما في ذلك علاقتها الخاصة مع إسرائيل التي تطوّرت كثيراً خلال العامين الماضيين.
وفيما يتحدث الجانب الفلسطيني عن مسعى إلى إنهاء هيمنة واشنطن على رعاية عملية السلام، عبر تفعيل دور أنشط لروسيا والصين والاتحاد الأوروبي. ويؤكد ضرورة تبني «مقاربة جديدة» للعملية السياسية بعد القرار الأميركي، لا تبدو موسكو متحمسة لبحث آليات جديدة. وهي أبلغت الجانب الفلسطيني بأنها تدعم استئناف الحوار المباشر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً للآليات المتفق عليها وعلى أساس القرارات الدولية، باعتبار أن «روسيا والولايات المتحدة لا تستطيعان تسوية هذا النزاع ولا بديل من مفاوضات مباشرة».
أكثر من ذلك، فإن الكرملين حذّر من خطوات جوابية «قد تؤدي إلى انشقاق جديد في المجتمع الدولي وتصعيد حدة التوتر». بهذا الموقف تتقلص آفاق رهان الجانب الفلسطيني على إحياء المبادرة الروسية التي طرحت ولم تنفذ منذ عام 2005 في شأن عقد مؤتمر دولي في موسكو للسلام في الشرق الأوسط. وحتى لو حاولت موسكو إعادة طرح الفكرة، تبدو فرص نجاحها معدومة في ظل المواجهة القائمة مع واشنطن وحليفاتها في الغرب.
البديل الروسي قد يبرز خلال أسابيع عبر توجيه الدعوة مجدداً إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لإجراء جولة حوار مباشر في موسكو. على رغم أن تجربة العام الماضي لم تكن مشجعة، إذ فشلت موسكو في جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لحوار مباشر حول آليات مقبولة من الطرفين لاستئناف المفاوضات.
أجهض نتانياهو المبادرة الروسية العام الماضي. وليس ثمة ما يدعو إلى التفاؤل بأنه سيمنح موسكو إذا أعادت المحاولة ورقة لتعزيز دورها، خصوصاً في ظروف الدعم غير المحدود الذي حصل عليه من واشنطن.
بهذا المعنى فإن تمسك روسيا بالآليات المطروحة حتى الآن لن يكون مجدياً، إلا بحدود توظيف ملف القدس والتسوية في الشرق الأوسط في إطار الحرب السياسية والإعلامية المشتعلة بين موسكو وواشنطن.
والسؤال عن رغبة الكرملين أو قدرته، في الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، على إطلاق مبادرات جديدة وخلاّقة يبقى معلقاً.
الحياة
أموالنا مقابل أصواتكم/ الياس حرفوش
لا مكان للقيم الإنسانية ولا لما يفرضه احترام القانون الدولي، ولا حتى لأصول التعامل بين الدول، في إدارة دونالد ترامب وفي سلوك هذه الإدارة مع العالم. الزبائنية التي تتحكم بالعقل الاستثماري والتجاري للرئيس الأميركي، هي نفسها التي تدير اليوم سياسة أميركا الخارجية. كما كشفت التصريحات الفضائحية التي أطلقها هو ومندوبته في الأمم المتحدة. تخلّت نيكي هايلي عن أبسط أصول اللغة الديبلوماسية في مخاطبتها زملاءها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مهددة بتسجيل أسمائهم تمهيداً لمعاقبتهم، إذا لم يصوّتوا كما تريد، ما يذكّر بأسلوب مخاطبة الناظر لتلاميذه في ملعب المدرسة، إذا أساءوا السلوك! وفي أوضح إشارة إلى الابتزاز المالي قالت لهم: عندما نقدم مساهمات مالية للأمم المتحدة، فإننا نتوقع أن نحظى بالاحترام، والأسوأ أننا مطالبون بالدفع في مقابل عدم احترامنا!
في نظر هايلي ورئيسها أن «احترام» أميركا يفرض الخضوع لمشيئتها ولقراراتها مهما فعلت. وإذا رأت الولايات المتحدة أن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو قرار»سيادي» على رغم أنه يخالف القرارات الدولية المتعلقة بمصير هذه المدينة، فإن على الدول الأخرى أن تحترم وأن تركع. لكن أكثرية دول العالم لم تفعل ذلك، ولم يبقَ إلى جانب ترامب ومندوبته سوى بضع جزر في المحيط الكاريبي، كما أن دولاً أخرى، مثل كندا، كانت مستعدة للتصويت ضد القرار، لكنها غيرت رأيها وامتنعت عن التصويت، رداً على لهجة التعالي والغطرسة الأميركية.
لهذا فنتيجة التصويت في شأن القدس في الجمعية العامة، التي كشفت عزلة إدارة ترامب على الساحة الدولية، ليست انتصاراً للقدس وحدها، على رغم الأهمية الاستثنائية لهذا التصويت. هذه النتيجة أظهرت أيضاً أن معظم العالم ما زال متمسكاً بضرورة احترام القوانين الدولية التي ترعى العلاقات. من أبسط هذه القوانين أن أيّ دولة، ولو كانت دولة كبرى، لا يحق لها بمفردها أن تتذرع بحجة السيادة لتخرق هذه القوانين. وباستثناء الدول العربية والإسلامية، التي تمثل القدس بالنسبة إليها رمزاً سياسياً وطنياً ورمزاً دينياً، فإن عدداً من الدول الأخرى، وفي مقدمها الدول الأوروبية، اختارت التصويت ضد دونالد ترامب، كرسالة بأن القانون الدولي له حرمة، كما قرارات مجلس الأمن المتعاقبة بشأن القدس، والتي تحول دون التفرد من أي جهة، بما فيها إسرائيل، بتقرير مصير المدينة.
يبقى الآن التعامل مع ارتدادات التصويت الأميركي على علاقات واشنطن مع حلفائها العرب والمسلمين، كما مع معظم دول الاتحاد الأوروبي (باستثناء هنغاريا وتشيخيا) التي عارضت الاعتراف المنفرد بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما يبقى التعامل مع ارتدادات العقوبة الأميركية على الأمم المتحدة نفسها. فقد بلغ حجم المساهمة الأميركية في موازنة المنظمة الدولية في العام الماضي 10 بلايين دولار، ما يشكل خمس الموازنة العامة. فضلاً عن بليونين ونصف بليون دولار هي مساهمة الولايات المتحدة في عمليات حفظ السلام التي تقوم بها القوات الدولية.
وإذا كان يفترض أن يكون الرد المالي هو مساهمة دول العالم الغنية والقادرة في تعويض المساهمة الأميركية وتلقين واشنطن درساً أنها لا تستطيع أن تشتري العالم بأموالها، فإن الدرس السياسي يجب ان يكون ما اقترحه الموسيقي اليهودي العالمي (والتعريف الديني له معناه هنا) وحامل الجنسية الإسرائيلية دانيال بارنبويم عندما دعا، (في مقال في صحيفة «الغارديان» البريطانية) كرد على هوج ترامب وقراره الاعتباطي، إلى اعتراف عالمي بدولة فلسطين، وبعاصمتها، القدس الشرقية.
الحياة
وماذا عن مسؤولية القيادة الفلسطينية عن قرار ترامب؟/ ماجد كيالي
يمكن قول أشياء كثيرة عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وتالياً نقل السفارة الأميركية إليها، كوصمه بالرعونة، والخفّة، والبلطجة وحتى بالنظرة الاستعلائية أو العنصرية، أو وصمه بافتقاد الحكمة والعقلانية والسياسة وقيم المساواة والعدالة، بيد أن كل ذلك لا يمنع من رؤية بعض المسؤولية التي تقع على عاتق القيادة الفلسطينية، أو لا يحول دون ذلك، ليس من مبدأ جلد الذات، وإنما من مبدأ مراجعة الطريق الذي انتهجته هذه القيادة، ووضعت فيه جميع رهاناتها على عاتق الولايات المتحدة.
وبغض النظر عن هذا الرئيس أو ذاك، أو مع كل التفاهة المتمثلة في شخصية ترامب، فإن تاريخ السياسة الأميركية في المنطقة يؤكد انحياز الولايات المتحدة، اللامحدود، والفاضح، لمصلحة إسرائيل، منذ قيامها، قبل سبعة عقود. والمعنى أن ما فعله ترامب ليس جديداً، ولا طارئاً، إذ لطالما عرفت الولايات المتحدة حليفاً استراتيجياً لإسرائيل، بواقع دعمها لها مالياً وعسكرياً وسياسياً، وبحكم علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي التي تربطها بها، إضافة إلى تغطيتها مواقفها السياسية الاحتلالية والعنصرية، في المحافل الدولية، وفوق كل ذلك ضمانها أمنها وتفوقها، في المنطقة، على صعدة كافة.
وفي الحقيقة، فإنه لا توجد سيرة لرئيس أميركي أنصف الفلسطينيين، أو اتخذ مواقف تضغط على إسرائيل لحملها على الاستجابة لمتطلبات السياسة الأميركية أو مراعاتها، باستثناء لحظتي الضغط التي أجبرت إسرائيل على الانسحاب من سيناء، في حرب 1956، وذلك لمصلحة أميركية بحت، والضغط، بالقروض الأميركية، من أجل دفع إسرائيل إلى مجرد المشاركة في مؤتمر مدريد لـ «السلام» (1990)، بغض النظر عن تلبيتها متطلبات الحد الأدنى من السلام، والتي لم يتورّع يومذاك إسحق شامير (رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك) بالقول أن التسوية ستحتاج إلى عشرين سنة مفاوضات (علماً أنها احتاجت أكثر وما زالت)، وتأكيده أن إسرائيل تذهب إلى التسوية وفقاً لشروطها.
هكذا، فباستثناء المثالين المذكورين فإن الولايات المتحدة ظلت باستمرار تحابي إسرائيل في شأن الاستيطان والسياسات المتعلقة بتهويد القدس ومصادرة الأراضي، وتغيير معالم الأراضي المحتلة، وعلى رغم تنصلها من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تقضي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، على رغم بعض تصريحات شكلية، من بعض أركان إداراتها التي تتحدث عن عدم رضاها عن بعض تلك السياسات.
السؤال الآن، موجه إلى القيادة الفلسطينية: فإذا كانت الولايات المتحدة مكشوفة إلى هذا الحدّ، فعلى أي أساس راهنت عليها، كراع نزيه أو كوسيط محايد، وكضامن، لعملية السلام؟ ثم لماذا استمر هذا الرهان أكثر من ربع قرن؟ وربما يجدر التنويه هنا إلى أن هذين السؤالين لا علاقة لهما بأي استنتاج يفضي إلى الطلب من القيادة الفلسطينية معاداة الولايات المتحدة، إذ إنها ليست على شاكلة الدولة عندنا، حيث لا مواطنة ولا مجتمع مدني، وإنما مجرد سلطة تتحكم في كل شيء، إذ يجدر بخصوصها التمييز بين الإدارة، في كل مرحلة، وبين مجتمع الأميركيين، أو القوى الفاعلة أو المحركة في هذا المجتمع، في السياسة والثقافة والأكاديميا والفنون والاقتصاد والعلوم والشركات. كما لا يعني ذلك أن على هذه القيادة أن تشن حرباً على إسرائيل، إذ إن ذلك ليس معقولاً، فضلاً عن أنه ليس بمستطاعها ذلك، بخاصة في ضوء تجربة عمرها أكثر من نصف قرن، وآخرها تجربة الانتفاضة المسلحة (2000 – 2004).
عدا عما تقدم فإن القيادة الفلسطينية، وهي قيادة المنظمة والسلطة و «فتح»، تتحمل مسؤولية عن القرار الأميركي، ليس لأنها تستطيع أن تفعل شيئاً ضد الولايات المتحدة، بل لأنها، عملت ما ليس ملائماً لها، ولا لشعبها، أن تفعله. مثلاً، هي، أولاً، قبلت تأجيل البتّ بقضية القدس (مع قضايا اللاجئين والمستوطنات والحدود)، في اتفاق أوسلو (1993)، وهذا أفسح المجال أمام إسرائيل لفرض الأمر الواقع، بحكم قوتها، وبواقع سيطرتها على أراضي الفلسطينيين. ثانياً، لأنها عندما أبرمت اتفاق أوسلو لم تستند إلى مرجعية القرارات الدولية، أي قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والهيئات المتفرعة عن الأمم المتحدة، المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إذ إنها قبلت بأقل من ذلك، علماً أن هذه القرارات كان يمكن أن تغني، ولا زالت، عن عملية المفاوضات العقيمة التي تخضع لتلاعبات إسرائيل، وتهرّباتها. ثالثاً، لنفترض جدالاً أن القيادة الفلسطينية تسرّعت في مراهنتها على الولايات المتحدة في عملية التسوية، لكن مفاوضات كامب ديفيد 2 (2000) كشفت انحيازها إلى إسرائيل، بقبولها تملّصها من قضايا الحل الانتقالي، ودعمها إملاءاتها التي تجحف بحقوق الفلسطينيين في قضايا الحل النهائي.
وعلى مر ربع قرن ظلّت الإدارات الأميركية تشدّد ضغطها على الفلسطينيين، وتتسامح مع إسرائيل، إلى درجة أنها تناست رفضها لخطة «خريطة الطريق» التي كان طرحها الرئيس بوش الابن (2002)، على رغم تنفيذ الفلسطينيين الاستحقاقات المطلوبة منهم فيها، والذين طالبتهم بالمزيد. رابعاً، المشكلة، أيضاً، أن القيادة الفلسطينية عندما دخلت عملية التسوية لم تطرح السقف الأعلى المتمثّل بقرار التقسيم (181، لعام 1947). مثلاً الذي يتضمن إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، مع فرض وصاية دولية عل القدس، ونوع من علاقات اقتصادية، بل إنها ذهبت إلى أقل من ذلك، بحيث أضحت أراضي الضفة (المحتلة عام 1967) موضع نزاع على الأراضي، بين الطرفين، بخاصة مع تجزئتها إلى مناطق أ وب وج.
باختصار، يمكننا أن ندين وأن نشجب وأن نرفض القرار الأميركي الذي لن يغير حال الفلسطينيين في صراعهم مع إسرائيل، لكن يجدر بنا، إلى جانب كل ذلك، أن نتوقف ولو مرة واحدة عند مسؤوليتنا نحن عن الخيارات والسياسات التي ننتهجها، أو تنتهجها قياداتنا.
الحياة
القدًس في زمن الثورة المضادة/ الياس خوري
انتهت السنة بمشهد دموي في ضواحي صنعاء؛ علي عبد الله الصالح مضرّج بالدم ومحمول وسط التهليل والتكبير، وهو مشهد لا يختلف عن مشهد مقتل القذافي منذ ستة أعوام، بعدما وقع في كمين مسلح.
لا مكان للفرح بهاتين الميتتين البشعتين، مثلما لم يكن إعدام صدام حسين بيد خصومه يدعو إلى التفاؤل. الطغاة يُقتلون بأيدي طغاة يشبهونهم، ومسلسل الدم لا يتوقف. والثورات المضادة التي حوّلت بلاد العرب إلى ركام، تئد الثورة تحت جثث الضحايا.
واقع تمتزج فيه المأساة بالملهاة؛ كلمات تصفّق بدلاً من أن تحكي، وخراب تصنعه الأصوليات التي تتقاتل، وتعلن زمن اللا أحد. سورية تتحول إلى أرض تستبيحها القواعد العسكرية الأجنبية، والشعوب تتحول من فاعل إلى مفعول به، والوحشية تطفئ الضوء في العيون. منذ البداية كانت الثورات المضادة مختبئة في ثياب الثورة، من مصر المحروسة بالانقلاب، إلى سورية التي اجتمع على شعبها بغاة الأرض كلهم، فتسللوا من شقوق الحلم كي يسدلوا ستاراً من الدم على بقايا مدنها المدمرة، وصولاً إلى ليبيا المجزرة المفتوحة، ويمن الكوليرا والحصارات والطاعون.
بلاد العرب كلها من الصحراء إلى الصحراء تلعق سراب المستبدين. كل استبداد أصولي وكل أصولية استبداد، والمستبد كالأصولي هو المبشر باللا أحد، أي بفراغ لا يملؤه سوى الخراب والدم. هذا ما أعلنه الطغاة العرب وهم يفاجأون بانتفاضات شعوبهم من أجل الحرية، وكان الرد الأصولي الذي تسلل من شقوق عجز الثورات عن إنتاج قيادات تاريخية جرّاء عقود من القمع والخيبة والشلل الفكري، هو التناوب مع الاستبداد على تحويل بلاد العرب إلى ولائم للقتل.
زمن الانقلابيين وقادة الميليشيات وروائح الثروة المستباحة، صنع الثورة المضادة، وقام بتهميش المكانَين الباقيين في ركام الأزمنة: هُمشت فلسطين، بل هناك مَن يبشّر بنهايتها في صفقة قرن لن تكون سوى قبلة الموت لمسار سلام لم يكن في الأساس سوى وهم، كما هُمشت بيروت التي صارت أسيرة نظام طائفي فتك بثقافتها وقام بتحويلها إلى ورقة ترتجف خوفاً من أشباح الحرب الأهلية.
منذ بداية الثورات المضادة التي قادها العسكر والمافيات والأصوليون وموّلتها الثروات العربية المهدورة، تحوّل الموت إلى احتفال. لم يسبق أن كانت المجزرة مدعاة لفخر مرتكبيها كما هي اليوم في بلاد العرب. ليس صحيحاً أن احتفالية الموت كانت حكراً على التيارات الأصولية العسكرية كما يدّعي مَن يسعى لتغطية الجريمة بذاكرة مفقودة، فالاحتفال بالموت العربي بدأ حين استُبيح الناس وهُدمت المدن، من مذبحة شاتيلا وصبرا إلى المذابح الكبيرة والصغيرة في المدن والسجون العربية، في تقاطع مريب بين القاتل الإسرائيلي والقاتل العربي. لكنها بلغت ذروة لا ذروة بعدها في الربيع العربي، كما صاغه مؤخراً المعلق الأمريكي توماس فريدمان في مقالة عجيبة نُشرت في جريدة «نيويورك تايمز» (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017)، وفيها يتناسى دم العرب المراق كي يحجب الربيع العربي خلف عباءة النفط.
لا تستحق مقالة فريدمان سوى وضعها في سياق اللعبة الأمريكية التي لا ترى في أرض العرب سوى بئر لنفطها من جهة، وتهديد محتمل لإسرائيل من جهة ثانية.
الثورة المضادة التي اجتاحت بلاد العرب وفّرت على الولايات المتحدة تخوفها من أي تهديد عربي لإسرائيل، فقد حوّل المستبدون الحلم العربي إلى كابوس، ونجحوا في لعبتهم الوحشية والدموية في جعل المشرق العربي منطقة لجذب الخراب، فأتت الميليشيات المسلحة من جميع أصقاع الأرض: أصوليون يريدون بعث دولة الخلافة، وأصوليون آخرون يحمون أنظمة مافيوية تسترت بالعلمانية، وفي لقاء الأضداد المتشابهة صارت بلاد العرب ملعباً للقوى الأجنبية.
لم يعد هناك أي خطر عربي على إسرائيل في المدى المنظور، بل هناك لهاث يسعى للتحالف معها بأي ثمن في لعبة الصراع الطائفية المجنونة التي تمزق مجتمعاتنا بالقوة الغاشمة. لذا ليس مستغرباً أن يمتطي دونالد ترامب عُته العرب بعتهه، ويعلن اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المنكوبة بالاحتلال الاستيطاني، فالسيد ترامب يتسلق على حبال الوهن العربي، كي يصل إلى ما سعت إسرائيل للوصول إليه منذ احتلالها القدس وبقية فلسطين في سنة 1967.
سيسجل التاريخ أن «الأمريكي البشع»، العنصري الأبيض، اللاسامي في أعماقه، هو شريك اليمين العنصري الإسرائيلي في تأسيس دولة تمييز عنصري كاملة الأوصاف. فاللاسامية في جوهرها لم تكن ضد اليهود إلاّ لأنها ضد المختلف. وكما جسّدت اللاسامية في القرنين التاسع عشر والعشرين المكبوت العنصري البربري في الثقافة الكولونيالية، فإن الإسلاموفوبيا وفوبيا العرب تفتتحان القرن الواحد والعشرين بهمجية تليق بهما، عبر تحويل أرض العرب إلى بحار من الدماء والدموع والألم.
إلى أين تمضي بنا الثورة المضادة؟
لا قعر للقعر، فالثورة المضادة جزء من مدّ يميني صاعد، وجد في رئيس أمريكي متهور ومرتكب وخائف من أن تصل إليه يد القضاء حليفاً لرئيس حكومة إسرائيلية غارق في الفساد ويسعى هو الآخر لتجنّب الإدانة؛ التقى الرجلان في حمى الفساد والفاشية ليجدا في القدس وفلسطين منفداً لحرف الرأي العام في بلديهما وفي العالم عن ملاحقة فسادهما. ولأن العرب في القعر فقد وجد الرجلان في عرب هذه الساعة المنقلبة حلفاء معلَنين أو مضمَرين من أجل شطب الشعب الفلسطيني، والتلاعب بمصير فلسطين والمنطقة، والتعبير عن أحقادهما الكولونيالية. المفاجأة لم تكن خطاب ترامب، ولا الصلف الإسرائيلي الذي صاحبه؛ المفاجأة هي ادعاء الحكام العرب والقادة الفلسطينيين بأنهم فوجئوا. مسألة القدس بالنسبة إلى الثنائي نتنياهو ـ ترامب انتهت من زمان، وجاء الإعلان الأمريكي من أجل إقفال الملف وليس فتحه كما يظن بعض السذّج. الأنظمة العربية تمثل وتكذب، وغداً سيكشف لنا التاريخ أن هذه الصفقة لم تكن ممكنة إلاّ بسبب هوان الأنظمة وتواطئها.
من جهة أُخرى، فإن بعض ردات الفعل اتسم بالسذاجة، ولعل الأكثر سذاجة بينها هو شعار أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين. في هذا القول تقليد للمقولة الصهيونية بأن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل. في الصراع الفكري مع الصهيونية يجب عدم السقوط في فخ خطابها. مجرد استخدام كلمة الأبد هو سقوط في الفكر الغيبي الذي قد يصل بسهولة إلى الفاشية. تذكروا ماذا فعل بنا أبد المستبدين العرب، وإلى أي دمار أوصلنا. ليس هناك لا عواصم أبدية ولا دول أبدية: لا إسرائيل أبدية ولا فلسطين أبدية، فالأبد هو نقيض التاريخ وسقوط في الشعوذة. الصراع ليس على الأبد أو على الماضي، إنه صراع في الحاضر وعلى الحاضر من أجل الدفاع عن عروبة القدس بصفتها لم ولن تكون إلاّ مدينة عربية.
إلى أين نسأل؟
قبل محاولة الإجابة يجب أن نؤكد حقيقة أن القدس، فضلاً عن رمزيتها الثقافية والدينية، هي جزء من الضفة الغربية الفلسطينية التي احتُلت منذ سنة 1967. فصل القدس العربية عن محيطها بالجدار والمستعمرات كان محاولة لطمس هذه الحقيقة. وحين أعلن الرئيس الأمريكي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، فإنه شرعن احتلال الضفة الغربية بأسرها.
فلسطين هي القدس والقدس هي كل فلسطين
هذه هي الحقيقة الفلسطينية اليوم، وهي حقيقة يجب أن تدفع الفلسطينيين إلى إعادة النظر في مجمل الاستراتيجية الفلسطينية منذ أوسلو وهزيمة الانتفاضة الفلسطينية وما استتبعتاهما من سياسات رضوخ ووهم. قال «الأمريكي البشع» بوضوح لمَن يدّعي أنه لم يفهم أن اللعبة القديمة انتهت، إن مَن يتوسل الحماية الأمريكية لنظامه الاستبدادي المتهاوي عليه أن يدفع الجزية أولاً، ثم يعلن جهاراً أنه جزء من صفقة القرن التي تريد إسدال ستار نهائي ليس على فلسطين وحدها، بل على العالم العربي أيضاً.
إلى أين نسأل؟
سؤال اليوم هو السؤال الذي لم يعد تأجيله ممكناً. منظمة التحرير اكتسبت شرعيتها الفلسطينية والعربية والدولية عندما كانت منظمة الفدائيين. حين كان النضال هو البوصلة كانت فلسطين، وحين يغيب النضال تندثر فلسطين.
أين المقاومون؟
في اللحظة التي سلّمت فيها القيادة الفلسطينية أوراقها لكذبة سلام الاستسلام، وخضعت لإملاءات الرباعية الدولية، وقامت بالتنسيق مع المحتل من أجل تغطية احتلاله، بدأت فلسطين تتشظى وتندثر، وصار وهم السلطة وهناً، وتحوّل الشكل السلطوي إلى صَدَفَة تحمل في داخلها جثة المحارة التي كانت. القدس اليوم هي العنوان، أمّا المتن فهو فلسطين. أهمية خطاب ترامب تكمن في أنه أعلن بشكل رسمي نهاية مرحلة انتهت منذ أعوام. المرحلة التي كانت حبلى بالسراب انتهت. وعلى فلسطين أن تعود إلى الأول كي تبدأ من جديد. والأول هو مشروع تحرر وحرّية، إنه المشروع الذي يحمل اسمين: الدولة الديمقراطية العلمانية و/ أو الدولة الثنائية القومية.
والاسمان هما عنوانان للنضال من أجل الحرية والمساواة: الحرية للفلسطينيين عبر ممارسة حقهم في تقرير المصير وحقهم في العودة إلى بلادهم التي طُردوا منها بالعنف والقتل والتطهير العرقي، والحرية لليهود أيضاً عبر تحريرهم من العنصرية الصهيونية ومن التعالي العنصري كي يعيشوا في وطن واحد مع ضحيتهم في ظل نظام من المساواة.
إنه نضال طويل ومؤلم.
لكن الحرية هي قدر الأحرار، فالشعب الفلسطيني في نكبته المستمرة يقدم احتمال خروج فلسطين ومعها المنطقة العربية من قاع التردي والانحطاط. وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني سيكون، كما كان دائماً، وحده في المواجهة التي تحمل في داخلها احتمال تصويب البوصلة العربية، ومنع السفهاء والمنافقين من الاستمرار في لعبة المتاجرة بالأوطان، وفي لعق مبرد الثورة المضادة.
بوصلة العالم العربي لها وجهة واحدة اسمها فلسطين.
هنا، في الأرض المستباحة، يعرف الشعب الفلسطيني ألا خيار له سوى البقاء والصمود والمقاومة. وشوارع الحرية في انتظاره. وهي شوارع تبدأ في القدس وتمتد إلى كل فلسطين، ومنها إلى المشرق العربي.
○ افتتاحية العدد الجديد (113) شتاء 2018 من مجلة «الدراسات الفلسطينية» الذي يصدر أوائل الأسبوع المقبل.
القدس العربي