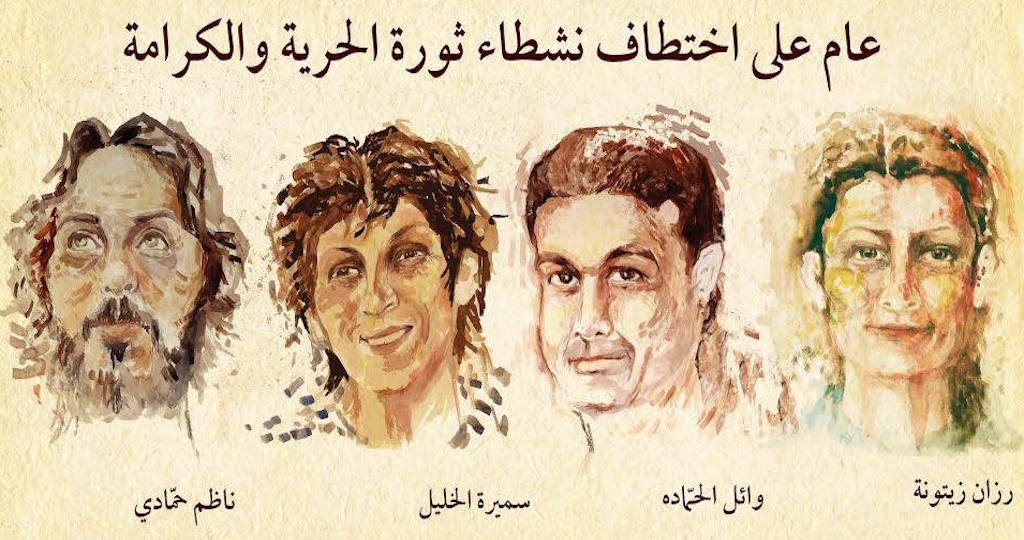عن السياسة الروسية في سورية –مقالات مختارة-

التلاعب الروسي/ علي العبدالله
عكس التحرك السياسي والدبلوماسي والعسكري الروسي إزاء المواجهة المحتدمة في مدينة حلب عن وجود ثلاثة مستويات لهذا التحرك، مستويات متداخلة ومتكاملة بهدف تحقيق نتيجة محددة سلفا ألا وهي تحقيق “انتصار” في حلب إن عبر تحقيق نصر سياسي بقبول القوى الإقليمية والدولية بإخراج فصائل المعارضة، جميع الفصائل، من شرق حلب أو عبر تحقيق حسم عسكري بالسيطرة على الأحياء الشرقية.
أخذ المستوى الأول شكل حملة إعلامية هدفها تشويه صورة الفصائل المسلحة وداعميها الإقليميين والدوليين عبر إبراز تعاونهم وتنسيقهم مع “جبهة فتح الشام” المصنفة دوليا كحركة إرهابية، وتحميلهم مسؤولية استمرار معاناة المدنيين في هذه الأحياء، بالحديث عن منعهم المدنيين من مغادرتها تارة وفرض إتاوة على الخروج قدرها 150 دولارا للفرد الواحد تارة أخرى، لتبرير مواصلة الحملة العسكرية ضدهم من جهة، ومن جهة ثانية تحسين صورة روسيا عبر تكرار الإعلان عن عدم قيام القوات الفضائية والجوية الروسية بأية غارات على هذه الأحياء طوال الشهر ونصف الشهر الأخيرة، والإعلان عن قبولها بإدخال المساعدات الإنسانية الى هذه الأحياء بعد الحصول على ضمانات كافية للعملية، والدعوة إلى إقناع الفصائل بالانسحاب من هذه الأحياء وإلا “فانه سيتم التعامل معها على أنها ارهابية”، والانخراط في مفاوضات مع قادة عدد من الفصائل المشاركة في القتال في حلب(10 فصائل بينها “حركة أحرار الشام” التي تصنفها حركة إرهابية، ربما قبلت مشاركتها لإغواء تركيا بإطعامها جوزة فارغة) في أنقرة برعاية تركية لإقناعها بالابتعاد عن الفصائل المتطرفة والقبول بمبادرة المبعوث الدولي بإخراج “جبهة فتح الشام” من هذه الأحياء، ورعاية الجيش الروسي “مصالحات” ريف دمشق والتي تقضي باخراج المقاتلين واسرهم من هذه المناطق ونقلهم الى محافظة ادلب، والإعلان عن استعدادها لإجراء مباحثات مع جميع أطراف الصراع في سوريا. أما المستوى الثاني فأخذ شكل حملة دبلوماسية تطالب بالعودة الى المفاوضات لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار 2254، ومطالبة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بالدعوة الى جلسة مفاوضات جديدة في جنيف وانتقاد تقاعسه وعدم جديته في القيام بمهمته كما يجب، جاء الانتقاد ردا على أطروحات المبعوث الدولي حول أحياء شرق حلب وخاصة دعوته للاعتراف بالمجلس المحلي وحقه في إدارتها، ودعوة واشنطن الى استئناف المفاوضات الثنائية حول الوضع في سوريا وتنفيذ الاتفاق السابق حول الفصل بين المعارضة المعتدلة والمتطرفة واستهداف الأخيرة في عمل عسكري منسق ومشترك، والانخراط في مباحثات مع تركيا تحت شعار “إيجاد حل سياسي في سوريا”، واعتماد سياسة الجزرة معها بهدف ضبط الحدود والتعاون ضد الفصائل المسلحة وانسحابها العسكري من معركة حلب وإبعادها عن حلفائها المحليين والإقليميين. وقد أخذ المستوى الثالث شكل تحرك عسكري واسع وعنيف شمل ريفي دمشق ودرعا ومحافظة إدلب والمناطق الجنوبية الغربية في محافظة حلب حيث استهدفت المواقع العسكرية والمدنية، وخاصة المستشفيات والأفران والأسواق الشعبية، دون تمييز، مستخدمة ذخائر شديدة التدمير، لإرباكها وعرقلة أية محاولة لدعم الفصائل التي تقاتل في مدينة حلب مباشرة أو عبر مهاجمة قوات النظام في مواقعها ما يضطره لاعادة توزيع قواته على أكثر من جبهة وتخفيف حشده في حلب، بالإضافة الى مد قوات النظام والميليشيات الشيعية اللبنانية والعراقية والأفغانية والباكستانية بأسلحة حديثة ومتطورة وذخائر خارقة حارقة، ومراقبة ساحات المواجهة الدائرة على الأراضي السورية والعمل على ضبط إيقاعها، تحفظها على توسيع عملية “درع الفرات” لتشمل مدينة الباب، بحيث لا تؤثر على تصورها للحل في سوريا، كل هذا مع الإعلان عن “انه لا يوجد حل عسكري للصراع في سوريا”.
ربط محللون بين التحرك الروسي بمستوياته الثلاثة والقلق من تطورات المواجهة الدبلوماسية والعسكرية واحتمالاتها ونتائجها الميدانية ومترتباتها السياسية والإستراتيجية، فالمعركة في الأحياء الجنوبية الشرقية في مدينة حلب، حيث الأبنية متلاصقة وتحتها خنادق وتخترقها معابر، لن تكون سهلة وكلفتها البشرية لن تكون بسيطة، ناهيك عن أن التركيز الإعلامي والسياسي على تطورات الموقف فيها لن يسمح بحركة حرة وحاسمة، خاصة والتحركات الدبلوماسية والسياسية الإقليمية والدولية(الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية) لا تتابع الموقف عن قرب وبشكل دقيق فقط بل وتطالب باتخاذ مواقف عملية لوقف قتل المدنيين وتدمير المدينة، وهذا ركز مزيدا من الضغط السياسي عليها، علما انها لا تريد العودة الى العزلة والنبذ وترغب، في الآن نفسه، استثمار الظرف وتسجيل مكسب سياسي بفرض رؤيتها للصراع في سوريا وعليها والبناء عليه في المساومات القادمة مع الإدارة الأميركية الجديدة، خاصة والرئيس الروسي يراهن على المكاسب الخارجية لضبط المشهد الداخلي، فقد سبق واستثمر انجازاته الخارجية في جورجيا وأوكرانيا في احتواء ردود الفعل المحلية على الفساد وتدني مستوى المعيشة والتضخم وتآكل سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، عبر اعتبار المنظمات الحقوقية والمدنية عميلة للخارج، وتعزيز أجهزة القمع، جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الدفاع ومجلس الأمن، وفرض قيود على شركات الإنترنت وتشديد الرقابة على وسائل الإعلام، وتشديد قوانين مكافحة التطرف والإرهاب. وقد زادته مكاسبه الأخيرة، من المكاسب العسكرية في سوريا، وخاصة إقامة قواعد عسكرية دائمة فيها، الى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية وفوز فرانسوا فيون كمرشح للرئاسة الفرنسية في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي وقبلها انتخاب رئيسين صديقين في بلغاريا ومولدافيا، جرأة وتطلعا الى فرض تصوراته على الخصوم والأصدقاء فوسّع مطالبه بانسحاب كل الفصائل من شرق حلب، والتهديد في حال رفضها الخروج باعتبارها إرهابية واستهدافها دون هوادة، ورفض إدخال مساعدات إنسانية الى الأحياء الشرقية قبل أن تعلن الفصائل قبول الانسحاب من هذه الأحياء، وقدم شرطين لقبول الاتفاق مع هذه الفصائل في مفاوضات أنقرة: الأول، موافقة دمشق على هذا الاتفاق. الثاني، وقف المعارضة معارك جنوب غربي المدينة، علما أن طلب موافقة دمشق يعني ضرورة موافقة طهران التي تشرف على ميليشيات بينها حركة النجباء في جنوب شرقي حلب، وطلب وقف معارك جنوبي غربي حلب، يعني دفع الفصائل الى إشكالية وتوتر مع جيش الفتح، الذي يضم سبعة فصائل بينها “أحرار الشام” و “فتح الشام”، ورفض الدعوات الى وقف إطلاق النار واستخدم حق النقض(الفيتو) ضد مشروع القرار المصري الاسباني النيوزيلاندي.
استغرب البعض استخدام الصين لحق النقض(الفيتو) متناسين الصراع المفتوح بين بكين وواشنطن على خلفية السيطرة على بحر الصين ومد خط المياه الإقليمية الصينية وإعلانات الرئيس الأميركي المنتخب حول التصدي للصين وتحميلها مسؤولية احترار الأرض ومكالمته الهاتفية مع رئيسة تايوان التي تتبنى سياسة الانفصال عن الصين، قبيل إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة استكمالا لاتفاقات لوزان على أمل انجاز اتفاق يضع الإدارة القادمة أمام أمر واقع، والإمساك بأوراق رابحة في أية مساومة إقليمية ودولية.
تتطلع موسكو الى تحقيق هدفها في خروج جميع مقاتلي المعارضة من شرق حلب بأقل كلفة ممكنة لذا فهي تناور وتعتمد تكتيك الانتقال من التصعيد العسكري الى التهدئة، وتراهن على خلق انقسامات ومواجهات بين هذه الفصائل بحيث تضعف بعضها بعضا وتقودها الى القبول او الهزيمة.
المدن
سورية.. تقاسم روسي إيراني/ بشير البكر
تتطوّر استراتيجية روسيا في حلب على نحو سريع جداً، من الضغط لفتح طرق خروج للمدنيين إلى المطالبة بمغادرة مقاتلي جبهة النصرة المدينة، ثم إلى انسحاب جميع مقاتلي المعارضة، وأخيراً إجلاء سكان الشطر الشرقي البالغ حوالي 300 ألف، الأمر الذي يصبّ في إطار ترتيباتٍ باتت جاريةً على الأرض، تقوم على تقاسم سورية بين روسيا وإيران، تكون الحصة الكبيرة فيها للطرف الروسي الذي تولى مهمة إنقاذ النظام من الانهيار، حين تدخّل قبل حوالي عام.
وحدها روسيا تصول وتجول في الساحة. ولم يعد النظام السوري وحليفه الإيراني يمتلكان حق الحديث بحريةٍ تامة، طالما أن هناك من يتولى العملين العسكري والدبلوماسي. في مجلس الأمن، يتحكّم المندوب الروسي، فيتالي تشوركين، في مجرى كل المفاوضات، ومنذ بدء الثورة السورية، رفع يده بالفيتو ست مرات، من أجل تعطيل قرارات دولية، كان من بينها ما يدعو إلى إدخال الحليب والخبز. وهنا، تجدر الإشارة إلى أنه لم يعد هناك أي فرن لإنتاج الخبز في شرقي حلب منذ 15 يوماً، ومن بقوا على قيد الحصار هناك يتدبرون أمورهم بوسائل بدائية جداً.
على المستوى العسكري، يتحكم الطيران الروسي في مجرى العمليات، فهو الذي يؤمّن التغطية الناريّة الأساسية، ويفتح الطريق أمام القوات الأرضية، ويجري الحديث، هنا، عن أمر جديد، هو بدء سيطرة الروس على المليشيات المقاتلة، وهناك من يؤكد أن لواء القدس في حلب الذي كان يعتمد على إيران، مالياً ولوجستياً، صار في عهدة الروس بصورة تامة، ولا ينفصل عن ذلك مشروع إنشاء الفيلق الخامس من متطوعين برواتب مغرية، يدفعها الروس بالدولار. ويقول خبراء يتابعون الشأن العسكري إن الروس لا يعتمدون على جيش النظام، ولا يثقون بأجهزة استخباراته. ولذا، أجروا تغييراتٍ واسعةً في أجهزة الأمن، بما فيها الحرس الخاص لبشار الأسد الذي كان يتولاه الإيرانيون، واستبدلوا قائد الحرس الجمهوري، اللواء بديع علي، بطلال مخلوف، وبدل رجل بشار الأسد، علي مملوك، صاروا يعتمدون أمنياً على اللواء ديب زيتون، رئيس الاستخبارات العامة. وقد شرعوا بتعزيز وجودهم في مايو/أيار الماضي، عن طريق بناء قاعدة عسكرية جديدة في تدمر، وهو أمر كشفته منظمة أميركية للمحافظة على التراث، ونشرت المدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية ومبادرات التراث الثقافي صورا التقطتها أقمار صناعية، تُظهر أعمال البناء القائمة على حدود موقع أثري دمره داعش.
وقال الباحث مايكل دانتي، إنّه لم يكن متوقعاً أن يبني الروس قاعدة عملياتٍ متقدمةٍ على جزءٍ من مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، وحذّر من أنّ الآليات الثقيلة ومواقع الأنظمة المضادة للطائرات والمناطق المخصصة لناقلات الجند تقوم بتعديلاتٍ في الموقع.
كان الظن أن الروس سوف يدعمون النظام من أجل تغيير موازين القوى، لفرض حل سياسي يُبقي بشار الأسد، رغم أنف المعارضة والمجتمع الدولي، غير أن الموقف تغيّر، وصارت التقديرات تتحدّث عن انتداب على سورية المفيدة التي عمل النظام والإيرانيون على أن تقتصر على المدن الكبرى، والتخلي عن الأرياف والصحارى. ولن يتأخر تطور المجريات عن كشف خريطة سياسية اقتصادية، تقوم على السيطرة على مصادر الثروات من جهة، وضمان أمن إسرائيل من جهة ثانية، ويجري فيها توزيع النفوذ، بحيث يصبح الشطر الجنوبي الغربي تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، والقسم الشمالي الغربي وتدمر تحت سيطرة الروس الذين سيحتفظون بالقسم الأكبر، وتكون لهم سلطة القرار.
باتت المعارضة السورية على وعيٍ بما يحصل، لكنه وعي متأخر، لا يستطيع أن يقدّم أو يؤخّر، وتقدر أوساط المعارضة أن الولايات المتحدة على إدراك لهذا المخطط، وغير مكترثة به. ولذلك، كان مندوبها، مايكل راتني، ينصح “الائتلاف” بضرورة التفاهم مع الرو
العربي الجديد
شائعات الأسد وبوتين/ فاطمة ياسين
انتشر، منذ أسابيع، خبر عن مرضٍ عضال أصاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأن الأخير ينوي التنحي بحلول العام 2017. صدر الخبر عن دوائر شبه رسمية، وتحدثت عنه شخصيات مقربة من النظام الروسي، ما استدعى التأمل والتصديق. ومؤكّد أن للروس، ذوي الأساطيل الحربية الموزعة في أرجاء الشرق والغرب، غاية من نشر الشائعة التي اختفت بعد أيام، من دون أن يكذّبها أي طرف.
الشائعات وسيلة حربية لإشاعة الحيرة والبلبلة والأمل أو القنوط، استُخدمت مع بداية النزاعات التي وثقها التاريخ، وقد انسحب الروس من الحرب العالمية الأولى، بتأثير شائعاتٍ عديدة، بثها الألمان لتقوية الثورة البلشفية في الداخل الروسي. نجحت الثورة ووصلت إلى السلطة في البلاد، وتسببت في توقيع صلح روسي ألماني دُعي صلح “برست ليتوفسك”، انسحب على إثره الروس، وتركوا حلفاءهم الإنكليز والفرنسيين في مواجهة ماكينة الحرب الألمانية.
قبل بلوغ القوات الألمانية حدود بريطانيا، روج الإنكليز شائعةً عن وصول مليون جندي روسي لحماية بريطانيا من الخطر الألماني القادم، وتفنّن الإعلام الإنكليزي في سرد مواقعهم وخططهم. لعبت تلك الشائعة، بالإضافة إلى دخول الولايات المتحدة الأميركية الحرب إلى جانب الحلفاء، دوراً كبيراً في هزيمة الألمان في الحرب. وربما كان ذلك سبباً دفع هتلر، فيما بعد، إلى تشكيل وزارة متخصصة، دعيت وزارة البروباغندا، ترأسها جوزيف غوبلز، أحدُ أبرز مؤسسي عِلم الشائعات.
روسيا بوتين التي طالما دعمت نظام الأسد أمدته بخططٍ، منها فكرة الاستفادة من الدعايات التي تُشاع عنه، سواء أكانت لصالحه أو ضده، ولطالما تورّط مسؤولون وسفراء روس في ترويج شائعاتٍ تخص الأسد، فتحدثوا عن هروبه ووصوله إلى إحدى الدول لاجئاً، أو حتى مقتله. كان اعتمادهم هنا بشكل رئيس على وسائل “السوشيال ميديا” التي تتيح لناشر الخبر التنصل منه عن طريق “تغريدة” لاحقة.
ومنذ أيام، عرضت قناة روسيا اليوم حادثة اختراق موقع وزارة الإعلام السورية الذي بث خبراً عن تسمم بشار الأسد في أثناء تناوله وجبة طعام. تثير طريقة صياغة خبر التسمم استفساراتٍ كثيرة، إذ لم يحمل الجديّة والرصانة المعهودة لمؤسسةٍ شبه عسكرية، تهتم بمنشوراتها إلى حد الهوس، حتى يستطيع المتابعون ابتلاعه على أنه خبر حقيقي صادر عن مؤسسة رسمية، ولا هو خبر كوميدي ذو طابع ساخر على طريقة المهكّرين الذين تتلخص غايتهم في التأكيد على إمكانيتهم الوصول إلى أي مكان.
تأكد كاتبو الخبر من عدم إغفال الصفة الرسمية للأسد التي تسبق ذكر اسمه، واستخدموا كلماتٍ ذات وقع غريب، من قبيل “العملية الشنيعة”، وقالوا إن التسمم قد تسبب في إصابة الأسد بمرض معدٍ خطير!
بعد خروج أولى المظاهرات ضد نظام الأسد في مارس/آذار 2011، نشب نزاعٌ إعلامي شرس بين طرفي الصراع. بدأ الهجوم معارضاً، وانتشرت شائعاتٌ عن انقلاباتٍ قام بها أفراد من بطانة الأسد ضده، وروجت أخبار عن مقتله أو تصفية أحد أفراد عائلته أو أقربائه. حظيت تلك الشائعات باهتمام واسع لدى السوريين، لكنها، في الواقع، أدت مفعولاً عكسياً، فكان الأسد يظهر بعد كل إشاعةٍ، ويتحدث بثقة تامة تصيب معارضيه بالخيبة. وعلى الرغم من أن فن الشائعات قديم، وأثبت نجاعته منذ أمد طويل، إلا أن الشائعات لم تنل من متانة قبضة النظام على البلاد، بل على العكس قرّر الاستفادة منها لاحقاً، وساعد في انتشارها بطرق عديدة، ريثما يتم دحضها لاحقاً، فتنهار الكذبة وينهار معها جزءٌ من مصداقية إعلام المعارضة الذي كان يعتمد أساساً على ما يتم تناقله عبر صفحات “فيسبوك”.
لا تتطلب الشائعة برهاناً أو دليلاً دامغاً، بل يكفي إدراجها في سياق منطقي، ووجود رغبة لدى المتلقي بتصديقها، لكن تكرار إثارة النوع نفسه من الأكاذيب عطل شَرطية تصديقها بشكل كبير، وأصبح العبء كله واقعاً على السلاح والطائرات لعمل تقدّم على الأرض.
العربي الجديد
الطلب على بوتين… وعلى روسيا أيضاً/ حازم صاغية
منذ أن شاع خبر «القروض» التي حصلت عليها «الجبهة الوطنية» الفرنسية، وقيمتها تفوق الـ11 مليون دولار، راحت الصحف الغربية تُفرد مساحات أوسع للتمويل الروسي الذي تحظى به تنظيمات قومية متطرفة، في أوروبا والولايات المتحدة، وتتشارك في توفيره الحكومة والكنيسة ومعاهد بحثية وإعلامية في موسكو.
بيد أن المسألة تنتهي بالتمويل ولا تبدأ به. فوفقاً لتحقيق نشرته «نيويورك تايمز» في 3 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، يتبين أن الإعجاب ببوتين يتعداه إلى حب روسيا نفسها، كما يتجاوز زعامات شعبوية كترامب، أو يمينية تقليدية كفيون، إلى تنظيمات صغرى ومتوسطة على جانبي الأطلسي، من «بريطانيا أولاً» و «الحزب القومي البريطاني» إلى «الحزب التقليدي العمالي» الأميركي، ومن «الفجر الذهبي» اليوناني إلى «اليمين الجديد» الروماني…
هكذا، مثلاً، يرى ماثيو هايمبان، زعيم «الحزب التقليدي العمالي»، المتشدد في القومية البيضاء والدفاع عن الحضارة المسيحية، في بوتين «قائداً للعالم الحر»، فيما يجزم سام ويكسون، وهو قائد سابق لـ «كوكلوكس كلان»، بأن «روسيا الموقع الحدودي في أقصى الشرق لشعبنا»، وأن الروس «العازل بيننا وبين الغزو الشرقي لوطننا والحامي الكبير للعالم المسيحي. إنهم الشعب الأبيض الأقوى على الأرض». ويضيف أودو فويت، زعيم «الحزب القومي الديموقراطي» في ألمانيا، الذي يخون المستشارة مركل لفتحها الباب أمام النازحين السوريين: «نحتاج إلى مستشار كبوتين، إلى شخص يعمل لألمانيا وأوروبا كما يعمل بوتين لروسيا».
والحال أن الرئيس الروسي لم يعبر عن آراء ومواقف كالتي تطلقها التنظيمات المتشددة هذه. وهو لم يتورع عن اعتقال بعض تابعيها الروس القائلين بالتفوق الأبيض. إلا أن الإعجاب الذي يلقاه في صفوف تنظيمات كهذه يكمل الحب الذي يُمحَض لبلده روسيا («الروسيا») بوصفها القبلة والنموذج.
وإذا كانت الأزمة الراهنة للديموقراطية الليبرالية والصعود الكوني للسياسات الشعبوية يفسران الإعجاب بسيد الكرملين، والذي بات يسهله على الجماعات اليمينية في الغرب انهيار الشيوعية السوفياتية، فإن محبة روسيا أعقد قليلاً.
فهي بلد كبير وقوي، خصوصاً متى كُتبت قيادته لزعامة عدوانية كزعامة بوتين. لكنه، إلى ذلك، يتمتع بدرجة بعيدة نسبياً من الصفاء العرقي الأبيض، الذي يزيده صفاءً أن روسيا نفسها ليست بلداً يقصده المهاجرون، أو يفتح ذراعيه لهم، مما يهدد ذاك الصفاء ويعرضه لتأثيرات أعراق وأجناس «منحطة». بهذا يلوح البلد المذكور خزاناً بشرياً لبيض المجتمعات الغربية، الديموقراطية والتعددية، ممن تساورهم هواجس الانقراض فيعادون الديموقراطية والتعدد. لكن روسيا عندهم خزان أفكار تقليدية كذلك، إذ هي حصن القيم المسيحية الشرقية أيضاً، لا سيما في مواجهة الإسلام، حيث أبلت البلاء الحسن على رقعة تمتد من الشيشان إلى سورية. هكذا التقت رجعيتا الأمة وزعيمها عند سياسة جنسية متطرفة في عدائها للممارسات «غير المقبولة»، كالمثلية والتحول، مما تناوئه بشدة تلك التنظيمات الغربية الداعية إلى نقاء الجنس والعرق. ومن هنا يفد العداء المشترك للعولمة والأمركة والكوزموبوليتية والروابط العابرة للحدود القومية، كالاتحاد الأوروبي أو حلف الأطلسي الذي يخافه الروس خوف الطاعون. وفي محفل من الأفكار كهذا، تقيم دائماً جرعة، قوية أو معتدلة، من اللاسامية، إذ اليهود، تبعاً للتقليد الخرافي الرائج، هم الرموز الدائمون لتلويث الأوطان والأديان والقوميات.
وقصارى القول إن الطلب على روسيا، بنقائها النسبي الأبيض، ومسيحيتها الشرقية الأقل تقدماً، وقيادتها العدوانية، يرقى إلى حاجة تسعى إليها البؤر المتخلفة في البلدان الديموقراطية الغربية. وهذه عواطف كان قد برز بعضها في حرب البوسنة في التسعينات، حيث أطلت المسيحية الأرثوذكسية مصحوبة بالسلافية والتفاخر القومي لتدافع معاً عن نقص غربيتها وانهجاسها بـ «الخصوصية» تلك.
ومذاك نمت لهذه العواطف أنياب تقضم راهناً مدينة حلب «المسلمة» و «الكوزموبوليتية» في آن، وتحاول أن تستعيد الأنياب السوفياتية. فـ «الروسيا» سبق أن قاتلت الديموقراطية الليبرالية من «يسارها»، وكان اسمها يومذاك الاتحاد السوفياتي، وها هي تقاتلها اليوم من «يمينها»، واسمها روسيا البوتينية، أما الهدف فواحد يجمع بين الشُلل اليمينية والفاشية، القليلة «الغربية»، في الغرب، والشُلل العسكرية والأمنية، المتسترة على «شرقيتها» الحادة بادعاء «غربية» بالغة الشكلية، وبزعم علمانية تكافح الإسلام بوثنية ترفع الأسد وبوتين (ونصرالله وأنطون سعادة…) إلى مصاف الآلهة. وعندهم جميعاً، كلما كثر الكلام في «الحضارية»، انكشف نقص التحضر وزاد تهديد الحضارة، وصولاً إلى الهندسة السكانية التي وعد بها مؤخراً حاكم سورية.
الحياة
انتداب روسي أم سيادة إيرانيّة – روسيّة مشتركة في سورية؟/ جورج مالبرونو
تُرسى أسس نظام انتداب روسي في سورية، بعد عام على التدخل الروسي العسكري من أجل إنقاذ نظام بشار الأسد. «فالروس يمسكون بمقاليد القرار الرئيسية، لكن هذا ليس بيسير»، يقول خبير أجنبي في دمشق لا يرغب في الإفصاح عن اسمه. والجيش وأجهزة الاستخبارات هما في مرمى الروس. «وإثر تقييم عمل عدد من القادة، نجح الروس في فرض بدائل عنهم، لكنّ بعضاً آخر لا يزال في عمله»، يقول الخبير. ونزولاً على طلب الروس، استبدل بشار الأسد قائد الحرس الجمهوري، اللواء بديع (مصطفى) علي، بطلال مخلوف. وفي عالم أجهزة الاستخبارات، ليس علي مملوك، رئيس مجلس الأمن القومي النافذ، رجل موسكو، بل رجلها هو اللواء ديب زيتون (رئيس شعبة الاستخبارات العامة) الذي زار أخيراً إيطاليا ومصر. والروس لا يأمنون جانب المملوك ويحذرون منه، على رغم أنهم يستقبلونه دورياً. «فهو رجل الأسد، وخبرته كبيرة، وليس طيعاً»، يقول رجل أعمال مقرب من السلطة.
ووجّهت موسكو سهام النقد الى الطريقة الإيرانية أو النهج الإيراني الذي يتوسل بميليشيات للتعويض عن نقص عدد السوريين الراغبين في القتال. ورغبت في وقت أول، في إنشاء جيش جديد يمتص الميليشيات ويدربها. وبعد أكثر من عام من مساعي إعادة هيكلة الجيش السوري، أنجز الروس ما يسعون إليه. والثلثاء الماضي (في 22 الشهر الجاري)، أعلن عن إنشاء القوة الخامسة المؤلفة من عشرات آلاف المتطوعين الذين يتقاضون بدل عملهم بالدولار. «لم يشأ الروس التعامل مع الميليشيات. لكنهم لم يوفّقوا»، يقول مسؤول في النظام. واليوم، تضطر روسيا الى الاستعانة بقوات مكملة من خارج الجيش، على غرار لواء القدس من مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين، على أطراف حلب. وفي الماضي القريب، كانت إيران تدرب اللواء هذا وتسلّحه. لكن رجاله اليوم يعتمدون مالياً ولوجيستياً على الروس.
وعلى شاشة كمبيوتره المحمول في مركز تحت الأرض في حلب، يردد أحمد، مسؤول الأمن السياسي، كلمات بالروسية يذكرها من إعداده المهني على يد جهاز الاستخبارات السوفياتية السابق، «كي جي بي»، بينما يريه أحد العملاء صور صفحات فايسبوكية ابتكرت للتواصل مع جواسيس في صفوف الثوار شرق حلب. وروسيا يشغلها رأي سكان حلب الشرقية في تدخّلها العسكري. لذا، أنشأت خلية مراقبة إلكترونية في قاعدة حميميم الجوية الساحلية. وفي هذه الخلية، يراقبون كل ما يقال على شبكات التواصل الاجتماعي في المناطق المنتفضة، يقول عسكري سوري يتواصل مع الروس. و»بعد الرصد، ينقلون إلينا النتائج، للتنسيق».
وتقاسم الروس والإيرانيون سورية: الشطر الجنوبي – الغربي في يد الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله»، والشطر الشمالي – الغربي وتدمر في يد رجال الكرملين الذي يشيدون على مقربة من المدينة الأثرية قاعدة عسكرية. وضمن الضباط الروس خروج الثوار من داريا وترحيلهم من ضاحية دمشق الى إدلب، في شمال – غرب سورية التي تقصفها روسيا. وفي قدسيا، أشرف الجيش السوري على خروج المتمردين، في وقت يمسك «حزب الله»، على مقربة من الحدود اللبنانية، بمقاليد مضايا والزبداني. ولا يخفي الضباط السوريون التباين مع الروس. «نرغب في استعادة سورية كلها، بينما الروس يكتفون بسورية المفيدة»، يقول مقرب من بشار الأسد. وترمي موسكو الى استعادة المدن الأخيرة والضواحي المحيطة بها وشبكة أنابيب النفط والغاز في البلاد، وترك الأرياف والصحراء للثوار. والتكتيك هذا يعيد الى الأذهان النهج الجزائري في مكافحة «الجماعة الإسلامية المسلحة». ويشعر محيط الرئيس السوري بالامتنان للروس. فهم أنقذوهم في صيف 2015، لكن أحد مستشاري الأسد لا يخفي قلقه، ويقول: «نحن لا نتحكم بمسار المفاوضات» على مرحلة انتقالية. ويبدو أن المستشار هذا يخشى أن يتخلى الحليف الروسي عن سيد دمشق.
وفي الربيع، اضطرت الاستخبارات الروسية الى التدخل والطلب من «حزب الله» ودمشق وقف أعمال بنى تحتية عسكرية بدأت الميليشيا الشيعية بحفر أنفاقها على مقربة من الجولان المحتل. فموسكو حريصة على علاقاتها برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وأفلحت في ثني حلفائها عن إنشاء قاعدة خلفية لنزاع مقبل مع تساحال. وتواجه الروس والإيرانيون حول مسألة تعيين حرس الرئيس الأسد، وهو مؤلف من سوريين وإيرانيين.
لكن، أهو انتداب روسي؟ أم سيادة مشتركة روسية – إيرانية؟ مهما كانت الصيغة، لا مناص من قبول الهيمنة الروسية، والأسد لا يسعه المناورة. فهو في حرب، يقول ديبلوماسي عربي في دمشق. وعلى رغم أن الروس قادرون على توجيه دفة الشؤون العسكرية، لن يساهموا في إعادة الإعمار. وفي الأشهر الأخيرة، سرعت موسكو وتيرة خططها العسكرية لتضع دونالد ترامب أمام الأمر الواقع، قبل استلامه مقاليد الحكم. وسعت موسكو الى إرضاء حلفائها الأكراد، فأعدت دستوراً جديداً وسمته بدستور الجمهورية السورية، وليس الجمهورية العربية السورية. وفي طرطوس، يحوّل الجيش الروسي المنشآت العسكرية الى قاعدة بحرية دائمة، وهو نشر الدرع المضادة للصواريخ أس – 300 في حميميم لتكمل عمل منظومة الصواريخ «أس – 400». ويسعى بوتين الى تحييد دول الجوار. فهو استمال مصر، وفاز بصمت الأردن وإسرائيل مقابل تحييد «حزب الله»، وفاوض الأتراك على تغيير سياستهم في الصيف الماضي. و»من قاعدة حميميم، رصدت الاستخبارات الروسية معلومات مفيدة عن محاولة الانقلاب على أردوغان سلّمتها الى الأتراك»، يقول الديبلوماسي العربي. لكن إبعاد أنقرة وتحييدها ليسا مضمونين، على رغم أن الأتراك وعدوا الروس بألا يتجاوز تدخّلهم في سورية 12 كلم»، يقول مقرب من الأسد. لكنهم نكثوا بوعدهم والثوار يتقدمون نحو الباب.
* مراسل، عن «لوفيغارو» الفرنسية، 24/11/2016، إعداد منال نحاس
الحياة
هل أنقذ بوتين الأسد؟/ خالد الدخيل
عملياً سقطت حلب في يد النظام السوري بدعم روسي استكمل دعماً إيرانياً كان يؤذن بالفشل. حصل ذلك بانكفاء أميركي متعمد شكّل عملياً غطاء سياسياً للتدخل الروسي. في هذه الأثناء بدأ الرئيس بشار الأسد يتحدث عن نصر قادم، وعن إعادة الإعمار، وتوزيع شهادات الوطنية على السوريين. قال الخميس الماضي في حديث لصحيفة «الوطن» السورية إن «من يربح في دمشق أو حلب يحقق إنجازاً عسكرياً كبيراً». هذا لا يعني، كما يقول «نهاية الحرب في سورية، لكنه محطة كبيرة في اتجاه هذه النهاية». يبدو من حديث الرئيس، ومعه جوقة إعلام «الممانعة»، أنه تم إنقاذه، وأنه يقترب من تحقيق نصر نهائي على «الإرهابيين». هل هذا ما حصل؟ أو ما يمكن حصوله قريباً؟ هذا سؤال ينبغي للرئيس قبل غيره أن يتوقف عنده ملياً، وهو الأعرف بما حصل، وبحجم التدخلات الأجنبية في الحرب السورية ودوره في ذلك، وبخفايا ما يقال، وما يحدث وراء الكواليس الإقليمية والدولية. لا أظن أنه يغيب عن بال الأسد أن السؤال أكثر تعقيداً مما يبدو عليه.
ربما أن التدخل الإيراني والروسي، وقتال الميليشيات الأجنبية إلى جانبه، أنقذ الأسد من مصير مشابه لما حصل للعقيد معمر القذافي، أو للرئيس المصري حسني مبارك، أو التونسي زين العابدين بن علي. ربما أن مصيره سيكون أقرب لما انتهى إليه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وربما سيكون مختلفاً عن كل ذلك. في كل الأحوال إذا كانت سورية سوف تولد من جديد بفعل الثورة والحرب التي انتهت إليها، فالأرجح أن بشار الأسد سيبقى جزءاً من ماضي الشام، وليس من مستقبله. حديث الرجل الخميس الماضي يشير بوضوح باذخ إلى أنه إما في حالة إنكار لما حصل، أو أنه يحاول تجاهل ذلك وكأنه لم يحصل. في هذا الحديث الذي استهلك أكثر من عشرة آلاف كلمة، كان الأسد يتحدث بذهنية النظام القديمة، كأنه لم تحدث ثورة، ولا حرب أهلية، ولا أحد مسؤول عما حصل. في مقابل ذلك تبدو سورية ما قبل الثورة شيئاً من الماضي البعيد. كيف يمكن تجسير الهوة بين إنكار الرئيس، وواقع البلد؟
في مثل الحرب الأهلية السورية يصعب الحديث عن منتصر ومهزوم بين السوريين. لكن بشار الأسد هو الخاسر الأكبر، لماذا؟ لأنه الرئيس، المسؤول الأول الذي خان العهد وانتهك الدستور، اختار عن عمد، وتيمناً بتاريخ والده، الحل الأمني منذ اللحظات الأولى في وجه انتفاضة شعبية، لم يفكر في استيعابها، والاستجابة لمطالبها. كانت انتفاضة سورية صرفة، لا تطرح أكثر من مطالب إصلاحية، لم يتدخل فيها أحد من الخارج طوال سنتها الأولى. ثانياً: أنه اختار نموذج حماة الذي استخدمه والده عام 1982، أو نموذج الأرض المحروقة ضد شعبه. ثالثاً: أنه استعان في البداية بشبيحة سورية من الهوية الطائفية نفسها التي ينتمي إليها الرئيس نفسه، ما أضفى على المواجهة صبغة طائفية لم يعهدها السوريون. رابعاً: عندما فشل الحل الأمني استعان بإيران. وهذه كانت تدعم الأسد منذ اليوم الأول للانتفاضة بالأموال والسلاح، وعندما لم يثمر ذلك، بدأت بإرسال مقاتلين وجنرالات وخبراء إيرانيين، ثم ميليشيات بعضها عربي (من العراق ولبنان)، والبعض الآخر غير عربي (من أفغانستان)، لكنها جميعها من لون طائفي واحد (اللون الشيعي) لمواجهة ما اعتبره النظام والإيرانيون انتفاضة سنية ضده. عزز هذا اللجوء المنحى الطائفي لمشهد تحوّل مع الوقت إلى حرب أهلية. خامساً: عندما فشلت الاستعانة بإيران وميليشياتها، اضطر للاعتراف بأن قواته لم تعد قادرة على السيطرة على كل المناطق السورية، وأن الالتحاق بالجيش أخذ يتراجع بشكل كبير. كان ذلك بمثابة استغاثة في صيف 2015، في خطاب ألقاه الأسد أمام أعضاء ورؤساء «المنظمات الشعبية والنقابات المهنية». وجاءت الإغاثة من روسيا في أيلول (سبتمبر) من العام نفسه.
السؤال في هذه الحالة، إذا افترضنا – جدلاً – أن الأسد انتصر، فعلى من انتصر؟ وبمن انتصر؟ انتصر على شعبه، وبقوات وميليشيات أجنبية ذات لون وهوى طائفيين. وإذا كانت مساعدة إيران للأسد جاءت لأنه علوي يعدّ بقاؤه – كما تراه القيادة في طهران – سداً منيعاً أمام غالبية سنية سورية قد تشكل تهديداً لهيمنتها في العراق، فإن مساعدة بوتين تأتي من طموح لإعادة روسيا إلى المنطقة، في سياق موجة يمينية تحتاج للأسد الديكتاتور رافعة أمام الإسلامي السياسي، والتوسّع الغربي في اتجاه روسيا، وهي موجة تتقاطع مع شعبوية غربية لا تخلو من عنصرية تجاه المختلفين دينياً وجنسياً وقومياً. كل ذلك سيفرض أثماناً باهظة على الأسد، وما هو الثمن المادي والسياسي الذي ستكتفي به هذه الأطراف الأجنبية؟
بعبارة أخرى، اختار الأسد حلاً أمنياً تبيّن أنه لا يملك القدرة على فرضه، وتسبب في حرب أهلية أضفى عليها بخياراته وسياساته طابعاً طائفياً أفقده السيطرة عليها في نهاية المطاف. وإذا كان إنقاذ الأسد وبقاؤه في الحكم على يد قوات أجنبية يلقي بظلال كثيفة على شرعية الرئيس، فإنه يعيد إلى الذاكرة أن هذا الرئيس وصل إلى الحكم بآلية التوريث من والده في نظام جمهوري، تم فرضه بالمؤسسة الأمنية. وإذا كانت بذور توريث الأسد الابن تفتقت من مذبحة حماة، فإن بذور الثورة زرعتها عملية التوريث ذاتها بمتطلباتها وأكلافها وما ترتب عليها.
من ناحية ثانية، لا يقدِّر الأسد كما يبدو ما حصل للوضع الاجتماعي والسياسي السوري بعد الثورة، كان السوريون قبل الثورة قد انتظموا في حالة استسلام لقدر استبداد النظام ودمويته الشرسة، وهي حالة استفاد منها الأسد الأب طوال حكمه. سمحت له بحصر مذبحة حماة داخل حدود المدينة، وعزل تأثيراتها عن بقية المجتمع. قيام الثورة وما أسفرت عنه من تضحيات غير مسبوقة، أخذت معها كل أو جل ما له صلة بما قبل الثورة. وانفجار الثورة بحد ذاته مؤشر على أن تلك الحالة تعرضت لتصدع كبير، وبالتالي، وبعد كل ما حصل هل يقبل غالبية السوريين أن يحكمهم رئيس وصل إلى الحكم بالطريقة التي وصل بها، لينتهي به الأمر بالاستعانة بقوات ومرتزقة أجانب لتثبيت حكمه فوق جثث مئات الآلاف، وعلى أطلال دمار حوّل أغلب مدن وقرى سورية إلى أشباح؟ من الواضح أن الأسد يراهن على أن جرأته على التدمير والقتل والتهجير ستعيد الرعب إلى مفاصل المجتمع السوري، وستعيد الشعب السوري إلى حظيرة الاستسلام للأجهزة الأمنية مرة أخرى.
لكنه يعرف أن زمن هذه المعادلة بات في موقع آخر على خط الزمن، كما يدرك الأسد أنه لم يحدث أن انتصر بالشعب وللشعب، ولا لحقوق السوريين، ولا بقوات سورية، ولا باسم القانون الدولي وشرعة الإنسان، ولا باسم البعث على رثاثته، ولا بالقومية العربية، ولا بشعار «المقاومة والممانعة» التي يفترض أنه ينتمي إليها. كان انتصاره دائماً لاستئناف حكم أبيه. وبالتالي يدرك أن الثورة سلبت منه شرعيته بعد استعانته بالأجانب لتدمير بلده وقتل شعبه. كان والده يستخدم العنف لتفادي مواجهة الشعب، أما هو فسقط في براثن نصائح حسن نصرالله والإيراني قاسم سليماني. فوق ذلك فقد بشار غطاءه العربي، وقد اشتكى من ذلك بشكل مباشر في حديثه المذكور، خصوصاً عن علاقة مصر به. وهو لا يحظى بأي دعم دولي حقيقي، عدا إيران وروسيا. من ناحيتهم تأكد السوريون أنهم تأخروا في الثورة كثيراً، ولأنها تأخرت شاءت الأقدار أن تأتي في توقيت باراك أوباما، وعلي خامنئي، وفلاديمير بوتين. لكن يعرف السوريون أيضاً أن الثورة لا ترتهن في الأخير لتوقيت أحد سوى توقيتها، وأنها بذلك باتت حداً تاريخياً فاصلاً بين ما قبل الثورة، وما بعد الثورة. ومن ثم فالسؤال الذي يجب أن ينشغل به الأسد هو: هل أنقذ الروس حكمه؟ أم أنقذوا رقبته؟ هنا يتبدى الاختلاف بين الروس والإيرانيين. يريد الإيرانيون إنقاذ حكم الأسد ورقبته معاً، الروس لا يمانعون في ذلك، لكنهم لا يرتهنون له مثل الإيرانيين، بين هذا وذاك فصلت الثورة الشعب السوري عن رئيسه. وفرضت طرح ملف النظام السياسي بتاريخه وطبيعته الدموية وما إنتهى إليه. بقي الشعب في مكانه وزمانه، وإنتهى الرئيس رهينة معادلات وتوازنات خارجية، وعليه بالتالي أن يستبد به القلق من هذا الفصل وذاك الطرح اللذين كانا خارج التداول من قبل.
* كاتب وأكاديمي سعودي
الحياة
الروس والإيرانيون شركاء في أعباء «الانتصار»؟/ عبدالوهاب بدرخان
تتكشّف النيات الروسية والإيرانية أكثر فأكثر، كما يستشرس أي وحش كلما ولغ في دم فريسته. لم يعد سفاحو حلب يطالبون بالتمييز أو الفصل بين «المعتدلين» معارضي نظام بشار الأسد و «الإرهابيين». سيعتبرهم سيرغي لافروف إرهابيين جميعاً، طالما أنهم قرروا عدم مغادرة المدينة. هذه فتوى للقتل العشوائي التلقائي، كما في أي عملية إبادة. «فيتو» على وقف لإطلاق النار، على هدنة، وعلى مرور غذاء للأطفال ودواء للجرحى المتروكين لمصيرهم. «فيتو» كهذا يعني نعم للإبادة، فالمطلوب إخلاء حلب واستباحتها، ولو لم يبقَ فيها سوى الركام. كثيرون راهنوا أو توقّعوا أن تأتي لحظة تظهر فيها روسيا كدولة كبرى مسؤولة ومعنية بشيء آخر غير أن ترتكب غروزني ثانية. بل اعتقدوا أنها يمكن ألا تكون متماهية مع وحشية نظام الأسد، وأن لا تقبل بإخراج سوريين من مدينتهم لتتركها نهباً للميليشيات الإيرانية… روسيا هذه لم تكن يوماً، ولن تكون، ولعلها استدعت الولايات المتحدة للحاق بها في تأكيد أن النظام العالمي بات بلا أي قيم، ولا وجوب للمراهنة عليه، أو توقّع احترامه قوانين وضعها ويمعن في تمزيقها.
آخر ما يمكن أن يفكّر فيه فلاديمير بوتين وعلي خامنئي والأسد، أن تُختزل سورية في معاناة البشر الذين يجوّعونهم، في جثث الصغار والكبار على قارعة الطريق، وفي أنين المصابين والمكلومين في احتضارهم الطويل. لم يأتِ الروس الى سورية إلا من أجل هذه اللحظة، وليست في جعبتهم «أخلاقيات» بل أدوات قتل يريدون تجريبها. كل الجدالات التي افتعلوها حول الإرهابيين، كل الهدنات التي أقرّوها لخرقها، كل المفاوضات التي شجّعوا عليها وحضّوا على إفشالها، وكل تفاهماتهم واتفاقاتهم مع الأميركيين، لم تكن سوى مسلسل من الكذب والخداع، سوى استهلاك للوقت ومناورات لإحكام الحصارات والمجاعات. أخضعوا الأمم المتحدة واستخدموا مبعوثها لتجويف قراراتها وحرفها عن أي منطق قانوني أو إنساني. داوموا على مساومة الولايات المتحدة (وأوروبا) على صفقة لا ترغبان فيها: سوريا (أو نصفها) مقابل أوكرانيا (أو نصفها)، استوعبوا الثنائي باراك أوباما – جون كيري وانتزعوا منه اتفاقاً لـ «التعاون» بين الجيشين، لكن رفض البنتاغون كلّف حلب وأهلها جولة من أشد الصواريخ فتكاً وتدميراً، إضافة الى سفك دم الإغاثيين في قافلة المساعدات.
كان بين تفاهمات كيري – لافروف تأكيد لضرورة ضرب «الإرهابيين» غير «الداعشيين»، في حلب وامتداداتها وكذلك في إدلب. الحجة أنه يُفضَّل التخلّص منهم «الآن» («قبل الحل السياسي») تفادياً لإزعاجات سيسبّبونها لاحقاً. لكن، ماذا عن الأسد، وماذا عن الإيرانيين، الذين لم يكن خيارهم مجرد الإزعاج بل إحباط أي حلّ لأي حلّ. ثم، عن أي حل سياسي كان الوزيران يتحدّثان؟ لم يكن في بال الروس سوى «حلّهم»، بـ «المعارضة» التي هندسوها من بين «المعارضات» المتوافرة في جيوب النظام. أما الحلّ الذي تخيّل كثيرون أنه موضع نقاش فيمكن القول الآن أنه كان طبخة أوهام، وكان كيري صريحاً الى حد الوقاحة في أكثر من لقاء مع معارضين من «الائتلاف» أو من «هيئة التفاوض»، إذ كان مكلفاً بإفهامهم أن أميركا أوباما تقبل ما تعرضه روسيا بوتين: «الحلّ» يكون مع الأسد أو لا يكون، وأن الخيار بين قبول هذا الحل مع ضحايا ودمار أقلّ وإلا فبمذبحة ودمار أكثر. الواقع، أن الروس لم يكونوا يعرضون سوى الحل العسكري الذي ينفّذونه حالياً، ولم يكن الأميركيون مكترثين فعلاً.
وآخر ما يمكن أن يعني السوريين اليوم، هو أيٌّ من الروس والإيرانيين والأسد سينتصر في نهاية المطاف، وأيّ قطعة سيظفر بها هذا وذاك من الجثة السورية، فهؤلاء تضافروا جميعاً لجعل شعب سورية مجرد أرقام في لوائح اللاجئين والمحتاجين الى مساعدة، أو لوائح ابتزازات «شبّيحة» النظام. بل لا يعنيهم أن يكون الروس والإيرانيون دخلوا في تنافس مكشوف يتظاهر الأسد بأنه يتذاكى في اللعب على تناقضاته. كانت حكومة النظام تستورد القمح من أوكرانيا ولم ينتبه الروس إلا بعد إبرام آخر صفقة، قبل بضعة أسابيع، فاستدعوا رئيس الحكومة الى حميميم وأمروا بإلغائها فوراً، ولما اتصل برئيسه لإخباره والاستفسار عما يجب أن يفعله، جاءه الجواب: نفّذ ما طلبوه منك. وعندما بدأ التدخل الروسي، كانت موسكو بالغة الاقتناع بأنها ستتمكّن من استقطاب المنشقّين وإعادة ضمّهم الى الجيش السوري، ثم اكتشفت أنه أصبح جيش الأسد وأن ضبّاطه أنشأوا ميليشيات لإدارة إقطاعاتهم فعملوا على استقطاب بعض منها وأسسوا لها الفيلق الرابع الموالي لهم والعامل بإشرافهم، علماً أن أوضاع الفيالق الثلاثة الأساسية ليست على ما كانت عليه. وها هو الجيش أعلن لتوّه تأسيس فيلق خامس سمّاه «اقتحام»، ولعل الاسم يكفي للدلالة على أن هذا الفيلق لا يمتّ الى الجيش بل الى الإيرانيين لتجميع الميليشيات التي أنشأوها ودرّبوها.
لحظة حلب هي لحظة انزلاق سورية الى هاوية المساومات الدولية ومناورات المتدخّلين. وفيما تخفي موسكو أوراقها منتظرةً تنصيب دونالد ترامب لتفتح معه صفحة جديدة بعد التخلص من عقدة حلب والشروع في إنهاك إدلب، وجدت طهران أن الوقت حان للإفصاح عن توقّعاتها وترتيباتها. إذ لم يكن محمد علي جعفري، قائد «الحرس الثوري» الإيراني، مباشراً الى الحدّ الذي بلغه حين قال أن إيران هي مَن تقرّر «مصير سورية»، وأن الدول الكبرى «لا بدّ أن تتفاوض مع إيران لتحديد مصير دول المنطقة بما فيها سورية» (22/10/2016). وتبعه رئيس أركان القوات المسلّحة محمد حسين باقري، بإشارته (نشرت في 27/11/2016) الى إمكان إقامة «قواعد بحرية في اليمن أو سورية» لأن إيران «تحتاج الى قواعد بعيدة» ومن الممكن أن تكون لها «قواعد على جزر» أو «قواعد عائمة». بعد يومين، شنّ طيران «مجهول»، بالأحرى روسي، سلسلة غارات على مواقع في بلدتي نبّل والزهراء الشيعيّتَين اللتَين كانت المعارضة تحاصرهما في ريف حلب الشمالي واستعادتهما الميليشيات الإيرانية، بغطاء جوي روسي، في شباط (فبراير) الماضي. هذه المرّة استهدف الطيران الروسي معسكر تدريب يقوم الإيرانيون بتطويره وتوسيعه، وليس مستبعداً أن يكون الروس أرادوا تحذير إيران في شأن طموحاتها و»قواعدها» البحرية – حتى في سورية – التي يمكن أن تخرّب مناخ تقارب بوتين – ترامب قبل أي تفاهم بينهما.
دخلت إيران حسابات «ما بعد حلب» لتحدّد المكاسب التي تتوقّعها. كانت صوّرت هذه المعركة على أنها بين معسكرَين دوليين متيقنةً بأن معسكرها سينتصر وأن هذا يكفي لتحقق مرحلة أكثر تقدماً في نفوذها. الأرجح، أن روسيا لا تشاركها هذا التقويم، فبعد حلب بالنسبة إليها محكٌّ دولي خطير يرتّب على بوتين أعباء لا يكفي التحدّي والتهوّر لمعالجتها. إذ إنها مضطرّة، خلافاً لإيران، لأن تحسب حساباً لمصالحها الأخرى وللمجتمع الدولي في سياق إدارتها الوضع السوري، فما تريده في سورية كانت ولا تزال حاصلة عليه، ومهما بلغت رغبة ترامب في التعاون معها فإنه لن يحدّد خياراته قبل منتصف السنة المقبلة ولن يتقاسم الأعباء معها مجاناً، ثم إنه قد لا يكون معنياً بأي مصلحة في سورية أو قد يدعوها الى مساومة على الدور الإيراني نفسه. وفي ضوء الأرقام المخيفة التي أعلنتها الأمم المتحدة أخيراً عن الحصيلة الراهنة للحرب، يصبح تساؤل مفوّضية الخارجية الأوروبية محقاً ودقيقاً: «من حقّق نصراً في حلب، إذا كانت جائزته بلداً منقسماً ومسلحاً يضيق بالإرهابيين ومعزولاً عن الساحة الدولية»؟
* كاتب وصحافي لبناني
الحياة
موسكو عندما تحاول بيع واشنطن «ورقة» الموت!/ محمد مشموشي
يبدو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كمن يحث الخطى لدخول البيت الأبيض قبل أن يدخله الرئيس الأميركي المنتــخب دونالد ترامب، في 20 كانون الثــاني (ينــاير) المقبل. هدف بوتين أن يضع «ورقة حلب» على الطاولة الرئاسيــة في المكتب البيضوي، قبل أن يجلس إليها «صديقــه» الجديد في واشنطن، وحتى قبل أن يطّلع هذا عـــلى أية ورقة أخرى في ملف سياسات بلاده وعلاقاتها الخارجية. وهدف بوتين هذا، من بين أمــور أخرى، هو الذي جعله يستخدم حق النقض («الفيتو») ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو الى «هدنة إنسانية» في حلب المدمرة، بحجة أنه لا ينص على انسحاب المسلحين من المدينة.
فليس في ذهن قاطن الكرملين، وهو يودّع «صديقيه» اللدودين باراك أوباما وجون كيري، سوى أن يضع الإدارة الأميركية الجديدة أمام «أمر واقع» سوري، وإقليمي ودولي من وجهة نظره، يعتقد أنه سيكون نقطة قوة له في علاقاته المقبلة معها. ولأنه استثمر الى آخر مدى، وبنجاح كبير، سياسات أوباما – كيري اللامبالية (في الواقع، الانسحابية) من المنطقة، فهو يرى في ما أطلقه ترامب في حملته الانتخابية، وانعزاليته الظاهرة عن مشاكل العالم، مدخلاً الى اعتراف أميركي ناجز وسريع بما حققه في حلب، وبالتالي في سورية والمنطقة كلها. ولعله من هنا، وللمرة الأولى منذ تدخّله العسكري في سورية في أيلول (سبتمبر) 2015، استخدم وزيرا دفاعه وخارجيته عبارات أقل ما يقال فيها أنها غير سياسية، وحتى سوقية: يخرج المسلحون من حلب أو يبادون عن بكرة أبيهم؟!
ليس ذلك فحسب، بل إن بوتين تعمّد في الفترة الأخيرة، وفي سياق مقاربته الأميركية ذاتها، تصعيد لغته السياسية في شأن ليبيا التي، كما يبدو، يعتبرها «عزيزة» على ترامب، على خلفية ما وصف بـ»سقطات» منافسته في الانتخابات الرئاسية، وزيرة الخارجية يومها هيلاري كلينتون، بعد اغتيال السفير الأميركي فيها كريستوفر ستيفنز في 2012. فبدلاً من كلامه على عدم السماح بتكرار «تجربة ليبيا» الأميركية، كما اعتاد على القول منذ سنوات، خرج بوتين قبل أيام بمطلب تقديم اعتذار أميركي علني وصريح عن تلك العملية. وغني عن البيان أنه، بمثل هذا الأسلوب، يعتقد أنه يقدم ما يشبه «أوراق الاعتماد» الى ترامب في حربه على الحزب الديموقراطي والإدارة السابقة، بقدر ما يحاول استغلال الإدارة الجديدة الى أقصى حد.
هل هكذا تكون السياسة الدولية؟ بل هل هذه سياسة أصلاً، فضلاً عن أن تكون سياسة خارجية تمارسها قوة كبرى، وفي القرن الحادي والعشرين في شكل خاص؟
المهم في الحال الراهنة، أن ما يعتبره بوتين «انتصـــاراً» كاملاً له ولحليفيه في حلـــب (بشار الأسد وعلــي خامنئي) يبدو معروضاً للبيع، أو حتى للمساومـــة، مع إدارة أميركـــية لا يتحدث الأميــــركيون، كما الأوروبيون والعالم كـــله، عنها إلا وهم يغطـــون أنوفـــهم هروبـــاً من الرائحــة الكريهـــة… إن فـي مجال العلاقات بين البشر والتمييز العنصري وحقوق الإنسان، أو في ما يتعلق بالأخلاق وأساليب تكديس الثروة والتهرب من الضرائب.
فلم يعد خافياً أنه ليس لدى بوتين، الضابط السابق في «ك.ج.ب» السوفياتية، في ممارسته السياسة الداخلية في بلاده كما في علاقاته مع دول العالم الأخرى، إلا ما تعلمه من هذه المدرسة في الاستخـــبارات ومارسه في ألمانيا الشرقية وغيرها، وإلا عمــلياً القتــل والاعتقال والتعذيب للناس، وعروض البيــع والشراء وتبادل المنافع مع البلدان وأجهزة الاستخبـــارات الأخرى. وعلى رغم غيوم التوجه الى حل سيــاسي، التي أطلقها في الأجواء، قبـــل تدخله الحربي في سورية وبعده (وظن البعض بها خيراً، كما حال كاتب هذه السطور)، فسيرة سياسات الرجل منذ ما يقارب ستة أعوام، وعمليات قـــواته الجوية والبحرية والبرية في خلال العام ونصف العام الماضية، تقول بما لا يدع مجالاً للشك، أن أهدافه في سورية، وربما في المنطقة كلها، لا تختلف في شيء عن أهداف حليفيه في دمشق وطــهـــران: هو، بحجة إنهـــاء وحدانية القطب وإرساء تعدديـــة في النظـــام الدولــي تفسح في المجال لدور روسي وحتى صيني وأميركي لاتيني فيه، والآخران، بذريعة مقاومة ما يسميانه «الاستكبار العالمي» بما فيه الصهيونية وإسرائيل في شكل خاص.
لكن، هل ينجح الرجل في ما يفعله… ليس في سورية والمنطقة فقط، إنما في أوكرانيا وما يسمى «الكومنولث السوفياتي» السابق و«دول البريكس» أيضا؟
غالب الظن، أن الرائحة الكريهة التي يهرب منها الأميركيون والأوروبيون حالياً، بعد انتخاب ترامب رئيساً لأكبر وأغنى وأقوى دولة في العالم، لن تكون مختلفة عن المآل الذي سينتهي إليه ما يعتبره بوتين «انتصاراً» له في سورية… وربما حتى في واشنطن إذا ما صدقت توقعاته عن «صديقه» الجديد في البيت الأبيض.
الحياة
سوريا بين الانتداب الروسي والنفوذ الإيراني/ د. خطار أبودياب
تجسد الخواتيم المأساوية لمعركة حلب أبشع مظاهر الفوضى التدميرية التي تجتاح العالم العربي، وتبرهن على أهمية القوة الجوية الروسية والقوات البرية التي تقودها إيران في فرض الوقائع الجديدة في سوريا إبان الوقت الضائع الأميركي.
وإذا كانت المواجهة العسكرية الدائرة تكشف، بما لا يقبل الشك، عن فعالية التنسيق بين روسيا وإيران، يتوجب الاستدراك أن تجارب التاريخ علمتنا صعوبة التعايش بين قوتين محتلتين على أرض واحدة، وفي حالتنا هذه إن لجهة تصور مستقبل سوريا ودور منظومة الأسد، وإن لناحية الحسابات الإستراتيجية والإقليمية للطرفين. ولذا لن يشكل إسقاط حلب إلا فصلاً من فصول أول نزاع إقليمي-عالمي متعدد الأقطاب، وأن مصير المشرق يبقى معلقاً على نتائج صراع مفتوح على أكثر من مسرح.
يزهو النظام السوري بقتل الإنسانية ونفيها في حلب وسواها، وفي استكمال تدمير المدن والدساكر وتغيير الديموغرافيا السورية.
في تصريح حديث له أقر بشار الأسد بأن النسيج الاجتماعي السوري اليوم ملائم تماما وذلك بعد اقتلاع وتهجير طالا أساساً المكون السني الأكثري، وسبق لبعض رموز النظام أن هددوا الحراك الثوري في العام 2011 بإعادة التركيبة السكانية في البلاد إلى ما كانت عليه عندما تسلمها حافظ الأسد أي حوالي 8 ملايين نسمة. وقبل استتباب الأمور له يستعجل النظام، مع شركائه، إحكام القبضة على لبنان ومنع العهد الجديد من الانطلاق قبل تطويعه. لكن هذه العجلة وهذا التمظهر الإعلامي لا يمكن أن يحجبا الواقع الفعلي الميداني والسياسي إذ أن النظام استمر ويستمر بفضل الانخراط الروسي-الإيراني الكثيف إلى جانبه، وقبل ذلك بفضل التغاضي الإسرائيلي والأميركي إضافة إلى العجز العربي والإسلامي والضعف الأوروبي. أما سوريا (قلب العروبة النابض حسب توصيفات النظام سابقا ونوستالجيي البعث والقومجيين، وسوريا الأموية حسب توصيفات أيديولوجية تاريخية) فقد تفككت إلى مناطق نفوذ حتى إشعار آخر، والنظام وقع ببساطة صك التسليم بالانتداب الروسي، وهو الخاضع عن قناعة لوصاية ونفوذ إيران.
قبل تسلم إدارة دونالد ترامب في الشهر القادم وبلورة سياسة سورية جديدة لواشنطن، وعلى ضوء مراقبة التقاطعات الروسية مع إسرائيل من جهة، ومع تركيا من جهة أخرى، يمكن التساؤل حول مآلات العلاقة الروسية-الإيرانية التي لا ترقى إلى مصاف الحلف الإستراتيجي، لكنها تتميز بمستوى متقدم من التنسيق تحت سقف لعبة المصالح المتبادلة. وكانت الساحة السورية مختبر العمل بين الجانبين وذلك لحاجة مزدوجة:
– حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ديمومة النظام السوري الذي يعتبر الجوهرة على تاج مشروعها الإمبراطوري، والذي حول سوريا إلى جسر إيران نحو البحر الأبيض المتوسط.
– تمسك الاتحاد الروسي بآخر نقطة ارتكاز في العالم العربي، إذ تتجاوز المسألة الدفاع عن النظام السوري إلى أهمية دور سوريا الجيوسياسي لناحية الوصول إلى المياه الدافئة وحروب مصادر وممرات الطاقة، بالإضافة إلى استخدام الورقة السورية في العودة بقوة إلى الساحة الدولية.
هكذا تركز التفاهم بين موسكو وطهران تحت عين إدارة أوباما المتجاهلة، ومنذ صيف 2015 تحول سلاح الجو الروسي ليكون الغطاء للقوات البرية التي تتحرك تحت إشراف إيران وغرف عملياتها من البيت الزجاجي بالقرب من دمشق، إلى ثكنة السيدة رقية (مركز البحوث سابقا جنوب حلب بالقرب من معامل الدفاع في السفيرة). ولوحظ وجود تقاسم للنفوذ والعمل على الأرض إذ تركز روسيا على استكمال بناء جزيرتها (روسيا الجديدة أو أبخازيا السورية) على ساحل المتوسط في غرب سوريا.
بعد التوقيع على صك تسليم قاعدة حميميم الجوية لمدة 99 عاماً، يجري العمل على ترتيب نفس العقد لقاعدة طرطوس البحرية، عبر الاتفاق الموقع بين فلاديمير بوتين وبشار الأسد في أغسطس 2015 والقاضي بإبقاء القوات الروسية حتى إشعار آخر ومن دون أي مسؤوليات جنائية. إنه الانتداب الروسي بغير قناع مع الحصانات المكتسبة والأراضي والمياه وعقود الطاقة المنتظرة وغيرها من المكاسب. أما مناطق النفوذ الإيراني فتمتد من دمشق وجنوبها حتى الحدود مع لبنان (الممر نحو حزب الله) وتصل إلى حلب نظرا لأهمية موقع المحافظة الإستراتيجي والاقتصادي، وهناك عامل تبريري لحشد الحرس الثوري الإيراني ميليشياته وقيادته لميليشيات لبنانية وعراقية وأفغانية وباكستانية، يتصل باعتبارهم محافظة حلب محافظة شيعية بعد أن حكمها الحمدانيون في القرن العاشر ولذلك يسعون لإعادة السيطرة عليها.
من خلال تصريح أحد الجنرالات الإيرانيين عن الرغبة في إقامة قاعدة بحرية في سوريا، يتبين إمكان تزايد عدم الثقة بين الشريكين على المدى المتوسط، لأن روسيا التي لا تريد تحول سوريا إلى مستنقع يمكن أن تكتفي بما يسمى “سوريا المفيدة”، وأن تعمل لاحقا مع تركيا والأكراد وربما تدفع إلى دور مصري من أجل تركيب حل في سوريا يحفظ مصالحها ووجودها، ومسألة بقاء أو عدم بقاء الأسد ستتصل بالتوازنات المستقبلية والمساومات الممكنة. في المقابل، تخشى إيران غلبة الدور الروسي وتهميش دورها على المدى المتوسط، ولذا تركز على الإمساك بالحلقة الأولى وبالقيادات الميدانية العاملة على الأرض، ويخشى بعض أنصارها ترحيب العلويين بالوجود الروسي.
على المدى القريب سيكون هناك الكثير من الأعباء على العلاقة التنسيقية الروسية-الإيرانية مع دخول تركيا على خط العلاقة مع موسكو للدفاع عما تعتبره مصالحها وأمنها القومي في الشمال السوري، ونتيجة احتمال تدخل إسرائيلي في المناطق حول دمشق وجنوبها تحت ستار منع إدخال أسلحة إلى حزب الله الذي يحتاج إلى مد أكثر انتظاماً من المد الجوي بعد مشاركاته الكثيفة في الميدان السوري منذ العام 2012. وهكذا يمثل النظام السوري دور الناطور أو شاهد الزور في لعبة دمرت سوريا وجعلتها ساحة حروب وتقاطعات الآخرين.
أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي للجيوبوليتيك باريس
العرب
من يتقارب مع رؤية الآخر في سوريا تركيا أم روسيا؟/ محمد زاهد غول
الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين أردوغان وبوتين لا تتوقف، واتصالات وزيري الخارجية الروسي والتركي متوالية، واجتماعات اللجان الأمنية والاستراتيجية والمخابراتية والعسكرية بين الحكومتين التركية والروسية متواصلة، منذ مؤتمر بطرسبورغ في روسيا قبل أشهر.
هذا كله يؤكد حرص الدولتين والزعيمين التركي والروسي على إيجاد قاعدة تفاهم مشتركة، ووضع خطط مشتركة لمواجهة التحديات والأزمات القائمة بين البلدين وفي المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة السورية. فروسيا بزعامة بوتين ووزير خارجيتها لابروف فقدوا الأمل بالتعاون المجدي مع أمريكا ووزير خارجيتها جون كيري، طالما أنها لم تضمن إلزام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بتنفيذ ما تم التوقيع عليه بينهما، كما حصل في الاتفاق الأخير بشأن وقف إطلاق النار في حلب.
أما الموقف الروسي من إيران، فإن الروس يدركون الآن أن الايرانيين حالهم في السياسة أسوأ منه في المعارك، فهم لا يستطيعون أن يتقدموا شبرا واحد في الحل السياسي، لأن الشعب والمعارضة السياسية والعسكرية السورية لا تثق بالإيرانيين إطلاقا، لأنها تجدهم هم المفاوضون مكان بقايا نظام الأسد، فلا وجود لنظام الأسد في المفاوضات التي تجري في دمشق وغيرها، ومن باب أولى أنه لا وجود لهم في الشمال ولا في الجنوب، ومن يتولى ذلك هم ضباط إيرانيون، وبالتالي فإن القيادة الروسية فقدت الأمل في الحل السياسي الذي ترعاه أمريكا، ومن إيران أيضاً. أما فقدانها الأمل بالحل العسكري فقد تحقق بعد أربعة أشهر من تدخلها العسكري المجنون بتاريخ 30/9/2015، وما تفعله حتى الآن محاولات للضغط العسكري فقط، بالقصف والتدمير والقتل لإجبار المعارضة السورية على الخضوع لما رفضته في مؤتمرات فيينا وجنيف، ولكنها فشلت في ذلك سابقاً، وهي تعود لذلك لفقدان الأمل بطرق أخرى، ولو في حلب وحدها الآن، ولأنها ستفشل أيضاً حتى لو دمرت حلب بالكامل، فالقصف الوحشي والإجرامي لحلب لن ينقذ روسيا بإيجاد حل عسكري في سوريا، لأن الشعب السوري يرفض الاحتلال الروسي، بوتين يدرك ذلك، والشعب السوري رفض الاحتلال الإيراني من قبل، ولن يجد في جيش الأسد بعد الآن إلا جيش احتلال على فرض وجوده، فهو غير موجود أصلاً، وما يطلق عليه قوات النظام هم ميليشيات طائفية ومرتزقة من لبنان والعراق وأفغانستان وإيران ومرتزقة من شركات أمنية أجنبية، تجلب مقاتلين مغامرين يشاركون في الحرب، هواية أو احترافا أو رغبة في القتل فقط، مثل المشاركين في رحلات الصيد، ولكنهم يجدون بفضل الأسد من يدفع لهم ثمن قتلهم للسوريين.
هذا يعني أن روسيا في مأزق عسكري وسياسي في سوريا، وفي ظل الانشغال الأمريكي بنقل السلطة من إدارة أوباما إلى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وفي ظل عجز إيران وتوابعها الشيعية من حزب الله اللبناني وغيره من تقديم أي مساعدة لروسيا أكثر مما فعلوا من قبل، فإن روسيا لا تجد طريقا غير الباب التركي لها، لإيجاد حل سياسي يغنيها عن الحل العسكري، وليس بإيجاد حل سياسي في حلب فقط، وإنما في كل سوريا بعد ذلك، الحل في حلب قد يكون المقدمة، ولكن ليس كما قيل في بعض مراحل مشاريع دي مستورا الوهمية قبل سنوات، وروسيا تدرك أن قدرات تركيا في مساعدتها في سوريا أكثر من فرص إيران، وبالأخص في الجانب السياسي، ولكن الحكومة التركية لن تمارس القتل للشعب السوري من أجل فرض حل سياسي أو عسكري، كما فعلت وتفعل إيران وحرسها الثوري، فالحكومة التركية لا تملك حرساً ثورياً تركياً لا في تركيا ولا في سوريا، وعلاقتها العسكرية بتقديم الدعم للشعب السوري فقط، ومن خلال فصائل المعارضة السياسية والمسلحة التي تدافع عن شعبها ووطنها ضد المحتلين، وبالتالي فان الحكومة التركية تعمل مع روسيا بالطرق القانونية والسياسية للتفاوض مع المعارضة السورية الحقيقية، وليس المعارضة التي تستجلبها إيران او حكومة السيسي إلى موسكو للتفاوض معها، وهي لا تملك من قرارها شيئاً، لذلك كانت زيارة وزير الخارجية الروسي لابروف إلى أنقرة يوم الأول من ديسمبر 2016 فرصة حقيقية لإيجاد حل سياسي لوقف اطلاق النار في حلب، وفق الرؤية التركية، حيث تجري الاتصالات بين روسيا والمعارضة السورية بوساطة تركية مباشرة، أو غير مباشرة، وكلا الطرفين الروسي والمعارضة السورية الحقيقية يملكان القرار، وبالأخص إذا لم يوجد طرف دولي يخرب تفاوضهما أولاً، كما أن من المؤمل أن لا تتدخل اطراف إقليمية لتخريب الاتفاق المقبل بينهما أيضا، حتى لو كانت تحت ضغوط امريكية، لأن الاتفاق بوساطة تركية خير من مواصلة القتل والتدمير والتشريد، ومن أضر بكل الاتفاقيات السابقة هي الادارة الأمريكية التي تسعى بطرق ملتوية لإدامة الصراع لسنوات أو عقود مقبلة، وروسيا اليوم متضررة كثيرا من استمرار الحرب في سوريا.
المشكلة الكبرى التي تواجهها القيادة الروسية اليوم هي التحالفات السابقة التي ربطتها بالتحالف الإيراني الأسدي، فقد ظنت أنه يمكن ان يحقق لها النجاح والمصالح الاستراتيجية والاقتصادية في سوريا، ولكنه عجز عن ذلك، فإما أن تبقى روسيا تواجه أزمتها نفسها التي واجهتها في أفغانستان، حيث كانت تستطيع القتال لعقود مقبلة ولكن دون كسب المعركة، أو ان تضع حدا لخسارتها العسكرية والسياسية، وهي اليوم في سوريا في المأزق الأفغاني نفسه، فهي تستطيع ان تقصف وتقتل وتدمر لسنوات مقبلة، ولكن دون نتيجة، لأن خسارتها الحقيقية في افغانستان عدم وجود شعب أفغاني يؤمن لها النجاح، واليوم لا يوجد شعب سوري يؤمن لها النجاح، وإيران وميليشياتها عبارة عن جيوش محتلة لسوريا، ولا تمثل الشعب السوري، وبشار الأسد لا يمثل أكثر من 20% من الشعب السوري في أحسن أحواله، وبالتالي فإن مأزق أفغانستان موجود في سوريا، فلا يوجد شعب يضمن لروسيا النجاح إلا الشعب الذي تمثله المعارضة السورية المعتدلة، والمؤيدة من الدول العربية والخليجية وتركيا. وعندما بدأت روسيا بالتحرك نحو تركيا أخذ الأسد يطمعها باتفاقيات الإعمار، واخذ يوقع مع الشركات الروسية العقود والأرباح، وهو لا يضمن إعمار نفسه، فكيف يوقع مع روسيا عقود إعمار سوريا، فلقد فقد الأسد كل شيء ويعيش في وهم أسطوري أن يبقى رئيسا، وهو ضحية الرغبة الأمريكية والاسرائيلية باستمرار القتال في سوريا، وضحية الجنون الإيراني الذي استعد تلبية للرغبة الأمريكية والاسرائيلية بمواصلة القتال لسنوات، بينما روسيا لا مصلحة له بهذه المعركة على هذا النحو الجنوني، ولذلك فإن من الصعوبة إيجاد الحل إذا لم تتحرر روسيا من قيود حلف إيران الفاشل، فالحل اليوم في يد روسيا باتخاذ القرار الذي يسهل لها التحرر من قيود المحور الإيراني الخاسر، فإيران فشلت في توقيع اتفاقيات ملزمة مع أمريكا في ملفها النووي وأصبحت في مهب العقوبات من جديد مع إدارة ترامب، ومن لا يملك انقاذ نفسه لا يجوز الاعتماد عليه لإنقاذ غيره.
روسيا أمام فرصة حقيقية في إيجاد حل سياسي في سوريا بتقاربها مع السياسة والرؤية التركية، ومن الخطأ ان تسعى موسكو لجلب تركيا إلى سياستها ورؤيتها العقيمة في سوريا، لأنها لا تضمن النجاح لها بمستقبل سياسي آمن في سوريا، وتركيا وروسيا ملتزمتان باحترام إرادة الشعب السوري، أو احترام إرادة الأغلبية السكانية المعروفة للشعب السوري، والابتعاد كليا عن السياسات الطائفية التي تثيرها إيران وتشعلها امريكا، بل إن على روسيا أن تسابق بتوقيع اتفاقيات مع المعارضة السورية المعتدلة بوساطة تركية قبل أن يتولى ترامب منصب الرئاسة الأمريكية فعلياً، فترامب ذو توجهات عسكرية وسياسة امريكية خشنة في الخارج.
كاتب تركي
القدس العربي
في أي اتجاه ستدفع روسيا النظام بعد حلب/ روزانا بومنصف
حين يطلب بيان مشترك وقعته كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا الى جانب فرنسا وإيطاليا والمانيا، من روسيا وايران التدخل لمنع النظام من تدمير حلب والسماح بإدخال المساعدات الانسانية، فكأن في الامر تكرارا لكيفية مطالبة هذه الدول، منفردة او مجتمعة، النظام السوري ابان وصايته على لبنان، بوقف القتال في الوقت الذي كان هو جزء لا يتجزأ من الحرب فيه على غرار ما هي روسيا اليوم وكذلك ايران، انطلاقا من انه لولا دعم هذين البلدين لحملات النظام العسكرية ورعايتهما لها لما نجح في التقدم قيد أنملة. لكن ذلك يدلل في الوقت نفسه على قمة العجز الغربي الذي لن ينجح إلا في ان يزيد تشدد روسيا وايران انطلاقا مما يكشفه الطلب الغربي منهما، وهو ما يسمح لهما برفع سقوفهما على ما فعلت روسيا في طلب رحيل جميع المقاتلين عن شرق حلب من دون استثناء، وليس فقط خروج عناصر “فتح الشام”. وثمة من يستدلّ على ذلك أيضا من الموقف الروسي الذي ارتفع سقفه في غياب الديبلوماسية الاميركية، او من خلال الاعتبار انه لا يمكن الكلام او الاتفاق معها حول سوريا او حلب تحديدا. ولم يعد هناك شك في أن الدول الغربية الموقعة على البيان أضحت في مكان آخر كليا من موقع القوة التي كانت تتمتع بها في الاعوام القليلة الماضية. فهي تتحرك من منطلق اخلاقي لإنقاذ السوريين، مع التسليم ضمنا بأن روسيا تقود الحملات الجوية ضد المعارضين، وهي هددت علنا بذلك، فيما تقر بالأمر بوضوح تقارير الامم المتحدة ايضا، في حين ان العجز هو بناء على الغياب الاميركي القسري بفعل الانتقال في السلطة مبدئيا، علما ان الرئيس باراك اوباما لم يكن يحرك ساكنا على نحو جدي. وهذا الانتقال في السلطة يستكمل في هذه المرحلة، بما يترك الاوروبيين من دون سند فعلي، في الوقت الذي انحصر الملف السوري تفاوضا بين الولايات المتحدة وروسيا بمعزل عن الشركاء الاوروبيين طيلة الاعوام القليلة الماضية، وهو ما كان مثار اعتراض لديهم من دون نتيجة، في حين ان الموقف الاميركي كان ولا يزال ضعيفا وغير ذي معنى بالنسبة الى سوريا. ومعلوم أن اوروبا، على رغم مصالحها المباشرة في المنطقة، لم تثبت يوما قدرتها على إثبات الحضور في ازمات المنطقة على اختلافها، فيما يعتقد كثر أن ثمة ما هو اكثر من الضعف او العجز الاوروبي، في ضوء ما اصاب اوروبا من ازمات على خلفية مسألتي الارهاب واللاجئين، بحيث غدت اولوية هذه الدول ان تأمن تداعيات الحرب الاهلية السورية ليس إلا، فضلا عن أن المساومة مع روسيا هي على مسائل اهم بالنسبة الى اوروبا، كما هي الحال بالنسبة الى اوكرانيا. هل هذا يعني ان هذه الدول تقوم بما تقوم به لئلا يفهم من مواقفها تخليها عن سوريا كليا، وهو امر لا يمكنها اعلانه؟. لعل هذا هو المرجح. ثمة من يسأل ما ستكون عليه الخطوة التالية بالنسبة الى روسيا وكيفية ضمان ترئيس بشار الاسد على السوريين السنّة مجددا، واذا كانت ستساعده في الابقاء على سلطته على المدن او تساعده في السيطرة على بقية سوريا. فهل روسيا ستساعد النظام في الحسم عسكريا، ام تدفعه الى مفاوضات سلمية انطلاقا من السؤال: هل الحل عسكري في نهاية المطاف ام سياسي؟ فروسيا تقيم قاعدة بحرية اضافية لها في سوريا غير قاعدة حميميم، وهذا معناه انها ستكون معنية جدا بالوضع السوري الداخلي، ما دام وجودها سيكون دائما او ابديا (!) بحيث لا يناسبها عمليات انتقامية ضد قواتها كما في افغانستان، وسيتعين عليها ان تؤدي دورا حاسما، أولا في ادارة الشأن السوري حماية لمصالحها بعيدا من الاضطرابات التي يمكن ان تنتقل اليها اذا استمرت الظلامة السنية باستمرار بشار الاسد، ثم يتعين عليها أيضا إرضاء الدول العربية الخليجية، أي الغالبية السنية في العالم العربي في صيغة حكم تستبدل الاسد أو تقلص صلاحياته على نحو يرضي بقية المكونات السورية الاخرى اذا تم التسليم جدلا بقدرتها على حماية بقائه في السلطة او لم تختلف مع ايران على ذلك.
النهار
المستجد في السياسة الخارجية الروسية/ عبد الستار قاسم
شعور روسيا بالقوة
الاستعلاء الغربي
توقعات
أعلنت روسيا مؤخرا عن “عقيدة” جديدة لسياستها الخارجية شملت عددا من النقاط الهامة وتناولتها وسائل الإعلام المختلفة بالتحليل والتدقيق. من هذه النقاط أن روسيا لن تخضع للضغوط الأميركية التي قد تمارس ضدها، وسترد بكل قوة على كل ما يمكن أن تتعرض له من ضغوط ومضايقات، وأنها مع استقلال سوريا ووحدة أراضيها، وتقف بقوة ضد الإرهاب وتعمل على إقامة تحالف دولي لمواجهته والقضاء عليه.
وأعلنت أيضا أنها ستعزز وجودها في المحيط الهادي وفي القطبين الشمالي والجنوبي، وستعمل على تعزيز دور الأمم المتحدة لتكون المرجعية في حل الأزمات الدولية، وتعزيز مكانة القوانين الدولية وإلزام الدول باحترامها. ووجهت انتقادا للولايات المتحدة التي عملت على مدى سنوات للسيطرة على العالم واحتكار البحث عن حلول للأزمات الدولية، وقالت “العقيدة” الجديدة إنه لا يجوز لأميركا عولمة تشريعاتها الداخلية وفرضها على العالم.
شعور روسيا بالقوة
تشعر روسيا أنها خرجت من حالة الضعف التي آلت إليها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. أتت عليها ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة بعد أن طارت أجنحتها الغربية والجنوبية وانتهت إلى اتحاد فيدرالي لا يخلو من التحديات الداخلية. كما أن الغرب استضعفها وأملى عليها كثيرا من السياسات بسبب حاجتها الماسة للمال والاستثمارات الغربية، لكنها بدأت منذ سنوات تسترد صحتها الاقتصادية، وتخلصت من العديد من الأمراض الاجتماعية خاصة من استشراء رأس المال الذي طغى على الطبقة الوسطى وأنهك الفئات الأقل حظا. وكان من حسن طالعها أن أسعار الغاز والنفط قفزت عاليا على مدى فترة طويلة، فاستغلت الفرصة لتحسين الظروف الاقتصادية لنسبة كبيرة من سكانها.
انتقلت روسيا من مرحلة الانكماش على الذات إلى مرحلة استرداد الكبرياء ولو قليلا، وحانت ظروف تمكنها من ذلك كان على رأسها الوضع الجورجي. لم تتصرف جورجيا بحكمة وربما وقعت تحت ظنين وهما أن روسيا أعجز من أن تهاجمها وتفرض شروطها، وأن الغرب لن يتركها وحيدة فيما إذا هاجمتها روسيا. خاب الظنان وقامت روسيا بالاستفراد بها دون أن يصنع أهل الغرب شيئا سوى الضجيج الإعلامي.
لقد ظفرت روسيا رغم أنف أميركا التي وقفت ضد الحرب ووجهت الكثير من الإدانات للأعمال الروسية. ثم أطلت المشكلة الأوكرانية برأسها، ولم تتوان روسيا فيما أسمته استرجاع شبه جزيرة القرم. أرسلت قواتها في وضح النهار إلى المكان وسيطرت عليه وأعلنت عودته إلى حضن أمه روسيا. ووجد الروس أن رد الفعل الغربي لم يكن سوى جعجعة فارغة. ولهذا رفع الروس التحدي درجة أخرى عندما قدموا الدعم الضروري للثوار الأوكرانيين في شرق أوكرانيا. تحدث أهل الغرب من السياسيين والإعلاميين ضد هذه الخطوة، ولم يجدوا في النهاية إلا فرض عقوبات على روسيا مع علمهم أن سياسة العقوبات فاشلة تاريخيا ولم تنجح ضد أي دولة فُرضت عليها عقوبات.
تراكم شعور الروس بالقوة إلى أن وصلت الأمور إلى سوريا؛ تردد الأميركيون كثيرا في دعم طرف لحسم المعارك واختاروا تدمير سوريا، فاستغل الروس الفراغ الحاصل في سوريا وقفزوا إلى الميدان لينفردوا في إدارة الصراع وتوجيهه بالطريقة التي يرونها مناسبة. ما زال الغرب يزاحم سياسيا وإعلاميا من أجل أن يكون له نصيب في إدارة الدفة، لكن الروس يقدرون أن أميركا ومن والاها لا يملكون مجالا أو بابا للتأثير الجدي في سوريا سوى باب الإعلام والتصريحات السياسية.
الاستعلاء الغربي
ماذا تفعل إذا أردت للقط أن ينقلب أسدا؟ تحشره في زاوية. هكذا فعل أهل الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة مع روسيا. لقد عملوا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي على محاصرة روسيا عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا وماليا وألحقوا بها إهانات كثيرة كان على رأسها الإهانة في العراق. وقد دعم أهل الغرب رأسماليين كبارا في روسيا من أجل تحويل الاقتصاد الروسي إلى نظام اقتصادي شبيه بالاقتصادات الأوروبية، وسببوا لروسيا آفات اجتماعية كثيرة منها انتشار العصابات الإجرامية والمخدرات، وتعمدوا تخريب المجتمع الروسي.
وفي ذات الوقت بدأ الغرب يخطط لحصار روسيا عسكريا وشل قدراتها على المواجهة، عملت أميركا وحلفاؤها على توسيع حلف شمال الأطلسي، وانضمت له عدد من الدول التي كانت ضمن المنظومة السوفييتية، وهي دول مجاورة في الغالب لروسيا، وخرجت أميركا بفكرة الدرع الصاروخية التي من شأنها تطويق روسيا من ثلاث جهات. تذرعت أميركا بأن هذه الدرع موجهة ضد الصواريخ الإيرانية، لكن ذلك لم يكن مقنعا للروس.
تطاول الغرب كثيرا على روسيا وعمل على إذلالها آخذا بعين الاعتبار أنها قوة نووية عظمى وتستطيع تدمير أوروبا وأميركا في آن واحد. لم تكن خطوات الغربيين ضد روسيا متناسبة مع التوازنات العسكرية الفعلية. وربما ينبع هذا من عقدة الاستعلاء التي يعاني منها الغرب في تعامله مع الأمم. هم يشعرون بأنهم أرباب النعم، وهم القادرون فقط على تحقيق الاستقرار والأمن والسلم العالميين، ويتعاملون مع الشعوب الأخرى على أنها متخلفة تنتظر رغيف الخبز من عطاء خزائنهم.
ولنا نحن العرب تجارب كثيرة مع أهل الغرب الذين دأبوا على استعمالنا مطايا لسياساتهم ومصالحهم. منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى الآن وهم يعبثون بالوطن العربي والمواطنين ويثيرون الفتن والأحقاد والضغائن ويدعمون حكاما استبداديين شهوانيين لا يتقنون سوى الهزائم.
توقعات
إزاء التطورات الجارية الآن على الساحة الدولية والعقيدة الروسية الجديدة للسياسة الدولية نتوقع حصول المزيد من التطورات أذكر منها:
سباق التسلح
يعيش العالم الآن أجواء الحرب الباردة على الرغم من أن لهجات السياسيين من كل الأطراف ناعمة إلى حد كبير. الروس والأميركيون حريصون على تخفيف نبرات تصريحاتهم، وهكذا يفعل السياسيون الأوروبيون، وجميعهم يؤكدون أنهم لا يسعون إلى التصعيد والمواجهة.
بالنسبة لنا نحن الذين نعيش على الهامش، التصعيد لا يخدم أي طرف منهم لكن تصعيدهم يتم بالوكالة عادة، أي نحن وقود تصعيدهم وحروبهم غير المباشرة. لكنهم في ذات الوقت يتبادلون النظرات والتدقيق، وباتوا يدركون أن الإصرار ظاهر على الوجوه حتى لو أدى ذلك إلى مغامرات عسكرية مدمرة. ولهذا سيسعى كل طرف إلى سد الثغرات العسكرية التي يعاني منها خاصة فيما يتعلق بالمعدات العسكرية.
تدرك روسيا أن أسلحتها التقليدية فيما يتعلق بسلاحي البر والجو ليست متطورة كالسلاح الغربي، وستسعى نحو المزيد من الجهود لتطوير قدرات جوية وبرية أفضل، وتدرك أميركا أن السلاح الروسي الذي من شأنه إبطال مفعول تفوقها البري والجوي متطور جدا ويفسد عليها الكثير من خططها العسكرية. ولهذا نتوقع السباق على إنتاج أجيال جديدة من الأسلحة خاصة فيما يتعلق بالتقنية الإليكترونية وسلاحي الدبابات والطائرات. ومن المحتمل أن يشمل السباق الأسلحة النووية على الرغم من تأكيد بعض الأطراف نيتها تخفيض قدراتها النووية. وسيمتد السباق إلى الفضاء وسيحرص كل طرف على تطوير التقنية الفضائية الخاصة بالتجسس والاستطلاع وإبطال مفعول تقنيات الطرف الآخر.
استعراض العضلات
ستعمد الدول المتنافسة بخاصة روسيا إلى استعراض عضلاتها لإيصال رسائل قوية إلى الأطراف الأخرى. ستسير روسيا مزيدا من طائراتها الإستراتيجية في أجواء العالم بخاصة في شمال الكرة الأرضية. وسترفع من وتيرة تجوال غواصاتها وسفنها الحربية في المحيطات والبحار، وستركز قطعا عديدة في مناطق المحيط الهادي قرب البحرين الصينيين الجنوبي والشمالي ومنطقة المحيط الهندي بالقرب من بحر العرب والسواحل العربية الإيرانية، ولن تترك البحر الأبيض المتوسط بركة سباحة للأوروبيين.
لكن هذا الاستعراض الروسي يبقى مقيدا بالقدرات الروسية الاقتصادية. روسيا ليست منافسا اقتصاديا أو ماليا للولايات المتحدة على الأقل تحت الظروف الراهنة. الاستعراض مكلف جدا، وروسيا تعاني من نقص مالي خاصة مع هبوط أسعار النفط والغاز عالميا. روسيا دولة ثرية ولديها الكثير من المصادر الطبيعية، لكن قدراتها على استثمار الثروات بقيت محدودة وطالما لجأت للشركات الغربية للاستثمار في أراضيها. أي من المحتمل أن يلوي الغرب ذراع روسيا اقتصاديا إلا أذا أحسنت روسيا استخدام ما في باطن أرضها من كنوز.
تحسين العلاقات بين الدول
العالم الآن مضطرب اقتصاديا ونفقات الأسر والعائلات في كل العالم تتصاعد، والشعوب تتطلع إلى تحسين ظروفها المعيشية وتحاسب حكوماتها وفق معيار الأوضاع الاقتصادية. والحكومات والأحزاب التي تشكلها حريصة على البقاء في الحكم، ولا مفر أمامها إلا تحسين ظروف الناس، وهو تحسين لا يأتي من خلال الحروب وإنما من خلال الادخار والاستثمار.
وعليه فإن الحكومات المتعقلة لا تتجه نحو الحروب حتى لا تستفز الناس وتلحق الظلم بهم، وإنما من خلال البحث عن الأمن والاستقرار والسلام. ولهذا فإن روسيا ستلجأ إلى تحسين علاقاتها مع دول متخاصمة معها إلى حد ما وهي اليابان وبعض دول أوروبا الشرقية بخاصة لاتفيا وإستونيا، وستعمل على معالجة مشاكلها الداخلية مع قوميات غير روسية. أما أميركا فستقلص من تدخلاتها في شؤون العالم، وسيتطور لديها اتجاه مقتنع بأنها ليست هي الدولة المسؤولة عن العالم. ومن الصعب لأميركا أن تهرب من الاقتراح الروسي الداعي إلى تشكيل تحالف دولي ضد الإرهاب. لقد فشلت أميركا في حربها ضد الإرهاب، وربما تدرك الآن أنها يجب أن تتعاون مع الآخرين وفق مبادئ الاحترام المتبادل لمواجهة الإرهاب العالمي.
إسرائيل
الدول النووية لا تلجأ إلى تصعيد خلافاتها حتى الحرب، لكن إسرائيل هي المفسدة العالمية القادرة دائما على توتير العلاقات الدولية. إسرائيل تدفع باستمرار ومنذ زمن نحو تمرد أميركا على الاتفاق النووي مع إيران، وفي هذا ما سيؤجج خلافات كثيرة قد تنتهي إلى حرب في المنطقة. وهي تستمر في تحريضها لأميركا على روسيا في سوريا.
وبغض النظر عن اتفاقنا مع روسيا أو اختلافنا معها، التوجهات الإسرائيلية من شأنها تأزيم أوضاع المنطقة بالمزيد، وغدا ستحرض ضد مصر ودول عربية أخرى. إسرائيل لا تطمئن لأجواء الأمن والسلام، وترى دائما أن القتل والدمار في خدمة أهدافها. فهل سيدرك الأميركيون الذي تجرهم له إسرائيل؟
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
الفشل التاريخي للروس هل يتكرر شرق أوسطيا؟/ نبيل الفولي
أنواع الفاعلين
قراءة التداخلات
شرق أوسط روسي مدمَّر
يغلب على فهم السياسة الأميركية تجاه الوجود الروسي في سوريا أن واشنطن تركت غريمها المندفع يتورط في المستنقع السوري؛ تجنبا -من ناحية- للمواجهة مع موسكو المتطلعة إلى حفظ بقايا نفوذها الإمبراطوري القديم، وضربا -من ناحية أخرى- للمعارضة المسلحة على الأرض السورية بكل صورها بلا كلفة أميركية؛ حتى إذا توقفت الحرب في سوريا لم يكن هناك كيان قوي يصعب السيطرة عليه؛ كما كان الحال في المواجهة الغربية السوفيتية في أفغانستان قبل عقود.
أنواع الفاعلين
الأميركيون لا يهمهم من مشكلة سوريا إلا حلفاؤهم في المنطقة وما يرتبط بهم من مصالح أميركية، خاصة في القاهرة وتل أبيب، والثانية على توافق تام مع الروس بعد لقاءات حميمة عديدة بين بوتين ونتنياهو، وأما القاهرة فخلافاتها مع موسكو ليست بالعمق الذي يهدد النظام المصري القائم.
وفي مقابل هذا يعاني الأوربيون مع مشكلة الحرب في سوريا من جهتين: الأولى قرب الحرب من الجغرافيا الأوربية، والثانية موجات النزوح البشري الواسعة التي باتت تركيا غير مستعدة لتحمل مؤونة المزيد منها، بل أعلنت أنها قد تشبعت تماما من هذه الناحية، ويكفي أن تظل أنقرة راعية لقرابة ثلاثة ملايين منهم على أرضها؛ خاصة في ظل رفض الأميركيين وجود منطقة آمنة في شمال سوريا.
ومن خلال هذه الحسابات يبدو للمراقب أن هناك ثلاثة فاعلين رئيسيين في المشهد السوري: فاعل صامت، وفاعل ناطق، وفاعل متطفل. والفاعل الناطق الصارخ هي طائرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما تحدثه من دمار في القطر العربي اليتيم وما تقتله من أبرياء جارت عليهم معادلات السياسة الدولية وحساباتها في المنطقة.
وهذا الفاعل الناطق يطمع في تكرار سيناريو استعادة غروزني سنة 2000 من يد الحكومة الانفصالية وقواتها بتوظيف سلاح الطيران الروسي في الدك والتدمير بدون خطوط حمراء، على أن تقوم قوات الأسد والميليشيات الإيرانية وشبه الإيرانية بإتمام مهمة السيطرة على الأرض.
وأما الفاعل الصامت في الساحة السورية، فهي الولايات المتحدة وبعض حلفائها في أوربا الغربية، وصمتها يبدو أنه سيكون أشد تأثيرا في تحديد مستقبل سوريا من تأثير غريمها؛ لأنه قائم على اللعب على تقاطعات الصراع المحتدم وحسابات الاتفاق والاختلاف بين القوى المتصارعة أكثر من قيامه على المغالبة بالقوة التي نشهد فيها تفاوتا كبيرا بين أطراف الصراع في سوريا دون أن نتوقع قدرتها على الحسم بدون مراعاة لطبيعة الموقف من نواح أخرى.
ولعل أهم معالم الفعل الصامت والمؤثر جدا للولايات المتحدة في سوريا هو ظهورها في صورة الأخ الأكبر للجميع في مواجهة عدو هلامي اسمه “الإرهاب”، وهو ما يمنحها فرصة للعب بمواقف المجتمع الدولي الذي توقف في المأساة عند حدود الشجب والبكاء الإعلامي، ومن وراء الستار تضرب سياسة واشنطن خصمها بيد غيرها، أي تضرب القوى المسلحة العاملة ضد النظام بيد الروس، وفي لحظات تبدو فيها الأمور محسومة بضربات الطيران الروسي يتسرب السلاح إلى المجموعات المسلحة فلا يتم الحسم التام لأي من أطراف النزاع المتحاربة.
ومن العلامات الكاشفة لهذا الدور الأميركي الصامت: تراجع الأميركيين عن أمرين خاصين بسوريا كانا مهمين قبل التدخل العسكري الروسي فيها: الأول المشاركة العسكرية المباشرة في المواجهات القائمة على الأرض السورية، والثاني فكرة إسقاط الأسد وتبني تصورات لسوريا بدونه.
وأما الفاعل المتطفل في المعضلة السورية، فهو التحالف الذي يجمع بقايا جيش الأسد وميليشيات حزب الله ومرتزقة من عدة بلاد تخضع كلها لإدارة قيادة عسكرية إيرانية وتوجيهات خبراء حرب من الروس، وتكمن خطورة هذه القوات – رغم عجزها عن حسم أي شيء بمفردها- في أنها تقاتل على الأرض، وتَصلى نيران الحرب مباشرة، وتكتسب خبرة قتالية قد يكون لها تأثيرها في مناطق أخرى فيما بعد، وبالتالي تنافس المجموعات السنية المقاتلة للنظام السوري في السيطرة على الأرض؛ أي أنها الأداة المكملة للقصف الروسي الساحق، مهما قلنا عن اتفاق أو اختلاف أهدافها عن الروس.
وتبقى المجموعات السنية المقاتلة بعد كل هذا رقما مهما، إلا أنها يتيمة سياسيا وعسكريا، فسياسيا لا أحد -شخصا كان أو هيئة أو مؤسسة- يحسن الحديث باسمها ولا باسم الثورة السورية عموما، وعسكريا لأنها ما زالت -رغم جهودها- ضعيفة الإمكانات مشتتة القوى، لا يأتيها الفرج إلا حين توشك المعركة على الحسم لصالح النظام ومن معه، فتنفخ فيها تقاطعات الصراع روح الحياة من جديد بدون حسم من هذه الناحية كذلك.
وليس هذا تقليلا من الجهود الحربية التي تقوم بها الأذرع العسكرية للثورة السورية، ولكنه توصيف للواقع الصعب القائم، وكثيرا ما أدت التطورات في لحظات تاريخية مشابهة إلى تقوية طرف خامل أو هامشي حتى كانت له كلمة الفصل في صفحة التاريخ بعد أن كانت الحسابات تستبعده من البقاء أصلا.
قراءة التداخلات
إذن ليست الصواريخ وحدها هي القادرة على حسم صراع عسكري بهذا التعقيد السياسي والجغرافي كالذي تشهده سوريا، فهل يسوق الروسَ تاريخُهم إلى مزيد من المغامرات الفاشلة ولو بعد حين؟!
أحسب أن هذا هو الذي نشهده بأم أعيننا في الساحة السورية، فالتاريخ مؤثر وقابل للتكرار ما دامت عوامل صناعته قائمة على حالها؛ إذ إن الاختلاف بين روسيا القيصرية ثم الشيوعية وبين روسيا بوتين يبدو في الدرجة وليس في النوع؛ إذ تقوم السياسات الداخلية لهذه التجارب الثلاث على التحكم في مفاصل الدولة في الداخل، والسيطرة على اقتصادها، وامتلاك قوة أمنية رادعة، وفي الخارج على رعاية المصالح باستخدام القوة وصناعة أو شراء الحلفاء.
لقد نافست روسيا دول أوربا الغربية إبان نهضتها الحديثة في عصر بطرس الأكبر وكاترين الثانية، وتوسعت استعماريا في الفضاء الإسلامي الواسع في وسط آسيا والقرم، لكن تجربتها في مجملها لم تبلغ حضاريا بل لم تقترب من قوة التجارب الإنجليزية والفرنسية والألمانية حينذاك. وكذلك نافس السوفيات غرماءهم الأميركيين في الحرب الباردة منافسة قوية وبندية كبيرة في الظاهر، إلا أن النموذج الروسي الشيوعي آل إلى الفشل الذريع أيضا، فسقطت دولة القياصرة في ثورة عام 1917، وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991.
ويأبى التاريخ الآن إلا أن يعيد نفسه في روسيا من جديد؛ لا لأسباب بيولوجية في الشخصية الروسية، فقد نفى العلم وجود هذه الفروق بين البشر نفيا لا رجعة فيه، لكن لثبات العوامل الصانعة للتاريخ الروسي، فبوتين يأتي إلى السلطة وفقا لقواعد ديمقراطية شكلية في حين أنه لا يختلف في هذا حقيقة عن زعامات العالم الثالث، ويتمكن من السلطة لا وفقا لقواعد دستورية وقانونية، ولكن وفقا للأمر الواقع الذي لا يملك أحد في روسيا تغييره، ويكفي أن نعلم أن واحدا فقط من الموالين للرئيس الروسي في الاتحاد الروسي، وهو حاكم الشيشان رمضان قديروف يوفر له ميليشيا شيشانية تربو على خمسة وعشرين ألف مقاتل وظيفتها حماية الرئيس وردع التظاهرات التي قد تخرج ضده.
وإشكالية هذه النماذج القيادية التي تقدمها روسيا من فترة تاريخية إلى أخرى هو أنها تخدم أغراضها لا شعوبها، وتضع مستقبل بلادها فوق بركان يوشك أن ينفجر، فقد يكون للزعيم من قوة الشخصية والسطوة ما يضمن له حفظ النظام في حياته، أو في فترة إدارته للبلاد، ثم تحمل المرحلة التالية من عوامل الانهيار الكثير.
شرق أوسط روسي مدمَّر
وهنا تحضر التجربة السوفياتية فيما يسمى بالشرق الأوسط لمناسبة ما تقوم به طائرات بوتين في سوريا من جرائم يندى لها جبين الإنسانية، حيث كانت للسوفيات مواطئ أقدام مهمة في اليمن الجنوبي وسوريا ومصر عبد الناصر، ثم انتهى النفوذ الروسي بمصر مع طرد السادات للخبراء العسكريين الروس إبان حرب رمضان 1393هـ/ أكتوبر/تشرين أول 1973 مع إسرائيل، وفي اليمن مع تفكك الاتحاد السوفياتي، في حين احتفظ آل الأسد بنفوذ حلفائهم في أرض سوريا حتى أفاقوا من سكرة التفكك.
ولعل الحجة التي يرددها الروس اليوم من أنهم إنما يقصفون أهدافا إرهابية في سوريا، تستدعي مشهدا تاريخيا قريبا شهدته العاصمة الشيشانية غروزني عقب احتلالها من جديد عام 2000، ويؤكد أن الروس اليوم ما زالوا يفكرون بالطريقة الخطأ نفسها التي فكروا بها أمس وقبل أمس، وسببت لهم كثيرا من العطب التاريخي والسياسي؛ إذ فضل رسلان حمزات غلاييف -أحد قادة الحرب الشيشانيين- الانسحاب بقواته من غروزني انسحابا علنيا، حتى يجنب المدنيين مزيدا من التدمير الفظيع الذي قام به الطيران الروسي، إلا أن الروس -رغم ذلك- استمروا في قصفهم الهستيري للمدينة المغضوب عليها، حتى صارت -على حد وصف تقارير الأمم المتحدة عام 2003- أكثر المدن دمارا في الكرة الأرضية (The most destroyed city on Earth”!).
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
خلاف إسرائيلي – روسي على سوريا/ رندة حيدر
للمرة الأولى منذ بدء الحرب الاهلية السورية يدلي مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بموقف واضح من التسوية السلمية لهذه الحرب. فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان صراحة رفضه ان يكون بشار الأسد وإيران جزءاً من هذه التسوية. وهذا يشكل مؤشراً لخروج إسرائيل عن موقفها المبدئي بعدم التدخل في ما يحدث في سوريا، ودليلاً على اختلاف في وجهات النظر بينها وبين روسيا في شأن الحلول السياسية لانهاء هذه الحرب.
وليس من قبيل المصادفة عودة الغارات الإسرائيلية على أهداف بالقرب من مدينة دمشق بعد توقفها زمناً طويلاً بذريعة احباط محاولات تهريب صواريخ متطورة الى “حزب الله”. وفي الهجوم الأخير لمّح ليبرمان الى امكان تهريب اسلحة غير تقليدية من سوريا الى الحزب. ويعكس هذا كله مدى اهتمام إسرائيل بما يحدث في سوريا وتخوفها مما يحاك حالياً من حلول سياسية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي حدث فجأة وجعل المسؤولين الإسرائيليين يتخذون موقفاً من بقاء بشار الأسد؟ وما هي دلالة الموقف الأخير لوزير الدفاع، خصوصاً ان مسؤولين إسرائيليين آخرين لا يكتمون سرورهم بالنجاحات العسكرية الأخيرة لبشار الأسد كما نقل عنهم المعلق العسكري في صحيفة “معاريف”؟
عندما يلمح ليبرمان الى عدم وجود اتفاق في الرؤية بين إسرائيل وروسيا في شأن الحل السياسي للحرب في سوريا وهو المعروف بقربه من روسيا وبعلاقاته الجيدة مع فلاديمير بوتين، فمعنى ذلك أن لدى إسرائيل مطالب أمنية معينة من الروس، وان التفاهمات والتنسيق العسكري التي جرى التوصل اليها بعد التدخل الروسي في سوريا في حاجة الى اعادة نظر والى مزيد من البحث.
من أهم المخاوف التي تقلق إسرائيل بعد انتهاء الحرب في سوريا مصير الوجود العسكري الإيراني هناك، وتأثير صمود نظام الأسد بفعل الدعم الروسي على تعاظم القوة العسكرية لـ”حزب الله”، بالاضافة الى هامش حرية تحرك إسرائيل في الأجواء السورية في ظل المنظومة الصاروخية الدفاعية الروسية التي تغطي جميع أنحاء إسرائيل، وأجهزة الرادار المتطورة القادرة على التحذير من هجوم إسرائيلي حتى قبيل انطلاق الطائرات الإسرائيلية من قواعدها.
قد يكون تواتر الغارات الإسرائيلية على أهداف تقع في عمق سوريا رسالة موجهة الى جميع الأطراف المنتصرين حالياً بأن عليهم ان يأخذوا في الاعتبار مصالح إسرائيل الأمنية في اي حل سياسي مستقبلي في سوريا. كما ليس من المستبعد ان يكون استخدام إسرائيل صواريخ أرض- أرض محاولة لاختبار رد الفعل السوري والروسي على حد سواء.
النهار