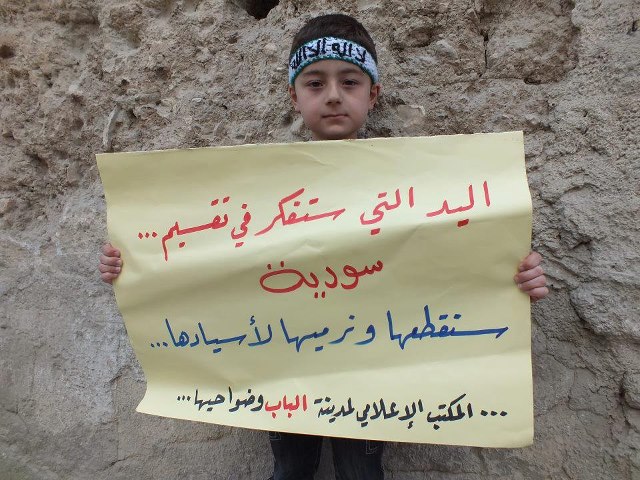عن حال اللاجئين السوريين وحالنا –مقالات محتارة-

ما الحال الذي لا يكون عليه السوري؟/ عمر قدور
في خضم الانتهاكات العنصرية التي تعرض لها سوريون في لبنان، برزت أصوات لبنانية تدعو السوريين إلى التعقل وعدم إبراز عنصرية مضادة، على وسائل التواصل الاجتماعي التي لا يملكون غيرها أصلاً، لئلا ينعكس ذلك انتهاكات أشدّ في حق المنكوبين. أصحاب هذه التحذيرات، بنواياهم الطيبة، يدركون ضعف السوري في لبنان، ويدركون أن العنصرية اللفظية تعبير عن الغضب ليس إلا، بما أن الغضب سلاح الضعيف وأول الانفعالات ظهوراً إثر الإحساس بالقهر، فتكون الخلاصة كأن المطلوب من السوري هو الصمت تحت طائلة التعرض لمزيد من الأذى، وهو تحذير فيه ما فيه من استباحة غير مقصودة بالتأكيد.
يُذكر أن السوريين منذ اندلاع الثورة تناولوا تنظيم الأسد بأشد النعوت، ولم يتراجعوا مع كل الوحشية الأسدية، ولم يطالبهم أحد بالتراجع لئلا يستفزوا آلة القتل أكثر فأكثر. لكن صورة السوري الصامت تتسلل اليوم لتملك جاذبية من قبل ضعفاء المنطقة، إذ يعي هؤلاء الضعفاء مغزى التطورات في المنطقة، وليس من شأنهم المباشر عدم التعايش مع بقاء الأسد، أو حتى عدم التعايش مع الأسدية في بلدان أخرى ما دامت الأخيرة موجهة إلى النازحين فحسب.
ليس القصد إطلاقاً تصوير السوريين كثوريين في محيط متخاذل، فهذا قول يعادل في تعسفه وصف نازحي لبنان بالإرهابيين من قبل شخصيات سياسية ذات وزن، ويعادل أيضاً وصفهم من قبل بطريرك موارنة لبنان بمنتزعي اللقمة من فم أبناء بلده. المشكلة هي في استسهال إطلاق الأحكام على السوريين في بلدان المنطقة، ما ينم عن استضعاف مطلق، إذ لا أسهل مثلاً من القول إن السوريين دمروا بلدهم، هكذا من دون إشارة «تبرئ ذمة القائل» إلى وجود عشرات الدول والتنظيمات المتحاربة على الأرض السورية.
لا أسهل أيضاً من وصم السوريين بحاضنة البعث، إذ يُهجى الأخير، وهل من دليل أقوى من بقائهم تحت حكمه نصف قرن قبل الثورة؟ وبالطبع لا أسهل من وصم فئة معتبرة منهم بحاضنة داعش، وهل من دليل أكثر إحكاماً من جعل الأخير مدينة الرقة عاصمة خلافته؟ بين هذا وذاك قد نأتي بأدلة من ممارسات عدة على أن السوريين تشربوا بأخلاق نظامهم، ولن نعدم المنطق الذي يقول بأن بقاء الأسدية لم يكن ممكناً لولا تعبيرها عن مجتمعها، مثلما لن نعدم ذلك المنطق الذي ينص على أن الثورات عموماً ابنة النظام الذي تثور عليه، وتحمل تالياً الكثير من صفاته.
لا يقع إطلاق هذه الأحكام في حيز النسبية، أو ضمن وصف لوحة مجتمعية مركّبة وشديدة التعقيد كما هو حال كل المجموعات البشرية. بل يذهب غالبية من يطلقون الأحكام إلى منحها مرتبة الحقيقة التي تستغني عما عداها. هذا التجرؤ في إطلاق اليقينيات، من دون استخدام ربما وأخواتها، يُفهم من قبل كثر من السوريين بوصفه استباحة معنوية تكمل الاستباحة المادية التي يتعرض لها سوريون في الداخل والخارج.
وقد لا نجافي الواقع بالقول إن بعضاً من هذه التحليلات، والإلحاح عليه، فوق ما فيه من مصادرة معرفية يذهب إلى تكريس صورة نمطية عن السوري تمهد لاستباحته فعلياً. فالتنميط، كما هو معلوم، هو أول أشكال العنف الرمزي، ومن أشكاله «الرقيقة» مجيئه تحت زعم محض معرفي، أو حتى تحت زعم مساعدة مجموعة بشرية على فهم ذاتها. ثمة اختلاف رئيسي بين هذا النوع من التحليلات ودراسة الظواهر الاجتماعية، فالأخيرة تتوخى فهم الظاهرة في بعدها الزمني، من دون إسقاط خصائص جوهرية على المجموعة البشرية المعنية، بينما أول ما توحي به تلك التحليلات هو إسقاط خصائص جوهرية على مجموعة بشرية بحيث لا يكون لها فكاك منها. في حالتنا السورية، ستملك هذه الخصائص تعسفاً أشد مع وجود واقع من التمزق المجتمعي قلّ نظيره، حيث تكون المخاطرة أساساً بالتحدث عن مجتمع يملك الحد الكافي من المشتركات.
لا نملك، على سبيل المثال، معلومات عن أثر تصادم بيئات سورية مختلفة في مخيمات اللجوء، ما يجعلنا عديمي المعرفة إزاء تلك المجتمعات الجديدة. ولا نملك سوى أرقام تقريبية عن عدد السكان الذين لم تتح لهم ظروفهم الهروب من حكم داعش في الرقة أو دير الزور، ولا نعرف تالياً تلك النسبة الموالية لداعش، ولا نعرف نسبة من يواليها عن قناعة أو عن انتهازية أو قسراً، مثلما لا نعرف نسبة المتبقين طوعاً أو قسراً في مناطق سيطرة الأسد.
لا يُعقل أيضاً إهمال ما يُعرف بوعي الأزمة، أو بوعي الهزيمة، عند التطرق إلى ظواهر لها بعد زمني. ولعل مثلاً بسيطاً مما يكشف البعد الزمني يغيّرُ نظرة شريحة كبرى من السوريين إلى حزب الله، من رؤيته مقاوماً الاحتلال إلى رؤيته ميليشيا تقوم بقتلهم بشعارات طائفية. هذا ينفي عن تلك الشريحة تهمة الطائفية إلى ما قبل سنوات قليلة مثلما ينفي عنها معرفة جيدة بطبيعة الحزب، ولا يُسقط عنها طائفية مستجدة نابعة من ظرف سياسي حربي، أو من شعور ضاغط بالمظلومية.
إن محاكمة مجمل الوعي السياسي في المنطقة، تذهب إلى هدف مغاير عندما يصبح ذلك الوعي عقلاً جمعياً، لا عقلاً ظرفياً ينقضي بانقضاء مسبباته. طول أمد بعض الظواهر، الذي يؤخذ حجة على عقل جمعي راسخ، قد لا يعني سوى بقاء المسببات ومنها ظروف خارجة على إرادة المجموعة البشرية المعنية، أو أكبر من قدراتها على نحو ما يواجه السوريين منذ حوالى سبع سنوات، وبالطبع على نحو ما واجههم من قبل ولا يزال يواجه غالبية شعوب المنطقة.
لم يُتح للسوريين التعبير عن أنفسهم، كمجموعة بشرية لها تطلعات مشتركة، إلا لفترة قصيرة في بداية الثورة. في ما بعد تم تحطيم ذلك الاجتماع الموقت، فقط في الأذهان بقي السوري معبّراً عن مجموع، وعلى ذلك أصبح الجزء مهما صغر مدخلاً لاستقراء ينطبق على كلٍّ غير موجود، وصار ممكناً نمذجة السوري «بوصفه جمعاً» على أي حال وجد فيه سوريون، لا يخرج عن ذلك تنميط «سوري الثورة» نفسه، إذ يزعم أن لا شيء يمثله سوى لحظة الثورة.
الحياة
العودة إلى دمشق: من جمر النار إلى الجحيم/ سميرة المسالمة
ترتفع في بيروت هذه الأيام أصوات المطالبين بعودة السوريين إلى ديارهم، فنسمع وقع صيحاتهم المدوية على أسماع مواطنيهم، ويتردد صداها في خيام و «منازل» اللاجئين، الذين يلملمون حاجياتهم ويضعونها في أكياس مهترئة بفعل الانتظار، يمسحون المكان بعيونهم الغائرة في وجوههم.
هنا تحت «سقف» لا يقي من برد أو مطر، ولا يعين على رد لهيب الشمس، كانت حياتنا، نحن «السوريين» (اللاجئين)، هاربين من الموت على يد النظام، حتى أصبحت أقدارنا المهزومة تواجهنا بموت آخر، وأن ما من مهرب. عودوا إلى موتكم الأول تحت حكم نظام الأسد، قنابله وبراميله، طيرانه وصواريخه، فهي ربما لا تؤدي إلى مصير مختلف عندما يكون الموت هو الخاتمة، ولو تحت التعذيب.
هكذا، أمام حال العجز والبؤس والإنكار، قابلت مجموعة من الناشطين السوريين حكم الموت على سوريين تحت التعذيب بـ «حرب الأمعاء الخاوية»، بهاشتاغ: (# صيدنايا- لبنان)، في إشارة منهم إلى ما يجمع مصائر المعتقلين السوريين، سواء في معتقلات نظام الأسد أو في بلدٍ طالما كانت تؤرق حريته مضاجع حكام العرب، فيهرب إليه كل باحث عن مساحة حرية لينشر فيه ما عذب من كلام الحق والحب والمواطنة الممنوعة عنه في «بلاد العرب أوطاني».
طبيعي أن موت بعض السوريين (لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين) في معتقل لبناني لا يقارَن بعشرات الآلاف ممن قضوا في سجون النظام، إذ يقول التقرير الأخير لـ «المرصد السوري لحقوق الانسان» إن ٤٥ ألف سوري قتلوا تحت التعذيب واحتجاز الحرية والإهمال، لكنّ الحدث اللبناني يأخذ بعداً آخر، حيث يفترض أن مؤسسة الجيش في لبنان ليست بيد حكومة ديكتاتورية، إلا إذا كان «حزب الله» الذي يقتل السوريين في سورية هو الذي يتحكم بمصائرهم في لبنان.
يمارس «حزب الله» إحدى أهم الاستراتيجيات المسلحة الايرانية في سورية (ولبنان)، وهي سياسة التهجير والتغيير الديموغرافي وفق خريطة مرسومة منذ الأسبوع الأول لاندلاع الثورة في سورية (آذار/ مارس ٢٠١١) وحتى ما بعد الاتفاق في جنوب سورية الذي تم أخيراً بين روسيا والولايات المتحدة لإنشاء ما سمي منطقة آمنة خالية من الوجود الايراني الذي يهدد امن السوريين وجوارهم، الأردن واسرائيل. ويبدو أن هذا الأمر نشّط الحراك الاجرامي للحزب بحق السوريين خارج الحدود السورية أيضاً، في الداخل اللبناني، وفي مخيمات اللاجئين تحديداً، ما حوَّلها محطَّ أنظار المجتمع الدولي من جهة، ومحلَّ صب جام غضب بعض اللبنانيين، من خلال آلاتهم الاعلامية وشائعاتهم التي أججت الخلاف وحوّلته، اضافة إلى طائفيته، خلافاً مناطقياً وطبقياً، وضاعفت توتر اللبنانيين بسبب ظرفهم الاقتصادي والمجتمعي والسياسي المتأزم، قبل ثورة السوريين ولا يزال.
وضمن خطة تبييض واقع النظام وميليشيا «حزب الله» في مناطق سيطرتهما المزعومة في القلمون، ولإقناع المجتمع الدولي بقدرتهما على اعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق المسترجعة من المعارضة، كان لا بد من فبركة «مشهد العودة» إلى الوطن والترويج له، والذي يعني بمضمونه العودة إلى الانضواء تحت حكم النظام، والتسليم بنجاحه المزيف في فرض حالة الأمن وإعادة المهجرين الذين ساهم «حزب الله» نفسه في تشريدهم من ديارهم ومدنهم واستولى على ممتلكاتهم وزرع بينهم غرباءه، لإحداث الشرخ المجتمعي والتغيير الديموغرافي. كانت عودة الأسر المغلوبة على أمرها من لبنان إلى القلمون عودةَ الهارب من جمر النار إلى جحيمها، بينما كانت مشاهد العائدين عبر كاميرات «حزب الله» تصور انتصار سلامهم المدمّى، متناسية أنهم يعودون إلى حيث قُتل أولادهم، وهم ينتظرون من المآسي ما يساوي فاجعتهم بمدنهم المدمرة، ومجتمعهم الذي لُوِّن بما ليس منهم.
في المقابل، يمنح «حزب الله» أمثاله من المتطرفين في الجانب الآخر، ممن سُمُّوا «متطرفي السنّة»، من «داعش» و «النصرة»، الفرصة ليكونوا عاملَ جذب آخر لعودة اللاجئين السوريين، حيث تخشى تلك الأسر على أولادها من تهمة الارهاب، بسبب نشاط تدعو إليه هذه المجموعات المصنفة ارهابية، وهي بذلك تخدم تماماً هدف النظام و «حزب الله» في خلط الأوراق، وتأكيد أن الحرب الدائرة هي فقط بين ارهابيين وحكومة شرعية، لتنجح في خطتها بإبعاد صفة الصراع السياسي عما يحدث في سورية ولبنان معاً.
يعود بعض العائلات المشردة من لبنان إلى ريف دمشق وفق الخطة التي وضعتها إيران وينفذها «حزب الله» من دون أي ضمانات سلامة، ومن دون أن تجد ما ينتزع خوفها على حياة أولادها المطلوبين للنظام، إن لم يكن بـ «جريمة» التظاهر ضده، فبجريمة الهرب من الخدمة الالزامية، التي ربما تستوجب استعداد المجند وأهله للتحول من مدافع عن الوطن وحدوده إلى قاتل لأبناء هذا الوطن، الذي فُتحت حدوده لكل من هب ودب من قوات عسكرية وأفراد بأجندات ارهابية عبروها ليقولوا إن الصراع في سورية هو صراع مع قوى ارهابية، مبتعدين بذلك من أي حلول سياسية تقربنا من اليوم الأول للثورة، التي انطلقت من اجل الحرية والكرامة وحق المواطنة، فغابت تلك المطالب وحضرت الفوضى والغوغائية، ووحدها حرية القتل هي المنتصرة حتى اليوم، وكذلك حضرت أجندات الفصائل المتقاتلة في ما بينها لتكون عامل فشل اضافي لثورة النصف مليون شهيد، ومنهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء بحسب المرصد، وأكثر من مليوني مصاب ومعوق.
يعود بعض العائلات إلى سورية، إلى حيث تجد مبرراً لتموت هناك في ظل نظام القهر والحصار والقهر والتجويع في زمن الحرب، بينما لا سبب يبقيها في لبنان طالما يد الموت تطاولها فيه، وبحجج واهية، ومعارضة تتوهم أنها تفاوض، وتنسى أن من تفاوض باسمهم يتجرعون مرارة الذل والحصار والتجويع.
قالت لي «عائدة»، وهي سيدة سورية تهم بالعودة إلى دمشق، إنها اشترت كل ما سوف تحتاج إليه هناك لدى عودتها إلى بلد النصف مليون ضحية، وضمن ذلك كفن أبيض، ربما استعداداً لما قد يكون مصيراً أسود، إلا أنها أردفت: لكنه أقل من سواد أن تموت لاجئاً، بذات اليد والسلاح اللذين هجّراك (حزب الله) وقتلا أولادك، ودمرا مدنك واحتلت أعلامهما الصفراء ساحات دمشق وطرق سورية «المفيدة».
* كاتبة وإعلامية سورية
الحياة
نحن كسوريين لا نتوقع خيراً من أحد/ نور عجوم
ليست فقط نزعة عنصرية، هي أيضاً باتت “فشة خلق” لكل مواطن في بلاد الجوار، لم يجد شيئاً أرخص من ضيفه السوري ليفرغ على رأسه جام غضبه، ويلقي عليه كل أنواع السباب والعذاب.
مواطنو دول الجوار هم مضيفون لأزمتنا بكل تفاصيلها، ليسوا فقط شاهدين على نزوح أهالينا نحوهم، بل شهدوا كل تفاصيل الألم الذي حل بالسوري، تعرفوا على كل مكونات الصراع، حتى إنهم اتخذوا مواقف لتأييد طرف ما على حساب طرف آخر يؤيده بعض آخر منهم.
يشرئب من هم مشهورون بينهم ليعطوا رأيهم تجاه سورية، ويحسب واحدهم بأن رأيه مهم، أو أن هذا الرأي سيغير شيئاً في اتجاهات جمهوره، دون علم منه أو منها بأن هذا الجمهور يكترث بهم فقط في لحظات يحتاج بها العقل إلى شيء من التفاهة!
وبالتزامن مع الكم الهائل من العنصرية والحقد الذي تتضمنه أقوال هؤلاء، يقاتل السوري على مجمل الكوكب، قتالاً فكرياً لن يخسره أبداً، ويرسخ ذاته بين النخب في كل مكان استطاع أن يتواجد به، فكيف به أن يكترث هذا السوري المجتهد بآراء نخب تافهة في دول لا هوية لها، ولا هيكل يحدد قوامها، والنخب فيه: مغنٍّ واستعراضية.
عصف الزمهرير بالسوريين في مخيماتهم في لبنان، ولأجل حسن الضيافة، “نَكَتوا” لهم خيامهم ونثروا آلامهم على طول الجبل، لم ترحمهم النار في سورية، فقرر لبنان أن يثبت أن له جيشاً أكبر من الذي ظهر في فيديو كليب نجوى كرم، ففلته على مخيمات السوريين.
واضطرب لبنان بمغنيه وممثليه واستعراضييه، تسابق الجمع على دعم جيش بلادهم في محاربة كل إرهاب على أرضهم، وطبعاً كان الدعم عبر منشورات رخوة أطلقوها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا أكثر!
ويذكر أن السوريين خير من خبر المخيمات وأهوالها داخل البلاد وخارجها وعلى حدودها، حتى إن مخيماً في شمال سورية شهد اشتباكاً كان هو الأعنف بين فصائل المعارضة. وصارت مخيمات السوريين معرضاً لوسائل الإعلام العالمية والمحلية ومهرجاناً للمنظمات الإنسانية التي تنثر الفتات وتمضي، لكن لم يسبق لدولة جوار أن فعلت بمخيم سوري كما فعل الجيش اللبناني المفدى، وبدعم من شبيحة سوريين! وكان هؤلاء الأكثر طرافة في المشهد حين قال أحدهم: “فليعد السوريون إلى بلادهم.. ماذا يفعلون في لبنان أصلاً”؟ يتحدث “أخونا” وكأن فنادق الهيلتون والشيراتون تنتظر عودة السوريين، وقد انتهت الحرب في بلادهم منذ عشرين عاماً ولم يعد لهم حجة تبقيهم في دول الجوار.. ألا يكفيهم أن سيادة الرئيس عيناه زرقاوان؟ أي جحود هذا؟
نحن كسوريين لا نتوقع خيراً من أحد، ونعلم جيداً بأن الخير الذي سيصيبنا سيكون من صنعنا، ومن إنتاجنا حول العالم، وبأنّ أمان السوري واطمئنانه سيكون من صنع سوري بحت، ويعلم السوري بأنّ الطاقات التي يمتلكها هي كنز لكل مكان يقيم فيه، فتكرم عليهم أيها السوري وبادلهم قدراتك لحين من الزمن.. فعلى الأقل إحصاءات اقتصادهم أكثر امتناناً لك منهم..
العربي الجديد
الموصل وعرسال والعفالقة المطلوبون/ حازم صاغية
احتُفل، في لبنان، بسقوط الموصل كما لو أنّ أمتاراً قليلة تفصلنا عن شمال العراق. الأمين العام لـ «حزب الله» كرّم ذاك الحدث بحدث آخر هو خطابه. إذاً نحن أمام حدثين في واحد. لقد هبّت العاصفة مرّتين.
من دون شكّ، وبفتوى السيستاني أو من دونها، يستحقّ سقوط «داعش» في الموصل أن يُحتفل به. لكنّ ما جرى ويجري يوحي أنّ المحتفلين احتفلوا بسقوط المدينة نفسها وبدمارها المهول. هناك خلطة من تحرير واحتلال انقسمت حولهما العواطف.
والفارق بين الاحتفال بسقوط «داعش» والاحتفال بسقوط الموصل بسيط: واحد يريد أن يسقط «داعش» في الموصل، والآخر يريد أن تسقط الموصل في «داعش». قانون جديد لـ «اجتثاث داعش»، على غرار قانون «اجتثاث البعث»، سيكون كفيلاً بفرض الانتصار النهائيّ والحاسم لوجهة النظر الثانية. ذاك أنّ دمار عاصمة الشمال العراقيّ وإذلال أهلها أقصر الطرق إلى ازدهار التنظيم الإرهابيّ، إلى سقوط الموصل في «داعش». وازدهار هذا التنظيم مطلوب ومرغوب:
فهو، أوّلاً، يبرّر الاستمرار في مشروع طائفيّ راديكاليّ مقابل، مشروعٍ يجد في تنظيم البغدادي ذريعته وعلّة وجوده.
وهو، ثانياً، يبرّر المضيّ في إلحاق المنطقة بإيران، لأنّ خطراً كخطر «داعش» يستدعي الاستعانة بقاسم سليماني وحواشيه. هذا الميل يعزّزه أنّ التوافق الأميركيّ – الروسيّ في الجنوب السوريّ «قد» (؟) يحرم الإيرانيّين جسراً بارزاً من جسورهم إلى المشرق.
وهو، ثالثاً، يبرّر الدفاع عن الأسد ونظامه المتوحّش، إذ إنّ هذا النظام، وفقاً لروايته، لا يقاتل إلاّ الإرهاب التكفيريّ. التتمّة المنطقيّة التي يتلقّفها الأتباع في بيروت هي: ضرورة التطبيع مع النظام المذكور و «التنسيق» لأجل «عودة اللاجئين». في هذه الغضون يتمّ إخضاع اللاجئين إيّاهم لرقابة بوليسيّة ولإذلال أرعن يشارك فيهما السكّان. إنّ «الأخوّة»، مثلها مثل «الطريق إلى القدس»، تعمل بأشكال كثيرة ومتفاوتة!
وهو، رابعاً، يبرّر مضيّ «حزب الله» في الإمساك بلبنان ودولته وجيشه إلى ما لا نهاية، بل تشديد هذا الإمساك وتمتينه. والموضة الآن، ما بين بغداد وبيروت، أن يُحتفى بالجيش احتفاءً يشبه تسمين الطريدة، وأن يُمنح القرار لميليشيا كـ «الحشد الشعبيّ» أو «حزب الله». ذاك أنّ الجيوش ضعيفة أمام «داعش»، مثلما كانت ضعيفة أمام إسرائيل. إنّها ضعيفة أمام أيٍّ كان. الميليشيات وحدها هي الأهل لذلك، ولهذا ينبغي أن يبقى سلاحها بيدها إلى ما شاء الله.
تبعاً للأهداف أعلاه تبدو بلدة عرسال اللبنانيّة مُلحقاً بمدينة الموصل العراقيّة. الإلحاق هذا قد يتأخّر يومين أو ثلاثة، أسبوعين أو ثلاثة، إلاّ أنّه ماثل بقوّة في الأفق. فبالحجر العرساليّ يصاب لبنان وتصاب سوريّة معاً، وبه نتواصل مع الموصل فيما يتأكّد، مرّة أخرى، أنّ سلاح الميليشيا ضرورة قاهرة. ولأجل أهداف كتلك تسهر قيادةٌ سياسيّة وميدانيّة لا نكون تآمريّين إن وصفناها بالغرفة التي تسري أوامرها على مدى عريض عابر للحدود. إنّها، وبطريقتها الطقسيّة، تصف نفسها بذلك: قاسم سليماني يقبّل يد حسن نصر الله الذي قبّل يد علي الخامنئي.
لقد سبق أن عرفنا، في هذه المنطقة، «قيادة قوميّة» تحرّك «العمل الثوريّ من المحيط إلى الخليج». على رأس تلك القيادة وقف رجل بائس تبيّن لاحقاً أنّه زوج مخدوع في حزبه. إنّه ميشيل عفلق الذي دعا إلى «انقلاب في الحياة العربيّة» ففهم أتباعه العسكريّون أنّ المطلوب انقلاب عسكريّ في كلّ بلد عربيّ. وحين حاول أن يعترض، تمرّدت «القيادات القطريّة» على قيادته «القوميّة»، وتمرّد عليه حزبه وعسكره ليكتشف متأخّراً أنّ «هذا الحزب ليس حزبي وهذا العسكر ليس عسكري». ويبدو أنّ القوى والأحزاب التي من هذا النوع بحاجة دائمة إلى عفلقها، أو إلى اختراع عفلق ما، أو إلى استضافة غريب طارئ كي يكون عفلقها العابر. والعفلق هذا قد يكون جيشاً وطنيّاً، عراقيّاً أو لبنانيّاً، وقد يكون شخصيّة دينيّة كالسيستاني، أو سياسيّة كحيدر العبادي أو سعد الحريري. أمّا القرار الفعليّ، من الموصل إلى عرسال، فيبقى في تلك الغرفة السوداء التي تجهد لإسقاط المنطقة في «داعش».
الحياة
وقائع مجزرة معلنة/ سامر فرنجية
«… لدى الكشف الطبي المعتاد الذي يجريه الجسم الطبي في الجيش بإشراف القضاء المختّص، تبين أن عدداً منهم يعاني مشاكل صحية مزمنة قد تفاعلت نتيجة الأحوال المناخية، وقد أُخضِعَ هؤلاء فور نقلهم للمعاينة الطبية في المستشفيات لمعالجتهم قبل بدء التحقيق معهم، لكن ظروفهم الصحية ساءت وأدّت إلى وفاة كل من السوريين…»
لم «يعذّب» نفسه الجيش اللبناني بصياغة عذر مقنع لتغطية حدث الوفاة أو القتل، مكتفياً ببيان مقتضب عن أحوال مناخية وأمراض مزمنة، يعيد إلى الذاكرة تبريرات الأنظمة الاستبدادية. وكان محقاً في اقتضابه. فأقنع التبرير «الأسدي» معظم الرأي العام اللبناني الذي واكبَ العذر الرديء من خلال حملة تضامن مع الجيش، فاحت منها رائحة الدم والعنف المكبوت. أمّا المعترضون أو المشككون القلّة، فكان مصيرهم التشهير والتهديد والسجن، و«لازم يتعبوا بسيارات وعالعدلية» حسب تصريح نائبٍ عونيٍ موتور. في لبنان المأزوم، لم يعد مقبولاً الاعتراض على حادثة التعذيب أو حتى السكوت عنها، بل أصبح مطلب المشاركة في عملية التعذيب وبيانها واجباً «وطنياً».
التعذيب لم يكن وليد العملية العسكرية الأخيرة ومتطلباتها، كما أنّه ليس نتيجة عنصرية أزلية عند اللبنانيين. فكما أن للإرهاب «بيئة حاضنة» حسب أرباب الحرب عليه، فللتعذيب بيئة حاضنة أيضاً وسياق تاريخي وتراكم كره. فلهذه العنصرية المستجدّة تاريخ يبدأ عام 2012 مع تحوّل الواقع السياسي والأمني تجاه الثورة، كما كتبت ريان ماجد1. وكان بطل هذا التاريخ «الرجلُ القوي» في العهد الجديد، صهر الرئيس، الذي طالب باكراً «بترحيل النازحين» وأفكارهم «الغريبة والشريرة التي تأكلنا». آنذاك، كان باسيل وحيداً مع تياره في استعمال هذه اللغة، ولكنّ سرعان ما انتشرت لغّته، أولاً في الممارسات، قبل أن تصبح الخطاب الرسمي لحكومة العهد الجديد. فبدأت المخيمات تحترق، والأزمات المناخية تنقض على السوريين، «وذلك قبل بدء التحقيق معهم».
تقاطعت «الكراهية» العونية مع الواقع «الحزب اللهي»، وشكّلا ميزة «العهد الجديد». قبضةُ حزب الله الأمنية في الداخل اللبناني تتلطّى بخطاب عوني، ليصبح التعذيب هو الممارسة الأكثر تمثيليةً لفائض القوة والاستياء اللذين يمثّلان هذا التقاطع. نجح العهد بتحويل العنصرية تجاه اللاجئ إلى نقطة ارتكاز التحالف الحاكم، فالعنف شبه اليومي تجاه السوريين هو المنفذ الأخير للعنف المكبوت بين الطوائف اللبنانية جراء انسداد قنوات الصراع الداخلي. وهذا ما يجعل الالتحام مع الجيش، كما تطالب به أبواق العهد الجديد، واجباً ليس بالرغم من التعذيب، بل لأنّه عَذَّب. فعنف الجيش أو حتى تعذيبه مطلوب لامتصاص فائض العنف الكامن في المجتمع، والمشاركةُ فيه هي اختبار الدخول إلى جنة العهد الجديد.
على من عارضَ النظام البعثي في الماضي أن يشارك في العنف، وإن كان دوره ثانوياً، ليبرهن عن ولائه للعهد الجديد. وهذا ما حصل مع الحريري، الذي تم «توبيخه» من قبل جريدة الممانعة لعدم دعمه عملية «تحرير» جرود عرسال، فتراجعَ وقدّمَ الدعم للجيش مصرحاً: «أن التشكيك في التحقيق الذي تقوم به قيادة الجيش أمرٌ مرفوضٌ أيضاً»2. وهناك اختباراتٌ قادمة من مظاهرات ومعارك، سيتبعها قمعٌ داخلي واختيارٌ لمن يحق له البقاء في العهد الجديد. فالخيار المتاح اليوم هو إما أن تكون الجلاد، أو أن تُعامَلَ كالنازحين. ليس من خيار آخر متاح.
ليس من ترحيلٍ يمكن أن يضع حداً لهذه المعادلة الجديدة، وليس الترحيل ما هو مطلوب أصلاً. فكما أشار حازم الأمين: «إعادتهم إلى سورية تعني للنظام ولـ «حزب الله» أن السنّة الذين تخلّصت منهم «سورية المفيدة» قد عادوا، واللاجئون هم البيئة التي انتفضت على النظام، والأخير لن يأمَنَ لهم بعد اليوم»3. كما أنّ المطلوب ليس مجرّد إعادة التواصل الرسمي مع النظام البعثي والتنسيق الأمني معه، والعودة عن القطيعة التي نجحت أحداث 2005 بفرضها بين الحكومتين. المطلوب هو انضمامُ لبنان إلى معادلة الجلاد والنازحين التي تمتدّ من الموصل إلى بيروت، وتحوُّلُه إلى طرف في الصراع الأهلي في المنطقة. وفي هذا التحوّل، بات الجيش اللبناني هو المكلّف بقمع المعارضة الداخلية، بينما حزب الله والطيران البعثي يقومان بالمعارك. لبنان يشهد حالياً ما يشبه الانقلاب العسكري، يقوم به العهد الجديد للقضاء على أية إمكانية اعتراض داخلي.
حاول البعض الاعتراض من داخل المنظومة القانونية القائمة، مطالبين الجيش بتحقيق بحدث الوفاة. وتمّ تبرير هذا المطلب انطلاقاً من مصلحة الجيش نفسه، فالتعذيب «غير المبرّر» يؤدي إلى تطرف، قال البعض، والهمجية تضرب هيبة الجيش، أكّد البعض الآخر، والعنف يُضعف الثقة بالجيش، تمتم القانونيون. فالمطلوب تحقيقٌ يمنع تكرار هكذا تصرف في المستقبل. لم يتأخر الجيش بالرد على هذه المطالب. فكما صرَّحَت مصادر عسكرية، الجيش «مستعدٌ للردّ على استفسار أي جهة دولية» (وهي الجهات الممولة)، ولكنّه غير معني بمطالبات بعض الناشطين المحليين. وإذا كان هناك من إمكانية لبداية تحقيق، فمخابرات الجيش حاضرة لتصادر «عينات تشريح موقوفي عرسال». وإذا كان هذا لا يكفي، فهناك مظاهرات يمكن تنظيمها لتبرير أي وقوع مستقبلي. قد يكون مطلب «التحقيق» أكثر المطالب جرأة في ظل هذا العهد، ولكّنه غير كافٍ في غياب سياسة تحيط به. وتجربة لبنان مع لجان التحقيق والمحاكم الدولية غير مشجعة، كما تُظهر صورة الحكم الحالي. القانون خارج سياق سياسي غير قادر على الاعتراض على سياسة خارجة على القانون.
بهذا المعنى، الاعتراض على التعذيب لن يجدي طالما بقي حقوقياً ولم يتحوّل إلى معارضة للعهد الجديد كمنظومة حكم ومشروع إقليمي. ربطَ الشهيد سمير قصير مصير لبنان وسورية بعبارته الشهيرة «ديموقراطية سورية واستقلال لبنان». قد لا تصلح تلك المفردات للحاضر، وربّما بات الأصح قلبُها، أي ربط استقلال سورية بديموقراطية لبنان. ولكن كيفما قلبنا التوصيفات، يبقى الرابط موجوداً. وفي غياب أي تسييس لهذا الرابط، تتحوّل المسألة إلى سؤال أخلاقي بحت، مرتبط برفض أقليةٍ العيشَ في ظل نظام يُعذِّب.
سقطَ اللاجئون في الفجوة التي خلفتها الثورة السورية، ليتحولوا من ثوار إلى لاجئين ومن ثمّ إلى نازحين، وبالتالي إلى كائنات خارجة عن السياسة وخاضعة لمعايير حسن الضيافة. وفي ظل الفراغ السياسي، غالباً ما يتدهور النقاش عن التضامن إلى صراعات داخلية حول لياقات الضيافة، هذا عندما لا ينحدر إلى عنصريات وتعميمات طائفية.
بيدَ أن صفة «النازحين» لم تعد استثناءً خارجاً عن السياسة في منطقة تشهد بعضاً من أكبر عمليات اللجوء والنزوح ونقل السكان. ما حدث في بيروت قد لا يختلف عما يحدث في سورية أو العراق، وقد يكون ميزة النظام الإقليمي الصاعد. فربّما الثورة كانت «سورية» في انطلاقها، غير أن «الثورة المضادة» التي قضت عليها كان طابعها إقليمياً، وتتحرك على إيقاع آلاف العناصر الذين يمتدون من الموصل إلى بيروت، تحت شعارات مختلفة من «حشد شعبي» إلى «عهد جديد» مروراً بـ «سورية المفيدة». وبالرغم من إقليمية هذا النظام الصاعد، بقي المشروع الآخر، أي مشروع الثورات، محصوراً بحدوده الوطنية، ومخيلاته قائمة على حدود ودول وشعوب لم يعد يعترف بها إلا الثوار أنفسهم. وفي هذا السياق، شكّل انعدام التضامن بين الثورات (خارج مكونها الإسلامي) إحدى ميزاتها، أو بكلام أدّق إحدى أخطائها المميتة.
لا عودة إلى مخيلات الثورات الوطنية، ولا إمكانية لمقاومة معادلة الجلاد والنازحين من خلال التمسّك بلياقات الاستقبال المحلية. خارج مشروعٍ لنبذ العنف الإقليمي، مستقبلنا سيكون مجرّد تعذيب وبيانات تبريرية ونزوح أكبر.
«… وفاة كل…»
كاتب لبناني. أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت
موقع الجمهورية
لبنان: من يتحمل مسؤولية اللجوء السوري الجيش أم حزب الله/ علي الأمين
في خطوة مشبوهة صدرت دعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد الجيش اللبناني تبنتها جهة سمّت نفسها اتحاد الشعب السوري في لبنان، وموجهة إلى اللاجئين السوريين بأن يتلاقوا ويتجمعوا ضد المؤسسة العسكرية الرسمية، وذلك على خلفية ما جرى من تجاوزات طالت اللاجئين السوريين في بعض المخيمات لا سيما تلك الواقعة في جرود عرسال، علماً أنّ الجيش اللبناني الذي أقر بوقوع مثل هذه التجاوزات، بادر إلى معاقبة بعض الجنود المرتكبين إلا أن نتائج التحقيق الرسمي لم تصدر بعد لتكشف نهائيا كيف تم موت أربعة من الذين اعتقلوا من قبل قوة من الجيش في مخيمات اللجوء.
الدعوة للتظاهر والتجمع في ساحة سمير قصير في وسط بيروت من جهة غير معروفة ومن على صفحات التواصل الاجتماعي، جهة تخاطب اللاجئين السوريين في لبنان، وضد المؤسسة العسكرية، كلها مؤشرات على أن الدعوة غير بريئة بل مشبوهة، فاتحاد الشعب السوري في لبنان أولا، جهة غير معروفة ولم تتبن أي شخصية أو فرد سوري في لبنان هذه الدعوة، بل بدت الدعوة للتظاهر ضد الجيش اللبناني هدفها استنفار عصب لبناني في المقابل ضد اللاجئين، وهذا ما جرى فعلا إذ دعا أهالي شهداء العسكريين اللبنانيين إلى التظاهر في نفس المكان وفي نفس الموعد وضد الدعوة الصادرة عن الجهة السورية المذكورة والمشبوهة.
الأمر الثاني، أن الدعوة أرادت أن توحي وكأن اللاجئين السوريين وحدهم في عراء لبناني، بينما كل المواقف التي انتقدت الأخطاء التي ارتكبت ضد اللاجئين صادرة عن الجيش كانت من أصوات لبنانية، رفعت صوتها وطالبت بإجراء تحقيقات جدية ومحاسبة المرتكبين أيا كانوا، وصدرت عشرات المواقف من سياسيين وناشطين كانت شديدة الجرأة في تضامنها الإنساني مع اللاجئين السوريين، وفي دعوة المؤسسة العسكرية لتطبيق القانون.
الأمر الثالث، الذي يزيد من الشبهات حول ما يسمى اتحاد الشعب السوري في لبنان ودعوته للتظاهر ضد الجيش، وهو الأهم في هذا السياق أنّ ثمة من يريد أن يورط الجيش اللبناني في معركة مع اللاجئين السوريين، وهي جهات تريد أن تبيّض صفحتها السوداء تجاه دورها في خلق مشكلة اللجوء وتهجير السوريين من ديارهم فضلاً عن تدمير بلداتهم وبيوتهم. فكل لبناني وسوري يعلم أنّه إذا كان من جهة لبنانية مسؤولة عن مأساة النزوح وأصل وجودها في لبنان، فهو حزب الله الذي كان له الدور البارز والفعلي في تهجير مئات الآلاف من السوريين تجاه لبنان، بسبب انخراطه في القتال في سوريا لا سيما في مناطق القلمون وريف دمشق، وبالتالي إذا كان من جهة يمكن للسوريين أن يخاطبوها بكلام قاس ويعترضون عليها فهي حزب الله وليس الجيش اللبناني، انطلاقاً من هذه المسؤولية.
لا نريد أن يفهم من هذا الاستنتاج أنّه دعوة لتوجيه اللاجئين اللوم والاحتجاج إلى حزب الله، بل المقصود أن نضيء على الشبهة التي صدرت في الدعوة للتظاهر ضد الجيش اللبناني، باعتبار أنّ الأذى الذي نال اللاجئين من حزب الله لا يقارن بما وقع عليهم من الجيش اللبناني، وبالتالي فإنّ عدم صدور أيّ دعوة للاحتجاج على حزب الله والتظاهر في بيروت، يرجح أنّ الهدف إثارة شرخ لبناني سوري.
ربطاً بما تقدم يجب الانتباه إلى أنّ لبنان الذي احتضن اللجوء السوري، وتضامن أكثرية اللبنانيين مع ثورة الشعب السوري ضد نظام الاستبداد، وشهد لبنان في معظم مناطقه الكثير من حالات التضامن خلال السنوات الست الماضية، وشذ عن هذه القاعدة محور حلفاء النظام السوري الذين وحدهم من كانوا يضعون شرط الوقوف مع نظام الأسد مدخلا لأي تعامل ايجابي مع الشعب السوري ومنهم اللاجئون.
في الوعي اللبناني بالأزمة السورية كما عند السوريين عموما، أن المحور الإيراني وذراعه اللبنانية حزب الله، شركاء في مأساة اللاجئين، وفي البيئة الحاضنة لحزب الله ثمة إدراك عميق لدور حزب الله في هذه المأساة المسماة اللجوء السوري، لا سيما عمليات القتل والإبادة والتهجير والتغيير الديمغرافي، ولأن هذا الجرح الذي طال أعماق الوجدان الجمعي لدى هذه البيئة، ثمة محاولة لجعل التناقض سورياً لبنانياً، وليس حزب الله- الشعب السوري، عبر وسائل شتى منها محاولة شيطنة اللاجئ السوري، وإظهار أنّ مشاكل اللبنانيين الاقتصادية والأمنية والاجتماعية متأتية من هذا اللجوء، وهذا الخطاب غير البريء يرتبط بحسابات طائفية لبنانية، فحزب الله ومن خلفه المحور الإيراني بامتداداته يقايض جهات مسيحية حاكمة في لبنان بمزيد من السلطة في الشؤون الداخلية لها مقابل الانسجام مع سياسة شيطنة اللجوء، إذ كلما ارتفعت أصوات مسيحية ضد اللجوء وزادت من توترها تجاههم، كلما كان حزب الله يشجع هذه الأصوات بمزيد من السماح لها بحصة إضافية في لعبة التوازنات الداخلية، وهو على الأرجح أسلوب وجد صداه حتى لدى رأس الكنيسة المارونية التي باتت تربط بين الهجرة المسيحية من لبنان، واللجوء السوري في لبنان.
الكلام المبالغ فيه لجهة تضخيم أزمة اللجوء السوري أو لجهة أسلوب مقاربته من قبل الجهات الرسمية اللبنانية وعبر التحريض الذي يستدعي ردود فعل في المقابل، يستكمل التدخل الذي قاده حزب الله في الحرب السورية، ذلك أنّ الدعوات اللبنانية لمعالجة مشكلة اللجوء السوري في لبنان عبر المطالبة بعودتهم إلى أراضيهم، لا تترافق مع أيّ مطالبة لحزب الله بسحب مقاتليه من هذا البلد، فإذا كان اللجوء السوري جريمة بحق لبنان، فإن السلطات اللبنانية تتعامى عن دور حزب الله في هذه الأزمة.
دعوة التظاهر التي أطلقتها جهة سورية غير معروفة ومشبوهة باسم اتحاد الشعب السوري في لبنان ضد الجيش اللبناني، هي حلقة من حلقات اللعبة الاستخبارية التي تهدف إلى ضرب المؤسسة العسكرية اللبنانية عبر تصويرها وكأنها عدو اللاجئين السوريين في لبنان، وهي لعبة وإن كان من يديرها شديد الخبث، إلا أن اللبنانيين عموما يدركون في تجاربهم أن قوة هذه المؤسسة تكمن في أنها تمثلهم، وأنها كلما ازدادت قوة كلما باتت أي قوة مسلحة وغير شرعية في لبنان مكشوفة، والعكس صحيح فإضعاف الجيش اللبناني وتوريطه في قضايا إنسانية تتصل بانتهاك حقوق الإنسان، ومحاولة تصويره وكأنه الخطر على اللاجئين، ليس إلا محاولة مستمرة من قبل من يخاطب اللبنانيين صباحا مساء بأنه يدافع عن لبنان لأن الجيش اللبناني غير قادر أن يدافع عن أرضه، وأنه يحمل السلاح لأن الدولة لا تستطيع أن تحمي لبنان، فيما هذا الطرف غارق في حروب خارجية وفي تفجير قضية اللجوء السوري في لبنان بعد أن كان من أبرز مسببيها.
كاتب لبناني
العربي
«سفير» الأسد/ علي نون
لا يمكن سفير رئيس سوريا السابق بشار الأسد في بيروت علي عبد الكريم علي، إلا أن يكون أميناً لصفته، وأن يدلق ما فيه انطلاقاً من جذر كونه صاحب تلك الصفة.
وذلك يعني مباشرة أشياء كثيرة، لا تدخل من ضمنها أدبيات الديبلوماسية المعتمدة في «العالم الطبيعي». ولا تدخل في تلابيبها كياسة المنصب. مثلما لا تُعنى، على عادة أربابها في بقايا سلطة الأسد، بأي احترام لحقائق الأرض وما عليها. ولا تعرف معادلة خارج تلك المتصلة بالعسف والإكراه والعنف والاستبداد الأرعن.
هذا ممثل لسلطة دمّرت العمران السوري. وفتكت برعيّتها كما لو كانت آتية من كوكب آخر. وقتلت وذبحت واستباحت كرامة السوريين بإعجاز لا نظير له.. ثمَّ يخرج على الناس في بيروت مستخدماً مصطلحات مثل «احترام كرامة النازحين السوريين»! و«العلاقات بين البلدين»! ويذهب بعد ذلك وفوقه الى الوراء مستعيداً أداء زمن الوصاية القميء الذي أعطى أصحابه لأنفسهم حق التمييز بين من هو «وطني» و«شريف»، ومن هو «عميل» و«خائن» و«مدسوس»!
يعود الى تلك النغمة ممثل بشار الأسد من دون خفر أو حياء:.. ويحاول أن يتذاكى: يشيد و«يقدّر» كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لكنه «يملي» على رئيس الحكومة سعد الحريري ضرورة «أن يحترم العلاقة بين البلدين» ويتّهمه بـ«الخروج عن الأعراف»!
وكأنّه آتٍ من مدرسة تعرف معنى «احترام العلاقات» بين الدول! أو تعرف معنى «الأعراف» المتّبعة في ذلك! أو الأصول والفروع المتصلة بها! أو سبق لها، أن عاملت لبنان الدولة، واللبنانيين، وسوريا الدولة والقانون والمؤسسات، والسوريين، وفق مدوّنة «الاحترام» هذه! أو استناداً الى أيّ نصّ مؤسساتي أو قيمي أو أخلاقي.
«سفير» الوصاية بلا وصاية! طبعه غلَبَ تطبّعه. يتجاهل تحوّل الزمن ودوران الأقدار، ويعود الى ماضٍ مضى بوهم إنزاله على حاضرٍ مستعصٍ، وفرادته أسدية خالصة: وحده في هذه الدنيا، يتجرّأ على إطلاق أحكام في حق كبار المسؤولين في الدولة المُنتدب إليها! ويحدّد على كيفه وعلناً من يعجبه منهم ومن لا يعجبه! ومن «يرتاح» الى مواقفه، ومن «تزعجه» مواقفه! وهذه حالة غير مسبوقة في العمل الديبلوماسي ولا مثيل لها، لكنّها لا تؤكد سوى المؤكّد من غلبة الطبع على التطبّع. ومن غربة بقايا السلطة الأسدية عن كل شأن ذي صلة بالمؤسسات والدساتير والقوانين والأعراف الحاكمة لعمل أي نظام على المستوى الداخلي، وللعلاقات بين الدول على المستوى الخارجي.
يتأسّى «سفير» الأسد، على أنّ ما يتعرّض له النازحون في لبنان والأردن «لا يحفظ كراماتهم»! وكأنّ هؤلاء المنكوبين نزحوا أصلاً، عن ديارهم وأملاكهم وجنى أعمارهم نتيجة فائض «الكرامة» التي شعروا بها على مدى سنوات الحكم الفئوي المافيوزي الأسدي!!
«سفير» بشار الأسد.. حرفياً!
المستقبل
من كبوة الربيع العربي إلى كبوة السياسة والعقل في لبنان/ وسام سعادة
ليس هناك، في فترة ما بعد الحرب الباردة، لحظة تصدّرت فيها الجماهير المشهد كمثل الذي حدث في عدد من البلدان العربية، يتجاوز مجموع سكانها أكثر من نصف مجموع العرب، عام 2011. وليس هناك لحظة يصعب ان ترجح، والى حد ما ان تميّز، بين عناصر انشطارها وتضعضعها وكبوتها، وبين آليات نخرها وشيطنتها وسحقها كما تلك اللحظة التي كان الرائج وقت نشوبها وانتشارها وسطوعها التشديد على عدم كفاية تعبير «الربيع العربي» لوصفها، وجرى لاحقاً الاستكثار عليه هذا التعبير.
وليس هناك لحظة عربية شاملة استطاعت التركيبة اللبنانية صدّ نفسها، بالمجمل، عنها، قدر تلك اللحظة.
في اللحظة التي بدت فيها شعوب الأمة الجامعة تسير نحو الحرية، وجد البلد نفسه عالقاً في القميص الأسود أكثر من ذي قبل. انقسم البلد حول الثورة السورية، لكنه انقسم بلا روح. من راهن على خط الثورة فعل ذلك للخروج من مجموع أزماته الداخلية، ومن تدخل بالسلاح لإنجاد النظام فعل ذلك كامتداد لاستقوائه بالسلاح على غيره من اللبنانيين. شيئاً فشيئاً، ظهر ان التوازن الكارثي سيد الموقف في البلدين. في سوريا نظام لا يتمكن من إخماد ثورة وثورة محكومة موضوعياً وذاتياً بعدم التمكن من الاطاحة بنظام دموي وخبيث. في لبنان، ورغم مسلسل الاغتيالات والتفجيرات والاشتباكات في عاصمة الشمال، بدت الدماء محقونة أكثر، من دون ان نغفل الفاتورة الدامية التي تكبّدها «حزب الله» في المشتعل السوري.
لا يعني التوازن الكارثي في الحالتين تعادلاً، لا سياسياً ولا أمنياً. بالمجمل العام، بقي المحور الذي تقوده ايران، وينضوي تحته نظام آل الاسد وحزب الله، اكثر قدرة على التحكم بالمسارات من أخصامه.
لم تنحصر الثورة المضادة بمحور اقليمي واحد، ولا بأيديولوجيا واحدة. لكن، بالمجمل العام أيضاً، كان الوضع في سوريا هو مرتكز كل ثورة مضادة لحركة الجماهير العربية لعام 2011.
رغم كل شيء، اتاح اتساع مدى انهماك «حزب الله» بالحرب السورية للبنانيين التنفس في هذه السنوات. مع منسوب سياسي واجتماعي من ارتفاع القلق في نفس الوقت. فمن جهة، لا انتخابات بعد 2009، وفترات من الشلل والفراغ الحكوميين ثم عامين ونصف العام من الشغور الرئاسي. ومن جهة ثانية، تداعيات الحرب السورية، وتهجير مئات الآلاف من السوريين باتجاه لبنان، خاصة في المناطق التي مشّطها «حزب الله» في سوريا، التي سجّلت من ريف حمص الى القصير والقلمون تفريغاً سكانياً اكثر من غيرها من المناطق في سوريا.
التدخل الروسي من جهة، وتركيز الغرب اولويته على محاربة «داعش» من جهة ثانية، وتمكّن النظام من البعثرة السكانية للمجتمع السوري من جهة ثالثة، كل هذا اعطى للنظام ما لم يكن يحلم به عام 2011. في نفس الوقت، لا تكاد العين الايرانية او الروسية تشرد، حتى يظهر ضعف النظام بشكل واضح جليّ. لم يعد قادراً على النوم لوحده. فكرة ان العالم سيطبّع تماماً مع هذا النظام هي ما يرغبه النظام اكثر منه ما ترغبه حكومات العالم.
لم نعد لبنانياً في لحظة 2005، وعربياً في لحظة 2011. بشكل عام، الهرم الذي كان يميل للجذرية في التغيير السياسي انقلب على اعقابه. صارت الاولوية في البلدان العربية للحريات السياسية على المشاركة السياسية، وللمشاركة على التغيير السياسي. معادلة لها ترتيب مختلف بالنسبة الى كل بلد. لكنها تعني في كل الحالات ان فضاء حراً يمكن ان تطرح فيها مقاربات مختلفة ومتجادلة مع بعضها، فضاء يتمتع رواده بالحقوق والحريات بات عنوان التحدي السياسي، خطاباً أو انتخاباً.
من الكاريكاتوري تصوير هذه المرحلة من تاريخ لبنان والمنطقة بأنها مرحلة «ولّى زمن الهزائم»، أياً كان منظار النصر والهزيمة. من السيئ الانصراف الى الانهزامية، او في المزايدات. ينبغي مصارحة الذات. إنها مرحلة دفاع عن الحدّ الأدنى من الحق بالعيش بحرّية وكرامة. هناك هجمة على الحرية السياسية يختلف شكلها في كل بلد، ولبنان الذي حُكي الكثير عن ازدهار الحريات فيه مقارنة بضعف ديموقراطيته، يجد هذه المساحة محاصرة اكثر من ذي قبل، ليس فقط بسبب هيمنة السلاح اللاشرعي، بل ايضاً بسبب من الغلاظة المعممة الناهرة عن افساح المجال للتداول بموضوعات الخلاف والاختلاف بوضوح وروح ايجابية. كم السلبية والتشنّج، بل افتعال التشنّج، مهول اليوم. كم المزايدة ـ لو كنت مطرحك لكنت نابليون أو غاريبالدي ـ أيضا زاد عن كل معقول.
المستقبل
الاحتلال اللبناني «الخوشبوشي» لمناطق من سوريا/ وسام سعادة
يحتل مسلحون لبنانيون منذ سنوات عديدة مساحات من أراضي «الجمهورية العربية السورية» لا تقل عن مساحة لبنان.
اعتبر ذلك خرقاً لإجماع لبناني وقع في القصر الجمهوري، بتحييد البلد عن التدخل في نزاعات البلد المجاور، وأوجد الخلفية التي تقف وراء الشلل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي فترة الفراغ الحكومي بعد استقالته في اذار 2013 (حيث لم يتح لخلفه تمام سلام تشكيل حكومته الا بعد احد عشر شهرا من تكليفه)، ثم الشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان.
واذا كانت «قوى 14 اذار» ، كما كانت لا تزال تتسمى الى ذلك الوقت، قد رفضت في البدء المشاركة في نفس الحكومة مع «حزب الله» طالما هو متدخل، بعسكره، في سوريا، فلم يواظب على هذا الموقف عندما تشكلت حكومة الرئيس تمام سلام (شباط 2014) سوى «القوات اللبنانية»، التي عادت وبنتيجة طبيعة التقلّبات اللبنانية، فتحالفت مع أبرز حليف مسيحي لبناني للنظام السوري و»حزب الله»: العماد ميشال عون.
سلّمت القوى اللبنانية الممانعة أمام هيمنة «حزب الله»، في نهاية الأمر، بتدخله في سوريا كأمر واقع أصبح أكبر من قدرات اللبنانيين ويتطلب قرارا دوليا حاسما. وهذا التدخل للحزب هو من دون أي طلب رسمي من الحكومة السورية الى الحكومة اللبنانية، الأمر الذي يكرّسه احتلالا، بل ان الشعور به كوجود عسكري وطقوسي غريب جاثم على صدور السوريين، وتحديدا في مدينة دمشق، يشترك فيه الموالي للنظام مع المعارض له، بل لا يزال النظام يغذي نفورا دمشقيا عاما بازاء هذه الثقافة الوافدة مع الميليشيات اللبنانية والعراقية والافغانية، الأمر الذي يجد تعبيره المذهبي في حملة وزارة الاوقاف السورية الاخيرة ضد «التشيّع». لا يعني هذا ان الاعتراض اللبناني على التدخل في الحرب السورية قد سحب من التداول، لكنه اعتراض «تشمّع»، وصار أشبه بالتعويذة المضافة الى جملة ما نجح الحزب الموالي لإيران في «تهذيبه»، من شعارات سياسية مناوئة له تحوّلت بمرور الوقت، واختلال الميزان، وشعور الانكسار وانعدام الحيلة أو الانتهازية الصرف، الى مجرد تحفظات رمزية «حتى قدوم الساعة».
والحكومات الغربية: تدين كل ما يقوم به «حزب الله» في الصراع مع اسرائيل، وتمتعض من تجبّره على اللبنانيين الآخرين بالسلاح، لكنها قلما تلتفت الى تدخل الحزب في سوريا. تصنّفه ارهابيا، ولا تعتبره بريئا من هذه التهمة بتجربته المتواصلة في محاربة ما يتوسع فيه هو من «ارهاب تكفيري» في سوريا، ليشمل فصائل متطرفة وأخرى أقل منه تطرفاً، على حد سواء.
والأنظمة العربية: استأثر تدخل الحزب في الخليج واليمن بتصلب الموقف منه. اعتبر ارهابيا على هذا الأساس، وليس لأنه متدخل في الحرب السورية. صحيح ان الحزب له باع في تدريب وتجهيز وأدلجة كوادر الحوثيين، لكن درجة تدخله في سوريا هي في أقل الايمان أعلى من ذلك بكثير.
سوّغ الحزب تدخله، من دون اجماع لبناني، ولا طلب سوري رسمي الى الجانب اللبناني، بأنه ذاهب لحماية مرقد السيدة زينب، ثم لحماية قرى شيعية من الجانب السوري للحدود، ثم لمنع «الارهاب التكفيري» من التمدد نحو لبنان، في نفس الوقت الذي توجه فيه الى الجهاديين اللبنانيين «الذي قد نكون وأنتم مختلفين في تفسير الواجب الجهادي» الى ملاقاته في الملعب السوري، حصرا. وبعد ان طاولت عمليات انتحارية منطقة الضاحية الجنوبية خرج الحزب بصيغة ان هذه العمليات كانت ستكون اكثر ايلاما وفتكا لو تأخر في التدخل بسوريا. التزم الحزب في كل هذه السنوات بالنهج السوري الرسمي في الاحتفاظ بحق الرد بعد كل غارة اسرائيلية تستهدفه، لكنه لم يلتزم بأي حدود لتوغله في الأرض السورية، وبعد ان كان يركز على المناطق القريبة من لبنان، كالقصير ويبرود، توسعت خارطة عملياته الى ريف حمص، وحلب، والبادية.
وكلما زاد الحزب في التوغل، زاد اللبنانيون المخالفون له في التطبع مع «لا حيلتهم» حيال تدخله. في نفس الوقت، قويت نزعة بينهم لفصل هذا التدخل عن نتائج تسبب بها كليا أو جزئيا. فاذا كان اللجوء السوري الى لبنان لا يختزل في تدخل الحزب وحده، لكن هذا التدخل اكثر من اساسي بالنسبة الى اهالي القصير والمناطق السورية في سلسلة جبال لبنان الشرقية. معظم اللاجئين السوريين في مخيمات شرق لبنان هم من «لبنان الداخل» جغرافيا، او «الأنتي ليبانوس» كما سماه الاغريق والرومان، اي السلسلة الممتدة من ريف حمص الى القلمون الى الغوطة الى حرمون. تهجير «لبنانيي الداخل» هؤلاء الى سهل البقاع، يتحمل مسؤولية كبرى فيه تدخل الحزب في المناطق التي كان مسلحو الثورة السورية فيها هم من نسيجها الأهلي بالدرجة الاولى، وليس من «المهاجرين» الجهاديين.
ان لا يكون لدى اللبنانيين قدرة على كف يد «حزب الله» عن سوريا، فهذا شيء، وان يكون بوسعهم فصل قضية اللاجئين السوريين من جهة، وقضية المجموعات المسلحة في جرود عرسال، عن هذا اللجوء فهذه مسألة أخرى. ليس صحيا ابدا ان لا تكون تظاهرة واحدة خرجت في بيروت ضد احتلال لبنانيين – من دون علم حكومة بلادهم رسميا رغم مشاركة حزب التدخل في الحكومة، للأراضي السورية.
لكن ما هو مرضي بحق، هو افتعال الكبرياء، للتعتيم على الشروط الاولية للسيادة الوطنية والحد الادنى من الالتزام بحقوق الانسان المنصوصة دستوراً: كبرياء الذين لا يترددون في قذف كل من يخالفهم الرأي في موضوع اللاجئين، بأنه «داعشي»، في مفارقة يصبح فيها الدواعش، بهذا الاتهام الاعتباطي، حركة علمانية عابرة للطوائف في لبنان، في مقابل عنتريات عنصرية وطائفية لنعامات تخفي رأسها في الرمل، لا تريد ان ترى الى واقعة أساسية، كواقعة تدخل الحزب في سوريا، الا كاختلاف في الاجتهاد أو كضرورة مكروهة. بقي ان الحزب لا يعطي المجال للنعامات طول الوقت، فتدخله الوشيك في جرود عرسال، يبعثر الرمال التي تخفي فيها رأسها. وبعد كل الجدل حول دور الجيش واسلوبه، يعود حزب الله ليذكر عمليا بما قاله الشيخ نعيم قاسم لفظيا: اي ان الحزب يخرج من الحرب السورية وقد تحول الى «جيش عظيم»، وبمعادلة «خوشبوشية»: لبنانيون يحتلون عسكريا أحياء من العاصمة السورية، وجيش النظام السوري ‘العائد» الى سهل البقاع.
كاتب لبناني
القدس العربي
بيان التضامن مع اللاجئين السوريين.. للتوقيع
وزعت مجموعة من الناشطين والناشطات بيانا يندد بالعنصرية والاعتداء على النازحين السوريين، ودعت الى توقيعه… هنا نص البيان:
قلقون نحن يا أصدقاء ويا صديقات،
ولعلّ أكثر ما أثار قلقنا وخوفنا وصدمتنا لم يكن قرار منع التظاهر ولا خطابات السياسيين العنصرية ولا تسريب بلدية بيروت لأسماء الناشطين من المنظِّمين للوقفة التضامنية ولا حتى التهديدات التي انهمرت على رفاقنا ورفيقاتنا في المنتدى الاشتراكي، أولئك الطيبين والطيبات الذين وقفوا دائماً مع الحقوق والعدالة.
قاسية كانت الحملة المضّادة لمجرّد تنظيم وقفة تضامنية متواضعة مع اللاجئ/ة السوري/ة في لبنان، والتي – بلعبة سياسية – حوّرت الموضوع لترغم اللبنانيين/ات على اتخاذ موقفٍ لم يكن مطروحاً أصلاً: “إما أنتم مع داعش أو مع الجيش اللبناني” (؟!) أو على الاختيار بين ازدواجية لا منطق لها: “إما أنتم مع السوريين أو مع اللبنانيين” (؟!).
ورغم قساوة تلك الحملة المضادة الشائكة، إن أهم ما دق ناقوس الخطر في قلوبنا هو تجاوبكم السريع مع هذا الفخ السياسي القديم الذي فتح باب الكراهية والحقد على مصراعيه ففاضت تلك البشاعة على مواقع التواصل الإجتماعي تهديداً وتخويناً وجزماً وتشنّجاً.
لن نضيف إلى ما صرّح به المنتدى الاشتراكي في بيانه التوضيحي الذي استنكر ما حصل. لكننا وحرصاً منّا على ما تبقى من قيم إنسانية وديمقراطية ومنطقية في هذا المجتمع، نتوجّه إليكم بثلاثة أسئلة ورجاء، لعلّنا نحافظ على بقعة صغيرة شجاعة في هذا البلد تقول الكلمة الصعبة غير الرائجة وتجد من يسمعها ومن يحاورها بطريقة هادئة وبناءة.
أوّلاً: هل نسمح بنجاح هذا التكتيك اليوم، فتسود سنة انتخابية مشحونة بالكراهية والعنف؟
إن كنّا نعرف أن خطاب الكراهية والعنصرية لا يأتي من الناس بل من السياسيين، فلماذا نقع في فخهم دائماً؟ كذب علينا الزعماء يا أصدقاء. أمضوا سنوات (بل عقود منذ اللجوء الفلسطيني) يكرّرون اللحن ذاته: أن اللاجئين/ات السوريين/ات في لبنان هم/ن سبب تفشّي البطالة وتراكم النفايات وانقطاع الكهرباء وزحمة السير وجفاف المياه في الصيف وفيضان الطرقات في الشتاء. غضوا النظر عن الموضوع الاقتصادي الاجتماعي والذي كنا فعلاً ولا نزال بحاجة لمناقشته بطريقة علميّة تقدّم الحلول (وما أكثر تلك الحلول!) وزجّوه في بحر من العنصرية ودون أي اهتمام بالعمل الفعلي لمعالجته – سوى السعي لجلب المساعدات والمزيد من المساعدات بالمليارات من قارات ودول تفضل ألّا يأتي اللاجئون/ات إليها.
قالوا مراراً وتكراراً أن اللاجئ/ة عدو كي يستخدموه/ا كبش محرقةٍ يبعدون به/ا إصبع الاتهام عنهم. إنها ورقة انتخابية تكاد أن تنجح دائماً: عندما يسعى الحكام إلى تفرقة الناس وافتعال الكراهية والخصومة، ننسى أن نحاسب الحكام. فكيف تحاسب ذاك الذي يتذرّع بالوطنية ومحاربة الإرهاب؟ أهذه هي استراتيجيتهم في هذه السنة الانتخابية؟ أهكذا يتهرّبون من محاسبة الناخب/ة؟ أهكذا يشترون النسيان ويضمنون النجاح؟ على ظهر اللاجئين/ات؟
ثانياً: هل نرضى بقمع التعبير عن رأيٍ يتضامن مع اللاجئين؟
هل أعمانا الإعلام الطائفي في المنطقة حتى استحال علينا رؤية الإنسان السوري العالق بين مطرقة بشار وسندان داعش؟ الهارب من الطيران الروسي والسلاح الأميركي؟ هل ضاقت بنا السبل لأن نعلق كل سبب أزماتنا على أفرادٍ لا يحملون/ن الجنسية، لا يصوتون/ن، لا ينتخبون/ن ولا يضعون/ن السياسات العامة للبلاد؟ هل بلغ بنا النكران واليأس لأن نلوم أولئك الذين واللواتي لم يمكن لديهم/ن الخيار في الرحيل من بلادهم وطلب الأمان في بلادنا؟ إن الموارد لا تكفي الجميع، هذا صحيح، لكنها لم تكفِ أحد قط، هل اللاجئون/ات هم أصحاب الشركات التي تشتري مرافق الدولة والتي بلغ سوء إدارة مرافقها درجة مخيفة من الإهمال؟
هل اللاجئون/ات هم/ن الذين/اللواتي يصرّون/ن على إفقار الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية؟ هل اللاجئون/ات يتوارثون/ن المناصب والمقاعد النيابية والانتخابية؟ هل يحمي اللاجئون/ات القتلة والمتاجرين بالبشر؟ هل ضاقت بنا السبل لنغلق أفواه فئة لا تشعر بالرّضى تجاه السياسات التي تحمّل اللاجئين/ات ما لا قدرة لهم عليه. هل نفقد إنسانيتنا لأن الحكام لم يعاملونا كبشر أصلا؟ إن حرية التعبير هي كل ما نملكه في بلد سرقت موارده، وأمواله، وشواطئه العامة، فلندافع عنها لأنها خلاصنا جميعا.
ثالثاً: هل الجيش فوق القانون؟
حتى وزير الداخلية صرّح بضرورة البحث في الوفيات السورية التي حصلت في عهدة الجيش. ألا يخضع الجيش للقانون والمحاسبة؟ حتى العمليات العسكرية تخضع لقوانين دولية تمنع استهداف المدنيين/ات وتفرض التحري في الوفيات وتمنع التعذيب. فهل هي خيانة أن نذكّر بذلك؟
إما أن يكون القضاء في لبنان مستقلّاً يحاسب من طعن رجلاً في الشارع بعد مشكل سير، ويحاسب من قتل زوجته بعد سنوات من العنف، ويحاسب من استغل عاملة أجنبية لأنه يعرف أنها لن تشتكي خوفاً من الترحيل، وأن يكون القضاء مصدر ثقة وطمأنينة عند الناس أو لا يكون.
إن الشجاعة مُعدية، كما المحاسبة تماماً، وكلاهما يؤديان لحلم يتوق إليه اللبنانيون/ات جميعا وهو حلم الدولة العادلة القادرة على إنصاف الأخلاق على العصبية. هكذا تُبنى البلاد، وهكذا يتعلم الحكام التعقّل، وهكذا نسترجع حقنا جميعا بالمواطنة الفاعلة.
إن الجيوش صورة عن بلادها، فهل نطلب الكثير إذا أردنا صورة محبة للإنسان وحقوقه؟ هل هذا مطلب كبير في بلاد أصبح التفاؤل فيها ألا نقتل برصاص طائش والسلاح المنتشر؟ إن المحاسبة نقيض الخيانة، لأنها توق إلى ممارسة دورنا كمواطنين ومواطنات، وإلى بناء قاعدة مشتركة بيننا جميعا: أن القانون فوق الجميع. وأنه يحق لكل إنسان بغض النظر عن لونه أو دينه أو عرقه – وحتى بغض النظر عن جريمته – أن يحظى بمحامٍ يدافع عنه، فهل نقبل بالتشهير بمحامية وقفت لحماية القانون والأصول وتوكّلت بقضية الذين قتلوا في ظروف غامضة؟
رجاءً لا تسمحوا لهم بأخذ ضمائرنا أيضاً!
طوال السنوات الماضية، تدهور وضع هذا البلد وأخذ سياسيّوه منّا الحقوق والآمال والمساحات العامة وحتى الرصيف والبحر والشجر والتراث – فهل نسمح لهم بأخذ الإنسانية والضمير أيضاً؟
فلتعلُ الأصوات المطالبة بالكرامة للإنسان – أي إنسان، فوق أصوات الطبول القارعة للمعركة – أية معركة.
للتوقيع اتبع الرابط التالي
https://sites.google.com/view/solidaritywithrefugees
وحدكم يا وحدنا/ الياس خوري
الحملة الإعلامية على السوريين في لبنان، تأتي في ظل الدم المراق في أقبية التحقيق اللبنانية. واللافت أن القوى السياسية اللبنانية المهيمنة تعيش حالة من الغيبوبة التوافقية، التي تجعل من أي نقد خيانة، بل تصل الأمور إلى مصادرة عينات من جثث الضحايا السوريين كي لا يجري تشريحها في مستشفى اوتيل ديو، تنفيذا لقرار قضائي!
أين نحن ومن نحن؟
هل صحيح أن معتقلي مخيمات اللجوء في عرسال، كانوا يستمعون إلى نسخة مطابقة للكلام الذي سمعه مئات آلاف المعتقلين في سوريا؟ هل صارت «بدكم حرية» تهمة في لبنان مثلما هي تهمة في سوريا؟
المنطق يقول إن علينا انتظار نتائج التحقيق، لكن عن أي تحقيق نتكلم وسط هستيريا الكراهية والقمع، وفي ظل هذا الخراب الوحشي؟
واللافت أن الحملة يشترك فيها طرفان:
طرف لبنانوي، يجد في الضحية السورية متنفسا لكبته السياسي، فبقايا جنون العظمة التي تتحكم بأداء رئيس التيار الوطني الحر السيد جبران باسيل، يرفدها تصريح لرئيس حزب القوات اللبنانية السيد سمير جعجع مهددا الأمم المتحدة بشحن مليون ونصف مليون لاجئ سوري بالبواخر إلى مقرها في نيويورك! هذا الطرف الذي يمثل بقايا المارونية السياسية بكراهيتها للعرب والسوريين والفلسطينيين بشكل خاص، يعبر عن عجزه عن التعامل مع الواقع السياسي اللبناني الذي يهيمن عليه حزب الله، عبر اللجوء إلى لغة العنتريات الفارغة والحرص على الجيش اللبناني، علها تسمح له باستعادة شيء من النفوذ في واقع المحاصصة التي حلبت البقرة اللبنانية حتى القطرة الأخيرة.
وطرف عقائدي ايديولوجي لا يعترف بالحدود الوطنية أصلا، يرسل جيشه إلى سوريا كي يهجّر أهل القصير والقلمون إلى عرسال، ويساهم في حرب التطهير الطائفي التي يقودها قاسم سليماني في العراق، ويلعب في كل مكان متاح، كأن لبنان دولة عظمى، تمتلك القدرة على إرسال جحافلها إلى خارج الحدود!
ما العلاقة بين الكيانين المغلقين على ذاتياتهم اللبنانية، والعقائديين الذين لا يعني لهم لبنان شيئا، وكيف تم إنتاج هذا التحالف الغريب على دماء السوريات والسوريين وآلامهم؟
لا تقولوا لنا إنها المعركة ضد الإرهاب. لم يذهب الجنرال عون إلى ضريح مار مارون في براد، في محافظة حلب عام 2008، خوفا من الإرهاب، يومها لم يكن هناك إرهاب ولا من يرهبون، بل كان هناك مشروع تحالف الأقليات ضد الأكثرية، وهي نغمة ما كان لها أن تستشري ثم تتوحش في حربها ضد الشعب السوري إلا من ضمن هذا السياق الجنوني الذي اسمه الحرب على الإرهاب عبر تسليم الموصل إلى تنظيم «الدولة» (داعش) وتشجيع القاعدة والإسلاميين التكفيريين في سوريا تمهيدا لتدمير البلاد وطرد الشعب إلى خارج الحدود وإذلاله.
أنظمة الاستبداد «تتدعوش» الآن بممارساتها الوحشية، مثلما سبق لـ «داعش» أن استبدت فصارت الوجه الآخر النظام الاستبدادي وصيغته النيئة.
وقبل أن يعطونا دروسا عن ضرورة عدم توجيه النقد إلى الجيش لأنه خط أحمر، عليهم أن يحددوا لنا هل المقصود بهذا الكلام الجيش النظامي اللبناني الذي يتبع سياسة لبنانية معلنة هي النأي بالنفس عن الأزمة السورية، أم المقصود جيش لبناني آخر يقاتل في سوريا ويحتل أراضي فيها؟ ونسأل أين يتعايش جيشان، أحدهما للداخل والآخر للداخل والخارج؟ وما هي قواعد هذه اللعبة الجهنمية الفالتة من أي نصاب سياسي، لأن هم الطبقة السياسية ينحصر في النهب والبلع؟
لم تعد هذه الأسئلة مجدية في هذه البلاد التي انحصر طموح أبنائها في هدفين: السترة والهجرة لمن استطاع إليها سبيلا.
هكذا ضمنت الطائفيات العنصرية اللبنانية موقعها في خريطة الخراب والدم، وصار اللاجئ السوري، الذي طردته وحشية النظام والميليشيات من وطنه، عرضة للإذلال اليومي والقمع والتخويف.
ونسى هؤلاء أن العمال السوريين، قبل موجة اللجوء، هم من عمر الباطون اللبناني بتعبهم وعرقهم، وأن الزراعة اللبنانية قائمة على العمال الزراعيين الموسميين السوريين، كما يتناسون أن لبنانهم كان جزءا من سوريا بمدنه الساحلية وأقضيته الأربعة، وأن لعبة العنصرية الحمقاء ضد اللاجئ الفقير والمشرد والمطرود من بلاده لا تدل سوى على الدناءة والضِعة والاستقواء على الضعفاء.
لن نقول لهم استفيقوا من هذه الغيبوبة، فمسألة اللاجئين السوريين ما كان لها أن تتخذ هذا المنحى الوحشي لو جرى التعامل معها بعقلانية مؤسسات حكومية تتصرف كمؤسسات مسؤولة عن أرضها وشعبها واللاجئين اليها.
فهم لن يستفيقوا.
لا أحد في هذا العالم العربي يريد أن يستفيق، بل لا أحد في هذا العالم معني بأكبر مأساة في القرن الجديد الذي أطل علينا مغمسا بدماء العرب.
لا أحد، فالسوريات والسوريون اليوم هم ضمير عالم فقد ضميره، إنهم عار الجميع، كيف يجري كل هذا ولا يحرك أحد ساكنا إلا حين يعتقد أنه يستطيع الاستيلاء على جزء من أشلاء الأرض السورية؟
صارت سوريا بلا سوريين، هذا هو الحلم الحقيقي لآل الاسد ومن لف لفهم من القوى الطائفية في المنطقة، وصارت حرية الشعب السوري مكسر عصا ودرسا في الموت لشعوب العالم بفضل عرب البنزين الذين أغرقوا سوريا بالايديولوجية الأصولية المغطاة بمال الكاز والغاز.
إنهم يقتلون سوريا أمام أعيننا التي لم تعد تستطيع أن ترى.
هل تذكر أيها القارئ ذلك الإنسان السوري الذي صرخ مرة «أنا انسان مش حيوان»، يريدون لهذا الإنسان أن يتجرد من إنسانيته ويرتضي بأن يكون حيوانا. وحين فر اللاجئون إلى البلاد المجاورة: لبنان وتركيا والأردن، اكتشفوا أن بلاد اللجوء هذه تريدهم حيوانات، وأن لا خيار لهم، سوى التمسك بانسانيتهم.
يا وحدكم.
أيها السوريات والسوريون أنتم وحدكم، وحدكم أي وحدكم، لا تصدقوا أحدا. وحدكم في العزلة ووحدكم في الألم. وحدكم تدفعون ثمن انهيار العرب وموت أرواحهم وذلهم أمام القوى الكبرى وانحناء أنظمتهم لإسرائيل.
وحدكم يا وحدكم.
وحدكم يا وحدنا.
القدس العربي
عرسال.. التحريض على قدم وساق/ عديد نصار
بدأت الحكاية إثر حملة المداهمة التي شنها الجيش اللبناني على مخيمين للنازحين السوريين في تخوم مدينة عرسال المحاذية للحدود اللبنانية السورية في سلسلة الجبال الشرقية، وما أعلنته قيادة الجيش عن تفجير انتحاريين لأنفسهم أثناء تلك المداهمات ما أسفر عن مقتل طفلة سورية من النازحين التي أعلن الجيش اللبناني أنها قضت نتيجة تفجير والدها نفسه.
الرواية التي شكك فيها كثيرون، ودعموا هذا الشك برواية تناقض تماما رواية الجيش تؤكد أن والدي الطفلة اللذين لا يزالان على قيد الحياة ومتواجدين في المخيم أكدا أن الطفلة قضت تحت أنقاض جدار بعد أن صدمته آلية للجيش اللبناني.
وما زاد الصورة قتامة الصور والأشرطة المصورة التي سُرّبت عن طريقة تعامل قوات الجيش اللبناني مع المئات من النازحين لحظة احتجازهم، وصولا إلى سقوط أربعة منهم على الأقل أثناء توقيفهم في أحد مواقع الجيش.
وقد ووجهت تلك التجاوزات المنسوبة إلى الجيش اللبناني باعتراضات واسعة باعتبار أنه لا يجوز لقوات نظامية أن تمارس ممارسات الميليشيات المسلحة، بل عليها أن تتعامل وفق القوانين النافذة محليا وضمن ما تفرضه القوانين الدولية في التعامل مع الموقوفين مهما كانت جنسياتهم وانتماءاتهم.
وقد ازداد الأمر تعقيدا بعد التعاطي الفظ لمخابرات الجيش مع موكلة ذوي الضحايا الأربعة التي حصلت على إذن قضائي بإجراء فحوصات مخبرية على عينات من الجثث لاستكمال التحقيق حول ظروف الوفاة، حين قامت وحدات من هذا الجهاز بملاحقة الموكلة إلى المستشفى الذي كان يفترض أن تجرى فيه التحليلات ومصادرة العينات منها بالقوة.
هذا التعاطي من المؤسسة العسكرية مع تداعيات مداهمات 30 يونيو، شغل الإعلاميين ووسائل التواصل الاجتماعي وانتهى إلى تبني مجموعة يسارية لبنانية الدعوة إلى لقاء تضامني مع النازحين السوريين في الثامن عشر من الشهر الجاري، وللمطالبة بتحقيق شفاف في قضية المتوفين أثناء التوقيف، ولرفع الصوت في وجه حملات التحريض العنصرية ضد السوريين عموما ونازحي المخيمات الفقراء خصوصا، كما في وجه الحملات العنصرية المضادة التي تنسب إلى سوريين ضد اللبنانيين.
لقد تم استغلال هذه الدعوة من قبل جهات استخبارية على ما يبدو، وتم إنشاء صفحتين على فيسبوك بشكل متزامن تقريبا واحدة تهاجم الجيش اللبناني واللبنانيين عموما وتدعو للمشاركة بالتحرك سابق الذكر، ولكن بنفَس عنصري مقيت، وأخرى تحت عنوان التضامن مع ذوي شهداء الجيش اللبناني بذات المواصفات العنصرية موجهة ضد السوريين النازحين ومخيماتهم في لبنان.
أسهم هذا التطور في رفع منسوب التحريض على النازحين السوريين بشكل مخيف، خصوصا أن الدعوة إلى التظاهر تضامنا مع النازحين ووجهت بدعوة للتضامن مع شهداء الجيش في المكان والزمان نفسيهما في بيروت، ما دفع المجموعة اليسارية التي دعت بداية إلى التحرك أن تلغي تحركها، ومن ثم منع وزير الداخلية أي تحرك احتجاجي أو تضامني أو سواهما في ذلك اليوم.
وفي حين تستمر وتيرة التحريض والعنصرية ضد النازحين السوريين في الارتفاع، تتزايد الأخبار وتتناقض حول تحركات الجيش اللبناني في عرسال وحولها، حيث تلعب وسائل إعلام الممانعة دورا رياديا في الترويج لعمليات عسكرية تمهيدية هناك لتعود قيادة الجيش فتنفيها.
وإذا كانت هناك شكوك كبيرة ومبررة حول تورط جهات استخبارية معينة في إنشاء الصفحتين سابقتي الذكر على فيسبوك للتحريض والتحريض المضاد، فإن الضخ الإعلامي المتزايد حول معركة عرسال والظروف الموضوعية الراهنة التي تحيط بالمنطقة تؤكد أن عملية “التسخين” تجري على قدم وساق لتلك المعركة، فلا يجد النازحون السوريون ولا حتى “العراسلة” من يحميهم أو يدين أي عملية اقتلاع ممنهجة يسعى إليها حزب الله ليستكمل سيطرته على الحزام الحدودي، بدءا من طريق دمشق عند نقطة المصنع، وصولا إلى القصير السورية في ريف حمص دون أي عوائق.
ولن يكون مستغربا، في ظل التوافق الداخلي بين المافيات الغاصبة للسلطة وللمؤسسات في لبنان، أن تستخدم مؤسسة الجيش اللبناني في هذه المعركة لتأكيد مشروعيتها، تماما كما استخدم الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية العراقية في تدمير مدينة الموصل ليبسط الحشد الطائفي سيطرته هناك على أنقاض المدينة وتاريخها وأهلها.
السؤال الذي يفرض نفسه، في حال تم لحزب الله ما يريده من معركة عرسال، ما هو المصير المتوقع للحزام الحدودي بين لبنان وسوريا والممتد من نقطة المصنع جنوبا إلى مزارع شبعا المحتلة؟ هل سيكون من نصيب الاحتلال الإسرائيلي بذريعة سيطرة حزب الله على القسم الشمالي من الحدود؟ وهل ستظهر قريبا معالم خارطة السيطرة وتقاسم النفوذ التي اعتمدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب في لقائهما الأول والمطول؟
كاتب لبناني
العرب
حين يوحد التعذيب بين اللاجئ السوري واللبنانيين/ شادي علاء الدين
قل “الجيش اللبناني وبس” اهتف لقائد الجيش ورئيس الجمهورية، اشتم كل ما هو سوري. هذا ما تطلبه مجموعة من غلاة الوطنية اللبنانية خلال قيامهم بحفلة تنكيل بلاجئ سوري وفق ما يظهره فيديو انتشر بقوة في بلاد الأرز.
لعل الكامن وراء تصوير الفيديو وعرضه، هو ما يقدمه من اقتراح إنشاء تعريف للسوري اللاجئ في لبنان بوصفه كائنا لن يحب الجيش، وقائده ورئيس الجمهورية إلا مرغما، وبعد خضوعه للضرب والإهانة. هذه هي صفة السوري والتي لا تنازعها أي صفة أخرى في قدرتها على عرض حقيقة السوري بشكل دقيق وحاسم.
لم يخطر على بال صنّاع هذا التعريف أنهم يساهمون في توسيع دائرة المشترك بين جزء كبير من اللبنانيين وبين هذا التعريف للسوري، إذ أن مسار الحال اللبناني يكشف أن وضع اللبنانيين بات مطابقا لحال السوريين المنكل بهم.
اللبنانيون غير قادرين على حب الجيش وقائده ورئيس البلاد إلا بواسطة التنكيل والإهانة. هذا ما يقوله خطاب السلطات بجميع أنواعها وما تقوله الممارسات المتغطية بحب الجيش تجاه اللبنانيين والتي باتت سمة المشهد اللبناني.
يجول جنديان بثياب مدنية بسيارة في ساحة قرية الفاكهة في حالة سكر شديد كما يؤكد بيان البلدية متعرضين لأهل القرية بالإهانات. ينشب خلاف بينهم وبين شباب القرية، تدخل إثره قوة عسكرية مع مجموعة من الآليات يرافقها مسببا المشكلة بثيابهما العسكرية إلى القرية وتنكل بأهلها، وبكل من صادف وجوده في المكان، وتعتقل أكثر من عشرين شابا بعد إشباعهم ضربا وتعذيبا تسبب للبعض بإصابات خطيرة.
هكذا تحول شباب قرية الفاكهة إلى لاجئين سوريين لا يحبون الجيش إلا تحت التعذيب. إذا كان حب الجيش متأصلا في نفوس اللبنانيين ومزروعا في قلوبهم من أبد الآبدين، فلماذا لا يتجلى هذا الغرام إلا مقرونا وملتصقا بحملات تنكيل صارت توحد بين السوريين وبين اللبنانيين من غير المتمتعين بأوصاف المقاومة والممانعة.
العلاقة مع الجيش إذن ليست علاقة مواطنة بل علاقة إيمانية يحكمها المقدس نازعا منها البنية الحقوقية والقانونية والمؤسساتية، ما يحولها إلى حالة طقوسية شعائرية تحل فيها الخرافات محل السياسة.
كذلك قد يكون من الضروري الانتباه إلى خطاب اللاجئ الواقع تحت نير التنكيل وكيف أنه وعلى الرغم من شيوع ظواهر الاعتداء وتكرارها بوتيرة عالية فإن ذلك لم ينجح في بلورة تعامل خاص مع القمع اللبناني، أو منحه أي خصوصية تفصله عن شكل القمع.
كان اللاجئ يئن صارخا “حاضر سيدي” مكررا أنات المعذبين في سوريا الأسد بشكل حرفي، يؤكد أنه لا يستطيع أن يتمثل التعذيب اللبناني إلا بوصفه استنساخا للتعذيب.
هكذا تضاف إلى مرارة التعذيب مرارة ذات طبيعة ساخرة تقول إن اللبنانيين لم ينجحوا حتى في إنتاج حالة لبنانية أصيلة من التنكيل، بل عمدوا إلى استعادة ملامح التنكيل الأسدي وتكراره كوصفة جاهزة يتوفر بين أيديهم دليل استعمالها، بل نعلم أن الخبرة بهذا التنكيل محفورة في ذاكرة الكثير من اللبنانيين وعلى أجسادهم، ومنتشرة في الفضاء العام، وفي قلب السيكولوجيا الناظمة للسلوك اللبناني.
تتدفق هذه الخبرة اللبنانية بمطواعية على جسد اللاجئ السوري مقرونة بإجباره على شتم وتحقير كل ما هو سوري، وحين يفعل يتبع ذلك بقوله “شو دخلني بسوريا”. يعتبر المنكّلون أنهم انتصروا، وأن آية انتصارهم التي شاهدها الجميع تتمثل في نجاحهم في انتزاع سورية هذا اللاجئ السوري.
يمثل هذا البعد تحديدا روح الانتصار اللبناني الوهمي على السوريين والذي يشكل القاسم المشترك بين هؤلاء المنكّلين باللاجئ السوري وبين التنكيل الرسمي والحكومي والدولي، وذلك التنكيل الخاص الذي تمارسه الجمعيات الإنسانية والحقوقية.
حين انتزع التنكيل سورية اللاجئ تحول إلى كائن بيولوجي بمعنى أنه لم يعد ممثلا لشيء يقع خارج حاجاته البيولوجية المباشرة، وبذلك صار آيلا لرحمة ليست سوى ذروة الازدراء، لأنها تهدف إلى إدامة مكوثه في ما هو عليه من احتضار طويل.
ينزع هذا التعامل عن الخاضع لنيره الأشد قسوة من التعذيب والبراميل المتفجرة أي علاقة بالزمن ويفصله عن تاريخه، بمعنى أنه يفترض أن هذا الكائن لم يكن يوما خارج هذا الوضع، ما يؤسس لتصور يريد أن يقول إن معاناته ليست سوى صفة لصيقة به ومحفورة في جيناته بشكل قدري. هكذا تتم تبرئة الجميع من المسؤولية عن مأساة اللاجئ السوري فهي لم تحدث بفعل فاعل، ولكنها بعض ما يفيض من داخله من صفات لا تسمح له سوى أن يكون آيلا للتعذيب من ناحية، وللشفقة التي تحول هذا التعذيب إلى مصير أبدي ونهائي من ناحية أخرى.
نقع نحن اللبنانيين في دائرة التطابق مع حال اللاجئ السوري لناحية الجهود الحثيثة التي تبذل لتحويلنا إلى كائنات بيولوجية محضة عاجزة عن إنتاج السياسة والتفكير تحت نير التجويع والضرائب والعسكرة العامة التي تلف ظلالها السوداء البلد مغرقة كل ما فيه من سياسة، وفن، وثقافة، واقتصاد في دوامة حداد مفتوح غير قابل للإنجاز.
نُعذّب فنحب الجيش والوطن والرئيس أو الجيش والشعب والمقاومة إذا شئنا توخي الدقة وهذا الحب مشروط بالتعذيب ولا يكون إلا به.
ولعل الخطاب الاحتفالي الذي صممه أحد معذبي اللاجئ في الفيديو خلال استعدادهم للاعتداء، والذي حاول منحه بنية التمهيد الساخر للانقضاض عليه يلخص الأحوال بشكل مكثف وموجز.
قال “كلنا ضد الجيش، وأنا مع داعش وهو مع النظام”. كلمة الحق سبقت كما يقول المثل، وهذه هي الحقيقة الأكثر خيالا من الخيال.
كاتب لبناني
العرب
العداء للسوريين يُطبخ في غرف مغلقة/ منير الربيع
أجواء الشحن اللبنانية- السورية ليست بريئة. آلية توزيع الأخبار والتسريبات والفيديوهات لم تكن عفوية ولا نتاج عمل فردي. كل دلائلها ومؤشراتها تفيد بأنها تُطبخ في غرف مغلقة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الدليل على ذلك، هو سرعة انتشار فيديو ضرب مجموعة من اللبنانيين مواطناً سورياً أعزل. حتى الكلام المستخدم في الفيديو وطريقة التعذيب، تحمل كثيراً من الدلائل والرسائل، خصوصاً أن مصادر مطّلعة على مسار التحقيق تؤكد لـ”المدن” أن هناك شخصاً إضافياً تلاحقه الأجهزة الأمنية. وهو ضليع في مسألة التعذيب والتصوير ونشر الفيديو، وهو شخص غير مدني.
ووسط هذه الأجواء المشحونة والتصعيدية، برز كلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن أن الجيش اللبناني هو المسؤول الوحيد عن حماية الحدود، وأنه سيلجأ إلى تنفيذ عملية موضعية ودقيقة في جرود عرسال. كلام الحريري يأتي في إطار قطع الطريق على محاولات زج الجيش في المعركة بشكل غير مباشر، أو أن يدخلها بناءً لرغبة حزب الله. بالتالي، قد يكون الموقف إعلاناً استباقياً أن الجيش سيشارك في حماية الحدود، وأن الحريري والحكومة يوفران له الغطاء لمواجهة الإرهاب، لاسيما حين يقول إن لدى الجيش دعماً سياسياً وفيراً في مواجهة التنظيمات المسلّحة.
لكن هناك من يعتبر أن كلام الحريري يهدف إلى قطع الطريق على حزب الله في استدراج الجيش، ومحاولة رسم فاصل بينهما. وهذا ما استكمله الجيش من خلال تعزيزاته في محيط بلدة عرسال وجرودها، ربطاً بجرود رأس بعلبك. وما تكرس في جولة قائد الجيش جوزف عون التفقدية، والعملية التي نفذتها مديرية المخابرات في عرسال، الأربعاء في 19 تموز، والتي قبضت خلالها على اثنين من المطلوبين.
في معرض التعليق على هذا الكلام، وتأكيده، سرت أجواء تحدّث عن تنفيذ حزب الله مناورة تشبه مناورة القمصان السود في بلدة العيشية قضاء جزين. وتتحدث المعلومات عن دخول مجموعة غريبة إلى البلدة والاعتداء على 13 منزلاً. لكن البعض اعتبر ما حصل قبل أيام هو تعرض عدد من المنازل في البلدة للسرقة، بعيداً من التفسير السياسي. إلا أن الأجواء التي تُرافق هذا الحدث تضعه في سياق لا ينفصل عن الأجواء المشحونة في البلد، خصوصاً لما تمثّله هذه المنطقة من رمزية، أولاً بسبب موقعها الجغرافي، حيث تقع في عمق السيطرة الميدانية والسياسية والأمنية لحزب الله، وثانياً باعتبارها منطقة مسيحية.
بمعزل عن الآراء المتضاربة التي توضع في السياقات السياسية المختلفة والمتناقضة لما حصل، فإن الايحاء المراد عكسه هو تعزيز مفهوم الاستنفار اللبناني في المناطق اللبنانية ضد السوريين، ولرمزية المنطقة المسيحية هنا، بحصر الإشكال بين اللاجئين والمسيحيين، إلى جانب محاولات زرع مشاكل أخرى بين اللاجئين والسنّة في عرسال مثلاً، على قواعد متعددة، منها التهديد بالوضع الأمني الذي قد ينعكس على البلدة بسبب وجود اللاجئين، وإمكانية تحول مخيماتهم إلى ملاجئ للإرهابيين. يجري ذلك فيما تخرج آراء تعتبر أن ما يجري هو مزيد من محاولات التحفيز لمشاركة الجيش في العملية العسكرية في عرسال، بعد الكلام عن أن الجيش يؤكد أنه لن يشارك فيها، بل يطالب بحلّ المسألة بأقل الخسائر الممكنة. وهذا ما يعتبره البعض أنه رأي متمايز للجيش عن رؤية حزب الله، الذي يستمر بالحشد العسكري والإعلامي لحسم تلك المعركة.
اللافت هو أنه حتى الآن، رغم انخراط حزب الله في المعارك السورية، لم يظهر حال من العداء في الشارع الشيعي للاجئين السوريين، بالحجم الذي يظهر في مناطق مسيحية وسنّية، خصوصاً بعد الاجراءات الأخيرة التي اتخذت بحق العمال السوريين، الذين يفتحون مؤسسات في مناطق الشمال، كطرابلس وعكار. وهذه الصورة، تعكس مدى انضباط الشارع الشيعي تجاه اللاجئين، رغم أنهم يعتبرون أن حزب الله هو من تسبب بطردهم من منازلهم وأراضيهم.
هناك نظرية بدأت تظهر في لبنان بأن أطرافاً تريد إخراج السوريين من لبنان، عبر إحداث توترات أمنية وعبر فيديوهات تشبه ما حصل، الثلاثاء في 18 تموز، وعبر رسائل أخرى في مناطق أخرى، ستترافق مع معركة عرسال. وإلى جانب العوامل السياسية، هناك نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري، يحسبون على مذهب معيّن. بالتالي، يسهمون في تغيير أي معادلات عددية إذا تطورت الأمور إلى الأسوأ، فإن نقطة التحوّل الأهم في هذا الموضوع، أن السوريين الذين كانوا يعتبرون أن لديهم مشكلة وحيدة في لبنان هي مع حزب الله، تطور مشكلتهم لتصبح معركة مع الشعب اللبناني والجيش اللبناني.
المدن
درس عرسال: لبنان تجربة مسيحية فشلت/ حازم الامين
إذاً، لم يكن ثمة من يُعد العدة لعمل إرهابي وشيك. المهمة في جرود عرسال تطلبت عرساً للوطنية اللبنانية الباحثة عن موضوع تملأ فيه فراغاً هائلاً يسودها منذ انبعاثها الثاني في 2006. لا بأس ببعض الكراهية، إذ لطالما شكلت الأخيرة بديلاً للوطنيات الفارغة من مضامينها. «حزب الله» أراد أن يستكمل منطقة نفوذه في ريفي القصير وحمص، فجردت له «الوطنية اللبنانية» حملة كراهية ممهدة لمهمته، وأطلق له رئيس حكومة دولة الكراهية اليد، وتمّ تكثيف المشهد بشريط فيديو، هو خلاصة ما حصل. عامل سوري فقير ينهال عليه فقراء لبنانيون من أقرانه، بالضرب والشتائم، ويجبرونه على إعلان «حبه» لرئيس الجمهورية اللبنانية العظمى.
لا شيء أكثر وضاعة من اندراج المرء في «وطنية» موضوعها الأساس كراهية بلهاء وعاجزة عن الإتيان بغير ذلك المشهد البشع لشبان ينهالون بالضرب على عامل أعزل. والوضاعة تكمن تحديداً في ذلك الانكشاف المذهل لمهمة حملة التحريض. ذاك أن معركة جرود عرسال تقضي بأن تنطلق الحملة، وأن يكون وقودها فقراء جلادين، وضحاياها فقراء مجلودين.
سفهاء القوم كانوا حملة الراية. استحضرت الجزمة من قاموس التشبيح البعثي، فاستعيض بها عن صور البروفايل على صفحات «فايسبوك». وأن تكون الجزمة جزءاً من أحجية وطنية، فذلك ما يدعو إلى التفكير في حقيقة أن لبنان فقد مهمته، وها هو يحاول تعويض هذا الفقد بشحنات من الكراهية. فـ «الوطنية» استحضرت في معركتها الأخيرة كل ما تملك من أسلحة، وجعلت من معركة الجرود واقعة مؤسسة للانبعاث، ولنا أن نتخيل وطناً مؤسساً على القبول بمقتل أربعة موقوفين في سجن جيشه، وعلى وظيفة مقتصرة على تأمين مهمة إقليمية لحزب مندرج في خريطة مذهبية عابرة للأوطان.
اليوم، وبعد انقضاء أكثر من أسبوع على الوثبة، صار بإمكان المرء أن يُفسر الوقائع الغامضة. الغارة المفاجئة على مخيمات اللاجئين في عرسال، وما أعقبها من أخبار عن إلقاء القبض على انتحاريين، وموت الموقوفين في سجون الجيش وتعقب محامية الموقوفين إلى المستشفى لمنعها من تحليل عينات الجثث، وتخبط رئيس الحكومة سعد الحريري في تغطيته الحملة وفي سعيه إلى تجنب دفع أثمانها.
«معركة الجرود بدأت» قبل يومين، و «حزب الله» قرر موعدها رسمياً في خطاب مسجل لأمينه العام. والحملة الهذيانية للوطنية اللبنانية بدأت قبل ذلك بأسبوعين. فهل من علاقة بين الحدثين؟ لا تطرح الوطنية اللبنانية هذا السؤال البديهي على نفسها، ذاك أنه يعرضها لمساءلة حول الفراغ الهائل الذي تتخبط فيه. فهي جردت للمهمة التي أوكلها إليها «حزب الله» كل خيالها الجامح. جزمة عسكرية وصور لموقوفين عراة، وعبارات لمغنين، وعراضات كلامية وزجلية، وهي فعلت ذلك لا لتواجه نفسها بما تكابده من فراغ، بل لتملأ هذا الفراغ بشحنات كراهية يبدو أنها الوسيلة الوحيدة لانعقادها.
القول أن لبنان فقد موضوعه صار اليوم حقيقة. المهمة الأولى التي أوكلت للمسيحيين تعثرت مرة ومرتين، لكنها اليوم فشلت. الحرب الأهلية كانت عثرة في وجه التجربة، ولم تكن فشلاً كاملاً. لم تتلاشَ الحدود خلالها، وبقيت الجماعات تتحارب تحت سقف أوهام سقطت اليوم بالكامل.
علامَ يمكن أن يُجمع اللبنانيون اليوم؟ ما هو موضوع هويتهم؟ التأمل في أحوال دولتهم لا يفضي إلا إلى التعويض عن الفشل بالكراهية. الفساد في لحظات الذروة اليوم، ولا أحد خجل بفساده. العجز عن حل كل المشكلات لا يعيق تصدر الفاشلين والفاسدين طوائفهم وأحزابهم. شراكات النفط العتيد عابرة للانقسامات المذهبية، وأن تشتكي اليونان من أن شواطئها بدأت تتأثر بالنفايات اللبنانية، فهذا ما لا يكترث له مسؤول لبناني واحد. وبينما يدعو الوزراء السياح الأجانب والعرب إلى المجيء، يستأجرون هم الطائرات الخاصة ويغادرون مع عائلاتهم إلى شواطئ العالم غير الملوث. وقبل أن يُغادروا إلى منتجعاتهم العالمية يوقعون على قانون انتخاب يعيد إنتاج الطبقة السياسية ذاتها مع تعديلات طفيفة تعفي «حزب الله» من بعض المزعجين في البرلمان.
الخريطة في الإقليم تنعقد ولبنان هذه حاله. لا قوة فيه إلا لـ «حزب الله». الحكومة مسخرة لتأمين مهمة الحزب في سورية، ولتقاضي الأثمان في النفط وفي النفايات وفي الضرائب والرسوم. لا أحد يثيره توقيف صحافي، وتهديد محامية طالما أن قلة تتقاضى الأثمان الزهيدة التي وزعها الحزب على «خصومه».
اليوم، صار يمكن القول أن لبنان هو «دولة حزب الله». المعنى الحقيقي لكل شيء يفضي إلى هذه القناعة. والحزب بصفته الدولة العميقة، صار يجيد توظيف ما تبقى من هويات الجماعات في مهمته «غير الوطنية». المسيحيون وخساراتهم وعلاقتهم بالجيش، وزعماء السنّة ورغبتهم في التعويض عن الإخفاقات، والشيعة وتمسكهم بالتصدر، لا شيء أسهل على الحزب من إدارة هذا الوهن، ومن توظيفه في مهمة تبدأ في عرسال ولا تنتهي في الموصل.
لكن، من جهة أخرى يكشف ما حصل في عرسال أن نهاية لبنان صارت حقيقة. في البدء، تلاشت الحدود الجغرافية، وانفتحت للمرة الأولى في تاريخ الكيان على حرب تدور خارجه، فصار البلد مساحة غير محددة. واليوم، وبعد ست سنوات من المهمة في الخارج، انكشف مستوى جديد للتلاشي اللبناني. لم يعد للبنان ولجماعاته الأهلية موضوع ووظيفة. الكراهية لا تسعف هنا، ذاك أنها هي ذاتها لا موضوع لها سوى كشفها للانهيار. فقد سبق أن أسست الكراهية لوطنيات، إلا أن ذلك كان ورماً في جسم مريض، أما الكراهية اللبنانية فهي تشتغل وحدها، لا جسم تنخره، ولا ثقافة تلوثها ولا هوية تهددها. كراهية تعويضية تتحرك في بلد صار مجرد مساحة، وهي أحياناً تثير الضحك وأحياناً أخرى تثير الغثيان. وبين هذين الشعورين، ثمة حزن على محاولات فشلت، ربما كانت مداواته في أن يقبل المرء بحقيقة أنه يعيش في دولة «حزب الله»، فهذا على رغم ثقله يبقى أقل استخفافاً بذكائه من أن يتوهم وطنية عناصرها جزمة عسكرية وأغنية هابطة.
الحياة
نقاش من البداية عن تلك البقاع الساخنة/ أحمد جابر
الفصل بين بلدة عرسال وجرودها أمر يعني الحكم اللبناني في المقام الأول، فهو المرجع الرسمي الذي يناط به حفظ الأمن الوطني، وهو المسؤول الأول عن الحؤول دون جعل النجاح في إخلاء الجرود من المسلحين السوريين، نجاحاً في إخلاء عرسال من أهلها. المعنيون بسلامة البلدة البقاعية، عرسال، تقع عليهم مسؤولية رفع الصوت عالياً، من دون أخذ في الاعتبار أصوات الانفجارات التي، على شدتها، لن تستطيع أن تحجب مسألة وطنية حساسة عنوانها عرسال، ومضمونها عدم السماح بالتلاعب بالاستقرار الداخلي، الأهلي والرسمي، تحت ستار دخان المعركة ضد الإرهاب.
ولتكن عودة إلى البداية، بداية الانخراط في المذبحة السورية، وبداية ابتكار التعريفات والتسميات من جانب النظام وحلفائه، ومن جانب التجمع الدولي، ومن ثم بذل الجهد في تعميمها، وفي اقتراح الخطط المناسبة للتعامل معها.
دفعاً لكل التباس قد ينال من وضوح الموقف، يجب الإعلان أن الدخول إلى سورية، دخولاً قتالياً، لم يكن قراراً لبنانياً رسمياً، ولم يكن موضع قبول شامل أو إجماع وطني عام، بل إن ذلك التدخل الذي تدرج من حماية القرى اللبنانية إلى حماية الرموز الدينية إلى التدحرج ككرة نار واضحة اللهب والمرامي، كان شأناً أهلياً لبنانياً فئوياً خاصاً، ودوافع المتدخل الفئوي. كانت فئوية المصالح في الداخل، ومنحازة إلى خط المصالح التدخلي في الإقليم.
لهذا وذاك، فإن ما يدور اليوم في الجرد العرسالي من قتال، حكْمه حكْم التدخل الأول، من حيث القول أن لا شأن للبنان بقراره، وأن نهاية التدخل، أو سلوك طريق خواتيمه، تنتمي إلى العملية السياسية ذاتها التي بدأت منذ سنوات ست، ويراد لها أن تنتهي، في فصول من فصولها، على الحدود اللبنانية – السورية. نفض اليد من الانتماء إلى العملية القتالية غير الرسمية، مقدمة لازمة لنفض اليد من قراءة «إنجازاتها»، ومن احتفاليتها الانتصارية التي ستُزف بشراها إلى كل اللبنانيين، الفريق الذي لا يتعامل مع هؤلاء اللبنانيين إلا كجمهور متلقٍّ، ولا يتعامل مع البلد ومصالحه، إلا بصفته ميداناً لتلقي التداعيات السلبية، ولدفع أثمان السياسات التي لا يد للبلد فيها، عند التدخل وعند الانسحاب.
أيضاً، ودفعاً لكل التباس في المجال الرسمي، يجب الإعلان أن ما يهم اللبنانيين المغلوبين على قرارهم، وعلى السيطرة على صناعته وصياغته، استقرارهم الداخلي، وحفظ مؤسساتهم وإداراتهم وتشكيلاتهم الأمنية والدفاعية، وفي طليعتها مؤسسة الجيش، هذا الذي ليس مطلوباً منه أكثر من الإمساك بالحدود الوطنية وحمايتها وصيانة كل ما يقع داخلها من بشر وشجر وحجر. في هذا المضمار، من المفترض، بل من الحقيقي والواجب، أن تكون مؤسسة الجيش التي تحركها السلطة السياسية، الجهة الضامنة التي يوليها اللبنانيون الذين ما زالوا داخليين، ثقتهم، وأن تكون المؤسسة ذاتها القوة الوحيدة التي تستطيع أن ترسم، وبقوة التدخل والمعنى والرمزية، الخط الفاصل الواضح، بين القتال في الجرود، وبين إثارة النعرات والتوتير الأهلي في الداخل. وإذا كانت العبارة السائدة اليوم هي عبارة الخط الأحمر، فإنه من لزوم ما يلزم الجهر وبقوة، بأن حماية كل بقعة لبنانية تشكل خطاً أحمر يجب ألا يسمح لأي من العابثين بتجاوزه.
وفي سياق المعركة الدائرة حالياً، هموداً أو اضطراماً، يجب ألا يغيب السجال مع السياسات التي سوَّغت التدخل في سورية، وألّا تفتر الهمّة السجالية عند تفنيد المبررات التي ما زال يُدلى بها لدى كل حديث عن ذلك التدخل. تذكيراً، ليس صحيحاً أن المعركة بدأت ضد ما بات معروفاً باسم الإرهاب في سورية، بل الصحيح أن النار فُتحت ضد المتظاهرين السوريين العُزَّل الذين هتفوا طويلاً: «سلمية سلمية… واحد واحد، الشعب السوري واحد واحد». كان النظام السوري مبادراً إلى العسكرة، شأنه شأن كل نظام تسلطي استبدادي، وكان التدخل الفئوي الأهلي اللبناني مؤازرة لهذا النظام وتعظيماً لنتائج بطشه. الخلاصة، لا صحة لإعلانات النهاية عندما تزوّر أو تموّه حقائق البداية، وإذا كان صحيحاً أن ما بدأه الشعب السوري قد انتهى إلى ما لا يرغب فيه هذا الشعب، وإلى ما لم يقصده، فإن الصحيح أيضاً، أن النظام وحلفاءه من اللبنانيين، قد كانوا أمينين لخططهم، وصادقين مع أهدافهم، من البداية التي كان موضوعها وأد صرخة السوري، إلى النهاية عندما صار الشعب نفسه أمثولة للقتل والتنكيل والنزوح والتهجير.
هي مسألة صمود عند القناعة الأولى، برفض الرواية النظامية السورية، وبرفض روايات حلفائها، بالأمس في دمشق وحمص وحماة وحلب والقصير والقلمون، واليوم في جرود عرسال، وحيال الإيحاءات السلبية حول عرسال ذاتها.
وهي مسألة أخلاقية أولى لا يتوانى حَمَلَتُها عن الجهر بالانحياز إلى جانب الشعوب المقموعة، وإلى جانب حقها في الحرية والكرامة، وضد الاستبداد، في أشكاله الإسلامية والعلمانية والقومية، وضد ملاحق الحركات التحررية والمقاومة والتحررية، التي تبدأ كثورة، وتنتهي كسلطة تبزُّ أشباهها من السلطات الحاكمة، في ميدان التسلط والديماغوجيا والتضليل والشعارية الفارغة.
بخلاف قول الشاعر العربي «اليوم خمر وغداً أمر»، تفرض الضرورات القول: اليوم أمر وغداً أمر أيضاً، ذلك أن لا مجال للانصراف إلى الصمت السياسي، عندما يكون صوت السياسات الأخرى صاخباً إلى حدود إصابتنا بالموت السياسي.
الحياة
النزوح من الغوغاء/ ساطع نور الدين
يستجيب شريط الفيديو الذي يصور تعنيفاً وإذلالاً متعمداً لنازح سوري من قبل شبان لبنانيين، لحملة تعبئة رسمية وشعبية واسعة النطاق ضد النازحين السوريين، وينحط بها الى مستوى دنيء وخطير، ويمثل إنتزاعاً للسلطة والقانون من قبل الشارع الذي لم يثبت يوماً أنه على سوية عقلية وأخلاقية تحفظ الاجتماع اللبناني، وتحميه من البركان السوري.
الشبان الذين إعتدوا على النازح السوري، شعروا أن بإمكانهم أخذ زمام المبادرة من الدولة في الدفاع عما يعتبرونه تهديداً للجمهورية، وأمنها وجيشها وإقتصادها، ورئيسها الذي بات إسمه يدرج في الحملة على النزوح، كمحفز ضمني على تصعيد المواجهة الرسمية والشعبية مع النازحين السوريين إنتصاراً للهوية الوطنية المستعادة، وغطاء رسمي يضمن العفو السريع عن كل من ينشد الحلول محل المؤسسات..بدل ان يكون العكس تماماً.
في الحملة ذاتها مفارقات ومغالطات كثيرة، لم تكشفها السلطة ولم يكتشفها الشارع طبعا: هي تتصاعد الآن في الوقت الذي تنخفض فيه معدلات النزوح السوري، أو بالاحرى ترتفع أعداد السوريين العائدين الى مدنهم وقراهم، إما طوعاً ومن دون أي دوافع خاصة سوى إحساسهم بعودة الأمان فعلا الى مناطقهم وأحيائهم، او تجنباً لأعباء نزوح طال كثيرا وإغاثة تأخرت أكثر.. او بناء على تسويات وتفاهمات مع النظام، عبر وكيله اللبناني الشرعي ، حزب الله.
تقديرات العائدين من لبنان الى سوريا في الشهرين الماضيين، وتحديداً منذ ما قبل عيد الفطر الماضي، لافتة. هي لا تصل الى مستوى العودة من تركيا الى سوريا التي فاقت النصف مليون نازح ، لكنها تقترب منها . ليس ثمة أرقام نهائية بل ملاحظات ومشاهدات لمنظمات إغاثة دولية وأقليمية، لا تسقط من الحساب أن عبور الحدود الرسمية والمعابر غير الشرعية، في الاتجاهين لا يمكن ضبطه وإحصاؤه بدقة، لا سيما وأنه واحد من أكبر حركات النزوح والهجرة المسجلة بين بلدين مجاورين ليس بينهما علامات حدودية صارمة، وبين شعبين ليس بينهما فوارق إجتماعية خاصة.
الوضع الامني في سوريا يستقر في ما يزيد عن نسبة 40 بالمئة من مساحة سوريا حسب تقديرات المعارضة السورية نفسها. أما المساحات الخاضعة للمعارضين فانها تكاد تكون جحيماً لا يطاق، سواء من حيث المعارك والاشتباكات بين التنظيمات المتنافسة على الخوات والضرائب، او على البرامج السياسية_الدينية الخرافية التي لا تمت الى الواقع الشعبي السوري بصلة. وهنا لا بد من الاقرار بان عودة النازحين السوريين تتم الى مناطق النظام او الى المناطق المحايدة، أو النائية عن جبهات القتال.
لكن تلك العودة لا تبدو في معظمها أنها بالتفاهم او حتى بالتفاعل مع النظام، الذي يخطىء اللبنانيون خطأ فادحاً عندما يظنون أنه يتوق الى إستعادة النازحين، ويناديهم ليلا ونهارا من أجل الالتحاق بوطنهم وأرضهم ومسكنهم. التهجير كان ولا يزال مخططاً مدروساً ومحكماً، هدف الى إفراغ سوريا من بعض سكانها وتعديل الخلل الديموغرافي (والطائفي) بينهم، وإلقاء عبء الهجرة السورية على كل من “تآمر” على النظام، من لبنانيين وأتراك وأردنيين وأوروبيين وأميركيين ..
وهي مغالطة كبرى يقع فيها اللبنانيون الذين ينادون بالحوار الرسمي المباشر مع النظام في دمشق من أجل إعادة النازحين ، وهم في ذلك يتميزون عن بقية دول اللجوء السوري التي تدرك ان مثل هذا الحوار غير مجد وغير ذي شأن ، بل يمكن ان يجرد تلك الدول من الحدود الدنيا من معاييرها الانسانية والاخلاقية والسياسية طبعا، ويخضعها لإبتزاز النظام الذي يمكن ان يتهمها بأنها هي التي أغوت المهاجرين لترك مدنهم وقراهم وبيوتهم ، ويطلب منها تعويضات مالية عن كل مواطن سوري يسمح له بالعودة الى وطنه.
لعل الشارع اللبناني الذي يبادر اليوم بترجمة الحملة الرسمية على النازحين السوريين يدرك هذه الوقائع، ويشعر أن الوقت قد حان لمساعدة السلطة على الخروج من تلك المغالطات التي يروج لها عن تزايد عبء النزوح ومخاطره، او عن شغف النظام بإستعادة النازحين. وهو بذلك لا يضع البلد على حافة حرب أهلية ، على ما يشاع حالياً، لان النزوح لم يُثر (حتى الان على الاقل) العصبيات الطائفية او المذهبية اللبنانية الكامنة، لكنه يمكن أن يؤدي الى إضطراب أمني لبناني لا تحمد عقباه، والى توتر لبناني سوري لا تعرف ضوابطه.
المدن
الوطنية اللبنانية الجديدة/ رشا الأطرش
لبنان ليس مِصر. المصريون يؤلّهون الجيش. ولذلك أسباب تاريخية واقتصادية متشابكة ومعقدة، من أيام محمد علي باشا وتأسيسه الدولة المصرية حول محور المؤسسة العسكرية، والتي نُصّبت نقطة ارتكاز وأساس بالمعنى الاجتماعي والثقافي للمعاش اليومي والإدارة والاستثمارات. والجيش المصري اليوم يسيطر على ثلث الاقتصاد في أقل تقدير.
لبنان ليس مصر التي حكمها “البكباشي جمال عبدالناصر”، معززاً شوفينية عربية تُضمِر شوفينية مصرية. وعلاقة المجتمع المصري ذي الغالبية المذهبية المعروفة، ونخبته الحاكمة والانتلجنسيا من جهة، بالمؤسسة العسكرية من جهة ثانية، مركّبة ومعقّدة، بل و”أصيلة” إن جاز التعبير في وصف جذورها العميقة. علماً أن انقلاب 30 يونيو 2013، ودولته، فتحا عيوناً كثيرة على صورة أخرى للجيش من زاوية مختلفة تماماً، بعدما كان آخر أضغاثها وقفته المزعومة إلى جانب ثوار 25 يناير2011، مع الاعتراف بأن منتقدي الجيش المصري (ومحاكمه العسكرية وأجهزته الأمنية ورجال أعماله…) أقل بكثير من مُقدّسيه، سواء كان الأخيرون مدفوعين بالخوف والرهبة، أم بالمشاعر “الوطنية” والهوياتية المريضة.
لكن، مجدداً، لبنان ليس مصر. ومع ذلك، نراه يزايد على بَلوَتها القومية.
لبنان ذو النظام الطائفي، والمحاصصة الفئوية. لبنان الحرب الأهلية التي أدت إلى انقسام الجيش. ولبنان “الطائف” الذي وزّع الدولة ومنافعها على أمراء الحرب في مقابل “ضبضبة” مليشياتهم وأسلحتهم وقتلاهم ومفقوديهم، مُطلِقاً يد “حزب الله” وسلاحه، ومفوّضاً نظام حافظ الأسد كمُشرف – مثل “فتوّة” غليظ العصا نهِماً للخوَّات – على الانتظام اللبناني في سِلمِه الجديد وحياته السياسية المفتعلة وإعادة إعماره، وكل هذا في ظل استمرار “مقاومة إسرائيل”. لبنان الذي جعل جيشه ركناً في ثالوث مضحك مبكٍ اسمه “شعب، جيش، مقاومة”، مكرَّسٍ في أكثر من بيان وزاري حتى بعد تحرير الجنوب، في حين ما زال جيشه وقواه “السيادية” دون امتلاك حصرية العنف على كامل الأراضي اللبنانية. الجيش اللبناني الذي ما انفكت القوى السياسية-الطائفية، في سياق صراعاتها الأزلية على مرافق الدولة والنفوذ، تتولى التفاوض على ترقياته وتعييناته ومنصب قيادته، إضافة إلى تعويضات متقاعديه بل و”التوازن الطائفي” في طالبي الانتساب إليه.. هذا الجيش، كيف أصبح فجأة رمز المشاعر الوطنية والانتماء اللبناني؟ وأي انتماء؟ ولأي وطن؟
التأمل في الخطاب السياسي والخريطة الطائفية في لبنان اليوم يفضي إلى عدد من الملاحظات. أوّلها، صعود المشاعر اللبنانوية من قبو النفي، نفي الآخر. لكن الآخر اللبناني، بالنسبة إلى “العهد القوي” وأبواقه، صار حليفاً وشريكاً في الحكم. في صوغ الانتخابات وقانونها الضامن للمحاصصات عينها، وفي تقاسم الثروات والصفقات المنتظرة. إذن، فليكن البحث عن آخر أسهل. وهذا موجود، بطّة جالسة في مَرمانا: اللاجئ السوري. هو الآخر الذي أثمر الخطاب اليميني السائد، عالمياً ومحلياً، في جعل جسمه “لبّيساً” لكل الآفات الجُرمية والإرهابية، كما لتهمة العبء الاقتصادي والخطر الديموغرافي. هكذا، تجاوزت الوطنية اللبنانية الجديدة، عُقدة التفوق التقليدية المعروفة، لتقترب من الفاشية، ولتقول: أنا لبناني لأني لست سورياً، أعود قوياً ومرهوب الجانب بقدرتي الآن على كراهية السوري ورفضه بعلانية صلفة، وبحقّي في المساعدات التي تأتي باسمه. بتمكّني من أدوات تصفيته، سواء بتدبّر ترحيله إلى جلاده (الذي كان يوماً جلادي!) أو بتصفيته جسدياً ومعنوياً، بالضرب والإهانة ومنع التجول والتحقير. عبر البلديات وأجهزة الدولة، ومن منابر الإعلام الخاص والشبكات الاجتماعية.
حُشر اللاجئ الفلسطيني، ذات مرة، في زاوية مشابهة، لكن الصورة اليوم أبشع وأكثر وقاحة. فالفلسطيني كان مسلّحاً لفترة، وتورط في الحرب الأهلية، بل وكان له مؤيدون وداعمون، عسكرياً وإيديولوجياً، من بين الأطراف اللبنانية المتقاتلة، إلى أن انكسر وصار مستباحاً للمجازر والتهميش. أما النازح السوري اليوم فهو الحياة العارية، مكسَر العصا الأعزل من أوّله، فيما طيران النظام السوري يقصف أراضي لبنانية بحجة محاربة “الإرهاب”، بمباركة العهد وحلفائه.
ما عادت كافية للفهم والتفسير، حجج الذاكرة اللبنانية عن سوريا، وتجربة الاحتلال/الوصاية، والعلاقات مع ضباط استخبارات “البعث” الذين عاثوا في البلاد فساداً وقمعاً وتعذيباً في معتقلات خاصة.
مثلاً، الطرف المسيحي، أي “القوات اللبنانية”، الذي تعاطف، ذات مرة، مع الثورة السورية باعتبارها تشاركه عداءه للنظام الأسدي، التحق بالخطاب العوني الذي تبرأ بدوره من نضاله وحروبه مع الجيش السوري وطبّع مع نظام الأسد منذ عودة قائده من منفاه الفرنسي، وها هو يقود جوقة الكراهية والتحريض على النازحين السوريين – ضحايا حليفه. كأن “القوات” تريد القول إن التيار العوني ليس أكثر مسيحية مني، خصوصاً بعد التحالف الذي أوصل ميشال عون إلى سدّة الرئاسة، واليوم الانتخابات على الأبواب.
“تيار المستقبل” مستعد لكل شيء في مقابل عودة ميسّرة إلى رئاسة الحكومة، تعوّض خسائره المالية والجماهيرية والخدماتية المستقطبة للولاء الطائفي المحلي، إلى درجة “تضحيته” برمزيته الطائفية الإقليمية ممثلةً بتراجُع سعد الحريري عن تحفّظه على العملية العسكرية في عرسال.
“حركة أمل” كسرت صمتها الحيادي إزاء الحرب السورية، وأعلنت تأييد النظام.
حزب الله” على موقفه، مليشيا إيرانية تساند النظام في حربه على شعبه في سوريا، وطموحها طموح الفقيه وولايته.
الكل يريد أن يكون حسن نصرالله، قائد مليشيا أصبحت جيشاً بكل معنى الكلمة، يمون على قاعدته الشعبية إلى حدّ تجنيد القاصرين وأكثر من فتى وحيد لأهله، في حربه “الوجودية” خلف الحدود، بحُجّة تطويق التكفيريين واستباق الإرهاب. الخطاب اللبنانوي، شبه الموحّد اليوم، في العنصرية إزاء اللاجئ السوري والتحريض عليه، يصبو إلى استكمال “الوحدة” بالإنكار والنفي، وبعدوٍّ كامل الأوصاف في مذهبه وجنسيته وهشاشته. لطالما اعتبر المسيحيون اللبنانيون، وتحديداً العونيون، المؤسسةَ العسكريةَ ملعبهم الأثير. لعل التصارع الداخلي لم تنتفِ محفزاته، لكنه لم يعد ممكناً في الصيغة اللبنانية التوافقية الراهنة. لا بالهجوم على سعد الحريري (من يذكر “الإبراء المستحيل”؟ وخطاب “لن نعود أهل ذمة”؟)، ولا على نبيه بري ووليد جنبلاط وسائر الأقطاب الذين لن يسير مركب من دون أي منهم. لكن “الحرب” ما زالت قابلة للتفريغ في ملفات النازحين السوريين وأجسادهم.. تلك الكتلة البشرية التي كان الحليف الأبرز للعونيين، أي “حزب الله”، أحد أسباب نزوحهم من قراهم السورية، لا سيما في عرسال. الذات اللبنانوية الناهضة بعنف المضطهَد الذي صار مضهِداً، تتكئ الآن على تقديس الجيش. وإن كان لله حزبٌ، فلهولاء اللبنانويين الجيش الوطني. وإن كان لـ”البعث” السوري أبٌ خالد ورّث “سوريا الأسد” إلى ابنه بشار الذي تُسرّب فيديوهات شبيحته وهم يجبرون أسرى المعارضة على السجود لصورته وتقبيل جزمات عساكره في أثناء تلقيهم الشتائم والركلات، فإن لـ”بيّ الكل” (ووريثه الجاهز والمعروف) شبيحة يجبرون النازحين السوريين على عبادة الجيش اللبناني وقائده ورئيس الجمهورية الآتي أيضاً من المؤسسة العسكرية.
هؤلاء المعتدون اللبنانيون ليسوا بالضرورة مجنّدين رسميين لخدمة خطاب الكراهية المتفاقم. من الواضح أن بعضهم الكثير متطوّع من تلقائه، لتعميم خطاب الكراهية في الشارع والصالونات والمقاهي، ولإنتاج فيديوهات التعنيف، والقتال إلكترونياً في مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا الخطورة الأكبر.
لبنان ليس مِصر السيسي، ولا سوريا الأسد. لكنه يحسدهما فيتشبّه بهما، وهذا هو مَرضُه الوطني الجديد.
المدن
حروب العنصرية بين اللبنانيين والسوريين/ عمر قصقص
ارتفعت بشكل لافت، في الفترة الأخيرة، نسبة الأشخاص الذين يعبّرون عن آرائهم من خلال نشر تسجيلات خاصة بهم عبر صفحاتهم على “فيسبوك”، فأصبح إيصال الفكرة بالصوت والصورة أنجع وسيلة لاستقطاب العدد الأكبر من المشاركات والتعليقات إلى جانب ارتفاع نسبة المشاهدين.
ظاهرة الفيديوهات سلاح ذو حدين، لها إيجابياتها وسلبياتها، فالبعض يستخدمها ليُخرج كل ما في داخله من حقد وعنصرية وخرق لخصوصيات الناس، والبعض الآخر كي يوصل أفكاراً أو رسائل ذات معنى ولياقة.
وتجتاح الموقع الأزرق في لبنان منذ أيام فيديوهات مليئة بالحقد والعنصرية التي لم تهدأ حتى اللحظة بين اللبنانيين والسوريين، وذلك عقب تنفيذ الجيش اللبناني مداهمات في مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال على الحدود السورية اللبنانية، بحثاً عن إرهابيين، وقد أسفرت العملية عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص واعتقال العشرات وتعذيبهم، إذ انتشرت صور التعذيب والذل الذي تعرض له اللاجئون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تطلب استنفاراً إعلامياً وسياسياً أدى إلى الضغط على الجيش لفتح تحقيق في الموضوع.
بدأ الخلاف عندما خرجت مجموعة كبيرة من الناشطين لتبرير التعذيب عبر منصاتهم، داعين لـ”الضرب بيد من حديد وإبادة المخيمات”. كما بدأوا يخوّنون كل من يطالب بتحقيق شفاف، وذلك حفاظاً على حقوق الإنسان والجيش اللبناني سوياً. ورد شاب سوري يقطن في أوروبا، من خلال فيديو يهاجم فيه الشعب اللبناني، ويقول في الفيديو: “إن هجم الإسرائيلي عليكم سأقف مع الإسرائيلي، وستدور الأيام وسننزل إلى لبنان ولنريكم ماذا سنفعل بكم”، مضيفاً: “الرجال على الجبهات وليس بالاستقواء على الأبرياء، وللأسف في لبنان لا يوجد رجال”.
كما انتشر فيديو آخر لسيدة سورية كبيرة في السن، تهاجم رئيس الجمهورية والشعب اللبناني وجيشه، مذكّرةً بحرب تموز/ يوليو وكيف استقبل السوريون اللبنانيين ووزعوا عليهم الأكل والشرب والملابس مجاناً، شاجبة دخول حزب الله في الحرب السورية. وانتشرت عشرات الفيديوهات لناشطين سوريين يهاجمون لبنان وشعبه وجيشه بالطريقة نفسها.
هذا الهجوم، قابله هجوم مضاد من عشرات اللبنانيين الذين علقوا على الفيديو بالطريقة نفسها، معتبرين أن “الشعب اللبناني الذي حارب إسرائيل لا يخاف ولا يهرب، وأن من وقف مع لبنان في حرب تموز، نرد له الجميل الآن حين نقاتل معه على الجبهات التي هربتم منها إلى تركيا وأوروبا ولبنان، إلى جانب رد الشتيمة والعنصرية بالمثل”.
وانخرط في الحملة سياسيون وفنانون وإعلاميّون، ووصلت إلى تطبيقات الدردشة كـ”واتساب”، إذ انتشر تسجيل صوتي من أشخاص يدعون فيه اللبنانيين إلى ضرب أي سوري يمشي على الطريق بعد الساعة السابعة ليلاً، وذلك بعد أن انتشرت دعوة لتظاهرة تضامنية مع اللاجئين، الأمر الذي لم يتقبله البعض، محرضين بدعوة لتظاهرة “متضامنة مع الجيش اللبناني”، وسط تهديدات بالقتل والاعتداء على كل من ينزل إلى الشارع.
وفي آخر فصول الحملة العنصريّة، قام ثلاثة شبان في منطقة الدكوانة بضرب شاب سوري أعزل بعنف وسحله في الطريق موثقين اللحظة الهمجية بالفيديو. الشبان لم يكتفوا بالضرب، بل بدأوا بالتحقيق مع الشاب وتلفيق التهم له بأنه مع النظام السوري وداعش، وبأنه يريد التظاهر ضد الجيش اللبناني، كما أجبروه على قول: “الله ورئيس الجمهورية، الله والجيش اللبناني”.
وخلال ساعات، انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط غضب اللبنانيين من هذا الاعتداء الوحشي والعنصري ضد الأبرياء. وصباح أمس، ألقت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض على الشبان الثلاثة الذين اعتدوا على الشاب، وفق ما أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عبر “تويتر”.
كما أُنشأت صفحات على “فيسبوك” و”تويتر” لشن هجوم على أي شخص يطالب بتحقيق أو يهاجم الجيش، وهذا ما حصل مع الإعلاميتين ديما صادق وديانا مقلد والنائب عقاب صقر، الذين طالبوا بتحقيق فقط، إذ تنتشر كل يوم صورهم مرفقة بشتائم وتعابير مهينة، إلى جانب التهديدات بالقتل واتهامهم بـ”الدواعش”.
من جهة أخرى، تقدم المنتدى الاشتراكي، الأسبوع الماضي، بعلم وخبر لبلدية بيروت لتنظيم وقفة تضامنية مع اللاجئين/ات وضد العنصرية وضد القمع على خلفية أحداث عرسال، إلا أن الوقفة تحولت خلال ساعات بقدرة قادر في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة ضد الجيش اللبناني.
وذلك بعد أن بدأت العديد من الصفحات، أبرزها “اتحاد الشعب السوري في لبنان”، إلى دعوة السوريين في جميع المناطق اللبنانية لمظاهرة ضد الجيش اللبناني، الأمر الذي لم يتقبله اللبنانيون وبدأوا بالدعوة لمظاهرة مضادة وسط تهديدات بالقتل والاعتداء على كل من ينزل إلى الشارع.
هذا وتعرض أعضاء المنتدى الاشتراكي إلى تهديدات بالضرب والقتل بعد أن تسربت البيانات وأسماءهم إلى الإعلام من بلدية بيروت. فسارع المنتدى إلى إصدار بيان استنكار وتوضيح محملا المسؤولية إلى كل من سرب أسماءهم وحور أهداف الاعتصام الذي ألغاه.
يذكر أن هذا الانقسام يعود بهذه الحدة للمرة الثانية، وذلك بعد مداهمات مشابهة للجيش اللبناني حصلت في عرسال أيضاً عام 2014. وظهرت وقتها صور تعذيب اللاجئين السوريين، وحرق خيامهم وتخريب ممتلكاتهم الخاصة. يومها أيضاً انقسمت مواقع التواصل الاجتماعي، وفقد الإعلام اللبناني أي موضوعية ممكنة، فظهر بعض المذيعين بملابس الجيش اللبناني لتقديم نشرات الأخبار.
العربي الجديد
“إلى حضن الوطن” بالقوة/ مهند الحاج علي
ثمة عُنصر غير بريء يطفو بين فيديوهات ضرب السوريين وصنوف التصريحات والاعلانات العنصرية، وصفحة الفايسبوك “السورية” المشبوهة. حدّة هذه اللابراءة تزداد عند تأمل توقيت هذه الأحداث، وتقاطعاتها الإقليمية.
أولاً، تزامن هذا التوتر مع عملية اعادة مئات اللاجئين السوريين الى عسال الورد، وهي لم تتسم بالشفافية اللازمة، سيما للتأكد من رغبتهم في العودة وتحقق شروطها. هذه العودة كانت بمثابة جس نبض أو نموذج لعملية أوسع قد يشهدها ملف النازحين واللاجئين خلال الشهور المقبلة.
ثانياً، تشهد الساحة السورية تغيرات متسارعة، ميدانياً وسياسياً، سيما الاتفاق الأميركي-الروسي الأخير على تحديد مناطق وقف النار، ووقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب برنامج وكالة الاستخبارات المركزية لتدريب وتمويل وتسليح المعارضة السورية ”المعتدلة“. ورغم أن البرنامج لم ينعكس على الأرض السورية، سوى سلبٍ للملتحقين به، إلا أن الغاءه بمثابة مؤشر للسياسة الأميركية المرتقبة في سوريا.
وأخيراً، هناك سياق لبناني مُشابه الى حد كبير لما شهده الأردن العام الماضي. في لبنان، استهدف انتحاريون عناصر الجيش اللبناني خلال تنفيذ عملية دهم، لتليها اعتقالات واسعة، ووفاة 4 محتجزين تحت التعذيب. هذه الوفيات زعزعت أمن اللاجئين وسط انتشار لفيديوهات الاعتداءات، ودعوات لاعادة السوريين لبلادهم.
قبل عام في الأردن، تكرر السيناريو ذاته تقريباً. في حزيران عام 2016، تعرض موقع عسكري أردني في منطقة الركبان على الحدود الشمالية مع سوريا، الى اعتداء أوقع 6 قتلى و14 جريحاً وتبناه تنظيم داعش. كما اعتداء عرسال، وقع الهجوم في منطقة تضم عشرات آلاف اللاجئين السوريين العالقين على الحدود. في أعقابه، انشغلت وسائل اعلام محلية إما بتأييد تشدد الحكومة في استقبال مزيد من اللاجئين، سيما أولئك العالقين على الحدود، أو في الدعوة لاعادتهم. كما استُخدم الهجوم لتبرير عمليات ترحيل قسرية إلى سوريا، طالت في حلول شهر كانون الأول الماضي وحده ألف لاجئ سوري. هذا الرقم ارتفع الى 4100 في نيسان الماضي، بحسب مقابلات مع مسؤولين في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نشرها الباحث الايطالي فيليبو دونيغي على موقع معهد الشرق الأوسط. دونيغي لفت الى علاقة الغرب بما يحدث في الأردن، ولو بشكل غير مباشر، لأن الأخير بات يُبرر سياساته بتشدد اليمين الغربي خلال السنتين الماضيتين. على سبيل المثال، قاطع ملك الأردن صحافياً غربياً كان يسأل عن أخلاقية رفض اللاجئين العالقين على الحدود، وأجابه بأنه ”لو رغبت في اعتلاء منصة الأخلاق الرفيعة، بإمكاننا نقل اللاجئين الى بلادك من أقرب مطار أردني“. صمت الصحافي، وانتقل في أسئلته لموضوع آخر.
هذا السلوك الرسمي، والمسكوت عنه غربياً، ترافق مع كتابات اعلامية رأت في استعادة القوات السورية مدناً أساسية العام الماضي، علامة على تحول عودة اللاجئين ”هدفاً واقعياً“.
إلا أن هذه العجلة في إعادة اللاجئين على الجانبين الأردني واللبناني، تُخفي الثمن المُراد تسديده للنظام السوري، وعلى رأسه التطبيع السياسي مع الدولة المضيفة، بكافة أطيافها السياسية في الحالة اللبنانية. ومن الواضح أيضاً في النموذج اللبناني أن هناك محاولة لتعديل المزاج السائد في أوساط اللاجئين السوريين من خلال دفعهم لتأييد النظام بصفته حامياً لهم. وبالإمكان رصد هذه المحاولات عبر بيان السفارة السورية في لبنان، وأيضاً الصور المُستعادة لحافظ الأسد وشعارات الترحم عليه بصفته ”عرف“ كيف يقمع اللبنانيين. مثل هذا الإخراج، لو نجح، مفيد لاعادة تعويم بشار الأسد دولياً، وقد يكون مُقدمة لعمليات ترحيل مماثلة من دول أوروبية غير بعيدة عمّا يحصل في منطقتنا.
المدن
اصفع سورياً تدخل الجنة/ دانيال غريب
اقبض عليه متبلساً بضعفه وغربته وقلة حيلته. اقبض عليه متلبساً بخوفه على أطفاله وعجزه عن الفرار بهم من هذا البلد الآسن. اقبض عليه متلبساً بوحدته وكن كثراً، فليس من شيمك الشجاعة. اقبض عليه متلبساً بالليل فليس من شيمك الوضوح، واصفعه على وجهه، تدخل الجنة.
أنت بحاجة إلى هذا الجسد المتروك النحيل لتنفس فيه حقدك، فاصفع ما استطعت. أنت بحاجة لأن تتشظى عنفاً، فانفجر في هذا المقطوع السبيل. انفجر فيه. تفجر. بدد على جلده غضب عقود من كرهك لنفسك وجارك وحيك ومدرسة ابنك وابنتك ومختار محلتك وطبيبك ومشفاك ودكانك ورب عملك وفاتورة كهربائك وزعيم طائفتك وزعيم طائفة عدوك وبلدك الملتبس عليك هوية وانتماء وأرزة وعلماً وتمييزاً وعنصرية.
فجر فيه كل ما يعتمل في صدرك من أسئلة عن النهاية المبهمة لحربك الأهلية التي وحدتك وخصمك في الهزيمة. فجر فيه كل خوفك من حاضرك ومن مستقبلك. فجر فيه روحك التي تراها رخيصة وبلا وزن ومعنى. انتقم منه ما دمت عاجزاً عن الانتقام من واقعك الجبار اللئيم، الذي يسحقك بلا رحمة، الذي يعاملك كصرصار. اصفع. اصفع. وهذه شتيمتك تخترق عينيه كسهم من نار لتتشفى من دكتاتور خالد ميت ساوى بينكما في الظلم حتى صرتما، لبنانياً وسورياً، ضحية واحدة في بلدين. اضرب ضحيته تنتقم منه حيث هو في عدمه. اضرب ضحيته ليضحك في قبره.
اصفع، وسيحفر التاريخ على صخور نهر الكلب صفعتك. أنت اللبناني، أنت الحرف وأنت المثل وأنت المثال. اللبناني النموذج. البطل الذي يتلطى بالعتمة لكي لا يُرى له وجه. المقاوم الذي يستعين بالجماعة لكي يستفرد بفريسة وينهشها. اللبناني المبدع الذي له أخلاق الضباع. اصفعه. لن تكون مشاعره أغلى عليك من مشاعر أبناء جلدتك الذين يموتون كل يوم برصاص الابتهاج الطائش والعنف الذي يكمن عند مفارق الطرق وفي غرف النوم وفي أروقة المستشفيات. اصفعه وتخيل أنه اللبناني الآخر يسدد لك ديناً عليه وقد تأخر عن موعده أكثر من سبعة وعشرين سنة. جدد فيه حربك وادع أنك تحرس أرزتك وعرضك وطائفتك. اسحقه ما دمت قادراً على سحقه. أذله ما استطعت ولن يجيد، تحت وقع قبضتك أن يصرخ فيك هيهات منا الذلة. فهو وإن كان يعرف الهتاف فلن يستطيعه بعدما رميت عليه من جديد كل أسباب فراره من بلده.
اصفعه، لست أول من صفع ضعيفاً، ولن تكون الأخير. اصفعه تدخل جنة العنصرية بطلاً من هذا الزمان. اصفعه واهبط إلى حضيضك، ولست وحيداً في هذا الحضيض. معك يذهب بلد برمته. اقتحم عراءه بعرائك وعرِّ لبنان من النفاق والتكاذب والدجل. كن كما أنت وحشاً كاسراً في البرية، ولكن كما هو، فريسة مستسلمة طرية العنق. انزع هذه الغلالة الرقيقة من التحضر عن هذا البلد واكشف عن أصله الغابة. عن أصله المستنقع. عن أصله الوحل.
اصفع سورياً تدخل الجنة. اشتمه واكسره نصفين واصلبه واقطع رأسه، واركله على خده الأيمن ولن يكون له إلا أن يدير لك الأيسر لتركله عليه. هو مسيحك يحمل عنك خطاياك، هو حسينك ينتصر بدمه على سيفك. هو أنت في المرآة فانتقم من مرآتك. اصفعها. حطمها كي لا ترى فيها وجه يهوذا ولا ترى وجه الشمر اللعين. حطمها كي لا ترى وجهك.
المدن
ترويج الذات العصرية.. بالعنصرية/ روجيه عوطة
تخوض السلطة السياسية لعبة النظام: أن يدور الخطاب اللاعنصري تحت مظلتها
قال المجرم، الذي قاد وصوّر الاعتداء على اللاجئ السوري، لأصحابه: “تفضلوا، شباب…شباب، من بحب يجي؟”، فبدا أنه يدعوهم الى مائدة طعام بارد في مساء حار. فكرهه للسوريين، وللاجئين، وللاجئين السوريين – والتقسيم والتركيب ههنا مقصودان – هي فعل من أفعال الترويح عن النفس بضرب وخبط الشاب الأعزل، وكَيل الشتائم له. بالتالي، من الضروري أن ننتبه الى أن ممارسة العنصرية في هذا المطاف ترادف التسلية. وهي، حين تصير على هذه الحال، حين تصير مساوية لحفلة شواء، أو لنزهة، أو لمشاهدة فيلم، فهذا يعني، بادئ ذي بدء، أنها أضحت مكرسة، وهذا ما يخولها أن تكون الأفق المقبل. إلا أن العنصرية، بما هي تسلية، ولكي تكون الحالة المقبلة للمجتمع الذي سيستهلكها، ولكي تظهر من جوفه على سطحه، وترسم سماءه، عليها أن تتصل بمساره، بنظامه، الذي قد تصح تسميته بالعصري. فالعنصرية الآن هي السبيل الى العصرية، التي تقوم بالتفتيش الدائم عن السلوى، لكنها، وأيضاً، تقوم بالتفتيش الدائم عن الشهرة.
فحين يذهب هؤلاء النجوم، الذين يتخرجون من مصنع الفن الواسع في لبنان، الى نشر حقدهم على اللاجئين السوريين، فهم يفعلون ذلك بغاية مضاعفة رواجهم. اذ يعلمون، وهم ذروة الشخصية الميديوية، أن عليهم أن يمضوا الى “تفجير قنبلة”، تكون هي الواقعة، كما حين يصدرون ألبوماً، أو متعلقة بواقعة، كما حين يصدرون موقفاً حيال موضوع ما. وعلى هذه “القنبلة”، ومن شدة دويها، أن تحولهم الى محط أنظار. يعلم هؤلاء أنهم، ولكي يبلغوا المزيد من الرواج، يتوجب عليهم، ومن حين الى آخر، أن يرموا “القنبلة”، التي امتلأت منذ أيام بالكره، ويعلمون أيضاً أن النظام الذي ينتجهم قد ينتج غيرهم، وقد لا يكونون عندها على علاقة بمجال الغناء، لكن يكفي أن يتنافسوا معهم على حجم وشكل وأثر “القنبلة” المرمية، ليزاحموهم على صعيد الرواج.
فالنظام العصري، الذي يستقر قانونه على حق أيٍّ كان في الشهرة، يدفع ساكنيه الى تفجير “قنابلهم” أكثر فأكثر لكي يتحولوا الى نجومٍ. وفي هذه الجهة، لا بد من الإشارة الى أن تصوير ذلك المجرم لإعتدائه على اللاجئ السوري بكاميرا هاتفه، وتسجيل عنفه كفيديو، يندرج في هذا السياق، أي سياق “الحق في الشهرة”، في سياق رغبته في تحوله الى نجم، لا يغني كرهه، بل ينفذه، قبل ان تنتقل صورته الى “الكل”، فيصير محط أنظار. فهذا المجرم العصري، لا يجد في العنصرية سبيل سلواه فحسب، بل سبيل رواجه أيضاً.
حسناً، اذا أردنا الاختصار في التعبير عن النظام العصري، عطفاً على قيامه بتقديس السلوى والشهرة، تقديس الترويح والرواج، من الممكن القول أنه نظام ترويج الذات، التي تبغي أن تكون محط أنظار، ولذلك قد تعمد الى الانتحار. لكنها، قبل هذا، قد تعمد الى نحر غيرها، تماماً مثلما هو الوضع في حين ممارستها لعنصريتها. على أن هذا النظام هو نظام السلطة السياسية أيضاً، بحيث أنه يحملها على ضخ الكره ضد اللاجئين السوريين، ولاحقاً، على استنكار هذا الكره. فمن جهة، وفّرت السلطة، وعلى اساس ذلك النظام، سلواها وسلوى جمهورها بنشر الحقد، “لنتسلى، لتتسلوا بكرههم”. وهذا يذكر بعبارة جبران باسيل “وينا كارولين؟”.. أي، وبحسب منطقه الذَكَري، “أين اللهوة؟”. ومن جهة اخرى، حققت رواجها بالتنديد بحقدها اياه.
فتخوض السلطة السياسية لعبة هذا النظام، موزعةً موقفين متناقضين على سبيل واحد: نشر الكره بهدف السلوى، والتنديد به بهدف الرواج. والإثنان لتروّج ذاتها، وأيضاً لتضمن شيئاً محدداً، وقد نجحت في هذا: أن يدور الخطاب اللاعنصري كله تحت مظلتها. فلا يهم هذه السلطة، وهي أقوى لاعبي ذلك النظام، أن تكون، مرةً عنصرية، ومرةً لاعنصرية، ما دامت تعرف، وهذا ما تتقدم عليه مقارنةً مع جمهورها، أنها في الحالتين تحقق ما تريد، أو أقل ما تريد، أي تحقق ترويجها لذاتها العصرية.
على هذا النحو، يتيح النظام العصري، ومن خلال ما بيّنته السلطة السياسية، ترويج الذات بالجمع بين نقيضين، بين العنصرية واللاعنصرية، بحيث أن خطاب الثانية، كخطاب الأولى، يصبح سبيلاً الى السلوى والشهرة أيضاً، وهذا ما يودي الى تعطيله، وجعله خالي الوفاض. ذلك، أن ذلك النظام، أو ذاته تحديداً، التي تبغي التسلية والرواج، تبغي الترويج، والتي يشكل كرهها للمختلف عنها مدماكها الأساس. قد لا تكون عنصرية هنا، على شاشة الاعلام، مثلاً، لكنها، وفي لحظة قصوى، في لحظة حدوثية على وجه الدقة، ستكون عنصرية هناك، على شاشة الاجتماع مثلاً، والعكس صحيح أيضاً.
بعد ذلك، ومن أجل مقاومة العنصرية فعلاً، لا بد من إعادة خلق خطاب مواجه لها، لا يكون، بدايةً، من انتاج معامل النظام العصري، بل يعارضها. أي لا تكون عنصريته مؤجلة الظهور لأنه يتستر عليها، ولا تكون بغيته الكامنة، والمحورية، هي الترويج لذاته. فمقاومة العنصرية هي مقاومة للعصرية، باعتبارها ترويجاً للذات عبر الإفراط في الكره، وعبر الإفراط في إستنكاره، تماماً على طريقة السلطة، أي عبر استدخال إنكاره: “أستنكر العنصرية لأنكر أنني لست عنصرياً فقط، لكي أصون ذاتي، لكي أحافظ على صورتي فقط”.
فقد كان من الممكن لذلك المجرم أن ينقلب الى ملاك لو أنه دعا رفاقه الى مساعدة اللاجئ السوري بدلاً من الاعتداء عليه. لكن هذا لن يبدد أنه سيبقى، بفعل التصوير والنشر، مجرد مروج لذاته، من خلال الشر أو الخير، لا يهم، ما دام الاثنان، للأسف، لا يزيلان هذه الحقيقة: اللاجئون السوريون في الخارج، هناك من لا يتحملهم فينفيهم، وهناك، من لا يتحملهم سوى عبر جعلهم مماثلين له. وفي المقلبين، تدور آلة ترويج الذات، ولا أحد في الواقع يهتم لمصيرهم.
فأن نكون ونصير سوريين الآن يعني ألا نسلّم بأي خطاب تصوري تنتجه عنّا ولنا، تلك الآلة ونظامها العصري، لأنه في لحظة ما سيتكشف عن كونه مصنوعاً ضدنا، عن كونه عنصرياً.
المدن
بيان لبناني ضد ممارسات عنصرية تطال مدنيين سوريين
الجيش ينبغي أن يكون الطرف الوحيد المسلّح في هذا البلد
وقع 260 مواطناً لبنانياً، من المثقفين والفنانين والكتّاب والصحافيين والأكاديميين والناشطين، بياناً ضد الممارسات العنصرية التي تطال المدنيين السوريين المقيمين في لبنان. هنا نصه:
نحن الموقّعين أدناه، ناشطين وكتّاباً ومثقّفين وصحافيّين وفنّانين لبنانيّين، ومن موقع إيماننا بلبنان وطناً للحريّة والتعدّد واحترام حقوق الإنسان، وبأنّ الجيش ينبغي أن يكون الطرف الوحيد المسلّح في هذا البلد، نعلن رفضنا القاطع واستنكارنا العميق لبعض الممارسات المقزّزة بحقّ المدنيّين السوريّين الذين اضطرّتهم مأساتهم إلى اللجوء إلى بلدنا.
إنّ ما يرافق هذه الممارسات من حملات تحريض على السوريّين، على وسائل التواصل الاجتماعيّ وفي بعض الصحف وشاشات التلفزيون، أو على ألسنة بعض السياسيّين، لا يقلّ بشاعة عن الممارسات الإجراميّة نفسها. وهذه مثل تلك لا تسيء إلى السوريّين الأبرياء فحسب، بل تسيء أوّلاً وأخيراً إلى صورة لبنان كما تنتقص من ضمائر اللبنانيّين.
فما يجري على هذا الصعيد لا يمثّلنا بتاتاً، بل يواجهنا بخيارات حادّة يتعلّق بعضها بتنظيف وطنيّتنا من شوفينيّتها، وبجعل الموقف من اللاجئين أحد معايير هذه الوطنيّة التي نريدها صنواً للديمقراطيّة وحقوق الإنسان.
وهنا لائحة الموقعين (حسب الترتيب الأبجدي):
إبراهيم نصار (خبير تخمين محلف لدى المحاكم والمصارف)، أحمد إسماعيل (ناشط)، أحمد سويسي (باحث)، أحمد عيساوي (طالب دكتوراه بفرنسا)، أحمد قعبور (فنان)، أحمد فيصل سنكري (استاذ جامعي)، أحمد مراد (صحافي)، أسامة وهبي (أستاذ ثانوي)، اسماعيل شرف الدين (ناشط اجتماعي مدني)، أكرم زعتري (فنان)، أكرم عراوي (مهندس)، أكرم محمود محمود (ناشط)، ألكسندرا حبيب (ناشطة اجتماعية مسكونية)، ألكساندر بوليكيفيتش (راقص ومصمم رقص)، الياس بجاني (ناشط لبناني اغترابي)، الياس خوري (كاتب)، الياس فوز (مهندس وناشط سياسي)، ألين ميلاد الشامي (ممثلة)، أمل طقوش (سكرتيرة تنفيذية)، أنديرا مطر (صحافية)، أنطوان أبو زيد (كاتب وأستاذ جامعي)، أنطوان حداد (أستاذ جامعي)، أنطوان قربان (باحث وأستاذ جامعي)، آيا النابلسي (منتجة)، إيلي الحاج (صحافي)، إيمان حميدان (كاتبة)، أيمن نحلة (فنان تشكيلي).
بشار حيدر (أستاذ جامعي)، بشار زياد الحلبي (ناشط حقوقي)، بشارة شربل (صحافي)، بشارة عطالله (فنان)، بول طبر (أستاذ جامعي)، بشير عصمت (أستاذ جامعي)، بطرس معوض (ناشط بيئي)، بكر صلح (استاذ ثانوي)، بيسان الشيخ (صحافية).
تيمور بريش (مُحاسب)، ثائر غندور (صحافي).
جاد يتيم (صحافي)، جاكلين سعد (كاتبة وصحافية)، جان- بيار فرنجيه (محام)، جمال العاصي (ناشط مدني)، جميل حمود (عميد كلية جامعية)، جورج مسوح (أستاذ جامعي)، جوزيف بدوي (صحافي)، جيزيل خوري (إعلامية).
حازم الأمين (كاتب وصحافي)، حازم صاغية (كاتب وصحافي)، حبيب بزيع (ناشط)، حبيب نصّار (ناشط حقوقي)، حبيبة درويش (ناشطة مدنية)، حسام عيتاني (كاتب وصحافي)، حسان حمود (طبيب)، حنا صالح (صحافي)، حسن شامي (صحافي)، حسن قطب (صحافي)، حسن كريّم (أستاذ جامعي).
خالد حسين الحجيري (مهندس)، خالد صبيح (فنان)، خالد عزي (استاذ جامعي وصحافي)، خالد ياسين (ناشط سياسي).
داليا عبيد (باحثة)، دانا كحيل (إعلامية)، دلال البزري (كاتبة)، ديانا مقلد (صحافية وإعلامية)، ديالا حيدر (باحثة وناشطة)، ديما الشريف (صحافية)، ديما كريّم (باحثة).
رائد أبو شقرا (صحافي وأستاذ جامعي)، راشد فايد (كاتب صحافي)، رانيا الجارودي (ربة منزل)، رشا الأطرش (كاتبة وصحافية)، رشا الأمير (روائية)، رفيف فتوح (كاتبة)، رلى موفق (صحافية)، رنا عيد (مهندسة صوت)، رنا نجار (صحافية)، روني الأسعد (ناشط في مجال حقوق الانسان والتنمية)، ريان ماجد (صحافية)، ريما ماجد (استاذة جامعية)، ريم الجندي (فنانة تشكيلية)، ريما نخل (فنانة تشكيلية)، رضا المولى (استشاري مالي واقتصادي)، روان حلاوي (ممثلة)، رائد بوحمدان (ناشط مدني)، رينيه معوض (مهندس)، ربى بيضون (باحثة اجتماعية)، ردينا بعلبكي (صحافية).
زكي طه (ناشط سياسي ونقابي)، زهية صفا (ناشطة اجتماعية)، زياد ماجد (أستاذ جامعي)، زياد عبد الصمد (مدير الشبكة العربية للمنظمات الأهلية غير الحكومية)، زياد عنتر (فنان)، زينة منصور (صحافية وأكاديمية).
طارق تميم (ممثل)، طارق سكرية (عميد الركن المتقاعد)، طارق حوا (رجل أعمال)، طلال خوري (مصور سينمائي)، طلال طعمة (صحافي وأستاذ جامعي)، طوني شكر (فنان معاصر)، طوني فرنسيس (صحافي).
سارة شاهين (أستاذة ثانوي)، سالم معربوني (أستاذ جامعي في بريطانيا)، سامر دبليز (منسق لقاء الصوت المدني)، سعد فاعور (باحث وإعلامي)، سعود المولى (باحث وأستاذ جامعي)، سمر مغربل (فنانة تشكيلية)، سمعان خوام (فنان تشكيلي)، سمير زعاطيطي (أستاذ جامعي متقاعد)، سمير علوان (ناشط مدني)، سناء سلهب (أستاذة ثانوي)، سهام حرب (أستاذة جامعية)، سهيل ناصر (إعلامي)، سوسن أبو ظهر (صحافية)، سيليا حماده (شاعرة).
شادي هنوش (ناشط اجتماعي)، شارل شهوان (كاتب وشاعر)، شذا شرف الدين (فنانة وكاتبة)، شيرين أبو شقرا (باحثة وسينمائية).
صبحي أمهز (صحافي)، صبحي مهدي عبد الله (ناشط مدني)، صهيب جوهر (صحافي).
عباس ابو زيد (ناشط اجتماعي)، عباس جوهري (ناشط اجتماعي وسياسي)، عباس ناصر (مدير التلفزيون العربي)، عبد الرحمن أياس (صحافي)، عبد الغني العماد (أستاذ جامعي وعميد)، عبدالله حداد (مهندس)، عبد المطلب بكري (رجل أعمال مغترب)، عبد الناصر سكريه (طبيب)، عبد كريدية (ناشط سياسي)، عبدالوهاب بدرخان (صحافي)، عدنان سلامة (رجل أعمال وناشط في الجالية العربية الأميركية)، عزة شرارة بيضون (أستاذة جامعية)، عقل العويط (شاعر وصحافي)، علي أحمد رباح (صحافي)، علي الحاج سليمان (ناشط سياسي)، علي السيد (ناشط سياسي)، علي المرعبي (باحث)، عليا حاجو (مصورة صحافية)، علي حموره (طبيب)، علي زراقط (مخرج سينمائي)، علي شرف الدين (صحافي)، علي طي (خبير في الشؤون الدولية)، علي شعيب (أستاذ جامعي في كندا)، علي عزالدين (طبيب جراح)، علي محمد حسن الأمين (صحافي)، علي مراد (أستاذ جامعي)، علي مكي (مدرّس)، عماد الديراني (ناشط)، عماد الشدياق (صحافي)،عماد فتوح (ناشط سياسي واجتماعي)، عماد قميحة (صحافي)، عمر حرقوص (صحافي).
غادة عريبي (ناشطة)، غيتا ضاهر (طبيبة).
فادي الطفيلي (كاتب ومترجم وصحافي)، فادي توفيق (كاتب)، فادي ملحم (مترجم)، فارس خشان (كاتب وصحافي)، فاروق يعقوب (ناشط اجتماعي)، فاطمة حوحو (صحافية)، فاطمة مرتضى (استاذة جامعية وفنانة تشكيلية)، فراس أبو حاطوم (ناشط سياسي)، فضيل حمود (طبيب)، فؤاد المقدم (كاتب سياسي وناشط)، فؤاد سلامة (طبيب)، فوزي ذبيان (كاتب)، فوزي فري (استاذ جامعي وناشط مدني)، فوزي يمين (شاعر وأستاذ جامعي).
قاسم قصير (باحث وصحافي)، قصيّ شرارة (شاعر).
كمال عزيز ناصيف (محام)، كريستال خضر (مخرجة مسرح).
لقمان سليم (ناشر وكاتب)، لوما رباح (فنانة تشكيلية)، لونا صفوان (صحافية)، ليال مصري جندي (ناشطة)، ليليان دَاوُدَ (إعلامية)، لينا سحاب (ممثلة).
مارك ضو (أستاذ جامعي)، ماريا جورج خيسي (ممثلة)، ماهر أبو شقرا (باحث)، ماهر عيتاني (ناشط)، مايا خضرا (طالبة دكتوراه في باريس)، مايا فيداوي (فنانة تشكيلية)، مايك عياش (عمل حر)، محسن حسين (طبيب)، مصطفى أحمد (ناشط سياسي)، مصطفى الترك (ناشط سياسي)، مصطفى فحص (صحافي)، محمد أحمد شومان (باحث علمي ومترجم)، محمد الحجيري (كاتب وصحافي)، محمد العزير (صحافي ومترجم في أميركا)، محمد أنور بعاصيري (طبيب)، محمد بدوي (مهندس)، محمد شامي (مهندس)، محمد شبارو (صحافي)، محمد عواضة (ناشط مدني)، محمد مكاوي (اعلامي)، محمد ميقاتي (ناشط)، محمد حمود (صحافي)، محمود سويد (كاتب)، محمود ضحى (صحافي)، محمد قاسم (مهندس مدني)، مروان أبي سمرا (باحث)، مروان جورج النجار (كاتب مسرحي وتلفزيوني)، مسعود يونس (باحث وناشر)، معتز فخرالدين (ناشط سياسي)، مكرم رباح (باحث وأستاذ جامعي)، منار وهبة (منتجة)، منال نحاس (صحافية)، منى جهمي (أستاذة ثانوي)، منى خويس (كاتبة)، منى فياض (كاتبة)، مهند الحاج علي (صحافي وأستاذ جامعي)، مهى البيداوي (موظفة)، مهى عون (صحافية)، مونيكا بورغمان سليم (مخرجة سينمائية)، ميريلا سلامة (فنانة تشكيلية)، ميشال حاجي جورجيو (صحافي وناشط سياسي)، ميشال دويهي (استاذ جامعي)، ميسم هندي (فنانة تشكيلية)، ميموزا العراوي (صحافية وفنانة تشكيلية).
نادر فوز (صحافي)، نافع سعد (ناشط سياسي)، نادين لبكي (مخرجة سينمائية)، نادين فرغل (محامية)، ناهد يوسف (اعلامية)، نبيل الحلبي (محام، مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الانسان – لايـف)، نبيل اسماعيل (مصوّر صحافي)، نبيل عبد الفتاح (صحافي وباحث)، ندى عبد الصمد (صحافية)، نديم حوري (كاتب وباحث)، نديم قطيش (إعلامي)، نعمه محفوض (نقيب سابق للمعلمين)، نوال مدللي (رئيسة جمعية سوا للتنمية)، نور بلوق (فنانة تشكيلية).
هاني منقاره (ناشط اجتماعي)، هاشم عدنان (مسرحي وناشط سياسي)، هدى الحسيني فايد (صحافية)، هدى شهاب الدين (أستاذة ثانوي)، هشام بو ناصيف (أستاذ جامعي)، هشام زين الدين (استاذ جامعي ومؤلف ومخرج مسرحي)، هناء جابر (باحثة رئيسية في مبادرة الإصلاح العربي، باريس)، هند درويش (صحافية)، هوفيك حبشيان (صحافي)، هيام حلاوي (أستاذة ثانوي)، هيثم شمص (مخرج سينمائي وأستاذ جامعي)، هيثم هلال (مهندس).
واصف خلف (طبيب)، وديع مزرعاني (طبيب أسنان)، وسام سعادة (صحافي وأستاذ جامعي)، وليد حسين (باحث)، وليد فخر الدين (استاذ جامعي).
يقظان التقي (إعلامي وأستاذ جامعي)، يورغي تيروز (ناشط سياسي)، يوسف الخليل (اقتصادي واستاذ جامعي)، يوسف بزي (كاتب وصحافي)، يولا الحاج (صحافية).
حقارة الاعتداء على سوري في لبنان/ خيرالله خيرالله
حقارة ليس بعدها حقارة أن يعتدي لبنانيون مسيحيون على لاجئ سوري أعزل وجد نفسه في الأراضي اللبنانية لسبب في غاية البساطة هو أن هناك نظاما سوريا، يشنّ حربا على شعبه.
لعلّ أحسن ما فعلته الدولة اللبنانية هو القبض على الذين نفـذوا الاعتداء. أظهر وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه لا تـزال هناك بقايا دولة ومؤسسات في لبنان. بقايا دولة ومؤسسات، تحمي اللبنانيين، خصوصا المسيحيين. تحميهم من أنفسهم أولا.
يكشف الفيديو الذي يظهر فيه شبّان لبنانيون يوجهون شتائم ولكمات إلى شاب سوري بحجة أنه لا يحمل أوراقا غيابا لأيّ نضج لدى قسم لا بأس به من مسيحيي لبنان. هؤلاء يتعاملون بعنصرية مع السوريين رافضين أن يتعلموا شيئا من تجارب الماضي القريب، وهي تجارب أخذت مسيحيي لبنان من كارثة إلى أخرى.
ما لم يستطع قسم من اللبنانيين المسيحيين، وليس جميع المسيحيين، فهمه في أيّ وقت طوال الحرب الأهلية وحروب الآخرين على أرض لبنان، أن كل ما قاموا به كان يخدم النظام السوري.
هذا النظام هو الذي جعل هذا الشاب السوري ينتقل إلى لبنان. كان هم بشار الأسد، ولا يزال، التخلص من أكبر عدد من السوريين بدعم إيراني واضح. يخوض رئيس النظام السوري حربه على سوريا والسوريين تحت عنوان واحد هو التغيير الديموغرافي والتخلّص من أكبر عدد من السنّة في سوريا.
هناك حاجة، اليوم قبل الغد، إلى صوت مسيحي عاقل يقول بالفم الملآن أن من يعتدي على مواطن سوري في لبنان لا يعتدي على لبنان فحسب، بل إنه يعرض مستقبل البلد لأخطار كبيرة
طوال الحرب اللبنانية، كان النظام السوري يدفع في اتجاه تكريس الشرخ بين اللبنانيين أنفسهم، بين المسلم والمسيحي، وبين اللبناني والفلسطيني. كان يسلّح الميليشيات المسيحية اللبنانية، مثلما كان يسلّح الفصائل الفلسطينية، كي تعتدي عناصرها على اللبنانيين.
عندما كان الخطف على الهوية يتوقف، كان النظام السوري عبر مسلحين تابعين له من منظمة “الصاعقة” وغيرها يلجأ إلى قتل مسيحي هنا ومسلم هناك، كي تكون هناك جولة أخرى من القتال وصولا إلى اليوم الذي استطاع فيه تحقق هدفه. كان هدفه وضع اليد على لبنان. كان هدفه أيضا وضع اليد على الفلسطينيين في لبنان.
مؤسف أن ياسر عرفات، الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، لم يدرك أبعاد هذه اللعبة. على العكس من ذلك، انخرط فيها من حيث يدري أو لا يدري. كانت تحرّكه ينطلق في كلّ وقت من عقدة السيطرة على أرض ما في مكان ما، بغض النظر عن الثمن الذي يمكن أن يدفعه آخرون، بما في ذلك لبنان واللبنانيون، من أجل الوصول إلى هذا الهدف.
من يتمعن في الفيديو، الذي يظهر فيه الشاب السوري يتعرّض لاعتداء، يكتشف أوّل ما يكتشف روحا عنصرية تنمّ عـن سقوط لمجتمع بكامله تقريبا.
الأهمّ من ذلك، أن هذا الفيديو يكشف كم أن قسما من المسيحيين يرفض أن يتعلّم. يرفض هذا القسم من المسيحيين أن يفهم أن الجيش اللبناني ليس في حاجة إلى دعم من هذا النوع الرخيص. كل ما على الجيش عمله هو تأدية المهمة المطلوب منه تأديتها على الصعيد الوطني، وتفادي ارتكاب أخطاء من نوع التسبب في وفاة مواطنين سوريين كانوا محتجزين لديه.
لا يوجد لبناني يشكّك في وطنية الجيش وفي المهمة التي يقوم بها على الصعيد الوطني. لكن هذا شيء والاعتداء على شاب سوري، لا حول له ولا قوّة، بحجة الدفاع عن الجيش يظل شيئا آخر.
ليس مسموحا أن تقف القيادات المسيحية مكتوفة أمام بعض التصرفات الحمقاء التي تسيء إلى المسيحيين أوّلا. فمن اعتدى على السوري، لم يفهم يوما أنّ الغباء المسيحي الذي لا حدود له أوصل النظام السوري إلى السيطرة في العام 1990 على قصر بعبدا ووزارة الدفاع اللبنانية في اليرزة. كان سقوط القصر الجمهوري في بعبدا ووزارة الدفاع نقطة تحول على صعيد التأسيس لمرحلة الوصاية السورية على كل لبنان، وذلك بعدما كانت هذه الوصاية مقتصرة على مناطق معينة منذ دخول القوات السورية إلى الأراضي اللبنانية في العام 1976.
لعل أسوأ ما في الأمر، أن المسيحيين في لبنان، والكلام ليس عن كل المسيحيين طبعا، لم يطرحوا على نفسهم سؤالا في غاية البساطة فحواه لماذا صاروا أقلية، ولماذا صار عليهم أن يكونوا تابعين لـ“حزب الله”، الشريك في الحرب على الشعب السوري، كي يثبتوا أنّه لا تزال لديهم كلمة في القرار اللبناني.
ثمّة حاجة إلى بعض من بعد النظر لدى بعض المسيحيين اللبنانيين. من بين ما يفترض أن يفكّر فيه هؤلاء ما الذي يمكن أن يجنوه من معاداة النازح السوري؟ هل يخدم الاعتداء على شاب سوري، بحجة الدفاع عن الجيش اللبناني، القضيّة اللبنانية بأيّ شكل؟
ليس في الإمكان تجاهل أن هناك تجربة مرّة للمسيحيين في لبنان مع المسلحين الفلسطينيين الذين استباحوا كل المحرمات قبل العام 1982.
ولكن، ما لا مفر من الاعتراف به أن خوض حروب مع الفلسطينيين، من دون إجماع وطني على ذلك، عاد بالويلات على المسيحيين وجعلهم في الـوقت الراهن يعانون من عقدة الأقلّيات التي في حاجة إلى حماية.
لعب “حزب الله”، العدو الأول للفكرة اللبنانية، الدور المطلوب منه في مجال توفير “الحماية” للمسيحيين، مستفيدا قبل كلّ شيء من فراغ في العقل السياسي المسيحي، ومن عجز مسيحي عن فهم ما يدور في المنطقة.
لا شك، مرة أخرى، أن ليس في الإمكان التعميم، ولكن لا بد من أصوات مسيحية تقول كلمة حق بعيدا عن الكلام الفارغ من نوع أن السوري جاء لحرمان اللبناني من لقمة العيش.
الأهم من ذلك كله أن الشعب السوري سينتصر يوما على نظام آل الأسد. ماذا سيفعل المسيحيون اللبنانيون عندئذ؟
من الواضح أن هناك حاجة، اليوم قبل الغد، إلى صوت مسيحي عاقل يقول، بالفم الملآن، أن من يعتدي على مواطن سوري في لبنان لا يعتدي على لبنان فحسب، بل إنّه يعرض مستقبل البلد لأخطار كبيرة.
هذا ليس عائدا إلى أن الشعب السوري، الذي يقاتل النظام وحيدا منذ ما يزيد على ست سنـوات، لن ينسى مـن وقـف معه فحسب، بل لأن ثمة واقعا لا يمكن تجاوزه أيضا. لا يمكن لأقلية في لبنان الوقوف ضد الأكثرية في سوريا. لماذا على المسيحيين اللبنانيين دفع ثمن القرار الإيراني بحمل “حزب الله” على المشاركة في الحرب على الشعب السوري من أجل تهجيره من أرضه؟ أليس في دخول لبنانيين مسيحيين في لعبة من هذا النوع دليل على غباء ليس بعده غباء؟
أمس خدم هؤلاء المسيحيون النظام السوري أيام كان حافظ الأسد رئيسا لسوريا. أوصلوه إلى التمكن من احتلال لبنان. دفعوا غاليا ثمن عدم إدراكهم ما هو النظام السوري وما هي أهدافه وما طبيعة تكوينه. سيدفعون ثمنا أغلى لعدم إدراكهم أبعاد اللعبة التي تحاول إيران زجّهم فيها عبر “حزب الله”… من بوابة عرسال وبوابة الاعتداء على مواطن سوري أعزل.
إعلامي لبناني
العرب
جرود عرسال وأثمان الحاجة الإيرانية/ وليد شقير
الانطباع الذي تركته ممارسات ومواقف داخلية حيال النازحين السوريين في لبنان منذ أسبوعين، وبث أفلام يتعرض فيها نازحون للتعنيف من قبل لبنانيين، هو أن السوريين سواء كانوا موالين للنظام أم معارضين له، توحدوا في وجه بعض المناخ اللبناني المعادي لهم.
وإذا كانت الأمور اختلطت بين العمليات الأمنية ضد المجموعات الإرهابية التي تتلطى ببعض مخيمات النازحين، وبين ممارسات أمنية فرضت طغيان صورة عدم التمييز بين النازح والإرهابي، فإن المشاعر العنصرية المتنامية عند مجموعات لبنانية في المجتمع وفي المؤسسات، حيال النازحين، سهّلت هذا المزج وأطلقت العنان للعصبيات المريضة، بالتزامن مع حملة سياسية إعلامية لإعادة النازحين إلى سورية، لم يكن هدفها الفعلي إلا دفع السلطات اللبنانية إلى التواصل مع النظام السوري بهدف التسليم بشرعيته. مفعول هذا الهدف السياسي كان تأجيج مشاعر العداء. ولا يحتاج المرء إلى دليل على أن تحقيق مآرب النظام تسبب منذ 6 سنوات ونيف بالأضرار والمآسي للسوريين. إلا أن اللبنانيين بدورهم سقطوا ضحية ذلك. وهي ليست المرة الأولى طبعاً. تنبه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي ينتمي إلى الفريق الملح على إعادة النازحين، إلى ضرر الحملة فقال إن حل أزمة النزوح لا يكون بنشر الكراهية.
لتنامي هذه المشاعر الذي يفاقم الحساسية بين الشعبين، عوامل كثيرة في ظل الوضع الاقتصادي اللبناني الصعب، والفوضى الإقليمية. منها إطلاق الحملة السياسية الإعلامية أيضاً، تحضيراً من «حزب الله» للتخلص من المسلحين التابعين لـ «النصرة» و «داعش»، في جرود عرسال، بعملية عسكرية، أثارت المخاوف من أن يدفع مدنيو مخيمات النزوح فيها وأهالي عرسال، ثمناً جديداً بتهجير آخر. وهي عملية أغراضها السياسية أبعد من مواجهة الإرهاب ومجموعاته، تتعلق بحاجة ايران إلى استكمال اقتطاع منطقة النفوذ التابعة لها في الميدان السوري، من دمشق ومحيطها إلى منطقة القلمون، في سياق التقاسم مع روسيا وأميركا وتركيا للكعكة السورية. وليست المرة الأولى التي يدفع فيها السوريون واللبنانيون بمن فيهم رموز السلطة اللبنانية، أثمان أهداف متصلة بالصراع الإيراني- الأميركي. فالحاجة الإيرانية للسيطرة على هذه المنطقة تتعدى تطهير الحدود من هؤلاء المسلحين.
قضى الاتفاق الأميركي- الروسي على المنطقة الآمنة في جنوب غربي سورية، بإخراج إيران منها وإبعادها من الحدود مع الأردن ومع الجولان المحتل من قبل إسرائيل في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء. انكفأت الميليشيات الإيرانية و «حزب الله»، منها وبقيت في بعض محافظة القنيطرة. والتفاوض يدور على انسحابها إلى ما بين 30 كيلومتراً عن حدود الجولان (كما يطالب الأميركيون) أي إلى محيط دمشق الإدارية في سعسع، و50 كيلومتراً كما يطالب الإسرائيليون، أي إلى غرب دمشق. وأبعد الأميركيون الإيرانيين من الحدود العراقية- السورية عند معبر التنف والمثلث الأردني العراقي السوري وفي محيطه حين حاولوا التقدم مع «الحشد الشعبي» العراقي، (بحجة انتهاء معركة الموصل والمشاركة في المعارك مع «داعش» في الرقة). كما أبعد الأميركيون وبغض نظر روسي، الميليشيات الإيرانية عن البادية السورية التي تقود إلى تدمر ودير الزور، ثم الرقة… وحال كل ذلك دون استثمار إيراني بالانتشار على مساحات كبيرة من الأرض السورية بعد 6 سنوات من القتال الذي خاضوه دفاعاً عن نظام بشار الأسد، في وقت تصاعدت حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد التدخل الإيراني في سورية وغيرها وصولاً إلى العقوبات ضد قيادات في «الحرس الثوري» التي صدرت قبل 3 أيام، بتهمة رعاية الإرهاب… بل أن الأميركيين زادوا قواعدهم في سورية تدريجاً من دون الإعلان عنها إذ باتت 7 قواعد، مرشحة لأن تصبح 12 قاعدة.
ترمي طهران من وراء تمهيد «حزب الله» لعمل عسكري في الجرود إلى استكمال السيطرة على غرب دمشق والقلمون المحاذية للبنان (وهي متصلة بالطريق نحو حمص وريفها حيث لها قوات) وإلى ضمان طريق الإمداد بالسلاح للحزب بين طهران وشرق لبنان وجنوبه. والإمداد الإيراني يتم بثلاث طرق: جواً من طريق مطار دمشق والمطارات العسكرية المحيطة بالعاصمة. براً عبر العراق، الذي حال دونه الأميركيون حتى الآن من دون استبعاد مواصلة طهران محاولتها فتحه. وهناك خيار ثالث في حال تعذر الطريقين الأولين، هو أن يتيح تصاعد الخلاف الأميركي- التركي حول دعم واشنطن الأكراد في شمال سورية، واستمرار احتضان واشنطن فتح الله غولن، لإيران استخدام طريق بري من الحدود مع تركيا وصولاً إلى الساحل السوري، (سبق أن تم استخدامه على رغم طوله) ومنه إلى القلمون، ثم لبنان.
فما علاقة لبنان وجيشه والنازحين بأثمان تلك الأهداف؟
الحياة
عرسال.. القدس!!/ علي نون
ليست معركة جرود عرسال على صِلَة بلبنان، بل ببعض أهله! وليست على صِلَة بالحرب المدعاة على الإرهاب بقدر ما هي على صِلَة بخريطة النفوذ الإيراني وملحقاتها التي يبقى الأبرز فيها الحفاظ على الغطاء الشكلي الذي يوفّره رئيس سوريا السابق بشّار الأسد لذلك النفوذ.
وآخر ما يمكن لأقطاب هذه المعركة إدّعاؤه، هو وضعها في سياق حديث النازحين الى لبنان، الدارج هذه الأيام. والمأخوذ كحُجّة لتبرير ما لا يُبرّر في شأن «العلاقات اللبنانية – السورية». والدعوة إلى العودة إلى التنسيق مع سلطة الأسد!
وهي، مثل كل المعارك الحاسمة في النكبة السورية، منذ بدء عسكرتها التامة، تُنفَّذ ميدانياً بعد استكمال تحضيراتها سياسياً! أي بعد إتمام وتأمين عدم وجود أي «فيتو» عليها من قبل أي طرف معيّن فاعل ومؤثر إقليمي أو دولي. وبعد خلوص المفاوضات والمناورات والمقايضات إلى نتيجة تتلاءم مع قرارات وسياسات هؤلاء المعنيين.
في عنوانها هي «معركة ضد الإرهاب» لكنها في واقعها هي استكمال للخرائط التي رسمها الأميركيون والروس أولاً وأساساً، وبإقرار إسرائيلي ثانياً.. وهذه لا تنفصل عن السياق العام القائل (أميركياً) بالحرب على الإرهاب. والقائل (روسياً) باستكمال كسر التوازن الميداني تمهيداً لفرض، أو محاولة فرض، حل مرحلي على حساب أكثرية السوريين.
لعب الروس ويلعبون الدور المحوري في رسم حدود توزّع النفوذ والقوى، بحدّ السكّين والنار. قايضوا مع الأتراك شرق حلب بحدود حملة «درع الفرات» في الشريط الشمالي الحدودي السوري! ويفعلون ذلك الآن مع الإيرانيين وملحقاتهم الميليشيوية.. وأيّاً تكن الخلاصة غريبة (وغير منطقية) فهي لا تغيّب تلك المقايضة. بحيث أنّ «ابتعاد» جماعة إيران عن حدود المنطقة الجنوبية وكل ما يعنيه ذلك، يقابله «السماح» لها بإتمام ما كانت بدأته في بلدة القصير قبل أربع سنوات، وإحكام السيطرة على كل الشريط الممتد من الساحل السوري شمالاً الى تخوم جبل الشيخ جنوباً.
تكفَّلوا (الروس) ويتكفّلون بإنجاح هذه المهمة الصعبة والمزدوجة. أي بتهدئة الإسرائيليين، طالما أنّ «جبهتهم» مؤمّنة! وتهدئة الأميركيين طالما أن خطّهم الأحمر محترم! وطالما في الإجمال، تجري المعركة بين «آخرين» بغضّ النظر عن المجرم والضحية والمفتري والمُفترى عليه منهم!
والتوليفة صعبة ومعقّدة بقدر ما هي غير دائمة. بحيث أن إنضاج الخرائط، الذي تندرج معركة جرود عرسال في سياقه، لا يُعكّر تركيز واشنطن على ضرب الإرهاب في سوريا والعراق، ويجنّبهم مع الإسرائيليين مرحلياً فتح معركة التصدي لنفوذ الإيرانيين، قبل أوانها.. لكن الأهم في هذه التركيبة هو موقف الجانب الإيراني، الذي (مرّة أخرى) لا يتردّد أمام أي شيء مخزٍ طالما يوصل ذلك الى تأمين مكاسب له! أي أنه ينصاع غصباً عنه لشروط التهدئة مع الأميركيين والإسرائيليين، وينزوي الى الخلف إزاء تهديداتهم، لكنه يستشرس في وجه أهل سوريا ويُكمل تغوّله في المذبحة، ولا ينسى أن يضع ذلك في خانة «الحرب على الإرهاب» بعد تبيان مفعول هذه الستارة في تغطية مراميه المذهبية والفئوية و«الاستراتيجية»! مثلما لا ينسى إضافة المعركة الراهنة الى ملفه المثقل بـ«الانتصارات الإلهية»!
وليس جديداً (ولا سهلاً!!) القول بأنّ مصلحة لبنان غير منظورة رغم ثانويتها، في معركة جرود عرسال! مثلما لم تكن هذه المصلحة منظورة أصلاً، في ذهاب «حزب الله» الى سوريا وانخراطه في قتل السوريين دفاعاً عن مصالح إيران وسلطة آل الأسد! إلا إذا أرادت ماكينة الممانعة الإصرار على متابعة الاستثمار في ثقافة التخويف (الإسرائيلية أساساً) وإقناع عموم اللبنانيين، بأنّ بضع مئات من المقاتلين المحاصَرين في جرود نائية، هم العقبة الوحيدة المتبقّية في الطريق الى نصرة المسجد الأقصى وتحرير القدس! وهم التهديد الاستراتيجي الخطير لـِ«المقاومة» برغم قدرتها المدعاة على «تغيير خرائط المنطقة»!
المستقبل