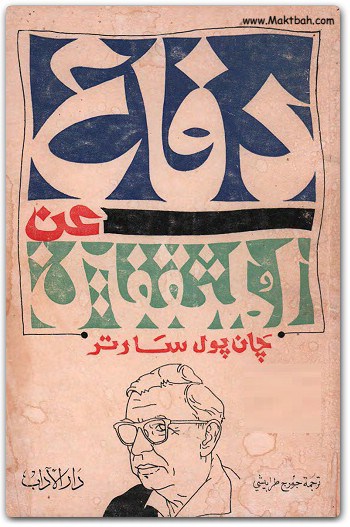في وجوب مفارقة الجماعة وشق عصا الطاعة/ ياسين الحاج صالح

تفاعلاً في ما يبدو مع إعلان الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مساندتها لحرب روسيا إلى جانب الأسديين في سورية، ووصف الحرب بأنها «مقدسة»، كتب الصديق حازم صاغيّة على صفحته على «فايسبوك» كلاماً يعلن انشقاقه فيه عن الطائفة الأرثوذكسية التي يتحدر منها بالولادة. ومضى حازم إلى دعوة المتصفحين إلى إعلان انشقاقهم عن طوائفهم، ورأى في ذلك «رائزاً ورمزاً واستفتاء» على استقلال المعنيين.
قد تبدو هذه المبادرة الشخصية بلا موضوع. فحازم وأشباهه، ومنهم كاتب هذه السطور، علمانيون ويساريون أو ليبراليون منذ سنوات شبابهم التي انقضت قبل سنوات طويلة، ويفترض أنهم كانوا منشقين سلفاً بحيث لا يستوجب الأمر إعلاناً خاصاً اليوم. كان هذا بالفعل تعليقاً متواتراً على مبادرة حازم الداعية للانشقاق. وبدا أن إعلان الانشقاق اليوم يثير الريبة في شأن توجهات المعنيين ومواقفهم وتاريخهم. فهل كانوا حقاً لا طائفيين من قبل حتى يشعروا اليوم بالحاجة إلى الانشقاق عن طوائفهم؟ والحال أن كلام حازم يفترض شرعية هذه الريبة في ما يبدو، ويصدر عنها، وهو ما يفترضه أيضاً هذا التعليق، وقبله مؤازرتي على «فايسبوك» دعوة حازم إلى الانفصال عن روابطنا الأهلية وتسميتها بأسمائها.
في سورية ولبنان، وفي العراق على الأرجح، يمكن لأي كان أن يستحضر أمثلة مخيبة عن شيوعيين وعلمانيين مجاهرين، ينحازون في «ساعة الحقيقة» إلى جماعاتهم الأهلية، هاجرين انحيازاتهم الفكرية والسياسية المكتسبة، أو، أسوأ، محافظين عليها ومسخّرين إياها في خدمة الأهلي. ومنذ ربع قرن على الأقل شاع ضرب من علمانية اختزالية، معنية حصراً بفصل دين بعينه عن الدولة من دون انشغال بتكوين الدولة والأوضاع الاجتماعية والحقوقية للسكان في ظلها، وتفاوت درجات تماهي السكان بها. سهل هذا التصور المبتذل لكثيرين أن ينتحلوا لأنفسهم صفة علمانية، ليس من دون تفحص للضمير السياسي فقط، وليس من دون التخلي عن أي «كلاكيش» طائفية فقط، وإنما كذلك مع انشغال حصري بالإسلاميين السنيين في سياق مثل السياق السوري، حيث يجتمع الطغيان مع تمييز وامتيازات طائفية لا جدال فيها. وهذا في تعارض واسع مع «مقاصد» العلمانية: المساواة بين الناس بصرف النظر عن الدين والمعتقد، ورفض الامتيازات الاجتماعية والسياسية المرتبطة بهما. وشاع في بيئات المسلمين السنيين في الفترة ذاتها تصور مبسط للديموقراطية يردها إلى حكم الأكثرية، الأمر الذي يسهل لأي سني في السياق السوري أن يكون ديموقراطياً من دون أن يتخلى عن شيء من «كلاكيشه» الدينية الخاصة.
حصلنا في النتيجة على تقسيم طائفي للإيديولوجيات: الديموقرطية للسنيين، والعلمانية لـ «الأقليات». ولم يكن هذا الوضع خافياً عن المدارك، وإن فضل مدركون كثيرون إخفاءه عن أنفسهم وغيرهم. كان هناك شرط سياسي يضعف إمكانية النقاش الواسع في هذه الشؤون، لكن كان هناك تكاذب عام شارك فيه معظم المثقفين أو تفادوا مواجهته.
وفي الثقافة العليا، راج منذ ربع قرن النهج الثقافوي الذي يرجع أوضاعنا السياسية والاجتماعية إلى الثقافة، مردودة وفق النهج الهنتنغتوني إلى الدين، مختزلاً إلى الإسلام وحده، مقلصاً إلى الإسلام السنّي. وبكل «براءة» هيمنت هذه النظرية عشرين عاماً، حتى صارت حساً عاماً وضرباً آخر من الظلامية التي تزعم لنفسها مواجهة الظلامية.
يتولد بالتدريج شعور بأن نقد الظلامية لا يندرج في إطار الدفاع عن الاستنارة العقلية والأخلاقية، عن الحرية الدينية والسياسية كما يفترض المرء، أو الدفاع عن الوضوح وتحمل الفاعلين العامين مسؤولياتهم، بل هو أقرب إلى صراع عقائد ضد عقائد، أديان ضد أديان، وجماعات ضد جماعات، وهو أمر إن لم تكن حوافزه طائفية منذ المنطلق، فإنه يسهل استخدامه من قبل الطائفيين، وباسم التنوير والعلمانية.
وهو ما حال، بالمناسبة، دون تطوير نقد ضارب وجذري لتفكير الإسلام السني بالذات على يد هؤلاء المثقفين أو غيرهم. فقد ظل الأمر كله يدور في مدار التعريض والتلميحات والتعفف الكاذب، متجنباً تسمية الأشياء بأسمائها أو إيراد تفاصيل من الواقع السياسي الديني المعاش، او النقاش الصريح الذي يفتح سجلات مغلقة.
ولا يعرف المتابع نصاً واحداً كتب في وصف خبرات دينية شخصية أو خبرات خروج من الدين أو علاقة الأفراد بجماعاتهم الأهلية. كان الواحد منا يفترض أنه ما دام علمانياً أو شيوعياً أو تقدمياً أو ملحداً، فإنه مبرّأ من الطائفية وانحيازاتها العلنة أو الخفية.
لكن منذ نحو جيل على الأقل أخذ يظهر أنه لا علاقة ضرورية بين الطائفية والإيمان الديني كي يكون الطائفيون هم المؤمنون، وكي يكون كافياً ألا يكون المرء مؤمناً حتى يكون غير طائفي. فالطائفية من نصاب الاجتماع والسياسة، و «العصبية»، وليس من نصاب الاعتقاد والإيمان، والطائفي العلماني ليس أندر كثيراً من الطائفي المتدين. كان بن غوريون يقول: يهوه غير موجود، لكنه وعدنا بهذه الأرض!
ما تقدم أكثر من كافٍ للريبة بكفاية علمانية ويسارية كثيرين بيننا، كلنا، في مواجهة الطائفية. بل إن هذه الممارسات الموصوفة على عجل تساهم في الإجابة عن سبب التدهور الثقافي والأخلاقي والسياسي في بيئاتنا الثقافية، والحروب والكراهية المزدهرة بين مجموعات المثقفين، والتخلي عن المسؤولية الاجتماعية للمثقف، والخداع العام. الكل تقريباً يعرف من هو من، ومن هو ممن، ومن هو مع من، ويسلك وفق ما يعرف، لكن الكل تقريباً يتصنع الجهل والترفع.
لقد فشل جيل، جيلنا، من معتنقي وورثة الإيديولوجات «التقدمية»، وتداركاً للفشل تقضي الكرامة الشخصية والثقافية المساهمة في إطلاق موجة قوية من مساءلة الضمير في وسط المشتغلين في الشؤون العامة. المجاهرة بالانشقاق عن الطوائف يمكن أن تكون عنصراً في تلك المساهمة.
الغرض من هذا التناول التخطيطي، ومن فكرة الانشقاق عن الطوائف، هو المساهمة في الاحتجاج على مخاتلة واسعة الانتشار تجعل من الثقافة ميداناً لغش الجميع للجميع وعدم ثقة الجميع بالجميع. المساهمة أيضاً في إثارة نقاش عام حول هذه القضايا، نقاش علني وبمشاركة واسعة. بدلاً من الجسارة في نقدهم والتلجلج في نقدنا، الاتساق الأخلاقي يقتضي، بالعكس، الجسارة في نقدنا والتحرج في نقدهم. نقدنا لهم لا يستقيم، معرفياً وأخلاقياً، من دون أن يكون منطلقه نقدنا لنا.
يبقى أن في فعل المجاهرة بالانفصال عن الطوائف تحدياً لمحرم شائع، في البيئة الإسلامية السنية بخاصة، وله أثر تحريضي على القيام بالأمر نفسه على نطاق أوسع خارج البيئات الإسلامية نظراً إلى صفتها الأكثرية. فالمجاهرة بالاعتقاد، وليس الاعتقاد بحد ذاته، هي ما كانت موضع قمع في العالم السياسي الديني الإسلامي، وهذا بالضبط لأن المجاهرة فعل عام، فيما الاعتقاد من «أفعال القلب»، يمارسه المرء في دخيلة نفسه. لقد فضلت السلطات الإسلامية على الدوام «المعصية» في الستر على جهر المرء بما يراه مما يخالف الجماعة. ووراء ما يبدو من صون وحدة «الجماعة» هناك، بالأحرى، فرض الطاعة، وما يقترن به من وأد الانشقاق واستئصال التمرد على السلطة.
عبر المجاهرة بالانفصال عن جماعاتنا الأهلية، لسنا نمارس فعل انشقاق مجاني من روابط خاملة، بل نتمرد على السلطة المحتملة ضمن هذه الجماعات، وفي الإطار العام للدول المعاصرة المتعددة الجماعات، ونعمل عبر فعل المجاهرة ذاته بمخاطبة آخرين والصداقة مع آخرين والتشارك مع آخرين، وتالياً في إقامة مجتمع مغاير. في المقابل، ترتاح الزعامات الطائفية وإداريو الدين، وأكثر منهم ترتاح دولنا كلها، حين نقبع في روابطنا، وليس حين ننفصل عنها ونتمرد عليها، وهي تعرف جيداً أن الاستقلال عن الأهلي وجه من أوجه عملية امتلاك للذات ستصطدم من كل بد ببنى السلطة القمعية، الآن أو بعد حين.
شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة هو الواجب، منذ الأمس.
* كاتب سوري
الحياة