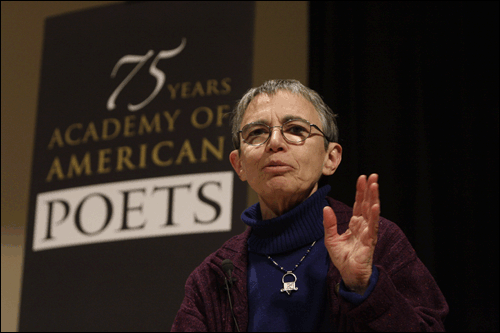حياتنا شاهدة لقبر العائلة/ نور دكرلي

لمَ أكتب كثيراً عن عائلتي؟ مرةً حاولت البحث عن سبب لذلك، من دون أن يهمّني الأمر كثيراً. لكني أدرك أن أي شخص يستطيع كتابة الكثير عن عائلتي، أو عن أي عائلة أخرى، ربما. عشت في عائلة تتكون من جدة وأم وأب وأولادهما التسعة. كلهم كانوا يعيشون في بيت واحد. لا أحد منهم يشبه الآخر، كأني عشت مع العالم كله وامتلكت كنزاً حقيقاً. كنا، نحن التسعة، ننام جنباً الى جنب، مما يجعل الغرفة شبيهة بصحن “يبرق” (محشي الملفوف). قبل النوم كانت جدتي تتحول حكواتي العائلة.
أختي الكبرى كانت تؤمن بالتعاويذ السحرية، الدينية منها، وتلك التي قرأتها في قصص الأطفال. لا أذكر أختي تلك إلا وهي تتمتم: تعويذة قبل النوم، تعويذة قبل الأكل، تعويذة للخوف… إلخ.
أخي الأكبر كان تاجراً منذ طفولته. كل ما كان يشغل تفكيره هو التجارة، حتى ولو خسر، وبدأ رحلته تلك بتجارة الكلل. أختي الأخرى لا نعرفها جيداً. كانت تعيش من أجل أن تدرس فقط. كثيراً ما بكيت من أجلها عندما كنت صغيراً، معتقدا أن الدرس عقوبة لها على ذنب ارتكبته. أخي الآخر كان مكتبة متنقلة. يحدّثك في التاريخ، في الدين، في الأدب، في الكائنات الفضائية. عندما كنت أعارضه من باب المعارضة فقط (وهي عادة في طفولتي)، كان الأمر ينتهي بلكمة منه أو رفسة. للأسف كبرتُ واكتشفتُ أن نصف المعلومات التي كان يفاخر بها غير صحيحة، ونصفها الآخر قابل للتشكيك. أختي التي تكبرني بعامين، كان الخوف ينهش سنوات عمرها. تخاف من الوحدة، من العتمة، من المدرسة، من الله… منّا. أخي الذي يصغرني بسنة، كان طيباً إلى درجة لا يمكنك معها إلا أن تتمنى له الموت ليرتاح من شقائه المجاني. كان يربّي الصيصان الملوّنة، يحزن عندما تكبر وتفقد ألوانها، معتقداً أن ذلك حدث بسببه. أخي الأصغر منه، وهو منجم حكايات، كنت أشك في أنه سُرِقَ من العراق ودُسَّ خلسة بيننا. منذ طفولته يغنّي في صوت يعادل حزنُه ﺣﺰﻥَ أربع ﺃﻣﻬﺎﺕ ﻓﻘدت ﻛلٌّ ﻣﻨﻬﻦ ﻭﺣيدﻫﺎ. في ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ من عمره ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﻧﺎﻇﻢ الغزالي ﻭأﻳﺎﺱ ﺧﻀﺮ، ويشرب ﺍﻟﺸﺎﻱ لكي تكتمل السلطنة.
ﺃﺧﺘﻲ ﺍﻟﺼﻐﺮى- هي ﺃﺻﻐﺮﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً- ﻭلدت ﺑﻘﻠب ﺃﻡّ. ﻛﺎنت إذ لا ﺗﺠد ﺃﺣدﺍً تحنّ ﻋﻠﻴﻪ، ترسم ﻭجهاً على المخدة ﻭتغطّيه ﻗﺒﻞ النوم لكي ﻻ يشعر بالبرﺩ.
ﻓﻲ السنوات الثلاث اﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻋﺎﺵ ﺑﻌض هؤلاء الأشخاص ﻓﻲ مخيم ﺍﻟﺰﻋﺘﺮﻱ ﺛﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ. إحداهن ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ وأخي ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، وثالثة في حمص. لكلٍّ ﺣكايته. بعد ﺍﻵﻥ ﻟﻦ ﺃﺳﺄﻝ ﻧﻔﺴﻲ، ولن ﺃﺟيب ﺃﺣداً ﻋﻦ ﺳﺆﺍله:
لمَ تكتب ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠتك؟ السبب أﻥ ﺃحدهم ﻛُتِب ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ يأخذ ﺩﻭﺭ الكاﻣﻴﺮﺍ طوال ﺍﻟﻮقت.
* * *
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ تقريباً ﺃﻗﻀﻲ ﻟﻴﻠﻲ بالطريقة نفسها. الفرق ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ غالباً ما يكون ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮﺯﺗﻲ. أﺟﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺃﻃﻔﺊ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﻭأﺳﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ نفسها ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ، ﻭﺃﺩﺧّﻦ. ﺃﺩﺧّﻦ ﻓﻘﻂ. ﻟﻜﻲ ﺃﻫﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻠﻞ، ﺃﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﺨﻴﻞ. أتخيّل ﺃﻱ ﺷﻲﺀ. أحياناً أﺗﺨﻴﻞ أﻧّﻲ ﺍﻵﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻨﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﻨّﻲ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﻘﻨﻲ ﺃﺳﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮاء ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟموسيقية، ﻓﺄﺣﺘﻀﻨﻬﺎ ﻷﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ حزناً، ﻓﺘﺼﺒﺢ مثلاً: ﺩﻭ ﺗﻌﻴﺴﺔ/ ﻓﺎ ﺳﻮﺩاء ﺷﺎﺣﺒﺔ/ ﻣﻲ ﺣﺰﻳﻨﺔ…
ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ، ﺷﻌﺮﺕ ﺃﻥّ ﻣﺨﻴّﻠﺘﻲ ﻗﺪ ﻧﻔدﺕ: ﺃﻧﻒ ﺟﺪﻱ، ﺷَﻌﺮ ﺃﻣّﻲ، ﻧﻤﻼﺗﻲ، ﺳﻴﺠﺎﺭﺗﻲ… ﻟﻢ يبق ﻟﻲ ﺷﻲء، فأصابني ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﻬﻠﻊ، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺃﻓﻜﺮ ﻛﻴﻒ ﺳﺄﻗﻀﻲ ﻟﻴﻠﻲ بعد ﺍﻵﻥ. ﺷﻌﺮﺕ أﻧﻲ ﺍﻧﺘﻬﻴﺖ وﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ ﺍﻟﻤﻮﺕ: ﻛﻴﻒ ﺄﺣﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻵﻥ؟ ﻧﻔدﺕ ﻣﺨﻴّﻠﺘﻲ، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻲ ﻭﻃﻦ ﺃﺣﻴﺎ ﻓﻴﻪ، فوقفتُ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺃصيح وأنا ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻗﻮﺍﻱ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ: ﺃﺭﺟﻮكم… ﻻ ﺗﺤﺒﺴﻮﻧﻲ ﺩﺍﺧﻠﻜﻢ وحيداً. ﺃﺭﺟﻮﻙ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺿﻤّﻨﻲ لأﺻﺒﺢ ﻣﺜﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺃﺭﺟﻮﻙ. ﺍﺭﺗﻤﻴﺖ على الجدار ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺃﺑﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻤﻲ ﻋﻠﻲَّ.
ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺃﻓﻘﺖ. ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ أحرّك ﺭﺃﺳﻲ ﻟﻜﻨّﻲ ﻟﻢ ﺃﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺃﺣﺮّﻙ ﻳﺪﻱ، ﺃﻥ ﺃﻣﺸﻲ، ﻟﻜﻦ من ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ. ﻛﻨﺖ مكبلاً تماماً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﺧﻠﺖ ﺃﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ. ﺍﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻨﻲ، حاملة ﻓﻲ ﻳﺪﻫﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻲ ﻭأﻧﺎ ﻣﺒﺘﺴﻢ ﻛﺎﻷﺑﻠﻪ. ﻋﻠﻰ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺿﻌﺖ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺳﻮﺩاء ﻟﻢ ﺃﻓﻬﻢ ﺳﺒﺒﻬﺎ. ﻛﺎﻧﺖ أمي ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺗﺒﻜﻲ. ﻓﺠﺄﺓ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻨﻲ ﻭﺛـﺒّـﺘﺖ ﻣﺴﻤﺎﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻴﻨﻲ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺑﻀﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﻤﻄﺮﻗﺔ، ﺫﻫﻠﺖ ﻭصحْتُ بها:
– ﺃﻣﻲ… ﻣﺎ ﺑﻚ؟ ﺃﻣﻲ… ﻫﺬﺍ ﺟﺒﻴﻨﻲ، ﻣﺴﻤﺎﺭ ﻳﺎ ﺃﻣﻲ، ﻣﺴﻤﺎﺭ!؟!
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻌﻨﻲ. ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻈﺮ اليَّ ﻭﻻ ﺗﺮﺍﻧﻲ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺻﺮﺥ مفجوعاً:
– أﻣﻲ… ﻫﻴﻴﻴﻴﻪ ﺃﻣﻲ… أﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﻗﺘﻠﻲ؟! ﻭﺑﻤﺴﻤﺎﺭ! ﻟﻤﺎذا ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻘﺪ؟!
ﺣﺎﻭﻟﺖُ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠّﻬﺎ ﺗﺮﺍﻧﻲ، ﻋﻠّﻬﺎ ﺗﻌﻄﻒ عليَّ، ﻟﻜﻨّﻬﺎ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ بالمسمار. ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﻲ ﻭﺟﻬﻲ.
مضتْ ثلاﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﺎﻝ. ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻨﻲ ﻭﻻ ﻳﺮﺍﻧﻲ ﺃﺣﺪ. ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻨّﻲ ﺃﻣّﻲ ﻭﺗﺒﻜﻲ. ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﻨﺰﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺗﺤﻀﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺃﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻬﺎ:
– لمَ ﺗﻜﺘﻔﻴﻦ باحتضان ﺻﻮﺭتي، ﻣﺎ دمت ﺃﻧﺎ ﺃﻣﺎﻣﻚ؟! ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ إلى مكاﻧﻬﺎ ﻭﺗﺨﺮﺝ. بقيت على حالي هذه ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ ﻗﺬﺍﺋﻒ عدة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ، فانهارت جدرانها. ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﺬﺍﺋﻒ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﻇﻬﺮﻱ، وفتّتتني قطعاً. ﺘﻨﺎﺛﺮ ﺟﺴﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ. ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺃﺳﺮﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﺑﺪأﻭا ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أحدٍ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺩُﻓﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻛﺎﻡ. ﺃﺣﺪﻫﻢ اﻟﺘﻘﻂ ﺭﺟﻠﻲ ﻭﺭﻣﺎﻫﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ من ﺩﻭﻥ أن ينظر ﺇﻟﻴﻬﺎ. آخر ﺩاﺲ على ﺭﺃﺳﻲ ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻃﺮﻳﻘﻪ. ﺃﻣّﺎ ﺃﻣﻲ فكانت ﺗﻘﻒ ﺑﺒﺮﻭﺩ ﻭفي يدﻫﺎ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ. حملت ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺗﻠﺘﻘﻂ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻛﺎﻡ ﻭﺗﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ. ما أدهشني ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺭﻛﺎﻣﻲ ﻓﻘﻂ. ﺑﻌﺪما ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ جمعي، ﺣﻤﻠﺖ ﺣﻘﻴﺒﺘﻬﺎ ﻭﻧﺰﺣﺖ، ﻧﺰﺣﺖ ﺑﻌﻴﺪاً، ونزحتُ ﻣﻌﻬﺎ.
* * *
لا أحد يموت هنا. لا تشييعَ كلّ صباح. هذا يعني أن لا مكان لي، ولا طقسَ أمارسه هنا لأبكي بسهولة، كما تعوّدت كلّ صباح في بلدي. هناك كنتُ أستيقظ على صوت المؤذّن وهو ينادي “الشهيد فلان ابن فلان”، فأسرع للخروج منتظراً مرورَ الجموع التي تحمل تابوتاً يشبه تابوت اليوم السابق مع فارق المحتوى. لم يكن محتوى التابوت مهماً، سواء أكان طفلاً، أنثى، عجوزاً، أم شاباً… المهم هو الطقس في ذاته. كائنات تريد أن يجمعها طقس لتصرخ وتبكي في الشارع بلا خجل، والجثة كانت قائدنا دائماً.
في إحدى المرات قالوا إن الجثة لطفل أصابته قذيفة بينما كان يطعم طيور الحمام على سطح منزلهم. عندما وصلنا إلى المقبرة وفتحوا التابوت، لم يكن في داخله سوى بنطال صغير ممزق.
طوال الطريق كان هذا البنطال يقودنا. أما الجثة فلم يكن قد بقي منها شيءٌ، سوى أشلاء لحمٍ تناثرت على سطح ذلك المنزل، فتقاسمتها الحمامات، فيما لملمت أم الطفل بعضاً من أشلائه وهربت. في المقبرة جلس بعض المشيّعين حول الحفرة، ودخّنوا سجائرهم، رموها في الحفرة، وعدنا من دون أن ندفن شيئاً.
قد تبدو الحادثة مفجعة قليلاً، لكنها لم تكن كذلك حينها. كان الأمر عادياً. أتذكر أني عدت إلى البيت وتناولت غدائي، ونمت جيداً. لم أكن أدرك أن هذه الجثث تتراكم داخلنا لتنفجر بعد ذلك ملطخةً دواخلنا كجدران ذلك السطح.
أحياناً أتخيّل طابوراً من الموتى يصطفّون بعضهم خلف بعض أمام شبّاك صغير يظهر منه وجه بلا ملامح ويصرخ فيهم:
– من أين نؤمّن قبوراً لكم جميعاً؟
شيخٌ كبير يقف في الصف حاملاً قلبه بين يديه وينادي بصوت مبحوح:
– والله أنا رجل كبير، لا أتحمّل الوقوف طويلاً، الله يخلّيك جِـدْ لي قبراً بسرعة.
امرأة تضمّ رضيعاً إلى صدرها وتتوسّل:
– أنا لا أكلفك الكثير، فقد أحضرت معي بعض التراب من حديقة بيتنا، أرجوك ارحم هذا الصغير، يكاد يحيا من البرد.
شابٌّ، أو نصف شابّ:
– ضعني مع أي جثة، لستُ أكثر من يدٍ وبطن. عقل كبير بشاربين طويلين معلّقة عليهما ملابس داخلية، يخترق خيالي ويصرخ في وجهي:
– كفّ عن قذف الجثث والأشلاء يا مريض.
يتحول لوني إلى الأصفر وينبت في ذراعي أنبوبٌ رفيع موصول إلى غيمة على شكل كيس سيروم.
– يا سيدي العقل، أرجوك، لا أملك النقود لأزور طبيباً نفسياً، قم أنت بذلك وخذ حصتك من الحبوب. أما أنا فسأستمر بقذف الجثث في كل مكان كبركان يتفجر من مقبرة، وسأبقى أخرج كل ليلة إلى العراء وأعوي كمستذئب، ثم أضع قلبي بين أنيابي وأعضّ عليه لينزف حتى يجفّ.
* * *
غداً عندما نعود، سنتسابق أنا وأفراد عائلتي في الوصول إلى بيتنا. لن نستخدم أي وسيلة للعودة. سنعود جرْياً. سنركض حفاةً مسرعين. سنتناوب أنا وأخوتي على حمل أمي والركض بها. سيتعب أبي ويغار من أمي ويبدأ بالصراخ: يا أولاد الكلب ألا تحملوني أيضاً؟ سنتابع الركض ضاحكين بكل ما في قلوبنا من شوق. أنا وأخوتي التسعة ووالداي، سنجري من كل حدبٍ وصوب، قاطعين ألوف الكيلومترات على الأقدام. كلما تعب أحدنا من حمل أمي رمى بها إلى الآخر. كأننا نلعب. سنقفز فوق الأبنية، ونقطع الأنهار، لا شيء سيوقفنا في سباقنا. عندما يتقدم أخي مبتعداً عنّا مسافة طويلة، سأحمل صخرة وأرميه بها. يسقط، ويشجّ رأسه، لكنه يقوم مسرعاً ويلتفت إليَّ ضاحكاً، يمدّ لسانه وينادي من بعيد:
– لن أموت قبل أن أصل أيها اللعين.
عندما نقترب من بيتنا لن نجد سوى حجر واحد فقط. سنقفز كلنا معاً ونطير بضعة أمتار. كلّ منا يطمع أن يلمس الحجر أولاً ليكون أول الواصلين. حتى أمي، التي بالكاد تستطيع المشي، ستقفز بكل رشاقة لتظهر بعباءتها كأنها Batwoman. لكن أول الواصلين الى الحجر سيكون أبي الذي لن يمنعه كرشه من التفوق علينا نحن الفتية. ستقترب أمي وتحتضن الحجر مع أبي، ثم نهجم، أنا واخوتي، ونتشاجر عليه. كلما أفلح أحدنا بالقبض عليه حمله على رأسه وجرى به كأنه “كأس العالم”. سنستخدم الحجر مرّةً كحائط، ومرّةً كسقف، وربما في النهاية كشاهدة لقبرنا الجماعي.
* كاتب سوري
النهار