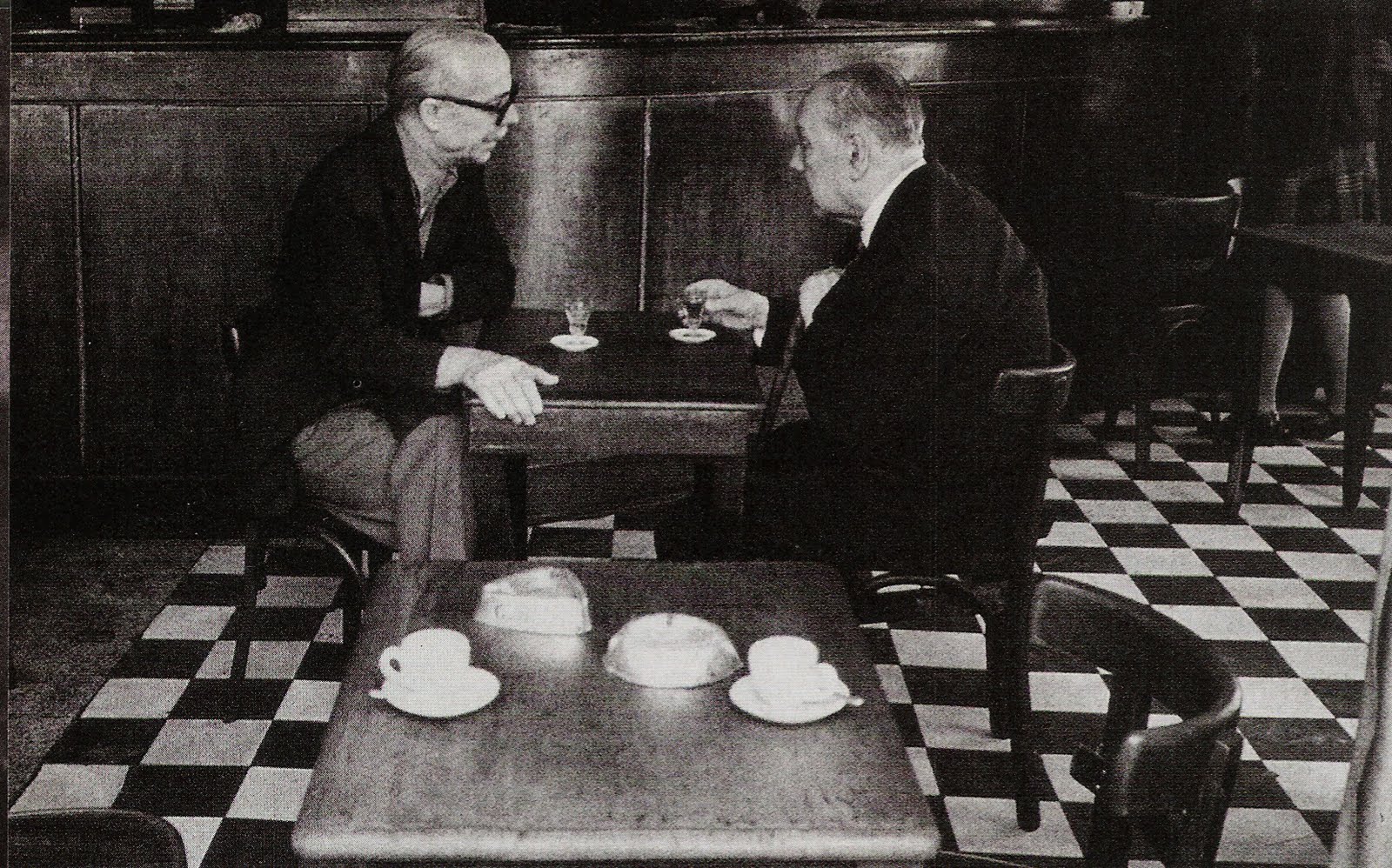محنة المثقف الليبرالي في سوريا: فؤاد حميرة نموذجاً
طلال النجار
لعلاقة الثقافة بالسلطة في سوريا خصوصية تميزها عن كثير من البلاد العربية الأخرى، وذلك لأن كثيراً من المثقفين السوريين، وحتى من العاملين في مجال السينما والتلفزيون، يتبنون موقفاً من الفن والأدب ينأى عن التسلية والترفيه ويرى فيهما تعبيراً حياً عن القضايا الوطنية، بل ومشاركة مباشرة فيها. إلا أن تلك المواقف المعلنة كثيراً ما تصطدم بسقف التعبير المحدود إلى أقصى درجة في معظم المجالات وبطش النظام السوري وعدم تقبله لأي آراء توحي بالاختلاف، حتى لو كانت تنويعات على مواقفه هو نفسه. وإذا كان العديد من هؤلاء المثقفين قد حلوا ذلك الإشكال بالتماهي مع النظام وتبني مواقفه، إما بصورة كاملة جعلتهم ناطقين بإسمه، أو بطريقة انتقائية تثني على مواقفه “المبدئية” و”النضالية، في إطار خطاب مثالي شعبوي يتبنى نهج المقاومة والممانعة والتضامن العربي، مع تجاهل جميع القضايا الداخلية، وتحديداً فيما يتعلق بالحرية والديمقراطية، التي قد تدخلهم في مواجهات لا تحمد عقباها مع النظام. كان ذلك حلاً مريحاً للكثير من المثقفين، وخصوصاً العاملين في المجال الفني، والذين تفرض عليهم مهنتهم التواجد الدائم في دائرة الضوء بشكل يقيد مجال التعبير لديهم.
ولكن بقي مع ذلك جزء لا بأس به من المفكرين الذين لم يستطيعوا أن يقسروا أنفسهم على هذه التسوية المريحة، ومعظمهم مما يمكن تسميتهم بالليبراليين، الذين لا ينتمون إلى تيار أيديولوجي معين يتبنون خطه ويدافعون عنه، بل يحملون لواء قضايا عامة تتبنى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وكان على هؤلاء أما التزام الصمت، كما هو حال معظم المفكرين السوريين حتى الآن، أو الانخراط في مجال النشاط السياسي المباشر، مع ما جره ذلك عليهم من محن، تبدأ بالاتهام بالخيانة ولا تنتهي بالاعتقال والتنكيل. وبين هذين الحدين تبنى البعض خطاً وسطاً يقوم على انتقاد بعض الممارسات الخاطئة، بطريقة توحي بالجرأة وحتى المخاطرة، مع تجنب أي مس بمحرمات النظام الكثيرة.
وهكذا مثلاً رأينا مسرحيات دريد لحام ومحمد الماغوط (والتي وصفها الأخير فيما بعد بأنها كانت من أخطاء حياته)، والتي هاجمت الفساد في أشكاله المختلفة والخطاب الغوغائي للنظام، بشكل بدا جريئاً جداً في ذلك الوقت، ولكنها ظلت تتقصد تعميم النقد وتمييعه بإسقاطه على واقع عربي عام، وكذلك بنهايات مقحمة مفتعلة تختزل بشاعة الواقع الذي صورته بالتغني بانتصارات تغب ما قبلها، وتلعب على أوتار مشاعر الوطنية العاطفية، بشكل جعل منها في رأي الكثيرين مجرد متنفس عن حالة الاحتقان التي أثقلت على البلاد، وخصوصاً في فترة الثمانينات التي تلت حوادث الأخوان الدموية وشهدت حصاراً اقتصادياً خانقاً أثر في كل الجوانب المعيشية للشعب السوري. ومع انتهاء حقبة حافظ الأسد وقدوم رئيس جديد قيل أنه يحمل مشروعاً إصلاحياً انفتاحياً، ارتفع سقف التعبير الإعلامي، وصار بإمكان المثقفين توجيه نقدهم بشكل أكثر مباشرة وجرأة. أو ذلك هو ما قيل، لأن ما تحقق في الواقع الفعلي أقل من ذلك بكثير. ونظرة سريعة لمجمل ما قدمه الأدب والفن في سوريا في السنوات الأخيرة تشي بأن سقف التعبير، ولو ارتفع نسبياً مقارنة بالفترة السابقة، إلا أنه يبقى أدنى بكثير مما يقابله حتى في البلدان العربية المجاورة. ولو نظرنا مثلاً إلى عمل مثل غزلان في غابة الذئاب، الذي قدم على أنه من أجرأ المسلسلات السورية في السنوات الأخيرة، فإننا لا نجد أكثر من الوصفة نفسها التي وضعها دريد لحام ومحمد الماغوط، أي انتقاد لبعض مظاهر الفساد والظلم، التي يختزلها العمل في النهاية بممارسات فردية لا ذنب للنظام فيها.
نذكر هذا العمل بالذات، أولاً لأنه فيما يفترض كسر كثيراً من المحرمات وتجاوز الخطوط الحمراء بشكل لا سابقة له، وثانياً بمناسبة المقال الانفعالي الشديد اللهجة الذي أصدره مؤخراً كاتب العمل فؤاد حميرة بشأن الأحداث الجارية في سوريا، والذي يمثل في رأينا نموذجاً للخطاب المتناقض والمراوغ الذي يتبناه كثير من المثقفين السوريين، الذي يريدون إثبات تقدميتهم وليبراليتهم دون ان يقطعوا شعرة معاوية مع النظام.
يبدأ حميرة مقاله بالإعلان على “على رؤوس الأشهاد” كما يقول أنه لا يحب النظام، دون أن يحدد ماهية النظام وهل يشمل الرئيس وكبار المسؤولين وحزب البعث مثلاً، أم ربما بعض المحسوبين عليه من الأجهزة الأمنية والحرس القديم الذي يعيقون البرنامج الإصلاحي للرئيس. العبارة تحتمل التأويل طبعاً، ويمكن للكاتب أن يعدلها ويفسرها في أي وقت دون أن يورط نفسه في ما لاتحمد عقباه.
من ذلك الاعتراف الذي يدعي الجرأة، رغم أنه أدنى بكثير مما وصل إليه خطاب المعارضة حتى داخل سوريا، يمنح حميرة نفسه براءة ذمة من تهمة الولاء للنظام والدفاع عنه، مما يعطيه الحرية المطلقة في مهاجمة الحركات الإحتجاجية في سوريا وإطلاق مختلف الأحكام المبتسرة والتعميمات الجاهزة عليها، وذلك بنفس أسلوب الإعلام الرسمي الذي يعتمد على والاجتزاء والتلميح والتعريض دون دليل، نفس الإعلام الذي يقول حميرة أنه ينتقده ولكنه يردد أحكامه دون تدقيق.
فالمتظاهرون كما يقول لا يعلنون عن أنفسهم. ولا نعلم هنا ماذا يقصد بالإعلان. ألا يعتبر الخروج إلى الشارع ومواجهة بطش الأمن، وخطر الاعتقال أو حتى القتل، ألا يعد ذلك إعلاناً؟ هل يطلق المتظاهرون هتافاتهم في السر أم في وضح النهار؟ وأي إعلان ينتظر منهم بعد ذلك؟ هل يتوجب أن يحملوا لوحات بأسمائهم كما يحدث في المؤتمرات؟ أم لعل السيد حميرة يتحدث عن انتماءات المحتجين واتجاهاتهم السياسية التي يجب أن تكوت معلنة؟ مرة أخرى، المظاهرات أبلغ تعبير عن المواقف، والمطالب واضحة وهي الحرية والعدالة ومكافحة الفساد. والمظاهرات عفوية ليس وراءها مخططون ومنظمون. أليس هذا معنى الحركة الشعبية؟ وهل كان السيد حميرة يرضى عن تلك الحركات لو كان وراءها محرض محدد؟ طبعاً لا. فتهم المؤامرة ستكون جاهزة، وهو لا يتردد في إطلاقها في كل الأحوال، والأسلوب هو نفسه أسلوب الإعلام السوري، صيغة التشكيك والانتقائية دون ذكر وقائع محددة، صيغة سؤال العارف الذي لا يلزم نفسه بأي حجة باعتبار أن اللبيب من الإشارة يفهم. فهو يتحدث عن علاقة المحتجين بقناتي العريبة والجزيرة (مع تناسي البي بي سي والفرنسية مثلاً). ولكن ما هي هذه العلاقة بالضبط؟ لا أحد يعلم؟ هل تتجاوز تغطية الأحداث؟ هل تسهم القناتان في دعم المتظاهرين؟ ثم هل وجد المتظاهرون متنفساً آخر للكلام ورفضوه؟ وهل يسمح الإعلام الرسمي بكلمة واحدة خارج إطار مديح النظام؟ وإذا كانت القنوات الخارجية مرفوضة، فلماذا يتسابق الناطقون باسم النظام للحديث فيها؟ أسئلة كثيرة لا يكلف الكاتب نفسه عناء الرد عليها، فالإجابة فيما يبدو واضحة، أو لعل التشكيك وحده يكفي.
ومن هنا ينطلق حميرة إلى اتهامات بالجملة، لا تقل في معظمها عن الخيانة، والتي استنتجها كما يقول من زيارة “صفحة الثورة السورية”، ودون يحدد أي منها، فهناك أكثر من واحدة بنفس الاسم، وكذلك من ملاحظاته الخاصة على أسلوب حوارهم الذي لا يحدد منه شيئاً. والأهم من ذلك كله أنه لا يقدم لنا أي دليل مقنع على أن هذه الصفحة تمثل المحتجين وتنطق باسمهم ، أو أن المواقف التي انتقاها من الموقع تمثل رأي الموقع عموماً، ناهيك بالمحتجين. ثم يأتي بعد ذلك كلام مختلط عن إسرائيل والسعودية وأميركا، والتي يطلب من المتظاهرين تحديد مواقفهم منها، وكأن المتظاهر الذي يدعو للحرية في بلده لابد أن يحدد موقفه من القوى الخارجية، علماً بأن الكثير من المحتجين والمعارضين عبروا أكثر من مرة عن رفضهم التدخل الأجنبي بكل أشكاله. ثم هل لو حمل المتظاهرون لافتات تندد بإسرائيل مثلاً، هل كان ذلك يحميهم من بطش قوى الأمن؟ وهل حمتهم شعارات السلمية واللافتات التي تدعو الأمن إلى حمايتهم؟ لماذا نقزم الموضوع بهذا الشكل؟ ولماذا نتجاهل مطالب المحتجين التي اعترف النظام بشرعيتها، لنعين أنفسنا قضاة وواعظين في قضايا ليسوا في واردها أصلاً؟ واللافت في خطاب السيد حميرة بإجمعه تركيزه على المتظاهرين ومواقفهم المعلنة والخفية مع التجاهل التام لممارسات النظام نفسه. فهل المحتجون هم الوحيدون في الساحة؟ وهل هم أصحاب القرار حتى نحصر كلامنا بهم؟ ألا توجد مثلاً ممارسات أمنية غير مقبولة؟ أليس هناك شهداء يقتلون كل يوم، ومن المسؤولون عن قتلهم؟
والنتيجة الحتمية التي يخلص إليها السيد حميرة أنه لا يحب المتظاهرين، هكذا كلهم دون تمييز، بل دون أن يقتصر كعادة الإعلام الرسمي على المخربين والمندسين. لماذا ولأي سبب؟ لأنهم كما يقول غير واضحون، بينما النظام واضح ومعروف، ولذلك فإنه سيقاتل في جانبه إذا اقتضى الأمر. وهنا كان يمكن للمرء أن يحاور السيد حميرة ويجادله فيما إذا كان الوضوح في حد ذاته ميزة، وإذا كان وضوح القمع والاستبداد في نظام ما يعد فضيلة في حد ذاته، وإذا كانت حكمة العجائز أن الشر الذي تعرفه خير من الشر الذي لا تعرفه تصلح في صياغة مواقف مبدئية. كان يمكن أن نفعل ذلك لو لم تكن مطالب المتظاهرين واضحة ومحددة، والهتافات هي نفسها تتكرر يوماً بعد يوم، فلماذا يصر إذن، كما يصر الإعلام الذي يقول أنه ينتقده، على الاستذكاء وقراءة ما بين السطور، والكشف عن غوامض لا يراها سواهم؟ لماذا لم يرَ أحد نفس النوايا الغامضة والمقاصد المجهولة في الثورة المصرية والتونسية؟ ولماذا نتقبل حدوث حركة شعبية في أي بلد آخر غير سوريا؟ أليس من المعقول أن يخرج آلاف الناس بشكل عفوي ليطالبوا بحريتهم دون أن يكون هناك من يوجههم؟ إن كان لدى السيد حميرة وقائع ودلائل محددة، فلماذا لا يكشفها؟ بدلاً من التذرع بهاتف قناة الجزيرة الذي لا يرد على مكالماته، الأمر الذي استنتج منه أنه لا يوجد شهود عيان.
وبعد موشح في ذم المحتجين ووضعهم في سلة واحدة مع الخونة والمتآمرين، والجزم بـأنهم لا يمثلون أكثر من خمسة بالمئة من الشعب (ولا ندري من أين جاء بهذه الإحصائية)، ينهي السيد حميرة خطبته بموقف عنتري أقرب للكوميديا، التي لا نعرف أن له فيها أية أعمال. فهو كما يقول يخشى أن يرسل النظام من يقوم باغتياله. ولولا خطورة المناسبة، ولولا الدم الذي يراق كل يوم، لضحكنا. من الذي سيغتالك يا سيد حميرة؟ وهل هناك بعض هذه الخطبة العصماء من يشكك في ولائك للنظام؟ فإن كان لديهم أي شك فيك قبل ذلك، فالواجب أن يحافظوا عليك الآن أكثر مما يحافظون على الناطقين باسمهم. فهاهو واحد من غير المحسوبين على النظام، بل ممن يجهرون أنهم لا يحبونه، يستميت دفاعاً عنه ويصف المحتجين عليه بالخيانة والتآمر. فماذا يطلبون أكثر من ذلك؟ ثم لو لجأ النظام إلى منهج الاغتيالات فهناك لائحة طويلة من الأسماء التي تسبقك على القائمة، هذا إذا كنت موجوداً فيها أصلاً. وهل تقارن قولك بأنك لا تحب النظام مثلاً، ونقول مثلاً، بعبارة رياض الترك “مات الدكتاتور”، وذلك قبل بشار ومشروعه الإصلاحي والانفتاح المزعوم؟ بل هل نقارنها بجرأة المعارضين الذي يضعون روحهم في كفهم ويتحدون النظام علناً بما هو أكثر من الإسقاطات التاريخية في مسلسلات عن العصر العثماني؟ فعلاً، رحم الله امرؤاً عرف قدر نفسه.
في النهاية فإن فموقف فؤاد حميرة، رغم تناقضاته (ورغم الذات المتضخمة التي تتبدى من ورائه) متوقع ومفهوم. بل هو يمثل في رأينا تناقضات بعض المثقفين السوريين الليبراليين، الذين لا يستطيعون إعماء أنفسهم عن أخطاء النظام، ولكنهم لا يملكون الجرأة، أو لاتسمح لهم ظروفهم، بالمواجهة المباشرة، فيعمدون أولاً إلى تبرئة ذمتهم بتوجيه بعض الانتقادات للنظام، ثم يصبون جام غضبها على المعارضين، على طريقة “لست مع النظام ولكن”. وبذلك يضرب عصفورين بحجر واحد، إذ يرضي مبادئه الليبرالية أمام قرائه وأمام نفسه أيضاً، وفي نفس الوقت يضع نفسه في مأمن من انتقام النظام.
وأخيراً، يا سيد حميرة، لا أعرف إن كنت تعد مسلسلاً درامياً في الوقت الحالي، والذي سمعناه عن مسلسل وصفته بالجرأة واختراق المحظورات كالعادة لا يعد بالكثير. فالشيء الذي يجب أن تدركه أنت قبل غيرك أن سقف الحرية قد ارتفع بما يتجاوز الماضي كله، وتحديداً بفضل هذه الاحتجاجات التي لا ترى فيها إلا الخيانة، والتي لو لولاها لم استطعت إطلاق عبارة “لا أحب النظام” التي أخافتك من الاغتيال. فالشباب الذين يخرجون في كل يوم ليتحدون السلاح بصدورهم العالية هم من جيل آخر، لم يعش عصور الخوف، جيل لم تكن غاية طموحاته نكتة تقال في مسؤول، أو انتقاد لأفعال الشاب الطائش دون علم والده ضابط المخابرات. هؤلاء جيل نسي الرعب الذي شل جيل آبائهم وخفض سقف آماله إلى أدنى حد ممكن، الخوف الذي يجعلني أكتب باسم مستعار ويجعلك تنتفض رعباً من فكرة سقوط النظام وتلقي نفسك في أحضانه. وفي النهاية لا أحد يطلب منك أن تتبنى مواقف المتظاهرين، أو لا سمح الله أن تقر بشيء من مطالبهم، ولكن حاول ألا تحبط من هممهم، أو أن تعترف لهم على الأقل بحسن النية، وأن تدرك أن تجاوزهم لخطوطك الحمراء في انتقاد النظام لا يعني أنهم خونة. ربما يكونون أكثر جرأة، أو ببساطة أكثر جنوناً، وربما يكون هذا مكمن قوتهم، فالتاريخ أحياناً لا يمكن صنعه دون المجانين.
خاص – صفحات سورية –