مقالات مختارة تناولت الانسحاب الروسي من سورية
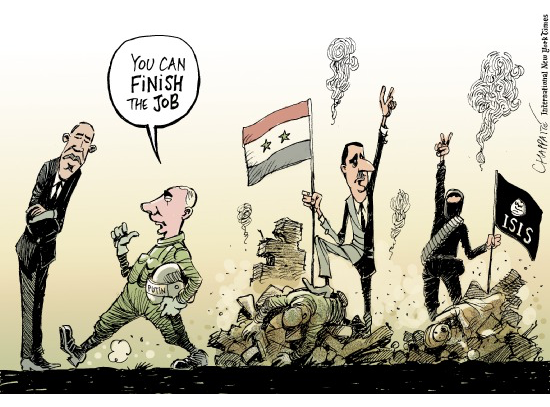
هل يذهب بوتين الى حد التخلص من الأسد؟/ غازي دحمان()
إنتهت المرحلة الاولى من مفاوضات جينيف بين وفدي المعارضة ونظام الاسد دون تحقيق تقدم يذكر، رغم كل الجهود التي مارسها الوسطاء والاطراف الدولية، ورغم محاولات الوسيط الدولي ستيفان دي مستورا البحث عن نقاط مشتركة يتوافق عليها الطرفان ويستطيع دي مستورا البناء عليها في الجولة المقبلة.
ولا يبدو ان الجولة المقبلة أو أي جولة أخرى لاحقة يمكنها تحقيق إختراقات حقيقية في جدار الأزمة السورية وبخاصة على صعيد الإنتقال السياسي، والذي يشكل جوهر الإشكالية في سورية، بل يمكن القول أنه الخيار الاكثر منطقية من جميع الخيارات في ظل محدودية إمكانية أن يغير العمل العسكري بعد اليوم الكثير من الوقائع بالنسبة لجميع الاطراف وليس طرفاً واحداً على ما يعتقد نظام الاسد وداعميه.
وواضح أن الإنتقال السياسي الذي يعني رحيل بشار الأسد بشخصه عن السلطة هو عقدة الحل التي يصعب الوصول إلى تسوية لها، والسبب أن الأسد يشكل بنفسه منظومة او نظاماً بحاله، ومن دونه بصبح الحديث عن نظام شيئاً زائداً عن اللزوم، وخاصة بعد ان تحطمت المؤسسات الشكلية التي صنعها النظام كغلاف خارجي له، مثل حزب البعث والجيش السوري، فبعد تحوله إلى ميليشيا طائفية ترتبط بمركز خارج الحدود لم يعد لتلك المؤسسات من معنى لوجودها فإنهارنت بحكم الامر الواقع.
من هنا أخذ الصراع في سورية طابعه الجيوسياسي، ومن هذه الحقيقة أصبح التفاوض بين السوريين إنعكاساً لهذا الصراع، لذلك لم نلحظ في سورية حديثاً عن مفاوضات يجري خلالها رأب الصدع بين البيئات الإجتماعية التي دخلت في صراع طاحن، ولا محاولة من قبل ما يسمى نظام دمشق المطالبة او البحث عن ضمانات لبيئته ودورها في مستقبل الحكم السوري، رغم ان فكرة الإنتقال السياسي تعطي لبيئة الأسد فرصة للإستمرار في رسم مستقبل سورية والشراكة العادلة والمتوازنة في الحكم.
عشية إنتهاء الازمات السياسية في تونس ومصر كانت الأطراف المتصارعة» الثورات والأنظمة» قد توصلت إلى تسويات معينة لعلّ أهم بنودها إبعاد رأس السلطة في البلدين مقابل مشاركة الانظمة القديمة والقوى الصاعدة في السلطة وإدارة المجتمعات، ولولا هذه التسويات لما أمكن الوصول إلى حلول بأقل الأكلاف وأقصر الأزمنة، ومن الواضح ان هذا الحل يستحيل تطبيقه في سورية، ذلك انه في الوقت الذي كانت انظمة تونس ومصر لديها شبه إستقلال عن الرأس يتمظهر بوجود مصالح وقوى متبلورة وبيروقراطيات حقيقية تتجاوز الرأس، فإنه في سورية لا يمكن ملاحظة مثل هذه البنى والتشكيلات، وما هو موجود ليس اكثر من شبكات مربوطة بخيوط يتحكم بها رأس النظام وهي شبكات غير متجذرة سياسياً وإجتماعياً.
لقد حاول بوتين عبر حملته ومن خلال تواجده في سورية البحث عن بنى لنظام الأسد يمكن أن يصنع منها بديلا للأسد، وحاول أن يستثمر وجوده العسكري في سورية كضمانة لهذه البنى، غير أن سطوة نظام الأسد المتغلغلة في النفوس أفشلت جهود بوتين الذي إكتشف أن خياراته في سورية ضئيلة وأنه بدل من صناعة مناخ تفاوضي يكون فيه وضع نظام الأسد في موقع أكثر قوة تجعله لا يخاف من الإقدام على تنازلات بحجم إستبعاد الأسد عن السلطة، وجد بوتين نفسه وقد دفع الأسد إلى التصلب بدرجة أكبر في المفاوضات.
بالطبع بوتين لا يفعل ذلك حباً بالسلام في سورية، بل لان التغيير بالنسبة له أصبح مفتاحاً لعلاقاته الدولية ولإستثمار حربه في سورية وتقديمها على انها شكّلت الحل الامثل للأزمة التي عجز العالم عن حلها، لم يكن صعباً إكتشاف محاولات بوتين تعويم دور الجيش السوري وتلميعه ليكون البديل عن بشار الأسد، لكن محاولات بوتين ستبقى تصطدم بتعنت بشار الأسد ورفض العالم أي حل بوجود الأسد في السلطة وهو ما يعني ان صفقات بوتين ستبقى مؤجلة التنفيذ وإستثماره سيبقى معطلاً ما دام الأسد باقياً.
هل يذهب بوتين إلى التخلص من الأسد مادام ليس قادراً على إقناع العالم بإستمرار وجوده في السلطة وما دام غير قادر على دفع الأسد على التنحي بالسياسة الناعمة والإقناع؟، من الواضح ان بوتين مهتم بتطوير علاقاته مع الغرب وتحديداً مع الولايات المتحدة الأميركية، كما ان لديه إهتمامات بتزخيم علاقاته مع دول الخليج للوصول إلى تفاهمات بشأن الطاقة، ولم يعد خافيا حجم المعاناة التي تمر بها روسيا نتيجة فرض العقوبات عليها، والمعلوم أن بوتين مطالب بالتنازل بأحد ملفين، أوكرانيا أو سورية، وإذا كان التنازل في أوكرانيا يعني خسارة جيوسياسية صافية، فإن المطروح عليه في سورية يبدو أسهل بكثير، الإحتفاظ بالمزايا الإستراتيجية التي حصل عليها وفتح نوافذ التواصل مع مراكز القوى الإقليمية والدولية، هذا إغراء وتحدي يواجه بوتين في المرحلة المقبلة.
() كاتب من سوريا
المستقبل
مغامرة تفسير قرارات بوتين/ غازي دحمان
حفلت الأيام القليلة التالية لإعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرار الانسحاب من سورية بآلاف التحليلات والتقديرات التي تحاول تفسير الحدث، حتى وصل الأمر إلى أن يكون للمصدر الواحد أكثر من تحليل مختلف، ومتضارب أحيانا، وهو ما يوضح حجم الفجوة المعلوماتية عن صناعة القرار في روسيا من جهة والإستراتيجية الحقيقية لهذا البلد.
حاولت مجمل التحليلات التي تناولت إعلان الرئيس الروسي الانسحاب من سورية تفسير الأمر برده إلى خلطة كبيرة من العناصر السياسية والاقتصادية والإستراتيجية التي تبدو، من الناحية الشكلية، منطقية، لكنها تنطوي دائماً على نقص يربك التفسير والفهم، إذ على الرغم من صحة المؤشرات التي يتم استخدامها في التفسير، إلا أن انطباقها على الواقع يبدو غير متناسق، كالمؤشر الاقتصادي مثلاً، والذي يتم الاستدلال به لتفسير الانسحاب الروسي، ذلك أن الوضع الاقتصادي الروسي لم يكن في حال أفضل، يوم قرر الكرملين التدخل في سورية!
لماذا انسحب بوتين؟ كان لمجلة فورين أفيرز الأميركية جواب لافت، يعكس الأزمة المعرفية في تفسير الأمر، حيث علقت “الإعلان الدراماتيكي عن الانسحاب، إلى جانب تحميل طائرات الشحن في سورية أطلقت استجابة مشابهة لاستجابة مترنيخ حينما بلغ نبأ وفاة تاليران في عام 1838 عندما قال: أتساءل ما الذي يعنيه ذلك؟”.
يحيلنا هذا الأمر إلى آلية صناعة القرار في روسيا، والذي يتميّز بخصوصيةٍ تجعله مختلفاً عن النمطية التي تحصل بها هذه العملية في العصر الحديث، في غالبية الكيانات السياسية، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بمقاربة أحداثٍ كبرى، من نوع شن الحروب أو عقد الاتفاقيات السياسية والعسكرية والاقتصادية. ففي غالبية الدول، ثمّة منهجية واضحة في اتخاذ القرارات، تتم باتباع آليات محددة، وبشفافية ووضوح غالباً، وذلك تحكمه قاعدةٌ لا مركزية اتخاذ القرارات وديمقراطيتها، وتحتّمها أيضاً ضرورة إشراك الرأي العام الذي يتحمل أفراده وزر هذه التصرفات، إن كان على مستوى المخاطر التي ترتبها القضايا محل القرار، أو على مستوى تحمل الأعباء والالتزامات، وقد رأينا هذا النموذج بشكلٍ واضحٍ في تصويت مجلس العموم البريطاني على مشروع التدخل في سورية، كما رأيناه في النقاشات الأميركية حول الانسحاب من العراق وأفغانستان.
“لا تصح مع روسيا التحليلات بعيدة المدى، والأفضل متابعتها يوماً بيوم، ومعرفة اتجاهات مزاج القيصر وحساباته وهواجسه وطموحاته”
في دولةٍ مثل روسيا، ثمّة ألف سببٍ قد يكون صالحاً لتفسير أسباب تدخلها في سورية وأسباب انسحابها. لكن، أيهما يقف خلف القرار بدرجةٍ أكبر بشأن تلك المسألة التي لا يمكن التأكد منها. وعلى هذه الشاكلة، جاءت أغلب التفسيرات، كان بعضها واسعاً وافتراضياً ومبالغاً فيه، مثل حصول تطوراتٍ في أوكرانيا استدعت قرار الانسحاب الفوري من سورية، علماً أن الأمور كانت أسوأ بما لا يُقاس في أوكرانيا، عندما قرّر بوتين التدخل في سورية، وبعضها بدا ضيقاً إلى درجةٍ لا يمكن تطويره مؤشراً، مثل انزعاج موسكو من تصريح بشار الجعفري عن عدم وجود شيء اسمه حكم انتقالي، مع أن المفترض أن روسيا التي ساهمت بدرجة كبيرة في صناعة سياق العملية التفاوضية تمسك بكل مفاتيحها!
المؤشر الأكثر سطوعاً على حجم الإرباك في تفسير السلوك الروسي، والناتج عن عدم المعرفة بالأسباب المركزية خلف القرار، أن مجمل التحليلات كانت تبدأ بـ “ربما”، وتنهي بـ “من السابق لأوانه الحكم”، وما بينهما سيل من التكنهات التي تتجاوز ذكر عشرات الأسباب، بما ينزع عنها صفتها التفسيرية، ويجعلها أقرب إلى كلامٍ تنجيمي صرف، حتى تصريحات المسؤولين التي يفترض أن تكون أكثر تحديداً ودقةً، استعملت التقنيات الآنفة الذكر.
بالطبع، لا يُلام من يخوض في تفسير السلوك الروسي على هذه الإشكالية، وخصوصاً حينما نكون أمام سلوكٍ وقراراتٍ تترك الأبواب مفتوحةً أمام خياراتٍ وبدائل عديدة، يصعب حصرها، ويصعب معرفة أي منها سيتحول إلى سيناريو عمل، تطبيقاً للقرار المتخذ، ودليل على ذلك أنه في وقتٍ يعلن الكرملين عن مغادرة الطائرات الروسية مطار حميميم، تأتي الأنباء من سورية عن إغارة طائراتٍ روسيةٍ على بعض المواقع، وفيما تنسق روسيا مع إسرائيل، بشأن انسحابها من سورية، تعلن إيران أنها ستزيد من حجم دعمها في الميدان السوري، بإرسال آلاف القناصين والجنود المحترفين؟
هل كل ما يتم كتابته عن روسيا مجرد تصوراتٍ، وليست حقائق؟ لعل المشكلة الأكبر في محاولات تشخيص الحالة الروسية أن تأثير المعطيات التي يجري بناء التفسيرات عليها ليست كافيةً وحدها في الحالة الروسية، مثل المعطى الاقتصادي، أو الرأي العام، أو توجهات النخبة، ثمّة عامل يشترك دائماً مع هذه المعطيات، ويعطب قدرتها التفسيرية، وهو العامل الفردي، أي دور الفرد في صناعة القرار، وهو هنا في الحالة الروسية فلاديمير بوتين. لذا، فإن أغلب التفسيرات لا تأتي على ذكر الاستراتيجية الروسية، مثلاً، بقدر ما تتحدث عن ذكاء القيصر وحساباته، وقدرته على التقاط الفعل في اللحظة السياسية المناسبة.
على ذلك، لا تصح مع روسيا التحليلات بعيدة المدى، والأفضل متابعتها يوماً بيوم، ومعرفة اتجاهات مزاج القيصر وحساباته وهواجسه وطموحاته، أما روسيا فهي بمثابة بلد كل شيء يقف فيه على حرف، الاقتصاد والعسكر، وحتى الديمغرافيا، وبقدر ما هو قابل للانتصاب، يبدو قابلاً للسقوط، بلد صارت قوته في سر غموضه، لذا خاسرٌ من يحاول الدخول الى عقل فلاديمير بوتين، ومحاولة تفسير قراراته، بل تتحوّل الخسارة إلى هزيمةٍ، إذا اتخذت العملية طابعاً منهجياً، مثل الذي يتم تطبيقه على قرارات صنّاع القرار العاديين.
العربي الجديد
خيبة بوتين السورية/ عمر قدور
لا ينفك التدخل الروسي في سوريا عن أن يكون مصدراً للتكهنات، ليظهر بوتين كأنه لغز يصعب حله، وليمنح محللون سياسيون أنفسهم حق الشطط في تأليف السيناريوهات، وأيضاً الشطط في استنباط نوايا ليس لها ما يسندها على الأرض. أما للتخلص من خطأ موجة التكهنات، عندما يثبت السلوك الروسي خطأها، فيكفي الحديث عن بوتين بوصفه صاحب مفاجآت، الأمر الذي يزيد في مهابته، بل يكرسه أحياناً في المكانة التي كانت طوال عقود حكراً على الرئيس الأميركي الذي تلتبس صورته بصورة الكاوبوي السينمائية.
هكذا، يمكن مثلاً القول بأن مبادرة بوتين لتهنئة بشار، إثر استعادة تدمر من سيطرة داعش، مفاجئة بعد الإهانات التي وجهها مسؤولون روس له، وبعد القول بأن الانسحاب الروسي إثر تلك الإهانات صفعة قوية لبشار. ستغيب في هذا السياق تفاصيل كثيرة، من قبيل عدم وجود أدنى ضغط روسي على وفد النظام أثناء جولة التفاوض الأخيرة في جنيف، وستغيب مثلها جزئية سحب الروس اعتراضهم على انتخابات “مجلس الشعب” التي ينظمها النظام استباقاً لنتائج المفاوضات، وقد يغيب أيضاً التأكيد الروسي على أن الجانب الأميركي بات أكثر تفهماً لبقاء بشار في السلطة.
لكن أهم ما يغيب عن بورصة التكهنات تلك هو العامل الإيراني. فمنذ بدء العدوان الروسي على السوريين توارى التركيز على التأثير الإيراني، لتبدو الميليشيات الشيعية كأنها مجرد كومبارس في العمليات العسكرية التي يديرها الروس، مع أن التنسيق كان على أشده في كافة العمليات انتهاء باستعادة تدمر مؤخراً. وكما نذكر، أريق حبر كثير لإثبات وجود خلاف بين طهران وموسكو، بخاصة من الأقلام التي ترى الصراع السوري من منظار الصراع الشيعي/السني في المنطقة، وكان رهانها على الكاوبوي الجديد أن يزيح إيران وينفرد بالسيطرة على نظام بشار. ولم يخلُ ذلك من الرهان على أن يتفوّق التنسيق الروسي/الإسرائيلي على حلف موسكو/طهران، مع تجاهل واقع عدم تأثير علاقة موسكو الممتازة بإسرائيل على علاقتها بطهران من قبل.
على صعيد متصل، كان من الشطط ردّ سحب جزء من القوات الروسية إلى ضغط على بشار، إذ كان من الأجدى التهديد بسحبها، مع العلم بأن سحبها قد يقلل من التأثير الروسي الذي صُوّر على أنه صار طاغياً. بالمثل، كان من الشطط ردّ الانسحاب إلى هزيمة روسية أمام إرادة السوريين، أو التخوف من الغرق في المستنقع السوري على المثال الأفغاني، إذ كانت الآلة العسكرية الروسية تعمل في أفضل حالاتها، بينما لم يقابلها أدنى دعم من قبل حلفاء المعارضة، ولم يكن متوقعاً وصول دعم نوعي يغير من موازين القوى.
الاحتمال الذي غُيّب وفق هذه المعطيات أن يكون سحب قسم من القوات الروسية إشارة غاضبة إلى الحليف الإيراني، أو ربما بالتنسيق معه. التدخل الروسي أتى أصلاً بالتنسيق التام مع طهران، التنسيق الذي تبرزه زيارة قام بها قاسم سليماني إلى موسكو قبل التدخل، وزيارة قام بها بوتين أثناءه إلى طهران، وتخللها لقاء ودي مع خامنئي. أي أن التدخل لم يكن ممكناً لولا المباركة الإيرانية، ولم يكن استمراره في أي وقت ممكناً بالوتيرة ذاتها إلا ضمن التنسيق التام بين الطرفين. بشار ليس سوى تفصيل، أو كناية عن النفوذ الإيراني الأكبر، ولو كان لموسكو ما أشيع لها من نفوذ لما اقتضى الأمر توجيه الإهانات إليه على الملأ، ولكان قد انصاع للمشيئة الروسية تماماً.
الانسحاب الجزئي الروسي قد يشكل خيبة، ومن المرجح أنه لم يحقق أهدافه لجهة الإمساك بالملف السوري. هذا انتصار صامت لطهران التي تمسك فعلاً بمفاتيح النظام على الأرض. وما أشيع عن علاقات بدأت موسكو بنسجها مع ضباط في قوات الأسد فيه قدر كبير من المبالغة والتهويل، فطهران سبقت موسكو بأربع سنوات على الأرض، وهي التي رتبت المسؤوليات الأمنية والعسكرية ربطاً بها، وهي التي أنشأت ميليشيات دربها الحرس الثوري وتأتمر بقراراته أولاً. أي أن كل ما قيل عن إمساك موسكو بقرار النظام لا يعدو كونه تضليلاً، وفيه ما فيه من الشطط عن الشراكة بين الجانبين، وعدم وجود مصلحة روسية حالية بالتخلي عنها.
خلافاً لذلك، لا تستطيع موسكو تنحية بشار إلا بالاتفاق مع طهران، وهي لم تفعل شيئاً منذ انطلاق عملية فيينا وبعدها جنيف سوى العمل في إطار الخطة الإيرانية التي سبق أن رفضتها المعارضة مع حلفائها. السيناريو الذي تعمل بموجبه موسكو على تنحية بشار هو مغاير كلياً، ويتطلب سلة كبرى من المقايضات، تقايض فيه بحلفها مع إيران على مكتسبات دولية وإقليمية غير مطروحة على الطاولة الآن. قد تبادر موسكو إلى تنحية بشار منفردة، ما يعني ضرباً لشراكتها مع طهران، في حال تحققت لها عائدات تبدأ من إقرار أمريكا والغرب برؤيتها للحل الأوكراني ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، وصولاً إلى تسوية مجزية تخص التنافس في قطاع النفط والغاز مع دول خليجية. مثل هذه التسوية تقتضي تنازلات أمريكية وغربية غير متوقعة إطلاقاً، فبشار وسوريا ليس لهما غربياً قيمة توازي الثمن المطلوب، ولا أسهل من ابتلاع المقايضة المطروحة أصلاً بينه وبين “الإرهاب”.
بهذا المعنى، الانسحاب الروسي بعد أن أدى التدخل دوره في تغيير موازين القوى لصالح النظام لا يزعج طهران أو رجالاتها في سوريا، على العكس الإزعاج قد يأتي من بقاء الثقل العسكري الروسي. فوق ذلك، الانسحاب الجزئي يخفف من مسؤوليات موسكو أمام المجتمع الدولي إزاء تنحية بشار، طالما أن المقايضة المطلوبة غير متاحة. قد تكون هناك خيبة روسية، لأن الحملة العسكرية لم تحقق أهدافها القصوى، لكنها أيضاً خيبة لأولئك الذين راهنوا على الكاوبوي الروسي أن ينجز ما كان عليهم فعله.
المدن
الباطنية الروسية/ باسل العودات
أثار قرار روسيا سحب جزء من قواتها العسكرية من سورية الكثير من الجدل والنقاش، خاصة بسبب سرعته ومباغتته وغرابته، وحاولت المعارضة السورية تفسير هذا القرار وتنوعت الآراء والتحليلات بتنوع مزاجيات وإيديولوجيات وثقافة هذه المعارضة، لكنها أجمعت بغالبيتها على وجود تحوّل في الموقف الروسي وبداية افتراق عن النظام السوري الذي دعمته بشكل مطلق وعرقلت كل قرارات مجلس الأمن من أجل عدم سقوطه.
استندت المعارضة السورية في تأويلها للانسحاب الروسي إلى فرضيات ليست من بينها أية فرضية حاسمة أو مُقنعة، حيث اعتبر البعض أن الخطوة الروسية هي رد على مشاكسة الأسد وعصيانه، واعتبر آخرون أن الانسحاب خطة لإضعاف موقف النظام السوري تفاوضياً في جنيف ودفعه للقبول بحل سياسي وسط، فيما رأى آخرون أن روسيا (هربت) من سورية خوفاً من الغرق في المستنقع السوري، أو خوفاً من عجز اقتصادي بسبب تكلفة الحرب الباهظة، وذهب البعض إلى أبعد من ذلك في فرضياتهم إلى حد التأكيد على أن روسيا أعادت حساباتها بعد أن رأت صور مضادات جوية بيد الثوار.
سرعان ما تبيّن عدم صوابية كل هذه الفرضيات، وثبت تسرّع المعارضة السورية في إطلاق أحكامها وقراءاتها للأحداث (كعادتها)، إذ اتّضح أن روسيا لم تسحب إلا جزءاً من قواتها ولوّحت بالعودة خلال ساعات، وأكّدت أنها لا ترمي لإضعاف النظام السوري أو الضغط على النظام الذي يقول الواقع أنه لم ولن يقدر على عصيان من حماه طوال خمس سنوات، واتّضح أيضاً أن روسيا لا تسعى بأي شكل من الأشكال للضغط عليه لتقديم تنازلات في مفاوضات جنيف، كما لم يكن سبب الانسحاب الجزئي التكاليف الاقتصادية للحرب والتي لا توضع بالحسبان عند الحديث عن مكاسب استراتيجية لدول كبرى.
بعد أسبوعين من إعلان الانسحاب الروسي العسكري الجزئي تبيّن أن روسيا لم تُغيّر مواقفها السياسية والعسكرية واستمرت حليفة وفيّة للنظام السوري، فتابعت عملياتها الحربية بعدم الاكتراث نفسه، وواصلت تدريبها الحي فقصفت مقاتلين ومدنيين بحجة استهداف تنظيم الدولة الإسلامية، ولم تضغط على النظام لتخفيف تشدده في مفاوضات جنيف، بل إنها لم تفعل شيئاً لتأجيل انتخابات برلمانية عبثية يُنظمها النظام الشهر المقبل، ولم يصدر عنها ما يمكن أن يوحي بأنها ترغب بإنهاء الأزمة السورية بطريقة معقولة.
في معرض تحليلها وتفسيرها للخطوة الروسية، نسيت المعارضة السورية أن السياسة الروسية خلال العقدين الأخيرين مبنية على دعم “أسوأ السيئين” في العالم، وأنها لن تتخلى عن أصدقائها أصحاب الأنظمة الشمولية الطاغية، مُغتصبي الحريات، المهرة بانتهاك الحقوق ونهب الثروات، ولن تترك للشعوب فرصة لتقرير المصير بعيداً عن هؤلاء الحكام، وأن قادة روسيا ينتهجون سياسة (باطنية) تتناقض فيها الأقوال مع الأفعال، ويضمرون عكس ما يُعلنون لتسهيل الوصول لأهدافهم، ويبدو أن المعارضة السورية لم تجد من يُذكّرها بضرورة مضاعفة الحذر قبل إطلاق أي حكم على تصرفات (النظام) الروسي.
تجلّت (باطنية) أو (ازدواجية) أو (مخاتلة) روسيا خلال الأزمة السورية بمواقف عديدة، فمع بدء الثورة قدّمت روسيا نفسها على أنها وسيط حيادي بينما كانت في الكواليس تدعم النظام السوري سياسياً وعسكرياً، بالمال والسلاح والخبراء، وبعد افتضاح هذا الدعم ولإخفاء نواياها، حمّلت بعض مسؤولية قتل السوريين للنظام، لكنها سرعان ما بررت ذلك بأنه رد فعل طبيعي ومشروع للدفاع، وفي مرحلة لاحقة حلفت أغلظ الأيمان بأنها غير متمسكة بالأسد ولا تربطها به أي صلة خاصة، واتّضح أن علاقتها بالأسد الابن أكثر عمقاً من علاقتها بالأب، وأنها حاضنته وشريان حياته، كذلك حاولت اجتذاب المعارضة السورية بوعود براقة، وسرعان ما تبيّن أنها نصبت كمائن لمن تجاوب معها منهم، كما ادعت أنها تتدخل عسكرياً لتحارب (داعش)، وتبيّن أن أول همومها تدمير فصائل المعارضة التي تؤرق النظام و(داعش) آخرها، وقالت إنها فاوضت فصائل المعارضة المسلحة التي سرعان ما نفت وكذّبتها، وشددت مراراً على وحدة سورية أرضاً وشعباً، ثم تبيّن أنها أول من حرّض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري لإعلان فيدراليته، كما مهّدت الطريق للنظام لإعلان دويلته فيما لو وُضِع في الزاوية.
هذا بعض من فيض السياسة الروسية المُخاتلة، والتي يراها زعماء روسيا حِرفيّة سياسية وليس مرضاً أخلاقياً، حرفيّة سياسة سهّلت على روسيا تثبيت تواجدها في المتوسط لأجل غير مُسمّى عبر قواعدها العسكرية في الساحل السوري، وهي بإعلان انسحابها إنما تواصل أسلوب اللعب نفسه لتحقيق أشياء أخرى ليس من بينها حرية الشعب السوري وكرامته.
يبدو أنه من الأفضل للمعارضة السورية أن لا تّخطىء وتتسرع في المرة الأخرى بتفسير أي تصرف أو تصريح أو ادّعاء روسي، لا على الصعيد السياسي ولا العسكري، ولا حتى على صعيد نشرة الأحوال الجوّية، فسياساتها (الباطنية) ليست أحسن حالاً من سياسات النظام السوري الذي جعل التضليل والخداع والتآمر والكذب نهجاً، وعلى هذه المعارضة الانتباه أن لا تقع في الحفرة نفسها مرات عديدة.
المدن
روسيا تنسحب من سورية؟/ سلامة كيلة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن سحب “معظم” قواته من سورية. كانت الخطوة مفاجئة وأثارت تكهنات كثيرة، وترحيباً مبالغاً فيه من أطراف متعددة، بما في ذلك أطراف المعارضة. وأثارت أيضاً خشية وترقباً وخوفاً من النظام وداعميه. هل حققت روسيا أهدافها لهذا قرّرت الانسحاب؟ أو أن الأمر متعدد الأهداف؟
لكن، أولاً، ما هي الأهداف الروسية؟ باختصار، كان الهدف هو وضع اليد على سورية، ولقد فعلت ذلك. وأرادت إظهار قوتها، وأيضاً فعلت ذلك. وثالثاً تكريس أنها قوة عالمية أساسية، أو حتى أنها القوة العالمية الأساسية، كذلك فقد حققت ذلك. ما كان يبدو أنها تريده هو تكريس بشار الأسد رئيساً لسورية من خلال سحق الثورة، ولا شك أن طموحها هذا ارتبط بكون بشار الأسد هو من وقّع على كل الاتفاقات معها، بما في ذلك الوجود العسكري “الرسمي” في سورية، والحصول على اتفاقاتٍ اقتصاديةٍ تتعلق بالنفط والغاز والمشاريع الاقتصادية الأخرى. وهو ما يعني تحقيق السيطرة العسكرية والنهب الاقتصادي معاً.
ظنت أنها قادرة على تعديل جذري في ميزان القوى لمصلحة النظام، من خلال القصف الجوي العنيف الذي مارسته، وشكّل شكلاً من أشكال التدمير الوحشي، كما فعلت في غروزني في جمهورية الشيشان. وعلى ضوء ذلك، تستطيع السيطرة على معظم مناطق سورية التي خرجت عن سيطرة النظام، الأمر الذي يعني فرض “الحل السياسي” الذي تريده، والقائم على إشراك أطرافٍ تعتبرها معارضةً في “حكومة موسعة”، ليكون هذا هو الحل النهائي لـ “الأزمة” التي تعيشها سورية. لكنها انسحبت قبل أن تحقق ذلك، وهذا ما أثار التساؤل حول الأسباب التي دفعت بوتين لسحب الجزء الأكبر من قواته، كما أعلن، حيث ظهر أنها فشلت في سحق الثورة، وتغيير ميزان القوى جذرياً لمصلحة النظام.
لماذا قرّر بوتين ذلك قبل أن “يُنهي المهمة”؟
هذا ما يجب التمحيص فيه. لكن، يجب الإشارة إلى أن روسيا لم تسحب قواتها، بل سحبت بعضها، بعد أن أصبح لها قواعد عسكرية في سورية، تستلزم بقاء قوات كبيرة. لكنها سحبت قوات الطيران “الزائدة”، التي كانت تستخدمها لقصف الجيش الحر، وتمهيد التقدم لقوات النظام التي هي، في الغالب، قوات من حزب الله وإيران وأشتات من العالم. على الرغم من ذلك، تعني هذه الخطوة “التخلي” عن أحد أهداف التدخل العسكري الروسي، والمتمثل في سحق الثورة وتحقيق انتصار الأسد، لأن سحب جزء من القوات مع التزام عدم القصف العنيف للجيش الحر (مع بقاء بعض القصف) يعني أن روسيا أوقفت محاولتها لتحقيق تقدم أكبر لقوات النظام تلك، وكرّست “الأمر الواقع” القائم على سيطراتٍ متعددة على الأرض السورية، بما في ذلك الجيش الحرّ الذي كان مستهدفاً بالأساس من الطيران الروسي.
هل يعني ذلك أن روسيا قرّرت تعديل ميزان القوى على الأرض، من أجل أن تكون المفاوضات “متكافئة”، بعد أن كان ميزان القوى العسكري مختلاً صيف 2015 لمصلحة الثورة؟ هذا ما صرّح بوتين به، حيث أفاد أن القوات الروسية قامت بمهمتها من أجل التمهيد للمفاوضات، بعد أن كان النظام مهدداً بالسقوط، الأمر الذي يخالف المبرّرات التي رافقت التدخل، والتي قامت على محاربة الإرهاب، ويخالف الهدف العملي الذي هو بقاء الأسد.
حصلت روسيا على قواعد عسكرية طويلة المدى في سورية، وأصبحت المسيطر على القرار السياسي في النظام. لكنها، كما يبدو، حصلت على اتفاق مع أميركا، يؤكد سيطرتها على سورية، ويجعل أميركا عنصراً فاعلاً في تكريس ذلك، ربما بإبعادها دور دولٍ إقليميةٍ، مثل تركيا، عن التدخل في سورية، وحصلت على “سيطرة اقتصادية” كذلك. وبعد ذلك كله، حصلت على وقف إطلاق النار، وتكريس التقدم الذي حصلت عليه قوات النظام بفعل التدخل الروسي. ومن ثم لتكون “جنيف 3” المدخل لتكريس الحل الذي يعني سيطرة روسيا على سورية، والذي بات ممكناً بدون الأسد.
العربي الجديد
رسائل بوتين في إعلان انسحابٍ من سورية/ باسل الحاج جاسم
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء انسحاب قوات بلاده من سورية، وأن تدخّل بلاده العسكري حقق معظم أهدافه، بعد مضي قرابة ستة أشهر، أي ضعف المدة التي كانت موسكو قد حدّدتها لتدخلها. وجاء الإعلان مفاجئاً، ويكتنف تداعياته وخلفياته غموضٌ كثير، ففي وقتٍ ذهب بعضهم فيه إلى اعتباره خطوةً تجاه تسوية سياسية، اعتبره آخرون يعكس رغبةً روسيةً بعدم التورّط في المستنقع السوري إلى ما لا نهاية. وقد جاء إعلان بوتين الانسحاب، ولا تزال قبضة الأسد على سورية مهتزة، واقتصاد روسيا الذي تأثر بانخفاض أسعار النفط، يتوقع أن ينكمش بنسبة 1 في المئة، هذا العام، وأن يواجه ركوداً طويل المدى، ولا تزال العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب عدوانها في أوكرانيا مستمرة أيضا.
كان الهدف من التدخل العسكري الروسي إنقاذ نظام الأسد من السقوط، وإضعاف أعدائه، فقد تمكنت روسيا من إضعاف فصائل الجيش الحر في مناطق شمال سورية. وعلى رغم من تمكين مليشيات كردية انفصالية من بسط سيطرتها ونفوذها على مناطق شاسعة لم تكن تحلم بها، تمتد من شرق سورية إلى غربها، إلا أنها فشلت في عزل تركيا عن كامل الشمال السوري. وإضافةً إلى إنقاذها الأسد في سورية، أرادت روسيا ضمان مصالحها، وعرض قواتها العسكرية، واختبارها، بالإضافة إلى استهداف التنظيمات المتطرفة، بسبب مشاركة المواطنين الروس في نشاطها، كما حاول بوتين ربط تحركاته في سورية بملفاتٍ أخرى، مثل نزاع أوكرانيا، والخلافات مع الاتحاد الأوروبي والعقوبات الغربية على روسيا.
عملت روسيا في تدخلها العسكري في سورية على تحقيق أهدافٍ جيوستراتيجية، وقد نجحت، إلى حد كبير، فيها، على الرغم من فشلها في تحقيق بعض تلك الأهداف، وجاء قرار إعلان الانسحاب، في ظل انخفاض أسعار النفط الذي ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الروسي، كما أن موسكو تدرك أنها تغوص، يوماً بعد يوم، أكثر فأكثر، في التفاصيل السورية التي تتحوّل إلى مستنقع، وقلق بوتين من أن أكثر من طرفٍ إقليمي ودولي يرغب في جعل التدخل الروسي في سورية يتحوّل، مع مرور الوقت، إلى استنزاف.
واللافت أن شعبية بوتين ارتفعت إلى ما يقارب 85%، بعد ما كانت 60%، بفضل سرعته في تنفيذ العملية، وإنجاز بعض أهدافها، بعيدًا عن تكبد الخسائر وهزّ هيبة روسيا، كما حدث في أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي.
كما أحدثت روسيا، على صعيد الجبهة الخارجية، صدى قوياً لنفسها، حيث حققت جزءاً كبيراً من أهدافها في سورية، وأنزلت كميات ضخمة من الصواريخ العابرة للقارات من بحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط، وأضافت إلى قاعدة طرطوس العسكرية قاعدة حميميم، وحدّت، إلى حدٍّ كبير، نشاط أنقرة في الشمال السوري، الأمر الذي أعاق تحرّك تركيا في استهداف الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابياً في تركيا وحلف الناتو، في مليشيات كردية انفصالية. وبالتالي، أسهمت في إضعاف قوات المعارضة المعتدلة على عدد من الجبهات، نتيجة انقطاع الدعم اللوجستي البري والجوي الذي كانت تقدمه تركيا، أو الأطراف الأخرى، من خلال الأراضي التركية إلى قوات المعارضة.
وقد تزامن إعلان بوتين مع استئناف محادثات جنيف، ويمكن أن يكون هذا التوقيت مهماً، حيث
“زرعت روسيا بذرة مشروع تمزيق سورية في خريطة قصفها الجوي المكثف” يرى مراقبون إعلان روسيا الانسحاب، بالتزامن مع بدء مفاوضات جنيف، رسالة إلى الأطراف الإقليمية بالدرجة الأولى التي اعتبرت أن روسيا، بتدخلها العسكري، أبعدت الحل السياسي، وعقدت الوضع السوري المعقد أصلاً. كما أن إعلان الانسحاب جاء بعد اتهاماتٍ لروسيا، من منظمات دولية، بارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم حرب، فهي بإعلانها الانسحاب، ترفع يدها، ولو “إعلامياً” عما ستقوم به لاحقاً، وهي، بكل تأكيد، لن تتوقف عن شن الغارات الجوية، بل وستشارك بفعاليةٍ في أي معارك مقبلة، خصوصاً ضد تنظيم الدولة الإسلامية ورافضي التفاوض مع الأسد.
كما يمكن تفسير قرار بوتين بأنه عكس إرهاقاً متزايداً من الغوص المتواصل في الحرب، وقد ذهب مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى القول إن تدخل موسكو كان يمكن أن تترتب عليه نتيجة غير مقصودة في جر روسيا إلى مستنقع الحرب واستعداء السنة على امتداد المنطقة، وهو ثمنٌ ربما لا يكون بوتين قادراً على دفعه.
بالإضافة إلى أن روسيا فشلت في إحداث أزمة لاجئين لبعض الدول الأوروبية، والتي تتصدّر فرض العقوبات على موسكو، لموقفها في أوكرانيا، بسبب الاتفاق التركي الألماني حول اللاجئين السوريين، وفشلها في جعل قوات الأسد تبسط سيطرتها الكاملة على مدينة حلب، والنجاح الكبير الذي حققته برياً، كان في ريف اللاذقية، أما في القلمون ودير الزور وريف حلب، بقيت الخارطة العسكرية متشابكة.
وصحيح أن روسيا جاءت إلى سورية بقواتها، لتعزيز سلطة الأسد، إلا أن الأشهر الستة الماضية عكست شيئاً آخر أيضا، وكان أخطر ما قامت به إضعاف الجيش الحر، وزرع بذرة مشروع تمزيق سورية في خريطة قصفها الجوي المكثف، حيث رسمت حدوداً جديدة، بدعمها مليشيات كردية، وجعلتها أمراً و اقعاً في سيطرتها على مناطق تقطنها أغلبية عربية مطلقة، لتحقيق التواصل الجغرافي الذي تفتقده المناطق التي سبق أن كانت تحت سيطرتها، فهي لم تكن تمتلك أي مقومات جغرافية، أو ديمغرافية لإقامة أي كيان فيدرالي أو انفصالي، إلا أن ذلك تغيّر جزئياً بعد التدخل الروسي. وبذلك، لا تضع موسكو فقط حدود تمزيق سورية، وإنما تقوّض سلطة الأسد على كامل سورية، والتي جاءت لتعزيزها، بالإضافة إلى أن قواعدها في اللاذقية وطرطوس استطاعت تأمين وجود مشروع مستقبلي لدويلةٍ علويةٍ، أو ما بات يطلق عليه سورية المفيدة.
الأكيد أن لا أحد، على وجه الدقة، يعلم حجم القوات التي أدخلتها روسيا إلى سورية. وبالتالي، من الصعب معرفة عن أي انسحاب تتكلم موسكو. ولمعرفة حقيقة إعلانها الانسحاب، لا بد من مراقبة سلوكها في الفترة القريبة المقبلة، لا سيما إعلان بوتين بقاء قوةٍ لحماية قاعدتيه العسكريتين في سورية، من دون تحديد حجمها، ما يعني أنه انسحب إعلامياً، ليبقى فعلياً.
تبقى الإشارة إلى رسالة مهمة أراد بوتين بإعلان الانسحاب من سورية توجيهها إلى الداخل الروسي، ولاسيما إلى جنرالات وزارة الدفاع، بأنه صاحب الكلمة العليا في روسيا، ولاسيما بعد ما تردّد عن إمكانية أن يكون حادث إسقاط الطائرة الروسية التي قالت تركيا إنها اخترقت أجواءها، كان نتيجة تنافس بين جنرالات البلدين، ولا يعكس حقيقة موقف القيادة السياسية في موسكو أو أنقرة. وتؤكد ذلك مؤشرات التهدئة مع الأتراك التي باتت تصدر من موسكو، بعد إعلان الانسحاب من سورية، وجديدها من ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية لوزارة لخارجية الروسية، أن الأزمة بين روسيا وتركيا عابرة.
العربي الجديد
ماذا تخطط روسيا وأميركا للمنطقة؟/ عبدالعزيز التويجري
تبدو ملامح تقسيم سورية واضحة في الأفق، تنفيذاً للتفاهم الروسي الأميركي حول الحل السياسي للأزمة السورية في إطار الخريطة الجديدة للمنطقة التي تم رسمها، أو التي هي في المرحلة الأخيرة من رسمها، بحيث ستكون سورية المستقبل القريب غيرها بالأمس. ومن المؤكد أن الدولتين تفاهمتا على توزيع الأدوار، أو لنقل بعبارة أشد صراحة، «تقاسم الكعكة»، بحيث تنال كل واحدة منهما الحصة المقررة لها، على أن يكون «النصيب الأكبر» لموسكو، برضا من واشنطن التي يظهر أن «حصة الأكراد» ستكون من نصيبها. ولنا أن نقيس على ذلك ما استقام لنا القياس.
منذ سنوات عدة، تم التخطيط لتقسيم دول المنطقة ومنها سورية، وعقدت القوى العظمى العزم على التدخل في المنطقة لصياغة نظام إقليمي جديد يتوافق مع السياسة التي تنهجها في التعامل مع المتغيرات التي يشهدها الإقليم، والتي ترمي من ورائها إلى تأمين مصالحها الاستراتيجية، وفي مقدمها أمن الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، وإنْ على حساب مصالح دول المنطقة الأخرى وضد إرادتها، وبالمخالفة لسيادتها الوطنية. وتبيّن اليوم، بالوضوح الكامل، أن الظروف باتت مناسبة لتحقيق تلك السياسة التي لا نجد وصفاً يليق بها من كونها السياسة الاستعمارية الجديدة، التي تطبق في العالم العربي على مراحل.
لقد أصبحت سورية قاب قوسين أو أدنى من التفتيت إلى كيانات هجينة بدعوى أن النظام الكونفدرالي هو الذي يناسب سورية، ويتلاءم مع طبيعتها السكانية، وهو إلى ذلك المخرج الوحيد من الأزمة السياسية الطاحنة التي يعاني منها الشعب السوري في الداخل والخارج. والواقع أن الدولة الاتحادية لن تكون الدولة النموذجية في هذا البلد المنكوب بالنظام الاستبدادي المفروض عليه منذ أكثر من نصف قرن. فلقد حاولت فرنسا، التي احتلت سورية تحت مسمى الانتداب في مطلع العشرينات، تقسيم هذا البلد. ولكن ما لبثت أن فشلت في خطتها، فاسترجعت سورية وحدتها، واستكملت سيادتها، إلى أن حصلت على استقلالها في منتصف الأربعينات، وإن دخلت منذ عهد الاستقلال في دوامة من الانقلابات العسكرية، انتهت باستيلاء الفريق حافظ الأسد، الذي ينتمي الى طائفة صغيرة في سورية، على الحكم في 1970، والذي جعل من سورية سجناً طائفياً حديدياً ورثه لابنه طبيب العيون بشار الأسد، الذي فقد بصيرته، وفاق أباه في التعسف والقتل والتدمير وفي تسليم البلاد إلى قادة إيران أولاً، ثم إلى روسيا، بثمن بخس، هو الاستمرار على سدة الحكم، ولو على أشلاء الشعب السوري الذي هاجر نصفه إلى خارج البلاد هائماً على وجهه في الأرض، يبحث عن الخلاص والحرية والكرامة التي افتقدها في وطنه المسلوب منه.
ويجرى تنفيذ تقسيم سورية في معزل عن مجموعة الدول التي اجتمعت في ميونيخ، وعن بيانات جنيف 1 وجنيف 2، وخارج المفاوضات التي تجرى في جنيف، أو تلك التي من المفترض أن تتم بين المعارضة ونظام بشار الأسد تحت رعاية الأمم المتحدة. وبذلك تكون الدولتان الراعيتان للحل السياسي تصنعان الحل وفق مصالحهما فقط لا بما يتفق ومصالح الشعب السوري. وفي ذلك انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وتكريس لمبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، ويمهد لمرحلة جديدة ينفرد فيها القطبان الروسي والأميركي، بالهيمنة على السياسة الدولية، ويردّ العالم إلى عصر الاستقطاب وتوزيع مناطق النفوذ على الدولتين العظميين. وفي ذلك انتكاسة للنظام العالمي، ستكون لها مضاعفاتها الخطيرة، وآثارها السلبية على السلم والأمن الدوليين.
ومما يزيد في خطورة هذا الوضع الغامض الذي تصنعه هاتان الدولتان، أن الدول الثلاث الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن، تتصرف وكأن هذه الأزمة الخطيرة والمستفحلة لا تهمها من قريب أو بعيد، وأنها لا تتحمل نصيبها من المسؤولية عنها باعتبار أنها مع الدولتين الأخريين، يمثلون القوة المفترض فيها أن تحفظ السلم والأمن في العالم، وكأن الآثار المدمرة لهذا الوضع المستجد لن تصل إليها. وهذا خطأ جسيم وخداع للنفس إن لم يكن خداعاً للعالم، وصرفاً للانتباه عن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام بشار الأسد الذي يحتمي بروسيا وبإيران وميليشياتها الطائفية.
في ظل هذا الوضع الخطير، تجد الدول العربية نفسها محصورة بين إرهاب مشبوه الهوية وتغول إيراني طائفي من جهة، وبين استعمار واضح المعالم من جهة أخرى. ولا يعلم أحد ماذا سيحدث لاحقاً للمنطقة. ولذلك فإن من الحكمة وعزم الأمور تقوية التحالف الإسلامي الذي تقوده الرياض، وأن يواجه الجميع تحديات الإرهاب والطائفية والاستعمار الجديد بأقصى حد من الحزم والعزم والحسم، حفاظاً على وحدة سورية، وحماية لحقوق شعبها، ودرءاً للخطر الداهم الذي يحيط بدول العالم العربي الإسلامي كافة، والذي بات حقيقة وليس وهماً.
* أكاديمي سعودي
الحياة
الصراع المعلّق في سورية يفسّر انسحاب روسيا الجزئي/ يزيد صايغ
يستمر الانسحاب العسكري الروسي الجزئي من سورية الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إثارة قدر كبير من التعليقات. وهنا تبرز ثلاثة تفسيرات لهذا الانسحاب. أولها يرى أن بوتين يهدف إلى تقليل الخسائر الروسية، وهو رأي ردّده أعضاء المعارضة السورية التي صورت الانسحاب باعتباره نتيجة لمقاومتها المسلحة، على الرغم من أن هناك القليل من الأدلّة على هذا الادّعاء. التفسير الثاني، والذي يشير في شكل صحيح إلى أن روسيا تحتفظ بقوة قتالية كبيرة في سورية يمكن زيادتها بسهولة من جديد، يقول أن دافع بوتين الأساسي هو «ليّ الذراع»، سواء بالنسبة إلى الولايات المتحدة أو الرئيس بشار الأسد، من أجل فرض قبول الشروط الروسية للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع السوري. وهناك رأي ثالث يقول أن بوتين حقق أهداف السياسة الخارجية والداخلية التي شجعت على التدخل في سورية، وهو مكتفٍ بالمكاسب التي جناها.
وثمّة تفسير بديل يقول أن بوتين لا يرى أن التوصّل الى اتفاق سلام في سورية وشيك، وهذا ما جعل اتخاذ الخيار في شأن إمكانية وكيفية مواصلة التدخل العسكري الروسي أمراً صائباً وضرورياً. ذلك أن فرض الشروط الروسية للتوصّل إلى اتفاق على الولايات المتحدة وغيرها من الداعمين الخارجيين للمعارضة السورية يتطلّب تصعيداً ملحوظاً للتدخّل، الأمر الذي يكبّد روسيا تكاليف مادية ومخاطر مواجهة جيوسياسية تفوق ما يبدو بوتين على استعداد لقبوله. بيد أن من الواضح أن الإبقاء على المستوى السابق من العمليات القتالية إلى أجل غير مسمى من دون توقع واضح بتحقيق نتائج سياسية إضافية لا معنى له أيضاً. والواقع أن مثل هذا الأمر ينطوي على خطر تبديد أي صدقية اكتسبتها روسيا نتيجة ترتيب الإطار الديبلوماسي، الذي ربما يكون قابلاً للتطبيق، الوارد في بيان فيينا في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، ووقف الأعمال العدائية الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 شباط (فبراير) 2016.
وفقاً لذلك، فإن الانسحاب الجزئي من سورية يعيد تموضع روسيا عسكرياً وديبلوماسياً للحدّ من التكاليف إذا ما ظلت التسوية السياسية لإنهاء الصراع غير قابلة للتحقيق، في الوقت الذي يزيد قوة تحمّلها وقدرتها على الاستمرار في تشكيل الأحداث على الأرض والاستجابة بمرونة للتطورات المستقبلية، بغضّ النظر عن الشكل أو الاتجاه الذي تتّخذه تلك التطورات.
في المقابل، إذا كان بوتين يعتبر أن فرص تحقيق تسوية سياسية ضعيفة في الوقت الحاضر، فإن مردّ ذلك جزئياً إلى أنه اكتشف حدود النفوذ الروسي على الأسد وبقية نظامه. فقد تباهى النظام مراراً بسيادته واستقلاله قبل ومنذ إعلان وقف الأعمال العدائية في 22 شباط، أولاً عبر الإعلان بأن الانتخابات البرلمانية ستجرى في 13 هذا الشهر، في تحدٍّ للشروط والجدول الزمني المنصوص عليه في بيان فيينا، ومن ثمّ عبر الإصرار على أن وضع الأسد غير قابل للتفاوض، وأن الحكومة تسعى لتحقيق نصر تام ولن تتحدث إلى من ترى أنهم إرهابيون، وتقصد بذلك المعارضة السورية. وإذا كان بوتين يأمل بإقناع الأسد بأخذ التنازلات التي من شأنها المساعدة في التوصل إلى اتفاق سلام بوساطة روسية بعين الاعتبار، فإن الانسحاب الجزئي الروسي ليس مقدمة لهذه المحاولة، كما قال البعض، بل هو انعكاس لفشلها.
ما من شكّ في أن الأسد يعتقد أن بوتين لا يمكنه أن يقلّل الدعم الروسي لنظامه بصورة كبيرة، ناهيك بإنهائه، من دون أن يخاطر بصورة حقيقية بإسقاطه تماماً. ومن الواضح أن هذا من شأنه تقويض هدف روسيا الرئيس في سورية وتبديد كل المساعدة العسكرية والاقتصادية التي أرسلت إلى النظام منذ العام 2011. ومن الواضح أن بوتين لا ينوي التخلّي عن النظام، غير أن من المستبعد أيضاً أن ينجح أي أمل لديه باستخدام علاقة روسيا القديمة مع الجيش السوري للفوز بدعمه واكتساب القدرة على التأثير في الأسد. ذلك أن هيكل القيادة الرسمي الذي تتعامل معه روسيا لا يمارس سلطة فعلية على القطعات العسكرية بقدر ما تمارس شبكات النظام الموازية داخل الجيش، ولذا فهو يتمتع بقدر ضئيل من الاستقلالية ولا يمكن أن يوفّر لروسيا وسيلة للتأثير.
ومن المفارقات أنه لا يمكن لروسيا تحقيق المزيد في سورية من دون النفوذ والموارد الإضافية التي يمكن أن تستثمرها الأطراف الخارجية الرئيسة الأخرى: إيران التي تقف إلى جانب النظام، ولكن أيضاً الولايات المتحدة وتركيا والسعودية. ويصح ذلك بخاصة اذا اقتنع بوتين بضرورة إيجاد صيغة تضمن رحيل الأسد في نهاية المرحلة الانتقالية. غير أن اهتمام الأطراف الخارجية الأخرى، مثل روسيا، يتركّز بصورة متزايدة على تحدّيات أخرى، بما فيها «داعش».
وهذا يبقي سورية في حالة من «الصراع المعلّق» حيث يرجّح أن يصمد وقف الأعمال العدائية خلال الأشهر المقبلة، بالتوازي مع محادثات السلام في جنيف التي من شبه المؤكّد أن تبقى متقطّعة رغم أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا عبّر عن أمله علناً بالانتقال من مناقشة المبادئ إلى مناقشة موضوعات سياسية فعلية.
السؤال إذاً هو ما إذا كانت الديناميات السياسية والاتجاهات العسكرية داخل سورية ستتطور في هذه الأثناء بطرق تؤثّر في التوازن العام. والواقع أن الجماعات المسلحة الموالية لـ «داعش» في جنوب سورية انتقلت إلى الهجوم لتوسيع منطقة سيطرتها في القرى الواقعة إلى الغرب والشمال من درعا عاصمة المحافظة. وقد استعادت قوات النظام مدينة تدمر الصحراوية، وهو ما يعتبر مكسباً مهماً، ويمكن أن تسعى لمواصلة الاندفاع نحو الجيب المحاصر حول مدينة دير الزور في الشرق، أو الضغط على المعاقل الباقية لـ «داعش» إلى الشرق من حلب في شمال البلاد. وقد ردّ حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي على استبعاده من محادثات جنيف بالإعلان عن نيته إعلان إقليم فيديرالي، وهو يتنافس مع النظام و «داعش» والمعارضة السورية لتشكيل تحالفات مع العشائر العربية في شمال وشمال شرقي سورية.
التقدم (أو عدمه) في الحرب ضد تنظيم «داعش» في العراق، سوف يؤثّر أيضاً في التطورات في سورية. النجاح سيميل لمصلحة نظام الأسد، من خلال منحه ميزة عسكرية نسبية على طول خطوط مواجهته الطويلة مع التنظيم، ولكن إذا تعطّلت الحملة ضد «داعش» في العراق فإن ذلك سيبقي سورية في وضعها الحالي، والذي يميل أيضاً لمصلحة النظام. وفي الوقت نفسه، يواصل النظام الضغط على المناطق المحاصرة في سورية، وخصوصاً جنوب دمشق وشمال حمص، كي تذعن للهدنات المحلية التي تبقي جماعات المعارضة المسلحة في مكانها ولكنها تحرر وحدات الجيش كي تنتقل إلى جبهات أخرى. وسيعمل الأسد على تعزيز زعمه بأنه يعمل على تهدئة الأوضاع في البلاد وتحقيق المصالحة، وتأتي الانتخابات البرلمانية المقبلة في هذا االسياق أيضاً. وعلى العكس من ذلك، تعتمد المعارضة بصورة كبيرة على تقدم محادثات السلام التي لا يلتزم بها النظام بصورة حقيقية، وهي، أي المعارضة، مهدّدة بفقدان المبادرة السياسية والعسكرية.
بناءً على الاتجاهات الحالية، سيظل نظام الأسد متقدماً قليلاً، كما كان دائماً منذ بداية الأزمة السورية. غير أن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق النصر التام على المعارضة الذي لا يزال يسعى إليه، ولا لدفع الولايات المتحدة إلى الدخول في شراكة غير مشروطة ضد «داعش» تبقي الأسد في الرئاسة والسيطرة الكاملة على الجيش والأمن في يديه. على العكس من ذلك، وحتى مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية واحتمال مجيء إدارة أكثر حزماً إلى الحكم، تبدو الولايات المتحدة أقل احتمالاً من أي وقت مضى لبذل الجهد الديبلوماسي الكافي، ناهيك بالتدخّل العسكري، لفرض اتفاق سلام أفضل. وبما أنه ليس لدى الولايات المتحدة ولا روسيا من مصالح استراتيجية تدفع أياً منهما لكسر الجمود الذي سينتج مجدداً، فيبدو دخول سورية في حالة الصراع المعلّق مؤكداً.
* باحث أول، مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.
الحياة
السلاح الروسي في مرآة الأزمة السورية/ هاني شادي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التاسع والعشرين من آذار الحالي أن إجمالي قيمة صادرات السلاح الروسي بلغت 14,5 مليار دولار في 2015، متجاوزة ما كان مخططاً له في السابق. وأكد بوتين أن المحفظة الإجمالية للطلبيات الأجنبية على السلاح الروسي تجاوزت 56 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1992، وبفضل العقود الموقعة في العام الماضي التي تقدّر بـــ 26 مليار دولار. وتشير صحيفة «كوميرسانت» الروسية إلى أن المبيعات الأساسية للسلاح الروسي في العام الماضي ذهبت إلى الهند والعراق والصين، موضحة أن الخطط الروسية في هذا المجال تعطي اهتماماً خاصاً في العام الحالي للجزائر ولتنفيذ العقود المبرمة مع بكين والقاهرة. ويربط مراقبون وخبراء روس وغير روس ما أعلنه بوتين من زيادة قيمة مبيعات السلاح الروسي للخارج في العام الماضي بالعملية العسكرية الروسية في سوريا، والتي، برأيهم، رفعت كثيراً من سمعة السلاح والمعدَّات العسكرية الروسية.
في تسعينيات القرن الماضي، تعرّض المُجمع الصناعي العسكري الروسي لأزمة عنيفة كادت تفكك أوصاله، وذلك نتيجة لسياسات الرئيس بوريس يلتسين. فقد عانى هذا المُجمع، في تلك السنوات، من نقص التمويل والاستثمارات الحكومية وتسرُّب العمالة الماهرة، وفقدان بعض الأسواق التقليدية الموروثة من العهد السوفياتي. الأمر الذي أثّر سلباً وبشكل كبير على صادرات السلاح الروسي، التي تراجعت من 3,48 مليارات دولار في العام 1993 إلى 1,55 مليار دولار في العام 1994. وارتفعت هذه الصادرات بعد ذلك إلى نحو ملياري دولار في العام 1998 بفضل المشتريات الصينية من الأسلحة الروسية. ولكن مع وصول بوتين إلى سدة الحُكم، بات المُجمع الصناعي العسكري تحت إشرافه مباشرة، وبات توسيع صادرات السلاح الروسي له أهمية خاصة للمصالح الاستراتيجية الروسية، بجانب رفد ميزانية الدولة بالعملات الصعبة. وأسفر ذلك عن نتائج إيجابية تجلّت في ارتفاع هذه الصادرات بعشر مرات تقريباً مقارنة بمستواها الأدنى في العام 1994. وعموماً، تضاعفت صادرات روسيا من الأسلحة والذخائر والتقنيات العسكرية خلال الأعوام العشرة الأخيرة بثلاث مرات. كما توسّعت خلال هذه الفترة جغرافية المبيعات العسكرية الروسية، حيث انضمّت دول جديدة إلى قائمة زبائن السلاح الروسي، وعادت دول أخرى لشراء الأسلحة الروسية بعد انقطاع طويل. وفي الوقت الراهن تبيع روسيا الأسلحة والذخائر والمعدّات والتقنيات العسكرية لنحو 58 دولة من دول العالم، على رأسها الهند والعراق وفيتنام والصين والجزائر وإيران وغيرها.
وبنظرة عامة، نلاحظ أنه خلال الفترة الممتدّة بين عامي 1992 و2009 اشترت الصين من روسيا أسلحة بمبلغ 28,15 مليار دولار، والهند بـ18,81 ملياراً، والجزائر بـ 4,7 مليارات، وإيران بـ 3,38 مليارات، وفنزويلا بـ 2 مليار، وماليزيا بـ 1,97 مليار، وفيتنام بـ 1,88 مليار، ودولة الإمارات بـ 1,14 مليار، واليمن بـ 1,12 مليار، والمجر بـ 1,11 مليار، واليونان بـ 1,06 مليار، وكازاخستان 850 مليون دولار. وبحسب معطيات المركز الروسي لتحليل تجارة السلاح العالمية، بلغت قيمة صادرات السلاح الروسي خلال الفترة الممتدة من العام 2008 وحتى العام 2011 نحو 29,8 مليار دولار، حيث احتلت الهند المركز الأول فيها بمبلغ 8,2 مليارات دولار، والجزائر جاءت في المركز الثاني بـ 4,7 مليارات دولار، وكانت الصين في المركز الثالث بـ3,5 مليارات دولار. ووصلت حصة الدول الثلاث المذكورة في إجمالي مبيعات السلاح الروسي 55,5 في المئة. وفي غالب الظن، ستظل الهند تحتل المرتبة الأولى في صادرات السلاح الروسي بحصة تصل إلى 27 في المئة خلال الفترة المقبلة. وبالنسبة إلى الصين التي احتلت في تسعينيات القرن الماضي المرتبة الأولى في صادرات السلاح الروسي، حيث كانت تشتري نحو نصف هذه الصادرات، فإنها تحتل المرتبة الرابعة حالياً. وتحتل مبيعات الطائرات الحربية بمختلف أنواعها المرتبة الأولى بين صادرات السلاح الروسي، وتأتي بعدها الأسلحة البحرية وأسلحة القوات البرية ووسائط الدفاع الجوي.
وبرغم التطورات الإيجابية، التي حقّقها المُجمع الصناعي العسكري الروسي في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، إلا أن روسيا تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المصدّرة للسلاح على المستوى العالمي. وبحسب معطيات أولية للمركز الروسي لتحليل تجارة السلاح العالمية، احتلّت روسيا في العام الماضي المركز الثاني في إجمالي صادرات السلاح العالمية بحصة تقدّر بنحو 15 في المئة، بينما كانت حصتها في 2012 حوالي 20 في المئة، وفي العام 2013 بلغت 23 في المئة، و17,6 في المئة في العام 2014. وعموماً، صدّرت روسيا أسلحة ومعدات عسكرية خلال السنوات الأربع الأخيرة بمبلغ 51,5 مليار دولار، أي بحصة تبلغ 18,3 في المئة من إجمالي صادرات السلاح العالمية. ووفق معطيات المركز الروسي المذكور أعلاه، فإن الولايات المتحدة تحتلّ وبفارق كبير عن روسيا المركز الأول في صادرات السلاح عالمياً. فقد قُدرت قيمة هذه الصادرات في العام الماضي بنحو 41,5 مليار دولار، أي بحصة تبلغ 44,8 في المئة من صادرات السلاح الإجمالية العالمية. وتأتي فرنسا في المركز الثالث، وألمانيا في المرتبة الرابعة، ثم بريطانيا في المركز الخامس، وبعد ذلك تأتي إسرائيل وإيطاليا واسبانيا والصين وسويسرا.
وإذا كان من المُبكر حالياً رصد تأثير العملية العسكرية الروسية في سوريا على زيادة قيمة صادرات السلاح الروسي، إلا أن الروس يعوّلون كثيراً على تحقيق نتائج إيجابية من وراء ذلك. فقد سمحت هذه العملية العسكرية لروسيا باختبار فاعلية أسلحتها ومعداتها العسكرية، وهو ما يجعلها تراهن على فتح الأبواب أمام صفقات سلاح جديدة وكبيرة تعقدُها مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها دول منطقة الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج خصوصاً. وربما من المهم، هنا، الإشارة إلى ما كرّره الرئيس بوتين غير مرّة من أن الحرب في سوريا تعتبر أفضل تدريب واختبار للقوات الروسية والسلاح الروسي، لاسيما أنّها كلفت ميزانية وزارة الدفاع 33 مليار روبل، أي نحو 500 مليون دولار فقط. وهذه، بالطبع، تكلُفة قليلة مقارنة بالمكاسب السياسية والعسكرية، التي راهن ولا يزال يراهن عليها الكرملين.
السفير
ماذا حقق التدخل الروسي في سوريا؟/ إبراهيم فريحات
فاجأ فلاديمير بوتين العالم بدخوله سوريا وفاجأهم بانسحابه منها، فهل جاءت حملته العسكرية بنتائج محددة سواء بالنسبة لسوريا أو روسيا نفسها أم كانت إحدى مغامرات رجل الـ”كي جي بي” في الكرملين? خاض بوتين ثلاثة مواجهات منذ قدومه إلى سدة الرئاسة (الشيشان وجورجيا وأكرانيا) وكسبها جميعا، ولم يكن تدخله العسكري في سوريا استثناء.
الحقيقة الواضحة للعيان هي أن التدخل الروسي أوقف انهيار النظام الروسي ولو مؤقتا، وهو ما لم يستطع إنجازه التدخل الإيراني سواء المباشر أو من خلال حزب الله، فبعد التدخل الروسي استعاد النظام كامل اللاذقية وتم ربطها بحلب واستعاد أجزاء من حمص وحماة واستعاد السيطرة على قاعدة كويرس العسكرية ومدينة تدمر.
نجاح بوتين بالتدخل على هذا الصعيد يظهر في توقيت الانسحاب، فلم يكن بإمكانه تحقيق إنجازات جوهرية لصالح النظام أكثر مما حققه، فمهما استمر التدخل الروسي فلن يكون بمقدوره القضاء تماما على المعارضة -معتدلة كانت أم متطرفة- أو استعادة كامل التراب السوري كما أصبح يحلم النظام الذي صدم الانسحاب الروسي وعيه.
صحيح أن التدخل الروسي فاجأ الكثيرين، ولكنه بالتأكيد لم يفاجئ سيد البيت الأبيض باراك أوباما، فالتدخل الروسي حصل بضوء أخضر أميركي والانسحاب جاء أيضا بضوء أخضر وتنسيق أميركي.
إن المكسب الرئيسي الذي حققه بوتين نتيجة تدخله في سوريا هو تعزيز المكانة الدولية لروسيا في النظام الدولي وعلاقتها بالأطراف الفاعلة فيه مثل الولايات المتحدة وأوروبا بالتحديد، فقلبه لموازين القوى على الأرض وانسحابه قبل مباحثات جنيف بيوم واحد كان إشارة واضحة لعدم رضاه عن أجندة نظام الأسد غير الواقعية، حيث أثبت بوتين أنه الوحيد القادر على إعادة الحياة للنظام من خلال تدخله العسكري، وأنه أيضا الوحيد القادر على عقلنة أجندته المتطرفة والضغط عليه للدخول في مفاوضات جدية بعيدة عن تصريحات المعلم وبشار الجعفري التي سبقت المفاوضات بإجراء انتخابات برلمانية فقط واستثناء الرئاسة منها.
بذلك أثبت بوتين لنظرائه أركان النظام الدولي أنه العنوان الصحيح والوحيد لعلاج أزمات استعصى حلها على رؤساء أوروبا التي ترزح بلادهم تحت موجات الهجرة التي وقفوا عاجزين عن أي عمل حيالها، بل أصبحت تهدد عروشهم كما حدث في خسارة انتخابات حزب أنجيلا ميركل في ولايتين من أصل ثلاثة أمام حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة.
النقطة المرجعية لحسابات بوتين السياسية هي النظام الدولي بتشعباته وملفاته المتعددة، وسوريا ليست أكثر من ورقة بالنسبة له يستخدمها أيضا للتأثير في أوراق أخرى عالقة بينه وبين الغرب مثل أوكرانيا وجورجيا وأنظمة الدفاع الصاروخي وغيرها، وهذا -مثلا- بعكس إيران التي تعتبر النظام الإقليمي مرجعيتها السياسية وكيف يمكن لها أن تضغط على السعودية من خلال سوريا.
بإثباته أنه رجل الحرب ورجل المفاوضات في سوريا جعل نظراءه في أوروبا وأميركا يتناسون عن الأزمة التي كادت أن تقطع شعرة معاوية بينهم وبينه قبل شهور والمتمثلة في أزمة أوكرانيا، فمن منا اليوم يتحدث عن جزيرة القرم أو يطالب بوتين بالانسحاب منها؟
وحتى أوباما عند سؤاله عن أوكرانيا في مقابلته مع مجلة الأتلانتيك أجاب بأن “أوكرانيا ستبقى دوما عرضة للهيمنة العسكرية من قبل روسيا مهما فعلنا”، وعليه فقد عمل بوتين بتدخله بسوريا انطلاقا من مبدأ أن الطريق إلى أوكرانيا -وملفات دولية أخرى- يمر عبر سوريا.
يشار إلى أن نجاحات متزايدة لبوتين في علاقاته مع الغرب ستعمل رويدا رويدا على دفع النظام الدولي للتحول باتجاه تعدد الأقطاب وإنهاء حالة الأحادية القطبية التي سيطرت بموجبها الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وما حققه من التدخل في سوريا هو ورقة بهذا الاتجاه.
بالانسحاب العسكري من سوريا في هذه اللحظة وازن بوتين في علاقاته مع دول المنطقة وبالتحديد مع المملكة العربية السعودية ورفض الانجرار نحو صراع يتم فيه اختصار دور روسيا من دولي إلى إقليمي يناصر طرفا على طرف.
ولا يستبعد هنا أن يكون للنشاط الدبلوماسي الخليجي خلال التدخل العسكري الروسي في سوريا دور في القرار النهائي لبوتين بالانسحاب العسكري والضغط على الأسد للدخول في مفاوضات جدية، فخلال الأشهر الماضية كانت هناك زيارات على مستوى القيادات السعودية والقطرية بالتحديد، الأمر الذي يذكر بالتفاهم الروسي السعودي القطري في فبراير/شباط الماضي للحد من إنتاج النفط في مسعى لإعادة العافية لأسعار البترول.
كذلك فقد أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي يفغيني لوكيانوف أنه من أجل نجاح التسوية بعد العملية العسكرية في سوريا فلا بد من مشاركة فعالة للمملكة العربية السعودية.
هناك مكاسب أخرى حققتها روسيا من عمليتها العسكرية في سوريا مثل تعزيز إطلالتها الإستراتيجية على البحر المتوسط من خلال قواعدها العسكرية ونشر صواريخ متطورة مثل نظام S-400، وكذلك ما صرح به لوكيانوف بأن العملية العسكرية أتاحت خبرة حقيقية للقوات الروسية لم تكن لتحصل عليها من خلال التدريبات العسكرية.
ولعل مثل هذا التصريح يظهر انعدام الجانب الأخلاقي في التأثير في القرارات الدولية السياسية والعسكرية، إذ ليس من المهم بالنسبة للوكيانوف أن يدفع الشعب السوري ثمن هذه العملية من دماء أبنائه، ولكن الإنجاز الذي يذكره هو وجود فرصة فعلية لاكتساب خبرات عسكرية للقوات الروسية.
ربما يكون أخطر ما تمخض عنه التدخل العسكري الروسي هو طرح الفيدرالية في سوريا كأساس للحل أكثر من أي وقت مضى، بل إن حزب الاتحاد الديمقراطي والمقربين منه سارعوا بعد انتهاء العملية إلى إعلان فيدرالية في شمال سوريا وبالتحديد في المناطق ذات الأغلبية الكردية.
كذلك فإن الموقف الروسي نفسه هو من أصبح يدفع باتجاه الفيدرالية من أجل توفير ملجأ قد يكون أكثر أمانا للنظام وتحديدا في المناطق العلوية، وفي الوقت ذاته يخدم الوجود الروسي في قواعده العسكرية على الساحل السوري في طرطوس واللاذقية.
يشار إلى أن بوتين لم يغلق ملف إسقاط الطائرة الروسية مع تركيا، وما زال يخوض حربا باردة مع أنقرة، أحد أوراقها تعزيز القوة الكردية وبالتحديد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي ينظر إليه كفرع لحزب العمال الكردستاني التي تعتبره تركيا منظمة إرهابية، ويهدد دوما بالانفصال.
الفيدرالية بحد ذاتها ليست نظاما سياسيا فاشلا، فهناك أكثر من عشرين دولة تقوم على نظام فيدرالي من ضمنها الولايات المتحدة وألمانيا وحتى روسيا، ولكن الفيدرالية في سوريا تستدعي أكثر من مشكلة، وقد تشكل كارثة بالنسبة لمستقبل سوريا السياسي، وذلك لعدة اعتبارات منها:
أولا: أي فيدرالية قد تنشأ بعد الصراع الدموي الذي استمر أكثر من خمس سنوات حتى الآن قد تشكل بداية حقيقية لتقسيم سوريا، إذ لن يكون من السهولة بمكان تجاوز التاريخ الدموي الذي امتد إلى مكونات المجتمع السوري وليس القيادات السياسية لوحدها.
الفيدرالية في هذه الحالة قد تتحول إلى “تقسيم مقنع” قد يزول القناع عنه في السنوات القليلة التي تلي أي اتفاق، لتتحول إلى تقسيم حقيقي.
ثانيا: أي فيدرالية قد تنشأ في سوريا في هذا الوقت ستكون قائمة على أصول عرقية (كردية) وطائفية (علوية، درزية) وغيرها، وهو ما سيضعف الدولة السورية إستراتيجيا وبنيويا. سوريا بهذه الحالة لن تساوي مجموع مكوناتها، وإنما مكونات غير مترابطة تفتقد لوظيفتها كالدولة الفيدرالية في الولايات المتحدة أو ألمانيا التي لا تقوم على أساس طائفي أو عرقي وإنما جغرافي مرتبط بقوانين وتشريعات وذات تمثيل مؤسساتي بالحكومة الفيدرالية التي هي أقوى من أي تجمع آخر في الدولة.
الحل في سوريا ليس فيدراليا على الأقل في هذا الوقت وضمن المعطيات الطائفية والعرقية الحالية التي عززتها الحملة العسكرية الروسية، الحل يكون بدولة القانون والمواطنة التي يتساوى فيها جميع الأفراد في الحقوق والواجبات وتمنح الجميع تكافأ في الفرص بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الطائفي أو الحزبي.
إن وجود نظام سياسي جديد في سوريا يقوم على المساءلة والحكم الجيد والشفافية هو الضامن لبناء سوريا بأيدي أبنائها ولأبنائها، وليست سوريا هشة قائمة على تقسيم “مقنع” أفرزته أو على الأقل عززته الحملة العسكرية الروسية.
أخيرا يجب التذكير بأن الانسحاب العسكري الروسي غير الكلي لا يعني أبدا تخلي بوتين كليا عن حليفه بشار الأسد، وإن كان قد ضغط عليه لتقنين مطالبه في مفاوضات جنيف ولتعزيز موقعه في النظام الدولي لمواجهة نظرائه في أوروبا وأميركا.
الجزيرة نت
بوتين ينجو من المستنقع السوري ويغرق في الأوكراني/ إيزابيل ماندرو
ساهم التدخل العسكري الروسي في سورية ثم سحب شطر راجح من القوات الروسية بعد ستة أشهر، في إخراج موسكو، جزئياً، من عزلتها الناجمة عن تدخّلها في النزاع الأوكراني. ولا يقيم بوتين وزناً للانتقادات التي وُجّهت إلى عملياته العسكرية واستهدفت معارضي بشار الأسد أكثر مما نالت من «جبهة النصرة» و «داعش». فشاغل الرئيس الروسي هو استعادة مكانة دولية يرى أنها تليق ببلده. وعلى رغم أنه أفلح في انتزاع مكانة الشريك البارز في الشرق الأوسط وتفادى خطر الغرق في «المستنقع الأفغاني» على نحو ما توقع كثر، وفاوض على هدنة مع الولايات المتحدة كما في الأيام الآفلة، يبدو أنه ينزلق أكثر فأكثر الى «مستنقع» أوكراني. وبعد عامين على ضمّها، ومصادقة البرلمان الروسي على إلحاقها بروسيا في 18 آذار (مارس) 2014، لا تزال شبه جزيرة القرم عقدة الخلاف. واتفاقات مينسك المبرمة في شباط (فبراير) 2015، والتي رمت الى طي النزاع الدموي في الدونباس وشرق أوكرانيا، تتعثر. والاتحاد الأوروبي مدّد العقوبات على روسيا.
وفي مطلع الشهر الجاري، انتهت قمة جمعت عرابي اتفاق مينسك (ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا) في باريس الى خلاف على تنظيم انتخابات محلية عملاً بالاتفاق. وفي الأثناء، تتواصل الاشتباكات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الروس، على رغم ضمور النزاع. فالانفصاليون مستقرون في الجمهورية المستقلة التي أعلنوها بدونيتسك في الدونباس، ويخطون خطوات استفزازية فينشرون نقاط عبور يطلبون فيها جوازات العابرين.
وصارت ربانة المقاتلة الأوكرانية، ناديجدة (أو ناديا) سافتشينكو، التي تحاكم في موسكو، رمز المقاومة في كييف، حيث نظمت أخيراً تظاهرات احتجاج أمام السفارة الروسية. وأعلنت سافتشينكو أنها «خُطِفت» واقتيدت الى روسيا. وهي انتخبت نائباً في البرلمان الأوكراني أثناء اعتقالها بتهمة التواطؤ لقتل صحافيين روسيين في الدونباس في تموز (يوليو) 2014. وقد تُحكم بالسجن 23 عاماً. وتتعاظم الدعوات في أوروبا والولايات المتحدة الى الإفراج عنها.
ولا شك في أن مسرح العمليات في سورية يبدو ضعيف الصلة بميدان المعارك في أوكرانيا، لكنهما، في الواقع، متصلان. ويعود الفضل الى الملف السوري في اعتلاء روسيا مكانة راجحة في الساحة الديبلوماسية الدولية. لكن «النجاح» الروسي في سورية لم يبدد القلق في أوكرانيا. «سمعنا عن سحب روسيا قواتها، لكنها كانت عمليات تبديل فحسب. وسمعنا وزير الدفاع الروسي يقول أن قصف الإرهابيين – وترى موسكو أنهم كل معارضي النظام – سيستمر. فلننتظر ونرَ ما سيحصل»، أعلن وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند.
وخلصت صحيفة «فيدوموستي» الروسية، الى أن «موسكو تعتبر أنها بلغت غايتها وخرجت من العزلة الدولية. لكن المشكلة أن الخروج من العزلة قد لا تنعقد ثماره الدولية… فمقايضة سورية بالدونباس أخفقت. وروسيا لا تزال تعاني من العقوبات وتتحمل مسؤولية النزاع الأوكراني». ويبدو أن بوتين نفد صبره من تأخر تحصيله مكاسب العملية في سورية التي صوّرت على أنها إحدى حلقات المكافحة الدولية للإرهاب، فأعلم الرئيس الأميركي، في 14 الجاري، بقراره فتح صفحة جديدة «ديبلوماسية» أكثر مما هي عسكرية. وفي بيانه، أعلن الكرملين أن «القياديين اتفقا على مواصلة السعي مع أطراف النزاع إلى حلّه». والنزاع المقصود هو طبعاً الأوكراني وليس السوري. ويبدو أن مواصلة الحوار الروسي – الأميركي تلبي حاجة روسيا الماسة الى الخروج من الأزمة الأوكرانية التي كلفتها أكثر من الحرب في سورية، التي قدرت صحيفة «أر بي كا دايلي» كلفتها بـ38 بليون روبل (500 مليون يورو). وإلى مساعي الحوار مع واشنطن، تتوجه موسكو الى العواصم الأوروبية، ولسان حال مبعوثيها أنها ليست مسؤولة عن تعثّر اتفاقات مينسك، فكييف لم تلتزم المتفق عليه. ويبدو أن العاصمة الأوكرانية هي الحائل دون تحقّق أحلام العظمة البوتينية.
* مراسلة، عن «لوموند» الفرنسية،20-21/3/2016،
إعداد منال نحاس
الحياة
معضلة روسية تواجه إيران/ د.وحيد عبد المجيد
عندما بدأ التدخل العسكري الروسي في سوريا في 30 سبتمبر الماضي، وجدت إيران نفسها إزاء موقف معقد. لم يكن أمام طهران بديل عن هذا التدخل لإنقاذ نظام بشار الأسد الذي لم تفلح في وقف تراجعه وانكفائه قبل أن يرسل الكرملين قواته، لكنها كانت قلقة على نفوذها في سوريا، لأن هذا التدخل يدعم دور روسيا على حساب الوجود الإيراني.
وليس هناك ما يدل على أن سعي موسكو لخطب ود إيران أدى إلى تهدئة مخاوفها، لكن زيارة بوتين لطهران، ولقاءه خامنئي في 23 نوفمبر الماضي، ربما ساهما في تهدئة القلق الإيراني من التدخل الروسي، فلم يتكرر التصريح الذي كان قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري قد أدلى به قبل أيام من زيارة بوتين (في 17 نوفمبر)، وحدد فيه المسافة بين السياستين الإيرانية والروسية: «إن الرفاق الذين جاؤوا من الشمال إلى سوريا للبحث عن مصالحهم قد لا يعنيهم مستقبل الأسد، بخلاف موقفنا الذي يصر على ضرورة استمراره».
ولم يختلف المأزق الإيراني في جوهره عندما قرر بوتين في 14 مارس الجاري سحب «القوات الرئيسية» في سوريا، فلا يكفي مثل هذا القرار لتهدئة مخاوف طهران التي تعرف أنه ليس بإمكانها تعويض الدور الذي اضطلعت به القوات الروسية، سواء في تمكين نظام الأسد من استعادة مناطق جديدة، أو حتى الحفاظ عليها، لذلك تظل إعادة القوات التي انسحبت وفق هذا القرار، واردة في أي وقت، وهذا ما قاله بوتين حين التقى مجموعة من الجنود الروس العائدين.
وفضلاً عن ذلك، فالواضح الآن أن الانسحاب الروسي الجزئي لا يقلل سيطرة موسكو على المفاصل الأساسية لنظام الأسد، ولا يتيح بالتالي لإيران استعادة نفوذها كاملاً، فقد تبين أن قرار الانسحاب الجزئي يقتصر على بعض الطائرات الروسية التي أُرسلت إلى سوريا، وعدد غير معروف من الجنود الذين بلغ عددهم نحو أربعة آلاف جندي.
أما الدبابات «تي 90» والمدرعات، ومنظومتا الصواريخ المضادة للطائرات، فهي كلها باقية في سوريا، ومعها معظم القوة البحرية التي تضم مدمرات ومروحيات مضادة للغواصات، فضلاً عن المروحيات الموجودة على متن حاملة الطائرات «فيتس أدميرال كولاكوف» قرب الساحل السوري، فهذه القوات الكبيرة الباقية ضرورية لحماية مركز الوجود العسكري الرئيس في قاعدتي طرطوس وحميميم.
لكن معضلة إيران مع الدور الروسي في سوريا لا تتعلق فقط بالوجود العسكري الذي سيستمر إلى أجل غير مسمى، بل بما يتيحه هذا الوجود من فرص لموسكو للتحكم في الترتيبات الداخلية، بغض النظر عن نتائج مسار جنيف الحالي، أو ما بعده من محاولات للحل السلمي.
ولعل طهران تتابع بقلق التحركات الروسية لترتيب مصالحات داخلية متنوعة في سوريا، يؤدي بعضها إلى اتفاقات مع مجموعات مسلحة صغيرة في مناطق التماس بأرياف دمشق وحلب وحمص ودرعا والقنيطرة، بينما يسفر بعضها الآخر عن تفاهمات بين عشائر وبلدات متنازعة.
وفي هذا السياق تحول مركز التنسيق الذي أُقيم في قاعدة حميميم لمراقبة الالتزام باتفاق الهدنة، إلى مركز للاتصالات والتسويات المحلية، على نحو قد يُعمِّق النفوذ الروسي في سوريا.
كما يثير قلقَ إيران حتى الآن اتجاهُ موسكو إلى دمج الكتائب التي شكّلتها في سوريا، عن طريق «الحرس الثوري»، في الجيش الرسمي. ورغم أن إيران تعتبر نظام الأسد بوجه عام إحدى أذرعها الإقليمية، فهي تكون أكثر اطمئناناً في حالة استقلال هذه الكتائب عنه كما هو حال ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق.
وفوق هذا كله، لابد أن تثير علاقة موسكو القوية مع القوى الكردية التي أعلنت اتحاداً فيدرالياً في شمال سوريا، قلقاً إيرانياً جديداً، لاسيما أن هذا الإعلان جاء بعد أيام من تصريح نائب وزير الخارجية الروسي بأن الفيدرالية يمكن أن تكون خياراً لسوريا.
ويعني ذلك أن قرار موسكو سحب قواتها الرئيسية لا يكفي لحل المأزق الإيراني الذي ترتب على إرسال هذه القوات، بل ربما يزيده ويحوّله إلى معضلة لطهران التي تكتشف الآن مدى عمق الوجود والنفوذ الروسيين في سوريا، سواء بوجود هذه القوات أو بدونها.
الاتحاد





