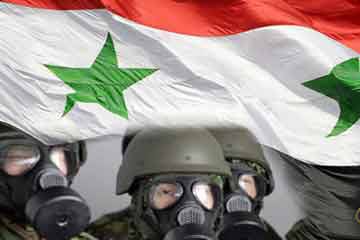ملف “صفحات سورية ” حول دخول الثورة السورية عامها الرابع

في الذكرى الثالثة للثورة السورية: نهاية جيل من التفكير السياسي السوري وبداية جيل/ ياسين الحاج صالح
(إلى سميرة .. إمامتي الغائبة)
أيا تكن مآلاتها الفعلية، تدشن الثورة السورية نهاية جيل من التفكير السياسي في سوريا وبداية جيل جديد لن تتضح ملامحه قبل حين. من بين قضايا كثيرة نرجح أن يتبدل التفكير فيها تبدلا كبيرا، هناك ثلاث قضايا كبيرة تبدو لنا عناوين مؤكدة لتفكير جيل جديد. أولها قضية الهوية الوطنية، وثانيها الدولة ونظامها السياسي والقانوني والإداري، وثالثها موقع الإسلاميين في الحياة العامة ودورهم. وقد نضيف قضية الشتات السوري التي تفرض نفسها كموضوع سياسي راهن دون سوابق.
ماهية سوريا ووجودها
كان التصور القومي العربي لهوية سوريا كقطر عربي لا معنى تاريخيا له غير الإعداد لإلغاء نفسه في وطن عربي واحد في أزمة عميقة قبل الثورة. ولم يكن مردّ الأزمة وجود سوريين غير عرب، وهو وجود كبير يتخطى الكرد والأرمن إلى السريان والشركس والتركمان…، بل من تراجع هيمنته في أوساط العرب أنفسهم بفعل افتقاره المتفاقم إلى محتوى سياسي وقيمي تحرري. وبعد أن لم يكن هذا التصور يوحّد السوريين، لم يعد يوحد الأكثرية العربية من السوريين.
ثم إن هذا التصور القومي مزّق الرابطة العربية التي يفترض أن تجمع السوريين بأشباههم في البلدان العربية المجاورة والأبعد. وهذا لأن القومية العربية ليست وعيا ذاتيا بما يجمع سكان بلدان مختلفة من مشتركات، بقدر ما هي حركة سياسية عملت على رد العنوان العربي الجامع إلى حزب سياسي، فجرى على هذا النحو نقل الهوية العربية المفترضة من مساحة الإجماع إلى مساحة الصراع، ما يعني عمليا تحطيم الرابطة العربية.
في المقام الثالث نصب التصور القومي العربي لسوريا حواجز نفسية ورمزية عالية بيننا وبين العالم، مع التأكيد على مغايرة جذرية بين الجهتين، تقابلها في الداخل وحدة لا نتوءات ولا تضاريس فيها لـ»الشعب العربي السوري». وما كان لهذا الترتيب المتعارض مع التدويل العميق لمنطقتنا، وانخراط النظام السوري ذاته في منطق التدويل، إن عبر أدواره الإقليمية أو عبر حراسته حدود إسرائيل رغم احتلالها الجولان، ما كان له أن يستمر إلا لأن وظيفة عزل السوريين عن العالم وتخويفهم منه هي التحكم بهم وتجريدهم من القدرة السياسية والفكرية، ومركزة الحياة السياسية في البلد حول بقاء النظام وأبديته. لقد جرى الاستثمار في العزل عقودا، وبنيت من أجله أسوار أمنية لا تقل تأثيرا عن الأسوار التي عزلت المدن في أزمنة مضت، لكن بدل الحماية، الغرض من هذه الأسوار بالأحرى هو السيطرة والتحكم بالسكان داخلها.
على كل حال قاد هذا التصور نفسه في درب انحطاط لا قعر له. من «حركة التحرر العربية» التي تحطمت بفعل تحولها إلى أنظمة طغيان مؤبدة ونخب فاسدة أكثر مما على يد إسرائيل ورعاتها الدوليين، جرى التحول إلى «الممانعة»، وهي إيديولوجية سلبية، تستأنف التأكيد القومي على المغايرة دون أي مضمون تحرري، ثم إلى صحبة منظمات ما دون الدولة ولعب دور تقسيمي في الإقليم ككل، وصولا إلى التبعية لإيران وعزيمتها إلى احتلال البلد وقتل المحكومين المتمردين.
تحطم التصور القومي العربي للهوية الوطنية السورية تماما بعد الثورة وبفعلها. وهناك اليوم صراع على هوية سورية بين واحد من ثلاث تصورات، ليس بينها التصور القومي العربي.
التصور الأسدي الذي يرد سوريا إلى قاعدة لملك السلالة الأسدية، قاعدة لا هوية فعلية لها، يعمل النظام على تأبيد نفسه عبر ما توفره له انقساماتها من هوامش حرية واسعة. السوريون وفق هذا التصور أسديون، رعايا للمالك الأسدي، ليسوا لا أحرار جوهريا، بل هم بالفعل عبيد سياسيا.
ويبدو أنه يصعد في التصور الأسدي لسوريا اليوم عنصر شيعي بفعل التدخل الإيراني وذراعها اللبناني «حالش» (اسم ابتكره سوريون لـ»حزب الله في لبنان والشام» أو «حزب الله اللبناني الشيعي» من باب إظهار وحدة الحال بينه وبين «داعش»، «الدولة الإسلامية في العراق الشام»). وفي الكلام عن يزيد الأموي وزينب التي لن تسبى مرتين، وعلى حماية المقامات الشيعية، ما يشكل إيديولوجية مناسبة لاحتلال البلد، والعمل على تحويل عناصر هويته القائمة. يسهل من الأمر أنه لا مضمون فكريا أو قيميا إيجابيا للنظام الأسدي من أي نوع اليوم. بقاؤه هو كل رسالته.
تصور الهوية الثاني هو التصور الإسلامي، السني في هذا المقام. وهذا يتراوح بين صيغة إخوانية مخففة سابقة للثورة، تحيل على الإسلام كـ«مرجعية حضارية»، وبين تصورات سلفية تتكلم على الدولة الإسلامية ودولة الخلافة، ومنها الشكل الفاشي المتمثل في «داعش»، وأشكال أقل وحشية، لكنها متمركزة حول تفسير تشريعي للإسلام، وتصور طائفي للمجتمع. وهي إلى عموم السوريين، بمن فيهم المسلمين السنيين، مثل القومية العربية إلى السوريين أنفسهم، بمن فيهم العرب. أعني أنها تُشرِّع لتنصيب حزب قائد، وإلغاء الحياة السياسية، وتحويل الإسلام إلى حزب سياسي، فتمزق بذلك المسلمين فوق تمزيق السوريين أنفسهم. هذا فضلا عن نصب حواجز فكرية ورمزية في وجه الاختلاط بالعالم، لنخسر جيلا أو جيلين آخرين، بعد جيلين خسرناهما على يد البعثيين والأسديين. لا تقدم ممكناً لنا فيما نرى من دون اختلاط مع العالم من حولنا وتفاعل معه وتعلم منه.
هناك تصور ثالث استيعابي، يحيل إلى سوريا ديموقراطية، منفتحة على تعددها الذاتي وعلى تمثيله سياسيا، وغير منعزلة عن العالم. ليس هناك تيارات واضحة تشتغل على هذا التصور، وتطوره مفهوميا وبرنامجيا، لكن ليس إلى غيره تحيل وثائق «المجلس الوطني السوري» و»ائتلاف قوى الثورة والمعارضة». المشكلة الأساسية في هذه الوثائق والقوى التي أصدرتها هي ضمور البعد التحرري في تكوينها وتفكيرها، والميل إلى تصور التعدد السوري تعددا ساكنا، هوياتيا، وليست تعددا سياسيا صراعيا ومتغيرا. وبقدر ما أن تصورنا للهوية الوطنية عنصر محدد لتصورنا للنظام السياسي، فإن من شأن تصور ساكن للتعدد السوري أن يفضي إلى نظام محاصّة طائفية مع هيمنة سنية. وهذا لا يشكل قطيعة مع النظام الأسدي، بل استمرارا مغايرا له. ما يمكن أن يكون قطيعة على هذا المستوى هو تصور السوريين كجمهرات متنوعة، تعمل على التحكم بشروط حياتها وامتلاك السياسة، بما في ذلك الكلام في الشؤون العامة والتنظيم والاحتجاج في الفضاء العام، وبما في ذلك صنع السياسات العامة والتحكم بالمواد الوطنية.
دولة جديدة
وهذا يقودنا إلى القضية الثانية التي نرى أن جيلا جديدا من التفكير السياسي السوري يتشكل حولها، قضية الدولة والنظام السياسي. لا يرتد الأمر هنا إلى التخلص من حكم السلالة الأسدية أو التحول من الاستبداد إلى الديموقراطية على ما يجري التعبير عن الأمر أحيانا، وإنما تحويل البنية السياسية والإدارية والقانونية لسوريا في اتجاهات مغايرة لتلك التي قامت عليها منذ الاستقلال. يجري الكلام أحيانا عن فيدرالية، موجهة بصورة أساسية نحو معالجة المشكلة الكردية. لكن ليس هناك نقاش جدي في الأمر، ويلوثه غالبا الاشتباه بالمقاصد: هل هو خطوة باتجاه وحدة سورية جديدة وديموقراطية، أما باتجاه تفكك معمم؟
على أنه لا بد من تفكير جديد في تكوين البلد وتنظيمه السياسي باتجاه مزيد من اللامركزية، وبما يوفر للجمهرات السورية مساحات أوسع من الحرية وإدارة أمورها. هناك تحديان يواجهان التفكير السياسي على هذا المستوى. الأول يتصل بكيفية توزيع السلطات على المستوى الوطني العام بما يحول دون نشوء مركز سلطة وحيد متضخم يبتلع البلد. والثاني هو ضرورة وجود مركز سياسي موحِّد، يحول دون التفكك العام، وانقسام البلد إلى إقطاعيات كثيرة متنازعة. ليس هناك حلول جاهزة في هذا الشأن. نحتاج إلى نقاش عام واسع من أجل الوصول إلى معالجات وحلول مثمرة.
في المبدأ، لا يستطيع السوريون التحكم بالسلطة المركزية من دون أن يشكلوا هم هذه السلطة، ومن دون أن ينظموا أمورهم بحيث تكون مقاومتهم فعالة لتعدياتها أو نزعاتها التسلطية. فإذا كانت تجربتنا السياسية الأساسية هي الطغيان الفاشي ومواجهته، فإن المبدأ الذي نرى أن ننطلق منه أنه ليس هناك أية اعتبارات، ولا حتى وحدة البلد، يجب أن تقف في وجه مقاومة السكان للفاشية.
على أننا نرى أن سوريا مكسب عام للسوريين، بمن فيهم الكرد، وإن ليس بأي ثمن، ليس بثمن محو الشخصية قطعا، ولا بثمن الفاشية. سوريا مكسب عام من حيث أن مقاومة الفاشية في الإطار السوري أنجع من مقاومتها في إطار إقطاعيات أصغر مثل الرقة تحت سيطرة «داعش». لكن الشرط الشارط لأولوية سوريا هو قيام الكيان الوطني على إقرار الجماعات السورية المختلفة كجماعات تأسيسية متساوية في المكانة. بما هي وطن السوريين، يتعين أن تتشكل سوريا بصورة تضمن للسوريين المختلفين أعلى درجة من الحرية والمساواة، وأن يتشكل نظامها السياسي ويصاغ دستورها وقوانينها حول هذا المبدأ.
والأكيد أن سوريا لا تفيض ماهيتها المفترضة على وجودها الفعلي، ككيان وكسكان، هي وحدها التي يمكن أن تكون سوريا ديموقراطية. «الجمهورية العربية السورية» ليست كذلك لأنها، تأسيسيا، تقصي بعض سكانها، وأي تصور إسلامي لسوريا ليس كذلك للسبب نفسه. و»روجوفا» أو «كردستان الغربية» ليست كذلك تأسيسيا أيضا. و»سوريا الأسد» ليست كذلك لأنها قائمة على عبودية السكان . سوريا التي تعرف بسكانها الكثيرين المختلفين وبكيانها القائم هي المؤهلة لأن تكون دولة ديموقراطية.
هذا التشكل عملية صراعية من دون شك، قد لا نكون اليوم في غير الجولة الأولى من جولاتها.
لا شيء يمكن أن يتحقق لنا دون كسب هذه الجولة، وطي صفحة «سوريا الأسد»، و»الأبد» الملازم لها. ولعله يلزم النظر إلى الأبد الأسدي بمزيد من الجدية، ففي تقديرنا أن العقيدة الضمينة للسلالة الأسدية هي التماهي بين السلالة وقاعدة ملكها السورية في «دولة» تدوم قرونا، وليس عقودا. ومن اعتبار سوريا ملكا أسدياً يواجه أي اعتراض داخلي على حكم الأسرة بالحرب مباشرة. ولعله لذلك لم يقدم النظام بعد ثلاث سنوات من الثورة عليه ولا ربع تنازل صغير. ولن يقدم. تكوينه من صنف تكوين أسوأ الأسر الحاكمة في التاريخ: إما حكم مطلق لا ينتهي، أو إبادة لا تبقي أثرا.
فإن لم يتحقق هذا الواجب الذي طرحه علينا التاريخ، تحطيم الدولة الأسدية والتخلص من الحكم السلالي الأبدي، فما سنواجهه ليس العودة إلى كابوس «سوريا الأسد»، بل إلى ما هو أسوأ بكثير، حكم الشبيحة مع احتلال إيراني، أو صراع منحط مفتوح بين إقطاعيات عسكرية طائفية، يدوم عقدا أو عقودا.
ونرجح لأي حكم إسلامي محتمل في سوريا أن يكون إقطاعية طائفية، لا تستطيع فرض نفسها على البلد، وربما تتعايش مع الإقطاعية الأسدية، وتكون بالتالي تجسيدا واقعيا لتقسيم البلد. قد يكون الشيء الجيد الوحيد في حكم «داعش» في الرقة ومناطق من شمال شرق البلد أنه أحرق بصورة نهائية احتمال حكم إسلامي لسوريا. خيارات الإسلاميين منذ الآن تتراوح بين نموذج «داعش»، أي إقطاعة دينية عسكرية تدخل في حرب مع محيطها، وبين الاندراج كحزب أو أحزاب سياسية مثل غيرها في سورية ديموقراطية. ليس هناك حكم إسلامي معتدل. الاعتدال هو الديموقراطية.
ولدت سوريا كدولة وطنية ترابية قبل أقل من قرن. هذا هو «برنامجها الوراثي». تحويلها إلى شيء آخر يعني تدميرها، أو تحويلها إلى كائن مسخ. نعلم هذا من تجربة تحويلها إلى مملكة أسدية. ولن يكون الحال إلا بالسوء نفسه أو أكثر إن جرى تحويلها إلى دولة إسلامية. لدينا مثال كابوسي على هذا الحكم منذ الآن، والتجربة مُحكِّمة.
موقع الإسلاميين
القضية الثالثة التي نرى أن جيلا جديا من التفكير السياسي في سوريا يتشكل حولها هي موقع الإسلاميين في الحقل العام. طوال 30 عاما قبل الثورة كان الإسلاميون قوة تغيير في البلد، هذا واقع جرى أخذه في الاعتبار في الجيل السابق. لقد فرض نفسه كمعطى «موضوعي» حين أتيح للسوريين التعبير عن أنفسهم في السنوات المنقضية من هذا القرن، من «ربيع دمشق» إلى «إعلان دمشق»، وصولا إلى «المجلس الوطني» و»الائتلاف». هناك بالفعل اعتراضات على موقع الإسلاميين هذا، لكن لم يصدر شيء منها من مواقع تحررية أو ديموقراطية، بل إن بعضا منها على الأقل صدر من مواقع فاشية (نبيل فياض وما شابه، وكتاباته ليس فقط لم تنتقد، وإنما احتفي بها في أوساط تفضل عادة تعريف نفسها بالعلمانية والحداثة…). كان الإسلاميون هم العدو الشبحي الشرير الذي يمكن قول كل شيء وأي شيء عنه، دون معرفة شيء فعليا عنه، وما يسوغ لمثقفين وتشكيلات سياسية الاصطفاف إلى جانب الفاشية الأسدية في مواجهته. أقصى نقد كان يوجه للنظام في هذ الشأن أنه يقمع يساريين وعلمانيين وليبراليين أيضا، ولا يكتفي بقمع الإسلاميين. لكن هذا كلام يحصل أن يقول ما يقاربه حتى بعض ضباط مخابرات النظام، أو جناحه «اليساري» و»العقلاني» إن جاز التعبير، أعني طائفيين وبرجوازيين «مستنيرين»، لا نفاذ لهم إلى نواة النظام الصلبة، ولا يتبنون برنامج السلالة الأسدي الأبدي.
ونوعية النقد الذي يوجهه هذا الطيف السياسي الثقافي للإسلاميين هو النقد الماهوي، الذي إن لم تكن محركاته طائفية صريحة، فإنه يغيب منها كليا ما يتصل بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، وليس في سجله ولو احتجاج حقوقي أو أخلاقي على الأساليب البربرية في معاملة الإسلاميين (أو حتى غير الإسلاميين، السجل متاح لمن يريد الاطلاع). أعني بالنقد الماهوي رد مشكلات مجتمعاتنا المعاصرة إلى الإسلام ذاته، وليس إلى أي شروط سياسية واجتماعية وفكرية نعيش في ظلها. «الإسلام» هو «البنية التحتية» التي لا نفهم أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون إدراك أنها محددة به.
في مواجهة النقد الماهوي ننحاز إلى نقد علائقي، يشرح تشكلات الإسلام التاريخية ذاتها بالشروط الفعلية لحياة الناس، ولا يتعامى عن مشكلات المتن العَقَدي الإسلامي.
وصل واقع الشراكة مع الإسلاميين ذروته ونهايته مع الثورة. من جهة جرت إعادة هيكلة داخلية للطيف الإسلامي لمصلحة السلفيين، وهم أكثر تمركزا حول الذات وإقصاء للغير من التنويعة الإخوانية؛ ومن جهة ثانية أظهر السلفيون، طلائعهم الجهادية بخاصة، من العدوانية والإجرام ما يمثل استئنافا للنظام الأسدي من حيث انتهى وليس حتى من حيث بدأ.
الواقع أن الثورة فجرت التناقض في الشراكة مع الإسلاميين، فهم قوة احتجاج وتغيير سياسي، لكنها قوة تقييد اجتماعي وذات تكوين أبوي في نظرتها إلى المجتمع والسياسة. طالما النظام الأسدي قائم والأمور مستتبة له، يغلب في دور الإسلاميين اعتراضهم السياسي عليه، لكن ما إن بدأت الثورة وحتى قبل أن تحقق هدفها الأولي، إسقاط النظام، حتى شفع نزوعهم التقييدي اجتماعيا والبطريركي بنزوع تسلطي سياسي.
والطابع اللاتحرري العام لفكر الإسلاميين تجسد كروح للشر والقبح في «داعش». لا يكفي القول هنا إن «داعش» تشكيل إسلامي متطرف، وأن الإسلاميين الآخرين لا يتحملون جرائر أعمالها. بالمعنى القانوني لا يتحملون فعلا، بالمعنى الفكري والسياسي يتحملون طبعا، وهم المطالبون قبل غيرهم وأكثر من غيرهم بالمجاهرة بالقطيعة الفكرية والسياسية مع «داعش» ومنهجها التكفيري وممارساتها الإجرامية. حتى المواجهة العسكرية لا تعوض عن ذلك لأنه يمكن أن تحركها اعتبارات المنافسة، أو اعتبارات سياسية ظرفية.
على كل حال يبدو لنا أن الأمور سائرة باتجاه تجاوز تجربة الجيل السابق، وأخذ الوقائع الجديدة بعين الاعتبار، وقائع ميل الإسلاميين الجامع إلى التسلط.
لكن المهم ليس هذا التحول وحده، بل أن يكون من مواقع تحررية وديموقراطية، ومع القطيعة مع النقد الماهوي، ومع المنطلقات الفاشية لمعاداة الإسلاميين في الجيل السابق. هناك طريق مسدود يستحسن ألا نهدر وقتا في السير فيه: استبعاد الإسلاميين عمليا، أو التأسيس الفكري لهذا الاستبعاد. هذا يخدم حصرا الأشد تطرفا بين الإسلاميين، ويضعف الشركاء المحتملين بينهم، وهم موجودون وليسوا نادرين. المهم من جهة أخرى أن تُشفع المخاصمة السياسية والفكرية للإسلاميين بالقطيعة مع مختلف تناسخات البطريركية، وتطوير تجارب تحررية على مستوى التنظيم والتفكير وأنماط الحياة، والتمييز الإيجابي لمصلحة النساء في تجاربنا الجديدة. علينا أيضا أن نمارس حرية الاعتقاد التي ندعو إليها ونجاهر بمعتقداتنا الدنيوية دون حسابات سياسية.
نقدر أيضاً أن الحاجة الاجتماعية لنقد التفكير والسلوك الديني، والتجارب السياسية الإسلامية، تتنامى منذ الآن، وستيعين إشباع هذه الحاجة بمفاهيم وقيم تحررية، لا يستطيع الإسلاميون توفيرها، ويعرض التفكير «الحداثي» عجزا ثابتاً عن توليد مثلها أيضاً.
سياسة الشتات السوري
وهناك قضية تفرض نفسها اليوم دون سابقة، أو بسابقة محدودة لم تتأسس عليها سياسة: قضية الشتات السوري. لدينا اليوم مليونان ونصف المليون من السوريين في مناف قريبة وبعيدة، أكثرهم في لبنان وتركيا والأردن والعراق، يلقون معاملة غير كريمة غالباً، ويحتاج أكثرهم إلى كل شيء، العمل أولاً، والوضع القانوني الشرعي ثانيا، والسكن والطعام والدواء وتعليم الأولاد ثالثاً. ليس هناك بعد معطيات كافية حول اللاجئين السوريين في بلدان الشتات، ولا توجد هيئة سورية عامة تهتم بأمرهم، وتعمل مع حكومات البلدان المضيفة بما يضمن لهم الحماية، أو على الأقل تنجز دراسات وخرائط عن أوضاعهم في البلدان المختلفة، وعن عدد الضحايا الذين ابتعلهم البحر في دروبهم إلى الشتات الأوروبي. البلدان الأوروبية تفكر في السوري كلاجئ سياسي محتمل، وتنصب حواجز قانونية عالية تحول دون وصول السوريين إليها، أو تقليل عددهم إلى أقصى حد. وتعقد اتفاقيات وتفاهمات مع البلدان المستقبلة للاجئين السوريين كي تحمي نفسها من هذا التدفق الكبير القادم من شرق المتوسط.
وبقدر ما هي تجربة قصوى، تجربة «الحياة العارية»، فإن تجربة الاقتلاع واللجوء والشتات، ومعسكرات اللجوء التي يحصل أن يقضي فيه بعض اللاجئين شهورا أو أكثر، أو ربما يعيشون أيامهم كلها فيها مثل مخيمات اللجوء التركية أو مخيم الزعتري في الأردن، هذه التجربة تصلح منطلقا لتفكير جديد في معنى الوطن والوطنية. ليس وطنا هذا الذي يقوم على العبودية، ويملك حكامه البلد. تجربة الشتات السوري تدين الوطنية البعثية وتزكي القطيعة معها كواجب سياسي أول للسوريين.
وفي الشتات الداخلي، إن جاز التعبير، يعيش نحو 7 ملايين سوري في ظروف قلما تكون أقل سوءا. وليس هناك أيضا معلومات كافية عن أوضاعهم أو جهة محددة تهتم بشؤونهم. كان النشاط الإغاثي الذي استهلك الكثير من طاقة ثائرين منذ شهور الثورة الأولي يجري بدوافع التضامن أو حتى كشكل للمشاركة في الثورة، لكن دون أطر عمل منظمة وموارد كافية، ودون تغطية جميع مواقع الشتات الداخلي، فضلا عن حاجات السكان المحاصرين في العديد من مناطق البلد.
كان كل شيء يعطي الانطباع بأن المشكلة قصيرة الأمد وإن تكن بالغة الحدة. ولقد حال هذا الانطباع دون بلورة سياسة مناسبة للشتات الداخلي والخارجي. أنسب اليوم أن نفكر في قضية الشتات السوري مثلما نفكر في الشتات الفلسطيني، قضية مديدة قد تدوم سنينا وعقودا. وقد لا يتأخر الوقت قبل أن ندرك أن النظام الأسدي ليس أقل سوءا من إسرائيل، ولا حلفاءه أقل سوءا من حلفائها.
وإلى تجربة الشتات تفرض نفسها بعد حين قضايا إعادة الإعمار واحتمال أن تكون مدخلا لضرب جديد من الهندسة الاجتماعية في أفق ليبرالي جديد، سواء على يد النظام، أو على يد أطراف محسوبة اليوم على الثورة.
في المجمل تفرض نفسها منذ الآن سياسة الشتات السوري. المعلومات عن اللاجئين أعدادا ومواقع وشروط حياة وأوضاعا قانونية، والموارد اللازمة لسد حاجاتهم، والهيئات التي تتابع هذه القضية في البلدان المختلفة وفي الداخل، مواضيع أولية لسياسة الشتات. أما الهدف النهائي لهذه السياسة فهو العودة وحق العودة إلى البلد.
بداية جديدة
الوجهة العامة لهذه التقديرات حول الهوية والدولة والإسلاميين هي الروح التحررية المبدئية للثورة السورية. المسارات المتعرجة التي سلكتها الثورة خلال ثلاث سنوات لا تنال من حقيقة أن القيم المحركة للثورة هي العدالة والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية، بل إن هذه المسارات مسوغ أقوى للتمسك بها ومحاولة التأثير على الواقع في اتجاهات موافقة لهذه القيم.
الأكيد في تصورنا أن جيلا قد انتهى. أن حساسية جديدة ومفاهيم جديدة في سبيلها إلى التشكل.
وبينما تنطوي صفحة جيل الأنوات بعد ربع قرن أو ثلاثة عقود من ظهوره، وتنطوي معها خصوماته الغامضة وحروب المكانة التي لا تنتهي يخوضها وجهائه، لعلنا نشهد اليوم ظهور جيل أبوات جديد، إسلامي، ثقيل الظل واليد والدم. يملأ هذا الجيل موقع المقاومة التحررية الشاغر بفعل إخفاق مقاومة جيل الأبوات وتقادمها في الوسائل والمعاني، وبفعل ضمور العناصر التحررية في تفكير وسلوك جيل الأنوات الذي أتى بعدهم. لكن جيل الأبوات الإسلاميين، بأسماء أبي فلان وأبي علان، وبلحى طويلة، وبطائفية بدئية، وقيم بطريركية معاية للنساء، أضيق أفقا وأشد عقما من سابقيه.
لا نتصور مخرجا من الأبواتية الجديدة غير تفكير وتجارب تحررية جديدة، لا في اتجاه الأبواتية القديمة وإيديولوجياتها العملية، ولا باتجاه الأنواتية ومذهبها الأناني. تجاربنا الجديدة ستكون مرتجلة وغير ناضجة دونما شك في بداياتها. لكن ليس هناك بدايات ناضجة.
المستقبل
الثورة السوريّة: سنة رابعة/ حازم صاغية
إذا حاولنا أن نتذكّر العناوين الأعرض للتاريخ السوريّ الحديث، أي التالي على استقلال 1946، فما الذي نتذكّره؟
تحضر في المقدّمة الانقلابات العسكريّة، من حسني الزعيم في 1949 إلى حافظ الأسد في 1970. نتذكّر الهزائم العسكريّة، ومن ثمّ السياسيّة، الكبرى كتلك التي حلّت في 1948 ثمّ تكرّرت موسّعة في 1967 قبل أن تتّخذ شكلاً مداوراً في 1982. نتذكّر «الصراع على سوريّة» وكون الأخيرة أوّل بلدان الشرق الأوسط في التوجّه شرقاً والتحالف مع السوفيات، وبالتالي اعتمادها العسكرة وتعزيز قبضة السلطة وأمنها. نتذكّر الوحدة مع مصر في 1958 ثمّ انفراطها في 1961. نتذكّر التوريث الأسديّ في 2000. نتذكّر التورّط في بلدان الجوار أو الوصاية عليها، من إنشاء التنظيمات الفلسطينيّة لتدجين حركة «فتح» ثمّ المواجهات الحربيّة المفتوحة معها، إلى حرب الأردن في 1970-1971، إلى الوصاية على لبنان التي بدأت في 1976، إلى تسهيل مرور الانتحاريّين والجهاديّين إلى العراق. نتذكّر، في الكثير من العناوين السالفة الذكر، ألاعيب حافظ الأسد «الاستراتيجيّة»، لكنْ الدمويّة، التي أكسبته صيت البراعة والمهارة الاستثنائيّتين.
هذه كلّها نتذكّرها بالسلاسة التي يجري فيها الماء، خصوصاً أنّ نهشها لحم الملايين من البشر لا يزال بادي الأثر. لكنّنا سوف نبذل الكثير من الجهد كي نتذكّر شيئاً مفيداً عن الاقتصاد السوريّ، عن التعليم، عن الصحّة. وحين يحضر إلى الذاكرة ما هو داخليّ بحت، فهو لن يكون سوى تدمير حماة القديمة في 1982 والسجون والزنازين ونشاط أجهزة المخابرات والتفنّن في التعذيب حتّى الموت.
هذا التباين بين سوريّة التي جُعلت عسكريّة و «استراتيجيّة» و «عملاقة»، والسوريّين الذين جُعلوا عبيداً وقُزّموا، هو المفتاح الأهمّ لفهم الثورة السوريّة. من هنا يُبدأ، لا من «داعش» و «النصرة». إلاّ أنّه أيضاً المفتاح الأهمّ لفهم استطالتها ومرور ثلاث سنوات عليها، مع ما صاحب ذلك من آلام وتضحيات وشجاعة استثنائيّة، وما لم يمكن تجنّبه من اصطباغ بالحرب الأهليّة والأزمة الإقليميّة.
ذاك أنّ السوريّين لم يثوروا ضدّ نظام، بل ثاروا ضدّ تلك السوريّة التي ولدت مع حسني الزعيم لتندفع اندفاعها النوعيّ الموسّع مع حافظ الأسد. وحين يكون ما يثار عليه مديداً إلى هذا الحدّ، عميقاً إلى هذا الحدّ، واسعاً إلى هذا الحدّ، تغدو الثورة نفسها مديدة بحيث تدخل عامها الرابع من دون أن تحرز انتصاراً واضحاً يتعدّى خلخلة النظام، وتغدو عميقة، مرشّحة لأن تزلزل كلّ ما هو مألوف في السلوك والأفكار التي ظُنّت بديهيّة، كما تغدو واسعة، تتّسع حتّى لخصومها الذين من طينة «داعش» و «النصرة» وأضرابهما.
لقد نجحت تلك السوريّة، لا سيّما على يد تتويجها الأسديّ، في أن تجعل النظام مستحيلاً والثورة، بوصفها البديل الوطنيّ الجامع للنظام، مستحيلة أيضاً. وبعنف وحشيّ يمارسه الذين يحكمون البلد كأنّهم يملكونه، ينتقل السوريّون من الحرب التي يحرّكها الاستحواذ على السلطة والإمساك بمسار البلد إلى حرب تستأنف ذاتها من دون أن يكون موضوع الاستحواذ قائماً. ذاك أنّ البلد لم يعد بلداً والسلطة لم تعد سلطة.
بيد أنّ العبيد، كائناً ما كان الشكل الذي سترسو عليه السياسة، بل الخريطة، وحتّى لو استمرّ النزاع أربعين عاماً، قرّروا أن يكونوا أسياداً. أمّا العبد وحده فهو الذي يشكّك في صواب قرارهم أو يخالفهم في حقّهم هذا.
الحياة
عُجالات على مشارف الذكرى الثالثة للثورة/ ياسين السويحة
الزمن يدور بسرعة… قد لا تُجاري سرعة دوران دوّامة القتل والتدمير والتشريد التي سلّطها النظام الأسدي، بكل تفانٍ وحماسة، وبعون كبير من حلفائه الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التورّط المباشر لـ«حزب الله» والميليشيات الطائفيّة العراقيّة، في حرب مطلقة على المحكومين السوريين، الذين قرروا، قبل ثلاث سنوات بالضبط، أن على زمن الصمت الفولاذيّ الثقيل أن يُدفن عميقاً، عميقاً جداً. أياً يكن، ستصل بعد أيام الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة السوريّة ضد نظام بشار الأسد وعَسَسِه، محاولةً المرور وسط تراكم التعقيدات المعجونة بالدم والدمع وتراب الرُكام.
«سوريا لم تعد سوريا»، «نحن لم نعد نحن»، أو حتى «الثورة لم تعد ثورة».. تعليقات ستُسمع كثيراً هذه الأيام، أكثرها مثقّل بالأسى والحزن. من بقي كما هو، عدا النظام وإجرامه؟
خلال السنة الماضية، مجزرة الغوطة كانت لحظة محوريّة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. اللحظة التي فشل كثيرون –منهم كاتب هذه السطور– في مقاومة الإحساس بأن الكلام قد انتهى: ماذا تقول أمام قتل أكثر من ١٣٠٠ إنسان في ليلة واحدة، وباستخدام سلاح فتّاك بصمت كالكيماوي؟ ماذا تقول وقد انربط لسانك أمام هول المشهد، مع عدم نسيان أن هذا العدد بالكاد يتجاوز ١٪ من مجموع ضحايا الحرب الأسديّة ضد السوريين، قنصاً وقصفاً وقتلاً تحت التعذيب في المعتقلات؟
قدّم المجتمع الدولي، في الأسابيع القليلة التالية على المجزرة، إحدى أكثر صوره إثارة للأسى والاشمئزاز: لوّح المعسكر الغربي بضربة عسكريّة «تأديبية»، لم تأتِ في النهاية، ولم تنفع سوى لكيّ تحرّك بعض الأوساط اليساريّة في الغرب رايات «لا للحرب على سوريا» الخفّاقة بريائها. اتّفق العالم بعدها، عبر مجلس الأمن، على عودة شرعنة النظام عبر إدخاله في معادلة سياسية دوليّة مذهلة في سرياليتها الدنيئة: تسليم السلاح الكيماوي مقابل كسب الوقت والدخول في «عملية سياسيّة» لا وضوح في أيّ من أركانها أو نقاطها. بدأ حينها الابتزاز بـ«جنيف٢».
لم تُحرز الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة شيئاً، ويمكن القول إن الفشل الأكبر لـ«جنيف٢» كان في أنه لم يكفِ لتوضيح أن طرح «مسار سياسي» بهذا الشكل المبتذل لن يؤدي إلا لمضغ الوقت لقمةَ مُرّة.
يبدو واضحاً أنه، لأسباب تخصّ واقع العلاقات الدوليّة على مستوى مجلس الأمن، ليس لدى النخبة السياسيّة العالمية ما تقوله عن سوريا إلا منطق «جنيف٢»، الذي يمرّ عبر تمييع الرغبة التحرّرية من نظام طغياني ومجرم قلّ مثيله في العالم، ثم تعريف ما يجري بأنه «حرب أهلية طائفية» أطرافها متساوون في كلّ شيء، بما في ذلك في السوء، ولا تصريف لهذا التساوي، خصوصاً التساوي في السوء، إلا بـ«تسوية» ما. يبدو النظام مرتاحاً لهذا الأمر، ويدفع باتجاه أن تؤدي التسوية لضرب من الانتخابات الرئاسيّة المُدجّنة، وبمشاركة بشار الأسد. هذا ما يظهر من الحديث المبكّر في الإعلام السوري عن الترشيح وشروطه.
من المجدي التفكير والبحث في منحى النظام السوري لفرض «مصالحات» بقوّة الحصار في أنحاء مختلفة من ريف دمشق، في سياق تحضيراته لما يفترض أنه نتيجة «التسوية»، بدل البقاء في نطاق تخوين أهل المناطق «المُصالحة» من جهة، أو الاكتفاء بتفهّم موقفهم دون تحليل أعمق من جهة ثانية.
لا يبدو المجتمع الدولي راغباً بصرف المزيد من الجهد على سوريا. هناك اليوم ساحات أكثر مركزيّة لتصريف النزاعات الدوليّة، كأوكرانيا. إقليمياً، يتأرجح الوضع بين استثمار إيراني في سوريا لجهة تثقيل القدرة التفاوضيّة، وبين نزاع خليجي-خليجي صار علنياً ومباشراً مؤخراً.
في مثل هذه الأوقات من العام الماضي، كان النقاش على أشدّه حول «جبهة النصرة» ودورها الغامض في الساحة السوريّة. نقاش تعقّد وتشعّب بعد ظهور وتبلور «داعش» في مناطق شاسعة من الشمال السوري، وبعدما فرضت نفسها كقوّة فاشيّة وشديدة التسلّط والعنف، بالإضافة لتقديمها سلوكيّات متواطئة موضوعياً مع مقاصد النظام وشديدة النفع له، ميدانياً وسياسياً وإعلامياً. حملت بدايات عام ٢٠١٤ مجريات انتفاض شعبي كبير ضد «داعش»، أتى نتيجة الاحتقان الكبير من ممارساتها الهلوسيّة المتطرّفة، وأدى لطرد هذا الفصيل من غالبيّة مناطق حلب وإدلب.
لا يمكن المرور أمام الانتفاضة ضد «داعش» دون الوقوف مطوّلاً أمام المعاني التحرّرية التي حملتها، لكن يجوز القول أيضاً أنها لم تُنهِ المشكلة، ولا تُشكّل نهاية المطاف.
ليس الوضع العسكري في سوريا اليوم أفضل من الوضع السياسي، فقد حمل العام المنصرم مجريات تفكّك أكبر في مفهوم «الجيش الحر»، لحساب تكتلات عسكرية-سياسيّة كـ«الجبهة الإسلاميّة» تتحرّك وفق مصالحها ومنطقها ككيان ذي هويّة أيديولوجيّة ثقيلة، وذي مشروع سياسي علني أبعد من إسقاط النظام، غير ملتزم بالخضوع لرغبة السوريين بعدها، وتربطه علاقات خاصة بالأفق الإقليمي الخليجي. هذا عدا «أمراء الحروب» المنتشرين في مناطق الشمال السوري خصوصاً، والمتفرّغين للدفاع عن زعاماتهم المحلّية، ولإدارة مصالحهم في التهريب والأتاوات والسرقة والخطف وتجارة مشتقات البترول.
العنوان الرئيسي لتوصيف حال المجتمع السوري اليوم هو التعب، والتعب مع انسداد الأفق وسوء الواقع يتحوّل إلى يأس بشكل شبه حتمي. هذه طبيعة الأمور. السوريون بشر، لم يُقدّموا أنفسهم يوماً على أنهم جبابرة أسطوريون، ولا يُمكن أن يطالَبوا بالذهاب إلى أبعد من قدرات البشر.
لا مجال اليوم للوقوف فقط عند ذمّ الطبقة السياسية المُعارضة على وضاعة أدائها، والذي نزل في مراحل كثيرة إلى درك الإهانة المطلقة لمشاعر وكرامات السوريين. هي تستحق الذم، وتستحق المحاسبة، لكن ذمّها وحده لا يكفي، ولا مجال يُذكر لكثير من التجارب على مستوى محاولة استبدال هذه الطبقة السياسية سريعاً، جزئياً أو كلّياً، أكثر من محاولة الضغط عليها ولعب دور رقابي عليها.
سوريا اليوم بحاجة للعمل على كلّ المستويات، من السياسة والمجتمع وحتى الثقافة… عمل طويل الأمد، وأكثر تأسيسيّة وأعمق أفقاً من حالة ردّ الفعل التي أُجبرنا عليها حتى الآن. منطلق كلّ عمل هو الانحياز للمجتمع السوري، لآلامه وجراحه، لتطلّعاته وآماله، ومحصّلة الانحياز للآمال والآمال هو الإيمان بأن حقّ الشعب السوري بحياة كريمة، سياسياً واقتصادياً، هو مطلق وغير قابل للوضع على أيّ طاولة تسويات من أيّ نوع. هو البوصلة، هو المنطلق والمستقر.
المأساة الإنسانيّة، موتاً ودماراً ولجوءاً واعتقالاً، هي السمة الأبرز لحياة السوريين اليوم، وهي المقصد الأكثر إلحاحاً للجهود، مع عدم نسيان ما كان يُفترض أن يكون بديهياً: لم يُعانِ السوريون زلزالاً أو فيضانات أو أي نوع آخر من الكوارث الطبيعية. رغم كلّ الويلات القادمة من انتشار الفاشيّات الدينية الصغيرة هنا وهناك، وفوضى السلاح، وسوء تصرّف المعارضة وتقصيرها، يبقى أن المنطلق الرئيسي للمأساة الملحميّة السوريّة هو وجود بشار الأسد وعسسه في الحكم في دمشق بعد عقود طويلة من الحكم الطغياني الإفقاري المنحطّ. هذا أصل الحكاية، وأي نهاية عدا رحيل الطغاة المجرمين ليست إلا بتراً دون بنج.
موقع الجمهورية
ماضون نحو تحقيق أهداف الثورة/ أحمد الجربا
بعد مضي خمسين عاما في ظل الطغيان والاستبداد وطمس كل معالم الحرية ومصادرتها، وتغييب كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية انطلقت الثورة السورية من واقع مادي وسياسي وثقافي معقد، خاصة بعد ظهور الربيع العربي، وكان متوقعا لسوريا أن تكون أولى الدول الثائرة، فإذا كانت الثورة التونسية ثورة كرامة، والثورة المصرية ثورة اقتصادية، والثورة الليبية ثورة سياسية، فإن الثورة السورية جاءت نتيجة كل تلك المشاكل مجتمعة.
منذ البداية خرج الشباب السوري مطالبا بالحرية وإسقاط النظام الاستبدادي، وكان عنوان الثورة «سوريا تريد الحرية» وخارج كل المؤطرات القومية والدينية والمذهبية صرخ السوريون تحت عنوان «واحد واحد الشعب السوري واحد»..
قابل النظام الشباب بالقمع والاعتقال وكان ينظر إلى الشباب الثائر على أنهم «دون كيشوت» الحالم الذي يحارب طواحين الهواء ناسيا أن الحالمين هم من يغيرون الواقع..
لم يستطع النظام إعادة الشباب إلى بيوتهم بالقوة، وكلما زاد إفراطا في القتل والاعتقال ازداد الشعب إصرارا على المضي في طريق الحرية.
انطلق قطار الثورة، ولم يعد لدى النظام حل إلا بإخراجه عن مساره، فحاول تكريس الطائفية باستحضاره ميليشيات حزب الله والحرس الإيراني وأبو الفضل العباس، وارتكب المجازر تلو المجازر ليكون هناك رد فعل عارم..
حاول النظام أن يقسّم الشارع السوري وعمل جاهدا على تلوين الثورة بلون غير لونها إلى جانب عسكرة مسارها، وخطط ليجبر الشباب على حمل السلاح ووضع لهم البنادق في الجوامع دون أن ينجح بذلك أيضا، فأفرط أكثر وأكثر في القتل والتعذيب وسياسة الأرض المحروقة.
وبالعودة إلى الوراء نرى أن إفراط النظام في قتله وتدميره وهمجيته هو من ولّد رد الفعل لحمل السلاح لتتعسكر الثورة بعد ستة أشهر من النضال السلمي للشعب المطالب بحريته.
بعد عسكرة الثورة وإنتاج النظام لداعش وغيرها من التنظيمات الراديكالية بقي النظام مستمرا في القتل بحجة محاربة «الإرهاب» تحت سمع وبصر العالم وارتكب أفظع المجازر ولم يترك سلاحا إلا واستخدمه، كما هجّر النظام السوريين ودمر بيوتهم وأماكن رزقهم، وعمل جاهدا منذ اليوم الأول من عمر الثورة على كسب الوقت وإطالة الأزمة حتى يمّل الناس ويتعب الثوار.
شهداء ومعتقلون يموتون جوعا بعد ممارسة النظام سياسة التجويع كل يوم وكل ساعة وكل لحظة في مناطق متفرقة.
نظام همجي لم ولن يفهم ولا يريد أن يفهم، يكرر أهازيج المقاومة وانتصاراته الكاذبة، ويكرر خطابه في محاربة «الإرهاب»، ولكنه فشل فشلا ذريعا أيضا أمام استمرار الحراك المدني والمظاهرات وأزيز رصاص الثوار الذي لطالما أرق نوم الأسد وقضّ مضجعه عبر ثلاث سنوات.
حاولنا تحقيق حلم اللاجئين والمهجرين بالعودة إلى أرض الوطن في مؤتمر «جنيف 2». وشاركت المعارضة في محاولة لإنهاء القتل والعنف، وعملت على إنجاح الحل السياسي نحو هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، إلا أن النظام أفشل «جنيف 2» بتمسكه بخطابه الممل المكرور نفسه، ولم يقدّم أي استحقاق أو التزام واستمر في اللغة الوحيدة التي يجيدها.. لغة القتل، بل بعد السلاح الكيماوي ابتدع البراميل المتفجرة بكل أحجامها لإرهاب السوريين بكل الطرق التي يجيدها.
ولأن السوريين كلهم كرامة وعنفوان، نعتمد على الشعب السوري العظيم الذي قرر تفعيل ودعم الحراك المدني واستمراره، وندعم كل خياراته في مختلف الحلول، ولن تظل الثورة تعاني بين رحى تجاذبات إقليمية ووسط مصالح دولية..
الثورة مستمرة والشعب السوري بعد أن قدم كل تلك التضحيات، وبعد ما بذله من دماء وما سطره من ملاحم بطولية لأعظم ثورة في التاريخ علّم العالم معنى التضحية في سبيل الحرية، وهو لن يتراجع عن أحلامه بالحرية والكرامة إلى أن يحقق النصر، وسيظل شعار «واحد واحد الشعب السوري واحد» الذي رفع في أول يوم من الثورة هو العنوان حتى النصر.
* رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
الشرق الأوسط
عام رابع من الثورة السورية/ حسام عيتاني
مع بداية العام الرابع للثورة السورية، يمكن اقتراح تقييم أولي على ما حققته أو فشلت في إنجازه برغم التضحيات الكبرى التي قدمها السوريون لتجعل من الثورة حدثاً رئيساً في تاريخ المشرق العربي المعاصر.
والتظاهرات التي انطلقت في المدن والقرى السورية ضمن أجواء ثورات “الربيع العربي” مطالبة في البدء بإصلاحات ضمن النظام القائم وخصوصاً وقف تعسف أجهزة الأمن وعدوانها الدائم على المواطنين، قبل أن تتحول إلى ثورة ضد الحكم الممسك بخناق البلاد منذ خمسين عاماً. التغير لم يشمل شعارات الثورة وأهدافها المعلنة فقط، بل امتد عميقاً ليبلغ أسس الاجتماع السوري والاقتصاد ومجمل العلاقات الداخلية والخارجية.
نماذج الثورات في البلدان التي سبقت سوريا كان مستوى عنف أنظمتها ضد المحتجين متناسباً مع ما هو معروف عنها من درجة القمع التي تفرضها على المجتمع. حتى استخدام معمر القذافي الأسلحة الثقيلة كان بشكل ما يتلاءم مع الميول الدموية الشهيرة عند النظام وعدم تورعه عن اللجوء إلى الاغتيالات والقتل على ما تشهد لائحة طويلة من ضحايا نظام القذافي. في المقابل، جاء العنف الذي مارسه نظام بشار الأسد والرامي منذ لحظات الاعتراض الأولى إلى ترويع المواطنين وزرع الرعب في من لم يشارك في الاحتجاجات قبل أولئك الذين تجرأوا على النزول إلى الشوارع، ليكشف وجهاً أعتقد كثر أن النظام السوري تخلى عنه بعد أحداث حماة، أي وجه القمع العاري والقتل المعمم.
نقاش الطبيعة العنيفة للنظام السوري التي أذهلت العالم من منهجة الاغتصاب والمجازر إلى قصف القرى الآمنة بالغازات السامة، يتطلب عودة إلى الأصول الاجتماعية للفئة الحاكمة بما يتجاوز الأصل الطائفي وحده. وقد يكون من المفيد ربط آليات صعود “حزب البعث” وضباط الجيش والأمن إلى سدة السلطة وتحكمهم بكل مفاصل الحياة العامة من دون رقابة تذكر، بتمسك هؤلاء بما باتوا يعتبرونه ملكاً شخصيا لهم ولعائلاتهم.
وفي الآليات المذكورة تستعاد المراحل الأولى لتأسيس السلالات الملكية في العالم.
فبعد حقبة “التراكم البدائي” التي يجمع فيها مغتصب الحكم ثروته بأساليب لا تختلف كثيراً عن أساليب قطاع الطرق والنهابين (المثال الأشهر هنا هو رفعت الأسد)، يأتي الجيل الثاني من العائلة الحاكمة ليستثمر الثروة في وسائل أكثر “شرعية” وأقرب إلى منطق العمل الاقتصادي التقليدي من دون التقيد، طبعاً، بالقوانين الناظمة لحركة رأس المال (والمثال هنا رامي مخلوف).
“امتلاك” البلد واستعباد ناسه جزء لا غنى عنه في تفسير إصرار الأسد على بقائه في منصبه. وكل الكلام عن المؤامرات الكونية والهجمات العابرة للقارات، تندرج في سياق اعتقاد النظام بحقه في التصرف بسوريا كتصرف السيد بعبده وحقه في اختيار السياسات الداخلية والخارجية الملائمة وفق مصالحه ومعاييره.
ولا يغيب عن بال أن هذا الضرب من السلطات عميق الجذور في الوعي العربي وأن تحديه يضع الثائرين عليه في موقع إشكالي. مثال على ذلك بروز عدد من صغار الديكتاتوريين بين قادة الكتائب المسلحة المعارضة وبين الشخصيات السياسية التي تتقدم المشهد السياسي المعارض. أما القوى الحاملة لفهم أرقى من مجرد استبدال استبداد طائفي- عائلي بآخر قد لا يقل سوءاً، فتعاني الأمرين من التهميش والمطاردة والملاحقة من قبل النظام وجهات محسوبة على الثورة. يضاف إلى ذلك فقر المخزون النظري والفكري، إذا جاز التعبير، الذي تغرف منه القوى البديلة، رغم وجود محاولات مهمة وكتاب جديرين بالتقدير.
والمهم، بعد مرور ثلاث سنوات شديدة الغنى في الدروس السياسية للثورة، أنها أخرجت كل ما اعتمل من عفن بعضه متراكم منذ مئات السنين. وبات من البداهة القول أن الثورة السورية لم تترك مجالاً لترميم صورة المشرق العربي على النحو الذي عرفه فيه العالم منذ نهاية الحرب العالمية الاولى وإنشاء دوله في سوريا والعراق ولبنان والاردن وفلسطين.
وفي وسع المراقب التكهن أن الصدمة التي احدثتها هذه الثورة وعمق التناقضات التي سلطت الأضواء عليها وحجم المصالح المتصارعة فيها، كلها عوامل تحول دون استئناف عمل “النظام” القديم، بمعانيه السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية. بيد أن ذلك لا يقود حكما الى الاطمئنان الى البديل. بل أن الاقرب الى منطق الامور توقع فترة انتقالية قاسية بل عسيرة تتصادم فيها تيارات آتية من عمق التركيبة الاجتماعية والثقافية للمنطقة مع الضرورات الملحة للشعوب بالتقدم والانتساب الى العصر.
وعلى عكس ما يعتقد بعض الحالمين، لم يكن من مجال لتجنب الثورة السورية ومساراتها المأساوية. ربما كان في الوسع تخفيف الخسائر الباهظة هنا أو هناك عند هذا المفصل أو ذاك، لكن أرض سوريا كانت تختزن زلزالاً ما زلنا بعد ثلاث سنوات من انطلاقه نجهل إلى أين سيفضي.
موقع 24
عام رابع: ثورة الـ”مو معقول”/ ياسين الحاج صالح
يمكن تلخيص الانفعال المنسي عند قطاعات واسعة من السوريين طوال عقود حكم حافظ الأسد الثلاثة بعبارة واحدة: مو معقول!
“مو معقول” أن يستطيع النظام ترويض الجيش الذي أتى هو منه، وتحويله إلى جهاز جسيم، منخور بالفساد والطائفية والخوف. “مو معقول” أن يتمكّن من تحطيم الأحزاب السياسية التي وسم أصحابها الحياة السياسية السورية ربع قرن بعد الاستقلال. “مو معقول” أن تصبح شوارع دمشق ميداناً لزعرنة عناصر “سرايا الدفاع” التي كان يقودها أخوه رفعت، واللاذقية ميداناً للشبّيحة.
“مو معقول” أن يتدخل النظام في لبنان ويحطم منظمة التحرير ويقتل ألوف الفلسطينيين، بينما هو يرفع راية القضية الفلسطينية. “مو معقول” أن يقضي معتقلون بالكاد نشروا بياناً أو قالوا كلمةً في السجن عشر سنوات وعشرين سنة. “مو معقول” أن يقتل عشرات الألوف في حماه ويدمر ثلث المدينة. “مو معقول” أن يستمر تعذيب المعتقلين في سجن تدمر عشرين عاماً؛ “مو معقول” أن تعامل سورية كمزرعة خاصة، وأن تدار مثل مزرعة خاصة؛ “مو معقول” أن يستمر النظام ثلاثين عاماً حاكماً لبنان وليس سورية وحدها؛ “مو معقول” أن يُهيّئ حافظ ابنه باسل لوراثة “الجمهورية”، ثم أن يفرض على السوريين الحداد عليه حين مات بحادث سيارة، وأن يُوصَف بأنه شهيد؛ “مو معقول” أن يجري تغيير الدستور خلال دقائق ليفصَّل على قياس الابن الآخر!
قال السوريون “مو معقول” تعبيراً عن ذهولهم وعجزهم عن التصديق. لكن فيه أيضاً تعبير عن هشاشتنا، أفراداً ومجتمعاً وكياناً، وعدم قدرتنا على التحول من الدهشة إلى المبادرة، ومن عدم التصديق إلى تغيير الواقع.
وبينما نحن في ذهولنا الطويل، كان “المو معقول” يرسّخ نفسه. عشنا في ظله الثقيل 30 عاماً، ثم 11 عاما أخرى، ثم 3 سنوات إضافية.
استُخدِمت كلمات مثل “الوحشية” و”تغوّل الدولة” لمقاربة الحال، لكنّ السوريين قلما أمكنهم تحويل عنائهم الرهيب إلى معان قوية. لدينا ضعف لا يطاق في الملكات المفهومية والرمزية التي كان يمكن أن تحفر عناءنا في سجل الألم الإنساني، وفي سجل التحرر الإنساني. نقول أشياء ليست قليلة، لكنها خفيفة ومتلاشية، لا نُسمّي، لا نبتكر مفاهيم وقيماً وعقائد، لا نصنع صوراً ورموزاً مؤثرة. هذه ليست أفعال معرفة، بل هي أفعال مقاومة وتحرر وظهور ذاتيات وفاعلين جدد، أفعال وجود.
في هذا نحتاج إلى ثورة تكمل ثورتنا المحطمة، وتشكل استمراراً مغايراً لها. لا نقول إن الثورة الحقيقية هي هنا، في بناء جمهوريات المعاني ومجتمعات المفاهيم المتحررة، وفي ابتكار العقائد والتضامنات الجديدة، لكن نكاد نقول ذلك. وقد لا يتمثل الفرق بين المجتمعات في المحن التي تصيبها، أو الأوضاع المجنونة التي قد يبتلي بها الناس، بل في القدرة على تحويل المحن إلى معانٍ، والجنون إلى عقول جديدة، مفاهيم ورموز وقوانين، وأديان، وفي تطوير مواثيق لتوليد المعقولات… نحن لم ننتج شيئاً مهماً على هذه الصعد منذ أزمنة بعيدة. وهو ما يعني أننا نعيش عيشاً مباشراً، لا ننفصل فيه عن الواقع الخام، ولا ننتج واقعاً آخر، إنسانياً ومعقولاً.
وبفعل ذلك، اجتمع على السوريين شرط “المو معقول”، المُعاش واقعياً والمحروس بالقوة، مع ضعف إنتاج معقولات قوية تشكل واقعاً منظماً، أو نظاماً مميزاً للواقع. دون معان ترويه وتحفظه وتؤوِّله وتعيد تأويله. عناؤنا الرهيب ضاع أو كاد.
بعد الثورة استعاد “المو معقول” سيرته كاملة وتفوّق على نفسه. في شوارع دمشق صار يُهتف: شبيحة للأبد، لأجل عيونك يا أسد! وتكتب على الجدران شعارات: الأسد أو نحرق البلد! أو: الأسد أو بلاها هالبلد! المضمون الفكري والقيمي للنظام اليوم هو “الأسد”، لا شيء آخر، وهو يوغل في الوحشية بالتناسب مع فقر محتواه. في السجل منذ الآن 9 ملايين ونصف المليون مهجرون، أي 40% من السكان، ومنهم مليونان ونصف المليون خارج البلد، وصناعة موت منظمة في أقبية الأجهزة الأسدية (11 ألف ضحية خلال عامين وخمسة أشهر في دمشق وحدها، 12 ضحية في اليوم الواحد)، واستخدام الطيران الحربي وصواريخ سكود والسلاح الكيماوي ضد “السوريين السود”، سكان “العالم الثالث الداخلي”.
من الأب إلى الإبن هناك استمرارية لا ريب فيها: “سورية الأسد”، دار العبودية السياسية وتمردات العبيد الدامية.
لكن مرة أخرى هناك ما أخذَنا على حين غرة، وصرنا نهتف كل حين: مو معقول! إنه المسلك الإجرامي لمجموعات إسلامية محاربة. في ظهورها وفي توسعها، وفي سلوكها حيال المجتمعات المحلية، هناك الكثير مما هو “مو معقول” بشأن هذه المجموعات. “مو معقول” أن تسيطر داعش على الرقة ومناطق من شمال وشمال شرق البلد؛ “مو معقول” أن يُخطف أشجع الثائرين ويغيَّبون دون معلومات عنهم؛ “مو معقول” أن تُختطف رزان زيتونة وسميرة الخليل ووائل حمادة وناظم حمادي في الغوطة الشرقية على يد “جيش الإسلام” وبالترتيب والتفاهم مع “جبهة النصرة”، دون معلومات عن مصيرهم بعد 3 شهور ونيف من الاختطاف؛ “مو معقول” أن تتقاسم “جبهة النصرة” والنظام عوائد النفط في دير الزور؛ “مو معقول” أن يُقطع رأس تمثال أبو العلاء في المعرة ويُحطّم تمثال هارون الرشيد في الرقة؛ “مو معقول” أن يجري قتل طفل في الثالثة عشرة في حلب لأنه جدّف في كلام عابر؛ “مو معقول” أن تُقطع يد سارق مفترض، وأن تجلد نساء لأنهن لم يتنقّبن تماماً!
لكن إن كان لنا ألا نقضي سنوات إضافية في الذهول وعدم التصديق، بينما يصنع “الدواعش” وأشباههم الوقائع على غرار ما سبق أن فعل نظام الشبيحة الأسدي، فلا بد من مقاومة متجددة. يمكن لانقضاء ثلاث سنوات على ثورة السوريين أن يكون منطلقاً لتجدد مقاومة المسخ المتعدد الرؤوس، واستجماع المقاومات المتفرقة المشتتة حالياً، ومن أجل تفكير جديد متحرر، وتيارات تحررية جديدة.
كان العام الثالث من صراعنا فظيعاً على السوريين، بدأ بتدخل أميركي “معقول جداً” من وراء الستار لحماية النظام من السقوط عسكرياً على يد الثورة (كان هذا ممكناً حتى مطلع ربيع 2013 في رأيي)، ثم بتدخل إجرامي معقول جداً بدوره من “حالش” بأوامر طهران وأموالها، متزامن تقريباً مع الصعود والتوسع المشهدي لـ”داعش”.
العام الرابع يمكن أن يكون عام العمل على استعادة زمام المبادرة، على صعيد التواصل والتفكير، وأشكال الانتظام والعمل، كمدخل إلى أشكال أكثر فاعلية من العمل التحرري.
في عالم يتقاسم تخريبه قوى إجرامية ثلاث، الأميركي الإسرائيلي الذي أجزم أننا لا نحيط إلا بقليل من أذاه أثناء الثورة السورية (دع عنك سجلّه قبلها)، و”الحوالش” و”الدواعش” (بزعيمَيهم المحتجبَين، وبما لا نحيط يقيناً بكثير من روابطهما) وأشباههما، ونظام الشبيحة الأسدي الذي يخفى عنا الكثير أيضاً من أسراره وروابطه (مقدار التدخل الإيراني، والعراقي…، عمليات قذرة على يد مجموعات جهادية مصنعة) تختلط الثورة ضد الطغيان حتما بكفاح التحرر الوطني وبالصراع ضد الطغيان الديني.
في مواجهة ثالوث الشر هذا، أكثر ما يلزمنا كفاح المخيلة والتفكير الحر، وابتكار أشكال جديدة من التضامن والتنظيم والاعتقاد، لإخراج مقاوماتنا التحررية من مأزق التجزؤ والحصار.
الخيال وشجاعة الفكر والأمل حلفاؤنا، وإن يكن الواقع حليف أعدائنا. نثق بحلفائنا.
موقع لبنان ناو
في الذكرى الثالثة للثورة السورية: الثورة المقهورة/ عمر قدور
(إلى فائق المير وسميرة الخليل ورزان زيتونة وفاتن رجب فواز، والكثيرين الكثيرين ممن يستحقون الحرية)
لم يتخيّل أحد من السوريين، قبل ثلاث سنوات، أن تمر الذكرى الرابعة لإندلاع الثورة وهي لا تزال مستمرة. اليوم، بوسع الكثيرين تفنيد الأسباب التي منعت الانتصار، ومنها عدم تقدير القوة الحقيقية للنظام، أي أن استعجال النصر كان خاطئاً في الأصل، إن لم يكن في مرتبة الوهم. ذلك يعني فيما يعنيه ألا نكون مع أوهام جديدة عن انتصار آتٍ، وأن نسلّم بأن الثورة في سبيلها إلى الانكسار وفق موازين القوى الحالية، وربما يكون استرجاعنا لذكرى الثورة نوعاً من الحنين إلى زمن الأوهام الجميلة، أو وقوفاً على أطلال ما تبقى من أناس وبلد، أتت عليهما معاً وحشية لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر. عدد القتلى وحده لا يعطي صورة واضحة عما حل بسوريا، إذا لم يكن مصحوباً بحجم الدمار، وبالتحطيم المنهجي الكامل لمقومات الحياة. وهذه حالة تعرض لها بعض المدن في التاريخ البعيد والقريب، لكن لم يتعرض لها بلد بأكمله. وبالتأكيد، لم يتعرض لها بلد من سلطته الحاكمة مهما بلغ استبدادها. على الأقل، من هذه الجهة، ليس بوسعنا الزعم بأن الثورة بخير ما دام البلد برمته ليس كذلك.
لقد أرادها النظام منذ ثلاث سنوات حرب وجود، بكل ما لها من معنى. وأيضاً، بأسوأ معانيها. وينبغي الاعتراف بأن الصراع الحالي بات أقرب إلى المفهوم الذي أراده النظام. نحن لم نعد أمام ثورة وفق الصورة التقليدية عن الثورات، بل أمام صراع يخص وجود السوريين على النحو الذي وجدوا فيه في أرضهم عبر مئات أو آلاف السنين، الصراع لم يعد صراعاً حول رؤيتين مختلفتين كلياً في السياسة، بل أصبح صراعاً حول الوطن، فإما أن تتكرس ملكيته باسم زمرة حاكمة، وأن نقرّ باستحالة عودة ملايين النازحين السوريين مع فتح الباب لملايين إضافية أخرى، أو أن يتملك السوريون وطنهم وقدرتهم على حكم أنفسهم معاً. كل الافتراضات التي يجري ترويجها عن حل سياسي في سوريا، لن يكون ممكناً تحققها إلا ضمن أحد هذين الحدين، لأن سوريا الموحدة لن تكون قابلة للقسمة بين النظام الحالي والسوريين؛ التقسيم شأن آخر لا يبدو مطروحاً الآن.
ثمة أوهام مقابلة تُروّج في الآونة الأخيرة عن انتصار النظام وإعادة تأهيله للبقاء، أوهام تستمد قوتها من الدعم الخارجي اللامحدود، الذي تتلقاه آلة القمع، وثمة رغبة جلية عند البعض في اعتبار الثورة وكأنها لم تكن، أو بعدّها حدثاً عارضاً في حياة السوريين. يترافق مع تلك الأوهام والرغبات، تمنيات صريحة أو مضمرة، بأن يتمكن النظام من تجاوز استعصائه الداخلي على التغيير، الاستعصاء الذي كشف عنه تعاطيه مع الثورة منذ يومها الأول. لكن المؤكد حتى الآن أن الثورة، رغم عدم تمكنها من النصر، منعت عن النظام فرصة حكم البلد على النحو الذي ساد لخمسة عقود؛ لا عودة إلى الوراء أبداً، العودة إلى ما قبل الثورة وهم كبير يراود أنصار النظام الظاهرين والمتخفين. المراهنة أيضاً على التضحية ببعض رموز النظام بغية الإبقاء عليه، قائمة على جهل بواقع السلطة السورية. فما تفهمه القوى الدولية الفاعلة محقةً، وهو الذي أعاق انتصار الثورة حتى الآن، هو أن تنحية رموز النظام ستكون مدخلاً لانهياره التام. الأمر لا يقتصر على حلفاء النظام وحسب، بل يشمل أيضاً القوى المحسوبة على أصدقاء الثورة، والتي تبرر تقاعسها عن حماية السوريين بالكلفة الباهظة لانهيار النظام.
قد تكون مصيبة السوريين، بخلاف ما حدث في دول عربية أخرى، أنهم أُجبروا على الفعل الأكثر جذرية، مع التبعات الباهظة لقطيعة من هذا القبيل. عمليات ترويض الثورة التي قامت بها مختلف القوى خلال ثلاث سنوات لم تؤدّ عملياً إلا إلى زيادة راديكاليتها (التطرف الإسلامي ليس سوى مظهر واحد من مظاهر التطرف)، لأن محاولات ترويض الثورة لم يقابلها في الجانب الآخر محاولات لردع النظام. ما حدث بالأحرى كان بمثابة تقوية للنظام على السوريين، ولعل الأخير لم يكن في بعض الأحيان أكثر من هراوة تُضرب بها الثورة، لتقبل ما لا تستطيع القبول به. ولعلنا لا نجافي الحقيقة بالقول إن الانتصار لم يُمنع تماماً عن الثورة، لأن الانتصار الأول قد حدث بمجرد انطلاقها، وبات معلوماً بعد عدة أشهر من البداية أن النظام غير قادر على إيقافها. لذا، بدءاً من العام الثاني تآزرت القوى الخارجية على إيقاف الانتصار، أو تفريغه من مضمونه على الأقل.
حرمان الثورة من أحقيتها بالنصر النهائي هو أعتى سلاح استُخدم ضدها حتى الآن، وقد تكون آثاره أمضى من الأسلحة المباشرة التي استخدمها النظام، لأن القهر الذي يولده الحرمان لن يتوقف عن الطرق على أبواب الحاضر والمستقبل. صحيح أنها ليست المرة الأولى في التاريخ التي تقُهر فيها ثورة، لكنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي يحدث فيها تدمير بلد وشعب بهذه الوحشية لكسر إرادته. أي أن الجميع يعلم استحالة قهر الثورة من دون قهر الغالبية العظمى من السوريين؛ على وجه الدقة، الجميع يعلم استحالة قهر الثورة من دون تدمير أهلها دماراً كاملاً. لقد صار وراءنا القول بأن السوريين وحيدون في معركتهم مع النظام، فالأصح القول إنهم وحيدون في معركتهم مع كافة القوى التي لا ترغب في انتصارهم، ومن ضمنها النظام وحلفائه. الثورة صارت أشبه بأمثولة سيزيف، صارت أن يدحرج السوريون الصخرة إلى الأعلى ثم تتكالب القوى عليهم لدحرجتها إلى الأسفل. لكن ذلك لم يمنعهم حتى الآن من معاودة المحاولة، مهما بدا الوصول إلى القمة مستحيلاً.
كان من الإنصاف أن ينزل السوريون في مثل هذه الأيام إلى الساحات للاحتفال بذكرى نصرهم، وكان من الإنصاف أن تغصّ الساحات بمئات الآلاف من أولئك الذين قُتلوا أو لا زالوا قيد الاعتقال. عدم حدوث ذلك حتى الآن، وعلى رغم كل العوامل المحيطة والمحبطة، لا يعني أنه لن يحدث فيما بعد. لقد مرّ السوريون بأوقات حالكة عديدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وفي كل مرة منها وضعوا أيديهم على قلوبهم خشية انتصار نهائي للنظام، إلا أن الأمل كان دائماً يأتي؛ صحيح أنه كان أملاً ناقصاً، وأحياناً بالكاد يكفي من أجل البقاء على قيد الثورة، إلا أنه برهن على قدرة السوريين على الاستمرار بأدنى الإمكانيات. هكذا هو حال الثورات عندما تتحول إلى صراع من أجل الوجود، ينعدم فيها ترف تعدد الخيارات، ويصبح التفاؤل واجباً إزاء الحياة نفسها، لا مزاجاً شخصياً أو جماعياً؛ في الواقع، أي خيار آخر سوى الإبقاء على الشعلة الصغيرة للأمل سيكون بمثابة قرار بالانتحار الجماعي. القرار الذي يُستبعد أن يُقدم عليه شعب مهما تعرض للقهر.
الآن، ربما لا تكون لحظة مناسبة للاحتفال، بل على الأرجح، الطرف الذي بوسعه الاحتفال هو النظام، لأنه صمد لثلاث سنوات كاملة. سيان بالنسبة له أنه صمد أولاً على جماجم مؤيديه ومرتزقته من الخارج. كل الدمار الذي لحق بالبلد هو دمار أُلحِق بالثورة، ولن يعوّضه سوى نصر نهائي كامل، كل الذين قتلهم النظام هم موتى بانتظار قيامتهم لحظة النصر.
المستقبل
ولكن أين النظام الذي ثرنا عليه؟/ غازي دحمان
ينهي السوريون ثلاثة أعوام من ثورتهم باكتشاف هائل، ليس هذا هو النظام الذي ثرنا عليه؟ وهو أمر، بل شك، مخيب للآمال بقدر ما هو مربك، ولعل ذلك ما يفسر حقيقة الإنزياحات التي طرأت على المشهد الثوري بمكوناته وعناصره المختلفة.
قبل ثلاثة أعوام خرج السوريون إلى الميادين والساحات، بصفتهم مواطنين يعيشون ضمن إطار سياسي قانوني عنوانه الرئيس دولة، وهذا ما يفسر الحالة السلمية والقبول بدفع ثمن الاستحقاقات اللازمة والمستوجبة لمثل هذا النوع من الأفعال، فالمواطن اعتبر أن الحكم بينه وبين من تظاهر ضدهم هو ذلك الإطار القانوني وصفته تلك، مواطن، وبالتالي فإن سقف عقوبته سيكون محدودا ومعلوما وممكنا تحمله.
قبل ثلاثة أعوام خرج السوريون إلى الميادين والساحات، ضد ما إعتقدوا انه نظام سياسي وطني، فاسد صحيح، قمعي صحيح أيضاً، وتجاربهم السياسية معه مؤلمة وقاسية، لكنهم اعتقدوا انه بالنهاية نظام، وأن فهمهم السياسي العام يجعلهم يعرفون السقف الذي قد يصل له مدى قمعه ووحشيته تجاههم، وحجم الأثمان التي يترتب دفعها، ستكون مرتفعة بلا شك. وهم جاهزون في سبيل الخلاص من هذا الوجع، الذي صار يعد دائماً بالمزيد من الألم.
في ذلك الحين، كان هناك متشائمون يتوقعون أن النظام سيقتلع البلد بسكانه وحجارته. وكان هناك متفائلون، يتوقعون ما أن تصل الجماهير إلى ساحة الأمويين حتى يخرج أحدهم من القصر ويعلن هرب الرئيس. والأمر حسب هؤلاء، لا يحتاج لأكثر من مقتل بضع عشرات المتظاهرين قبل أن يلقي العسكر سلاحهم، ويتعانقون مع إخوتهم المتظاهرين، لتبدأ سوريا صباح اليوم التالي بلا نظام الأسد!
كان هذان الرأيان موجودين في منتصف آذار 2011، لكن الرأي العام الغالب كان يميل لترجيح مشهد وسطي بينهما، فلا النظام يستطيع تدمير سوريا بالكامل، لأن تلك مهمة لا يستطيع تحمل تبعاتها، إذ لا البيئة الدولية، في زمن سيادة شعارات حقوق الإنسان والشرعية الدولية، تسمح له بهذا الحد، ولا مناخ «الربيع العربي»، الذي يرخي بظلاله على شعوب المنطقة، يتيح إمكانية اغتياله بهذه الطريقة البشعة. من جهة أخرى لا يعني ذلك أن النظام الإستخباراتي القمعي سينهار، بالسهولة التي انهارت بها أنظمة تونس ومصر. الثورة لن تكون رخيصة الثمن، بل سيكون ثمنها مؤلما، لكن ما لابد منه لا بد منه.
هذا الرأي الغالب كان أيضاً يضع في حسابه حقيقة أن من يثورون هم مواطنون، ومن تشتعل الثورة ضده نظام سياسي، مع إدراك الفارق بين مفهومي المواطن والنظام كما هو في سوريا، من حيث الوضع القانوني ودرجة الحقوق وطبيعة التأثير، عما هو موجود ومعروف في العالم المعاصر. الثورة أصلاً حصلت في إطار هذا الفهم، وبهدف تصحيح ذلك الخلل الحاصل في العلاقة، ومن اجل الوصول إلى الوضع الأفضل للعلاقة بين المواطن والنظام.
بعد ثلاث سنوات، توصّل السوريون إلى حقيقة مفارقة تماما لتلك التي كانت بأذهانهم، الطريق إلى هذا الفهم كلفهم رحلة عذاب لم يشهد مثلها تاريخ العلاقة بين المواطن والدولة، في الزمن المعاصر. أكتشف السوريين أن ما ثاروا عليه لم يكن نظاماً ولا دولة، والنتائج تدلل على نفسها، فلا نظام وطني يمكن أن يقدم على كل هذه الأعمال، ولا دولة يكون الشعب أحد أركان شرعيتها ومكوناتها الوجودية، قد تسمح أنظمتها ومؤسساتها وقوانينها بكل تلك الاستباحة للشعب، الذي يفترض أنها تمثله وتحميه! إذاً، ما هذا التشكل الذي انضوى السوريين في إطاره كل تلك السنوات، وما هو شكل العلاقة التي ربطتهم بالمؤسسات والأنظمة الموجودة، بل ما طبيعة تلك الكيانات والأطر أصلاً؟
شرعية هذه الأسئلة تؤكدها بالفعل لحظات التأسيس الأولى للثورة السورية والمسار، الذي سارت عليه لشهور طويلة. ويكفي فحص إحداث تلك المرحلة والفعاليات التعبيرية لها، والشعارات التي تم رفعها وكذا الخطاب السياسي للثوار، للتأكد من حقيقة أن هذه أدوات مواطنين في مواجهة نظام سياسي ودولة. فهل اخطأ السوريون حينها بأدواتهم التعبيرية لأنهم في الأصل كانوا أمام حالة ليست هي الحالة التي تصوروها؟ وما هي الأدوات البديلة التي لو أستعملها السوريون حينها لاستطاعوا من خلالها عبور مرحلتهم تلك، إلى نظام سياسي أفضل، ودولة أكثر انسجاماً، ومواءمة لتطلعاتهم؟ وهل ثمة بالأصل أدوات أخرى ممكنة ومقبولة؟
خرج السوريون إلى ثورتهم، وظنهم أنهم كباقي الشعوب، يمتلكون نظاماً سياسياً ودولة، أليسوا هم جزء من المنظومة العالمية والسياق العالمي، القائم على وجود مؤسسة الدولة كظاهرة سياسية حداثية؟ لم يكن في ظن أحد منهم اختراع إطار جديد غير ذلك الموجود أصلاً. ما كان في البال هو الإصلاح أو التغيير ضمن حدود اللعبة السياسية المعروفة، أياً تكن نسبة ذلك التغيير وحدوده، لكنهم فوجئوا بحالة غريبة يصطدمون بها، حالة دولة ونظام مغايران عما هو معتاد وطبيعي. من السيولة بحيث سهل تحوله إلى أطر مرنة تضيق لدرجة لا تتسع فيها سوى لشخص الزعيم. وفي حالات أخرى لبعض مواليه وأنصاره، وتتسع في صلاحياتها بحيث تتجاوز صلاحيات الدولة الحديثة، وحدود قدرتها على إخضاع مواطنيها، والسيطرة المطلقة عليهم، لدرجة الاستهانة بحياتهم وإنسانيتهم، وأن هذه الدولة قد تكون مغلقة أمام أصغر مطالب مواطنيها، وفي الوقت نفسه لديها القدرة على استدعاء قوى خارجية للقيام بوظائفها كدولة في مواجهة مواطنيها!
سوريا بعد ثلاثة أعوام من الثورة بلد بلا نظام ولا دولة، ميليشيا بشار الأسد ليست نظاما، هي مجرد فصيل بين فصائل كثيرة متحاربة، والمؤسسات التي تسير شؤون حرب هذا الفصيل ليست الدولة السورية، يكفي أن هذه التشكيلات تدير، وبمنهجية، أكبر عملية تهجير وقتل للسوريين. والثورة على عتبة عامها الرابع تجد نفسها في حرب على جبهات عديدة، وقد أربكها ذلك التحول الطارئ على الدولة والنظام. وحتى تتكيف مع تلك التطورات الغرائبية، يلزمها تصحيح الكثير من الإنزياحات الحاصلة في بعض مكوناتها.
المستقبل
لا بدّ من مبادرة/ سمير العيطة
بعد ثلاث سنوات من انطلاق حركة شعبيّة كبيرة في سوريا نادت بالحريّة والكرامة، ومع ما آلت إليه أمور هذا البلد وأهله اليوم، لا فائدة الآن من السجال إذا كان على هذه الحركة أن تبقى سلميّة مهما كان القمع أو التحريض الخارجي، أم لا.
ما يفيد اليوم هو التفكّر في ما يمكن أن يخرج سوريا من محنتها. فهناك سلطة قائمة عملت منذ البداية على معادلة طرفاها: بقاؤها أو تدمير البلد. لكنّها سلطة لها قراءة سياسيّة داخلياً وخارجياً للواقع، من ضمن منطقها، أدقّ من منطق أولئك الذين ادّعوا دعم «الثورة» في سوريا.
وهناك معارضة سياسيّة قامت منذ البداية على أوهام أنّها يمكن أن تدير حراكاً كان في الأساس شعبيّاً وشبابيّاً، لا منّة لها عليه، من دون قراءة منطق الخصم. لقد اعتقدت أنّه يمكنها أن تعتمد على شرعنة دول خارجيّة لهياكلها من دون أن تبحث كيف تبني مؤسسات تخلق ترابطاً عضويّاً بينها وبين الحراك الشعبي، ريادة وتنظيماً، من أجل مقاومة مخطّطات الخصم، لا في زمن النضال السلمي وحسب، بل خاصّة حين انزلقت الأمور إلى الصراع المسلّح.
السلطة القائمة ماضية في صلفها. فها هي تعمل في مناخ الفوضى التي أخذت إليه لتنظيم انتخابات رئاسيّة صوريّة، نتائجها معروفة مسبقاً. وها هي المعارضة السياسيّة غارقة في خلافاتها، تبحث عن قرار مجلس أمن دوليّ لن يأتِ، أو عن تدفّق للسلاح لا يفيد طالما أن لا تنظيم للسلاح ولا تمييز حاسما بين التطرّف والمقاومة. وها هو الحراك الشبابي الشعبي منهمك في الإغاثة، يبتعد أكثر وأكثر عن السياسة.
فكيف الخروج من الاستعصاء القائم؟
فرصة التفاوض السياسيّ على حلّ من خلال «جنيف 2» تتبدّد رويداً رويداً، لأنّ السبيل لمواجهة صلف السلطة هو توافق معارضيها على موقفٍ واحد، ونبذ خلافاتهم، والتخلّي عن منطق أنّ المهمّ هو الحصول على الشرعيّة الدوليّة، لا كمعارضة قائمة على برنامج مشترك، وإنّما كدولة ستحلّ مكان الدولة القائمة. وهذا لا يبدو أنّه سيحصل قريباً.
فرصة الحسم العسكريّ أيضاً تبدو بعيدة المنال. ولا تسمح به حالياً التوازنات الدولية القائمة.
من الأجدى في ظلّ هذا الواقع التوجّه إلى شيء آخر يثبت أنّ زمام المبادرة بيد السوريين، لا غيرهم.
إنّ أيّ خروج من الاستعصاء القائم لا بدّ له أن يلبّي أوّلاً ما تطالب به أغلبيّة السوريين: أي وقف الاقتتال. لكنّنا نعرف بوضوح أنّ النظام القائم لن يتفاوض على ذلك إلاّ مقابل مكاسب سياسيّة. وهنا ربّما تكمن القوّة والريادة في إعلان عن وقفٍ شامل لإطلاق النار من طرف واحد بمبادرة من المعارضة المسلّحة، ولو لفترة وجيزة، بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق الانتفاضة الشعبيّة. والطلب من الأمم المتحدة، وروسيا والولايات المتحدة سويّة، المساعدة على تثبيت وقف إطلاق النار.
نعم، وقف إطلاق نار من طرفٍ واحد، ليس استسلاماً، ولكن ضمن خطّة متفق عليها على جميع الجبهات كي تتمكّن الجهود الإغاثية من إيصال الطعام لجميع المناطق ويستطيع الناس المحاصرون التقاط أنفاسهم.
السفير
في الذكرى الثالثة للثورة السورية: الصورة والحكايات والحقيقة/ ماجد كيالي
لعبت الصور، ومعها أشرطة الفيديو، دوراً كبيراً في التعريف بالسوريين، بحكاياتهم ومكنوناتهم، بتفاصيلهم الحلوة والمرة، بمشتركاتهم واختلافاتهم، بآلامهم وآمالهم، بتضحياتهم وبطولاتهم، كما عرّفت على بلادهم، التي تبيّن أنها كبيرة جداً وعميقة جداً ومغيّبة جداً.
هكذا أضحت الصورة، طوال الثلاثة أعوام الماضية، جزءاً حقيقياً من الثورة السورية ومن فعالياتها، أي جزءاً من فعل التحرّر، وتخيّل الحرية، عند السوريين. والواقع فهذه المرة الأولى، منذ خمسة عقود، التي يتم فيها كسر احتكار النظام للصورة النمطية التي روّجها عن سوريا، باعتبارها مجرّد ساحة، أو مكانا، يضم حشوداً من البشر تصفّق للأسد، وتهتف له وترفع صوره، وحيث صور الأب، وبعده الابن، تحتل الحيّز العام، في الشوارع والساحات والحدائق والمكاتب والمدارس والجامعات والأسواق والمطارات.
لم يكن هذا الأمر هيّنا إذ أن مجرد التقاط صورة، ناهيك عن نشرها في شبكات التواصل الاجتماعي أو إرسالها إلى محطة فضائية ما، بات بمثابة عملية انتحارية قد تودي بصاحبها إلى الجحيم. فهذا النظام الذي حول سوريا إلى صندوق مغلق، والذي لم يتسامح طوال عمره مع الرأي الأخر، ولا مع كلمة، أو صحيفة، لم يتسامح مع الصورة، إذ بات يفتّش عنها في الموبايلات و»الفلاشات» والكومبيوترات، كأنه يفتش عن سلاح.
على أية حال فقد كسرت الثورة الصندوق المغلق، وكسرت معه احتكار النظام للصورة، وللمجال العام، وفوق هذا وذاك فقد كسرت هيمنته وهيبته، وكان هذا ايذاناً بظهور السوري الجديد، الحرّ، مع كل ما في هذا الظهور من عذابات وفوضى وانفلاش.
في صور السوريين الجدد غدت اللقطة بمثابة لحظة تاريخية، أو ايذانا بتاريخ جديد، هذا بدأ مع الصورة الأولى التي فاجأت العالم، والتي وثقت للمظاهرة الأولى في حي «الحريقة» الدمشقي (17/2/2011) والتي تعرّف العالم عبرها على شعار: «الشعب السوري ما بينذل»، وقتها (وكنت شاهداً على هذا الحدث بالمصادفة) كان المارة يتسابقون على تصوير هذا الحدث العفوي الذي دخل التاريخ بموبايلاتهم، ليصبح بعد دقائق على شبكات التواصل الاجتماعي.
بعد ذلك توالت الصور، من مظاهرة أهالي المعتقلين أمام مبنى وزارة الداخلية (15/3/2011) إلى المظاهرات في ساحة عرنوس أو الميدان، إلى صور انتفاضة أهالي درعا، احتجاجا على اقتلاع اظافر اطفالهم، وهكذا بدأت حكاية الثورة كما باتت ترويها صورها.
طبعاً قد يمكن الحديث هنا عن ألوف أو عشرات ألوف الصور، إذ بالتأكيد أن ثمة لكل سوري حكاية وصورة، لكن ثمة صور أثرت أكثر من غيرها في التعبير عن حال السوريين، وصياغة رؤيتهم لذاتهم، وفي تعريف العالم عليهم.
مثلاً، في الأشهر الأولى للثورة برزت صور المظاهرات العارمة والمدهشة التي استعاد فيها السوريون مجالهم العام، لاسيما باعتصامهم الحاشد في مدينتي حماه وحمص. كما ظهرت في خضم هذه الأحداث صور المتظاهرين وهم يمزّقون صور بشار الأسد المعلقة على مبنى محافظة حماه (7/5/2011)، أو يحطمون تماثيل الأسد الأب، في حمص وحماه، وهي الصور التي تكررت في معظم المدن السورية، وقد تصدرتها صور تدمير التمثالين الكبيرين في الرستن (15/4/2012) ودير الزور (4/9/2012)
وفي 30/3/2011 اشتهرت صورة عضو «مجلس الشعب»، الذي وقف يقول مخاطباً رئيسه: «الوطن العربي قليل عليك وأنت لازم تقود العالم ياسيادة الرئيس»، والتي صورت الواقع الكاريكاتوري لنظام الحكم في سوريا.
لكن أشهر صور في هذه الفترة كانت لكل من احمد البياسي من قرية البيضا، التي تعرض أهلها لتنكيل مهين من قبل قوات النظام، والتي نفاها النظام، إذ قام احمد (15/4/2011) بإبراز هويته أمام الكاميرا في مكان الحدث في تأكيد منه على ماجرى، وهو أمر بالغ الجرأة والخطورة، ومعلوم أن احمد اعتقل ولم يعد أحد يسمع عنه. وثمة صورة أخرى لمحمد أحمد عبد الوهاب الذي صاح من وجعه أمام الكاميرا: «أنا إنسان ماني حيوان..وهالناس كلها متلي» (14/06/2011) ثم صورة جثمان الطفل حمزة الخطيب (27/5/2011)، التي تم التمثيل بها، وصورة المقدم حسين هرموش الذي انشق عن الجيش (9/6/2011) بعد اقحامه في قمع المتظاهرين، وهو الحدث المؤسس لقيام ما عرف بـ»الجيش الحر». وفي 13/11/2011 برزت صورة الدبابة التي قام قائدها بدهس متعمد لجثة مواطن سوري في بلدة البارة (ادلب)، وهي صورة بينت وحشية النظام في تعامله مع البيئات الحاضنة للثورة.
بعد ذلك توالت الصور من تدمير الجامع العمري في درعا إلى صورة الشيخ أحمد الصياصنة، وهو شيخ ضرير اشتهر بمعارضته للنظام، وقد اضطر للمغادرة إلى الأردن (28/1/2012)، بعد أن استشهد ابنه واعتقل إبن آخر له وهُدد بقتل باقي أولاده.
ومع تصاعد المواجهات المسلحة (عام 2012) باتت الصور تأخذ منحى آخر، إذ أضحت تعج بصور الدمار المهول الذي عم المدن السورية، لاسيما حمص وحلب ودرعا ومدن غوطة دمشق، التي قصفت من دون رحمة بالدبابات والصواريخ، والبراميل المتفجرة. وفي هذا الإطار ذاته باتت صور المشردين، النازحين في المدن السورية واللاجئين إلى الاردن ولبنان ومصر وتركيا تحتل حيزاً أكبر بين صور الثورة السورية. وقد بينت هذه الصور الجانب المأساوي الناجم عن الانفجار السوري، وعن تنكر العالم لعذابات السوريين الذين بات مئات الألوف منهم يعيشون في ظروف قاسية وصعبة في مخيمات لا توفر الحد الادنى للعيش، ما اضطر كثير منهم الى ركوب قوارب الموت للخلاص في الطرف الأخر من البحر المتوسط، وهو ما عكسته صور الراحلين في القوارب بكل مرارة وأسى. ويمكن احتساب ضحايا مجزرة الكيماوي (آب/أغسطس 2013)، والصور الـ 50 الف المروعة، التي تصور مصرع الألوف من المعتقلين تحت التعذيب، من اقسى الصور، وأكثرها تعبيرا عن واقع النظام في تعامله مع شعبه.
ثمة صور ذهبت في منحى اخر، وضمنها بالذات صور لافتات «كفر نبل»، التي اكدت تصميم الشعب السوري على ثورته، والتي لم توفر هذه الثورة بالنقد، والتي عبرت عن مستوى راق من الوعي، الممزوج بالسخرية السياسية.
في أواخر العام 2013 برزت صورة الطبيب البريطاني عباس خان الذي قتل تحت التعذيب في سجون النظام، كما برزت الصورة المؤسية لوالدته، التي فجعت كأي ام سورية بولدها، وقد عادت صورتها للتصدر مرة أخرى مع اللافتة الشهيرة التي رفعتها في جنيف، إبان المفاوضات.
وفي هذه الفترة أيضاً باتت صور مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين مكانة تحتل المكانة الأبرز بين الصور السورية بسبب موت العشرات من الجوع، بعد تعرض المخيم لإغلاق تجاوز ستة أشهر، وقد برزت بينها صورة الأهالي المتبقين في المخيم، وهم في طريقهم لتلقي السلال الغذائية، فبدا الحشد في الشارع المدمر كأنه يوم الحشر، أو «يوم القيامة»، وهي صورة نشرتها وكالة فرانس برس نقلاً عن موقع صحيفة «الغارديان».
طبعاً، ثمة صور أخرى، أثرت سلباً على صورة الثورة ضمنها صورة الاعتداء على عبد العزيز الخير في القاهرة (9/11/2011) من قبل اشخاص محسوبين على المعارضة، واختطاف الأب باولو وعبد الله الخليل وفراس الحاج صالح، واللبنانيين الذين كانوا مختطفين في اعزاز، وصور اختطاف راهبات معلولا، واختطاف الناشطة والحقوقية رزان زيتونة وسميرة الخليل ووائل حماده وناظم حمادي.
لكن الصور الأكثر ضررا نجمت عن انفلاش العمل العسكري، ولاسيما وجود جماعات مسلحة لاعلاقة لها بالثورة السورية، وتعمل على الضد من مقاصدها، إذ نجم عن وجود هذه الجماعات بروز صور قاسية جدا اضرت بالثورة وبصورتها أمام شعبها وأمام العالم وضمنها صور الجلد والسحل والقتل بالسلاح الابيض وصورة أبو صقار والملثمين. المشكلة ان هذه الصور تمثل حوادث فردية، أو تتبع لحالات لا تمت للثورة بصلة، إلا انها تعرضت للنفخ والترويج، لتوظيفها في التشويش على الثورة، واثارة الشك بشأن نبل مقاصدها.
المستقبل
في الذكرى الثالثة للثورة السورية: ليبراليّة» بشار الأسد التسلطيّة: قراءة نقديّة في الخطة الخمسيّة العاشرة/ حسن مراد
يُمَثِلُ إندلاعُ ثورةٍ في أي بلدٍ أَكْبرَ مؤشرٍ على إهتراءِ النُظمِ السياسية، الإجتماعية والإقتصادية التي تحكمه. فالثورةُ تَعكِسُ إرادةً شعبيةً للقطعِ مع واقعِ البلادِ الراهنِ عبر صياغةِ عقدٍ إجتماعيٍ جديد.
في كُلِ الثوراتِ تَتراكَمُ عَوامِلُ متعددة لتُوَلِدَ الإنفِجارْ.
بعد ثلاثِ سنوات على إندلاعها، قيلَ الكَثيرْ عن الخَلْفِياتِ الإقتصادية للثَورَةِ السورية، لَكِنْ إذا نَظَرْنا إلى الماضي القَريبْ كي نُشِيرَ إلى العَاملِ الإقتصاديِ المُباشرْ الذي سَرّعَ من وتيرة تَراكُمِ الأسبابِ الإقتصادية، يمكننا القَولْ بأنه التَطْبيقُ المشوّه للخُطةِ الخمسية العاشرة.
خِلالَ حُكْمِ آلِ الأسد لسوريا، عَرِفَتْ البِلادُ ثَلاثَ موجاتٍ من التحرير الإقتصادي: الأولى كانت عند وصولِ حافظ الأسد إلى السلطةِ وإستمرت طِوالَ عقد السبعينات. المَوجَةُ الثَانية التي إِمْتَدَتْ مِنَ العامِ إلى تميزت بإستقرار المُؤَشِراتِ الإقْتِصاديةِ الكُلية، أما المَوجَةُ الثالثة فارتبطت ببشار الأسد وتحديداً مَعِ الخُطَةِ الخَمْسيَةِ العاشرة التي شملت الفترة -.
خِلالَ هذه الموجَةِ الثالثة مِنَ التَحرير بَدَأَتْ تتوفَرُ بيئةٌ إسْتِثْمارِيةٌ جديدة، وقَدَ ساهَمَتْ ثَورَةُ المراسيم بوضْعِ إِطارٍ تَشْريعي لتَنْظيمِ وإِعادة هَيْكَلَةِ بيئةِ الأعْمالِ وفَتْحَ القِطاعاتِ التي تَحْتَكِرُها الدولةُ أمامَ الإسْتِثْمارِ الخاصْ. أَصْبَحَتْ سوريا حينها دولةً جاذِبَةً للإستِثْماراتِ، فتَحالَفَتْ رؤوسُ الأموالِ السوريةِ مع نظيرتها الأجْنَبِيَةِ لا سيما الخليجيةِ منها مستفيدةً من إرتفاعِ سِعْرِ بَرْميلِ النفط بنسبة في المئة بين و، كما شَهِدَتْ سوريا أيضاً عودةً لرؤوسِ الأموالِ السوريةِ من الإِغْتِرابْ. خلال هذه الفترة، بَلَغَ متوسطُ النموِ الإقتصادي السوري خمسة في المئة وقد تميز بثباته وإبتعاده عن التَقَلُباتِ الحادة.
إلا أَنَ مَوجاتَ التَحْريرِ الإقتصادي الثَلاثُ هذه لم تَقْتَرِنْ بِأَيِ عَمَلِيةِ إصلاحٍ سياسي، بَلِ إِقْتَصَرَ الإنْفِتَاحُ السياسي على دَمْجِ الشَريحَةِ الإقْتِصادِيةِ الصَاعِدة في السُلْطَةِ بوصْفِهم مُسْتَقلينْ.
كان يُمْكِنُ للخطةِ الخمسيةِ العاشرة أَنْ تُشَكِلَ علامةً فارقةً في مسارِ التخطيطِ التنموي السوري، إذ رَبَطتْ بين النمو الإقتصادي ومَسارِ التَنْمِيةِ مِنْ جهة، والإصْلاحِ المؤسساتي مِنْ جهةٍ أخرى. إلا أَنْ المُؤتَمَرَ العاشِرَ لحِزْبِ البَعْثِ حَذَفَ الشِقَ الإصلاحي المؤسساتي منها، فإِخْتُزِلَ الإصلاحُ الإقتصادي الشامِلُ إلى عَمَليةِ تحريرٍ إنتقائية، وذلك بِحُجَةِ عَدَمِ فواتِ قِطارِ النمو الإقتصادي، فتَحْقيقُ نتائِجَ إقتصادية في إطارٍ مؤسساتيٍ سَليمْ كانَ يتطلبُ مساراً يتراوحُ بين ثمانية وإثني عشر عاماً، فإنساقَ النِظامُ السوري وراءَ النظريةِ القائلة: التجارة الخارجية تَقودُ النمو.
إِخْتزالُ الإِصْلاحِ الإقتصادي إلى مُجَرَدِ عملية تَحْريرٍ أدى إلى غِيْابِ مؤسساتٍ وهيئاتٍ تَضْطَلِعُ بدورٍ رقابيٍ وترعى حُريةَ التَنْافُسِ بينَ الأفرادِ، فكانت النَتيجةُ نشوءَ علَاقةِ تشاركية بين الشبكةِ السياسيةِ – الأمْنِيةِ الحاكمة من جهة وشريحةِ رِجالِ الأَعْمالِ الجديدة من جهةٍ أخرى (خصوصاً أولئك المسيطرين على الشركات القابضة (، فلم تخضع هذه الأخيرة لسُلطَةِ الدولة بل جرى العَكْسُ والسَبَبُ هو النِظامُ السياسي التسلطي الذي أَجْهَضَ الإصلاحَ المؤسساتي، أضف إلى هذا تغييبَ المُجْتَمَعِ المدني على مدى عقود ما ساهمَ بإفتقارِ سوريا للعُنْصُرِ الثالثِ من هذه العلاقة التشاركية، هذا العنصر – وبنتيجةِ سُلْطَتِهِ الرَقابية – يَحولُ دونَ نشوءِ علاقةٍ زبائنية بين الطرفين الآخرَين.
فأَصْبَحَتِ الدولةُ إحدى قوى السوقِ المُتصارِعَة الأمرُ الذي أدى إلى ظهورِ منافسةٍ إحتكاريةٍ، على عَكْسِ ما يقتضيه فَتْحُ بابِ الإستثماراتِ للقطاعِ الخاصْ من حريةٍ في المنافسة على قَدَمِ المساواة.
واِنْسَحَبَتْ هذه العلاقة التشاركية على ما اصْطُلِحَ على تسميته بظاهِرَةِ تَحالُفِ رؤوسِ الأموال التي يُرادُ لها إِظهارَ ديناميكية الإقتصادِ الجاذِبِ للإستثمارات وقُدْرَةِ رَجُلِ الأعمال السوري على التّعولم، عَبْرَ دخوله في مشاريعَ مُشْتَرَكةٍ مع مستثمرين أَجانِبْ. لكن هذه الظاهرة تعودُ بجزءٍ منها إلى إِدْراكِ المُسْتَثْمِرينَ الأَجانبِ لغيابِ المؤسساتِ الكَفيلةِ بحماية مَصْالِحِهِمْ وحقوقهم، إضافةً إلى أَنْ دخولَ السْوقِ السورية يتطلبُ منهم نَسْجَ علاقاتٍ مَعِ الطَبَقةِ الحاكمة، فيكون هذا التَحالُف لإيجادِ مَصالِحَ مُشْتَرَكَةٍ مَعْ رؤوسِ الأَموالِ السورية، لتجيير تلك العلاقة التشاركية لصالح إستثماراتهم الآتية من خارجِ الحدود. فعلى خلاف ما قد يظنه البعض، هذه الظاهرة ليست بالضرورة دليلُ عافيةٍ إقتصادية.
كما أنه وعلى عَكْسِ ما يَتِمُّ الترويج له، هذه البيئة الإقتصادية لَمْ تَجْذِبْ الكَثيرَ من رؤوسِ الأَموالِ الأجنبية، والدَليلُ هو إزديادها الخجول: فبعدما كانت تساوي في المئة من الناتِجِ المحلي الإجمالي عام ، أصبحت تساوي في المئة في العام . لذلك فإن الحديث عن تزايدٍ كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر، فيه بَعْضُ المبالغة.
إذاً، ضِعْفُ النشاطِ الإستثماري في سوريا سببه الأساسي غِيابُ المناخ التنافسي. فتَفعيلُ هذا المناخ لا يقتَصِرْ على إِصدارِ قوانينَ وتشريعات، بل يَحْتاجُ أيضاً إلى إِصْلاحٍ إداريٍ يُسْمَحُ فيه لجميعِ الفِئاتِ الإجتماعية بالمشاركة في صُنْعِ القرارِ الاقتصادي.
مِنْ ناحيةٍ أخرى، ونتيجةَ العلاقةِ التشاركية التي ربطتْ شريحةَ رِجالِ الأَعْمالِ الصاعدة مع الشَبَكَةِ السياسيةِ – الأمنية الحاكمة، لَمْ يَتِمَ توجيه رؤوسِ الأَمْوالِ والإستثمارات في إطارِ خطةِ عَمَلٍ تنموية. فالنمو يَقيسُ المُعَدلْ الكمي (الحجم والكمية) وليس النوعي. بمعنى آخر، التنمية تَحْتاجُ إلى النمو لَكِنَ النمو لا يَقودُ بالضَرورةِ إلى التنمية.
على سَبيلِ المِثالْ، مَشْروعَا بَوابةِ حلب ويعفور السَكَنِيّينْ هدفا إلى الرِبْحِ السريع عَبْرَ تقديمِ خَدماتٍ سكنيةٍ فخمة، فيما الإستراتيجية التنموية كانت تقتضي حَلَّ مُشْكِلَةِ العشوائيات التي يَقْطُنُ فيها بين – في المئة من سُكانِ المُدنِ المليونية.
فكان قِطاعُ الخدماتِ الوِجْهَةُ الأولى للإسْتِثْمارِ مَعْ شبه غِيابٍ للقِطاعِ الصناعي وغِيابٍ تام للقطاعِ الزراعي، وقد عَكَسَ هيثم جود كبير مؤسسي «السورية القابضة» هذه الرؤية عَبْرَ ترتيبه الأولويات الإستثمارية كالتالي: التجارة أولاً، ثم السياحة وأخيراً الصناعة.
على خطٍ موازٍ، توجهت الإستثمارات نحو المناطق الأَكثَرْ نمواً (دمشق، حلب، اللاذقية(، وإبتعدت عن تلك التي تَشْهَدُ مُعدلاتِ نموٍ منخفضةٍ (دير الزور، درعا، الرقة(
سُجّلَ أيضاً – خلال الخطة الخمسية العاشرة – تراجعٌ في الإنفاقِ الاستثماري العام: فبينما كان يساوي في المئة من الناتج المحلي في فترة – ، إنحدرَ إلى في المئة كمعدلٍ وسطي بين و وذلك بخِلافِ ما كان مُخَططاً له في الخطة الخمسية العاشرة وهو في المئة. تركزت أولوياتُ هذا الإنفاقِ على توفيرِ البنيةِ التحتيةِ لقطاعِ الخدمات، أما القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة التحويلية ) فكان نصيبها منه ضئيلاً جداً.
تَعكِسُ هذه الأرقامُ دليلاً على إنسحابِ القطاعِ العام من الحياةِ الإقتصادية، بينما كان يُفْتَرَضُ به وِفْقَ الخطة الخمسية أَنْ يَسْتَثمِرَ في المجالات التي يُحْجِمُ القطاعُ الخاص عن الإسْتِثْمارِ فيها.
قد يَتَحدثُ البَعْضُ عن زيادةٍ في الإِستثماراتِ الحكوميةِ ويستندون في ذلكَ إلى عَجْزِ الميزانيةِ الذي قَفَزَ من في المئة إلى ، في المئة بين و، إلا أن فرضية زِيادةِ هذه الإستثماراتْ يَدْحَضُها تقريرُ صُندوقِ النَقدِ الدولي حول الإقتصادِ السوري الصادر عام حيثُ تَمّتْ الإشارةُ فيه إلى أن هَدَفَ الحكومةِ السورية، كان ولا يَزالْ، احتواءَ العَجْزِ الكُليّ إلى أقل من في المئة (من إجمالي الناتج المحلي) على المدى المتوسط، وتَرْتَكِزُ هذه الإستراتيجية على إِسْتِحْداثِ دعائمَ جديدة، أَهَمُها الضريبة على القيمة المضافة، ضَبطُ الإنفاقِ العام وإعادةُ النَظَرِ بسياساتِ الدَعْمِ. هذا الأمر يعني أن أي زيادةٍ في الإستثمارات الحكومية هو إستثناءٌ، فرضته الأزمة المالية حينها، فيما القاعدةُ كانت إِنسِحابَ الدولةِ لمَصلَحةِ القطاعِ الخاص وزبائنيته.
بدَورِها، فاقمت السياسةُ الضريبيةُ مِنَ الضغوطاتِ الاجتماعية -الإقتصادية. فقد قامت الحكومةُ السوريةُ بتَخفيضِ الضرائبَ المباشرة على الأرباحِ الحقيقيةِ للشركاتِ لتصل إلى في المئة للشركاتِ المساهمة العامة و في المئة لشركات الأفراد، كما تمت زِيادةُ الضرائبِ غير المباشرة بالإضافةِ إلى ضريبةِ الرواتبِ والأجور، حيث تضاعفت نسبتها إلى الناتجِ المحلي بين و لتَبْلُغَ حوالي . في المئة، وهذه الضرائب تتحملها بِشَكلٍ أساسي الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وبالمحصلة، إِنْخَفَضَتْ نِسبةُ الضرائب المباشرة (التي تُعْتَبَرُ أَكثَرَ إِنصافاً من مَنظورِ العدالة الضريبية) إلى الناتج المحلي الإجمالي من في المئة إلى في المئة بين و. رغم ذلك، إِستمَرَّ التَهربْ الضريبي ما إنعَكَسَ تراجعاً في الإيرادات. فعلى الرَغْمِ مِنْ أن مساهمة القِطاعِ الخاص بالناتج المحلي بَلَغَتْ . في المئة عام ، إلا أن إجمالي الضرائب المباشرة التي سَدّدها للخزينةِ العامة بلغت . في المئة من الناتج.
فبدلَ أن تؤدي السياسة الضريبية إلى توزيعِ الدَخْلِ بشكلٍ عادلٍ، لَعِبَتْ دوراً معاكساً: فالمُحَرِكُ الرئيسي للنمو في الاقتصاد السوري هو الاستهلاك وليس الاستثمار. ما يعني أن السياسة الضريبية غير العادلة أَثرتْ سلباً على القدرة الاستهلاكية للمواطن السوري، ما أدى إلى تفويت فرصة تحقيق معدلاتِ نموٍ أَكثرَ إرتفاعاً.
تداخلتْ هذه السياسات مع عَوامِلَ أخرى أدت لزيادةِ الأَوضاعِ سوءًا: فالغيابُ الكاملْ للقطاعِ الزراعي عن إهتماماتِ الشركاتِ القابضة أَلْحَقَ ضرراً كبيراً بهذا القطاع الحيوي للاقتصاد السوري. إِضافةً إلى هذا، شَهِدَتْ سوريا بين و أقصى موجةَ جفافٍ منذ خمسة عقود. وبما أن القطاعَ الزراعي مازال يَعْتَمِدُ بشكلٍ شِبْهِ تام على العَواملِ المناخية، والظُروفِ الجويةِ، ويستعمل الأساليبَ التقليديةِ، إذ لم يَتَحولْ للمكننة أو طُرقِ السقايةِ الحديثة، نتيجةَ غيابِ الإستثمارات اللازمة. فإجتمعت التَقَلباتُ المناخية مع الإرتفاعِ العالمي لأسعارِ السِلَعِ الغذائية حينها والمنافسة الخارجية الشديدة، ما أدى لتحويل الزراعة إلى نَمَطِ إنتاجٍ ثانوي، حتى أنه في بَعْضِ المناطقِ إِسْتَمَرَ النَشاطُ الزراعي كنمطِ حياةٍ وليس كنمطَ إنتاج.
التحولاتُ الديموغرافية ساهمتْ هي الأخرى في عرقلة مسيرتي النمو والتنمية. فنمو الفئة العمرية – (أي لمن هم في سن العمل) كان أعلى من النمو السكاني، ما رفع عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل لحوالي ألف سنوياً في الأعوام الثلاث التي سبقت الثورة. من الطبيعي أن تتجلى مشكِلَةُ البطالةِ حين يَشْهَدُ الإقتصادُ زيادةً ديموغرافيةً في ظلِّ غيابٍ للنمو الإقتصادي المطلوب، فبلغَ مُعَدَّلُ البطالة في المئة عام بحسب المكتب المركزي للإحصاء.
على سبيلِ المِثال، خَسِرَ القطاعُ الزراعي بمفرده حوالي ألف فرصةَ عَمَلٍ بين و، بينما لم يخلق الاقتصاد الوطني سوى ألف فرصة (بمُعَدَّلِ نموٍ هو في المئة) في حينِ كان يَلزَمُ تأمينَ ألف فرصةَ عملٍ، ما مَثّلَ فَجْوةً كبيرةً بين العَرضِ والطلب.
هذه النقطة تؤكِدُ ما تمت الإشارةُ إليه سابقاً حول الإستِقطابِ الضئيلِ لرؤوسِ الأموالِ الأجنبية، بدليلِ أنها لم تكن على المستوى المطلوب لإستيعابِ كاملِ قوة العملِ. وبناءً على وجهة الإستثمارات التي تم الإشارة إليها سابقاً، نستنتج أن شبه الإِهمالِ، الذي لَحِقَ بالقطاع الصناعي شَكّلَ حاجزاً أمام إستيعابِ الهجرةِ الريفية المتزايدة إلى المدينة الناجمة عن الخسائرِ التي لَحِقَتْ بالقطاعِ الزراعي، بسبب إهماله التام، ما زاد الطين بلة.
علاوةً على ذلك، كانت نِسبةُ التَشْغيلِ تَرْتَفِعُ عند حَمَلَةِ الشهاداتِ الإبتدائية وما دون – مقارنةً بنِسبةِ البطالة عند حَمَلَةِ الشهادات الثانوية والجامعية- والسَبَبُ يعود إلى التقنية المنخفضة لمُعْظَمِ منشآت القطاع الخاص، الأمر الذي يُجَنّبْ أَرْبابَ العَمَلِ دَفْعَ أجورٍ مرتفعة. هذه الحالة ساهمت بِدَفْعِ الفئاتِ المتعلمة لأن تُشَكلَ قوام الحركات الإحتجاجية وذلك لقدرتها على الربطِ بين الحقوقِ الاقتصادية، الإجتماعية والسياسية.
إستناداً إلى ما سبق، ليس مستغرباً ألاّ تَنْعَكِسَ هذه الحالة الإقتصادية إيجاباً على المستوى الإنمائي، فمؤشرُ التنمية البشرية بين و سَجّلَ نمواً طفيفاً بلغ حوالي في المئة، إلاّ أن هذا النمو كان دون المُعدّلِ العالمي ما أدى إلى تراجُعِ الترتيب السوري سِتْ درجات (عام إحتلت سوريا المركز عالمياً). السبب الرئيسي لهذا التراجع هو البطء في تَراكُمِ رَأْسِ المالِ البشري وبخاصةً لناحيةِ متوسط سنوات الدراسة ما يُشَكِلُ بالتالي عائقاً أمام نَقْل التكنولوجيا وتطوير أساليبِ الإنتاج والإنتاجية.
لم تبادر حكومات بشار الأسد المتعاقبة إلى معالجة مشكلات القطاع التعليمي، بل على العكس تفاقمَ الوضْعُ سوءًا بسببِ التركيز على التوسع الكمي وليس النوعي، إضافةً إلى أن متوسط الإنفاقِ على البحثِ العلمي كان شديدَ التواضعِ حيث بلغ في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وفقاً للمكتب المركزي الإحصائي، لم تتطور إنتاجية العامل السوري خلال نصف قرن بأكثر من في المئة وذلك على الرغم من كل التقدم التكنولوجي العالمي.
وبما أن سوريا لم تَسْتَفِدْ كثيراً من التَقَدُمِ التكنولوجي العالمي، نستنتجُ أن رؤوسَ الأموالِ الأجنبية التي جذبتها، لم تساهم كثيراً في نَقلِ المعرفة إلى داخل البلاد.
تراجُعْ مؤشر التنمية يعودُ أيضاً إلى سياسةِ النظامِ الصحية حيث إتجه إلى خَصْخَصةِ القطاع الصحي من دون وجود بدائلَ شاملة، ولعل أَبْرَزَ ما قامت به الحكومةُ السورية في هذا الصدد هو إصدارها في العام القانون رقم الذي إعتَبَرَ المشافي الجامعية وحداتٍ إقتصاديةٍ مستقلة تَعْتَمِدُ على مواردها الذاتية.
أدت هذه السياسات إلى تدهورٍ في الأوضاعِ المعيشيةِ للمواطنين، فحسب تقرير UNDP الصادر عام ، يعيش في المئة من السوريين ما دون خطِ الفقر الأعلى ( ليرة سورية للفرد في اليوم.(
قد يلقي البعضُ بمسؤوليةِ التباطؤ في عملية التنمية على عاتِقِ صندوق النقد الدولي وتوصياته في محاولةٍ منهم لرفع المسؤولية عن النظام، لكن هذا الكلام فيه القليل من الواقعية. فأولاً لم تكن توصياتُ الصندوقِ ملزمةً لسوريا، ما يعني أن سياسةَ التحريرِ بالشكلِ الذي رست عليه كانت بإرادةٍ داخليةٍ بحتة.
صحيحٌ أن إِهتِمامَ صندوقِ النقدِ يَنصَبُّ على تعزيز النمو الإقتصادي الكلي حصراً، إلا أنّ الخطأَ الذي وقعت فيه الحكومة السورية هو عدم إستيعابها أن تقليص عجز الموازنة وخفض الدين العام هما السببان المباشران اللذان يدفعان الصندوق لإعتبار الحدّ من الدور الإقتصادي للقطاعِ العام ضرورةً ملحةً، وعلى أساسه يوصي بإعتماد تلك التوصيات. لكن عَجْزَ الموازنة السورية ونسبة الدين العام (إلى الناتج المحلي) كانا منخفضين في السنوات التي شُرِعَ فيها بلبرلة الإقتصاد، فلم يكن هناك من عائق لإستمرار حضورِ القطاع العام وإنفاقه لأَجْلِ القيامِ بإصلاحاتٍ مؤسساتية، خصوصاً وأن البيئة السياسة والإقتصادية السورية كانت بأَمَسِ الحاجةِ إليها.
خلافاً لما هو سائد في الأوساطِ الحكومية، ليس هناك من تعارضٍ بين حَجْم تدخل الحكومة واقتصاد السوق إذا ما كان هذا الأمر مرحلياً ويساهم في تحريرِ الاقتصادِ بوتيرةٍ مستقرة، فالمشكلة السورية ليست بحَجْمِ الدور الحكومي بقَدْرِ ما تتعلق بهشاشة هذا الدور وعيوبه. كان يتوجبُ علِاجَ هذا الأمر عبر عمليةِ اصلاحٍ مؤسساتية تُفْسِحُ المجالَ أمام القطاع الخاص للتمدد، ضمن ضوابط تسمح بتفعيلِ عجلة التنمية.
النظام السوري يتحمل مسؤولية التَمَلُصِ من تنفيذِ الإصلاحات المؤسساتية اللازمة لما قد يرتد عليه سلباً لناحية تقويض سطوته السياسية. فالإصلاحُ المنشود كان سيسمح بوضعِ ضوابطَ للسوق في إطارِ سياسة نموٍ إقتصادي وإستراتيجيةٍ تنمويةٍ تأخذُ في عينِ الإعتبارِ المصلحةَ العامة، وهو ما يتعارضُ مع مصالحَ الشبكةِ السياسيةِ – الأمنيةِ الحاكمة، التي لا يناسبها وجودُ مؤسساتٍ تحدُّ من فسادها، بالإضافةِ إلى أن حريةَ المنافسةِ كانت سَتَسْمَحُ بتشكيلِ طبقةٍ من رجال الأعمال المستقلين عن النظام، الذين يرون مع الوقت أن مصلحتهم تقتضي التخلُصَ من المنظومةِ الإستبداديةِ، لكونها عائقاً أمام تَوَسُعِ أعمالهم.
خطأٌ آخر إرتكبته الحكومة السورية، وهو إِعْطاءُ الأولويةِ لمُحاربة التَضَخُمِ الذي بلغ . في المئة عام . من الطبيعي أن تُرَكِّزَ السياسةُ النقديةُ على إستقرار الأسعار عندما يكون التَضَخُم كبيراً، ولكن من غير المنطقي التركيز على ذلك عندما تكون المشكلة الأساسية هي الركود الاقتصادي والبطالة.
في مَعْرِضِ دفاعهم عن الأسد، يشيرُ البعض للنمو الإقتصادي الذي تحققه الدكتاتوريات في محاولةٍ لمساواتها بالأَنْظِمَةِ الديموقراطية، حتى أن البعض منهم يذهب أبْعَدَ من ذلك فيتبنى فرضية «لي» (نسبةً لرئيس وزراء سنغافورة السابق لي كوان يو): «تغييب الحقوق السياسية يساعد على تحفيز النمو الإقتصادي والتنمية».
لا أُنْكِرُ أن دولاً غير ديموقراطية يُمْكِنُ أن تَعْرِفَ نمواً إقتصادياً وأن يؤدي بدوره إلى تنمية. إلا أن أَحَدَ أَسْبابِ هذا الأمر هو غِيابُ المؤسساتِ الديموقراطية (مجلس النواب والوزراء) ما يَسْمَحُ لهذه الأنظمة بوضعِ سياساتها الإقتصادية مَوْضِعَ التَنْفيذِ بصورةٍ أسرع، لعَدَمِ حاجتها للمرورِ عبر مؤسساتها التنفيذية والتشريعية، على عَكْسِ الأنظمةِ الديموقراطية التي تَحْكمها قوانينٌ وأَجْهِزَةُ رقابة يَسْتَحيلُ تجاوزها، فعاملُ الوَقْتِ يكون أحياناً في صالحِ الدكتاتوريات، على المدى القصير والمتوسط، لكن ليس على المدى البعيد.
بدوره، أوضَحَ روبرت سولو عبر نظريةِ Catch-Up Effect أنه في العديدِ من الحالاتِ، يمكن تفسير النمو الإقتصادي الكبير بتأخُرِ الدولِ عن معدلاتِ النموِ العالمية، ما يعني أن الإزْدِهارَ الاقتصادي لا يعودُ لكفاءةِ الأنظمةِ الدكتاتورية بقدِر ما يرتبط بحاجةِ البيئةِ الإقتصادية لتدارك تأخرها. أما على المدى البعيد، فيوَضّح سولو أن المحافظةَ على نموٍ إقتصادي ثابت يكون عَبْرَ التَقَدُمِ التكنولوجي، وهو ما تَفْتَقِرُ إليه سوريا كما تمت الإشارةُ سابقاً.
من جانبٍ آخر، رَغْمَ تَعَدُدِ النظريات والأبحاث الإقتصادية التي تعالج توزيع الثروة والعدالةَ الإجتماعية إلا أن فلسفتها السياسية واحدة: كلما ارتفعت قيمةُ الفردِ بنَظَرِ الدولة، كلما زادت العدالةُ في التوزيع. فعندما تنعدم تلك القيمة فبالضرورة ستَنْعَدِمُ معها العدالة الإجتماعية المنشودة. من البديهي القول أن غيابَ الديموقراطيةِ يؤدي إلى إنعدامِ قيمةِ الفردِ بِنَظَرِ السلطة الحاكمة، وهذا ما تجلى في السياسة الضريبية المجحفة.
من خِلالِ الخطةِ الخَمسِيَةِ إبتغت الحكومةُ السوريةُ العبورِ نحو إقتصادِ السوقِ الإجتماعي، إلا أنها سرعان ما إِنْحَرَفَتْ عن هدفها هذا. ففي المحصّلة، إتبعت سوريا سياسةً إقتصاديةً أَقْرَبْ ما تكون لتوصياتِ صندوقِ النقد الدولي حتى لو لم تُعْلِنْ هذا الأمر صراحةً.
رَغْمَ هذا التحول، لم يَتِمَ العَمَلُ على إنتاجِ بيئةٍ مؤسساتيةٍ قادرةٍ على إحتضانِ هذه السياسة، لحَصْدِ النتائج المطلوبة. هذا الأَمْرُ عَكَسَ تخبطاً إستحالَ مَعَهُ تَفْعيلُ الدورةِ الإقتصادية وأدى بالتالي إلى تردٍ إقتصادي – إجتماعي.
إن تَجاهُلَ الإصلاحاتِ السياسةِ ليس أمراً عابراً كما يُسَوّقْ له أَنْصارُ النِظامِ. فحسب أمارتيا صن في كتابه «التنمية حرية»: «بَلورةُ أي خطةٍ إقتصاديةٍ وتنموية تَفْتَرِضُ حواراً وتبادلاً للآراء بين الجِهاتِ المعنية«. حوارٌ إجتماعي كهذا يُحَتّمْ عَدَمَ إنتهاكَ الحقوقِ المدنيةِ والسياسيةِ للأفرادِ والجماعات إذ أن عَدَمُ إنتهاكها يُفْسِحُ المجالَ أمام حريةِ الإعتراضِ على عَمَلِ الحكومةِ، للمطالبةِ بإِصْلاحِ أيِّ خللٍ. ما يدفع الحكومة للتَحَرُكِ لأَجْلِ مَنْعِ وقوعِ كوارثَ اجتماعيةٍ أو الحدِّ من تبعاتها. كما أن إرساءَ نظامٍ ديموقراطي يعطي للشعب حقَ إختيارَ حكامه، ما يعني أنه، ومن حيث المبدأ، تأخذُ الحكومةُ هذا الأمر بعينِ الإعتبارِ، فتسعى لكسبِ ودَّ الناخبين، عبر السعي لتحسين مستوى معيشتهم.
إستناداً إلى فَشَلِ الخطة الخمسية العاشرة، يُمكِنُ القول أن النظامَ الإقتصادي، الذي سادَ في سوريا قبل الثورةِ كان عبارةً عن ليبراليةٍ تسلطية. فرغم التحولاتِ الإقتصادية التي عرفتها البلاد طوال العقودِ الأربعةِ الأخيرة، إلا أن الثابتَ كان سعي النظامِ الدائمِ للتَحَكُمِ بموارد البلاد، كوسيلةِ ضغطٍ على المواطنين بهدفِ إِحْكامِ قَبضَتِهِ على السلطة.
المستقبل
ثلاث سنوات على الأزمة السورية
ابراهيم حميدي
بعد مرور ثلاث سنوات، لا يزال باحثون ومسؤولون غربيون يناقشون في التوصيف الاكاديمي الدقيق للأزمة السورية. وفي مقابل اختلاف آرائهم بين القول انها «انتفاضة» او «ثورة» او «حرب أهلية» مع تحول في أحد جوانبها الى «حرب بالوكالة»، فإن الخطاب الرسمي للنظام السوري ومواليه، بقي مخلصاً لوصفة واحدة وأحادية: انها «مؤامرة». لم يحد النظام كثيراً عن كونها «مؤامرة» وتجلياتها قولاً وفعلاً سواء في الاداء العنيف والعسكري أو في مفردات الخطاب السياسي. وعندما خطف جماعات متشددة للثورة، وتحولها مسلحة كرد فعل على القمع العنيف والعشوائي للنظام، وجد الخطاب ضالته في تقديمها على انها «حرب على الارهاب».
في الذكرى الثالثة، صدر كثير من التقارير الدولية والحقوقية التي تكشف تفاصيل عمق المأساة التي لحقت بالبشر والدمار في البنية التحتية. كما أطلق مسؤولون كثيرون تصريحات سياسية، كان بينهم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي ناشد روسيا وأميركا التحرك لتخليص السوريين من «الكابوس».
اقترحت «الحياة» في هذه المناسبة، الاطلاع على وجهات نظر مختلفة ومقاربات من خبراء وكتّاب غربيين للأزمة السورية ماضياً وحاضراً. خبراء كتبوا عن سورية وواكبوها في العمق في العقود السابقة، من حكم الرئيس الراحل حافظ الاسد الى حكم الرئيس بشار الاسد.
طُلب من ثلاثة خبراء غربيين وروسي تفقد «موضوعهم» السوري، والاجابة عن سؤالين: عندما تنظر الى السنوات الثلاث، كيف تفسر ما حصل وتطوراته من الحراك السلمي الى المواجهة المسلحة؟ وكيف ترى ماهية الحل الذي سينبثق من رحم الأزمة والتفتت الذي تعيشه البلاد وإطاره الزمني؟
هنا إجابات الخبراء الأربعة:
الحل بعقد اجتماعي جديد/ فولكر بيرتس
عام 2011، بدأ النزاع في سورية على شكل تظاهرات سلمية من أجل كرامة الإنسان والإصلاح السياسي. واستخلص نظام الأسد عبره من تونس ومصر واختار اللجوء إلى ما سمّاه بـ «الحلّ الأمني»، أي قمع كلّ تظاهرة بالقوة العسكرية. وأدّى ذلك بدوره إلى حصول انشقاقات في صفوف القوات المسلحة وإلى عسكرة الانتفاضة. ومنذ منتصف العام 2011، تحوّل النزاع إلى حرب أهلية وإلى صراع دامٍ من أجل السلطة في سورية، سرعان ما تطوّر إلى صراع إقليمي من أجل سورية.
إلى ذلك، ازداد الاستقطاب المذهبي، غير أنّ النزاع في سورية ليس عبارة عن حرب طائفية وله أبعاد دولية قوية، لكن الولايات المتحدّة والاتحاد الأوروبي وحتى روسيا تعتبره مشكلة إقليمية لا ترغب في الانجرار إليها.
تسعى القوى الإقليمية وراء مصالحها الجيوسياسية في سورية، إلا أنّ النزاع ليس حرباً بالوكالة. فلا يحارب بشّار الأسد من أجل إيران بل من أجل سلطته الخاصة. كما أنّ معظم الموالين للنظام لا يحاربون من أجل الأسد بل يشعرون بأنّهم مجبرون على الدفاع عن النظام الموجود خوفاً على بقائهم. وتسعى المعارضة الموجّهة نحو الدولة أو المعارضة «الوطنية» إلى الحصول على دعم أوروبا والولايات المتحدّة وتركيا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى. فهي لا تحارب من أجل مصالحها بل من أجل سورية أفضل.
أما الجماعات الجهادية أمثال تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) فيتّبعون أجندتهم العدمية الخاصة التي لا علاقة لها بمستقبل سورية. في الواقع، لا يقوم النظام بمحاربتهم بل يستفيد من وجودهم بقدر ما يضعفون المعارضة وينشرون الذعر في صفوف الأكثرية الساحقة من السوريين.
وكلما طالت مدّة الحرب، يرجّح انقسام سورية. من الناحية الجيوسياسية، من شأن انقسام سورية أن يحلّ النظام الذي ولد عقب الحقبة العثمانية (اتفاقية سايكس بيكو) في الشرق العربي. بدأت الحدود بين سورية من جهة والعراق ولبنان من جهة أخرى تتلاشى. ومن الناحية الجغرافية-الثقافية، قد يؤدي انقسام سورية إلى القضاء على فكرة الدول المتعدّدة المذاهب والمتعدّدة الإثنيات في المنطقة. ويمكن أن تكون حينها الكيانات السياسية الجديدة أحادية الثقافة، وفي أحسن الأحوال قد تبدي نوعاً من «التسامح» تجاه الأقليات. من الواضح اليوم أنّه لا يمكن الحفاظ على النظام الإقليمي إلا في حال انتهاء الحرب في سورية. كما من الواضح أنّ أياً من الفرقاء المتحاربين لن يكون قادراً على تحقيق انتصار عسكري والحفاظ على الدولة السورية في شكلها الجغرافي الحالي.
لا يسيطر اللاعبون الخارجيون على القتال بل ثمة حاجة إلى إدراك دولي لإنهائه. على الأقل، يجدر بالولايات المتحدّة وروسيا والمملكة العربية السعودية وإيران الاتفاق على استبعاد الانتصار العسكري من الجانبين وعدم مساعدة حلفائهم لبلوغ ذلك. يمكن إجراء وساطة خارجية لإطلاق محادثات السلام وتقديم الدعم لها، لكن ينبغي على السوريين الاتفاق على مستقبل بلدهم. يجب الإبقاء على عملية جنيف التي جرت بوساطة الأمم المتحدّة. وبما أنها تركّز على العلاقة بين الحكومة والمعارضة، تبدو فرص حصول خرق لجدار الأزمة ضئيلة. يجب بالتالي إكمال «جنيف-2» بـ «طائف سوري» وهو اجتماع استشاري خارج البلد يجمع المواطنين المعنيين من كل المناطق السورية والمجموعات الإثنية والمذهبية من أجل معرفة ما إذا كان السوريون لا يزالون يريدون العيش مع بعضهم ضمن دولة واحدة وعلى أيّ أساس. سيستمر الأسد في رفض حصول انتقال حقيقي، إلا أنّ عدداً كبيراً من العلويين والأكثرية في المناطق التي يسيطر عليها النظام سيفضّلون تقاسم السلطة على استمرار الحرب. سيرفض جزء من المعارضة تقاسم السلطة مع ممثلي النظام، إلا أنّ معظم سكان الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة يفضّلون تقاسم السلطة على استمرار الحرب. لن يساهم جمع الممثلين عن المجتمع الذين يحظون بصدقية في إنهاء المواجهة العسكرية على الفور، لكنّه قد يساهم في تبلور أساس للعقد الاجتماعي الجديد وبالتالي سيغيّر الديناميات السياسية للنزاع.
* المدير التنفيذي للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين. مؤلف كتاب «الاقتصاد السياسي في سورية»
صراع مؤلم بين الحياة والموت/ نيكولاوس فان دام
صادفت الأسبوع الفائت الذكرى الـ 51 لاستيلاء حزب «البعث» على الحكم في سورية في 8 آذار (مارس) 1963. لكن لم يكن هناك سبب للاحتفال بذلك نظراً إلى أنّ البلاد تعيش حالة من الخراب ناجمة عن حرب دموية داخلية. كما أن كلّ ما تمّ تحقيقه حتّى الآن يتنافى مع مبادئ حزب «البعث»؛ إذ إنّنا نشهد حرباً أهلية طائفية بدلاً من المساواة العلمانية بين الطوائف الدينية السورية، وفساداً مستشرياً بدلاً من المساواة الاجتماعية، وتجزئةً للمجتمع السوري بدلاً من تحقيق الوحدة العربية.
وعلى رغم ذلك، تشير هذه الذكرى إلى 51 سنةً من الخبرة العملية حول كيفية بناء نظام قويّ بوجود شخصيات سياسية موالية في مختلف المناصب الرئيسة. وقد استخفّ العالم الخارجي بشكل عامّ بقوة شبكة النظام وتماسكها، علماً أنّها تستند إلى الولاءات الإقليمية والقبلية والطائفية، فضلاً عن المحسوبية والمنسوبية. غير أنّ هيمنة العنصر العلوي على النظام تشكّل أيضاً مصدر ضعفه، ما يعوق كلّ إمكانية لتطبيق إصلاحات سياسية حقيقية.
ومنذ البداية، غلب على المقاربة الغربية المتّبعة إزاء الثورة السورية نوع من المبالغة في التفكير المشتهى (الرغبوي)، من خلال إعطاء أسبقية للمبادئ التي من المفترض أن تستند إلى الديموقراطية على السياسة الواقعية. واعتمد الكثير من السياسيين الغربيين على ردود الفعل السياسية المحلية اليومية من أجل بلورة مواقفهم، بدلاً من وضع رؤية طويلة الأجل واتباع التفكير البراغماتي الموجّه نحو تحقيق نتائج ملموسة، والمساعدة على حلّ النزاع في شكل فعليّ. أمّا معظم السياسيين الغربيين، فكانوا يصمّمون على الإطاحة بالرئيس السوري، اعتباراً منهم أنّ من الممكن وضع حدّ للصراع فقط في حال توقّف الأسد عن تأدية أي دور فيه. ويُشار إلى أنّهم كانوا شديدي الوضوح بشأن بعض الأمور التي لا يوافقون عليها، إلا أنّهم لم يقترحوا أفكاراً واقعية تجسّد ما يريدون تحقيقه في المقابل. ولا شكّ في أنّهم يريدون تطبيق الديموقراطية في سورية، إلا أنّ من المستحيل أن ينتهي عزل الأسد عن الحكم من خلال اللجوء إلى العنف بتطبيق الديموقراطية بطريقة سلمية.
وحتّى بعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الثورة السورية، لا تزال الجماعات المعارضة عاجزة عن التوحّد، كما أنّ بعضها يقاتل البعض الآخر. وقد تبيّن أنّ الأسد أقوى من المعارضة وليس لديه أي نية للتنحي عن الحكم. بل على العكس، إنّه عازم على تجاوز الثورة وإحراز انتصار في المعركة من أجل إبقاء السيطرة على سورية مهما كلّفه الأمر. إذ كلّما ارتفعت التكاليف المتكبّدة، ازدادت رغبته بمواصلة القتال لكي لا تكون عمليات القتل والضحايا التي خلّفتها قد ذهبت سدى. وهذا الأمر ينطبق على كلّ من النظام والمعارضة.
واللافت أنّ نظام حزب «البعث» السوري الديكتاتوري تميّز على مدى نصف قرن بوحشيّته، إلا أنّ الجهات الخارجية تجاهلت هذا الواقع أو غضّت النظر عنه. وقد تمّ توثيق ممارسات القمع والعذاب داخل السجون، فضلاً عن مصير عدد لا يحصى من السجناء السياسيين، بكلّ ما تحمله من تفاصيل مروّعة. أمّا حقيقة أنّ نظام حزب «البعث» يتسبّب بموت عدد من خصومه الحزبيين البعثيين داخل السجون، فهي دلالة واضحة على أنّه لا ينبغي أن نتوقّع أي شيء إيجابي من الطريقة التي يتعامل بها الأسد مع معارضيه، والتي لا تعرف الرحمة أو العفو. وماذا عن الطريقة التي يتعامل بها مع قوى المعارضة الثورية المسلّحة التي تحاول إسقاط النظام، فهي تشتمل على المبدأ الآتي: إمّا القتل أو التعرّض للقتل؟
في الواقع، لا تظهر أي إمكانية للتوصّل إلى تسوية، لأنّ التوصّل إلى تسوية حقيقية بين المعارضة والنظام قد يساهم في حدوث تقاسم فعلي للسلطة وتطبيق إصلاحات سياسية جوهرية، سيكون محفّزاً لسقوط النظام في وقت لاحق.
وبالنسبة إلى النظام، تشكّل الثورة الحالية مسألة صراع بين الحياة والموت، كما هي الحال بالنسبة إلى المعارضة. وإذا ما تمّت الإطاحة بالنظام، لا يبقى على قادة النظام هذا إلا انتظار صدور حكم إعدامهم، كما ستواجه جميع الشخصيات البارزة في نظام الأسد التي تمّ اختيارها من أوساط الطائفة العلوية خطراً شديداً، كما هي الحال بالنسبة إلى جميع الأفراد المنتمين إلى هذه الطائفة. لذلك، لا يعقل أن يوقّع الأسد على أمر بتنفيذ حكم الإعدام بحقّه.
توقّعات للسنوات المقبلة
بفضل الاتفاق الذي تمّ توقيعه بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا في العام 2013، حول التخلّص من الاسلحة الكيماوية التي تملكها سورية، استعاد الرئيس بشار الأسد بصورة شبه رسمية الشرعية التي تعطيه إيّاها الدول الغربية، علماً أنّ هذه الدول كانت قد توقّفت خلال مرحلة سابقة عن اعتباره رئيساً شرعيّاً للبلاد. ونتيجة عقد هذا الاتفاق، تراجعت الولايات المتحدة الأميركية عن تهديدها العسكري. إلا أنّه بعد التخلّص من أسلحة الدمار الشامل، قد يتمّ توجيه تهديد عسكري مجدّداً. وعلى رغم ذلك، من غير المرجح أن يحصل تدخّل عسكري على نطاق واسع من خلال نشر القوات على الأرض، نظراً إلى أنّ الدول الغربية لا تُظهر أي رغبة سياسية فعلية بتحقيق ذلك.
ويدرك الأسد هذا الواقع تماماً، لذلك لا شكّ في أنّه سيواصل محاربة المعارضة التي تشكّل تهديداً محتملاً لمنصبه الرئاسي. غير أنّه قد يتمّ إجراء عمليات عسكرية أجنبية على نطاق أصغر، تقضي مثلاً بمنع القوات الجوية السورية من شنّ هجمات على المعارضة داخل المراكز السكنية. وثمة بعض الشكوك حول ما إذا كان من شأن فرض مناطق حظر الطيران تغيير التوازن العسكري على الأرض بشكل حاسم لمصلحة المعارضة العسكرية.
من الممكن أن تستمرّ الحرب في سورية، ربّما لوقت طويل جدّاً، إلى حين ينجح أحد الطرفين في الاستحواذ على السلطة. والملاحظ أن الظروف الراهنة ترجّح أن يكون الانتصار من نصيب النظام، وربّما يتأتى عنه استبعاد موقت لبعض المناطق الجغرافية. وقد يعمد الأسد في وقت لاحق إلى إجراء بعض الإصلاحات السياسية فقط في حال كانت لا تشّكل خطراً على منصبه في المستقبل. إذاً، لا شكّ في أنّ هذه الإصلاحات ستكون شكليّة فحسب.
ولا بدّ من أن يزداد الشعور باستياء شديد من النظام، حتّى في أوساط الطائفة العلوية التي تعارض إلى حدّ كبير كلّ ما كان نظام الأسد قد تعهّد بتطبيقه. إذ إنّ سلوك النظام هذا عرّض أفراد الطائفة العلوية كلّهم إلى خطر جسيم، بمن فيهم عدد كبير من المعارضين العلويين للأسد.
والحقّ أنّ النزاع الحالي سيستمرّ إلى حين تحقيق العدالة لعدد كبير من الضحايا الذين سقطوا، مهما كان الطرف الذي ينتمون إليه. ولا تزال الجماعات المعارضة التي يُحتمل أن تشكّل أكبر خطر بالنسبة إلى نظام الأسد تنبثق من المجتمع العلوي نفسه. إلا أنّ انقلاب العلويين ضدّ الأسد يشكّل مسألةً ذات خطورة شديدة، لذا من المستبعد أن يحصل في المستقبل القريب، وبخاصّة إذا ما بقيت الطائفة العلوية تشعر بالتهديد من المعارضة التي تسيطر عليها الطائفة السنية.
لقد أدّت الثورة السورية إلى اندلاع حرب بالوكالة، كانت لجميع القوى الخارجية، بما فيها البلدان الغربية وروسيا، وإيران، و «حزب اللّه»، مصلحة فيها، تكمن في تحقيق انتصار أو هزيمة أحد الطرفين السوريين في النزاع، الأمر الذي قد يؤدي إلى استمرار الأزمة الحالية على مدى السنوات المقبلة. لقد قدّمت الدول الغربية دعمها لقوات المعارضة التي تريد إسقاط النظام أو إضعافه، إلا أنّها في الواقع لم تساعد المعارضة في شكل ملموس على الاستيلاء على السلطة.
* مؤلّف كتاب «الصراع على السلطة في سورية». سفير سابق لهولندا لدى دول عربية.
هشاشة الدولة المتصدعة/ رايموند هينبوش
إنّ أكثر مصطلح مقبول على نطاق واسع لوصف النزاع في سورية هو «الانتفاضة السورية»، لا سيّما أنّه يبتعد من الجدلية القائمة حول ما إذا كان يجب اعتبار ما يحصل ثورة أم حرباً أهلية أم صراعاً بين القوى الإقليمية المتخاصمة، مع العلم أنّه يشمل خصائص هذه المصطلحات الأخيرة كلّها. يتطلّب فهم تعقيد هذه الأزمة النظر إلى مجموعة من الأبعاد، قليل منها يمثّل حالة فريدة لسورية، إلا أنها جُمعت مع بعضها هناك وشكّلت مزيجاً خطيراً.
ويمكن الانطلاق من البحث عن سبب الأزمة الحالية المتجذّر في الفشل في بناء دولة. وكان ربما محكوماً بالفشل على دول المشرق التي أنشأتها الإمبريالية بطريقة اصطناعية مع خرق الهويات المهيمنة لدى شعوب المنطقة. وانجذب الأشخاص المولجون في بناء الدولة نحو الممارسات الموروثة حديثاً والقائمة على مزيج بين العصبية في فكر ابن خلدون، أي تضامن النخبة المرتكز على روابط بدائية (حالة العلويين في سورية)، وبين الآليات البيروقراطية الحديثة مع استخدام الوفرة الريعية لتأسيس «عقد اجتماعي» شعبي مع الجماهير قائم على الزبونية. غير أنّ تراجع الريعية والنمو السكاني أنشآ أزمات اقتصادية فرضت ضغوطاً هائلة على هذه الدول، لا سيّما تحت تأثير الليبرالية الجديدة على المستوى العالمي بهدف الانتقال نحو ما يمكن تسميته بالحقبة التي «تلي التحرّك الشعبي» حيث تقوم الدولة، كما هو الحال في سورية في ظلّ حكم بشار الأسد، بالتراجع عن تقديم الإعانات وبتفضيل المستثمرين، الأمر الذي من شأنه إنشاء رأسمالية صديقة جديدة ومفاقمة التفاوت الاجتماعي. وساهم ذلك كلّه في بروز مجموعة من الشكاوى التي أدت إلى اندلاع الانتفاضة.
من جهة أخرى، كان المغتربون السوريون في الخارج الذين لا يملكون سلاحاً آخر سوى شبكة الإنترنت يبحثون في إمكان استخدام الانتفاضة في تونس ومصر من أجل المضي في اتجاه الإطاحة بالنظام في سورية. وأصبح التظاهر في الشارع أمراً عادياً في العالم غير الغربي فيما تلقى تشجيعاً من تمويل المنظمات غير الحكومية الغربية وخطابات الانتقال إلى الديموقراطية. ومن شأن تظاهرة مماثلة في حال ظلّت سلمية تمهيد الطريق لحصول انتقال إلى الديموقراطية في بلدان مماثلة مع العلم أنّ ظروف ذلك تتمثّل في اتفاقية بين الإصلاحيين غير المتشددين في النظام وبين المعتدلين في المعارضة من أجل تهميش المتشددين المتطرفين على الجانبين.
لماذا فشلت هذه النتيجة في سورية؟ تعدّ المؤسسة والخيارات الفردية مهمّة، ولو لم يختر بشار الأسد الردّ على التظاهرات السلمية بالعنف، أي باعتماد «الحلّ الأمني» وردّ بدلاً من ذلك بتبني إصلاحات ديموقراطية، لكان يمكن تفادي الانتفاضة. بدلاً من ذلك، عمد من خلال الوقوف إلى جانب المتشدّدين في النظام إلى تمكين المتشدّدين في المعارضة أيضاً. وحين أصبحت المعارضة قادرة على ملء الشوارع بتظاهرات متواصلة، وجد النظام نفسه في موقع دفاعي. وساهم الأسد من خلال اللجوء إلى الخطاب الطائفي ضد «الإرهاب» وزيادة حالة العنف ضد خصومه، في تحويل التظاهرات السلمية إلى نزاع طائفي عنيف.
وغطّت الديناميات المتزايدة للحرب الأهلية على إمكان حصول انتقال إلى الديموقراطية. وفي مرحلة معيّنة، حين انهار النظام، برزت معضلة أمنية تمثّلت في تشجيع التضامن الطائفي الدفاعي وتعزيز مشاعر الكره ضد «الطرف الآخر» إلى جانب اقتناع أعضاء النظام والمعارضة بأنه لا يمكن التوصّل إلى حلّ سياسي حتى لو تبيّن أنّ أياً من الطرفين غير قادر على هزيمة الآخر. وفيما بدأت الانتفاضة بطريقة عفوية، زادت القوى الخارجية التي سعت إلى الاصطياد بالمياه العكرة من حدّتها، ما حوّل سورية إلى ساحة معركة إقليمية بين هذه القوى التي تعتبر النتيجة في سورية من شأنها تغيير ميزان القوى الأوسع في منطقة الشرق الأوسط بين ما يسمى بمحور المقاومة/الشيعة والكتلة السنية المعتدلة الموالية للغرب.
أخيراً، لا تتطابق شراسة النزاع السوري مع أعراض «الحروب الجديدة» التي أعلنت عنها ماري كالدور. ففي السيناريو الذي طرحته، تعزّز الدول الضعيفة الفاعلين المتعددي الجنسيات من الدول ومن غير الدول الذين يخوضون حروب هوية وتطهيراً إثنياً، حيث يتلاشى الفارق بين المحاربين وغير المحاربين. فيما يقوم حكم أمراء الحرب بردم الهوّة الأمنية. ويساهم تدفّق اللاجئين والتمويل الذي ترسله الجالية المغتربة وتهريب الأسلحة عبر الحدود في إدخال النزاع ضمن صراعات إقليمية أوسع وفي جعل مهمّة حلّها صعبة. أما إحدى العبر التي يمكن استخلاصها من هذه القصة فهي هشاشة الدول المتصدّعة مثل سورية. إذ يسهل زعزعة استقرارها ويصعب جداً إعادة جمع مكوّناتها من جديد.
* مدير المركز السوري للدراسات في جامعة سانت أندروز – اسكتلندا. مؤلف كتاب «سورية ثورة من فوق».
سورية “رحلت الى الأبد”/ نيكولاي كوزهانوف
منذ عام 2011 وربما الى حين وقوع الأحداث الأوكرانية الأخيرة، كان الوضع في سورية أحد المواضيع التي حظيت بنقاش واسع، أو ربما أكثرها نقاشاً، في صفوف صنّاع القرارات والمحللين السياسيين والصحافيين الروس. لكنّ معظمهم فاتته بداية النزاع السوري. فقد اعتُبرت التظاهرات والصدامات الأولية التي اندلعت عام 2011، مجرّد صدى للربيع العربي في تونس وليبيا ومصر. ولم يكن أحد يتوقّع أن تتحوّل هذه الاضطرابات المدنية وغير العنيفة في البداية إلى تحرّك أكبر.
كان الخبراء الروس يعتبرون سورية إحدى أكثر الدول استقراراً في منطقة الشرق الأوسط وشعبها ليس ميالاً الى تنفيذ أعمال عنف. إلا أنّ وجهة النظر هذه تغيّرت مع حلول عام 2012 حين اكتشفت المعارضة السورية قدرات تسمح لها بتنظيم صفوفها ضمن قوة عسكرية قادرة على تحدّي السلطات الرسمية. وكانت هذه المرة الأولى التي بدأت فيها وسائل الإعلام الروسية الحديث عن «انتفاضة» ضد نظام بشار الأسد غير الديموقراطي لوصف الأحداث الدائرة في هذا البلد.
لكن سرعان ما استُبدل مصطلح «انتفاضة» بمصطلح «حرب أهلية». وحصل ذلك لأسباب عدة. أولاً، أبدت موسكو اهتماماً تدرّجياً بدعم دمشق الرسمية ولم تكن محقة، من الناحية العقائدية، في إطلاق تسمية «ثوّار» على معارضي الأسد (وهو مصطلح يملك معنى إيجابياً باللغة الروسية). من جهة أخرى، تدلّ الأحداث التي توالت في عامي 2012 و2013 الى أنّ النزاع السوري هو أكثر تعقيداً ممّا كان يظنّ البعض في البداية، وعلى أنّ القوى التي تناضل من أجل تغيير النظام الحاكم لا يحرّكها دائماً القتال من أجل الحقوق المدنية.
واليوم، حين يتمّ الحديث عن الأحداث في سورية، يستخدم الخبراء الروس وصنّاع القرارات مصطلح «حرب» ويركّزون على طبيعة النزاع المتعدّدة الأبعاد. ويتمّ إذكاء النزاع السوري الذي بدأ كنضال من أجل الحرية المدنية الكبرى، من الأحداث الدامية القديمة ومن العداوات الدينية التي تقسّم المجتمع في البلد بين علويين وشيعة وسنّة ومسيحيين ودروز فضلاً عن عرب وأكراد وتركمان وآخرين. ويمنع ذلك بدوره المحللين من إطلاق تسمية ثورة على النزاع.
لا يمكن اعتبار هذا النزاع سورياً محضاً لأنّ الأعمال العدائية قسّمت حدود البلد بين العراق ولبنان. فضلاً عن ذلك، يساهم تدخّل القوى الغربية وروسيا والقوى الاقليمية في المواجهة في دفع بعض الخبراء إلى الحديث عن حرب بالوكالة. بالنسبة إليها، تحوّل هذا النزاع إلى معركة من أجل النفوذ في المنطقة.
وفي لا وعيهم، يعتبر الروس أنّ جهودهم في سورية هي محاولة للثأر من الأميركيين الذين لم يأخذوا برأي موسكو حيال الوضع في يوغوسلافيا العام 1999 وفي العراق العام 2003 وفي ليبيا العام 2011.
ترتبط المخاوف التي تراود البعض حيال سورية بالدور المتزايد الذي يلعبه المتشددون الإسلاميون في النزاع. فمشاركتهم الفاعلة في الأعمال العدائية حوّل هذا البلد إلى جبهة أخرى للجهاد العالمي. وبتنا شهود عيان على كيفية تحول سورية ميداناً لإنشاء علاقات بين المجموعات المتشدّدة الدولية. وقد فهمت هذه المجموعات تدريجاً بعد أن تمّ فصلها عن بعضها وتشتيتها في أنحاء العالم أنها جبهة موحّدة. ومن الممكن الافتراض بأنّه لدى عودة هؤلاء المتشددين إلى دولهم سيستخدمون علاقاتهم وتجاربهم في القتال لزعزعة الوضع هناك.
بشكل عام، يبدو أنّ الوضع الحالي في سورية وصل إلى حائط مسدود. لا تزال إراقة الدماء مستمرة ولا يخفى على أحد أنّ القوى الخارجية تلعب دوراً مهمّاً على هذا الصعيد. وتساهم طبيعة النزاع المتعدّدة الأبعاد في دفع المتحاربين إلى إطلاق نضال مستمر ضد بعضهم من دون التفكير في المصالحة. ومن شأن ذلك إطالة الحرب لوقت طويل. وفي ظلّ هذه الظروف، لا يمكن افتراض أو توقّع أي شيء حول ما ستؤول إليه الأمور في المواجهة السورية. إذ إنّ الشيء الوحيد الذي يمكن قوله على الأكيد هو أنّ سورية التي عرفناها منذ عقود عدة قد رحلت إلى الأبد.
* محاضر في الاقتصاد السياسي في جامعة سانت بطرسبورغ. خبير في معهد الشرق الأوسط في موسكو.
الحياة
في الذكرى الثالثة.. متفائلون بتحقيق أهداف الثورة رغم الصعوبات/ د. بدر جاموس
كان خروج المظاهرات في مارس (آذار) 2011 مفاجئا ومفرحا في آن، فبعد نحو خمسين عاما من القمع والتسلط وكم الأفواه من قبل نظام دموي، وجه السوريون رسالة للعالم بأنه «آن للظلم أن ينجلي».. وبأنهم يريدون حريتهم من نظام الأسد الذي عانوا منه الأمرين اعتقالا وترهيبا وقتلا وتشريدا.. وبدأت الثورة في أشهرها الأولى كحراك سلمي اتخذ من الأغاني والموسيقى والورود والشعارات واللافتات المبتكرة وسيلة للتعبير عن تطلعات شعب تواق إلى الحرية والكرامة والعدالة، وما لبث أن عم الحراك معظم المحافظات السورية ابتداء من درعا إلى القامشلي وبانياس إلى حمص واللاذقية وإدلب وحماه ودير الزور وحلب وغيرها.
لكن قمع النظام لثورة الشعب بكافة الوسائل، بدءا بالاعتقالات ورمي المتظاهرين بالرصاص وانتهاء بما سماه النظام «الحسم العسكري» ضد شعب أعزل استخدمت معه قوات الأسد، في قصفها على المدنيين، جميع أنواع الأسلحة الثقيلة، جعل الشرفاء من قوات جيش النظام ينشقون عنه، ليشكلوا الجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسعد وذلك في نهاية شهر يوليو (تموز) 2011.
وهكذا أصبح الثوار يقارعون أشد الأنظمة ديكتاتورية في العصر الحديث، نظام ادعى وروج طويلا لكذبة أنه «نظام مقاوم» و«ممانع» يسعى لتحرير الأراضي المحتلة، لكن الثورة أسقطت ورقة التوت هذه عنه ليظهر على حقيقته التي أخفاها طويلا عن السوريين.
فقد حارب نظام الأسد الشعب السوري حربا شعواء، في حين أنه لم يطلق رصاصة واحدة على جبهة الجولان تجاه عدوه الإسرائيلي المفترض منذ أن احتل جزءا من الأرض السورية.. واستخدم النظام من دون توان جميع الأسلحة التي دفع الشعب ثمنها باهظا وكأنه يقاتل «عدوا صهيونيا غاشما» لا شبانا طالبوا بحقهم في الحرية والعدالة.
ولا يخفى على أحد، أن نظام الأسد في حربه على الشعب، خدم أجندة إسرائيل التي تسعى منذ زمن إلى استنزاف سوريا، وإلى إضعاف نظام الملالي الإيراني الذي قدم دعما لا حدود له لحليفه الأسد تمثل بالمال، وبالمساعدة التقنية، وبتقديم عناصر ميليشيا حزب الله الإرهابي للقتال إلى جانب قوات النظام. كما كان واضحا أشد الوضوح دعم روسيا لربيبها نظام الأسد، فقد أمدته بالسلاح والعتاد والأموال أيضا، للحفاظ على توازنات إقليمية وحسابات دولية ولإبقاء حليفها موجودا في المنطقة.. وتدخلت دولة العراق أيضا في إرسال ميليشياتها الطائفية التي أجرمت بحق المدنيين العزل، وارتكبت مجازر مروعة كان بعضها بالأسلحة البيضاء.
وفي خضم الصمت الدولي المستمر، وتقاعسه عن دعمه الحقيقي لثورة الشعب السوري، والإشاحة بوجهه عن مأساة الشعب الذي قدم 140 ألف شهيد بل أكثر، وغادر بلاده هربا من قصف النظام ليصل عدد السوريين في بلاد اللجوء إلى ستة ملايين. مع كل هذا، أصبح جليا سقوط الأقنعة التي كانت ترتديها دول العالم، والتي كانت تتجمل بشعارات حماية حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، وغيرها من شعارات كانت تعبر فيها عن تحضرها.. فقد كان وقوفها عاجزة – أو متغاضية – أمام انتهاكات نظام الأسد، وارتكابه بشكل مستمر للمجازر، والتي امتدت حتى استخدامه للسلاح الكيماوي على المدنيين في الغوطة الدمشقية، دليلا على أن هذه الشعارات مجرد أقوال لا ترقى لمستوى الأفعال والنتائج، وهي مجرد كلمات مبدئية لا تصل لمستوى المصالح السياسية والاقتصادية لهذه البلدان التي تعتبرها خطا أحمر لا يجوز المساس به مهما كانت الوسيلة.
وكان موقف الغرب عالقا أيضا أمام تعقد التوازنات الدولية، والتردد في حسم الموقف وحسابات أخرى تتعلق بموقع سوريا الجغرافي وقربها من دولة إسرائيل، الأمر الذي شجع نظام الأسد على إرضاء المجتمع الدولي وكسب وده بتسليم سلاحه الكيماوي الذي كان يفترض أن يشكل السلاح المهدد لإسرائيل، في حين استمر النظام بقصف المدنيين وبشكل مستمر بالبراميل المتفجرة التي يلقيها من طيرانه الحربي فتدمر وتقتل وتشوه على مرأى أعين العالم.
وعلى الرغم من إجرام هذا النظام، فقد وافق الائتلاف الوطني على الحل السياسي وعلى التفاوض حقنا لدماء السوريين، وكطريق لتشكيل هيئة حكم انتقالي تملك كافة الصلاحيات. لكن هذا الأمر لم يعجب نظاما ما زال يتلقى دعما من حلفائه، نظاما أطلق كذبة «محاربة الإرهاب» وصدقها وأصر عليها وحاول الإقناع بها، في حين أن الجيش السوري الحر هو من يحارب إرهاب تنظيم «دولة العراق والشام» الذي خلقه النظام نفسه ليفسد ثورة الشعب السوري وينهي آماله في الحرية، وليقدم نفسه على أنه محارب شرس لإرهاب هو ممثله ومبدعه.. لكن هيهات أن يخدع العالم..
وفي ذكرى الثورة الثالثة، ثورة شعب تاق طويلا إلى الحرية، ودفع ثمنا باهظا في طريقها، وبالتزامن مع كل الصعوبات والمستجدات، وعلى الرغم من تقاعس المجتمع الدولي عن تقديم الدعم بشكل جدي للثورة والثوار، نحن متفائلون جدا بأنه مهما طال المطاف بثورتنا الجليلة، ومهما قدمنا من تضحيات جسام، فإن الثورة سوف تنتصر حتما، لأن الشعب السوري قوي وقادر على نيل مراده وتحطيم أصنام نظام جعل شعبه يعيش في وهم «صراع مع إسرائيل» الذي لا يتعدى حرب طواحين الهواء.. نظام ورث حكم والده حافظ الأسد المتسلط وصاحب مجازر حماه وحلب، بعد أن عدل الدستور بدقائق متسلما الحكم في 10 يوليو (تموز) 2000، متجاهلا وجود شعب يحق له الاختيار والاعتراض عليه.
ونحن نقول إن ثورتنا ما زالت مستمرة حتى آخر رمق، وما زال شعبنا صامدا ومصرا على الوصول إلى نهاية النفق.. وما زال الائتلاف الوطني السوري صوت الشعب المدوي أمام المجتمع الدولي، يفضح جرائم النظام وأكاذيبه وترهاته ويسعى لانتهاء المطاف به إلى محكمة الجنايات الدولية.
وما زال الجيش السوري الحر مقاتلا شرسا يحقق الانتصار تلو الانتصار ضد قوات نظام أجرم بحق الشعب وبحق الإنسانية، وسيلقى قريبا مصيره الأسود، نظام يتجاهل الحل السياسي ولا يعرف ولا يفهم سوى لغة القوة.
* الأمين العام للائتلاف السوري المعارض
الشرق الأوسط
خلاصات في ثلاث سنوات سورية/ فايز سارة
تشير بعض التقديرات المتصلة بالقضية السورية إلى اقتراب عدد الضحايا الذين أصابهم الصراع في سوريا بصورة مباشرة من مليون شخص قتلوا وفقدوا وتحولوا إلى معاقين وسجناء مجهولي المصير، وهناك نحو خمسة ملايين سوري لاجئين أو مهجرين خارج البلاد.. وضِعف هذا العدد مشردون من بيوتهم إلى مناطق أخرى في سوريا، بل إن بقية السوريين، لم يكونوا بمعزل عن التأثر بنتائج ما حصل في سوريا عبر السنوات الثلاث الماضية من ثورة السوريين على نظام الأسد، والتي يمكن القول إنها صاحبة أكبر فاتورة في الصراعات الداخلية التي شهدها العالم في القرن الماضي.
ورغم فظاعة فاتورة الصراع، فإن نتائجه غير محسومة، حيث النظام ما زال قائما، وثورة السوريين ما زالت مستمرة، وثمة أسباب كثيرة، لكن السبب الرئيس يكمن في التدخلات الإقليمية والدولية المستمرة والتي فتح نظام الأسد بابها في الشأن السوري، ويستمد النظام قوة بقائه من تلك التدخلات، وأهم اختصاراتها دعم سياسي أبرزه الدعم الروسي الذي كبّل مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات حاسمة ضد نظام الأسد وسياساته وممارساته، ودعم إيراني لوجيستي، يشمل المساندة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاستخبارية، ثم دعم بالقوة العسكرية المباشرة من خبراء روس وجنود إيرانيين ومقاتلين من حزب الله وميليشيات عراقية وغيرهم.
إن أهمية التدخلات الخارجية في بقاء نظام الأسد، لا تخفف من أثر سبب آخر منع انتصار السوريين في ثورتهم على النظام، وهو فشل تشكيلات المعارضة السورية الضعيفة أصلا في الوصول إلى وحدة سياسية وعملية لمواجهة النظام، رغم اتفاقها وتوافقها على ضرورة إسقاطه.. بل إن هذا الفشل وضعف المعارضة أديا إلى نشوء بيئة ساعدت في تسلل وتنامي جماعات متطرفة، أبرزها المنتمية إلى «القاعدة» وأخواتها مثل جبهة النصرة، ودولة العراق والشام الإسلامية (داعش)، والتي عملت ولا تزال على أخذ ثورة السوريين إلى غير أهدافها، وهذا موضوعيا قدم خدمات كبيرة للنظام ولا سيما على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، وكرس مستويات مختلفة من الصراع في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام أساسها صراع بين جماعات التطرف وتشكيلاتها المسلحة وقوى الثورة المدنية والعسكرية في تلك المناطق.
لقد جاء مؤتمر «جنيف 2» في ظل تعقيدات الصراع في سوريا وحولها، وكان هدف المؤتمر فتح بوابة لحل سياسي للقضية السورية، كما هو معروف. غير أن هدفا كهذا كان بعيد المنال وصعب التحقق، والسبب الرئيس معارضة نظام الأسد لفكرة الحل السياسي، وهو سلوك تكرس منذ اندلاع الأحداث في سوريا قبل نحو ثلاث سنوات، برفض النظام كل محاولات الحل المحلية والإقليمية والدولية وآخرها «جنيف 2»، وإصراره على المضي في مشروع الحل الأمني العسكري الذي يواصله اليوم.
وإذا كانت المعارضة السورية أكدت ميلها إلى الحل السياسي عبر المشاركة في «جنيف 2»، وهو ما تجسد عمليا في طروحاتها وسلوكياتها في المؤتمر والمتوافقة مع محتوياته الأساسية وخاصة لجهة إنشاء هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات وتنفيذ «جنيف 1».. فإن النظام كرّس العكس في الطروحات وفي الممارسات التي جسدها ساعيا إلى أخذ المؤتمر إلى غايات أخرى منها البحث في موضوع الإرهاب، عاملا على كسب الوقت في حربه على السوريين لإخضاعهم، وسط ضعف في مستوى الأداء الدولي والأممي بما في ذلك أداء رعاة «جنيف 2».
إن رفض النظام الانخراط في عملية سياسية تعالج القضية السورية في جوهرها، يمثل سببا رئيسا في فشل «جنيف 2»، كما أن ضعف الموقف الدولي في التعامل مع سياسات ومواقف نظام الأسد ومع مجمل القضية السورية ومجرياتها، هو سبب آخر، وكان التخلي الروسي عن التزامه بمحتويات «جنيف 2» وهدفه، يمثل السبب الثالث في عوامل فشل «جنيف 2».
ومما لا شك فيه، أن فشل «جنيف 2» في فتح بوابة لحل سياسي في سوريا، أعطى ويعطي دفعة من الزخم لقوى التطرف الديني والقومي التي ستذهب في موازاة تطرف وتشدد النظام ودمويته المتصاعدة، مما يساعد في تعميم عمليات القتل وتوسيع رقعة الدمار، ويزيد في أعداد المشردين والمهجرين واللاجئين، وهذا ما تؤكده الوقائع الراهنة في سوريا، والتي من بين أبرزها توضيح الاختلاف بين القوى المنتمية للثورة من الناحيتين السياسية والعسكرية، وقوى التطرف الديني والقومي، وهو أمر لا يظهر فقط في التجاذبات السياسية – العسكرية، التي صارت مكرسة في تشكيلات تخص كل طرف، وإنما أيضا في إعلان الافتراق والاختلاف السياسي حول هدف كل منهما، حيث قوى الثورة تسعى من أجل دولة ديمقراطية توفر الحرية والعدالة والمساواة للسوريين، بينما تسعى قوى التطرف الديني إلى دولة دينية بملامح متعددة تدور ملامحها قريبا من فكرة تنظيم القاعدة عن الدولة الإسلامية، وقد أدت التجاذبات ولا تزال إلى تصادم سياسي ومواجهات عسكرية كثيرة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بالتزامن مع حرب يشنها نظام الأسد في كل المناطق السورية.
إن استمرار الصراع السوري في نتائجه المحلية التي وصلت إلى عمق الكارثة، وفي نتائجه الإقليمية والدولية، والتي أخذت ملامحها تتوالى في مشاكل سياسية واقتصادية وأمنية وخاصة في دول الجوار وفي الأبعد منها وصولا إلى العمق الأوروبي، سيكون ذلك بين عوامل تغيير في السياستين الإقليمية والدولية حول القضية السورية، وهو ما يمكن أن يساعد السوريين في إعادة ترتيب وحدة صفوفهم وأوضاعهم السياسية والعسكرية، واستعادة روح الثورة في الحرب ضد نظام محمول على قوة التدخل الخارجي وما يقدم إليه من دعم وإسناد، لن يمنع من تداعيه وانهياره لو توفرت جدية دولية وأممية في التعامل معه ومع سياساته وممارساته الدموية، وسوف يقود تعاون سوري تمثله المعارضة بشقيها السياسي والعسكري مع المجتمع الدولي في مواجهة نظام الأسد وجماعات التطرف إلى خلق قوة تغيير قادرة على تغيير النظام وخلق نظام ديمقراطي جديد في سوريا، ولو بالمرور عبر مرحلة انتقالية.
الشرق الأوسط
عشية السنة الرابعة: المعارضة السورية بحاجة إلى استراتيجية/ عبدالوهاب بدرخان
عشية السنة الرابعة للصراع في سورية يستعصي على كثيرين استيعاب هذا الكمّ من العوامل الدولية التي لعبت ضد الشعب السوري وقضيته، فلا يجدون تفسيراً سوى «الصـدفة المعـاكسـة» أو «الـحظ الـعاثر». عندما استفاق هذا الشعب لم يجد سوى روحه على كفّه يقدمها ليتخلّص من الاستبداد، وإذ لم تكفِ التضحية لم يعثر على من يساعده بحقّ، لا في قمة العالم ولا في قاعه. وعندما استفاق العالم على هول المأساة وتعرّف الى تعقيدات الأزمة، لم يستطع بدوره العثور على «عقلاء» ولا على «وطنيين» بالحدّ الأدنى في النظام، كان هناك متـعطـشون لـلدم مـهووسون بـجرائـمهم ومـزهوون بـإذلال مواطنـيهم.
في القمة وجد الرئيـس الروسي في سورية الضالة التي يبحث عنها ليبني مجده الخاص ويستعيد الأمجاد الإمبراطورية والســوفياتيـة فـي آن، ورأى ملالي قم وطهران أن خوض معركة نفوذهم في سورية، مهما بلغ الثمن والخراب، يبقى أجدى من خوضها على أرض ايران. أما الرئيس الاميركي، الخطيب المفوّه عن الحرّيات والديموقراطية في العالم العربي، فاستحال بطّةً عرجاء عاجزة حين دُعي الى اتخاذ قرار من أجل شعب سورية. أدّى صراع الدولتين الى تعطيل مجلس وإقفاله: لا حماية للمدنيين، لا مناطق حظر للطيران، لا محاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، ولا عقوبات على قصف المدنيين بالسلاح الكيماوي والصواريخ والبراميل المتفجّرة… كل ما استطاعه المجتمع الدولي ذاك القرار غير الملزم لتسهيل وصول المساعدات الانسانية، قرار أشبه بحبّة مسكّنة لمصاب بمرض عضال كي يتحمّل آلامه في انتظار العائدين من اوكرانيا وأزمتها، فتلك أزمة اخرى مشابهة بتعقيداتها بل أكثر أهمية بحكم موقعها وقد تفجّرت في لحظة سورية حرجة لتراكم مزيداً من «الحظ العاثر».
عشية السنة الرابعة لم ينكشف وهم «التفاهم» بين الولايات المتحدة وروسيا فحسب، بل تلبّدت الأجواء الدولية مجدداً بـ «الحرب الباردة» وأشباحها. وتزامن سقوط خيار «الحل السياسي» لسورية مع اقتراب انهيار الحكم الموالي لروسيا في كييف مع ترحيب النظام السوري بـ «الهدايا» التي لا يتوقعها لكنها تأتيه تلقائياً ليتخلص من «جنيف 2» ومفاوضاته ويعود الى التركيز على استراتيجية استكمال سيطرة مستعادة، حتى أنه يبني على استقالة الوسيط الدولي الثاني ليحدد خيارات كانت متاحة له دائماً لكنه أخفق في تحقيقها، ولا يعبأ بمن يكون الوسيط التالي بل يعده بمصير مماثل، فأي وسيط لا يستطيع شيئاً من دون توافق اميركي – روسي لم يعد متاحاً الى حين.
بين الأطراف المفترض أنها معنية بالأزمة، سورياً وإقليمياً ودولياً، ينفرد نظام بشار الاسد وحليفاه الروسي والايراني بامتلاكهم استراتيجية شريرة غليظة الوسائل لكن واضحة الأهداف، إذ تطمح الى الشيء نفسه الذي شكّل القطيعة بين النظام والشعب. استراتيجية ضد منطق التاريخ لكنها تستغلّ ثغرات الوضع الدولي شاهرةً أكذب الشعارات متخففة من أبسط المبادئ مثقلة ببراميل الحقد الأسود. فروسيا تقدّم نفسها رائدةً للحل السياسي فيما تواصل شحن الأسلحة الى النظام، حتى أنها استطاعت «إقناع» اميركا التي صدّقت لأن لا خيارات اخرى لديها. وإيران تتولّى ادارة العمليـات العـسكرية حالياً وتعزز الوضع الميداني للنظام معتبرةً أن أي حل لا بدّ من أن يخضع لاحقاً لموازين القوى. أما النظام فيمضي في جني ثمار الحصارات والتجويع بهدنات مذلّة ومحدودة، لكنه يفشل في استعادة ثقة المناطق المهادنة، لذا يعود الى خرق الهدنات تلبيةً لنزوات «الشبّيحة». لكن هناك الأهمّ في هذه الاستراتيجية، وهو الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية الأسوأ في تاريخ الاجـتماع البـشـري. فعدا فوز معلن مسبقاً للمرشح قبل إجراء الانتـخابات أو من دونه، بل عدا احتقاره المثبت والمـوثّق لشـعبه، فإنه سيُنصّب علناً فوق جـثث وجروح وآلام نحو مليون سوري قتلوا أو قضوا تحت التعذيب أو أصيبوا أو فقدوا أو لا يزالون رهائن محتجزين في السـجون، إضافة الى عشرة ملايين سوري مهجّر أو نازح وليس بين همومه الأولى أن يعيدهم الى بيوتهم وديارهـم كما يُتوقّع من أي «رئيس» وحاكم «منتخب».
أما بالنسبة الى المعارضة، وباستثناء ما أظهرته من قدرة على التشرذم وتفتيت الذات وما أنجزه النظام من اختراقات في صفوفها عبر تنظيم «داعش» وبعض العسكريين ورجال الأعمال المزدوجي الأدوار، فإن سياسييها وعسكرييها لم يتوصّلوا الى بناء استراتيجية على مستوى الطموح. استطاع سياسيو المعارضة خلال مفاوضات جنيف أن يُظهروا جدّية وجاهزية لتحمّل المسؤولية عندما يُمنحون الفرصة، على رغم الانقسامات والتشويشات التي سبقت هذه الاطلالة الدولية المهمة، وعلى رغم ابتلاء المعارضة بـ «أطراف داعمة» أكثر تناحراً وتشرذماً في ما بينها ولا استراتيجية لها هي الاخرى. أما اجتماع العسكريين الذي تحوّل الى «حفلة ملاكمة»، فلم يكن مسيئاً ومخجلاً فحسب بل كان نذيراً باستحالة الرهان على «جيش حر» موحد القيادة والأركان والطاقات والسلاح، كما لو أن تلاعب الدول «الداعمة/ غير الداعمة» بتسليح هذا الجيش وتمويله أجهز على احتمالات اعادة تنظيمه وتماسكه.
هذه الحال المراوحة بين «الأفغنة» و «الصوملة» هي التي اعتبر محللون، أمام لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي، أنها قد تطيل الصراع في سورية الى عشر سنوات مقبلة وأكثر، استناداً الى أن أي طرف لن يستطيع أن يحسم. قبل ذلك كانت «مراجعة الخيارات» التي طلبها باراك اوباما من خبراء الادارة قد انتهت الى أن كل الاستراتيجيات التي سبق رفضها تبقى مرفوضة وأهمها التدخل العسكري المباشر وغير المباشر. اذاً، فلا استراتيجية للولايات المتحدة وإنما رغبة في تخفيف المعاناة الانسانية واستعداد مبهم لرفع الفيتو عن التسليح النوعي على نطاق ضيق ولمجموعات «معتدلة» معروفة. كان «الجيش الحر» يعتبر «نموذج اعتدال» مع رئيس أركانه السابق الذي أطاحته «الجبهة الاسلامية» فاضطر زملاؤه الى اقالته، وليس واضحاً بعد اذا كان الاميركيون مستعدين للتعامل مع هذا التغيير الذي بدا موضوعياً وضرورياً. قبل «جنيف 2»، تشدّدت واشنطن مع جميع الحلفاء في منع التسليح وتقنين التمويل، بل كانت واضحة في أنها لا تريد تغييراً في الوضع الميداني وكأنها كانت متيقنة بأن الحل السياسي وشيك على رغم علمها بالتقدّم الذي كان يحرزه النظام بواسطة حلفائه. لذلك، فإن سماحها الآن بالتسليح يأتي متأخراً كما كل قراراتها في شأن سورية.
لا شك في أن المؤشرات الحالية تنبئ بأن الصراع سيطول، فلا جدوى من المراهنة على ارادة دولية لإنهائه مثلما لم يكن هناك مجال للتعويل على ارادة سياسية داخل النظام. وقبل تكهن خبراء واشنطن بـ «عشر سنوات وأكثر» كانت أوساط المعارضة باشرت التفكير في هذا الاتجاه،، قبل «جنيف 2» وبعده، دائمة الإلحاح على التسليح والوفاء بوعود التدريب. لكن الدول «الداعمة/ غير الداعمة» تبدو مدعوة الى مهمتين عاجلتين: الأولى إحكام التنسيق في ما بينهما بالنسبة الى الدعم المالي والعسكري للمعارضة، والثانية الإقرار بأخطاء المرحلة السابقة ووضع استراتيجية لما بعد سقوط خياري الحل السياسي والضربات الصاروخية. فالنظام استطاع أن يفرض استراتيجيته التي ليحكم حيث يسيطر حتى على مدن خالية من السكان، وطالما أنه لا يزال موجوداً في معظم المناطق، فإنه يستبعد «الأفغنة» أو «الصوملة»، وكلما تقدّم ازدادت الصعوبات التي ستواجهها دول الجوار سواء مع النازحين أو مع المعارضة المسلحة بمختلف ألوانها معتدلةً ومتطرفةً.
* كاتب وصحافي لبناني
الحياة
سوريا تحتضر/ هشام ملحم
بعد قرن من المجاعة التي اجتاحت شرق المتوسط في الحرب العالمية الاولى والتي صنعتها القوى الخارجية المتصارعة وحصدت مئات الآلاف من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، تعود المجاعة مرة أخرى، لكنها هذه المرة محصورة بسوريا، وهي من صنع النظام السوري بامتياز. للمرة الاولى منذ مئة سنة يموت السوريون بالمئات والآلاف من الجوع والمرض والبرد والقصف بالبراميل المتفجرة والاسلحة الكيميائية نتيجة الحصار الذي فرضه النظام على احياء ومخيمات وضواحي مدن، واسلوب الحصار والتجويع اسلوب قديم قدم البشرية، يستخدم ضد عدو خارجي، الا ان نظام الاسد يستخدمه ضد شعبه. في القرون الوسطى كانت الجيوش تستخدم المنجنيق لقصف المحاصرين بجثث الحيوانات الميتة كي تتفشى الامراض في صفوفهم. نظام الاسد يستخدم وسيلة عسكرية بدائية بمقاييس العصر، أي رمي البراميل المتفجرة فوق رؤوس المدنيين المحاصرين وخصوصا في حلب. نجاح نظام الاسد في ترويع حلب وتدميرها مماثل لنجاح آخر طاغية متوحش اسمه تيمورلنك “زار” هذه المدينة العريقة ودكها قبل 600 سنة.
مع دخول الفجيعة السورية سنتها الرابعة، لم تعد التحليلات السياسية والتقويمات الميدانية والاستراتيجية تجدي. كيف تحلل وتستوعب مقتل 10 آلاف طفل سوري، من أصل 140 ألف قتيل؟ كيف تقوّم وتدرس اقتلاع وتهجير اكثر من تسعة ملايين سوري وانتشارهم في مخيمات البؤس في الداخل وفي لبنان والاردن وتركيا والعراق؟ كيف تفهم وتستخلص العبر من تدمير الإرث الحضاري والثقافي لإحدى أهم الدول الحاضنة لأعظم ما خلقته الحضارات الرومانية والبيزنطية والمسيحية والاسلامية. من سيعيد بناء كنائس سوريا ومساجدها الرائعة، ناهيك بحمص وحماه وريف دمشق؟ من سيحاسب البرابرة الجدد أكانوا في صفوف النظام أم في صفوف “جبهة النصرة” و”داعش” وغيرهم من الذين يلفون أنفسهم بعباءة الاسلام السياسي والمسؤولين عن تدمير الجامع الاموي والاسواق القديمة وقلعة صلاح الدين في أم المدن السورية حلب؟ او الذين قصفوا مآذن وقباب التحفة المسماة جامع خالد بن الوليد في حمص، او الذين دنسوا كنائس وأديرة معلولا وصيدنايا وخطفوا راهباتها لفدية؟ أو البرابرة الذين لجأوا الى حصن الاكراد والذين قصفوه وجرحوا هذه التحفة المعمارية التي رممها الاستعمار الفرنسي – نعم الاستعمار الفرنسي – ليعيد لها مكانتها كإحدى اجمل قلاع القرون الوسطى في العالم كله؟
سوريا التي عرفناها وعهدناها وأحببناها تحتضر. أشعر كل مرة أكتب فيها عن سوريا كأنني أكتب مراثي، او ذكريات قصة حب مضى. سوريا تموت ببطء والعالم يفرك يديه ويتحسر ولا يتحرك. سوريا تموت وتجرّ معها لبنان، ونظام الأسد يخطط للبقاء فوق هرم هائل من الركام.
النهار
من سيسقط في عام سوريا الرابع؟/ عبد الرحمن الراشد
السؤال مع دخول الثورة السورية عامها الرابع، هل سيحسم فيه مصير النظام بالخروج، أم سيتمكن أخيرا من القضاء على المعارضة، وتركيع الغالبية الثائرة عليه؟ الكم الهائل من المعارك اليومية في أنحاء سوريا يبين بشكل أكيد أن ثلاث سنوات لم تنجح في قمع الشعب السوري، رغم ما أوتي النظام من قوة ودعم. قبل سنتين كان الرئيس بشار الأسد يحاول شراء بضعة أسابيع من أجل السيطرة على البؤر المتمردة عليه. وفي مطلع العام الماضي كان قد وافق مبدئيا على التفاوض على نظام جديد، من أجل أن يشتري المزيد من الوقت.
ثم، في مذبحة غاز السارين في غوطة دمشق، سارع، بضمان من روسيا وإيران، لتقديم عرض بالتخلص من أهم أسلحته، أي الكيماوية، يقوم أيضا على منع التدخل الأميركي ضده وشراء المزيد من الوقت لحسم المعركة لصالحه. ورغم كل ما اشتراه من وقت وأسلحة وخبراء، ورغم حرمان المعارضة المسلحة من العتاد النوعي، فشل الأسد في الإمساك بسوريا. كل ما أفلح فيه هو تدمير البلد بصورة لا تعبر إلا عن حالة حقد وكراهية. نحن ندخل السنة الرابعة في أشرس حرب عرفتها المنطقة لإسقاط نظام حاكم، وقد أصبح نصف السكان مشردين، وعدد القتلى يصل إلى مئات الآلاف، وفي الوقت نفسه المعارك مستمرة بما في ذلك محيط العاصمة دمشق. في سنة حرب رابعة يفترض أن التخلص من الكيماوي قد استنفد المهلة، وبتنفيذه، يصبح النظام عاريا بلا سلاح كيماوي، أو أن يستمر مماطلا متذاكيا لفترات أطول، ستحرج الموقف الأميركي، والأرجح أن تضع الأسد في مرمى نيران حلف الناتو.
ماذا عن الجبهة الخلفية للمعارضة؟ هل لا يزال لديها الحماس، والإمكانية، والتحمل لتسليح الجيش الحر، وإعانة ملايين اللاجئين يوميا، وخوض المعارك السياسية ضد الأسد وإيران في المحافل الدولية؟ لا تزال القوى المؤمنة بالمعارضة، والداعمة للشعب السوري، ملتزمة بموقفها، وتحديدا السعودية والإمارات وقطر. وهذه الدول تدرك خطورة التخلي عن المعارضة، لأنه يعني انتصار النظام الإيراني في عموم المنطقة. وتعي كذلك أن المأساة ستتسع إن تخلت عن دورها في ترجيح كفة الصراع الإقليمي الذي بلغ مرحلة مهمة تستوجب الحسم. وبدخول المعارضة عاما آخر من المعاناة واللاحسم، يزداد الحمل على الجيش الحر، ومجلس الائتلاف، والقوى والمجالس التي ترفع علم الثورة. وهي بكل أسف، تمثل الحلقة الأضعف في مجمل القصة السورية. لا تزال باهتة، ومفككة، وعاجزة عن الانضباط الهيكلي، ومستمرة في صراعاتها. والمعارضة بدورها تنقل نزاعاتها إلى أعلى، حيث بسببها تحدث اشتباكات بين الدول الراعية. وهي تتحمل قسطا من المسؤولية في ضعف الدعم الدولي السياسي، التي أثارت شكوكا، ومخاوف، في قدرة المعارضة على إدارة الأرض والسكان والموارد. وبسبب تناحرها دخلت بين صفوفها جماعات إجرامية، مثل «داعش» و«جبهة النصرة»، خدمت نظام الأسد، وهددت الأقليات، وروعت معظم السكان الذين ثاروا على الأسد كرها في نظامه التسلطي ليجدوا جماعة لا تقل شرا وتسلطا عليهم.
وفي كل الأحوال، سوريا الآن، ليست سوريا الأمس، ولن تكون سوريا المستقبل. لقد تغير المشهد إلى الأبد، الأسد ونظامه جزء من التاريخ الذي طوي، مهما حاول، وحاولت إيران وحزب الله، ومعهم روسيا. نحن نرجو أن تكون الآلام أقل، والانتقال أسرع، لكن بكل أسف يصر العالم على جعله أكثر إدماء، وإيلاما، ووحشية.
الشرق الأوسط
العرب ودروس الأزمة السورية/ عبدالله الأشعل
لا شك في أن الحل الأمثل للأزمة السورية المعقدة هو الحل السياسي، لأن إدارتها من جانب بعض الدول الكبرى بقصد استطالة أمدها وإنهاك الوطن السوري وإذلال شعبه، لا يجوز التسليم بها. وإذا كانت جولة «جنيف- 2» فشلت، فيجب أن نواصل البحث في جولة ثالثة تستفيد من ثغرات الجولتين السابقتين. وحتى يتحقق ذلك تظل الأزمة السورية مصدراً خصباً لدروس ثمينة يستفيد منها العالم العربي ليعيد بناء منظمات العمل المشترك على أساس سليم.
أول هذه الدروس أن يتم تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم داخل الدول العربية على أساس التراضي وليس القمع. والدرس الثاني، أن القسوة في معاملة الشعوب، لم تعد مقبولة، بعد تفاقم مشاكل الاستبداد والفساد وانكشافها في المرآة الدولية. الدرس الثالث، حظر تدخل الدول العربية لمساندة المعارضة في دول عربية أخرى وحظر مدها بالسلاح أو غيره.
صحيح أن مد المعارضة السورية بالسلاح قد يكون له هدف نبيل وهو مواجهة بطش السلطة، لكن تظل سلمية الاعتراض وعدم رفع السلاح في وجه الحكومة أكثر حكمة وأكثر فاعلية فى نيل الحقوق.
الدرس الرابع، أن الدول المجاورة للعالم العربي لها مصالح بعضها مشروع يستحق التعاون وبعضها منكور يستحق المصارحة. لذلك لا يجوز أن تتفرق المواقف العربية حول هذه النقطة وأن تتماهى بعض المواقف العربية مع مواقف الدول الخارجية.
الدرس الخامس، أن الحاكم المستبد يدفع ثمن بقائه من استقلال بلاده وحياة مواطنيه، ولذلك فإن تذرعه بأنه هو الوطن وأن استمرار نظامه برغم أخطائه هو المصلحة العليا للوطن، يحتاج إلى مناقشة. الدرس السادس، ضرورة وجود مشروع لبناء الوطن وتنميته يشغل كل دولة بما ينفعها وأن يكون هناك مشروع قومي للقضاء على الفقر والبطالة ومشاكل الشباب وأن تستفيد الشعوب العربية من مساحات وموارد العالم العربي والتركيز على التنمية الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية في إطار عربي حتى نلحق بجيراننا في أوروبا وأن نقيم أفضل الصلات مع العالم ليكون العرب إضافة للحضارة الحديثة وليس عبئاً ينشغل العالم به.
الدرس السابع، إعادة النظر في إنشاء المشروع القومي العربي الذي يلتقي ولا يتصارع مع المشروعات القومية الأخرى بخاصة المشروع الإيراني والمشروع التركي. وإذا كانت تركيا ذات التاريخ الطويل سياسياً وثقافياً مع العالم العربي، لها مشروع في المنطقة، فإن إيران لها مشروع أيضاً، وعدم وجود مشروع عربي يجعل فضاءنا مخترقاً من المشروعين، فضلاً عن المشروع الصهيوني.
الدرس الثامن، أن الأزمة السورية لا بد أن تعرف الحل السياسي مهما طال الزمن، لكن الذي يعرقل هذا الحل هو عدم التوصل إلى صيغة تتناسب مع مصالح أطراف الصراع الأجانب، ولا يعطي أي اعتبار لمصالح الشعب والدولة في سورية. ولذلك يجب أن يتفق العالم العربي على حل واحد يراعي هذا البعد الغائب حتى يمكن التوصل إلى حل سليم.
وبصراحة أكبر فإن الصراع الإيراني – السعودي لا بد أن يتم حله بأسرع ما يمكن، وكان الظن قائماً عند المراقبين أن تخفيف التوتر الإيراني الأميركي سيؤدي إلى تخفيف التوتر في العلاقات السعودية الإيرانية. ولكن ظهر العكس، وهو ما يقتضي من العرب التنبه إلى ملامح وتحولات السياسات الدولية في المنطقة. ومن بين مبادئ هذه التحولات أن محاولة التقرب من روسيا نكاية بواشنطن تعتبر حلاً ساذجاً، لأن المصالح المشتركة بين البلدين كفيلة بأن تجعلهما المستفيدين معاً من مثل هذا التقارب بعدما انتهت الحرب الباردة إلى غير رجعة. ومن هنا لن نمل الالحاح على البدء في حوار عربي – إيراني، ويجب ألا نغفل عن أهميته. الدرس التاسع أن شباب العالم الإسلامي الذي أصبح وقوداً للصراعات والمفاهيم الخاطئة لا بد من إنقاذه وتوجيه طاقاته إلى التعليم والوعي والبناء. عند هذه النقطة أدعو التيارات والحركات الإسلامية كافة إلى مراجعة أولوياتها وأن تعتمد في ذلك على عقولها وليس على التوجيه الأعمى من قياداتها مهما علت، لأن الرجال يُعرفون بالحق وليس العكس. هذه المراجعة تعد بالغة الأهمية بعيداً من الأجندات السياسية، ويوم تخلص النيات وتستنير العقول فسوف ترى أن دعم الأقصى ونجدته بالأسلوب العلمي هي الأولوية المطلقة وليس القتال بين المسلمين بنار الفتنة والتضليل.
التسوية الإيرانية السعودية، والحوار العربي الإيراني والتركي، والمراجعة الأمينة لمشروع الحركات الإسلامية، ونبذ الفتنة بين أتباع المذاهب، بل الشرائع، والتعاون في بناء الأخلاق العامة، هي بنود برنامج المرحلة المقبلة، بعد حقن الدماء الزكية في سورية والعراق واليمن ولبنان ومصر وليبيا.
* كاتب مصري
سوريا: أربع سنوات من العار/ حسين شبكشي
يعرف السوريون جيدا العبارة الغبية التي كان يضعها نظام الأسد في صفحات جوازات سفرهم، والتي كانت تقول: «يُسمح لحامل هذا الجواز السفر إلى كافة دول العالم إلا العراق وبروناي»، ولم يكن أحد يعرف لماذا تم استثناء العراق وبروناي، وليس إسرائيل أو إنجلترا أو الولايات المتحدة، باعتبارها «دولا معادية وإمبريالية وصهيونية ومغتصبة وخبيثة» وبقية القائمة البعثية المعروفة في الشتائم والسباب.
ولكنها نموذج للفهم المغلوط الذي نشأ عليه نظام الأسد الذي يدخل عامه الرابع في مواجهة ثورة شريفة من شعبه الرافض لإجرامه ودمويته وطغيانه، شعب قام بعد أن وصلت الأكاذيب والإضلال والطغيان والفساد والجبروت لمراحل لم يعد من الممكن السكوت عنها ولا عليها.
أكذوبة الممانعة فضحت وعرفت بالأدلة والبراهين والإثباتات أن النظام الأسدي هو الحامي الأول لحدود إسرائيل، وشهد بذلك رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد وبوابة النظام الاقتصادي، حينما قال بصريح العبارة: «أمن سوريا من أمن إسرائيل»، وهي مسألة اتفق معه فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال هو الآخر تصريحا بالمعنى نفسه، حينما قال: «إن بقاء الأسد في الحكم فيه ضمانة لأمن إسرائيل» وسقطت بذلك كل الأوهام بشعارات الممانعة التي كان يروج فيها النظام لنفسه، وسقطت أيضا شعارات العروبة والقومية، وكيف أن النظام تبنى نهجا وفكرا يغوص في القومية والعروبة وهو يستلقي بأكمله في أحضان إيران التي علاقتها بالقومية والعروبة كعلاقة كوريا الشمالية بذلك الأمر، وحديثها عن العلمانية وحماية الأقليات لم يكن سوى واجهة مضللة لإبراز وجه طائفي بامتياز، خرجت معه من الجحور أرتال من العصابات الطائفية أتت للقتال مع هذا النظام من كل صوب، متناسين هم أيضا شعارات المقاومة والقتال ضد العدو الإسرائيلي، وغير ذلك من الشعارات الجذابة.
إنه نظام الخوف والكذب، وها هو يستمر في إهانة شعبه، ويعلن عن إغلاق سفاراته في أكثر من دولة، وعندما سأل أحد الصحافيين مسؤولا دبلوماسيا سوريا عن الذي من المفترض عمله من قبل المراجعين السوريين في تلك الدول لقضاء حاجاتهم، فرد بكل وقاحة: «يسطفلوا».
إنه نظام يحتقر شعبه بامتياز، ولا يخجل من إظهار ذلك بكل الطرق والوسائل النظامية منها والدموية. لم يسلم هذا الشعب الشريف من أي وسيلة مدمرة إلا واستخدمت بحقه؛ من صواريخ وبراميل وقذائف وطائرات ودبابات وكيماوي. إنه النظام الأكثر دموية في العصر الحديث. دمر الحجر والبشر، ولم تسلم منه أي مدينة ولا قرية إلا ذاقت الدماء والمر والرصاص.
سقطت الأقنعة، وانكشفت الوجوه، وذابت الأكاذيب، ومزقت الشعارات، وها هو الرئيس الذي أتى إلى المنصب بـ«وراثة» غير مسبوقة ودستور مفصل على قياسه ومجلس شعب يصفق كـ«المساريع» لتأييده، يأتي اليوم على أنقاض بلاده، وعلى أرتال من الجثث التي قضت من أبناء بلاده يعلن عن نيته الترشح لمنصب الرئاسة، وهو يعلم أن شعبه قد تقلص عدده بين مشرد ومقتول ومسجون وضائع، وبالتالي لم يبق بالبلد سوى من يخشى ويخاف، أو مجبور على أن يؤيده.
ولذلك أقنعوه بأنه «سيفوز»، لأن الموضوع بات اليوم «أسهل» عدديا بكثير. من المضحك المبكي أن الرئيس بشار الأسد اليوم يُقارن بأنجلينا جولي الفنانة الأميركية المشهورة التي زارت مخيمات اللاجئين السوريين أكثر من مرة، وقدمت لهم الدعم الكثير بينما لم يجرؤ أحد من حكومته ولا هو بطبيعة الحال الاعتراف باللاجئين، وبالتالي زيارتهم. سوريا كحكم ونظام انتهت أخلاقيا قبل أن تنتهي سياسيا، ولا عزاء للشرفاء.
أربع سنوات من الدم والموت والقتل والصبر والهوان والمذلة، ويبقى رئيس يعاد انتخابه على أشلاء بلاده، هي صفعة ليست للسوريين الشرفاء وحدهم، ولكنها عار على كل من في جسمه دم أو بواقي ضمير. حقا قالها خالد بن الوليد رضي الله عنه دفين حمص الأبية: «فلا نامت أعين الجبناء».
الشرق الأوسط
ما قبل زوال النظام/ ساطع نور الدين
عندما يتكىء ثوار سوريا على الحتمية التاريخية وحدها، تصبح الذكرى الثالثة لانطلاق ثورتهم مجرد لهوٍ على ايقاع الزمن البطيء، يشجع النظام وتنظيم داعش على المضي قدما في رقصهما المجنون على القبور.
في مستهل عامها الرابع، ما زال الثوار جاهدين في مسعاهم لتعريف تلك الهبة الشعبية، وتفكيك رموزها، وتحديد معالمها. لم يصلوا بعد الى توضيح وجهتها، التي تبدو في بعض الاحيان، وكأنها ثأر شخصي مع الرئيس، مع العائلة، مع الطائفة.. مع ان المعركة صارت اكبر من تصفية حسابات تاريخية قديمة، وابعد من كونها حركة تغيير لنظام حكم او بنيان دولة.
ما زالت واحدة من اغرب الثورات في العالم واعنفها على الاطلاق. ثمة خيط رفيع يربط بين المقاتلين على المحاور وخطوط التماس المنتشرة على امتداد الارض السورية. هو بالتحديد ذلك الثأر. وكل ما عداه ينذر بان السنوات الثلاث الماضية كانت مجرد مناوشات محدودة.. لم تساهم في تقريب موعد تشكيل القيادة العسكرية الموحدة وغرفة العمليات المشتركة، ولم تؤد تاليا الى اضعاف النظام وقوته، بل ولم تفرض عليه حتى تغيير اسلوبه الوحشي ضد المدنيين العزل.
لن يتوقف القتال ولن ينتظم، لان الدوافع الفردية ( غير السياسية) كانت ولا تزال هي الاقوى، ولان الهوة سحيقة بين كل ما هو عسكري وما هو سياسي-ثقافي. التخاطب مقطوع بين الجانبين اللذين يطمئنان فقط الى عدالة القضية، والى بعدها الانساني والاخلاقي. ويستوي في ذلك المعارضون مع الموالين..الذين اكتسبوا نتيجة الانقلاب الاسلامي الاخير في صفوف الثورة زخما اضافيا في الداخل والخارج، لم ينجح في تقويضه المجادلون في شرعية الثورة وأحقية مطالبها.
هؤلاء يؤدون دور الناطق الرسمي باسم الثورة، والمدافع عن هويتها امام العالم.. من دون ان يقترن هذا الدور بمخاطبة الثوار انفسهم ومناقشتهم ومحاسبتهم وتصويب مسارهم، ومن دون ان يتفاعل ذلك الدور مع المؤسسات التي انتجتها الثورة، ويفعّلها، بحيث لا تكون سببا اضافيا للشقاق بدل ان تكون مركز جديدا للقاء. الائتلاف الوطني نموذج صارخ، لذلك الخلل البنيوي في صفوف المعارضة السورية، وربما ايضا في تكوين الشخصية السورية. وهو خلل مذهل فعلا، اذا ما قورن بحجم الدم الذي يسيل في سوريا اليوم، والذي كان يفترض ان يؤلف بين الجميع ويضعهم في خندق واحد.
لن يتوقف القتال، لان طرفيه ما زالا يتحدثان مع العالم الخارجي اكثر مما يتحدثان مع جمهورهما. وهما ينسخان اللغة اللبنانية التي ابتكرت “حروب الاخرين على ارض لبنان”.. مع ان ميزة الحرب السورية هي انها في الاساس جهد خاص، ما زال “الاخرون” على اختلافهم، يتهيبون الانخراط به حتى النهاية مخافة الاستنزاف او حتى الانكسار، وما زالوا يعتمدون على وكلاء لبنانيين وعراقيين او “عرب افغان”..
لعل الانتخابات الرئاسية السورية تكون فرصة لمثل هذا الحديث المؤجل، سواء من جانب النظام ومرشحه الاوحد مع جمهوره الخاص، او من جانب المعارضة التي لن يكون لديها مرشح، لكنها ستكون مدعوة الى التفكير بهذا الاحتمال الذي سيظهر يوما ما، من تحت الركام السوري ليتحدى جمهورها وجميع تنظيماتها السياسية والعسكرية.. طالما ان التفاوض مرفوض ومحظور ، لاسباب وجيهة الان، من قبل الجانبين ، لكنها لن تبقى كذلك عندما يدنو خطر التقسيم باعتبارها مفراً اخيراً من الحسم الباهظ الثمن، بل والمستحيل.
وفي مثل هذا النقاش حول الرئاسة، ما يمكن ان يفسر الكثير من سلوك النظام وما يكشف من شعبيته الحقيقية وما يحدد خطته المقبلة السياسية والعسكرية ، وما يبرر للمعارضة القول انها نجحت في التشكيك بشرعية النظام وحالت دون تحويل التوريث الى شرعة سورية أبدية، وهي مستعدة لدخول السياسة من اوسع ابوابها، ولترتيب شؤونها الداخلية المحيرة للعالم اجمع .
نقاش متواضع، بالمقارنة مع الحتمية التاريخية لزوال النظام ، لا يوازي التضحيات التي قدمها الشعب السوري حتى الان.. لكنه اجدى من السؤال عن سبب بقاء النظام وعن سبب صمود الثورة.. اوعن مدى تورط الخارج، ودوره في دخول السنة الرابعة من عمر الثورة.
المدن
شمعة رابعة لعزرائيل/ راجح الخوري
مع بداية السنة الرابعة للمذبحة السورية كثرت دموع المرائين وتصريحات العاجزين، التي تدعو الى التقيؤ، لأن لا المأتم السوري سيتوقف ولا غياب العالم المطلق سينتهي. الأخضر الابرهيمي نطق اخيراً فلم يجد ما يقوله غير التحذير من ان مضي بشار الاسد في تجديد ولايته سيفجر العملية السياسية المتمثّلة بمحادثات جنيف. ولكأن هذه العملية المسخرة لم تتفجر بالبراميل كما يتفجر الناس!
بان كي – مون بدا اكثر مدعاة الى الشفقة كي لا نقول السخرية، عندما دعا (حرام) الحكومة السورية والمعارضة الى “التحلّي بالمسؤولية والعمل على انهاء المأساة التي الحقت الضرر بملايين السوريين”، معرباً عن الأسف لفشل العملية السياسية!
فلاديمير بوتين مدير المظلّة الدولية لحماية النظام، الذي اوصل سوريا لتصير مستنقعاً صومالياً، بدعمه الحل العسكري منذ البداية، وتعطيله مجلس الامن وتفخيخه بيان جنيف، غارق في حربه الجديدة في اوكرانيا مطمئناً الى مسارات البارود الروسي والدم في يبرود!
باراك اوباما سعيد ومرتاح الى قراءات الكونغرس، التي طمأنته الى ان الحرب في سوريا قد تستمر عشر سنين اضافية، اذاً فليكسّر هذا “الفخّار” بعضه بعضاً، فالنفط لم يعد عامل ضغط، وخصوصاً مع انبثاق عصر النفط الصخري، وأمن اسرائيل لم يكن مضموناً كما هو اليوم، وهذا يوقف شرور ثعالب الصهيونية في واشنطن، وليغرق الروس في كراهية اكثرية المسلمين في العالم بدعمهم المذبحة السورية، وهكذا ننصرف الى مواجهة التحديات التي يراكمها التنين الاصفر في شرق آسيا!
الايرانيون الذين يقاتلون مع الاسد في المتاريس مع اذرعهم العسكرية اللبنانية والعراقية، ديموقراطيون وشفّافون، فها هم يدعون المعارضة السورية الى مواجهة النظام في صناديق الاقتراع ولكأن التوابيت لا تكفيهم، هذا اذا توافرت، واذهبوا ووقعوا على سبع سنوات جديدة لـ”الاسد قائدنا الى الأبد”!
المعارضة او المعارضات السورية (حرام أيضاً) دخلت المستنقعات الصومالية فهي تتقاتل وتقتتل وتقاتل النظام وتقتل سمعة الثورة بسكاكين الارهابيين والتكفيريين، وسوريا صارت مشاعاً دولياً مفتوحاً للقتلة ممتهني العنف والدم، والاسد يلقي براميله والموت يصفّق!
العرب كما لم يكن العرب في اسوأ مراحل تاريخهم، إذ يكفي ان نتأمل في خريطة الانقسامات والخلافات العاصفة بينهم، والتي تتهدد مؤتمر القمة الذي سيعقد بعد ايام في الكويت، لكي ندرك الى اين تتجه المنطقة على قرع طبول الضغائن المذهبية بين السنّة والشيعة، وقد تمكنت اميركا والصهيونية من اثارة تاريخها البغيض!
شمعة رابعة تشعلها البراميل المتفجرة لطوفان الدماء والمآسي التي تدمر سوريا، وبالمناسبة التي تنخر في لبنان، فلا يختلف أهله على كلمة في بيان وزاري فحسب، بل على ما اذا كانوا يستحقون دولة او انهياراً اخيراً يدفنهم في مقابر سيبويه!
النهار
ومع ذلك.. فهي تثور/ حسان عباس
تدخل سوريا عامها الرابع ثورة. “العمر كله” كما نقول احتفاءً بميلاد مجيد. في البدء تماحكنا وتناظرنا وتعاركنا حول شرعية التسمية. أهي ثورة؟ أم انتفاضة؟ أم حراك ثوري؟ أم حرب أهلية؟ أم مؤامرة كونية؟ إلى ما هنالك من تسميات أطلقها بعضنا، ونحن منهم، تأسيساً على إرادوية تمتنع عن إسقاط المشتهى على أحداث لا تشي بحضوره، وأطلقها بعضنا الآخر تبخيساً لفعل تغيير مذهل لم يدخل ضمن تخوم خيالاته وتصوّراته، وأطلقها بعضنا الثالث تهرّباً من ضريبة ما كان لها إلا أن تُستحق طال الزمان أو قصر، وأطلقها آخر رابع تخوّفاً من اهتزاز بنية نفعية تشرنق فيها وبات كل من يشير إليها بالنقد خائناً وعميلاً و”برغياً” في آلة المؤامرة المحاكة على وطن تقزّم حتى تطابق مع جسد نظام مشوّه خارج التاريخ..
تعددت الأحكام والواقع واحد.
والواقع هو أن ما كان انتهى، وأن شيئاً جديدا أتٍ لا محالة.
انتهت حقبة جعلت من السوريين كائنات خائفة ترتجف إن حلمت بحرية. انتهى زمن تختزل فيه مواطنية المواطن إلى التصفيق والرقص والتهريج احتفاءً بشعاراتٍ مقعّرة فُرّغت من كل محتوى وغدت إشارة حسّية لإطلاق منعكس الثغاء الجمعي الجدير بقطيع. انتهى عهد الفرجة، حيث بات المواطن متفرّجاً على الفساد باسم القانون، وعلى التسلّط باسم الدستور، وعلى القمع باسم حماية الأمن، وعلى الخراب باسم التطوير والتحديث.
انتهى ذاك الزمن ودخلت البلاد في مخاض التغيير. ويا له من مخاض عزّ نظيره في حكايات الشعوب الحبلى بالشوق إلى الحرية والمسكونة برجاء القيامة. يا لها من جلجلة يقف إزاءها التاريخ مشدوهاً، منقطع الأنفاس. يا لها من ملحمة تقف البشرية دونها خجلة من نفسها، مسربلة بالعار.
لم يكن المخاض كرنفالاً يحتفي بفرح الشعوب الطفلي وهي تتلبّس الجديد. ولم يكن تنويعاً، بنسخة سورية، لسردية انتفاضة لشعب مقهور يستيقظ نحو خلاصه. لكنه كان النموذج الفريد لأمرين اثنين: شيطانية النظام ومأساة الشعب.
تمثّلت شيطانية النظام في إصراره على حفر هاوية بلا قرار تجذب، كثقب أسود، كل ما يتفاعل في المحيط، بما في ذلك النظام أيضاً. كأن لسان حاله يقول: لن أسقط وحدي، بل سأسقِط الكل معي. إن كانت النهاية فلا أحد سينجو. وإن كان ثمة ناجون، ولو محطّمين، فسأكون بينهم، محطّماً مثلهم، أو ربما أقلّ. شيطانية اختزلها شعار “الأسد أو لا أحد”.
وتمثلت مأساة الشعب في ما لحقه من خراب روحي واجتماعي وحضاري، لكن أيضاً في حَيرته أمام ما انتهت إليه شيطانية النظام. وثمة عناوين كثيرة لهذه الحيرة: من أين جاءت تلك الوحشية التي عصفت بكل ما كان يميزنا من رحمة وكياسة؟ كيف لنا أن نعيد بناء نسيج وجودنا المشترك؟ أين المخرج ونحن نرفض ظلم النظام ولا نريد ظلامية التشدّد الديني؟ ثم من نحن في نهاية المطاف؟ هل سنعود مواطنين في بلد له اسم وهوية وتاريخ أم سنستفيق على حال نكتشف فيه أن كل ما ظنناه لم يكن سوى وهم، وأننا أسرى لأوهام؟
ربما تكمن عبقرية المخاض هنا تحديداً، أي في طرحه لأسئلة لا حلّ لها في بقاء الحال القديم، وفي وعده القاطع بجديد لا يترك مجالاً لشك
بقدومه، حتى لو لم يرسم ملامح هذا القادم الجديد. في هذه السيرورة من القديم المنتهي نحو القادم المبتدئ ترتسم حياة الثورة.
سمّوها ما شئتم، انتقدوها كما أحببتم، اخدعوها، راودوها، تحايلوا عليها، احفروا الأرض تحت أقدامها، لوّنوها، العنوها، افعلوا ما شئتم.. فهي، وبمحاكاة لما قاله غاليليو غاليليه لمرهبيه: ومع ذلك فهي تثور. هي باقية، وهي أصلاً لم تبدأ إلا لتبقى حتى تصل إلى ما يريده أهلها: حياة كريمة بلا ظلم ولا ظلامية.
سوريا تدخل عامها الرابع ثورة.. كل عام وأنت بخير يا وطني.
المدن
لماذا أرادوا للثورة السورية أن تدخل عامها الرابع؟/ د. فيصل القاسم
استغرقت الثورة التونسية ثمانية وعشرين يوماً فقط. أما المصرية فدامت لثمانية عشر يوماً بالتمام والكمال. صحيح أن الثورة أخذت بعض الوقت في اليمن، لكنها انتهت من حيث الفعل الثوري خلال فترة وجيزة. وحتى في ليبيا التي أخذت شكل الصراع السوري المسلح، انتهت الثورة خلال ثمانية أشهر على الأرض من خلال تدخل دولي. لا شك أن الأوضاع بعد الثورات في تونس ومصر واليمن وليبيا تعسرت في بعض الأحيان، وتفاقمت أحياناً أخرى، لكنها على الأقل انتهت بخسائر مادية وبشرية محددة تبدو مجرد ‘لعب عيال’ بالمقارنة مع ما يحصل في سوريا من أهوال ودمار طال البلاد كلها، وبدأ يطال البلدان المجاورة، وحتى أنه راح يهز المنطقة العربية برمتها جيوسياسياً واقتصادياً. باختصار، لم يكن هناك مصلحة للكثير من القوى استمرار الثورات على الأرض في تونس ومصر واليمن وليبيا. لاحظوا أيضاً كيف وضعوا حداً للأزمة الأوكرانية خلال أسابيع قليلة، فتنحى الرئيس يانكوفيتش منعاً لمزيد من التفاقم. وهنا نتساءل: لماذا سمح العالم لبقية الثورات أن تنتهي بسرعة، بينما ترك الثورة السورية تتفاقم لتصبح وبالاً على السوريين والمنطقة عموماً؟ لا نعتقد أن الأمر مجرد تقاعس، أو إهمال، أو عدم مبالاة.
هناك الكثير من المؤشرات والدلائل على أن ترك الثورة السورية تتفاعل، وتأتي على الأخضر واليابس داخلياً، وتهز المنطقة برمتها خارجياً ليس أمراً عرضياً، بل يبدو مدروساً ومتعمداً. فلو كان هناك نية دولية حقيقية لانتهى الوضع قبل أن يدخل عامه الأول، لكنهم تركوه يدخل الآن عامه الرابع. لاحظوا مثلاً أن أمريكا ترفض تسليح قوى المعارضة بسلاح مضاد للطيران، لا بل تمنع البلدان الأخرى من تقديم ذلك السلاح للجيش السوري الحر منذ زمن. فلو توفر ذلك السلاح على الأقل لتوازن الصراع على الأرض بين النظام والمعارضة، وبالتالي دفع الجانبين إلى مفاوضات حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سوريا. لكن الواضح أن هناك خطة لإطالة أمد الصراع من خلال تزويد النظام بأعتى أنواع السلاح الروسي والإيراني، وتزويد قوى المعارضة بسلاح يسمح باستمرار القتال فقط، لكنه لا يسمح بحسم الأمور على الأرض، ولا حتى بتحجيم قوة النظام. وهذا لوحده دليل كاف على أن المطلوب في سوريا استمرار الاستنزاف والدمار. لقد غدا واضحاً أن الجيش الحر يدخل منطقة ما، فيحاصره جيش النظام، وتجري المعارك، فتتدمر المنطقة، ويهاجر سكانها، فينتقل الجيش الحر إلى منطقة أخرى، وهلم جرّا. إنه مسلسل تدميري مفضوح يمارسه النظام وقوى المعارضة بنية التدمير المقصود والمبرمج والممنهج.
هل كان للكثير من القوى أن تسمح بإغراق سوريا بمختلف الجماعات المقاتلة القادمة من الخارج وتحويلها إلى أفغانستان أخرى، لو أن العالم كان يريد فعلاً حل القضية السورية؟ بالطبع لا. لقد فاقم دخول جماعات مختلفة إلى سوريا الوضع، وفتحه على احتمالات خطيرة للغاية، خاصة بعد دخول القوى الشيعية كحزب الله وغيره إلى ساحات القتال. هنا بدا وكأنه حرب مذهبية مدروسة. لاحظوا أن القتال يجري الآن بين قوى شيعية وسنية بشكل مفضوح. وهناك من يرى بأن الحرب المذهبية الحقيقية في المنطقة انطلاقاً من سوريا مازالت في بداياتها، وأن القادم أعظم.
لقد انتهى مؤتمر جنيف دون أي ضغط دولي لإحراز أي تقدم. والأنكى من ذلك أن العالم منح الرئيس السوري بعد فشل المؤتمر ضوءاً أخضر لخوض الانتخابات الرئاسية كمرشح أوحد، مما يعني ضمناً إطلاق رصاصة الرحمة على مؤتمر جنيف الذي كان ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية تنتقل بسوريا إلى عهد جديد. أين العهد الجديد بعد أن يفوز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة لسبعة أعوام؟ لاحظوا الآن كيف يتم التحضير لحملة الأسد الانتخابية وسط صمت ومباركة دولية لا تخطئها عين، وكأنها مكافأة دولية للدور الذي يلعبه النظام في خلخلة المنطقة وإعادة تركيبها. لقد تنحى الرئيس الأوكراني بعد مقتل مائة شخص وبضعة أسابيع فقط من المظاهرات، بينما يسمح العالم للرئيس السوري بالترشح والفوز في الانتخابات بعد نزوح ثمانية ملايين سوري داخلياً، وتهجير ستة ملايين خارجياً، وتدمير ثلاثة أرباع البلد، ومقتل مئات الألوف. لا يمكن أن يكون هناك هدف من وراء التعامي عن انتخاب بشار الأسد لفترة رئاسية جديدة سوى استمرار مسلسل التخريب داخل سوريا لتدمير ما لم يُدمر بعد، وإنهاك المنطقة خدمة لمشاريع دولية كبرى. ويرى بعض الساخرين أن الأسد لن يكون فقط رئيساً جديداً لسوريا، بل قائداً مُتوجاً لمشروع الفوضى الخلاقة الأمريكي.
ولو عدنا إلى تصريحات بشار الأسد نفسه بعد ستة أشهر على اندلاع الثورة في لقاء مع صحيفة ‘التايمز′ البريطانية لوجدنا أن ما هدد به الأسد من فوضى وقتها يتحقق الآن على أرض الواقع بحذافيره، وكأنه كان يخطط مع قوى كثيرة لإيصال سوريا والمنطقة كلها إلى هذه النقطة الحرجة والخطرة جداً. قال الأسد وقتها: ‘إن سوريا تقع على فالق زلزالي خطير، وإذا تحرك هذا الفالق، ستخرب المنطقة بأكملها’. لقد كان الرئيس السوري في ذلك التصريح يهدد بتنفيذ مشروع ‘الفوضى الهلاكة’ نيابة عن صاحبه الأمريكي. ويبدو أنه أوفى بوعده تماماً. لاحظوا الآن أن الوضع السوري بدأ يشكل خطراً وجودياً على باقي دول المنطقة، فعدد اللاجئين السوريين في لبنان أصبح أكثر من مليون ونصف، وبات يهدد تركيبة لبنان الديمغرافية. وكذلك في الأردن، ومصر، وتركيا. ناهيك عن أن وضع العراق يزداد سوءاً بالتناغم مع الوضع السوري. وهذا بحد ذاته تهديد مرعب للمنطقة. أضف إلى ذلك أن بعض دول المنطقة بدأت تهتز على وقع الزلزال السوري، وخاصة تركيا. ولا ننسى كيف بدأ الوضع السوري يستنزف خزائن بعض الدول العربية المنخرطة في الصراع.
ألا يرى ضباع العالم هذا الوضع الخطير داخل سوريا وعلى حدودها في الدول المجاورة؟ أم إنها الفوضى الخلاقة التي أرادوها لرسم شرق أوسط جديد، وها هو النظام السوري ينفذها على أكمل وجه؟ يبدو أن هذا هو المطلوب من إطالة عمر الأزمة السورية، فهم يستغلونها، ليس فقط لاصطياد العصفور السوري، بل لضرب عدة عصافير عربية وإقليمية بحجر واحد.
من مهازل هذا الزمان أن النظام السوري هو أكثر من هاجم مشروع ‘الفوضى الخلاقة’ الذي أعلنته وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، وهو الذي يقوده الآن بإخلاص منقطع النظير. وسلم لي على ‘الممانعة والمقاومة’.
‘ كاتب واعلامي سوري
القدس العربي
ثلاث سنوات مستمرة على دمٍ/ غسان المفلح
في هذه الايام تمر السنة الثالثة من عمر الثورة السورية، لايزال النظام الاسدي مصرا على خيار القتل.
– لا أحد في هذا العالم لا يقر بأن هذا النظام قد تأخرت الثورة عليه عقودا، لأنه من أسوأ الانظمة في التاريخ المعاصر، نموذج تم تثبيته بقرار دولي- باركته امريكا والاتحاد السوفييتي ت2 1970 وهذه سابقة لم تحدث من قبل ولم تحدث طيلة عقود الحرب الباردة. حيث جاء نتيجة لنكسة 1967 وذيولها. لهذا إسرائيل كانت ولا تزال المدافع الأول عن هذا النظام، الذي أخرج سورية من معادلة أن تكون دولة طبيعية ومنافسة في عملية سلمية، إسرائيل لاتخاف عسكريا من سورية بالاسد وبغيره. لهذا وضعت العالم أمام خيارين: إما الاسد أو تدمير البلد، لأن البديل معاد لاسرائيل، وهذا بالطبع غير صحيح من زاوية واضحة لا تقبل الجدل، وهي أن الشعب السوري مع السلام. ودليل آخر هو ترحيب إسرائيل بتدخل إيران وحزب الله في قتل الشعب السوري إلى جانب شبيحة وجيش الاسد. لو اعتبرنا أن حزب الله مقاومة ضد إسرائيل، فإسرائيل تتركه يحتل جنوب دمشق لكي يقيم طوق مقاومة حولها، فيصبح على الجبهتين اللبنانية والسورية!!! نكتة. إسرائيل تريد لحزب الله الايراني أن يطوقها!! بناء على هذه المعطيات وغيرها، القوى الدولية الفاعلة تمارس شراكتها في قتل الشعب السوري، كل من مصلحته. لهذا السبب الاسد استمر في قتل الشعب هذه السنوات الثلاث. الشعب السوري لم يستسلم ولن، ليس لأن الموضوع متعلق بميزان القوى المتحرك، بل لأن الشعب السوري لم تعد تربطه اية روابط مع هذا الاجرام الايراني الاسدي الروسي.
– القوى الدولية التي تركت الشعب السوري يذبح، تحتاج لمعارضة تتساوق معها ونخب سياسية وثقافية سورية تتساوق معها ايضا، وترفض التدخل الدولي لحماية المدنيين من جهة، ونخب خفيفة سياسيا وبعضها أكثر خفة أخلاقيا من جهة اخرى. حتى لو كانت هذه النخب غير موجودة في صفوف المعارضة لكانت خلقتها!!! انظروا الآن من يتحكم بالمعارضة؟ لهذا نقد المعارضة لا يعني أن هذه المعارضة قادرة على تجاوز هذا الشرط الدولي الحقير، بل من أجل التخفيف من حدة حضوره ومشاركته في هذه الجريمة، بالطبع من ينظر لهذه النخب وكيفية ادارتها للعلاقة مع روسيا كمثال يعرف تماما زيفها.
– استطاعت الطبقة التجارية الدمشقية والحلبية تحت اشراف امني من الطغمة الاسدية أن تشتري وتبيع ببعض قوى الثورة، منضمة للمسيحية السياسية واللبنانية منها بشكل خاص المتحالفة مع حزب الله. لدرجة أنها اقامت مؤتمرات معارضة وتحالفات، اتت باسماء بعضها يعلن ارتزاقه!! وهذه الاسماء استطاعت جر الاكثرية معها، لنقارن بين ميشيل كيلو واحمد الجربا أو بين جورج صبرا ومصطفى الصباغ..
– التناقض السعودي القطري كان له مساحة كبيرة في شرذمة قوى الثورة بغطاء أمريكي قاده روبرت فورد السفير الامريكي السابق.
– تلغيم الثورة أمريكيا وبعض خليجيا وإيرانيا وروسيا وعراقيا واسديا بالطبع بالملثمين العراقيين والاجانب حاملي الرايات السوداء. اصبح لدينا ظاهرة الافغان العرب في الثورة السورية. وهذا ما أدى إلى شق التمثيل العسكري للجيش الحر الذي كان يحقق انتصاراته سوريا، وتحت العلم السوري للثورة.
– الاخوان المسلمون كانت حصيلتهم سلبية. والاسلاميون الجدد أكثر سلبية.
– شارك بالتظاهرات السلمية التي انطلقت في سورية، أكثر من نصف سكانها مطالبة بالحرية وأن الشعب السوري واحد. لاأظن أن هنالك ثورة بالتاريخ على نظام مجرم شارك فيها أكثر من 10% من سكان أية دولة حديثة أو معاصرة. ما يؤكد ذلك لو نظرنا إلى اعداد المفقودين والشهداء واللاجئيين في دول الجوار والعالم والنازحين من بيوتهم داخل سورية لوجدنا النسبة تتجاوز ال40% من سكان سورية، حيث أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ان “الوضع خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بداية الأزمة في سوريا تطور إلى كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة. فهناك أكثر من 9 ملايين من السوريين في حاجة إلى مساعدة عاجلة، بما في ذلك 6.5 ملايين نازح داخل بلادهم، نصفهم من الأطفال، يكافحون من أجل البقاء وسط القتال. وفر 2.4 مليون شخص آخرين من سوريا منذ كانون الثاني 2012، حيث لجأوا إلى لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.
– هيئة التنسيق استطاع حسن عبد العظيم المتواطئ تاريخيا مع النظام أن يجير كثير من الاسماء المناضلة لمصلحة خط سياسي، كتبه هيثم مناع إيرانيا.
– النخب الثقافية ليست ثقافية، لأنها نخب عموما تتسم بالفجور..هذه ثقافة السلطة منذ عام 1970. نخب الكذب ديدنها. احتقار الآخر نوع من التبادلية التفاعلية بينها وبين السلطة ومفرزاتها. نخب تدعي العلمانية وهي طائفية بالعمق والسطح، نخب تدعي الديمقراطية وكل واحد فيهم لا يتحمل رأيا صغيرا مختلفا…
المجتمع السوري انكشف بشكل كامل، وانكشفت معه ما تركه هذا النظام فيه. ولا تزال بعض النخب تبحث عن تأسيسات ثقافوية، لا علاقة لها بجوهر الصراع بل بالعكس إنما، تزيده ارباكا. لاأظن أن سوريا واحدا ضد قيام دولة ديمقراطية، حتى الذين منهم الآن يزايدون اسلامويا. أظن أن مهمة النخب في هذه اللحظة الدموية العمل من أجل الحصول على ما يدعم الثورة في ميزان القوى القائم على الارض. التركيز على النشاط السياسي بشكل أساسي. لأننا مهما تحدثنا ثقافة، ومهما اسسنا من منتديات وجمعيات خارج مدى التأثير بالحقل السياسي بما هو حقل ميوازين قوى، تبقى محاولاتنا تذروها رياح المعلوماتية والتلفزيون.
– السؤال الذي يراود الكثيرون: ما الذي ابقى النظام الاسدي ثلاث سنوات، يقتل شعبنا ويدمر البلد؟ ثلاث اسباب جوهرية والباقي تفاصيل: الأول- المركب الاسرائيلي بما يعنيه غربيا. الثاني- طائفية السلطة وطبقيتها الفاسدة. الثالث- المركب الغربي الشرق اوسطي الفاسد أساسا من ضمنه إيران طبعا. أما روسيا فهي ليست أكثر من مافيا سلاح. الاسباب الأخرى ثانوية من مثل ضعف المعارضة، لأن هذا المركب الثلاثي لو لم يجد ضالته في المعارضة القائمة لاخترع غيرها وهذا ما حدث نسبيا. نعم باختصار الشعب السوري واجه كل هذه القوى متفرقة احيانا ومجتمعة أكثر أحيانا..لهذا سيستمر الدم في سورية، ما لم يتغير هذا الثلاثي اللا أخلاقي… وهذه مهمتنا كمعارضة بالدرجة الأولى وعلينا واجب العمل بهذا الاتجاه أكثر من أي عمل آخر..لأن امكانية اختراق هذا الثلاثي بالمصالح دوما قائمة..لا ازرع اليأس ولا ادعو للتفاؤل، ولا استثني نفسي من هذا النقد أعلاه، لكن الثورة هذه ليست معركة عسكرية كما يتوهم الاسد، بل هي مسار لن يتوقف بحكم طبيعة الامور وما انفتحت عليه هذه الثورة…ثلاث سنوات منذ 18 آذار في حوران شعبنا وحيدا يدفع الثمن..
ايلاف
عام اخر يا سوريا… من يجرؤ على التفاؤل؟
رأي القدس
في مثل هذا اليوم قبل ثلاثة اعوام القى طفل من مدينة درعا حجرا في بحيرة آسنة، قوض جدار الصمت العتيق، وخط على الرمل طريقا الى حرية طال غيابها، وجعلها تبدو ممكنة.
في مثل هذا اليوم التحقت سوريا بركب الربيع العربي، مع تفتح الزهور في ربوعها الخضراء، املا في نهاية شتاء استمر لعقود تجمد فيها الامل في سوريا جديدة تنتمي الى عصر جديد.
لكن النظام الذي لا يجيد الا لغة واحدة، وسياسة واحدة، وتحكمه اسرة واحدة، باجندة فيها بند واحد: البقاء في السلطة الى الابد، وبأي ثمن، ابى الا ان يفرض لون الدم على هذه الصورة المفعمة بالنبل.
ولا يتسع المجال هنا لسرد وقائع دراما هذه الثورة التي باتت رسميا حربا اهلية، بعد ان تداعى كثيرون على قصعتها، من داخل سوريا وخارجها، ففضوا براءتها، وسرقوها من اصحابها الشرعيين، لترتفع رايات سوداء، وشعارات ايديولوجية جوفاء كاذبة لا علاقة لها بدين او وطن، او ليتخذها البعض بضاعة يتاجرون فيها، فيحصدون من ورائها الملايين، فيما تؤكد الامم المتحدة ان تسعة ملايين سوري يعانون من الجوع، بعد ان تعرض نحو اربعين بالمئة من ابناء هذا الشعب الكريم الى التشرد. بينما تشير الاحصائيات الى ان عدد القتلى يحوم حول مئة وخمسين الفا، ناهيك عن العدد الهائل من المصابين وضحايا الانتهاكات بكافة اشكالها.
ومن المفارقة التي تدعو للبكاء اكثر من الدهشة، ان تحل الذكرى الثالثة للثورة السورية، فيما يواصل النظام السوري عرض المسرحية القديمة نفسها: (استفتاء على تمديد رئاسة بشار الاسد)، بينما يقر نظامه بخروج بعض المناطق عن سيطرته، فيما تتواصل ‘حفلة القتل المجاني’ بين فصائل وميلشيات وجيوش ومسلحين من كل صنف ولون في العديد من المحافظات.
وكأن هذا الاستنساخ للتراجيديا اليونانية او الجرائم النازية يجري في بلد اخر، لم ‘يستح’ اعلام النظام من عرض صور قبل يومين قال انها لمواطنين يعلنون تأييدهم لبشار في اجواء احتفالية، بعد ان قام بزيارة يفترض انها ‘انتخابية’ الى احد المراكز الاجتماعية في دمشق.
اما الجوهر الحقيقي للمأساة السورية فهو ان احدا لم يعد يجرؤ على التفاؤل، بعد ان بشرنا بعض المتاجرين بهذه المأساة بأن النظام ‘يوشك على السقوط، بل انه سيسقط حتما قبل حلول الصيف، لكن دون ان يحدد في اي عام’.
فالمعارضة، التي كانت محقة، اعتبرت بشار مجرم حرب، عادت فقبلت ان تجلس معه في جنيف، لتخسر مصداقيتها، او ما كان بقي منها، ويعود وفده باعتراف دولي ضمنيا بشرعيته، سمح له بالمضي قدما في هذا الاستفتاء الدموي على رئاسته.
اما الولايات المتحدة فتتصدر قائمة الضحايا السياسيين، اذ فضح الصراع السوري فقدانها للنفوذ التقليدي في الشرق الاوسط، بعد ان راهنت على انها يمكن ان تصل الى ‘اهداف مشتركة’ مع روسيا، تقوم على التضحية بالنظام والحفاظ على مصالحها. الا ان مؤتمر جنيف كشف مدى حمق هذه الاستراتيجية، وسذاجة الرئيس الامريكي الذي بنى عليها سياسته.
اما الامم المتحدة ومبعوثها الاخضر الابراهيمي، فاكتفى بالاعتذار للشعب السوري عن فشله، وكأن الآلاف من الذين قتلوا بسبب فشله ذلك ليسوا بشرا. واصبح واضحا انه يكتفي بتحقيق نجاحه الشخصي في الاحتفاظ بمنصبه. بينما لا تملك المنظمة الدولية الا تجديد الدعوة للمفاوضات، ولو من اجل المفاوضات فقط، او ذرا للرماد في عيون عالم لم يعد يبالي كثيرا بارقام الضحايا اصلا.
وبينما تواصل روسيا وحلفاؤها سياسة واضحة، ولا تبدو مضطرة لمراجعتها بعد ان اتت بثمارها تثبيتا للنظام، واستعادة لنفوذ اقليمي، يبدو ان اي حل سواء سياسيا او عسكريا في سوريا بات مؤجلا الى اشعار اخر.
عام اخر يا سوريا بين فكي ديكتاتورية دموية وارهاب اسود بحضور عربي هو اقرب للغياب، مع كثير من الاسف بل والبكاء ايضا.
القدس العربي
ثلاثة أعوام على التسعين “لايك”/ روجيه عوطة
لم يحصل البوست الأول في صفحة “الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011” على أكثر من تسعين “لايك”. كانت رسالته الموجهة إلى الديكتاتور البعثي، واضحة: “منحبك ترحل…ترقب”، فسوريا ما عادت خاضعة له، والدليل على ذلك أن التظاهرات بدأت تندلع في مناطقها. “أنباء عن تظاهرات في درعا….في دمشق…في حمص…في حماة…الرقة إلخ.”، تظاهرات تتنقل من مدينة إلى أخرى، من شارع إلى آخر. والسوريون ينتفضون في الإفتراض، لا سيما في “فايسبوك”، الذي بات، بالنسبة إليهم، “سوريا الإلكترونية”، حسبما جاء في تعليق أحد المستخدمين على “ستاتوس” آخر، كان قد نُشر على الصفحة، وكُتب فيه: “من يصدق أن الشبكة العنكبوتية تسقط الحكومات القمعية، وتكشف كيف يتحول الزعماء إلى عملاء و بلطجية؟”
فعلاً، من كان يصدّق بأن سوريا ستتحرك في وجه الإستبداد، وأن الأسد سيبدأ بالسقوط؟ لقد كان كل ذلك ضرباً من الجنون، وهو، لأنه على هذه الحال، كان عبارة عن ثورة خالصة، أو لنقل، انه الثورة!
“إعمل لايك و شير في كل مكان للصفحة، على الأقل ضع الصفحة على بروفايلك، لا تخف، لعلك تكون السبب في إسقاط المجرم. كن مقداماً”، بهذه العبارات توجهت الصفحة إلى مشتركيها، راغبة ًفي الوصول إلى أكبر عدد من السوريين، بغاية تحفيزهم على المشاركة في التحركات: “ستكون أعظم ثورة عربية بل وبشريّة على الإطلاق! بسقوط النظام الحالي سينتهي أعتى حكم ديكتاتوري في الكرة الأرضية”، فعلى إثر الثورات في مصر، وتونس، ومن ثم ليبيا، “إجاك الدور يا دكتور”، بحسب الشعار التظاهراتي المشهور.
“يرجى منكم أيها الاخوة، أن ترسلوا مقاطع فيديو أو صور، لننشرها على صفحتنا”، إذ انطلق توثيق الأحداث، تظاهرة بعد أخرى، أو بالأحرى من يوم جمعة إلى آخر. فغداً “جمعة الغضب”، والسوريون يريديون “تغيير سلوك النظام في السماح بحرية التعبير، والتعددية والمشاركة في الحياة السياسية ، فهي ليست حكراً على حزب البعث، كما نريد استقلال ونزاهة القضاء، والإفراج عن السجناء السياسيين”، لكن، النظام قطع الإنترنت في أكثر من محافظة، وعلى الرغم من ذلك، “ستعم المسيرات والتظاهرات السلمية كافة المناطق، وسنوافيكم بالصور فور وصولها”.
وصلت الفيديوهات والصور، حمّلها المتظاهرون في “يوتيوب”، أو بروفايلاتهم الخاصة، فاستعانت الصفحة الفايسبوكية بها، كي تنشرها، وتدفع المشتركين إلى الوقوف على الوقائع الجديدة. “سيدي الرئيس، نحملك كامل المسؤولية عن أي قطرة دم ستنزف غداً. ونأكد لك للمرة المليون بأن التظاهرات ستكون سلمية، وستنادي بإسقاطك أنت ونظامك النازي!”. من هنا، بدأت المواجهة، وأشعل النظام حربه ضد السوريين، الذين لم يتوقفوا منذ المظاهرة الأولى عن الموت قتلاً أو الإختفاء اعتقالاً. فهم في صدد تحطيم سلطات الطغيان، ويدركون أن المعركة ليست سهلة على الإطلاق، إذ سيضطرون في المقبل من أيامهم لنقد صفحة الثورة الأولى، خصوصاً بعدما بدت كأنها تحتكر الإفتراض الثوري، وتطلق الأسماء على تظاهرات الجمعة، بطريقة غير ديموقراطية، وبأسلوب ينزع نحو الأسلَمة.
ذاك، أن العلاقة بين السوريين والصفحة لم تستقر على حال واحدة، بل تغيرت مع مرور الوقت، بحسب الدور الذي أدته “الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011″، ففي البداية، كانت المصدر المعلوماتي الأساس، ومن ثم، ظهرت صفحات ثورية إخبارية أخرى إلى جانبها، كما أن الإختلاف الإيديولوجي بين المواطنين، انعكس على نسبة متابعتها، نتيجة طابعها الإسلاموي، على ما وُجّه إليها من انتقادات.
في كل الأحوال، وبعد مرور سنوات ثلاث على اندلاع الثورة السورية، تصح الإشارة إلى أن تلك الصفحة كانت رائدة في مجال الإعلام البديل عن التلفزيون والإذاعة الرسميين، بالإضافة إلى كونها المساحة الأولى، التي تمرن فيها السوريون على بث الأخبار، وعلى التفاعل معها أيضاً. لقد كانت تلك الصفحة بمثابة التوطئة الإفتراضية للثورة، توطئة واسعة، ثبتت على عامها الأول، أي الـ”2011″، لتعذر تغييره فايسبوكياً ربما، لكنه، مع ذلك، يبدو كأنه الرمز الزمني للإندلاع السوري، فالثورة بدأت في هذا العام، وهي، بالطبع، لن تتوقف بعده، كأن كل يوم منها هو 15 آذار، وكل لحظة من لحظاتها أيضاً.
“اليوم، جمعة ثورة شعبية…وليست حرباً أهلية، فساحات العاصي وبانياس والباب وتلبيسة ودرعا وقامشلي وسقبا وغيرها من المناطق تشهد على شعبية ثورتنا…”، انتهى البوست، مئات اللايكات، والثورة تستمر.
المدن
أسئلة الثورة السورية بعد 3 سنوات/ ياسر الزعاترة
دفع السوريون الثمن الأكبر في موجة الربيع العربي، ويبدو أن مسلسل معاناتهم وتضحياتهم لم يختتم بعد، فالموت لا زال يحصد منهم كل يوم؛ بالبراميل المتفجرة والصواريخ والقنابل، فيما تمعن آلة التدمير تخريبا فيما تبقى من بلدهم.
بعد 3 سنوات من الثورة، ما زال النظام جاثما على صدر سوريا والسوريين، فيما بات أكثر من ثلث الشعب رهن التهجير، وأكثر من 150 ألفا في عداد الموتى، وأضعاف العدد من الجرحى، فضلا عن عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف بالغة البشاعة.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بهذه المناسبة، هو ذلك المتعلق بالسبب الكامن وراء بقاء النظام إلى الآن، وربما تراجع آفاق الحسم القريب، أعني الحسم لصالح الثورة، فيما لا يبدو الموقف أفضل بالنسبة للنظام الذي تغيب سيطرته عن نصف التراب السوري.
لعل أحقر ما يمكن أن تسمعه في سياق تفسير هذا الوضع، أعني بقاء النظام بعد 3 سنوات من الثورة عليه، هو القول، إن ذلك يؤكد ما يحظى به من شعبية في أوساط الناس.
والحق إننا إزاء إجابة تافهة لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة، ليس لأننا إزاء نظام فاسد ومستبد لا يماري في فساده واستبداده أي عاقل، بل أيضا لأنه يأتي في زمن انفجار الهويات الإثنية والطائفية، واستحالة أن تكون الغالبية في سوريا مع النظام، حتى لو لم يشارك بعضها في الثورة ضده.
ليس ثمة شعب يثور بالكامل ضد نظام، وفي جميع التجارب كانت هناك طلائع تقود الثورة وتشارك فيها، بينما توفر الأخرى حاضنة شعبية، ولم يحدث أن نزل الشعب كله ولا حتى ثلثه إلى الشارع، لأن من لديهم القابلية للتضحية في هكذا مناسبات هم القلة، بينما يشارك الآخرون بالدعم والإسناد.
على أن الميزة التي تحلى بها نظام بشار، إنما تتمثل في وجود أقلية ربطت مصيرها بمصيره، وهي ليس أقلية شعبية عادية، بل أقلية مسلحة؛ لأنها هي عماد المؤسستين الأمنية والعسكرية، وما تبقى منها غير مسلح، ما لبث أن حمل السلاح، وجرى تدريبه بيد مليشيات الحرس الثوري الإيراني. أما الجانب الآخر، فيتمثل في أقليات أخرى ساندته أيضا، وإن بشكل أقل وضوحا من طائفة (الرئيس) في نظام رئاسي مطلق. والنتيجة هي تأمين حوالي ربع السكان لصالحه، إلى جانب تأمين المؤسسة العسكرية والأمنية، أو جزء كبير وأساس فيها.
لم يكن ذلك هو وحده ما منح النظام رصيد القوة، بدليل أن وضعه بدأ يترنح نهاية 2012، ومطلع 2013، وما أسنده عمليا على الأرض هو تدخل قوات حزب الله وكتائب عراقية، وكل ذلك بإشراف الحرس الثوري. هذا في الشق العسكري، أما الذي لا يقل أهمية، فيتمثل في الجانب الاقتصادي، ذلك أن إيران هي التي دفعت وتدفع عمليا كلفة الحرب، ولولاها لانهار النظام اقتصاديا قبل أن ينهار عسكريا. وبوسعنا هنا أن نضيف الدعم العسكري والسياسي القوي من طرف روسيا والصين، والنتيجة أن جبهة النظام كانت قوية ومتماسكة في شقها العسكري والسياسي والاقتصادي.
في المقابل كانت جبهة الثوار تعاني من بؤس لا مثيل له. ونحن هنا نتحدث عن الجانب العسكري. ولو كانت هناك إرادة لإنجاح الثورة لنجحت قبل تحولها إلى مسلحة، لكن الشرذمة التي تعانيها هي التي حالت دون تطوير النضال السلمي إلى عصيان مدني يسقط النظام، وهو ما أفضى إلى تحولها إلى ثورة مسلحة.
بعد السلاح دخلت التناقضات من كل شكل ولون على الثوار، وكان واضحا منذ البداية أن الرؤية الصهيونية للمعركة هي التي حكمت المواقف الغربية، أي إطالة أمد المعركة حتى تدمير البلد، واستنزاف الجميع (إيران، تركيا، حزب الله، وربيع العرب)، وقد قلنا ذلك منذ الشهور الأولى لانطلاق الثورة المسلحة. بل إن بعض الداعمين للثورة في الظاهر قد ارتاحوا للعبة الاستنزاف، أولا ضد إيران، وثانيا لأنهم ضد ربيع العرب والثورات، ولا يريدون لأي منها أن تنجح.
الموقف الصهيوني كان يتمثل في منع السلاح النوعي عن الثوار عبر ضغوط أمريكية مشددة على القوى الداعمة للثورة، ولذلك بقي النظام متفوقا في القتل والتدمير، ومع ذلك تقدم الثوار ببسالة واضحة، وتمكنوا من السيطرة على مناطق واسعة، لكن ذلك لم يمنحهم فرصة الحسم.
تناقضات الثوار أنفسهم، وتناقضات الداعمين، والموقف الأمريكي والغربي الرافض لمنحهم السلاح النوعي، كل ذلك أدى إلى ضعف جبهتهم مقابل تماسك جبهة النظام.
تلك هي الحقيقة التي أفضت إلى استمرار المعركة؛ ما يعني أن المؤامرة كانت ضد الثورة وليست ضد النظام، ورأينا بأم أعيننا كيف انتهت لعبة الحشد لضرب النظام نهاية العام الماضي إلى الاكتفاء بتسليمه السلاح الكيماوي، ولو كانت هناك نية لإسقاطه لما كلف ذلك الكثير؛ لأن كلفة الضربات كانت مدفوعة أصلا.
بعد 3 سنوات على هذه الثورة الباسلة، وكل هذه التضحيات، فإن ما ينبغي قوله هو، ان الوضع لن يعود إلى ما كان عليه بأي حال، فمن دون تسوية ترضي الشعب السوري، ستتواصل المعركة، وسيستمر النزيف، لكن النهاية في كل الأحوال لن تكون كما يعتقد المجرمون الذين ساندوا هذا النظام الفاشي وشاركوه -تبعا لذلك- جريمته بحق شعبه.
الدستور
سورية: الحرب الأهلية مرحلة في تاريخ الثورة/ خالد الدخيل
اكتملت أمس ثلاثة أعوام على انطلاق الثورة السورية. مرت هذه الثورة بتحولات ومنعرجات ونجاحات وانكسارات عدة، وفي كل ذلك كان الشعب السوري هو الذي يدفع أثماناً، ويتحمل آلام ما يحصل. تبلورت على مدى هذه الأعوام الثلاثة صورة الشعب في مقابل النظام. ليس في هذا شيء جديد إلا أمر واحد، وهو أن هذا التقابل لم يتعمد من قبل بمثل هذا الكم الهائل من الدماء والآلام والدمار.
أراد النظام بدمويته المعروفة أن يضع الشعب أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الدم، أو الخضوع لإرادته. كيف يمكن أن تكون النتيجة النهائية لمعركة يتقابل فيها الشعب مع النظام على هذا النحو؟ سيقول بعضهم إن التنظيمات الإرهابية المنخرطة لا تمثل الشعب. وهذا صحيح، لكن النظام هو الذي أدخل هذه التنظيمات في المعركة ابتداء. كان بإمكانه أن يختار طريق الحوار والاحتواء، لكن تاريخه وطبيعته وتحالفاته الطائفية لم تسمح له بذلك، لا من قبل ولا من بعد. قيل أيضاً إن الثورة أخطأت عندما انجرت إلى معركة كان يريدها النظام. وهذا ليس صحيحاً، وليس دقيقاً.
يشبه النظام السوري بتركيبته وأهدافه النظام الإسرائيلي. تغتصب أقلية طائفية الحكم وسط غالبية ساحقة، فتتحصن داخل عقلية «الماسادا»، وهي عقلية لا تعرف ولا تعترف بشيء اسمه الحق أو الشرعية أو الحوار. لا تعرف ولا تطمئن إلا لتصفية المعارض، أو الانتحار إذا فشلت في ذلك. تاريخ النظام السوري تاريخ حلول أمنية منذ يومه الأول عام 1963، مروراً بانقلاب 1970، حتى بداية الثورة. من يتحدث عن مسألة خيار بين حل أمني وغيره يتحدث عن شيء وتاريخ لا وجود لهما.
نعم، حقق النظام نجاحات عدة لا يمكن تجاهلها. نجح في تحويل الثورة إلى حرب أهلية مدمرة، فجّر صراعات طائفية لم تعرفها سورية من قبل، استدعى المقاتلين من كل حدب وصوب للمشاركة في الحرب من منطلقات طائفية، استدعى «داعش» و «جبهة النصرة» ومثيلاتهما أولاً من قوائم معتقلاته المترامية في أنحاء سورية، وثانياً باستعانته من منطلق عصبية طائفية بمقاتلي ميليشيات «حزب الله» اللبناني و «كتائب أبو الفضل العباس»، و «عصائب أهل الحق» من العراق. ومن المنطلق ذاته استعان بضباط «الحرس الثوري» الإيراني ومقاتليه، وقبل ذلك -منذ اليوم الأول للثورة- كان أطلق يد «ميليشيا الشبيحة» في الاعتداء والقتل والمداهمة والاختطاف في كل أنحاء سورية المتمردة. كشفت سرعة انطلاق هذه الميليشيات وانتشارها عن إعدادها وتجهيز كوادرها قبل الثورة بأعوام لمواجهة مثل هذا الطارئ، ولتكون خط الدفاع الأول عن النظام. تنتمي الغالبية الساحقة من الشبيحة إلى طائفة الرئيس وأقاربه في قيادة النظام.
من نجاحات نظام الأسد أيضاً، أنه مستمر في تدمير سورية: دمر المدن والقرى والأرياف والأحياء بقصف لا يتوقف، وبكل أنواع الأسلحة. قتل ما يقرب من 200 ألف مواطن، وهجّر أكثر من 9 ملايين سوري داخل سورية، وأكثر من مليونين ونصف المليون خارج سورية -وفق إحصاءات الأمم المتحدة كما نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس-، وقتل أكثر من 10 آلاف طفل سوري. ووفقاً للإحصاءات نفسها، فكل دقيقة يتحول ثلاثة سوريين إلى لاجئين في الخارج، وكل دقيقتين يضطر ثمانية أطفال سوريين إلى مغادرة منازلهم، ولذلك، ارتفع عدد الأطفال المشردين من 920 ألفاً إلى ما يقرب من 3 ملايين مشرد. ووفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، سقط أكثر من 146 ألف قتيل، وهذا رقم متحفظ، لأنه لا يتضمن من قُتلوا تحت التعذيب في معتقلات النظام، ومن ماتوا مشردين في مناطق نائية، ومن اختفوا ولا أحد يعرف عنهم شيئاً. والأرجح أن صورة الدمار في سورية أكبر وأبشع مما تبدو بكثير، وهذه حصيلة طبيعية أخذاً بالاعتبار دموية النظام وهمجيته.
استخدم كل أنواع الأسلحة، بما فيها البراميل المتفجرة والكيماوي، ولم يتوانَ لحظة واحدة عن استخدام سلاح آخر لا يقل فتكاً ضد المواطنين، سلاح الحصار والتجويع، وقطع كل أنواع الخدمات عن الأحياء والمناطق المتمردة. وضع النظام المواطن أمام خيارين: أن ينحاز إليه ويناهض التمرد، أو أن يواجه كل احتمالات القتل، الموت جوعاً أو من المرض أو تحت القصف.
من أسلحة النظام أيضاً الخطف والاعتقال والتعذيب والإعدام والتصفيات الجماعية، وكان آخر ما كشف عن ذلك -بالصور (55 ألف صورة)- وفاة 11 ألف مواطن تحت التعذيب في المعتقلات، وهذا ما كشف عنه انشقاق من كان يتولى تصوير جثث القتلى في المعتقلات، وهرّب معه نسخاً إلكترونية لآلاف صور الجثث، وحظي هذا الموضوع بتغطية واسعة في الإعلام العربي والدولي.
ومن نجاحات النظام البارزة، أنه حوّل ما كان يُعرف بـ«الجيش العربي السوري» إلى أكبر وأقوى ميليشيا في حرب أهلية تدور رحاها منذ ثلاثة أعوام. كان لهذا الجيش تاريخ وطني باذخ أمام الاستعمار وأمام العدو الإسرائيلي، ثم عبث نظام البعث تحت حكم الأسد بتاريخ هذا الجيش وبتركيبته وعقيدته الوطنية، ما انتهى به إلى الانحراف عن دوره الأصلي. بات دوره يقتصر على حماية عائلة تمسك بالحكم تحت غطاء الطائفية، وتتحالف مع إيران في سياق طائفي يمتد من طهران مروراً بالعراق لينتهي في الضاحية الجنوبية من بيروت. لم يعد لهذا الجيش نصيب من الاسم الذي كان يعرف به. عندما يلغ الجيش في دم الشعب على النحو الذي يحدث في سورية الآن، يفقد هذا الجيش دوره الوطني ويخسر هويته الوطنية. ما يسمى بـ«الجيش العربي السوري» يقتل الشعب السوري، لأجل أن يبقى الأسد في الحكم، وهذا دور لا تضطلع به إلا ميليشيا تتدثر باسم «الجيش العربي السوري».
قيل للسوريين على مدى أكثر من 40 عاماً إن هذا «الجيش» ينتظر لحظة مواجهة مقبلة مع العدو على الحدود الغربية لتحرير الجولان. كان يقال إن النظام السوري في الأصل نظام مقاومة، لكن ما يقال شيء، وما يحصل على الأرض شيء آخر.
قتل «الجيش العربي السوري» في ثلاثة أعوام من السوريين فقط أضعاف ما قتل «جيش الدفاع الإسرائيلي» من العرب على مدى أكثر من 60 عاماً. كان الكلام يباع للسوريين وللشعوب العربية. من سوء حظ الأسد أن الغالبية لم تكن تأخذ كلامه على محمل الجد، وجاء الزمن ليبرهن صحة رؤية هذه الغالبية. قبل الأسد بعقود قال من هم أكثر منه صدقية ووطنية الكلام نفسه، ورددوه كثيراً، لكنه لم يؤدِّ إلى شيء. على الأرض كانت «مقاومة» النظام السوري متروكة لمقاتلي «حزب الله» على الحدود الجنوبية اللبنانية، وداخل سورية يعتمد النظام على الطائفة وأجهزته الأمنية، وعلى تحالف مغلق مع إيران لقمع الشعب السوري. لم تكن في الأمر مقاومة، وإنما لعبة سياسية دموية، كان ولا يزال هذا الشعب يدفع ثمنها من دمه، ومن مستقبله، ومن تاريخه.
هل ما نجح فيه النظام حتى الآن يمثل علامة انتصار؟ في مثل هذا الصراع الملحمي هناك فاصل كبير من الوهم بين الانتصار والانتحار. وعلى رغم تخاذل إدارة أوباما الأميركية، والدور العدواني لروسيا وإيران، وتخاذل العرب وفشلهم في إنقاذ الشعب السوري من نظامه، فإن هذا الصراع مرشح لما هو أكثر من ثلاثة أعوام بكثير، وستكون على الجميع المشاركة في دفع أثمانه بأكثر مما يتصور بعضهم. لم يحدث في التاريخ أن انتصر الإرهاب على الشعب. ولن تكون سورية استثناء في ذلك.
* أكاديمي وكاتب سعودي
الحياة
سوريا الجرح المفتوح: 3 سنوات على «خراب الدورة الدموية»
بين قذيفة وأخرى… «ورشة الأمل» مستمرة
ثلاث سنوات مرت على الـ 15 من آذار (مارس) 2011. الانتفاضة المجهضة سرعان ما تحوّلت إلى شلال دم هادر، جارفاً الآلاف من الشهداء والجرحى حتى باتت شهرزاد الجديدة عاجزة عن رواية كل حكايات الجحيم السوري. كيف كان هذا الجرح في مرآة الثقافة والإبداع والفنون؟ وهل استطاعت الأعمال الذي توالدت وتناسلت من الأزمة أن تعبّر عن هول الكارثة؟
خليل صويلح
دمشق | لم تتمزّق خريطة المثقفين السوريين، كما هي حالها اليوم. قبل الحراك بقليل، لن يخطر في بال أحد أن يهجر وليد إخلاصي شوارع حلب ليستقر في الصومال ويتأمل سفن القراصنة بدلاً من حجارة القلعة، أو أن يلجأ فراس السوّاح إلى الصين ليكمل ترجمة «كتاب التاو» في بلاد بوذا، وأن يغادر نزيه أبو عفش عزلته الدمشقية إلى لبنان، ويعبر صالح علماني وعاصم الباشا البحر المتوسط إلى الأندلس. قائمة طويلة لا تنتهي من المهاجرين، بأسماء لامعة، وأخرى ركبت الموجة بمجدافي الشعار والهتاف.
لعلّنا نحتاج إلى عصا خبراء الخرائط كي نحصي الأماكن التي شهدت هجرات عشرات المثقفين السوريين إلى مختلف أصقاع العالم. منفيون أم مهاجرون أم هاربون من الجحيم؟ لا إجابة حاسمة في بلاد تتبادل الخنادق والمتاريس والسهام المسمومة. يصعب استيعاب تحوّلات المشهد، كأن ينافح العلماني عن طائفته، ويدافع القومي عن عشيرته، ويُساجل المفكر ما بعد الحداثي في خصوصية مذهبه. كل ذلك حدث خلال الألف يوم الماضية. شهرزاد الجديدة ليس بوسعها أن تروي كل حكايات الجحيم السوري، إذ وجدت نفسها حيال أضخم وليمة للافتراس الجماعي. هاملت الأمس يصعد سلالم مسرح القباني مغادراً خشبة المسرح إلى إيثاكا متخيّلة بقارب مثقوب وأوهام شكسبيرية، من دون أن يجيب عن سؤال: «كيف تصنع ثورة هناك، بعدما هربت من نارها
هنا؟».
سؤال سوف يبقى معلّقاً في فضاء الاتهامات المتبادلة، والاصطفافات الحادة، ذلك أنّ ثقافة التخوين هي العملة الوطنية الوحيدة التي يتداولها الجميع في بورصة البلد المنهوب. في هذا المقام، علينا أن ننبش أحشاء مواقع الانترنت لمعرفة حجم معارك كسر العظم بين محاربين افتراضيين، معظمهم من وزن الريشة في حلبة الملاكمة، فيما عدّاد الموتى كان يعمل في مكانٍ آخر بطاقته القصوى. كما أننا لن نلتفت بجديّة إلى ورشات العاطلين من العمل والمخيّلة الذين وجدوا ضالتهم في مقاولات صغيرة، على هيئة مواقع الكترونية، وجرائد مناطقية، ومنظمات حقوقية وهمية، وأشرطة سينمائية مصنوعة على عجل، ومراكز بحوث غامضة، وألقاب تسبق أسماءهم على الشاشات، كأن يتحوّل الروائي إلى خبير عسكري، والشاعر المغمور إلى مفكّر، والهارب من الجندية ما قبل الحرب إلى موزّع صكوك غفران وشهادات حسن سلوك.
المسألة أكثر تعقيداً، مما يظنه بعضهم، في بلاد فقدت هيبتها، وأضاعت أختام حضارتها القديمة. وإذا بها تقف في عراء الهمجية، تتناهبها ضباع المهاجرين، ويلتهم ما تبقى منها ثعالب الأنصار بقاموس هجاء ضخم يطال كل الأعناق.
بلاد عارية تجللها عباءة ثقافة الضغينة والثأر وتصفية الحسابات الشخصية، في أكبر عملية إعادة تموضع، وفقاً لأحوال الطقس وجهة مستلم البريد وحجم الجعالة. ينتصر المثقف العلماني للعمامة تارةً، وللخوذة طوراً، تبعاً لمصلحته الطارئة، غير عابئ بما يحتضر حوله وبسببه. هكذا تصدّر المشهد المثقف الطارئ، ممن أغراه الحساء الساخن للثورة، وعسل الذات المتضخّمة، متكئاً على أمجاده في الفايسبوك فقط، فهو يجلب مئات اللايكات بدقائق، مقابل عبارة نارية في هجاء الاستبداد عن بعد، فيما لن يتمكّن مثقف معروف من تحصيل ربع محصول الأول، من قمح الشجاعة وطواحين الهواء. اخترع بعض المثقفين السوريين خلال ثلاث سنوات من الحرب، بلطة حادة لقطع الأشجار العالية بدقائق، استجابة لثقافة الأرض المحروقة، تحت شعار اجتثاث ثقافة الأمس بكل رموزها وأيقوناتها. حتى أنّ أحدهم كتب اعترافاً صريحاً بأنه ندم لزيارة ضريح سعد الله ونوس قبل سنوات، ومن كان يعتز بالتقاطه صورة مع أدونيس في أحد المهرجانات الشعرية، يتفرّغ اليوم لهجاء شاعره المقدّس بذريعة أن أدونيس يدافع عن طغيان السلطة، فيما هو يرتدي البيجاما، ويدير المعارك في الموقع الأزرق، مما وراء البحار، ثم يحصي ضحاياه من الخصوم. لم تتوقّف المعارك عند حدود الشوارع الخلفية للثقافة السورية، بل تجاوزتها إلى الساحات الكبرى. ها هو العلماني صادق جلال العظم يدافع من بلاد غوته عن «مظلومية السنّة» في مواجهة صريحة مع أدونيس ومواقفه المضادة. كما سوف يستهجن بعضهم منح نزيه أبو عفش «جائزة العويس الثقافية» التي كانت في الأمس القريب، بالنسبة لهؤلاء أنفسهم «جائزة نفطية مشبوهة».
رغم هذه الحروب التدميرية التي تستخدم الكيبورد كنوع من السلاح الأبيض، إلا أن دمشق تحاول لملمة جراحها وندوبها ومحنتها الطويلة، بما تبقى من مثقفيها، بعيداً من الثقافة الرسمية التي تشكو في الأصل من فقر دم مزمن.
هكذا، انتشرت مجموعة من الملتقيات الأدبية والمسرحية والموسيقية المستقلة في أحياء دمشق، لإعادة الروح إلى «ورشة الأمل» بين قذيفة وأخرى. ثقافة الحاجز حوّلت أحياء دمشق إلى مربعات متباعدة، فيما ينهمك آخرون بفحص تضاريس الجغرافيا السورية مجدّداً، وينفضون الغبار عن وثائق وخرائط سايكس بيكو لإعادة رسم بلاد، كان ابن جبير قد وصفها يوماً، بأنها «جنّة المشرق»، قبل أن ينسف «لورانس العرب» سكة قطار دمشق، حيفا، الحجاز.
جنّة المشرق أم جنّة البرابرة؟ ثم هل علينا أن ننظر بتبجيل إلى النص الركيك لمجرد وجود دمغة الثورة مع توقيع صاحبه؟ وهل علينا هدم أساس البناء الثقافي الذي لم تطله التشوهات، في غياب الدعائم الصلبة لنصّ اليوم الرخو، أم علينا أن ننتظر قليلاً، ما ستفرزه مطحنة الحرب، خارج عبثية المشهد؟ لعل ما تحتاجه الثقافة السورية، في اللحظة الراهنة، أن تقوم بإزاحة المقاولين الطارئين عن المشهد، هنا وهناك، في الداخل والخارج، وتشذيب حقولها من الأعشاب الضارة التي نبتت في الوقت الضائع، وتفعيل صوت العقل وحده، بوعي خلّاق يعيد رأس المعري المقطوع، وتمثال أبي تمّام إلى مكانهما في الذاكرة، وإلغاء صكوك التخوين والتحريم والعنف اللفظي المتبادل، كي تتنفس المدوّنة السورية هواءً آخر… هواء لم تلوثه الأختام الجاهزة، والهويات المهتزّة، وأجنحة الطواويس.
يوميات «البوح المالح»: للموت أسماء مستعارة/ يزن الحاج
التوثيق بالكتابة في زمن الحرب شكل من أشكال التحايل على الموت، أو مهادنته، أو إلباسه أسماء مستعارة. وكما أذهلنا كمّ الكتابة التي ولد في الانتفاضة السورية، بدا كأنّ السوريين ــ الكتّاب منهم بالأخص ــ بدأوا الاعتياد على الموت اليومي. ومن رحم هذا الاعتياد، ولدت «كولاجات» اليوميات التي تتضمّن الشعر والسرد النثري الطويل والشذرات، بدرجات مختلفة من الفلسفة والتأمل. وبعيداً عن الأسماء المكرّسة، بدأ ظهور «الكاتب ـ المواطن» بالتزامن مع «الصحافي ـ المواطن»، كإشارة إلى ولادة زمن جديد، وجنس أدبي جديد نسبياً، وروح جديدة في الكتابة والحياة.
السوريون يكتبون يومياتهم. ثمة من استكثر على الراغبين بالبوح أن يكتبوا. وثمة من استهجن «الحياد» الذي يكتب به البعض. الحياد تجاه القذيفة والطائرة والذبح والموت. لم يدرك هؤلاء «المراقبون» ربما بأنّ هذا التلعثم وعدم اليقين هما ما يجعل لما تبقّى من الحياة السورية معنى. بعيداً عن الركام والرصاص، ثمة من سئم دموعه ودمه، وبدأ البوح. بدأ ملح الكتابة، والملح هو كلّ ما تبقّى للسوريين من دمهم ودموعهم. وسيكون هذا الملح الجارح بداية أخرى للشعب «الحكّاء» الذي سئم سنوات الصمت. ربما كان ثمة اختلاف في نبرة الصراخ ودرجاته، لكن الهمس وحّد الجميع. همس اليوميات بسذاجتها، وطزاجتها، وحرقتها. بالطبع، كان لا بدّ للطوفان من سد ينظّم اندفاعه. ومع بداية السنة الثالثة للانتفاضة وتحوّلها إلى حرب يومية، بدا كأن ثمة «اقتناعاً» جمعيّاً احتل السوريين، مؤيدين ومعارضين، بأن زمن الحرف انتهى وبدأ زمن السلاح. سنة كاملة من الاقتتال مرت وانتهت، لتبدأ السنة الرابعة، ولتبدأ ثمار اليوميات بالظهور، بعد انتهاء «ألف ليلة وليلة» من الحرب السورية. بدأ هذا التوثيق يأخذ شكلاً مؤسساتياً بعيداً عن فوضى الشذرات العابرة. انتهى عصر اليوميات وبدأ عصر الشهادات. صارت الشهادات جنساً أدبياً مرغوباً من دور النشر، وبدأت حمى نشر الكتب بعد ما يزيد على عامين من النشر المنتظم لليوميات السورية في الصحف على اختلاف توجّهاتها السياسية والفكرية.
ربما لم يكن ثمة اختلاف كبير في التفاصيل الهامشية اليومية بين اليوميات والشهادات، ولكن الأمر اللافت هو أنّ فسحة جديدة للبرود التأمّلي قد ولدت في الكتابة التوثيقية. ولعل هذا المزج الذي قد يخالف «الأصول» المتعارف عليها في التوثيق، هو ما جعل للشهادات نكهة مغايرة: تجاور اليومي العابر مع استعادة التاريخين القريب والبعيد على حد سواء، إضافة إلى التقاط اللحظات النفسية الحرجة في الأزمات. ليس ثمة ادّعاء بالشجاعة أو «السوبر – وطنية»، وليس ثمة يقين بشأن المستقبل. هناك تدوين بارد لليوميات الساخنة، وهناك رؤية جديدة للحدث تحاول قراءة «الآخر»، بل محاولة فهمه. وهذا الخلط والتناقض هو ما سيجعل لهذه الشهادات حضوراً أكبر في الأيام القادمة. وليس من المصادفة ربما حضور هذه النبرة الجديدة في التدوين بالتزامن مع انطلاق سلسلة «شهادات سورية» المتخصصة في نشر كتب اليوميات، وقد أصدرت أربعة كتب حتى اليوم. من يتأمل اسم دار النشر «بيت المواطن»، والحضور المتناقض لها (كما تشير الصفحة الأولى من منشوراتها) في دمشق برقم هاتف لبناني، سيدرك بأنّ هذه الأحلام المؤجلة ببيت يضمّ الجميع بدلاً من تفصيله على قياس مزاجيّ، وبمواطنين بدلاً من الرعايا، هو ما يجعل لهذه النبرة «التصالحية» الجديدة معنى، وسيضاعف الألم لأن قدر هذه الأحلام هو أن تُثمر (ولو موقتاً) خارج حدود هذه الأرض التي ضاقت بالوطن وبأبنائه.
وكما كان الصراخ، قبل ثلاث سنوات، هو الذي أطلق الانتفاضة المجهَضة، سيكون الهمس الآن بداية لمرحلة سورية جديدة. وبعد الخيبات السياسية المتلاحقة، وإقصاء الثقافة والتفكير خارج كادر الصورة المؤلمة، تعود اليوميات/ الشهادات لترسم حدوداً جديدة في المشهد الأدبي السوري. ولعل هذا الانتقال من الشفاهية إلى الكتابة والتدوين سيشكّل أساساً متيناً ما في زمن التعثرات والكبوات، وسيُفرد الواجهة للحياة وليس للموت بأسمائه المستعارة الثقيلة
“خربشات” على جدران الانتفاضة… طوفان الـ “ديجيتال آرت”/ يزن الحاج
دمشق | ليس من المبالغة القول إنّ الفن التشكيلي هو أعظم نتاجات الانتفاضة/ الحرب السوريّة. كما يصحّ القول بشيء من التعميم إنه كان الثمرة الأكثر ديمقراطيّة لهذه المأساة التي ستدخل عامها الرابع. ورغم ما قد تحمله العبارة من تبسيط، إلا أنّه يمكن اعتبار أنّ «ديمقراطية الفن التشكيلي» لا تحتاج إلى أكثر من حساب على الفايسبوك، ودرجة ما من الموهبة، وستتكفّل الذائقة المختلفة بالضرورة، والتسويق الرائج أخيراً لكل ما هو سوري بما تبقّى. والأهم هو هذا الحضور الفني الهائل للمعارض الدائمة في مواقع التواصل الاجتماعي، كأنه إشارة خافتة إلى أنّ زمن «الشلليّة» والمحسوبيات قد انتهى بدرجة ما.
ورغم التفاؤل الذي تغرق فيه الجملة الأخيرة، إلا أنّه لا بد من التأكيد بأنّ هذه «الديمقراطية» ذاتها، كانت (وستبقى إلى فترة لا بأس بها) السبب الأكبر في إعادة البضاعة الفنية القديمة المرافقة للشعارات الكبيرة ودكتاتوريّتها. إنّها اللوحة الموغلة في المباشرة التي (رغم أهميتها التوثيقية) ستشكّل عبئاً من نوع آخر، عبء الدكتاتورية الجديدة.
دكتاتورية الثورة «الجديدة» التي تدّعي بأنّها ــ في وجه من وجوهها على الأقل ــ مناهضة لـ «الثورة» البعثيّة القديمة عام 1963 بكل مآسيها، وبالأخص المأساة الثقافية. يمكن اعتبار أنّ «ديمقراطية الفن التشكيلي» استمدّت شرعيّتها وانطلاقتها من أولى «الخربشات الثورية» على جدران المدن مع اندلاع الانتفاضة. كانت تلك الخربشات إيذاناً برحلة فنية جديدة صارخة، بعد عقود من الصمت حيث كرّست ثقافة الجدران الكاكية الجوفاء، حيادية اللون.
إلى إن استدعى الأمر وجود مناسبة (وطنية أو قومية) فتتلوّن حينها الجدران «عفوياً» بألوان العلم السوريّ أو الشعارات القومية.
وليس من المصادفة ملاحظة عودة هذه «الموضة»، أي رسم العلم السوري على جدران وأبواب المحلات التجارية، وكأنها إشارة ضمنيّة إلى أنّ قبضة السلطة عادت بقوة، وبأن «فسحة الديمقراطية» التي شهدت كراً وفراً بين الشعارات والشعارات المضادة طوال ثلاث سنوات، ستعود إلى زيّها العسكري الصارم، ولونها الموحّد.
لا يتّسع المجال لتعداد أسماء كل من رسم خلال السنوات الثلاث الماضية، سواء كان قد ولد فنياً في هذه الانتفاضة، أو كرّس تجربته بصبغة جديدة، أو تمّت استعادة أعماله القديمة. ولد مئات من الفنانين خلال ثلاث سنوات، ويكفينا تأمل بسيط في هذا الرقم المرعب لندرك كمّ الأعمال القادمة، بجيّدها وسيّئها الذي سيكون «كابوساً» حقيقياً لأي متابع أو ناقد فني. آلاف اللوحات الكاريكاتورية، ومئات أعمال الـ «ديجيتال آرت»، ومئات أقل من لوحات الأنماط التشكيلية الأخرى، من دون أن ننسى عشرات المنحوتات.
كلّ هذه الأرقام تستدعي سؤالاً مهماً: من أين ولدت كل هذه الأعمال؟
وكما كان لمواقع التواصل الاجتماعي فضلٌ في انطلاقة هذه الأعمال، كان لها فضل تجميعها في انتظار تقييم نقدي ينبغي ألا يتأخر. لم يقتصر الأمر على «الصفحات الاختصاصية» في الفايسبوك، بخاصة صفحة «الفن والحرية» التي تم إنشاؤها مع اندلاع الإنتفاضة لتواكب طوفان الأعمال الفنية المتوالدة يومياً، بل ظهرت أيضاً مواقع إلكترونية فضّلت «الاتجاه المغاير» في التوثيق، بعيداً عن فوضى السلاح والحرب اليومية، وبدأت بتوثيق المبادرات المدنية للانتفاضة، بكل اتجاهاتها الإبداعية، مثل قسم «مبدعون سوريون» في موقع «Syria Untold حكاية ما
انحكت».
في هذه الصفحات والمواقع، سنتابع معظم الأسماء الفنية التي ظهرت خلال السنوات الماضية، بـ «فوضى» جميلة، يتجاور فيها المبدعون على اختلاف تجاربهم ومدارسهم وأجيالهم.
هل سيتكفّل الزمن بغربلة هذا الطوفان الفني السوري؟ لا إجابة جازمة. الأمر مرتبط بمدى التسويق المرتبط أساساً بأجندات سياسية بالضرورة، لا سيما بعد ولادة «وباء» المنظمات غير الحكومية.
لكن يمكننا ملاحظة أن الاهتمام بدأ ينحسر عن «اللوحة اليومية» في الكاريكاتور، لصالح الأعمال «الجادة» بمدارسها المختلفة لا سيما الـ «ديجيتال آرت» الذي شهد تطوّراً لافتاً كماً ونوعاً خلال السنتين الماضيتين على وجه الخصوص. هل الأمر مرتبط بتغيّر الذائقة الفنية أم بتغيّر الميل السياسي؟ لا يمكن الجزم، لكن يمكن القول بثقة بأنّ اتساع «ديمقراطية الفن» سيكون هو السبب الأكثر أهمية في الغربلة. أشعلت حرية الجدران شرارة النار الأولى ضمن المستنقع السوري، ولعل امتدادها الافتراضي في جدران التواصل الاجتماعي سيسهم في دوام ألقها. في البدء كان اللون، وربما سيكون هو الختام.
الإعلام الغربي والخليجي في المجرور الطائفي/ صهيب عنجريني
التباين الحادُ في مواقف وسائل الاعلام إزاء قضية ما ليس أمراً جديداً. وربما كان هذا التباين أحد أهم مقومات الإعلام. ليسَ منطقياً أن يرى الجميعُ حدثاً واحداً بعينٍ واحدة. لكن التباين المحمود حتماً هو ذلك الناشئ عن اختلافٍ في الرؤى المهنية، لا المنبثق عن اصطفافات سياسية. وبات من المسلم به أنّ الأزمة السورية تحولت إلى واحدة من أعقد المسائل التي تجاوزَ فيها التناول الإعلامي مرحلة التباين المهني، لينخرط في أنفاق طويلة متوازية، لا يبدو ثمة أمل في تلاقيها.
خلال ثلاثة أعوام هي عمر الأزمة، لا نكادُ نلمحُ اختلافاً فعلياً في طريقة تناول الإعلام للشأن السوري، خصوصاً وسائل الإعلام العربية. إلى حدٍّ يمكن معه تشبيه الـ 15 من آذار (مارس) 2011 بموعد انتظام طلاب مدرسةٍ ما في الطابور الصباحي، حيثُ يكون موقف كل تلميذ محدَّداً وفق توجيهات «الناظر». وأي محاولة لتغييره من دون توجيهات جديدة، تضع التلميذ تحت طائلة العقوبة. في جوهر الأمر، يبدو هذا «النهج» شديد الإخلاص لطبيعة العمل الإعلامي في المنطقة العربية، حيث الاختراقات نادرة الحدوث، والمواقف السياسية بوصلة ثابتة لوسائل الإعلام، بما فيها تلك التي يُصدِّرها القائمون عليها بوصفها «ملكية خاصة ومستقلة».
على هذا المنوال، اصطفّ الإعلام العربي (في معظمه) ضمن نسقين أساسيين: «مع النظام»، و«ضد النظام». رفع معسكر «الضد» السقف عالياً، بل ربما ألغاه، لتتصدر شعارات «الحرية، والديمقراطية» واجهاته، بما في ذلك الوسائل الرسمية. تبدو الحالة (خصوصاً في الإعلام الرسمي) غريبة وغير مألوفة بالنسبة إلى إعلام اعتاد تمجيد أصحاب الشأن، و«الذوات الملكية، والأميرية»، ولا تكادُ علاقته بما يدور في الدول العربية «الشقيقة» تتجاوزُ إعداد تقارير مطولة عن «العلاقات التاريخية» بين كل دولتين يعتزم «أصحاب الجلالة، والفخامة، والسمو..» فيهما، تبادل الزيارات.
وغير بعيدٍ من هذا، تخندق «معسكر الـ مَع» في صف «القيادة الحكيمة». وقرّر نبش «الأرشيف الأسود» لـ «الإخوة الأعداء»، ضارباً عرض الحائط «عمق العلاقات التاريخية» التي دأب أيضاً على التغني بها، مثله في ذلك مثل سابقه. وبين هذا وذاك، تحول الشعب السوري إلى لعبة شدّ، تتقطع فيها الحبال، ولا يهتز رمش للمتجاذبين. وسط هذه المعمعة، وجد إعلام عربي ثالث نفسهُ حائراً. إعلام دأب أساساً، وقبل موجة «الربيع العربي» على القفز بين الحبال. ولا يمكن له في حال من الأحوال أن يرضى بالخروج من «السوق السورية». وكتحصيل حاصل، اختار هذا الإعلام تناول الشأن السوري وفق سياسة «ضربة على الحافر، وضربة على المسمار» من دون أن ينتبه (أو ربما من دون أن يكترث) إلى أنّ كلّاً من الضربتين ستترك أثراً دامياً على الشعب السوري.
بالانتقال إلى استعراض تعاطي الإعلام الغربي مع الأزمة، لن تكونَ النتائج مختلفةً من حيث النتيجة، ولو اختلفت من حيث الشكل. يكاد «الربيع العربي» أن يكون المناسبة الأولى التي يفصل فيها هذا الإعلام بين الشعوب العربية، وأنظمة الحكم.
في الشأن السوري على سبيل المثال، بقي تناول الإعلام الغربي لسنوات طويلة يختصر البلد بصورة الرئيس بشار الأسد، وزوجته، محتفياً غير مرة بهما، كنموذج خارج عن الصورة النمطية المعتادة للحكام العرب. ويمكن تلمس هذه الحفاوة حتى مع بدايات «الربيع العربي». ها هي مجلة Vogue مثلاً، تحتفي عبر تقرير مطول نُشر في 25 شباط (فبراير) 2011 بـ «أسماء الأسد… وردة في الصحراء». قبل ذلك بأسبوعين، كانت صحيفة Wall Street Journal تحتفي بالرئيس الأسد على طريقتها، مبرزةً تعليق المصورة التي التقطت صوراً للأسد خلال الحوار الشهير الذي أجرته الصحيفة معه. يومَها، أفردت الصحيفة حيزاً خاصاً لانطباعات المصورة كارول الفرح: «لا أستطيع أن أصدق. كنت ألتقط صوراً للرئيس الأسد، في مكتبه، عن قرب، لكنه كان كما يتضح عبر الصور، كان ذلك حقيقياً».
لكن على نحو مفاجئ، بدا أن الإعلام الغربي اكتشف فجأة وجود الشعب السوري. وبدءاً من آذار 2011، بدأت صورة الأسد تتحول هناك إلى «دكتاتور»، لتكرّ السبحة، وصولاً إلى تقديمه كـ «سفّاح». وبالتزامن، كان التحول يطال صورة زوجته، ليتحول التهليل لأناقتها، إلى مهاجمة لـ «بذخها»، وتفرد الـ «غارديان» البريطانية على سبيل المثال، حيزاً لنشر «تسريبات إلكترونية عن شراء أسماء الأسد حذاءً بـ 7 آلاف دولار».
ربما كانت وكالة «رويترز» صاحبة قصب السبق في تلك التحولات. الشأن السوري الذي قلّ أن يحضرَ على صفحاتها قبل الأزمة، إلا في سياق الحديث عن المسائل الإقليمية، أو عبر تحقيق من طراز «الخبز الناعم يلقى رواجاً كبيراً في سوريا خلال رمضان» (نُشر في رمضان 2010). هذا الشأن تحول فجأةً إلى خبرٍ أول، أخذ على عاتقه منذ بدء الأزمة تشريح المجتمع السوري طائفياً، سابقاً بذلك تكفيريي المعارضة السورية.
هكذا، قرأنا في سياق خبر نشرته بتاريخ 24 آذار 2011 (بعد أقل من عشرة أيام على اندلاع الأزمة)، عبارات مثل: «والأجواء يوم الخميس مختلفة تماماً عن عام 1982 (…) عندما كانت الأقلية العلوية تحكم قبضتها على البلاد». و«وردد المحتجون في درعا وأغلب سكانها من السنة هتافات ضد تحالف بلادهم مع إيران الشيعية».
آذاران سوريّان، تفصل بينهما ثلاث سنوات، وعشرات الآلاف من الضحايا، وأضعافهم من المشردين، ومئات آلاف المقالات، والساعات التلفزيونية في لعبة يُمثل الشعب السوري الحلقة الأضعف فيها، وتتحول الحقيقة خلالها إلى كرة تتقاذفها الأرجل.
نجوم عائدون يحصون خسائر الروح
يعيش غربة بكل المقاييس، وعباس النوري يرى أن الفنانين السوريين ما زالوا عرضة لحملات التخوين، وباسم ياخور يدعو إلى الحوار. «الأخبار» التقت في دمشق بثلاثة من أبرز الوجوه الفنية السورية. بعد ثلاث سنوات على اندلاع الأزمة، جردة خسائر وحديث عن الغربة، والعودة، والتهديدات، وتدني الخطاب بين المثقفين، وغياب الحق في الاختلاف.
ما الذي غيّرته الأزمة في غسّان مسعود؟ يجيب بأسف «زادتني الأزمة اقتناعاً بأن ألتزم الصمت، لأنه حين قلنا منذ الأشهر الأولى للأزمة، فليجلس الناس إلى الطاولة على مئتي ضحيّة، قبل أن يجلسوا على مئتي ألف، لم يسمع صوتنا أحد. وأظنّ أنّه حتى هذه اللحظة، ما زال رأينا غير مسموع من كل الأطراف». على المستوى الشخصي، يرى نجم «أشواك ناعمة» أنه بعد مرور ثلاث سنوات على الأزمة، باتت «الحقيقة اليوم هي براعة تلك الآلة الجهنمية (الميديا) في صناعة الحقيقة. ثمة حقيقة تُصنَع، وهي مغايرة لتلك المشتقة من كلمة «حق». اليوم الحقيقة مشتقة من آلة إخبارية تضفي لباساً ملكياً على أجساد مشوّهة». على المستوى الشخصي أيضاً، يقول: «في ما مضى كنت أشكو من مفهوم الاغتراب، لأن الفنان كيان هش وقلق، تجده يشكو الغربة عن وسطه. اليوم بتُّ أشتهي تلك الغربة، غربة ما قبل الأزمة، وأجدها مزحة. ما أعيشه اليوم هو غربة مكتملة بكل المقاييس».
على سيرة الغربة والاغتراب، نال مسعود، كالعديد من نجوم الدراما، نصيبه من التهديدات التي طالته وطالت عائلته، ما دفعه إلى السفر إلى بيروت. لكنّه بقي يتردّد على سوريا وصوّر فيها فيلمه «رسائل الكرز»، ومسلسلين هما «المصابيح الزرق» و«ياسمين عتيق». وبدأ أخيراً تصوير «بواب الريح». يرفض الخوض في تفاصيل هذه التهديدات. يقول «في المحصلة أبعدت أولادي لأننا كفنّانين أهداف سهلة، ليس لدينا سلاح أو مرافقات، ووجوهنا تكشفنا. خلال السنتين الماضيتين، لم أستقر في بلد». هل لديك مخاوف من وجودك في دمشق اليوم؟ يجيب «هناك مثل شعبي يقول «راح الغالي ما أسف ع الرخيص»». بين عمل وآخر، وإقامة متقطّعة في بيروت، كان مسعود مقلّاً في إطلالاته الإعلامية، ووجدَ في الصمت ملاذاً كما شرحَ لـ«الأخبار». يقول: «لم أعد قادراً حتى على إعطاء خبر عمّا أقدمه من أعمال. أغلقت حسابي على فايسبوك بسبب ما رأيته من لغة منحطة في الخطاب بين السوريين. وسائل التواصل الاجتماعي علمتنا الفجور، وهذا غير مقبول، خصوصاً حين يصدر عن سوريين محسوبين على الثقافة والفكر. يبدو ذلك جارحاً جداً، ويساوي الدم». ما السبب في هذا الانحطاط، خصوصاً أنّه يفترض بالفنانين والنخب أداء دور جامع في ظلّ الانقسامات؟ «ومن قال لك إنّ منطق الجمع مقبول؟» يضيف مسعود «ما يُقبَل منك فقط هو منطق القسمة، والانحياز. 24 مليون سوري بما يملكون من حضارة صاروا بين شبّيح وذبّيح، ما هذا الغباء؟». ويختم «لا أحد يريد خطاباً جامعاً. ثم هل السوريون يستحقون هذين التصنيفين المغلقين؟ هل يستحق السوري بعد كل هذا التاريخ أن يكون إمّا أو إمّا؟».
لماذا فشلت الوجوه الفنية في أن تكون شخصيات جامعة، بل إنّها زادت من حدة الانقسام والتحريض؟ يجيب عباس النوري «ليس مطلوباً من الفنّان أن يكون شخصية جامعة. الفنان عمله إشكالي لأنه يشتغل في الشأن العام، لكنه غير سياسي، ولا يصلح لأن يكون كذلك. وإذا حدث، فالأفضل له ترك الفن قبل أن يُطرَدَ من مساحة الصدق والثقافة، شأنه في ذلك شأن كل السياسيين. فهذا يكون من باب الارتزاق، والاستفادة من شيء تحت أهداف معينة مثل الكثير من الفنانين الذين استفادوا من السلطة في عهود الاستقرار، ثم أعلنوا انشقاقهم». ويستدرك «ثم لا يمكن أن نتحدث عن الفنّانين السوريين ونتجاهل دور نقابة الفنانين، بوصفها الشخصية الاعتبارية التي ينبغي لها حماية حق الفنان في اختلافه مع النظام، من دون أن تتبنى مواقف أخرى، وتلزمه بالخضوع للتحقيقات الأمنية والحزبية. حين انتقدت القيادات النقابية بعد الانتخابات الأخيرة، اتُّهمت بكوني غير وطني. نقابة الفنانين تحوّلت إلى مخفر، قائده غير معروف. الكثير من الأسماء الفنية السورية البارزة غادرت البلاد اليوم. كثيرون عليهم خطوط حمراء، بعضهم مطاردون، وآخرون ممنوعون من العمل، وكلهم سوريون وسوريون جداً، ومن حقهم أن يعودوا لأنهم الأقدر في التعبير عن حساسيات الناس. أنا طالبت بإزالة الخطوط الحمراء عن زملائي. طالبت برفع حرمانهم من العمل، بل يفترض أن يتم إعطاؤهم الضوء الأخضر، وأن تفرش لهم السجّادة الحمراء في المطارات. البلد لا ينبغي أن يصادره أحد مهما كان قوياً». ولدى سؤالنا عمّا إذا تعرّض لتهديدات على خلفية آرائه، أجاب «التهديدات حاضرة طوال الوقت، ومن أطراف مختلفة، تحت وطأة حملات التخوين».
بقي عبّاس النوري في دمشق خلال الأزمة، حيث صوّر سبعة أعمال. وهو يعود في موسم 2014 إلى «باب الحارة 6»، كما يصوّر حالياً دوريه في «الغربال» و«ما وراء الوجوه»، فهل فكر في مغادرة دمشق خلال السنوات الماضية؟ أجاب بصراحته المعهودة «لن أكذب أو أزاوِد. لقد فكرت في ذلك، وكنت مدفوعاً بهمّ حماية بيتي وعائلتي، وأولادي، لكنّني لم أصل إلى اتخاذ القرار». وأضاف بلهجته الشاميّة المحبّبة «بس أولاً وأخيراً وباقتناعي الشخصي، ما في مواطن، مو فنان بس، بيطلع برّات البلد إلا بيصير جواتها بشكل أكبر». وختم «الكل خاسر من هذه الأزمة، خسائرنا بالجملة، وهزائمنا بشعة، وسنحصد آثارها لاحقاً».
كمعظم نجوم الدراما، نال باسم ياخور حصّته من التهديدات والتخوين، وبلغت ذروتها على خلفية تجسيده شخصيّة «أبو نبال» في مسلسل «منبر الموتى» الموسم الفائت. غاب باسم عن البلاد لما يزيد على عام، وأشيعَ أنه كان ممنوعاً من دخول سوريا، الأمر الذي نفاه النجم، كما كذّب الشائعات والتصريحات «الملفّقة» على لسانه. عودته أخيراً إلى دمشق لتصوير مشاركاته في «بقعة ضوء 10» اعتبرها البعض نوعاً من تسجيل الموقف إزاء ما يجري. يعلّق ياخور: «موقفي واضح منذ بداية الأزمة. أنا مع شكل الدولة، ولا يوجد بديل منها ومن مؤسساتها في سوريا. وبديلها هو فوضى غير خلاّقة ستودي بالبلاد إلى الهاوية». ويضيف «في النهاية نحن كفنّانين ومثقفين نكتفي بإبداء وجهة نظر، وأحياناً تكون محفوفة بالمخاطر، لأن جزءاً كبيراً من الطرف الآخر الذي يطرح اليوم فكرة الحرّية لسوريا، ويتحدث عن سوريا الجديدة كبلد حر ديمقراطي، لا يتقبّل مجرّد رأي قاله مثقّف أو فنّان. مع احترامي الشديد للمعارضة، لكنّ جزءاً كبيراً منها لم يستطع تقبّل وجهة نظر صادرة عن آخر لم يمسك السلاح أو يقم بإيذائه. واليوم يهدّدوننا بالذبح، والقتل والنسف، فكيف له أن ينفّذ ادّعاءه بسوريا جديدة حرّة؟ فاقد الشيء لا يعطيه. وأنا من الناس الذين تعرّضوا للكثير من التهديدات». إذاً كان غيابك عن الشام بسبب إحساسك بالخطر؟ يجيب: «أحد الأسباب المباشرة لمغادرتي البلاد هو إحساسي بالخطر. نحن عانينا، وما زلنا نعاني بسبب إقامتنا في الخارج. الحياة ليست سهلة هناك، ولدينا مواجعنا اليومية، منها ما هو مادي، واجتماعي. أنا لم ألتقِ بأهلي لأكثر من سنتين». ومن كواليس تصوير «بقعة ضوء10»، ختم ياخور «أنا مع أن يجتمع السوريون مجدداً. لا الموالون ولا المعارضون سيختفون. الحلّ الوحيد هو قبول بعضنا لبعض، رغم المواجع التي حصلت. لا يوجد حل آخر، وإلا فسنواجه التقسيم، ليس بحدود سياسية ربما، بل التقسيم الاجتماعي والطائفي والإقليمي، وهذا أخطر ما يهدد بلدنا».
تمزّقات الدراما السورية… من أين أدخل في الوطن؟/ وسام كنعان
سيتعرّف المشاهد العربي إلى نفسه من خلال التاريخ، وسيحيك قصته الأثيرة بعيداً من الشاشات. هذا ما توقّعه معظم المهتمين والمتابعين للدراما العربية منذ أن أضرم محمد البوعزيزي النار في جسده وأشعل زمن الربيع العربي الذي سرعان ما تحوّل خريفاً مغمّساً بالدماء.
وسط الترقب والعدوى السريعة في الوطن العربي، حصلت المعجزة السورية بعدما تعبت كاميرات الإعلام وهي ترصد ساحات فارغة في دمشق كان يُفترض أن تمتلئ بالمتظاهرين وفق دعوات متكررة على الفايسبوك. لكن لم تغب شمس الـ 15 من آذار 2011 حتى كان السوريون يتناقلون فيديو رديء الجودة نُشر على يوتيوب لمجموعة من السكان والعاملين في حي الحريقة الدمشقي العريق وهم يهتفون بصوت واضح «الشعب السوري ما بينذل». وما هي إلا أيام حتى اندلعت أحداث درعا وطغى صوت الرصاص وكرت سبحة الاحتجاجات في المناطق السورية. وبينما كان النظام يواجهها بقمع ممنهج ويعتمد على نجوم التلفزيون لمخاطبة الشارع وتهدئته، وقعت الدراما في حيرة. كيف تواصل النجاح الذي بدأته منذ عقد من دون أن تغوص في إشكالية الثورة؟ ومَن ذاك الذي يتجرأ على الغوص في وحل ما يحدث، مجابهاً النظام الذي يفرض سطوة وسيطرة أمنية ومونة واسعة على غالبية نجوم الدراما؟ ثم كيف لهذه الدراما أن تستمر وقد كان أحد أبرز أسباب نجاحها تصديها للواقع السوري وملامسة قضايا الناس، لتصل إلى فضح ممارسات المؤسسة الأمنية وتجاوزتها؟
وسط حالة التردد وضياع البوصلة، اختار معظم صنّاع الدراما سياسة النأي بالنفس. في موسم 2011، قدّموا حوالي 28 عملاً لم يتطرق سوى أربعة منها إلى الأزمة أبرزها «خربة». رغم نجاح العمل الكوميدي، إلا أنّ المسلسل بدا ساذجاً في مقاربة الأزمة. وهناك لوحات من «بقعة ضوء 8»، ثم حالة إسقاطية في «الولادة من الخاصرة1»، فيما تصدت الرقابة للعمل الكوميدي «فوق السقف» فأوقفته بعدما دخل في عمق القصة وصوَّر تظاهرات بشكل مباشر لكن بطريقة كوميدية ساخرة.
على أي حال، كان موسم 2011 بمثابة إعلان عن الاستمرارية في كل الظروف ولو ظلت الصناعة السورية الأكثر رواجاً بعيدة عن الواقع. في العام التالي، طغى صوت الرصاص على الحراك الذي بدأ سلمياً وازداد الانقسام بين الشعب السوري، واتسعت الخلافات في صفوف الفنانين وانتشرت قوائم العار والشرف من طرفي النزاع. مع ذلك، أنتج السوريون حوالي 23 عملاً وقد بدأت الجرأة تتضح في المادة المقدَّمَة. لم يعد ممكناً غض الطرف عما يحدث. بعض المحاولات جاءت كسيحة وعجزت عن ملامسة الظرف الطارئ وبعضها نجح بشكل نسبي. هكذا، قدم الممثل الشاب يامن حجلي تجربة «خلصت» ليحكي في حلقات قصيرة عن تعليق الشعب السوري آماله على نهاية الأزمة. تلك النهاية التي وعدته بها مؤسسات النظام الإعلامية من خلال لازمتها الشهيرة «خلصت» التي تحوّلت إلى شعار بعد فترة وجيزة من اندلاع الاحتجاجات. وحاول سامر المصري من مكان إقامته في دبي مراقبة الحدث بطريقة إسقاطية في مسلسله الكوميدي «أبو جانتي2»، فاتُّهم بالتهريج والسطحية. وبنت رشا شربتجي في «الولادة من الخاصرة2» رؤية استشرافية للحالة الاحتجاجية التي زحفت باتجاه التسليح. لكنّ أكثر الناجحين كان «بقعة ضوء 9» الذي لامس بجرأة وواقعية حال السلطة والمواطنين. هكذا، تحولت لوحة «أنت أو لا أحد» إلى حديث الشارع. ولاحقاً، صار الحديث عن أعمال تلامس الواقع مطلباً ملحّاً لدى الجمهور. جاء رمضان 2013 ليقدّم حوالي 21 مسلسلاً أفردت هامشاً أكبر للوضع السوري. وُصف بعضها بأنّه جزء من عملية تسييس الفن وتطويعه في خدمة الأطراف المتصارعة. حتى أن المحطات الفضائية راحت تشذب المسلسلات وتحذف ما يخالف سياستها. هذا ما فعلته محطة «أبوظبي» مع مسلسل «الولادة من الخاصرة 3» (منبر الموتى) لتخفي أي مشهد يظهر ولاء الجيش السوري للوطن أو صدق بعض ضباطه، فيما وصلت إلى تلفزيون السوري قائمة مؤلّفة من أسماء يحظَّر ظهورها على الشاشة الوطنية. واتُّهم نجدت أنزور بالترويج للنظام في مسلسله «تحت سماء الوطن» الذي أنتجته «المؤسسة العامة». أنتجت الأخيرة أيضاً «وطن حاف» وهو محاولة كوميدية للدخول في عمق معاناة السوريين، فيما انفرد مسلسل «سنعود بعد قليل» برصد التداعيات الاجتماعية على المهجّرين السوريين في بيروت. وسط تلك الحالة، سمعنا أصواتاً هنا وهناك عن محاولات لنجوم المعارضة السوريين لإنجاز مسلسلات تخصهم وحدهم. وإذا بفؤاد حميرة ينجز مسلسلاً على الانترنت بعنوان «نساء ورئيس» لم يتجاوز عتبة التهريج، متبنّياً أكثر الروايات سطحية وسخافة ضد النظام السوري.
وبعد، هل يمكن القول اليوم إنّ هامش الحرية اتسع في الدراما السورية؟ الملفت أنّه قبل الأزمة، كان «بقعة ضوء» يمثل هامشاً واسعاً لانتقاد السلطة والقبضة الامنية بسخرية. وفي ما يخص بقية الأعمال، كانت شركات الإنتاج تغامر في إنجاز مسلسلات تزعج الرقيب، لكنه لم يكن يستطيع إيقافها، خصوصاً أنّ نجوم الدراما كانوا قادرين على التواصل مع أرفع المسؤولين وأخذ الضوء الأخضر منهم. لكن بعد «الثورة»، انخفض هامش الحرية بسبب ظهور تنظيمات مسلحة متطرفة في تأييدها للنظام هددت نجوم الدراما وتوعدتهم بسوء المصير إن كان في مسلسلاتهم ما لا يروق لهم.
لكن الخسارة الأكبر كانت في الموت المتتالي الذي طال نجوم الفن السوري. حصدت النيران المندلعة أرواحاً كثيرة على رأسها الكوميديان الكبير ياسين بقوش، والممثل الشاب محمد رافع، والممثل طارق سلامة، وعدد من الفنيين، إضافة إلى بقاء مجموعة من الفنانين والإعلاميين رهن الاعتقال كالسيناريست عدنان الزراعي والمخرج المسرحي زكي كورديللو وابنه مهيار.
عربة السبايا الوردية/ أحمد علاء الدين*
دوماً عند وقوع حرب في هذه الجغرافيا الملعونة، يتم إعداد الرجال وتجهيز السلاح، وحفر القبور، وتهيئة الأرض، فمن العثماني الأخير إلى الفرنسي الأول حتى الانقلابات العسكرية، فالتوتر السياسي، انتهاءً بالنموذج الأخير، وسوريا لم تسترح يوماً واحداً، وإنه لمن السهل جداً إثخان الجسد المتعب بالجراح، حتى إذا قاوم، أُنهِك وإذا لم يُقاوم انتُهِك، وسوريا جسد أتعبته الحروب.
الحرب السوريّة. استحق ما يجري في سوريا هذا النعت بعد مرور وقت على الأحداث_ حيث وُصِّفَ ما يجري في البدء على أنه أزمة تمرُّ بها البلاد، وما أن تبدّت شواكل الهلاك حتى أُطلقت تسمية «حرب» بشرعيّة كاملة. لكن هنالك شيءٌ ما كان يتوقع حدوثه أحد، ليس وقوع الحرب، إنما غياب المقاتل. الحرب الآن قائمة على حربها، تتصارع أدواتها بأدواتها، وكل البنادق مسدودة تنعكف على مطلقها، إذن من الغالب؟ وأي الأهداف تُقصد؟
بتأثير من التاريخ الناطق بالمستقبل، استطاعت البلاد مناقشة الدماء إلى حدٍ ما وتفادت أكبر قدرٍ من كرات النار الموجّهة عليها، على الرغم من هشاشة المواضع وتوالي الضربات فإن ذاكرتها حيّة تجريديّة، لكن ما جدوى المعرفة دون الصنيع، وترك تاريخ الأرض وحده يحارب الغموض!
باستغراب قد يُسأل: كيف لهذا البلد روحٌ إلى الآن أمام كل هذا العنف والقوة البربرية المكثفة، وما تكون الآثار على المدى الطويل من وحشية حرب لا حدود لها؟!
دمشق، ابنة سوريا السيئة الحظ إن صح التعبير، هي التي ورثت كل هذه الصراعات الدموية وحملت عبء وجود الأرض بمحيطها، لم تزل كما وصفها محمد الماغوط «دمشق… عربة السبايا الوردية» تتنازع على نتفة غيمٍ عابرة، وبحرة في بيت عربي قديم تنشج الهواء الحزين وترجعه بسلامٍ إلى الأماكن الرطبة. فهي لطالما ظنت أنها على موعدٍ مع الصبابة بعد كمدٍ وبؤس أحاط بها قرون عدّة، لتتفاجأ بظهور الردى الجديد من القبو، وتشهد في الوقت نفسه تجزئة نموذجية تماماً، تستبدل المنحوتات والثقافات المحفوظة بالآثار المذهبية الضارة.
2011 _ 2014 نبوءات الخراب القديم تتحقق حصيلةً لغياب الفكر المعتبر، تتفجّر متمدّدة في ممرات المدينة بين شوارع الهاربين الضيقة، في خضمِّ موطنٍ كان منشأ للعقل المعرفي الأول، ورغبةَ المدنيّة المبتكرة، والمعبر الأعظم صوب الحضارة، وهنا تكون المعركة.
شاعر سوري
ولا يزال الديناصور هنا/ خليل صويلح
وفي اليوم الألف، لم تتوقّف الحرب.
لقد حرثنا تضاريس البلاد جيداً، من شمالها إلى جنوبها، نهبنا الكنوز القديمة المدفونة تحت التراب، ودفنّا الموتى والأحياء في مقابر وخيام مرتجلة، اختلطت أقمشة الشعارات والأعلام والرايات بأقمشة الأكفان، في أطول لحن جنائزي، واستعملنا بجدارة تفوق الوصف، كافة أصناف الأسلحة، بما فيها السكاكين والسيوف الصدئة لجزّ الأعناق، مرفقة بصيحات «الله أكبر».
عظام الموتى تكفي لإعادة تركيب هيكل عظمي لديناصور ضخم.
ديناصور يتجوّل في الأرض الخراب، باحثاً عن أسلافه. ديناصور يشاركني قهوتي وسريري وكتبي. ديناصور يدخّن تبغ الغنيمة باطمئنان. ديناصور خرج من «الحديقة الجوراسية» في وضح النهار، وأخذ يحطّم كلّ ما في طريقه نحو الهاوية. الديناصورات تخرج من الكتب، حتى أن القصّة التي كتبها أوغوستو مونيتروسو، واعتبرها غابرييل غارسيا ماركيز، أعظم قصة قصيرة صادفها في حياته، كانت تلحّ عليّ طوال هذا اليوم، ذلك أن بطلها ديناصور أيضاً «عندما استيقظتُ من نومي، كان الديناصور لا يزال هنا». انتهت القصة عند هذا الحدّ، بأقلّ من عشر كلمات، لكن الديناصور لا يزال هنا حقاً، وبدقة أكبر، لا أحد موجود سواه. أفكّر بمخاطبته، غير إنني لا أجد لغة مشتركة بيننا. أذهب إلى مشاغلي الأخرى، من دون أن يغادر الديناصور الغرفة، فقد كان يسدُّ عليّ النافذة الوحيدة للضوء، النافذة التي كنتُ أرقب خلالها القنّاص المتوهَّم، و هدير الحوّامات، وأسراب الغربان، وحركة العاملة البدينة في مشغل الخياطة، في البناء المقابل. أتتبع حركة الإبرة فوق القماش الأبيض، هل ما كانت تطرّزه كفناً، أم ملاءة لسريرٍ فارغ، أم هي بينلوب أخرى، تنسج خيوط الزمن الضائع، بانتظار محارب لن يعود؟ لا يجيبني الديناصور. أظنّ بأنه في إغفاءة قصيرة، بعد أن التهمَ، في وجبةٍ واحدة، أشجار قرية كاملة، وشارعين، ومئذنة، وتسع دراجات هوائية، ومكتبة، وثلاثاً وعشرين حقيبة مدرسية، وحقل سبانخ، وواجهة متحف، وفناء كنيسة، وسبطانة مدفع مهجور، ومخزناً للطحين.
في هذه الأثناء، كان أحمد البديري الحلّاق، ينهي يومياته بقائمة لموتى الطاعون بقوله «وقد طال الأمر، وكثر القهر، وزال السرور، وزادت البغضاء والشرور، ولم يدرٍ الإنسان أين يدور، من شدّة البكاء والنفور، ولله عاقبة الأمور».
في اليوم الألف، واليوم الذي تلاه، لم تتوقف الحرب، وكان على شهرزاد «ي» المنهكة، أن تستدعي ليالٍ أخرى، كي تنجو من الهلاك.
لا تكفي حكاية إضافية واحدة، حتى تغلق باب الغواية في وصف طبقات الجحيم، فإن تتجاوز اليوم الألف، هذا يعني دخولك في الليالي اللانهائية، وفقاً لرؤية خورخي لويس بورخيس، وما عليك إلا أن تتعلّم العدّ من جديد: يوم، يومان، شهر، مائة يوم، خمسمائة يوم… ولا يزال الديناصور هنا.
* مقطع من رواية بعنوان «جنّة البرابرة»، ستصدر قريباً عن «دار العين» (القاهرة).
صار للموت صفحة على فايسبوك/ سامر محمد إسماعيل*
بعد ثلاث سنوات على الكارثة الوطنية، أعتقد أننا في صدد التحضير لعرض آخر. السوريون الذين قدموا أغلب مسرحياتهم باللغة الفصحى؛ كانوا يحرصون دوماً على أن يعمّروا حديقةً خضراء في عمق الخشبة؛ يشربون نبيذاً وهي تمطر عبر مؤثرات الإضاءة والصوت؛ يضمون حبيباتهم في عتمة المسرح، وهم يعرفون أو لا يعرفون أن هذا كل ما يرتجونه في العيد الثالث للمجزرة. الاستحمام بالضوء وورائهم حديقة بأشجار ديكور مؤقت، يدخنون ويشربون على الخشبة كأنهم نسخة من حكايات عالمية، فيوماً ما سيعود الوطن إلى مسلسلاته السورية.
سيعود برنامج «حكم العدالة» إلى الإمساك بالمجرم الذي اغتصب «المغدورة ملك» كي يسرق صيغتها، وسيعود المذيع علاء الدين الأيوبي ليسأل الجاني عبر برنامجه «الشرطة في خدمة الشعب»: «هل أنت ندمان أيها الشعب»؟ وطبعاً سيجيبه الشعب: «ندمان يا سيدي… والله ندمان وصرفت النقود على ملذاتي الدموية». فعلاً اشتقنا لمجرمي «حكم العدالة» البريئين الطيبين، السذّج. أما أنا فكعادتي سأنخّلُ عقبان ليراتي السورية من دولارات السماسرة في بلادٍ شربت من نهر الجنون، فـ «شارع الحمراء» أخضر، و«مسرح الحمراء» أزرق، أما علبة تبغي الحمراء طويلة وبنفسجية. الله يا حرية. ليس مصادفةً أن يلتهم القتلة أكباد ضحاياهم، ليس مصادفةً أن يشووا رؤوساً وهم يرددون: «بندورة…بندورة»، وليس مصادفةً أن يكون الأحمر اللون الأعلى في العلم السوري، لكنه ليس بندورة، ليس بندورة.
أجل، بعد ثلاث سنوات على الملحمة السورية، يبدو أن يوم الجمعة لم يعد صالحاً للكفاح الثوري. أعتقد أن الساعة حانت لاتخاذ يوم الثلاثاء بديلاً عنه وتسمية أيامه «تكتيكياً» من اليوم وصاعداً. أعيدوا لنا جمعتنا السورية، يا أخي خذوا الثلاثاء. والله إنه يوم حلو ومناسب و «ثوري»، وليكن اسمه «ثلاثاء جمعة الندم على سوريا»، فكارمن السورية ما زلت تراقص ثورها العجيب وتدلّك له قرنيه بزيت الخديعة. تمرر وجهه على مفاتنها الدفينة، ثم تغرس في جبهته دبوس شعرها الأخضر على هيئة نجمتين.
بعد ثلاث سنوات على هذا الفيلم الأميركي الطويل، أخبار البيض والفروج لا تطمئن. الأسعار أمست مسعورة؛ والبشر على ميزان الذبح العمومي، تلفزيون البيض والفروج والسيارات المفخخة. أرجوك يكفي «جظمظاً»…
بعد ثلاث شموعٍ حمراء في بلادي التي تُدبلجُ كلَ شيء، تُسحق الشفاهُ على نطع المونتاج، ويموت الممثلون في استديوهات الغاز فيما تُطحن حناجرهم السورية في مخادع «حريم السلطان». لكن أخيراً صار للموت صفحة على فايسبوك؛ كتب بخط رديء عبارة على حائطه «وحده الفايسبوك السوري أكبر صفحة وفيات مجانية، مجانية وستبقى مجانية.
*شاعر سوري.
اعلام متخبط وصحافيون غارقون في الدماء/ وسام كنعان
منذ اندلاع الأزمة السورية، كان العنوان العريض لكل ما يحدث هناك هو “صحافيون في وجه الموت”. تحول هؤلاء الإعلاميون إلى هدف من جميع الأطراف فقط لأنهم يحاولون نقل الحقيقة أو جزء منها. النظام شدد قبضته واعتقل عدداً من الصحافيين. مات بعضهم في سجونه آخرهم معاذ خالد، بينما لا يزال يعتقل مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش ورفيقيه.
لم تقصِّر المعارضة من جهتها. اختطفت وقنصت وقتلت وأسقطت نيرانها أخيراً مصور «الميادين» عمر عبد القادر أثناء تغطيته لما يحدث في دير الزور . إلى جانب تلك الحالة الغارقة في الدماء، كان الإعلام السوري يدخل في حالة تخبط واضحة من دون أن يتمكن من الارتقاء إلى مستوى الأحداث. انطلقت قناة «تلاقي» الرسمية ليكون شعارها دعوة إلى اللقاء، ولو في منتصف الطريق، فإذا بها تقدم خلطة منوعة غريبة لم تتمكن من جذب المشاهد ولا تحظى باهتمامه في ظل الظروف الأمنية والإقتصادية المتدهورة التي تعيشها البلاد. ثم بدأت تعد العدة لإطلاق قناة “عروبة” للاستعانة بها في حال نفذ قرار الجامعة العربية وأنزلت الفضائية السورية عن القمر “نايل سات”. وأريد للمحطة أن تحمل فكراً عروبياً قومياً جديداً يتخطى اللغة الخشبية التي سيطرت على الإعلام السوري الرسمي لعقود طويلة. لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال. بعد حوالي سنة ونصف السنة من التحضير، اجتمع المسؤولون في التلفزيون السوري وأبلغوا فريق المحطة شفهياً قرار وزراة الإعلام بإلغاء القناة أو تأجيل إطلاقها. لكن رغم هذا التخبط لدى إعلام الدولة في سوريا، إلا أنه يظل أحسن حالاً من محطات المعارضة حديثة العهد مثل «سوريا الغد» و«سوريا 18 آذار». أشرف على تلك المحطات إعلاميون تربوا في مدارس النظام منهم توفيق الحلاق، وسميرة المسالمة، فإذا بهم يطلقون وجهاً آخرا للإعلام الرسمي السوري تُضاف إليه لغة التحريض المذهبي المقيت. أما المحطات الشهيرة، فقد كان عنوانها في المرحلة الأخيرة هو إعادة ترتيب الأوراق بعد غياب أي أمل في سقوط قريب للنظام وامتداد التيار المتطرف التابع لتنظيم «القاعدة». فإذا بـ «الجزيرة» تنسحب تدريجاً من الحدث السوري بالتزامن مع تنحي أمير قطر لصالح ابنه تميم. لم يبق إلا فيصل القاسم ليلعب دور “الدينامو” ولو اضطر إلى تكرار المواضيع ذاتها بالأسلوب ذاته وبضيوف مكررين بشكل دائم. لم يمر إعلان تدخل «حزب الله» في الحرب السورية من دون أثر إعلامي بليغ. سارع الموقع المعارض “كلنا شركاء” لإطلاق حملة توثيق 1000 قتيل لـ «حزب الله» في سوريا، وباشر بنشر صور وأسماء نقلتها عنه صحف عريقة مثل «النهار». لكن سرعان ما انكشفت الحيلة حين اتضح بأن الصور يعاد نشرها أكثرمن مرة، وأنّ عدداً كبيراً من تلك الأسماء استُشهدت خلال حرب تموز عام 2006 أو في أمكان وأزمنة أخرى بعيداً عن سوريا.
كل تلك الفوضى التي تعيشها سوريا عكستها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي غرقت في الانقسام والطائفية كمرآة حقيقية لما يحدث على الأرض.
قبل أن تبلغ الحرب سنّ الرشد!/ زيد قطريب*
الحرب تبلغ عامها الثالث، بعينين وحشيتين ووجه معفّر بالدماء! صورة لا يمكن أن تعبر عنها كلمة «خلصت»، ولا الانعطافات التي حدثت خلال مئات من الأيام عندما كانت بمثابة تمرينات ثم تحولت إلى معادلة قدرية جعلت الدم يتغذى على الدم! كأن الخراب كبر اليوم وشبّ عن الطوق ليغدو أكثر حرفية وفداحة، في حرب أكثر ما يُرعب فيها أنها لن تبلغ سن الرشد قبل أن تقضي على من تبقى من أسماء الأصدقاء في قائمة الهاتف أو الفايسبوك أوالحيّ، في أكبر عملية لمسح جغرافيا النتوءات الاجتماعية والذهنية التي تحولت هي الأخرى إلى جنازات جعلت من تبقّى يدفنون كل يوم جزءاً منهم في ما يشبه أسطورة جديدة في مهارات الفناء!
وإذا حسبنا أنه إلى جانب كل خراب أو قتل، يوجد نص كامن في الظل، يمكننا أن نتخيل تلك اليوتوبيا الخرافية التي اخترعها شعراء في موازاة تراجيديا الفداحة. على الأقلّ، كي يتمكنوا من الاستمرار فوق خطّ الموت، وبأقلّ ما يمكن من حياةٍ راحت تتقلص وتنحسر لصالح دراكولا تناسل وأنجب أطفالاً شرهين بكامل معداتهم ومسوغاتهم لتظهر الحرب في حقيقتها كأنها نص مقابل نص أو نصوص مقابل أخرى. نصوص مدعومة بكل الماورائيات و«الأماميات»، وأخرى غير قادرة سوى على استخدام كاف التشبيه وحروف العطف. تلك المنازلة غير المتكافئة من حيث الخسائر والفتك، ولدت على الجانب الآخر قبائل من الأشعار والروايات التي تنمو ببطء في شهيق الحرب من دون أن يجرؤ على إعلانها أحد إلا في ما ندر. حرب موازية أيضاً حتى على صعيد المصطلحات، راحت تنشأ بين ما يسمونه مثقف الداخل والخارج حول سلامة المفردة. هل نسمي هذه حرباً أم مؤامرة، أم إنها ثورة انعطفت وضلت طريقها لينكشف المشهد على مكنات تعمل ليل نهار على رفد ذلك الأوار بالبنزين اللازم ليبقى مشتعلاً حتى لو وصل الأمر إلى هدم المعبد وقتل الآلهة وتدمير المسرح مع الجمهور؟
من المؤكد أن أحداً من السوريين لن يشعل شمعة الحرب في سنتها الثالثة، أو يغني «سنة حلوة يا جميل». اللهم إلا إذا تحدثنا عن المسترخين في أكناف البذاخة والعيش الرغيد الذين تحولوا إلى معلقين في مباريات عالمية لا يعنيهم فيها سوى أن تستمر بأشواط إضافية ما دام وابل الأهداف يخترق شباكاً أخرى، خصوصاً إذا كان تمديد المباراة يعني مزيداً من السمسرة وقبض الأموال والتهام البوشار آخر السهرة أمام شاشات التلفزيون. والأسوأ في كل ذلك ربما، هو مجموعة السطوات التي ولدت في هذه المرحلة وشكلت عبئاً على المثقف إذا فكر أن يغرد خارج حماسة «استاد» الجمهور. الحرب التكنولوجية شحذت سكاكينها في العتم سلفاً، وهي جاهزة للانقضاض على صاحب الدريئة إذا تورط وأطل برأسه أمام المدى المجدي لسلاح المنهمكين بالتصفيق على المدرجات أو داخل الملعب. المطلوب هنا، أن تشارك ولو بشتيمة أو تخوين تسوقه عبر تعليق صغير مثل الأوراق الثبوتية أو الكفارة التي تبقيك إلى حين في مأمن من الطعن علناً في الصدر! هكذا يبدو الأمر ببساطة كلما ارتفعت حرارة الحرب وتقدمتْ في العمر لتصبح أكثر مهارة في الإلغاء والسفك. كأن عملية تحويلك إلى نص مهادن متواطئ وهزيل، مسألة لا يختلف عليها أحد سوى في الملكية النهائية التي ستؤول إليها قصيدتك إذا افترضنا أنك شاعر أو مسرحيّ أو مدمن طواحين هواء!
كبرت طفلة الحرب، وتحولت إلى أرشكيجال ضخمة على باب العالم السفلي، في يدها منجل هائل تقطر منه الدماء، وفي عينيها موت سحيق يلتهم كل شيء. هكذا هو المشهد، حتى تصدق الأسطورة فيزهر أمل ولو هزيل في حقول الدم!
* شاعر سوري
سوريا.. والحرب المفتوحة!/ غازي العريضي
اليوم، تدخل الحرب السورية عامها الرابع. بدأت انتفاضة سلمية قادها رجال من درعا استنكاراً ورفضاً لسياسة النظام واعتقال أطفال وتعذيبهم وسحب أظافرهم، ثم إهانة أهلهم وشيوخهم وكبارهم الذين جاؤوا للبحث عن تسوية تحفظ كرامة وعادات وتقاليد متوارثة منذ عقود من الزمن.
النظام لم يحاسب ولم يعاقب، بل قتل بعدها أطفالاً، واعتقل متظاهرين في عدد من المدن وأصرّ منذ البداية على اعتبار أن ثمة مؤامرة، وأن الضرب بيد من حديد والتشدّد الأمني، هما الحل والخيار الوحيدان. توسعت دائرة الاعتراض والانتقاد وعمّت المواجهات المحافظات المختلفة حتى تحولت إلى حرب حقيقية. ومع الوقت باتت الحرب، حرب الحروب. حرب الدول والأمم، والمحاور، والمخــــابرات، والأحزاب، والحركات، والعصابات، والحسابات المختلفة في القرى والمدن، وفتحت الحدود لكل أشكال التدخل وأخطرها وصول متطرفين وإرهابيين من كل حدب وصوب، بعد أن عمل النظام على إطلاق سراح عدد من هؤلاء من السجون لاستخدامهم في الداخل ولاقاه في ذلك النظام العراقي الذي أطلق بدوره إرهابيين من سجون مختلفة وأرسلهم إلى سوريا، مما أفاد النظام في استغلال هذه المسألة، لتأكيد زعمه من الأساس بأن المسألة ليست مسألة تغيير وإصلاح تطوير وحقوق شعب وديموقراطية وحرية، بل ثمة إرهابيون يريدون تخريب سوريا وإسقاطها! وهذا العنوان عمل عليه من الأساس واستدرج دولاً كثيرة إليه باتت تخشى عودة من صدّرتهم إلى سوريا، أو جاء من دون علمها إليها للمشاركة في «الجهاد»، وتنفيذ عمليات «إرهابية» على أرض بلاده!
استعراض السنوات الثلاث الماضية يحتاج إلى صفحات كثيرة، لكنني أتوقف اليوم عند الأدوار الأساسية في الحرب، والاستحقاقات المرتقبة فيها، وتعثـّر الحل السياسي، ولعبة الدول المؤثـّرة.
الأميركيون اندفعوا في البداية ضد النظام، اعتبروا أنه فقد شرعيته وأن على رأسه الرحيل، وصوّروا موقفهم دعماً للمعارضة بكل الأشكال، وهذا ما لم يتم، بل أقلعوا عن الدعم تحت عناوين مختلفة أهمها خشيتهم من وصول السلاح إلى القـوى المتطرفة، وهم لم يقدموا دعماً يذكر للمعارضة قبل ظهور المتطرفين! ثم ذهب الأميركيون إلى اتفاق مع الروس على الحل السياسي، الحل الوحيد الممكن، وانطلق الطرفان من المعادلة التالية التي لا تزال ثابتة حتى اليوم. الأميركيون يقولون: بدء العملية السياسية ليس مشروطاً بتنحيّ الأسد. والروس يؤكدون: انتهاء العملية السياسية ليس مربوطاً ببقاء الأسد. يعني يرحل الأسد عندما تنتهي العملية السياسية، يعني عندما نكون قد اتفقنا، وحتى الآن لم يحصل الاتفاق. لأنه ليس اتفاقاً على سوريا فحسب، إنما يشمل قضايا وملفات كثيرة عالقة بين الطرفين، وهي مرتبطة ببعضها البعض، وجاء الوضع في أوكرانيا ليزيد الأمور تعقيداً.
أميركا اليوم لا تدعم المعارضة، لا تدعم أي تحرك عسكري، لاتسلحّ، بل تسلّم بأولوية مكافحة الإرهاب، تختلف مع الدول العربية الحليفة التقليدية، وهذه الدول تختلف في ما بينها، أميركا تذهب إلى إيران تتفق معها، يتأخر التنفيذ بسبب الضغط الإسرائيلي رغم التزام إيران بكل ما تم الاتفاق عليه، إسرائيل تريد الابتزاز في كل اتجاه، هي المستفيد الأول من كل ما يجري في سوريا وفي المنطقة.
سوريا تدمّر جيشها ينقسم، وصورته تهتز، عتــــاده يستخدم في حرب داخلية، سلاحه براميل فوق رؤوس الناس، ملايين المشردين واللاجئين والنازحين في الداخل وإلى الخارج. اليونيسيف تتهم النظام، تحمله مسؤولية الأوضاع الإنسانية وواقع الأطفال وسياسة التجويع، التقارير المنشورة عن ما يتعرض له النساء في السجون والشوارع مرعبة. اغتصاب الفتيات والنساء أمام أزواجهن وأولادهن بعد التعذيب ومعلومات ومشاهد مقزّزة.
جنيف 2 يفشل، ومجلس الأمن يتخذ قراراً حول الوضع الإنساني وتذهب الدول إلى مناشدة الأسد بالتنفيذ واتخاذ خطوات إنسانية ! عجز كامل، دول تدعو إلى الضغط على الأسد للتنحي وعدم الترشح في الانتخابات، وجيشه يتقدم على الأرض والمعارضة تنقسم على بعضها. تتقاتل فيما بينها وتستمر محاولة التركيز على التطرف والإرهاب وكأن لا معارضة شعبية، أو لا شعب في سوريا، العملية هي فقط مجموعة من الإرهابيين، الذين جاؤوا من الخارج وهم يدمرون سوريا ويهددون أمن الناس ويروعّون الأبرياء ويفرضون نظام قيم غريباً وخطيراً، بعيداً عن حقيقة المجتمع السوري.
هذا جانب صحيح ومؤلم وبشع من المشهد السوري في ضفة المعارضة، لكنه ليس كل الحقيقة، الحقيقة أن ثمة سوريين معارضين مقاتلين ورافضين للنظام ولهذه الممارسات في الوقت ذاته لكن دورهم إلى تراجع بسبب الأخطاء والخطايا التي ارتكبت من قبل ما يسمى المجتمع الدولي والتأخر عن قصد في دعمهم وبسبب السياسات العربية والتركية الخاطئة التي اعتمدت في مواجهة النظام. فعندما يصبح الشأن العام في يد أولاد أو أوغاد أو مراهقين أو متهورين في المعارضة والنظام لا يمكن أن تكون النتيجة إلا على ما هي عليه اليوم.
أميركا، من أوباما إلى كيري إلى السفير السابق «فورد»، الكل يتحدث عن استنزاف روسيا وإيران و«حزب الله» في سوريا، يعني لتستمر الحرب ! وخبراء في الإدارة الأميركية يقولون إنها قد تمتد لسنوات عشر أخرى! روسيا ستتشدد في مواقفها أكثر بعد تطورات أوكرانيا. إيران لم تغير موقفها في دعم النظام وستكون خطواتها أكثر حزماً إلى جانبه مستخدمة حضورها المباشر ودور «حزب الله» اللبناني و«فيلق بدر» وكتائب أبو الفضل العباس العراقية.
إذاً الحرب مستمرة، والدول العربية لم تعد قادرة على التراجع وتركيا تراجع حساباتها، والعرب مختلفون. والذين لا يزالون على اتفاق، الكل يمارس سياسة الهروب إلى الأمام. يريدون إسقاط بشار وقد سقطوا في وحول سوريا من جهة ويخشون الإرهابيين من جهة أخرى وبشار يستفيد. وهو سيترشح للرئاسة بعد أشهر قليلة وسيكون رئيساً رغم كل ما يُقال مسبقاً عن الانتخابات وظروف إجرائها وعدم شرعيتها ومعنى استمراره. وواقع الحال اختصرته صورة نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية عن مخيم اليرموك. من أفضل اللقطات التصويرية لكنها الأكثر إيلاماً، الألوف محشورون في شارع ينتظرون فتات مساعدات لم تأت بعد أن مات قسم من الناس جوعاً ولم يجد كلاباً أو أعشاباً لأكلها.
سوريا في السنة الرابعة من الحرب تتجه إلى مزيد من الخراب والدمار والحقد والقتل، ساحة تبادل رسائل وتصفية حسابات.
«ما أحمله إليكم أخبار غير جيدة عن سوريا، حيث فصيل من (القاعدة) يواجه فصيلاً آخر من (القاعدة) أيضاً. الوضع منقسم إلى هذه الدرجة. شظية حادة مقابل شظية حادة أخرى ». هكذا اختصر «روبرت فورد» السفير الأميركي السابق لدى سوريا، المشهد منذ أيام، الذي لطالما قدّم نفسه بطلاً داعماً للمعارضة على الأرض السورية مباشرة! لا يرى معارضة شعبية ديمقراطية، بل الكل قاعدة ! وخطر التقاتل والعنف والإرهاب الذي ستصل شظاياه إلى كل الإقليم واضح.
الرئيس الأميركي يتحدث عن «عقلانية وهدوء وقوة إيران التي لا تقدم على الانتحار بل تتجاوب مع الحوافز. الإيرانيون لديهم استراتيجية. لا يتصرفون بردّات الفعل، لديهم رؤية عالمية، يستطيعون أن يروا أين موقع مصالحهم، يتجاوبون مع الثمن والمنفعة»! يقول ذلك قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية. سبحان مغيّر الأحوال. يكفي أن نقرأ هذا الكلام لنعرف رأيه بالعرب الذين لا يزالون تحت الصدمة، ويتصرفون بردّات الفعل وانقساماتهم كبيرة وخطيرة، وأميركا ليست بعيدة عن الأسباب والحوافز!
مقبلون على أشهر صعبة في سوريا التي منذ ثلاث سنوات قلنا إنها دخلت في دائرة البازار الكبير، سنرى المزيد من التصعيد والتعقيد والدم والقتل والنار المشتعلة في كل اتجاه والبراميل المتفجرة في كل الساحات، والمزيد من المهجرين والمعذبين والمشردين، والانتخابات الرئاسية التي ستأتي بالأسد رئيساً مرة جديدة !
لم يأت أوان التغيير بعد، لابدّ أنه آت. متى؟ لا أدري، طويلة هي الحرب، لكن عندما يأتي سيكون في النتيجة على خراب سوريا ودمارها والكوارث المرعبة وعلى حساب وحدتها المهدّدة.
الاتحاد
أزمة سوريا في سنتها الرابعة: مراجعات عربية مطلوبة/ عبدالوهاب بدرخان
تفرض الأزمة السورية على العرب، وهي في بداية سنتها الرابعة، إجراء مراجعات عدة: لطريقة تعاملهم معها، لأسباب فشلهم في حلّها، ولمستقبل المشرق العربي في السيناريوهات المتصوَّرة لنهايتها. ولعل المؤكد الآن أن هذه الأزمة مرشحة لأن تطول إذا لم يتمكّن أي من الطرفين من حسم الصراع عسكرياً، علماً بأن هذا النوع من الحسم إذا توفر فإنه لا يشكّل حلاً في حد ذاته. وقد سبق للقوى الخارجية، بما فيها تلك الداعمة وغير الداعمة للمعارضة، أن حذّرت من انتصارها ومن إسقاط النظام عسكريا لأن هذا يعني في نظرها أمرين: مذابح طائفية مهولة، وانهيار الدولة ومؤسساتها خصوصاً الجيش والأمن. وكان هذا الموقف الافتراضي مفهوماً باعتباره «أخلاقياً» و «مسؤولاً»، إلا أنه لم يُقابَل بمواقف مماثلة من الدول الحليفة للنظام، روسيا وإيران والعراق، التي دعمته في كل ممارساته الفعلية (وليس الافتراضية) من المجازر الطائفية، إلى تدمير كارثي للمدن والحضارات الإسلامية التاريخية، إلى القصف بالسلاح الكيماوي وصواريخ «سكود» الاستراتيجية والبراميل المتفجّرة.
في الأساس لم يكن النظام يعوّل على دور عربي أو دولي، بل على تحالفه مع إيران التي تضامنت معه ضد «المؤامرة» منذ اللحظة الأولى، ومن ثم على تحالف كان موجوداً لكنه استطاع بلورته وتركيزه بعد ستة شهور من بدء الأزمة، أما العراق فالتحق في سياق تبعية حكومته لإيران. واستناداً إلى هذه المعادلة راح يتعامل مع المبادرة العربية أولاً (2011)، واضعاً شروطه التي كان واضحاً أنها ترمي إلى تطويع تلك المبادرة وتوظيفها في خططه لقمع الحراك الشعبي -السلمي آنذاك- بل إن النظام اعتبر التحرك العربي موجة هجومية أولى من «المؤامرة» الخارجية. وما لبث أن تصرّف بالمثل مع خطة كوفي أنان (2011) التي كانت «الموجة الثانية» بالنسبة إليه وانتهت باستقالة الوسيط الدولي- العربي لكن بعدما زرع «بيان جنيف» كمعلم ومنارة للباحثين عن حل سياسي للأزمة. وبذلك أحبط النظام التعريب والتدويل بمفهوميهما التقليديين، ثم توصل أخيراً بتواطؤ مع روسيا إلى إفشال «التفاهم» أو بالأحرى «اللاتفاهم» الأميركي- الروسي (2013) الذي لم يسقط فحسب بل غرق في لجّة الأزمة الأوكرانية المستجدّة. ويستدلّ من تقويم الأخضر الإبراهيمي أن مفاوضات جنيف باتت في خبر كان.
الأسوأ أن النظام لم يطرح، طوال الأعوام الثلاثة، ولاسيَّما في العام الأول، أي مبادرة لحل داخلي ذي مصداقية يمكن للقوى الخارجية أن تدعمه وتشجعه، رغم أنها كانت تحضّه جميعاً، بما فيها الولايات المتحدة، على أن يحدد الحل «ويقوده». غير أنه فهم هذه الإشارات بأنها تأييد لبقائه، وبالتالي تأييد لنهجه العنفي. ولا مبالغة في القول الآن، بعد ثلاثة أعوام وحصيلتها البشرية والعمرانية المأسوية، أن النظام برهن أنه مجرد «آلة قتل» وأنه فعل ويفعل الشيء الوحيد الذي يتقنه، لكن «انتصاره» العسكري المفترض لن يعني إطلاقاً نهاية الأزمة، التي ستبقى مفتوحة على احتمالين: صراع مسلّح مستديم، وحل سياسي ينتظر توافقاً دولياً ربما في إطار مساومة كبرى تتناول أوكرانيا ثم سوريا، علماً بأن بلورة مثل هذا التوافق ستحتاج إلى وقت.
أما المراجعات العربية المطلوبة فيفترض أن تجيب عن الأسئلة الوجودية والاستراتيجية التي طرحتها هذه الأزمة. ذاك أن أمامهم نموذج لصراع داخلي مدوّل يمكن أن يؤدي تهاون المجتمع الدولي وعجزه إلى انتهائه بانكسار للشعب، أي إلى نهاية ضد منطق التاريخ والإنسانية، بما يعنيه ذلك من تداعيات مستقبلية ليس داخل سوريا فحسب بل في عموم المنطقة. ولعل هذه أهم هذه التداعيات في حال توصّل النظام والسوري وحلفائه من فرض حل عسكري:
أولاً– سينشأ في المنطقة العربية وضع تترسّخ فيه بالقوة «شرعية» الأنظمة الفئوية بما تفترضه من حكم الأقلية للأكثرية، بل «تتشرعن» فيه الصراعات المذهبية بحكم الأمر الواقع والضرورة. وإذا كان صعود التيار الإسلامي فرض إشكالية على أنظمة الدول التي تشهد تحوّلات، فإن «انتصار» النظام المذهبي الأقلوي بدعم من قوة دولية وأخرى إقليمية سيديم العالم العربي في حل «الرجل المريض» لسنوات طويلة مقبلة.
ثانياً– ستكون لهذا المعطى، إذا فرض نفسه في سوريا، انعكاسات سيئة على تشكّل النظام العراقي الذي لا يزال في مرحلة انتقالية يراد لها أن تبلور غلبة مذهب على آخر، فضلاً عن انعكاسات سلبية أيضاً على النظام اللبناني الذي تعرّض لهزّة خطيرة بفعل قتال «حزب الله» في سوريا، ولن يكون الأردن والفلسطينيون بمعزل عن المخاطر لأن إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان إلى استغلال التأزم لفرض «الخيار الأردني» كإطار لحل القضية الفلسطينية.
ثالثاً– بما أن هذا الوضع لا يعيد الاستقرار ولن يكون قابلاً للإدامة فإن الحلول التي ستطرح نفسها ستنزلق تلقائياً إلى إعمال السكاكين في الخرائط، بحثاً عن تقطيعات وتقسيمات يمكن أن تضمن شيئاً من التجانس والوئام. وبما أن هذه العملية لن تتم إلا بـ «عناية» دولية فإن المستفاد من تقسيمات القرن الماضي على أيدي الدول الاستعمارية -وهي نفسها التي زرعت إسرائيل في قلب العالم العربي- أنها لا تحرص على السلام مقدار حرصها على ضمان مصالحها واستمرارها في استتباع الكيانات التي تنشأ.
رابعاً– سينعكس الوضع السوري أيضاً على مسار التحوّلات في البلدان التي مرّ بها «الربيع العربي» أو تلك التي لا تزال تقاوم «ربيعها» الحتمي، وهو سيؤثر استطراداً في إنهاض النظام العربي من عثرته وإعادة بنائه، وهذه عملية باتت تواجه منذ الآن واقع الاختراقات التي تعرضت لها المنطقة وتنازع الدول الثلاث (إيران وتركيا وإسرائيل) على النفوذ فيها.
العرب
على عتبة العام الرابع من الثورة السورية/ لؤي صافي
تدخل الثورة السورية خلال أيام عامها الرابع من الكفاح من أجل الحرية والكرامة، وآفاق الحل السياسي للصراع الدموي في البلاد ما زالت مجهولة، ومعاناة الشعب السوري تزداد حدة يوما بعد يوم. ثمن الحرية والعدالة التي طالب بها السوريون مرتفع، بلغ حتى الآن أكثر من 140 ألفا من الشهداء حسب أكثر الإحصائيات تشددا، وأكثر من 180 ألفا من المفقودين، وملايين من النازحين واللاجئين والمنازل والبنى التحتية المدمرة، وكم لا يحصى من المعاناة والألم وضياع في الإنتاج، وتراجع في الحياة التعليمية والإنتاجية والثقافية.
مؤتمر جنيف الثاني حول سوريا، الذي أعطى الكثير من السوريين أملا بالوصول إلى حل سياسي، انتهى إلى طريق مسدود بعد أن رفض النظام تنفيذ الخطة التي وضعها بيان جنيف والتي تبدأ بتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية. ممثلو النظام تذرعوا برغبتهم في تطبيق بيان جنيف بندا بندا وادعوا أن البند الأول هو محاربة الإرهاب. البند الأول من بيان جنيف لا يشير من قريب أو بعيد إلى موضوع الإرهاب، ولكنه يتحدث عن وقف العنف في البلاد بالتزامن مع فك الحصار عن المدن وإعادة الجيش إلى ثكناته. بند وقف العنف من بيان جنيف الذي تشبث به ممثلو النظام بعد أن سموه بند محاربة الإرهاب هو البند الأول من النقاط الست التي حملتها مبادرة كوفي أنان في منتصف عام 2012 وقبلها النظام حينذاك، ولكنه لم يعمل بها، كما بين كوفي أنان قبيل استقالته في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المساهمون في مؤتمر جنيف الأول أدركوا، بعد محاولات كثيرة سبقته لوقف الاقتتال وإنهاء الصراع الدموي، أن نظام الأسد غير معني بحل الأزمة سياسيا ولذلك حددوا خطة عملية لإنهاء الصراع تبدأ بتشكيل هيئة حاكمة انتقالية يتم اختيار أعضائها بالتوافق بين الحكومة والمعارضة، وتكلف العمل على تنفيذ النقاط الست والإعداد لدستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة. لذلك أصر وفد المعارضة على مناقشة آليات تشكيل الهيئة الحاكمة بالتوازي مع بحث ملف العنف والإرهاب، ولكن النظام رفض التعاطي مع جدول الأعمال هذا الذي تبناه المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي وقبله وفد المعارضة. وفد النظام الذي لم يكن مخولا من قبل رئيسه بالحديث عن هيئة حاكمة انتقالية اختار الدخول في حرب إعلامية لإخفاء حقيقة موقفه، واتهم وفد المعارضة بالإصرار على البدء بتشكيل هيئة حاكمة سعيا وراء السلطة، متجاهلا أن الهيئة الحاكمة سيتم اختيارها بالتوافق بين الوفدين، وأن أعضاء تلك الهيئة لن يتشكلوا بالضرورة من داخل الوفود المفاوضة.
نظام الأسد أعلن مرارا وتكرارا على لسان رئيسه بأنه لن يدخل في حوار إلا بعد القضاء على «الإرهابيين»، وهو مصطلح يستخدمه النظام للإشارة للثوار الذين حملوا السلاح للدفاع عن مدنهم وقراهم وأحيائهم ضد هجمات قوات النظام المكونة من قوات النخبة ذات التركيبة الطائفية داخل الجيش ومن الفصائل الشيعية المتحالفة مع النظام. وبينما تجاهل النظام القوة الإرهابية الحقيقية في سوريا، كداعش وفصائل أبو الفضل العباس، واختار الدخول معها في تحالفات استراتيجية، بل والتنسيق تكتيكيا في بعض المعارك كمعركة أعزاز، واجهت قوى الجيش الحر هذه التنظيمات الطائفية الدموية التي تقاتل بعقيدة البعث فتبيح تصفية المعارضين والخصوم السياسيين، ولكنها تختبئ خلف شعارات وادعاءات إسلامية تلتزم ببعض أشكال الإسلام التاريخية، بينما تتعارض كليا مع روحه السمحة وقيمه الإنسانية السامية.
سعي النظام للوصول إلى حسم عسكري وهم كبير وسعي وراء سراب، فالحل الوحيد الممكن في سوريا اليوم هو الحل السياسي الذي يحقق أهداف الشعب في المشاركة السياسية وحرية الرأي والتنظيم وبناء دولة القانون التي تسمح بمساءلة القيادات السياسية وتحقيق العدالة. قيادة النظام التي استخدمت كل الأدوات المتوفرة لديها، من أمن وجيش واقتصاد، للبقاء في السلطة عملت على تدويل الصراع بالاعتماد على ميليشيات لبنانية وعراقية وإيرانية ذات هوية طائفية واضحة. ومع تزايد حجم وجود قوى خارجية على الأرض السورية، والاعتماد على دعم مالي وعسكري خارجي متزايد، وحصول النظام على الكميات الأكبر والنوعية الأفضل من هذا السلاح، تراجع القرار الوطني، وانتقل التأثير إلى القوى الإقليمية والدولية الفاعلة على الساحة السورية والمتدخلة في الشأن السوري. سوريا اليوم مستباحة إقليميا ودوليا، وحديث النظام عن سيادة وطنية يأتي من باب ذر الرماد بالعيون. فالنظام كالمعارضة يعتمد اليوم على دعم إقليمي ودولي لمواجهة الطرف الآخر، والطريقة الوحيدة لعودة السيادة إلى السوريين هي الوصول إلى حل سياسي بين الأطراف السورية المتنازعة، وبالتالي القبول بتشكيل هيئة حاكمة انتقالية بكامل الصلاحيات، تعمل على إنهاء الاقتتال وبدء العملية الانتقالية نحو نظام جديد يحقق سيادة الشعب السوري.
الخيارات المتوفرة أمام السوريين أصبحت اليوم واضحة: إقامة دولة المواطنة التي تحترم حقوق السوريين بكل مكوناتهم، والتي تعمل على إعادة إعمار سوريا وتحويلها إلى دولة ناهضة، أو الاستمرار في صراع عسكري يمكن أن يمتد إلى عقد من الزمن، تتحول فيها سوريا إلى دولة فاشلة شبيهة بالدولة الأفغانية أو الصومالية. ولأن الخيارات واضحة فإن السوريين مطالبون اليوم باتخاذ القرار الذي يمنع انهيار دولتهم، ويعينهم على إقامة دولة ناهضة تحمي أبناءها وتسمح لهم بالعمل لبناء حياة كريمة لهم وللأجيال القادمة، وبالتالي الإصرار على الوصول إلى حل سياسي وفق إطار بيان جنيف.
السوريون مطالبون باتخاذ القرار الذي يمنع انهيار دولتهم ويعينهم على إقامة دولة ناهضة تحمي أبناءها، وتسمح لهم بالعمل لبناء حياة كريمة لهم وللأجيال القادمة. وهذا يتطلب تغييرا جذريا في الطروحات المتداولة ضمن دوائر السلطة والمعارضة. في دوائر المعارضة، يجب على كل القوى الثورية والسياسية الالتزام بالرؤية الأساسية التي اجتمعت حولها قوى المعارضة، وحظيت بدعم دولي واسع، والمتمثلة بقيام دولة المواطنة التي تحترم الحقوق والتعددية السياسية والدينية داخل البلاد. وهذا يعني أن على القوى الثورية والفصائل الإسلامية الالتزام بهذه الرؤية الجامعة التي تتفق من حيث المبدأ مع قيم الإسلام المؤكدة على الحرية الدينية والشورى واحترام الخلافات العقدية. أما في دوائر السلطة، فإن المطلوب التخلي على مفهوم دولة الأسد، والزعيم المتعالي عن المساءلة والمحاسبة، وإنهاء نظام الأسرة التي اختطفت الدولة خلال العقود الماضية، والقبول بعملية التحول السياسي، الذي يسمح بظهور قيادة سياسية جديدة يتم تمثيلها في هيئة حاكمة انتقالية تتمتع بدعم أطياف الشعب السوري جميعا.
* عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والناطق الرسمي باسمه
الشرق الأوسط
سوريا.. سنة أخرى من الثورة/ عمر كوش
الأسطورة المؤسسة
تحولات مسار الثورة
تعقيدات كثيرة اعترت الأزمة السورية، مع إكمال الثورة السورية عامها الثالث، ودخولها العام الرابع، حيث بات من الصعب استشراف المسار الذي ستتخذه الثورة، خاصة مع سيادة حالة من الاستعصاء على المستوى العسكري، بالتزامن مع حالة من الانسداد على المستوى السياسي.
الأسطورة المؤسسة
مع وصول الأزمة، التي سببها تعامل النظام مع غالبية السوريين، إلى درجة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، فإن قوى ما يسمى “المجتمع الدولي”، لم تقدم للسوريين سوى وعود فارغة، بعد أن حصرت مراهنتها على وهم حل سياسي، يمكن أن يقدمه مؤتمر جنيف2 الذي فشل قبل انطلاق عجلة مفاوضاته.
واتضح للعالم أجمع أنه ليس هناك من جماعة النظام، من هو صاحب إدارة سياسية، أو من يهمه إيقاف سيلان نهر دماء السوريين، بل إنهم مجموعة من المتعطشين للدماء، وثلة من المتغطرسين والمدجنين في بوتقة نظام فاشي، يستند إلى أسطورة، تنهض على سردية ثأرية غابرة، ويستقوي على العزل بعصبية طائفية بربرية، شعارها الأساس هو الموت أو الخضوع.
وبعد ثلاثة أعوام، مازال نظام الأسد الفاشي يوغل في القتل، وعلى مرأى من العالم، لذلك يصعب على كثيرين استيعاب هذا الكمّ من العوامل الدولية التي لعبت ضد الشعب السوري وقضيته، حيث تشير كل المؤشرات الحالية إلى أن القوى الدولية لا تأبه بالكارثة السورية، ولا يعنيها طول أمد الصراع.
وبالتالي لا جدوى من المراهنة على الإرادة الدولية، كونها تقوم على معايير غير إنسانية، تأخذ في الحسبان اعتبارات المصالح وحسابات الربح والخسارة، ولا تعير أي اهتمام للأخلاق أو القضايا الإنسانية، بالرغم من أن الثورة السورية بدأت سلمية، وبقيت كذلك أشهرا عديدة، بالرغم من التعامل الفاشي معها، وباتت غالبية السوريين تشعر بأنها يتيمة ووحيدة، ولم تجد سوى أن تضع دمها على كفها، ماضية في طريق الخلاص، الذي لا رجعة فيه.
وفي الوقت الذي تنأى به إدارة الرئيس الأميركي عن فعل شيء، إزاء الكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب الشاملة للنظام ضد الثورة وحاضنتها الاجتماعية، فإن كل شيء بات مباحا دوليا، أو -على الأقل- مسكوتا عنه، ووصل الأمر إلى درجة استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين من الأطفال والنساء والرجال، في أكثر من موقع وواقعة، ولم يكتف النظام بذلك كله، بل راح يسوق لأيديولوجية متغطرسة تبرر إجرامه وإرهابه، وتضعهما في مصاف الأمور الطبيعية، وفق معيارية فاشية، تمتد جذورها داخل نسق طائفي مقيت، وأبعاد أخلاقية مولدة له.
ووسط ردود الفعل الدولية البائسة ضده، راح حاكم دمشق، يتشدق بكلمات عن الشرعية والأحقية في الحكم، معتبرا حفظ أمنه وأمن عصابته، من أمن الدولة والاستقرار والوحدة، بوصفه يجسد الدولة في شخصه، في مواجهة المؤامرات والمكائد الداخلية والخارجية، حتى تحول الأمر لأسطورة مؤسسة لنظام الأسد الفاشي.
ويدرك غالبية ساسة العالم وصناع القرار فيه، حجم وهول ما صنعه الفاشي من فظائع خطيرة، وليس ذلك وحسب، بل إنه حوّل سوريا إلى مرتع للمجموعات الإرهابية، التي تتخذ من الإسلام يافطة، بغية الوصول إلى دويلاتها وإماراتها.
وأضحى السوريون تحت وطأة وحشية مزدوجة، وحشية هذه المجموعات الإرهابية، ووحشية النظام، الذي يفاخر بأيديولوجيته المقيتة، وعصبيته الذميمة، وسياسته الطائفية الغادرة، وخطاباته المنفلتة من أية عقال، ومواقفه المتهورة، التي انصبت على محاولات إثارة الحرائق في دول المنطقة، خلال السنوات الثلاث الماضية، وما يزال ماضيا في أفعاله دون أي رادع، بل إنه وجد في ملالي إيران وساسة موسكو وصفاء له، ومدافعين عنه، وداعمين له بكافة الوسائل المادية والعسكرية والسياسية.
إن كل سوري عانى، منذ أكثر من أربعة عقود، من مظاهر الفاشية الأسدية، بنسختيها، الأب والابن، حيث كان يُفرض -وما يزال- على الصغير والكبير إثبات خنوعه وولائه وتبجيله للقائد الأوحد، وظل الله على الأرض، والمعلم الأول، الملهم الأول، والفارس الأول، والفريق الأول، والأب القائد، الذي يختصر كلا من الدولة والوطن في شخصه الأوحد، والويل الويل لمن يجرؤ على المسّ به، من قريب أو حتى من بعيد.
إنه الفاشي الأول والأوحد، الذي ربط مصير سوريا كلها بمصير بقائه حاكما أوحد، وليس لديه أي شك في أنه سيدمر سوريا إن أحس بأن كرسي حكمه سيفلت من بين يديه.
ولا شك في أن العالم ليس بحاجة إلى أدلة وإثباتات وقرائن على فاشية النظام الأسدي، ولن يكون آخر القرائن صور جثث أحد عشر ألف معتقل، عذبوا حتى الموت في زنازين وأقبية استخبارات هذا النظام، بوصفها فظاعات باتت تضاهي فظاعات النظام الفاشي النازي، ملهم النظام الأسدي وقدوته ومثاله الأول.
وإذا كان السوريون تركوا وحدهم في مواجهة فظاعات هذا النظام، فإن المراهنة على إرادة دولية لإيقاف جرائمه تبدو مراهنة فارغة، بعد ثلاث سنوات من عمر الأزمة السورية، فيما الثابت هو أن كل دول العالم متفقة على تقنين الدعم للثورة السورية، وعدم مدّها بالسلاح النوعي، الذي يمكنه أن يحدث توازنا في القوى.
هذا في وقت تُرك فيه النظام، ينفذ ما يحلو له من خطط، واستخدام لأسلحة مدمرة، بواسطة الطائرات والدبابات والمدافع، حيث تنهمر براميل الموت والصواريخ والقنابل يوميا على كافة المدن والبلدات السورية، ولا مانع لدى النظام من أن يعيد سيطرته على مدن وبلدات وقرى فارغة من سكانها، فهم ليسوا بشرا في معياريته الفاشية.
تحولات مسار الثورة
لعل التحول الأول على مسار الثورة، طرأ نتيجة اضطرار قسم من شبابها، الذين شاركوا بشكل أو بآخر في حركة الاحتجاج السلمي العام، الذي شمل معظم المناطق السورية، إلى حمل السلاح، ليدخلوا في حرب غير متكافئة مع النظام الأسدي، بعد إعلانه الحرب على المتظاهرين السلميين وعلى حاضنتهم الاجتماعية، وخوضه حربا شاملة مدمرة ضد غالبية السوريين ومناطق سكناهم.
وهو الأمر الذي أفضى إلى تراجع المظاهر المدنية السلمية التي أسست للثورة السورية، حين كان المتظاهرون يوزعون التمّر على الجنود، ويحملون الورود وأغصان الزيتون في مواجهة رصاص قوى الأمن والشبيحة.
وكانت صور اللافتات، في مرحلة التأسيس للثورة، تجمع بين الهلال والصليب، وتساوي ما بين السني والعلوي والدرزي والإسماعيلي، وبين العربي والتركماني والكردي.
وهي صور مازالت ماثلة أمام الأذهان، وتختزنها ذاكرة الثورة، وكلنا يذكر شعار “واحد واحد واحد.. الشعب السوري واحد”، الذي صدحت به حناجر المحتجين في معظم المناطق الثائرة.
غير أن التحول في مسار الثورة استحال إلى حرب حقيقية، أزاحت المظاهر السلمية لتظهر مشاعر الكراهية والانقسام، وصعدت مظاهر العسكرة من خلال تسلح مجموعات عسكرية وأهلية، وخاصة في الريف السوري، حيث إن أفراد عائلات بلدات وقرى كثيرة جنّدت شبانها ورجالها من أجل الدفاع عن حياتهم وأماكن سكناهم، لكنها أدخلت أيضا نفسا من الكراهية وروحية الانتقام من الآخر.
وراحت المجموعات العسكرية غير المنظمة تبحث عن موارد تسليحها وعيشها بشتى الطرق، المشروعة وغير المشروعة، خاصة مع انعزال معظم الضباط الذين انشقوا عن الجيش النظامي وآثروا اللجوء إلى تركيا والأردن وسواهما من البلدان.
ولعب الدعم الخارجي، المنحاز وغير المنتظم، الذي تلقته المجموعات والفصائل المسلحة، دورا في تعدد ولاءاتها وتناثرها، وقد ارتاب سوريون كثر من الأجندات التي تهدف إليها الدول الداعمة، بوصفها كانت عاملا رئيسا في إشاعة فوضى السلاح والتسلح، وإطلاق اللحى والذقون.
وإذا كان لا بد من العسكرة والتسلح غير المنتظم، بوصفهما من مظاهر رد الفعل الأولية والطبيعية على جرائم وهمجية النظام الفاشي الأسدي، لكنها -مع الأسف- لم تتحول إلى فعل مقاومة منظم ضد استباحة النظام للمدن والمناطق والقرى السورية، بالرغم من أن خصوصية الثورة السورية وفرادتها، تستلزم مقاومة منظمة، متعددة المظاهر والفعاليات.
ويتأكد ذلك أكثر إذا تذكرنا أن سوريا اليوم، تخضع لآثار احتلال مركب: احتلال داخلي، ممثلا بالنظام الفاشي الذي احتل البلد منذ أربعة عقود، واحتلال خارجي، تجسده فصائل إسلامية متشددة وخبراء إيرانيون ومليشيات حزب الله ومليشيات عراقية وغير ذلك.
وبالتالي، باتت الثورة السورية توجه نظاما، يعتبر نفسه قوة احتلال، واستدعى قوات احتلال أجنبية، كي تساعده وتخوض المعارك معه ضد الشعب.
وعشية دخول الثورة السورية عامها الرابع، ما يزال المدنيون السوريون مستمرين في فعل مقاومتهم، فيما تبدو بعض الفصائل المسلحة بعيدة كل البعد عن فعل المقاومة، بمختلف مظاهرها.
ولعل العسكرة المنفلتة من رباطها وعقالها، أنتجت مظاهر و”هيئات شرعية” و”إمارات”، بعيدة كل البعد عن أهداف الثورة السورية ومطالب ناسها، فالناس في الثورة أحسوا بأنهم أحياء، حين قرروا الخروج من بيوتهم والنزول إلى الساحات والشوارع للاحتجاج على الاستبداد المقيم منذ أكثر من أربعة عقود.
لقد خرج غالبية السوريين طلبا للحرية واسترجاع الكرامة، ولوضع حدّ لليأس والذل والخنوع، وتحملوا لأجل ذلك كل أنواع القذائف والقنابل والرصاص التي مازالت تنهمر عليهم، وتخطف أرواحهم.
لذلك، من الطبيعي أن يشعر الثائرون السوريون بأن حياتهم أضحت ذات معنى في الثورة، وأن كل فرد فيهم يمتلك ذاتا، شعر لأول مرة في حياته بقيمتها في ميدان التظاهر والاحتجاج، فقرروا جميعا عدم التراجع أمام إمعان النظام في القتل والمجازر، بل وأظهروا قدرة لا توصف على التحمل بالرغم من كل أنواع القصف والدمار الذي لحق بهم وبأماكن سكناهم.
أما بالنسبة للمعارضة السياسية، فإنها لم تثبت خلال السنوات الثلاث الماضية سوى قدرتها على الانقسام والتشرذم والاستعراض، فيما نجح النظام الفاشي في إحداث اختراقات كثيرة.
لكن، ورغم ذلك، فإن قوى الثورة ستظل تصارع من أجل تحقيق آمال الشعب السوري في نيل الحرية والتحرر، والوصول إلى دولة مدنية تعددية، تنهض على مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان.
وإن كان ثمة فعل ضروري ومطلوب من الجماعات المسلحة، فهو الانخراط في صف الثورة، والمشاركة في المقاومة بشكل موحد ومنظم، بغية الوصول إلى سوريا الجديدة، والعمل على الحفاظ على صورة سوريا التاريخية، باختلافاتها وتنوعاتها ومدنيتها.
الجزيرة نت
الثورة السورية تدخل عامها الرابع/ ماجد كيالي
مع دخولها العام الرابع تبدو الثورة السورية الأبهظ ثمنا والأكثر تعقيدا، بين ثورات “الربيع العربي”، وهي أيضا، الأكثر تأثرا من التدخلات الخارجية، والأكثر تأثيرا في جوارها، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.
واضح أن ما يجري في سوريا لم يعد يقتصر على كونه ثورة شعب ضد نظام استبدادي، حوّل البلد إلى “عزبة” عائلية، يتوارثها الأبناء من الآباء، أو ثورة ضد الظلم والفساد وسلب الحريات وامتهان الكرامات، إذ صارت ثمة مستويات أخرى من الصراع في سوريا، وعلى سوريا.
هناك الصراع الإقليمي والدولي في سوريا وعليها، والذي تنخرط فيه العديد من القوى، على اختلاف مواقفها وأجندتها ومصالحها وتوظيفاتها، وهذا لم يعد خافيا على أحد، انطلاقا من حقيقة سياسية مفادها أن سوريا تمثل بلدا “مفتاحيا” في العالم العربي وفي الشرق الأوسط.
في هذا الإطار تبدو روسيا وإيران أكثر دولتين، على الصعيدين الدولي والإقليمي، تدعمان النظام. إذ ترى روسيا في وقوفها إلى جانب نظام الأسد جزءا من معركتها لتعزيز نفوذها كقطب دولي في مواجهة الولايات المتحدة والدول الغربية، ومحاولة لاستعادة مكانتها كدولة كبرى مقررة.
وبالنسبة لإيران فإن سوريا بالنسبة لها بمثابة حجر الأساس في سعيها للحفاظ على مكانتها ونفوذها الإقليميين، من العراق إلى لبنان، ما يعني أن الدفاع عن النظام السوري هو دفاع عن ما تعتبره أمنها الإقليمي ومجالها الحيوي.
طبعا، ثمة دور للقوى الأصغر، التي باتت تضطلع بدور رئيسي في حماية النظام من السقوط، مثل حزب الله في لبنان، وكتائب أبو الفضل العباس وعصائب الحق العراقيتين، وكلها بمثابة مليشيات سلطوية وطائفية (“شيعية”)، تشتغل لذاتها، وكأذرع عسكرية لإيران، في سوريا كما في مجالها الجغرافي والمجتمعي في لبنان والعراق.
في مقابل ذلك تقف الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية والدول العربية (لاسيما الخليجية) التي تدعم سقوط النظام السوري، والتي تشتغل على التأثير في الثورة السورية، والوقائع السورية، لكن مشكلة هذه القوى أنها لا تدعم ثورة السوريين بقدر ما تدعم روسيا وإيران النظام السوري.
كما أن مشكلتها تكمن في أن كلا منها يشتغل بحسب مصالحه وأجنداته، بغض النظر عما يريده السوريون حقا، أو بغض النظر عن المقاصد التي اندلعت من أجلها الثورة السورية.
ومن هذه القوى من يدعم التغيير السياسي في سوريا باتجاه قيام دولة ديمقراطية، ومنها من يحاول أن يحد من عمق هذا التغيير، وضمنه منع امتداد تأثيراته، أو عدواه، إلى محيطه، وربما أن معظم هذه الدول يهمه إضعاف سوريا والانتهاء من دورها الإقليمي.
توجد، أيضا، طبقة صراع أخرى في سوريا، تتمثل في قوى لا دولتية، محسوبة على الإسلام السياسي الجهادي، الذي يتبع منظمة “القاعدة” وتفريعاتها، وهي تشتغل على نحو آخر. فهي مثلا لا تعترف بالحدود الوطنية، ولا بالشعب السوري، ولا بكل ما يتعلق بالديمقراطية، فضلا عن أنها لا تعترف إلا بالمسلمين “السنّة” فقط، لكن ذلك لا يشمل المسلمين عموما إن لم يتبنوا أطروحاتها، ويمنحوا البيعة لأبي بكر البغدادي أمير ما يسمى “الدولة الإسلامية في العراق والشام”!
ومعلوم أن هذه الجماعة، ومثيلاتها، تعتبر أن الصراع في سوريا هو جزء من الصراع العالمي لفرض الإسلام، وإعلاء شأنه، واستعادة دولة الخلافة، فهي لا ترى في الديمقراطية وغيرها إلا مجرد هرطقة ينبغي صدها أو التخلص منها.
ولا شك أن هؤلاء أضروا بالثورة السورية، وبمقاصدها الأساسية، كما أثاروا المخاوف في مجتمع السوريين، بتكويناته المختلفة، فضلا عن أنهم شوّهوا صورة الثورة لدى الرأي العام العربي والدولي.
والأنكى أن هؤلاء لا يعتبرون أنفسهم ضمن هيكلية الثورة السورية من الأصل، ويصرحون علنا بأنهم غير معنيين بأهدافها.
المشكلة أن صعود هذه القوى أثار الشبهات بشأن طبيعة تكوينها، وحقيقة توظيفاتها، وصدقية ادعاءاتها، إذ بدت معادية للثورة أكثر مما هي معادية للنظام.
واللافت أن هذه القوى قدمت خدمة للنظام بإسهامها بترويج ادعاءاتها بشأن أن ما يجري في سوريا ليس ثورة شعبية من أجل الديمقراطية وإنما مجرد هجمة لقوى إرهابية ومجرد مؤامرة خارجية.
وما يلفت الانتباه هو أن ظهور هذه القوى في المناطق “المحررة” حصرا، مع مواقفها المتشددة والغريبة عن نمط عيش السوريين، وممارساتها الشاذة والقاسية ضدهم، في المناطق التي تخضع لسيطرتها، اسهمت في عزلها، وإظهارها بمظهر المساند للنظام، وإن بشكل غير مباشر.
وقد شهدنا أن هذه القوى، المتمثلة بـ “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، دخلت مؤخرا في حرب مكشوفة وشرسة مع جماعات “الجيش الحر”، وحتى مع الجماعات الإسلامية العسكرية الأخرى، في حين أن النظام لم يستهدف البتة هذه الجماعة.
أيضا، فقد شهدت الثورة السورية نوعا من الانقسام والانشقاق فيها، تمثل بظهور قوى دينية، ترى أن الثورة قامت من أجل إقامة نظام إسلامي في سوريا، وما يعزز من نفوذ هذه القوى أنها تتشكل في أجسام عسكرية، توحدت مؤخرا في “الجبهة الإسلامية”.
طبعا ليست المشكلة مع هذه القوى في ما تطرحه، فهذا حقها، لكن المشكلة تكمن في أن هذه القوى تحاول مصادرة مستقبل سوريا وفرض رؤيتها الأحادية على السوريين بقوة الواقع، أو بقوة السلاح.
ومن المفيد أن نذكر هنا أن هذه القوى المحسوبة على الجماعات السلفية تجد نفسها في تعارض مع القوى الإسلامية الأخرى من اليمين واليسار، إن صحّ التعبير.
فهذه القوى، مثلا، تقف في تعارض مع أطروحات “الدولة الإسلامية في العراق والشام” و”جبهة النصرة”، اللتين تنتميان للجهاد الإسلامي العالمي، وتدعوان للخلافة، ولا تعترفان بحدود سوريا ولا بالمواطنة، وهذا من اليمين.
أما من اليسار، فإن هذه القوى تجد نفسها في تعارض حتى مع حركة “الإخوان المسلمين”، التي تعترف بحدود سوريا وبواقع التنوع والتعددية في الشعب السوري، والتي تتوخى قيام دولة مدنية ديمقراطية، يتم فيها تداول السلطة، وتضمن الحرية والمساواة بين المواطنين من دون أي تمييز، على نحو ما جاء في “وثيقة العهد والميثاق” التي أصدرتها في (مارس/آذار 2013)، هذا فضلا عن أن ثمة طيفا واسعا من الجماعات الإسلامية السورية لا يتوافق مع ما تطرحه الجبهة.
المشكلة أيضا أن هذه الأوضاع أدت إلى إضفاء بُعد طائفي وديني على الثورة السورية، ما زاد من تعقيداتها ومن مشكلاتها.
أما من ناحية كونها الثورة الأكثر كلفة، فهذا يتجلى أكثر من أي شيء آخر في تشرد أكثر من ثلث السوريين، داخل سوريا وخارجها، كنازحين أو كلاجئين، مع فقدان الكثيرين لبيوتهم وأملاكهم ومصادر عملهم، وهذا شيء غير مسبوق في تاريخ الثورات، إذا استثنينا زمن الحروب والكوارث.
فمن حيث الكلفة البشرية فبحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان” ثمة حوالي 140 ألفا من السوريين لقوا مصرعهم حتى 15/2/2014، علما أن هذه الإحصائيات تمثل الحد الأدنى، بالنظر لصعوبة التوثيق في هذه الظروف، وبالنظر إلى أن كثيرين يفقدون حياتهم من دون أن يدري أحد بهم.
في كل الأحوال، فقد بلغ معدل عدد الضحايا الذين لقوا مصرعهم في سوريا حوالي أربعة آلاف شخص في الشهر الواحد، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومعظم هؤلاء قتلوا بالقصف الأعمى للمناطق السكنية من الجو والبر، بواسطة الطائرات والدبابات والمدفعية بمختلف أنواعها، ما يفسّر هذا العدد الكبير، وهذا الحجم المهول من الدمار، وتشريد ملايين السوريين داخل سوريا وخارجها.
وقد استطاع “مركز توثيق الانتهاكات في سوريا” تنظيم جداول بأسماء نحو تسعين ألفا من ضحايا النظام، مع طريقة قتلهم، ومكان وتاريخ ذلك، كما استطاع، وبالمعايير ذاتها، توثيق أسماء أكثر من 12 ألف شخص من النظام لقوا مصرعهم في المواجهات مع الجماعات المسلحة ولاسيما “الجيش الحر”، وذلك خلال الثلاثين شهرا الماضية.
أما صفحة “إحصائيات الثورة السورية” على فيسبوك فقد بلغ -بحسب إحصاءاتها- عدد ضحايا النظام السوري، من منتصف مارس/آذار 2011 وحتى 31 يناير/كانون الثاني 2014، حوالي 106820 شهيدا بينهم 1810 فلسطينيين، و10700 طفل شهيد، و10009 نساء شهيدات، 4654 شهيدا تحت التعذيب، وهذا يخص الشهداء الموثقة أسماؤهم، أما عدد الشهداء التقديري بحسب نفس المصدر فبلغ 210000 شهيد.
من ناحية التفاصيل، فقد بلغ متوسط عدد الضحايا، حتى في أشهر الثورة السلمية، وهي الأشهر الثمانية الأولى للثورة، من مارس/آذار حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2011، برصاص أجهزة الأمن والشبيحة، نحو ستمائة شخص شهريا، وهو عدد كبير جدا.
وقد ارتفع هذا العدد، منذ ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى يونيو/حزيران (2012) من ألف إلى أكثر من ألفي ضحية شهريا، بحكم التحول نحو الثورة المسلحة. ومنذ يوليو/تموز (2012) ومع تصعيد النظام لحربه ضد المناطق الحاضنة للثورة، باستخدام الطائرات وقذائف المدفعية والدبابات تضاعف عدد الضحايا، إذ بات يزيد على ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف شهريا، ضمنهم 6300 في أغسطس/آب (2012)، وهو الشهر الأكبر من حيث عدد الضحايا، يليه سبتمبر/أيلول مع 5500 شخص، ثم أكتوبر/تشرين الأول مع مصرع حوالي خمسة آلاف شخص.
وفي عام 2013 كان أغسطس/آب هو الأعلى مع مصرع 4700 شخص، إذ تم فيه استخدام السلاح الكيميائي في غوطة دمشق.
ويستنتج من معطيات “قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية” أن عمليات القصف الجوي والقوى الأمنية وعصابات الشبيحة نجمت عنها مئات المجازر الجماعية، في السنوات الثلاث الماضية، أكبرها المجزرة المروعة في الغوطتين الشرقية والغربية، التي عرفت بمجزرة “الكيميائي”، التي أودت بحياة 1400 من السوريين، في يوم واحد (21/8/2013).
أما المجازر الأخرى، التي شملت مجمل الخريطة السورية، فبحسب خريطتها العددية، ثمة مجزرة ذهب ضحيتها أكثر من أربعمائة من السوريين في جديدة عرطوز جنوبي دمشق (أبريل/نيسان 2013)، ومجزرة راح ضحيتها 399 في زملكا (21/6/2013)، وأخرى ذهب ضحيتها أكثر من 342 شخصا في حمص (4/2/ 2012)، وخمس مجازر قتل في كل واحدة منها أكثر من مائتين إلى ثلاثمائة شخص في تريمسة وداريا (يوليو/تموز، وأغسطس/آب 2012).
وفي البيضا (مايو/أيار/ 2013)، وحمورية (21/8/2013) ووادي بردى (25/10/2013)، 21 مجزرة ذهب ضحية كل واحدة منها ما بين مائة ومائتين، في جسر الشغور (يونيو/حزيران 2011) وكفر عويد (ديسمبر/كانون الأول 2011)، وفي دمشق وحمص وحلب والحولة والديابية وداريا (2012)، وفي دوما وكفر بطنا ورأس النبع والديابية وداريا والحولة والمعضمية وحمص وحلب 2013.
أيضا، ثمة 78 مجزرة لقي في كل واحدة منها ما بين خمسين ومائة شخص مصرعهم، ونحو 750 مجزرة لقي في كل واحدة منها ما بين 25 وخمسين شخصا مصرعهم في كل واحدة منها في مختلف مدن سوريا وأريافها، أغلبها عامي 2012ـ 2013.
الآن، وبالنظر إلى هذه الكلفة الباهظة، من النواحي البشرية والمادية والمعنوية، ربما يصعب على الإنسان، من الناحية الأخلاقية، أن يوازن بين الثورة كضرورة وبين كلفتها، لكن هذه الموازنة لم تعد تفيد بعد أن حصل ما حصل، إذ بات التعويض عن كل ذلك يكمن فقط في خلاص السوريين.
الجزيرة نت
عن الحرب التي قتلت سوريا/ نصري الصايغ
خبراء النسيان لم يعترفوا بثمالة الذاكرة. المشهد السوري فائض عن كفاية الاحتمال، والصور تتدافع في المخيّلة، كأن القتل فضيلة. يتنافس الطرفان، في ممارستها والاعتناء بحسن أهدافها السياسية.
إنها السنة الثالثة. ثلاث سنوات بعمر ثلاثة عقود أو أكثر. ونبض الدم السوري ليس إلى انحسار وليس بوسع أحد أن يحسم موعد النهاية. الذكرى الثالثة لاندلاع «الربيع الدامي» في سوريا لا تغري أحداً بالتذكر. لا وقت للعودة إلى الوراء أبداً. هي مناسبة للتوقع فقط. السنة المقبلة، لن تكون الأخيرة. قد تندفع إلى ما بعد العاشرة. هكذا يتوقع خبراء الحروب والفتن والقتل، وهكذا يقرأون ما ستؤول إليه سوريا، إن ظلت حيّة تُرزق.
لذا، ليس مجدياً تذكر البدايات. اجترار الماضي لا يفضي أبداً إلى إعلان الندم. كأن يقال مثلاً، لو «أنه» أدرك ماذا تعني أصابع أطفال درعا، لكان وفر على سوريا هذا الدمار وهذه المذبحة. أو، كأن يُقال، كان لا بد من عصمة الحراك السوري من السلاح. أو، كأن تُستعاد فصول الجولات السياسية والعسكرية بهدف تبرئة الذات المذنبة. أو كأن تبرر المعارضة لجوءها إلى السلاح بعنف النظام. أو، كأن يستمر النظام في اتهام المؤامرة وبأن درعا لم تكن حادثة «صبيانية» بل خطة محكمة الخيوط. أو، كأن تفسر المعارضة لسبب انتمائها المزدوج إلى داخل مشتت وخارج لا يشبه ربيع العرب. أو، كأن ينفي النظام أحقية الحراك ويصر على ارتباطه بالسعودية وقطر والإمارات وأوروبا والغرب.
لم يعد مجدياً استعادة سردية المعارضة المتهافتة ولا سردية النظام المتداعية. لا مجال لإقحام البراءة لأي من الفريقين. فالنظام مرتكب والمعارضة ارتكاب. فلتُحذف من المشهد السوري مقدماته. المبادئ والشعارات والممانعة والديموقراطية، سقطت جميعها.
ولم تعد الساحة تحتمل غير لغة القوة، فمن كان الأقوى كان له أن يفرض سرديته في المستقبل. وبما أن القوى ليست مفضية إلى انتصارات، بل إلى مكاسب موضعية، فسوريا ماضية بثبات إلى ما بعد السنة الثالثة، بحزم وجدارة.
المبارزة الدائمة بين الفرقاء حول الحق والحرية والعدالة والديموقراطية والممانعة، صارت بلقاء وحملة. المشهد المرتسم لا يحتاج إلا إلى إجادة التطلع وجودة البصيرة. سوريا ضحية النظام والمعارضة. لا أحد كان يتوقع، لا في النظام، ولا في المعارضة، أن تصبح سوريا أرضاً لحروب داخلية وإقليمية ودولية، مباشرة أو بالواسطة. لا أحد من أبرياء «الربيع العربي»، والسوري تحديداً، كان يتوقع أن تقع المعارضة أسيرة تحالف موضوعي!!! وإغرائي!!! مع «قطر العظمى» (أين الحرية؟) ومع السعودية الوهابية (أين كل الكلام؟) مع تركيا الإخوانية (أين العلمانية؟) مع الولايات المتحدة الأميركية (أين فلسطين؟) ومع حلفاء، ليس بينهم غير اليتم الأخلاقي والمبدئي، ولا يتمتعون إلا بفحولة مالية استئثارية ومصالح تهدف إلى تدمير سوريا وتدمير الثورة معاً…
لا أحد من الذين خرجوا بعد درعا في شوارع وميادين المدن، على مدارات أيام «الجمعة»، بشعارات نبيلة ونقية، أن ينتهي الطواف بتسلم إسلاميين، جاؤوا من وثنية النصوص وجاهلية التكفير، مناطق ورقابا، أعملوا فيها شرع السيف والبتر والقطع والجز؟
لقد معست المعارك البدايات وهتكت الأهداف. فقر حال وطني. بؤس ديموقراطي. إفلاس قومي. تشتت ممانعة… لم ينتصر غير القتل المتبادل، بكل ما لدى الفريقين من أدوات تدمير واقتلاع وانتقام وثأر وهمجية. لقد فاضت سوريا بعنفها على شعبها الذي أصبحت ملايينه السبعة، نازحة أو لاجئة أو هاربة أو قيد الاعتقال والقتل والسراب.
لا هدف راهنا، غير استمرار القتال… سوريا فاضت على جيرانها عنفاً وبؤساً ولاجئين. استضافت على أرضها جحافل بربرية مدعومة بعقيدة دينية، قُيّدت لحساب «القاعدة» و«النصرة» و«الاخوان» وفرق لا عدد ولا حصر لجرائمها. استضافت أموالاً وسلاحاً ودولاً ومنظمات، ففتحت جبهات لم تهدأ. روسيا وأميركا وإيران وأوروبا هناك. ومع ذلك، فلا حل، ولا جنيف. لا صوت يعلو فوق صوت الدمار المتبادل والمعاد والمكرَّر…
في مثل هذه الحالة، صار الاحتفال بـ«الانتصارات» يثير الشفقة والبكاء. لا انتصار بعد لأحد. كرّ وفر. إلا إذا تخلى حليف خارجي عن دعم حليفه في الداخل، وهذا غير متوقع. لا إيران ولا روسيا ولا «حزب الله» والمجموعات العراقية، ستتخلى عن النظام. ليس حباً بالنظام، بل دفاعاً عن الذات…
ألم يكن ذلك مفهوماً منذ البداية لدى المعارضة. أما درسوا أن النظام السوري حلقة في سلسلة. وأن التحالف بين الدول، ليس على مبادئ بل على مصالح، وإذا تيسرت المبادئ، كان ذلك أفضل، وهو من النوادر؟ ألم يعرف النظام، أن المعارضة ستلجأ إلى طلب المساعدة من «أي خارج»، نعم، من أي خارج يمد لها يد المساعدة؟ لهذا، تُترك المعارضة تسقط. السعودية باقية في سوريا ولن تخرج منها، وهي منشرحة كثيراً في أنها انضمت إلى معسكر مكافحة الإرهاب، الذي كان ذات يوم قريب، هو إرهابها. وهي قادرة على أن تحالف نظام مصر وتشترك في حربه على «الاخوان» وتقاتل نظامي دمشق وبغداد، بالإسلاميين أيضاً.
بعد أوكرانيا، ستذوق سوريا طعم الحرائق. الحلول التي كانت صعبة في جنيف، صارت مستحيلة.
الكلمة ستبقى للسلاح.
الحاضر تحكمه الأسلحة.
المستقبل تقتله هذه الأسلحة وما سيرد إلى سوريا بعد ذلك. ولجميع الأطراف.
أمس، أطفأت سوريا شمعتها الثالثة الكالحة وأشعلت الرابعة، والعتمة أمامها… خبراء النسيان ينصحون بالابتعاد عن المشهد السوري كي لا ينزلق إلى الاعتياد على تحمل الفظاعات وإلى تبلد الإحساس وتجلد المشاعر. ينصحون بأن تستمر بالحياة بعيداً عن الحرائق.
لعل المطلوب هو المزيد من الوعد والمزيد من الإحساس والمزيد من الانخراط والمزيد من التذكر، ليبقى هذا الألم الفظيع والفائض، سوطا يحث ضميرنا على الالتزام بالمستقبل وعدم نسيان الماضي، ويدفعنا إلى ابتداع اصطفاف جديد: «ضد الحرب» مهما كان الثمن.
لا ننسى ما أبكانا وما أدخلنا في الفجيعة، بعيداً عن الحجج السياسية والذرائع المتبادلة… لا ننسى درعا، دوما، داريا، الميدان، برزة، السويداء، تلبيسة، الرستن، تلكلخ، معرة النعمان، باب عمرو، باب السباع، كرم الزيتون، حمص، حماه، بصرى الحرير، اللاذقية، بانياس، طرطوس، إدلب، الرقة، الحسكة، القامشلي، الزبداني، النبك، القصير، السلمية، حبلة، حلب و… ولا ننسى ما ومن كان فيها، وما لم يكن فيها بعد ذلك.
هل هذا تفاؤل غبي؟
ربما، لكنه أفضل من الاستمرار في المشهد الذي وصفته هالا محمد، الشاعرة السورية بالكلمات التالية: «من أعالي الجبال، من القرى، من المدن، من الأحراج، من الغابات، من الحدائق، من تخوت البيوت… خشب الجنازات».
السفير
ثلاث سنوات أخرى/ غسان شربل
بعد ثلاث سنوات على اندلاع الأحداث في سورية، يمكن أي مراقب أن يرى في المشهد السوري الحالي آثار ثلاثة قرارات كبرى حالت دون وقف نهر الدم المتدفّق. ظهرت تلك القرارات واضحة غداة اتخاذ الأحداث طابعاً دموياً مريعاً وتدفّق المقاتلين الجوّالين الى الأرض السورية.
القرار الأول إيراني. وهو اعتبر الأحداث في سورية مسألة حياة أو موت بالنسبة الى دور إيران الإقليمي وهيبة نظامها والأوراق التي تملكها.
باكراً عبّر المرشد الإيراني عن هذا القرار أمام احد زائريه. قال: «تكون سورية كما كانت (قبل الأحداث) أو لن تكون لأحد». وبعد ثلاث سنوات يقول زوار طهران إن موقفها لم يتغيّر ولم يتزحزح.
ترجمت إيران قرارها بدعم مالي وسياسي وعسكري بلغ حد إعلان «حزب الله» اللبناني رسمياً انخراطه في الحرب السورية وبموازاة ميليشيات عراقية هبّت هي الأخرى لدعم النظام السوري.
القرار الثاني روسي. وهو منع الولايات المتحدة من استخدام مجلس الأمن لنزع الشرعية عن نظام الرئيس بشار الأسد وتوفير مظلة لتدخّل غربي يسرّع عملية إسقاطه. وفي موازاة ذلك، كثّفت روسيا عملية تسليح النظام وأنقذته من ورطة السلاح الكيماوي ومنحته عبر عملية «جنيف 1» و «جنيف 2» فرصة لتحسين مواقعه.
وبعد ثلاث سنوات، لا يبدو أن موسكو غيّرت موقفها. وثمة من يعتقد أن المشكلة الأوكرانية ستضاعف ميلها الى التشدد.
القرار الثالث أميركي. وهو قرار باراك أوباما بعدم إقحام أميركا في حرب جديدة. وأظهرت التطورات أن أوباما لم يكن راغباً في أي تدخل عسكري في سورية يمكن ان ينسف المفاوضات النووية مع إيران. وهذا يفسّر مسارعة واشنطن الى الابتهاج بقرار سورية تسليم ترسانتها الكيماوية بضغط من روسيا ولإنقاذ النظام من تبعات هذا الملف الحساس. وبعد ثلاث سنوات لا شيء يشير إلى أن أميركا في صدد اتخاذ قرار بالتدخل في سورية وإن تكن تُجري حالياً مراجعة لخياراتها في ضوء تعاظم الخطر الإرهابي انطلاقاً من سورية ومسؤولية النظام عن تعاظمه.
بعد ثلاث سنوات يمكن القول إن السوريين فقدوا المبادرة في الصراع الدائر على أرضهم، وربما فقدوا معظم قدرتهم على القرار بسبب اعتمادهم المفرط على الدعم الخارجي. القوى التي أنقذت النظام حاضرة في القرار. والقوى التي دعمت المعارضة أيضاً. وخلال هذه السنوات تداخلت الحروب الدائرة على الأرض السورية. ثورة مسلّحة ضد النظام تدور على شفير حرب أهلية. تحوّلت المواجهة ايضاً جزءاً من النزاع السنّي – الشيعي في الإقليم. تحوّلت سورية في موازاة ذلك الى معقل لـ «القاعدة» وأشباهها وباتت أوضاعها تناقش من زاوية الإرهاب ومخاطره والحرب عليه.
على الصعيد الميداني يمكن القول ان النظام حسّن مواقعه خصوصاً في الشهور الماضية. لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه قادر على إعادة فرض سلطته على كامل الأراضي السورية. مثل هذا الحسم يستلزم معركة طويلة وباهظة الأثمان بشرياً لا يبدو النظام قادراً على دفعها. في المقابل لا شيء يشير إلى أن المعارضة قادرة على توجيه ضربة قاصمة الى النظام في المدى المنظور. تسليحها قد يساعدها على حماية مناطقها، لكنه لا يؤهلها لانتزاع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
الواقع الميداني يوحي باستمرار النزاع. وبقاء القرارات الإيرانية والروسية والأميركية على حالها يوحي بالأمر نفسه. بين المعنيين بالمأساة السورية من يتحدث عن ثلاث سنوات أخرى. يقولون إن سورية القديمة التي نعرفها انتهت. وإن السنوات الجديدة سترسم الحدود داخل سورية التي تصدّعت وحدتها الوطنية. وإن سورية المقبلة ستكون سورية الضعيفة التي ستتوزع على مكوناتها بعد ان تمضي سنوات في ظل تقسيم غير معلن وغير رسمي.
هل تستطيع المنطقة احتمال ثلاث سنوات أخرى من النكبة السورية؟ ماذا عن لبنان والعراق والأردن وتركيا؟ وماذا عن العلاقات الإيرانية – السعودية؟ وماذا عن النزاع السنّي- الشيعي وحروب «القاعدة»؟ الإجابة ليست سهلة. ملفّان يستحقان المتابعة حالياً: ذيول الأزمة الأوكرانية وزيارة أوباما القريبة الى السعودية.
الحياة
ثلاثة أعوام على المخاض السوري/ طيب تيزيني
في15 مارس 2011، كان موعد مخاض سوريا قد أعلنَ عن نفسه بكثير من الفرح والأمل، ودونما توعّد لأحد بمكروه. بالعكس من ذلك، كانت ثمة دعوة للقاء على كأس الكرامة والحرية والعدالة، وعلى التوافق حول وسائل مشروع ثوري نهضوي ديموقراطي وتعددي مدني. لقد شعر الناس بما يجعلهم بشراً بعد عقود تتجاوز الأربعة، ولن أنسى ما حييت ما قلته للرئيس الراحل حافظ الأسد، إجابة على سؤال طرحه عليّ، حين قدِمْتُ إليه زائراً بناء على دعوة بزيارته. كان السؤال هو التالي ما الذي يحدث في البلد؟ كان السؤال هذا الذي طرح عليّ كأنه لامس ما قد يكون الرئيس سمعه بطريقة نقل ما من أحدهم ممن كانوا موجودين في بهو جامعة دمشق منتظرين الدخول إلى قاعة المحاضرات. كانت العبارة التي قيلت وسُمعت هي: اليومَ ربما بنا بصدد انقلاب في سوريا! ها هنا وجدتُ نفسي تحت ردود فعل ما قرأته – في حينه- عن الرئيس الجزائري بومدين والرئيس عبدالناصر في آخر حكميهما بأنهما حاولا إعادة النظر في استراتيجيتهما الوطنية الثورية، بسبب الإخفاقات التي مر كل واحد من الزعيمين بهما. كما استعدتُ ما وقر في ذهني من قصة الزعيم السوفييتي «أندروبوف»، الذي قيل إنه مات مسموماً، خوفاً من دور إصلاحي يمكن أن يقوم به.
إن تلك الأفكار أفضت بي إلى ذكر ما أردته إجابةً على حافظ الأسد. قلتُ مجيباً: ما يوجد في البلد يا سيادة الرئيس هو هيمنة وسيطرة ما أصبح سيّد الموقف في النظام السائد في البلد، وهو الذي أزعم أني اكتشفته بوصفه قانوناً عملياً، وهو قانون الاستبداد الرباعي، أي الذي يقوم على أربع، هي الاستئثار بالسلطة وبالثروة وبالإعلام والمرجعية السياسية المجتمعية المتمثلة بالقول بأن «الحزب القائد» – أي حزب «البعث العربي الاشتراكي»-، هو الذي يقود الدولة والمجتمع وبزعامة وقيادة «القائد الخالد حافظ الأسد».
كان الرئيس الأسد يتتبع كلامي بكثير من الدهشة والفضول وبشيء ثالث أتفكر به واضعاً عدة افتراضات قد يصح أحدها للإجابة عن فضولي السياسي والمعرفي الممكن. وكانت ثمة لقاءات وحركات أتيحت لي أن أقوم بها في إطار مشروع الإصلاح، ولكنها لم ترقَ إلى مستوى العمل الجماعي والمنظّم. ولم يُسمح إلا بهوامش من العمل يُسمح بها في سبيل الإصلاح. أمّا اللوحة الممثلة للواقع السوري فقد امتلكت فيها هذه الهوامش نسبة ربما لم تتجاوز الخمسة بالمئة سقطت الطبقة الوسطى، وتحولت إلى أكوام من الشحاذين، في حين أن طبقة الكادحين من كلتا الطبقتين العمال والفلاحين جرى سحقهما. والشيء المهم والبارز جداً راح يتبلور في أن شِتات الفقراء والمعوزين والمهانين والمذلّين المنتشرين في الوسط المجتمعي السوري العام، أخذوا يُحوّلون إلى فئات تقوم في خدمة الأعلين، بحيث ارتفعت نسبة المذلين المجردين من معظم ما كانوا يمتلكونه، ليشكلوا مع الآخرين سيلاً من العاطلين عن العمل.
كما أن سقوط ما كان يؤلف الطبقة الاجتماعية (ما بعد المتوسطة)، جعل كثيراً منهم يتحولون إلى مرتشين وخدم لدى الأعلين، وجهاً لوجه أمام من أصبحوا كل شيء ومع شعور أولئك الدّونيين بخط عمومي ناظم، هو خط المذلة والعجز مع تدخل فظيع من قبل «الدولة الأمنية» المنتشرة بإطلاق في الكل وبالكل.
ذلك الناظم أسهم إسهاماً عميقاً في توحيد المجتمع السوري تحت قبضة البحث عن الكفاية المادية، هذا هو واقع الحال، الذي أسس لانتفاضة سلمية للشعب السوري. ومع سلمية هذه الانتفاضة وتحريم النزعات الثأرية والطائفية والتقسيمية من قبل المنتفضين خرج النظام بعد مرور ستة أشهر على سلمية الانتفاضة هذه، ووجه السلاح الناري بكل أنواعه ضد المتظاهرين، بحيث تحولت سوريا الآن إلى تعبير عن عارٍ لم يرتكب مثيله له في التاريخ.
الاتحاد
سوريا 2011 – 2014 | هل ربح النظام وخسر معارضوه؟L منذر خدام
يعدّ رايان كروكر _ سفير أميركي سابق في سوريا وفي العديد من الدول الأخرى، والخبير في شؤون المنطقة العربية _ أحد أبرز ممثلي «الواقعية» السياسية في الأوساط الدبلوماسية الأميركية، وهو معروف أيضاً، على الصعيد العالمي، كخبير وممثل جيّد للبراغماتية الدبلوماسية الأميركية.
مناسبة هذا الكلام عن السيد كروكر، الذي لا يضيف شيئاً إلى ما هو معلوم عنه، هو إطلالته اللافتة، في هذا الظرف الذي تمر به سوريا، على صفحات جريدة «نيويورك تايمز» ليقول ناصحاً إدارته: «نحن بحاجة إلى بدء التحدث مع نظام الأسد مرة أخرى…». لكنه ينصح بأن يتمّ ذلك «بسرية للغاية، وبهدوء…». ويبرّر كروكر ضرورة التحدث مع الأسد بقوله: «فعلى الرغم من سوء الأسد، لكنه ليس بسوء الجهاديين الذين يمكن أن يتولوا الحكم في حال غيابه».
يعترف كروكر بأنّ النظام «قد لعبها صحّ»، وبنى استراتيجيته كلها على أساس أنّ العنف المفرط هو الذي سوف يدفع الناس إلى حمل السلاح، وسوف يخلق، بالتالي، كل الظروف الملائمة لصعود القاع الاجتماعي، الريفي منه على وجه الخصوص، إلى الواجهة ليتقدم صفوف المعارضة المسلحة الجهادية المتطرفة، ويحوز قطبيتها السياسية والعسكرية في مواجهة قطبية النظام. هذا في الجانب الموضوعي من المسألة، لكن النظام لم يكتفِ بذلك، بل عمل عليه بصورة مباشرة أيضاً، من خلال إخلاء سجونه، في بداية الانتفاضة، من كل القوى المتطرفة الجنائية وغير الجنائية ودفعها إلى ساحة الفعل العسكري كما تشي بذلك معلومات كثيرة. يقول كروكر: «لقد نجح نظام بشار الأسد في خلق وتسويق المنظمات الإرهابية التي يحتاج إليها للبقاء على قيد الحياة، على الأقل في جزء من سوريا». وبدلاً من أن يشعر كروكر بالخجل والحياء مما آلت إليه أوضاع سوريا والسوريين التي قادهم إليها نظامهم، بمشاركة موضوعية ومباشرة من قبل إدارة بلده، من خلال دعمها منذ البداية للخيار العسكري في سوريا وتزويدها «المجاهدين» بالمال والسلاح، في تأمين مباشر لنجاح استراتيجية النظام، فهو يطالب بالثناء عليه. يقول كروكر «النظام يستحق الثناء الكامل…» لما تميّز به من «جرأة وعزم وفكر دموي»، فهو «حرق سوريا بالنيران». وبطبيعة الحال هذا ما تريده أميركا والغرب عموماً، وإسرائيل على وجه الخصوص. وإذ يشكره كروكر، فإنه يشكره لهذا السبب. وبعد إنجاز هذه المهمة بنجاح وفق المقاييس الأميركية، يطالب كروكر بتفهم الأسد، إذ يقدم نفسه على أنه «رجل إطفاء». ولذلك ينبغي أن يسحب من التداول فوراً، ونسيان الحديث عن «الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها»، وعن ضرورة «تنحي الأسد».
هكذا إذاً، ينبغي أن يسحب من التداول المطلب بتنحي الأسد، بحسب كروكر، كما تقتضي «الواقعية السياسية»، لا لأنه صار يواجه القوى الجهادية المتطرفة، التي يخشاها الغرب عموماً، بل لأنه ببساطة انتصر على «الولايات المتحدة والغرب»، وأنه بالتالي حان الوقت لوضع «شروط الاستسلام». ومهما وصفتم النظام بعبارات أخلاقية سلبية، تأثراً بفظاعة ما يقوم به يومياً من «جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، فهو النظام الذي «ينبغي» أن تبدأوا «الحديث معه».
بالطبع، السيد كروكر لا يقول كلمة واحدة عن مسؤولية بلاده في ما وصلت إليه الأوضاع في سوريا، وكيف أنها كانت تراقب عن كثب صناعة التطرف في سوريا ليس فقط من قبل النظام، بل من قبل دول عديدة فاعلة في المنطقة وفي أوروبا، بل كانت تشارك في ذلك مع الآخرين بتشجيع قدوم آلاف الإرهابيين من مختلف دول العالم ومن أميركا وأوروبا بالذات إلى سوريا، وتقديم الدعم المالي والعسكري لهم. لقد قيل الكثير، ويبدو لي فيه وجه صواب، أن أميركا وحلفاءها عملوا بصورة مدروسة على تجميع الإرهابيين من جميع دول العالم وسوقهم إلى المحرقة في سوريا، غير مكترثين بأن نار هذه المحرقة سوف تطال السوريين وعمرانهم ومصادر رزقهم.
اليوم فقط، وبعد نحو ثلاث سنوات على الصراع المسلح في سوريا، تعلن الخارجية الأميركية في بيان رسمي لها ضرورة منع الإرهابيين من القدوم إلى سوريا، وتجفيف منابع الدعم المالي والعسكري لهم… لقد حققت أميركا كل أهدافها في سوريا، فقد تحقق لها أولاً؛ تدمير البلد وتمزيق وحدة شعبه وخروجه من معادلة الصراع مع إسرائيل لعقود من السنين. وثانياً نجحت في تجميع الإرهابيين من كل دول العالم في سوريا لتصفيتهم، ولن تقبل بأقل من ذلك في أية تسوية محتملة تصدر عن مؤتمر «جنيف 2». وثالثاً؛ فقد شوهت سمعة حزب الله كحركة مقاومة كان لها في قلوب السوريين منزلة مقدسة، عداك عن تكبيده خسائر بشرية كبيرة جراء تدخله العسكري في سوريا. ورابعاً؛ فقد حالت دون تحوّل انتفاضة الشعب السوري إلى ثورة حرية وكرامة وديموقراطية، الأمر الذي كانت تخشاه كثيراً نظراً إلى موقع سوريا الجيواستراتيجي، وتأثير ذلك على أمن إسرائيل وأمن واستقرار المنطقة عموماً.
ويبقى السؤال عن دور السوريين أنفسهم، نظاماً ومعارضة، في تنفيذ هذه الاستراتيجية الأميركية؟ في الحقيقة، من الأصح حصر السؤال بالمعارضة فقط، باعتبار أن النظام كان قد بنى استراتيجيته في مواجهة مطالب شعبه منذ البداية على العنف، بل والإفراط فيه، ما قضى على انتفاضة الشعب السوري في سبيل الحرية والديموقراطية، وحوّل الصراع الجاري إلى صراع بينه وبين قوى إرهابية موصوفة. إن مسؤولية المعارضة التي صارت توصف بالخارجية، والأصح أن توصف بالمعارضة المصنّعة أميركياً. وإذا أخذنا على محمل الجدّ تصريحات السيد روبرت فورد فهي لا تقل عن مسؤولية أميركا وحلفائها في إعادة تعويم النظام، بل هي شريك موضوعي ومباشر في وأد انتفاضة الشعب السوري من خلال استجابتها دون تبصّر لإغواء السلاح، فشجعت على عسكرة الانتفاضة، وهذا بالضبط ما كان يريده النظام.
اليوم، ومن خلال مؤتمر جنيف كانت قد لاحت فرصة تاريخية، ربما لن تتكرر، لكي تصوب هذه «المعارضة الخارجية» بعض أخطائها القاتلة بحق الشعب السوري، وذلك من خلال التركيز على هزيمة النظام سياسياً من خلال ضمان مستقبل ديموقراطي حقيقي لسوريا، والعمل من ثم على وقف العنف، ومنافسته في صندوق الاقتراع. لكنها لم تفعل للأسف، بل استمرت في تقديم الذرائع له للاستمرار في العنف من خلال إعلانها وفاة الخيار السياسي، وهذا ما كان يريده النظام بالضبط.
* كاتب سوري
الأخبار
سوريا 2011 – 2014 | من الحرية إلى انهيار الأطر الوطنية/ معتز حيسو
يقف السوريون في بداية السنة الرابعة من أزمتهم التي حوّلتهم نتيجة تداخل وتراكب عواملها، وانفتاحها على التناقضات الدولية والإقليمية إلى أدوات تُصهر في بوتقة المشاريع الدولية الكبرى. وقد كان واضحاً منذ البداية، إنّ مآلات الصراع السوري سوف تحدد مصير المنطقة العربية، ومستقبل التحالفات السياسية على المستويين والإقليمي والدولي.
قد يكون الكلام عن واقع سوريا السياسي والاقتصادي قبل الأزمة مكروراً، لكنّه يُحدّد بعض من أسباب الحراك السوري. في وقت يواجه فيه من يؤكد على أن الأزمة العامة والمركبة، كانت الدافع الأساس للحراك، دعاة المؤامرة، التي تستهدف من وجهة نظرهم، سوريا ونظامها العروبي المقاوم، لإعادة رسم الخارطة الجيو سياسية للمنطقة. بالتأكيد يحمل هذا الموقف الكثير من الصوابية. لكنه يكتنف في فصله عن العامل الأول، كثيراً من الإجحاف بحق السوريين الذين لم يعودوا يطيقون صبراً بأزمتهم التي كانت تتراكم مفاعيلها وأسبابها، نتيجة لتفشّي مظاهر القهر السياسي، الذي تحوّل في سياق إعادة إنتاج السلطة، إلى أحد ملامح الأزمة البنيوية. كذلك الإفقار العام ونهب الموارد والثروة الوطنية، وانتشار مظاهر الفساد، الذي ساهم في تمكينه آليات سياسية واقتصادية رسمية. إن إطلالة سريعة على واقع سوريا قبل الأزمة، يوضّح الكثير من الأسباب الداعمة لمشروعية أهداف الحراك السلمي في تجاوز الأزمة البنيوية العامة والمركبة. للانتقال إلى نموذج سياسي اجتماعي واقتصادي ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية، ويفتح المستقبل على نظام سياسي ديمقراطي يضمن الحريات السياسية والأساسية والعامة.
فالأزمة السورية قبل اندلاع «الثورة» يمكن مناقشتها على مستويين. الأول سياسي يتجلى في احتكار السلطة واعتماد القهرية والعنف والإقصاء والتهميش لتجفيف منابع الحياة السياسية. إقصاء الشباب عن النشاط المدني والسياسي المستقل. سيطرة المؤسسات الحزبية والأجهزة الأمنية على كافة التفاصيل اليومية والمراحل العمرية. ذلك من خلال الهيمنة على المؤسسات التعليمية والقطاعات الإنتاجية والخدمية والمنظمات الشعبية والنقابية وصولاً إلى الأحزاب المنضوية في إطار «الجبهة الوطنية التقدمية». فالمجتمع بكامل تفاصيله وحيثياته كان محكوماً من منظور المادة الثامنة، الذي عزّز الاشتغال فيها مظاهر الفساد والمحسوبيات والولاءات الشخصية والاستزلام والنفاق السياسي… والأهم أنها شكلت مدخلاً إلى إحكام القبضة الأمنية على المجتمع. مما ساهم في تفريغ المجتمع من السياسية، وتشكّل فجوة واسعة بين الشباب والعمل السياسي والمدني، ووسّع الفجوة العمرية بين الناشطين السياسيين والشباب. إذ أنّ الكهولة كانت السمة الطاغية في القوى السياسية، وهذا يهدد باندثارها في حال بقيت السلطة تقصي المجتمع عن الحياة السياسة، وبقيت هذه القوى مُبعدة وبعيدة عن النشاط ضمن الأوساط الشبابية. إضافة لذلك فقد كانت الفجوة المعرفية تتسع بين أجيال المجتمع السوري، وبين الداخل والخارج. في السياق ذاته اتّبعت الجهات المسؤولة، سياسة غضّ النظر عن نشاط الحركات الدعوية الإسلامية في المدارس والمعاهد الشرعية والجمعيات، مما ساهم في تمكين الحواضن الاجتماعية والفكرية للسلفية الإسلامية الأحادية، التي تحولت زمن الأزمة إلى منصّات للجهاد الإسلامي، تتقاطع عليها مصالح هذه الأطراف، مع جهاديين وافدين يفيضون بالعنف الجهادي الإلغائي ضد إي نزوع مدني علماني وديمقراطي.
في المستوى الاقتصادي، تم اعتماد سياسات الانفتاح الاقتصادي، التي شكلت المدخل إلى تحرير الاقتصاد والتجارة وحركة رأس المال والأسعار والأسواق والخدمات. وقد ساهم هذا التحوّل في تراجع الإنتاج الوطني الزراعي والصناعي العام نتيجة تقليص الدعم الحكومي وأسباب أخرى. بينما فُتحت أبواب الدعم والتسهيلات أمام الإنتاج الخاص المرخص وغير المرخص. إضافة لذلك فقد انكشفت ذات المرحلة عن حالات التزاوج غير الشريعي بين رأس المال والمستثمر من جهة، وأصحاب القرار السياسي ومن يسيطر على الثروة الوطنية من جهة أخرى. وبين طرفي هذه المعادلة كانت فئات وكتل بشرية كبيرة تنحدر إلى أدنى درجات السلّم الاجتماعي. لقد كشفت السياسات الجديدة عن تخلي السلطة عن دعم الفئات الاجتماعية الفقيرة ودفعها إلى مستنقعات الفقر والبطالة. وكان هذا مؤشراً على تغيّر في بنية السلطة التي رأت بعد استنزاف الموارد والثروات الوطنية، إن استمرار سلطتها يكمن في تحرير الاقتصاد واعتماد التجارة كقاطرة للتنمية، والقطع مع أي تحوّل ديمقراطي يساهم في إطلاق الحريات السياسية والمدنية ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. هذه التحولات عمّقت التناقض الاجتماعي، وزادت من معدلات الإفقار والبطالة، وقضت على الفئات الوسطى، وساهمت في القضاء على ما تبقى من القطاعات الإنتاجية وتحديداً المملوكة من قبل الدولة. وهذا بالضرورة كان يستدعي مزيداً من السياسات الأمنية، لقمع أي تحرك سياسي يناهض ميول السلطة السياسية والاقتصادية.
وقد ساهم المناخ السياسي والاقتصادي السائد في تعميق الفساد وتحوّله إلى وعي عام. وهذا لا يعني أن المواطن السوري فاسد، لكن شروط وعوامل الأزمة أجبرته على اعتماد أساليب ملتوية لتحقيق هامشاً من الاستقرار الذاتي. وساهم أيضاً في اتساع تأثير ودور الانتماءات والتشكيلات قبل الوطنية (عشائرية، مذهبية، جهوية، عرقية، عائلية…) وتنامي مظاهر الإستزلام والتملق والمداهنة والمراوغة والتقيّة والمحسوبيات والنهب، وكذلك نشوء مافيات ذات وظائف ومهام متعددة ومختلفة، استغلت وضعها الطائفي وغطاء السلطة. وكان هذا التحول مؤشراً على تراجع دور الدولة الاجتماعي وعجزها عن انجاز مشروعها التنموي، وفشلها في التحوّل إلى دولة المواطنة، التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات. جميع العوامل التي ذكرناها، كانت من أسباب الحراك الشعبي، وكذلك من أسباب فشل الحراك المدني والسياسي السلمي، الذي كان نجاحه يحتاج إلى قوى سياسية ومدنية وحوامل اجتماعية قادرة على إحداث تغيير اجتماعي وسياسي نوعي. فالعوامل التي حكمت المجتمع قبل الأزمة، انعكست بأشكال سلبية على مجريات الأزمة التي ساهم في تعميقها، الحلول الأمنية، عسكرة الحراك السلمي، طغيان الجهادية التكفيرية، تناقض المصالح الدولية في سوريا وعليها. تدفق الدعم والتمويل إلى أطراف الصراع المتكاثرة والمتوالدة. فتح الحدود لتسهيل دخول الجهاديين الذين حولوا سوريا إلى ساحة للجهاد العالمي. تراجع دور السوريين الذين يتمتعون بوعي عقلاني وموضوعي ويؤمنون بضرورة التغيير الوطني الديمقراطي السلمي كمخرج من الأزمة. ولم تسلم هذه الفئات من الضغوط الأمنية، إذ يعانون نتيجة مواقفهم الموضوعية زمن الأزمة ضغوطاً متزايدة من قبل أطراف الصراع، وتحديداً المستفيدين من استمراره. وقد ساهم تحوّل بعض الأطراف عن شعارات الحرية والوحدة الوطنية ونبذ العنف والطائفية والتدخل الخارجي إلى شعار إسقاط النظام، وعسكرة الحراك السلمي، واعتماد خطاب وأدوات وآليات مذهبية، عقائدية، طائفية، جهوية، إقصائية، الغائية، والقبول بالارتهان والدعم والتمويل الخارجي الذي مهّد الطريق لفرض أهداف الدول الداعمة على من يدّعي تمثيل الشعب السوري، في القضاء على أحلام السوريين في مستقبل ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية. وتحديداً مع تزايد العنف الجهادي التكفيري، الذين استغل قادته الأزمة ودفاع قادة معارضة الخارج عنهم واعتبارهم من مكونات «الثورة» رغم تُهم الإرهاب التي وجهت إلى بعض المجموعات. في وقت لم تتراجع القيادات ذاتها عن رفضها لأي شكل من أشكال التعاون والتنسيق مع معارضة الداخل. فكانت آليات اشتغالها تتقاطع مع المتشددين في السلطة وخارجها لتعطيل الحلول السياسية، وإخراج السوريين المدافعين عن التغيير الديمقراطي السلمي من الساحات، التي تحولت إلى ميادين قتال تعج بكل من هب ودبّ. وقد شكّل هذا تراجعاً واضحاً عن الأهداف والشعارات والمهمات الوطنية والديمقراطية، مقابل تنامي دور المفاهيم العصبوية الضيقة، وتهدّم المفاهيم والأطر الوطنية الجامعة في سياق الانحدار إلى أطر وتشكيلات مجتمعية ذات بّعد مذهبي عقائدي جهوي عشائري عائلي. حتى أن بعض التشكيلات السياسية تحوّلت في سياق الأزمة إلى مكونات دون وطنية. فقد بات المواطن السوري يلمس انحدار مكونات المجتمع السوري الأهلي وحتى المدني والسياسي إلى حقول العصبوية التي تُشكل إرتكاساً ونكوصاً عن مستوى التطور الاجتماعي الذي كان سائداً قبل الأزمة، رغم أنه كان تطوراً شكلانياً يخفي ملامح التخلف الذي حاولت مؤسسات الدولة إخفاءها بمظاهر علمانية شكلانية لا تُعبر عن البنية العميقة لوعي المجتمع وبنية السلطة. وقد تزامن تراجع دور الدولة والمؤسسات المدنية والقوى السياسية، مع تنامي تأثير الفكر السلفي الذي اقترن بالجهاد الوافد والأصيل في قمع مظاهر الفكر التنويري والعلماني، ومع التراجع عن المفاهيم والانتماءات الوطنية. وقد عززت هذه التحولات التشتت والتناقض والصراع العصبوي المرتهن لإرادات دولية.
إن تخلّع البنى المجتمعية، وتشظيها إلى مكوناتها الأولية، وتدمير القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنى التحتية،والمرافق العامة، والمنشآت النفطية، سرقة وتهريب المشتقات النفطية، تفكيك المصانع وتهريبها، وضرب القدرة الدفاعية والهجومية للجيش السوري. يدلّل على مخاطر تحلل الدولة الكيانية، وإدخال المجتمع القائم على التنوع في صراع مركب ومتداخل. فتحوّل أشكال التناقض، من أشكال سياسية، إلى صراع ديني طائفي مذهبي عشائري جهوي عرقي اثني مسيّس. ساهم في تبدّل الحوامل الاجتماعية للتغيير، وانقسام المجتمع على ذاته أفقياً وعمودياً. وهذا يُخيف السوريين من مستقبل يمكن أن يحوّله العنف العصبوي، إلى كارثة وطنية، من سماتها تحلّل الدولة الكيانية ودخول مكونات المجتمع في صراع مفتوح ومركب. أخيراً نشدّد على أن الخروج من الأزمة إلى فضاء سياسي يعيد لقوى المجتمع زمام مستقبلها السياسي والاجتماعي ينحصر في تحمّل الأطراف السورية لمسؤولياتهم الوطنية. والتمسّك بالمفاهيم الوطنية والديمقراطية، ورفض العنف بكافة أشكاله ومستوياته، وتكثيف الجهود الوطنية من أجل إنهاء الصراع بما يضمن تحقيق أهداف السوريين في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ورفض كافة مظاهر التعصب (طائفي، عرقي، إثني، جهوي) ومجابهة مظاهر النكوص العصبوي، ورفض التدخل الخارجي، ورفض أي شكل من أشكال التبعية والارتهان. التمسك بوحدة الأطر الوطنية، وضع الأسس الكفيلة بإنجاح تسوية شاملة تضمن حقوق كافة المتضررين من الأزمة (مهجّرين، مخطوفين، معتقلين…). بعد تمكين حالات المصالحة الجزئية، يُفترض العمل على توفير الشروط المناسبة للانتقال إلى إنجاز مصالحة وطنية عميقة وشاملة تشكّل مدخلاً لحوار وطني شامل يمهد الطريق ويضع الأسس للانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي،الربط بين التنمية والديمقراطية. والمحافظة على عوامل قوة الدولة وتماسكها، فقوة الدولة واستقلال قرارها يشكّل الضمان لتحقيق التنمية والديمقراطية. أما في الدولة الفاشلة والمتحللة كيانياً، فلا معنى للحديث عن التنمية أو الديمقراطية، لأن الحديث عن إنجاز تنمية في هكذا دولة لا يعدو عن كونه هراء. فيما الدعوات إلى التحوّل الديمقراطي لا يعني إلا مزيداً من الضعف والتحلل للدولة.
* باحث وكاتب سوري
الأخبار
Print Article
سوريا: ثلاث سنوات من الثورة.. وسنتان من الخذلان/ إياد أبو شقرا
أكملت الثورة السورية، قبل أيام، ثلاث سنوات من عمرها، مع ملاحظة أن ثمة أوساطا في الغرب غيّرت تسميتها من «ثورة»، ولعلها الثورة الوحيدة في تاريخ العرب الحديث، إلى «حرب أهلية».
لمَ لا؟ «حرب أهلية» اسم مريح.. لأنه يبرّر التقاعس، بل الخذلان. لقد غدا مطلوبا تقزيم الحجم السياسي والأخلاقي للثورة السورية إلى «حرب أهلية». مطلوب على مستوى قيادة النظام.. ومطلوب كذلك إيرانيا وغربيا وروسيا وصينيا.
الجميع من مصلحتهم بعد ثلاث سنوات من الدماء والدموع والمعاناة الإنسانية الإشاحة بالوجوه بعيدا عن انتفاضة الشعب العفوية، التي ظلت سِلميّة نحو سنة في وجه القمع الفاشي الإجرامي، بحجة أنها «حرب أهلية». ففي الحروب الأهلية لا يصح الانحياز، إذ ليس فيها شاة وجزّار ولا ظالم ومظلوم ولا قاتل ومقتول. «الكلّ سواسية في سوريا» وفق منطق سيرغي لافروف. و«الحرب الأهلية السورية» مُعقّدة جدا كما قال لنا باراك أوباما وجون كيري وروبرت فورد، وهو ما علينا توقّعه أيضا من النجم الجديد في حلبة «اللافعل» الأميركية دانيال روبنشتاين!
بالأمس قرأت مقالة للدكتور جون شندلر، الخبير في شؤون مكافحة الإرهاب، أعجبني جدا عنوانها «لا أحد يعرف شيئا» حول جهل الجيل الشاب الذي يدير الشؤون الخارجية الأميركية – ومعظمهم دون سن الـ45 – بأساسيات السياسة والردع. عنوان المقالة اقتبسه شندلر من كتاب «مغامرات في مهنة السينما»، حول صناعة السينما، ألّفه وليم غولدمان عام 1983، وكان يكرّره غولدمان في إشارة إلى أنه على الرغم من الأموال الطائلة التي تُنفَق والساعات المُضنية التي تخصَّص لإنتاج فيلم، فإن أحدا من كبار هوليوود لا يستطيع أن يعرف مُسبقا ما إذا كان الفيلم سينجح أم يفشل. وبالتالي، فالمسألة كلها مسألة تخمين وافتراضات!
ومن ثَم، يقول شندلر إن الأزمة الأوكرانية اليوم تكشف تماما أن السياسة الخارجية الأميركية أيضا ليس لديها أدنى فكرة عن حصيلة تحركاتها وخياراتها. ويتابع: «قلت المرة تلو المرة إن سياسة أوباما الخارجية ضعيفة جدا، وإن الجهاز الذي يُديرها يعجّ بأشخاص مؤهلاتهم رائعة من الناحية النظرية لكنهم عاجزون عن التعامل مع أي مواجهة حقيقية مع موسكو.. والأسابيع الأخيرة أوضحت بصورة قاطعة أن البيت الأبيض يجهل تماما ما عليه فعله عندما تواجهه مشاكل صعبة يخلقها عتاة ميّالون بشكل روتيني لممارسة العنف الماكر والترهيب الفاقع». وبعدما أوضح شندلر أن هذا العيب لا يقتصر على حزب واحد أو إدارة بعينها، أردف «إن سببا من الأسباب هو أن الولايات المتحدة أنتجت جيلا كاملا من متمرّني السياسة الخارجية الذين لا يفهمون شيئا عن العالم الحقيقي من حولهم. إن المؤهلات المُبهرة التي نقرأها في السير الذاتية لهؤلاء الأربعينيين..لا تستطيع مقارعة عادة القتل بدم بارد التي تمرّس بها الكرملين، بقيادة قائده الأمني (فلاديمير) بوتين..»..
كلام جميل. ولعله يفسّر بصدق رد الفعل الباهت، بل الأخرق، الذي تبنّته واشنطن وتوابعها في الاتحاد الأوروبي إزاء خطوة جيو بولتيكية – استراتيجية في حسابات موسكو. بل إن في ظروف كهذه كان من الأفضل لواشنطن وحليفاتها ألا تفعل شيئا.. على أن تعلن إجراءات سخيفة وضعيفة لن تغيّر في المعادلة شيئا، ولن تردع بوتين – على الأرجح – عن مواصلة السير قدُما في إفشال أوكرانيا ككيان سياسي ذي سيادة.. مستثمرا نفوذ روسيا الكبير في شرقها وجنوبها.
ولكن لندع أوكرانيا جانبا، ونعد إلى الموضوع السوري.
كلام شندلر عن تواضع مستوى مخطّطي السياسة الخارجية الأميركية ومنفذّيها قد يكون صحيحا. إلا أن تعامل واشنطن مع سوريا مختلف. ففي سوريا، بجانب الموقف الأخرق هناك موقف مشبوه. ومن دون الحاجة للعودة إلى كلام أوباما لمجلة «ذي أتلانتيك» (مقابلة جيفري غولدبرغ) الذي أزعم أنه يشكل أهمّ «وثيقة» تكشف التوجّهات الحقيقية للرئيس الأميركي إزاء الشرق الأوسط، نلاحظ محاولة للتذاكي على جميع اللاعبين الإقليميين. وبالفعل، في مقالة ناقدة كتبها لي سميث أخيرا، في مجلة «الويكلي ستاندارد» اليمينية، اتهم الكاتب البيت الأبيض بشن حملة من «أنصاف الحقائق» Half-truths و«الأكاذيب» على امتداد ثلاث سنوات لتضليل الشعب الأميركي إزاء حقيقة موقفه من سوريا، وبالذات، التخفيف من واقع صعود إيران في الشرق الأوسط. وبعدما استخدم سميث عبارة «تاريخ الحرب الأهلية السورية أيضا سجلّ لأكاذيب البيت الأبيض»، أورد «سخرية» أوباما في مقابلة «ذي أتلانتيك» ممن يقولون «إن إيران ربحت في سوريا، التي كانت صديق إيران الوحيد في العالم العربي.. وهي اليوم خراب». وإضافته القول إن إيران «تنزف لإنفاقها مليارات الدولارات عليها.. وتابعها الأساسي حزب الله الذي كان يتمتّع بموقف مرتاح وقوي في لبنان، يجد نفسه اليوم عرضة لهجمات المتطرّفين السنّة». واستنتج «هذا الوضع ليس جيدا بالنسبة لإيران. إنهم أكبر الخاسرين».
أسوأ من كلام أوباما، قول سفيره المتقاعد روبرت فورد، الذي يعتبر نفسه «مُستعرِبا» في مقابلته الأخيرة في «الشرق الأوسط»، عن أن «تجربتنا في العراق علّمتنا أن الحلّ في سوريا ليس أميركيا..!!!». ذلك أن هذه عبارة تفتقر إلى المنطق أولا، وتستخفّ بعقول الناس ثانيا. وفيها يتبنّى فورد فكرة البيت الأبيض القائمة على أن التدخّل في العراق كان «خطأ لا يجوز تكراره»، لكنه يتجاهل الواقع السياسي والعسكري الذي أنتجه، ألا وهو تسليم العراق وسوريا ولبنان تسليم اليد لـ«الحرَس الثوري الإيراني».
هذا الواقع، إذا كانت واشنطن حقا ترفضه.. يستوجب تصحيح «الخطأ» بتغييره على الأرض. ولكن ما يدعو إلى الشك بصدق قول فورد، ومن خلفه مواقف البيت الأبيض، كما أكدت مقابلة «ذي أتلانتيك»، هو أن واشنطن تبني اليوم استراتيجيتها الإقليمية على أساس ديمومة مفاعيل ذلك «الخطأ» المزعوم لأنها لا تعتبر النظام الإيراني الحالي خصما.. بل شريكا إقليميا.
سوريا وثورتها – بل الهويّة العربية في المنطقة – تدفع اليوم ثمَن هذه «الشراكة».
الشرق الأوسط
ثلاث سنوات من الثورة في سوريا/ د. بشير موسى نافع
توالت التقارير، وهذا المقال يكتب، حول نجاح قوات نظام دمشق، بمساندة من حزب الله والميليشيات الشيعية، في السيطرة على مدينة يبرود. قاتل الثوار في المدينة طوال أسابيع ببسالة نادرة، ولكن مصير يبرود كان محتوماً، منذ بدأت قوات النظام وحزب الله في استهدافها، بدون أن يتوفر للثوار فيها طريق امدادات وتعزيزات منتظمة، يمكن أن يساعد على استمرار القتال في مواجهة قوة تتمتع بتفوق هائل في العدد والنيران، ولا تتقيد بأي قيم أخلاقية للحرب. ولكن، وبغض النظر عن الحسابات العسكرية، فليس ثمة شك أن سقوط المدينة المجاهدة يمثل ضربة معنوية للشعب السوري وثورته. هذه أوقات صعبة في مسيرة الثورة السورية، بالتأكيد، وكما في مسيرة كل الثورات في التاريخ الحديث، تستدعي الأوقات الصعبة مراجعة، أحياناً، وجلداً للذات، في أحيان أخرى. ولأن زمناً ملموساً قد مر اليوم على انطلاق الثورة، فليس من الغريب أن تستند هذه المراجعات إلى بعض من الحقائق، وبعض من الأساطير، وأن يؤسس لجلد الذات على الاثنين معاً.
لم تنطلق الثورة السورية، في 15 أو 18 آذار/ مارس 2011، بإرادة أو قرار قوة سياسية محددة. كان مناخ من الثورة والأمل في التغيير وإعادة بناء الذات السياسية قد اجتاح المجال العربي منذ سقوط وهرب الرئيس التونسي السابق بن علي في كانون الثاني/يناير 2011، وجاء التحاق سوريا بحركة الثورة العربية بصورة طبيعية. في البداية، كان ثمة حراك شعبي، محدود أو واسع النطاق، في عدد من المدن الكبيرة، مثل درعا وحمص وحماة وبعض أحياء دمشق وحلب، كما في دير الزور والقامشلي والرقة، وفي عدد آخر من المدن والبلدات الأصغر في ريف دمشق والساحل والشمال. ولكن النظام سارع، ومن الأيام الأولى للثورة لاستخدام اقصى وسائل القمع مع الشعب، وإلى تصنيف الحراك الشعبي طائفياً. من آذار/مارس إلى منتصف الصيف، اشتغلت آلة النظام الإعلامية، معززة بوسائل إعلام حلفائه، لوصف الحركة الشعبية بالإرهاب، والسلفية، والاندساس من الخارج، في تسويغ سابق التصميم والتصور لآلة القتل الجامحة التي أخذت في حصد أرواح السوريين، ونشر قوات الجيش في أنحاء البلاد، وبناء تماه صلب بين مصير العلويين، وأبناء الأقليات الأخرى، ومصير النظام. النظام، وليس أي قوة أخرى، من عمل من أجل دفع الشعب إلى التسلح، ومن أجل الانتقال بالحركة الشعبية إلى مربع الصراع الطائفي.
في نهاية آب/أغسطس، وعلى نطاق محدود، وبصورة غير ملموسة على الإطلاق، أخذ شعور متزايد وواسع بالإهانة يدفع قطاعات من السوريين إلى حمل السلاح، بداية ببلدات ريف دمشق وحمص. حتى الانشقاقات عن الجيش كانت لم تزل محدودة آنذاك، ولم يكن لأحد أن يأخذ إعلان حفنة الضباط المنشقين الصغيرة عن تأسيس الجيش الحر بأي درجة من الجدية. وفي شوارع المدن والبلدات، استمرت الحشود الشعبية في التوكيد على سلمية الثورة وعلى وحدة الشعب. وليس ثمة دليل على وجود تغيير جوهري في وضع النظام العربي والإقليمي؛ ليس حتى نهاية العام، على أية حال. كان المبعوثون الأتراك والقطريون والسعوديون (الدول التي ستتهم بعد ذلك بالتآمر على النظام) يتوافدون على دمشق، سراً وعلناً، يرجون أن يقوم النظام بمقابلة شعبه في منتصف الطريق، ويعدون بتقديم كل وسائل الدعم الإداري والمالي لإصلاح أحوال الدولة السورية والنهوض بالاقتصاد السوري. في الشارع العربي، السني والشيعي، طالما أصبح التصنيف ضرورياً، كان ثمة رغبة وأمل في أن يصل السوريون لحل، يضع حداً لنزيف الدماء، ويضع سوريا على طريق الإصلاح. مع نهاية 2011، كانت سورية تأخذ انعطافة ثانية، بعد انعطافة اندلاع الحركة الشعبية في آذار/مارس.
كذب النظام المستمر على شعبه وعلى حلفائه الإقليميين، واستمرار القمع الوحشي، سيما بعد الاقتحام الدموي لحمص وحماة، وإخماد الحركة الشعبية في مدن الساحل بأقصى درجات العنف، أسس لقطيعة كاملة في العلاقات مع تركيا والسعودية ودول الخليج، إقليمياً، وإلى توجه متزايد لحمل السلاح، من جهة، وإلى تصاعد حركة الانشقاق في صفوف الجيش، داخلياً. لم تتوجه الثورة نحو التسلح بقرار من حركة سياسية معينة، ولا بتشجيع من قوة عربية أو إقليمية. ولدت جماعات مسلحة، وبصورة متشرذمة، في كافة أنحاء البلاد، سيما في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، حيث التقاليد الإسلامية لم تزل عميقة الجذور، وحيث الشعور بالإهانة في أعمق صوره، وحيث الاغتراب عن الدولة في أشد درجاته. ولكن، هذا التوجه للتسلح لم يجد تأييداً من المجلس الوطني السوري، الذي كان يمثل المظلة الوحيدة للقوى السياسية المؤيدة للثورة آنذاك، قبل أن يولد الإئتلاف الوطني. والذي تعرفه أجهزة النظام ويعرفه حلفاؤه أن الجماعات المسلحة لم تتلق دعماً من الخارج، بأي درجة من الدرجات، طوال الفترة من نهاية 2011 وحتى صيف العام التالي، عندما أخذت تقارير في الإشارة إلى بداية تنسيق سعودي قطري تركي لمد يد العون الإغاثي والمالي والتسليحي للثوار. كان قرار التسلح، باختصار، قراراً شعبياً، كما قرار الثورة نفسها، وهو قرار رسبته سياسات النظام ووسائله القمع الفاشي التي وظفها للتعامل مع شعبه، وعجزه عن تقديم ولو دليل واحد على جدية بحثة عن مخرج سياسي للأزمة الوطنية السورية.
وهنا، تبرز أسطورة الثورة الثانية: أسطورة وجود خيار تفاوضي لم تتعامل معه قوى المعارضة بالجدية الكافية. تصور النظام في البداية أن بإمكانه بالفعل القضاء على الحركة الشعبية، وأنه لا يحتاج للتفاوض مع أحد. ولكن استمرار الحراك واتساع نطاقه، إلى جانب الضغوط المتزايدة من الحلفاء، دفعت النظام إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، التي اتضح سريعاً أنها لا تمثل سوى إصلاحات شكلية، لا أثر حقيقاً لها على أرض الواقع. لا إلغاء قانون الطوارىء ولا تعديل الدستور، أشار إلى نهج سياسي جديد. عندما يواجه نظام حكم ما، أي نظام حكم، معارضة شعبية بالمستوى الذي واجهه النظام السوري في 2011، وفي سياق حركة تغيير وإصلاح سياسي عربية، يصبح من الضروري أن يبدي قادة النظام مستوى كافياً للقبول بالتغيير، درجة ملموسة من التغيير. في سوريا، طوال أشهر 2011، كانت دعوات التفاوض الصادرة عن بعض قادة النظام تصدر جنباً إلى جنب مع صيحات ‘ الأسد للأبد أو نحرق البلد’، التي يطلقها شبيحة النظام في شوارع المدن والبلدات السورية. كل القوى السياسية وأغلب الشخصيات العامة داخل البلاد أرادت بالفعل الحوار والتفاوض، حتى عندما أبدى المجلس الوطني تردداً في الذهاب إلى خيار التفاوض. ولكن النظام، على أية حال، لم يطرح الحوار مع المجلس الوطني، ولم يكن يريده. الجلسة الرسمية الوحيدة للحوار الوطني مع طيف واحد من السوريين تقريباً، الذي ترأسه فاروق الشرع، لم تتلوها جلسة ثانية؛ وما إن طرح اسم الشرع كأحد مخارج الأزمة، أخفي نائب الرئيس عن الأنظار كلية، ثم أخرج نهائياً من هيكل الحزب والسلطة. كان بإمكان النظام، لو كان جاداً في دعوة التفاوض، أن يعقد حواراً مع هيئة التنسيق، التي لم تخف أبداً خلافها مع معارضة الخارج ورغبتها في التوصل لتسوية تفاوضية. ولكن النظام لم يتلفت لا لهيئة التنسيق ولا لغيرها. وعندما أجبره الضغط الدولي أخيراً على الالتحاق بمفاوضات جنيف، بذل وفده كل جهد ممكن لإجهاض المسار التفاوضي ومنع تقدمه ولو خطوة واحدة باتجاه الحل. الحقيقة، أن تصور النظام للمسار التفاوضي لم يتغير مطلقاً منذ 2011: أن المقصود بالتفاوض عودة سورية إلى ما كانت عليه قبل آذار/مارس 2011.
ينظر البعض، من جهة ثالثة، إلى حدث الثورة السورية، مقارنة بما شهدته دول الثورة العربية الأخرى، مثل تونس ومصر وليبيا. في ظاهر هذه المقارنة، تبدو سوريا وكأنها غرقت في نزاع أهلي مسلح، ليس له من نهاية، وتبدو الثورة السورية، بآلام لم يشهد لها العالم مثيلاً منذ الحرب الفيتنامية، وكأنها حدث مديد، لم يعد من الممكن أن يصل إلى نتيجة. حقيقة الأمر، أن ليس ثمة دولة عربية واحدة من دول الثورة يمكن أن يقال بأنها وصلت إلى نهاية الطريق، أو أن عملية الانتقال إلى الحرية والديمقراطية والعدل قد أنجزت بالفعل. كل دول الثورة العربية لم تزل في قلب المعركة على المستقبل، وكلها مهددة بالردة على مكاسب السنوات القليلة الماضية، بينما دول عربية أخرى توشك هي الأخرى أن تنفجر. في هذا التدافع التاريخي الكبير، سيتغير المجال العربي كله، أو لن يتغير. وكان قدر سوريا أن تتحمل العبء الأكبر، والأثقل وطأة، لعملية التغيير؛ ليس فقط لموقعها، فلكل من الدول العربية خصوصياتها الاستراتيجية، ولا لما تختزنه من ميراث تاريخي، فكل بلاد المشرق ترتكز إلى مواريث تاريخية عميقة الجذور، ولا حتى لتعدديتها الإثنية والطائفية، لأن العراق وتركيا وإيران لا تقل عنها تعددية؛ ولكن لسبب آخر، ربما هو الأكثر أهمية من ذلك كله: أن سوريا كـــانت ولا تــزال مفتاح النظام الإقليمي الذي ولد في نهـــاية الحرب الأولى، النظام الذي أسس لقرن كامل من الإهانة والبؤس وعدم الاستقرار.
ليس لأحد أن يتنبأ، على وجه اليقين، بما يمكن أن يؤول إليه مصير سوريا في المدى القصير، ولكن المتيقن أن النظام الفاشي في دمشق، ومهما بلغت قدرته على التدمير والقتل، ومهما كان حجم الحشد الطائفي الإقليمي، والاستبدادي الدولي، الذي يسانده، لن يستطيع أن يعيد تأسيس سيطرته على سوريا، ولن يستطيع إعادة بناء نظام تحكمه بالسوريين. أثبت النظام مصداقية بالفعل عندما هدد الشعب بالعودة إلى زمن الخضوع أو التدمير الشامل، وسيثبت السوريون مصداقية أكبر لإعلانهم بأنهم لن يركعوا بعد اليوم إلا لخالقهم.
‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
القدس العربي
عام رابع وخيار أوحد/صبحي حديدي
في 18 مارس (آذار) 2011 انتفض الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدل الاجتماعي، ضدّ نظام كان عدوّاً لهذه القِيَم جميعها، فحاربها طيلة أربعة عقود، وفرض بدلاً عنها نظام الاستبداد والفساد والحكم العائلي الوراثي وشبكات الولاء الطائفي، وقَهَر المجتمع عن طريق أجهزة أمنية مُنحت صلاحيات مطلقة في الاعتقال التعسفي والتعذيب وخنق الحريات، حتى دون حاجة إلى الأحكام العرفية التي فُرضت منذ العام 1963.
لقد باتت معروفة الآن جميع التفاصيل المأساوية التي يعاني منها السوريون، داخل الوطن وفي معسكرات النزوح والمنافي الكثيرة، نتيجة وحشية النظام في مساعي قهر الانتفاضة، واللجوء إلى أشدّ الأساليب عنفاً وفاشية، والتطبيق الفعلي لشعار: “الأسد، أو نحرق البلد”. ولم تعد خافية أنواع الأسلحة التي استخدمها، من المدفعية الثقيلة والدبابات، إلى صواريخ الـ”سكود” والطيران الحربي، مروراً بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية. كذلك انفضحت التكتيكات الأخرى غير العسكرية، من الحشد الطائفي وتسعير العداء بين فئات الشعب السوري، إلى ارتكاب المجازر وأعمال الاغتصاب والسلب بهدف دفع السوريين إلى ردود أفعال ثأرية يمكن أن تؤدي إلى اقتتال أهلي، وصولاً إلى تشجيع المجموعات الإسلامية المتشددة والجهادية والتواطؤ معها واستغلال ممارساتها البغيضة لتمرير رواية النظام عن هيمنة “الإرهابيين” على الحراك الشعبي.
ولأنّ هذه التكتيكات فشلت، أو لم تحقق إلا القليل من أهدافها، اضطر النظام إلى استقدام مقاتلين من “الحرس الثوري” الإيراني، و”حزب الله” اللبناني، وهنالك الآن قرابة 35 مجموعة أجنبية تحمل العبء العسكري الأكبر بالنيابة عن الوحدات الموالية. ومن المسلّم به أنّ العمليات القتالية التي شهدتها مناطق القصير ويبرود والقلمون، بصفة خاصة، دارت رحاها بين “الجيش السوري الحرّ” وهذه المجموعات الأجنبية، ولم يكن للنظام أيّ دور عسكري ملموس في حسمها.
سلاح النظام الأخير كان الدعم المطلق، المالي والعسكري والتسليحي والدبلوماسي، الذي تمتع به من حلفائه في إيران وروسيا؛ مقابل تلكؤ المجتمع الدولي عموماً، والولايات المتحدة خصوصاً، في اعتماد خيارات كفيلة بتعديل موازين القوى، سياسياً وعسكرياً. يُضاف إلى هذا ما تمارسه إسرائيل من ضغط خفي، وعلني أحياناً، لإطالة عمر النظام ما أمكن، تحت مبدأ أنّ “الشيطان الذي نعرفه”، أي آل الأسد، خير من أيّ “شيطان” سوري آخر يعقب سقوط النظام، ومن المؤكد أنه سيكون أكثر عداءً لإسرائيل، ولن يُبقي خطوط التماس في الجولان المحتل هادئة وساكنة وآمنة، كما كانت عليه حالها طيلة 40 سنة ونيف.
وليس غريباً أن يبدو مشهد الانتفاضة السورية بالغ التعقيد اليوم، في سنتها الرابعة. ذلك لأنّ مجمّع النظام، القائم على المؤسسة الأمنية والعسكرية المتحالفة مع المال القذر وشبكات المافيا المحلية والدولية، يواصل اعتماد خيارات في القمع ليست طرائق مستحدثة لقهر الانتفاضة الشعبية الراهنة، وحدها؛ بل هي جزء تأسيسي لا يتجزأ من ذلك النهج المتكامل الذي اعتمده النظام في العلاقة مع المجتمع، ونهض على مختلف طرائق الترهيب والقمع والتنكيل. وهنالك حفنة من الحروب الوجودية التي لا تُخاض على الأرض السورية إلا من باب الاستماتة في حفظ بقاء قوى وميليشيات وكيانات مذهبية أو طائفية او فئوية؛ على غرار “حزب الله”، و”الحرس القومي العربي”، وحزب التوحيد العربي”، في لبنان؛ أو “لواء أبو الفضل العباس”، و”جيش الإمام المهدي”، و”لواء أسد الله الغالب”، في العراق…
والمشهد بالغ التعقيد، أيضاً، لأنّ ما يجري ليس حرباً أهلية أو طائفية أو جهادية، بين أديان أو طوائف أو مذاهب أو إثنيات أو مناطق؛ بل هو انتفاضة شعبية تتعرّض لإبادة جماعية، وتطهير مناطقي، ومذابح تعيد إنتاج أبغض تقاليد الهولوكوست. ولهذا فإنّ انتصار الشعب السوري سوف يغيّر وجه المنطقة بأسرها، ولن يفتح المزيد من الآفاق أمام انتفاضات العرب الأخرى، في تونس ومصر وليبيا واليمن، فقط؛ لكنه سيكسر المشروع الفارسي الإيراني في مثلث العراق ولبنان وسورية، وسينقل الوعي العربي بمعنى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية إلى أطوار جديدة أرقى.
وإذا صحّ أنّ الانتصار قادم، لا محالة، وهو مسألة وقت؛ فالصحيح أيضاً أنه، وللأسف، يتطلب خسائر فادحة سدّدها، ويواصل سدادها، الشعب السوري. فلا خيار آخر تبقى أمامه، في نهاية المطاف.
القضية السورية.. نهاية العام الثالث/ د. رياض نعسان أغا
تحولت الثورة السورية إلى مأساة كبرى غير مسبوقة في التاريخ العربي، بل إن العالم يراها أخطر قضايا العصر، ويكاد يقف أمامها عاجزاً عن التقدم بأي حل عملي، وقد تجاوزت خطورتها ما حدث في نكبة فلسطين عام 1948 ونكسة عام 1967، بل إن ضحاياها تجاوزوا ضحايا الحرب الأهلية اللبنانية وضحايا الحرب على العراق. وستكون الفجيعة أكبر إذا بقيت جراح القضية السورية نازفة، وإذا استمرت حلولها معطلة أو مؤجلة كما هو الأمر في أفغانستان والصومال، وقد بت أخشى أن تنتقل المطالبة السورية بعد سنين إلى حق اللاجئين في العودة كما يسعى الفلسطينيون منذ ستة وستين عاماً، وقد سمعت مقترحات عجيبة تدعو إلى توطين اللاجئين السوريين في الفواصل الحدودية بين سوريا وبين دول اللجوء، مع بقاء ملايين من السوريين مهجرين ومغتربين يبحثون عن ملجأ أو إقامة أو تأشيرة لجوء أو هروب. والخطر الأكبر تنامي أعداد الأطفال الذين حرموا من دخول المدارس بعد أن تجاوزوا السادسة من العمر، ومن حرموا من المتابعة. وتشير التقارير الدولية إلى أن نحو ستة ملايين طفل سوري هم اليوم بحاجة إلى المساعدة بعد أن زاد عدد المحتاجين للعناية بنسبة مليون ونصف مليون خلال السنة الماضية التي شهدت مزيداً من النزوح الجماعي في الداخل والبحث عن أماكن لجوء في الخارج.
وإذا كانت المنظمات الدولية تتحدث عن 150 ألف شخص فقدوا حياتهم جراء الصراع الدامي فإن العدد الحقيقي لا يزال مجهولاً ولا يستبعد أن يكون عشرة أضعاف الرقم المعلن لأن من قضوا تحت الأنقاض لم يتمكن أحد من انتشال جثثهم لعدم وجود آليات تساعد على إزالة الأنقاض، كما أن أعداد من قضوا من الجيش السوري ومن مقاتلي النظام لا يزال خارج الإحصاء. وكذلك عدد من هم بحكم المفقودين يتجاوز عشرات الآلاف فضلاً عن المعتقلين الذين لا يوجد إحصاء مؤكد لأعدادهم ولكنها تقدر بمئات الآلاف.
ولابد من الاعتراف بأن غالبية السوريين يشعرون بانسداد الأفق واليأس من ظهور حل ينهي تصاعد المأساة التي لا يتحملها قلب ولا عقل، وما يحدث من فواجع يفوق في وحشيته كل ما سبق في تاريخ الحروب وما ينشر في مواقع الإنترنت من مقاطع مصورة عن أساليب القتل والترويع والإرهاب يفوق ما حدث في البوسنة بل ما حدث في العصور الوسطى في حروب المغول والصليبيين على رغم ما يرافق المأساة السورية من تدفق إعلامي غير مسبوق أيضاً، ولكن الضمير العالمي الذي لم يتحمل رؤية أطفال الغوطة وقد قتلوا بأسلحة كيماوية محرمة فقد حيويته وسلم الأمر لمؤتمر جنيف، الذي انتهى إلى مزيد من اليأس والضياع.
ومع أن مؤتمر جنيف حقق بداية للدخول في حل سياسي، حيث جلس فريقا المعارضة والنظام في حوار يعني اعترافاً متبادلاً، إلا أن إصرار وفد النظام على تحويل المؤتمر من كونه مؤتمر حل للقضية السورية إلى كونه مؤتمراً لمكافحة الإرهاب جعل المؤتمر فرصة ضائعة.
ولا أحد ينكر دخول منظمات إرهابية على خط الثورة الشعبية التي بدأت سلمية وكان من الممكن احتواؤها بذات القرارات التي جاءت متأخرة ففقدت صلاحيتها، ودخول هذه التنظيمات أفقد الثورة كثيراً من التعاطف في الداخل والخارج، وكثير من السوريين يعتقدون أن هذه المنظمات اصطنعت كي تشوه الثورة، وتأخذ أهدافها بعيداً عن الإرادة الشعبية، وتجعل السوريين يخشون الوقوع في فخ استبداد ديني متطرف يشهر عليهم سيف التكفير ويدعو إلى قيام خلافة إسلامية لا أحد يضمن أن يظهر فيها عدل عمر رضي الله عنه، أو إخلاص علي كرم الله وجهه.
والداعون إلى الخلافة يظنون أنها الشكل الوحيد للحكم في الإسلام، وهم يعيشون خارج العصر، بل خارج التاريخ.
والمؤسف أن دعاة الدولة المدنية الديمقراطية لم يجدوا دعماً دولياً يمكنهم من تحقيق هدفهم، في حين وجد الإرهاب من يدعمه ويقدم له المال والسلاح، وسرعان ما ظهر أمراء الحرب، وتحول كثير ممن يفترض أنهم يدافعون عن حقوق الشعب في الحرية والكرامة إلى حكام كانتونات، وزاد الأمر سوءاً ما وقعت فيه المعارضة السياسية في الخارج من تعدد الولاءات بسبب تعدد مصادر الدعم وغياب صندوق موحد يلم الشمل، ودخل في المعارضة من يشتتون وحدتها، مما جعل كثيراً من السوريين المتابعين عبر قنوات التواصل يمعنون في هجاء المعارضة ويعلنون فقدان الثقة فيها، حتى إن كبار شخصيات المعارضة باتوا يشكون غياب قيادة لها.
وكان مفجعاً أن يتجه النظام إلى سياسة كسر العظم بدل أن يلتقط اللحظة المناسبة حين جاءت المعارضة إلى حل وسط في جنيف، ذلك أن قبول المعارضة والنظام وقواهما العسكرية بالتفاوض هو مفتاح الحلول مع الاعتراف المحلي والعربي والدولي بأن الحلول العسكرية غير ممكنة، وقد كنت ممن تفاءلوا بمؤتمر جنيف، لقناعتي بأن الحل العسكري الذي (رفضته من البداية، وكان نقطة اعتراضي وتحذيري من كونه سيقود البلاد إلى الدمار، وسيفتحها أمام قوى الإرهاب، وسيحولها إلى صراعات طائفية، وهذا ما حدث) لم يعد قادراً على الحسم في كلا الضفتين، ولابد من إيجاد حل سياسي، وكنت وما أزال أرى أن انفتاح حرب الفوضى في سوريا لا منتصر فيه ولا مهزوم، فحتى المنتصر سيكون مهزوماً أمام فظاعة ما سيرثه من مسؤوليات وكوارث، من أخطرها تفتت الوحدة الوطنية، فعلى صعيد شعبي تحتاج سوريا إلى سنوات من العمل الجاد لتضميد الجراح وإعادة بناء الثقة، ولا تستطيع القوة العسكرية ولا القتل والاعتقال أو التهديد به، ولا قرارات المصادرة التي تشهر على معارضي الرأي والتعبير، أن تؤسس لمصالحة وطنية.
إن غياب الحكمة في البحث عن حلول هو ذاته ما كان سبباً في سقوط سوريا في مستنقع الفوضى، وغرقها في طوفان الدم.
واليوم مع بدء السنة الرابعة على تصاعد الفجيعة والتغريبة السورية الكبرى، ننادي كل حكماء سوريا وكل مثقفيها وقواها البشرية إلى مؤتمر وطني عام يتدارسون فيه مستقبل بلدهم، فالحل لن يكون إلا من الداخل وبيد السوريين أنفسهم، وها نحن نرى تراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية، وتراجع الدعم الإغاثي، وإن لم يجد السوريون على الضفتين فرصة لحل سياسي ينقذ سوريا، فإن الكارثة ستصبح أكثر فجائعية وربما تتعرض لإهمال دولي خطير مع انشغال العالم بما يحدث في منطقة القرم.
الاتحاد
الصراع مستمر والمصير مجهول/ زياد حيدر
في شهر نيسان المقبل، يعلن مجلس الشعب السوري عن بدء حملة الترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا، التي من المتوقع أن تجري في شهر حزيران المقبل، بعد إقرار المجلس قانوناً جديداً للانتخابات العامة، متوافقاً مع الدستور الجديد للبلاد، يفسح المجال أمام تولي الرئيس السوري بشار الأسد ولاية دستورية ثالثة، إن لم يحصل أي تأجيل.
لن يكون المشهد السوري قد اختلف كثيراً بعد شهرين على الأرجح، كما من غير المتوقع، أن يختلف جذرياً قبل أعوام تأتي. الحرب المستمرة، وإن تخللتها مصالحات، ونجاحات ميدانية، ستبقى بهويتها الإقليمية والدولية، وربما تستعر حيناً، وتهدأ حيناً آخر.
ما يشغل بال القيادة السورية غير ذلك. هما أمران بالدرجة الأولى، ترسيخ التقدم الميداني وإعلانه «نصراً»، وتوسيع أكبر قدر ممكن لعمليات المصالحة الوطنية «لتحييد أكبر قدر من العامل المحلي».
عديدون في سوريا يرفضون قطعياً أي تسمية تشير إلى «حرب أهلية» في البلاد. المعارضة والحكومة تتفقان، كما نادراً، على رفض هذه التسمية. بالنسبة إلى الدولة، ما يحصل من قتال هو بين الجيش الوطني ومسلحين أجانب مدعمين ببعض المسلحين المحليين «المغرر بهم»، وبالنسبة إلى المعارضة الحرب هي «ثورة شعب» ضد نظام.
لكن بالتغاضي عن جدل المصطلحات، ثمة من في هرم القيادة السياسية، وبين فاعليها، من تثبت من القناعة بأن حاجة البلاد، تتمثل دوماً بعد الحفاظ على قوة الجيش وتماسكه باعتباره عنصر الأمان الرئيسي للدولة، هو في تحقيق «المصالحات الوطنية». وهي مصالحات تتم طبعاً بعد استبعاد الأجنبي، وبين الأخوة المتقاتلين من الشعب الواحد.
منذ أسبوعين، وفي استعراضه لنتائج اجتماعات «جنيف 2» أمام مجلس الشعب، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن خيار الدولة المتبقي هو «الاستمرار بإنجازات قواتنا المسلحة التي تدعو إلى الفخر، ومواصلة الحوار مع مختلف مكونات المجتمع السوري والمعارضة الوطنية والجبهة الوطنية التقدمية…، وتشجيع المصالحات الوطنية التي تجري في أكثر من منطقة وتعميمها على باقي أرجاء الوطن لأن من شأنها التخفيف من نزف الدم السوري».
والكلام لا يجسد رأي الديبلوماسي الأول في سوريا فحسب. فوفقاً لما قاله مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ«السفير» فإن توجيهات رئاسية صدرت في الأسابيع الأخيرة من شهر شباط الماضي بالعمل على «استنساخ» نموذج الهدنة القائمة في حمص، التي جرت لإخراج المدنيين من الأحياء القديمة، وأسفرت عن تسليم 140 مسلحاً لأسلحتهم في الوقت ذاته.
وأعطيت التوجيهات لتشمل ريف دمشق وحلب، واللاذقية بالإضافة إلى حمص، خصوصاً كونها المدن التي تحوي «تجمعات سكانية كبيرة مختلطة».
وبالرغم من أن المسؤول يقر بأن كثراً يقفون ضد هذا النهج، سواء داخل الدولة أو بين المسلحين، «إلا أنه لا سبيل إلا باستمراره»، منوهاً بصعوبة الأمر على الطرف الآخر أيضاً، الذي اضطر أخيراً لإلقاء السلاح بعد سنوات من القتال، والخسائر الكبيرة.
وأعطيت التوجيهات بهذا الخصوص أيضاً للقيادات الدينية، وساهم مفتي الجمهورية الشيخ أحمد حسون، بلقاءات عديدة في الأسابيع الأخيرة مع شبان ورجال سلموا أنفسهم، بغرض تسوية أوضاعهم، وذلك بعد جهود مماثلة له، في مناطق أخرى من البلاد، شملت بلدات وقرى، قررت رمي السلاح الموجه ضد الدولة.
ويعتقد سياسيون وميدانيون، ولا سيما في قيادات الجيش، أن استعادة المساحات الجغرافية المحتلة والمضطربة، والتمهيد لقيام دولة موحدة سليمة من جديد، لا يكون إلا بهذه الطريقة، التي تقي الجيش من خسائر إضافية، وتمهد لباقي أجهزة الدولة إمكانية العمل من جديد واستعادة السيطرة الكاملة.
وتجري «المصالحات» الحالية متزامنة مع الحملة العسكرية، في أغلب الأحوال، وتعتمد على الحصار وعامل الوقت، في مناطق، وعلى الاختراق الأمني أو الاقتحام العسكري في مناطق أخرى. وكما بات معلوماً فإن أول شروط المصالحات هو إعادة رفع علم البلاد، كتعبير رمزي عن عودة المنطقة إلى كنف الدولة، وذلك استمهالاً لعمليات شاقة أخرى، تتمثل في إعادة التأهيل النفسي والاقتصادي والتنموي لتلك المناطق.
عملية ذات تحديات كبيرة، كما اعترف رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، في لقاء أجراه منذ اسبوعين مع التلفزيون المحلي. طرح الحلقي رقماً مذهلاً لحجم الأضرار المادية التي أصابت البنية التحتية، في دولة فاخرت طوال عقود بقدرتها على الاكتفاء الاقتصادي الذاتي.
فحتى الأشهر الأخيرة، بلغت كلفة الدمار في سورية 4,7 تريليون ليرة سورية (ما يزيد عن 47 مليار دولار). وبما أن التخريب لم يتوقف بعد، يستمر الحديث عن إدارة أزمة، ومحاولة الإبقاء «على خط حياة المستلزمات الأساسية للحياة اليومية» من طاقة وغذاء.
وأقر الحلقي أن قسماً كبيراً من الإنفاق الحالي يأتي من المجهود الحربي، الذي كان يستهلك سابقاً قسماً كبيراً من التحصيل الضريبي، وتجهد الدولة في سياسة الدعم الاجتماعي التي تكلف سنويا 614 مليار ليرة سورية. ولا يبدو واضحاً كيف يتم تأمين تكلفة ما تبقى من متطلبات، خصوصاً أن الحلقي يذكر رقماً آخر يجفف اللعاب، لحجم الاستيراد النفطي كل شهر في سوريا، المتمثل باستيراد ثلاثة ملايين برميل من النفط مقابل 800 مليون دولار، في بلد كان مخزونه الاحتياطي المعلن من العملة الصعبة يقارب 18 مليار دولار.
فهل سوريا في طور التحول إلى دولة دائنة؟ أم أنها تحولت إلى دولة مديونة وانتهى الأمر؟ خصوصاً أن مجمل مستوردات سوريا هي من قطاعات تصديرية قبل الأزمة، كالقمح والطحين والنفط والقطن وغيرها من المواد الإستراتيجية، من دون التذكير بتعطل العملية الإنتاجية بشكل يفوق نسبة تسعين في المئة. ولا يستثنى من الأعباء الثقل الاقتصادي الذي سيمثله «العائدون» من المناطق المهجورة والساخنة، وأعدادهم بالملايين في مخيمات متفرقة في دول الجوار، من دون الإشارة إلى عبئهم الأمني المحتمل أيضاً.
ميدانياً، لم يعد ثمة شك بأن الجيش، متحالفاً مع «حزب الله»، وبخط إمداد مفتوح من إيران ومشروط من روسيا سيبقي على تفوقه في المعركة. ويقر كثيرون بأن «النصر» الميداني لا يعني «الاستقرار الأمني»، حيث ستبقى البلاد تحت وطأة هذا الهاجس لعقود تأتي، بعد انتهاء الحرب.
جغرافياً، وعلى المستوى العسكري، يبقى الأكثر غموضاً مستقبل مناطق الشمال. وبالرغم من أنه بات بحكم المعلوم سراً، أن اتفاقاً يظلل العلاقة بين مجموعات الحماية الشعبية الكردية والجيش السوري، في ظل الاقتتال الحاصل بين فئات المعارضة الإسلامية المختلفة في تلك المنطقة، إلا أنه لا يزال مجهولاً كيف سيتطور مصير تلك المساحة من سوريا، وفي أي اتجاه.
معروف أيضاً أن الأكراد ينشئون من دون توقف كيانهم الذاتي في الشمال الشرقي، ويرفعون أعلام كردستان، تماماً كما ترفع أعلام بقية الفصائل في المناطق المتصارعة.
ومفهوم أيضاً أن القبول بسيطرة كردية تامة على تلك المنطقة لاحقاً، لن يكون ممكناً، لظروف إقليمية ودولية معروفة، ولغنى المنطقة الاقتصادي من جهة أخرى. أما بقية مناطق القطر فمصيرها يبقى معلقاً بقدرة الحسم الميداني للطرف الأقوى، والتي يبقى حتى اللحظة الجيش السوري متقدماً فيها.
ولا يساور أحد شك، بأن المعركة مع التطرف في سوريا، هي معركة طويلة جداً، وممتدة إلى الدول المجاورة، بحكم توسع هذه الجماعات وتفرع اصولها، لتكون تهديداً إقليمياً وربما دولياً، لا سورياً فقط.
أما سياسياً، فمن المتوقع أن تستمر عزلة سوريا الدولية في الفترة المقبلة. وحتى اللحظة ما من مؤشرات فعلية على حصول قفزات، سواء بحجة «التعاون الأمني» لمكافحة «القاعدة» أم لأسباب أخرى. ويرى محللون قريبون من مركز القرار أن الاشتباك الروسي الأميركي المتجدد لا يساعد على «حلحلة» الأمور في سوريا، بل إن ثمة مخاوف من «انتقام أميركي» على الأرض السورية.
كما أن السعودية لا زالت بعيدة عن إعطاء مؤشرات لبقية البلدان العربية بتوجه مماثل. وقبل تحول الحكم في تركيا إلى نقيضه من الصعب حصول التفاتات سياسية. لذا تبقي سوريا على علاقات مبطنة مع الإمارات، وعلنية مع سلطنة عمان، وتشبك أمنياً مع مصر، واقتصادياً وعسكرياً مع العراق. عدا ذلك، التحالفات الاعتيادية، وعلاقات رسمية جداً مع دول «بريكس» حتى اللحظة.
أما داخلياً، فما هو المنتظر سياسياً؟ تآلفت التصريحات مع بعضها البعض في شهر آذار. حزب «البعث» الحاكم، حدد بالطبع مرشحه لانتخابات الرئاسة بعد شهرين من الآن، ومن جهته دعا وليد المعلم إلى «الحوار الوطني» مذكراً بأحد إطاراتها كـ«الجبهة الوطنية التقدمية»، والتي تشكلت في سبعينيات القرن الماضي، ومثلت تحالف عدة أحزاب مع «البعث»، وإن غابت تماماً عن الرؤية في ظل الأزمة. كما تحدث الحلقي عن العمل على إعادة «بناء نسيج المجتمع في بعض المناطق»، وتركيز العمل على «المصالحة الوطنية»، وتوسعتها، وهو ما يوحي بأنه ما من مقدمات لتغيير جذري في التوجه السياسي الحالي، وأن مجمل التركيز سيصب على الاستحقاق الدستوري المقبل، تمهيداً للانتخابات الرئاسية المتوقعة بأكثر من مرشح في صيف هذا العام، ولكن من دون أية مفاجآت، إلا في حال أسفر اتفاق دولي إقليمي يجري تداوله إلى تأجيلها، إلى حين «نشوء ظروف تسوية سياسية»، وهي فكرة لا يزال الجانب السوري يرفضها بالمطلق.
السفير
ثلاثة أعوام سورية بين تجريبيتين/ غازي دحمان
مرّت ثلاثة أعوام على الثورة السورية، لعل أبرز ما فيها أنها شكلت تجربة سياسية فريدة، إن لجهة التطورات التي حصلت في سياقها وبنيتها، أو لجهة تأثيرها التفاعلي في أطر العلاقات الإقليمية والدولية، فضلاً عن كونها حدثاً مرشحاً على الدوام للتطور على أفق واسع من الفرص والمخاطر.
في خضم ذلك، برزت على مدار أعوام الثورة ظاهرة السياسات التجريبية، وخصوصاً تلك التي اتبعها الرئيس الأميركي باراك اوباما، ورأس النظام السوري بشار الأسد، وهي ظاهرة ساهمت نتائجها بكثير من عناصر المشهد الحالية كما يتوقع أن تكون لها بصمتها في مستقبل الصراع وتطوراته.
ولعل الذروة في هذا النمط التجريبي تمثلت بإعلان اوباما لخطوطه الحمر ثم الإعداد العسكري لضرب قوات الأسد بعد أن تجاوزت بالفعل تلك الخطوط الحمر، ثم تراجعه عن ذلك، لكن ما بين الإعداد للضربة والتراجع حصلت متغيرات مهمة في السياق العملاني للثورة حيث عمل حلفاء بشار الأسد على تجهيز مسرح المعركة لاستيعاب ضربة نوعية من قبل دولة عظمى، مما يعني زيادة حزمة المحفزات القتالية وتحسين أدائها، بحيث صارت اكبر من قدرات الثورة على كسرها، أو على الأقل غيرت من معادلة القوى على الأرض وصارت تلك المعادلة بحاجة إلى إعادة تفعيل خصوصاً على جبهة الثوار لتصبح موازية في القوة والكفاءة والأداء لجبهة النظام التي جرت تغذيتها بخبرات وأفراد ومعدات من قبل أكثر من طرف.
حصل الأمر مرّة أخرى في إطار إعلان الإدارة الأميركية البحث عن خيارات جديدة بعد فشل «جنيف -2»، حينها جرى تسريب إمكانية إشعال جبهة حوران عبر تنسيق إقليمي، ما حصل أن النظام أيضاً حسّن من قدراته بمساعدة الروس، حيث تزامن ذلك مع بداية إحداث أوكرانيا، واشتداد العصب الروسي.
كثيراً ما يجري وصف سياسة اوباما بالمترددة، الواقع أنها أعمق من ذلك، هي سياسة ترتكز على نظرية الديبلوماسية الناعمة وفكرة إعادة صياغة الانخراط الأميركي على المستوى العالمي، أما منهجيتها فتقوم على إحلال بدائل سياسية للتفاعل الصراعي مع القوى الأخرى، كالمفاوضات في حالة إيران، والحوار والتقارب مع روسيا، غير أنها في الملف السوري تأخذ نمط التجريب، ربما بسبب سيطرة إدراك سياسي لدى اوباما ودوائر صنع القرار الأميركي أن الحالة السورية غير مؤثرة كثيراً في الأمن القومي، وربما بسبب تشابكها الحاد مع قضايا حساسة ومتناقضة في آن، امن إسرائيل مثلاً والمكون الأصولي في الثورة السورية، وكذا مصالح روسيا وعدم الرغبة باستفزازها للحاجة لها في ملفات أخرى ومصالح الحلفاء الخليجيين من جهة أخرى.
تحت ظلال تجريبية رئيس أقوى دولة كان يتوقع حضورها في الحدث السوري، تولّد نمط تجريبي لدى رأس النظام السوري، كان يجري تطويره بين الحين والآخر، وتمثلت مصادر تلك التجريبية بعنصرين، الأول: سبر اتجاهات السياسة الأميركية من جهة، والثاني: لم تكن لدى النظام حتى وقت متأخر من اندلاع الثورة ضده تقدير موقف حقيقي لممكناتها ومساراتها ولا حتى لردود الفعل الدولية تجاه تصرفاته، وطوَر جزءاً كبيراً من سياساته تجاه الثورة بناء على قرائنه اللحظية لتوجهات السياسة الدولية.
تميزت تجريبية الأسد بكونها تنويع على وتر واحد، فهي اتبعت سياسة تدرجية باستخدام العنف من حيث الكم والكيف، مستغلة المجالات الحيوية التي كانت تفتحها سياسات الرئيس اوباما له، فحين وضع الأخير استخدام الكيماوي خطاً أحمر منحه هوامش واسعة باستخدام كل أنواع الأسلحة ما عدا الكيماوي، وحين قبلت إدارة اوباما بشروط جنيف وتجريب تحريك قواعد اللعبة منحت للنظام مساحة كبيرة للتحرك تتجاوز حدود التمديد الرئاسي للأسد وإمكانية إعادة انتخابه.
ولكن ما تجب الإشارة له أن تجريبية الأسد لها جذور عميقة في شخصيته وسلوكه السياسي، وقد ظهرت بوادرها الأولى في نمط تعامله مع الاحتلال الأميركي للعراق وتجريبه مشاكسة أميركا والتعاون الاستخباراتي معها بنفس الآن.
بين تجريبيتين مرت سورية بمخاض عسير، لا يتوقع أن تنتهي معه من دون سياسات واضحة الأهداف، وذلك لن يحصل من دون تفكيك عناصر تلك التجريبيات وتغيير شروط ممارستهما، لا يبدو في الأفق ما يبشر بذلك، في حين أن خيارات كثيرة صارت تبدو أسهل وأكثر إمكانية للتحقق.
* كاتب سوري
الحياة
على عتبات العام الرابع للثورة السورية/ سعاد نوفل
تدخل الثورة السورية عامها الرابع ولا تزال سفينة الموت تُبحر بدماء البسطاء من السوريين، ممن لم يستطع ترك البلاد والرحيل إلى حيث الأمان له ولأسرته.
ولنكن صادقين مع أنفسنا في هذه الوقفة، ونقول إن الكثير من السوريين باتوا اليوم يترحمون على أمرين: فمنهم من يترحّم على ما قبل الثورة، وهم ممن التزم ‘الحياد’، أي الرماديون، ومنهم من انخرط بالثورة لتكون ستارا لتاريخه غير المُشرّف وحماية لماله وعياله، وهم المتسلقون؛ أما البعض الاخر فهم الناشطون المدنيون الذين أرادوها سلمية كما بدأت، وعملوا على هذا الاساس ولم يحملوا السلاح، لكن دخول المتأسلمين على خط الثورة الذي لم يكن مفاجئاً، فمجازر حماة عام 1982 وهروب قيادات حزب الأخوان المسلمين، وترك الشعب تحت مطرقة الموت من قبل الاسد الاب ما تزال شاهدة عليهم. والمتأسلمون هم الذين يسعون جاهدين لتطبيق فكرهم بالقوة مستخدمين الدين الإسلامي وسيلة لتنفيذ مشروعهم. وفي الثورة السورية ظهروا بشكل جلي وكان لوجودهم وقعا سلبيا، حيث استطاعوا إفراغ الثورة من مضمونها الثوري الشعبي عندما ألبسوها عباءة الإسلام، وبذلك منحوا النظام فكرة محاربة الإرهاب والتطرف، فهم الخنجر المسموم الذي انغرس بخاصرة الثورة وفتح فيها.. لن نقول ثغرة، إنّما تسبب بتسمم جسمها. هذا بالضبط ما أراده النظام السوري.. أظهروا للشارع الثوري بعض الانتصارات على الأرض، لجعل الثوار يلتفون حولهم، ولكن سرعان ما سقط هذا القناع وبانت عوراتهم. فتنظيم ما يسمى ‘داعش’ شتت الثورة، وأفرز عناصر جُل عملها هو الإساءة لها في محاولة إظهارها بأنها العدو الأوحد للشعب. فرض الاستبداد الذي مارسه هذا التنظيم على الشعب باسم الدين الإسلامي، جعل الناس تترحّم على أيام النظام، وهذا ما أرادته عصابة الأسد عندما تمكنت بهذه الأداة التوأم الحقيقي لها أن تحوّل الثورة إلى صراع، حيث حاربت الكنائس واحتلتها، وفرضت الجزية على الاخوة المسيحيين السوريين، وهنا اظهرت للعالم أنّ الأقليات ستُعدم في حال سقوط الأسد وتسّلمهم السلطة، وأيضا محاربة الكرد السوريين ومضايقتهم في قُراهم، وبذلك هي تنفّذ كلام النظام بالحرف، عندما قال في بداية الثورة انّ ما يحدث في سورية هو فتنة طائفية وليس ثورة. داعش بسلوكياتها تمزق النسيج’الاجتماعي السوري والنظام من جهته وبمساندة إيران يشق الصف ما بين العلويين والسنّة بالحرب المفتوحة عليهم.. ما تقوم به داعش هو خدمة مجانية للنظام.. داعش تعمل على تعزيز التخلّف بكل أشكاله، وتقف بوجه الإنسان وتمتهن كرامته ورغبته بالحياة الكريمة. هذا لم يُحوّل مسار الثورة فقط، وإنما زاد من ويلات السوريين، وبات ذراعا للموت فنجد الجلد بالسوط والذبح بالسيف وقطع الأيدي، غالبا أمام العامّة لتربية شخصيات معقدة ودموية مستقبلا. لم يعمل هذا التنظيم إلا على تشويه الدين الإسلامي وتشويه الإنسان من الداخل.
ونحن اليوم على أعتاب عام جديد للثورة، ومن خلال مشاهداتنا للشارع السوري ممن تبقى طبعا فيه إن كان بالداخل، أو ممن حمل أسرته ونزح لبلد آخر، أو سكن في مخيم بائس، نستطيع أن نقول: ما من أحد بقي يتغنّى بأمجاد الثورة إلا من نال حفنة من مال مسروق تحت اسم غنيمة او بيتا كَبّر عليه، والأمر بات مكشوفا لأبسط الناس. وطبعا السرقة هنا لم تعد تقتصر على المحتاج، إنّما تعدت لتشمل المُتنفذين الذين وجدوا في الثورة فرصة لزيادة ثروتهم وجشعهم الذي لا نهاية له، وذلك عن طريق زج أحد ابنائهم أو إخوتهم بلواء إسلامي، وبذلك يضمن حماية وزيادة لأمواله وتجارته، وفي الوقت نفسه يكسب لقب أبو الثوار. عند هذه الوقفة نكون قد وصلنا لمقولة الثورة باتت ثروة للبعض من ضعاف النفوس وما أكثرهم.
صراع أراده النظام في سورية وأطراف أخرى ساندته، وأعتى المحللين لا يمكنهم التكهّن بما تحمله السنة الجديدة من عمر الثورة للسوريين.
‘ ناشطة عايشت الثورة لعامين ونصف العام
في الرقة قبل أن تضطرها داعش إلى الملجأ التركي