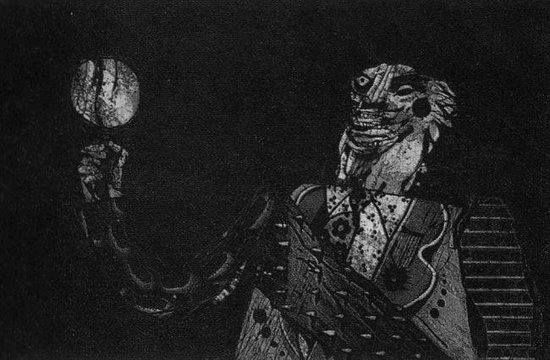هل هناك فرص للحل السياسي في سورية، محاولات تعويم الأسد –مجموعة مقالات-

خرافة الحل السياسي في سورية/ برهان غليون
ليس هناك شخص عاقل واحد يعتقد أن من الممكن التوصل إلى حل سياسي مع بشار الأسد، ومن ورائه، مع خليفة قم علي خامنئي، تماماً كما لم يكن من الممكن لعاقل في عموم أوروبا أن يعتقد أن من الممكن التوصل إلى حل سياسي مع أدولف هتلر. وهذا ما أثبتته الأحداث على مدى السنوات الأربع الماضية. فالأسدية ليست بالأصل سياسة، إنها الحرب، ولم تعرف يوماً التعامل مع الشعب بغير العنف والإخضاع بالقوة والقهر. ومشروع النظام القائم على الانفراد بالسلطة والسيطرة من طغمة مافيوية فاشية، لا يقبل أي بديل عن لغة التصعيد الانتحاري، وشعارها: إما قاتل أو مقتول، ولا توسط بينهما. أما طهران التي تمسك، اليوم، بمصير هذه القيادة الانتحارية، فهي تعيش حالة من الجنون القومي المذهبي الذي يدفعها إلى الركض وراء سراب إعادة بناء الامبرطورية الفارسية على أسس دينية في المشرق العربي كله، كجزء من تحدي الغرب والتاريخ، وتنظر إلى سورية باعتبارها حجر الزاوية في مشروعها الإمبراطوري هذا، وتعرف أن التخلي عن السيطرة عليها، أو القبول بالمشاركة فيها مع قوى إقليمية أخرى، بل حتى مع الشعب السوري نفسه، يقوّض طموحها، وليس أمامها خيار سوى الاستمرار في التصعيد، مهما كانت الخسائر، إلى أن
تحقق أهدافها. تبدو قم، اليوم، مدانة بالدخول في المغامرة نفسها التي دفعت الحركة الصهيونية إلى ارتكاب جريمة الإبادة السياسية، قبل الجسدية، لشعب كامل: ترسيخ الاحتلال وإدامته لتغيير البنية السكانية، وتغيير البنية السكانية، على الأقل في المناطق الاستراتيجية، لترسيخ أقدام الاحتلال في سورية ولبنان بعد العراق. وهي تحلم أن تحقق ذلك من خلال التفاهم مع واشنطن، في سياق التوقيع على الملف النووي، والتغطية على مشروع احتلالها بفكرة المقاومة لإسرائيل، والتي تعني، في العمق، تقاسم النفوذ في المنطقة، بعد التوصل إلى تفاهم رسمي مع تل أبيب، يسمح بتقنين وجودها في سورية، تماماً كما حصل من قبل عند تقنين وجود نظام الأسد في لبنان، ثمن ضمانه أمن إسرائيل.
لهذا السبب، أخفقت كل مبادرات الحل السياسي، سواء التي بدأها أصدقاء النظام، منذ الأشهر الأولى من الثورة، القطريون والأتراك والسعوديون والأوروبيون وغيرهم، كما أخفقت مبادرة جامعة الدول العربية، ومن بعدها بعثة كوفي أنان لتطبيق بيان جنيف، ومهمة الأخضر الإبراهيمي التي انتهت مع فشل لقاء جنيف2 الذي لم يشهد أي نقاش سياسي، سوى الاتهامات بالتخوين والشتائم السوقية التي كالها وفد الأسد لوفد المعارضة. وقد اضطر المبعوثان الكبيران للاعتراف بفشلهما، ومسؤولية نظام الأسد عنه، وقدما استقالتهما.
أما المبادرات المتعددة التي يدور الحديث عنها، بعد فشل مؤتمر جنيف، فهي لا ترقى إلى مستوى المبادرات، ولا حتى الأفكار الواعدة. ومعظمها لا يهدف إلا إلى اللعب على المعارضة، السياسية والعسكرية، بهدف تأهيلها لتقديم التنازلات التي من “المحتمل” أن تساعد على تذليل العقبة الروسية، مع العلم أن روسيا، على الرغم من دورها العسكري المهم، ليست قادرة على فرض أي حل، لا على الأسد ولا على طهران. ولا يختلف الوضع عن ذلك في ما يتعلق بمبادرة مبعوث الأمم المتحدة، ستيفان ديميستورا، التي تعترف سلفاً بالفشل، ولا تطمح، مع غياب أي أمل في حل سياسي أو عسكري، إلى أكثر من المساعدة على عقد هدن محلية، بهدف التخفيف من معاناة السكان، هنا وهناك.
السياسة ليست بديلاً للحرب
“تعيش طهران حالة من الجنون القومي المذهبي الذي يدفعها إلى الركض وراء سراب إعادة بناء الامبرطورية الفارسية على أسس دينية في المشرق العربي كله”
من هنا، لا يعني الاستمرار في تمسك الأمم المتحدة والدول الكبرى والعالم بالحل السياسي أن هناك اعتقاداً لدى أحد بوجود إمكانية للحل بالفعل، وإنما هو وسيلة للتهرب من الاستنتاج المنطقي لانعدام فرص هذا الحل، وما يمليه ذلك من واجبات والتزامات على الأمم المتحدة والدول التي يلزمها ميثاقها بعدم الوقوف مكتوفة الأيدي أمام حرب إبادةٍ، تقوم بها طغمة أصبحت أداة بيد دولة أجنبية، بعد أن اختطفت الدولة ومؤسساتها. بمعنى آخر، يستخدم اللعب بالحل السياسي لملء الفراغ الدبلوماسي، وتغذية الوهم بأن هناك تحركاً دولياً، وأن الشعب السوري ليس متروكاً وحده يذبح على مرأى العالم ومسامع الدول الكبرى، وهذه هي الحقيقة. كما تستخدم المبادرات أو المناورات الدبلوماسية للتغطية على الفشل الذريع للأمم المتحدة، وبان كي مون شخصياً، في اتخاذ إجراءات حاسمة، لوقف الحرب، أو التخفيف من معاناة السوريين. لكن وظيفتها الأهم والأخطر هي حرف نظر الرأي العام السوري والعربي والدولي عن الاستقالة الأخلاقية والسياسية للغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، تجاه الأزمة السورية. وقد استخدمت، خلال السنوات الأربع الماضية، لخداع المعارضة، وتبرير رفض واشنطن القيام بأي عمل جدي لإنقاذ الشعب السوري.
لن تكون هناك نهاية للحرب، مع استمرار الخيارات السياسية الراهنة للدول، وللولايات المتحدة بالذات. ولن يكون هناك أي حل سياسي، لا يكون مجرد استسلام للأسد وخامنئي، ما لم يتم تحطيم آلة الحرب المشتركة للقرداحة وطهران، والمكونة من بقايا الجيش السوري والمليشيات المذهبية المجيشة من عشرات الدول والبلدان. وكل تأخير في إنجاز هذا العمل لن يعني سوى السماح بمزيد من التصعيد في العنف والوحشية، ومن تفاقم الأزمة السورية ومعاناة السوريين، ومن مخاطر انتقالها إلى الدول المجاورة.
لا مهرب من تدخل عربي
إذا كانت الدول الغربية لا تشعر بالخطر القريب من جراء استمرار القتل والدمار في سورية، ولا تعاني من غياب الحل السياسي وانعدام إمكانية الحسم العسكري معا، فذلك لا يمكن أن ينطبق على البلاد العربية، ولا على تركيا التي تعيش في قلب العاصفة، سواء بسبب ما يتعرض له أمن هذه الدول، القومي والأهلي، من تهديدات خطيرة بانهيار الدولة السورية، والإمساك بها من طهران وقوات الحرس الثوري، واستخدامها منصة للعدوان على جاراتها والضغط عليها، أو بسبب إسقاطات الأزمة السورية، السياسية والإنسانية عليها. ولا ينبغي للدول العربية، وليس من مصلحتها، أن تقف مكتوفة الأيدي، أو تنتظر حتى يكتمل انتشار سرطان العنف والفاشية في جسدها. عليها أن تتحرك، وتجبر الأمم المتحدة، وبقية دول العالم، على السير وراءها، للدفاع عن مصالحها القومية ومصالح شعوبها.
فسورية ليست جزءاً من الوطن العربي فحسب، لكنها مركز توازن المشرق بأكمله. والسيطرة عليها ستحدد مصير المنطقة ومآلات السيطرة الإقليمية. الاستمرار في تجاهل ما يجري فيها يعني، ببساطة، تقديم سورية لقمة سائغة لطهران، والتخلي عنها لصالح سيطرة المليشيات المذهبية المتطرفة من كل دين، أي القبول بالاستسلام الكامل أمام التوسعية القومية المذهبية الإيرانية والاعتراف بالهزيمة من دون حرب، وتكريس شلل المجموعة العربية وانقسامها، وتشجيع خصوم الدول العربية جميعا على التحرش بها، والاعتداء عليها، بما في ذلك مليشيات المرتزقة والمجموعات الإرهابية، وفي النهاية، خسارة كل الجهود التي بذلتها بلدان المنطقة، للحفاظ على الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي.
كان على الدول العربية، ولا يزال، أن تعتبر قضية الحرب الدموية في سورية قضية عربية أولاً، وتدعم مبادرتها السياسية، التي تبنتها الأمم المتحدة، وتحولت إلى مبادرة أممية فاشلة، بسبب غياب آليات العمل وأدوات التنفيذ، بمبادرة عسكرية تفرض على الأطراف السورية الإذعان لمبادئها وشروطها، وتضع حداً لسفك الدماء وتمزيق البلاد وتسابق المجموعات الإرهابية والميليشيات المذهبية على السيطرة على أراضيها، وإقامة إمارات خاصة فيها.
“يستخدم اللعب بالحل السياسي لملء الفراغ الدبلوماسي، وتغذية الوهم بأن هناك تحركاً دولياً، وأن الشعب السوري ليس متروكاً وحده يذبح على مرأى العالم ومسامع الدول الكبرى”
فأمن سورية جزء أساسي من أمن المشرق العربي، وهذه حقيقة وليست على سبيل المبالغة. وسوف يتأكد ذلك أكثر مع الزمن، بعد أن تظهر الانعكاسات الخطيرة لأزمتها على الدول والمجتمعات العربية القريبة والبعيدة، بل على العالم أجمع. وتكفي الإشارة، منذ الآن، إلى الخلل الاستراتيجي الذي أدت إليه بتمكينها طهران وحلفاءها من تطويق الجزيرة العربية، وتهميش مصر وشمال أفريقيا وإخراجهما من المنطقة، وإطلاق شياطين الحرب المذهبية والطائفية الإقليمية التي تهدد الجميع، وتفكيك نسيج المجتمع السوري، ودفع الملايين من أبنائه إلى اللجوء والتشرد والضياع، وما يعني ذلك من كارثة إنسانية للسوريين ولعموم المنطقة، من دون الحديث عما أصبحت الأرض السورية تمثله من مرتع لبؤر التطرف الديني وغير الديني، ومن قطب جذب لجميع العصابات الدموية إلى المنطقة.
والحال أن الدول العربية استهانت بالصراع السوري، ورمت مسؤولية حله على الأمم المتحدة مع علمها بأن مجلس الأمن معطل، ولن يكون هناك أي تدخل دولي. واستمرت في سياسة النعامة، خلال سنوات أربع طويلة، من دون أي رد فعل، واكتفت بتقديم فتات الدعم المادي والعسكري والسياسي لقوى مدنية، تسلحت على عجل، ولم تعرف حتى كيف تساعدها على ضبط تنظيمها وتدريبها وتأهيلها، واستهانت بإرادة الهيمنة الإيرانية، وتركتها تحقق أهدافها من دون أي رد فعل. فأعلنت طهران سيطرتها على باب المندب، وإلحاق اليمن صراحة بمشروعها الإقليمي، وإرادتها في تطوير هذا المشروع، في اتجاه دول الخليج في المستقبل. وبهذا تكون الدول العربية قد فتحت أبوابها لكل المخاطر والتهديدات.
ما كان يتوجب على العالم العربي أن يفعله لا يزال يحتاج إلى أن يُفعل. والتأخر في إنجازه لن يحل الأزمة، لكنه سوف يزيد من تكاليف مواجهتها ومخاطرها الإنسانية والسياسية والعسكرية، بصورة يمكن أن تصبح غير قابلة للاحتمال، بمقدار ما سوف يدفع إلى تفاقمها، ويوسع من دائرة انتشارها وتهديداتها. ما كان على أوروبا أن تفعله لمواجهة النازية الهتلرية هو تماما ما ينبغي على البلاد العربية وتركيا أن تفعلانه، بدعم من الأمم المتحدة والتحالف الدولي، أم بدونهما. وهذا هو الوقت، وليس بعد أن توقع واشنطن وطهران مذكرات التفاهم وحل موضوع الملف النووي الإيراني.
العربي الجديد
ممكنات حل سياسي قريب في سوريا/ عمر كوش
انسداد الأفق
محاولات دي مستورا
حصاد الروس
كثرت المبادرات والخطط المطروحة لإيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية، دون أن تفضي إلى تخفيف وقع الكارثة التي أصابت سوريا والسوريين، وذلك بالرغم من مرور أربع سنوات على بدء الأزمة.
وتبدو الممكنات الفعلية للحل المأمول ومتحققاته بعيدة المنال وفق المعطيات الراهنة، إذ لا يزال النظام السوري يعتقد أن بإمكانه القضاء على معارضيه، والعودة بسوريا وناسها إلى ما قبل الخامس عشر من مارس/آذار 2011. وفي المقابل، هناك من يعتقد من المعارضين للنظام أن بالإمكان إسقاطه عسكرياً.
وقد بات واضحاً للجميع أن الأزمة الوطنية العامة تحولت إلى حرب كارثية تخوضها إيران والمليشيات الطائفية (اللبنانية والعراقية والأفغانية وسواها) التابعة لها، دفاعاً عن بقاء النظام الأسدي ومن أجل إعادة تثبيته بقوة السلاح، ورغماً عن إرادة غالبية السوريين.
انسداد الأفق
تفترض أبجديات علم السياسة أنه للتوصل إلى أي حلّ سياسي لأزمة سياسية ما، يتوجب على الأطراف المتصارعة أن تحتكم إلى حقل السياسة وأن توليه اهتماماً، أو أن يُفرض عليها حل سياسي تتوافق عليه مجموعة من القوى الدولية بوصفها ضامنة لإنجاح خطواته، كما حصل في مواضع عديدة من العالم مثل دول البلقان ولبنان.
وهو أمر لم يحصل إلى يومنا هذا في الأزمة السورية، فالنظام الأسدي -الجاثم على صدور السوريين منذ ما يقارب نصف قرن- لا يعترف بالسياسة ولا يسمح للسوريين بخوض غمارها، بل وجرّد المجتمع السوري من أية ممارسة سياسية بعد أن صادر فضاءه العام.
وجسدت مصادرته إغلاق الحقل السياسي ومنع التواصل والاجتماع العام، وبالتالي منع أي نقاش أو حوار بين عموم السوريين يمكنهم من خلاله أن يتناولوا فيه شؤونهم ومشاكلهم وهموهم، ويبحثون فيه عن ممكنات ومعالم طريق الانتقال السلمي نحو مندرجات دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تضمن المواطنة وحقوق المواطن، وتنهي احتكار السلطة والاستبداد المقيم منذ عدة عقود.
وأفضى انتفاء السياسة ومصادرتها إلى اغتيال صوت العقل لصالح الجنوح إلى نهج أمني وعسكري لا يعرف سوى لغة القمع والتوغل في استخدام العنف المنفلت من عقاله، والذي حصد -ولا يزال يحصد- أرواح مئات الآلاف من السوريين، بعد أن قسّم النظام السوريين إلى معسكرين: “واحد معنا، وآخر ضدنا”.
وكان ينظر إليهم -ولا يزال- بوصفهم خانعين اضطروا للوقوف معه أو خونة يقفون ضده، وعليه فتجب تصفيتهم ومحاربته باعتبارهم جراثيم ينبغي القضاء عليها، حسبما وصفهم بشار الأسد في بدايات الثورة.
وعلى هذا الأساس، بدأ النظام منذ أربعة أعوام شن حرب شاملة على المحتجين الذين كانوا سلميين وعُزْلاً في بداية الثورة، ورفع شعار “الأسد أو نحرق البلد”.. و”الأسد أو لا أحد”، للتعبير عن بدئه حرباً شاملة، وبالتالي فلا يمكن لمن يمتلك مثل هذا العقل والنهج أن يحتكم إلى السياسة، أو أن يقبل بحل سياسي للأزمة.
ولذلك عمل النظام على إفشال كافة المبادرات والمقترحات والخطط الهادفة إلى إيجاد حل سياسي منذ أربعة أعوام، بدءاً من محاولات من كانوا في صف أصدقاء النظام مثل قادة تركيا وقطر وفرنسا، ومروراً بمبادرة الجامعة العربية وإفشاله مهمة المراقبين العرب ثم إفشاله خطة كوفي أنان، ووصولاً إلى إفشال مفاوضات مؤتمر جنيف-2، واعتراف الأخضر الإبراهيمي بإفشال النظام السوري لمهمته.
محاولات دي مستورا
بعد فشل مؤتمر جنيف-2 واستقالة الإبراهيمي، عُيّن ستيفان دي ميستورا مبعوثاً أممياً إلى سوريا، وطرح مجموعة من الأفكار لا ترقى إلى مصاف مبادرة لحل سياسي في سوريا، وتهدف إلى نسف الأساس السياسي الذي نهض عليه “اتفاق جنيف-1” في 30 يونيو/حزيران 2012، والمتعلق بالتوصل إلى تشكيل هيئة الحكم الانتقالية الكاملة الصلاحيات، وكذلك البنود الستة التي تضمنتها خطة كوفي أنان، بالرغم من حديثه عن أنه يستند إلى الاتفاق في تحركاته.
والبديل الذي قدمه دي ميستورا هو التركيز على “تجميد القتال” في مناطق محددة مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إليها، وذلك انطلاقاً من فهم يقوم على اختصار الأزمة السورية إلى مجرد أزمة إنسانية، تحقيقاً لمقولته التي تعتبر أن “المشكلة الأساسية في سوريا تكمن في الأزمة الإنسانية”.
لا جدال حول أهمية المسألة الإنسانية في سوريا التي يجب أن يضمنها المجتمع الدولي دون نقاش أو تردد، إلا أن ما يطرحه دي ميستورا، يتضمن خروجاً عن المهمة الأساسية التي أوكلت إليه، والمتمثلة في تكثيف جهوده لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة ويلبي طموحات الشعب السوري.
حيث بدأ يتنصل منها شيئاً فشيئاً، فطرح جملة من الأفكار التي تبدأ من الأسفل، دون المساس برأس نظام الحكم، وتحدث في البداية عن تجميد القتال في أكثر من 15 منطقة سورية، ثم عاد وتراجع عن طرحه -بسبب معارضة النظام- ليقتصر على تجميد القتال في مدينة حلب.
وبعدها راح يتحدث عن “إيجابية النظام” وترحيبه بخطته، ثم أطلق تصريحات وقام بعدد من الزيارات إلى دمشق تصب في سياق رفع مستوى التنسيق مع نظام الأسد إلى مستوى تعويمه وإعادة تأهيله بإعادة الاعتراف الدولي به، وجعله شريكاً في الحرب على داعش، بل واعتبره جزءا من الحل في سوريا.
كما طالب المعارضة بالتوحد مع النظام “لمواجهة خطر داعش الذي يتهدد الجميع”، مستغلاً انشغال المجتمع الدولي وتركيزه على الحرب ضد تنيظم داعش، ليسوق أفكاره كي تتناغم مع الجهود الرامية إلى تحويل كل الجهود نحو هذه الحرب.
وتجاهل دي ميستورا -عن قصد ودراية- دور الأسد في جذب الإرهابيين وتوفير ممكنات تمددهم، لكونه المسؤول عن إطلاق سرحهم من سجونه، ولانسحاب قوات جيشه من العديد من المواقع لصالحهم، حتى باتوا قوة لا يمكن تجاهلها.
حصاد الروس
وبدورها، استغلت روسيا الفراغ السياسي الذي أحدثه تراجع الإدارة الأميركية في التعامل مع الملف السوري، وظهر تحرك روسي شحيح المحصول، تجسد في زيارات واتصالات قام بها عدد من المسؤولين الروس، بدءاً من التنسيق مع المسؤولين في كل من طهران ودمشق، ومرورا بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا، ووصولا جولات ميخائيل بوغدانوف (نائب وزير الخارجية الروسي) في كل من إسطنبول وبيروت والقاهرة، التي التقى خلالها شخصيات في المعارضة السورية، وانتهاء إلى عقد لقاء تشاوري بموسكو في الفترة ما بين 26 و29 يناير/كانون الثاني الماضي، بين وفد من النظام وآخر من المعارضة التي يمكن وصفها بأنها معارضة من أجل النظام وليست ضده.
وظهر أن ما بذله الساسة الروس من جهود وما طرحوه من أفكار لحل الأزمة السورية لم يرقَ إلى مصاف مبادرة متكاملة لها مرجعية وأسس وخطوات محددة، ولم يحظ برعاية دولية من طرف الدول الفاعلة في الملف السوري. ولذلك، بدوا وكأنهم يستغلون فراغاً سياسياً يحاولون إشغاله، في ظل غياب الفاعلين الآخرين في الملف السوري عن القيام بأي فعل لحل أزمته الكارثية.
وارتكز التحرك الروسي حيال الأزمة السورية على تطلع الساسة الروس للقيام بدور وسيط يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة، لكن حيثيات تحركهم مشدودة إلى طرف النظام، وتحاول إعادة تأهيله وتلميعه بالنظر إلى الدعم العلني الذي قدمته روسيا إلى النظام السوري -على مختلف الصعد- منذ بدء الثورة السورية.
ولا تبتعد حيثيات التحرك الروسي عن فرضية مفادها أن النظام والمعارضة وصلا إلى نهاية الطريق في الأزمة، وأن حالة من الاستعصاء باتت تسود الوضع، بعدما تبيّن أن قوات النظام غير قادرة على استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، مما يعني أن النظام لم يعد يحكم كل سوريا.
وفي المقابل، فإن المعارضة أيضاً أضحت غير قادرة على الاحتفاظ بجميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها أمام هجمات النظام من جهة، وهجمات التنظيمات المتطرفة (خاصة “جبهة النصرة”، وتنظيم “داعش”، من جهة أخرى)، الأمر الذي يقتضي توحيد جهود المعارضة والنظام للوقوف في وجه التنظيمات والمجموعات الإرهابية.
ولا شك في أن الروس نسقوا تحركاتهم مع ساسة النظام الإيراني لتسويق حلّ سياسي للأزمة السورية يخدم النظام قبل كل شيء، ولم يفتهم التشاور مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لموسكو مؤخراً.
وربما، تكفل الأخير خلالها بإطلاع السعوديين على الطرح الروسي، وتسويق مقولة إن الحرب ضد داعش هي حرب ضد الإخوان المسلمين أيضاً، وأن لا فرق بين الاثنين باعتبارهما “تنظيمين إرهابيين” بالنسبة له، وبالنسبة للمملكة السعودية التي تصر على إيجاد بديل عن بشار الأسد.
وأظهرت حصيلة التحرك الروسي أن الساسة الروس يهمهم التركيز على الشكل دون الاهتمام بمضمون ما يطرحونه، لذلك انفضّ لقاء موسكو التشاوري السوري/السوري دون أن ينتج عنه شيء يذكر بشأن التوافق أو الاتفاق على خطوات أو حتى مقدمات لحلّ سياسي للأزمة السورية، التي باتت تشكل كارثة مدمرة ضربت البلد وناسه، وبصورة غير مسبوقة في التاريخ السوري قديمه وحديثه.
ويبدو أن ما زرعه الروس قد حصدوه، حيث إن اللقاء لم يحضّر له جيداً قبل المجيء إلى موسكو، ولم يتضمن أجندة أو خطة أو سقفاً للتحرك، ولم توجه الدعوة إلى الكيانات والتشكيلات السياسية السورية المعارضة وصاحبة التمثيل والتأثير الحقيقي في سوريا، إضافة إلى رفض العديد من المدعوين بصفتهم الشخصية المشاركة في اللقاء.
وإذا كان التحرك الروسي يلتقي مع خطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، فإن واقع الحال يكشف أنه لا يمكن لخطة دي ميستورا أن تعالج الأزمة الكارثية التي أصابت السوريين، وهي مثل التحرك الروسي لأنها لا تنظر في مسببات الأزمة، وتتغاضى عن الحرب الشاملة ضد أغلبية الشعب التي بدأها النظام الأسدي منذ اندلاع الثورة السورية.
ويدرك المتابع للنهج الذي يتبعه النظام السوري وسلوكه وممارساته أنه لن يقبل بأي حل سياسي للأزمة إلا حين يعي تماماً أن نهايته قد اقتربت، وأن كرسي السلطة قد بدأ يترنح تحت بشار الأسد، أو في حال خضوعه لضغوط وتهديدات خارجية جدية يشعر أيضاً بأنها قد تودي بكرسي حكمه.
وهذا ما شاهدناه حين اضطر إلى سحب قوات احتلاله من لبنان الذي بقيت فيه ثلاثين سنة، وحدث الأمر أيضاً حين سلّم مخزونه من الأسلحة والمواد الكيميائية في صفقة روسية أنهت تهديد الولايات المتحدة الأميركية بتوجيه ضربة عسكرية للنظام، وبالتالي لا يمكن أن يمتثل هذا النظام لأي حل سياسي بالطرق الدبلوماسية والوساطات، ومهما كثرت الخطط والمبادرات السياسية.
الجزيرة نت
دي ميستورا وفرص الحل السياسي في سوريا/ عماد مفرح مصطفى
مع تعدد الأهداف والاعتبارات، لا تمتلك أغلب الخطط والمبادرات حول الحل السياسي في سوريا، فرص النجاح. فمن المبادرة المصرية، والتي لم تكن سوى دعاية سياسية للسلطة المصرية الجديدة، مروراً بالتحرك الروسي، في إقامة «منتدى موسكو»، أملا في كسر عزلتها الدولية وإعادة ماضيها الإمبراطوري، وصولا إلى خطة دي ميستورا، لا تبدو هذه المبادرات بمضامينها السياسية، قادرة على احتواء حجم المأساة السورية، وحاجتها القصوى إلى حل سياسي شامل وواضح، ينهي الصراع وإفرازاته وتداخلاته المعقدة.
ولعل قصور تلك المبادرات، لا يقتصر على قلة الدعم والتوافق الإقليمي والدولي حولها، وافتقارها للقراءة الدقيقة لواقع الصراع ومآلاته، بقدر ارتهانها وتغليبها للهواجس الدولية على مصالح الشعب السوري، وقد بينت التصريحات الأخيرة للموفد الأممي ستيفان دي ميستورا، حول اعتباره الأسد» جزءاً من الحل الرامي إلى تخفيف العنف» ـ في توضيح لتصريح سابق ذكر فيه، أن «الأسد هو جزء من الحل» للأزمة السورية بأكملهاـ عن مدى انصياع تلك الخطط للرغبات الدولية المتناقضة، على حساب ما يستوجب التأكيد عليه كاستحقاقات داخلية، طالب بها السوريون منذ خروجهم في تظاهراتهم الأولى.
صحيح أن عوائق الحل السياسي في سوريا كثيرة ومتداخلة، وهذه العوائق لا تبدأ فقط، بتباين القراءات السياسية للقوى الإقليمية والدولية حول الحدث السوري؛ بين مفاهيم «المؤامرة» و»الثورة»، وحق «السيادة» وضرورة «التدخل الإنساني»، وصولا إلى شرعنة «عنف الدولة» ومواجهة «الإرهاب»، والحد من خطورته على الغرب. إلا أن كل ذلك التداخل، لا يبرر الاستهتار الدولي بحق السوريين في تحقيق مطالبهم المشروعة في بناء دولة ديموقراطية تسودها العدالة والكرامة، مثلما لا يبرر ذلك، عدم إدراج مطالبهم في مقدمة الأولويات ضمن الخطط المقترحة.
وفي هذا السياق الذي يحدوه الغبن والاستهتار، يفهم التصريح الأخير للموفد الأممي، كاشفا، عن المنطق الذي ينتهجه في صياغة خطته، الشبيهة بالشكل، وربما بالمضمون، باتفاقيات «المصالحات» المناطقية، التي جرت بين النظام وكتائب من المعارضة المسلحة في بعض الأحياء، تلك «المصالحات» التي أُخرجت بطريقة لا تحمل أي رمزية للانتصار السياسي للمعارضة، بعد أن تم تفريغ بنودها من المضامين السياسية، وصياغتها بمفردات تناسب خطاب السلطة وتأويلاتها.
لكن، وبالرغم من ذلك المنطق المتحفظ، الذي يلف كامل خطة دي ميستورا، وأهمية خطته في وقف آلة القتل، إلا أن بعض النقاط التي تركز عليها الخطة، تحمل مضامين غير مريحة، من تكريس سلطة أمر الواقع لكل الجماعات والميليشيات المسلحة ـ ومنها القادمة من وراء الحدودـ وتقسيم الصراع وفق أسس هوياتية ومناطقية متباينة، وهو ما قد يترتب عليه، الابتعاد عن حل سياسي شامل، وإجراء العديد من مشاريع الحل في المستقبل، تتناول كل واحدة منها مقتضيات وظروف كل منطقة. يضاف إلى ذلك، أن مفهوم «تجميد الصراع»، في بعض جوانبه، يتوافق ونظرة النظام لمجريات الأمور، تلك النظرة القائمة على أن الأزمة ناتجة عن تمرد مسلح في وجه «الدولة»، التي تمتلك كامل الخيارات للرد على «المتمردين»، وأن الأمور تنتهي بالعفو عنهم وتأهيلهم بعد «تمييع» مطالبهم السياسية إلى مطالب خدماتية.
هذا التوجه، بطبيعة الحال، لا يسهم في فض الإشكال القائم منذ انطلاقة الحراك الشعبي في سوريا، وما تبعه من تحولات لاحقة، وأساسه رفض قطاعات واسعة من المجتمع السوري، طبيعة النظام السياسي الحاكم، وآليات احتكاره لسلطة الدولة والمجتمع.
الحقيقة أن العائق الأكبر أمام أي حل سياسي اليوم، يرتبط بمستوى الارتياب والتوجس، بين السوريين والمجتمع الدولي، وهذا الارتياب لا يتوقف عند حدود خذلان السوريين، وتجاهل معاناتهم، بعد سنوات من القتل والتشريد والتدمير، بل يتجاوزه إلى محاولة المجتمع الدولي «تعويم« النظام، الذي لا يتوافق بجوهره وطبيعته مع مجريات أي حل سياسي شامل.
وفي هذا السياق، فإن المنطق السياسي والأخلاقي، يفرض على صانعي القرارات الدولية اعتبارات وشروطاً عدة، لا يمكن تجاوزها، في حال صياغة أي مشروع للحل، أولها أن يكون شاملا، ويلامس كل الجوانب وتفرعات الحالة السورية، وفي مقدمتها اعادة هيكلة منظومة الجيش والأجهزة الأمنية، مثلما أصبح من الضروري، إعادة هيكلة الحياة السياسية في سوريا، وفق عملية متكاملة توفرها قرارات دولية تصدر عن مجلس الأمن الدولي، تجعل من المنظمات الأممية والدولية، الشريك الفعلي في العملية السياسية، ذلك أن الهوة التي تفصل الأطراف السورية باتت من العمق والتباين بحيث تعجز الاتفاقيات المناطقية والمحلية، التي جرت تحت ضغط الحصار والنار والتجويع، من أن تستوعب حجم التداعيات والتغيرات الهائلة في ذهنية وطبيعة النسيج والكيانات الاجتماعية السورية.
كذلك فأن أي حل سياسي، لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل والظروف الداخلية، ومدى وصول تلك العوامل بمقارباتها إلى عتبة النضج السياسي، في قبول واستيعاب مبادرات سياسية للحل، مثلما يستوجب الحل، التقليل من دعم عنف الأيديولوجيات المتناقضة والمتحاربة على مشاريع أكبر من طاقتها وحجمها السياسي، وإفساح المجال أمام القوى المعتدلة للتعبير عن نفسها. فقد أصبح الضعف والعجز، الصفة المميزة للقوى السياسية السورية جميعها، وعلى رأسها النظام، حيث افتقاد القدرة على فرض، أو استيعاب، أو طرح، أي حل سياسي شامل، مع تحول أغلب القوى المسلحة إلى ما يشبه جماعات عنفية، تحوز على قدر كبير من السلطة والنفوذ في مناطق سيطرتها، لصالح أمراء الحرب الذين يعملون وبشكل فعلي وفاعل، على عدم تمكين الحل السياسي بأي شكل من الأشكال.
المستقبل
الأسد هو المشكلة وليس الحل/ طارق الحميد
يحاول مندوب الأسد في نيويورك بشار الجعفري القول الآن بأن الوقت قد حان كي تقبل أميركا والقوى الغربية الأخرى بأن بشار الأسد باق في السلطة، وأن تتخلى عما وصفها بأنها استراتيجية فاشلة تقوم على محاولة تقسيم منطقة الشرق الأوسط إلى جيوب طائفية.
ويقول الجعفري لوكالة «رويترز» عشية الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الثورة السورية إن الأسد مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وغيرها لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه يمكن للأسد أن يحقق الأهداف، لأنه قوي يحكم مؤسسة قوية هي الجيش، ويقاوم الضغوط منذ أربع سنوات. مضيفا أن الأسد «يمكنه تنفيذ أي حل»! هل هذا كلام دقيق؟ بكل تأكيد لا! هذه محاولة دعائية أسدية مفضوحة، وتتزايد الآن، والهدف منها هو القول إن الأسد أفضل من «داعش»، ولا بد من التعاون معه ضد الإرهاب، لكن الحقائق تقول إن «داعش» ما كانت لتتمدد، ومثلها «القاعدة» لولا جرائم الأسد، ولعبه بورقة الإرهاب والتطرف، خصوصا أن الأسد هو من أطلق سراح قيادات «داعش»، و«القاعدة» من سجونه، وهو الأمر نفسه الذي فعله نظام المالكي في العراق سابقا.
وهذا ليس كل شيء، حيث كشف مؤخرا عن مراكز تدريب إيرانية في سوريا لتدريب ميليشيات الحوثيين، وبإشراف إيراني تام، وليس لنظام الأسد أي سيطرة على ذلك، ورغم أن التدريب يتم في سوريا التي باتت مقسمة إلى أجزاء يتقاسمها حزب الله والميليشيات الشيعية الإيرانية من ناحية، تحت قيادة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بينما الأجزاء الأخرى في سوريا هي تحت سيطرة «داعش» و«القاعدة»، وجزء آخر تحت سيطرة الجيش السوري الحر. فأي قوة تلك التي بيد الأسد؟ وكيف يوصف بأنه الرجل القوي، بل هو الرجل الكارثة، وليس على سوريا وحسب، بل وعلى كل المنطقة، وحتى على المجتمع الدولي، خصوصا بعد الإعلان أول من أمس عن أن عشرة آلاف مقاتل أوروبي متطرف يتجهون إلى سوريا والعراق.
كل ذلك يقول لنا إن الأسد أساس المشكلة، وهو من حوّل سوريا إلى بؤرة تدريب، وتهريب، للإرهاب الإيراني، وغيره، فكيف يقال بعد كل ذلك إن الأسد هو الحل؟! الأكيد أن الأسد هو المشكلة، وهو الأزمة بحد ذاتها، وخطر الأسد لا يقل عن خطر «داعش»، و«القاعدة»، وحزب الله وإيران، والحقيقة التي سيدركها الجميع أن سقوط الأسد هو الحل، آجلا أو عاجلا، وهذا ما لا تحاول إدارة أوباما فهمه لأنها مشغولة لدرجة الهوس بالتفاوض مع إيران، ويبدو أن واشنطن وضعت ملف الأسد قيد الانتظار حتى الوصول إلى نقطة حسم بالتفاوض مع إيران، وهذا بالطبع يعد عامل هروب للأمام، لأن وقتها سيكون أوباما قد دخل مرحلة البطة العرجاء باقتراب نهاية فترته الرئاسية، وهذا يعني أن الكارثة ستكون أكبر على سوريا، والمنطقة، والمجتمع الدولي، لأن الأسد هو المشكلة، ولا يمكن أن يكون الحل.
إعلامي و كاتب سعودي ورئيس تحرير سابق لصحيفة “الشّرق الأوسط”
الشرق الأوسط
عن المصالحات الوطنية في سورية/ هيفاء بيطار
شاركت في ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، في بيروت يومي 7و8 مارس/آذار الجاري، عنوانها (فرص التوافق في سورية من المصالحات الوطنية إلى مبادرة دي ميستورا)، وشارك فيها حوالي أربعين شخصية سورية قيادية وفكرية فاعلة ومنفتحة على الحوار، وللأسف كان الحضور النسائي قليلاً. وأبدع، مثلاً سمير العيطة في تشخيص الحالة السورية وتحليل الاحتمالات الممكنة للمصالحة الوطنية. وأبهر بشير السعدي، رئيس المنظمة الآشورية في القامشلي، الحضور بعلمه وثقافته ورؤيته لإمكانية المصالحة الوطنية. وأدار المدير العام لمركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، ببراعة ورشة العمل التي شهدت مداخلات عميقة، وشخصت أمراض المعارضة والنظام. وكان الجو العام بين المشاركين ودياً بامتياز، مع تباين وجهات النظر واختلافها. وكان المشاركون، على الرغم من الاختلافات الكبيرة في آرائهم، يشعرون أنهم في مركب واحد، هو وطن اسمه سورية، المهددة بالغرق في دماء أبنائها. والكل كان يشعر أن الزمن السوري من دم، وأن الوضع السوري خطير جداً، وبأن مأساة الشعب السوري تفوق الوصف وتتطلب وضع كل الخلافات جانباً، لإيجاد توافق على حل
سريع لوقف القتل، ولتوحيد المعارضات المتشرذمة. وكان الكل يشعر بالخطر على المسيحيين والأكراد والآشوريين والعلويين والسُنة. لا توجد طائفة في سورية إلا وتضررت ضرراً فظيعاً، لا يوجد بيت إلا وقُتل أحد أبنائه، سواء كان من الجيش النظامي أم من الجيش الحر، أو من ضحايا الصراع الدامي بين الفصائل المتطرفة والنظام. والكل كان يشعر بالألم الذي يحاول إخفاءه، لأن هذه الندوات والمؤتمرات الخاصة بالأزمة السورية لا تُقام على الأرض السورية، بل في موسكو أو جنيف أو القاهرة أو بيروت إلخ.
وقد شعر كل سوري مشارك في ورشة العمل، وعنوانها العريض “المصالحات الوطنية”، بألم كثير، حين علمنا أن مؤتمراً سيُعقد في القاهرة، في إبريل/نيسان المقبل، وبرعاية من الحكومة المصرية، بين شخصيات من النظام وأخرى من المعارضة. إلى متى سنترك الدول الصديقة وغير الصديقة تتدخل في بيتنا الذي يحترق بنار الحقد، إلى متى سنترك السؤال الأبدي عمن بدأ بالحريق، بدل أن يسعى الجميع إلى إطفاء الحريق أولاً، ثم المساءلة والمحاسبة؟ أي إحساس بالخزي والخجل، حين ينتهي المؤتمر بطرح سؤال من نوع: هل ستسمح القاهرة بأن يشارك ممثلون عن الإخوان المسلمين في المؤتمر الذي ستستضيفه بهدف المصالحة الوطنية؟ ألا يعني هذا أننا، كسوريين، نحتاج أوصياء وراعين، كما لو أننا قاصرون عن اتخاذ قرارات مستقلة، بدون رعاية إقليمية عربية أو غير عربية؟
والأهم، أي معنى للمصالحة الوطنية، ومثقف سوري وطني معروف بموقفه الأخلاقي، هو سمير العيطة مُقدم لمحكمة الإرهاب في سورية؟ كيف سيجلس وفد من النظام مع العيطة، المعارض الوطني، وثمة يافطة يلصقها على صدره النظام السوري بأنه يجب أن يُحاكم بتهمة الإرهاب؟ ولماذا لا يتمكن عالم وباحث آشوري، له شهرة عالمية يقيم في القامشلي، مثل بشير السعدي من الحضور إلى اللاذقية، لأن كدسة تقارير أمنية مكتوبه ضده؟ أليس من البديهي أن جوهر الإصلاح يبدأ من فك قبضة الأمن والاعتقال عن الناشطين السلميين الذين يهبون حياتهم ووقتهم وعلمهم للشعب السوري المخذول في محنته؟ أليس جوهر الإصلاح والمصالحة الوطنية أن يتمكن بشير السعدي من إلقاء محاضرات عن الحضارة الآشورية العظيمة في المركز الثقافي الفخم في اللاذقية، والذي يستضيف، إلى الآن، محاضرات من نوع كيف نقول لا لأميركا، حضورها من نسيج واحد، هم المطبلون والمصفقون، وهم أنفسهم لا يصدقون أنفسهم، بل الكل يكذب على الكل، وتستمر حياة الذل.
“أي حديث عن مصالحة وطنية وشعارات طنانة تريح الأعصاب راحة خُلبية يجب أن يبدأ من استئصال جذور الخوف من قلب المواطن السوري”
قبل الحديث عن إمكانية المصالحة الوطنية، يجب إعادة ثقة الشعب السوري، أولاً، بالأجهزة الأمنية، أي ألا ترتعد فرائص الناس ذعراً لدى ذكر كلمة أمن، ففيما هي من الأمان، لها مفعول عكسي في سورية، هو الاعتقال. ويكفي أن أذكر حادثة مؤلمة وتثير الضحك في الوقت نفسه، فحين نُشرت مقالتي في صحيفة الحياة (صبحية في فرع أمن الدولة)، نصحني أصدقاء كثيرون بألا أسافر إلى بيروت لحضور ورشة العمل، وقالوا لي إنني “عليت السقف هذه المرة”، فشعرت أننا نعيش حياتنا ورأسنا ملتصق بسقف من الرصاص وليس الباطون. وقد زارتني صديقة من حلب، وشربنا القهوة، وأحسست بالشكر لوجودها إلى جانبي، تحاول طمأنتي أنني سأسافر وأرجع بالسلامة، وبأن مقالي ليس خطيراً، ووجدتني أكتب بعفوية على صفحتي على “فيسبوك” (القهوة مع صديقتي إياها لها طعم الحنان)، فما كان منها إلا أن أصاب ملامح وجهها الذعر، وطلبت مني الإسراع بمحو العبارة، وقالت لي بعفوية: هل أنت مجنونة حتى تكتبي هكذا تعليق في اليوم الذي نشرت فيه مقالتك عن الأمن! أذهلني الرعب في قلبها، أذهلني إحساسها أنها التي لم ترتكب أي ذنب، ولم تتخذ أي موقف معارض للنظام، بل هي موالية تماماً، تشعر أنها مُتهمة ومذنبة، وبأن أجهزة الأمن
أو المخابرات يمكن أن تستدعيها بتهمة شرب فنجان قهوة مع كاتبة نشرت مقالاً عن في فرع أمن الدولة. تمثل تلك الصديقة الحبيبة شريحة كبيرة من الشعب السوري المُروع من المخابرات، والذي يشعر أنه حتى لو عاش أصم وأعمى وأبكم، لا قدر الله، فإن تهمة ما قد تسقط على رأسه، كما تسقط نقطة ماء من مكيف على رأس مواطن يسير في الشارع.
علاج الخلل يجب أن يبدأ من الأسفل إلى الأعلى، وعلى الرغم من أنني لا أعتبر نفسي كاتبة سياسية، بل مواطنة سورية، أعبر عن ضمير شعب عظيم، صبر كثيرا وتحمل ما لا تحتمله الجبال، فإن أي حديث عن مصالحة وطنية وشعارات طنانة تريح الأعصاب راحة خُلبية يجب أن يبدأ من استئصال جذور الخوف من قلب المواطن السوري، وإعادة الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية، وألا يضطر كل شخص سوف يغادر سورية إلى أن يسأل في قسم الهجرة والجوازات عن اسمه، ما إذا كان ممنوعاً من السفر، لتهمة ما (كما لو أنه مطلوب كل يوم أن يقدم براءة ذمة أنه مواطن صالح).
لا معنى لكل تلك المؤتمرات الكثيرة، وفي أفخم الفنادق، إن لم تبدأ، أولاً، بالعناية بروح المواطن السوري المعذبة والمشوهة بالخوف والذل. وأخيراً، كلي أمل، مثل ملايين السوريين إخوتي في المعاناة، أن تُعقد المؤتمرات التي تخص الشعب السوري في دمشق أو حلب أو اللاذقية أو حتى في كسب. هل ما نتمناه معجزة؟
العربي الجديد
هل علينا التصالح مع الأسد؟/ عبد الرحمن الراشد
مع ارتفاع وتيرة قتال الإيرانيين وحلفائهم إلى جانب قوات نظام الأسد، وتولي الإيرانيين أيضا قيادة حروب القوات العراقية في تكريت وصلاح الدين، يدعو البعض إلى إعادة النظر في السياسة الحالية، والقبول بالتصالح مع نظام بشار الأسد.
وفي رأيي العكس صحيح، تماما. ربما كان التصالح مقبولا في بدايات الأزمة السورية، لكنه اليوم أسوأ قرار يمكن لأي حكومة عربية، خاصة خليجية أن تفكر فيه.
المشكلة ليست مع شخص الأسد بل مع ترِكتِه، وتوأمته مع نظام طهران، والبحر الهائل من الدماء التي أسالها. وقد كان الوعد حينها صادقا بمنحه فرصة الخروج، وحمايته من طالبي الثأر، وفتح صفحة جديدة مع بعض قيادات النظام وتشكيل حكومة انتقالية تجمع كل السوريين بطوائفهم وأعراقهم.
ولا يمكن النظر إلى الحرب في سوريا على أنها مشكلة سورية داخلية، ودون فهم المعادلة الإقليمية، وتحديدا الصراع مع إيران. وفي حال سايرت السعودية نصائح المصريين، أو دعوات المحللين، وقبلت بحل أو مصالحة يبقى فيها الأسد، فإنها تكون قد سلمت كامل الهلال، العراق وسوريا ولبنان إلى إيران! فهل يمكن لأي دارس علوم سياسية أن تفوته النتيجة الحتمية، وهي الهيمنة الإيرانية على شمال الخليج والسعودية؟!
حجة الانزعاج من تركيا و«الإخوان» و«داعش» صحيحة، لكنها ليست سببا لتسليم الإيرانيين سوريا والعراق. نحن في زمن فيه حروب متعددة، والخطر فيها درجات، الإيراني أعظمها، خاصة مع اقتراب عقد اتفاق النووي مع الغرب. وستترجم النتيجة إيران إلى شحنة هجوم غير مباشرة على خصومها على ضفة الخليج الغربية. ومهما وعدنا الأميركيون أنهم لن يسمحوا للإيرانيين بإيذاء جيرانهم فلا يمكن لنا تصديقهم، خاصة أننا نعرف أن قدرات الولايات المتحدة في منطقتنا تقلصت، وسياستها الجديدة صارت التوجه شرقا نحو الصين. لهذا فإن دعم المعارضة السورية المعتدلة سياسيا وعسكريا ضرورة قصوى لعرب الخليج، لحرمان الإيرانيين من سوريا، ناهيك عن كونها قضية إنسانية هي الأدمى في تاريخ المنطقة. لا يمكن للسعودية أن تتخلى عن عشرين مليون سوري مهما كانت الأسباب، ولا يمكن لها أن تغض النظر عن خطر التوسع الإيراني في بلاد الرافدين، ولا يفترض أن نقبل بنظرية مصالحة الأسد حيث لا مكان لها في حسابات الخليج العليا. هل يمكن للسعودية مصالحة الأسد الذي قتل ربع مليون إنسان من أجل محاربة عصابات داعش؟ مستحيل تماما. وكيف لنا إقناع العشرة ملايين مشرد الذين دكت طائرات الأسد بيوتهم وأحياءهم بالتخلي عنهم؟
أما بالنسبة لتركيا، فالمشكلة تتمثل في شخص رئيسها، الذي يسبب هذا الكم الكبير من الشقاق والإزعاج، لكنه وحكومته لم يفعلوا شيئا حتى لحماية مصالح بلادهم الهامة في سوريا، عدا حماية ثم جلب رفات سليمان شاه الذي شبع موتا من مئات السنين.
وعندما تأتي الساعة التي تصبح فيها القضية محل النقاش هي مصير الأسد في أي حرب أو حل سلمي مستقبلي، فإنه لا أحد سيهتم بمسألة الانتقام. فالتركيز اليوم هو على حلين متوازيين، دعم المعارضة المسلحة المعتدلة، الجيش السوري الحر، والثاني دعم أي حل سلمي يقوم على مصالحة كل السوريين، والمحافظة على النظام السوري دون قياداته العليا. ومن دون دعم الجيش الحر، فإن الحل السياسي لا يمكن فرضه بشكل عادل.
الشرق الأوسط
واشنطن : مسؤولو ملف سوريا يتركون مناصبهم تباعا/ حسين عبد الحسين
في أقل من أسبوع، شغر أرفع منصبين مسؤولين عن ملف سوريا في إدارة الرئيس باراك أوباما. في “مجلس الأمن القومي”، أعلنت رئيسته سوزان رايس انتقال مسؤول “إيران، والعراق، وسوريا، ودول الخليج” روبرت مالي ليصبح مسؤولا عن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي وزارة الخارجية، سرت انباء عن ترشيح مسؤول سوريا، دانيال روبنستين، لمنصب سفير أميركا في تونس، حسب موقع انباء بولمبيرغ. أما الجنرال جون آلن، المبعوث الرئاسي للتحالف الدولي للحرب ضد “تنظيم الدولة الإسلامية”، فأعلن مراراً ان اهتمامه ينصب على الشق العراقي من دون السوري.
هكذا، أصبحت المسألة السورية، كما في العالم كذلك في العاصمة الأميركية، يتيمة، ومن دون مسؤولين ذوي نفوذ في الإدارة يتابعونها، او يهتمون بتطوراتها، او يلفتون نظر الرئيس باراك أوباما وكبار مساعديه اليها. وهكذا، اكتملت عملية تلزيم ملف الازمة السورية الى روسيا وإيران، ومن دون أي خجل او وجل أميركي.
سبب نقص الاهتمام الأميركي ينبع من أوباما نفسه، الذي تسببت لا مبالاته بالمعاناة السورية برحيل الرعيل الأول من الديبلوماسيين الأكثر حنكة وتأثيراً في الرأي الأميركي داخل واشنطن، ففرد هوف، الذي عينه المبعوث الرئاسي لمفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، جورج ميتشل، مسؤولاً للمسار السوري، وجد نفسه فجأة من دون مسار وأمام ثورة شعبية اندلعت في وجه الرئيس السوري بشار الأسد وحكمه، فتحول هوف الى ديبلوماسي مسؤول عن ضبط الإيقاع الأوروبي تجاه سوريا، ونجح بدعم من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في استصدار عقوبات على الأسد وقطاعه النفطي.
إلى جانب هوف، عمل مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جيفري فيلتمان، على ضبط إيقاع الدول العربية وتوحيد صفوفها، فنجحت الأخيرة في طرد الأسد من “جامعة الدول العربية”، وأطلقت مبادرات بالاشتراك مع الأمم المتحدة للتوصل الى وقف إطلاق نار كمقدمة لانتقال سياسي يؤدي الى خروج الأسد من الحكم.
ومع هوف وفيلتمان عمل السفير الأميركي السابق في سوريا روبرت فورد، الذي قام بنشاط قارب المجازفة بأمنه عندما زار حماة المنتفضة، فرماه الحمويون بالورود. كما زار مجلس عزاء غياث مطر في دمشق في تحد للأسد ونظامه، قبل ان تجبره وكالات الاستخبارات الأميركية على الخروج من سوريا خوفاً على أمنه.
وهوف كان من المخضرمين في المسألة اللبنانية والسورية، بينما سبق لفيلتمان أن عمل سفيراً أميركياً في لبنان، فضلاً عن عمله في عواصم عربية متعددة قبل ذلك. أما فورد، فهو من المستعربين في وزارة الخارجية ممن لعبوا دوراً محورياً في مواكبة عملية “زيادة القوات” في العراق وبناء “قوات الصحوة” من عشائر غرب العراق، حيث نجح التحالف بين الاثنين في القضاء على “تنظيم القاعدة في العراق”، وأنهى الحرب الأهلية هناك.
وحمل الديبلوماسيون المخضرمون الثلاثة هوف وفيلتمان وفورد لقب سفير، وتمتعوا برصيد داخلي وخارجي، ونجحوا في إجبار الأسد على “الوقوف على قدمه الخلفية”، حسب التعبير السائد هنا. لكن جهود هؤلاء الثلاثة، مقترنة بتوصيات كلينتون ومن بعدها خلفها جون كيري – ونجم حرب العراق ومدير “وكالة الاستخبارات المركزية” (سي آي ايه) آنذاك دايفيد بترايوس – لتسليح ثوار سوريا، اصطدمت بعناد أوباما، الذي أصر على تبني المقاربات الروسية والإيرانية لحل سياسي مزعوم.
في وجه الجدار الأوبامي، أصاب الإحباط كل العاملين على الأزمة السورية، فخرجوا الى التقاعد على التوالي. وبعد خروجهم، تحول هوف وفورد الى أكبر مؤيدَين لثوار سوريا ولتسليحهم، مهاجمين إدارة أوباما وسياسات سبق ان اجبروا ان يدافعوا عنها بحكم وظيفتهم. وحده فيلتمان، الذي أصبح مستشار أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية، بقي أميناً على تنفيذ سياسة أوباما، فزار طهران والتقى مرشد الثورة علي خامنئي، ولعب دوراً محورياً في تدبير دعوة أممية الى إيران لحضورها مؤتمر جنيف الثاني، وهو حضور لم يحصل بسبب رفض المعارضة السورية للأمر.
على أن من يعرفون فيلتمان يعرفون ان قلبه وعقله مع الثوار، وان الدور الذي يقوم به هو امانة لمنصبه. ربما بعد تقاعده، يتحول فيلتمان، مثل هوف وفورد من قبله، الى مؤيد لثوار سوريا وتسليحهم، ولكن بعد فقدانه أي دور مؤثر في صناعة السياستين الأممية والأميركية.
وبعد خروج ثلاثي هوف – فيلتمان – فورد، حل مكانهم جيل من الديبلوماسيين الاميركيين الأحدث عهداً والأقل وزناً، فجاء مكان فورد، الديبلوماسي المستعرب دانيال روبنستين مسؤولاً عن سوريا. لكن روبنستين لا يحمل صفة سفير، والخارجية ككل دورها مهمش منذ خروج كلينتون لمصلحة مجلس الأمن القومي، حيث حل صديق الأسد روبرت مالي مسؤولاً عن الملف السوري.
وفيما كان كيري يسلم ملف سوريا الى نظيره الروسي سيرغي لافروف، كان مالي يشارك في المفاوضات النووية مع إيران ليسلم ما تبقى من ملف سوريا الى إيران. ويبدو أن منصب سفير في تونس لاح في الأفق، فرأى روبنستين فرصة في اغتنامه بدلاً من بقائه من دون دور في الشأن السوري. أما مالي، الذي من المفترض ان يكون أنهى دور تسليمه سوريا الى إيران مع حلول نهاية الشهر الحالي، موعد توقيع اتفاقية مضمرة او معلنة مع طهران، فيصبح مسؤولاً عن ملف مفاوضات السلام بدءاً من السادس من الشهر المقبل.
هكذا، يصبح الملف السوري في الحكومة الأميركية من دون مسؤولين عنه، بعدما تم تخفيض درجة المسؤولين في مرحلة سابقة. وهكذا، لا عجب أن لا سياسة أميركية – أو عربية أو عالمية – تجاه الأزمة السورية، ما يجعل مصير الثوار في مهب الرياح، ويجعله في أيديهم وحدهم امام قوة إيران وروسيا وحلفائهما السوريين واللبنانيين المقاتلين على الأرض السورية.
المدن
سورية ترجع إلى الخلف/ سامح راشد
حراك سياسي متصاعد تشهده الأزمة السورية منذ أسابيع، وعلى الرغم من أن جديداً لم يطرأ لجهة التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية ومتوازنة، إلا أن سمة جديدة ميزت هذا الحراك، خلاف المحاولات السابقة لنحت مسار سياسي للتسوية، أو إدارة الأزمة. وهي التوازي بين محاولات التنسيق بين القوى المعارضة للنظام السوري ومحاولات التوصل إلى أرضية مشتركة، يمكن للنظام مع المعارضة الاستناد إليها في أي تسوية محتملة. المسكوت عنه في ذلك التطور أن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، رفع يده عن الأزمة السورية، وصار موقفه منها أقرب إلى وضع “المراقب” منه إلى الانخراط المباشر طرفاً أصيلاً. صحيح أن موقف واشنطن وحليفاتها الغربيات كان دائماً أقل من المتوقع، بل ومن المعلن، إلا أن الأمر انتقل من مرحلة التغاضي المقنع إلى الصمت الصريح. وكلاهما إخلال بوعد نصرة الشعب السوري، ونكوص عن وعيد بإسقاط نظام بشار الأسد. أمام هذا الخذلان الغربي، كان لا بد أن تتقدم موسكو لتستلم زمام المبادرة، وأعطى هذا ضوءاً أخضر للقاهرة، لتدخل على خط الأزمة وتنتزع دور الراعي الإقليمي للحل السياسي من تركيا. في محاكاةٍ لتولي موسكو دور الراعي العالمي، بدلاً من واشنطن.
وكما كان التحرك الأميركي/ التركي يعتمد منطلقات واحدة متوازية، هناك مشتركات تجمع التحركين الروسي والمصري، أهمها، على الإطلاق، استبعاد جدوى الحل العسكري، ما يعني عدم التعويل على الحسابات العسكرية، أو المعطيات الميدانية على الأرض، إلا في حدود ما تمليه من شروط أو قيود على التفاوض، وبالتالي، انعكاسات ذلك على الحل أو التسوية المحتملة.
الملمح الثاني المشترك في التحرك المصري الروسي أن الأسد باق حتى إشعار آخر، إن لم يكن بشخصه فبنظامه. وهذا ليس موقفاً مصرياً روسياً فقط، بل هو أيضاً جوهر الموقف الأميركي الغربي، والدافع وراء الانسحاب من صدارة المشهد، تجنباً للإحراج. والواقع أن القبول الغربي لتأجيل خروج الأسد تجسد بوضوح في تفاهمات “جنيف-1″، بغموض نصها والتباس تفسيرها.
ومن المفارقات أن أخطاء الغرب تتكرر بحذافيرها، فالانتقائية والفرقة في المعارضة لا تزال قائمة. وبدلاً من إطلاق “معارضة اسطنبول” على المجلس الوطني، ثم ائتلاف قوى الثورة والمعارضة، ثمة نموذج آخر قيد التشكل، سيكون جديرا بحمل اسم “معارضة القاهرة”.
وبدلاً من أن تتقارب فصائل المعارضة، وتصطف معاً في مواجهة النظام ومعسكره، إذا بها تقترب من موقف النظام ومعسكره، بالتخلي عن شرط رحيل بشار، قبل خوض أي مفاوضات حول تسوية سياسية. وبعد أن يلتقي معارضون مختارون بالاسم في القاهرة، تلتئم معارضتا الداخل والخارج في باريس. وبينهما تعقد روسيا (موسكو-1) لتبادل الرسائل بين المعارضة والنظام. إنه تقريباً التسلسل نفسه الذي بدأ قبل أربعة أعوام، اجتماعات في اسطنبول ومباحثات في لندن ومفاوضات في باريس وحوار في جنيف، والمحصلة لا شيء، بل الآن الوضع أسوأ، فوقتئذ، كانت المحصلة ضئيلة والمواقف عالية. الآن، تؤول المواقف والنتائج إلى الصفر. إن كان من مغزى في كل تلك التطورات فهو أن مطالب السوريين لا تشكل أهمية كبيرة، وأرواحهم لا تساوي كثيراً لدى أي طرف، سواء المعارضة ومن يقفون وراءها، أو نظام بشار وداعميه. وليس أدل على ذلك من العجز عن تأمين أدنى حقوق الإنسان في سورية، مجرد فتح ممرات وإدخال مساعدات للمنكوبين والنازحين والمشردين. أما النتائج المكرورة المتشابهة لكل التحركات والمشاورات السياسية، فدلالتها الخفية أن لا فرق حقيقياً يميز محور موسكو/ القاهرة عن نقيضه السابق (واشنطن/ اسطنبول)، إن لم يكن في الدوافع والأهداف، ففي الأداء والنتائج.
العربي الجديد
الاسد بمساعدة حلفائه…يبدو انه باق/ توم بيري وليلى بسام
بيروت 10 (رويترز) – يبدو ان فرص نجاة الرئيس بشار الاسد من الازمة السياسية سالما باتت أكبر من أي وقت مضى منذ بدئها قبل أربع سنوات.
فقد تلاشت الأيام عندما كان ظهوره الاعلامي يعد حدثا إخباريا حيث توجد يوميا الان اخبار عن لقاءاته. ومن ضمن الوفود التي زارته مؤخرا أربعة نواب فرنسيين خالفوا سياسة حكومتهم.
ومما لا شك فيه أن الحرب أضعفته لكنه لا يزال أقوى من المجموعات التي تقاتل من أجل الاطاحة به. ولا تزال هناك دول قوية ترغب برحيله لكنهم لم يظهروا العزيمة التي يظهرها حلفاؤه الذين يستمرون بالوقوف إلى جانبه.
ومع إقتراب الذكرى السنوية الرابعة للازمة فان دعوات خصومه الغربيين التي كانت تدعو بإستمرار إلى رحيله باتت قليلة. وبدلا من ذلك تحول إنتباههم إلى محاربة تنظيم الدولة الاسلامية الذي يعتبر عدوا مشتركا.
وفي حين أن الولايات المتحدة واعداءها العرب يقصفون المسلحين المتشددين في الشمال والشرق شن الاسد وحلفاؤه هجوما كبيرا في منطقة أكثر أهمية لهم وهي منطقة الحدود الجنوبية بالقرب من إسرائيل والاردن.
وفي الوقت نفسه خاض الاسد بثقة عالية حملة من نوع آخر حيث أجرى خمس مقابلات منذ ديسمبر كانون الاول. وكانت ثلاث منها مع وسائل إعلامية مقراتها في الدول الغربية الأكثر معارضة لحكمه وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
ولا تبدو أن محاولته تلك ستضع حدا لعزله في دول الغرب وأعدائه العرب. وتقول تقارير الامم المتحدة أن الجيش استخدم العنف بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة.
وكثيرا يصفه المسؤولون الامريكيون بأنه القائد الذي يستخدم الغاز ضد شعبه وهي تهمة تنفيها الحكومة السورية.
ويستبعد المسؤولون الغربيون فكرة إعادة طرح الاسد كشريك في القتال ضد الدولة الاسلامية.وهم يأملون ان تصل ايران وروسيا ابرز حلفاء الاسد الى الخلاصة نفسها في وقت أدى فيه الانخفاض الحاد في سعر النفط إلى زيادة عبء الاقتصاد السوري المدمر.
لكن لا يبدو هناك أي علامة على تحول موقف طهران أو موسكو تجاه قائد اصبح جزءا من الصراع بين المملكة العربية السعودية السنية من جهة والجمهورية الاسلامية الايرانية الشيعية من جهة اخرى والولايات المتحدة وروسيا من طرف آخر.
ويبدو ان التزام إيران تجاه الاسد يتعمق مع إقتراب ذروة المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.
وقال مسؤول رفيع في الشرق الاوسط على اطلاع بالسياسة السورية والايرانية”الايرانيون ما زالوا يعتبرون الاسد الرجل الاول.”
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لان تقييمه استند الى محادثات خاصة “ان الاسد نقطة الارتكاز في علاقتهم مع سوريا”
الحرب طويلة
ويشكل الدور البارز الذي لعبه حزب الله اللبناني المدعوم من ايران في المعركة بالجنوب أحدث مثال على عزم حلفاء الاسد الوقوف الى جانبه. كما ان المستشارين الايرانيين على أرض المعركة وهذا ما يتماشى مع الوضع في العراق حيث يساعد الايرانيون في الاشراف على العمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال المسؤول “النظام سيبقى منشغلا وستبقى الخروقات هنا وهناك.المعركة في سوريا ما زالت طويلة جدا لكن من دون تهديدات وجودية على النظام”
ويقدر الآن عدد القتلى بحوالي 200 ألف شخص إضافة الى تشريد ما يقرب من نصف السكان وفقا لأرقام الأمم المتحدة ووصفها رئيس وكالة الامم المتحدة للاجئين بأنها أسوأ أزمة إنسانية في هذا العصر.
وقد تقلصت سيطرة الدولة لكن لا تزال تدير المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان. وينقسم الباقي بين المسلحين السنة المتشددين ومقاتلين آخرين والأكراد الذين ظهروا كشريك مهم في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الدولة الاسلامية.
ومني الجيش السوري والقوات المتحالفة معه بخسائر كبيرة في العام الماضي. وحتى مع القوات الجوية فان الجيش لم يستطع توجيه ضربة قاضية للمسلحين في بعض المعارك المهمة مثل حلب.
وقد صد المسلحون هجوم الجيش الاخير الذي كان يهدف الى تطويق اجزاء يسيطر عليها المقاتلون في حلب. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان فان 150 جنديا على الاقل قتلوا من الجيش والقوات المتحالفة معه في هذه العملية.
ولكن لا حلب ولا أجزاء من البلاد التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق تهم الاسد بقدر أهميته بالممر الارضي الذي يمتد من دمشق الى الشمال عبر مدينتي حمص وحماة ومن ثم غربا الى الساحل.
والمعركة لسحق المسلحين التي تمتد من دمشق الى الجنوب الى الحدود مع الاردن واسرائيل من شأنها القضاء على واحدة من آخر التهديدات الكبيرة لحكم الاسد في حال فوز الجيش وحلفائه.
وفي حال قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب زيادة الضغط على الاسد فانها يمكن ان تزيد الدعم العسكري لما تسميه “المعارضة المعتدلة” في الجنوب عبر الاردن.
وبالنسبة للاسد فان استعادة الجنوب تقضي على ذلك الخطر وهو ما من شأنه أيضا ان يحافظ على الحدود مع اسرائيل وهذا هو احد الاعتبارات الكبيرة لكل من دمشق وحزب الله وايران الذين سعوا الى بناء مشروعية شعبية استنادا الى الصراع مع اسرائيل.
وفي دمشق فان المراقبين يرون ان الحملة الجنوبية تشكل بداية هجوم استراتيجي مضاد من شأنه انهاء الحرب بشروط الحكومة.
وقال سليم حرباالباحث والخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية السورية “بدأ الآن ما يسمى بالهجوم المعاكس الاستراتيجي على أكثر من اتجاه لتطهير وتحرير كل المناطق التي تتواجد فيها المجموعات الارهابية.”
اضاف ان عملية الجنوب “تعتبر تحولا نوعيا في اطار الحرب”.
وقال محمد كنايسي رئيس تحرير صحيفة البعث التي تديرها الدولة في مقابلة اجريت معه مؤخرا في مكتبه بدمشق “الظروف الموضوعية والتطورات في المنطقة تدعو الى تغيير الموقف الامريكي لكن المشكلة ان امريكا لا تغير بالسرعة المطلوبة لا زالت تلعب على أكثر من حبل”.
وفكرة الانتصار العسكري تتعارض مع الرأي السائد على نطاق واسع بان الحرب يمكن فقط ان تنتهي بتسوية سياسية. فالجهود الدبلوماسية الرامية الى تعزيز مثل هذه النتيجة لم تستطع ان تحقق شيئا منذ انهيار محادثات جنيف للسلام عام 2014.
ويبحث مسؤولون غربيون عن سبل لدعم ما يسمونه “معارضة معتدلة” لتقويتها في أي مفاوضات مستقبلية.
والولايات المتحدة على وشك البدء بتقديم التدريب والعتاد للمسلحين لمحاربة الدولة الاسلامية. ولكن لا يبدو أن حجم وهدف البرنامج سيغير من موازين القوى.
وحتى بعض معارضي الاسد أبدوا مرونة في مسألة توقيت رحيله في المرحلة الانتقالية التي يأملون ان تنهي حكمه. ويبدو ان الاسد يراهن على ان الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية ستجبر في نهاية المطاف الولايات المتحدة على فتح قنوات إتصال معه خاصة وان القوات العراقية تستعد لاستعادة الموصل.
ويتم ابلاغ الاسد بالضربات الجوية التي يشنها التحالف في سوريا عبر أطراف ثالثة بما فيها العراق.
ولكن هناك إنعدام عميق للثقة حيث يرى معارضو الاسد أنه إستغل موضوع التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الاسلامية لصالحه.
وقال مسؤول غربي “لا مفر من فكرة ان سوريا مع الاسد في سدة الحكم لن تكون موحدة. هو لا يستطيع إعادة توحيد سوريا .ولو تراجعنا فهذا لن يحل المشكلة.”
(إعداد ليلى بسام للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
بشار باقٍ بفضل “داعش”/ الياس حرفوش
عندما يبلغنا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي اي) جون برينان ان بلاده لا تريد انهيار الحكومة السورية والمؤسسات التابعة لها، لأن ذلك يخلي الساحة للجماعات الاسلامية المتطرفة ولا سيما «داعش»، فإنه يبدو كأنه يقرأ في خريطة الطريق التي أعدها الرئيس بشار الأسد منذ بداية الأزمة، واختار لها المسار الذي أرادها ان تذهب اليه، وهو ان بقاء هذا النظام هو الذي يحمي المنطقة من انتشار الارهاب، وان مصلحة الغرب ان يقف مع الاسد في هذه المعركة، لأنه الوحيد القادر على كسبها.
لا شك ان برينان يدرك ان ما يسمّيه «الحكومة السورية» هو الرئيس الأسد والمجموعة الحاكمة، الامنية خصوصاً المحيطة به، والمسؤولة عن المجازر التي ارتكبت في سورية على مدى السنوات الاربع الماضية. ويعرف ايضاً ان كل المحاولات التي بذلت لـ «اختراع» مجموعة حاكمة (سمّيت احياناً هيئة انتقالية) منفصلة عن الاسد، فشلت، لأن مثل هذه المجموعة ممنوعة من الظهور في دمشق. كلام برينان يعني، بالنتيجة، ان ادارته اختارت بقاء بشار خوفاً من تقدم «داعش».
لا يهتم المسؤولون في ادارة باراك اوباما بكيفية تحول المعركة في سورية الى مواجهة بين خيارين: نظام بشار الأسد أو تنظيم أبو بكر البغدادي. ويتجاهلون ان إتاحة المجال لآلة القتل السورية على مدى السنوات الاربع الماضية لتفتك بالشعب السوري، هي التي دفعت الحراك السلمي الى العسكرة، وهي التي غذّت ظهور التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها «داعش». ألم يكن هذا هو السيناريو الذي خطط له رأس النظام السوري ونجح في تحقيقه نجاحاً باهراً؟
ما وصلنا اليه اليوم، بعد أربع سنوات على هذه المجزرة المفتوحة، هو نتيجة التقاء العجز الدولي، والاميركي خصوصاً، مع وحشية النظام السوري. لذلك لا يلام المعارضون السوريون عندما يتحدثون عن مؤامرة دولية لإبقاء النظام جاثماً فوق رؤوسهم. اذ كيف يمكن تفسير الحرب التي سارع العالم الى خوضها ضد تنظيم «داعش»، وهي حرب ضرورية ومشروعة، في مقابل الصمت عن الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، والمرشحة للاستمرار الى مدى غير منظور؟ ألا يعني هذا ان الدماء الغربية التي تسيل على يد جزّاري «داعش» هي أغلى من الدماء السورية التي تسيل على يد «الشبيحة» واجهزة الاستخبارات والتعذيب الموزعة في اقبية المدن السورية؟
استفاد بشار الأسد من هذا العجز الغربي الى آخر الحدود. كان يعرف منذ البداية ان تصميمه على البقاء في السلطة لن يواجَه بأكثر من كلمات التهديد. وضع الحملة الشعبية الواسعة على حكمه في إطار المؤامرة الكونية على ما يسمّيه «خط الممانعة». لم تعد المعركة اذن ضد النظام السوري وحده، ولذلك صارت تستدعي مشاركة كل اطراف هذا الخط في المواجهة. لم يقصّر حلفاؤه في المشاركة. وكان الايرانيون على رأس الداعمين. موّلوا معركة بقاء الاسد ببلايين الدولارات على رغم اوضاعهم الاقتصادية الصعبة. فهم كانوا يدركون المكاسب من بقاء هذا النظام على مشروع التوسع المذهبي الذي يقودونه، وعلى امتدادهم العسكري وصولاً الى جنوب لبنان، من خلال «حزب الله». بعد نجاح الايرانيين في كسب معركة بغداد نتيجة تعاونهم مع الاحتلال الاميركي، ها هم يكسبون معركة دمشق نتيجة دعمهم للنظام الذي يزعم مقاومة هذا الاحتلال، فيما يعود بقاؤه بالدرجة الاولى الى شلل القيادة الاميركية وعجزها عن تولي المسؤولية الدولية التي يفرضها موقعها.
الروس من جهتهم كانوا الطرف الآخر في الاسراع الى دعم النظام السوري. وبحجة الاعتراض على قرار التدخل الغربي في ليبيا الذي انتهى الى تدخل حلف الاطلسي عسكرياً هناك، منعوا أي دور لمجلس الامن في الازمة السورية. لكن فلاديمير بوتين كان، في الحقيقة، يستخدم الشعب السوري كحجارة شطرنج في مواجهته مع الغرب. ومثل شعب اوكرانيا، يدفع السوريون ثمن الدور المفقود الذي يحاول الزعيم الروسي استعادته.
عناصر كثيرة اطالت عمر النزاع السوري. غير ان أهمها عاملان: قدرة النظام على الاحتفاظ بتماسكه وبقدرة اجهزته الامنية على القتال الشرس ضد مواطنيه من دون قلق من النتائج، ومن جهة ثانية ثقة هذا النظام ان القرار الغربي بازاحته ليس قراراً جدياً. لم تكن هناك أي نية في أي عاصمة غربية لازاحة بشار الأسد بالقوة، كما حصل مع معمر القذافي وقبله مع صدام حسين. بشار الأسد تأكد من هذه الحقيقة وتصرف على أساسها، والسوريون يدفعون الثمن اليوم من دمائهم، وسورية تدفع الثمن دماراً كاملاً لمدنها ومعالمها.
الحياة
الأسد يعيش على المساعدات الإيرانية: سورية تحت الأنقاض/ عدنان عبد الرزاق
إسطنبول
يتفق محللون سوريون أن نظام بشار الأسد حوّل سورية إلى مأساة العصر، بعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من 33 مليار دولار عام 2014 بحسب تقرير رسمي لنقابة عمال المصارف السورية.
وحسب التقرير زادت ديون سورية الخارجية على 11 مليار دولار بعد تصفير الديون قبل الثورة، كما قال صندوق النقد العربي.
وزادت خسائر سورية الاقتصادية على 202 مليار دولار، كما أورد أخيراً المركز السوري
لأبحاث الدراسات، لتكلل الخسائر بأكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث، بعد أن زادت نسبة الفقر على 80% والبطالة على 70% بحسب خبراء سوريين.
وتراجع عدد سكان سورية من 20.87 مليون نسمة في 2010 إلى نحو 17.65 مليوناً في آخر العام الماضي.
الجرعات الإيرانية
فجّر «المركز السوري لبحوث السياسات» قنبلة جديدة، وإن متوقعة، من خلال تقديره حجم الخسائر الاقتصادية التي منيت بها سورية جراء الحرب على الثورة التي تدخل اليوم عامها الخامس.
وقال المركز خلال التقرير الحديث المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة “الأونروا”: بلغت خسائر الاقتصاد السوري أكثر من 202 مليار دولار منذ اندلاع الثورة في آذار/مارس 2011 حتى نهاية عام 2014، أي ما معدله أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة، وبزيادة قدرها 58.8 مليار دولار عن الخسائر المقدرة بنهاية عام 2013.
ويشير التقرير إلى أن القطاعات الإنتاجية والخدمية تعاني من الشلل، مع تصميم نظام الأسد على محاربة “المؤامرة الكونية” والاستمرار في تمويل الحرب عبر رهن مقدرات سورية وبيع ثرواتها. ويحدث ذلك تحت ظل الإفلاس الذي تعانيه الحكومة السورية، وعجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 40.5% في 2014.
ويقول الدكتور عماد المصبح: على جسامة وخطورة رقم “المركز” إلا أني أتوقع أن الخسائر أكثر من 200 مليار دولار بكثير، لأن التقديرات قلما تأخذ المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بالحسبان، وقلما تدخل الخسائر الاجتماعية التي لها انعكاس اقتصادي، من تهجير وقتل وإعاقات، ضمن دراسات وأرقام المراكز البحثية.
وأضاف الاقتصادي المصبح لـ “العربي الجديد”: “الاقتصاد السوري منهار بكل معنى الكلمة اقتصادياً، لكنه يعيش على المساعدات الإيرانية التي تجلت بمنح مالية مباشرة، لوقف انهيار الليرة وبتصدير السلاح والأغذية والمشتقات النفطية و”شراء” قطاعات الكهرباء والصوامع بحجة الاستثمار وإعادة الهيكلة والإصلاح، فضلاً عن الدعم الروسي الذي بدأ يتسلل إلى قطاع السياحة، بعد تمكنه من قطاعي النفط والغاز”.
وأضاف أن نظام بشار الأسد خسر عائدات تصير النفط وفوائض المؤسسات الاقتصادية الحكومية، كما تراجعت العائدات الضريبية إثر تهديم المنشآت وهروب المستثمرين ورجال الأعمال خوفاً من الموت والاعتقال.
ويختم مصبح: ليس من أي اعتبار لآثار الحرب، فرغم الآثار الهائلة على الاقتصاد والسوريين، والتي لن تمحى أو تعوض لعقود، نرى حملات تسويق بشار الأسد عبر “سورية
بخير”، فمرة نقرأ عن صادرات سورية لحلفاء الحرب والدم، رغم حاجة السوق السورية وغلاء الأسعار، وتارة نسمع عن تزييف بأرقام الصادرات ونسب النمو، وكأن “عصابة النظام” يهمها أن يبقى الأسد بخير وعلى كرسي الوراثة، حتى لو تحولت سورية ومن عليها إلى رماد.
عام الموت
يقول الدكتور أسامة القاضي: مع انتهاء السنة الرابعة على الأزمة الاقتصادية الخانقة، تختفي الإدارة المركزية بشكل شبه تام عن النشاط الاقتصادي السوري، فقد باتت وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومعها وزارة النفط والزراعة وهيئات التخطيط والتعاون الدولي هياكل إدارية لا معنى لها، بعد أن تقطعت أوصال سورية، وأصبحت كل محافظة بمثابة جزيرة منفصلة عن الأخرى. وأضاف لم تعد هناك طرقات أو مطارات آمنة، وخرجت معظم المعابر خارج سيطرة النظام، اللهم إلا في لبنان.
كما أن 97 حقل نفط وغاز باتت تقريباً كلها خارج سيطرة النظام، وتراجع الإنتاج من نحو 380 ألف برميل مطلع الثورة إلى أقل من 15 ألف برميل في اليوم، وخرجت معظم صوامع الحبوب والقطن عن سيطرة الإدارة المركزية.. فماذا تبقى من الاقتصاد السوري؟
ويضيف رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، أسامة القاضي، لـ “العربي الجديد”: “خسرت سورية نتيجة القصف والحرب التي شنها نظام بشار الأسد على الثورة بنيتها الزراعية والصناعية، وخرجت السلة الزراعية في إدلب وحلب ودرعا ودير الزور والرقة والحسكة والقامشلي عن الرادار الاقتصادي للنظام السوري”.
وقال أصبحت لا علاقة لوزارة الاقتصاد بهذه المناطق، اللهم إلا ترتيب تعاملات سرية مع تنظيم داعش لاستقدام نفط وقمح ودفع إتاوة رغم أنف الإدارة المركزية العتيدة.
وأشار إلى أن هذا ما أوصل الاقتصاد السوري بعد أربع سنوات من التدمير الممنهج “لإعلان الوفاة” أمام واقع تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار من 50 إلى 250 ليرة اليوم، وتبديد كامل الاحتياطي النقدي، والعيش على جرعات من إيران وروسيا وبيع ثروات سورية، فوق الأرض وتحتها.
وكان تقرير أمانة الشؤون الاقتصادية لنقابة عمال المصارف في سورية، أكد أن الناتج المحلي
الإجمالي انخفض من 60 مليار دولار عام 2010 إلى 56 مليار دولار عام 2011، ثم انخفض إلى 40 مليار دولار عام 2012 بمعدل انخفاض %28.6، ليتابع انخفاضه إلى أقل من 33 مليار دولار عام 2014 .
وأشار التقرير الرسمي السوري إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير، وسط ازدياد نسبة البطالة بسبب تخريب المنشآت الاقتصادية ومنها النفطية، فبعد أن كان معدل النمو الاقتصادي 4.8% عام 2011 فقد تحول إلى معدل سالب وسجل -3.6% في 2012، ولكنه ارتفع قليلاً في عام 2013 ليصل إلى -3.23% و-3.2% لعام 2014.
ومع تزايد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار لكثير من السلع الأساسية، فقد ازداد معه الهبوط الحاد في قيمة دخل المواطنين، وانعكس ذلك على الاستهلاك.
العربي الجديد
إستراتيجية الدولة السورية لإدارة الأزمة: مقاربة أمنية ـ سياسية.. بانتظار تغييرات دولية/ زياد حيدر
أثمرت استراتيجية الدولة السورية نسبياً ازاء الحرب التي تخوضها في حين فشلت الاستراتيجيات المقابلة.
ومع اقتراب الصراع السوري من الدخول في عامه الخامس، يمكن القول ان التركيز على خطر الإرهاب صار محور الاهتمام الدولي، فيما بقيت الاستراتيجيات البديلة أقرب إلى السياسات الإعلامية المترافقة مع التوتير الأمني منها الى الخطط السياسية.
وربما يكون أبرز أسباب فشل الطرف الآخر هو عدم وجود هذه الإستراتيجية فعلياً، واقتصار السياسات على الرغبة في تحقيق أهداف سريعة، من بينها «إسقاط النظام»، من دون وضوح ما بعده، أو حتى كيفية حصول ذلك أو إمكانيته، وهي حال سياسات أممية أصابت دولاً عدّة بمصائب لا شفاء عاجلا منها، وبينها ليبيا ومصر والعراق… وبالطبع سوريا.
من جهتها، ومنذ الأشهر الأولى للصراع الذي بدأ فعليا في 18 آذار العام 2011، بدا للحكومة السورية، بمستوياتها السياسية والأمنية والعسكرية، أن عربة البلاد قد وضعت على سكة مواجهة لم يعد ممكناً تفاديها، وذلك بعد أشهر من استقرار الخيار الأمني للمعالجة، في مقابل فشل إمكانية اجتراح حلول سياسية واجتماعية على مستويات محلية ضيقة أو مناطقية.
وبالرغم من أن المحتجين نُعتوا منذ الأيام الأولى في الإعلام الرسمي، وعلى لسان بعض المسؤولين، بصفة «الإرهابيين»، إلا أن سياسة الدولة لم تواجههم علانية وبشكل «إعلامي صريح» حتى خريف العام 2011.
وابتداءً من تلك الفترة، تحولت الإستراتيجية الأمنية والسياسية نحو تحقيق مطالب سياسية لجناح، وتصعيد الحملة الأمنية والعسكرية على جناح آخر.
وكان الوقت حينها بعيداً عن عقلية اللحظة الراهنة، التي تروج فيها الدولة السورية وتشجع على المصالحات الوطنية القائمة على توافقات بين المسلحين، أبناء بيئة معينة، وبين الجيش، والتي درجت وحققت فعالية مقبولة في مناطق عدّة.
وحتى الأشهر الأخيرة التي أعلنت فيها هذه المصالحات، كانت الدولة السورية ترفض إعطاء الصراع الدائر أي صفة أهلية، مركزة على البعد الخارجي فحسب. والواقع أن هذا التجاهل ما زال مستمراً، بالرغم من اعتراف كل سلطات الدولة، وكذلك الإعلام المحلي الرسمي والخاص، بوساطات وهدن ومصالحات تجري بين طرفين سوريين بشكل حصري، وإن اتهم بتعطيلها في كثير من الأحيان «الأجانب» من مقاتلين ومتنفذين خارج القطر لهم كلمة طولى على المجموعات المحلية.
إلا أن الإستراتيجية العامة لم تتأثر، عموماً، كنظرة معمقة لما ستؤول إليه المنطقة، وليس البلد بحد ذاته، بعد عام وعامين، بل وأكثر، فالقيادات في سوريا كانت تعرف جيداً، ما الذي يعنيه فسيفساء الشرق الأوسط، وعمق الصراع المذهبي القائم بين طبقات السياسيين الإقليميين، متمثلين بجناحي إيران والسعودية، ومستوى الاحتقان المذهبي على المستوى الشعبي المستعد للانفلات، ولا سيما أنها كانت اختبرته عمليا خلال فترة دعمها لـ «المقاومة العراقية» إبان الغزو الأميركي، والذي اعتبره مسؤولون سوريون كثيرون، تحدثت إليهم «السفير» في بدايات الحرب السورية، من «أكبر علامات الساعة» بالمفهوم السياسي لا القدري.
وكان الحديث حينها يدور عن احتجاجات في مدن سورية محدودة، وإن سالت دماء ضحايا مدنيين فيها، فيما ترددات الزلزال الأكبر تأتي من القاهرة.
وبالرغم من أن الأحداث تأخذ طابعاً مختلفاً نسبياً في ليبيا ومصر وتونس، وكانت قد بدأت للتو في سوريا، إلا أن النظرة العامة كانت أن ما يجري هو من آثار الغزو الأميركي للعراق، بسبب «حالة الواقع الراهن التي أنشأها»، والتي كانت تأخذ منحيين: «الأول سابقة تغيير نظام سياسي عربي بالقوة العسكرية من دون ردع إقليمي أو دولي، والثاني إيقاظ الحقن المذهبي الذي كانت السطوة العراقية تفرضه» ما سمح بنمو الحالة المذهبية وصولا الى «جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري»، والتي وضعت حينها في السياق ذاته.
لذا كانت القناعة السائدة، منذ الأشهر الأولى، أن ما يجري في شقه الخارجي هو احد اثنين: «إما مشروع استنزاف للدولة يأتي بعده ما يأتي من مشاريع»، أو «مشروع إسقاط صريح للنظام لتنصيب نظام آخر، كان الاعتقاد السائد أنه من قيادات الإخوان المسلمين، المدعومين من قطر وتركيا، وبقبول أميركي، وبشكل لا يخلو من إشارات طائفية هو الآخر».
وبالرغم من أن القيادة السورية قدمت، نهاية العام 2011، «إصلاحات سياسية» كان الغرض منها سحب حجة الرغبة بالإصلاح لدى «المعارضة»، إلا أن الحل الحقيقي المستند إلى إستراتيجية بعيدة المدى كان متابعة الخيار الأمني العسكري، مع ترك موجة الجنون التي تعصف بالإقليم تأخذ مداها، في ظل رغبة تركيا في ركوبها، وتسليحها ومدها لوجستياً بالعناصر البشرية، بقبول غربي ومساندة خليجية، حتى صار الخطر أكبر من أية إمكانية لمواجهته على مستوى فردي، أو حتى على مستوى تحالف جوي دولي.
وبالرغم من أن كثيرين يقولون أن احتواء الأزمة في سوريا كان ممكناً قبل أن تتحول إلى صراع دموي، ومن ثم إلى حرب إقليمية بالوكالة، وذلك عبر اتخاذ خطوات تصالحية في مدينة درعا، التي بدأ بها الحراك الشعبي، وإجراء إصلاحات سياسية حقيقية تصيب جوهر النظام السياسي لا شكله، إلا أن المواجهة التي استعدت لها دول عدّة، مثل قطر وتركيا، منذ الأشهر الأولى، ودعواتها الملحة إلى تغيير سياسي يعيد جماعة «الإخوان» إلى صلب السلطة السياسية من دون أدنى مجهود سياسي من قبلهم، وصولا إلى قفزة سريعة لمطلب رحيل النظام متمثلا برأسه، يعزز موقف الرأي الآخر، الذي يعتبر أنه لم يكن من مفر من المواجهة.
وهذا كان من بين الأسباب التي وضعت فيها الدولة بنداً ثابتاً في إستراتيجيتها الطويلة الأمد، تمثل في قرار الحفاظ على الدولة، بمؤسساتها، وسير عملها، ومشاريعها المستقبلية قدر الإمكان، فظلت مؤسسات الكهرباء تعمل بطاقتها الممكنة، واستمر تدفق الرواتب الى آلات الصرف الآلي، ولم يتوقف روتين ختم الأوراق لتسيير المعاملات المختلفة، كما لم يتوقف عناصر شرطة المرور عن تسطير مخالفات السير، حتى في أوقات سقوط الصواريخ والقذائف على أحياء دمشق، علماً بأن كلفة هذه «الاستمرارية الخدمية للدولة» تفوق خمسة مليارات دولار سنوياً، وفق ما قال مسؤولون سوريون لـ «السفير».
وظل العمل، ولا يزال، على ترسيخ القناعة المحلية كما الدولية، على أن الدولة باقية لا محالة، وصولاً إلى استنتاج الأعداء قبل الحلفاء أخيراً، بأن بقاء الدولة السورية، ولو بصورتها التي لا يحبذون، أبقى على نوع الاستقرار النسبي، كان يمكن دونه أن تدمر كل خاصرة شرق المتوسط أمام خطر التطرف.
ومع مرور أربع سنوات، تبقى كل الفرضيات محيرة فيما اذا كان ممكناً تجاوز ما جرى أم لا، ولا سيما أن قراءة الواقع الإقليمي وتغيراته السريعة والجذرية، لا توحي بأن فترة ربيع العام 2011 كانت تقبل بمصالحات، سواء على مستوى داخلي تعززه حالة الجموح الشعبي التي ينقلها الإعلام (وإن كانت مبالغا بها) مقابل حالة التصلب المطلوبة من قبل النظام من جهة، وإقليمي ودولي من جهة أخرى ترى إمكانية رسم خريطة نفوذ جديدة في الشرق الأوسط المضطرب، مقابل صمود للدولة الخصم.
إلا أن ما تتفق عليه، كل الأطراف المعنية بحرب سوريا الدموية، هي أن احداً لم يتخيل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، من مآس ودمار معنوي ومادي.
كما تتفق هذه الأطراف، على أن حساباتها لتوقيت الصراع الزمني ومداه، لم تكن لتمتد لسنوات أربع مستمرة.
وتتمثل الإستراتيجية القائمة حالياً في المشاركة الإيجابية بمناقشة الأفكار السياسية المطروحة من قبل الأصدقاء، أو بسبب ضغطهم، والسعي لتحقيق المزيد من المصالحات الوطنية على مساحات أوسع، من دون التنازل عن المسار العسكري، والذي صار مؤخرا يحظى بمشاركة عسكرية إقليمية صريحة ومعلنة رسمياً، وذلك بانتظار أن يعي العالم ما جرى تجاهله منذ نقلت وكالة «فرانس برس» صورة أول مقاتل لتنظيم «القاعدة» في قرية زارا الحمصية في ربيع العام 2012… أي أن ثمة خطراً عالمياً لا يمكن مواجهته من دون التنسيق مع دمشق.
مؤتمرات حوارية
÷ حزيران 2011: المؤتمر التشاوري
عقد المؤتمر برعاية رئيس الجمهورية، وأداره نائب الرئيس السابق فاروق الشرع، وتميز بمحادثات ومداخلات لا سابق لها بين مسؤولين بعثيين وشخصيات معارضة، وبحضور متنوع لممثلين عن شرائح المجتمع. وعقد بهدف التمهيد لمؤتمر وطني جامع.
وانتهى المؤتمر بإصدار بيان استغرقت عملية صياغته يوماً كاملاً، واتفق فيه على وقف العنف والتشاور بين الشخصيات المشاركة، بهدف عقد مؤتمر حوار وطني يتم فيه الاتفاق على أسس التغيير السياسي في سوريا. لكن المؤتمر لم يتقدم خطوة منذ تاريخه.
÷ تشرين الأول 2012: مؤتمر الحوار الوطني في طهران
عقد مؤتمر الحوار الوطني في طهران، بموافقة من الحكومة السورية، وذلك كـ «مساهمة» في التمهيد لحل سياسي، لكن من دون مشاركة شخصيات معارضة خارجية. واختتم بالاتفاق على تشكيل لجنة متابعة، قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية أمير عبد اللهيان وقتها إن هدفها الإعداد لاجتماع مقبل في دمشق.
وعقد المؤتمر، تحت شعار «لا للعنف، نعم للديموقراطية»، بمشاركة حوالي 170 شخصية سياسية سورية، بينها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل ووزير المصالحة الوطنية في سوريا علي حيدر، بحضور وزير الخارجية الإيراني السابق علي أكبر صالحي.
÷ شباط ـ آذار 2013: مؤتمر الحوار الوطني الداخلي
جرى برعاية من «حزب البعث»، وشكل في واقع الحال حواراً بين كوادره وفعاليات اقتصادية واجتماعية لا تنتمي في واقع الأمر الى المعارضة المعروفة أو المعلن عنها. واعتبر المؤتمر بالنسبة لقيادات سورية، كما للإعلام المحلي في حينه، مكملاً للمؤتمر الوطني الذي تأخر عقده، بالرغم من وعود متكررة بعقده، من دون أن يثمر جدوى حقيقية.
÷ حزيران 2012: مؤتمر «جنيف 1»
انبثق مؤتمر «جنيف 1»، الذي عقد في 30 حزيران العام 2012، عن اتفاق الجانبين الأميركي والروسي على وثيقة سميت «جنيف 1» الشهيرة، التي تنص على فترة انتقالية تمهد لقيام نظام سياسي جديد، استناداً إلى حوار أو مفاوضات تقوم بين المعارضة والنظام.
÷ كانون الثاني 2014: مؤتمر «جنيف 2»
جلسة الحوار المفترض بين النظام والمعارضة، والتي تمثلت بقوى «الائتلاف» المعارض، عقدت لمدة يومين، ولم تؤدِّ إلى نتيجة تذكر، بسبب اختلاف الطرفين على أجندة المؤتمر وأولوياته.
÷ كانون الثاني 2015: منتدى «موسكو 1»
عقده الروس، بتشجيع أميركي وأممي، بين وفد حكومي رفيع المستوى وممثلين عن المعارضة الداخلية والخارجية، لكن من دون تمثيل حقيقي لـ «الائتلاف». ويفترض أن يعقد منتدى «موسكو 2» في نيسان المقبل إن لم تطرأ تغييرات.
السفير
بين إسقاط الأسد وإسقاط “داعش”/ علي حماده
لنقل الامور بصراحة، لا يمكن انقاذ المشرق العربي مما يسميه كثيرون في العواصم العربية الكبرى “الاحتلال الايراني” من دون الحاق هزيمة حاسمة بالمشروع التوسعي الايراني في سوريا. فسوريا هي حجر الرحى، وتفوق العراق اهمية كونها واقعة في قلب المشرق العربي. وبكلام لا يقل صراحة لا يمكن الحاق هزيمة حاسمة بالمشروع الايراني من دون انشاء “جبهة عربية” تتكون من دول الخليج العربي، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، مع مصر، وتكون متحالفة مع تركيا تضع ثقلها في معركة سوريا التي توشك ان تصير حرب تحرير عربية بصرف النظر عن واقع تنظيم “داعش” الذي يجري التحجج بوجوده في الشرق من اجل ادامة نظام بشار الاسد المهترئ، وتستغله ايران من اجل تقديم مشروعها على انه مجرد حرب ضد “الارهاب” حين ان الارهاب الذي يمارس ضد الشعب السوري، و سنة العراق لا يقل فظاعة عن ارتكابات “داعش”. لذلك يجب تجاوز ذريعة “الحرب على الارهاب” بخطوات ملموسة في اتجاه الفصائل الثورية السورية التي بتحالفها تحت مظلة مشروع عربي متحالف مع تركيا يمكن ان تقلب الموازين على الارض، وتعجل في اسقاط نظام بشار الاسد.
لم يعد من المسموح عربيا القبول بالقراءة الاميركية للواقع السوري، فالسياسة التي انتهجتها ادارة الرئيس باراك اوباما تتسبب بالكوارث، وبتسليم المنطقة الى ايران على طبق من ذهب، بعدما ادى تأييد الاميركيين لتولي نوري المالكي الحكم في العراق الى انهيار ذلك البلد بفعل التنكيل بالمكوّن السني. اما في سوريا فأدى تمسك الادارة الاميركية ببقاء نظام بشار الاسد الى انهيار المعارضة المعتدلة من جهة، وتمكين الميليشيات الطائفية التابعة لطهران من العبث بالكيان السوري وتوازناته من جهة.
كما ادى الى تنامي قوة التطرف السني على حساب الاعتدال، من دون ان ننسى تجاوز عدد الضحايا في سوريا عتبة المئتي الف قتيل (ثمة تقديرات بثلاثمئة الف قتيل). لم يعد مقبولا الرضوخ لقراءة ادارة الرئيس باراك اوباما للخريطة الاقليمية. حان اوان القول للرئيس اوباما كفى. لقد ادت سياسة الادارة الاميركية الى افقاد اميركا اهم عنصرين في سياستها الخارجية ثقة الحلفاء وخشية الخصوم.
اذا غابت مصر عن “الجبهة العربية” لا يمكن ان تقوم. واذا غابت تركيا عن الحلف العربي – التركي لا يمكن مواجهة سياسة اوباما الكارثية على العرب.
تقول واشنطن أن الاولوية هي لمقاتلة “داعش” ثم يمكن النظر في مصير نظام الاسد. نحن نقول ان الاولوية لتحرير سوريا انقاذها من نظام بشار الاسد والميليشيات الطائفية التابعة لايران.
هذا ليس كلاما راديكاليا ولا حالما. ومن هنا اهمية السعي السعودي الى حل الخلافات العميقة مع تركيا، وحث انقره على تغيير تعاملها مع مصر ما بعد الاخوان، بما يسهل وضع مصر في قلب “الجبهة العربية” لمواجهة التمدد الايراني. ولمصر مصلحة في احتلال موقع متقدم في مواجهة التمدد الايراني الذي يستهدف الهوية العربية قبل اي شيء آخر.
النهار