أزمة الكتابة في السينما العربية/ أمير العمري
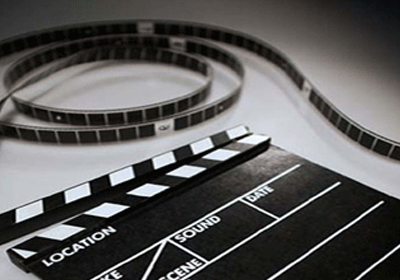
ليس بإمكان كل المخرجين الكتابة عن أفلامهم وتجاربهم السينمائية، فمعظمهم لا يكتبون لأنهم باختصار لا يتقنون الكتابة لأنها فن مثل صنع الأفلام، والكتابة الجيدة عن الأفلام إبداع يوازي إبداع الفيلم، الجيد طبعا، ومخرجو السينما في العالم لا يتفلسفون ولا يحتلون أعمدة في الصحف ليكتبوا فيها أي كلام، بل حتى عندما يريدون كتابة مذكراتهم أو سيرهم الذاتية فإنهم يعهدون بها إلى ناقد أو صحفي متخصص أو كاتب ضليع في كتابة هذا النوع من الكتب.
الحال ليس كذلك في عالمنا العربي، فأي مخرج يمكن أن يصبح كاتبا وفيلسوفا ومنظرا وناقدا لأفلامه بل لأفلام الآخرين أيضا إذا أراد، فمساحات الكتابة مفتوحة أمامه تحت تصور أن شهرته كفيلة بأن تجلب الرواج للصحيفة أو المطبوعة أو لدار النشر التي تنشر ما يكتبه، بغض النظر عن مستوى إلمامه بقواعد اللغة العربية وفن الكتابة وصياغة الأفكار.
على الصعيد العالمي يمكن القول إن قلائل من المخرجين الكبار، أصحاب النظريات الفلسفية والفنية والمتأملين في الإبداع، هم من استطاعوا الكتابة عن أفلامهم في سياق التأمل الفكري والنظري في معنى السينما ومفهومها وعلاقتها بفكرة الزمن مثلا أو المونتاج، وعلاقة المونتاج باللغة وغير لك.
ولعل في مثال مخرجين مثل سيرجي أيزنشتاين أو أندريه تاركوفسكي، ما يوضح هذه الفكرة، لكنه الاستثناء وليس القاعدة، فمخرج عبقري مثل أورسون ويلز مثلا، لم يكتب عن أفلامه، ولم يضع النظريات حولها بل تركها للنقاد والمتخصصين.
كتابة السيناريو
هذا المدخل يقودنا إلى زاوية أخرى ربما تكون أكثر أهمية من كتابة الذكريات والنقد والتحليل السينمائي، وتتعلق بكتابة السيناريو.
فربما كان من أهم ما يمكن ملاحظته في مسار غالبية المخرجين العرب الذين بدؤوا مسارهم الفني بأفلام شديدة الطموح والجاذبية، أنهم انتهوا بعد فترة إلى تكرار أنفسهم أو الدوران حول الأفكار نفسها التي سبق لهم تناولها في أفلامهم الأولى، أو تشبثوا بقشور أفكار يغلفونها عادة بالكثير من مشاهد الفولكلور والتقاليد الشعبية الغريبة التي يعتقدون أنها ترضي الجهة الغربية التي تمول مثل هذه الأفلام.
تستند معظم هذه الأفلام أيضا إلى نظرية المخرج المؤلف التي شاعت في السينما الفرنسية منذ حركة الموجة الجديدة في أواخر الستينيات. كان نقاد الموجة الجديدة الذين تحولوا فيما بعد إلى الإخراج السينمائي، يرون أن الفيلم السينمائي يجب أن يكون عملا فنيا رفيعا، مثل الرواية والقصيدة واللوحة التشكيلية.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد أن يكون هناك “فنان” واحد يُسند إليه الفيلم، أي يكون هو صاحب الرؤية الفنية التي يتضمنها، كما في حالة الروائي والشاعر والرسام. كيف إذن يمكن إسناد الفيلم إلى مبدع واحد بينما الفيلم نتاج جهود جماعية من طرف كتاب السيناريو ومصممي الديكور والمصورين والممثلين و”المونتيرين” وغيرهم؟
وكان رأي نقاد “الموجة الجديدة” أن المخرج هو هذا “الفنان”، “فنان الفيلم” أو “المخرج المؤلف”. ولا تعني كلمة مؤلف هنا أن المخرج يجب أن يكتب سيناريوهات أفلامه بنفسه، بل أنه يوازي في إبداعه المؤلف الروائي، أي يعبر عن رؤيته الخاصة من خلال أفلامه. وأصبح بالتالي لا يكتب في عناوين الفيلم العبارة التقليدية: “فيلم من إخراج فلان”، بل “فيلم لفلان”.
وقد درس معظم المخرجين السينمائيين من بلدان المغرب العربي -تونس والجزائر والمغرب تحديدا- السينما في فرنسا، وبدرجة أقل في ايطاليا أو بلجيكا. وفي هذه البلدان سادت منذ الستينيات نظرية المخرج المؤلف، وأن المخرج أهم من كاتب السيناريو، وأن الكاتب مجرد “صنايعي” أو “حرفي” يمكنه نقل رواية أدبية أو مسرحية مثلا إلى لغة السينما، أما المخرج فهو يعبر عن رؤيته الخاصة، باعتباره مؤلف أفلامه.
رؤية وتجربة
ولكن المشكلة أنه لكي يتمكن المخرج من إنجاز فيلم يعكس رؤية فلسفية ما، يجب أولا أن تتوفر لديه التجربة الإنسانية العميقة التي تسمح له بالتعبير عن موقف فلسفي وفكري من العالم. لكن الملاحظ أن الهم الأساسي لدى السينمائي العربي هو الهم السياسي، أي نقد السلطة ومظاهر التخلف الاجتماعي دون التطرق إلى مشكلات أكثر عمقا تصب في التاريخ، وتتعامل بنظرة فلسفية مع الكثير مما يشغلنا في حياتنا.
غياب التجربة -وبالتالي الرؤية العميقة- مع التشبث بضرورة أن يكتب المخرج فيلمه بنفسه، أدت على المدى الطويل إلى انقراض مهنة كاتب السيناريو المحترف الذي يفهم أصول الدراما السينمائية، والذي يمكنه نقل الفكرة البسيطة المجردة التي قد تأتي من المخرج، إلى مجال الدراما السينمائية المركبة.
لذلك أصبحت الأفلام تتشابه في حبكاتها وأساليب مخرجيها، فهي لا تعتمد على الدراما المركبة، بل على الوصف الخارجي الانطباعي الذي يعتبر أقرب إلى مجموعة من الخواطر العابرة، مع تأكيد نزعة التمرد عن طريق الإفراط في تحريك الكاميرا بلا هدف، أو اللجوء للقطعات والانتقالات السريعة من خلال المونتاج دون أن يكون لهذا أي ضرورة فنية في السياق السينمائي نفسه.
فأنت عندما تتخذ زاوية ما لتصوير لقطة معينة، تكون الصورة قد انطبعت في ذهنك وأنت تفكر في مغزى اللقطة ومضمونها ومكانها في سياق الفيلم وعلاقتها بغيرها من اللقطات، لكنك لا تحدد مسبقا وفي الفراغ شكل لقطة ما فقط لأن زاوية الكاميرا تعجبك أو تبدو مثيرة أو غريبة، فهنا يصبح الأمر مجرد تلاعب شكلي مراهق.
ما أقوله هنا لا يتعارض مع فكرة التجريب في السينما، أي تجريب أشكال وأساليب وطرق جديدة للسرد ولكسر القوالب التقليدية للصورة، ولكن يجب قبل تكسير السرد التقليدي وتحطيم قواعد اللغة التقليدية أن يكون المخرج قد أتقن أصلا أسلوب سرد قصة.
فمن الأفضل مئة مرة أن تتمتع بالقدرة على رواية قصة محكمة ذات بداية ونهاية، ويكون لها مغزى ما -حتى لو كانت مقتبسة عن الأدب أو المسرح- من اللهو بالكاميرا والدوران حول الشخصية الوحيدة التي ترغب في التعبير عن أزمتها دون أن تصل إلى شيء، ودون أن تحقق الشرط الأساسي في السينما أي متعة المشاهدة.. والمتعة في النهاية غير التسلية!
_____________
* ناقد سينمائي مصري
الجزيرة نت





