إشكاليّة التَّمركُز والاختلاف في كتاب: “أنطولوجيا الذات” للدُّكتور أحمَد برقاوي/ د. مازن أكثم سليمان
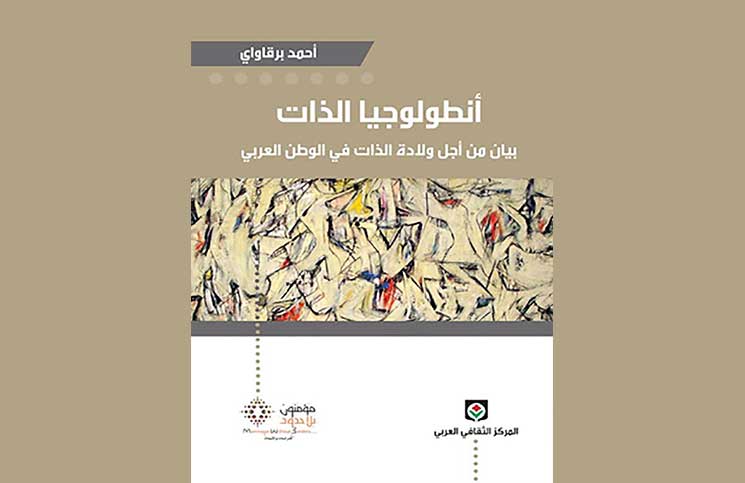
يُعلِنُ المُفكِّرُ الدُّكتور أحمَد برقاوي منذ افتتاحية كتابه “أنطولوجيا الذات” (الصّادر في طبعته الأُولى عام 2014عن المركز الثقافي العربي ومؤسَّسة مؤمنون بلا حدود في الدار البيضاء وبيروت)، عن “ولادة الذات العربية” على الرغم من “كل آلام مخاض التاريخ” (الصفحة 11) كما يقول، مُديراً ظَهرَهُ لمَنْ يسمِّيهم بـِ “طُغاة الفلاسفة” وأتباعِهِم من العرب الذين انساقوا برأيه وراء مَقولات الغرب حولَ موت الذات وموت الإيديولوجيا، وهوَ لا ينفي انتماء هذه الذات العربية بالمعنى التَّحقيبيّ إلى مرحلة ما بعدَ الحداثة، لكنه يرى أنَّها ما زالت تنتمي في الوقت نفسه إلى ثقافة ما قبل حداثوية، تفرضُ عليها أنْ تكونَ ذاتاً فاعلة وموجودة، لا ذاتاً تابعة ومُنسحِبة وميتة. ولذلك يبدأ المُؤلِّفُ كتابَهُ في تعيين ما أدعوه “الخصوصيّة” أوَّلاً، وفي ربط ولادة الذات العربية _في ضوء هذه الخصوصية_ بالشرط الوجودي التاريخي العربي الخاضِع حالياً للاستبداد بقواه الغاشِمة والناعمة في آنٍ معاً (انظر الصفحة 13)، فالذات العربية ذاتٌ هشّة هامشيّة خانِعة وحيدة تعيشُ خوفَها المُزمِن وقلَقِها على المَصير، ولهذا عليها أنْ تُولَدَ من رحم هذا المُستوى الوقائعيّ بما هيَ (أي الذات) حسب اعتقادِهِ “مركز الوجود والوجود معاً” (الصفحة 18).
إنَّ ولادة الذات العربية هيَ عودة إلى “وَحدة الذات والحُرِّيّة، ومن أجل وَحدة الذات والحُرِّيّة” (الصفحة 20)، وهيَ بذلكَ تُواجِهُ “الوعيَ القطيعيَّ” القائِمَ في عالمها العربي، والذي “توحَّدَتْ فيه مركزيّة الإله معَ مركزيّة الحاكِم” (الصفحة 23)، فاستُبْدِلَتْ هذه الذات ببِنيةٍ لا تعترِفُ بها، وتمزَّقَ وعيُها الوجوديُّ بينَ “وعي بالسِّيادة، وعي بالعُبوديّة، ووعي بالتمزُّق والتَّخلُّص من هذا التناقُض” (الصفحة 67).
وهكذا، لا ينفي الدُّكتور برقاوي تفتُّتَ الذات العربية وتشتُّتِها؛ أي لا ينفي فُقدانها للتَّمركُز مثلها مثل الذات الغربية التي نظَّرَ لها فلاسفةُ الغرب، وفي مُقدِّمتِهِم فلاسفة الاختلاف، لكنَّ الفرقَ بين الذاتيْن المُمزَّقتيْن _وفقَ تحليلي لتوجُّهات المُؤلِّف_ يكمنُ في الفرق بينَ الشرطيْن الموضوعيين للتمزُّق؛ فالفلسفة المُعاصِرة تجِدُ أنَّ تمزُّقَ الذات يعودُ إلى انقضاض الاختلاف على وَحدتها بفعل طبيعتِها غير القابِلة للتعيُّن، وهو الأمر المُرتبِط بطبيعة الحال بتمزُّق المُستوى الوقائعي في الغرب، والذي مرَّ عندهُم بثورات صناعيّة وتقنيّة ومَعلوماتيّة وبُيولوجية هائلة، أكَّدَتْ مآل هذه الذات إلى التَّفكُّك وفُقدان أيَّة وَحدة مركزيّة مُتماسِكة ذاتاً أو مُجتمَعاً. في حين أنَّ تمزُّقَ الذات العربية نابِعٌ من مُمانَعَةِ الاختلاف في العالم العربي بفعل تمركُزات الذّوات السُّلطانيّة الحاكِمة التي تُصادِرُ حُرِّيّةَ الذات العربية، وجميع إمكانيّات التعدُّديّة والتَّباعُد والتَّجاوُز الوجوديّ، وذلكَ كما يقول الدُّكتور برقاوي عبرَ استلابِها بتأثير سَطوة الحقيقة المُنزلة عليها من مُستوىً أعلى مُرتبِط بمركزيّة السُّلطة المُستبدّة، والتي تفرضُ على الذّوات العربية ناقِصة الكينونة أنْ تكونَ ذواتاً تابِعة ومُنتهَكة و”سيَّارَة” تدور حولَ المركز _ الحاكِم (انظر الصفحة 140).
وعلى هذا النَّحْوِ، يُنشِئُ المُؤلِّفُ نوعاً من الاختلاف بينَ الذات العربية والذات الغربية انطلاقاً من فَهمِهِ الخاصّ للتمركُز والاختلاف نفسهما؛ ففي العالم العربي يقمَعُ “التمركُز السُّلطويّ” إمكانيّة انفتاح الذّوات نحوَ تعدُّدِها وتنوُّعِها واختلافِها، في حين ترعى “الديمقراطيّة الغربية” عبرَ نظام حُكم “الدولة _ المدينة” تخارُج الذّوات السُّلطانيّة المركزيّة نفسها برعاية “حُقول مُمارَسات الذّوات السُّلطانيّة لشهوة حُضورِها، ليسَ في جهاز السلطة الحاكِمة فحسب، بل في مُؤسَّسات تتطلَّبُ ذواتاً سُلطانيّة: الحزب، النقابة، النادي، الجمعيّة…إلخ” (الصفحة 146)، وهيَ المسألة التي يُسمِّيها بـِ “امتلاك القوة عبر الديمقراطية” (الصفحة 166)، ويشرَحُها بأنَّها “التَّوزيع شبه العادِل للقوّة” (الصفحة 166)، مُميِّزاً بينَ “الذات السُّلطانيّة الإمبراطوريّة” في العالم العربي، والذات السُّلطانيّة الديمقراطية القائِمة على ثقافة الاعتراف في الغرب (انظر الصفحتين 166_167).
ويذهَبُ الدُّكتور برقاوي إلى الاعتقاد أنَّ “المركزية الأوروبية” قد تولَّدَتْ بفعل هذا الاختلاف؛ أي بوصفها “ثمرة طبيعية لانتصار مركزية الإنسان انتصاراً لحُرِّيّة حُضور الذّوات السُّلطانيّة في حقلِ الحُرِّيّة، وبإعداد ذوات تشعرُ بحُرِّيَّتِها” (الصفحة 148)، في مُقابِلِ ذاتٍ عربيّة هامشيّة ذات وجود هشّ فقير يشعرُ بالدّونيّة أمامَ ذلكَ الوجود الغربي المركزي _ الديمقراطي المُعتزّ بمُكتسباتِهِ (انظر الصفحة 148)، والذي أبقى حِيازةَ “الديمقراطية” حِكراً عليه، ومارَسَ إزاءَ الآخَر سياسات هُوِيّة استعماريّة لم تُوفِّرْ “أي وسيلة كانت لنزع الاعتراف من المُستعمَر، القتل، الثقافة، منح فضلات قوّة، الأيديولوجيا، اللغة” (الصفحة 87)، وهيَ القضيّة التي تضَعُ “الفكر الغربي” أمام مُساءَلة أخلاقيّة بوصفه فكراً قد سقَطَ _وهوَ المُحتفِي بالاختلاف_ في فُصام بينَ ادّعاءاته الديمقراطية، وسياساتِهِ الإيديولوجيّة الجوهرانيّة المُتعصِّبة والعُنصرية التي لم تعترِفْ بالمُختلِف! وهُنا يبدو السؤال المحوري الذي ينبغي مُواجهَته في هذا السياق: هل يُعيدُ الدُّكتور برقاوي إنتاج “مركزية عربية” مُقابِلة للمركزية الغربية بوصف العلاقة بينهُما تناحُريّة وتفاصُلية تبلغُ حدودَ العنف؟
ينتقِدُ المُؤلِّفُ “الذات العربية المُترجَمة” التي “خضعَتْ لمنطق قوّة ذات أُخرى، قوّة الذات الأُخرى هُنا قائِمة في المكانة والهيبة، والذات التي راحَتْ تُترجِمُ هيَ ذاتٌ شاعِرَةٌ بالدّونيّة تجاه الذات المُترجَمة هُوِيَّتُها” (الصفحة 59)؛ فالذات التي تعيشُ اختراقاً أوروبياً _ ثقافيّاً أو إيديولوجيّاً أو…إلخ هيَ ذات تعيشُ “أمامَ مُشكِلة أنطولوجيّة بامتياز، مُشكِلة وجود، وجود أصيل ووجود شبيه” (الصفحة 61)، حيث “أنتَجَ الغرب أغرَبَ ظاهِرة في عالم الحضارات وعلاقاتِها، أقصد ظاهِرة الصراع داخِلَ الثقافة العربية بينَ ثقافة الغرب المُخترِقة لعالمنا وثقافة الإرث التاريخيّ العائِشة حتَّى الآن وفي حال تزعزُع” (الصفحة 60). والمُؤلِّفُ إذ يُميِّزُ في هذا الإطار بينَ “الذات المُترجَمة” الخاضِعة لتفوُّق الآخَر الغربي، والذات العالميّة الثريّة بآخِر إنجازات الفكر العالمي، والتي تُفكِّرُ انطلاقاً من هذه الإنجازات (انظر الصفحة 64)، يَحمي قراءَتَهُ هذه _ومن حيث المبدأ_ من شُبهَةِ الرَّدّ الانفعالي على التَّمركُز الغربي بتمركُز عربي مُقابِل، وإنْ كانَ يرى في افتتاحيته أنَّ أحد أهَمّ سِمات “ولادة الذات العربية” تكمنُ في مُقاوَمَتِها للمركزية الغربية في صيغتِها المُعاصِرة؛ أي بوصف “العودة إلى الذات مُواجَهة مصيريّة معَ العقل _ التِّقنيّ الرَّأسماليّ، معَ العقل المصرفيّ _ العولميّ” (الصفحة 19)، وأعتقِدُ أنَّ هذا التَّوجُّه يُعزِّزُ السِّمة الكونيّة المَرجوّة لحُضور الذات العربية، لا السِّمة المركزيّة، ولهذا يجِدُ الدُّكتور برقاوي أنَّ أصل الإشكاليّة _عربياً وغربياً_ يرتبطُ بالعلاقة بينَ “الذات والاعتراف”، وفي نزعة العداء للاختلاف، والتَّقويم الإيجابيّ للتَّشابُه ضدَّ الاختلاف (انظر الصفحة 92)، فالذات، وجودٌ (مُعترَفٌ به) و(مُعترِفٌ بـِ)، قائِمٌ في علاقات اعتراف هيَ وعيٌ بالآخَر، ووعيٌ بالذات الأُخرى يُحدِّدُ العلاقة بها والموقف منها (انظر من الصفحة 79 حتَّى الصفحة 83).
غير أنَّ هذا الاعتراف ينبغي أنْ يكونَ مُتبادَلاً، وألّا يقومَ على الإخضاع والتَّسلُّط، فـَ “الاعتراف المُتبادَل بين الذّوات يُحوِّلُ الذات _ الآخَرَ إلى عاملِ أمانٍ وليسَ إلى خطَر. ولا يَظهَرُ الخطَر إلّا في حال سلب الاعتراف” (الصفحة 85)، وهذا ما يُفضي باعتقادي إلى مُجاوَزة المركزيات الجوهرانيّة التَّسلُّطيّة، ويمنَعُ إعادةَ إنتاج ثُنائيّات ميتافيزيقيّة مُتناقضة ومُتناحِرة، ويكشفُ عن منطق وجوديّ حيويّ يقومُ على المصالح البشرية المُتبادَلة، والنّاهِضة على بداهات الحياة والعدل والحُرِّيّة.
لعلَّ الخلَل الأساسيّ في “المركزية الغربية” بما هيَ مركزية نظَّمَتِ الذّوات السُّلطانيّة ديمقراطيّاً، وفي الوقت نفسه مارَسَتْ عُنصريتَها على المُستعمَرين بوصفهم آخَرينَ يَفتقِدونَ للأهليّة الوجوديّة الحُرّة، يتعلَّقُ هذا الخلل في اعتقادي في عدم مُجاوَزة الغرب فعليّاً لـِ (ميتافيزيقا الحُضور)، فهوَ ما زال في نظريّاته وآليّاتِهِ العمَلانيّة وفيّاً لمركزية الذات التِّقنيّة الأداتيّة المُتحكِّمة بالطبيعة والعالم والآخَرين؛ أي بوصفها ذاتاً واحديّة مُغلَقة ومُتعالية، مُنسجِمة ومُتجانِسة، وقادِرة على تمثُّل الوجود والمَوجودات وإحضارِها أمام العقل الغربي المُتعقِّل، وإخضاعِها له ولمنظوماتِهِ الإيديولوجية والعمَلانيّة! وهذا أسّ كارثة الفُصام الغربي الذي يدَّعي التفوُّقَ على الاستبداد المَشرقيّ ببسطِ استبدادٍ من نمَطٍ آخَر، استبداد يقوم على ترسيخ وعي دائِم بفكرة “المُخلِّص” و”الذات الرَّسوليّة” كما يدعوها الدُّكتور برقاوي (انظر الصفحة 168)، فـَ “المُخلِّص _ الذات _ المركز المُعلِّم هوَ خِطاب يحوز القداسة” (الصفحة 175)، ويكون لديه أتباعُهُ أو ذواتُهُ السَّيّارة في مَدارِهِ، ذلكَ أنَّ المطلوب من (الآخَر _الأدنى منزلةً) أنْ يستمرَّ في الدَّوران بوصفِهِ تابِعاً في هذا المدار، وهيَ القضية التي تعني أنَّ الغرب يُولِّدُ استبداداً مُوازِياً للاستبداد المَشرقيّ، أو مُتقاطِعاً معَهُ بمَعنىً من المَعاني عبر مُمارَسة دور المُخلِّص الاستعماريّ.
إنَّ ما سبَقَ يدعوني إلى الإشارة إلى مَسألتين: أوَّلهُما أنَّ هذا الغرب المُتعالي لطالما سعى سعياً دؤوباً في سياساتِهِ ومَراكِز قرارِهِ إلى دعم سياسات الهُوِيّة الاستبدادية المركزية في المَشرق وفيما يدعوه العالم الثالث من ناحية أُولى، وثاني المَسألتين يكمنُ في وجوب أنْ نُميِّزَ بينَ سياسات الوَحدة المركزيّة للذات الغربية بوصفها تُلحِقُ (أو تسحَق) الآخَرَ المُختلِفَ والضَّعيفَ بها، ورُؤى بعض الفلاسفة الغربيِّين الحديثين والمُعاصِرين الذينَ حاوَلوا تفكيك تلكَ المركزيّة، ونظَّروا لتمزُّق الذات وتشتُّتِها، ذلكَ أنَّ تسلُّلَ الاختلاف إلى داخِلِ الذات ليُفتِّتَ وَحدَتَها المُغلَقة والمُتعالية، وليحتفِيَ بالتنوُّع والتَّعدُّد والتباعُدات الوجودية، ظلَّ في خطاب الإيديولوجيا الغربية وتطبيقاتِها خاصّاً بالفرد الغربي وبمُجتمعاتِهِ وما تنطوي عليه من مُستويات وقائعيّة، ولهذا لم يكفّ الغرب عن بثِّ (حقائقِهِ المُطلَقة)، وفرضِها من الأعلى إلى الأدنى. وما يزيد من سُخريّة الأمر هوَ توظيف هذا المَنحى السياسيّ لنظريّات ما بعدَ الحداثة نفسها ومَقولات مثل (النِّسبيّة المُطلَقة) لتأكيد مركزيَّتِهِ المُهيمِنة والاستغلاليّة التي تُدافِعُ بضَراوةٍ شديدة عن سياساتِهِ الاستعمارية، ولذلكَ أقولُ إنَّ التَّهافُتَ المركزيَّ الغربيَّ، وفي مُقابلِهِ التَّهافُت النرجسيّ الدّونيّ والجريح بما هوَ ردّة فعل تتمترَسُ حولَ (مركزيّة عربية) مُواجِهَة للآخَر الغربي؛ هوَ تهافتٌ ينهَلُ في الحاليْن من المَنبع الميتافيزيقي نفسه، مُتمثِّلاً بالتَّوضُّع في ثنائيات تقابُليّة مُتناحِرة تُعمِّمُ (الحقائق المُسَبَّقة والمُطلَقة)، وهيَ الحقائق التي لطالما كانت طارِدةً لديمقراطية الاعتراف والتَّعدُّد والاختلاف، وهذا ما يتعرَّى ويتفكَّك تلقائيّاً؛ وذلكَ عبرَ انقضاض كُلّ طرَف من الحدَّيْن المُتناحِريْن أو المُتفاصِليْن على مركزيّة الآخَر، ليُفتِّتَها من داخِلِها، ويُبعثِرَ وَحدَتَها الزائفة واستقرارَها المَوهوم، ويكشف عبر استراتيجية الاختلاف، وحركيّة الصيرورة، أكاذيب البِنى الهُوِيّاتيّة المُنسجِمة التي يُبنَى عليها خِطابُ الصراع الحضاري ونفي الغيريّة وتناسي الخصوصيات، ولا سيما في عصرٍ مُتراكِب مَعرفياً وثقافياً واقتصادياً كعصرِنا هذا.
يُقدِّمُ الدُّكتور برقاوي اقتراحاً لافتاً يدعو فيه إلى نقل “الحقيقة” من حقلِها المعرفيّ إلى حقلها الأنطولوجيّ (انظر الصفحة 119)، وذلكَ لأنَّ “الحقيقة ليست مجرّد اعتقاد أو تعيين فحسب، وإنَّما حالة وجود للذات، وصِلَة تواصُل بين الذّوات أيضاً” (الصفحة 119)، ويُطلِقُ على هذه الرؤية مُصطلَحَ “الحقيقة التَّواصُليّة” (الصفحة 120)، مُعتقِداً أنَّ هذه الحقيقة بقدر ما تنطوي على الاختلاف والصِّراع والتَّناقُض، تُوَظَّفُ أيضاً لصالح ترسيخ مركزيات السُّلطات المُتنوِّعة (انظر الصفحتين 121_122)، ولذلكَ يُفنِّدُ وجهةَ نظَر “هابرماس” الذي يُقدِّمُ التَّواصُلَ بوصفه “مشروعاً للإنسانية قائِماً على الأخلاق والقانون واللغة، من أجل التَّفاهُم المُشترَك ضدَّ عُنف المُنازَعات، ولم ينتبِهْ إلى أنَّ التَّواصُلَ بينَ الذّوات، سواء أكان تواصُلاً أخلاقياً أم سياسياً أم مَشاعرياً، إنَّما يقومُ على الاعتقاد، الاعتقاد بأنَّ هذا الخزّان مليء بالحقائِق المُتغيِّرة دائماً، بل إنَّ الدفاع عن الحداثة باعتبارِها مشروعاً لم يكتمِلْ، هوَ دفاعٌ عن حزمة من الأحكام الحداثوية، الحقائِق الحداثوية التي يُريدُ لها هابرماس أنْ تكونَ أساساً دائماً للتَّواصُل” (الصفحة 127).
وهُنا ينبغي أنْ أُشيرَ إلى مُلاحَظتين أيضاً: أوَّلهُما تُؤكِّد أنَّ “الحقيقة التَّواصُليّة” التي يقول بها الدُّكتور برقاوي، والتي تتقاطَع معَ “تواصُليّة هابرماس” وتنتقدُها في الوقت نفسه، تُبيِّنُ الحاجة المُلحَّة لمُجاوَزة المركزيات الغربية التي ناقشتُها في الصفحات السابقة، ولا سيما بوصفها تتمحور وتحتفي بعقلانية العلم والتقنيّة، أو بما يُصطَلَحُ عليه بـِ “العقل الأداتيّ” الذي اختزَلَ الوجود وصادَرَهُ عبرَ نزعة علميّة نفعيّة أداتيّة تُثبِتُ أنَّ “الحقيقة التَّواصُليّة” _وكما ذهَبَ المُؤلِّف في هذا الإطار_ غير مُتحرِّرة تماماً من خطر إعادة توظيف خزّانِها الاعتقاديّ لصالح إعلاء مركزية التسلُّط السُّلطانيّ، ولهذا أرى في مُلاحَظتي الثانية أنَّ من شروط الانتقال بـِ “الحقيقة التَّواصُليّة” من تعميم المركزية إلى توليد الاختلاف أنْ ننظُرَ إلى الحقل الأنطولوجيّ بوصفه أساليبَ وجودٍ بصَرية مُتنوِّعة ومُتحرِّكة خارج أيَّة جوهرانيّة ثابتة، وأنْ نختبِرَ _وفقَ اعتقادي_ أيَّةَ حقيقة تواصُليّة بما هيَ مُنطوية على حدَث أو فعل، في سِياق ظاهري للتَّجريب والإثبات يتجاوَزُ أيَّةَ إعادةٍ لتوضُّعٍ تقابُليٍّ ميتافيزيقيٍّ لثنائية (الحقيقة _اللّاحقيقة)، من دون أنْ يعنيَ هذا الاقتراحُ أنَّنا نحتفي بالنسبيّة المُطلَقة، بقدر ما يعني أنَّنا نحتفي بالنسبية الاحتمالية المَفتوحة نحوَ مُمكنات وجوديّة ثرّة.
إنَّ الذات حسب المُؤلِّف “تنتقِلُ (…) من هَمِّ بقائها البيولوجيّ إلى فائِضِ نشاط، يحملها على العمَل من أجل الحُضور” (الصفحة 34)، لكنَّ هذا الانتقال بوصفه “شهوة حُضور” (الصفحة 36)، يقودُ إلى احتلال مكانة داخِلَ الجماعة البشرية بما هوَ امتلاك لسُلطة ما، وكُلُّ سُلطة هيَ نمَطٌ من السَّيطرة (انظر الصفحة 36)، وهيَ عمَليّاً آليّةُ تَوُحُّدٍ معَ السَّيطرة الأداتيّة التي تُحوِّلُ الذات إلى ذاتٍ مُهيمِنة (انظر الصفحة 37)، فما هوَ الحلُّ لتفكيك هذه الإشكاليّة المُنتِجة باستمرار للتَّمركُز، والحامِلة في طبيعَتِها خطَرَ نفي الآخَر المُختلِف؟
إذا كانَ “سُؤال الكينونة ومَعنى الكينونة يفترضان بالضَّرورة سُؤالَ الفعل” (الصفحة 50)، فإنَّ النَّظَرَ إلى الذات أنطولوجيّاً هوَ تأسيسٌ لجعلِ هذه الذات حاضِرةً بوصفها ذاتاً فاعِلة ونقيضة للذات الخانِعة (انظر الصفحتين 14_15)، وهيَ خطوة ضروريّة لتحرير الذات من أَسْرِ الميتافيزيقا التي تحبسُها في زنزانة الهُوِيّة (انظر الصفحة 26)، فالذات الفاعِلة هيَ “الذات المُتأفِّفة” المُعتدَّة بذاتِها بحَظٍّ من الحُرِّيّة، والواعِية لما يُصَبُّ في خزّانِ وعيها، ولما يخرجُ منه ويُصرَفُ (انظر الصفحة 56)، على العكس من “الذات المُستعمَرة” التي يمتلِئُ خزّانُها مرَّةً واحِدة حتَّى نهاية العُمر، وتتعامَلُ معَ العالم وفقَ رؤية جامِدة بدَلاً من أنْ يكونَ خزّانُها دائم التَّصريف ودائم الاستقبال والتَّجدُّد (انظر الصفحتين 52_53). ولهذا لا ينشَأُ الفعلُ الكيانيُّ الأصيلُ إلّا إذا وُجِدَتْ هذه الذاتُ الفاعِلة المُتأفِّفة، والتي تشعرُ باستمرار بالخطَرِ الوجوديِّ، فتُحوِّلُ حياتَها بشجاعة إلى صراعٍ دائِمٍ من أجلِ الحُضور في قلب المُجازَفة (انظر الصفحة 306)، وهُنا تُواجِهُ هذه الذات المركزيات التَّسلُّطيّة أيّاً كانَ شكلُها (شيوعيّة _ رأسماليّة)، والتي تسلبُها مركزيتَها عبرَ تسليعِها، فتُحافِظُ على شُعورِها بالحُرِّيّة، وسعيِها إلى الانتصار على الخطَر (انظر الصفحة 312).
لكنْ: ألا يُؤكِّدُ هذا التَّوجُّهُ أنَّ المُؤلِّفَ يُعيدُ إنتاجَ التَّمركُز الذاتيّ في مُواجَهة التَّمركُز الاستبداديّ، ويُسوِّغُ للذات المُتأفِّفة عبرَ شهوة حُضورِها نفيَها الآخَرَ أو نفيَها الاختلافَ معَ ذلكَ الآخَر؟
للإجابة عن هذا السؤال المحوري في هذا الكتاب، لابُدَّ أنْ نُقارِبَ التَّعريفَ الذي يبسطُهُ الدُّكتور برقاوي للذات، فهيَ “الأنا الذي خرَجَ إلى العالم ليُعيدَ تشكيلَهُ من جديدٍ، والعالمُ بدورِهِ صارَ هوَ الذات في فاعليَّتِها” (الصفحة 30)، ذلكَ أنَّ “الذات كُلِّيّة، وجود، ولهذا فهيَ موضوعٌ أنطولوجيّ. وحدها الذات تعي ذاتَها على أنَّها مُنتمِية إلى الأنطولوجيا” (الصفحة 42)، وهذا الوجود الكُلِّيّ للذات هو برأي المُؤلِّف الوجود الوحيد بوصفها مركز العالم والعالم معاً، فاستعادةُ الذات هيَ برأيِهِ استعادة وَحدة الوجود الإنسانيّة (انظر الصفحة 16)، وهذه الوَحدة تعني أنَّ الذات تتعيَّنُ بوصفِها وجوداً مُطلَقاً، وتنطوي، وتخلقُ إمكانات لا تنفد أبداً، فالإمكانيّة التي لا يُستنفدُ تحقُّقها مدى العُمر هيَ إمكانيّة لا تتحقَّق (انظر الصفحتين 38_39). وبناءً على ذلكَ يغدو “الموضوع” جزءاً لا يتجزَّأُ من الذات، ولا يعودُ خارجيّاً؛ إنَّما هوَ وعيٌ ما للذات بوجودِها، وإذا كفَّ عن ذلكَ، عادَ إلى عالمه المُستقلّ عنها بالإطلاق (انظر الصفحتين 50_51)، ومَعنى هذا الاعتقاد أنَّ الموضوع لا يكونُ جزءاً من الذات إلّا بالفعل والعمَل (انظر الصفحة 31)، ومن جديد أتساءَلُ: هل يُعيدُنا هذا التَّفنيد إلى مركزيّة ذاتيّة مُتعالية ومُتحكِّمة بالموضوع الذي تتمثَّلُهُ وتُخضعُهُ لوعيها؛ أي هل يُعيدُنا هذا التَّفنيد إلى ميتافيزيقا الحُضور؟
لا يُلغي الدُّكتور برقاوي الوعي المركزي بتاتاً، لكنَّهُ يُعيِّنُهُ في قلب الموضوع، ويُؤسِّسُ صلةَ الذات مع الموضوع على الانفتاح بوصفه وعياً للذات، وهذا لا يعني أنَّ جميعَ الذّوات المُنفتِحة هيَ واحِدة ومُتشابِهة، بل يختلف الوعي بينَ الذوات المُختلِفة (انظر الصفحة 33)؛ ذلكَ أنَّ “الوعي هوَ المَعيش الدّائِم والمُتنوِّع. ولأنَّ الذات وجودٌ مَعيشٌ دائماً، فهيَ وجودٌ واعٍ دائماً” (الصفحة 41)، ووَحدة الذات بوصفها مركزَ العالم والعالم في آنٍ معاً “لا تفيضُ إلّا عن الاختلاف تناقُضاً، تضادّاً، أو تمايُزاً” (الصفحة 17)، فـَ “الذات إمكانيّة دائمة، إذاً الذات إمكانيّة اختلاف دائمة، اختلاف داخِلَ الذات، واختلاف عن الذات الأخرى” (الصفحة 92)، و”الاختلاف هوَ الاعتراف بالذات بلا هُوِيّة. الذات التي تختلف عن نفسها دائماً وعن الآخَر، وتُعبِّرُ عن هذا الاختلاف في حقل الحُرِّيّة، الحُرِّيّة بارتباط بالاعتراف بالذات” (الصفحة 96).
وهُنا يُلِحُّ أكثر السُّؤال عند القارئ المُتمعِّن الذي _قد_ يشعرُ بتناقضٍ ينطوي عليه التَّوضُّع السابق: أي الاعتراف باختلاف الذات من ناحيةٍ أُولى، والمُحافَظة على نمَطٍ من مركزيتِها الواعية من ناحيةٍ ثانية؟
تفسيرُ هذه الإشكاليّة تفسيراً حاسِماً يُقدِّمُهُ الدُّكتور برقاوي في سِياق نقدِهِ لفلاسفة الاختلاف (فوكو، دريدا، دولوز) الذينَ “راحوا يُمَجِّدونَ الاختلاف ضدَّ الوَحدة، ضدَّ الشُّموليّة، ولم يلتفِتوا إلى تحوُّلات الذات نفسها. لا تفلتُ الذات من صاحبِها فحسب، بل تفلتُ أيضاً من الآخَر. إنَّهُ يُؤكِّدُ أنَّ الآخَرَ مُختلِفٌ عنِّي أو أنِّي مُختلِفٌ عنهُ، فهذا لا يعني أبداً بعد أنَّ هُناكَ اعترافاً باختلاف الذات الداخليّ. صحيحٌ أنَّ الرَّغبة في إيجادِ التَّشابُهِ وعيٌ شُموليٌّ استبداديٌّ لكُلِّ سُلطةٍ غاشِمة أو غير غاشِمة، لكن رفض الذات بوصفها وجوداً مُتحوِّلاً، هوَ الآخَر، نوعٌ من القمع الشُّموليّ” (الصفحة 242)، وتتضِحُ الصورةُ أكثَرَ عندما يقول: ” ولا يحسبنَّ أحَدٌ أنَّ القولَ بالاختلاف داخِلَ الذات ينفي وعي الذات بذاتِها باعتبارِها هيَ هيَ، إنَّها هيَ هيَ التي تعِي ذاتَها في تحوُّلاتِها، إنَّها في كُلِّ لحظةٍ هيَ هيَ، وهذا وعيٌ مُستمرٌّ لا يعودُ إلى التَّذكُّرِ، بل إلى استمرار الوجود المُتحوِّل ووعي هذا الاستمرار” (الصفحتان 242_243).
وهكذا، يغدو “الوعي” عند المُؤلِّف مُتحرِّكاً ومُتحوِّلاً ومُختلِفاً بتحرُّك وتحوُّل واختلاف وجود الذات في العالم، أو بتحرُّك وَحدة الذات والعالم المركزية، وهوَ فَهْمٌ لا ينفصِلُ لديه عن “الرَّغبة المُستحيلة” (الصفحة 205)، النّاجِمة عن إحساس الذات بالشُّحّ في الإشباع، لتكون رغبتُها المُستحيلة هيَ ثمرة تأفُّفِها إلى الحدّ المُطلَق، كرغبة الذات المُستحيلة في وجود العالم بلا شرّ (انظر الصفحة 206). ولهذا يُعرِّفُ المُؤلِّفُ هذه الرَّغبة بأنَّها “الذات في المُستقبَل” (الصفحة 206)؛ أي بوصفها دافعيّة التَّحرُّك والتَّحوُّل والاختلاف التي تبلغُ ذروتَها عند المُبدعين الذينَ يتعيَّنُ وجودُهُم في أعمالِهِم الإبداعيّة بوصفه “وعياً بالحُضور المُطلَق” (الصفحة 194)، حيث إنَّ “الخَلْق الفنِّي انتصار مُطلَق للذات” (الصفحة 196). وإذا كانَ المُؤلِّف يرى أنَّ ذات المُبدِع تعتقِدُ نفسَها مركزَ الدُّنيا بلا مُنازِع (انظر الصفحة 199)، وأنَّ هذه الذات تقومُ على مركزية مُهيمِنة تظهَرُ في النَّفي المُتبادَل بينَ الذّوات المُبدِعة، حتَّى يبدو الإبداع بلا جَدوى من دون هيمنة، ومن دون آخَر (انظر الصفحة 203)، فإنَّني إذ أوافِقُ الدُّكتور برقاوي على أنَّ المُبدِع المُهيمِن هوَ (ذات _ مركز) من حيث المَبدأ الشعوريّ، أُشيرُ في الوقت نفسه إلى أنَّني قد دعوْتُ في أكثر من نصّ مَنشور لي سابِقاً (مثل بَياني الشعري المُعنوَن بالإعلان التَّخارُجيّ والمَنشور أوّل مرّة عام 2015) إلى التَّمييز بينَ (ذات المُبدِع في عالمها الوقائعيّ)، و(الذات المُبدِعة في عالمها الإبداعيّ)، أو: إلى إجراء (فصم) عمَلانيّ لا فعليّ لتحرير العالم الإبداعيّ من سَطوة مركزية ذات المُبدِع؛ ولا سيما أنَّني أرى أنَّ لحظة الإبداع هيَ لحظة انفتاح وحُضور مُطلَق ليسَ بوصفه حُضوراً في التَّمركُز والوَحدة والتَّعيُّن، إنَّما بوصفه حُضوراً في التشظِّي والتَّبعثُر والاختلاف الذي ينطوي عليه الفعل الإبداعيّ بما هوَ فعل تشتُّت مُستمرّ، حيث تتعرَّضُ ذاتُ المُبدِع المركزيّة في لحظات الإبداع إلى هُجومٍ من صلب طبيعة ديناميات الإبداع بما هيَ ديناميات تبثُّ قوى اختلافيّة تُفتِّت ذات المُبدِع بمُسَبَّقاتِها المُستقرّة والمُتعالية، بمعنى أنَّ وعيَ ذات المُبدِع يتعرَّض إلى آليّات تبعثُر بوصف الإبداع حركيّة تحوُّلات مُتراكِبة في طبقاتٍ مُتعدِّدة، ولعمري لا أظنُّ أنَّ أحَداً كـَ “المُبدِع _ المَركز” يُعاني من هول التَّشظِّي والمُغايَرة والتَّباعُد وتمزُّق الوعي في عالمه الإبداعيّ، ولا أحَد يصِلُ إلى ما يصِلُ إليه من شُعورٍ باللُّهاث والتَّسارُع داخِلَ فَجوة الإبداع، ومن رغبة أنويّة مركزيّة بالدِّفاع عن سُلطتِهِ المُطلَقة على العمَل الإبداعيّ تتجلَّى بالانهمام بتمكين هذه السُّلطة المُتفلِّتة منه في العالم الجديد المَخلوق، ومن صراعٍ عُنفيٍّ معَ قوى التَّحوُّل والاختلاف الذي يجعل (أي هذا الصراع) في أحيانٍ كثيرة مِنَ العناصِر القَبْليّة القائِمة على نفي الذّوات المُبدِعة الأُخرى هيَ نفسها عناصِر اختراق لوَحدته المركزيّة _ الإبداعيّة، وخَلخلةً مُستمرَّةً لها، ومَفتوحةً إلى ما لا نهاية، ولهذا يكونُ فعل (فصم الذات) الذي أقترحُهُ في الفعل الإبداعيّ هوَ تعميق لآليّة حِماية العمَل الإبداعيّ، وتحجيم لتغوُّل سُلطة الذات المُسَبَّقة التي إنْ تمكَّنَتْ من طيِّ العالم الإبداعيّ على مركزيتِها طيّاً واسِعاً إلى حدّ كبير، تكونُ _في اعتقادي_ قد أساءَتْ إلى روح هذا العالم وأصالتِهِ الوجوديّة الإبداعيّة.
لعلَّ هذا التَّوجُّه يصحُّ باعتقادي على فكرة “قتل الأب” أيضاً، والتي يتناولُها الدُّكتور برقاوي مُطوَّلاً في كتابه هذا (انظر من الصفحة 209 حتَّى الصفحة 229)، فهيَ بقدر ما تبدو عمَليّاً تحوُّلاً للمُبدِع القاتِل إلى “أب _ مركز” جديد يحلُّ محلَّ “الأب _ المركز” السابق، تُؤكِّدُ مدى النُّخور والتَّفتيت الذي يُمارِسُهُ حُضور آباء المُبدعين على تمركُزات هؤلاء المُبدعين الذين لا ينفكُّوا يَشعرونَ بتهديد التَّشابُه والتِّكرار لخُصوصية ذواتِهِم المُبدِعة، ليكونَ هذا الصِّراع القاسي مع الآباء هوَ بدورِهِ صراعَ تشظٍّ واختراق مُتحرِّك ودائِم للمركز الجديد الذي يظنُّ أنَّهُ أنجَزَ جريمةَ القتل الإبداعيّ الجميلة بنجاح، لنكتشِفَ دائماً _وربَّما تبعاً لتقنيّات النّقد ولا سيما تقنيّات التَّناصّ_ أنَّ ثمَّةَ فَجواتٍ شاسِعة ما زالَتْ تفعَلُ فعْلَها في ذات المُبدِع، وتُخلخِلُ وَحدَتَها المركزيّة بتقاطُعاتٍ كثيرة غير مُتوقَّعة.
وفي مَنحى مُكَمِّل، يرى الدُّكتور برقاوي أنَّ الذات المُبدِعة هيَ “ميتا_ذات” لكونها تمنَحُ الوجودَ تجاوُزَهُ (انظر الصفحة 261)، وبهذا المَعنى لا يَستوي منطقيّاً برأيي أنْ نتحدَّثَ عن “ذاتٍ مُبدِعة مركزيّة”، وفي الوقت نفسه أنْ نُعرِّفَ الميتا_ذات بأنَّها “الذات التي تحرَّرَتْ من المألوف، المُختلِفة عن المألوف، المُتجاوِزَة للمألوف، التَّحرُّر والاختلاف والتَّجاوُز يعني حُضور الذات (…)، وهذه الميتا_ذات تُعيدُ تشكيلَ الوجود بوصفه وجود الذات الحاضِرة المُقاوِمة للعدَم الطبيعي عبر الوجود الروحي” (الصفحة 262)؛ إذ إنَّ هذا الوجود الإبداعيّ الجديد بوصفه انفتاح فَجوة (ميتا_وجود الذات المُبدِعة) في عالمها الإبداعي المُغايِر، لن ينفكَّ عن توسيع الهُوَّة بينَ ما دعوتُهُ (ذات المُبدِع في عالمها الوقائعيّ)، بوصفها من حيث المبدأ “ذاتاً مُبدِعة مركزيّة” و(الذات المُبدِعة في عالمها الإبداعيّ)، بوصفها الذات الجديدة التي تحرَّرَتْ من المألوف، واختلفَتْ عنهُ، وتجاوَزَتْهُ وفق تعبير المُؤلِّف.
إنَّ علاقة ذات المُبدِع مع عمَلِه الإبداعيّ مسألة مُركَّبة ومُتراكِبة في آنٍ معاً، وتحتاجُ إلى بحثٍ مُستفيضٍ ليسَ مكانه هُنا، لكنْ _وفي جميع الأحوال_ أُشيرُ إلى رفض الدُّكتور برقاوي قضيّة “موت المُؤلِّف” _ضِمنيّاً_ في حديثِهِ عن الذات والتأويل، فها هوَ ذا يقول: “فيما فيضُ الذات هوَ الذات نفسها، وقد صارَتْ في الخارِج، لكنَّ هذا الذي صارَ نصّاً ولوحة يظلُّ مُنتمياً إلى الذات، إنَّهُ أشبه بوشمٍ أو ختمٍ طبيعيٍّ يَستحيلُ مَحوهُما عن جسَدِ الذات المُبدِعة. هاهيَ الذات وقد أصبَحَتْ حقلاً للتجوال من قِبَلِ الآخَرِ، أو هيَ في تجوالٍ دائِمٍ في ذواتِ الآخَرينَ _ لافرق” (الصفحة 274)، ويبدو لي أنَّ هذا الرأي يُعيدُني من جديد إلى فكرة أنَّ “الذات المركزية المُبدِعة” مَسكونة بالاختلاف مهما توهَّمَتْ التَّماسُكَ والاستقرار، فقدَرُ المُبدِع الانفتاحَ على الآخَرين _ذواتاً مُبدِعة أو مُتلقِّينَ_، ذلكَ أنَّ من طبيعةِ الإبداع الأصيلة خَلْقُ عالمٍ جديد يُفلِتُ إلى حدٍّ بعيد من يدِ ذلكَ المُبدِع، مُلتقِياً معَ المُؤلِّف في عدمِ القول بموتِهِ على كُلِّ حال.
وفي هذا المِضمار، ينتقِدُ الدُّكتور برقاوي رُؤى “التَّأويليّة المُعاصِرة” و”نظَريّات التَّلقِّي” التي ترى أنَّ العلاقة بينَ النَّصّ والمُؤوِّل هيَ علاقة حوار، “لأنَّ الحوار يقوم بينَ طرفيْن يتبادَلان الآراء، فيما التأويل هوَ طريق يتجوَّلُ في النَّصّ، يغوصُ في أعماقِهِ من دون توجيه من النَّصّ نفسه حتَّى” (الصفحة 290)؛ فالنَّص كما يذهبُ المُؤلِّفُ لا يعترِضُ “على المُؤوِّل، ولا يُعلِنُ عن رأيِهِ للمُؤوِّل، ولا يختلِفُ معَ المُؤوِّل. وإذا كانَ الأمرُ هكذا، فأينَ هوَ الحوار إذاً؟” (الصفحة 290)، و”المُؤوِّلُ ذاتٌ تقتحِمُ النَّصَّ _ تقتحِمُ ذاتاً هيَ في الأَسْرِ، ذات أَسَرَتْ نفسَها في النَّصّ، من دون أنْ تقومَ بأي ردّ فعل على هذا الاقتحام” (الصفحة 290)، ومن المُؤكَّد أنَّ أدبيّات التَّأويليّة ونظريّات التَّلقِّي تُقدِّمُ الكثيرَ من الرُّدود على هذا الرّأي الجدَليّ، والذي يُؤكِّدُ من زاويةٍ غير مُباشَرة حتميّة التَّحوُّل الذي يعتري ذات المُبدِع الوقائعيّة وهيَ تصيرُ ذاتاً مُبدِعة في عالمها الإبداعيّ حسبَ تمييزنا المُشار إليه من قبل، وأنَّ هذا التَّحوُّل نفسه هوَ ما ينطوي على فَراغات وفَجوات وتغيُّرات تُبعثِرُ المَراكِزَ المُسَبَّقة، وتفتتِحُ مَسافات الاختلاف التي تسمَحُ للمُؤوِّل أنْ يتسلَّلَ إلى عوالم النَّصّ، ويقومَ باستنطاقِها على نحوٍ ما.
ما من شكّ أنَّ المُفكِّر الدُّكتور أحمَد برقاوي في كتابِهِ هذا يطرحُ جُملةً من الأسئلةِ المَصيريّة والكيانيّة التي لا تقبَلُ الإرجاء، وتتطلَّبُ تعامُلاً مَعرفيّاً مَسؤولاً مع قضايا مُلحَّة كادَ يطويها نسيانُ العرب ليسَ فقط لوجودِهِم الأصيل في العالم؛ إنَّما نسيانهم أيضاً _وبفعل القنوط المُتحكِّم بواقعِهِم_ أنْ يُقلِّبوا وجودَهُم الحالي كي يجِدوا حُلولاً نهضويّة ما، وأنْ يُقارِبوا الذاتَ مُقارَبةً تفحُّصيّة بحثاً عن اقتراحات تُعيدُ لها شيئاً من زخَم الحُلم بالولادة والعودة إلى التاريخ، أو تضعُها على الأقلّ في طريق هذه العودة. وهوَ الأمر الذي عمِلَ عليه الدُّكتور برقاوي هُنا، مُتسلِّحاً بالرؤية الثاقِبة، والروح الحُرَّة المُتفرِّدة في طُروحاتِها، والشُّعور بالنِّديّة تجاه الآخَر الغربيّ حسبما اقتضَتِ ضرورة الخوض في المُصطلحات والمَفاهيم المُختلِفة، وهذا ما بدا جليّاً إنْ في مُحاوراتِهِ مع قضايا الذات الفلسفيّة بينَ التَّمركُز والاختلاف، أو حتَّى في مُحاوَراتِهِ الخاصّة بالذات المُبدِعة وعلاقة التأويل بها.
دمشق في تمّوز 2016.
شاعر وناقد سوري





