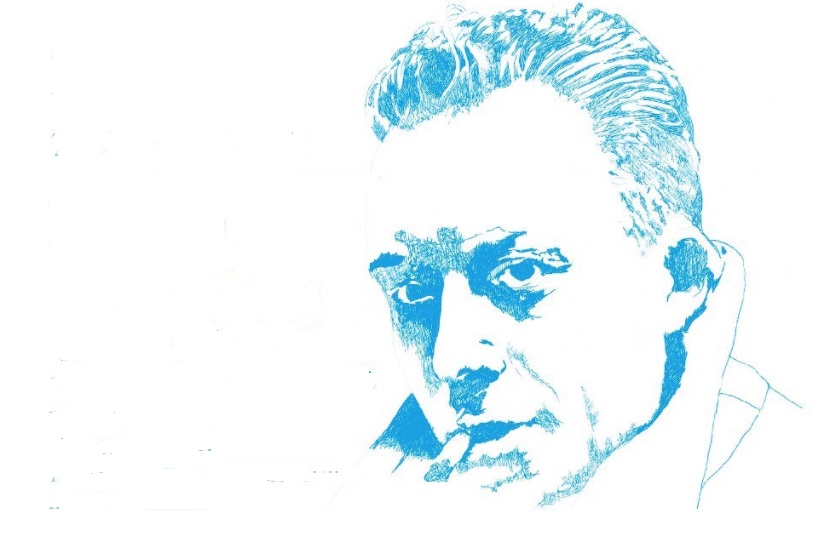إلى أين تذهب الولايات المتحدة الأميركية؟/ ناصر الرباط

جئت إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل ست وثلاثين سنة. لم أكن مأخوذاً بما عرفته عن الثقافة الأميركية التي نشأت على ابتلاع أراضي السكان الأصليين للبلاد قبل أن تغزو العالم، أحياناً بطرق استعمارية. بل كنت واعياً لجرائمها داخلياً وخارجياً وتغلغلها في النسيج الاقتصادي الدولي وسيطرتها على مقدرات الأمور في كثير من البلدان الضعيفة. فأنا كنت قرأت نقد عدد من الكتاب الأوروبيين الاشتراكيي الاتجاه مثل جورج برنارد شو وريجيس دوبريه وتأثرت به. ولكنني لم أكن أيضـاً أعمى عن المنجزات الثقافية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت الولايات المتحدة قد حققتها خلال سنوات عمرها القليـلة التي لم تتجاوز القرنين. ولم أكـــن جاهلاً بالمبادئ الإنسانية التي تضمنها الدستور الأميركي قبل أي من الوثائق المشابهة، أو بالديموقراطية الصغيرة التي تؤطر الحياة السياسية الأميركية على مستوى البلدة والمدينة. كنت أيضاً متفائلاً بما حققته ثورة الشباب في نهاية الستينات من تحرر اجتماعي وجندري وجنسي وموسيقي، وفي الضغط على الحكومة الأميركية لإيقاف نزيف الدم المستمر في الحرب الطائشة في فيتنام. كنت فوق ذلك كله مستعداً، بل راغباً، في الاندماج بالحياة الأميركية المتحررة التي استهوتني في بداية شبابي في دمشق في شكل رئيسي، عبر الموسيقى والأدب والعمارة والأفلام التي كانت تصلنا بالقطارة.
وصلت إلى البلاد في بداية عهد رونالد ريغان، الرئيس الممثل والعجوز المحافظ مالياً الذي قاد حملة لتغيير الوضع الاقتصادي في أميركا لمصلحة ما أطلق عليه «اقتصاد جانب العرض» الذي يعطي الأولوية لرأس المال في إدارة الاقتصاد على حساب العمل أو الحكومة. هذا التوجه الحكومي أطلق عدة قـــوى محافظة من عقالها الذي فرضته عليها إنجازات منتـــصف القرن العشرين ابتداءً من «الصفقة الجديدة» التي أقرها الرئيس فرانكلين روزفلت في بداية رئاسته عام 1932 لإنعاش الاقتصاد والمجتمع ولمواجهة الأضرار الجسيمة التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية، إلى تشريعات الرئيس ليندون جونسون عام 1964 المسماة تشريعات «المجتمع العظيم» لدعم الحقوق المدنية وتحقيق العدالة الاقتصادية، إلى مارتن لوثر كينغ الابن ونضال حركة الحقوق المدنية لمكافحة العنصرية سلمياً، طبعاً إضافة إلى حركات الشباب الاحتجاجية ونضال الأفارقة – الأميركيين ضد التمييز، نهاية الستينات، والتي أثارت القوى المحافظة ودفعتها إلى تنظيم رد فعل مضاد.
بعد أن بدأ ريغان تحرير الاقتصاد الرأسمالي من رقابة أجهزة الدولة ومن التشريعات الهادفة إلى تقليم تغول رأس المال، تضافر الفكر النيو – ليبرالي مع الاتجاه المحافظ في السياسة الأميركية (ممثلاً في شكل رئيسي بالمحافظين الجدد في الحزب الجمهوري، ولكن أيضاً بالمؤسسات الكنسية العملاقة واليمين المسيحي المسيس والمتشدد) للسيطرة على السياسة والاقتصاد الأميركيين بطريقة سافرة. فقد سار جورج بوش الأب على نهج ريغان وتابعه في ذلك، بل زاد عليه ابنه المحافظ المتدين جورج دبليو بوش الذي أحاط نفسه بنخبة من الدعاة النيو – ليبراليين الذين استفادوا من الهلع الذي أصاب المجتمع الأميركي، إثر هجمات 11 أيلول (سبتمبر) لكي يمرروا أجندتهم الرامية إلى تخفيف الرقابة والضرائب على رأس المال مع التشدد في التعامل مع العالم من منطلق إمبريالي منتصر، بخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بداية التسعينات. ولم تغير رئاسة بيل كلينتون الديموقراطي الذي حكم بين عهدي بوش الأب والابن من هذا التوجه النيو – ليبرالي، بل ربما ساهمت باستمرارها نوعاً ما بإعطائها صبغة دعائية تقدمية، خصوصاً أنها كانت بمجملها رئاسة انتهازية تزامنت مع نهضة اقتصادية سببها الرئيسي تطور العالم الافتراضي والشركات التي تعمل عليه.
لم يقتصر التغلغل اليميني المحافظ على الأمور الاقتصادية والشؤون الخارجية، بل امتد إلى لب المجتمع الأميركي نفسه مستغلاً تراثاً متطاولاً من التشدد الديني والتمييز العنصري، لكي يعيد صوغه بحلل جديدة ركزت على الانفلات الأخلاقي المفترض وانعدام الأمن لكي يكسب الرأي العام الأبيض ولكي يسيطر في النهاية على أجهزة الحكم كلها في الولايات المتحدة، من الرئاسة إلى الكونغرس إلى المحكمة الدستورية العليا. وقد أدى وصول باراك أوباما إلى سدة الرئاسة عام 2009 إلى صدمة نفسية في صفوف المحافظين البيض الذين لم يهضموا فكرة رئيس أسود. وعلى رغم أن أوباما بان في النهاية استمراراً لتوجهات السياسة الأميركية العامة من دعم للرأسمالية داخلاً وخارجاً، وأنه كان مخيباً لآمال كثر منا من الليبراليين الذين انتخبوه لوعوده التقدمية، فإن فكرة وجوده في البيت الأبيض نفسه أثارت اليمين المحافظ لكي يضاعف جهوده لمنع تكرار هذه التجربة، مع أنها كانت صورة أكثر من كونها مضموناً.
هذا هو بتقديري السبب الأساسي لانتخاب من لم يكن من الممكن انتخابه كرئيس لأقوى دولة في العالم في شروط طبيعية: دونالد ترامب. لم يكن ذلك لأن سياساته مختلفة أو أفكاره متطرفة، بل لأنه بكل بساطة فالت اللسان والتصرف ومحرج لطبقته الحاكمة من الرأسماليين الذين يسيطرون على مقدرات البلاد. لكن اللحظة الصعبة، رمزياً في الأقل التي مر بها التحالف الرأسمالي النيو – ليبرالي واليمين المحافظ حتمت عليهم القبول بالرأسمالي الشعبوي لأنه تمكن من انتزاع تأييد الطبقة الوسطى البيضاء التي لم تتمكن حتى اليوم من تجاوز تخوفها من السود، ربما لإدراكها الضمني بفداحة الجريمة التي ارتكبها أجدادهم بحق هؤلاء الأفارقة الذين جُلبوا غصباً للعمل كعبيد في ظروف شديدة القسوة. هذا التراث ما زال ينخر في البنية الاجتماعية الأميركية على رغم الإنجازات التي حققها السود في مجال الحقوق المدنية والنهضة الاقتصادية.
لكن رئاسة ترامب تحقق أيضاً أشواطاً من التقدم باتجاه استكمال سيطرة رأس المال التامة على كل مناحي الاقتصاد والاجتماع في الولايات المتحدة. فقانون الضرائب الجديد الذي مرره الجمهوريون في آخر الليل، نهاية الأسبوع الماضي، يتوج الجهود التي بدأها ريغان لتمكين الطبقة الأوليغاركية الثرية من الحفاظ على مكاسبها كاملة على حساب الطبقات الأخرى، بل على حساب صحة الاقتصاد نفسه ودوام العقد الاجتماعي. هذا الاتجاه المنتصر اليوم يبشر، من وجهة نظري، بتضعضع متزايد في اللحمة الاجتماعية وقبول الطبقات الفقيرة بواقعها وبتغول متصاعد في الرأسمالية الكاسحة لكل ما يقف أمامها من أفراد وأفكار ومؤسسات ودول وتحالفات دولية، بل طبيعة وبيئة، كما نرى في انسحابات الولايات المتحدة المتتالية من اتفاقات دولية مختلفة. هذا هو المنحدر الخطر التي تنزلق فيه الولايات المتحدة، بينما العالم يراقب وجلاً، ولا جائزة نوبل للسلام جديدة تطمئنه.
* كاتب سوري، أستاذ العمارة في جامعة أم أي تي
الحياة