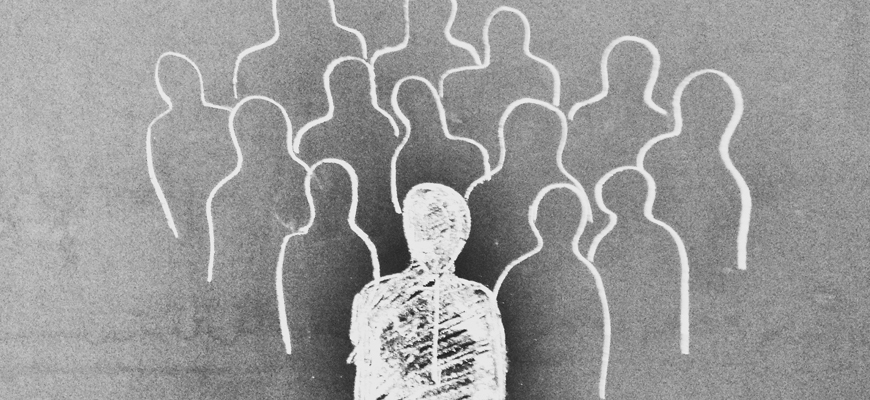الحلم حارس النوم والنوم أرض كنوزه/ عبده وازن

إنني شخص حالم. أحلم في الليل عندما أغمض عينيَّ، وفي أويقات الصباح الأولى حين يخطفني النعاس قبل أن أنهض متثاقلاً من الفراش، وفي هنيهات ما بعد الظهيرة، لمّا يحلّ بي الوسن الشفيف الذي يغدو كأنه نومٌ ويقظة في آن واحد. لكنّ أحلام الليل تختلف عن أحلام النهار، ولو أمكنني أن أسمي أحلام النهار “أُحيلاماً” لسمّيتُها، وهي جمع “حُلَيم” أي الحلم مصغراً، كما يفيد النحو العربي. أما أحلام الليل فهي بروق تلمع في عمق الظلام وعلى مرتفعاته، في قلب الأزل الذي هو البدء والمنتهى، في أغوار النفس التي لا تخوم لها. لكنّ أحلام الليل والنهار غالباً ما تتلاقى في رأسي، أنا الحالم، فلا أجد من فروق بيّنة بينها، ما خلا أن احلام النهار تعبر بسرعة وغالباً ما تتلاشى في الهواء. أما أحلام الليل فتملك طقوسها وإيقاعها المتهادي حيناً والمتقطع حيناً، ومناخها الظليل ورهبتها التي تجعلني عاجزاً عن الخروج منها بسرعة. وقد أحتاج في أحيان الى دقائق لكي أخرج منها وألملم نفسي وأكون كمَن ينتقل من عالم الى آخر في حال من الاضطراب الخفيف.
كأنما الأحلام وُجدت لليل، الليل الغريب، الليل المنبسط حيناً مثل صحراء، والمتموّج مثل بحر يستعيد نفسه دوماً. أحلام الليل هي التي تمنح الليل معناه الملغز، غموضه وإشراقه الخفي. بل هي التي تضيء ما لا ينام فينا، الهناك والهنالك، الماوراء الذي هو الماقبل والمابعد. كأن لا ليل بلا أحلام، الليل هو ساعة يقظتها، ساعة يقظة الروح التي تظل مجهولة مهما قيل عنها. لا أقصد هنا ليل الشاعر القدّيس يوحنا الصليب أو ليل الشاعر نوفاليس، بل الليل الذي من أخلاط وأمزجة وأوهام وهواجس ورؤى وإشراقات تمتزج كلّها لتؤلف روح الليل وجسده. كنت في أحيان، من شدة طغيان الحلم عليّ، أقول لنفسي: إنني ذاهب لأحلم، عوض أن اقول إنني ذاهب لأنام. الحلم أمر شخصي، مثل الحب والحزن والسرور. عندما أحلم فإنما أنا الذي يحلم لا سواي. الليل يفتح كنوزه لي مثلما يفتحها لسواي. لكنّ الباب الذي ألج من عتبته مملكة الأحلام يختلف عن أبواب الآخرين. وفي الليل عندما أحلم أغدو كأنني أؤدي مونولوغاً أحدّث فيه نفسي وأروي لها حكايات غريبة وأرسم لها صوراً ومشاهد لم تخطر لي يوماً.
■■■
لا أذكر متى بدأتُ أحلم، لكنني أذكر، أنّ أمي كانت تقول لنا في طفولتنا، عندما نحلم أحلاماً بشعة، صلّوا الى العذراء مريم واطلبوا منها أن ترمي هذه الأحلام في البحر. كنا في صغرنا نخشى تلك الأحلام التي كان يقال عنها بشعة. ما كان أحد في الحي وبين الأقارب يسمّيها كوابيس مثلاً. بشعة كان يقال عنها فقط. وكنا عندما نسردها لأمي وجاراتها في أحيان، تتشاءم وتصرّ علينا أن نصلّي مرةً تلو مرة ونردد طلبنا الى مريم برمي تلك الأحلام في البحر، ولا سيما في الصباح. أما الأحلام البشعة فكانت في الغالب تدور حول الموت: أشخاص أبصرناهم يموتون في حوادث غريبة، غرقاً أو احتراقاً أو في انقلاب سيارة… كان بعضهم في الحي يفسّر موت الأشخاص في الحلم بكونه حياة جديدة مُنحت لهم. هذا التفسير كان شائعاً. لكنّ بضعة آخرين ما كانوا يأخذون بهذا “التفسير” وحجتهم أن أولاداً رأوا آباءهم ميتين في مناماتهم فماتوا. ولم يكونوا يعدّون مثل هذه المنامات مصادفات، بل كانوا يصرّون على أنها رسائل من الغيب الى الأهل من خلال صغارهم. كانت إحدى جاراتنا تقول: ألا تذكرون كيف رأى مارون، ابن جيراننا، في المنام، أباه ميتاً في ثلاث ليال متوالية، وكيف توفي أبو مارون بعد أسبوع؟ ولا تكتفي بحكاية مارون وأبيه بل تسرد أحلام آخرين وما أعقبها من حوادث جسيمة. كنا نخاف كثيراً أحلامنا ولا سيما اذا كانت عن الموت. المستغرب أن الأحلام ارتبطت دوماً بما تحمل من شؤم. لم يكن أحد يتحدث عن حلم جميل أبصره. أذكر كيف كانت خالتي التي قضت ردحاً من حياتها في أفريقيا، تخاف علينا كثيراً اذا أخبرناها أننا ابصرنا رجلاً أو امرأة ميتين يأخذان منا شيئاً ما، مالاً أو طعاماً أو لباساً… كانت ترتعب حقاً وتوصينا بالصلاة. كان برأيها أن الموتى اذا أخذوا شيئاً من الأحياء في الحلم فهؤلاء سيكونون عرضة للموت، أو المرض. أما إذا أعطى الموتى الأحياء مالاً أو طعاماً فهذه أعطية غالية. أذكر كم كنت أفرح عندما كنت أبصر جدي أو جدتي أو أبي في المنام يجزلون عليَّ عطاءاتهم، وكم كنت أخاف فعلاً عنمدما يأخذون هم مني. في الحقيقة كان الأمر سيّان، فلا العطاء كان عطاء ولا الأخذ كان أخذاً، ولكن لم يكن في وسعنا الاّ أن نخاف أو نفرح. لكنّ رفيقي بسام في المدرسة، الذي كان معفى من تلقي دروس التعليم المسيحي والمشاركة في القداديس لأنه مسلم، فكان يروي لي كيف علّمه أبوه أن الأحلام إذا ظلت سرية ولم تُروَ فهي لا تتحقق البتة. وكان يشير عليه ألّا يروي الأحلام البشعة التي يبصرها لأحد، فهي آنذاك تتلاشى وتغيب. أما الأحلام الجميلة فعليه أن يرويها كي تتحقق. كان هذا الحل رهيباً فعلاً، ولو لم يكن فهمه سهلاً في أعمارنا الباكرة.
إلا أنني ما إن بلغت سنّ المراهقة حتى رحت أكتشف معنى آخر للحلم. يمكن الحلم أن يكون جميلاً جداً عندما تبصر في نومك فتاة تحبّها، وقد يكون أجمل عندما تبصر نفسك تقبّل هذه الفتاة وتضمّها اليك. وقد تبصرها عارية وإنْ عرياً مبهماً، فتتلذذ بها وتحلّ بك رعشة جماع هو أقرب الى الاستمناء العذب، فيدفق ماؤك السري في حال بين النوم واليقظة، وتتخدر… هذه الأحلام التي كثيراً ما راودتني، دافقة أو من غير دفق، لم أكن أخبر بها أمي، فلا خوف هنا ولا موتى بل رغبات أولى تتفجر من تلقائها. وكنت دوماً أتحاشى الفضيحة التي يتركها المنيّ على سروالي الداخلي والبيجاما في أحيان فكنت أنسلّ سرّاً الى الحمّام وأغسل البقعة بالماء ثم أعود الى الفراش رطباً الى أن أخلع السروال صباحاً وقد زالت عنه آثار “الجريمة” ولو غير كاملة. أجمل صفة وجدتُها لمثل هذه الأحلام الدافقة هي “الأحلام الرطبة” بحسب التعبير الأميركي. وكم كنا نتندر نحن الفتيان بهذه الأحلام وكان واحدنا يسأل الآخر: مَن ضاجعتَ هذه الليلة؟ فيردّ: فلانة. وكنا فعلاً نتخيّل أنفسنا لحظة النوم نضاجع فلانة، فتاة أو امرأة، كنا نتحرق الى مشاهدتها عارية.
■■■
عاش الحلم معي منذ تلك الأعوام، عشت معه، عشنا معاً، كبرنا معاً، ترافقنا، خنته وخانني، غادرني أشهراً طويلة، بل غادرته في الليالي التي أسمّيها ليالي الأرق. أنت لا تحلم إذا لم تنم. يجب أن تنام كي تحلم. أحلام اليقظة تتواطأ أنت في صنعها. تركّبها كما تشاء وتفعل فيها ما تشاء. تقتل، تضاجع، تتخيل نفسك ثرياً… إنها “فانتسمات” بحسب علم النفس. أما أحلام الليل فهي التي تصنع نفسها وتصنعك. في أعوام قاتمة غادرني النوم ولم أدرِ ما السبب ولم أبحث عنه. كنت أحياناً أنام نوماً متقطعاً، لا تكاد تغمض لي عين حتى أستيقظ. رحت أشرب الكحول بوفرة، ثم لجأتُ الى حبوب النوم. في مرات لم يكن يغمض لي جفن، ولا لحظة. ما كان أقسى تلك الليالي. تنتظر الفجر لتشعر فقط أن الليل مضى. لا تنتظره لتستيقظ فأنت لم تنم أصلاً. لجأت الى “كريات كياس” الفرنسية وهي من شمع يضعها المرء في أذنيه فتوقعه في حال من الصمم الخفيف. تنقطع الأصوات لكنها لا تغيب تماماً. هذه الكريات كثيراً ما استخدمتُها خلال الحرب، في الليل كما في النهار. وكم من مرة تمنيتُ لو أنني أصمّ. كل هذه الأحابيل كانت موقتة. الى أن استعدتُ النوم، لا أعلم كيف. ثم استعدتُ عادتي القديمة: الحلم. لعل النوم هو الذي يحكمنا، مثله مثل الأرق. تنام في أحيان بلا سبب. تنام في وقت ينبغي أن تكون صاحياً فيه. قبل الظهر مثلاً. أحيانا لا تدري ما الذي يجعلك تستيقظ باكراً جداً، فجراً وقبل الفجر. إنها لحظات لا تنسى. العالم في الفجر هو غيره في النهار أو الليل. السماء هي غيرها، ولا سيما في الصيف، آخر العتمة، أول الضوء، الزرقة المتراوحة بين قتام خفيف ووضوح كابٍ.
مرت أعوام كان النوم فيها صديقي وكذلك الأحلام. عشية إحدى الليالي وجدتُ نفسي أرِقاً وعاجزاً كل العجز عن النوم. راحت الحال تتفاقم، في الليل وفي النهار: أحاسيس غامضة، حزن في ضوء الشمس، كآبة لا حد لها، قلق، خوف، غثيان، شلل في عمق الروح، تعب منذ أول النهار، رغبة في الاختفاء… خلال عام من الاكتئاب غاب النوم مرة أخرى، غابت الأحلام وانقطع شريطها. قالت الطبيبة إن هذا الاكتئاب ناجم عن اكتئابات صغيرة ترجع الى أعوام بعيدة. لعلها تسمى اكتئابات “مقنّعة”. راحت تذكّرني بحالات من الاضطراب الخفيف كانت تنتابني متقطعة ولم اكن أعيرها اهتماماً. ذكّرتني بأحزان لا سبب لها، بهواجس صغيرة ومخاوف لم أكن أدري من أين تأتي… وما إن بدأتُ تناول دواء يدعى “أنافرانيل” حتى رحت أستعيد نفسي. تلاشى الاكتئاب رويداً رويداً، لكنه لم يغب تماماً. ترك ما يشبه الطيف الذي ظلّ يتردد. وحان وقت وقف الدواء. أوقفتُه. وبعد نحو عامين عاودني الاكتئاب ولكن أقل احتداماً أو ضراوة. طلب الطبيب مني أن استعيد “الأنافرانيل”. استعدتُه. علّمني الطبيب كيف عليّ أن أوقف هذا الدواء عندما أشعر أن لا حاجة بي اليه. وقال: أولى علامات عودة الاكتئاب الأرق أو اضطراب النوم، أي انقطاع الأحلام. أنت تراقب نفسك وتتناول من الدواء ما تراه ملائماً. بعد جراحة القلب المفتوح توقفت الأحلام. أوقف الطبيب دواء “الأنافرانيل” وأوصاني بتناول “سيبراليكس”. عاد النوم أكثر مما من قبل. انقشعت الغيوم التي كانت تتلبد حيناً تلو حين في سماء العينين. عادت الأحلام أكثر مما من قبل أيضاً. باتت تهطل كالمطر. أحلام. أحلام. ما إن أغمض عينيَّ حتى تتوالى على تلك الشاشة الداخلية التي لا أعرف ماذا أسميها. أحلام وكوابيس، أضغاث أحلام، شذرات أحلام، تخيّلات، تهيوءات، رؤى… أما أحلام اليقظة، أو الفانتسمات، فاستعدتُها أيضاً بلهفة.
بات بيني وبين الحلم صداقة شديدة، متينة، لعلها أقوى من الصداقة التي بيني وبين النوم. أعرف أن لا حلم بلا نوم وأن النوم يمكن أن يحلّ بلا أحلام، أو بأحلام لا يتذكرها النائم، كما يقول علم النفس. الحلم هو الذي يسحرني، يسحرني أكثر من النوم، حتى بتّ أقول بالسر كلّما دبّ فيَّ النعاس: إنني ذاهب الى الحلم. ذاهب لأحلم، لا لأنام. وكم خطر في البال أن أقول للساهرين: تصبحون على خير، لقد نعستُ وأريد أن أحلم.
“الحياة حلم”
ليس الحلم وجهاً من وجوه الحياة، الحلم هو الحياة نفسها، الحياة بصفتها حياة أخرى. لا أستعير هنا مقولة غولدوني “الحياة حلم”. هذا ما لمستُه خلال أعوام وعشته من دون أن أبرره أو أسعى الى تأكيده. ولم أُبدِ يوما كبير اهتمام في تفسيره. لستُ عالماً نفسانياً لأؤكد مثل هذا الافتراض. لست طبيباً ولا فيلسوفاً ولا عالماً فلكياً ولا ساحراً ولا نبياً… إنني الحالم. الحلم حياة أخرى تضاف الى الحياة. حياة في النهار وحياة في النوم. النوم ليس زمناً ضائعاً إذا سكنته الأحلام. نوم بلا أحلام هو زمن ضائع، ووحدها الأحلام تمنحه معنى الحياة، معنى حياة تبدو متخيلة بينما هي في العمق حياة داخلية، لا عبث فيها ولا سأم ولا تعب ولا ندم ولا… يربح الحالم حياتين إذاً، حياة يعيشها هو، وحياة هي تعيشه. لكنهما حياتان متداخلتان على رغم اختلافهما أو عدم تشابههما ظاهراً. في أحيان يلتبس الأمر عليَّ بين ما عشته وما حلمته. أبصر مشهداً فأظن أنني أبصرته سابقاً. أسمع حكاية فيخيَّل إليَّ أنني أعرفها. حتى الأماكن تلتبس عليَّ. مرةً رحت أبحث عن مقهى التقيتُ فيه فتاة فلم أجده. كنت حلمتُ أنني التقيتُ هذه الفتاة في مقهى اختلقه حلمي. مرةً عاتبتُ صديقاً لأنه لم يأت الى موعد فقال لي إنّ ما من موعد كان بيننا. أمور كثيرة تحصل في الحلم أظنّها حصلت في الواقع، والعكس أيضاً. هذه الحال، حال الالتباس تبهرني. قد يظن بعضهم أنني أهذي ولكن لا، هذه حقيقة، حقيقة لا معقولة، لكنها حقيقة. كم أحب هذا الخيط الواهي الذي يفصل بين هاتين الحياتين، بين الحياة والحلم. خيط واهٍ لكنه لا ينقطع. إذا انقطع يحدث أمر رهيب: هذا ما قد يسمّى الجنون أو الهذيان أو البارانويا أو الموت. هنا أتذكر هذه المقولة البديعة: “والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا”. كأن الموت هو ولوج عالم الانتباه، عالم اليقظة الأخرى، عالم النيرفانا التي هي اليقظة التامة، عالم الحلم الذي هو الحياة الأخرى.
كم كان يستهويني التأويل القديم للحلم. وما زلت أميل رغماً عني الى نظرة الشعوب البدائية الى الحلم، وكذلك الى التصورات التي ارتآها أهل الحضارات الغابرة، في بلاد ما بين النهرين ومصر واليونان والهند، وكلها تلتقي حول الطابع الميتافيزيقي للحلم. لكنّ هذه المقاربات أُسبغ عليها لاحقاً التأويل الخرافي والأسطوري، ولا سيما بعد الثورة التي أعلنها علماء النفس وفي مقدمهم فرويد. عاقبني فرويد وعاقب أمثالي وحرمنا نعمة الخيال والتوهم الجميل عندما أعاد جذور الحلم الى اللاوعي كما فهمه هو. لكنّ عالِماً عظيما مثل يونغ ردّ الينا مقداراً من الأمل وأحيا فينا بعضاً من معتقداتنا البدائية.
كانت الأحلام في الأزمنة القديمة حيّز اللقاء بين الآلهة والبشر. تنزل الآلهة في الليل من عروشها وتزور بالسرّ، البشر النائمين، تبلّغهم رسالة أو تشي لهم بأسرار. لم تكن من علاقة مباشرة بين البشر والآلهة خارج الاحلام. وكان الآلهة يسمَّون في أحيان قوى الغيب أو قوى المافوق والماوراء، والحلم هو أداة التواصل بين الهنا والهناك، بين الأرض والسماء، بين الظاهر والخفي… أما الحالمون فكانوا هم الوسطاء بين الآلهة والبشر. لم يكن كل الناس بحالمين “موهوبين”، ليسوا جميعاً مهيَّئين لمثل هذه الوساطة. والحالمون يجب أن يكونوا من خيرة البشر، صالحين ومنزّهين عن العيوب والشرور، لتزورهم الآلهة، آلهة الخير. أما الأشرار فلا يزورهم سوى الشياطين. الشرير يتصل بالأشرار وأرباب الخير بالأخيار. إلا أن التواصل بين الآلهة والبشر كان يبادر به الآلهة أنفسهم. البشر ليسوا هم الذين “يظهرون” على آلهتهم أو يتراءون لهم. لكنهم كانوا ينادونهم ويصلّون لهم كي يزوروهم. وراجت في حضارات عدة ظاهرة النوم في المعابد والهياكل وعلى أقدام تماثيل الآلهة. كان الصالحون يلجأون الى هذه “الحيلة” بغية تلقّي الأحلام والوحي والرسالة. كان مثل هذا النوم في الأماكن المقدسة القديمة أشبه بـ”التشفع” لدى الآلهة لتظهر في أحلام الصالحين. كان الإله بحسب الأسطورة الاغريقية، يحلّ على النائم وبغية التأكد من يقظته في قلب الحلم، يسأله: أأنت نائم؟ وإن لم يجب يغادره. هذه الطريقة في التواصل تُظهر أن على الحالم أن يكون يقظاً في نومه، مستعداً لتقبّل الزيارة والرسالة. كان الحلم في معنى ما، يقظة في صميم النوم.
كم كانت تبهرني هذه المقاربات القديمة، بحقائقها وأوهامها، بأسرارها الدفينة وخرافاتها. إنهم الآلهة على تماس شبه دائم مع البشر، في عمق الليل. لم يجر كلام عن أحلام يقظة وأحلام في أوج النهار. الليل هو معترك اللقاء. وكانت شعوب عدة تعتقد أن الروح تغادر عند النوم جسد النائم وتروح تجوب الآفاق مكتشفةً ما خفي من حقائق وأسرار. أما الجسد عندما تغادره الروح، فلا يبقى فيه سوى الأنفاس، الى أن تؤوب الروح من تطوافها الذي قد يشمل الأرض أيضاً وليس السماء فقط. وكان بعض البدائيين لا يفرّقون بين النوم والموت، ففي كليهما تغادر الروح البدن، فإما أن ترجع اليه وإما ألاّ ترجع ويحدث ما يسمّى الموت حينذاك. ويقال إن فكرة وجود الروح نشأت لدى البدائيين من خلال مراقبتهم أنفسهم أو أرواحهم عند النوم. فالأحلام التي كانوا يبصرونها في نومهم والمنامات العجيبة والظواهر الخارقة كانت تجعلهم يتخيلون وجود الروح في أبدانهم. لعل هذا التخيل حملهم على الاعتقاد بأنّ كل ما في الدنيا له روح وجسم وبأن العالم تسكنه أعداد لا تحصى من الأرواح، وهي خيّرة وشريرة. أما الآلهة فهي أرواح نقية وسامية وذات قدرات فائقة أصبحت محلّ عبادة ورهبة أو خشية.
كان أثر الأحلام يبلغ مبلغه في حياة البشر الأقدمين حتى ليأخذوا بها في حياتهم اليومية والواقعية. كان البشر لا يعجبون من رجل يخاصم رجلاً آخر، قريباً له أو من أهل الحي، جراء رؤيته إياه في الحلم يعتدي عليه أو يسيء اليه. وكان أحدهم يعاتب صديقاً له على خطأ ارتكبه ضده في الحلم. وكان الذين تقع عليهم التهمة لا يجرؤون على انكار هذه التهمة التي كيلت لهم، فالحالم هو الشاهد الأصدق وما دام الحالم أبصر في الحلم ما يرويه فلا بد للمذنب من الاعتذار. وكم من محاكمات جرت انطلاقاً من أحلام ولم يكن على المحكومين أن ينكروا فعلتهم. بل إن حروباً وقعت جراء أحلام خضعت للتفسير المصيب أو الخاطئ. واستوقفني عرف لدى إحدى القبائل البدائية كان يُجيز للرجل مضاجعة أيّ فتاة أو امرأة حلم أنه ينام فوقها أو ترقد هي تحته، إنها تصبح من نصيبه ما دام قد قام بينهما وصال. هذا العرف لو طُبّق في زمننا لكان لي من العشيقات كثيرات، حلمت أنني اضاجعهنّ.
القوى البدائية
كان يبهرني التفسير القديم للأحلام، وما زلت حتى اليوم آخذ منه ما يفسر أسرار الأحلام وطبيعتها الغامضة. وما زلت أعتقد كل الاعتقاد أن الأحلام هي خيط يصلنا بالماوراء أو بالغيب كما يقول الأقدمون. وهذه الكلمة بديعة أصلاً: الغيب. إن فيها من الغياب والحضور ما يجعلها تعني حالاً فريدة من أحوال الكون الذي وُجد لئلا يُسبَر. وليست الذات، ذات الانسان الحالم، أقلّ غموضاً من الغيب نفسه، إن فيها من العمق ما يستحيل سبره. الأحلام تضيء جوانب من الطريق التي تفضي الى الغيب، المكان الذي هو اللامكان. إنني أدرك بما أدعوه الحدس، السرّ الخفي للأحلام. وهو ما يفتنني فيها. وهو ما جعلني أكتشف في جهود يونغ مقولات هي بمثابة اللقى العجيبة. لست من أتباع يونغ الكثيرين في العالم، إنني مجرد واحد من قرّائه السريين، المعجبين به والآخذين بالكثير من آرائه. لم أقرأ كل ما كتب بل ما بدا يعنيني أو يمكنني فهمه لديه، من مقارباته الروحانية والباطنية ونصوصه في الأحلام واللاوعي والنفس والماوراء. وكان عليّ أن أنحاز اليه في مسألة تفسير اللاوعي والأحلام في خلافه مع فرويد، العالِم الكبير الآخر. يونغ عالِم وأكثر، عالِم وساحر، عالِم ورؤيوي، عالِم ونبي، لكنه نبي بلا رسالة نزلت عليه من السماء. رسالته تلقّاها من الإصغاء الى ذاته التي هي مختصر الكون. كان يونغ قريباً من الفلسفة والدين والماورائيات ومعتقدات الشعوب والحضارات القديمة. لم يكن عالِم نفس وطبيباً فحسب. وهذا ما تجلى في نصوصه ذات البعد الفلسفي والتأملي والاستبطاني. قراءة نصوص يونغ هذه تتيح لقارئه أن يعود الى نظريات سابقة في الحضارات والفلسفات القديمة.
الأحلام بحسب يونغ تكشف أسرار الحياة الداخلية، في كل ما تحمل هذه الحياة من رموز ومعان ورؤى وأصداء ورجْع أصداء. كانت هذه المقاربة اليونغية قد جذبتني وتوقفتُ عندها طويلاً. أسرار الحياة الداخلية، أسرار حياتي بصفتي حالماً وأسرار حياة أخرى لا حدود لها في الزمن البشري، حياة تضرب جذورها في حياة الأسلاف الذين لا نعرفهم. هكذا رأى يونغ على خلاف فرويد، أن الأحلام لا تمثل الرغبات المكبوتة الكامنة في اللاوعي والمنبثقة منه فقط، بل تعبّر عمّا خمد في الذات العميقة للانسان ويحتاج الى نار البصيرة لينبثق فيكتمل من خلاله شخص الحالم. لا تسعى الأحلام الى إرضاء الرغبات المكبوتة فحسب، بل إن معانيها تدلّ على غاية تحاول الوصول اليها، لتخبر الحالم أين يمضي به اللاوعي. وفي نظر يونغ لا تنبئ الأحلام عن المكان الذي أتى الانسان منه فحسب وإنما أيضاً عن المكان الذي يسير اليه. ويجد يونغ في الأحلام ما يصفه بـ”التعويضي” و”التصحيحي”، فالأحلام تكشف عن “القوى البدائية” المستقرة في اللاوعي والساعية الى التعبير عن وجودها، مما يتيح لها فرصة الاندماج في كيان الشخصية الانسانية. اللاوعي أو العقل الباطن كما يسمّيه يونغ، وهي أجمل تسمية، الى كونه ذاكرة الماضي، هو مسكب بذور الأفكار والمواقف والأحوال النفسية التي تتجلى في المستقبل. علاوةً على الذكريات المنبعثة من ماضٍ سحيق يظهر في أفق الوعي، فالأفكار واللمعات الابداعية الحديثة يمكنها أيضاً أن تخرج من فضاء اللاوعي، وهي أفكار ولمعات لم يعرفها أفق الوعي من قبل. إنها تنمو وتترعرع في أعماق العقل الباطن المعتمة كما تنمو زهرة اللوتس، لتشكّل الناحية الأهم من النفس الانسانية. يتحدث يونغ عما يسمّيه “إبداع الأحلام” الذي يتجلى في اللغة الرمزية للأحلام نفسها. والصور والأفكار التي تتضمنها الأحلام لا يمكن تفسيرها في ضوء لغة الذاكرة فقط، فهي تعبّر عن أحوال جديدة لم تبلغ عتبة الوعي من قبل. والأحلام في نظر يونغ تُطلع الإنسان على مواقف ووقائع قبل أن تحصل بزمن طويل، وهذا ليس من قبيل المعجزات بالضرورة، ولا هو شكل من أشكال الإدراك المسبق. فثمة أزمات كثيرة في حياة الانسان ذات تاريخ لا شعوري طويل، والانسان يتجه نحوها خطوةً خطوة جاهلاً الأخطار التي تتراكم. لكنّ ما يعجز العقل الواعي للانسان عن إدراكه، غالباً ما يدركه عقله الباطن الذي يمكن أن يمرّر ما يعلمه، عبر تلك الأحلام التي تستطيع آنذاك أن تحذّر الانسان. في نظر يونغ تملك الأحلام في أحيان، قدرة على الحدس والتنبوء فتجعل الحالم يتوقع حوادث تقع في المستقبل. أما الكشف الذي أحدثه يونغ فهو ما سمّاه “اللاوعي الجماعي” أو “اللاشعور الجمعي” لدى الانسانية جمعاء، ورموزه تظهر من خلال الأحلام نفسها. هذا اللاشعور الجمعي يتكوّن كما يقول، من عناصر فطرية موروثة تعبّر عن نفسها في الأحلام عبر صور ذات طرز بدائية. ومن المحتمل أن هذه الطرز تميز طبيعة البشر وعاداتهم القديمة والمطلقة والمتحررة التي تحدد سلوكهم، وهي تتكرر فيهم مرات كثيرة حتى لتترك في لا شعورهم أثراً من المتعذر محوه. كثير من هذه الطرز والصور يرتكز الى معطيات الأديان أو الأساطير أو القصص الشعبي.
لا أبحث في الحلم هنا ولا أتقصى حقائقه وظواهره كما يفعل العلماء، قصارى ما أكتب مقاربة الحلم كما عشته وأعيشه وكأنني مريض مصاب بداء هو الحلم. في ظني أن مَن لا يحلم لا يمكنه أن يدرك سرّ الحلم، مَن لا يبصر المشاهد التي يتيحها الحلم في ما يشبه فيلماً سينمائياً، لا يمكنه أن يفقه لغزه. وجوه وأشخاص أو أطياف أشخاص تبدو كأنها تُعرض في شريط هو أقرب الى “النيغاتيف”، واقعية ولكن على مقدار من الغرابة، مناظر ناطقة أو صامتة، صور تهتزّ حيناً وتجلو حيناً، بالألوان النقية أو الباهتة أو بالأسود والأبيض، حديثة أو قديمة كما لو أنها أُخرجت للحين من علب الذكريات. أما ما يمكن تسميته “ديكورات” الحلم فهي أغرب ما يمكن أن تصادفه عين. يبصر الحالم مشاهد مركّبة تركيباً غرائبياً يستحيل إيجاد ما يماثله وكأن الأشياء والعناصر تتلبس هنا أشكالاً غير مألوفة لا يعلم الحالم مَن ابتدعها أو “ركّبها” وكيف. الثنائيات هنا، على سبيل المثل، التي لا يمكن أن تلتقي، تتواشج وتتداخل في طريقة فريدة جداً. إنها المصادفات البصرية التي تصنع خصائص المشهدية الحلمية التي تفوق الوصف. وعندما يستفيق الحالم ويفتح عينيه لا بد من أن يسأل نفسه: كيف أمكن أن أرى ما رأيت؟
لا يمكن استجلاء حقيقة الحلم في منأى عن الحلم نفسه. هذا أصلاً ما قال به علماء النفس والأعصاب. فرويد كان حالماً كبيراً وكذلك يونغ وابن سيرين والنابلسي… ولئن كنت أميل شخصياً الى يونغ لغايات في نفسي فهذا لا يعني البتة أنني لم أتوقف عند فرويد وقبله، كما أشرت، عند الأديان والحضارات التي قاربت الأحلام وحدبت عليها. كان فرويد رهيباً في كتبه التي تناول فيها الأحلام وخصوصاً كتابه “علم الاحلام” الذي أحدث بدءا من عام صدوره 1900 ثورة في علم النفس والفلسفة والطب، وكان بمثابة العلامة التي أشرقت في سماء البشرية وألقت نوراً باهراً على عالم اللاوعي الكامن في عمق الانسان. وبدا علم النفس كأنه كان ينتظر فرويد ليضيء لغز الحلم ويفكك أسراره وفق منهج علمي، ويفتح الطريق أمام علماء النفس ليوافقوه في كشفه أو ليختلفوا معه ويتمردوا عليه. لكنّ جميع هؤلاء لم يمكنهم إلاّ أن يعترفوا بما سمّاه فرويد “العلاقة المباشرة بين الحلم والرغبة”، حتى وإن فهموا الرغبة، كلٌّ على طريقته. وبدت مقولة فرويد صريحة: “الحلم هو تحقيق، مقنّع ام غير مقنّع، لرغبة، مكبوتة أو غير مكبوتة”. يملك الحلم في نظر فرويد معنى يكشف الرغبة اللاواعية داخل الانسان، لكنّ هذه الرغبة تعبّر عن نفسها في طريقة مقنّعة جراء مواجهتها الرقابة الداخلية. أما الأقنعة التي يستخدمها الحلم فلا ترجع فقط الى كونها أداة تغافل الرقابة بل تعود أيضاً الى طبيعة الطبقات السفلى من العقل. وهذه لا تخضع لقواعد المنطق التي ترين على العقل في أوقات اليقظة، بل تعمل بحسب منطق هو أقرب الى منطق الطفل والانسان البدائي القديم. ويمكن القول إن الحلم وفق فرويد يزخر بمحتويات ثلاثة: اللاوعي المتكوّن من رغبات وغرائز طفولية مكبوتة، بقايا التجارب التي عاشها الانسان خلال اليوم أو الأيام القليلة السابقة، الأحاسيس والإثارات الحسية التي يتعرض لها الانسان الحالم أثناء النوم. وما يمكن استخلاصه أنّ أهم تكاوين الحلم تنبع من صميم الحوافز والرغبات التي “تنوجد” في المراتب الطفولية للنمو النفسي وخصوصاً في الدورين الما قبل أوديبي والأوديبي. هكذا ترتبط الاحلام بالرغبات الجنسية الأولى المكبوتة وتغدو كأنها متنفّسها وطريقها الى الظهور والسعي للإرضاء. ولعل المختصر المفيد أن الحلم هو “السبيل الملكي” الذي يوصل الى اللاوعي عند الانسان. إنه الأداة الرئيسة لاستكناه اللاشعور الفردي الذي يعدّه فرويد مكمن الحوافز والمكبوتات والغرائز.
مع يونغ ضدّ فرويد
كان عليَّ أن أنحاز الى يونغ في خلافه مع فرويد، انحيازا غير علمي طبعاً، فأنا لست عالم نفس ولا محلل أحلام، وما يشفع بي في هذا الشأن أنني حالم، حالم ذو مراس ومعرفة حدسية واختبار. حتى قراءتي لهذين العالِمين، فرويد ويونغ، لم تكن منهجية، قرأتُ ما أردت أن أقرأه وما اخترتُ أن أقرأه ولا سيما ما يتعلق باللاوعي والأحلام. وأعترف أن يونغ أثّر فيَّ وهزّني. يونغ ابن القسيس وحفيد القسيس، المتصوف والفيلسوف والعرفاني والرؤيوي والحالم، أسرني بنصوصه الروحانية التي يشطح فيها شطح الصوفيين ولا سيما كتابه “حياتي: ذكريات، أحلام وأفكار” و”تحولات النفس ورموزها” و”الأحلام”. تمثلت إحدى نقاط الخلاف الجوهري بين يونغ وفرويد، أستاذه السابق، حول ما يسمّى “الليبيدو”، فيونغ رفض التصوّر الفرويدي الذي يجعل الأصل الجنسي أساس الطاقة النفسية معتبراً الليبيدو طاقة حيوية تُضاف اليها غرائز أخرى مثل الجوع والحاجة الى الثقافة. أما اللاوعي الذي بدا لدى فرويد حيّزاً للمكبوت، فهو بحسب يونغ يتضمن أبعاد النمو والتطور وحوافز البحث عن المعنى. اللاوعي “ذكي” في يونغ ويسعى الى التطور والتبلور. أما الفكرتان الأخريان اللتان ترتبطان بعضاً ببعض فهما “القناع” و”الظل”. مفردة “قناع” أو “برسونا” النابعة من المسرح الإغريقي تعني فعلاً القناع الذي يضعه الممثلون على وجوههم وهم على المسرح، وهو بصفته قناعاً، لا يعبّر عن الفرد بواقعيته وذاتيته بل عمّا يفكر هو فيه أو يفكر الآخرون في أنه هو. أما الوجه المقابل فهو “الظل” ويوازي الجانب الخفي من الشخصية، الذي يضمّ في اللاوعي معظم عناصر الحياة النفسية، الشخصية والجماعية، التي لا تعاش جراء عدم توافقها مع نمط الحياة الذي يتم اختياره بوعي. يشكل “الظل” إذاً شخصية مستقلة تتعارض مقاصدها مع مقاصد الوعي. هكذا كان على يونغ أن يختلف مع فرويد حول الكثير من آرائه في اللاوعي والأحلام، فالحلم لا يمكن اعتباره فقط فضاء تحقق الرغبات ولا سيما الجنسية منها والمكبوتة، بل هو في نظر يونغ يؤدي وظيفتين أخريين، الوظيفة التعويضية أو التكميلية التي تعيد الى الشخص توازنه السيكولوجي، والوظيفة التطلعية او التنبوئية. والحلم يوفر للشخص ما لم يتيسر له في حياة اليقظة.
لعل ما يجدر تذكره هنا أن علم الأحلام لم يكن يوماً وقفاً على فرويد ويونغ ومَن سار على منهجهما، فالعلماء الذين تولّوا تحليل الأحلام علميا وطبياً لا يُحصَون، وخصوصا بعد الثورات التي أعقبت ثورة فرويد وما نجم عنها من مفاهيم حديثة، بدا بعضها معارضاً للنظرية الفرويدية. وادّعى بعضهم تخطي فرويد وتحديثه ولكن انطلاقاً منه ومن أفكاره واختباراته التي لا يمكن التخلي عنها. قد يكون من الخطأ إذاً حصر تأويل الحلم في دائرتَي فرويد ويونغ، فالفلاسفة والمتصوفة ورجال الدين الذين سبقوهم في هذا القبيل هم كثرة، وكذلك علماء النفس الذين أعقبوهم وهم ليسوا بقلة وبعضهم ناقشهم واعترض على بضع من أفكارهم، وتعرّض فرويد خصوصاً لحملات مناوئة كادت أن تلغي آراءه وتدحضها، ومنها على سبيل المثل حملة المفكر الفرنسي ميشال أونفري الذي كاد يدعو الى إحراق فرويد.
أصداء فلسفية
في الحقبة الإغريقية، إن استثنينا العالِم أرطميدورس، صاحب أول كتاب في تفسير الأحلام، الذي لنا عودة اليه في تناول هذا النوع من الكتب، أبدى بضعة فلاسفة اهتماماً كبيراً بالأحلام واختلفوا حولها نظرياً. أفلاطون مثلاً، قال بصدق الرؤيا وتنبوئها وعلاقتها بالغيب، وهي كانت تُعتمد في المحاكم لإدانة المتهمين أو تبرئتهم. أما أرسطو فتوغل في مقاربة الأحلام ووضع عنها كتاباً موضوعياً ورأى أن معظم الأحلام تنشأ عن مؤثرات حسية، وتنجم عن أثر الأمزجة والعواطف والنزعات لدى الانسان في تشكيل أحلامه. ويتوقف أرسطو عند الرؤيا الصادقة أو الأحلام التي تتحقق بعد رؤيتها في النوم. أما تحقق الأحلام في نظره فيقوم على عوامل عدة منها: المصادفة التي يلتقي حولها الحلم والواقع، الإيحاء الذي يجعل من الحلم حقيقة، الشعور المضخم الناجم عن إحساس الانسان باضطراب عضوي أثناء نومه. في رأيه أن الآلهة لا تتواصل مع البشر عبر الأحلام، ولو هي شاءت مثل هذا التواصل لقامت به في وضح النهار وفي طريقة أوضح. أما الرواقيون فعاكسوا أرسطو ودافعوا عن الرؤيا الصادقة معتبرين إياها وحياً إلهياً على طريقة القدماء. فالنفس البشرية في نظرهم تكون خلال اليقظة فريسة الشهوات الجسدية وفي النوم تتحرر منها وتصبح لها القدرة على التنبؤ والعلم الغيبي.
لم تغب الأحلام عن الفلسفة الأوروبية مثلما لم تغب البتة عن الفلسفة الاسلامية والعربية. هيغل وهنري برغسون والقديس توما الأكويني وشوبنهاور ونيتشه وسواهم كتبوا عن الأحلام، كلٌّ بحسب نظرته، ولعل كتاب نيتشه الرهيب “هكذا تكلم زرادشت” ينتمي الى أدب الرؤيا أو فلسفة الرؤيا وإن كانت الرؤيا هنا تنفي وجود إله وتبشّر بموته. أبرز حدث فلسفي في حقل الأحلام عاشه الفيلسوف الفرنسي ديكارت صاحب “الكوجيتو” الشهير: “أنا أفكر إذاً أنا موجود”. في مستهل كتاب “الأحلام: السبيل الملكي للاوعي” (دار تشو، باريس 1979) يتناول العالم النفساني الفرنسي فرنسيس باش الأحلام الثلاثة المشهورة التي أبصرها ديكارت ومنها حلم وُصِفت الليلة التي حلمه فيها بـ”الليلة المضطربة”، وهي صادفت ليل العاشر من تشرين الثاني 1916. أبصر ديكارت نفسه يمشي متعباً في الشارع بعدما شعر أنّ أشباحاً ظهرت له، ثم هبّت عليه ريح وحملته في ما يشبه الإعصار ودارت به دورات وهو واقف على قدمه اليسرى. ألفى نفسه يمشي بصعوبة، خائفاً من الوقوع أرضاً، حتى أبصر على طريقه، معهداً مفتوح الأبواب فدخله بحثاً عن راحة ومداواة لألمه. اتجه نحو كنيسة المعهد لكنه أبصر شخصاً يعرفه مرّ به من دون أن يلقي عليه السلام، فعاد خطاه ليحييه، فإذا الريح تهبّ مرةً أخرى وتحمله لتضرب به عرض الكنيسة بقوة. لكنه أبصر في الحين نفسه شخصاً آخر يناديه وسط ساحة المعهد باسمه ويعهد اليه، إن كان سيذهب لملاقاة السيد ن، أن يحمل إليه غرضاً يبغي إرساله اليه. ظنّ ديكارت أن الغرض هو شمامة جُلبت من بلاد غريبة. لكنّ ما فاجأه رؤية أشخاص آخرين يلتفّون حول هذا الشخص ويتحدثون، وكانوا على خلافه هو، التعِب والمنهك، متماسكي القوام، أقوياء… ثم استيقظ ليجد نفسه ينام على جانبه الأيسر، ما يفسر بشاعة الحلم الذي أبصره. صلّى إلى الله سائلاً إياه أن يقيه شرّ ذاك الحلم. وبعد ساعتين من التأمل في خير العالم وشرّه، نام على جانبه الأيمن. خضع هذا الحلم والحلمان الآخران لمقاربات عدة سعت الى الكشف عن ينابيع فلسفته. لكنّ تحليله الشخصي لهذه الأحلام وبخاصة الحلم الأول كان الأعمق، فهو لمس في هذا الحلم وعيداً منذراً إزاء حياته السابقة التي لم تكن بريئة أمام الله ولا أمام البشر، ومن هنا تبدّى الرعب والهلع في الحلم.
الرؤيا والحلم
الفلاسفة المسلمون والمتصوفة كانت لهم أواصر وطيدة بالحلم أو الرؤيا بالأحرى، ومعظمهم، ما خلا بضعة علماء وبضع فرق باطنية، كتبوا في ميدان الأحلام وبحثوا وتأملوا، ولكن في ضوء المفهوم الإسلامي للرؤيا. والرؤيا هي المفردة الأسلم التي اعتُمدت بصفتها مصطلحاً اسلامياً، على خلاف مفردة الحلم التي غالباً ما ارتبطت بمفردة “أضغاث”. مفردة الرؤيا ذات منشأ “كتابي”، يهودي ومسيحي، بحسب التوراة والأناجيل ولا سيما سفر الرؤيا أو رؤيا يوحنا وهي من النصوص الرئيسة التي تعتمدها الكنيسة، عطفاً على رؤى أخرى مثل رؤيا القديس بطرس، رؤيا القديس بولس وسواهما. أما الرؤيا في التوراة فتوزعت على أسفار عدة منها: رؤيا النبي اشعيا، رؤيا النبي ايليا، رؤيا النبي حزقيال، رؤيا النبي دانيال. غير أن مفردة حلم ظهرت أيضا في الأناجيل… إسلاميا وردت مفردة الأحلام، بمعنى ما يراه النائم، ثلاث مرات في القرآن وفي آيتين (يوسف 44، الأنبياء 5)، وعُطفت مرتين على مفردة أضغاث، أما كلمة رؤيا فوردت سبع مرات في ست آيات (يوسف 43، يوسف 5، الإسراء 60، الصافات 104، 105، الفتح: الآية 27، يوسف 100). وفي “لسان العرب” يفرّق ابن منظور بين الحلم والرؤيا تفريقاً بيّناً فيقول: “الحلم عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء، ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن، وغلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح، ومنه قول-عز وجل- “أضغاث احلام” (يوسف 44)”. في موضع آخر يربط ابن منظور بين الأضغاث والأحلام قائلاً: “وفي التنزيل العزيز “قالوا أضغاث أحلام” أي رؤياك أخلاط ليست برؤيا بينة، “وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين” (يوسف 44) أي ليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل لأنها لا يصح تأويلها. هكذا ارتبطت مفردة أضغاث بالأحلام لأنها لا تفسر ولا تؤول لاختلاطها بعضها ببعض، فأصل كلمة الضغث كما جاء في “مختار الصحاح” هو “قبضة حشيش مختلطة الرطب واليابس، وأضغاث أحلام: الرؤيا التي لا يصح تأويلها”. وفي شأن الرؤيا تستخدم كلمة “تعبير” محل تفسير أو تأويل، وجاء في “لسان العرب”: “عبر الرؤيا يعبرها عبرا وعبارة وعبّرها: فسّرها وأخبر بما يؤول أمرها”. في المعنى الاسلامي هناك تخصيص للمصطلحين: الأحلام أضغاث والرؤيا تعبير، وتم التخصيص استناداً الى القرآن والحديث الشريف، وقد أورد البخاري في صحيحه: “الرؤيا من الله والحلم من الشيطان”، وفي رواية: “الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان” (البخاري). أما في اليهودية والمسيحية فلم يتم الفصل بين المفردتين أو المصطلحين، فرؤيا النبي يوسف في القرآن هي على سبيل المثل، حلم وأحلام في التوراة (تكوين 5:37-11)، وفي إنجيل متى ترد كلمة حلم مرتين في حدثين ربّانيين، الأول عندما ظهر الملاك على يوسف خطيب مريم العذراء في الحلم ليعلن له الحبل الإلهي (متى 1:20)، ثم ظهور الملاك على المجوس في الحلم (متى 2:12) وظهوره مرةً أخرى على يوسف في الحلم أيضاً ليبلغه بالهروب الى مصر بالطفل وأمه مريم فراراً من بطش هيرودوس (متى 2:13 ). لعل هذا ما يعني أن الرؤيا والحلم في العهدين القديم والجديد (التوراة والأناجيل) لم تتم التفرقة بينهما على رغم تقدم الرؤيا على الحلم لاهوتياً ودينياً. فالحلم حمل في الغالب دلالة التنبيه، وحملت الرؤيا معنى التجلي، على خلاف الاصطلاح الاسلامي. ملاك الله يظهر في الحلم مثلما يظهر في الرؤيا لكنّ الرسالة هي التي تختلف بينهما.
كان لا بدّ من هذه الإشارة التي توضح الفرق بين المصطلحين، الحلم والرؤيا، قبل التوقف عند آراء الفلاسفة المسلمين والمتصوفة، الذين شغلتهم مقولة الرؤيا، وهي آراء فريدة تحمل أبعاداً فكرية وتفاسير تتقاطع مع التأويل الديني وتختلف عنه في أحيان. فمفهوم الرؤيا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم النبوة كما تجلّى في الإسلام. ولعل الفيلسوف الكندي 801-866 م كان من أشد الفلاسفة اهتماماً بقضية الرؤيا والحلم، وهو تفرّد بوضع كتاب أو رسالة بعنوان “رسالة في علة النوم والرؤيا وما ترمز به النفس”. وقد سعى فيها الى التعريف بالنوم والرؤيا وهما في رأيه من لطائف العلوم الطبيعية ولا يمكن الباحث الخوض فيهما ما لم يتقن معرفة ماهية النفس وقواها وأفعال هذه القوى. وإن كان النوم يمثّل انصراف النفس عن مباشرة الحواس، فهو درجة من درجات التفكير ولكن التفكير العميق، عطفاً على استخدامه القوة المصورة استخداماً كاملاً. أما تعريف الرؤيا في نظره فإنما يندرج في سياق قوى النفس وهي ثلاث: القوة الحسية والقوة العقلية، وهما على تباعد، والقوة المصوّرة وهي تتوسط تينك القوتين، وتعمل القوة المصوّرة عملها في اليقظة وفي النوم أيضاً. وقال الكندي بالرؤيا الصادقة وبأضغاث الأحلام. الرؤيا الصادقة تنجم عن التهيؤ التام للنفس التي يصفها بـ”العلامة اليقظانة الحية” لقبول الآثار وهي نقية من الأعراض المفسدة. وتتفاوت النفوس بحسب القوة والضعف في القبول. اذا كانت النفس غير مهيأة للقبول كانت الرؤيا بلا نظم، أي تخليطاً، وهي المسمّاة أضغاث أحلام. الفيلسوف الفارابي 870-950 م تطرق إلى هذه القضية في كتابه “الشفاء” وقال إن القوة المتخيلة، مرجع الرؤيا، تحاكي ما يصادف البدن من مزاج، فإذا صادفت مزاج البدن رطباً، حاكت الرطوبة عبر تركيب محسوسات تحاكي الرطوبة كالماء مثلاً، وإذا صادفت مزاج البدن يابساً، حاكت يبوسته بمحسوسات تدل على اليبوسة، وكذا الأمر في الحرارة والبرودة. في “كتاب الشفاء” أيضاً تطرق الفيلسوف ابن سينا إلى الرؤيا. وفي رأيه أن المخيلة تعمل في النوم وفي اليقظة على السواء. لكنّ عملها أثناء النوم قد يكون أوضح وأقوى، فالمخيلة آنذاك متحررة من قيود الحواس الظاهرة ومن العقل. ولم يغفل ابن سينا تأثير الاحساسات العضوية الداخلية التي تجد في النوم وسكون القوى النفسية مجالاً للظهور والنشاط. ويتحدث ابن سينا عمّا يسمّيه “فضيلة التخيل” ويرى أن “المتخيّل في الحلم والرؤيا، المستعد يؤتى له ما يقوى به على تخيلات الأمور الحاضرة والماضية والاطلاع على مغيبات الامور المستقبلية فيُلقى إليه كثير من الأمور التي تقدم وقوعها بزمان طويل فيخبر عنها وكثير من الأمور التي تكون في زمان المستقبل فينذر بها. وقد يكون هذا لكثير من الناس في النوم ويسمّى الرؤيا، وأما الانبياء فإنما يكون لهم ذلك في النوم وفي اليقظة”. يعترف ابن سينا بدوره أن أضغاث الأحلام إنما تنشأ عن إحساسات بدينة كاذبة. ويرى أيضاً أن للرؤيا دوراً حاسماً في إثبات وحدة الذات. أما الفيلسوف الغزالي 1058-1111 فرأى أن من عجائب الرؤيا الصادقة انكشاف الغيب بها، وإذا جاز الأمر في النوم فلا يستحيل في اليقظة. فالنوم بحسبه لا يفارق اليقظة إلا في ركود الحواس وعدم اشتغالها بالمحسوسات، “فكم من مستيقظ غافل لا يسمع ولا يبصر لاشتغاله بنفسه”.
هذه قبسات من قراءات شغوفة عن الحلم قمت بها كما كان يحلو لي، بحرية وحماسة ولا سيما في أوج الفتنة التي أشعلها فيَّ سر الحلم وما يحيط به. وكنت أعمد الى جمع كل ما يقع تحت يديّ عن الحلم من كتب ومقالات وقصاصات بالعربية والفرنسية أو مترجمة الى العربية. إنها قراءات انتقائية أتخيّرها لأقع فوراً على ما أنشده. وأعترف أن كتباً عدة لم أقرأ فيها سوى ما دار حول الحلم والرؤيا والنوم… ولعل هنا تتبدى مزايا هذا النص الحر، المفتوح، الذاتي والموضوعي في آن واحد، الذي رسم مسلكه بنفسه بعيداً من أي منهج أو طريقة مسبقة. هذا نص مفتتن بالحلم وما يجاوره، وكذلك بأطرافه الدانية والقصية.
هل تفسَّر الأحلام؟
هل يُفسَّر الحلم؟ هل “تُعبّر الرؤيا”، بحسب المقولة الاسلامية؟ اختلف العلماء والفلاسفة حول هذه القضية وحول طريقة التفسير والتعبير وغاياتهما، لكنّ الاختلاف لم يعن البتة عدم إمكان التفسير والتعبير، بل إن التجارب في هذا الحقل جمّة. حتى علماء النفس المعاصرون عمدوا الى تحليل أحلامهم وأحلام مرضاهم وصولاً الى الحقائق المكبوتة أو الخفية. في التراث العالمي، لا تُحصى الكتب التي وُضعت في هذا الحقل وهي تزداد على مرّ الأعوام تبعاً لرواج ظاهرة تفسير الأحلام وإقبال البشر عليها في ما يشبه الولع بمعرفة خفايا المستقبل. أما التراث العربي فيزخر بتفاسير عدة بعضها صدر في كتب وبعضها ظلّ مخطوطاً أو شفهياً، ووردت في “كشف الظنون” و”الفهرست” عناوين تصانيف معظمها بات مفقوداً. من أبرز التآليف كتابان هما “تفسير الأحلام الكبير” لإبن سيرين و”تعطير الأنام في تعبير المنام”، واللافت هنا أن هذين الكتابين الفريدين تفصل بينهما قرون، فالإمام ابن سيرين ولد في أواخر خلافة عمر بن الخطاب في البصرة وتوفي قرابة العام 110، بينما رافق الشيخ عبد الغني النابلسي العصر العثماني خلال نحو قرن فهو ولد عام 1050ه.(1641م.) وتوفي عام 1143ه. (1173 م.) وعاش حياة تختلف كل الاختلاف عن حياة ابن سيرين، رائد علم تفسير الأحلام، وتلقى علوماً ومعارف شتى وخبِر تجارب عميقة في التصوف والثقافة الدينية. ويتبدى الاختلاف بين الكتابين بيّناً، على رغم وحدة مآربهما وغاياتهما، ولا سيما في المفردات والمصطلحات وطريقة التفسير جراء اختلاف العصر، والتقدم الذي شهده القرن السابع عشر في كل الميادين. لكنّ “حداثة” تفسير النابلسي زمناً لم تتخطّ “قدامة” تفسير ابن سيرين الذي ما زال يعرف رواجاً واسعاً على خلاف تفسير النابلسي الذي ظلّ وقفاً على النخبة. غير أن الكتابين يكمل واحدهما الآخر ويحفلان بما يصعب تعداده من تآويل ومعان وشروح ورموز تجعل منهما خير مرجعين في هذا الحقل. وتبدو قراءتهما اليوم ضرباً من المتعة المصحوبة بوافر المعرفة والحكمة.
ابن سيرين
تبدو المقدمتان أو المقدمة و”خطبة الكتاب” اللتان وضعهما ابن سيرين بمثابة مدخل الى كتابه، على رغم صفحاتهما الإحدى والعشرين، مرجعاً من المراجع الرئيسة والقليلة التي استند اليها معظم الذين كتبوا عن الأحلام والرؤيا لاحقاً، وما يسمهما أنهما تضمّان القراءة الاسلامية لظاهرة الأحلام والرؤيا الى قراءات إخرى سابقة، عربية و”أجنبية”. وقيل إن ابن سيرين استوحى كتاب الإغريقي الشهير أرطميدوس. ويستهل ابن سيرين المقدمة عارضاً فيها معايير تفسير الأحلام والرؤيا والمقاييس التي على المعبر أو المفسر اعتمادها، مفيداً القارئ ان ما يُرى في المنام هو على قسمين، قسم من الله وآخر من الشيطان، وحجته قول الرسول “الرؤيا من الله والحلم من الشيطان”. لكنّ الله هو خالق كل ما يُرى في المنام من خير أو شر. وفي رأيه أن الرؤيا الصادقة في قسمين أيضاً، “قسم مفسر ظاهر لا يحتاج الى تعبير أو تفسير وقسم مكني مضمر تودع فيه الحكمة والأنباء في جواهر مركباته”. ويرى أن أصدق الرؤيا التي تحصل في الأسحار قبيل الفجر، وفي القائلة، في منتصف النهار أي القيلولة، و”أصدق الأوقات وقت انعقاد الانوار ووقت ينع الثمر وإدراكه، وأضعفها الشتاء”. في رأيه أيضاً أن رؤيا النهار أقوى من رؤيا الليل، وهذا رأي فريد حقاً. الطريف أن الرؤيا بحسبه، تتغير عن أصلها باختلاف هيئات الاناس وصناعاتهم وأقدارهم وأديانهم، وكأنه يبغي القول إن الرؤى لا تخضع لقانون ماورائي أو ديني، فالمسلم والمسيحي واليهودي على سبيل المثل، تختلف الرؤيا لديهم لاختلافهم دينياً. وهذه المقولة تفرّق أيضاً بين العرق والطبقة وسواهما. وفي “خطبة الكتاب” أو المقدمة الثانية يمعن ابن سيرين في قراءة الرؤيا دينياً، أي إسلامياً، وينقل عن حديث للرسول يقول فيه: “إذا اقترب الزمان تكدرت رؤيا المسلم، أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، والرؤيا ثلاث: الرؤيا الصالحة بشرى من الله عز وجل، ورؤيا المسلم التي يحدّث بها نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره، فلا يحدّث به وليقم فليصلّ”. ويتعرض ابن سيرين لبعض الرؤى النبوية ومنها رؤيا آدم وابرهيم ويوسف وموسى ورؤيا المصطفى.
تفسير النابلسي
أما الشيخ النابلسي فيفتتح مقدمة كتابه “تعطير الأنام في تعبير المنام” بجملة بديعة تستبطن فعل النوم قائلاً: “الحمد لله الذي جعل النوم سباتاً وخلق الناس أشتاتاً وبسط الارض لهم فراشاً وجعل الليل لباساً والنهار معاشاً…”. ثم يروح يحدد مفهوم التعبير والتفسير لافتاً الى كتاب مجهول رآه قبل أن ينطلق في صنع كتابه وهو لإبن غنّام ويعدّه السابق الى “هذا الأسلوب التام ولكنه مختصر لا يفي بغلة المتعطشين من ذوي الافهام”. أما مقدمته فبدت ذات روح شبه علمية في استعراضها المقولات الرئيسة في الرؤيا واستخلاصها أبرز المفاهيم الدينية والنبوية نظراً الى اعتمادها جلّ ما كُتب وصُنِّف في علم التعبير والتفسير. ويورد النابلسي في خاتمة كتابه عناوين الكتب والتصانيف التي وضعها علماء ومعبّرون كثيرون من أمثال الدينوري المعروف بالقادري وابن الدقاق المقري والخليلي الداري والمزني الشافعي وابن عمر السالمي والشيخ جمال الدين وسواهم. والمستهجن عدم ايراده كتاب ابن سيرين كأنه لم يقع بين يديه على رغم شهرته وذيوع اسمه واكتفى بجملة يقول فيها: “ونقل عن ابن سيرين رحمه الله تعالى انه كان إذا وردت عليه مسألة رؤيا مكث فيها ملياً من النهار…”. ولعل هذا ما يؤكد عدم اطلاعه على كتاب ابن سيرين الفريد والسبّاق.
يتطرق النابلسي في مقدمته الى الرؤيا الصادقة، وهي في رأيه خمسة أقسام، انطلاقاً من القرآن والحديث والمأثورات النبوية، وكذلك الى الرؤيا الباطلة وهي في سبعة اقسام، وأطرف قسم هو الحلم الذي يوجب الغسل ولا تفسير له. هذا الحلم أشار إليه أكثر من مرجع ديني، وغالب الظن أنه يعني الاحتلام في النوم، وهو ما يوجب دفق ماء اللذة ويفترض من ثمّ الاغتسال. هذا الاحتلام الليلي “الباطل” اسلامياً، يسمّى بالانكليزية “الحلم الرطب”. ويرى النابلسي أن الرؤيا يراها الانسان بالروح ويفهمها بالعقل، ومستقرّ الروح نقاط دم في وسط القلب ومستقرّ القلب في رسوم الدماغ و”الروح معلّق بالنفس فإذا نام الانسان امتدّ روحه مثل السراج أو الشمس فيرى بنور الله وضيائه تعالى ما يريه ملك الرؤيا”. ويضيف: “فإذا عادت الحواس باستيقاظها إلى أفعالها ذكر الروح ما أراه ملك الرؤيا وخيل له”.
لعل قراءة متون كتابَي ابن سيرين والنابلسي، تمثل متعة بذاتها، فهما يجعلان من التفسير والتعبير ضرباً من الفن والتفنن ناهيك بالحكمة والتأمل والمضي في التأويل والتشبيه والمقارنة، حتى لتغدو مادة المعجمَين ابداعية ولا سيما في اللغة وبيانها. ولعل هذه الخصال هي مما يضفي عليهما مواصفات العمل الأدبي الذي يتخطى معايير الأدب القديم ويمضي في ابتداع لغة هي بنت العصر وخارجة عنه في آن واحد، بموضوعاتها وألفاظها وتراكيبها ونسيجها (كأنهما يحلمان عبر الكتابة).
المنهل الإغريقي
غير أن معظم الباحثين في هذا الحقل غالباً ما يشيرون الى كتاب أغريقي قديم كان له أثر في علم تفسير الأحلام عربياً وعالمياً، ويدعى صاحبه أرطميدورس (أو أرطاميدورس أو أرتميدورس) ويقال إنه أول كتاب وجد في التاريخ عن تفسير الأحلام. وقد ترجم هذا الكتاب في العصر العباسي وراجت ترجمته بين العلماء والفلاسفة المسلمين والعرب. ويعزو ارطميدورس الأحلام، مثله مثل بعض الجماعات، الى تدخل الآلهة وعالم الغيب، لكنه يدرجها في خانتين: الاحلام الصريحة والسافرة التي تنبئ عن الغيب مباشرةً، والأحلام الرمزية أو المقنّعة التي تتوارى خلف إشاراتها. اهتمّ أرطميدورس بالأحلام المقنّعة ووضع لها معايير وقواعد لتفسيرها وتأويلها. ويرى أن الرموز في الأحلام تستمد جذورها من شخصية الحالم ومن ظروفه وأحواله والعادات التي تهيمن على بيئته، مما يتطلب من مفسر الأحلام الاطلاع على هذه المجريات وفهمها كي يتمكن من تفسير رموز الأحلام وإشاراتها. ويقول الكاتب العراقي علي الوردي في هذا الصدد: “حين نقرأ كتب أرطميدورس نجد شبهاً غريباً بينها وبين الكتب المنتشرة بين المسلمين في تأويل الاحلام”. عاش الإغريقي أرطميدورس في افسس قرابة العام مئة ق.م. كتابه في تفسير الأحلام يتألف من أربعة اجزاء ونُقل الى لغات اوروبية عدة بعدما طُبع باليونانية رسميا في العام 1518 ومنها اللاتينية (1539) والايطالية (1547) والفرنسية (1634). أما الترجمة العربية للكتاب فأنجزها المترجم السرياني الشهير حنين بن اسحق في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) بحسب ما ورد في “فهرست” ابن النديم. لعل أحد محققي هذه الترجمة العربية القديمة الباحث الأكاديمي اللبناني الأب توفيق فهد، الأستاذ في جامعة ستراسبورغ الفرنسية. هذا الكتاب الذي يعدّ الكتاب الرائد في علم تفسير الأحلام كان له عميق الأثر في معظم الكتّاب والمفسّرين العالميين والعرب، قديماً وحديثاً. وقد جعلت منه ترجمة حنين بن اسحق إلى العربية واحداً من المراجع الأبرز بين أيدي الفلاسفة والعلماء العرب. في العصر الحديث عرف هذا الكتاب شهرة في أوساط العلماء النفسانيين ولقي لديهم ترحاباً، وكان فرويد نفسه كال له المديح في كتابه “الأحلام وتفسيرها”.
لكنّ السؤال الذي طالما راودني وما فتئ هو: هل ينبغي تفسير الاحلأم؟ ألا يكفي المرء أن يبصر أحلامه ويعيشها بما تختزن من سحر ومن أسرار تظل أسراراً ولا تحتاج الى أن تخرج الى الضوء؟ لم يقل الحلم لنا يوماً لماذا وجد. لم يبح يوماً بلغز وجوده. ولا من أين يأتي ولا إلى أين يذهب. قال لنا: هذا أنا احلموني. احلموني فقط.
هل يمكن حقاً تفسير الأحلام؟ هل يمكن وضع معاجم وقواميس- بات بعضها الكترونيا- تفسر كل ما يبصر الحالم وتوجد لكل عنصر أو رمز أو صورة تفسيراً أو تأويلاً واحداً في منأى من طبيعة الأشخاص الحالمين؟ مَن يقدر على تفسير تلك المشاهد الغريبة التي تطل علينا في عمق الغفوة؟ تلك المناظر العجائبية التي لا نعرف من أبدعها بجمالها الرهيب وغرابتها التي لا يمكن تصورها؟ مناظر يلتقي فيها ما لا يخطر في بال، شوارع لم يرها المرء مرة، بيوت يقطنها أناس لا يشبهوننا، حقول يملأها عشب لم تطأه قدم من قبل، غابات وحدائق، أشخاص لا أحد يدري مَن خلقهم ورماهم هناك، شواطئ ورمال ومراكب كأنها في أقصى واقعيتها… صور لا يسهل ادراكها، يحتاج المرء أن يفرك عينيه كثيراً كي يبصرها. وجوه رُسمت بملامح غير مألوفة وتُركت هناك في تلك البلاد التي ندخلها ونخرج منها من دون علمنا أو مشيئتنا. أحلام كأنها وجدت لئلا نسأل كيف ولماذا.
ما جدوى تفسير الأحلام في كتب تتناولها الأيدي كما لو أنها مراجع لا بد منها. هل يمكن اختزال الشجرة على سبيل المثل في معنى أو رمز واحد؟ الشجرة التي يحلم بها الحطّاب هل هي نفسها الشجرة التي يراها شاعر أو رسّام أو كاهن أو صيّاد أو تلميذ في حلمه؟ هل تعني الشجرة لابن سيرين ما تعنيه لفرويد أو يونغ؟ لا يمكن إخضاع الأشياء في الأحلام الى تفاسير مسبقة و”جاهزة”، فالحلم أصلاً هو ضرب من الالتباس الحسي والروحي، تتداخل فيه الأشياء وتختلط اختلاطاً عجيباً وتتآلف فيه الثنائيات والمتناقضات حتى الامحاء. لكنّ قراءة كتب التفاسير القديمة تظل حافلة بـ”الامتاع” و”المؤانسة” والخيال و”المعرفة”. وقد تشبه نصوص هذه الكتب أحلام اليقظة التي يصنعها الحالم بنفسه، منتقياً أحلامه كما يحلو له ويحسن. هذه الكتب وضعها علماء هم حالمون ولكن بوعي ويقظة وتأمل وتأويل… كأنهم يفسرون وهم على يقظة مما يتخيلون أنهم يحلمونه. بل كأنهم عندما يفسرون يتحدثون عن أحلام يرغبون في أن يبصروها هم. أتحدث هنا عن كتب التفاسير الحقيقية وليس عن الكتب ذات النزعة التجارية المنتشرة شعبياً، التي ليست غريبة عن تفاسير البصارات والبصارين الذين يصدّقهم كثر من البشر.
* فصل من نص طويل هو عبارة عن خاتمة لكتاب “غيمة أربطها بخيط: أحلام بأحلام” (يصدر قريباً).
النهار