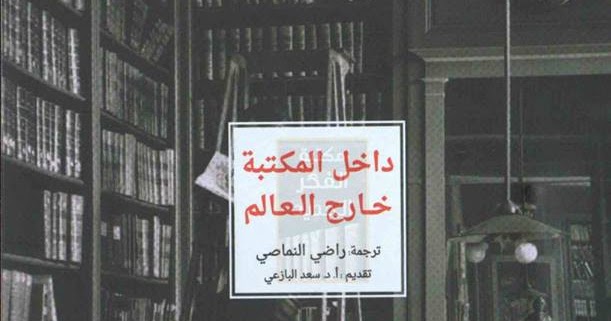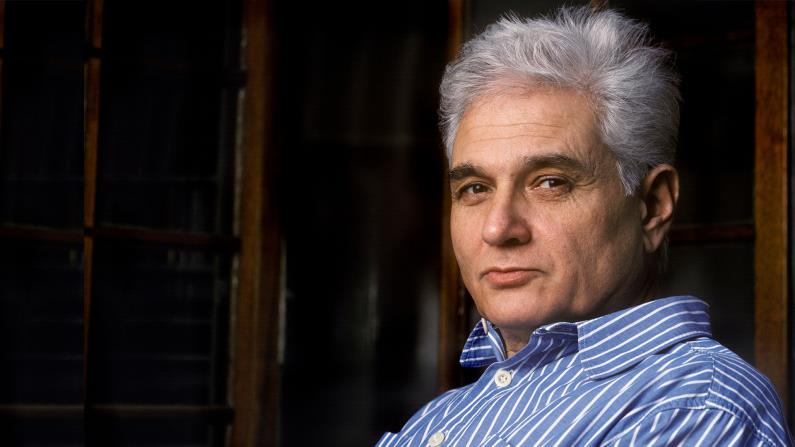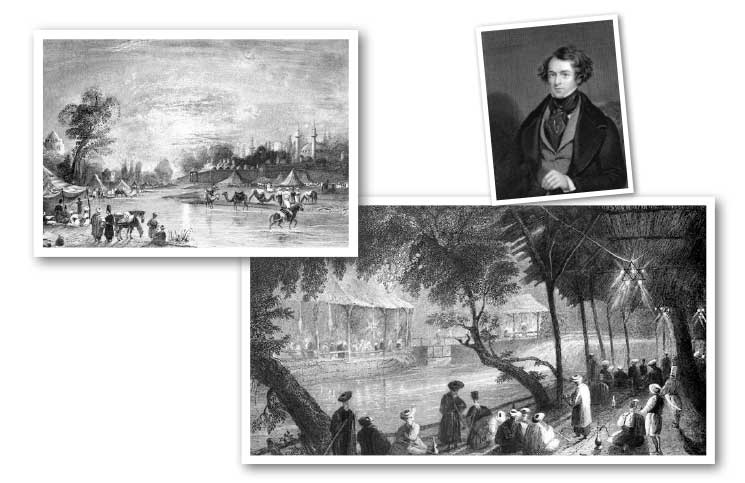السلطة والاستخبارات في سوريا” لرضوان زيادة
اغتيال الديموقراطية والحراك السلّمي
تهامة الجندي
“لماذا الثورة السورية؟” يتساءل رضوان زيادة في مقدمة الطبعة العربية من كتابه الجديد “السلطة والاستخبارات في سوريا”، ويجيب عن السؤال مستشهدا بكلام الصحافي البريطاني آلان جورج: “سوريا حالة مثالية للثورة، حيث اجتمع فيها الفشل السياسي مع الإخفاق الاقتصادي، فهي لم تحقّق لا الخبز ولا الحرية”، فضلا عن قصص فساد رجال الأعمال المحدثيّ النعّمة، الذين اعتمدوا بشكل رئيسي على التحالف مع الأجهزة الأمنية من أجل بناء ثرواتهم، التي تظهر حجم الهوة بين طبقة تزداد ثراء، ومجتمع يزداد فقرا، فهناك 30 في المئة من السكان تحت خط الفقر، وفق الإحصاءات الرسمية (قبل الخروج إلى ساحات التظاهر)، وإذا كانت الثورة قد تأخرت، فيعود ذلك إلى “ذاكرة الخوف” التي ترسّخت لدى السوريين بعد أحداث حماه الثمانينات، التي خلّفت أكثر من 30 ألف قتيل، وما يزيد عن 125 ألف معتقل سياسي، و17 ألف مفقود، لا يعرف ذووهم مصيرهم حتى الآن، ناهيك عن سير التعذيب المرعبة (ص26).
يتكوّن الكتاب من خمسة فصول، تتناول مرتكزات “حكم البعث” في إدارة شؤون الاقتصاد وسياسة البلد الداخلية والخارجية، منذ أن تولى سدّة السلطة في سوريا يوم الثامن من آذار 1963، مع التركيز على فترة رئاسة بشار الأسد لمقاليد الدولة، وهي المرحلة التي تزامنت مع تخنّدق المعارضة السورية حول قضايا التحوّل الديموقراطي ومفهوم “المجتمع المدني” بوسائل سلمية علنية، الأمر الذي عكس نفسه جليا في شعارات “ثورة الحرية”: دولة مدنية بدستور جديد، يكفل الحقوق والحريات العامة لجميع المواطنين من دون تمييز بين الأديان والطوائف والإثنيات.
في سياق بحثه، يشير المؤلف إلى أن تاريخ الدولة السورية الحديث يمكن تحقيبه في ثلاث جمهوريات: “الجمهورية الأولى” انطلقت بعد الاستقلال عام 1946، وحاولت أن تحاكي النموذج الفرنسي في نمط بناء الدولة والمؤسسات والدستور. ويُعتبر دستور 1950 من أول الدساتير في المنطقة العربية، الذي أتاح الحريات العامة ضمن مبادئ التعددية الحزبية، والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان في الكثير من مواده. وفي هذا الإطار، مُنحت المرأة السورية حق التصويت عام 1949، وحق الترشّح عام 1953.
“الجمهورية الثانية” دشّنها قيام دولة الوحدة بين مصر وسوريا (1958-1961)، وفيها تم حلّ الأحزاب السياسية والبرلمان السوري، وتم تقييد الصحافة. أما الثالثة، “جمهورية الثورة” فجاءت باستلام حزب البعث للسلطة، وما زالت قائمة حتى اليوم على مبدأ التماهي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتحقيق التراتب الهرمي في بناء أجهزة الدولة، بحيث تتركز سلطة القرار في قمة الهرم الذي يمثله قائد “الثورة”، وكذلك الدمج بين مؤسسات الدولة وميزانيتها وبين التنظيم السياسي الحزبي. وقد وضع قواعد هذه الجمهورية الرئيس الراحل حافظ الأسد عن طريق إعادة كتابة الدستور السوري، وهيكلة مؤسسات الدولة، لضمان التفرّد في آلية صنع القرار.
أنشأ الأسد “مجلس الشعب” عام 1971 وقام بتعيين أعضائه. أسس “الجبهة الوطنية التقدمية” عام 1972 كصيغة من صيغ التعددية السياسية، وتتألف من “الحزب الشيوعي السوري” بجناحيه، “الاتحاد الاشتراكي العربي”، “حركة الوحدويين الاشتراكيين” و”حركة الاشتراكيين العرب”.. وجميع أحزاب الجبهة تعترف بقيادة البعث لها، ويُحظر عليها العمل في أوساط الطلبة والعمال. أما المعارضة السياسية فلم تحظَ بالاعتراف، وتعرّضت إلى حملات قمع كثيرة، بدأت باعتقال صلاح جديد والمحسوبين على جناحه أو “جناح العراق” والإخوان المسلمين، وصدر بحقهم القانون 49 الذي يقضي بإعدام كل من ينتسب إلى الجماعة، ولا ينسحب منها خطيا خلال شهر واحد، كما طُبقت سياسة “الذراع الطويلة” لتصفية معارضي الخارج.
إلى ذلك تم اتباع سياسة “التبعيث” وتأطير المجتمع في هيئات شعبية موالية، هدفها ضبط الحركة المطلبية، مثل “طلائع البعث” واتحادات (شبيبة الثورة، الفلاحين، العمال، النسائي..)، كما تم حلّ النقابات المستقلة (الأطباء، المحامين، المهندسين) بعد أن أعلنت إضرابا عاما للمطالبة بالحريات الأساسية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ووُضعت عوائق أمنية مشدّدة لمنع قيام هيئات مدنية مستقلة. وبعد أن كانت سوريا من أوائل الدول العربية المبادرة إلى تأسيس الجمعيات والمنظمات الأهلية، أضحت الأفقر في عهد الأسد، إذ لم يتجاوز عدد الهيئات غير الحكومية 750 منظمة وجمعية عام 1999.
عام 1973 تم الإعلان عن دستور جديد بنظام رئاسي، بدل دستور 1969 المؤقت، الذي كان يربط السلطات التشريعية بالحكومة، ويمنح الدستور الجديد رئيس الجمهورية (الأمين العام لحزب البعث) الحق في قيادة الدولة والمجتمع (المادة الثامنة)، قيادة الجيش والقوات المسلحة (المادة 103)، وضع سياسة الدولة الخارجية (المادة 94)، وصلاحيات الرئيس تتجاوز الصلاحيات التنفيذية إلى التشريعية، فهو يملك حل مجلس الشعب (م107) والتشريع في غير دورات انعقاده (م111)، رد القوانين، تعيين نائب له أو أكثر، تعيين رئيس مجلس الوزراء وأعوانه والوزراء، وإعفاء كل هؤلاء من مناصبهم، إعلان حالة الحرب (م100) إعلان حالة الطوارئ وإلغائها (م101)، (ص 57).
والأذرع التي مكّنت رأس الهرم من بسط السيطرة على شؤون العباد والبلاد، تشكّلت من: الإدارات الحكومية، فروع حزب البعث، والأجهزة الأمنية. فالمحافظون الأربعة عشر ينفذون أوامر الرئيس مباشرة، وهم يهيمنون ويشرفون على أعمال الإدارات الحكومية والقطاع العام في المحافظة وما حولها من مناطق وقرى، وفي حالات الطوارئ يكون المحافظ قائداً لقوات الشرطة والجيش المتمركزة في محافظته، وبموازاة المحافظ يكون أمين فرع حزب البعث، ومهمة الفروع مراقبة أعمال الإدارات وجميع المؤسسات التعليمية والثقافية والصحية، يتوجهون بتقاريرهم إلى قادة الفروع، وجميع هذه الأنشطة تكون ضمن مراقبة أجهزة الأمن التي رجحت الموازين لصالحها مع مرور الزمن، وهي: “الاستخبارات العامة” (أمن الدولة) تتبع وزارة الداخلية، “الأمن السياسي” دائرة في وزارة الداخلية، “استخبارات القوى الجوية”، و”الاستخبارات العسكرية” تتبعان إسمياً لوزارة الدفاع، ويشرف على هذه الأجهزة “مكتب الأمن القومي” التابع للقيادة القطرية لحزب البعث، وتمتلك أجهزة الأمن مراكز عمل في العاصمة، وفروعا في جميع المحافظات، تضم 65 ألف موظف بدوام كامل، وعدة مئات من الألوف بدوام جزئي، بمعدل عنصر لكل 257 مواطناً.
والمفارقة التي يشير إليها الباحث أنه على الرغم من سيطرة حزب البعث على مفاصل الدولة، وإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء الصحافة الخاصة، فالمراقب للحياة الثقافية السورية في نهاية الستينات وأوائل السبعينيات، يلحظ جهدا معرفيا مميزا للمثقفين السوريين في كافة المجالات، كجهود ياسين الحافظ وإلياس مرقص، فيما يسمى البعد الديموقراطي في الممارسة القومية، وجهود جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة بمجموعة من الفقهاء، أمثال: مصطفى الزرقا، علي الطنطاوي، محمد المبارك، فتحي الدريني وغيرهم، فيما أصبح يُطلق عليهم بـ “المدرسة الفقهية الشامية” التي عُرفت باعتدالها ومرجعيتها الرصينة، وجهود بعض منظري الحزب الشيوعي لفك الارتباط بالاتحاد السوفياتي، وإعادة النظر بالماركسية في المسألة القومية والوطنية.
في سياق تناوله لما يُعرف بـ”ربيع دمشق”، الذي تزامنت انطلاقته مع انتقال السلطة من الأب إلى الابن بشار الأسد في حزيران 2000، يعيد زيادة ارهاصات الربيع إلى نهاية فترة الرئيس الأب، وتصاعد الاستياء الشعبي من الفساد وركود الأوضاع اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وتجلى ذلك في منتديات الحوار العلنية، الرسمية “جمعية العلوم الاقتصادية السورية”، والأهلية منتدى “أبو زلام” للدراسات الحضارية. كما أن استئناف مباحثات السلام مع إسرائيل أطلق نقاشا حاميا حول مسائل التطبيع وموقف المثقف منها. ومع فشل المفاوضات، تجدد الحديث حول الفساد والإصلاح، وأخذ طابعا دراماتيكياً مع عزل رئيس الوزراء الأسبق محمود الزعبي، وفصله من الحزب، ثم انتحاره في أيار مايو 2000. وسبق ذلك انتخابات الدورة التشريعية السابعة لمجلس الشعب (1999-2003) ودخول النائبين رياض سيف وعارف دليلة عن دمشق، مطالبين بتعديل قانون الانتخابات، وتفعيل دور المجلس في المراقبة والمحاسبة.
بعد انتقال السلطة إلى بشار، وخطاب القسم في 17 تموز 2000، أضحى مفهوم “المجتمع المدني” مدخلا للتحوّل الديموقراطي لدى النخب المتحاورة، وجاءت فكرة تأسيس “جمعية أصدقاء المجتمع المدني” التي انبثقت عنها “لجان إحياء المجتمع المدني”، فيما افتتح رياض سيف “منتدى الحوار الوطني” في 13 أيلول 2000، بمحاضرة لأنطون مقدسي، المفكر السوري الذي كان قبل ذلك بشهر قد وجه رسالة إلى الرئيس عبر صحيفة “الحياة”، تعتبر الأولى من نوعها، أدت إلى فصله من موقعه كمدير لهيئة التأليف والترجمة والنشر.
وفي 27 أيلول من العام ذاته وقع المثقفون السوريون بيانهم الأول المعروف بـ”بيان الـ99″ داعين إلى إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية المطبقة في سوريا منذ 1963، وإصدار عفو عام عن كافة المعتقلين السياسيين، والسماح بعودة المنفيين، وإرساء دولة القانون، وإطلاق الحريات العامة والاعتراف بالتعددية السياسية وحرية الاجتماع والصحافة والرأي. وكانت استجابة السلطات الرسمية إيجابية، فلم يتعرض أي من الموقعين لأية ضغوطات أمنية، بل تم الإفراج عن 600 معتقل سياسي في تشرين الأول، وكانت الصحف الرسمية أول من نشر الخبر، في اعتراف رسمي أول بوجود معتقلين سياسيين في السجون السورية.
انتشرت المنتديات كـ “المنتدى الثقافي لحقوق الإنسان”، ومنتدى “جمال الأتاسي للحوار الديموقراطي”، وفتحت جريدة “الثورة” الرسمية برئاسة محمود سلامة صفحاتها لسجالات المثقفين حول المجتمع المدني، ثم وُقع “بيان الألف” الذي أدان بشدة حكم البعث على مدى ثلاثة عقود، وتم الإعلان عن تأسيس “التجمع من أجل الديموقراطية والوحدة” كحزب سياسي معظم أعضائه من الناصريين القدامى، ثم أعلن كريم الشيباني عن “الحزب الوطني الديموقراطي” في 18 كانون الثاني 2001، كمؤشر لقرب صدور قانون الأحزاب، ما دفع رياض سيف للإعلان عن تأسيس “حركة السلم الاجتماعي” في 31 كانون الثاني 2001، كحزب ليبرالي لا يعمل تحت مظلة “الجبهة الوطنية التقدمية”، ثم بدأ الأمن بالتضييق على المنتديات وإغلاقها، واعتقال أبرز ناشطي “ربيع دمشق” في أيلول 2001: النائب مأمون الحمصي، رياض الترك ورياض سيف.
ويلاحظ المؤلف أن هذا الحراك على محدوديته أفرز تبلورا مغايرا في اتجاهات العمل السياسي: العلنية والسلمية، فالنخب المثقفة والنشطاء بدوا متفقين على رفض كل أشكال العمل السري، التي اعتادوا عليها خلال الفترات السابقة، ويمكن رصد هذا التحول في وثيقتين، فقد أعلن “الإخوان المسلمون” في أيار 2001 مشروع “ميثاق شرف وطني للعمل السياسي”، أكدوا فيه تمسكهم بالحوار وآليات العمل الديموقراطي ونبذ العنف وحماية حقوق الإنسان، كما أكد البرنامج السياسي لحزب الشعب الديموقراطي (الحزب الشيوعي-المكتب السياسي سابقا) الاحتكام إلى الديموقراطية كخيار نهائي.
مع نهاية عام 2001 بدا أن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على أوضاع جديدة، بعد انتخاب شارون رئيسا للوزراء في إسرائيل أوائل العام، وأحداث الحادي عشر من أيلول في أواخره، ومن ثمة الغزو الأمريكي للعراق 2003، حينها تصاعدت الضغوط الدولية على سوريا إلى حد التهديد بتغيير رأس النظام، لعلاقتها بالمنظمات السلفية الجهادية: الفلسطينية “حماس” و”الجهاد الإسلامي” و”حزب الله” في لبنان، ثم الشكوك في ضلوعها باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وهو الحدث الذي أدى إلى انتحار وزير الداخلية غازي كنعان وانشقاق نائب الرئيس عبد الحليم خدام. في هذه الأثناء، حاولت المعارضة المطلبية الانتقال إلى شكل من أشكال العمل السياسي المنظم عبر “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي” في أيار 2005، الذي تزامن مع عقد اجتماعات دورية بين مجموعة من مثقفي لبنان وسوريا لمناقشة العلاقة بين البلدين، أسفرت عن “إعلان دمشق-بيروت” في أيار 2006 الذي دعا إلى احترام وتمتين سيادة واستقلال كل من الجارين في إطار علاقات ممأسسة وشفافة تخدم مصالح الشعبين، فكان رد السلطات تشديد القبضة على الناشطين واعتقال العديد منهم، أبرزهم ميشيل كيلو وأنور البني.
حسب رضوان زيادة، لم يهدأ الحراك السلمي طوال فترة حكم الرئيس بشار، لكن الانتقال إلى “الجمهورية الرابعة” رهن بانتصار الثورة السورية، فهي تهدف إلى تحقيق إصلاح سياسي جذري، يؤكد على التعددية السياسية، حقوق الإنسان، والفصل التام بين السلطات الثلاث، مع إصلاح الجهاز القضائي، وضمان حرية الإعلام والرأي، وحماية حقوق الأقليات لا سيما الأكراد. وفي تحليله لبنية الثورة يرى أنها: انتفاضة شعبية غير منظمة، من دون قيادة محدّدة، لا تدين بأي أيديولوجيا، لعب المسجد دوراً محورياً كنقطة لانطلاق التظاهرات، وليس لتوجيهها، فبحكم القبضة الأمنية المشدّدة، كان يستحيل وجود حالات منظمة أو شبه منظمة لحركات شعبية، حتى ولو نشطت في السر، وهو ما يفسّر عشوائية عارمة في مناطق خروج التظاهرات، وفي طريقة رفع الشعارات، وإن تمحّورت جميعها على مطلب الحرية والكرامة. وكان من الطبيعي بعد ذلك أن يخرج قادة ميدانيون في كل مدينة، قادرون على تنظيم وتصعيد الاحتجاجات، يتميزون بخطاب صلب مناهض للنظام، شجّع الكثيرين للخروج إلى التظاهر. وهؤلاء القادة الجدد ينتمون إلى الطبقة الوسطى ذات التحصيل العلمي العالي، ويشكلون أحد مكونات المعارضة السورية الفاعلة على الأرض، وهم إما معتقلون، أو يعيشون متخفين خشية الاعتقال.
يُضاف إلى هؤلاء، نشطاء الإنترنت، والنشطاء الحقوقيون الذين أبدوا قدرة رائعة على كشف انتهاكات حقوق الإنسان، وإيصالها إلى المنظمات الحقوقية الدولية، ثم دور معارضة الخارج الأساسي والمحوري في إيصال صوت السوريين إلى الخارج عبر وسائل الإعلام. (ص35).
المعارضة التقليدية هي المكون الآخر في بنية الثورة السورية، وتشمل: شخصيات معارضة مستقلة، جماعة “الإخوان المسلمين”، الأحزاب المعارضة التي أُبعدت عن أو رفضت الدخول في “الجبهة الوطنية التقدمية”، ثم انتظمت فيما يُسمى “التجمع الوطني الديموقراطي” عام 1983، وهي: “حزب الاتحاد الاشتراكي”، “حزب الشعب الديموقراطي”، “حزب العمال الثوري”، و”حزب البعث العربي الاشتراكي الديموقراطي”، وجميعها تجتمع تحت مظلة “إعلان دمشق”، ولم تلعب دورا يُذكر في قيادة التظاهرات، أو حتى التحريض للانخراط بها، لكن رموزها يتمتعون بالخبرة السياسية الضرورية في عمليات التفاوض وإدارة المرحلة الانتقالية القادمة، وربما لهذا السبب قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم.
ولأن المعلومات الواردة في الكتاب حول الثورة السورية، كُتبت في مرحلة مبكرة من عمرها، فهي معلومات باتت معروفة وناقصة في الآن ذاته، إذ إنها لم تواكب التطورات اللاحقة من تشكيل ألوية الجيش الحر، عسّكرة الثورة، وسياسة الأرض المحروقة التي يتبعها النظام السوري لسحق المعارضة المسلحة.
[ “السلطة والاستخبارات في سوريا”، دراسة في 347 صفحة قطع متوسط.
[ المؤلف: رضوان زيادة
[ الناشر: دار رياض الريس، بيروت 2013.