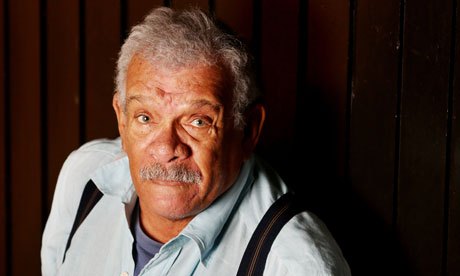السيناريوهات الثلاثة المتخيلة لنهاية الأبدية – 2005
نشر المقال بالتزامن في (صحيفة القدس العربي اللندنية) (صحيفة النهار- الملحق الثقافي) 17/4/2005
منذر مصري
كأنها بطلت، كأنها بطلت تماماً، تلك المراهنة على إمكانية مباشرة النظام السوري بمشروع إصلاح وطني كامل. أ كانت من داخله، حيث كان يقال إن هناك طرفاً إصلاحياً في جسد النظام بالذات لديه مصلحة في الإصلاح، ربما كان هذا الطرف رأس النظام بالذات، الذي توسمت فيه رغبة التغيير التي يحملها الشباب، أم بتأثير ضغوطات داخلية وخارجية، كان يعتقد أنه، لا بد في النهاية، لأي نظام مهما تيبّس ومهما تسوّر، أن يستجيب لها.
منذ أول عهد الأسد الابن، ووراثته لسوريا، نظاماً وشعباً وأرضاً، وكل ما يجرجره ذلك الإرث من ركام، أبدى النظام، المعروف برفضه القاطع لكل ما يأتي من خارج قاموسه اللغوي، تحسساً زائداً من مجرد ورود كلمة أصلاح. ففي اليوم السابع رأى الربّ كل شيء حسناً وليس في الجنة السورية عيوب صنع أو أعطال ضمن فترة الضمان المكتوبة على العبوة، تستدعي أن تصلح أو تبدل. إلاّ أنه بسبب ظروف طارئة خارجة عن الإرادة في المنطقة وفي العالم، أقرّت وأعلنت حاجة هذا القطاع أو ذاك لبعض العمليات التجميلية في القسمات، يمكن القيام بها تحت شعار، والنظام السوري سيد الشعارات بلا منازع في المنطقة العربية على الأقل: (التطوير والتحديث). أمّا شعار التغيير فقد أفهم النظام الجميع، دون لبس، أنه يعتبره بمثابة محاولة انقلابية!. وقد جارته المعارضة السورية بكل أطيافها، ما عدا بعض الاستثناءات، وخاصة من قبل بعض المعارضين الذين خارج البلد، في هذا الاعتبار. هي التي خبرت ماذا فعل وماذا يستطيع أن يفعل بالخارجين عن قاموسه، متخذة موقف الوسط، ومطالبة بإصلاحات تدريجية فيه، لغاية في نفسها، لكنها أكثر ما تكون مكشوفة للطرف الثاني بالذات، أن تؤدي هذه الإصلاحات، شيئاً فشيئاً، إلى التغيير المأمول في النظام. ولخمس سنوات مضت جرت خلالها أحداث كثيرة، توسلت، إن لم أقل استجدت، هذه المعارضة من النظام أن يبدأ بأي إصلاح، سياسي أو أمني أو اقتصادي أو إداري أو قضائي أو تعليمي… لكنه لم يفعل. لم يفعل سوى أن يثبت لها وللجميع عدم رغبته، وعدم قدرته، وعدم مصلحته، إصلاح أي شيء، ولا حتى نفسه.
أحسب أن بداية العدّ التنازلي للنظام السوري من قبل العامل الخارجي، الولايات المتحدة الأمريكية كحكم حلبة فيه، قد فوت الوقت على كل من النظام والمعارضة، ليتابعا لعبة شد ورخي الحبل، غير المتكافئة، حتى نهايتها اللاّ منظورة. كما أغلق كوة المراهنات على خياري الإصلاح أو التغيير، لم يكونا يوماً من خيارات النظام. إن وصول سوريا إلى هذه النقطة الحرجة، عنق الزجاجة الضيق جداً، لم يكن بسبب ما آل إليه الهيكل المفرغ لنظامها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ولا بسبب علاقة هذا النظام المشروخة مع شعبه، ولا بسبب تفشي الشعور بالضيق والتململ والرغبة بالانعتاق لدى هذا الشعب. أقصد ليس بسبب ما يمكن تسميته بالعامل الداخلي، كما ليس بسبب العامل الإقليمي، المتمثل بضعف الدور السوري في المنطقة بعد خروجه من لبنان وخسارته للرهينة اللبنانية، وما يبدو أنه تراجع، أو حتى تدهور، في علاقاته مع عدد من الدول العربية، مصر والمملكة السعودية أهمها. دون أن ننسى العراق!. وإسرائيل التي ما زالت إسرائيل وما زالت تحتل ومنذ ما يقارب الأربعين سنة جزءاً كبيراً من أراضيه وما عادت تهتم كثيراً بإعادتها له. إلاّ أن كل ذلك، كان يمكن للنظام السوري التعامل معه والخروج منه سليماً أو بجراح طفيفة على طريقته، لولا تدخّل العامل الخارجي (الدولي) الضاغط والفظ. فبعد مساندة سوريا للنظام العراقي، ومعارضتها الحرب التي شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والتي انتهت إلى الإطاحة بنظام صدام حسين توأمها القومي والسياسي، ثم تأييدها لما أطلق عليه المقاومة العراقية ومطالبتها الملحة في كل مناسبة بخروج هذه القوات من العراق، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون محاسبة سوريا، ثم قامت بتصعيد المواجهة مع النظام السوري وصولاً للتلويح بمشروع قانون تحرير سوريا، واعتبار حزب البعث القائد للدولة والشعب بمادّة من الدستور حزباً إرهابياً. ومن جهة أخرى صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم /1559/ القاضي بخروج سوريا من لبنان جيشاً وأمناً بمبادرة فرنسية واستجابة أمريكية سريعة. ثم نشر تقرير بعثة تقصي الحقائق في جريمة اغتيال رفيق الحريري، إلى قرار مجلس الأمن /1595/ في السابع من هذا الشهر (نيسان) بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بكافة الصلاحيات التي تؤمن الوصول إلى معرفة مرتكبي الجريمة. كل ذلك بإجماع دول العالم لم يحصل مثله يوماً. الأمر الذي عبّر عنه بغصة الرئيس الأسد (بدون ابن كما بات الاسم يردد دائماً) في خطابه الأخير في مجلس الشعب بقوله: (إننا نعيش في عالم ليس فيه قانون.. ولا فيه ميزان عدل). وكيف أنه (في كل جريمة هناك عدّة احتمالات إلاّ في هذه الجريمة لم يكن هناك إلاّ احتمال واحد وهو سورية!).
يكاد يكون هذا كلام كله معروفاً. كما هو معروف أيضاً، حرص النظام السوري الشديد على نفي، اجتثاث، أي بديل محتمل له، من خارجه أو من داخله. فما أتاحه من داخله هو وراثته، بالمعنى السياسي حصراً وهو الأهم، أي بمتابعته، كما كان وكما هو الآن وكما سيبقى إلى اللانهاية، إلى الأبد، حتى بالاسم. لأنه حقّاً لم يكن شعار (الأسد للأبد) كغيره من الشعارات السورية، لوحة ثابتة على جدار، أو لافتة ترفع في المسيرات، أو ثلاث كلمات مقفاة يفتتح بها الشعب السوري حياته كل صباح. كان (الأسد للأبد) النظام برمته، كان الإستراتيجية الحقيقية لسياسته الداخلية والخارجية، ولكل برامجه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن إيغاله في أبديته، اجتثاثه للبدائل، اجتثاثه لاحتمالات البدائل، جاء نفيه للنهايات، إعدامه لكل نهاية محتملة، أو حتى متخيلة له، إعدامه النهائي للنهايات أجمع. وها نحن الآن نقف، جميعنا، حائرين في معرفة ماذا ينتوي فعله، حائرين أي قرار سيتخذه، حائرين، أية خطوة سيخطوها، وفي أي اتجاه.. وأية نهاية من أي نوع، اضطرارية أو غير اضطرارية.. سوف يختارها؟
قلت اضطرارية، لأن ما يفسّر نهج النظام السوري الحالي وما يقوم به من أفعال ويقبل به من قرارت دولية، هو اضطراره أن يفعل وأن يقبل. وحتى في ما بقي، على عادته، يراوغ به، فإنه أيضاً مضطر لهذه المراوغة، ولو إلى حين. لكن عصر المراوغات ربما، أقول ربما، قد انتهى، وربما ما عاد العالم، عن حقّ أو بطل، يتقبل وجود نظام خارج عن قاموس العالم هذه المرّة. أو بتعبير معاكس، ما عاد العالم يتقبل بوجود فوضى في نظامه. وهكذا، بناء على معادلة الاضطرار والمراوغة الاضطرارية ترسم المخيلة السياسية لمتتبعي الوضع السوري نهايات أشبه بتنبؤات، يختلف حولها الجميع، ولكن لا أحد يستطيع الجزم أن أياً منها سوف يحدث. لا بل البعض يجزم أن أياً منها سوف لن يحدث، وبدوري أجد أني أقرب إلى هذا الاحتمال، ولو لزمن طال أم قصر. وهي كما يبين العنوان يمكن حصرها بثلاثة سيناريوهات (كما درج المحلّلون السياسيون أن يعبّروا) أولها، وربما الأشدّ احتمالاً برأي الكثيرين:
التنازلات
سياسة البدء بالتنازلات، التخلّي التدريجي عن مراكز القوى السياسية والأمنية والإدارية، لمن؟ لمؤسسات الدولة القانونية وللعاملين فيها. البدء بالاستجابة لمطالب المجتمع السوري، وقف العمل بقانون الطوارئ العمل وإلغاء الأحكام العرفية، تفكيك الأجهزة الأمنية وحصر عملها بوظيفتها الأساسية وهي أمن المجتمع والبلد، إصدار قانون أحزاب يسمح بعودة الحياة السياسية لسوريا، إجراء انتخابات حرة لأعضاء مجلس الشعب، يتبعها انتخاب رئيس للبلاد من بين عدّة مرشحين تحت إشراف منظمات دولية، تعديل عدد كبير من مواد الدستور السوري حسب تغيرات ومتطلبات العصر، إلغاء المادّة الثامنة من الدستور التي تحصر السلطة بيد حزب واحد هو حزب البعث كقائد للدولة والمجتمع، إعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية شاملة لا عقائدية ضيقة.. إلى آخره إلى آخره.. ويرى من يرجح هذا الاحتمال، الذي يمكن أن نصفه أيضاً بالانسحاب التدريجي للنظام، أنه قد بدئ به فعلاً، فالنظام قد تخلّى عن كثير من آلياته القسرية، وهو يتيح للكثيرين قول وكتابة ما لو تلفظوا به في أحلامهم سنوات عقدي الثمانينات والتسعينات لما عرف النمل أمكنتهم، ويسمح بعقد اللقاءات والندوات المعلنة وشبه المعلنة بين أفراد وجماعات يتداولون النقاش في الشأن العام، كما أنه يعيد تنظيم مؤسساته الأمنية وقد أبدل بالفعل طرائقها في الاستدعاء والتحقيق، كما أطلق سراح آلاف المعتقلين السياسيين، حتى الحديثين منهم. إضافة لكون هذا الانسحاب التدريجي يؤمن النقلة الآمنة للنظام والمجتمع، من هذا الظرف الحرج شبه المغلق إلى ظرف يسير ومفتوح لتغيير الوضع السوري كلياً. وبالرغم من أنه يمكن فهم خيار كهذا، تبعاً لآلية الاضطرار تلك التي يفسّر بها البعض كل ما يقوم ويقبل به النظام، إلاّ أنه بدوره يتوقف على مقدار كبير من التصديق بأن سلامة البلد، الوطن، هي أولية مطلقة عند النظام. وكذلك على إعطائه المساحة الكافية من الوقت للقيام بهذه التنازلات على دفعات، وإلاّ فقد تذهب التصورات إلى السيناريو الثاني، وهو:
الانهيار
أي أن يختفي النظام فجأة ودفعة واحدة. أو على الأقل بسرعة مفاجئة، كأن تنحلّ بدون مراسم أو تحضيرات عقدة النظام الكبيرة، فيتفكك ويقع. أن يترك رموز النظام، هكذا دون أن يطلب منهم أحد، مواقعهم ويذهبون إلى مكان ما، إلى بيوتهم مثلاً أو إلى فنادق في أوروبا وروسيا ينتظرون فيها ما سوف يحدث، أو لا يبالون به على الإطلاق لأنهم في منأى عنه. وهنا ينقسم هذا السيناريو الفنتازي حقّاً عن سيناريوهين متعاكسين، ربما الأكثر واقعية، نمرة واحد، كما يقول أخوتنا المصريون: حدوث فوضى فظيعة، حالة عامة تتغلب بها الغرائز والهواجس على العقل والمصلحة. شيء كالحرب الأهلية مثلاً، وهذا أسوأ ما يمكن حدوثه لأي مجتمع، الكارثة التي يجب أن يعمل الجميع على تجنّبها بكل الطرق والوسائل. لأنه، وهذا ما أثبتته كل الحروب الأهلية، لا شيء يرتجى منها إلاّ بعض الدروس المأساوية، التي لا يحتاجها الشعب السوري أو أي شعب من الشعوب في العالم. نمرة (تنين): قدرة المؤسسات العريقة للدولة السورية، الوزارات والجيش والأمن الداخلي، مهما بلغ ما اعتراها من تخريب، على تدبير أمور الناس وحماية أرواحهم وملكياتهم. ريثما يتمّ تشكيل حكومة مؤقتة تدير شؤون البلاد لفترة وجيزة، يتبعها انتخابات حرة لمجلس نيابي ولرئيس جديد، وما إلى ذلك. يدعم هذا التفاؤل، كون الشعب السوري بطبيعته، بأغلبيته، شعباً واعياً، يعرف تماماً ما يفيده وما يضره. متلاحماً ومترابطاً، لم يقدّم في تاريخه على حرب أهلية حقيقية وليس مجهّزاً لها، والدليل على ذلك أنه لم يحرك ساكناً في فرص عديدة توقّع الكثيرون أنه سينتفض بها أو يحاول الانتقام. إضافة إلى أن العالم بأكمله، أو ممثلاً بجهة ما، منظمة الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي أو أقربه جامعة الدول العربية، سيكون من واجبه مدّ يد المساعدة، المساعدة المباشرة والفعالة، إذا احتاج الأمر، لعبور هذا المرحلة.
السيناريو الثالث، الأشدّ قسوة على الإطلاق، هو:
المواجهة
قرار النظام بأن يسند ظهره على الجدار ويقاوم، خارجياً وداخلياً، فإن كان خارجياً، تقتضي الحكمة تقديم كل ما يقدر عليه من التنازلات الإقليمية المطلوبة، مقابل القبول بوجوده واستمراره، فداخلياً لا شيء يضطرّه إلى هذا. وسوف يزود عن مصالحه حتى آخر نفس، كما يتوقع من أي نظام يتصف بالشمولية أن يفعل، وخاصة عندما لا يتبيّن له فرص نجاة ولو نسبية إلاّ عن هذا الطريق. وهذا ما تنبّه له بعض ذوي المعرفة والخبرة في المنطقة، حين نصحوا الإدارة الأمريكية بأن تأخذ السوريين باليد اللينة. لا أن يحصر النظام السوري في تلك الزاوية التي لا يجد فيها ما يفعله سوى أن يستشرس دفاعاً عن نفسه. وأن يتيحوا له الوقت والفرص لإيجاد حلّ ما لأزمته المستعصية. وربما يكون من رأي الأوربيين أن يساعدوه على حلّها. وذلك ليس حرصاً عليه بقدر ما هو حرص على دولة من دول العالم وشعب من شعوب العالم، وعلى استقرار منطقة قابلة لتصدير مشاكل بالجملة للعالم. وكذلك متابعة لبرامجهم التي درسوها وأعدّوها لانخراط كل بلدان هذه المنطقة الحساسة في وقائع العالم الجديد. أمّا إذا كان هذا السيناريو الثالث، الخيار الوحيد، الاضطراري، النهائي، الذي ترك للنظام السوري أن يمضي به دفاعاً عن مواقعه موقعاً موقعاً، دون اعتبار لأي شيء، مضحياً بكل شيء، فإنني أتركها لأشدّ المخيّلات كابوسية إمكانية تصور ما لا أسمح لنفسي بتصوّره من عواقب وخيمة على البلد والناس والمنطقة والعالم برمته، ما دام هذا العالم يدّعي أنه واحد..