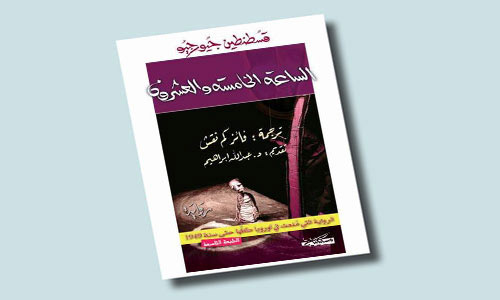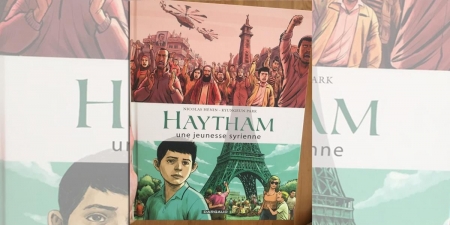“الشاعر وجامع الهوامش” لفواز حداد: بين الدين والتدين/ جمال شحيّد

بعد رواية “السوريون الأعداء” (2014)، التي واكبت أحداث السنتين الأوليين من عمر الثورة السورية، يطل علينا فواز حداد في روايته الجديدة “الشاعر وجامع الهوامش” (دار الريس، 2017)، ليتابع تجاذبات هذه الثورة حتى بدايات 2016، ويطرح فيها جملة من المتابعات؛ من بينها تداعيات الدين والدولة في أوساط السلطة الحاكمة في سورية.
تبدأ الرواية بتكليف المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب في دمشق الشاعرَ مأمون الراجح بإشراك الناس متعةَ الشعر في المنطقة الساحلية، وتحديداً في بلدة “مغربال” التي يتعايش فيها السنّة والعلويون والمسيحيون والإسماعيليون. وقبيل سفر محمود، استدعاه أحد فروع المخابرات التابع لقصر الرئاسة ليزوده بالتعليمات الضرورية كي تسير المهمة وفقاً للهدف المرجو منها. وطمأنه عن حصافة النظام: “كثيرون يعتقدون أن مهمة النظام تنظيم حركة المرور، تسيير المسيرات، قنص المتظاهرين، تفجير الجنازات، تمويل الشبيح، إلقاء البراميل المتفجرة… على أن تنفّذ طبعاً بدقة، إلا إذا أردناها عشوائية. أؤكد لك أن النظام في حالة تفكير دائم بتوءدة وعلى مهل ولديه الوقت لذلك وغالباً ما ينظر إلى البعيد، البعيد جداً”.
والحقيقة أنه استدعاء للبحث في ظاهرة التدين التي بدأت تتفشّى عند بعض العسكريين العلويين المتقاعدين بقيادة اللواء الركن نادر العارف، الذي قاده “الغيب إلى الدين” والذي شارك في حصار حماة وانتقلت قطعته إلى لبنان حيث عمل في التهريب وجمع منه ما جمع. وبعد التقاعد أخذ ينادي “ببعث الدين، وبالعودة إلى الأصول، ونشر العقيدة بعد تجديدها”. فاستعدى عليه المشايخ التقليديين الذين ظنوا أن الدولة وراءه. وسمّى الحركة الدينية الجديدة بـ”الحركة التصحيحية” التي هي رد عليهم. ولكن تصدى لها أحفاد المشايخ ونادوا بشعار “تصحيح التصحيح”.
ورافق وفدَ اتحاد الكتاب عناصرُ من قيادة الدفاع عن العاصمة أخفوا أسلحتهم تحت المقاعد. وفي الطريق إلى مغربال حصلت مشادة بين أعضاء الوفد المدعومين بالعناصر وبين الشبيحة الذين اعترضوا سبيلهم واستولوا على مؤونتهم من الدخان والمعسّل والمتة. ومرّ الوفد على حاجز للجيش الحر، فلم يتعرضوا لا لمساءلة ولا لأذى. ووصلوا أخيراً إلى مغربال التي تكاثرت فيها فيلات الضباط الفخمة وتكدّست في محلاتها المهربات اللبنانية. ويذكر الكاتب أن البلدة “أصبحت من الخزانات البشرية لتزويد النظام بالجنود والشبيحة”. فاحتل الشبيحة قبو المركز الثقافي في مغربال: “الأزمة لم تضعهم فوق الثقافة والأدب والمسرح والسينما فقط، بل وفوق القانون والبشر”؛ وصار هذا القبو مركزاً لتعذيب المعتقلين والمخطوفين.
ويدعو العميد رئيس فرع المنطقة رئيسَ وفد الكتّاب إلى العشاء، وأثناءه يتكلمان عن الإعدامات، فيقول العميد: “الإعدامات لا تتم اعتباطاً، قانونية مئة بالمئة، يحملون قوائم بأسمائهم، زودهم بها مخبرونا، لا يقتلون سوى الذين ساعدوا الإرهابيين بالسلاح والأدوية والطعام”. ويتكلم عن الشبيحة قائلاً: “إنهم زعران، لا علاقة لهم بالتهذيب، لكنهم مفيدون، الجنود أحياناً يترددون إزاء القتل، أما هؤلاء فمجرمون بالسليقة”. ثم يتكلم عن التعفيش: “بعد أن يقصف الجيش القرية أو الحي، يدخل الجنود ومعهم الشبيحة، وكل من شارك بالحصار لتمشيط المنطقة من المسلحين، فيعفشون ما أصبح مشاعاً، أي كل ما يصلح للاستخدام أو للبيع، ما شكّل حافزاً لعدم الإبقاء على أحد حيّاً؛ قتل عائلة بالكامل، يحلل لهم الاستيلاء على كل ما يحتويه منزلهم”؛ فيستولون على كل شيء وكل ما يمكن انتزاعه من الجدران، كالتمديدات الصحية من مغاسل وحنفيات وأنابيب، والكهربائية من برايز وأسلاك وتوصيلات، وطبعاً قطرميزات المونة، وأكياس الرز والسكر. ويبرر التعفيش من منطلق طبقي قائلاً: “في العهد البائد لعب البرجوازيون دور المعفِشين مصاصي دماء الشعب، والآن جاء وقت انتقام الفقراء المعفَشين… إذا استمرت الحرب على هذه الشاكلة التعفيشية المتسارعة، ستصحح الخلل الطبقي” وستنشأ طبقات ثلاث حديثة: الجيش، المخابرات، الشبيحة. ويضيف: “لا يعتمد المحارب النجيب على ما يتقاضاه من الدولة، بل على نفسه وقدراته”.
ويعيدنا الكاتب إلى مقتل أو انتحار المهندس سليمان، بطل رواية “السوريون الأعداء”، وتساقط الشهداء من أهالي مغربال وردود الأفعال المختلفة: “مصيرنا مرتبط بمصير العائلة”. ويطّلع الصحافي المغربالي حسين على أوضاع الاغتصابات التي يُقدم عليها الضباط ورجال الأمن والشبيحة، والتي سَمع عنها رئيس وفد اتحاد الكتّاب تفاصيل كثيرة. وبعد الأمسية الشعرية الهزيلة التي أقامها الوفد، يعودون إلى دمشق، من دون رئيسهم الذي استبقي في مغربال لدراسة المشروع الديني الجديد الذي راح يساور شبيبة البلدة، والذي عارضه الضباط المتقاعدون.
في هذه الأجواء المشحونة يعيدنا الكاتب إلى موضوع أثير لديه: التشبيح. يقول: “ثمة قانون واحد يسري في البلد، قانون التشبيح، لا يشبه أي قانون في العالم، يبيح استعمال العصي والقضبان الحديدية والهراوات والقنابل الدخانية والرصاص والدعس، بلا كابح ولا حدود، ومن غير مساءلة؛ لا مكان إلا للشبيحة، كل موال، مسؤولاً كان، أو وزيراً، أو نائباً، أو ضابطاً، أو صحافياً، أو كاتباً، أو محللاً سياسياً، أو مذيعاً… أصبح شبيحاً”. ويعود الكاتب إلى مسألة الاغتصاب التي يريد الصحافي حسين أن يفضحها أمام الصحافة الأجنبية، يقول: “كانت القيادة على علم بحوادث الاغتصاب، ولم تصدر أوامر بمنعه أو إيقافه، تُرك لتقديرات قادة الأفرع وضباط الجيش؛ فأصبح وارداً ولا اعتراض عليه حتى لو أدى إلى الموت. جرى التشجيع عليه مبكراً في التحقيقات. وكان آنياً ومرتجلاً في المداهمات، ثم أصبح قاعدة، يحاسب من يرفض القيام بها… صار الاغتصاب بمرتبة الأمر العسكري. اعتقل الممتنعون عنه في القطعات العسكرية، وتعرضوا للإذلال واتهموا برجولتهم. الأسوأ أن الذين احتجوا بغضب الله، اتهموا بأنهم من الإخوان المسلمين. فلم يتمكنوا من عصيان الأوامر. قيل لهم في البلد هناك إله واحد هو الرئيس، هل تعصى ربك؟”.
وتعيدنا الرواية إلى موضوعها الرئيسي، وهو الدين والتديّن. تنشب مشادة بين الضباط المشايخ والشبان الحداثيين. وتظهر في مكتب رئيس فرع المخابرات لافتة كتب عليها “المخابرات نور السماء”، ما يعني أنها مسؤولة عن شؤون الدين والدنيا، وأنّ “كل الدروب تؤدي إلى الفرع”. ويختصر المستشار المسألة قائلاً: “الخطر قادم من دمشق، السلطة هناك بألف لون ولون، تتلاعب بالأديان والمذهبيات، الشيطان يقود هذه المتناقضات في حرب لولا الطوائف لخسرها النظام الذي كان علمانياً، إسلامياً، سنيّاً، شيعيّاً، علويّاً، درزيّاً، مسيحيّاً… بآن واحد، وفي الحقيقة بلا دين، يغيبها كلها، ويجهر بها، يحرّض الأقليات ضد الأكثرية، ويحرض الأكثرية ضد الأقليات، لا تقل لا، ما دام هناك مخابرات، فلديه وسائله”. ويضيف: “الدولة تتقيد بالدستور، والنظام يعترف بالإسلام ديناً، لكنه ليس مسلماً إلا حفاظاً على المظاهر، لئلا يثير السنّة ضده، مع أنه أثارهم. وإذا كان منحازاً للعلويين، فلأنه مضطر إليهم، لم يستعِن بهم إلا لأنه بحاجة لهم، خطّط لهذا، منذ زمن بعيد، وطوّر خططه خلال أكثر من أربعين سنة، وطوّر معها علمانية واقعية بأسلوب محكم، وهي استحالة التوافق بين الطوائف، إلا بتحكم الأقلية”. ويذهب بعيداً في الحكم على انتهازية النظام: “البقاء للأبد، إذاً، ينبغي ألا يهتز الأبد أبداً”، لذلك لا يتورع النظام عن أي شيء، المهم أن يبقى ويرسّخ بقاءه، كما قال.
ويُعقَد اجتماع في المركز الثقافي في مغربال بإشراف مندوب اتحاد الكتاب للنظر في المجابهة بين الضباط المشايخ والشبان المتنورين حول وضع معالم الدين الجديد. فيقول الشبان عن الضباط: “هؤلاء لا يمكن التفاهم معهم، لا ثقافة ولا علم، رؤوس فارغة، وعقليات متخشبة… ما الذي يفقهونه من حرية البحث؟ إنهم خارج المجتمع والحضارة والتاريخ، لا يمتّون بصلة لأي عصر”. ويقول الضباط عن الشبان: “صبية طائشون وأوغاد، يبغون الظهور من دون التحلي بالحد الأدنى من الأخلاق”. كان الشبان يريدون “إبطال ألوهية الإمام علي”، و”تصحيح الموقف من عبد الرحمن بن ملجم الذي اغتال علياً”، وإلغاء الصلوات الخمس والاستعاضة عنها بذكر خمسة أسماء: هي علي، حسن، حسين، محسن، فاطمة، وهكذا يتخلص الناس من مشقة الركوع والسجود، والاستيقاظ صباحاً باكراً لأداء صلاة الفجر، وعدم الانقطاع عن العمل نهاراً، وتوفير وقت إضافي للهو والنوم، ما الداعي ليتصل الإنسان بالله خمس مرات باليوم؟ سعى الشبان إلى “تخليق دين شعبي بسيط، مع الأخذ بالاعتبار القديم، بعد تشذيبه، والإبقاء على قدر من الأواصر بينهما”. يجب على هذا الدين أن يقطع الصلة بالإسلام الوهابي، “عنوان التخلف بفتاواه الجهادية ونسائه المحجبات والمبرقعات”. راموا ديناً يتناسب مع الألفية الثالثة، ديناً يستوعب عقل هذا العالم الشيطاني، ويفرض نهجاً يراعي الحداثة، وما بعدها من حداثات وتحديثات، ديناً “لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، بلا عبادات مرهقة، ولا ممنوعات صارمة، يبيح شرب الخمرة، وأكل لحم الخنزير، وصلاة بلا وضوء، وطهارة بلا رفع جنابة، وحجاً بلا سعي، وطوافاً بلا كعبة، وصوماً عن المنكرات لا عن الطعام والنساء”.
وتتطرق الرواية للإمام المعصوم، أي الضابط الأكبر سناً ومرتبة (لواء). وتداول المجتمعون مسألة الإمامة:
“سؤال: هل نحن بحاجة إلى إمام معصوم؟
جواب: نعم، لأننا نحن البشر غير معصومين.
سؤال: أليس الإمام من البشر، لماذا يكون وحده المعصوم؟
جواب: الله هو الذي عصمه.
سؤال: لماذا هو وليس غيره؟
جواب: علامات سماوية دلت عليه.
سؤال: ما هي هذه العلامات؟
جواب: لا تسألوني، اسألوا الله”.
وينبري صوت ينادي بإنهاء هذه المهزلة. ويتساءل: “ما الهدف من إلغاء الأديان لصالح دين موحد أو نشدان الخلود؟”. وتستعرض الرواية أوضاع الطوائف في سورية: “السنة الذين صحوا متأخرين عدة قرون”، “العلويون الذين أصابهم الغرور، ووقع في أذهانهم أن البلد بلدهم وحدهم، والجهلة منهم أباحوا لأنفسهم كل ممنوع من النهب إلى القتل، وارتدّوا إلى التوحش”، “الشيعة الذين شدت الحرب عزائمهم نحو تشييع البلد بدعم من بلد الشيعة”، “الدروز الذين حافظوا على صلاتهم مع الجميع، لكن الخطر قد يأتي من هذه الصلات بالذات”، “الإسماعيليون الذين لم يتحرشوا بأحد، الآخرون تحرشوا بهم”، “المسيحيون الذين يميّزون أنفسهم عن الآخرين… حسب اعتقادهم أنهم أكثر رقياً من جميع من ورد ذكرهم… ممسوسون بالنظافة والمعقمات؛ يلمحون تارة إلى أنهم سكان سورية الأصليون، وتارة أخرى يدّعون أنهم أوروبيون، يتحسسون من جميع أشكال العنف”.
ولا تغفل الرواية عن ذكر بعض المقولات الدينية الحساسة: كالظاهر والباطن، والتقية، والتناسخ والتقمص، والمهدي، والمسيح الدجال، وياجوج وماجوج. وشرع المجتمعون بترويج “تسريبات حول الدين الذي سيعتمد ديناً للجميع، يجد فيه السني والمسيحي والعلوي والدرزي والشيعي والإسماعيلي، كل منهم بغيته، يجمع السوريين بعدما مزّقتهم السياسة ومزّقتهم الحرب… دين يلغي الحواجز بين الأديان ولا يتعارض مع مبتكرات العصر والعلم الحديث… يصلح أن يكون عالمياً”.
وبين قوسين، تنقلنا الرواية إلى توصيف التشبيح والمشبحين، فتقول عن زعيمهم زيدون في منطقة الساحل: “إنه حاز على منصبه التشبيحي لمؤهلات حقيقية، منظورة بالعين المجردة، فهو الشبيح الأكثر ضخامة بين شبيحة المنطقة، تارة يشبهونه بالبغل وتارة أخرى بالجحش، الضخامة الشكل الدارج والمطلوب بين الشبيحة لإيقاع الرعب في النفوس، يعملون على نفخ عضلاتهم بحقن الهرمونات والبروتين المستورد، والانكباب على الرياضة لا سيما رفع الأثقال، القصد منها الجمال الجسماني، ما يؤدي إلى البشاعة الجسمانية، فكان من الطبيعي، أن يثير مظهره التقزز، كل عضو من أعضائه مضاعف عدة مرات”. وتذكر الرواية حدة المنافسة بين الأجهزة الأمنية والشبيحة غير المنضبطة، وهذا أدى إلى تفجير سيارة زيدون فقتل فيها.
ثم تعيدنا إلى لب المسألة المطروحة: تخليق دين جديد. ولكن الغرب “أعلن عن موت الإله مراراً في القرن الماضي، فلماذا نحييه في هذا القرن؟ ما جدوى إعادته إلى الحياة؟”، ويتبدى الجواب تدريجياً: “النظام هو الله”، “حتى ولو كان الله حقيقة، لا بدّ أن نحيله إلى وهم، ليسهل علينا تشكيله كيفما نشاء”. وشيئاً فشيئاً، تلمّح الرواية بأن “لا إله إلا المخابرات، كانت كلية الوجود، كلية المعرفة، كلية القدرة. تمثل بكل كفاءة، الرب الجبار المهيمن العليم القادر المقتدر الغفار القهار الوهاب المنتقم الرزاق”.
وتنتهي الرواية بمقتل الصحافي حسين، فاضح الاغتصابات، حسين الذي “لم تنقذه علويته”، كما يقول النص. وتدريجياً تدرك السلطة أن مسألة الدين الجديد هي مسألة يجب تأجيلها، لأن أصحاب الرايات السوداء يقتلون جنود النظام بمنتهى البشاعة، كأن “الرب ربهم وحدهم”. تطرح الرواية في النهاية فكرة تقول بأنه لا بد من “تركيب إله طيب في الظاهر، وبراغماتي في الباطن… إله لئيم وفاجر، عربيد وفاسق، ملعون وحاقد، يبيح لهم الإسراف في القتل والاغتصاب والنهب… ليس سوى الإرهاب اللغة الوحيدة لسطوة الرب”.
تبدو مسألة تخليق دين جديد وإله جديد مسألة عبثية تناولتها الرواية بشيء من السفسطائية. ولكنها على طرافتها، في الوضع السوري، تعيدنا إلى المربع الأوّل: التطرف كرد فعل على التطرّف، التعصب كرد فعل على التعصب، بدل المناداة بالتسامح والصفح عن الشرور؛ وما أكثر ردود الأفعال الأعظمية خلال السنوات الأربع التي غطّتها رواية “الشاعر وجامع الهوامش”.
ضفة ثالثة