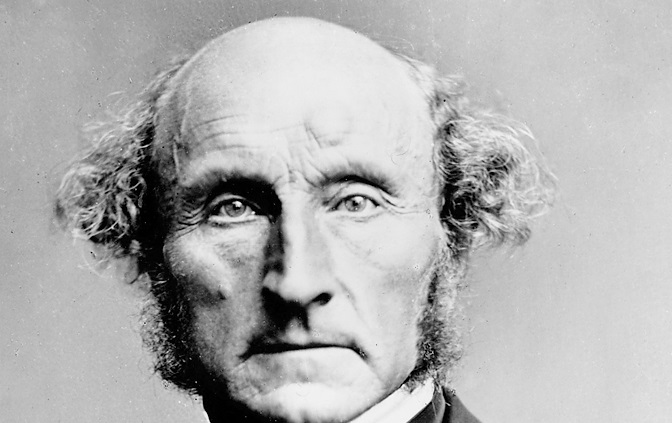الطائر الأسير إن خرج
أنطوان الدويهي
انتهى عصر في العالم العربي وبدأ آخر. لا شكّ في أن ما يحدث، يحمل بارقة أمل للتجربة اللبنانية التي جوهرها الحرية. لكن التجربة اللبنانية لن تتكرر في مكان آخر نظراً الى خصوصية بنيتها ومسارها التاريخي. فهل تجد الانتفاضات العربية الصيغ الخلاّقة لتقيم، هنا وهناك، مساحات جديدة للحرية والديموقراطية والتعددية والتسامح؟ وهل تستطيع التوفيق بين الدنيوي والمقدّس؟
لا يسع المهتمّ بالمسألة اللبنانية إلاّ التطلع بانتباه بالغ الى الانتفاضات الشعبية التي تهزّ أنحاء العالم العربي منذ أن أسقطت الثورة التونسية في 14 كانون الثاني الماضي ديكتاتورية بن علي. إنه لحدث كبير ومفاجئ يؤكد لنا مرةً أخرى ما نعرفه جيداً في عالم الأنتروبولوجيا، وهو أن الجمود لا وجود له في المجتمعات والظواهر المجتمعية. وأن هناك حركية دائمة، سريعة، أو بطيئة، أو غير مرئية، حتى في المجتمعات والأنظمة الأكثر ثباتاً ورسوخاً. وحيث كان يغلب الشعور بأن الشعوب العربية عاجزة عن التحرك، وخاضعة كلياً للأنظمة التي ترزح تحتها منذ عقود طويلة، هبّت فجأةً العاصفة وانكسر حاجز الرعب وبدأت تتهاوى الديكتاتوريات أمام أعين العالم الذي لا يكاد يصدّق ما يرى.
والمهتمّ بالمسألة اللبنانية، التي هي في جوهرها مسألة الحرية، لا بدّ من أن يولي الكثير من الاهتمام لهذه الموجات الشعبية الرافعة شعار الحرية، في المنطقة كلها، مشرقها ومغربها، وذلك للمرة الأولى منذ رحيل الاستعمار الغربي عنها قبل أكثر من نصف قرن. في ذلك الحين، كان شعار الحرية مرفوعاً في وجه الاستعمار. وهو يرتفع اليوم في وجه الأنظمة التي تلت الاستعمار ولم تحقق شيئاً من أحلام النهضة التي حملتها حركات التحرر الوطني. فهذه الأنظمة لم تقدّم غير الشعارات، وغير القمع والإفقار والفساد وإثراء الحاكمين والتخلف ومحاولة توريث السلطة، بحيث بات العالم العربي قابعاً على هامش التاريخ الحديث، لا طريق له إليه ولا سبيل.
هل هي بارقة أمل للمسألة اللبنانية؟ لا شكّ في ذلك. لكن بارقة الأمل شيء، ومدى تحقّقها في الواقع شيء آخر. فكيف يمكننا النظر الى علاقة لبنان، حاضراً ومستقبلاً، بانتفاضة الشعوب العربية التي باتت تُعرَف في العالم بـ”الثورة العربية”، أو بـ”ربيع العرب”؟
حركة الانعتاق وحركة الدمج
إن اهتمامي بالمسار الثقافي والمجتمعي في المكان اللبناني في الأزمنة الحديثة، من القرن السادس عشر الى اليوم، قد أوصلني الى الاستنتاج الرئيسي الآتي، الذي عبّرتُ عنه أكثر من مرة قبلاً: إن معنى التاريخ اللبناني على مدى القرون الأربعة الأخيرة، لا يرتكز في صورة أساسية على صراع الطوائف وتوافقها، ولا على صراع الطبقات، ولا على التجاذبات الدولية. فالبرغم من أهمية هذه المعطيات كلها، فإن معنى التاريخ اللبناني في القرون الأربعة الأخيرة يكمن أساساً في السعي الدؤوب، الدائم، الى تحقيق نظام حياة متمايز ومختلف عن نظام الاستبداد الشرقي. ويتسم نظام الحياة المنشود بالتوق الى الحرية، والى الحكم الذاتي والاستقلالية، والانفتاح على الحداثة والعالم، والرهان على العلم والمعرفة، وتحسين نوعية الحياة.
لقد واجهت هذا المنحى التاريخي الثابت صعوبات هائلة، في إطار السلطنة العثمانية وبعدها، ولا تزال تواجهه اليوم أيضاً. وقد شهد المكان اللبناني منذ أواخر القرن السادس عشر حتى اليوم حركتين كبيرتين متناقضتين: حركة الانعتاق من النظام السائد في المشرق، وحركة الاندماج فيه. والطريق الشاق الذي يسلكه “الحلم اللبناني” ناتج من المعادلة البالغة الصعوبة الآتية: كيف يمكن إقامة مساحات حرية في منطقة جغرافية تسودها أنظمة تسلطية، حيث لا يوجد للتجربة اللبنانية حليف حقيقي في كامل محيطها؟
فهل توليها “الثورة العربية” الراهنة، في مكان أو أكثر، مثل هذا الحليف؟ إنه لتساؤل كبير.
الرهان الصعب المنال
لا شكّ في أنه بقدر ما تنتشر ثقافة الحرية في المنطقة، يستقر المكان اللبناني في تجربته المميزة. ذلك أن المعضلة العميقة التي تعاني منها هذه التجربة منذ أمد طويل، تكمن في التناقض الجوهري بين طبيعتها وطبيعة التجارب السائدة في محيطها. فطالما أن الصفة الأمنية هي التي تطغى على تجارب المحيط، وبما أن استثماراته وجهوده تنصبّ أساساً على بعده الأمني، فهو يملك، بمختلف أطرافه، القدرة على اختراق المكان اللبناني الذي سمته الحريات، وعلى تهديده الدائم بعدم الاستقرار. والتجربة اللبنانية موضوعة على الدوام أمام هذا الرهان الصعب المنال: كيف الجمع بين الحرية والاستقرار الطويل الأمد داخل منطقة أمنية؟ فإذا اختارت التجربة اللبنانية الاستقرار بسلوك الطريق الأمني، أصبحت مماثلة لتجارب منطقتها وفقدت حريتها وروحها. وإذا تشبثت بخصوصيتها وحرياتها، أبقت نفسها عرضة للاختراقات والاهتزازات التي اشتدت وتيرتها منذ العام 1975. من هنا بارقة الأمل – الأولى من نوعها – التي توفّرها “الثورة العربية” للتجربة اللبنانية. فإن استطاعت هذه الثورة إقامة مساحة حرية، أو مساحات عدة، في المنطقة، فهي ستريح التجربة اللبنانية وتفكّ الطوق الأمني الذي يلفّها، وتخفّف الضغوط والتأثيرات السلبية الفاعلة في مسارها، وتوفّر لها حليفاً أو حلفاء حقيقيين في محيطها، تقوى بهم ويقوون بها، وذلك للمرة الأولى في تاريخها. هكذا تصبح هناك في الشرق منابع أخرى لنظام الحريات غير المكان اللبناني. فهل يمكن ذلك؟ وما هي حظوظه الفعلية؟
حول التجربة الأوروبية
على رغم الأمل الدائم بأن حركة التاريخ ذاهبة في اتجاه تحقيق الحريات البشرية، فإن بناء الأنظمة الديموقراطية ومساحات الحرية يتطلب شروطاً وظروفاً ومسارات لا يسهل توافرها. ولا بدّ في هذا المجال من الإضاءة، ولو بإيجاز بالغ، على التجربة التاريخية لأوروبا الغربية، لأنها هي التجربة الأساس التي انبثقت منها الحداثة واستندت إليها أنظمة الحرية والديموقراطية في العالم المعاصر. والتجربة الغربية هي نتاج مسار طويل بدأ منتصف القرن الخامس عشر، وتوالت على مدى خمسة قرون، تحوّلاته الكبرى، المعرفية والإيديولوجية والقيمية والفنية والاقتصادية والسياسية والعلمية والتقنية والمجتمعية، من النهضة الأوروبية، إلى فكر التنوير، إلى الثورة الصناعية، إلى الثورة الفرنسية. وقد أدى هذا المسار إلى انحسار الفكر الديني الذي كان مهيمناً على ألف عام من القرون الوسطى، لصالح الفكر الدنيوي، وأصبح المحور البشري وليس المحور الماورائي هو محرّك التاريخ، ونشأ مفهوم التقدم، وبرز العقل النقدي الذي أتاح إعادة نظر عميقة وشاملة في كل مسلّمات “النظام القديم” ومرتكزاته، وانفصل العلم عن الفلسفة، وظهرت طبقة اجتماعية جديدة هي البورجوازية التجارية والمالية التي أضحت هي موقع الثقل ورائدة التغيير، وتكوّنت أسس الحضارة الصناعية والمادية الصاعدة، وقام مجتمع الأفراد على أنقاض مجتمع الجماعات، وتكرّست مفاهيم المساواة والحرية والديموقراطية حيث بات الشعب هو مصدر السلطات بعد انهيار نظام الرتب الثلاث وسقوط السلطة التيوقراطية المرتكزة على الحق الإلهي.
هذا هو النموذج الديموقراطي الأوروبي الغربي الملازم للمجتمعات الصناعية، الذي امتد الى الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوستراليا واليابان، وفي المرحلة الأخيرة الى أوروبا الشرقية بعد زوال المعسكر الاشتراكي.
أهمية “السبل المختلفة”
هل تمكن إقامة أنظمة حرية وديموقراطية خارج النموذج الغربي وسياقه التاريخي؟ يطرح هذا التساؤل مشكلة منهجية لا يكاد يتطرق إليها أحد، وهي كانت منذ أمد طويل ولا تزال مصدراً لالتباسات كثيرة، غالباً ما ساهمت في عدم الادراك العلمي للواقع المجتمعي والسياسي في لبنان. تكمن هذه المشكلة في أن محللين مشرقيين وأجانب عمدوا الى الاستخدام الحرفي للمفاهيم والأطر المنهجية العائدة الى التجربة التاريخية الأوروبية، وإسقاطها على مسألة النظام اللبناني من دون التنبه الى خصوصياته البنيوية والتاريخية. ونشأ من ذلك مأزق نظري لا بدّ من إدراكه وتخطيه.
إن الحرية والديموقراطية اللتين وصل إليهما المكان اللبناني، هما نتاج مسار تاريخي مختلف تماماً عن المسار الأوروبي. من الأهمية بمكان التوقف عند المسار اللبناني لأنه يمثّل إحدى الحالات النادرة لخلق مساحة حرية خارج الجغرافيا الأوروبية وبعيداً من المجتمعات الصناعية. ولا تنحصر أهمية التجربة اللبنانية في إطارها المحدَّد فحسب، كونها تؤكد أمراً بالغ الدلالة باستنتاجاته النظرية والعملية، وهو إمكان الوصول الى ثقافة الحرية ونمط عيشها بسبل مختلفة عن النموذج الأوروبي، مما يعزز الأمل بإمكان “السبل المختلفة”.
عن المسار اللبناني
مثلما أوجزنا باختصار المسار الأوروبي الغربي، سنحاول الإضاءة على المسار اللبناني، مما يتيح المقارنة بينهما، على مستويي التمايز والتفاعل أيضاً.
لا شكّ في أن التجربة اللبنانية ترتكز أساساً على المعطى الطبيعي والموقع الجغرافي لجبل لبنان، كمرتفع حصين وفريد في محيطه، ملائم من حيث مناخه وموارده لاحتضان الجماعات البشرية وحمايتها من جهة، وقائم من جهة أخرى مع ساحله وسهله، في نقطة التقاء حضارات الشرق الأوسط القديم وفي نقطة تفاعلها مع الحضارة الغربية، عند هذا الشاطئ الذي يشكل الحد الفاصل، والجسر الواصل، بين آخر آسيا الغربية وأول المتوسط الأوروبي.
لكن الحتمية الجغرافية والطبيعة لا تكفي لتفسير المسار الذي شهده المكان اللبناني من أواخر القرن السادس عشر الى اليوم وأوصل الى تكريس مساحة الحرية فيه وسط صعوبات لا تحصى. فلا بدّ من التركيز أيضاً على العوامل البشرية والتاريخية الكثيرة الأهمية في إنتاج ذلك، ولا سيما: وجود جماعة مشرقية في جبل لبنان متصلة منذ القرون الوسطى بروما، مما أتاح لهذا الجبل دون سواه، الانفتاح المبكر على الحداثة الناشئة وعلى العالم غير العثماني. وما عزّز ذلك هو التحالف التاريخي بين الأمراء المعنيين والشهابيين والكنيسة المارونية، في سعي طويل مشترك الى الحكم الذاتي والتمايز السياسي والثقافي. كذلك تنامي النفوذ الأوروبي في المتوسط الشرقي الذي شكّل توازناً مع النفوذ العثماني، أفاد منه المكان اللبناني لتطوير تجربته. هكذا شهد جبل لبنان في القرنين السابع عشر والثامن عشر نهوضاً تعليمياً وثقافياً ومعرفياً واقتصادياً لا مثيل له في المحيط العثماني. ثم جاء بروز بيروت في القرن التاسع عشر وتألقها كمنارة للنهضة العربية ليكملا هذا المسار الطويل ويتوّجاه.
التوازن المجتمعي
لكن ذلك كله، على رغم أهميته الكبرى، لم يكن ليرسي ويكرّس مساحة حريات في المكان اللبناني، لولا المعطى الجوهري الآتي: التوازن الطائفي المجتمعي، من ضمن التعدد والتنوع، القائم في هذا المكان دون سواه من أنحاء الشرق، المجسد في زمن الإمارة في شخصية الأمير (حين كانت السلطة مختصرة فيه)، والمكرّس دستوراً وعرفاً في زمن المتصرفية، ثم في زمن لبنان المستقل.
من هنا يستحيل التطبيق الحرفي لمفاهيم التجربة الأوروبية على الواقع اللبناني. والمطالبة بإلغاء ما يُعرَف بـ”الطائفية السياسية” على سبيل المثال، التي تلقى آذاناً صاغية عند العديد من المثقفين اللبنانيين والعرب والغربيين، كخطوة أولى للوصول الى العلمنة المنشودة، إنما تؤدي في الواقع الى ضرب إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها مساحة الحرية في المكان اللبناني، وفتح الباب في هذا المكان أمام إقامة نظام سلطوي وأمني آخر من أنظمة المنطقة، وسدّ الطريق نهائياً على العلمنة، مما يشكل انتصاراً تاريخياً لحركة الدمج على حركة الانعتاق. لا شكّ في أنه يجب تطوير النظام اللبناني، لكن بتعزيز الحريات والممارسات الديموقراطية فيه بوسائل خلاّقة وتقوية دولته وتحديثها والعمل على دفعه نحو مجتمع الأفراد، وليس هدمه.
بحثاً عن الصيغ الخلاّقة
لا بدّ من الإدراك أن التجربة اللبنانية، بمسارها التاريخي وخصوصيتها، يصعب أن تتكرر في مكان آخر في محيطها. وعلى الانتفاضات العربية الراهنة أن تجد السبل والأشكال الملائمة لإقامة مساحات الحرية والديموقراطية في مجتمعاتها.
ويغلب الاعتقاد، الى حدّ بعيد، أن الأنظمة السلطوية العربية التي تلت رحيل الاستعمار، وصلت الآن الى نهايتها، وأن الثورة العربية الراهنة هي بداية مرحلة تاريخية جديدة، لا بدّ من أن تكون واعدة، وفي كل حال، أفضل من سابقتها.
الأمل التاريخي المنشود، اللبناني والعربي، هو أن تجد الانتفاضات الراهنة الصيغ الخلاّقة لإقامة مساحات فعلية للحرية والديموقراطية والتعددية والمساواة والانفتاح والتسامح. فكيف يكون التوفيق بين الدنيوي والمقدّس، بين المحور البشري والمحور الإلهي، وبين حقوق الأفراد ومجتمع الجماعات؟
النهار