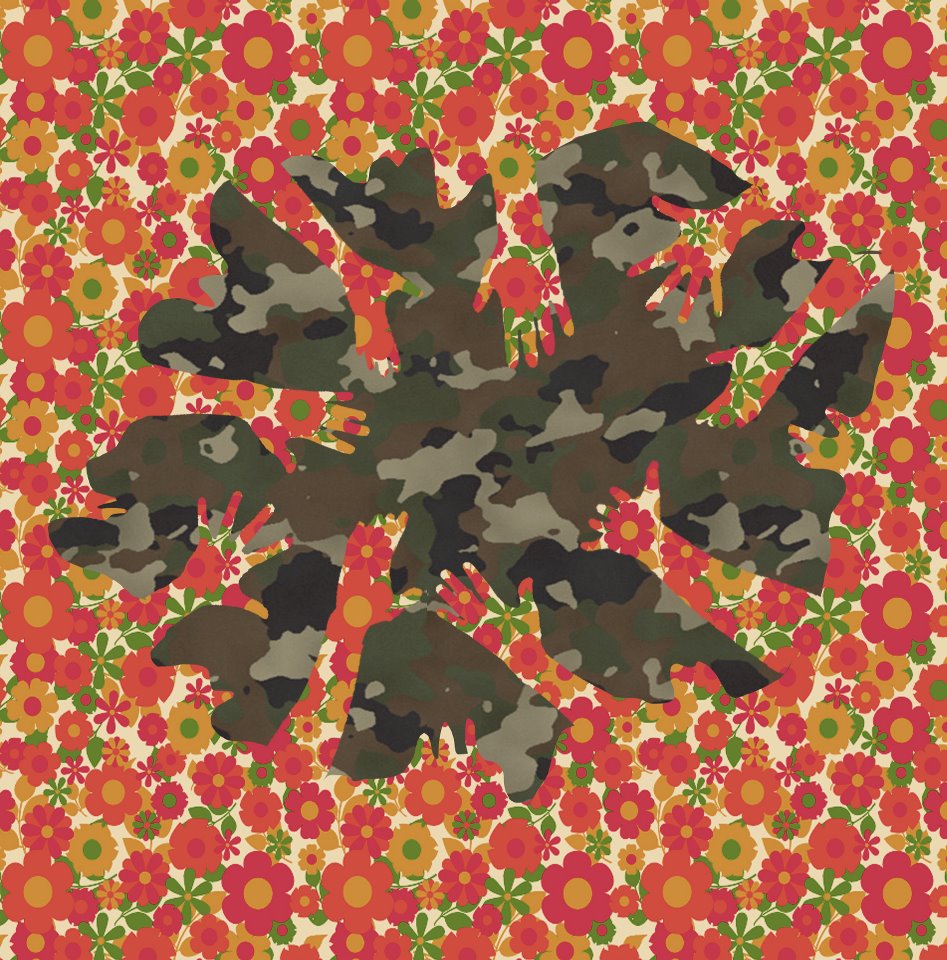حسين العودات.. وداعا

حسين العودات.. عصر في رجل/ ميشيل كيلو
إذا كان هناك نفر قليل يلخص تطور السوريين السياسي في النصف الثاني من القرن الماضي وما انصرم من هذا القرن، فإن حسين العودات كان أحد أبرز رجال هذا النفر الذين واكبوا تطور شعبهم، وما عاشه وطنهم من أحداث، وعرفه من حكام وهزائم، وتعرّض له من خيباتٍ، وبلوره من خيارات، وتبناه من أفكار.
كان أبو خلدون فتى يافعاً، عندما ضيعت السياسات العربية فلسطين. ومثل كثيرين من أبناء جيل النكبة، رد عليها بالانتساب إلى حزب البعث الذي كان بعض قادته قد ذهبوا إليها للدفاع عنها ضد الصهاينة، وعادوا من هناك، قانعين بأن حرباً أخرى لا بد أن تُخاض داخل سورية، ضد ما سماه ميشيل عفلق، في إحدى مقالاته عام 1946 “حكم التخت والمزرعة”. بعد أعوام قليلة من الكارثة التي عاشها راحلنا الكبير، وهو على مقاعد الدراسة في قريته الصغيرة، أم الميادن، قرب الحدود الأردنية، تعرّف أبو خلدون على حوران ومناطق من جبل العرب في العطل الدراسية، حيث كان يعمل “جمّالاً” يجوب قراهما وبلداتهما، وتلتقط ذاكرته مشاهد البؤس والتخلف والجهل التي ظهر أثرها لاحقاً في رؤيةٍ سياسيةٍ، تجاوزت اجتماعياً ما كان “البعث” يوليه لقضايا الشعب الفقير، وجعله أحد ممثلي “اليسار الاشتراكي” في الحزب. وقد تعزّز هذا الجانب في شخصيته من خلال ما عرفه في أثناء قيامه بالتدريس في حوران، وتقلده وظائف إدارية تتصل بالتعليم. لذلك، اقترب، بعد انقلاب “البعث” العسكري عام 1963 من تياره اليساري الذي أعطى القضية الاجتماعية الأولوية على القضية القومية، وأيد التعاون مع الحزب الشيوعي، وعارض ملاحقته واضطهاد كوادره ومناضليه. في هذه الأثناء، كان دور أبو خلدون يبرز بسبب المكانة التي احتلها قلمه في عالم الإعلام، وما أبداه من درايةٍ في إدارة مؤسساته، الرسمية طبعاً التي لم تكن مواقفها متطابقةً في قضايا معينة مع مواقف “القيادة”.
بعد هزيمة حزيران، والصراعات التي أعقبتها، وانتهت بانقلاب حافظ الأسد على الحزب ورفاقه، افترق أبو خلدون نهائيا عن الحزب، على الرغم من محاولات احتوائه بمناصب أسندت إليه. في هذه الفترة، اقترب أبو خلدون من الحزب الشيوعي، وحين أيقن أن هذا الحزب وجه آخر للنظام، شمله هو أيضاً بالنقد الذي كان يوجهه في مقالاته للأمر القائم، وصار واحداً من طبقةٍ ثقافيةٍ مستقلة حزبياً، معارضة للنظام وجبهته الوطنية التقدمية وأحزابها الكركوزية، أعادت قراءة أفكار ماركسية عديدة والتثقف بها، في ضوء التجربة السورية للسلطة، وما رسخته في الحياة السورية من ظلمٍ طبقي غير مسبوق باسم الاشتراكية، وقُطرية صارخة ومعادية للعرب باسم القومية، وقمع شامل طاول جميع فئات الشعب باسم الحرية، وسلطوية غاشمة، أمنية ومتعسكرة، قادت البلاد إلى هزائم متعاقبة أمام العدو الإسرائيلي، بعد أن سلمته الجولان، واستقوت باحتلاله من أجل البقاء في الحكم.
وشهدت هذه الحقبة زيارات أبو خلدون المتكرّرة أجهزة الأمن التي لاحقته بالمضايقات
“تكثف سيرة حسين العودات تاريخ سورية الحديث وما عرفه من وعودٍ كاذبةٍ” والاعتقالات، قرابة ثلاثين عاماً، كان قد أسس في أثنائها دار نشر حملت اسم “الأهالي”، طبعت مؤلفاتٍ وترجماتٍ لكتّاب ومفكرين سوريين وعرب، ممن كانوا قد انفكّوا بدورهم عن النظام العربي الفاسد والقمعي، والتحقوا بسياساتٍ أسستها قراءاتٌ ثقافيةٌ، استهدفت إعادة إنتاج المشروع العربي، باعتباره مشروع حريةٍ قبل أي شيء آخر، أي مشروعاً للمواطن العادي الذي لا بد أن يجعل حريته رهانه السياسي الرئيس، ويربط بها جميع رهاناته الأخرى، بكل ما يجب أن يتجدّد بواسطتها في ميادين الاشتراكية، باعتبارها عدالةً اجتماعية، والوحدة هدفاً ومهمة للدولة الوطنية، والحرية قيمةً تتعين بها المساواة والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
بهذه المقدمات، وقبيل موت حافظ الأسد بأيام، كان حسين العودات من أوائل من أسسوا “لجان إحياء المجتمع المدني في سورية” التي رفضت المعادلات السياسية السائدة بين السلطة والمعارضة، وأخرجت السياسة من إهابهما، ونقلتها إلى حيز جديد، هو حرية المواطن الفرد: نقطة الارتكاز في وجوده التي إن فقدها فقد كل شيء، حقوقه وكرامته وإنسانيته، ولا بد أن يناضل لنيلها إذا كان سيثور على نظام عنيف وسلطوي، يفكّك مجتمعه ويغيبه عن الشأن العام، ويعرّضه لقدر لا يرحم من الاضطهاد الذي يصدر عن سلطةٍ وعدته بالحرية. وكان من الطبيعي أن يكون مكتب أبو خلدون وبيته مقر اجتماعات اللجان اليومية الدورية والطارئة، وأن يتولى الإنفاق على كثير مما كانت اللجان توزعه من مقالاتٍ ونشراتٍ ظرفية، وأن يكون من كتاب “إعلان دمشق” وكتاب ومفاوضي “إعلان بيروت/ دمشق ـ دمشق/ بيروت”، وأحد المثقفين الستة الذين دعوا، بعد الثورة، إلى توحيد المعارضة، واقترحوا خططاً، ودعوا ممثلي التجمعين المعارضين الرئيسين إلى لقاءاتٍ حوارية حول مشروعيهما. كما كان من المفهوم أن لا يبقى نائباً لرئيس “هيئة التنسيق” التي تشكلت من الحزب الناصري، ومزق يسراوية متنوعة، فكرّس قيامها انشقاق المعارضة، بدل أن يوحّدها، خصوصاً بعد أن بدأ بعض قادتها يغازلون النظام، ويتعرّضون للإدانة من الشعب، حتى أن مواطني دوما منعوا منسقها العام من حضور مجلس عزاء أقيم لأحد شهداء المدينة من الناصريين، مع أن المنسق هو الرئيس المفترض للحزب الناصري الذي ينتمي الشهيد إليه.
لم يغادر أبو خلدون سورية بعد الثورة، بل بقي فيها إلى أن وافته المنية، على الرغم مما كان يتعرّض له من مضايقاتٍ، بسبب كتاباته شديدة الوضوح والجرأة، وإسهاماته التلفازية التي دافعت عن حق الشعب في الثورة ومقاومة جرائم النظام، وكشفت حجم ارتكاباته ضد عزّلٍ يطالون سلمياً بأقدس ما في وجود الشعوب والأفراد: الحرية. ولم ينقطع أبو خلدون، على الرغم من ظروفه الشخصية الصعبة، وأمراضه المتكاثرة، وفقده إحدى عينيه، عن تكريس وقته للدفاع عن الناس، بالكتابة في الصحف والاتصالات اليومية معهم، وعبر البحث وإصدار دراسات وكتبٍ عالجت، بعلمية وصراحة، أكثر قضايانا التاريخية والراهنة حساسيةً وأهمية، من تلك المتصلة بالإسلام وتاريخه ومدارسه الفقهية ومشكلاته السياسية والفكرية إلى قضايا الأقليات وحقوقها، والمرأة ودورها، والسياسة ومعانيها ومرتكزاتها.
تكثف سيرة حسين العودات تاريخ سورية الحديث، وما عرفه من وعودٍ كاذبةٍ، قدمها انقلابيون طيّفوا السلطة، وأحلوا مصالحهم محل مصالح وطنهم العليا، وعاشه، في المقابل، من نضالاتٍ قام بها مواطنون، ضحوا بكل شيء من أجل نصرة المظلومين، وإنقاذ شعبهم وأمتهم، بما عرف عنهم من شجاعةٍ أدبية وجرأة، وتحد لموازين قوى كانوا الطرف الأضعف فيها، لكن حبهم وطنهم وولاءهم لشعبهم جعلهم يؤمنون بما كان كثيرون يعتبرونه جنوناً: أعني الإيمان بأن الثورة واجبة وآتية، وأن دورهم يلزمهم بالتمهيد لها، والانخراط فيها، من دون حساباتٍ صغيرة أو شخصية، ومن دون يأس.
كان أبو خلدون نموذجاً لهذا المثقف الذي بدأ حياته متحزباً، وأنهاها مناضلاً وثورياً، يؤمن أن انتصار ثورة الشعب انتصار له، حياً أو ميتاً.
صديقي وأخي أبو خلدون: نم قرير العين، فقد حققت الثورة لك ولنا الامتلاء الإنساني والوجودي الذي لولاه لكانت حياتنا مأساة مرعبة، ولكنا فشلنا في أن نبارح الدنيا ونحن سعداء.
العربي الجديد
حسين العودات.. آخر الرجال المحترمين/ حازم نهار
فارقنا، قبل أيام قليلة، حسين العودات، أبو خلدون، الذي كان وسيظل اسماً ناصع البياض على امتداد الخارطة العربية في مجال الإعلام والصحافة والثقافة والنضال السياسي والانتصار لقيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان. لكن، فوق هذا كله، كنت أشعر دائماً بأن أهم وصف يليق بحسين العودات، قبل أي حديث آخر، هو: آخر الرجال المحترمين، على الرغم من معرفتي بالطبع بوجود آخرين يستحقون الاحترام والثناء.
حسين العودات من المثقفين والسياسيين القلائل الذين تحرّكهم بوصلة وطنية سورية بحت، ويترفعون عن الذات وأمراضها، ولا أبالغ، عندما أقول إنه من المثقفين والسياسيين أسوياء العقل والروح والنفس القلائل. إنه، بتكثيفٍ أشد، من فئة المثقفين والسياسيين النبلاء.
تعرفت إليه منذ نحو عشرين عاماً، وكنت أراه دائماً رجلاً عاقلاً وحكيماً، لا يفتنه مال أو جاه أو موقع، يُتقن جهاد النفس الأمّارة بالسوء، يدير ظهره للمعارك الصغيرة، يضع نفسه دائماً خلف الجميع، وفي آخر الصفوف، عندما يتعلق الأمر بالمغانم والمكاسب.
آمن أبو خلدون، منذ اللحظة الأولى لثورة السوريين، أنها لم تكن ضد السلطة الاستبدادية القائمة فحسب، بل ضد مرحلةٍ بأكملها، بما اختزنته من قوى وشخصيات وأيديولوجيات. لذلك، رأى أن عماد الثورة هم الأجيال الشابة، على النقيض من تلك الديناصورات التي أرادت أن تأكل زمن غيرها، بعد أن أكلها زمنُها ولفظها. أليس غريباً أن يتحول كثيرون من أهل الثقافة والسياسة، خلال سنوات الثورة، إلى مجرد لاهثين وراء الإعلام أو اللقاءات مع سفراء الدول ومندوبيها؟!. لا عجب في ذلك، فالصغار والفارغون هذا سعيهم واهتمامهم، فيما الكبار والممتلئون يحسبون خطواتهم باتزان. ولا عجب إذاً أن نقول: هم راحلون وحسين العودات باقٍ.
يختلف حسين العودات عن أبناء جيله في أنه يتجاوز نفسه باستمرار، فيما هم تخثّروا عند مرحلةٍ معينةٍ، وأكلت عقولهم الأيديولوجيات والأوهام. إنه يتقن الاعتذار، عندما يعتقد أنه أخطأ في أمرٍ أو تقديرٍ ما، وكثيراً ما يسمعه المرء، يقول “كنت أهبل في لحظةٍ من اللحظات”. مثل هذه العبارة لا يقولها إلا كل ممتلئ وحقيقي.
كان مجتهداً ومواظباً على العمل والكتابة، حتى في لحظات الموت. أنهكته عيناه في السنوات الأخيرة، لكنهما لم تمنعا عقله وروحه من متابعة كل شيء، تحرّكه روح وثّابة، ويسنده عناد عجيب. قلائل هم من يستطيعون الاستمرار في الكتابة، وهم يعرفون أنهم سيفارقون الحياة قريباً. هذه من سمات الأنبياء فحسب، أولئك الذين يؤمنون بالأجيال الجديدة، ويشعرون بواجبهم تجاهها. إنه كالفارس النبيل الذي يظل يقاتل حتى اللحظة الأخيرة، فارس لا يدفعه اقتراب الموت نحو الضرب في المناطق الممنوعة.
قبل التوافق والاختلاف معه في الفكر والسياسة، هناك حسين العودات الإنسان الذي يجعلك تحبّه، وتشعر بدفئه وصدقه في كل لحظة. لا أملك إلا أن أضحك كلما تحدثنا، يمزج النكتة بالمأساة وبالفكرة العميقة. وفي خلفية الحديث، تجد روحاً صادقةً، لا يمكن إلا أن تقدِّرها مهما اختلفت معه. نادراً ما أحفظ النكات، لكن نكات حسين العودات لا تُنسى.
ينزع بعضهم صفة الثورية عن حسين العودات، بالاعتماد على مقاييسهم التي تشوبها ألف شائبة. ليس أبو خلدون ثورياً عندما يكون المقصود بالثورة الصراخ والجعجعة والشتائم، فهو يبني علاقةً سوية بين الثورة والسياسة، جذريٌّ في مواقفه، لا تنقصه الجرأة والوقاحة، عندما تكون هناك حاجة إليهما، لكنه يؤمن، وهو محق، أن الأداء السياسي الصائب، والمستند إلى المعرفة، هو الذي يخدم ثورة السوريين.
بعد وفاته، كتبت عنه قوى وهيئاتٌ وشخصياتٌ سورية عديدة، جاء أكثره في إطار الواجب،
“ينزع بعضهم صفة الثورية عن حسين العودات بالاعتماد على مقاييسهم التي تشوبها ألف شائبة” خصوصاً أنني أعرف أنه لا يودّهم في الحقيقة، بل كثيراً ما عبّر عن انزعاجه من بعضهم، بسبب “هبلهم” أو “انتهازيتهم” أو “قلة عقلهم”، على حد تعبيره، خصوصاً أن من هؤلاء من أرادوه، بشكل أو آخر، شاهد زور على انحطاطهم ومواقفهم وممارساتهم البائسة.
كلنا يعلم، اليوم، أن وجود المرء في أي هيئة سياسية “معارضة” لا يعني أنها تستنفده، أو تعبِّر عنه كلياً بالضرورة، فشخصيات كثيرة عملت تحت عنوان “لعل وعسى” أملاً في تقليل الخسائر والأضرار، وليس قناعةً بما هو موجود. لامني أبو خلدون كثيراً، في بدايات الثورة، على ابتعادي من أجواء المعارضة التقليدية والهيئات والمجالس والائتلافات التي تشكلت، ثم شدّ على يدي بقوة: “حسناً فعلت”. وهكذا فعل فيما بعد.
مع حسين العودات، يكون المرء في حضرة جلالة التاريخ، فضلاً عن كونه ممتلئاً بقصص البسطاء من الناس، يذكرها بشغف، ويعتمدها كثيراً في قراءة الواقع. متواضع بلا تصنّع، بعيدا من التواضع المرضي الذي يختصّ به “اليسار العربي” عموماً الذي انفجر تواضعُه احتقاراً للبشر في لحظة الثورة. مع أبي خلدون، يعشق المرء العروبة. عروبة حضارية وثقافية بلا أوهام عن الذات والآخر، وبلا استبداد وإقصاء، وبلا ادعاءات وخطابات رنانة.
اعتقلنا معاً في مايو/ أيار 2005 ثمانية أيام، إثر تخطيطنا المشترك، إضافة إلى الصديق علي العبدلله، لندوة حول الإصلاح السياسي في سورية آنذاك. لا أحد يستطيع أن يعتقل روح حسين العودات، فقد أمضى تلك الفترة يقصّ علينا الحكايات التي تجعل المرء ينفجر ضاحكاً.
أذكر أيضاً كيف ضحك من قلبه في أثناء اعتصامنا أمام القصر العدلي في دمشق في مارس/ آذار 2005، عندما هجم عليه أحد شباب المدارس الثانوية الذين جلبتهم أجهزة الأمن لتفريق الاعتصام. خاطبه ذلك الشاب، قائلاً: أنت عميل للإمبريالية، فكاد أبو خلدون يختنق من كثرة الضحك، فيما دُهش الشاب من جوابه بلهجةٍ حورانيةٍ تزيد إجابته الصادمة متعة: “أنا لو طالع بيدي أصير عميل للإمبريالية ما قصّرت، إنت مفكر بيقبلوا أي واحد يصير عميل عندهم، شو بدهم بواحد مثلي”.
اعتدت سماع صوته، كلما غادر دمشق، فقد كان يتصل بي، ويستفيض في بثّ آلامه وشجونه. كان متألماً جداً تجاه أحوال أصدقائه، وكيف أصبحوا خلال السنوات الأخيرة والمحطات التي وصلوا إليها. لم يتردّد أبداً في سنوات ما قبل الثورة في مساعدة أصدقائه، خصوصاً عندما يُلقى بهم في المعتقلات.
عرفت، أخيراً، أن حالته الصحية تدهورت سريعاً، اتصلت بابنه باسل، وحاولت الاتصال به مرات عدة، لكن الشبكة “الحكيمة” في دمشق لم تسعفني. كثيراً ما جالت في خاطري عودة سهرتنا الشهرية المعتادة في منزلي مع بقية الأصدقاء.
رجال يرحلون فتبكيهم أسرهم، ورجال يرحلون فيبكيهم الأصدقاء، ورجال يرحلون فيبكيهم الوطن… سورية اليوم تبكي أحد رجالها المحترمين. سلام عليك حاضراً وغائباً، يا أبا خلدون، فقد كنت كبيراً في حياتك، وستشمخ كثيراً بعد الغياب.
العربي الجديد
عن حسين العودات/ معن البياري
أجمعت كتاباتٌ نعت، في اليومين الماضيين، الكاتب السوري، حسين العودات، على “ميزةٍ” حازها، من بين كثيرين من أترابه المثقفين من بني جلدته، هي بقاؤه في سورية في أثناء محنتها الراهنة، محافظاً، في الوقت نفسه، على انحيازه ضد التسلط والاستبداد والفساد، وعلى قناعته بوجوب حلّ سلمي للأزمة الحادثة في وطنه، وعلى إيمانه المؤكد بأهداف الثورة السورية التي انطلقت من مدينته، درعا، قبل خمس سنوات. بدا أن التنويه بمرابطة حسين العودات في دمشق، في استعراض سيرته، وفي الإضاءة على مؤلفاته وتجربته الثقافية والسياسية، مع وفاته يوم الجمعة الماضي، ينطوي على إعجابٍ مضاعفٍ بالرجل، وعلى سؤالٍ مضمر عن أسباب من غادروا بلدهم، وكان في وسعهم البقاء فيه، أو ربما كان لازماً أن يبقوا فيه. وأتذكّر، هنا، عدم استحسان الروائي السوري، خالد خليفة، السؤال الذي كثيراً ما يُطرح عليه، في غير بلدٍ عربي، عن سبب بقائه، إلى الآن، في سورية. وفي الوسع أن يُقال إن حسين العودات لم يكن يرى في “صموده” في دمشق أفضليةً لديه على غيره من زملائه المثقفين السوريين، الوطنيين ذوي الخيار التحرّري الديمقراطي، والذين ما “نفوا” أنفسهم خارج بلدهم إلا لشعورهم بأن أدواراً في وسعهم النهوض بها، لخدمة القضية السورية، بشكل أكثر جدوى ونفعاً مما لو ظلوا تحت الحصار المعلوم، وفي أجواء التضييق المعروفة، وفي ظل سقوف السلطة، ولعبتها السخيفة في التمييز بين “معارضة وطنيةٍ” و”معارضة غير وطنية”.
من شمائل غير قليلة في الراحل النظيف، حسين العودات، أنه كان مطبوعاً بمقادير غزيرة من البساطة والروح السمحة التي تكاد بلا حدود، وربما الوداعةُ التي كانت باديةً في شخصه هي التي جعلته غير جذريٍّ في ثوريّته، وغاندياً في معارضته السلطة في بلده، ربما يراها بعضنا، من زاويةٍ راديكاليةٍ، مشوبةً ببعض المحافَظة. وفي الوقت نفسه، حظي بإجماعٍ تام (بلا مبالغة؟) من كل تلوينات المعارضات السورية الوفيرة، على مناقبيّته الوطنية، وأخلاقيّته الرفيعة في تمسّكه المؤكد بوجوب تخلص السوريين من الدولة الأمنية، ومن حكم النظام الشمولي. عمل موظفاً رفيعاً في الدولة السورية، سنواتٍ طويلة، وكان في وسعه أن يصير وزيراً لو جال في خاطره أمرٌ كهذا، غير أنك، في غضون وظائفه الحكومية، قبل عهد حافظ الأسد وفي أثنائه، لا تعثر على ما يخدش الحيّز الذي أراده لنفسه، مثقفاً صاحب خيار آخر غير الذي تُريده السلطة، أي الالتحاق الذيلي بها من النوع إيّاه. وفي الوسع أن يُقال، هنا، إنها ليست مصادفةً أن يكون آخر كتب الراحل هو “المثقف العربي والحاكم” (دار الساقي، 2012). وقد جاء فيه على محاولات الحاكم العربي فرضه على المثقف “الطاعة في مقابل امتيازاتٍ يقدّمها له”. كأنه ودّ أن يودّع الحياة (عن 79 عاماً) وقد قال كلمته في هذا الشأن الشائك، وفي سورية خصوصاً التي تقيم منذ أزيد من خمسين عاماً تحت سلطةٍ لم تر للمثقف غير دور الطاعة.
تابع حسين العودات نشاطه مثقفاً مدنياً، صاحب موقف، في مقالاته التي واصل نشرها، في صحيفتين عربيتين، من دمشق نفسها، عن الاستبداد والتوحش، عن راهن سورية وتشابك المصالح والمناورات والمعارك حولها. وفي كل ما كتب، بقي، رحمه الله، على مبدئيته في تأكيد حق السوريين بدولةٍ حديثة، تقوم على مرجعية المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. وهذه كلها، وغيرها، ثوابتُ في التشكيلات المدنية التي كان الراحل من مؤسسيها وفاعليها النشطين، منتدى الأتاسي وإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وغيرهما، قبل أكثر من عشرة أعوام. وقد توازى حضور هذه المرجعيات في مؤلفات حسين العودات (منها “النهضة والحداثة بين الارتباك والإخفاق”، دار الساقي، 2011) وحضوره الفكري والثقافي في بلده مع شغفٍ بثقافة الجمال والإبداع، دلّت عليه إطلالة له على “السينما والقضية الفلسطينية”، في كتاب أنجزه بهذا العنوان (للتذكير فقط)، وكان من إصدارات دار الأهالي للنشر التي أسّسها، وطالعنا منها غير القليل الذي أحببنا وأمتعنا..
العربي الجديد
أبو خلدون، المعلم… إلى اللقاء/ زياد منى
برحيل الأستاذ والمعلم الكبير، حسين العودات، تفقد سورية، والعالم العربي معها، رائداً من رواد النهضة الحديثة والتحديث والحداثة، وواحداً من كبار نخبها الفكرية. قبله فقدنا أحد عظام السينما في العالم العربي، الصديق الراحل نبيل المالح الذي شرفّنا بتصميم لوغو الدار وكثير من أغلفتها، ومن قبل الصديق الصدوق ممدوح عدوان وزوجه إلهام عبد اللطيف، وقبلهم كثيرين، والقائمة تطول.
الراحل الكبير لم يكن ناشراً عادياً، لا يَعُدُّ هذا المجال أمراً تجارياً، بل عالِماً حريصاً على اختيار إصدارات دار الأهالي، التي كان لي شرف نشر مؤلف لي عبرها، عندما كنت مقيماً في ألمانيا. فالراحل كان أيضاً مؤلفاً مؤرخاً ومحدثاً يمتعك بالحديث عن تجاربه اليومية، وعن حيواته وخاصة ما يتعلق بتاريخ موطنه في حوران، والمسيحية الضاربة جذورها في تلك الأرض الطيبة.
قبل حضوري إلى سورية للإقامة والعمل في مطلع التسعينيات، لم أكن أعرف الراحل الكبير شخصياً، ومن قدمني له كان أيضاً من كبار رواد السينما الملتزمة، في المقام الأول، صديق قديم وعزيز، عراقي المولد، فلسطيني الهوى، قيس الزبيدي.
حسين العودات همّه السوري كان فلسطينياً في المقام الأول فتجلى في أحلى صوره بالمكتبة التي أصدرتها دار الأهالي عن مدن فلسطينية، تضم أكثر من عشرين مؤلفاً.
لكن همه كان أيضاً سورياً، ومؤلفاته الأخيرة عن نزيف سورية والحرب فيها وعليها، تعكس قلقاً حقيقياً. الراحل جمع بين الفكر والممارسة، لذلك اختار البقاء في وطنه النازف، لكن من دون السكوت عما رآه من عوامل ضعفه التي أفضت إلى المأساة السورية. قد يختلف المرء معه في بعض التفاصيل، لكن لا بد من أن يتفق معه في الأولويات وفي مقدمتها الحفاظ على الوطن السوري، دولة عِلمانية لكل أهلها، وقلعة عروبية صلبة، ورفض قاطع للارتهان للقوى الخارجية ولأموال الفساد البترودولاري وإفساداته.
وعندما أتيت سورية في زيارة عائلية، تشرفت بالتعرف إليه وإلى زوجه السيدة المربية الفاضلة صبحية بحبوح، في منزلهما في حي المزة الدمشقي، فزاد وسع معارفها وفكرها الريادي سحري بالعائلة الكريمة وموقعها في عالم النخب الثقافية.
وفي بيته تعرفت أيضاً إلى ابنه الأخ العزيز باسل العودات، صاحب مكتب السندباد، الذي كان يُخرج إصدارات قدمس، وعبره تعرفنا أصول الإخراج وأفضل المطابع التي تنجز أعمالها بالحرفية المطلوبة.
وعندما بدأت بالتحضير لتأسيس دار قَدْمُس، أشار إليّ الشريك في الدار والصديق العزيز د. زياد إسرب، باستشارة الراحل الكبير قائلاً: «ستتعلم منه تفاصيل هذا المجال المعروفة والمكتومة. استمع إلى كل ما ينصحك به، فإن قوله هو الصدق بعينه».
وهكذا كان حقاً، ومنك، أبا خلدون، تعلمنا الكثير، وإرثك الفكري والتاريخي وما أصدَرَت دار الأهالي برعايتك وإشرافك سيبقى له أمكنة خاصة في عقولنا وفكرنا، وفي مكتباتنا، الخاصة ومكتبات بلادنا العامة.
وعندما قررنا، د. زياد وأنا، تأسيس دار نشر في لبنان، بالاسم ذاته، في بيروت، حيث الأوضاع تختلف، نصحني الراحل الكبير باستشارة صاحب/ شريك في مكتبة بيسان البيروتية، هو الصديق العزيز عبد المسيح أبو جودة. قال لي وقتها الكلمات ذاتها التي قالها العزيز زياد إسرب في الراحل. قال: «سيعطيك أصدق الأخبار والمعلومات، وستجد فيه شخصية نادرة الخلق والصدق والمعرفة». وهذا ما فعلت، وما اكتشفته أيضاً. فبفضل الراحل الكبير تعرفت إلى شخصية استثنائية، ليس فقط في عالم الكتب والنشر، فكانت استفادتي مزدوجة، وفوزي الروحي عظيم حقاً.
الراحل الكبير، المتحدث اللبق والودود والصادق والمرح، كان أيضاً حريصاً على التحذير من آفات عالم الثقافة والعمل فيه، ومن الجهل المحيط «من الخليج إلى المحيط!». فقال لي مرة: حذار من تبعات اختيار عالم النشر، فقد يزور مكتبك زائر ليسأل عن «المنشرة» التي تنشرون بها كتبكم! وقد يسألك أيضاً عما تفعلونه بـ«نجارة» الكتب المنشورة وفوائدها، وإن كان بإمكانه الحصول على بعضها!
مرحه الودود تجلى مرات كثيرة في لقائتنا المطولة خصوصاً عندما بدأت العمل وكنت في حاجة مستمرة لاستشارته والأخذ برأيه في أمور النشر ومشاكله. كنا نلتقي في أغلب الأحيان في أحد المطاعم في منطقة الربوة الدمشقية، المطلة على نهر بردى، الذي كان ذهبياً كاسمه اللاتيني الأصل، والمحتضر حالياً، فأخطأتُ في اسم المنطقة والمكان، فأجابني مازحاً: ما فائدة معرفتك بما كان قائماً في دمشق قبل خمسة آلاف عام إذا لم تكن تعرف اسمها الآن! معارفك التاريخية لم تفدك أيها المؤرخ، وعليك البدء بقراءة جغرافية البلاد الحالية أيضاً، كي تتمكن من جمع حاضر هذه المدينة والبلاد العريقة إلى ماضيها الضاربة جذورها في أعماق الأرض.
الراحل الكبير التقيته قبل نحو شهر في مكتبة الفرات في بيروت، لصاحبها الصديق العزيز عبد المسيح أبو جودة، المعروف تحبباً بالاسم المختصر، عبودي، وكانت آخر مرة ألتقيه، عند صديقه ذاته الذي أوصاني به.
إن فقدانك أيها المعلم الكبير لخسارة، ليس فقط لأحبائك، بل أيضاً لسورية التي تَحِنُّ إلى عقل وفكر حداثي تنويري، هي أشد ما تحتاج إليه خصوصاً في هذه المرحلة، لكن ما تركت أنت، وكل النخب الفكرية والعلمية والأكاديمية في سورية وبلاد العرب، من إرث فكري حداثي تقدمي سيبقى منارة للأجيال الجديدة ومرجعاً لها لهزيمة المشاريع الماضوية المتخلفة، مشاريع الغزو والنهب الأعرابية، التي لا تعرف أمراً غير أحط الجرائم وأكثرها خسة، المعروف منها وغير المعروف.
إلى اللقاء أيها المعلم.