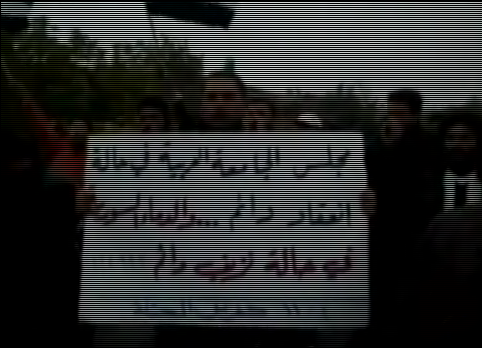حماة الديار.. عليكم سلام!!: فاديا زيد

فاديا زيد
في “الدحاديل” حيث الهاربون من الفقر وقلة الحيلة.. وحيث التاركون لأرضهم بسبب فساد الزراعة، يجتمع أهل الساحل السوري، مع قلة من محافظات أخرى ينتمون للمصير ذاته؛ من الذين تركوا أراضيهم و قراهم وقرروا الفوز بوظيفة في دمشق، إلى جانب كثيرين ممن فتحت أمامهم فرصة التطوع في الجيش والشرطة والأمن على مصراعيها، كي يؤسسوا مجتمعهم المغرق في الخصوصية والغرابة، كشكل جديد مشوه لمنهج تلاقح الريف مع المدينة.
هناك حيث يتعايش الجهل والفقر، جنبا إلى جنب مع وهم السلطة واللاقانون، ستتعرف على سوريا الحاضر… سوريا التي خًرِبت مدنها عن سابق إصرار و ترصد!
في الدحاديل لن تشعر بأنك غادرت قريتك. فالشوارع الترابية والبيوت المتراصة بعشوائية حميمية، و المترافقة مع رجس خاص من موسيقى الكلام الذي تضج به تلك العشش، سيعيد إليك تلك الألفة المفتقدة من حياة الغربة والمدينة بشكلها الكلاسيكي النمطي، لكن لتتعرف على شكل آخر صنعه ريفيون نزحوا قسرا إلى مدينة الأحلام دمشق!
الوقت: هو عصر أحد أيام الصيف الحارقة.. وها هي النسوة الآن يرششن الماء أمام بيوتهن الفقيرة. بيوت بنيت حسب ما تيسر. هي اقرب ما يكون إلى مآو موقتة، ريثما يشتد عود الموظف الفلاح ويتسلق رويدا ليفوز بإحدى بيوت الجمعيات السكنية أو في مساكن عدرا العمالية، دونا عن غيره من الموظفين، فهو: بالضرورة ابن أو أخ أو ابن عم أو خال أو أخت أو قريب، ذلك الضابط في الجيش العربي السوري.
إلى أن يأتي ذلك اليوم، لا بأس من أسقف ممدودة على “عضاضات” خشبية وفوقها طبقة رقيقة من الباطون، أو القش الممزوج بالتراب -على طريقة القرية الريفية- تكون عرضة بشكل دائم لدلف مياه الأمطار، أو التصدع أو السقوط!!
لكن هذه العشوائيات وعلى فقرها، لها جماليتها الخاصة الممتعة أيضا. فتلاصق الأبنية -العشش وقربها من بعضها البعض، وطبيعة بنائها، ككتل متراكمة، سيزيد من عملية التواصل بين النازحين. وسيتمكن الجيران من سماع نقاشات بعضهم البعض بما فيها تلك العائلية الداخلية، والاطلاع على أخبار من يعرفون ولا يعرفون من الضيعة، كما متابعة آخر مستجدات الترفيعات والحوافز والمهمات العسكرية والمدنية داخل وخارج القطر. أما الأكثر إثارة، فهي تلك الآهات الخارجة عنوة في الليل من مخادع الزوجية.. .. هذه بالذات ستشكل، في اليوم التالي، موضوعا ساخنا وممتعا للتندر والمزاح حين تجتمع النسوة أمام البيوت.
تُخرِج “أم جعفر” الكراسي من بيتها وترتبها حول طاولة منخفضة وضعت عليها صحون البزر المصري ودوار الشمس للتسلية، مع عدد من “كاسات المتة” المنقوعة وعلب سجائر “الحمراء الطويلة”. ثم تنادي بأعلى صوتها الجبلي على أم صفوان في البيت المجاور كي تجلب معها الغاز “السفاري” والإبريق. وهكذا يستمر الصراخ إلى يكتمل النصاب ويبدأ دولاب الأحاديث في الدوران.
في ذلك اليوم كنت في زيارة لصديقتي، التي دعتني لمشاركة النسوة في طقسهن اليومي المعتاد، فرحبت بالفكرة. و بعد السلام و التعارف أحسست بأنني اعرف إحداهن كانت تخبرنا عن طقم الصالون الجديد الذي اشترته اليوم من صالة 8 آذار.. نقدا. وكم كانت دهشتي عارمة حين تبين أن هذه المرأة هي ذات المرأة التي نراها تجلس في الصالحية أمام بياع العصير منذ خمس عشرة سنة، تتسول على لفافة تدعي أنها ابنها المريض!!
أما دهشتي الثانية فقد أتت على لسان “أم علي” وهي تسرد مسيرة حياتها مع زوجها أبو علي، الذي شاهدته للمرة الأولى بينما كان “يتقنزع” خلف مقود الجيب الفخمة مرتديا بزته العسكرية المموهة وبجانبه يجلس الضابط الكبير.
غمز لها فأودت تلك الغمزة إلى زواج يستمر إلى اليوم منذ ثلاثين عام. مازالت تحبه بالطريقة والحماسة ذاتهما رغم وجود أربعة أولاد. أكبرهم ترك المدرسة منذ سنوات وفتح “كشك” في السومرية يبيع فيه المهربات اللبنانية. أما رَغَد، البنت الكبرى ذات التسعة عشر ربيعا فقد نجحت في البكالوريا وتزوجت ضابطاً من “جبلة” يعمل مسؤولا في جمارك المطار، استطاع في زمن قياسي أن يشتري شقة “ديلوكس” في برزة- حاميش ويبني “فيللة” فخمة في الضيعة، وأفخم منها في “يعفور”. وآخر ما أهدى لابنتها، سيارة “ع الزيرو” لون أحمر مع شهادة السوق!!
المفارقة أن أم علي في حديثها لم تكن تتفاخر فقط، ولكن كانت تسوق أمثلة للمقارنة بين ما عانته هي مع “أبو علي” كي يصلوا إلى ما وصلوا إليه، و بين سهولة الحياة أمام أبنائها الذين دخلوا و بسرعة من باب الأموال الطائلة من دون مرورهم بما تصفه أم علي: الكفاح! فهي لا تكف عن التذمر باستمرار من طريقة تصرف أولادها وصرفهم المجنون للأموال الكثيرة على ملذات ليست ذات جدوى. فما معنى تلك الليالي المتكررة في “العرَّاد” ؟؟ والسهر كل خميس في جونية وبيروت؟ ولماذا الاستجمام في باريس واسطنبول مع أن “رأس البسيط” في رأيها أجمل مكان في الدنيا كلها؟
تنفث أم علي تبغ سيجارتها بهدوء وتتابع السرد، لتأخذنا معها إلى أيام نضالها حين كانت أنموذجا للمرأة المدبرة الصالحة. فقد جمعت “القرش فوق القرش” وصنعت لزوجها ثروة لا يحلم بها اكبر “دكتور بهاالبلد”. وكي تثبت لنا أهمية منهج التدبير، ودور المرأة، حصراً، في هذه النظرية، استحضرت “أم علي” المثل العامي الذي تردده كافة النسوة في الريف: الزلمة جنَّى والمرا بنَّى، وبالفصحى: الرجل يجني و المرأة تبني، حين نقلت، وبحسن تصرفها و إدارتها، أبو علي من جندي بسيط حقه “فرنكين”، كما تقول ممازحة، إلى مساعد أول يمتلك اليوم سيارة أجرة خاصة، و سيرفيسين يشغِّل أحدهما على خط المزة 86 و آخر على خط “مزة جبل كراجات”، بالإضافة إلى شقتين في ضاحية الأسد، يؤجر كل منها بعشرين ألف ليرة سورية في الشهر، أما كيف؟ فإليكم القصة:
دخلت أم علي وهي عروس على غرفة مستأجرة مع عائلة، هي كل ما كان يملكه الشاب أبو علي أما الأثاث فلم يكن يتعدى “طراحة” وبطانية عسكرية ولحاف صوف صنعته الوالدة، مع بعض أدوات المطبخ “المشترك” البسيطة. رضيت بالقليل كونها كما تقول: “بنت أصل”. ولكن سرعان ما فتحها الله في وجههم وأصبح أبو علي مساعد أول في الجيش. ولأنه كان المسئول عن إطعام الجنود، فقد اعتاد “أبو علي” في البداية ان يحضر معه إلى البيت قليلا من الخضار والفاكهة من الثكنة! و تندم “أم علي” اليوم على غباء أصابها حين كانت توزع ما يزيد عن حاجتها إلى الجيران، بعد أن ابتكرت بفطنتها فكرة نقلتها من الأرض إلى السماء، حين سألت أبو علي يوما إن كان يستطيع أن يرسل لها كميات أكبر من الأطعمة. وحين استغرب من طرحها قالت له: “هنت شو خصك. بعات وبس!!” لم يتوان أبو علي” عن إطاعة زوجته التي يثق بذكائها وفطنتها فأصبح يبعث لها من الثكنة صناديق فاكهة وبيض وخضار ودجاج بالإضافة إلى خاروف مع كل دفعة. ولأنها امرأة تحب بيتها، فقد اتفقت “أم علي” مع جارهم السمان “أبو جعفر” بان ترسل له الكميات بأسعار اقل من أسعار السوق وبعد فترة انتعشت تجارة “أم علي” فتعاملت مع أكثر من تاجر وأكثر من لحام! وهكذا، ومع مرور الزمن بدأت أم علي، تضع الألف على الألف، والمئة ألف على المئة ألف حتى اشتروا البيت المستأجر و البيت الذي بجانبه. ومن غرفة “صغيرة و حنونة” إلى بيت فسيح مكون من خمسة غرف و صالون وارض ديار فيها عريشة عنب و بحرة ومجموعة نراجيل مرصعة !! تختتم “أم علي” سيرة نضالها من الفقر إلى الثراء و تقول: “الدنية بدها صبر.. عشنا فقر كتير بس الحمدالله لو ما كون أنا قد حالي كنا ظلينا ع الحصيرة و الطراحة”!
يومها عرفت ماذا يأكل الجيش العربي السوري، ولماذا يحتاج الجندي آلاف الليرات شهريا مع أنه يخدم الإلزامية المجانية! وعرفت أيضا كيف يقضي الجندي الفقير أيام تلك الخدمة منتظرا يوم التسريح بفارغ الصبر. وأكثر: لماذا يكره الجندي جيش وطنه! فإذا كان في كل ثكنة أبو علي واحد، تقف خلفه أم علي واحدة كالتي تعرفت عليها، فبالتأكيد سيكون الجوع سيد الموقف، وحمدت الله أن أم علي لم تكن جشعة أكثر وتطلب نصيبها من خبز العسكر، الذي على ما يبدو كان هو غذاء الجنود الأساسي، لكن الأكثر إيلاما كان في سؤال مازال يؤرقني: كيف سيدافع هؤلاء الجنود عن الوطن بمعدة فارغة؟ كيف سيقاتلون عدوا بقيادة مسؤولين لم يورثوا سوى حقد مكبوت على كل من أمثال أبوعلي ومن يقف خلفه! على كل من يسرق قوت العسكر ومن يساعد ويستفيد من صناعة آلاف من أشباه أبو علي…
المستقبل