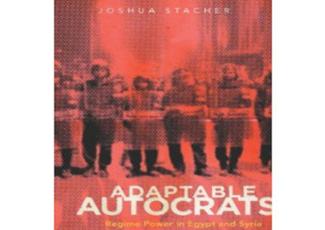حوار طويل مع محمود درويش في كتاب جديد لإيفانا مرشليان: أنا نادم على خروجي من حيفا!

عام 1991، كان الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش في مرحلته الباريسية وكان يطلق من هناك دواوينه الشعرية التي كتبها بوحي من ذاكرته الطفولية الوطنية وأيضاً بوحي من منفاه الجميل: إنها باريس وكان يسكن في أحد شوارعها في شقة لطالما أشار إليها كل محبّيه من عرب وأجانب راصدين خروج شاعرهم لموافاته وإلقاء التحية عليه، وكانت المحاورات الصحافية قد توقفت معه بطلب منه معتبراً أن كل ما أراد أن يقوله قد قاله في مقابلات سابقة. غير أن الصحافية إيفانا مرشليان وكانت آنذاك تعمل في القسم الثقافي من مجلة “الدولية” في باريس وتتابع دراستها الجامعية في آن، قد انطلقت في مغامرة الحصول على مقابلة معه من شغفها الكبير بشعره وقصائده، فرتّبت أسئلتها وحضرت الى موعد معه كان الاحتمال الأكبر عدم حصوله، وكانت المفاجأة أن الشاعر أحب الأسئلة وتلمّس بداية صداقة شعرية عميقة ستربطه بهذه الشابة التي حفظت كتبه غيباً من شدة حبها لقصائده، فقرر أن يكتب لها المقابلة بخطّ يده وعلى دفعات قائلاً لها: “سيكون هذا المخطوط بعهدتكِ”… وبعد سنوات على كتابته للمخطوط، كان لقاء في بيروت عام 2002 فسألها عنه وأكدت له تمسكها به كأيقونة مقدّسة.
اليوم، وبعد خمسة أعوام على رحيل الشاعر الكبير محمود درويش، أعدت إيفانا مرشليان كتاباً صدر أخيراً عن “دار الساقي” في بيروت وتوقّعه ضمن “معرض بيروت العربي والدولي للكتاب” بتاريخ السبت 14 كانون الأول مساء، وفيه المقابلة الشبيهة بالسيرة الذاتية للشاعر الى جانب مقدمة طويلة كتبتها من وحي المناسبة أرّخت فيها وعلى طريقتها تلك اللحظات الاستثنائية التي جمعتها به حيث توطّدت بينهما صداقة وحوارات طويلة حول الشعر والحياة وفلسطين والحب والمرأة والأم وكل الموضوعات التي شكّلت عالمه الشعري الساحر: “أنا الموقّع أدناه محمود درويش… بحضور إيفانا مرشليان” عنوان الكتاب (صدر عن دار الساقي) ويضمّ الى المقدمة والمقابلة المطبوعة، المخطوط وعدداً من الصور الفوتوغرافية غير المنشورة للشاعر. نقتطف من الكتاب جزءاً من المقدمة ومن المقابلة:
[من مقدمة إيفانا
تشرين الثاني/ نوفمبر 1991
زمن لم يكن فيه لا المرض ولا الغياب مرادفين لاسم الشاعر الفلسطيني محمود درويش، بل النجومية المطلقة، في مدينة النور، حيث أمضى أعوام مرحلته الشعرية الذهبية، في عجقة الحضور والنشر والتأليف والأمسيات.
… وهناك أيضاً، احتفل الشاعر بدخوله الخمسين.
لقاؤنا الأول تم في باريس، العام 1991، بعد أمسية قرأ فيها من ديوانه الأخير “أرى ما أريد” واحتشد لسماعه آلاف العرب والأجانب… أما الثاني، ففي منزله الكائن في ساحة الولايات المتحدة الباريسية، والمطلّة من طبقته الخامسة على برج إيفل و”أشجار المنفى والحمامات الرمادية”، وذلك بعد أن وافق شاعر فلسطين، المعتكف عن المقابلات لأكثر من أربعة أعوام، على إجراء حوار أدبي معي، بطلب من الأستاذ أنطوان نوفل، رئيس تحرير مجلة الدولية، وكنت يومها محررة ثقافية فيها.
تأجل موعدي مع محمود درويش مرتين:
الأولى “لأسباب عمل طارئة”، والثانية لدواع بحت مزاجية.
أنتظرك غداً في الرابعة… ولا مانع لدي إن تأخرتِ قليلاً”.
دعوة ملغومة، تشبه، الى حد غير مبالغ فيه، أغنية فيروز “تعا ولا تجي”، وأفهمتنا جميعاً مضمونها المبطّن الذي يخفي ربما رغبة في عدم اللقاء.
دعوة انتظرتها لأكثر من أسبوعين، لكن ما أن وصلتني حتى أجفلتني وقلبَت سعادتي غمّاً وعتباً، من دون أن يتأثر او يتفاجأ لهذه المزاجية زملائي والمسؤولون في المجلة، بل راحوا ينبّهون عليّ بإجماع العارفين:
“تحضّري وحضّري أسئلتك بذكاء وعناية. وفي مطلق الأحوال لا تتوقعي أن يستقبلك لحوار صحافي، بل ربما للتعرف الى عاشقة استثنائية لأشعاره، بحسب ما أخبرناه عنكِ بعد الأمسية”.
في ذلك اليوم بكّرت في ترك مكاتب المجلة، وأهملتُ، لأول مرة، محاضرات مهمة في الجامعة لأتفرّغ ليلة كاملة للأسئلة.
عدت مسرعة الى غرفتي في البيت الأرمني من المدينة الجامعية، وحضّرت القهوة المرّة لقريحتي المشتّتة، ورحت أتأمل بصمت الشجرة العملاقة، قبالتي، تتمايلها عاصفة هوجاء في الخارج، ففتحتُ لها، لأول مرة منذ أربعة أعوام، شبّاكي الزهري الواسع، وتركتها تقتحم الغرفة بأغصانها المبلّلة:
“شعر درويش الحزين قلتُ في نفسي يشبه الشتاء… فعسى المطر الغزير في الخارج يلهمني أسئلة تروق له، فلا يرفضني ولا يرفضها، وإلا سأحقُد عليك أيها الشتاء طالما حييت”.
وحيدة جلستُ عند حافة النافذة، أراقبُ حركة المارة ومظلاتهم المتطايرة على امتداد جادة جوردان، وأدوّن أفكاراً وأسئلة محتملة لشاعر “جواز السفر”… و”أمي” و”ريتا”.
20 سؤالاً وأكثر رتّبتها وأنا على قلق:
ماذا لو خيّبني درويش بعد لقاء الغد، كبقية الإعلاميين الذين اعتذر منهم بالجملة ولم يخصّ أياً منهم بعبارة أو كلمة؟
أقنعتُ نفسي بالأمل الى أن اقتنعتُ أخيراً:
الحوار مع شاعر “ورد أقل” و”ذاكرة للنسيان” يستأهل كل هذا الانتظار، حتى لو لم يحصل اللقاء أبداً!
10 كانون الأول/ ديسمبر 1991
إنها الرابعة من بعد الظهر، إلا… عشر دقائق، جاءت إضافية رائعة ومنقذة، جلت خلالها وحدي في أرجاء الساحة الفسيحة، أستنشق جوّها الماطر باستمتاع وهدوء، وأبحث عن الرقم 7 من بين سائر المباني المتشابهة، محاولة التخفيف مما في داخلي من توتر… كيف لا والشاعر الذي فوق هو محمود درويش، وكنت أتحضّر نفسياً للاختبار الثقافي الذي نبّهني إليه زملائي، وتلك سابقة أربكتني لأنها غير مسبوقة في حياتي المهنية(…).
وجاء اليوم الموعود… وقفتُ على بعد خمس طبقات من تحقيق حلمي الصحافي، أعانقُ عقارب الساعة: إنها الرابعة والربع، ولدي بعد متّسع من الوقت أتأخّره بحرية، نزولاً عند رغبة صاحب الدعوة… ولم أحسم أمري قبل الرابعة والنصف، حين صعدتُ أخيراً، لأجده في انتظاري، أمام مصعد شقته، جميلاً أنيقاً مبتسماً و… متأملاً ساعة يده:
ـ يا أهلاً بإيفانا الرهيبة… لماذا هذا التأخير؟
ـ أنتَ طلبتَ مني أن أتأخّر…
واستعجلتُه: أستاذ محمود، هل تمنحني الحوار لأن رئيس التحرير أصرّ عليه؟
فأجابني، محاولاً التخفيف من وطأة الاتهامين:
[ حقاً أنت رهيبة! هذا كله تأويل!! “كنت أمزح معاكِ”(…).
25 كانون الأول/ ديسمبر 1991
الساعة الثالثة
تركت مترو كليبير وبي شوقٌ الى السير على القدَمَين حتى الساحة الكبيرة للولايات المتحدة. المطر كان خفيفاً، وزينة الميلاد التي تملأ الجادة الواسعة والشوارع خلفها أنبأتني بيوم استثنائي سعيد. أعرف الآن، وفي هذه اللحظة بالذات، أنه كان أروع ميلاد في حياتي أقضيه وحدي في باريس، لكنني في الواقع كنتُ أستعد أيضاً، ومن حيث لا أدري، لاستلام أثمن الهدايا:
من أجمل رجل… في أجمل ساحة… في أجمل مدينة.
تجوّلت في الشوارع الخاوية، وكأن نوراً إلهياً يضيئها. لم أفرح يوماً في باريس كمثل ذلك اليوم. كل شيء حولي كان ينذر بسعادة نادرة، كتلك التي تشعر أنها لا تأتيك إلا مرة في العمر. تطايرتُ في الضباب الكثيف كالفراشات. شعرتُ بروحي خفيفة، هائمة وملونة المشاعر… حطّيت فوق مقعد خشبي أتأمل زينة الساحة الميلادية من دون أن تزعجني الحمامات الرمادية، كما العادة… بل اشتريتُ لها خبزاً بالحليب من “البراسري” قبالتي، ورحت أطعمها بيدي، ولم أمنع نفسي عن السؤال:
لماذا أنا سعيدة الى هذا الحد؟
من أين أتتني كل هذه السعادة فجأة؟
هل تكون مرادف الفرح الخائن الذي تحدث عنه درويش في “يوميات الحزن العادي”؟
(“… وفجأة تضحك، تضحكك المساواة بين المحتلين والغزاة. وأنت تناضل لكي لا تأتمن الفرح… ولقد علّمتك الأيام أن تحذر الفرح، لأن خيانته قاسية، فمن أين يأتيك فجأة؟”).
لقد أتاني الفرح فجأة، فلمَ أخذله؟
سأشتري هدية العيد لدرويش، ولكن أين أجد هدية تليق بشاعريته؟ رحتُ أبحث وأتفننّ في انتقاء الهدية: يجب أن، تكون منحوتة أو لوحة فنية… ولكن، من أين لي ثمنها؟ إذاً، لا بد من تذكار رمزي يفي بالغرض(…).
[من المقابلة
سألت محمود درويش:
[ الارض الأولى هي الأم الأولى. هي الحب الأول. هي أيضاً الأغنية، التي ما ان ترافق ولادة أبنائها حتى تصبح صورة حقيقية لوجه تلك الأرض. فلو ذهبت الأرض تبقى الأغنية، وأغني فلسطين اليوم هي الأرض الموعودة. لو أعدت الى ذاكرتك صورتك الأولى هناك،
أي مشاهد تلتقط؟ أي أحاسيس ترجع إليك؟ حدثنا عن محمود “الصغير والجميل”، كما تقول في إحدى قصائدك، وعن الريح، وعن سكناك جذوع الحكايات والسنديان..
[ علي أن أبتعد عنه أكثر، في الزمان وفي المكان، أو أن أدنو منه أكثر لكي أراه بشكل أوضح، ولكي اروي سيرته. فها هو ما زال معي، أو فيَّ، يمدني بالصورة الأولى للأرض الأولى كما كانت، لا كما اصبحت عليه. وما زال يحمل الارض لعبة، وما زال يرضع من ثديها. وما زال يحن للعودة إلى بيت الارض الأول، أو إلى أرض الأرض، إذا جاز التعبير.
والريح… ما زالت هي الريح، أنصب عليها خيامي التي لا تتوقف عن الإقتلاع. ما زالت تهب من كل ناحية، وخاصة من ناحية القلب. وكأنني لم أسكن شيئاً سوى الريح التي هي تحتي – كما كان المتنبي يقول- أو فوقي كما أحاول أن اقول. فهل في اللغة ما يكفي من الارض كي نعرف سكنانا؟ ربما كان في هذا التعويض ما يبرر استمرار الأغنية، ولكن للهوية شرطاً أكثر صلابة، إنه شرط الأرض. فهل تبقى الأرض إذا ذهبت الأغنية؟ أو على العكس؟(…).
[ “أنا أعرف – تقول – أن الأرض أمي…”.
تركت وجهك فوق منديلها، حملت الجبال في ذاكرتك ورحلت.
وحين راودتك أحلام العودة كتبت: “يا أمنا انتظري، إننا عائدون”..
فكأنك لا تريد من بلادك التي ذبحتك غير منديل أمك واسباب موت جديد. تحن غإلى قهوتها، إلى لمسة يدها وإلى خيط يلوح في ذيل ثوبها. إن كل قصيدة تتناول أمك نجدك فيها “سيد الحزن” من دون منازع. وكأنك تحلم باسترجاع الأرض، فقط لتهديها إياها، لتحقق لها حلم العودة.
ماذا تروي لنا عن أمك، سر قصيدتك وحاملة نجوم طفولتك؟
أمي
[ – أمي هي أمي. ولو استطعت أن افك خصرها وضفائرها من لعنة الرموز لفعلت. نعم، تركت وجهي على منديلها، لأني خارجها أفقد ملامحي. وعندما لا أطلب من ظل هذا المأسوي، الذي هو ما يدور في بلادي وعليها، غير منديل أمي، فلأنني أسعى لاسترداد ملامحي الأولى، لاسترداد إنسانيتي في صورتي كما هي، لا كما ترسمها الجريمة الكبرى التي ارتكبت في بلادي من ناحية، ولا كما ترسمها البطولة من ناحية أخرى.
في أمي، كلما نأت، ذاكرة الارض الفلسطينية ومشهد تاريخها المتنوع. والثابت على مرأى من تحول الزمني وبقاء الروحي. والارضي التي هي أمي، هي الارض ذات الفصول الاربعة، ذات البحر الابيض وذات البحر الميت، هي الخارطة الحية لكل الشجر والعشب والزهر والدم. هي الباقية، وكأنما بلا إكتراث بالعابرين من الغزاة حتى لو صار بعضهم آباء أو إدعوا الابوة. ولكنها هي بأمومتها التي لا يشك بها مؤرخ أو طبيب أو مهندس زراعي هي أمي.
لست “سيد الحزن” في حضرتها، فهي، في تحررها من رموزها، سيدة قوية، وقاسية أحياناً، وليس في وسع الإبن أن يكون سيد أي شيء في حضرة أم قاسية. كنت أظن، وأنا صغير، أنها لا تحبني.
لا أتذكر قبلاتها وهداياها الا في سجني الأول. وبعدما تكررت سجوني تكررت زياراتها وقبلاتها وهداياها. لأدرك أن وراء قسوتها المصطنعة أماً عاطفية، هشة، وجميلة، ولكنها ايضاً لاذعة في السخرية. وعندما قابلتها، قبل أشهر في القاهرة، عثرت فيها على راوية بارعة.. لا تتوقف عن نقد السياسة والسياسيين. وحين عاتبتها: لماذا كنت تضربينني كثيراً وتحملينني المسؤولية عن كل ما يجري في الحارة؟ ضحكت لتوحي لي بأنني كنت جامحاً وكثير النكد. وعندما سالتها إن كنت سأعود إليها في بيتها، رفعت دعواتها إلى الله واضافت: إن غرفتك ما زالت كما تركتها، بمكتبتها ولوحاتها، لكننا أضفنا إليها صور زوجاتك وأنزلناها، فمتى نثبت الصورة الأخيرة؟ وطالبتني بأن أنجب طفلاً وارسله إليها.
وقالت: صحيح، إن البيت لم يتغير. ولكن كل شيء خارجه قد تغير.
… والنساء
[ من بين النساء، تذكر دوماً ريتا ونذكرها.
ريتا.. في قصائد لديك وأغنية: “ريتا، عيناك ضائعتان في صمتي وجسمك حافل بالصيف والموت الجميل”.. ريتا التي تهرب، ولا يتعبك في الليل إلا صمتها حين يمتد أمام البيت كالشارع، كالحي القديم.
من هي ريتا، التي كنستها المدينة مع باقي المغنين والتي لا تزال صورتها تأتيك بعد ثلاثين عاماً مع سنبلة أكملت عمرها في البريد، وراء الخريف البعيد؟
ـ ريتا، ليست إسم امرأة. هي إسم شعري لصراع الحب في واقع الحرب. هي إسم لعناق جسدين في غرفة محاصرة بالبنادق. هي الشهوة المتحدرة من الخوف والعزلة دفاعاً عن بقاء كل من الجسدي في ظرف يتحاربان فيه خارج العناق.
منذ خمسة وعشرين عاماً يوقظ الشتاء موقع ذلك الوجع، حيث لسعتني الأفعى، لا، لم يكن حباً، بقدر ما كان حادثة ومفارقة، واختباراً لانسانية الجسد في تحرره من الوعي.
كأنها، كأن هذا الإسم كان يغني، بعد الصهيل، ذلك الصمت البعيد البعيد الذي يأخذ كل واحد منا إلى منفاه الذي لا يتجاور مع منفى الآخر. كان يغني بلغة لا أفهم منها غير اغترابنا وتلاشي الظل في الظلام. ولكننا ندعي ملكية الزنبقة ذاتها.
لم يكن في وسع هذه الرغبة أن تنطفئ تدريجياً. كان عليها أن تحترق وأن تحرقنا. وكان على كناسي الشوارع أن يكنسوا الحادث ومغنيها في الصباح.
لا لأن حكايات شهرزاد قد انتهت، بل لأنها قد بدأت. ولأنه ليس في وسع الجسد أن يسرق الجسد كثيراً، على مرأى من بنادق الحراس.
ولكن، من هي ريتا؟ سابحث عنها مرة أخرى في جسدي. وربما تستطيع قصيدة ما أن تجدها.. ربما!
.. وبيروت
ـ عشت في بيروت فترة عشر سنوات. لكننا لا نعرف الكثير عن حياتك هناك باستثناء ما ورد في بعض القصائد، كقصيدتي “بيروت” و “مديح الظل العالي”، حيث كتبت مودعاً:
“أنا أسميك الوداع.. ولا أودع إلا نفسي”. بعد سنوات على رحيلك عن المدينة تعود إليها اليوم وبشكل لافت، في أغنيات كثيرة تتبنى قصائدك..
بأي قلب تتذكر بيروت؟ وبأي قلب تذكرك بيروت؟
ـ عشت في بيروت عشر سنين كانت كافية لأن أعبر عن حبي الإنساني أكثر لبيروت، لولا صفتي الوطنية التي قد تخدش من يعتقدون أن التعبير عن حب بيروت يعكس نية في التوطين.
مع ذلك، كتبت كثيراً عن هذه المدينة التي توقع زائرها في حالة الإدمان العاطفي عليها. ولأن بيروت أكثر من مدينة، في كل شارع مدينة، فإن كل واحد منا يبجث عن نفسه ويجدها في مرآة بيروت، دون أن يعي أن بيروت ليست هنا. وإنه هو ليس في بيروت بقدر ما هو مقيم في صورتها التي شارك في رسمها.
هل كانت بيروت جزيرة للكلام المختلف؟ هل كانت لوحة معلقة على كتيب من رمل؟ لقد دفعت ثمن هذا التميز وهذا الوصف، لا لشيء إلا لكي تدخل في حظيرة المساواة، ولكي ترتاح تل ابيب من محاكمة المقارنة التي ليست في مصلحتها(…).
.. والخيبات
ـ “كل حرب – تقول – تعلمنا أن نحب الطبيعة أكثر. بعد الحصار نعتني بالزنابق أكثر. نقطف قطن الحنان من اللوز في شهر آذار، نزرع الغاردينيا في الرخام ونسقي نباتات جيراننا”.
كأن حياتك الآنية، الرقيقة كبياض الزنابق مرحلة موقتة، تؤكد دماً أنها ستنتهي لا محالة إلى الرجوع. فيها بنيت قصائد ومددتها جسر للعائدين، وفرشت لهم الدنيا انتظاراً. ألا تخاف من خيبة الأمل؟ الا تخاف على قصيدتك إن هي بقيت أجيالاً أخرى معلقة فوق آمال العائدين وخيباتهم؟
ـ لم يعد هناك ما يكفي من الوهم لأخاف خيبة الأمل. فالعقد الأخير من هذا القرن العاصف علمنا ان نفتح باب المخيلة لكافة الاحتمالات. وعلمنا انه ليس للهاوية من قرار. وعلمنا الا نفرح أو نغضب بما يقدمه لنا الواقع التاريخي من مفاجآت.
كأن علينا أن نركب عقلاً آخر لكي نتحمل صدمة المفاجآت، ولكي نتكيف مع متطلبات فهم العالم الفوضوي الجديد.
كل شيء إذا، موقت ما دام التاريخ في حالة تعويم عام، وما دام عشوائياً الى هذا الحد. ومع ذلك، ما زال في وسعي ان أحلم، ما زال في وسعي أن أواجه صدمة الواقع بصدمة شعرية هي الوحيدة الكفيلة بتبرير حياتي. ما زال في وسعي ان أشهد على أكثر من تاريخ عشته وأعيشه في لحظة واحدة.
ماذا يبقى من كل ذلك؟
لا أعرف. وربما لا اريد أن اعرف.
فليس في قلبي مكان لطعنة جديدة.
لا اريد أن أرى بعيني سقوط ما كتبته على الورق وعلى الجدران وعلى الهواء. لا أريد أن ارى أكثر مما رأيت من خيبات الأمل. ولعل ذلك هو ما تبقى لي من أمل: أن أحصن نفسي ضد الخيبة.
أما العائدون، فانهم عائدون، بقصيدتي أو بغير قصيدتي.