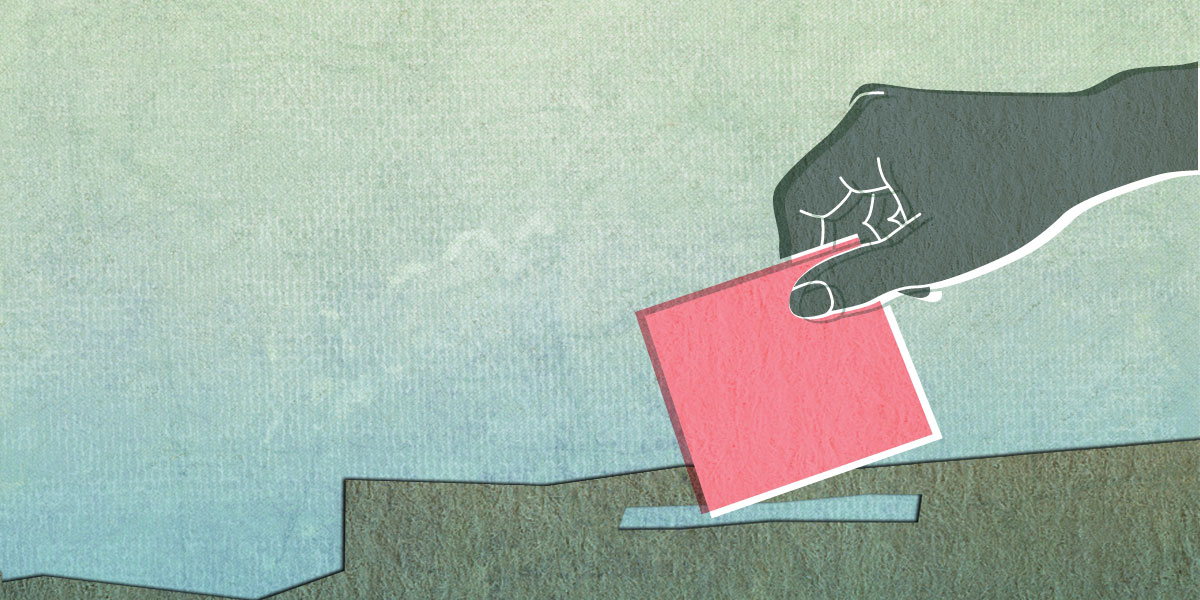حيرة الحراك العربي والتباس معنى «الثورة» و«الانقلاب»
حسن شامي
يستخدم الأتراك والإيرانيون كلمة «انقلاب» بالمعنى الذي نعطيه بالعربية الحديثة والمعاصرة لكلمة «ثورة». قد يكون هذا الاستخدام صائباً من الناحية اللغوية ما دام اسم المصدر يدلّ على تبدّل جذري تنقلب فيه أحوال جماعة أو أمة أو شعب رأساً على عقب، أو ما يقرب من ذلك. ونحن نعلم، على أي حال، أن اللغة تنمو وتذهب كما تشاء، أي كما تتقيد دلالاتها وتترسّخ في التجارب التاريخية لمجتمعات وثقافات مدعوة إلى الاحتكاك والتبادل مع مجتمعات أخرى.
ليس هنا مجال الحديث عن العروبة اللغوية والثقافية وتغلغلها في قاموس مصطلحات شعوب ذات مرجعية إسلامية عريضة اعتمدت الحرف العربي، كما حال إيران الفارسية منذ القرن التاسع أو العاشر الميلادي، وحال تركيا طوال قرون حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، وتبديل أتاتورك الحرف العربي باللاتيني. ما يعنينا الآن هو رسوخ تمايز بين مصطلحي «انقلاب» و «ثورة» في مخيلة غالبية العرب المعاصرين والمحدثين وإدراكهم. ولا نستبعد أن يكون الاتصال بأوروبا والاقتباس عنها، خصوصاً ما يتعلق بالثورة الفرنسية ودورها الأسطوري في تأسيس سردية الدولة – الأمة، بين أبرز العوامل التي حضت على اجتراح كلمة «ثورة» وعلى صوغ مرجعيتها القيمية وهالتها السحرية الجذابة في ظروف معينة.
غني عن القول، في المقابل، إن كلمة «انقلاب» باتت سيئة الذكر والسمعة في وعي قطاعات عريضة من المجتمعات العربية، بسبب دلالتها على واحد من أشكال الوصول الفئوي المرتجل والإرادوي في آن، أو القفز المفاجئ إذا شئتم، إلى السلطة من دون الاحتكام إلى آلية تمثيل شعبي صريح وشفاف. والراجح في الظن أنّ تعاظم القيمة المعطاة للتمثيل الشعبي الاختياري، وآليّته القائمة على الانتخاب الحر عبر صناديق الاقتراع هو ما يجعل «الانقلاب» أمراً سلبياً في حدّ ذاته. لكن الوصول المستند إلى تكتل مجموعة من الأفراد وإلى حظوظ نجاحهم في تأليب الرأي العام ضد الحاكم الذي أمعن في التفرّد وفي احتقار الإرادة الشعبية، كما يتصورها ويصوّرها أصحاب الانقلاب، لا يرسو على صورة واحدة. وطغت في العقود الأخيرة صورة الانقلابات العسكرية التي تنظمها في الخفاء مجموعات آتية من الجيش أو من الأجهزة الأمنية على ما عداها من صور «الانقلاب» المتأتي أحياناً من داخل السرايا أو من داخل الأسرة الحاكمة.
والحال أنّ فكرة «الانقلاب» وصورته تحفلان بتنويعات تكاد أن تعصى على الحصر، ليس فحسب من حيث الشكل، بل من حيث المضمون أيضاً. أعمار السلطات المتولّدة عن الانقلابات تعرف هي أيضاً تنويعات كبيرة بحيث يصعب تقديرها بالاستناد إلى قاعدة أو مقياس محدّدين.
يحفل التاريخ العربي والإسلامي، البعيد والقريب زمنياً، بكل هذه التنويعات. لا يمنع هذا، ترجيح الاعتقاد بأن نموذج الانقلاب الحديث جسدته تنحية السلطان عبدالحميد الثاني عام 1908 على يد ترويكا (طلعت وأنور وجمال) من القادة العسكريين الناشطين في جمعية الاتحاد والترقي، مع تعيين خلف سلطاني بلا سلطة إلى أن ألغى أتاتورك الخلافة وأعلن تأسيس الجمهورية العلمانية. معلوم أيضاً أن هذا الانقلاب تسبب في شرخ في العلاقات التركية – العربية وأطلق العنان لصوغ هويات وأيديولوجيات قومية، لدى الطرفين ولدى غيرهما من رعايا السلطنة، بطريقة لا تخلو من التسرع والارتجال. هناك بالطبع انقلابات قصيرة العمر ويغلب عليها التدبير الخارجي، كما حال الانقلاب الذي قاده حسني الزعيم في سورية عام 1949 بتدبير أميركي، أو انقلابَي رشيد عالي الكيلاني بتدبير ألماني خلال الحرب العالمية الثانية. ثم توالى مسلسل الانقلابات العسكرية – الحزبية، خصوصاً في سورية والعراق على خلفية التجاذب المعهود في الحرب الباردة وموقع الزعامة الناصرية في المنطقة. الرعاية الخارجية لا تفسر في حد ذاتها قصر عمر السلطات الانقلابية أو طوله.
وأبرز مثال هو الانقلاب الذي نظمته ورعته الاستخبارات المركزية الأميركية ضد حكومة الجنرال محمد مصدق في إيران عام 1953 والذي أعاد الشاه إلى السلطة لفترة مديدة إلى أن خلعته ثورة 1979 الإسلامية، مع بقاء ذكرى تجربة مصدق ماثلة في أذهان قادة الثورة كي لا تتكرر. لا حاجة للتوقف عند انقلاب جعفر النميري في السودان، أو معمر القذافي في ليبيا، أو عند الانقلاب الأبيض الذي قاده زين العابدين بن علي في تونس، ناهيك عن كثير من المحاولات الانقلابية الفاشلة. يبقى أنّ التشديد على تنوع الانقلابات، شكلاً ومضموناً، ضروري لئلا نقع في التعميم والتبسيط.
هناك انقلابات حملت طوعاً صفة الثورية وقبلت هذه الصفة من فئات واسعة بالنظر إلى السعة الاجتماعية للتأييد، وإلى التحولات الملموسة واستجابتها تطلعات قطاعات اجتماعية عريضة. ينطبق هذا خصوصاً على تجربة الضباط الأحرار في مصر إلى حد أن زعيم الانقلاب جمال عبدالناصر عنون مشروعه بـ «فلسفة الثورة». وهذا الافتتان بصورة الثورة أدى إلى إطلاق الصفة هذه على حركات تمرد وعصيان وانتفاض في التاريخ القريب والبعيد على حد سواء. هكذا، وصف التمرد الذي قاده أحمد عرابي في مصر بالثورة. وهكذا راح باحثون يتحدثون عن الثورة العباسية ضد أرستقراطية الأمويين القبلية، وعن ثورة القرامطة والزنج. ومع أن هذا السخاء اللفظي لا يخلو من مغالطات تاريخية بسبب إسقاطه مواصفات الحاضر على الماضي، فإنه يعبّر عن حاجة إلى معيار يجيز هذا التعريف أو ذاك. وهذا المعيار يتعلق في نظر كثيرين بسعة الفئات الاجتماعية وحجم الرهانات المعقودة عليها. والحق أن هذا ينطبق على الأمثلة المذكورة. فتمرد عرابي تحول في فترة قصيرة إلى حراك شعبي واسع ضد سلطة الخديوي والكتلة الشركسية – التركية وامتيازاتها ما استدعى التدخل ومن ثم الاحتلال البريطاني لمصر. ويستفاد من هذا أن الحدود الفاصلة بين «الانقلاب» و «الثورة» تبقى عائمة وغير واضحة. ويدل هذا على مقدار من التخبط والاضطراب الدلاليين.
النقطة المهمة هي أنّ هذا الاهتزاز الدلالي يتراسل مع اضطراب مبدأ الشرعية وفكرتها. فنحن نجد تقريباً كل أشكالها المستندة إلى قوة التقليد أو الدين أو التمثيل الشعبي أو المنظومة الحقوقية والدستورية. لا مبالغة في القول إنّ نماذج الشرعية كما رصدها وعرضها ماكس فيبر، تتزاحم وتتزامن داخل مجتمعاتنا. ويعود هذا إلى أن العيش في عصر واحد لا يعني بالضرورة العيش في زمن اجتماعي واحد. من هنا مخاوف كثيرين من سيطرة الإسلاميين، وإن كانت عبر الانتخابات.
الحياة