خيانات مضمرة/ راتب شعبو
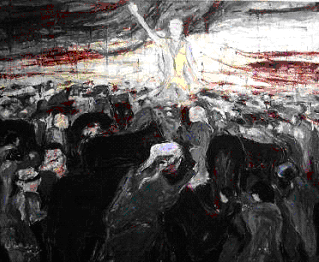
كانت النجاة الفردية من العقوبة في ذلك السجن العسكري الرهيب، تشكّل للفرد عيداً نفسياً صغيراً حتى لو شيّد هذا العيد ذاتَه على أصوات عذاب صديق ورفيق وحبيب سقط ضحية الاختيار التعسفي لـ”الرقيب أول”، على رغم مشاعر التضامن ووحدة الحال والمصير، وعلى رغم القرابة الفكرية والسياسية، وعلى رغم الصداقة والرفاقية والمحبة والعيش اليومي المشترك والمديد.
حين كان يتغلغل “الرقيب أول” بيننا ونحن مصطفّون على شكل أنساق، في كل نسق خمسة منكوبين برؤوس منكسة وعيون مغمضة ووجوه تتجه إلى الحائط، كان يختار من بيننا واحداً أو اثنين أو أكثر كي يتحولوا لبعض الوقت إلى موائد للكرابيج. كان يختار من بيننا، نحن الذين تحولنا ثمة إلى لحم بشري مخزون لغرض التعذيب.
لا أحد يستطيع التكهن بمعايير “الرقيب أول”. لماذا يقع اختياره على هذا دون ذاك؟ هل هو الطول أم ضخامة الجسد أم لون البشرة أم مكان وجود الضحية في الصف أم لون الثياب التي يرتدي أم ضخامة الأنف أم غلاظة الشفتين أم الشبه الممكن مع عدوّ شخصي لـ”الرقيب أول”… لا أحد يستطيع التكهن. وإذا صحّ تكهن ما في ما يخص “رقيباً أول” ما، فإنه لا يصح في ما يخص “رقيباً أول” آخر. على هذا لا يمكن لأحد من هؤلاء البؤساء المنكوبين المصفوفين خمسة خمسة أن يستبعد اختياره لحفلة التعذيب.
يدخل “الرقيب أول” بخطى وئيدة مطمئنة بين الصفوف، يتمتم بجمل قصيرة تشي بموقفه السياسي والأخلاقي منا، فنحن لسنا إلا مجموعة من الخونة والمنايك. يضع يده على كتف أحد هؤلاء البائسين المرتجفين ويقول بصوت بارد ومسيطر: اطلع! فيخرج الضحية من بين الصفوف لينتظر ما ينتظره. لا يعرف الباقون، برؤوسهم المنكسة وعيونهم المغمضة، على مَن وقع المصير الأسود. الشيء الوحيد الذي يعرفه كل فرد من الباقين هو أن المصير الأسود حاد عنه وأنه نجا ولو موقتاً من جرعة ألم هي بدورها غير قابلة للتخمين. فقد تكتفي الكرابيج من لحم الضحية بالقليل المقدور عليه، وقد تطمع وتطمع فلا تترك ضحيتها إلا وقد فارقها الوعي.
ربما تتكرر كلمة: اطلع، التي تقع في القلب مثل أفعى باردة، مرة أخرى وربما أكثر، قبل أن يكتفي “الرقيب أول”، ويطلب من البقية الناجية دخول المهجع، لتبدأ وليمة التعذيب. لحظات ويكتوي وجودنا بأصوات صراخ واستغاثات الذين اختارهم المصير الأسود. عذاب نفسي حاد، تجاوره، مع ذلك، غبطة صغيرة بالنجاة الفردية، نوع من التواطؤ مع النفس أو من الخيانة المضمرة. فعلى رغم كل شيء تبقى للفرد أنانيته الخاصة وانفصاليته التي لا تُخترَق إلا في لحظات استثنائية كما في لهيب الثورات أو في تمادي الحب.
اليوم، يمارس أحدنا تواطوءاً مع نفسه حين يتاح له الشعور بسعادة أن يزور أمّه في عيد الأمّ، وأن يقبّل رأسها ويشعر باحتضانها وبسعادتها لحضوره. كثير من الأمهات قضين في هذا الصراع، وقد حالفنا الحظ أن أمّنا لم تكن بين مَن ماتوا، حتى الآن. ثم حالفنا الحظ أننا لم نمت بعد، وأننا قادرون على زيارتها، حتى الآن. كانت أمّنا إذاً من الناجين، وهذا ما يبعث فينا سعادة ما، سعادة لم يكن لها أن توجد بهذا الشكل وهذا الدفء الأناني، إلا وسط افتقاد الكثيرين لأمهاتهم اللواتي رماهنّ هذا الدمار الواسع في عتمة الموت. إنها سعادة أنانية يشعّ بريقها على خلفيةٍ من بؤس الغير. ليس في الأمر هجاء أو تهمة شريرة لمن يغتبط بالنجاة من موتٍ حصد آخرين. في النهاية لم يكن له يد في موت الآخرين أو عذابهم، ولم يستشره القدر في مَن يميت ومَن ينجي. ولكن تبرز في هذه اللحظات فردية الشخص وانفصاليته، ويشتد سطوع القول بأن الجرح لا يؤلم سوى صاحبه.
كذا حال الأمّ التي تتحسس ابنها وتتأكد من أنه نجا حقاً من آلة الموت النشطة، وأنه لا يزال لها أن تسعد بوجوده على قيد الحياة، سعادة تكتسب قيمة خاصة على خلفية الموت الغزير الذي يُثكل الأمهات بلا هوادة.
“اطمئنوا، لستم بين مَن قتلتهم العبوة الناسفة أو شوهتهم، مات غيركم وغيركم مَن تشوّه، أما أنتم فما زلتم على قيد الحياة والسلامة”، هكذا يهمس صوت خفيض كائن في خفايا نفوسنا، بعد تفجير يودي بحياة أبرياء كان يمكن أن نكون من بينهم. هكذا تزهر في نفوسنا غبطة ناعمة لأن الحظ اختار غيرنا للموت ونَكَب غيرنا بالتشوّهات ووفّرنا نحن. هكذا يمكن أن ينحني الضمير قليلاً، ومن تلقاء ذاته، بما يسمح لتلك الغبطة “الآثمة” بأن تمر.
النهار




