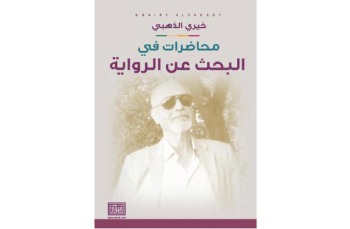دع القلق وابدأ اللامبالاة!/ أسامة فاروق

لم يجد مارك مانسون أفضل من جملة بوكوفسكي “لا تحاول” مفتتحاً لكتابه “فن اللامبالاة”. ومن قصه بوكوفسكي نفسه للتدليل على عبثية القلق على مكانتنا في العالم دون أن نعرف حدود ما نستطيع الوصول إليه.
الرواية التي ينقلها مانسون لم تضف جديداً على الحكايات المعروفة عن تشارلز بوكوفسكي “مدمناً على الكحول، مقامراً، زير نساء، بخيلاً، وأخرق..إلخ” لكن اللافت أن النجاح الكبير الذي حققه بعد 30 عاماً من الفشل، لم يغير الشيء الكثير في طبيعته الشخصية، وهو ما لفت انتباه مانسون للحكاية برمتها، يقول إنه لم يكن مبالياً بالنجاح الكبير الذي وصل إليه أخيراً، وحتى بعد أن صار شهيراً، ظل يستقبل في قراءاته الشعرية أشخاصاً بؤساء ويحاول أن ينام مع كل امرأة يستطيع العثور عليها “لم يجعله النجاح والشهرة شخصاً أحسن من ذي قبل. ولم يصبح ناجحاً شهيراً عن طريق تحوله إلى شخص أفضل”، ربما سعى بوكوفسكي نحو مكانة ما، لكنه ما إن وصل إليها حتى أنكرها، لم يهتم بها أو يقلق من الحفاظ عليها، لذا لم يكن غريبا ًأن نقرأ العبارة المحفورة على قبره: “لا تحاول”.
حكاية أخرى لا تقل في دلالتها، لكنها هذه المرة من كتاب آلان دو بوتون “قلق السعي إلى المكانة”. حكاية بطلها راوي البحث عن الزمن المفقود لمارسيل بروست، فذات مساء كثيف الضباب في باريس عند نهاية القرن التاسع عشر، يذهب الراوي البرجوازي إلى مطعم فاخرٍ لتناول العشاء مع صديقه الأرستقراطي، الماركيز دي سان لوب. يصل الراوي مبكرًا ويتأخر صديقه، فيحكم العاملون في المطعم على زبونهم بناء على معطفه الرث واسمه غير المعروف، ويفترضون أن مَن دخل مطعمهم العريق ليس إلا نكرة. فيتعاملون معه بتعالٍ، ويأخذونه إلى طاولة عُرضة لتيّار هواء شديد البرودة، ويتوانون عن أن يقدّموا له أي شيء يؤكل أو يُشرَب.
لكن الماركيز يصل بعد رُبع ساعة، ويجد صديقه الذي ينتظره، وفي لمح البصر يغيّر من قيمة الراوي في أعين العاملين في المطعم. يقدّم المدير له انحناءة عميقة، ويفردُ قائمة الطعام، عارضًا أطباق اليوم المميزة بأوصاف بلاغية مُثيرة للشهية، كما يُطري على ثيابه، كما لو كان يُقنعه بأن تلك المجاملات ليست بسبب علاقته بالصديق الأرستقراطي، ثم راح يمنحه بين آونة وأخرى ابتسامة صغيرة مُختلسة بدت إشارة على عاطفة شخصية تمامًا.
يعلق بوتون: مهما كان نكوص المدير على عقبيه مُرضيًا، فإن الآلية الجوهرية مكشوفة وبائسة، فهو بالتأكيد لم يُصلح بأي درجة معياره المتعجرف في تقييم الناس. كل ما هنالك أنه كافأ شخصاً ما بطريقة مختلفة داخل الحدود الظالمة نفسها لمعياره القيمي.
الحكاية التي ينقلها بوتون وأيضا مانسون، تأتي ضمن حكايات كثيرة حول تقبلنا لأنفسنا وللآخرين طبقاً للموقع من السلم الاجتماعي، وكلاهما -مانسون ودو بوتون- يبحث في الأمر نفسه، تلك الحلقة الجهنمية التي ندور فيها يومياً؛ السعي لأن نكون محبوبين ومقدرين وأصحاب مكانة في المجتمع، والقلق من أننا لن نصل إلى تلك المكانة أبدا، لكن مانسون –قليل الصبر- وصل منذ البداية إلى أن العالم مكان سيئ، وأن هذا شيء لا بأس به، لأن العالم كان هكذا على الدوام ولأنه سيظل هكذا على الدوام، ومن ثم توصل إلى أن الحل هو “اللامبالاة” فعدم الإفراط في الاهتمام هو ما سينقذ العالم من وجهة نظرة “من خلال عدم اكتراثك بأن يكون لديك شعور سيئ، فإنك تبطل مفعول تلك الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها، أنت تقول لنفسك: لدى إحساس سيئ! حسنا ما أهمية هذا؟ ثم وكأن أحدا رشك بمسحوق اللامبالاة السحري، تجد أنك قد توقفت عن كره نفسك لأنك تشعر بهذا السوء كله”!
يرى مانسون أنه لا ضير في أن يكون الإنسان عادياً، لأن التقسيمات هي سرّ المعاناة من الأساس، يراه نوعاً خطيراً من التفكير “فما أن تقبل فرضية أن الحياة لا تصير ذات قيمة إلا إذا كانت مرموقة أو عظيمة، حتى يصير معنى هذا أنك تقبل من حيث الأساس حقيقة أن معظم بني البشر فاشلون لا قيمة لهم (بمن فيهم أنت) ومن الممكن أن تتحول هذه الذهنية تحولاً سريعاً إلى شيء خطير عليك وعلى الآخرين”.
بوتون أيضا يطرح الفكرة نفسها، وربما توصل للنتيجة نفسها أيضا لكن عبر منحى مختلف نسبياً، حيث افترض أن قدرة المرء على الشعور بالرضا عن نفسه لا تتعلّق بتحقيق النجاح في كل مسعى من مساعي الحياة. لكنه يؤكد أننا لا نشعر على الدوام بالمهانة إذا ما أخفقنا في بعض الأمور؛ نشعر بالمهانة فقط إذا ما استثمرنا كبرياءنا وإحساسنا بقيمتنا في طموح أو إنجاز محدّدين، ثم خاب سعينا إليه “تفرض أهدافنا ما الذي سوف نترجمه باعتباره نصرًا وما لا بد أن نعدّه كارثة”، ثم يشرح الفكرة ببساطة ناقلا جملة أستاذ علم النفس الأميركي وليام جيمس: “من دون محاولة لن يكون هناك إخفاق؛ ومن دون إخفاق لن تكون هناك مهانة”.
لكنه بعكس مانسون، بدلا من أن يرفع صيحة بوكوفسكي “لا تحاول”، يوضح أن تقديرنا لذاتنا في هذا العالم يعتمد اعتماداً تامًا على ما نؤمن بأننا نستطيع أن نكونه ونحققه. لذا فالحياة كما يصورها عملية متواصلة من استبدال قلق بآخر ورغبةً محل أخرى، “وهو ما لا يعني بالمرة أننا يجب ألا نكافح بالمرة لتجاوز أي أوجه للقلق، أو نكافح لتلبية أي من رغباتنا”، لكنه يقترح بدلاً من ذلك أنه علينا ربما أن ندمج بكفاحنا هذا إدراكاً لطرائق عمل أهدافنا.
لذا، ربما يكون من الظلم وضع الكتابين في سلة واحدة، فالحقيقة أن كتاب مانسون يبدو كوجبة سريعة أمام عمق أفكار بوتون وتحليلاته، حيث يبدأ “قلق السعي إلى المكانة” بتسلسل سلس يشرح فيه المؤلف فكرة المكانة بشكل عام، ثم يؤصل لها، ويراجع تاريخها في فصول تالية، حتى يصل في النهاية إلى طرح حلولها.
يبدأ بتعريف المكانة بأنها موقع المرء في المجتمع، بالمعنى الضيق تشير إلى موقع المرء قانونياً ومهنياً داخل المجتمع (متزوج، ملازم في الجيش.. إلخ) ولكن بالمعنى الأشمل فإنها تشير إلى قيمة المرء وأهميته في أعين الناس، وهي الأكثر تعقيدا، والأكثر إثارة للقلق.
يقول بوتون إن حياة كل شخص بالغ، تحكمها وتحددها قصتا حب كبيرتان، الأولى – قصة سعينا وراء الحب الجنسي – وهي قصة معروفة وواضحة المعالم، وهي مقبولة ومُحتفى بها اجتماعيًا. أمّا الثانية – فهي قصة سعينا وراء حُب الناس لنا – وهي حكاية مُخجلة وأشد سرية. وإن ذكرت تُذكر بطريقة تهكمية لاذعة، كما لو كانت أمراً لا يهم في الأساس إلا الحاسدين ضعاف النفوس، عدا ذلك فإن دافع تحقيق المكانة يُترجم بمعنى اقتصادي وحسب. ورغم ذلك فإن قصة الحب الثانية تلك ليست أقل حدّة عاطفية من الأولى، ولا تقل عنها تعقيدًا أو أهمية أو عالمية، كما أن إخفاقاتها لا تقل ألمّا. هنا أيضا تتحطم القلوب.
لكن السعي للمكانة لم يكن ثابتاً على الدوام، ففي العالم القديم -إن صح التعبير- ساد الاعتقاد بأن التفاوت بين الناس أمر منصف، أو على الأقل لا مناص منه، هذا الاعتقاد بدا مقبولا حتى لدى المقهورين أنفسهم “فلم يومئ المنظرون السياسيون المسيحيون إلا قليلا نحو إمكانية أو ضرورة إصلاح الهيكل الاجتماعي الدنيوي، بحيث يمكن لجميع أبناء الكنيسة تقاسم ثروات الأرض بدرجة أكبر من المساواة”.
وقتها صار جون من سالزبري بكتابه Policraticus (سنة 1159) أشهر كاتب مسيحي، حيث قارن المجتمع بالجسد البشري، واستخدم هذا التشبيه لتبرير نظام التفاوت الطبيعي. في تركيبة سالزبري، فإن كل عنصر في الدولة له نظيره التشريحي: فالحاكم هو الرأس، والبرلمان هو القلب، وأفراد الحاشية هم الأضلاع والجوانب، أمّا القضاة وموظفو الدولة فهم العيون والآذان واللسان، وخزانة الدولة هي المعدة والأمعاء، والجيش هو الأيدي، والفلاحون والطبقات العاملة هم الأقدام”. يطرح بوتون هذه الصورة مؤكداً أنها أعادت ترسيخ المفهوم القائل بأن كل عضو في المجتمع قد عُهد إليه بدور لا تبديل له.
في منتصف القرن السابع عشر فقط بدأ الفكر السياسي يجرؤ على السير في اتجاه أكثر نزوعا نحو المساواة، لكنها –المساواة- تسببت بدورها في صداع آخر، وهو راحة البال، والحسد أيضاً فـ”عندما تُلغي جميع الامتيازات الناجمة عن المولد والثروة، وعندما تكون كل مهنة متاحة أمام كل شخص… فإن أي رجل طموح قد يعتقد أنه من السهل أن ينطلق في مسيرة مهنية عظيمة، وأنه مدعو لشيء آخر غير المصير المشترك لعامة الناس. لكن هذا ليس سوى وهمٍ سرعان ما تنقضه التجربة”.
يشبه بوتون الأمر بالعيش في كوخ غير صحي تتلاعب به الرياح الباردة تحت الحكم الغاشم لارستقراطي يشغل قلعة كبيرة، كنا لنرضى بهذا الوضع لأننا نرى أشباهنا وأندادنا يعيشون جميعا كما نعيش “سيكون مؤسفا بالتأكيد ولكنه ليس تربة جيدة لنمو الحسد”، فمع التسليم بالتفاوتات الهائلة التي تواجهنا بصورة يومية، فقد تكون الملحوظة الأشد تقديرًا التي يؤكدها بوتون في الحَسد هي أننا ننجح في ألا نحسد جميع الناس “هناك أشخاص غارقون في النعم الباذخة بحيث يخرجون تماماً من دائرة انشغالنا، في حين تتسبب مزايا متواضعة لآخرين بأن تجعلنا نحترق بنار عذاب لا تهدأ. إننا نحسد فقط أولئك الذين نشعر بأننا أشباه لهم – نحسد فقط أعضاء مجموعتنا المرجعية. قد نتسامح مع كل نجاح يحققه الآخرون إلا نجاحات أندادنا المزعومين، فهي لا تُطاق”.
ومع التطور التكنولوجي بات القلق مضاعفاً، ليس فقط لكثرة المغريات المطروحة في السوق، وتعدد البدائل، ولكن لأن تلك التطورات التكنولوجية نفسها أصبحت سبباً رئيسياً في حرمان البعض من أمانهم الوظيفي ومكانتهم التي حاربوا للوصول إليها، لكن ورغم ذلك كله يؤكد بوتون أن الخشية من الإفلاس ليست السبب الرئيسي وراء عدم الاستقرار والقلق بل يقلقنا الحب أيضا “عملنا يعد عاملاً محدداً رئيسياً لمقدار الاحترام والرعاية الذي سنناله من الآخرين”.
ولمواجهة حالة الإهمال وعدم الاهتمام، تظهر فوائد الطريقة الفلسفية التي يطرحها الكتاب ضمن حلول أخرى للسيطرة على قلق المكانة، منها الفن والدين والسياسة وحتى البوهيمية، الحلول الفلسفية التي يعرضها المؤلف تحت مسمى “مذهب كراهية البشر الفلسفي”، تدعوك أولا إلى النظر إلى قيمة من يعارضك أو يبدي رأيا فيك، فلا ينبغي أن نسمح لأي إدانة خارجية أن تحطم احترامنا لأنفسنا إلا إذا كانت صحيحة. سوف نغدو بالتدريج لامبالين تجاه ما يجري في عقول الآخرين عندما نكتسب معرفة كافية بضحالة أفكارهم، أو كما صاغ شوبنهاور الأمر: أيمكن لعازف الموسيقى أن يشعر بالإطراء أمام تصفيق جمهوره واستحسانه إذا ما كان يعلم تمام العلم أن جمهوره، باستثناء واحد أو اثنين، من الطرش؟
لكن بوتون يحذر من حلول الفلاسفة، يقول إنها قد تحرمنا من الأصدقاء ويفضل إذا أردنا استخلاص نصيحة من دراسات الفلسفة، أن نتبع وصيتهم بأن نتبع العلامات الداخلية لوعينا وضمائرنا، وليس الإشارات الخارجية للاستحسان أو الاستهجان “ليس المهم هو ما نبدو عليه في أعين جماعة عشوائية من الناس، بل ما نعرف أننا عليه في داخلنا”.
يأتي الموت كحل أخير لقلق المكانة، يقول المؤلف إن الموت يكشف مقدار هشاشة الاهتمام الذي نحصل عليه بفضل المكانة، وربما أيضا انعدام قيمته. عند اقتراب الموت، نصير عرضة لأن تنتابنا نقمةً شديدة على مَن أحبّونا بسبب مكانتنا، كما ينتابنا غضب من أنفسنا لأننا بلغنا من الغرور درجةً كافية لنقع في حبائلهم كما لو أننا اشتركنا معهم في تنسيق خداعهم القاسي منذ بداية الأمر”، ربما ليس هناك طريقة أفضل لتخليص جدول ارتباطاتنا من الشوائب مما لو تساءلنا من مِن معارفنا سيكلف نفسه عناء رحلة حتى فراشنا في المستشفى”.
(*) كتاب “فن اللامبالاة.. لعيش حياة تخالف المألوف” تأليف مارك مانسون، وترجمة الحارث النبهان، صدر عن منشورات الرمل.
(**) كتاب “قلق السعي إلى المكانة.. الشعور بالرضا أو المهانة” تأليف آلان دو بوتون، وترجمة محمد عبد النبي، صدر عن دار التنوير.
المدن