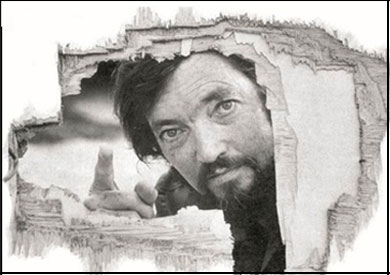زنوجة ليست كاتدرائية/ صبحي حديدي

في مثل هذه الأيام، ولكن قبل 34 سنة، كان الشاعر والسياسيّ السنغالي ليوبولد سيدار سنغور (1906 ـ 2001) قد انتُخب لعضوية الأكاديمية الفرنسية؛ فدشّن، في شخصه وموقعه الأدبي والثقافي والسياسي، عهد انضمام أبناء المستعمرات السابقة إلى الأكاديمية الأرفع مقاماً لجهة رعاية اللغة الفرنسية. فيما بعد، وكما هو معروف، سوف تنضم آسيا جبار (1963ـ2015)، وأمين معلوف؛ وقبلهما أعضاء من هاييتي والصين والأرجنتين؛ فضلاً عن دول أوروبية، والولايات المتحدة (مارغريت يورسنار عُدّت أمريكية الجنسية).
طريف، في المقام الأوّل، أنّ سنغور جلس في المقعد 16 (هنالك 40 مقعداً)، الذي يجلس فيه اليوم الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ـ دستان؛ وسبق أن احتله شارل موراس، السياسي والصحافي والشاعر والمنظّر العنصري، الذي تعاون مع نظام فيشي أثناء الاحتلال النازي، واضطرّت الاكاديمية إلى اعتبار مقعده «شاغراً»، ليس أكثر؛ إذْ كان إقصاؤه من المؤسسة، أو طرده، إجراء غير معتمد. كانت تلك مفارقة سياسية وثقافية جلية، بين فرنسي عنصري، وشاعر سنغالي لم يكن مناضلاً ضد الاستعمار الفرنسي والهيمنة الاستعمارية عموماً، فحسب؛ بل كان أحد منظّري مفهوم «الزنوجة» في الأدب، وفي الكتابة والثقافة والسلوك.
كان سنغور ثالث ثلاثة كبار لعبوا، منذ أن التقوا للمرّة الأولى في العاصمة الفرنسية باريس سنة 1931، دوراً حاسماً، بالغ الحيوية والفاعلية، في تنظيم المقاومة الثقافية ضدّ الاستعمار: الأوّل كان إميه سيزير (1913 ـ 2008)، أيقونة المارتينيك الشعرية والإنسانية الكبرى؛ والثاني كان الشاعر والكاتب الغوياني ليون غونتران داماس (1912 ـ 1978). وإلى هؤلاء تنتسب تلك الأحقاب الحافلة، الشريفة والنبيلة والإشكالية، التي شهدت طرازاً رفيعاً من تحالف النصّ الأدبي والبيان السياسي، واقتران المخيّلة الفنّية الطليقة بالواقع الملموس الأسير، وما نجم عنهما من حصيلة اندماج التحرير الجمالي بالتحرّر من الاستعمار.
وطيلة عقود طوّر هؤلاء مفهوم الزنوجة، الذي كان سيزير قد نحته كمصطلح يتوسل منهجاً تطبيقياً في دراسة ما سموه «الكتابة السوداء»، ولكي يتيح مادّة فكرية ونقدية لمقاومة الهيمنة الثقافية الفرنسية التي ظلّت جزءاً لا يتجزأ من سيرورة المشروع الاستعماري. ولقد كان للمفهوم فضل كبير في تحديد الثقافة السوداء والهوية السوداء، رغم سلسلة الإشكاليات التي اكتنفته منذ البدء، والتي كان على رأسها معضلة تنميط علم الجمال الأسود بوصفه نقيض علم الجمال الأبيض، ليس أكثر.
وحتى عهد قريب، ورغم تثمينه العالي للكتابات التي اندرجت في المفهوم، ظلّ النيجيري وولي سوينكا (نوبل الآداب، 1986) يساجل ضدّ الزنوجة؛ معتبراً أنّ المصطلح ينطوي على نزعة قَدَرية في إقامة مواجهة بين جمالية سوداء وأخرى بيضاء، وينطلق من جوهرانية عرقية لا تحتسب فوارق الجغرافيات والثقافات.
لكنّ الناقد الأمريكي هنري لويس غيتس يرى، في كتابه الشهير «الأدب الأسود والنظرية النقدية»، أنّ مناهج دراسات الخطاب ما بعد الكولونيالي عرفت كيف توظّف المفهوم وتطوّره في حقول الأدب الأفرو ـ أمريكي، وموسيقى الجاز، والفنون التعبيرية والفولكلورية الأفريقية؛ إلى جانب نسف تصنيفات استعمارية مثل أدب الكومنولث، وموضوعة «الزنجي/الأسود» في النصوص الغربية. وفي الأساس، كانت لدى الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر أسباب وجيهة لكي يتحمّس للمفهوم، حين كتب مقدّمة «أنطولوجيا الشعر الزنجي والمدغشقري الجديد»، المجلّد الذي صدر سنة 1948 وكان بمثابة التدشين الأكبر لنزعة الزنوجة.
وفي كتابها «مفهوم الزنوجة في شعر ليوبولد سيدار سنغور، الذي يعدّ بين أفضل المراجع عن الشاعر في اللغة الإنكليزية، تشير سيلفيا واشنطن ـ با إلى أنّ سنغور اختصر المفهوم في هذه الصيغة: «خلاصة القيم الثقافية للعالم الأسود كما يُعبّر عنها في الحياة، والمؤسسات، وعمل الافراد السود». وبمعزل عن الطابع الاختزالي لهذا التعريف، ونبرة التعميم التي لا تخفى، فإنّ سنغور اشتغل بدأب لتطوير بُعد مركزي في رؤيته الشخصية لـ»روح» الكتابة السوداء؛ أي إرث العذاب، حيث يستحيل على الكاتب الأسود أن يتحدث عن نفسه بدون استعادة الحقيقة التاريخية التي انطبعت عميقاً في دخيلة نفسه: العبودية، سواء تلك المباشرة الفردية، او تلك الجماعية عن طريق الاستعمار. ولهذا، تساجل واشنطن ـ با، تشتمل الزنوجة على أبعاد وجودية أولاً، ثمّ جمالية، وأخرى نفسية ـ اجتماعية، ورابعة إيقاعية في الشعر بصفة خاصة، وهكذا…
وكانت «دفتر عودة إلى البلد الأمّ»، قصيدة سنغور العظيمة التي أنجزها سنة 1939، قد تحوّلت إلى ما يشبه البيان الأدبي للزنوجة، خاصة حين نالت مديحاً (متوقعاً) من سارتر، فيلسوف الوجودية؛ وآخر (غير منتظَر) من أندريه بروتون، منظّر السوريالية. ثمّة، هنا، ذلك الشعر الحرّ في الشكل وفي المحتوى، الحداثي التجريبي، وليد حكايات الناس وحكمة الأسلاف؛ الحافل بالمجاز البرّي والصورة المركّبة، الغنائي تارة والملحمي طوراً، التاريخي هنا والأسطوري هناك. وثمة، غنيّ عن القول، ذلك الفخار الزنجيّ الدافق: «زنوجتي ليست حَجَراً، لأنّ صممها يتعالى فوق اصطخاب النهار/ زنوجتي ليست كيس مياه ميّتة في العين الميتة للأرض/ زنوجتي ليست برجاً ولا كاتدرائية/ ما من بقعة في هذا العالم إلا وتحمل بصمة أصابعي/ وآثار أقدامي مطبوعة على ظهور ناطحات السحاب/ مثلما تتبدّى نعومتي في لمعان الأحجار الكريمة»…
القدس العربي