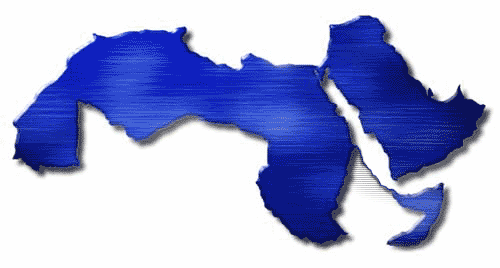“سايكس – بيكو” بعد قرن/ حازم صاغية

بعد عامين، تحل الذكرى المئويّة لما عُرف باتفاقية الدبلوماسيين البريطاني مارك سايكس والفرنسي جورج بيكو. هذه الاتفاقية الموصوفة على نطاق واسع بتقاسم الشطر الآسيوي من المشرق العربي، عبر تجزئته إلى منطقتي نفوذ بريطانية وفرنسية، عاشت قرابة قرن كامل قبل أن تتصدع. وأمر كهذا دليل قوة لا يرقى إليها الشك، قوةٍ تتعدّد أسبابها ومصادرها.
لكن لا تُفهم أسباب القوة قبل إيضاح سوء الفهم الواسع المحيط بالاتفاقية المذكورة. ذاك أن النظرية التي تقول بتجزئة المشرق العربي تقفز فوق حقيقة أن ذاك المشرق لم يكن موحداً أصلاً. والحال أنه، بولاياته وإيالاته ومناطقه، كان جزءاً من سلطنة عثمانية انهارت في الحرب العالمية الأولى، ما استدعى من القوى المنتصرة في الحرب إعادة توضيبه في أوعية سياسية هي الدول. ولا بأس بالتذكير هنا، وكملاحظة مقارنة، بأن الغربيين (الذين نصفهم بحب تجزئتنا) لم يجزئوا بلداً كمصر كان في الأصل وحدة سياسية واحدة.
هذا لا يعني، بطبيعة الحال، أن البريطانيين والفرنسيين لم يستهدفوا بناء مناطق نفوذ لهم. فأمر كهذا كان من طبيعة ذاك العصر الذي سجّل خروج الدول الأوروبية الصناعية إلى ما يتعدى حدودها. إلا أن المصالح تلك كانت قابلة للتجانس مع إعداد دول المشرق الجديدة للاستقلال، وهو تحديداً ما تعنيه كلمة «الانتداب» كوظيفة تمارسها بريطانيا في العراق وفلسطين فيما تمارسها فرنسا في سوريا ولبنان.
بلغة أخرى، كان السبب الأول لنجاح خريطة «سايكس- بيكو» أن منطقة المشرق لم تملك تصوراً بديلاً للدولة بعد انهيار السلطنة العثمانية. فإلى جانب الأحلام والأوهام المتراجعة بإمكان بعث السلطنة (التي تخلت عنها تركيا الكمالية نفسها)، كان البديل الوحيد الذي قُدم هو دولة الشريف حسين وابنه فيصل في دمشق التي لم تعمر طويلاً. وهذه كانت، غير قادرة على التوفيق بين مصلحتها في الاستمرار ومصلحة القوى المنتدبة. هكذا، وتحت وطأة الحماسة والمغالاة، اندفع يوسف العظمة، وزير دفاع فيصل، إلى حرب بائسة ضد الفرنسيين توّجتها معركة ميسلون وكُتبت بنتيجتها نهاية الدولة الهاشمية في سوريا.
وحتى مطالع الثلاثينيات، كان سبب آخر يعزز الصيغة التي أرساها «سايكس- بيكو». ذاك أن النخب السياسية كانت متقبلة مبدأ تعلم السياسة وإدارة الدول على يد الدولتين المنتدبتين. يصحّ هذا على قادة العراق في عهد فيصل الأول، وسوريا في زمن الكتلة الوطنية، والأردن في ظل الأمير، ثم الملك، عبدالله، ولبنان الذي حُكم بموجب الدستور الذي صيغ في 1926. ولم تكن حال المثقفين لتختلف كثيراً عن حال السياسيين، إذ كان معظمهم مسلّماً بالأولوية التي ينطوي عليها النموذج الغربي وبضرورة تعلم فن الحكم على يديه.
بطبيعة الحال تدهورت الأمور فيما بين الحربين العالميتين، مع اتساع موجة التأثر بالفاشية الألمانية والإيطالية، وتحت وطأة الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وصولاً إلى إنشاء دولة إسرائيل. هكذا انفجرت دعوات استقلالية حادة وملحّة في العراق وسوريا تسندها رغبات فئات اجتماعية مدينية صاعدة. حتى لبنان غير المعروف بتيارات راديكالية قوية آنذاك، طالب باستقلاله وناله في 1943. إلا أن تلك التطورات، بما فيها أعنفها كانقلاب رشيد عالي الكيلاني في العراق في 1941، لم تطرح على المحكّ خريطة أخرى تناقض «سايكس- بيكو». صحيح أن بعض هذه الحركات دعت إلى وحدات عربية وإلى تمزيق الحدود «التي أقامها الاستعمار»، غير أن ذلك لم يرقَ إلى صياغة لخريطة بديلة ولم يتحوّل مرةً إلى برنامج للتنفيذ. هكذا، مثلاً، أُعدم أنطون سعادة، مؤسس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» في 1949 بعدما سلمه حاكم سوريا حسني الزعيم إلى السلطات اللبنانية. كذلك عومل بقمع وقسوة «حزب البعث العربيّ» ومؤسساه ميشيل عفلق وصلاح البيطار اللذان أعلنا عن وجوده الرسمي في 1947. والحزبان هذان كانا أكثر الأطراف إصراراً على بناء «أمة» تهدم الحدود بين البلدان القائمة وتنشئ دولة قومية جديدة.
وجاءت الحرب الباردة أوائل الخمسينيات لتعزز، هي الأخرى، «سايكس- بيكو» وخريطتها. فالنزاعات في داخل الدول المستقلة حديثاً، بما فيها الانقلابات العسكرية، كانت في معظمها تتضمن الإقرار بالحدود القائمة، فيما تؤكد القوى والأحزاب المتصارعة أن كلاً منها هو الأجدر بحكم البلد المعني. ولئن ثبتت الحرب الباردة صورة جامدة للعالم وتوازناته وخرائطه، فهذا لا يلغي ظهور محاولات للتمرد على هذا الواقع، إلا أنها كلها باءت بالفشل. فحين اندفعت سوريا في 1958 إلى وحدة مع مصر، لم تعمر هذه الوحدة سوى ثلاث سنوات. أما البعثيون الذين حكموا العراق وسوريا معاً، وملأوا الدنيا ضجيجاً حول الوحدة وإزالة الحدود «القُطرية»، فترتب على نظاميهم عداء غير مسبوق بين البلدين البعثيين وتمتين غير مسبوق أيضاً للسلطة «القُطرية» في كل منهما. وجاءت الحرب الأهلية- الإقليمية في لبنان، عام 1975، تعلن أن البلدان قد تتصدع من داخلها، إلا أن تصدعها لن يقود إلى كيانات أكبر، لا بل إنه مرشح لأن يقود إلى كيانات أصغر. لقد بدأ يختلف الأمر مع انتهاء الحرب الباردة الذي أدى إلى تراخٍ في الصورة المثبّتة للعالم وخرائطه. ولكن هذا التحول ترافق مع عاملين متضاربين في نتائجهما: من جهة، تجرّؤ أكبر عند السكّان على أنظمة عسكرية واستبدادية كانت قد صمدت طويلاً بوصفها جزءاً من معادلة كونية راسخة. ومن جهة أخرى، ظهور متعاظم لهويات دينية وجهوية وإثنية وطائفية طالما كبتتها أنظمة الاستبداد التي لم تبن دولاً ومجتمعات بل فككت ما كان متوفراً من عناصرها.
ولنا اليوم أن نقول إن اتفاق «سايكس- بيكو» الذي عاش قرناً كان أقوى كثيراً مما توقعنا. أما سقوطه الذي نعيشه راهناً تحت وطأة الأسباب المذكورة أعلاه، فقد يتركنا أمام دم كثير وأمام حسرة كبيرة.
الاتحاد