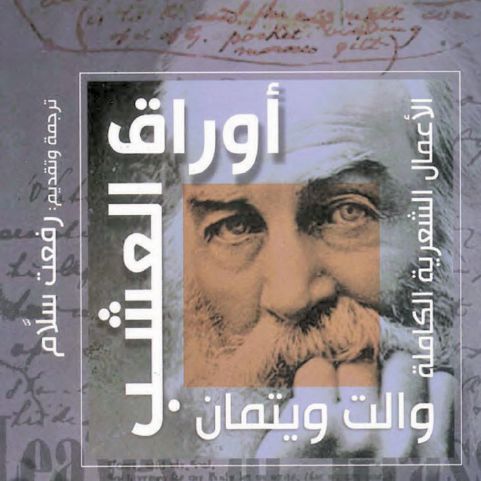“سوريا تتحدّث”: كتاب يوثّق فنون الثورة في زمنها السلمي/ محمد أبي سمرا
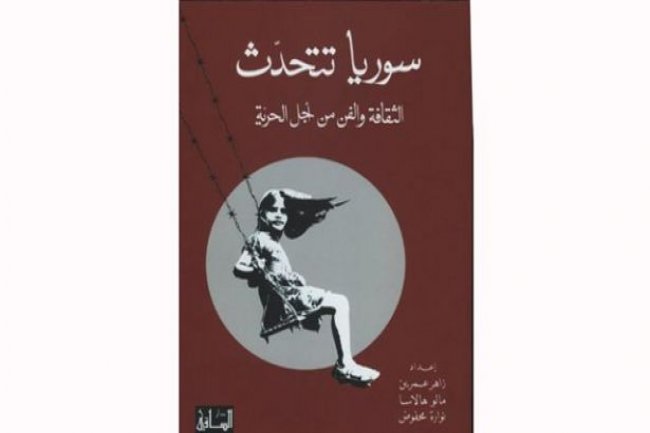
أُعدّ كتاب “سوريا تتحدث – الثقافة والفن من أجل الحرية”، وُضّب وأُخرج، مستلهماً أساليب فنون التجهيز والاداء والعروض البصرية، والأشرطة المصورة بكاميرات الهواتف المحمولة، متضمناً شهادات واعترافات ورسوماً وملصقات واكبت الثورة السورية في حقبتها السلمية. أَعدّ الكتاب زاهر عمرين، مالو هالاسا، ونوارة محفوض. نشرته “دار الساقي” في بيروت، 2014. وموّله كل من “صندوق الأمير كلاوس للثقافة والفنون والتنمية” و”المركز الدانماركي للثقافة والتنمية”. وشارك فيه أكثر من 50 من الكتاب والفنانين السوريين المنتشرين في العالم، ليكون شريطاً وثائقياً حياً عن ثورة السوريين السلمية في سنتها الأولى.
بعد مقدمة الكتاب نقرأ صفحة واحدة في عنوان “حماة 82”. فمنذ ذلك العام حتى العام 2011 “كان الحديث جهاراً عن مجزرة حماة أمراً محرماً. فكلما اراد السوريون التحدث عنها استخدموا كناية مشهورة: “الاحداث”. لكن بعد سنة على انطلاق الثورة بدأ عدد من النشطاء بجمع معلومات عن تلك المجزرة. من ابرز الانشطة التقاط صور نادرة للضحايا مأخوذة عن بطاقات الهوية القديمة، دفاتر العائلات، جوازات السفر، وسواها من الوثائق الرسمية. هذه المبادرة، وما جمعه الكتاب، لتوكيد ان سوريا لن تعود الى الصمت.
الخروج من فندق الأبد
في مستهل استنطاقه دلالات “الرمز والرموز المضادة” و”تمظهرات السلطة والبروباغندا من حكم الاسدين الى ثورة الحرية والكرامة في سوريا”، ينقل زاهر عمرين مقطعاً من النشيد الرسمي لمنظمة “طلائع البعث”: “نضيء كالصباح/ ونحمل السلاح/ للوحدة التي سقاها أهلنا بالدم/ نمشي اليها/ ثورة ووجنة من دم/(…) اقدامنا حقول، طريقنا مصانع/ وتلمع الرايات في موكب الطلائع”. يصف عمرين ليلة امضاها، قبل شهور من بداية الثورة السورية، في فندق من الفنادق والنوادي الكثيرة التي تنتشر في سوريا البعث والاسد، وتقدم خدمات ترفيهية للضباط وعائلاتهم، بعد تحقق الحلم البعثي.
يشبه الفندق ثكنة عسكرية. تغزو جدرانه وممراته ومطاعمه وسائر مرافقه ملصقات سيئة الذوق: مزيج من صور الأسد الأب، ابنه القائد الشاب بشار، ابنه الآخر “الشهيد” باسل، وابنه الثالث العقيد ماهر. هؤلاء مع زوجة الأب العرّاب ضاحكون موفورو الصحة. الفندق الموصوف بحري، لكن ادارته العسكرية تمنع النزلاء من الظهور بلباس البحر في الممرات المؤدية الى المسبح، وفي سائر الصالات الداخلية، ربما صوناً لحياء عائلة الرئيس الراحل، ومراعاة لمقام القيادة. النُدل في الفندق يتنقلون بلباسهم العسكري الموحد، فيبدون كفرقة دهم او دورية حراسة في ممرات وأروقة وصالات خاوية. على الجدران عند اعلى الاسرّة في الغرف، صور مماثلة لـ”القائد الخالد”، فيستحيل على النزلاء أن يحلموا أحلام نوم او يقظة من دون رقابة القيادة. تجربة عمرين في ليلته الفندقية تلك، ذكّرته بتجربة جاك نيكلسون الهستيرية الجنونية في فيلم “البريق – شاينينغ” للمخرج الأميركي الراحل ستانلي كوبريك الذي صوّر بطله في فندق خاوٍ معزول، ادت اقامته فيه الى اصابته بالرعب الهذياني، وصولاً الى القتل الهستيري.
بعد صفحات من عرضه مسار تربّع حافظ الأسد وزمرته العسكرية والعائلية في سدة الحكم والسلطة في سوريا طوال 40 سنة، ينتقل عمرين الى استعراض الصور وأشرطة الفيديو الأولى التي واكبت بدايات الثورة في سوريا العام 2011. عوداً الى ذكرى ليلته في الفندق، يستوقفه شريط فيديو صوّر في مدينة حمص الثائرة: أحد المتظاهرين يتسلق واجهة نادي الضباط في المدينة، ويركل بقدمه لافتة كبيرة تحمل صورة حافظ الأسد، فيتمزق وجه القائد العرّاب، فيما الجموع تهتف بنشوة عارمة يخالطها هول المفاجأة والذهول. مع توسع التظاهرات في الديار السورية، تردد كالنار في الهشيم بين المتظاهرين هتاف “يلعن روحك يا حافظ”، فيما هبّت الجموع في موجات عامة، فدمّرت تماثيل الأسد ونزعت صوره من الأماكن العامة التي اخذت تصدح في أرجائها اصوات المتظاهرين، هاتفين مغنّين منشدين، وامتلأت جدران الساحات والشوارع بالشعارات الجديدة وبرسوم فنانين الغرافيتي.
غلب طابع السخرية السوداء على الكثير من شعارات الثورة السلمية السورية، وهتافاتها ورسومها. في مسحه الاحصائي لمصنّفاتها، رأى عمرين ان منتجاتها تندرج في ثلاثة ابواب أو اصناف اساسية: اللوحات والأفلام والاغاني ذات الطابع الفني الابداعي. المادة الاعلامية – الفنية التي تشمل الملصقات، الأهازيج، واشرطة الفيديو وأعمال التجهيز. أخيراً الصنف الأكثر تداولاً ويشمل الشعارات والاعلانات الثورية، والتصاميم الرقمية وأشرطة الفيديو الترويجية. اما البروباغندا الأسدية فتختصرها شخصية “الشبيح” التي لم تفارق حكم الأسد منذ ثمانينات القرن العشرين، وتتمثل في الاعتقال والقتل.
الاغتصاب والسلاح والرعب
مالو هلسا اجرى مقابلة مع الناشط اسعد العشي عن دور “المتسوّق السري ولجان التنسيق المحلية” في الثورة. كان دور العشي ومهمته تأمين المعدات والأجهزة التقنية للناشطين الذين عملوا في الاعلام والاغاثة في العامين الأولين من الحراك السوري. هؤلاء نسجوا علاقات مع سوريين مقيمين في الخارج. من طريق الدوحة ودبي كانت الأجهزة، من كاميرات وهواتف محمولة وأجهزة كومبيوتر، تنتقل عبر شبكات سرية الى سوريا. علم الثورة طُبع اولا في الصين. بعض الناشطين من اصحاب الخبرات السابقة نظّموا ورش تدريب على هذه الأجهزة في سوريا. بعد الهجوم العسكري للنظام على مدينة حماة في حزيران 2011، وقتله اكثر من مئة شخص، بدأ الجميع يتساءل: الى متى نُبقي الثورة لاعنفية؟! في آب من العام نفسه تأسس “الجيش السوري الحر” فتتالت الانشقاقات عن الجيش النظامي منذ كانون الأول. يروي العشي ان الاغتصاب كان من ابرز الأسلحة التي لجأ اليها نظام الاسد لدفع المتظاهرين الى التسلح تحت إلحاح مطالبة الناس بحمل السلاح للدفاع عن انفسهم. فالاغتصاب لم يعتمد منهجية عامة في المعتقلات والسجون فحسب، بل أخذ الجنود يقتحمون المنازل في كل بلدة يدخلونها، فيغتصبون النساء امام ازواجهن وآبائهن واخوانهن. في حلول صيف 2012 كانت الثورة قد تسلحت على نحو كامل. هكذا تحول الناشطون المدنيون وتحولت لجان التنسيق المحلية منظمة للاغاثة والطبابة وتأسيس المستشفيات الميدانية. لكنها استمرت ايضا في العمل الاعلامي الذي تمحور حول نقل الاخبار عن عدد القتلى في كل يوم. مع اكتمال تسليح الثورة، انتقل قرارها ومسارها الى مستوى دولي، لتصبح صراع قوة بين المعسكر الدولي الداعم للأسد والمعسكر الداعم للثورة. اما لجان التنسيق فتحولت “عدّاداً للقتلى” في الاعلام الاقليمي والدولي.
على صعيد الاعلام المكتوب والمرئي في سوريا قبل الثورة وبعدها، يكتب عمر الاسعد ان سوريا لم تعرف طوال 40 سنة من حكم الاسد مصدراً للأخبار سوى وكالة “سانا” الرسمية التي تأسست العام 1965، وعاشت البلاد على 3 صحف يومية لبث البروباغندا البعثية والاسدية. سياسة ما سمّي “التطوير والتحديث” كشعار للأسد الابن، اقتصرت على قفل صحيفة “الدومري” الساخرة في العام 2003، وعلى منح تراخيص الصحف لرجال النظام المقرّبين، في مقدمهم رامي مخلوف صاحب صحيفة “الوطن”، ومحمد حمشو الممول الأساسي لمحطة “الدنيا” التلفزيونية. في المقابل ظهرت في السنة الاولى من الثورة المكاتب الاعلامية التابعة للجان التنسيق، ثم للكتائب العسكرية تالياً، فنشأت ظاهرة “مواطنون سوريون صحافيون”. مئات منهم قُتلوا في ايام الحراك السلمي. حتى ايار 2013 احصت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية 23 صحافياً اجنبياً قضوا في سوريا. اما عدد الصحف المحلية التي صدرت في سوريا الثورة حتى نهاية عامها الثاني، فبلغ 75 صحيفة ونشرة دورية.
عن “السينما السورية غير الكاملة” يكتب زاهر عمرين (للمرة الثانية في الكتاب) ورشاد الياس ان ميزة التظاهرات السورية البادئة في العام 2011، هي استخدام المتظاهرين هواتفهم المحمولة لتوثيق نشاطهم بطريقة مبتكرة، فيما هم يتعرضون لخطر القتل. فمقاطع الفيديو المشوّشة وصورها المهتزة تسجل ارتعاشات الايدي التي تحمل الهواتف والكاميرات. وهي على تضاد مع الصور الأيقونية المثالية التي سجلت حوادث الثورة المصرية. عدد مقاطع الفيديو التي حُمّلت على موقع “يوتيوب” وسواه منذ بداية الثورة السورية بلغ 300 الف مقطع مصورة وفق تقنيات السينما التقريرية لشهود عيان. تكمن فرادة المقاطع التوثيقية هذه في انبثاقها من اللحظات الانسانية الحميمة التي تصوّر يوميات الناس العاديين في لحظات استثنائية، قبل أن تصير قابلة للنشر في شبكات الاخبار التلفزيونية العالمية. في واحد من الأشرطة، صورة شخص مجهول بكاميرا هاتفه من نافذة بيته، تظهر قوات الأمن وهي تعتقل امرأتين محجبتين، تجرهما وتركلمهما في شارع خاوٍ. من لهاث المصور المجهول المرتجف ينتقل الينا الرعب مع الصمت المطبق المخيم في الشارع ومحيطه، من دون ان نسمع سوى تعليق خائف مقتضب عن تاريخ الحادثة ومكان وقوعها.
في باب الشهادات الأدبية، يكتب خالد بركة من دمشق: “انتهى بنا الأمر الى انشاء جمهورية موازية للتعبير عن الحيز الذي بدأت تظهر فيه الصحافة والفنون والأنشطة والمعارض في الشبكات الافتراضية على نحو مواز للحوادث الفعلية على الارض”. هاني السواح يكتب في شهادته من حمص انه لم يكن في البداية مع الثورة. لكن “ما اعرفه ان الشارع شدّني اليه، فأسكرتني الجموع التي تغنّي وترقص وتبكي. وجدت نفسي محمولاً على الأكتاف، انا الشاب الذي يفاخر بصوته الأجش العالي، صوت هتّيف التظاهرات”.
شهادات السجون والمعتقلات
في الكتاب شهادات – اعترافات شخصية سوداء تستعيد يوميات من حياة السوريين في ظلال البعث والاسد. في عنوان “هل اتاك حديث الصور… حديث القتل في سوريا؟” تكتب فاديا لاذقاني: “كان لي اخ يلعب، ابتلعته حفرة كبيرة في مكان ما من سوريا، في يوم من أواخر كانون الاول 1983”. في زيارتها الأولى لأخيها الآخر الأكبر، نزيل سجن صيدنايا، “كي يسترجع هيئته البشرية، قبل تخلية سبيله المحتمل”، بعدما امضى 9 سنوات في سجن تدمر، ظل الأخ طوال الزيارة يحاول “اختلاس هنيهة” شرود امه كي يبلغ اخته الخبر اليقين عن اخيهما الآخر، فتكتب: “كيف خطر بباله ان يقسو عليَّ كل هذه القسوة، وهو يمرر يده على رقبته بسرعة البرق، ليشير الى امحاء عبد من الوجود؟”. قبل ذلك تمكن خالها من الوصول الى مكتب مسؤول فرع المخابرات الجوية (ع. د) الذي نظر في سجل أمامه وقال: “الكبير في تدمر. الثاني لا تسألوا عنه بعد اليوم”. الراوية نفسها في مشهد آخر نزيلة فرع سجن كفرسوسة لثلاث سنوات وشهرين. الرائد (ت. ع. د.) يخضعها لطقوس التحقيق: “يجب ان تحكي عن أسرتك، إخوتك، وأجداد أجداد الذين خلّفوكِ”. ربما في باريس استطاعت الراوية أن تكتب: “كان أخي شاباً في ريعان الصبا وكان جميلاً. كان في السنة الأخيرة من كلية الهندسة الكهربائية. الشام وأمه كانتا حبيبتيه. لم يدع له العسف نصيباً كي يضيف إليهما إبنه الذي سيولد بعد سبعة أشهر من اختفائه”.
يارا بدر تكتب اعترافاتها في عنوان “ثلاثة أدوار في حكاية عمرها ثلاثون عاماً”: “أنا معتقلة سابقة لوقت قصير، إبنة معتقل لاثني عشر عاماً في تجربة اعتقاله الثالثة، وزوجة معتقل حالي”. في الثمانينات تفيد الأرقام بوجود أكثر من 14 ألف معتقل سياسي من الأحزاب والطوائف السورية على اختلافها. الرقم هذا لا يشمل الذين قضوا تحت التعذيب أو أعدموا. كان عمر الراوية سنة وخمسة أشهر، ولا تملك “ذاكرة بصرية عن ذلك الليل الكانوني من عام 1986″، عندما “اقتادوا والديَّ وتركوني مع عمي في المنزل. عادت والدتي في نحو التاسعة صباحاً بكدمة على خدها وأذن تنزف وبكم هائل، جراء صفعات وتهديدات وتعذيب زوجها أمامها أثناء التحقيق”. الراوية بدورها أصيبت بالبكم طوال عامين وشهور في طفولتها. بعد ما يزيد على عشرين عاماً تكتب: “غاب والدي وحضر زوجي مازن درويش وزملائي. للمرة الثانية نُقاد الى زنزانة الاعتقال بشكل عائلي: هذه المرة كنا أنا وزوجي”. إنه زمن الثورة. وفيه يصعب التحقق من دقة الأرقام: 200 ألف سوري في المعتقلات، قضى منهم قرابة 12 ألفاً تحت التعذيب. أخيراً الراوية في مشهد في سجن عدرا تستعيد شريطاً من ذكريات اثني عشر عاماً في شكل معكوس: “كان والدي المعتقل في سجن صيدنايا، هو من يأتينا ليقف خلف القضبان حين نزوره أنا ووالدتي. اليوم زارني والدي وأنا خلف القضبان. لاحقاً وقفت أمام زوجي أزوره وهو خلف القضبان. في زياراتي لوالدي كان يحاول أن يبتسم دوماً. كان دمعه وهو معتقل أقل حضوراً في مقلتيه مما كان وهو يزورني”.
الشاعر جولان حاجي يذيّل بقصائده أعمالاً للرسام محمد عمران في أثناء معرض “فن المقاومة السورية” في كوبنهاغن ربيع العام 2013. يكتب حاجي في عنوان “ضوء آذار”: “أنا حيّ، وأقربائي يموتون في أرض بعيدة: عمتي العمياء، وأختي وأبي. أنا حيّ ولست في الجحيم لأن نسمة عبرت منذ قليل؛ لست معتقلاً، على الأقل في الوقت الراهن (…) لأنني وحدي لن يرغمني أحد على تفسير وجودي هنا، عارياً هكذا، من دون أي حياء، مثل نطفةٍ ميتة”.
النهار