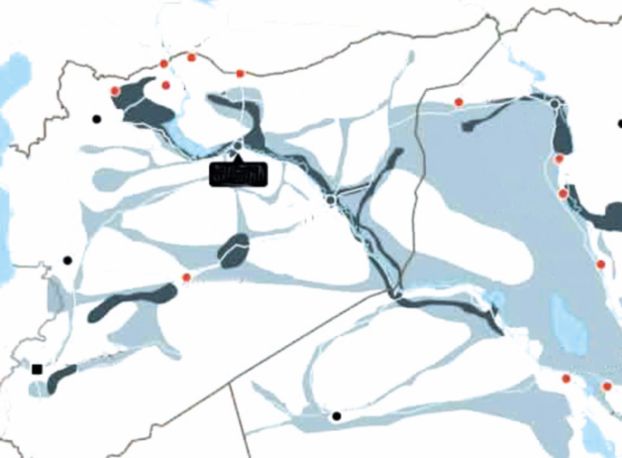سورية شعبا ونظاما في طليعة الثورة العربية الجديدة؟
مطاع صفدي
يسألني أصدقاء إن كنت سأصدّق أن نظام سورية سوف يُصلِح نفسه بنفسه. والواقع أنني لا أملك جواباً حاسماً. لن أقول مرة واحدة ان إرادة التغيير مازالت غائبة كلّياً من أوساط مراكز القوى. لكن الاختلاف حول وسائل التغيير وحدوده، قد أصاب مؤسسات السلطة بالجمود والتخثر.
مازلتُ مقتنعاً أن الرئيس بشار جاء إلى السلطة قبل أحد عشر عاماً، على أكتاف عاصفة من آمال الإصلاح. لكن سنوات الحكم المتوالية عَلَّمته حقائق متناقضة؛ فمن ناحية تضاعفت خبرته بأعطال الدولة والحزب والمجتمع. إلا أنه في الوقت عينه زوَّدته هذه الخبرة عينها بمشاعر ملتبسة، منها ذلك الإحساس باللاجدوى المسبقة من أية محاولات فوقية لن تتناول إلا مناحي معينة من الجسد العليل، لكنها دون القدرة على الإطاحة بالأعطال الكبرى.
أهل النظام في الشام هم الأدرى بأحواله. أحاديثهم فيما بينهم تتناول الأعراض والأسباب، لكن دون اقتراح الحلول. الأسد نفسه هو أول المنتقدين. وقد يشاركه في ذلك أركان النظام. فأين هي العلّة حقاً. هذا السؤال انتُظر أجوبته طويلاً وعبثاً، حتى انفجر الشارع الشعبي. ما يعني أن النظام عاجز عن إصلاح نفسه وحده، لابد له من شراكة تأتيه من خارجه كلّياً. لعلّها هي أخيراً شراكة المجتمع المحكوم. وهنا يصبح السؤال بالغاً صعوبته الواقعية، إذ كيف يمكن لِــقِمَّة الهرم أن تتفاعل مع قاعدته. كيف تتغير علاقة السيد/العبد، إلى علاقة السادة فيما بينهم جميعاً. إلى أيِّ حدّ سوف تَقْبل مراكز القوى بهذه الشراكة، وأية صيغة ستتخذها علاقات القوى الجديدة.
بعيداً عن المصطلحات والتسميات (المدنية) المحفوظة والمتداولة إعلامياً وشعبياً، من سلالة الديمقراطية ومشتقاتها في الحرية والعدالة والشفافية في الأخلاق والسياسة..إلخ، فإن انفجار الأزمة في سورية اليوم له شكل واحد، هو تنازع القوى المتناقضة ما وراء مختلف الشعارات والمواقف والتأويلات. ولعلّ صراع مراكز القوى في بنيان النظام لن يقلَّ احتداماً صامتاً حتى الآن، عن صراع السلطة والمعارضة. فما يوحّد قِمَمَ السلطة في هذه المرحلة هو شدَّة التحدي غير المسبوق الذي يواجهها. ومع ذلك فإن ردود فعلها قد تبقى قيْد الكتمان إلى وقتٍ ما، لكنها في واقع الأمر سوف تغدو عواملَ تفْرقةٍ ما بين أقطابها الرئيسية. فالفلسفة التي قام على أساسها نظام الحكم السوري منذ نشأته الأولى من رحم الانقلابات العسكرية اللاغية لبعضها، بَعْد سقوط تجربة الوحدة الأولى خاصةً، أوائلُ ستينيات القرن الماضي، هذه الفلسفة اعتمدت مبدأ الحكم الأُحادي القوي، الجامع لمختلف خيوط السلطتين العسكرية والمدنية، ضمن قبضة حديدية، لا تقبل نقاشاً أو حواراً أو معارضة، من الأقربين أو الأبعدين. كان لهذه الفلسفة غطاءٌ سياسي خارجي أثبت نجاعته (سلطوياً) طيلة عقود، ومازال مستمراً بين عهديْ الأسديْن، الأب والإبن. نسيجُ هذا الغطاء لُحْمةٌ وطنية قطرية صامدة، مطعّمة بشعارات قومية فضفاضة. هنالك حدود دُنيا لسياسة إقليمية ودولية لا تهبط دون استقلالية الرأي الوطني المؤالف ما بين مصلحة أهل الحكم وتأويلات ظرفية لمبدأ السيادة (السورية)؛ كما أن هذه الحدود لا تتصاعد إلى مستوى ثوريات ذلك العصر المفعم بأعنف الاستقطابات الدولية، وانعكاساتها اليومية على مجمل الخارطة العربية.
لم تكن مسألة الزعامة الشخصانية مطروحة إبان الحرب الباردة، لا غربياً ولا شرقياً. فكان أمراً مقبولاً أن تتزعم الأيديولوجياتِ المتصارعةَ رموزٌ نضالية مُتَنَفّذة، بحيث يمتزج الشخص كلّياً مع مبادئ (ثورته) وإنجازاتها العملية. وهي في الدرجة الأولى إنجازات لمواقف سياسية.. أو ثورية مقننة غالباً. ولقد سيطر محور الصراع العربي الإسرائيلي على أوليات كل أيديولوجيا عربية آنذاك، كما على أنظمتها وزعمائها. ولم تكن سورية أبداً قادرة، وفي أي ظرف سلطوي أو سياسي مرَّت به المنطقة. على مبارحة دورها المركزي من محورية هذا الصراع؛ ما يمكن قوله أن مجتمعات المشرق كانت مُعَسْكَرة بإرادتها واختيارها. كما كان أمراً طبيعياً أن تُقاد بحزب (ثوري)، وأن يكون رئيس الدولة قائداً عسكرياً قبل كل شيء. لكننا لا نقول، متسرعين، أن هذه الهيكلية قد عفا عليها الزمن كلياً الآن. ليس هذا، لكون الوضع الدولي قد تجاوز انقسامه الأيديولوجي الحاد بين الرأسمالية والإشتراكية، وأن العالم العربي قد تناسى تناقضه الدهري مع الصهيونية. فالمايحدث الواقعي هو أن عَسْكَرة المجتمع قد فقدت تسويفها بالثورة ومنطقها وضروراتها الحقانية والنضالية. أمست عَسْكَرةُ المجتمع بدون غطاء الثورة، ما أن دُفعت المنطقةُ إلى مستنقعات الحلول السلمية الزائفة مع العدو؛ فالعسكريات الحزبية والمجتمعية والسلطوية أمست عاطلة عن العمل، محرومة من مهماتها العمومية. بعدَها، ليس غريباً أن يستيقظ المجتمع المدني من تحت ركام الإنتظارات اللامجدية لتحقق الإنتصارات المطلقة، مطالباً باسترداد حقوقه الذاتية، تلك الحقوق التي لم يتنازل عنها تحت طائلة الحق المطلق للثورة، بل كأنه قَبِلَ بتأجيلها مرحلياً ريثما تنال (الأمة) استقلالها التاريخي التام؟
ما تعلن عنه هذه اليقظةُ العارمة يتلخّص في مبدأ الاعتراف بالحاجة الأخلاقية لمجتمعات الأمة في استرداد مشروعية وجودها الإنساني قبل أية مشروعية أخرى، حتى وإن اتصفت بالثورية أو المدنية، فلعلّ العطب الأصلي الذي اشتكت منه ثوريات القرن العشرين هو افتقادها للوازع الإنساني، في أفكارها المؤدلجة قبل أن تتجسد في إنجازاتها وانعطافاتها الدرامية الحاسمة، والمُحْبطَة في معظمها. ولقد كان تعلّم الغربُ من فظائع ثورياته، درساً مركزياً، شكّل امتيازه الأهم حضارياً، تعلم كيف يترجم ثقافة الأَنْسَنَة المجردة إلى شرعة المواطنة الموثَّقَة بمبادئ حقوق الفرد، كأصول واقعية لمدنية الجماعة البشرية.
شبابنا العربي الثائر اليوم استلهم شعار (الكرامة) تلقائياً، إنها عنوان إنسانه المفقود والمقموع، والممنوع من تفتح حرياته على أية إمكانية نهضوية لائقة بمطامحه الأولية، وليست تلك البعيدة المنال. ذلك أن الاستبداد وصنوه الفساد، مَحَقَ كلُّ منهما على طريقته، وجودَ الأربعمائة مليون من البشر، على مستوى أمم الشرق الكبرى الأخرى، وذلك في سعيها إلى احتلال مكانها ودورها في إبداع الحضارة المعاصرة. وسورية كانت من رُوَّاد هذه الحضارة (الشرقية)، لذاتها ولأمتها، منذ ان تسلّمت من المستعمر الغربي مفاتيح استقلالها. كان استقلالها ذاك مفهوماً كمدخل إلى الاستقلال القومي الشامل. كان أراد وطنُها الصغير المتحرر، أن يكون مثالاً ونموذجاً لتحرر الوطن العربي الأكبر؛ لكن سورية، تلك الرائدة الباعثة على أنبل مطامح الحرية العادية لأبسط الناس في بيتها الآمن، وفي بيت الأمة الأعظم، عانت وكابدت من تقلبات الصراع على القمم، خلال ستين عاماً، ما أفْقَدَها ذخيرتَها الغنية، من كنوز حريتها الذاتية. فليس لأية فئة، مهما تميَّزت افتراضاً، بعبقرية قيادية، القدرة وحدَها على اختزال شعبها. حتى عندما تفوز هذه القيادة ببعض إنجازات نوعية، هي من صدف الجغرافية الشامية، ومن حصائل تاريخها الإقليمي والاجتماعي، فإنها لا يمكنها أن تُبقي طويلاً على أدوار كيانٍ منفتحٍ خارجياً، وفارغٍ أو مُفَرَّغٍ من إمكانيات شعبه داخلياً.
سورية لا تنتهي من خوض معاركها المصيرية اليوم أو غداً. بل إن الصراع الأخطر والأدهى هو ما ينتظرها، في هذه اللحظة التاريخية حقاً من عودة الروح إلى الجثة العربية الهامدة. سورية لن تكون من ضحايا الثورة الجديدة، الباحثة عن روادها القدامى. سورية/الثورة العربية منذ عشرات العقود، لن تكون في مؤخرة الركب. لن تكون شوارعها مسارح لحصائل الانقسامات الأهلوية الدفينة تحت رماد القمع طيلة العهود السابقة. مكان سورية هو في مقدمة الطليعة الصاعدة، وليس في قاطرتها الأخيرة المتهرئة.
ليست مهمة النظام الحاكم الدفاع عن نواقصه وعيوبه التي يعرفها أركانُه قبل سواهم؛ تحدّيه الحقيقي الحاسم اليوم ألا يكون مختاراً بين الإصلاح أو الثورة، أو الفوضى العمياء، بل ألاّ يكون أمامه إلا طريق الحرية، له ولشعبه في وقت واحد. سورية شعباً ونظاماً، عائدة إلى صدارة الطليعة للثورة العربية الجديدة.. وإلا واجهت المجهول الأخطر.
أقول للرئيس الشاب بشار، (وكنت انتخبته قبل أحد عشر عاماً، زائراً لأول مرة سفارة سورية في باريس مع رفاق من معارضي المنفى الفرنسي)، أقول له: ما زلتَ في بداية الطريق، كحالك يوم رئاستك الأول. مع مضاعفة الأعباء الكبرى التي تنتظرك، أقول لك: لستَ مُطالباً بإعادة تصالحك مع شعب سورية، فهو لا يزال معترفاً بصدقيتك، لكنه يطالبك بأن تنزل إلى شوارعه وتتحالف مع جماهيره، لتكون قائداً جديداً لثورة الكرامة الإنسانية ضد أعداء سورية في الداخل هذه المرة، وليس في الخارج وحدها، فلقد أثبتَّ أنك كُدْتَ تملأ دور القائد السياسي للشام الكبرى خلال معارك أقطارها المحيطة، طيلةَ مواقع العقد السابق من هذا القرن. ليس لك اليوم إلاّ أن تغتني برصيدك القومي في مكافحة أعطال القطر بدءاً من قمته وجوارها. تحالفك مع مواطني سورية وليس مع رعاياها، يطلق رهان التاريخ العربي على استعادة عصر الثورة العربية الشاملة، بوحدة جماهيرها الشابة. ومن المحيط إلى الخليج دائماً؟
‘ مفكر عربي مقيم في باريس
القدس العربي