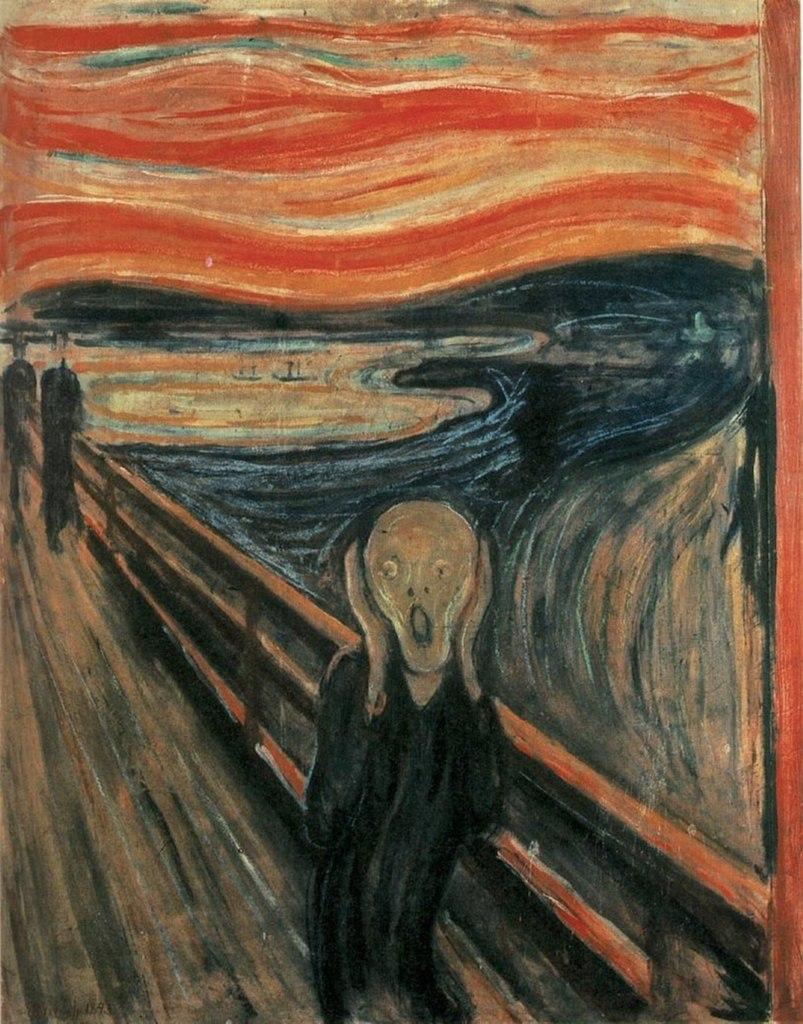“صادق جلال العظم” وداعا

صادق جلال العظم.. رحيل بعيد عن دمشق
أُعلن فجر اليوم عن رحيل المفكر السوري صادق جلال العظم في برلين، بعد أزمة صحّية تعرّض لها الشهر الماضي ودخوله في غيبوبة. ولد الراحل في دمشق عام 1934 وتلقى تعليمه في مدارس الشام وصيدا قبل أن يتخرّج في “الجامعة الأميركية” في بيروت.
حاز العظم شهادة الدكتوراة من “جامعة ييل” الأميركية وكانت أطروحته التي نشرت بالإنكليزية عن الفيلسوف الفرنسي هنري بيرغسون. عاد إلى دمشق بعد تخرجه، قبل أن ينتقل إلى بيروت ليعمل أستاذاً في “الجامعة الأميركية”، التي رفضت عام 1968 تجديد عقده على خلفية مواقف سياسية يسارية معادية للسياسة الأميركية ولخلافه مع شارل مالك، رئيس الجامعة في وقتها. وفي صيف عام 1968 بدأ تدريس الفلسفة في “الجامعة الأردنية” في عمّان، التي سرعان ما أجبرته السلطات الأردنية على مغادرتها في ربيع عام 1969.
عمل العظم، بعد ذلك، في “مركز الأبحاث الفلسطيني” في بيروت الذي ساهم في تأسيسه وانتظم في الكتابة لمجلة “شؤون فلسطينية”الصادرة عن المركز، لكنه سرعان ما أوقف عن العمل في المركز من قبل قيادة “منظمة التحرير الفلسطينية” على خلفية كتابه “نقد فكر المقاومة”.
في أوائل الثمانينات بدأ التدريس في “جامعة دمشق” ليصبح رئيساً لقسم الفلسفة فيها حتى تقاعده عام 1999. وكان العظم في أواخر الثمانينات عمل أستاذاً زائراً في جامعة برنستون الأميركية لخمس سنوات متواصلة، ثم عاد إليها لسنوات بعد تقاعده وبقي فيها حتى 2007.
نشر العظم عام 1968 كتابه “في الحب والحب العذري”، وأتبعه عام 1969 بكتابيه “النقد الذاتي بعد الهزيمة” و”نقد الفكر الديني” والذي حوكم وسجن بسببه قبل أن تبرئه المحكمة عام 1970، وهو نفس العام الذي أصدر فيه “دراسات يسارية في فكر المقاومة”. في عام 1975 نشر “الصهيونية والصراع الطبقي”، لتليه”سياسة كارتر ومنظرو الحقبة السعودية” عام 1977 و”زيارة السادات وبؤس السلام العادل” عام 1978. ثم “دراسات في الفلسفة المعاصرة” عام 1981 و”الاستشراق والاستشراق معكوساً” عام 1981 والذي ساجل فيه أطروحة المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد وكتابه الشهير “الاستشراق”. ثم أصدر العظم “دفاعاً عن المادية والتاريخ” عام 1987، وصولاً لواحد من أكثر كتبه إثارة للجدل عام 1994 أي “ذهنية التحريم: سلمان رشدي وحقيقة الأدب” والذي أتبعه بـ”ما بعد ذهنية التحريم” عام 1997.
بعد الثورة السورية عام 2011 أيّد العظم مطالبها وحراكها وانتظم في أُطرها الثقافية وانتخب عام 2013 كأول رئيس لـ”رابطة الكتاب السوريين” التي تأسست من قبل كتّاب داعمين للثورة السورية. كُرّم العظم في أكثر من مناسبة خلال مسيرته، وآخرها العام الماضي عندما منحه معهد “غوته” وسام الشرف الألماني.
صادق العظم.. مفكر درس الفلسفة واستغرقته السياسة
صادق جلال العظم أكاديمي ومفكر سوري؛ يوصف بأنه من أبرز “العقلانيين العرب” المنافحين عن العلمانية والديمقراطية، أثارت آراؤه جدلا كبيرا وخاض معارك فكرية متعددة بسبب كتاباته، وحُكم عليه بالسجن إثر نشره كتابه “نقد الفكر الديني”. أيد بقوة الثورة السورية.
المولد والنشأة
وُلد صادق جلال العظم عام 1934 في العاصمة السورية دمشق لأسرة تنتمي لعائلة سياسية عريقة من أصل تركي، وكان والده جلال العظم أحد العلمانيين السوريين المعجبين بتجربة مصطفى كمال أتاتورك في تركيا.
الدراسة والتكوين
درس صادق العظم المرحلة الابتدائية في دمشق والثانوية في المدرسة الإنجيلية بصيدا في لبنان، ثم التحق بالجامعة الأميركية ببيروت حيث نال البكالوريوس في الفلسفة 1957. سافر إلى الولايات المتحدة لإكمال دراساته العليا في جامعة ييل فحصلعلى الماجستير في الآداب (1959) والدكتوراه في الفلسفة الحديثة (1961)، وكانت رسالة تخرجه عن الفيلسوف الألماني إيمانويل كانتْ.
التوجه الفكري
اعتنق العظم الفكر الشيوعي وكانت الماركسية هي الموجه الأساسي لآرائه ومواقفه، حيث وصفها في أحد كتبه بأنها “أهم نظرية شاملة صدرت في العلوم” بينما قال “إن الدين بديل خيالي عن العلم”. كما يعتبر من أكبر العلمانيين في العالم العربي القائلين بضرورة الفصل بين الدين والحياة والرافضين لوجود أي مرجعية دينية “للأفكار العلمية والفلسفية”.
الوظائف والمسؤوليات
تولى العظم عدة وظائف ومسؤوليات، فبعد نيله الدكتوراه عاد إلى بلاده 1962 حيث عمل أستاذا للفلسفة في جامعة دمشق، وانتقل 1968 للتدريس في الجامعة الأردنية بعمّان، ثم عاد لدمشق فرأس قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية بكلية الآداب خلال 1993-1998.
كما درّس في كل من الجامعة الأميركية ببيروت، وجامعات هارفارد ونيويورك وبرنستون بأميركا، وجامعات هومبولت وهامبورغ وأولدنبورغ بألمانيا، وفي جامعة أنتويرب ببلجيكا، وجامعة توهوكو باليابان.
أسنِدت إليه عام 1969 رئاسة تحرير مجلة الدراسات العربية التي تصدر في بيروت، كما عمل باحثا أيضا في مركز الأبحاث الفلسطيني. وكتب عشرات المقالات والأبحاث في مجلات عديدة، مثل “دراسات عربية” و”الثقافة العربية” و”حوار”.
وانتخب كتاب سوريون في اجتماع بالقاهرة العظم رئيسا لرابطة الكتاب السوريين التي تأسست مطلع 2016 بوصفها تجمعا مستقلا للكتاب السوريين من مختلف التيارات الأدبية والفكرية خارج إطار الهيئات الرسمية.
التجربة الفكرية
تأسست تجربة العظم الفكرية منذ البداية على المعارك الضارية التي اشتبك فيها مع مقولات التراث والحداثة والجدل الفلسفي الديني، مما عرضه لكثير من الانتقاد وأثار عليه غضب شرائح مجتمعية عديدة. فقد حوكم بسبب كتابه “نقد الفكر الديني” الصادر عام 1969 إثر نكسة حزيران 1967، وصدر عليه حكم بالسجن مطلع عام 1970 لكن المحكمة أعلنت براءته لاحقا في نفس العام.
وفي الوقت الذي يعتبره كثيرون “علمانيا ملحدا”؛ يصفه أنصاره ومريدوه بأنه داعية إلى “التمسك بالعلوم والمعارف المادية في عالم عربي يشهد انحسارا لدور العقل”، ولذلك فإنه “يواجه استبداد العادات المتوارثة بيقظة العقل المتجددة”.
ويرون أنه “قدم إسهامات فكرية في نقد المؤسسة الدينية” واحتل بها “مكانه في طليعة المفكرين الذين تصدوا للموروثات الدينية والسياسية”، حتى صار “أحد أشهر العقلانيين العرب”.
وبعد حوالي ربع قرن من صدور كتابه “نقد الفكر الديني”؛ أثار العظم عاصفة جدلية أخرى بكتابه “ذهنية التحريم” الصادر 1992 والذي دافع فيه عن سلمان رشدي وروايته “آيات شيطانية”، وذلك بقوله “إن أدب سلمان رشدي ينتصر للشرق ولكن ليس لأي شرق بالمطلق، بل للشرق الذي يجهد لتحرير نفسه من جهله وأساطيره وخرافاته، وبؤس دكتاتوريته العسكرية وحروبه الطائفية والمذهبية وهامشيته الكاملة في الحياة المعاصرة”.
ورغم أن العظم درس الفلسفة في جميع مراحل تعلمه الأكاديمي وتخصص فيها دراسة وتدريسا؛ فإن علاقته بها لم تحل دون انخراطه في الواقع السياسي العربي الذي قدم فيه مساهماته الفكرية السياسية نقدا وتشخيصا وطرحا للحلول والبدائل كما يراها. ولذلك وُصف بأنه “قريب من العامة، ولم تكن علاقاته الاجتماعية حكرا على النخب رغم كونه ينتمي إلى عائلة أرستقراطية”.
وعندما اندلعت الثورة السورية عام 2011 على نظام بشار الأسد، أخذ العظم -الذي انتقل بعد تطور الأحداث إلى ألمانيا للعيش فيها- موقفا داعما لها على عكس كثير من نظرائه اليساريين العرب، وقال إن هدفها هو “استرجاع الجمهورية من السلالة الحاكمة إلى الأبد، ومن مجمعّها العسكري/التجاري الاحتكاري لكل شيء مهم في البلد”.
وأضاف أنه “لا يمكن للصراع أن يصل إلى خاتمته بدون سقوط ‘العلوية السياسية‘، تماما كما أن الحرب في لبنان ما كان يمكن أن تصل إلى خاتمتها بدون سقوط ‘المارونية السياسية‘ (وليس الموارنة) في لبنان”.
ووصف العظم الثورات العربية بأنها “العودة الربيعية للناس إلى السياسة”، ويرى أنها أوجدت جيلا جديدا سيقوم بتصفية مشاريع توريث السلطة لسلالات حاكمة في الجمهوريات العربية بنقل السلطة مباشرة إلى أبناء الحاكم أو أقاربه. ويؤكد أنه “ربما يكون في ذلك تمهيد لمستقبل أكثر ديمقراطية وحرية مما عرفناه حتى يومنا هذا”.
وفي 14 سبتمبر/أيلول 2016 أصدر العظم -رفقة نحو 150 من الكتاب والفنانين والصحفيين السوريين وصفوا أنفسهم بأنهم “ديمقراطيون وعلمانيون”- بيانا مشتركا أدان السياسات الأميركية والروسية في بلادهم “بأقسى العبارات لمقاربة القوتين المتدخلتين في سوريا (الولايات المتحدة وروسيا) لشأننا السوري، وعملهما -منذ عام 2013 على الأقل- على إلحاق كفاح السوريين التحرّري بحرب ضد الإرهاب…، دون ذكر لمليشيا حزب الله والمليشيات الطائفية الأخرى التي تحارب إلى جانب الأسد”.
يقول العظم معرفا بنفسه ومنهجه: “أقدم نفسي كمثقف ومفكر وكاتب حاول ما استطاع الاقتداء بالحكمة السقراطية القائلة بأن الحياة غير المفحوصة جيدا غير جديرة بأن تعاش أصلا (…)، مع رفضي كل محاولة لرفع أي موضوعات -مهما كانت- فوق مثل هذا الفحص أكان فرديا أم جماعيا، باسم توجه الناس نحو السماء وباسم القداسة والمقدسات”.
ويضيف: “لا ألعب أبدا لعبة اشتقاق الحلول لمعضلات عالمي العربي الراهن مما يسمى بـ‘التراث‘، لأن علوم زمني وثقافة زمني وأفكار زمني ومشاريع زمني هي التي تفسر التراث وتحتويه وتعطيه معناه وتقدم الحلول لمشكلاته، وليس العكس على الإطلاق”.
المؤلفات
أصدر العظم -منذ 1968- مؤلفات كثيرة تعالج الفكر والسياسة والفلسفة، منها: “النقد الذاتي بعد الهزيمة”، و”نقد الفكر الديني”، و”الاستشراق والاستشراق معكوسا”، و”دفاعا عن المادية والتاريخ”، و”ذهنية التحريم، سلمان رشدي وحقيقة الأدب”.
ومن مؤلفاته أيضا: “دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة”، و”الإسلام والعلمانية”، و”هل يقبل الإسلام العلمنة” (باللغة الفرنسية)، و”عسر الحداثة والتنوير في الإسلام” (باللغة الألمانية)، و”الإسلام والغرب اليوم” (بالإنجليزية).
الجوائز والأوسمة
في عام 2004 حاز العظم “جائزة ليوبولد لوكاش للتفوق العلمي” التي تمنحها جامعة توبنغن الألمانية، ومنحه “معهد غوته” وسام الشرف الألماني عام 2015.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أعلنت عائلته تأسيس “مؤسسة صادق جلال العظم” قائلة إن الهدف منها هو المحافظة على “إرث صادق جلال العظم الفكري والثقافي واستمراريته”.
كما أعلنت “مؤسسة اتجاهات – ثقافة مستقلة” مطلع ديسمبر/كانون الأول 2016 فتحها باب التقدم إلى “جائزة بحثية استثنائية تحمل اسم العظم، وتتوجه إلى الباحثين المتميزين في مجالات الثقافة والفنون من السوريين والفلسطينيين السوريين”.
الوفاة
توفي صادق جلال العظم يوم الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2016 في ألمانيا بعد صراع طويل مع المرض.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
رسائل إدوارد سعيد إلى صادق جلال العظم
محمد الدخاخني/ باحث ومترجم من مصر
كتب صادق جلال العظم (1934-2016) مراجعةً لكتاب “الاستشراق” لإدوارد سعيد (1935-2003)، بعنوان “الاستشراق والاستشراق معكوسًا”، وأرسلها إلى مجلة “الدراسات العربية” الفصلية، التي كان يقوم على تحريرها في ذلك الوقت سعيد وفؤاد المغربي. وعلى إثرها كانت هذه المراسلات.
10 تشرين الثاني/نوفمبر 1980
عزيزي صادق،
جزيل الشكر على إرسال تحليلك المطوَّل “للاستشراق”: إنه، كما أعتقد، مشغول بعناية فائقة، ويقدِّم -من خلال مصطلحاتك الخاصَّة- وثيقةً مقنعةً ومثيرةً للإعجاب حقًا. غير أن فؤاد [المغربي]، وأنا، نعتقدُ أنه طويل جدًا بحيث يصعب نشره كما هو. بالتالي، هناك خياران: الأول، أن تقوم باختصاره نحو 15 صفحة (يمكن استبعاد الكثير منها بسبب التكرار والحشو اللفظي)؛ الثاني، أن نختصره نحن، أو بالأحرى، يختصره المحرر ونرسله إليك للموافقة عليه. دعنا نعرف ردَّك في أقرب وقت ممكن، حتى نتمكن من المضي قدمًا في عملية نشره. وعلى أي حال، ريثما يتسنى لك الرد سنقترح عليك الاختصارات المطلوبة، بحيث، إذا اخترت ثاني الخيارين (المذكورين أعلاه)، يكون لدينا نص مهيأ للنظر من جانبك دون تأخير.
shareإ. سعيد: تلقيتُ العديد من المراجعات بخصوص “الاستشراق” وقررتُ عدم الرد على غالبيتها العظمى
لقد تلقيتُ العديد من المراجعات بخصوص “الاستشراق”، كما تعلم، وقررتُ عدم الرد على غالبيتها العظمى. وفيما يتعلق بمقالتك، سأقدِم على فعل غير مسبوق بالنسبة إلي: سأقوم بالرد عليك. دعني أكن أمينًا معك كصديق معجب بك ومحب لك. في كتاباتك الأخيرة، اكتشفتُ ضيق أفق ودوغمائية مؤسفين أضعفا عملك: وتلك هي الحال مع القراءة التي قدَّمتها لكتابي. أجدُ بعض نقاطك مصقولةً ومقدمةً بشكل جيد. بيد أن دفاعك عن ماركس والنقاط المتعلقة بـ “نُصحي” للمستثمرين الأمريكيين، في اعتقادي، غير ناضجة وسطحية، وسأقوم في ردّي بالبرهنة على شيء من خواء بلاغتك. لا أعتقدُ أنك، في أي وقت سابق، قد اشتبكت مع مُجادل من نوعيتي: إن هجماتك ضد أناسٍ هزيلي الحجة، تُمسك بهم من خلال تعبيراتك المملة، قد ذهبت إلى غير رجعة. من هنا، أعتزمُ أن ألقنك درسًا في كيفية الجدال وبلورة النقاط، ليس لشيء غير الرغبة في حس تعليمي. لعل أسوأ ما في كتابتك هو المدى الذي عليه سوء قراءتك: في الأخير، كما ترى، حين نقرأ ونكتب، نتعاطى مع كلمات، وطريقة تعاطيك مع الكلمات حَرفية جدًا وغير حَرفية كفاية، في الوقت نفسه، وليس بإمكانك أن تمضي في كلا الاتجاهين. حين تقتبس تسيء الاقتباس وحين تُفسِّر تسيء التفسير، وكلا النشاطين بـ “دقة” و”صحة” حجتهما. كمثال على ذلك، خُذ زعمك أن مفهومي حول الاستشراق أحادي الخط (unilinear): ببساطة، أنت لا تقرأ ما أقوله في كل موضع، أن الاستشراق كلمة متعددة المعاني، وعلى المرء أن يكون حساسًا تجاه تلك المعاني. وإذا كان هنالك أي شيء يمكن اعتباره أحادي الخط، فهو [أي الاستشراق] كذلك ليس كمفهوم (ما عدا عند القارئ الكسول وقليل الإحساس)، لكني سأشرح لك هذا أيضًا.
اقرأ/ي أيضًا: أثر الناقد.. نموذج تودوروف
أعتقد أن الفرق الحقيقي بيني وبينك أنك دوغمائي وحَرفي لم يمضِ أبعد من ماركسية الأممية الثانية؛ وإنني شكوكي، في كثير من الأحيان، وأناركي لا يؤمن على طريقتك، بالقوانين، أو الأنظمة، أو أيًا كان ذلك الهراء الذي يثبط فكرك ويحد من أفق كتابتك. وماركس بالنسبة إليك يُشبه الخميني بالنسبة إلى أتباعه: في واقع الحال، إنك خمينيّ يسار لم ينتمِ أبدًا أبطالي، غرامشي ولوكاش، إليه.
لا بُدَّ لي أن أقول، أخيرًا، إنني وجدتُ تلميحاتك حول علاقاتي الوهمية بالإمبريالية الأمريكية دون مستواك، وغير جديرة بك. ويمكنني فقط أن أرجعها إلى مجاري الصحافة اللبنانية، التي أمضيت فيها الكثير من وقتك. بالنسبة إلى باحث ومفكر مثلك، أن تُلمح إلى أشياء من هذا القبيل يعني أن تترك نفسك مفتوحةً على تُهم أسوأ، على سبيل المثال، كونك (حرفيًا) خادم طوعي وصامت للنظام السوري، الذي يوظِّفك حاليًا ويطلب صمتك، ثمن – كما قلتُ لك سابقًا، أنت قبلت بدفعه للأسف. لكني لا يمكن أن أصرّح بذلك علانيةً؛ وهذا هو الفرق بيننا. سأقولها لك سرًا كما أفعل الآن، ليس أكثر. ولعل الأمر برمته جزء من متلازمة إخصاء الذات التي أجدها في عملك؛ متلازمة مَن لديه الكثير ليقوله ويُسهم به، لكن يقوِّض ويدمر نفسه في كتاباته. هذا ما أعتقدُ أنك قد أقدمت عليه؛ لقد ضحيتَ بتأثيرك المحتمل لصالح ضجة وتشهير، لن يجعلانك، في النهاية، إلا أقل تأثيرًا بكثير مما كان متوقعًا منك. أيضًا، السؤال الذي سيكون علي أن أحاول الجواب عليه هو: لماذا يؤذي صادق نفسه وقضيته طواعيةً، ولماذا يشل مقدرته في ذات النَفَس الذي يعبِّر فيه عنها؟ هذا سؤال ثقافي من المفيد جدًا طرحه.
آمل أن تأخذ نقاطي بالروح التي قصدتُ منها. لكن سيكون من الجيد للمجلة أن نناقش بعضنا البعض بتأدُّبٍ على صفحاتها: لهذا، فكِّر في المواضع التي ستختصرها. على أي حال، لن يكون لدي وقت للرد عليك حتى الأول من كانون الأول/يناير. فأنا، حاليًا، غارقٌ في العديد من الواجبات والأوراق: ومع ذلك، أتطلع بشغفٍ إلى الرد عليك تفصيلًا.
مريم تُرسل مودتها لفوز ولك – وأنا أيضًا.
احترامي،
إدوارد
2 كانون الأول/ديسمبر 1980
عزيزي إدوارد،
شكرًا جزيلًا لك على الخطاب الذي أرسلته في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1980. عرفتُ أن مقالتي ستكون مزعجةً، لكنني لم أتوقَّع مثل هذا الانفجار العنيف من جانبك، خاصةً الهجوم على شخصي. وحقيقةً، أعتقدُ أن حدة ردة فعلك لا تتناسب و”الجرائم” التي يبدو أنني اقترفتها في انتقاد بعض جوانب كتابك.
shareالعظم: خضتُ نقاشات ومناظرات أشد مرارةً من قبل ونجحتُ في الاعتصام بموقف مستقل إلى حد معقول
لقد خضتُ، كما تعلم، نقاشات ومناظرات أشد مرارةً من قبل ونجحتُ في الاعتصام بموقف مستقل إلى حد معقول. ومن ثمَّ، أتجنَّبُ اتهاماتك التعسفية، وأتغاضى عن المقارنة التي عقدتها بين الصفات والفضائل المتعلقة بك وتلك الخاصَّة بشخصي المتواضع، والتي تقود كلها، كما هو متوقَّع بما فيه الكفاية، إلى نتيجة محتَّمة تتمثَّل في تفوقك. أعتقدُ أن أمورًا كهذه ينبغي أن تترك للآخرين كي يتحدثوا ويتناقشوا بشأنها (لو كان ينبغي)، لأننا لا نُقدِّم الكثير لأنفسنا حين ننغمس في مثل هذه المقارنات والتقييمات الأنانية. كما أحبُ أن أنوِّه إلى أن “هزيلي الحجة” الذين اشتبكتُ معهم لم يكونوا أساتذةً متعكري المزاج أو مثقفين هادئين، وإنما أشخاص، ومؤسسات، وحكومات مدججة بالسلاح وخطيرة بشكل لا يقبل الجدال. وغارقين في تقاليد “الاستبداد الشرقي”، يُعرف عنهم الميل إلى تسوية الاختلافات في الرأي مع النُقَّاد والمجادلين عبر اللجوء إلى الرصاص والمتفجرات والحرق والقمع والاغتيال.
اقرأ/ي أيضًا: الصور النمطية.. بين هدر الواقع ومسخه
يؤسفني إصرارك على إساءة فهم الصفحات القليلة الأخيرة من الجزء الأول من مقالتي. فكما يبدو لي، ثمة اختلافٌ واضح بين القول إن “س” لديه علاقات (من نوع أو آخر) مع الإمبريالية الأمريكية، والقول إن “س” يحمل آراءً ويُعبِّر عن وجهات نظرٍ تلعب دورًا (أو قد تلعب دورًا) أو تقدِّم منفعةً للإمبريالية الأمريكية، ينبغي تنبيهه بخصوصها والنقاش صراحةً بشأنها. وتكون هذه المهمَّة أكثر أهميةً وإلحاحًا إذا كان “س” مشهورًا بموقفه المناهض للإمبريالية.
إن الصفحات المعنيَّة توضح لك أن الإمبريالية الأمريكية يسرّها: (أ) حكمك أن علاقة التبعية العربية-الأمريكية غير مأساوية؛ (ب) إصرارك أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط تسير على ما هي عليه لأن المخيال الاستشراقي ما زال يسيطر على عقول واضعي السياسات وغيرهم من الخبراء الذين يوجِّهون هذه السياسة. يبدو لي، بشكل وجيه، أن هذه المواقف لا يمكن أن تنسجم مع موقف حقيقي مناهض للإمبريالية. وددتُ لو أراك تُجادل عكس ذلك بدلًا من أن تكون غاضبًا جدًا معي. وبشكل مماثل، إذا كنت ترغبُ في الدفاع عن الشرق ضد الاستشراق الغربي والإمبريالية فإنه ينبغي أن تتوقف عن الالتزام بالنقطتين (أ) و(ب)، أو عليك أن تخبر الزعماء الأمريكيين أن عليهم تطهير رؤوسهم الإمبريالية من التوهمات والتجريدات الاستشراقية. وعندي أن هؤلاء الزعماء وخبراءهم هم أناس عديمي المشاعر يمتلكون في العموم عددًا قليلًا من الأوهام ويعرفون بالضبط ماذا يفعلون وفي سبيل أية أهداف. ربما أكون مخطئًا. لكني أرغبُ في رؤيتك تجادل أن الموقف المعارض يمكن الاستمرار في الدفاع عنه بجانب التزامٍ حقيقيٍ بمناهضة الإمبريالية، بدلًا من نعتي بأوصافٍ لا تليق.
أعتقدُ أننا ننتمي إلى هذا النوع من الناس الذي يمتلك وجهات نظر قوية حول مسائل الحياة المهمَّة وقضاياها المشتعلة، وأننا ندافع عن قناعاتنا بقوة وننتقد الآخرين بحماسة، لكن هذا لا يقدِّم حجةً لأي منا أن يُظهر توفقه الأخلاقي، ويحمِّل المواقف أقدس مما ينبغي، ويزعم قدرات متفوقة في إعطاء الآخرين دروسًا نموذجية. وسواء كانت وجهات نظر ماركس بشأن الهند ناتجة عن استلاب أفكاره من قِبل رطانة المستشرقين وتعريفاتهم القاموسية، أو ناتجة عن نظرته العامَّة بشأن التغير التاريخي؛ وسواء كان هناك تصور أحادي الخط للاستشراق في كتابك أم لا، كلها تساؤلات قيمة يمكن نقاشها وتوضيحها بعقلانية دونما التلمظ بمتلازمات ونظريات الإخصاء، أو اللجوء إلى أشكال أخرى من الاغتيال الشخصي.
فيما يتعلق بنشر مقالتي في مجلة “الدراسات العربية”، لدي نقطتان: (أ) بالنظر إلى أن مقالتي تتعاطى مباشرةً مع كتابك وبالنظر إلى أن ردة فعلك قد جاءت حادة على محتوياتها (إلى حد كسر تعهداتك بعدم الرد على المنتقدين)، ظننت أنك ستمتنع تمامًا عن أخذ أي نوع من القرارات أو الاقتراحات التحريرية وما إلى ذلك، بخصوص هذا النص. (ب) أصرُّ على نشر مقالتي دون حذف كلمة واحدة وكما هي، مهما كانت مشاكلها. وهذا أمر نهائي وغير قابل لمزيد من النقاش. وفي حال وجدت المجلة طلبي غير معقول (أو من المستحيل تلبيته لسبب أو لآخر)، سأقدِّر إعادة نسختي على عنواني في بيروت في أسرع وقت ممكن.
نتمنى لكم جميعًا عيد ميلاد سعيد وسنةً جديدةً سعيدة.
خالص الاحترام،
صادق
10 كانون الأول/ديسمبر 1980
عزيزي صادق،
مَن يُبالغ الآن في ردة فعله؟ لم أذكر في خطابي أي شيء يمس شخصك غير خنوعك للنظام، وسرعان ما تخطيتُ الأمر. أما أن خطابي يشير أو يتضمن ادعاء تفوقي عليك، فهذا محض هراء. لستُ أنا من يستخدم هذه الأساليب، ولكن ما قلتُه -وهذه مرة أخرى تسيء فيها القراءة- إنني متفوق كمجادلٍ أو مشتبكٍ مع هجماتك، في الجدالات على الأقل، مقارنةً بخصومك المعتادين. وها أنت تؤكد ذلك عبر قولك إن خصومك عمومًا كانوا مستبدين شرقيين يُعملون السيف. تلك بالضبط هي وجهة نظري، التي لا شك أنها فاتتك.
shareإ. سعيد: ما أقوله حول أن سياسة الولايات المتحدة يجري بناؤها على المخيال الاستشراقي
بالنسبة إلى نقطتك الأخرى، حول النُصح أو تقديم المنفعة للإمبريالية. إذا قرأت المقطعين المعنيين، ستعرف 1) ما أقوله حول أن سياسة الولايات المتحدة يجري بناؤها على المخيال الاستشراقي ليس أكثر من إعراب عن حقيقة، لا تتضمن توجيهي النُصح بشأن ما هو الشرق، ولا أني أود أن أكون معاونًا في تغيير تلك السياسات. بل على العكس تمامًا، أقول ما يجب أن يُقال كوصف لما يحصل، و -إذا كنت تكمِل القراءة- أقول أيضًا إنه ما من سياسة مختلفة ممكنة نظرًا لطبيعة المؤسسات والنظام وما إلى ذلك. 2) أما الفقرة الثانية، عن العلاقة التبعية -ما قلتُه أن العلاقات التبعية بحد ذاتها لاحظ أني استثنيت العلاقات الاقتصادية (حيث إن كل منظري الإمبريالية الذين ذكرتهم، فرانك وجاليه وأمين إلخ، يتكلمون عن علاقات التبعية الاقتصادية)- ليست سيئة تعريفيًا. ما أعنيه هو أنه من المستحيل أن تكون كل الثقافات متساوية في عالم ثقافي معقد، وأن كل هذه الثقافات مستقلة ومبدعة ولا تستنسخ غيرها: هل يمكننا القول إن علاقة التبعية بين روما واليونان كانت سيئة نتيجة أنها كانت علاقة تبعية من الناحية الثقافية، كما كان الحال في العلاقة التبعية بين ألمانيا وإمبراطورية النمسا؟ لا. فبعض العلاقات من هذه النوعية قائمة نتيجة شكل العلاقة – ومثالًا على ذلك علاقة العالم العربي مع الغرب، حيث إن العلاقة أحادية الاتجاه، وبالتالي هي علاقة استنساخ، ومن ثم غير متكافئة. هذه هي النقطة التي أردتُ أن أثيرها. أما حجتك حول ماركس فلن أكلف نفسي عناء التعاطي معها هنا، لأنها تنطوي على أشياء أكثر تعقيدًا، كما أنها مثيرة للاهتمام لأسباب أخرى.
على أي حال، افترضتُ أن رسالتي ستثير الغضب بعض الشيء، وأنا آسف لذلك. وشكرًا لأنك دعوتي بالأستاذ متعكر المزاج: لكن كيف أدعوك، الناقد الهادئ والأولمبي لأخطاء الآخرين؟ وهو كذلك – أنت ناقد هادئ وأولمبي لأخطاء الآخرين.
من العار أن تشير إلى أنه، بسبب انخراطي شخصيًا في المسألة، لا ينبغي عليّ اقتراح تغييرات وتعديلات على نصّك. الحقيقة أنني أكثر نزاهةً وعدلًا من ذلك: أتمنى أن ترى ذلك ولو لمرةٍ واحدة. قبل أن أكتب إليك، راجعتُ الأمر مع المحررين المشاركين، فؤاد وإبراهيم أبو لغد: في واقع الأمر، عندما وصل نصك إلى يدي فؤاد، أخبرني، قبل أن أفعل، أنه طويل جدًا. وقد رفضتُ قراءته حتى قدّم لي هو وإبراهيم انتقاداتهم. ويعتقدُ الأخير أن نصك ينبغي أن يُختصر إلى خمس، نعم خمس، صفحات. بالتالي، ما كنت أقوله لا يعبِّر عن تعليق شخصي، ولكن عن عمل تحرير جماعي. وردّك، برأيي، جاء غبيًا جدًا وطنانًا، لأن الاختصارات من الأمور المعتادة حتى في أفضل المجلات، أيضًا لماذا تعتقد، بطريقة أو بأخرى، أن كل كلمة لك مقدسة وفوق النقد؟ من المضحك أن يتخذ المرء مواقف كتلك التي تتخذها. على كل حال، سنعقدُ اجتماعًا في نهاية هذا الأسبوع. وسيكون موقفي مع نشر نصك بالكامل، حتى آخر كلمة، وكما هو. وإذا رفض المحررون موقفي سيعود إليك نصك. وإذا لم يرفضوا، سأنشر حقي في الرد إلى جانبك. هل يعجبك هذا؟
shareإ. سعيد: الاستشراق ليس كتابًا جيدًا جدًا، ولكني أصر على أنه يحتوي على قراءات وتفسيرات ممتازة
أظن أن الضغينة التي بيننا سيبددها الوقت. وما زلتُ أعتقد أنك لم تكتب هذا النص بنية صافية (نية فكرية صافية)، ولم تقرأ كتابي بالعناية والذكاء المعهودين منك. كما أعربُ عن ندمي على أي شيء قلته وبدا انفعاليًا (لكن هذا لا يشمل الكلام الدقيق الذي قلته لك، حيث إن أغلب ما قلته لك كان دقيقًا) ومسيئًا، لكني لستُ نادمًا على إخبارك شعوري تجاه النقودات التي تكتبها الآن، وتسلطها، بشكل أو آخر، على من يلوح في أفقك. لعله من النافع الإشارة إلى أنني عندما أكتب كتابًا من هذا النوع أكون في حالة معينة وأكتبه لجمهور عمومي وليس لشخص واحد، وما إليه، لكن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار كفاية في مقالتك.
أنا على استعداد لقول إن الاستشراق ليس كتابًا جيدًا جدًا، ولكني أصر على أنه يحتوي، مع استثناءات قليلة، على قراءات وتفسيرات ممتازة. شكواي الرئيسة منك أنك لا تقرأ جيدًا، أو أنك تكتب أفضل مما تقرأ. وآمل أن تفهم ما أعنيه. ما من جراح بالغة، على الرغم من وجود بعض الكدمات. وعمومًا، قد لا يكون الوضع بالغ السوء. سأكون في بيروت إجازة الأسبوع الموافقة 9-11 كانون الثاني/يناير عند أمي. هل يمكننا أن نلتقي، إذا كان في وقتك متسع؟
كل التحية لأربعتكم-
احترامي،
إدوارد
صادق جلال العظم: لماذا لستُ مؤمنًا؟
في السادس من آذار/مارس 1927، ألقى الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل محاضرةً بعنوان: “لماذا لستُ مسيحيًا؟”، صارت فيما بعد مقالةً ذائعة الصيت، خصوصًا بعد أن نُشرت مع مجموعة مقالات أخرى لرسل حول الدين، على يد الفيلسوف الأمريكي-النمساوي بول إدواردز عام 1957. وفي نَفَس فلسفي يتماشى مع تلك الفترة، يناقش المنطقي والرياضي البارز النقاط التالية: ما المسيحي؟؛ وجود الإله؛ حجة العلة الأولى؛ حجة القانون الطبيعي؛ حجة التصميم؛ الحجج الأخلاقية؛ حجة رد المظالم؛ شخصية المسيح؛ المجيء الثاني للمسيح؛ المشكلة الأخلاقية؛ العامل العاطفي؛ كيف أعاقت الكنائسُ التقدم؛ الخوف: أساس الدين؛ ماذا علينا أن نفعل.
shareيعبر كتاب “نقد الفكر الديني” لجلال العظم عن منزع “راسلي” تجاه القضايا الدينية
في تشرين الأول/أكتوبر 1969، أي بعد أكثر من أربعة عقود بقليل على “لماذا لست مسيحيًا؟”، نَشر الفيلسوف السوري الراحل صادق جلال العظم كتابًا بعنوان “نقد الفكر الديني”، طبع عدة طبعات، قانونية وغير قانونية، ومنع في عدد كبير من الدول العربية، سواء تلك التي تمتلك نظامًا دينيًا صريحًا كالمملكة العربية السعودية، أو تلك التي رفعت شعارات “تقدمية” قومية أو ناصرية، كعراق صدام حسين أو ليبيا معمر القذافي. بل إن الناقد والمنظِّر الثلاثيني حينئذ قد جُرَّ إلى المحاكمة، في بيروت التي كان يعمل بها أستاذًا جامعيًا، بتهمة “التحريض علىى إثارة النعرات الطائفية”. وقد ألحقت وثائق المُحاكَمة بالطبعات التالية للكتاب.
عدا المقدمة، يضم الكتاب (230 صفحة) الفصول الستة التالية: الثقافة العلمية وبؤس الفكر الديني؛ مأساة إبليس؛ رد على نقد؛ معجزة ظهور العذراء وتصفية آثار العدوان؛ التزييف في الفكر المسيحي الغربي المعاصر؛ مدخل إلى التصور العلمي المادي للكون وتطوره.
وسوف تتطرق هذه المقالة إلى توضيح نقطتين رئيستين تتعلقان بـ”نقد الفكر الديني”: مناسبة الكتاب ومنهجيته، لأهمية التذكير والوعي بهما وإمكانية البناء عليهما والذهاب بالنماذج التطبيقية التي قدمها العظم إلى أقصاها.
لا يُخفي العظم تأثره براسل، وهو يحيل أكثر من مرة، في الفصل الأول، إلى مقالته “عبادة الإنسان الحر”، المنشورة في كانون الأول/ديسمبر 1903، والتي تُعد أكثر نصوص راسل شهرةً وطباعةً، وإحدى علامات الفكر الأوروبي المبكر في القرن العشرين، و”قطعة أدبية جميلة” على حد تعبير العظم نفسه. كما يتناص معه في مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بالكون والعلم ووجود الإله. من هنا، يُمكن القول إن كتاب العظم يعبر عن منزع “راسلي” تجاه القضايا الدينية على نحو يُمكن معه أن نضع عنوانًا جديدًا و”راسليًا” للكتاب، هو: لماذا لستُ مؤمنًا؟
قبل أن يُجيب العظم على هذا السؤال المفترض، يشرح بصراحة شديدة مناسبة هذا الكتاب: “بعد هزيمة 1967، [تبين] أن الأيديولوجية الدينية على مستوييها الواعي والعفوي هي السلاح “النظري” الأساسي والصريح بيد الرجعية العربية في حربها المفتوحة ومناوراتها الخفية على القوى الثورية والتقدمية في الوطن. كما أن بعض الأنظمة التقدمية وجدت في الدين عكازًا تتكئ عليها في تهدئة الجماهير العربية وفي تغطية العجز والفشل الذي فضحته الهزيمة” (ص. 9).
لقد رأت التيارات الإسلامية في الهزيمة الحزيرانية دليلًا على بُعد الأنظمة القومية، لا سيما النظام الناصري في مصر، عن الدين، وبرهانًا على “إلحادها”، على حد تعبير واحد من أشهر الأبواق الدعائية الإسلاموية؛ متولي الشعراوي، الذي سجد حين علم بـ”النكسة”، و”فرح أننا لم ننتصر ونحن في أحضان الشيوعية، لأننا لو نُصرنا لأصبنا بفتنة في ديننا”. ورأت الأنظمة القومية، وقد منيت بالهزيمة، أنه لا خيار أمامها سوى اللجوء إلى الدين لاستيعاب غضب الجماهير والترويج لأخبار من نوعية “ظهور العذراء” في حي كذا (وهي المسألة التي يفرد لها العظم فصلًا مطولًا ولاذعًا) وافتتاح الرئيس لمسجد كذا، على الصفحات الأولى لجرائدها الرسمية.
لكن جواب العظم أو بالأحرى نقده، المفتوح على جبهتين -واحدة تذوي وأخرى تصعد- لن يكون مشابهًا لنقودات غالبية الانتلجنسيا العربية التي انغمست، منذ تلك اللحظة، في نقد ثقافوي لم تخرج منه إلى الآن. سيكون النقد عنده ماديًا، أي ماركسيًا.
shareرأت التيارات الإسلامية في الهزيمة الحزيرانية دليلًا على بُعد الأنظمة القومية عن الدين
اقرأ/ي أيضًا: صادق جلال العظم.. الحوار لا يزال مفتوحًا
يحذر لينين من “طرح المسألة الدينية بشكل تجريدي مثالي، باعتبارها مسألة “ثقافية” غير ذات صلة بالصراع الطبقي”، في الوقت الذي يؤكد فيه على أن “الوحدة في هذا النضال الثوري الذي تخوضه الطبقة المقهورة من أجل خلق جنة على الأرض أكثر أهمية لنا من وحدة الرأي البروليتاري حول الجنة في السماء” (الاشتراكية والدين، 1905). والموازنة بين 1) الإقرار بالجوهر الإلحادي-العلمي للماركسية، و2) بالطبيعة المادية/غير الثقافوية لنقدها للدين، و3) وكون وحدة البروليتاريا فوق أي شيء آخر، يحققها العظم في كتابه بألمعية شديدة.
لا يعني العظم بالإيمان الديني “ظاهرة التسليم البسيط الساذج الذي يطبع موقف معظم الناس في كل ما يتعلق بدينهم” (ص. 18)، ولا يقصد “الدين باعتباره ظاهرة روحية نقية وخالصة على نحو ما نجدها في حياة قلة ضئيلة من الناس” (ص. 17)، وهنا يمكن أن نتلمس النقطة الثالثة ضمن الثلاثية اللينينية سالفة الذكر. إن الفكر الديني عند العظم هو “الإنتاج الفكري الواعي المتعمد في ميدان الدين كما يتم التعبير عنه صراحة على لسان عدد من الكتاب أو المؤسسات أو الدعاة لهذا الخط” (ص. 7). وهذا “الفكر الديني” يعمل على “تزييف حقيقة الصراع الاجتماعي القائم” (ص. 9)، وهنا يمكن أن نتلمس النقطتين الأولتين.
بأخذ ما سبق في الاعتبار، يكون كتاب العظم الراسلي والماركسي (وقد كان راسل اشتراكيًا على طريقته) لا غنى عنه في النظر إلى تاريخنا الاجتماعي والسياسي، خصوصًا الهزيمة الحزيرانية، وفي تحديد الخط الفاصل بين القوى التقدمية والرجعية، والتأسيس لمنظور علمي للمسألة الدينية.
محمد الدخاخني/ باحث ومترجم من مصر
صادق جلال العظم.. تفكيك الحب/ ريناس مللي
لعلنا جميعًا سمعنا بخبر الوعكة الصحية التي توشك أن تنعي لنا شخصية نذكرها دائمًا كعلم من أعلام الفكر في سوريا، شخصية ميزت المشهد الثقافي السوري وقدمت محتوى ثقافي ذا أهمية كبيرة. وعكة قد تودي بحياة الفيلسوف والمفكر صادق جلال العظم في مدينة برلين، الرجل الذي ولد في دمشق 1934، ودرس الفلسفة في الجامعة الأمريكية في بيروت، وتابع تعليمه في “جامعة بال” في الولايات المتحدة، وعمل أستاذًا جامعيًا في الولايات المتحدة قبل أن يعود إلى سوريا ليعمل أستاذًا في جامعة دمشق، ومن بعدها انتقل إلى التدريس في الجامعة الأمريكية في بيروت بين 1963 و1969، ومن ثم عمل أستاذًا في “جامعة الأردن”، بالإضافة إلى أنه، في سنة 1969، أصبح رئيس التحرير في “مجلة الدراسات” التي تصدر في بيروت.
كتب العظم عن الفلسفة، وقدّم دراسات ومؤلفات عن المجتمع والفكر العربي المعاصر، ونقد في المفكر المعاصر، وكتب مثل “الاستشراق والاستشراق معكوسًا”، و”ما بعد ذهنية التحريم”.. وغيرها.
shareفي كتابه “في الحب والحب العذري” ينفض صادق جلال العظم كل الغبار المتراكم في عقولنا
ولعل أبرز ما عاد إلى ذاكرتي عند سماع خبر هذه الوعكة الصحية التي ألمت به، هو كتابه الشهير “في الحب والحب العذري”، ربما لأنه من أكثر الكتب التحليلية التي فاجأتني في طروحاتها المهمة. ولعله أيضًا من الكتب التي لعبت دورًا في تغير الكثير من اعتقاداتي، واعتقادات شباب كثيرين من أبناء جيلي، عن الحب.
في الكتاب ينفض العظم كل الغبار المتراكم في عقولنا بخصوص مفهوم وخصائص الحب التي اعتدنا الاعتقاد بها تقليديًا، فيقوم بوضع طروحات جديدة تنجدنا من مأزق تساؤلاتنا التي لا نستطيع إيجاد إجابات شافية لها من محض عقولنا، دافعًا إيانا إلى البحث في الكتب والمراجع.
اقرأ/ي أيضًا: الحياة العاطفية للفلاسفة
يطرح الكتاب ملامسة جدية لمجتمعاتنا، عندما يبيّن العظم أن الإنسان الذي يعاني من الكبت والحرمان الجنسي الطويل، لا يميز بين الانجذاب الجنسي والحب، وكثيرًا ما يقع الشخص المحروم في هيام وحب أول إنسان، يبدي نحوه اهتمامًا عاطفيًا حتى ولو كان ذلك من باب المصادفة، فالباعث على حالته ليس الحب بل الرغبات المكبوتة. وهنا يتعامل مع ظاهرة العلاقات الفاشلة التي تنتهي باكتشاف أحد الطرفين، أو كلاهما، أنه لم يكن هناك حب حقيقي لأن الحب تلاشى بعد فترة قصيرة من الزمن، بالإضافة إلى شرحه سلوك العاشق، أو العاشقة، في هذه الحالة، وهذا الصنف من العلاقات، وكما نعرف ونرى حقًا هذا الإشكال كثيرًا في مجتمعاتنا.
تبدأ مفارقة الحب في الكتاب، بين بعدي الاشتداد والامتداد، فالامتداد يعني دوام الحالة العاطفية واستمرارها، والاشتداد هو مدى حدة العاطفة في لحظة معينة من الزمن، وعلى هذين العنصرين تتغير أشكال العلاقة وقوة الحب.
يشير العظم في الكتاب إلى أن الحب ليس ماهية واحدة، بل هو مفهوم مجرد يشير إلى أطياف من المشاعر والأحاسيس، وحسب رؤيته فإن الحب في مرحلة ما بعد العبور من طور الانجذاب الجنسي، وتخطيه إلى ما هو أهم وأكثر تعقيدًا، يشمل كيان الإنسان، جسدًا وعقلًا وروحًا. وما يشير إليه هنا يمثل نقطة مهمة للدخول في عمق الكتاب وتحليله، القائم على أن المرأة أيضًا قادرة على الحب مثل الرجل، وتستطيع جذب الرجل، على عكس ما زرع في عقولنا.
يتجلى مفهوم “مفارقة الحب”، كما أشرنا، في أن عاطفة الحب لها بعدان أساسيان هما الاشتداد والامتداد. الامتداد في الزمان يعني دوام الحالة العاطفية واستمرارها، بينما الاشتداد هو مدى قوة وحدّة الحالة العاطفية في لحظة ما من الزمن، لكنه يشير أيضًا أنه كلما طالت مدة الحب تنخفض حدته، وأما الامتداد فهو الرغبة في بقاء العلاقة وتحقيق الثبات النسبي، لكن من منظور العظم نرى أن شريعة الامتداد هي جعل الزواج خاتمة للحب، وذلك بطبيعة الحال يصب في الأيديولوجية الاجتماعية السائدة، التي تسعى بطريقتها تلك للحفاظ على ثبات المجتمع واستمراريته، وكما يرى صاحب “مأساة إبليس” فإن الوفاء آلي في العلاقة بين الزوجين، ومن يلتزم بالامتداد ويعمل على إشباع حبه بواسطة الزواج عليه أن يدفع الثمن، بأن يفقد كل ما يملكه الحب من صلة مع اندفاعات ورغبات عارمة وانفعالات.
shareالزوج الوفي، وفقًا للعظم، من لا ينظر إلى أطراف الطريق، ويلتزم بآلية تراتبية بين البيت والعمل
من صفات الزوج الوفي وفقًا لهذا المنطق، هو من لا ينظر إلى أطراف الطريق، ويلتزم بآلية تراتبية بين البيت والعمل، بينما تتمثل صفات الزوجة الوفية كما حددها العظم بأن تكون وفية وساذجة وطاهرة وبريئة، وبأن لا تعرف شيئًا من تجارب الحياة، وبأنها تؤمن إيمانًا كاملًا بفضل زوجها عليها، وأن واجبها يكمن في طاعة زوجها طاعة كاملة، والزوجان الوفيان يحظيان بتوصيف من العظم أنهما يعيشان مع بعضهما على طريقة “مكره أخاك لا بطل”، وكما أن الزوجين الوفيين يكونان في نظر المجتمع عماد الخلية والعامل الأول لاستمرار المجتمع ودوامه.
وكوصف لتناقض المجتمع مع القصص الشعبية عن الحب، يصف العظم ذلك بالمرضي والخارج عن المعقول، كتعبير عن تلك النفس المكبوتة، وأن هذه الأساطير ماهي إلا تنفيس لتلك الطاقة الحبيسة، بأن تلك القصص التي تتحدث عن مغامرات فلان، وقصص الشرف و… غيرها، تلعب دورًا رئيسيًا في حفظ التوازن في العلاقات الاجتماعية السائدة، عندما تمتص تلك الأقاصيص الميول والرغبات، وتهدئ من عنفها ولا تدعها تنفجر، وذلك جزء لا يتجزأ من الأيديولوجية السائدة.
أما الاشتداد فهو تحقيق الحب بأقصى درجات الانفعال والجيشان العاطفي، وكما دعاه، وكما هو متعارف عليه أيضًا، بالمغامرة الغرامية، ويشرح أو يوضح رغبة الاشتداد الذي طرحها عن طريق تفسير أو تحليل شخصية الدنجوان وسماته، بوصفه مثلًا أعلى لرغبة الاشتداد في الحب، فهو من يرغب في العشق في المستوى العنيف والانفعال الحاد، ويرفض القيم والمعايير الاجتماعية السائدة، لهذا يكون مُحاربًا دينيًا واجتماعيًا، لكن أيضًا يوجد تنويه مهم في الكتاب الى أن هناك فرق بين الدنجوان ومن تتيح له ظروفه الخاصة بالاستمتاع، ويقصد هنا الإشارة إلى عهد الجاريات، والظروف التي كانت تتيح لصاحب المال بأن يحظى بالكمية التي يريد من الجاريات.
أثناء غوصه في تحليل الحب العذري، يشير العظم إلى أن بعض الكُتّاب قالوا إنه نسبة لقبيلة بني عذرة، ووصفوا الحب العذري بأنه يقوم على العفة والوفاء، وبأنه انتصار للروح على الجسد، وأنه الحب الذي يتعامل معه العاشقون بأنهم يريدون إنهاءه بالزواج، لكن العظم يقوم بتحليل هذه الظاهرة مستخدمًا القصة الشعبية الشهيرة “جميل وبثينة”، كمثال أو نموذج لما يدعى بالحب العذري، فيقوم بذكر الحادثة التي تعرّف فيها جميل على بثينة، ويذكر أيضًا أنه من المعروف والسائد في عادات القبيلة بأنهم كانو يحرمون التغزل بالنساء، وأنهم كانوا يحرمون الزواج على من يقوم بالتغزل، وهنا يطرح تساؤلًا: لماذا لم يمتنع جميل عن التغزل ببثينة طالما كان يحبها، ويبغي الرباط المقدس معها؟ وطالما أن الحب العذري كما يقولون عفيف وطاهر؟
من هنا تبدأ فكرة أن من خصائص الحب العذري هي خرق مؤسسة الزواج، وليس العكس، وتقود التساؤلات إلى أنه إذا كان الحب العذري يتصف بالعفة والطهارة، فلماذا جميل كان يزور بثينة في عقر دارها مع عدم رضا أهلها وزوجها؟
shareمن خصائص الحب العذري خرق مؤسسة الزواج، كما يقول العظم
ومن الطريف في نقد العظم لتلك القصص، أنّ من يقرأ تلك القصص يجد نفسه يكره الزوج الذي يصبح الأبله والغبي في نهاية الحكاية. وهنا يسرد إحدى قصص زيارة جميل لبثينة، ويقول إن جميل كان من عشيرة ثرية وذات مكانة، وإنه كان يعلم بأنه مهما فعل فلن يرفض أهل بثينة طلبه لزواج منها، ولن يقوموا بأي عمل ضده خوفًا منه. فإذا كان هذا واقع الحال فما الإشكال في زواجهما؟! نلاحظ في هذه القصة أنه هناك شبه بين العاشق العذري والعاشق الدنجوان، لرغبتهما في “اشتداد الحب”، لكن الفرق أن الدنجوان ينتقل من حبيبة إلى أخرى، لكن العاشق العذري يكثف حبه باتجاه حبيبة واحدة، لكنه في ذات الوقت يضع العراقيل بينه وبينها لكي يبقي نار الحب مشتعلة، ويطرح العظم مثالًا آخر للتحليل والنقد في الحب العذري، وهو عفراء وعروة، اللذان قال فيها عمر بن الخطاب بأنه لو عاصرهما لزوّجهما.
اقرأ/ي أيضًا: موسم الارتداد عن الحب
يرى العظم أن من ميزات الحب العذري أنه يتمتع بشيء من “السادوماسوكية”، فهو تعبير عن حالة مرضية في عمق قلب العاشق، مما يجعله يتمتع بحرقة الشوق الذي لا أمل في إشباعه، حيث يتحول الحب إلى ذات العاشق، بينما تكون العشيقة مجرد أداة أو وسيلة لذلك الهدف.
وفي متابعة لما وصفه العظم بالظاهرة التي تَنتج عندما ينحدر الحب العذري في المجتمع، لا سيما المجتمع الذي يعاني الكبت العاطفي والغرامي، ليقع في أيدي أشباه العشاق أو العشاق “الدونكيشوتيين” كما وصفهم، وهم من يتقمصون صور مسبقة للحب ويسمحون لها أن تتغلغل في قلوبهم، وتتحكم في حركاتهم وسلوكهم ومخيلتهم وأحلامهم، فهم يضعون أنفسهم في قالب جاهز للحب، وهم أيضًا يعانون من مشكلة أنهم يقعون في حب أي فتاة يصادفونها، فهم لا يميزون بين الحب الذي يقوم بطبيعته على الانتقاء والاختيار، وبين شهوتهم المكبوتة التي تطلب الإشباع فقط، وهم أيضًا من النوع الذي يرفض التصريح للحبيبة عن حبه وما يجول في صدره، لغرض يرغبون به، وهو تعقيد الأمور واستكمال صورة العاشق المعذّب.
كما يرى العظم في نهاية الدراسة والتحليل في مفارقة الحب أنه يستحيل تحقيق حل مثالي للإنسان، مادام يحيا ضمن نطاق الزمان والصيرورة، وأن كل إنسان يعي الإشكال الذي ينطوي عليه الحب، ويدرك أهميته وطبيعته، يعرف بأن عليه أن يواجهه في نهاية الأمر.
طالب من سوريا، مقيم في إسطنبول
صادق جلال العظم… الإنساني المتعدد والرحب/ حسام عيتاني
في كراس صغير يحمل عنوان «الإسلام والنزعة العلمانية الإنسانية»، يخبئ صادق جلال العظم واحداً من مفاتيح فكره التي رأى بعض قرائه تناقضاً فيه خصوصاً في أعوامه الأخيرة.
وفق الدراسة التي يتضمنها الكراس يمكن رسم لوحة تقريبية للآليات التي كان ينظر فيها العظم الى الواقع ويقيّمه بناء عليها: لدينا في الأساس القيم التي اتت بها الحداثة الأوروبية واكتسبت سمتها العالمية الشاملة وخرجت من اقليميتها ونجحت في اثبات نفسها كضرورات سياسية واجتماعية، ومنها حقوق الإنسان والحريات المدنية والديموقراطية وغيرها. وعلى رغم كونية هذه القيم الا انها ما زالت تتعرض لهجمات من طرفي ما بعد الحداثة، النسبوي الغربي العائد الى فكرة تكريس الخصوصيات المحلية، والأصولي الديني الرافض للاعتراف بعالمية قيم الحداثة، ما يضعه في لقاء موضوعي مع النسبوي الغربي.
الدرجة الثانية من بنية العظم الفكرية هي ألا تناقض بين القيم المؤسسة المذكورة والتركيز على الخيارات الحرة في الأنظمة السياسية والاجتماعية، ما كفل له تأييد الليبراليين من جهة وعداء اليساريين المتزمتين من جهة ثانية. لكن هذين التأييد والعداء لم يخرجا من سياق اعرض أسس العظم عليه بنايته الفكرية، قيم الحداثة العالمية الشاملة التي لم تظهر دفعة واحدة ولا احتلت موقعها الحالي بيسر بل بصراعات لم تخل من دموية وعنف.
في الكراس المذكور يمضي مفكرنا الى الدفاع عن الإسلام النهضوي الإصلاحي في مقابل رد الفعل العنيف الذي تأسس مع ظهور جماعة الإخوان المسلمين، بعد أربع سنوات من إلغاء مصطفى كمال الخلافة الإسلامية. ويقول في فقرة بديعة، تجسد قدرته على التكثيف الواضح: «ان كل من يستمد تلقينه من حركة الإصلاح العظيمة هذه ويعتبر نفسه سليلاً ووريثاً لإنجازاتها الفكرية والاجتماعية والدينية لن يجد اي صعوبة أبداً في الإجابة عن اسئلة من قبيل: هل يتفق الإسلام مع النزعة الإنسانية العلمانية، او هل الإسلام والحداثة في انسجام؟ فجوابه سيكون بالإيجاب من دون تردد او إشكال… [و] كل من يستمد معاييره حالياً من حركة مناهضة الإصلاح هذه ويعتبر نفسه سليلاً ووريثاً فكرياً [لهذه الحركة المناهضة] لن يجد صعوبة كبرى في الإجابة عن اسئلة من قبيل: هل يتفق الإسلام والعلمانية؟ الخ. فجوابه سيكون بالنفي البات القاطع بأنهما لا يتفقان». ويتابع «ان الإجابة الدقيقة عن سؤال «هل يتوافق الإسلام مع النزعة الإنسانية العلمانية ومكوناتها؟»، هو القول ان الاثنين متناشزان (غير متفقين) اذا نظرنا اليهما من وجهة المعتقد الجامد، وأنهما متسقان اذا نظرنا اليهما من الوجهة التاريخية».
بكلمات ثانية، تظهر مشكلة الإسلام مع الإنسانية العلمانية عند إخراجه، على ايدي قوى سياسية، من تاريخيته، بمعنى توافقه مع المعطى التاريخي للمسلمين في كل عصر بعينه ومحاولة زجه في قالب جامد من المعتقدات والطقوس.
الدرجة الثالثة في سلم صادق العظم الفكري هو النقد كأداة إعادة تشكيل دائم للوعي ومتطلباته كضرورة لا غنى عنها عند اي بحث في شأن فكري او سياسي. لذلك، بدا قاسياً في رفضه طروحات جورج لوكاتش ولوي إلتوسير (في كتابه «دفاعاً عن المادية والتاريخ») وهما ممن يصنفون من رموز الماركسية الجديدة، لرؤيته ان مناهجمها لا تقدم اضافة حقيقية في معرفة الواقع بل تقيم، كما في حالة إلتوسير خصوصاً، سداً منيعاً بين المعرفة والواقع بحيث يستقل الواقع وآلياته عن المدرك الفكري المتصور وتستقل قوانين كل منهما، ما يعيد انشاء المثاليات المعرفية الديكارتية والكانطية من دون حلولها.
عند مفكر اشتغل طويلاً، منذ «النقد الذاتي بعد الهزيمة» مروراً بكتيبه «عن الحب والحب العذري» في دحض الخرافات والتبريرات الذرائعة، واستغلالها في تأبيد الصنوف المختلفة من السيطرة الإيديولوجية والسياسية، مثل صادق جلال العظم، يصعب قبول تماسك إلتوسير اللفظي كبديل عن تهربه من حل التناقضات التي اوصل نفسه اليها.
نرى هنا كيف تضيق قمة هذه البنية، من التأسيس العريض على القيم الإنسانية العالمية، إلى الاعتراض على تجارب فكرية، يمينية ويسارية لم ير فيها القدرة الكافية للوقوف امام نقده. لكن العظم، الذي خاض نقاشات ومعارك عدة في حياته الفكرية الغنية، لم يملْ في اي لحظة الى الانغلاق على خياراته. فظل رفيقاً لكل من أراد السير معه في هذه الرحلة. وهو ما يفسر، على ما يبدو، قدرته على ايجاد الأرضية الحوارية المشتركة مع الليبراليين والإسلاميين والعلمانيين والماركسيين. رفيق درب لهؤلاء كلهم الى ان يصل الواحد منهم الى الحدود التي لا يستطيع بعدها ان يتابع السير مع صادق.
ولسنا نكتشف أمراً عظيماً بالقول إن صادق العظم الذي رفض الخرافات القومية في «النقد الذاتي بعد الهزيمة» وتلك الدينية في «نقد الفكر الديني» وصولاً الى الاعتراض على خرافة «الحب العذري» التي تأسست عليها مدراس من الشعر العربي، لم يكن مهادناً في رفضه خرافات اخرى في مجالات الثقافة العربية وممارساتها على ما بيّن في كتابيه «ذهنية التحريم» و»ما بعد ذهنية التحريم»، ناهيك عن قراءته الدقيقة لفلاسفة القرن العشرين الأوروبيين الكبار، ومجادلتهم في ما ذهبوا اليه (مارتن هايدغر وإتيان باليبار ولودفيغ فتغنشتاين وغيرهم)، وهو ما يتطلب قدراً كبيراً من الشجاعة بالنسبة الى كاتب عربي يجد دائماً من يلاحقه باتهامات بالنقص والدونية ناهيك عن الإحاطة الموسوعية بأعمالهم.
ولا بد ان مفكراً على هذا المستوى من الرحابة وتنوع المعرفة وعمقها، سيكون منبوذاً في بلده سورية، تطارده بعض الأصوات الناشزة والمنكرة.
الحياة
مَن يرثي مَن؟/ الياس خوري
في مستشفى صغير مخصص للمرضى الذين دخلوا في طور النهاية، كان اللقاء الأخير بصادق جلال العظم. ذهبنا الروائي والشاعر العراقي الصديق سنان انطون وأنا، في زيارة وداعية إلى صادق في مستشفى «العازر» الذي يقع في شارع برونوير في برلين. لكن زيارتنا خلت من طقوس الوداع. صادق مستلق على سريره في اغفاءته الطويلة التي صارت ملجأه الوحيد من السرطان الذي افترس دماغه، ونحن وقفنا صامتين وعاجزين عن الكلام، أمام رهبة الموت الذي كان ينتظر.
أحسست وأنا استمع إلى وصايا صادق التي روتها لنا زوجته إيمان، أنني أقف إلى جانب موتين، موت المفكر السوري الذي احتلّ مساحة كبيرة من وعي جيلنا، وموت جيلنا الذي يتجسد في حمام الدم السوري الذي لا نهاية له.
مَن يرثي مَن؟ هل يستطيع الأموات رثاء الأموات؟ أليس الرثاء حيلة الأحياء كي يَرِثوا الموتى ؟ من يَرِث اليوم وماذا يَرِث، وركام حلب يغطينا، وأنين المدينة الذبيح يحتلنا.
مات صادق بلا رثاء، لن نلفه بالكلمات التي نفدت، وبالعبارات التي لم يعد تكرارها مجدياً. مات السوري المنفي بصمت وكبرياء. سمعت صمته ورأيت كبرياءه مسجى إلى جانبه في السرير، وأحسست بحاجة إلى دموع لم تعد تأتي لتبلل الحزن بماء الحياة. كلماتنا جفت ودموعنا تلاشت، وصارت كرامتنا تشبه كلاباً ضالة تحاول اللحاق بمهجري سوريا وضحاياها، الذين يمضون إلى موتهم وغربتهم وسط طنين الصمت الذي يغلّف هذا الزمن بضجيج الهمجية.
ورغم الصمت فإن ذاكرتنا تأبى ألاّ تتذكر. أرى صادق في حرم «الجامعة الأمريكية» بعيني الفتى الذي كنته. خرجنا من محاضرة ألقاها في «الأسمبلي هول» عن الفلسفة اليونانية، فتبعته إلى الخارج وكنت أحمل في يدي كتابه «النقد الذاتي بعد الهزيمة». التفت نحوي وأخرج قلمه من جيب سترته معتقداً أنني أريد توقيعه على الكتاب، لكن بدلاً من أن اقدم له الكتاب كي يوقّعه، سألته «والآن ماذا علينا أن نفعل»؟ نظر إلي هذا الدمشقي كأنه لم يفهم قصدي. فكررتُ سؤالي، قلتُ ان علينا أن نبدأ من جديد وسألته ماذا يقترح. لا أذكر جوابه بالضبط، هل قال ان هذه مسؤوليتكم؟ أم قال انه لا يدري؟
لكنه كان يعرف في قرارة نفسه أن الفدائيين وحدهم يستطيعون تقديم بداية الجواب. صادق صار مقرّباً من الجبهة الديمقراطية التي أسسها نايف حواتمة بعد انشقاقه عن الجبهة الشعبية، ونحن ذهبنا إلى فتح. والتقيت به مرة ثانية في مركز الأبحاث الفلسطيني، بعد انضمامي إلى أسرة المركز، حيث كان العظم يعمل كأحد كبار الباحثين.
في أثناء عمله في المركز كتب العظم «نقد فكر المقاومة الفلسطينية». أتت عاصفة هذا الكتاب بعد زوبعة كتاب «نقد الفكر الديني»، حيث واجه «الدمشقي الكافر» الملاحقة القضائية والسجن في بيروت. أذكر يوم اتصلت بنا سكرتيرة مدير المركز أنيس صايغ ودعتنا إلى اجتماع عام للباحثين في القاعة العامة. وهناك فوجئنا بوجود صلاح خلف (ابو اياد)، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واحد كبار قادتها، وهو يقدم مرافعة دفاعية عن فتح في وجه النقد العنيف الذي كتبه صادق. كان صادق جالساً معنا يستمع إلى احدى أغرب المرافعات التي كشفت التركيبة الفكرية التي جعلت من فتح جبهة وطنية تستقبل جميع التيارات الايديولوجية في بوتقة الكفاح المسلح.
ابو اياد في مرافعته شرح لصادق كيف يفهم هو معنى الكلمات، مبرراً تناقضات الخطاب الفتحاوي، التي صرف العظم جهداً كبيراً في تحليلها، بالتكتيك ومستشهداً بلغة البدو التي تقول، حسب زعمه، عكس ما تُضمر.
لا أذكر كيف سارت المناظرة بين الرجلين، لكن نتيجتها المباشرة كانت سحب توقيع صادق عن تقريره الشهري عن القضية الفلسطينية دولياً، الذي كان يُنشر في مجلة «شؤون فلسطينية»، ثم انقطاعه عن العمل في المركز بعد ذلك بفترة قصيرة.
في الحكايتين، دلالة على علاقة الكتابة بالممارسة الاجتماعية والسياسية، وعن فرض الغُربة على المثقفين المجددين عبر أدوات القمع والاستبداد، التي حصدنا نتيجتها التباساً كبيرًا يكاد يقضي على الثورة السورية، ويدمر تضحيات هائلة قدمها الشعب السوري في بحثه عن حريته وكرامته.
تابع صادق بحوثه الفكرية والثقافية الصاخبة، كان يسعى إلى السجال العلني مع أقرانه من المثقفين، مؤكداً دائماً موقعه النقدي، وبحثه الدائم، الذي أوقعه في خلافات حادة مع أصدقائه، صارت اليوم جزءاً من ماضٍ نتذكر ترفه الفكري بحنين.
هل عبّرت الثورات العربية المجهضة، بشكل جزئي، على الأقل، عن قصور ثقافة مرحلة النقد الذاتي، في بحثها عن حرية الفكر وحرية الانسان؟ أم أن الثقافة نفسها كانت ضحية الاستبداد، وتحولت صرخة استغاثاتها في السجون والمنافي إلى نداء من أجل كسر جدار الخوف؟
أسئلة مؤجلة إلى أن يأتي أوان الرثاء، ففي لحظة عجزنا عن رثاء زمننا الغارب، نكتفي بالتقاط مَحَار الحزن من قلب المأساة، ونتذكر مع صادق العظم فضيلتي الشجاعة والتماهي.
شجاعة الدمشقي المنفي الذي أبلغ المحيطين به بعد فشل جراحة الدماغ التي أجريت له بأنه يرفض أن يعيش اصطناعياً، مطالباً بحقه في الموت.
أما التماهي ففي الوصية التي أبدى فيها رغبته الأخيرة بأن يُلقى رماده في بحر بيروت علّه يجد طريقاً للوصول إلى سوريا.
مثلما تاه المهجّرون السوريون في البحر، وها هم يبحثون عن طريقة للعودة إلى أرضهم المحترقة، قرر الدمشقي الشجاع أن يترك لرماده أن يتيه قبل أن يصل إلى أرض بلاده المغتسلة بدماء الضحايا.
أراد صادق جلال العظم أن يمضي محمولاً على شعر المنفى، فكانت قصيدة محمود درويش «لاعب النرد» التي ألقيت في حفل الوداع في برلين، رفيقه في رحلته الأخيرة.
تحية إلى صادق جلال العظم.
القدس العربي
قمر العظم إذ ينطفئ بعيداً من ياسمين دمشق/ موسى برهومة
ستفتقد الليالي الظلماء المديدة بدرَها المنير الذي انطفأ في منفاه الألماني بعيداً من ياسمين دمشق، فمَن غير صادق جلال العظم يُفتقد في هذا الحريق الذي التهم، أو يكاد، المعاني والمباني والأفكار، فضلاً عن أسئلة الوجود والحرية والأخلاق؟
وإذ يرحل صاحب «نقد الفكر الديني»، فإنّ ميراثه لا يرحل ولا يغيب، لا سيما وأنه قدّم أكثر الصور سطوعاً عن التحام المثقف بخطابه في مختلف التحوّلات والمنعرجات، من دون ارتجافة أو تنازل، وهو ما بوّأ العظم موقعاً سامياً في مصاف المثقفين الذين لا يخذلون شعبهم، ولا يخونون حبرهم في اللحظات المفصلية القاسية.
وإن كان الشيء لا يعرف إلا بضده، فإنّ تساقط المثقفين العرب، وبعض السوريين خصوصاً، أمام المقتلة السورية المفتوحة، وتواطؤهم مع الجزّار، ونقدهم الناعم له، ورجاءهم المتقطع الأنفاس أن يترفق بالضحايا، فلا يجزّ أعناقهم بشدة من الوريد إلى الوريد، جعل من صادق العظم نموذجاً للمثقف الذي يقول للطاغية «لا» كبيرة، ولا يكتفي بذلك، بل يذهب إلى مصارعته في ساحات الفكر والسياسة، فيصيب فكرته بالكساح، ويكشف عطالة الاستبداد، وتوحش النظام الأبوي الطائفي الأقلّوي الذي جعل سورية مزرعة للفاسدين وتجار السلاح والشعارات، وسجناً مفتوحاً لاقتلاع الكرامة والحياة.
ويصحّ أن نقول إن صادق جلال العظم صدّع السلطة قولاً وممارسة، وأزال الأقنعة عمن يخاطبون الديكتاتور المبلّل بدماء الأطفال بـ «السيد الرئيس»، فالعظم لم يشأ أن يمسك العصا من المنتصف كما فعل أصحاب الذهنيات الانتهازية، بل مضى إلى أقصى مدى في الامتثال لسؤال الحرية الذي لا يقبل المهادنة، فلون الدم أحمر، وصواريخ سكود دكّت مدينة حلب وقلعتها، وليس تل أبيب، والبراميل المتفجّرة سقطت فوق المباني السكنية التي يقطنها الآمنون، وأما الإرهاب فإنّ زارعه هو «السيد الرئيس» الذي جعل كل ثابت متحولاً وسائلاً ودامياً ومفتّتاً وهائماً على وجه الخراب وأدخنة الجثث!
وإنْ وُصف العظم بالتطرف، فإنّ أجمل ما فيه تطرفه الذي معناه الإخلاص للفكرة والولاء للموقف وعدم التفريط بالكليات التي تاجها الحرية. وقد فعل ذلك في الثقافة قبل أن يمدّ حرائقه النقدية إلى السياسة، فيلتهم التهافت، ويتقدّم الصفوف منافحاً عن سؤال الحقيقة وهي ترجّ روح الكائن. لهذا راح يوغل نصله في جراح هزيمة حزيران (يونيو) 1967، وسمّاها «هزيمة» وليس «نكسة»، وفكّك أسبابها، وخلّص نتائجها من الميتافيزيقا، وردّها إلى التخلّف والخرافة وانعدام الاستقلال، وغياب الحرية وهيمنة السلطة الأبويّة.
وفي مجمل كتبه، ظل العظم وفيّاً حتى العظم، لمنطلقاته الفكرية وشجاعته في تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية من دون تورية أو مراوغة، وقد تبدى ذلك في موقفه من الاستشراق ودفاعه عن سلمان رشدي، ونقده التصوّرات الغيبية عن الكون، ودعوته إلى فصل الأفكار الدينية عن المسائل العلمية والفلسفية، وإزالة القداسة عن كل ما هو مُعطى للبشر.
ففي كتابه «دفاعاً عن المادية والتاريخ»، يعاين العظم بروحه النقدية التحليلية الصارمة ما يسميه «رواج نظريات عودة الإسلام وما يشبهها، وكأنّ الإسلام روح هيغلي يمتد وينتشر ثم يعود فينسحب ويتقلص»، كاشفاً في هذا السياق عن الفهم الاختزالي الماهوي الغربي لحياة الإسلام، الذي «يتطابق تطابقاً كلياً مع المقولات التي تطرحها الحركات الأصولية الراهنة عن الإسلام وطبيعته، ومع المفهومات النظرية التي تستخدمها هذه الحركات في تفسيرها الإسلام التاريخي والحالي والمستقبلي».
وحتى عندما كتب «في الحب والحب العذري» لم يفقد العظم جموحه التحليلي وأدواته النقدية، فنظر إلى الحب باعتباره «عاطفة تقوم أساسًا على التناقض والمفارقة»، وحلّل «الشخصية الدونجوانية» بصفتها «محاولة مستمرة للبقاء بالحبِّ في مستوى العشق العنيف والانفعال الحاد» من دون أن يسقط في فخاخ الأحكام المعيارية.
وفي مختلف نظراته وتأملاته وتحليلاته، ظل العظم قابضاً على جمر رؤيته النقدية، ولم يتخلّ عن هذه الروح حينما اندلعت الثورة السورية، بل انخرط في أتون المحتجين الذين دشّنوا ثلاث صيحات مدوية «لا تجديد، لا تمديد، لا توريث» فضلاً عن انفصالهم عن التقاليد العربية الرائجة التي تتعلق بشخصية كاريزمية واحدة قريبة من الإله، فمن محاسن هذه الثورة، كما رآها العظم، أنها حطّمت أوثان الزعيم الأوحد، والقائد الملهم، والحزب الواحد، والرأي الواحد.
* كاتب وأكاديمي أردني
الحياة
حينما عَلِق سعيد في “أناه”.. واعتصم العظم بالرُّقي النقدي/ روجيه عوطة
في الرسائل المتبادلة بين إدوارد سعيد وصادق جلال العظم في العام 1980، إثر إستلام الأول، وبوصفه رئيس تحرير مجلة “الدراسات العربية”، لمقالة الثاني عن كتابه “الإستشراق”، نوع من التشنج بين المثقفَين، وهو تشنج ينم عن إرتطام المنقود بناقده، وتأرجحه في التعامل معه بين تأديبه بالتجبر، الذي يكاد يفقد عقاله، والقبول به على مضضٍ، من السهل تعقبه في إثر بيانه. أما الناقد، فينطلق من كونه لم يتوقع رد فعل منقوده، جامعاً بين الأسف عليه وتصويب كلامه، بالإضافة إلى التصدي له بالشرح والإصرار، قبل التشبث بنصِ نقده، وشبه إعلانه بأن المس به بمثابة تجاوز لـ”خط أحمر”.
تبدأ رسالة سعيد الأولى إلى العظم بشكره المقرون باعتباره أن التحليل في مقالة “الإستشراق والإستشراق معكوساً” مشغول “بعناية فائقة”، و”يقدم وثيقة مقنعة ومثيرة للإعجاب”. وهذا، ما يتبعه باقتراح نشرها بعد تعديل طولها. لكن، وفجأةً، تنقلب نبرة سعيد، ومن دون مقدمات، من ناشر دمث إلى منقود مضطرب من جراء تعرضه لـ”المراجعة”. ولكي، يبعد التهديد عنه، يلجأ إلى أناه المتكبّرة، وإلى لغتها، التي ينزل فيها على سبيل التطبع بالتواضع. فقد “تلقى العديد من المراجعات” بخصوص كتابه، إلا أنه لم يولِ اهتمامه لأي منها، وها هو، حين يرد على “مراجعة العظم”، يقدم على “فعل غير مسبوق”، لا سيما أنه “صديق معجب” بناقده و”محب” له. سرعان ما يتحول هذا “التصادق الإعجابي” إلى تنابذ هجائي، تخلله إتهامات، غايتها التقريع، وغطاؤها “التعليم”. فسعيد يريد أن يلقن العظم درساً، ولهذا، لا يتردد في تصويره، وعلى أساس مقارنته بشخصه كمهاجم “أصحاب الحجة الهزيلة”، وكقارئ سيء، ومُفسِّر ضال، ودوغمائي وحَرفي، ومُفكّر الخواء والهراء، ومن عَبَدة ماركس، الذي يشبه، بالنسبة إليه، الخميني، والمأخوذ بالسلوك الفضائحي للـ”الصحافة اللبنانية”، و”خادم طوعي وصامت للنظام السوري” الذي “يوظفك حالياً ويطلب” سكوته، والمصاب بـ”متلازمة إخصاء الذات” أيضاً.
وبعد هذا الكم من عبارات التوبيخ والتشهير، يعود سعيد من كاتب خالص إلى ناشر وكاتب، ولا وقت له للرد على ناقده بسبب “غرقه” في شؤونه الأخرى. ومع ذلك، “يتطلع بشغف إلى الرد عليه تفصيلاً”. فما سبق كان مجرد “تثقيف” عاجل، وليس نقداً للنقد. وبالتالي، سعيد “الأناركي”، بحسب تعريفه لنفسه، وبكل تكتيك لا خلق فيه، بل اختلاق للتواضع المسكون بتقذيع غيره، يفتح نزاعاً مع العظم، وبالفعل نفسه، يخبره أن النزاع لم يبدأ بَعد، متهرباً من أي “هجوم معاكس” عليه.
على ان العظم لم يهجم على سعيد، بل قال له بما معناه: “اعرف ان مقالتي مزعجة، لكنني لم أتوقع انفجارك العنيف”، ويكمل ان “جرائمه”، أي نقده، لا تستحق كل هذه الحدة. ثم ان العظم ينبه سعيد الى مقارنته الأنانية، والى رغبته في إثبات تفوقه. وذلك، قبل ان يرجع الى صلب الفعل والرد عليه، اي الى الكتاب، داعياً مراسله الى الابتعاد عن أخذ “النقاش” الى التجريح الشخصي، ولاحقاً، يؤكد العظم على كونه يبغي نشر مقالته كاملةً، وبلا اي تعديل وإلا فليجرب إعادتها اليه.
على هذا المنوال، بقي الناقد على تهذيبه، وحدد نزاعه في إطار نصي محض، وطبعاً، لم يتحير في وصف سعيد، وبطريقة غير مباشرة، بانه “أستاذ متعكر المزاج”. لم ينزلق العظم الى اضطراب هذا “الاستاذ”، وحافظ على اتزانه وتوازنه. غير ان سعيد رد مرة اخرى، وبذلك، استمر عالقاً في اضطرابه قائلاً لناقده: “انا لم أمس شخصك وكل ما قلته عنك انك خانع للنظام السوري”، وفِي الوقت عينه، عاود تقريع العظم، ووصفه بـ”الناقد الهادئ والأولمبي لأخطاء الآخرين”، وهذا، قبل ان يتمسك بتفوقه، ويكرر مقارنة نفسه بناقده ومجادليه. وهكذا تدور رسالته من التهرب الى المواظبة على التقريع والتراجع عنه والتشبث بالعنجهية، وصولاً الى تصوير ذاته كموضوع “مؤامرة” نقدية. وفِي نهاية رسالته، يبلغ سعيد خلاصته: “عندما اكتب… أكون في حالة معينة وأكتب لجمهور عمومي وليس لشخص”، اي ليس لناقده، كأنه يقول للعظم: “انت في الأساس ما علاقتك بكتابي؟ لماذا تتطفل عليه؟”.
على طول هذه الرسائل، يظهر ان سعيد لا يدرك كيف يهاجم العظم فيخرجه عن هدوئه، بل انه، وفِي اثر هدوء الناقد، يزداد اضطراباً، ويمضي فيه اكثر، لدرجة انه لا يعود يميز بين كونه في نزاع ام لا، ولا يعود قادراً على الاختيار بين خوض النزاع ضد ناقده او انكاره. وكل هذا، في حين يبقي العظم ثابتاً في حدود نقده للكتاب. فالرسائل المتبادلة بين الاثنين، تشير الى ان الاول، اي سعيد، رأى في نقده استهدافاً لأناه، كأنها محرك كتابته. والثاني، اي العظم، ظل على اعتقاده بفصل الكتاب عن “أنا” كاتبه. وفِي كل الأحوال، مراسلات سعيد – العظم موضوع قراءة قريبة من التسلية أولاً، ومن الوقوف على شخوصهما ثانياً. وذلك، اكثر من كونها موضوعاً طارئاً. فهي علامة من علامات دوران النقد، بصيغته الأولية، في زمن طُويت صفحاته الى غير رجعة.
المدن
صادق جلال العظم في عمّان/ هاني حوراني
كنت في السنة الثالثة من دراستي في الجامعة الأردنية، حين تعرّفت على صادق جلال العظم الذي انضم للهيئة التدريسية في الجامعة، خلال العام الدراسي 1968/ 1969. وكنت قد قرأت له كتابه الشهير “النقد الذاتي بعد الهزيمة”، وتأثرت بمنهجه العقلاني، ونزعته النقدية الصارمة. وكنت، من حين إلى آخر، قد تابعت بعض مقالاته في مجلة “دراسات عربية”، بما فيها التي جُمعت في كتابه “النقد الذاتي بعد الهزيمة”.
كان قد فُصل من الجامعة الأميركية في بيروت، وجاء تعيينه مدرّساً للفلسفة في كلية الآداب في الجامعة الأردنية ضرباً من المفاجأة لي ولغيري ممن اطّلعوا على كتاباته. وقد سمح المناخ السياسي الذي كان سائداً في الأردن والعالم العربي بخطوة إدارة الجامعة الأردنية التي كانت تتسم بقدرٍ من النزعة المحافظة، فقد كنا في زمن ما بعد حرب 1967 والهزيمة المدوية للجيوش العربية وصعود موجة المقاومة الفلسطينية المسلحة التي بدأت للتو الوجود بكثافة في الأراضي الأردنية. وفي خلفية ذلك الصعود الفلسطيني، كان العالم يعيش تحت تأثير الهزائم الأميركية في فيتنام، وتنامي حركات الاحتجاج الشبابية والطلابية في أوروبا والولايات المتحدة. وبالقدر نفسه، كانت حركات التحرّر الوطني في أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا حاضرةً بقوة في المشهد العالمي، وغنيّ عن البيان أن الصبغة العامة لتلك الحركات كانت يسارية عموماً.
ما كان انتقال صادق العظم للتدريس في الجامعة الأردنية ليتم لولا تدخل أحمد طوقان (الوزير في حكومات أردنية سابقة، والشقيق الأكبر لشاعري فلسطين إبراهيم طوقان وفدوى طوقان) والد زوجته فوز، وكان حينها نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية والدفاع. ولكن نفوذ أحمد طوقان لم يكن ليحول دون تجديد عقد صادق العظم سنة دراسية أخرى، إذ حالت الأجهزة الأمنية دون ذلك.
كان لقائي الأول بالعظم على غداء، بدعوة من نايف حواتمة الذي كان قد عاد إلى عمّان، بعيد تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكان حينها يتزعم ما وصف بالجناح اليساري في الجبهة العتيدة. ومع قرابتنا السياسية، فإني لا أذكر أنني التقيت حواتمة في جلساتٍ ذات طابع اجتماعي، إلا بعد سنواتٍ طويلة في نهاية الثمانينيات في دمشق. كان أبو النوف مهتماً بالتعرّف على المناخ الثقافي في عمّان، وعلى رموز الثقافة اليسارية، ولا بد أنه كان قلقاً من جفاف عمّان الثقافي، مقارنةً بمدينة بيروت، حيث كان يقيم سنوات طويلة.
خلال العام الوحيد الذي قضاه صادق العظم في عمّان، كنت ألتقي به، وأنا الطالب والناشط السياسي، بصورةٍ تكاد تكون يومية، إن لم يكن في الجامعة، ففي جلسات خاصةٍ في منزل أهلي، أو في مرسمي، أو في “الأسد الأحمر”، وهو نادٍ ليلي.
كنت عام 68/ 1969 أقود تنظيماً طلابياً فريداً في تكوينه وبنيته التنظيمية، هو “جبهة العمل الطلابي”. ولأسبابٍ تتعلق بالتنافس السياسي على تمثيل طلبة الأردن، فقد اقترن بهذا الاسم اسم آخر هو “الاتحاد الوطني لطلبة الأردن”، والذي عاش عقوداً، من خلال تنظيماته خارج
“كان صادق العظم يحظى بتقدير تيار واسع من الطلبة الذين احترموا تواضعه ودماثته وتعامله النديّ معهم” الأردن، وكان محسوباً على الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. قبل ذلك، كانت “جبهة العمل الطلابي” أقرب ما تكون إلى تنظيم سياسي للطلبة، أو هي بمثابة “حزب سياسي طلابي”، فقد كانت ترفع شعاراتٍ خاصة بها من نوع ربط الجامعات، والتعليم عموماً، بالعملية الإنتاجية، وبمراجعة دور الجامعات التقليدي القائم على تزويد الأجهزة البيروقراطية بالكوادر، وتدعو الجامعات إلى الإسهام في تحويل الاقتصاد الأردني عن دوره الخدماتي، ليكون إنتاجياً متنوعاً. حينها، أسهم صادق العظم في توجيه انتباهي نحو أهمية لعب جبهة النضال الطلابي دوراً مباشراً في الدفاع عن مصالح الطلبة اليومية والمعيشية، وأن نكون صوتهم في رفع المطالب إلى إدارة الجامعات، وبالتالي، عدم الاكتفاء بترديد الشعارات الاستراتيجية والتثقيف السياسي.
وأزعم أن صادق العظم كان وراء زرع فكرة تحول “جبهة النضال الطلابي” إلى “اتحاد طلابي” أو “نقابة طلابية” في أذهان قيادة ذلك التنظيم، وأنا منها. وأذكر أننا خضنا حينها عدة معارك مطلبية، منها تخفيض أسعار الوجبات في كافتيريا الجامعة، وخفض الرسوم الجامعية. وفي العام الجامعي التالي 1969/1970 احتل الاسم الثاني للتنظيم الطلابي “الاتحاد الوطني لطلبة الأردن” محل اسمه الرومانسي الأول، والذي كان يميز نفسه بشعار مرسوم يجمع بين البندقية والقلم، وهما في وضعية متقاطعة، وبينهما كتابٌ مفتوح خلفه أشعة الشمس.
إلى جانب عملي الطلابي، كنت قد انضممت إلى منى السعودي، النحّاتة الأردنية التي كانت تقيم في باريس، وعادت بعيد حرب 1967 إلى الأردن، لتنفذ مشروعاً فنياً يشجع أطفال مخيم النازحين في البقعة على رسم معاناتهم ومشاهداتهم عن الحرب والنزوح والعيش في الخيام. كنت حينها أتردّد دورياً على المخيم الذي كان فيه حضور مؤثر للجبهة الشعبية. كان قد أقيم قبل نحو العام، ويعتمد أساساً على الخيام المنصوبة لإيواء العائلات النازحة من الضفة الغربية إبّان حرب 1967، وكان يفتقر إلى الحد الأدنى من البنية التحتية. وهكذا، كان علينا أن ننفذ مشروع جمع رسوم أطفال البقعة في ظروفٍ غايةٍ في الصعوبة، خصوصاً في أشهر الشتاء، حين كانت الخيام والطرق المحيطة بها تغرق في الطين.
كان علينا أن نلجأ إلى مدارس وكالة الغوث في المخيم التي كانت أيضاً خيماً وبركسات بدائية. كما لجأنا إلى عبدالله حمودة، وهو صديق ورفيق سابق في حركة القوميين العرب، كان يزاول دوره القيادي في الجبهة الشعبية من مقرّه في مخيم البقعة. وفّر لنا حمودة الدعم السياسي واللوجستي، لتنفيذ مشروع فني- سياسي ريادي، ما كان ليتحقق بدونه. وهكذا كنا نجمع رسوم الأطفال يوماً بعد يوم، ونحفظها في مرسمي في جبل عمان، لنقوم بعد ذلك بتصنيفها وتقييمها واختيار الأفضل بينها لغايات العرض والنشر.
لعب صادق العظم، الذي تعرّف على منى السعودي وعبدالله حمودة في مرسمي، دوراً مهماً في تعريف الرأي العام العربي برسوم أطفال مخيم البقعة للنازحين الفلسطينيين، بكتابة مقالة
“لم تكن جامعات الأردن جاهزةً لاستضافة مفكّر حر بقامة صادق جلال العظم، وهو الذي ضاقت به الجامعة الأميركية في بيروت يوماً” تعريفية عن المشروع، والقائمين عليه، وأبرز الموضوعات والاهتمامات التي تناولها الأطفال في رسومهم. ونشرت المقالة في الصحف اللبنانية الرئيسية. وأكثر من ذلك، تبرّع على نفقته بطباعة مطويةٍ ملونةٍ للمعرض الأول لرسوم أطفال البقعة، والذي أقيم في بركسات الوكالة في المخيم. واحتوى البروشور على مقالة صادق جلال العظم عن المشروع، والتي ظلت المادة الرئيسية للتعريف برسوم أطفال البقعة، إلى أن انتقلت منى السعودي إلى بيروت، ونشرت حينها كتاباً ضم نماذج من تلك الرسوم، من دون إشارةٍ إلى جهود صادق العظم أو الفريق الذي دعم تنفيذ المشروع ميدانياً.
لا أعرف الكثير عن تأثير صادق العظم على طلبة الفلسفة في سنته الوحيدة مدرّساً في الجامعة الأردنية، فقد كنت، حينذاك، طالباً في كلية العلوم السياسية والإدارة العامة. لكن كانت له مساهمات في المجال العام داخل الجامعة وخارجها. لعل أبرز مساهماته في المجال الجامعي العام المناظرة الحوارية التي رعتها جمعية طلبة العلوم السياسية، وضمت محمد صقر، وهو أحد أقطاب جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، وكان أستاذاً للاقتصاد في الجامعة، والأكاديمي اليساري المصري وأستاذ علم النفس في الجامعة، حنا عزيز. وكانت المناظرة بمثابة “مصيدة مدبّرة”، من تنظيمنا الطلابي يساري الهوى، للدكتور صقر والتيار الذي كان يمثله. وقد انتهت لصالح العظم وعزيز، حيث كان الجمهور، في أغلبه مشبعاً بالأفكار المؤيدة للمقاومة والتيارات اليسارية والقومية. وبقدر ما كان صادق العظم يحظى بتقدير تيار واسع من الطلبة الذين احترموا تواضعه، ودماثته وتعامله النديّ معهم، فإن تياراً آخر من الطلبة والأكاديميين المحافظين أخذوا منه موقف العداء، ولم يفهموا أبداً نزعته المنفتحة على طلبته، ولا نمطه الحياتي، وبالتأكيد أفكاره ومسلكه الليبرالي.
غادر صادق العظم الجامعة الأردنية في نهاية العام الدراسي، ثم عكف على الانتهاء من تحرير كتابه الأشهر “نقد الفكر الديني”، ودفع به للنشر لدى دار الطليعة، ولم يلبث أن تعرّض، هو وناشر الكتاب بشير الداعوق، للملاحقة القضائية بفعل دعوى رُفعت ضده، بتهمة الإساءة للدين الإسلامي. وبعد اختفاءٍ قصير خارج لبنان، بمساعدة أحد فصائل المقاومة، عاد إلى بيروت ليرأس تحرير مجلة “دراسات عربية” عامي 1969/ 1970. كما عمل باحثاً في مركز الأبحاث الفلسطيني، ومحرّراً للشؤون الدولية في مجلة “شؤون فلسطينية” الصادرة عن المركز نفسه.
زار صادق العظم عمّان عدة أيام عشية انفجار اشتباكات أيلول/سبتمبر 1970 الدامية، لحضور اجتماع طارئ للمجلس الوطني الفلسطيني، عُقد بمشاركة طائفةٍ واسعةٍ من السياسيين العرب المؤيدين لحركة المقاومة الفلسطينية. ولا أعرف إن كان زار عمّان في العقود الثلاثة التالية، لكن المؤكد أنه في عامه الوحيد في الجامعة الأردنية ترك بصماتٍ قويةً على كل من عرفه، أو تتلمذ على يديه مباشرة. لم تكن جامعات الأردن حينذاك (وربما في أي وقت) جاهزةً لاستضافة مفكّر حر بقامة صادق جلال العظم، وهو الذي ضاقت به الجامعة الأميركية في بيروت يوماً.
العربي الجديد
“الدمشقي الكافر”/ محمود الزيباوي
رحل صادق جلال العظم عن هذه الدنيا تاركاً مجموعة من المؤلفات، أشهرها “نقد الفكر الديني” الذي أوصله إلى المحاكمة والقضاء في لبنان. صنع هذا الكتاب من صاحبه أسطورة في نهاية الستينات، وجعل منه رمزاً حياً للتمرّد والعصيان والثورة، وقيل يومها: “بعد الآن سيُقال في تاريخ الفكر العربي: قَبْل صادق العظم وبَعده”.
صدر “نقد الفكر الديني” عن دار الطليعة في بيروت في خريف 1969، وجاء على شمل بحث يتألّف من ستة أبواب: “الثقافة العلمية وبؤس الفكر الديني”، “مأساة إبليس”، “ردّ على النقد”، “معجزة ظهور العذراء وتصفية آثار العدوان”، “التزييف في الفكر المسيحي الغربي المعاصر”، “مدخل إلى التصور العلمي ــ المادي للكون وتطوره”. تميّز الكتاب بجرأته في “التصدي الصريح للبنى الفكرية، وللأيدولوجية الغيبية السائدة في مجتمعنا”، كما جاء على الغلاف الخلفي. تبنّى “ملحق النهار” بحماسة بالغة هذا البحث فور صدوره في مطلع شهر كانون الأول-ديسمبر، وأفرد غلافه لصورة المؤلف بريشة بيار صادق، مرفقة بعنوان عريض اقتصر على كلمتين: “الدمشقي الكافر”.
نشر “الملحق” مقالتين طويلتين من توقيع عبد الكريم أبو النصر وناصيف نصار، وأشعل معركة نقدية استمرّت على أسابيع، تتالت خلالها الردود على الكتاب كما على المقالات التي تناولته، سلباً وإيجاباً. هلّل عبد الكريم أبو النصر في مقاله التعريفي بالكتاب وبمؤلفه، وحملت مقالته عنواناً مثيراً: “خارج على عائلته المسلمة الأرستقراطية وواحد من العصاة الشياطين الحقيقيين”. استهل الصحافي مقالته بقول الأديب الفرنسي أندريه جيد: “لن ينقذ العالم، إذا أمكن انقاذه، الا العُصاة. من دون العُصاة، لقُضي على حضارتنا وثقافتنا، وما نحب، وما يعطي وجودنا على الأرض تبريراً سرياً. هؤلاء العُصاة ملح الأرض”. ووصف صادق العظم بـ”الشيطان العاصي”، ونقل عنه قوله في المسألة الدينية: “أنا لا أقصد الدين باعتباره ظاهرة روحية نقية وخالصة، على نحو ما نجدها في حياة قلة ضئيلة من الناس، كالقديسين والمتصوفين وبعض الفلاسفة. ان الدين الذي أعنيه في بحثي هو قوة هائلة تدخل في صميم حياتنا وتؤثر في جوهر بنياننا الفكري والنفسي وتحدّد طرق تفكيرنا وردود فعلنا نحو العالم الذي نعيش فيه، وتشكّل جزءاً لا يتجزّأ من سلوكنا وعاداتنا التي نشأنا عليها. لذلك سننظر إلى الدين باعتباره مجموعة من المعتقدات والتشريعات والشعائر والطقوس والمؤسسات التي تحيط بحياة الإنسان احاطة شبه تامة”.
استعاد عبد الكريم ابو النصر السؤال الشائع: “هل الخلاف بين الدين والعلم خلاف ظاهري وسطحي، أم ان الإسلام والعلم يقفان على طرفي نقيض؟”. وقال أن “صادق جلال العظم يميل إلى الرأي الثاني”، وأنه يرفض مقولة “الانسجام الكامل بين العلم والإسلام”، كما أنه يرفض “التوفيق الخطابي” السائد في مجتمعنا، و”التوفيق التبريري” الذي تتبناه الدول العربية “التقدمية” كما الدول “الرجعية”. ” تقول الدول العربية التي أعلنت سياسة ثورية تحررية أن الإسلام يتوافق تماما مع شعاراتها السياسية “باعتبار أن الدين الإسلامي هو دائما ثوري وتحرري”. وفي الدول العربية الرجعية والمحاربة لهذه الشعارات، “نجد أن أئمة الإسلام هناك هم من طليعة المبررين لسياسة الدولة الرجعية والمدافعين عن الوضع الاجتماعي المتخلف”. من هذ المنطلق، تبدو “تعاليم الإسلام واسعة فضفاضة بحيث تسمع باستيعاب الاشتراكية العربية، بالإضافة إلى أنظمة مغرقة في الرجعية”. يسخر صادق العظم من هذه المساعي التوفيقية، ويرى أن أتعس هذه المساعي هي “محاولة التوفيق التعسفي”، وتتمثّل هذه المحاولة في “التوفيق بين الإسلام والعلم الحديث باستخراج جميع العلوم الحديثة وتظرياتها ومناهجها من آيات القرآن، ومن ثم الزعم بأن القرآن كان يحتوي منذ البداية على العلم برمته”، كما فعل يوسف مروّة في كتابه “العلوم الطبيعية في القرآن”. أمّا أسخف هذه المحاولات، فتتجلّى في “التوفيق على الطريقة اللبنانية”، “أو ما يُدعى بالحوار الإسلامي المسيحي”، وهذا الحوار بائس وعقيم، وسيبقى “أقرب إلى حوار الطرشان مما هو إلى أي نوع آخر من الحوار المجدي”، “ما لم يصبح المنهج العلمي التاريخي النقدي هو رائدنا في درس الظاهرة الدينية بصورة عامة”.
طرح عبد الكريم أبو النصر في مقالته آراء “ابن العائلة المسلمة الإقطاعية والأرستقراطية الدمشقية” الرافضة للأيديولوجية الدينية، وقال إن صاحب هذه الآراء درس الفكر الأوروبي الليبرالي في القرن الثامن عشر قبل أن يتجه إلى الفكر السياسي، ثم تبنّى الفكر الماركسي والاشتراكي اثناء دراسته في الولايات المتحدة. وهو اليوم يحلّل في أبحاثه “مكان العقلية الدينية الغيبية في الهزيمة وما بعدها”، والسؤال الذي يطرحه: “مسلم النصف الثاني من القرن العشرين أمن الحتم عليه الاعتقاد بالجن والملائكة وهروت وياجوج وماجوج؟”. في المقابل، رأى ناصيف نصار في مقالته أن صادق العظم يشكّل “تكملة للشيخ علي عبد الرزاق في التمييز بين الدين والدولة”. نشر الشيخ القاضي علي عبد الرازق كتابه “الإسلام وأصول الحكم” العام 1925، بعد عامٍ من القضاء رسمياً على مسمى الخلافة العثمانية، وأشعل معركة ثقافية وسياسية ضخمة. كان هذا الكتاب، في رأي نصار، الخطوة الأولى الحاسمة للتمييز بوضوح وجرأة بين الدين والدولة في الإسلام. وبعده يأتي “نقد الفكر الديني”، وهو “خطوة أخرى من الداخل، في اتجاه النقد والرفض”. يستعيد الناقد قول صادق العظم: “لا يعني اني أريد نسخ الشعور الديني في تجارب الإنسان من الوجود، ولكن أرى من الضروري التمييز بين الدين والشعور الديني”، ويشدّد على موقف الكاتب الجريء في الدعوة إلى الفصل بين الدين والدولة، غير أنه ينتقد بلطف تبنّيه للماركسية التي يرى فيها العظم “فلسفة العصر” بحسب تعبير جان بول سارتر، ويستشهد في انتقاده بقول هنري لوفيفر: “ان ما حققه ماركس ضروري، لكنه غير كاف، لفهم هذا العصر”.
في الأسبوع التالي، نشر “الملحق” ردّ صادق جلال العظم على المقالتين، وفيه رأى “الكافر الدمشقي” أن الملحق “تجاهل نصف الحقيقة” عنه، وشدّد على أنه ماركسي يؤمن بالثورة الاشتراكية، وقال: “أساهم في نشر وتعميق النظرية الاشتراكية العلمية، الماركسية اللينينية، وممارستها في محيطنا العربي، لأن الثورة الاشتراكية وحدها ستمكّننا، في التحليل الأخير، من انقاذ أنفسنا وعالمنا في هذه الحقبة التاريخية”. وأضاف: “أهمل الملحق المقدمة التي وضعتها لكتابي لأنها تشرح الإطار الثوري الذي ينبغي أن توضع ضمنه الأبحاث المتضمنة في الكتاب، وتتخطّى الصّعيد الفردي في الرفض والثورة التمردية الذاتية المزاجية في طرح الموضوع”.
رأى صادق العظم أن علي عبد الرازق “كان أولاً وآخراً مصلحاً دينياً أراد إنقاذ النظام الإسلامي عن التجديد والإصلاح الداخلي، وان كانت بعض أطروحاته تنطوي على بعض الإجراءات الجذرية”، وقال إنّ “الإسلام وأصول الحكم” يمثّل “محاولة توفيقية” سعى إليها المؤلف، واستطرد قائلا: “أنا لست مصلحاً دينياً على الإطلاق، ولست من جماعة المتمردين على الأزهر في سبيل أزهر أفضل وأكثر عصرية”. وشدّد على ماركسيته، وقال إنها منهج وليست مذهباً، وهي “تهمة” يتشرّف “بالالتصاق بها وبثورتها، وليس بمجرد تمرّدها وعصيانها”.
تواصل هذا السجال بحدّة. في 21 كانون الأول-ديسمبر، نشر الملحق رداً من مفتي طرابلس، نديم الجسر، ورداً آخر من مفتي جبل لبنان محمد علي الجوزو، إضافة إلى مداخلة أخرى من ناصيف نصار. برز رد الجوزو بحدته، وكان عنوانه العريض: “عوض أن يحرّر الشيوعيون الشعور الديني عند المسلم، فليحرّروا الشعور الماركسي المسحوق تحت عبء المعتقدات المتحجرة”. لام مفتي جبل لبنان ملحق الصحيفة “المسيحية” على تبنيها كتاباً يتهجّم على القرآن، وقال: “إننا نربأ بأية صحيفة اسلامية أن تترك مجالاً للتهجّم على الإنجيل، حتى لو كان التهجّم من قبل مسيحي اعتنق الماركسية. وكان الأجدر أن يكون هذا موقف الجريدة المسيحية بالنسبة إلى القرآن الكريم، حتى لا يُتّهم أصحابها بأنهم خرجوا على مبدأ اللياقة مع المسلمين وأن يتّهموا بأشياء أبعد من ذلك”. وسخر من أطروحة صادق العظم، ورأى أن “ربط هزيمة حزيران بالتراث العربي والعقلية الدينية الغيبية تخريف وافتراء لأن المدرسة الإسلامية العسكرية أخرجت عمالقة في الفتوحات”.
من جهته، أفرد أنسي الحاج صفحته الأسبوعية لصادق جلال العظم، وحيّا محمد النقاش الذي سارع إلى الدفاع عنه “بينما كان التقدميون واليساريون يستترون وراء ألف ستار ويهربون من المجابهة”، كما حيّا كمال جنبلاط الذي “استقبل صادق العظم في مكتبه، في وزارة الداخلية، وأثبت أنه أكبر من الدولة”، ونوّه بالناشر بشير الداعوق الذي ” تبنّى كتاب العظم والتزم بقضيته التزام الأبطال”، وقال: “كان صادق العظم، بعد صدور القرار باعتقاله ومحاكمته، صورة الحقيقة وصورة العدل، وصورة المستقبل. الحقيقة يطاردها الجدل، والعدل يصادرها الإرهاب، والمستقبل يقف كل شيء في طريقه”، “سينسى التاريخ هذا الوجه التاعس من الحكم اللبناني ولن ينسى أحد صادق العظم. بعد الآن سيقال في تاريخ الفكر العربي: قَبل صادق العظم وبعده”. وختم مقالته بالقول: “لا أمل بأي واحد من الأنظمة العربية. اننا نعهد بصادق العظم وبكل صادق عظم من أبناء هذا الجيل العربي الشجاع، العليم، الرافض، الثائر على كل شيء، نعهد بهم إلى الثائرين مثلهم على كل شيء. نعهد بهم إلى الثورة الفلسطينية. ان هؤلاء المفكرين الأحرار الثوار هم رفاق الثورة الفلسطينية، كما هم رفاق كل ثورة، وهم الجهة الروحية لهذه الثورة. فلتكن الثورة الفلسطينية لبنان الأحرار”.
استمرّ مسلسل الردود في الأسابيع التالية. كتب وليد خير الله وسامي حمود رداً بعنوان “الإسلام ليس المسلمين والدمشقي الكافر وقع في التناقض”. وكتبت “جمعية المحافظة على القرآن” رداً من خمس نقاط حمل توقيع أمين سر هذه الجماعة، الحاج محمد كمال طبارة. في الاتجاه المعاكس، ناصر ابراهيم العريس “الدمشقي الكافر”، وقال في مداخلته: “بإمكانكم أن ترسلوا من يغتال صادق العظم، لكنّنا عرفنا كيف تكون طريق المستقبل”. في مطلع العام 1970، قدّم عثمان الصافي، مراجعة لهذا الملف قال فيها “أن المفاجأة في كتاب العظم أنه مارس أسلوب التعرّض المباشر، لكنه كتاب رجعي لو نشر في الغرب لكان موضع سخرية”. ورأى سهيل ديب أن “الكتاب لم يأت بجديد”، وأن “الماركسية سوف تتعايش مع الأديان”. وفي الأسبوع التالي، كتب منير العكش: “ليس صادق العظم هو المضطَهد وإنما الإسلام، والمشانق التي نصبتها الثورية العربية للفكر الإسلامي تضاهي قارة من خشب”. وفي المعنى نفسه، كتب فتحي يكن: “الإسلام سيبقى مستعصياً على معاول الهدم”.
في 22 شباط-فبراير، بدأ الملحق بنشر سلسلة مؤلفة من ست مقالات طويلة تناول فيها الشيخ محمد مهدي شمس الدين، فصول كتاب صادق العظم، وحملت هذه المقالات تباعاً العناوين التالية: “ترداد لأفكار عصر النهضة الأوروبية وعمل تافه يتّسم بالنزق الفكري والعاطفية”. “العلم عند صادق العظم أكثره افتراضات، والدين كما فهمه، مستند على أباطيل”.”رد العظم الكون إلى أصل غير معروف فآمن بالغيب، لماذا يكون غيبه حقاً وغيب المؤمنين بالأديان باطلاً؟”. “قصة ابليس، صادق العظم حوّرها ليجعلها أسطورة”. “الله الإسلام يبدو عند صادق العظم شريراً وعابثاً لأن الكاتب لم يفهم لغة القرآن. لا يجوز للناقد أن يبتر النص ويختار منه المقطع الذي يؤيد هواه”.
وداعاً صادق جلال العظم/ هشام ملحم
مع رحيل المفكر والناقد السوري الكبير صادق جلال العظم فقدت الثقافة العربية ربما أهم مثقف عام منذ الحرب العالمية الثانية. قلائل جداً الكتاب العرب الذين شرّحوا نقدياً البنى الفكرية والسياسية والدينية المهيمنة في العالم العربي بصدق لا يعرف المساومة كما فعل العظم مدى نصف قرن بالعربية والانكليزية والالمانية. ان يحتضر صادق وهو يراقب حلب تحتضر، والانتفاضة التي أيدها تنتكس، وان يتوفى ويدفن في منفاه الالماني بدل ان يحتضنه ثرى سوريا الى الابد، هو ألم لا يحتمل لمحبي صادق الكثر.
تعرفت إليه في بيروت عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري بعد صدور كتابه “النقد الذاتي بعد الهزيمة” وقبل صدور كتابه التالي “نقد الفكر الديني”. كنت ومجموعة صغيرة من الاصدقاء اليساريين نرافقه الى المحكمة حين احالته الحكومة اللبنانية على القضاء بعد صدور “نقد الفكر الديني” لاظهار تضامننا معه بعدما تعرض لتهديدات. آنذاك في 1969 قبل طغيان التيارات والحركات الظلامية التي تلف نفسها بغطاء اسلامي، والتي اغتالت لاحقاً شخصيات فكرية بارزة أمثال حسين مروة ومهدي عامل، كان الادباء والكتّاب يتصدون دون خوف للترهيب الفكري أكان مصدره دولة متخلفة أم رجال دين أكثر تخلفاً. كثيرون وقفوا مع صادق في ذلك الوقت وأذكر منهم بالتحديد أدونيس وأنسي الحاج.
بعد هزيمة 1967 تحولت بيروت الى بيت حاضن للمفكرين العرب الذين حاولوا تشريح واقع الطغيان العربي وتعريته من الاكاذيب السياسية والاساطير الغيبية لمعرفة أسباب الهزيمة وتخطيها بالديموقراطية والتمثيل السياسي الحقيقي وفصل الدين عن الدولة. آنذاك، أعطتنا سوريا، عبر مجلة “مواقف” التي أسسها أدونيس (وغيرها من المطبوعات اللبنانية، مثل “الطليعة” و”الطريق” وملحق “النهار”)، أجمل ما لديها من مبدعين، أمثال صادق وأدونيس وسعدالله ونّوس ومحمد الماغوط وغيرهم.
كنت ألتقي صادق عندما كان يزور الولايات المتحدة، وشاركنا في ندوات ومؤتمرات، وكنا دائما نتابع حواراتنا وكأننا لم نفترق سنوات. وتعلمت منه حب الادب الروسي والفلسفة الأوروبية في القرن التاسع عشر.
إلتقيته للمرة الأخيرة في بوسطن خلال السنة الثانية للانتفاضة السورية. أذكر انني كنت متشائماً أكثر منه، لكنه، مع ادراكه لجسامة التحدي، كان على عهده مقاوماً شرساً لليأس والاحباط.
قبل أيام كتبت مرثية لحلب، وتذكرت ان صادق المريض في منفاه الالماني سوف يرحل قريباً، ويترك فراغاً كبيراً في حياتنا، أنا وجيلي من اللبنانيين والعرب الذين عاشوا حقبة ما بعد هزيمة 1967، ورأوا فيه منارة فكرية لا تخبو، وسأضطر قريباً الى كتابة مرثية لصديق عزيز ومعلم كبير. وداعاً صادق.
النهار
الحق في الاختلاف/ صبحي حديدي
تعلمت الكثير من صادق جلال العظم، في مسائل فلسفية وفكرية وسياسية وثقافية، في ضوء منهجية نقدية لا تكلّ؛ الأمر الذي لم يحجب عني الحقّ في الاختلاف معه بصدد قضايا أخرى، قليلة ومحدودة النطاق؛ ولم يمنعني، أيضاً، من مساجلته علانية، على صفحات هذه الصحيفة تحديداً، حول رأيه في مفاوضات السلام السورية ـ الإسرائيلية.
ففي صيف 2000، في مقالة مسهبة بعنوان «المشهد من دمشق»، نشرتها المجلة الأمريكية المعروفة New York Review of Books ، كُتبت قبيل وفاة الأسد الأب وتوريث الأسد الابن، ساجل العظم على النحو التالي منذ السطور الأولى في مقالته: «هل سوريا، بوصفها سوريا وليس مجرّد حكومة أو نظام، جاهزة للسلام مع إسرائيل في الوقت الحاضر»؟ الجواب، تابع العظم، «ينبغي أن يكون: نعم، حَذِرة ومعللة».
ويومذاك، رأيت عجباً في أن يبلغ العظم ـ صاحب «في الحب والحب العذري» و«نقد الفكر الديني» و«النقد الذاتي بعد الهزيمة» ـ هذه الخلاصة القاطعة؛ ورأيت عجباً أشدّ في أن يطري دبلوماسية أمثال وليد المعلم، وأن يعتبر رافضي إسرائيل «أقلية» داخل المجتمع السوري تقتصر على الإسلاميين والقوميين، ثمّ أن يمتنع عن قول كلمة واحدة (على امتداد مقالة في 11300 كلمة) بصدد مفردات مثل «الديكتاتورية» أو «الاستبداد» أو «الفساد»؛ بل أن يستخدم توصيفات مثل «الرئيس الشاب» و«الدكتور بشار الأسد» في تتمة للمقالة وُقّعت بتاريخ تموز/ يوليو تلك السنة.
كان الراحل يدرّس في جامعة برنستون العريقة، في حينه، وكان أيضاً قد نشر، في فصلية Khamsin، 1981، مقالته «الاستشراق والاستشراق معكوساً»، بالإنكليزية؛ التي ستتخذ صفة كراس فيما بعد. وكان هذا الموقف مثار عجب أيضاً، ليس لأنّ عمل إدوارد سعيد لا يحتمل النقد والتفنيد، إذ العكس هو الصحيح بالطبع، ونقّاد سعيد كانوا بالعشرات يومها، ومن حقّ العظم أن يدلي بدلوه في الأمر، وهو المفكر ذو الشخصية النقدية أوّلاً. كان مثار العجب أنّ منهج العظم في نقد سعيد قام على تقويض «بارادايمات» الأخير، لأنها تختزل ميشيل فوكو؛ ولكن العظم نفسه لجأ إلى «بارادايمات» مماثلة في سيرورة التقويض، قابلة بدورها للنقض، وخضعت للكثير من الاختزال.
أخيراً، لم أتمكن في أي يوم من هضم مفهوم «العلوية السياسية» الذي قال به الراحل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعجزت عن استيعاب شروحاته وتعليقاته حول المفهوم (وقد كانت قليلة متقطعة في كل حال)؛ وذلك رغم يقين شخصي عميق بأنّ هذا العقل النقدي الجبار كان يمتلك جهازاً مفهومياً على درجة من الصلابة والتماسك والتناسق، لا تتيح نفاذ أي بارقة طائفية. كذلك لم يساورني أي شك في انحياز الراحل إلى انتفاضة شعبه، والتزامه بحقوق هذا الشعب في الكرامة والحرية، دون أدنى تمييز بين الأعراق والأديان والمذاهب. وكان بعض ما عانيت من «عسر» في تقبّل المفهوم أنه ظلّ، أو هكذا بدا لي على الأقلّ، متخففاً ـ بدرجة مفاجئة، غير مألوفة عند العظم، في يقيني المتواضع ـ من وطأة الاجتماع السوري وجدل مكوناته، خلال عقود طويلة زاخرة بالتحولات؛ ولا يصحّ أن تُختصر في خمس سنوات من جرائم حرب النظام، أو جدل هذا الموقف أو ذاك، لدى هذه الطائفة أو تلك.
سوف يكتب غيري موادّ رثاء في العظم، وإطراء له، وافرة ومستحقة، وسأتفق مع تسعة أعشار ما سيُقال ويُكتب، لأنّ سوريا خسرت عقلاً فلسفياً ونقدياً كبيراً، لامعاً ورفيعاً وفريداً؛ وبعض تكريمه قد يكمن، أيضاً، في تبيان نزر يسير من اختلاف المتتلمذ مع المعلّم.
٭ ناقد سوري
القدس العربي
صادق العظم: تقنية الرأي الشجاع/ بدرالدين عرودكي
منذ محاضرته الأولى عن “مأساة إبليس” التي قدمها أمام جمهور عربي بدمشق عام 1963، قبل أن ينشرها مفصلة في كتابه “نقد الفكر الديني” رسم صادق جلال العظم مسار طريقه بوضوح لا لبس فيه: موضوعاً ومنهجاً وتقنية وسيسير عليه طوال نيف وخمسين عاماً دون أن يحيد عنه قيد أنملة.
لم يكن منتظراً أن يعود شابٌّ من الولايات المتحدة أو من أي بلد غربي بعد حصوله على درجة دكتوراه في الفلسفة نالها بناء على رسالة قدمها حول الفلسفة الفرنسية المعاصرة من خلال فلسفة الأخلاق لدى الفيلسوف هنري برغسون، أن يبدأ مساره كاتباً ومفكراً بتناول موضوعات لا تمتُّ بصلة إلى هذه الفلسفة خصوصاً ولا إلى الفلسفة الغربية عموماً، ولم يسبق لها كذلك أن طُرِحَت على بساط البحث انطلاقاً من نظرة خارجة عن المألوف أو عما يمكن تسميته بالتقاليد التي هيمنت على مقاربة الموضوعات الدينية خصوصاً والسياسية عموماً في بلدان سبق لها أن أوشكت على سجن طه حسين لمجرد أنه شكك في انتماء الشعر الجاهلي إلى عصر الجاهلية، إي إلى عصر ما قبل الإسلام، ونزعت صفة العالم عن الشيخ علي عبد الرازق، العالم الأزهري، الذي حاول الاجتهاد من خلال كتاب “الإسلام وأصول الحكم” في موضوع ديني / سياسي لا سلطة للخوض فيه إلا لما تقرره السلطة السياسية عبر المؤسسات الدينية الخاضعة لها.
وفي حين كانت دراسة طه حسين في الأزهر ثم في الجامعة المصرية خصوصاً، من دون الحديث عن دراسته في الجامعة الفرنسية، تتيح له بلا عناء شديد الحديث في موضوعات لا يمكن لأحد أن يماري في قدرته وأهليته الفكرية لمقاربتها؛ وكانت مثلها دراسة الشيخ علي عبد الرازق الأزهرية التي سمحت له الخوض في موضوع خلافي أساساً عبر مقاربة موضوعات كانت تؤلف قوام المواد الدراسية لطلاب الأزهر. على أن ما لم يكن مسموحاً به كما تبين آنذاك من ردود الفعل الرسمية من قبل المؤسسات الدينية والسياسية والناطقين باسمها بوجه خاص كان الخروج على تقاليد البحث أو ما يمكن أن نطلق عليه “المحرّمات”، وكان مثل هذا الخروج يعتبر تحدياً تضفي عليه المؤسسة الدينية ومسؤوليها صفة خطيرة يمكن تصل إلى حدِّ الاتهام بالكفر وتستنجد في سبيل إقرارها بالسلطة السياسية لقمع من يقوم به بصورة أو بأخرى. كان ذلك يضع حداً لأي نقاش أو سجال. ومن هنا كُتِمَ أهمُّ صوتين عرفتهما بداية الربع الثاني من القرن الماضي ولم يجرؤ بعدهما أحد على السير على هديهما أو أن يستأنف مجدداً العمل في إطار مشروعهما.
فأن يختار صادق العظم بناء على ذلك في أول لقاء له بالجمهور في بلاده ثيمة قرآنية وموضوعاً إسلامياً بامتياز، لم يكن يبدو أنه كان مهيّأً لمقاربته خلال مساره الدراسي والعلمي كان والحق يقال يعبِّر عن جرأة سرعان ما استحالت بسبب تكوينه العلمي بالذات والطريقة والتقنية اللتين اتبعهما في كتاباته، شجاعة سوف تسم مقارباته التالية كلها أياً كانت ثيمتها أو ميادينها.
ذلك أن قوام مشروع صادق العظم الذي سيتكشف بالتدريج عبر دراساته المتوالية منذ تلك المحاضرة يتجلى في نقد نسق متكامل من العادات الفكرية والطرق السائدة في التفكير الغيبي وغياب المنهجية والعقلانية في المقاربات سواء في تلك التي تنظر في النصوص القديمة أو تلك التي تحاول فهمها ثم تعمل على تأويلها، أو خصوصاً في ضروب تطويعها على أيدي مختلف السلطات السياسية على صعيد الممارسات الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية. بهذا المعنى، لم تكن الثيمات التي اختارها من مختلف ميادين التفكير الديني أو السياسي أو الأدبي ثيمات من أجل بناء فكري جديد ومتماسك يماثل مشروع طه حسين في نقده الجذري للشعر الجاهلي أو علي عبد الرازق في إعادة قراءته للتاريخ السياسي للإسلام عبر منظومة مفهوم الدولة فيه، وهما المشروعان اللذان أُجْهِضا ما إن نَشِرا على الملأ، بقدر ما كانت تستهدف في مقاربتها تحريك المياه الآسنة من خلال الخوض في عدد المحرمات الأساس في حياتنا الثقافية والفكرية والسياسية، وفي مقدمتها المحرمات الدينية والسياسية.
وإذا لم يكن هذا الاختيار لميدان نشاطه الفكري يتطلب استعداداً علمياً شاملاً، دينياً أو سياسياً، يشرعن خياراته أو يمنحها على الأقل قاعدة صلبة تستند إليها مقارباته، فإن ما كان ما يحتاج إليه بالدرجة الأولى تقنية شديدة الدقة قوامها الأساس المنهج العقلاني، منهج كان في دراسته للفلسفة قد امتلك ناصيته بحيث بات جزءاً من سلوكه اليومي.
تجلت تفاصيل هذه التقنية في كتابات صادق العظم على اختلافها، بدءاً من مقالات “نقد الفكر الديني” وانتهاءً بمقالاته التي تضمنها كتاباه “ذهنية التحريم” و”ما بعد ذهنية التحريم”، وطريقة قبوله مختلف ضروب النقد الذي وجه إليها وطريقة ردوده عليه وحرصه على نشرها كاملة ضمن كتبه المذكورة. يتجلى أهمُّ عناصرها في دراسة عميقة وشاملة للثيمة المعالجة لا تترك أية ثغرة في مراجعها والوثائق المتعلقة بها فضلاً عن كل ما كتب عنها قديماً أو حديثاً وفي مختلف المجالات، وكذلك في تفاصيل معالجتها التي ستؤلف موضوع النقد.
لم يُنقد صادق العظم فيما كتبه من دراسات في كتابه “نقد الفكر الديني” ولا سيما حول “مأساة إبليس” أو “معجزة ظهور العذراء وتصفية آثار العدوان” على ما بينهما من اختلاف في طبيعة الموضوع ومصادر كل منهما، لنقص في معارفه. كان معظم النقد موجهاً إلى تجاوزه الحدود المرسومة التي اخترقتها دراساته، وهي حدود كان تجاوزها هو الهدف الأساس في معظم ما كتبه في مجال نقد الفكر الديني أو الفكر السياسي أو الاجتماعي. ولذلك كان يرى خلافاً للغالبية العظمى من الكتاب أمثاله، أن عليه أن يلاحق كل ردود الأفعال على ما يكتبه وأن يرد على ما يوجه إليه من نقد بالتفصيل، ثم أن يقوم بنشر نصوص النقد كلها وردوده عليه مع النص الأساس بحيث تتاح للقارئ فرصة النظر والمقارنة واستخلاص النتيجة التي تؤدي إليها مجمل هذه السجالات من حول الدراسة الأساس.
هكذا كان لا بد لهذه الجرأة كي تستحيل شجاعة من استخدام هذه التقنية في مقاربة موضوعات كانت تودي بكل من يقاربها خارج الحدود إلى التهلكة. ولقد تجلى ذلك أيضاً وعلى نحو أكثر وضوحاً في معالجته لقضية سلمان رشدي وروايته “الآيات الشيطانية” التي كانت سبباً في “حكم عابر للقارات” كما وصفه العظم أصدره الخميني على الروائي بقتله مقابل جائزة مالية سخية. لم يكن من السهل في ذلك الحين أن يتبنى مثقف عربي موقفاً كذلك الذي تبناه صادق العظم في بلده سورية مدافعاً عن حرية الكاتب في الكتابة وفي التفكير في إطار ما سماه “ذهنية التحريم وعقلية التجريم ومنطق التكفير وشريعة القمع”. هنا أيضاً نشر صادق العظم ثلاثة وعشرين مقالاً أو دراسة نقدية لدراسته حول سلمان رشدي قام بالرد عليها بطريقة تثير الإعجاب في هدوئها وفي منهجها في تفنيد الأفكار أو الطريقة من دون المساس بشخص الكاتب أو الناقد.
فتحت هذه الطريقة، منهجاً وتقنية، المجال واسعاً لجيل كامل من الباحثين الشباب كي يطرقوا أبواباً في البحث لم تكن من قبل مطروقة أو لم يكن مسموحاً طرقها ولا سيما في المسائل الدينية. والحق أن الثورة النقدية التي أطلقها صادق العظم وحركت كل ضروب المياه الآسنة في الفكر أو في المعتقدات الدينية أو السياسية كانت نموذجاً لما أطلقته الثورة السورية الأخيرة حين كسر شبابها حواجز الخوف والمحرمات في ميادين الفكر الديني والسياسي والاجتماعي.
لم يكن غريباً والحالة هذه أن يسير صادق جلال العظم في ركاب الثورة منذ لحظتها الأولى. فقد بدت وكأنها جاءت لتدفع بمنهجه النقدي الصارم إلى حدوده القصوى: تحطيم الأصنام الحديثة وتحويل المياه الساكنة إلى أنهار.
ضفة ثالثة
صادق جلال العظم: من الثورة إلى الثورة/ أحمد باشا
عند استحضار سيرة المفكّر السوري صادق جلال العظم (1934 – 2016)، الراحل أمس في برلين، تتراءى أمامنا ملامح تركيبة استثنائية، ناقد ماركسيّ يتحدر من عائلة دمشقية أرستقراطية، وأستاذ جامعي كثير الخروج على حقل تخصصه (الفلسفة)، ومحارب شرس ورصين في وجه الخرافات، وناشط سياسي منحاز لقضايا شعبه.
نتتبع حياة العظم المولود في دمشق سنة 1934، تلميذاً في مدرسة الفرير الفرنسية، وفي المدرسة الإنجيلية في صيدا، وفي شبابه قرّر دراسة الفلسفة في “الجامعة الأميركية” في بيروت، ومنها تخرّج سنة 1957 ليذهب إلى أميركا حيث نال درجة الدكتوراه من “جامعة ييل” عن أطروحة أعدّها حول الفيلسوف هنري برغسون وكان موضوعها “فلسفة الأخلاق عند برغسون” (ولم تكن الأطروحة حول الفيلسوف الألماني كانط كما تذكر خطأ مصادر مختلفة).
عاد العظم إلى بلاده ليبدأ بالتدريس في الجامعة التي بدأ مشواره الأكاديمي فيها (“الجامعة الأميركية” في بيروت) عام 1963. في العام نفسه، لفت الأنظار إليه من خلال محاضرة أقامها في “المنتدى الاجتماعي” في دمشق، يذكرها المترجم بدر الدين عردوكي في إحدى مقالاته، عن “مأساة إبليس”، حيث ناقش ابن الـ29 عاماً ظاهرة إبليس في إطار التفكير الميثولوجي – الديني، وفيها قال العظم: “لو أعيد لنا النظر بالصفات الممنوحة له لظهر لنا أن إبليس يسيّر قسماً كبيراً من مجرى الأحداث، ويعتبر مسؤولاً عن معظم الحركات الفكرية والفنية والسياسية في تاريخ الحضارة”.
بعد ما يقارب السنتين، يقدم العظم محاضرة في بيروت عن إبليس في “النادي الثقافي العربي”، يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر عام 1965. وينشر لاحقاً دراسته في مجلة “حوار” سنة 1966، وفي مجلة “الثقافة العربية” 1966. بسبب الدراسة السابقة، توالت الردود والاتهامات على العظم في الصحف والدوريات حتى نشر الطبعة الأولى من كتاب “نقد الفكر الديني” في تشرين الثاني/ نوفمبر 1969. بعد ذلك، ستُسحب النسخ من الأسواق وسيحاكم غيابياً ويدخل السجن سنة 1970 (من 8 يناير/ كانون الثاني حتى 15 منه). ومن الأسماء التي كانت كشهود دفاع في قضية العظم نذكر الشيخ محمد جواد مغنية، وميخائيل نعيمة، وقسطنطين زريق، وحسن صعب، والأب جبرائيل مالك.
أثناء الاستجواب، رفض العظم أن يتراجع عما كتبه، كان ذلك قبل أن تبرّئه المحكمة. سيعيد العظم نشر كتابه مع ملحق بوثائق محاكمة المؤلف والناشر والردود على منتقديه. استهلّ العظم الطبعة الثانية باقتباس من المفكر السوري ياسين الحافظ (1930 – 1978): “إن نقد جميع جوانب المجتمع العربي الراهن وتقاليده نقداً علمياً علمانياً صارماً وتحليلها تحليلاً عميقاً نفاذاً، واجب أساسي من واجبات حركة الطليعة الاشتراكية الثورية في الوطن العربي”.
هكذا، سيتضح لنا بشكل أكبر أن أكبر معارك العظم ستكون مع ما سمّاها بـ”الإيديولوجيا الغيبية”، فهو الذي طالما اعتبرها السلاح الأساس والنظري بيد الرجعية العربية في حربها المفتوحة ضد القوى الثورية والتقدّمية في الوطن العربي.
وفي السياق نفسه، وبينما كانت الموجة الأضخم في الفكر والسياسة تعيد إنتاج ما كان سائداً قبل الخامس من حزيران/ يونيو، راح العظم، مع قلة من مجايليه، يغرّد خارج السرب منبّهاً إلى خطورة الاستمرار بالنهج المعمول به، ولعل صوته كان الأكثر ارتفاعاً وقتها، فعمل على نقد العقلية المتواطئة مع البنى المؤسّسة للهزيمة في “النقد الذاتي بعد الهزيمة” (1968)، ومجابهتها، حيث كانت الغالبية تتبنّى خطابات إيديولوجية متعامية عن الواقع وبعضها كانت تحوّل الهزيمة إلى انتصار ومصدر للفخر.
في الكتاب نفسه، وقف العظم في وجه أصوات كثيرة كانت تُفرغ الصراع العربي – الصهيوني من محتواه وتحوّله إلى خرافات تتصارع، حيث حذّر العظم في الكتاب نفسه من أن “رسم صورة خرافية للقضية الفلسطينية تكذّب الصراع العربي -الصهيوني وتفرّغه من محتوياته الواقعية والتاريخية الملموسة، فيتحوّل بذلك إلى مشكلة غيبية دينية لا قبل بها ولا قدرة لنا، في الواقع، على مواجهتها أو التصدي لها”.
بعد قضية “نقد الفكر الديني”، عاد العظم إلى دمشق، واستمر في كتاباته التي كانت تتمحور حول الواقع السياسي في المنطقة وما تبع “هزيمة حزيران”: “سياسة كارتر ومنظرو الحقبة السعودية” (1977)، و”زيارة السادات وبؤس السلام العادل” (1978).
في الثمانينيات، عمل صاحب “الاستشراق والاستشراق معكوساً” (1981)، أستاذاً في قسم الفلسفة في “جامعة دمشق”. ومع مطلع التسعينيات أصدر كتابه “دفاعاً عن المادية والتاريخ” (1990). أربع سنوات بعدها، سيصدر له ضمن تفاعلات قضية سلمان رشدي، كتاب “ذهنية التحريم” (1994)، حيث يدافع عن حرية الكاتب وحقوقه، وينتقد الطريقة التي تم بها تلقي مسألة الرواية والفتوى ضدها عربياً. سيُتبع العظم هذا الكتاب بـ”ما بعد ذهنية التحريم” (1997)، الذي يردّ فيه على منتقديه حول قضية رشدي.
عام 1999، تقاعد العظم من منصبه كرئيس لقسم الفلسفة في “جامعة دمشق”، لكنه أكمل نشاطه كأستاذ زائر في بعض الجامعات الأوروبية والأميركية. أما في الشأن السوري العام، فكان من الأسماء الموقّعة على بيان الـ”99” الذي يطالب بإنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات العامة في البلاد (عام 2000). كما كان فاعلاً في إطار عمل “لجان إحياء المجتمع المدني”. لكن ذروة ارتباطه بالشأن العام كانت عند انطلاق الثورة السورية، عندما أعلن بوضوح تام وقوفه إلى جانبها. هذا الانحياز الأخلاقي لم يكن مفاجئاً في سيرة مثقف دفع الكثير من سني عمره في مقارعة الأصوليات بكافة أشكالها. كان مؤمناً حتى أيامه الأخيرة بانتصار الثورة السورية رغم كل ما حدث، لكنه كان يشعر أنه قد لا يشهد هذا الانتصار بنفسه.
انتمى العظم، سلوكاً وفكراً، إلى عصره المضطرب، نستعيده بكلماته: “لا أبكي على الأطلال لأنني ابن عصري بإنجازاته وانهياراته، بفتوحاته وجرائمه، باكتشافاته وشنائعه، باختراعاته ومباذله، ولا أمشي برأس “مندارة” للوراء لأني أحيا زمني، وزمني هو الذي يعطي معنى التطلع إلى الوراء، وإلا فلا طائل أو نفع من هذا الوراء”.
العربي الجديد
العظم صادماً العشّاق الدونكيشوتيّين/ هيثم حسين
يسجّل للمفكّر صادق جلال العظم تحقيقه السبق في عدد من المواضيع والقضايا التي تناولها وعالجها في كتبه، وكان رائداً في العالم العربيّ في مقارباته الفكريّة الفلسفيّة، وكشفه عن بعض مكامن الخلل والعلل التي استوطنت الوعي الجمعيّ بطريقة النقل من دون مساءلة للتاريخ ولا إعمال للعقل في مواجهة تلك الأمور والأفكار والقضايا التي كانت تعدّ من المسلّمات التي يجب الإيمان بها والبناء عليها.
تصدّى العظم لتفكيك “ذهنية التحريم” في وقت كانت حمّى الشعارات تعمي كثيرين، نقد الفكر الدينيّ المتحجّر الذي يحاول فرض قيود على الفكر الحرّ، أثار العديد من الأسئلة التي حرّضت النزوع للبحث لدى القارئ والمتلقّي وحفّزته للخروج من القوقعة التي يسعى أولئك الذين نصّبوا أنفسهم سدَنة للتراث أو الدين أو الفكر لفرضها على الناس بذرائع شتّى.
يعدّ الحبّ من أهمّ القضايا الإنسانيّة الحاضرة في اهتمامات الأدباء والمفكّرين وأعمالهم، كما يعدّ من أكثر المواضيع الشعريّة في التراث الشعريّ العربيّ، ونظراً لما يحيط به من التباس لا يني يتجدّد مع التفسير والتأويل والاستعارة والكناية والتورية التي يكفلها الشعر للشاعر، ويعفيه من أيّ مساءلة أو استجواب، ونظراً للانسياق وراء مقولة “يجوز للشعراء ما لا يجوز لغيرهم”، وكيف أنّ هذا الجواز أصبح بالتراكم حقّاً مؤصّلاً ينبغي عدم السؤال عنه ولا مناقشة صاحبه في ما يقول، ولربّما في ما يفعل أيضاً قياساً على الإجازة الممنوحة له من جهة مجهولة باسم الشعر، مع السماح أو التغاضي للتأثير في الحياة والشغب فيها كما يحلو له، أدلى صادق جلال العظم في كتابه “في الحبّ والحبّ العذريّ” الذي نشره سنة 1968 بدوله الصادم في مسألة كانت تعدّ من البديهيّات في ذهن كثيرين.
سعى العظم في عمله إلى نوع من التحليل للخطاب الشعريّ والسلوك المرافق، وكيف أنّ الشعراء الذين استماتوا في قصائدهم بمعشوقاتهم كانوا يخوضون في ملعب الجنس والشهوة ويروون نداء الجسد وضغطه في سياق مختلف، ويبقون الحبّ في سياق القصيدة والاستشعار، وكيف أنّ ذلك كان يشكّل نقطة افتراق بين القول والفعل، بين الحقيقة والواقع، بين الصدق والكذب، ولربّما كان في القول بأنّ “أعذب الشعر أكذبه” إجازة من زاوية أخرى للشعراء كي يستعيروا صور الحبّ ويسبغوا عليها التعفّف والعذريّة بحثاً عن طهارة منشودة، أو تطهّر من واقع الممارسة بعينه.
نوّه العظم في مقدّمة كتابه إلى الإشكالية التي تظلّ مصاحبة لأيّة مقاربة لمفهوم الحبّ نظراً لاتّساعه وغناه وانفتاحه على الحياة، وحدّد مجال تحرّكه ومقاربته، وأشار إلى نقطة مهمّة تتمثّل في أنّ كلّ امرئ يعتقد في نفسه الكفاءة والجدارة والخبرة للإدلاء بدلوه في الحبّ انطلاقاً من خبرته وتجربته التي قد يسعى لتعميمها. كتب العظم معبّراً عن توقّعه وقراءته لتلقّي بعضهم لعمله: “.. أعلم أنّه لابدّ لمن يكتب عن ظاهرة الحب من أن يلقى حساباً عسيراً من القرّاء، والمستمعين كافّة، لأنّ ما من إنسان إلّا ويعدّ نفسه خبيراً في موضوع الحبّ، مطّلعاً على تفاصيله ومخوّلاً لأن يبدي الرأي حوله ويطلق الأحكام (النقدية والمؤيدة والمجحفة..) على آراء الآخرين فيه..”. وتراه ينوّه في موضه آخر من كتابه قائلاً: “إنّ عدّ الحبّ العذريّ ظاهرة مرضيّة في أساسها لا يعني بأنّنا نريد الحطّ من شأنه التاريخيّ أو الإنزال من أهمّيّة الأدب الذي نتج حوله وبسببه”.
درس العظم جوانب مما يوصف باشتداد الحب واستعار المشاعر واحتدام العواطف والأحاسيس، كأنّه كان يصوّر حرباً دائرة داخل المرء نفسه، وبينه وبينه محبوبه بطريقة ما، على طريقة نيران صديقة أو مجابهة في ميدان التجييش العاطفيّ، ذاك المتجسّد في جانب منه في تسعير الرغبة الجنسيّة، أو بحثاً عن الوصال الجسديّ، ثم مزاعم التسامي ونُشدان العذريّة في القصيدة.
الشاعر نزار قبّاني الذي كان قد نشر مجموعته “الرسم بالكلمات” سنة 1966 وفيها قصيدته “ماذا أقول له” التي غنّتها المطربة نجاة الصغيرة، والتي ينشد في أحد أبياتها: “الحبّ في الأرض بعض من تخيّلنا.. لو لم نجده عليها لاخترعناه” وجد في كتاب العظم تقاطعاً فلسفياً مع فكرته عن وهم الحبّ أو ضرورة اختراعه لضمان استمرار وهم العيش أو خدعته بمعنى ما، وأشاد بالكتاب في نصّ تمهيديّ قائلاً: “قبل هذا الكتاب، كان العشّاق العذريّون في تصوّرنا أنقياء كالملائكة، معصومين كالقدّيسين. ويأتي صادق جلال العظم في هذا الكتاب ليمزّق القناع عن وجوه العشّاق العذريّين، وليكشف بالمنطق والفكر الفلسفيّ العميق أنّهم كانوا في حقيقتهم نرجسيّين وشهوانيّين..”.
لم يفكّك العظم وهم الحبّ بقدر تشريحه لبنية الإيهام المصاحبة لذاك الموصوف بالحبّ والمقنّع بأقنعة العذريّة التي أصبحت في سياق التداول صفة ممدوحة لذاتها أكثر من النسبة لقبيلة، واتّسعت لتشمل قبائل العشّاق من كلّ زمان ومكان، واستمرّت بنوع من التجديد والمعاصرة لترمز إلى الغائب المأمول في الحبّ، أو ذاك الذي يظلّ بمنأى عن القبض والإحاطة.
كان كتاب العظم صدمة في زمنه، ويظلّ صادماً لأولئك الواهمين الذين لا يفصلون بين المشاعر والغرائز، وينساقون وراء تغليف الشهوة من خلال تقنيعها بأقنعة سرابيّة أو خلّبيّة في محاولة للتضليل؛ تضليل أنفسهم قبل غيرهم، والتحايل على الواقع والقوى الدافعة لسلك درب بعينه دون سواه..
أربك العظم في عمله وبحثه العشّاق الدونكيشوتيين، وضع الشعر في سياقه التاريخيّ وربط بين الشاعر وشعره ليظهر الهوّة بين الحيلة والوسيلة، تبحّر في التراث ليستخرج العبر والحكم والأسئلة الدافعة على التفكير خارج أطر التقديس والتوثين، درس التاريخ والتراث في ضوء الدراسات والنظريات الفلسفية الغربية التي كان مطّلعاً عليها، وكان في صدمته الواعية للقارئ محرّضاً له على التفكير ومحفّزاً على البحث والتنقيب.
دفاعاً عن مادية صادق العظم وتاريخه/ خلدون النبواني
فما هي الفلسفة إلا تعلُّم الموت؟
تطالب به مملكة السماء ولا ترضى جمهورية الأرض التنازل عنه، بينما يقرر العظم أن يختار مصيره بنفسه، مختاراً أن يقطع الطريق بينهما وحده بلا وصاية أحد. وليس الطريق بجديد عليه، فهو اختبره مراراً من قبل، ما إن بدأ بالتفلسف.. فما هي الفلسفة إلا تعلُّم الموت؟.. كما يقول أفلاطون على لسان سقراط، في محاورة فيدون حول خلود الروح، مضيفاً أن الفلاسفة الحقيقيين، هم من بين البشر الأقل خوفاً من الموت. وصادق العظم هو أحد الفلاسفة الحقيقيين، فلا نقلقن عليه إذن من مواجهة الموت.
لكن، هل الحديث عن خلود الروح عند أفلاطون، مقدمة مناسبة للدفاع عن مادية صادق العظم وتاريخه؟ نعم. لأن مادية صادق العظم لم تكن بسيطة، تتموضع كمقابل أنطولوجيّ مقابل الروح أو العقل أو المثالية الخ من هذه الثنائيات الميتافيزيقية غير المتناقضة أو المتقابلة أصلاً كما يعتقد تاريخ الميتافيزيقا. من دون أن يكون أفلاطون فيلسوفه المفضل، يستعير العظم من هذا الفيلسوف الإغريقي فكرة الجدل والحوار، أو فلنقل إدخال المسرح إلى الفلسفة بجعل الشخصيات تتحاور في ما بينها حول مسائل فلسفية أنطولوجية أو أخلاقية أو جمالية أو منطقية أو سياسية أو قانونية.
يستعير العظم أسلوب أفلاطون المسرحيّ الحواري، مرتين على الأقل. المرة الأولى في حوارية متخيلة سريعة تعود لأيام الستينات من القرن الماضي بعنوان “الشك واليقين عند كيركغارد”، والذي صدر في كتابه “دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة” (1966). في هذا الكتاب يضع العظم، الفيلسوف وايتهيد، في حوار افتراضي مع كيركغارد الذي مات العام 1855، أي قبل ست سنوات من ولادة الفيلسوف والمنطقي الإنكليزي. المرة الثانية، وهي الأهم، ستكون في كتابه الأهم فلسفياً، في رأيي، “دفاعاً عن المادية والتاريخ”، حيث يدخل العظم نفسه إلى خشبة المسرح الفلسفية في مواجهة شخصية افتراضية، تحمل اسم “عفيف قيصر”. في هذا الكتاب الفلسفي الفريد في اللغة العربية، يعيد العظم الروح إلى محاورات أفلاطون وأسلوبها الجدلي التوليديّ، ويمكن القول إن كتاب العظم هذا هو كتاب أفلاطونيّ معكوس، أو فلنقل أنه فيدون معكوس حيث تنتصر المادة على الروح، وسيرورة التاريخ على مطلقية المثل وتعاليها الأنطولوجيّ.
لكن، لنعد قليلاً إلى مادية العظم، والتي تبدو مؤدلجة جداً ويقينية أكثر من اللازم، في كتابه المهم ذاك، وفي أعمال فلسفية أخرى مهمة مثل دراسته حول حدسي الزمان والمكان عند كانط، أو دراسته لنقائض العقل المحض عند هذا الفيلسوف الألماني، والتي اعتمد فيها العظم المنهج التاريخي الماركسي. ولنلاحظ أن ماديته تسكنها الروح والحركة والحيوية. مادية تُذكّرنا برفض ماركس لمادية فيورباخ الثابتة الجامدة أو شبه الميتة. سبق وانتقدتُ ماركسية العظم، أذ اعتبرتُها متصلبة تجاه ماركس الذي يبدو في “دفاعاً عن المادية والتاريخ”، وكأنه محور الفلسفة، يقسمها إلى ما قبله وما بعده ويمثل المرجعية النهائية لها، فتقاس جميع كل الفلسفات على سريره البروكوستي. لكني سبق أن حاولت، في موضع آخر، إثبات أن مادية العظم على العموم مخترقة بالروح.
لنتذكر إذن أن هذا المفكر الاستثنائي اختار الاشتغال على فلسفة برغسون في أطروحة الدكتوراه. لنتذكر أن برغسون هو أحد رواد الفلسفة الحيوية والطاقة الروحيّة والفكر والمتحرك والتطور الخلاق، وليس عبثاً أن يختاره العظم الشاب كموضوع لأطروحته. تتجلى روح مادية العظم أيضاً في مقارباته الأدبية الأنيقة لـ”مأساة إبليس” ولرواية “آيات شيطانية” لسلمان رشدي. أقول هذا، لا لأسلخ عن العظم قناعاته الماركسية المادية التي دافع عنها طويلاً، إنما لأؤكد بأن أحد أسباب قوة العظم الفلسفية يكمن في روحيتها وفكرها المتحرك الخلاق، لا في أيديولوجية ثابتة قارّة لا تتحرك ولا تتغير ولا تتطور وتتجاوز نفسها. إنها مادية حيوية قارَع فيها العظم أوهامنا القارّة وخرافاتنا الحاكمة لنا والباعثة لعبوديتنا، أو، كما يقول ماركس في بداية “رأس المال”، إنه وخلافاً لبرسيه، كان يحتاج أن يلج الضباب لكي يبرهن عدم وجود وحوش خرافية وألغاز ما بعد طبيعية في الواقع.
تتجلى أصالة العظم واتساق فكره مع نفسه في موقفه من الثورة السوريّة. لا يمكن لماركسي حقيقي ألا يقف مع الثورة ضد الظلم الاجتماعي والفرز الطبقي والتعالي الهرمي المصطنع والقوة الجائرة والديكتاتورية ذات القبضة الفولاذية. على خلاف الكثيرين من المثقفين المزيفين الذين بانت عوراتهم زمن الثورة، والذين كانوا يتغنون بالحداثة والثورة وضرورة التغيير، ثم انقلبوا إلى مواقعهم الأكثر بدائية وطائفية عندما حان موعد التاريخ مع الثورة والتغيير. بغض النظر عن مآلات الثورة اليوم في سوريا، وتداعيات الربيع العربي، إلا أن اتخاذ موقفٍ شجاع مما يحدث كشف ويكشف معدن المثقفين، وأبان لنا أصالة العظم ومعدنه الصافي. ولهذا، وبعد دفاعي عن مادية العظم، لا بد لي من الدفاع عن تاريخه أمام حملات التشويه المستعرة ضده.
بكل أسف، تقترب اليوم حياة المفكر السوري صادق جلال العظم، المادية، من نهايتها، لكن من دون أن تنهي معها روح فلسفته وأفكاره ومواقفه، ومن دون أن تقفل صفحة تاريخه، بل لتخلدها. كأي شخصية عامة مهمة، يثير مرض العظم الذي ابتدأ بتشخيص كتلة سرطانية في الرأس، ثم العملية الجراحية غير الناجحة لإستئصالها، الكثير من القال والقيل والإشاعات في صفحات التواصل الاجتماعي. منذ أكثر من أسبوع، تتوالى نعوات وشائعات موت العظم ورحيله، بينما هو لا يزال في المستشفى، لم يفارق الحياة، ولم تتخلّ هي عنه. في الرحيل، يتكثف الحضور ويتولى كثيرون مهمة “منكر ونكير” قبل حتى إعلان الوفاة. ولعل صادق العظم، الذي ملأ الدنيا وشغل الناس في حياته، قادرٌ أيضاً، لأهميته، على أن يشغلهم ويملأ يومياتهم بخبر رحيله.
والمفارقة الأهم التي تطاول العظم تتمثل في تهمتين متناقضتين، تنشغل الأولى في اتهامه بالإلحاد، بينما تتولى الثانية نعته بالسُّنيّ والإسلاميّ أو حتى الداعشيّ. وفي حين صدرت وتصدر التُّهمُ الأولى عن متعصبين دينيين لم يجدوا في مواجهة معاول العظم الفكرية الهادمة لقناعاتهم، سوى التكفير والفتاوى وهدر الدم والشيطنة، تصدر التهمة الأخرى عن أشخاص لا يقلون تعصباً وعماءً عن الفئة الأولى، وهم وإن لبسوا الثياب المدنية وربطات العنق إلا أنهم يخفون تحتها رشاشات وحذاءً عسكرياً وأسلحة روسيّة. وإذ تُمثل الفئة الأولى، وسأسميها “جماعة منكر”، حشوداً من المكفّرين أصحاب الذقون الطويلة والأفكار المتحجِّرة وحُرّاس الماضي وأعداء الحداثة، فإن الجماعة الثانية “جماعة نكير”، تتمثل في مُدّعي الحداثة ومناصري الثورات نظرياً، ثم المنقلبين على أعقابهم والمتمسكين بطوائفهم وديكتاتورهم، وإن أنكروا ذلك. وإن يكن العظم قد تبنى التهمة الأولى، ولم يتنصل منها حتى هذه اللحظة، فإن الفئة الثانية التي تتهم العظم بعودته إلى حضن الإسلام السنيّ الوهابيّ وتصالحه مع السلفيين والإخوان، ينسون أن العظم لم يغير إلى اليوم موقفه من الوجود والعدم، حتى وهو في أمسّ الحاجة إلى عون روحيّ خارجيّ.
نعم، صدرت عن العظم بعض العبارات التي يمكن أن تُفسّر ـ من قِبل من يحب أن يصطاد في الماء العكر ويتصيد أدنى دليل ليبرر جبنه الشخصي وموقفه المعادي للشعب – بطريقة مُحرّفة. وقد تأكدتُ من موقفه العلماني الذي يحلم بسوريا حرة عادلة علمانية، لكل أهلها، خلال زيارتي الأخيرة له في برلين. فقد كان أول شخص فكرتُ بالاتصال به حين أمضيت أسبوعين في ألمانيا، نهاية شهر آب الماضي. ما إن عرف أني هناك حتى دعاني إلى بيته، وبالفعل لم اتأخر بالذهاب إليه برفقة اخي ودليلي مناف. في بيته، مكان إقامته في ألمانيا، ما ان تدخل الممر حتى تجد نفسك في ساحة مفتوحة بجنينة صغيرة، تذكرك مباشرة بالبيت الدمشقي القديم. أخذني معانقاً بالأحضان كالعادة، وفي صالون الاستقبال الصغير جلست محاطاً بالتاريخ: صادق العظم ومؤلفاته وقد ترجم معظمها إلى لغات عديدة، ثم صُوره وحفلات تكريمه والجوائز العالمية التي حازها.
جلستُ معه مبتدئاً بالسؤال عن صحته ووضعه وجديده، ثم انتقلنا مباشرة بلا مقدمات إلى الجرح السوري، فاتفقنا كثيراً واختلفنا قليلاً، قبل أن يوحدنا الألم. وما إن سألني هو عن جديدي، حتى خضنا في نقاشات فلسفية محضة، جلس معنا فيها جون لوك وكانط وماركس وهيوم وسارتر وادورنو وفوكو ودريدا. كان لقاؤنا ذاك هو المرة الأولى التي نجتمع فيها بعد مشاركتي في ملف حوله، في مجلة “نزوى” العُمانية، وكانت مشاركتي تلك قد أثارته، فتبادلنا على اثرها مجموعة من الرسائل الإلكترونية. هذا، وقد كنتُ دعيت مع العظم، منذ ثلاث سنوات، تقريباً إلى الإجابة على أسئلة طرحتها علينا المجلة الفرنسية/ الألمانية Philosophie Magazine وكان حوارنا محور العدد بعنوان “فيلسوفان سوريان يناقشان الوضع في سوريا”، وقد صدرت باللغتين الفرنسية والألمانية. على خلاف الكثيرين، لا يأتي صادق العظم على ذكر الأصدقاء والمعارف بالسوء، حتى أولئك الذين ناصبوه العداء نتيجة موقفه المساند للثورة السورية.
في زيارتي الثانية له، قبل مغادرتي ألمانيا، اعتذرت منه بعد ساعتين مليئتين بالنقاش والود، لأني يجب أن أقضي بضعة ساعات مع أهلي قبل السفر. حضنني بقوة وأنا أودعه متسائلاً: هل ستكون المرة الأخيرة؟… قلت له: “سنلتقي من جديد بلا شك”. وقال لي عندما هممتُ بالمغادرة: “إبقَ، لا تذهب”… وكنت اقول له في نفسي متوسلاً: “إبقَ، لا تذهب”. وتركته، وتركت وراءنا مشاريع معلقة، كتأليف كتاب حواري مشترك بيني وبينه عن الفلسفة الحديثة والمعاصر
صادق جلال العظم الف تحية وتحية!/ فايز سارة
ليس جديداً، ان يحيي السوريون صادق حلال العظم. فهذا جرى القيام به مرات ومرات، ليس من جانب السوريين فقط، بل من جانب آخرين من العرب والأجانب سواء في اطار التحية الفردية او المؤسساتية. فالرجل قيمة معرفية وعلمية كبيرة، وهو بين القامات السورية العالية، التي وقفت في وجه الاستبداد، وكان مفكراً وباحثاً ومعلماً في النضال الوطني والديمقراطي الذي شغل العالم على مدار عقود، وكان بين الأوائل الذين وقفوا في صف الثورة السورية في مواجهة نظام الاستبداد والقتل.
تحية صادق جلال العظم هذه المرة، وهي إعادة تأكيد واحياء للدور البارز والنشط الذي قام به الرجل على مدار عقود، طرح فيها وعالج من خلال مؤلفاته وكتاباته وابحاثه ومشاركاته في ندوات ومؤتمرات أهم قضايا وتحديات الواقع في ابعاده المحلية والإقليمية والعالمية من موقعه مفكراً وفيلسوفاً ريادياً، ولدوره في التعليم، وقد تتلمذ وتخرج على يديه عشرات آلاف الجامعيين في العديد من الجامعات في سوريا والبلدان العربية والأجنبية ممن لم يكتسبوا العلم والمعرفة منه فقط، بل اكتسبوا منه طرق تعامله الإنساني والديمقراطي، ونعلموا طريقه انخراطه في الفضاء العام وقضاياه، وهذه مزية ربما كانت الأهم فيما تركه الرجل في علاقته مع الآخرين ومع تلامذته بشكل خاص، لان العلم والمعرفة، يمكن ان تكتسب بطرق مختلفة، اما الأخيرة فلا تكتسب الا بالمعايشة والتجربة المباشرة.
كثيرون (وانا منهم) عرفوا صادق جلال العظم من خلال كتاباته، ولاسيما كتبه، والتي جاء بعضها بالمشاركة مع آخرين مختلفين ومتوافقين، ليعطي موضوعاتها مضامين ومحتويات تزيد من أهميتها، وكان الأبرز بين كتبه :دفاعا عن المادية والتاريخ وذهنية التحريم، وما بعد ذهنية التحريم ونقد الفكر الديني، واثر الثورة الفرنسية في فكر النهضة، والاسلام والنزعة الانسانية العلمانية، ثم الاصولية الإسلامية: تحديد نقدى للمشكلات والافكار والمداخل الى جانب كتب أخرى.
غير ان معرفتي الأهم مع الرجل، كانت مع بدء ربيع دمشق في السنوات الأولى من العقد الماضي، والتي توجت بعمل مشترك مع فعاليات ثقافية وسياسية واجتماعية، غلبها هم اخراج سوريا والسوريين من واقع نظام الاستبداد والتخلف الذي كرسه في حياة السوريين وبلدهم، وهو العمل الذي انتج وثيقتي ربيع دمشق: بيان 99 وبيان الالف، قبل ان يتمخض عن التجربة الأهم في لجان احياء المجتمع المدني، وقد لعبت دوراً ريادياً في السعي من اجل تغيير ديمقراطي ومتدرج وسلمي، خوفاً لما كان بين التقديرات في ذهاب نظام الأسد نحو العنف العاري بالصورة التي صارت اليها الكارثة السورية.
صادق جلال العظم، كان في صفوف كوكبة السوريين، التي وضعت ملامح المسار الوطني الديمقراطي وتحولانه في سوريا، ثم ذهبت الى الابعد من القول وصولاً الى الممارسة، ومن السر الى العلانية، ومن الانغلاق على الذات النخبوية وما حولها وصولاً الى الفضاء العام بمافيه من مواطنين لتعزيز احساسهم بالمواطنة والمساواة والإصرار على الذهاب نحو الحرية باعتبارها قيمة عليا للإنسان وموجهاً اساسياً في حياته.
في ذاكرة تلك الأيام كثير من تفاصيل وحيثيات عن الطموحات والاهداف، عن الموضوعات والنقاشات الجارية حولها، عن الأصدقاء وعن المعاناة، التي كانت تحيط بهم من نظام الاستبداد واجهزته، وكثير منها كان بيت صادق في المهاجرين احد مسارح مجرياتها… الراحلة فوز، والعزيزة ايمان كانتا بين شهود تلك المرحلة، التي اعطى فيها صادق كثير من وقته وجهده لاغنائها مع أعزاء آخرين من اجل سوريا حرة رغم ما أحاط بالسوريين وبلدهم من كوارث، لن تمنع مجيء التغيير الذين حلم به صادق جلال العظم وعمل على تحق
نبذ أصوله الإقطاعية وحمل راية العلمانية/ خليل صويلح
كنّا ننظر باطمئنان إلى علمانية صادق جلال العظم (1934- 2016)، بوصفها سراجاً مضيئاً في عتمة النفق الضيّق للفكر العربي. نتأمل بإعجاب وتبجيل أفكاره الراديكالية في المادية والتاريخ والحب العذري. ها هو مفكر سوري مثير للجدل، سجالي من طرازٍ خاص، ارستقراطي بمعطف ماركسي حاضر بيننا، نستظل بقامته العالية ونتكئ إلى حكمته وبريق اسمه النافر، فنحن إزاء أكاديمي بمواصفات استثنائية بحق لطالما حطّم الأسوار العالية للجامعة المغلقة على الأفكار اليقينية.
وكنّا نعيد حادثة رواها ذات مرة كدليل إرشادي إلى أصالة الفكرة. حضر الفيلسوف السوري إلى «مطعم قصر النبلاء» الراقي في وسط دمشق، ملبياً دعوة على العشاء بسيارته القديمة المتهالكة. بدا بالنسبة إلى حارس المكان كما لو أنه أخطأ العنوان، وسط قافلة السيارات الفخمة لعلية القوم. وحين أدرك ارتباك الحارس، قال له وهو يبرز بطاقة الدعوة «بالمناسبة أنا النبيل الوحيد بين كل هؤلاء المدعوين».
وكنّا نذهب إلى «الأسبوع الثقافي» الذي يستضيفه قسم الفلسفة، ربيع كل عام، في أروقة جامعة دمشق، في تسعينيات القرن المنصرم، بوصفه أبرز العلامات على حيوية الثقافة السورية وتنوّعها في تلك الفترة العاصفة. ارتبط نجاح هذا الأسبوع الاستثنائي باسم صادق جلال العظم الذي كان يرأس قسم الفلسفة، وكوكبة من الأكاديميين والمفكرين السوريين والعرب، قبل أن تنزلق الندوات الساخنة تدريجاً نحو أسئلة أقل وطأة وجاذبية بحكم محاصرته وخنق رحابته الفكرية، لاختراقه الخطوط الحمر في سجالاته حول الإسلام السياسي، وعلم الاجتماع، والاقتصاد، بمساهمة مفكرين ونقّاد من طراز طيب تيزيني، وحسن حنفي، وحليم بركات، ونايف بلّوز، وعادل العوا، وعبد الرحمن منيف، وجورج طرابيشي، ومحمد سعيد العشماوي، وأحمد برقاوي، وفيصل درّاج، وآخرين.
فكّك المنظومة الدينية والإيديولوجيا الغيبية
هكذا انطفأ النقاش فجأة، وفرغت مدرجات الجامعة العريقة من جمهورها النوعي. من جهته، انشغل العظم لاحقاً بسجالات لا تقل حيوية عمّا سبقها. في تلك الفترة، برزت قضية تكفير سلمان رشدي إثر صدور روايته «الآيات الشيطانية» وما أثارته من ردود فعل غاضبة، وإذا بهذا المفكّر الإشكالي يجد في هذه القضية «فضيحة أدبية كبرى»، مراهناً على العقل المغاير في تفكيك سطوة المقدّس، بصرف النظر عن أدبية الرواية أو لا أدبيتها. لكن كتيبة «ذهنيّة التحريم»، وفقاً لعنوان أحد كتبه، ستنتفض بعنف داعيةً إلى هدر دم الروائي البريطاني/ الهندي، وسوف تشمل حملة التكفير العظم نفسه بوصفه ملحداً ومهرطقاً. لكنه سيشق طريقه نحو أسئلة أخرى أكثر جذريّة مساجلاً إدوارد سعيد في «الاستشراق والاستشراق معكوساً» تارةً، ثم أدونيس في «النقد المنفلت من عقاله» ردّاً على مقاله «العقل المعتقل» طوراً، بالإضافة إلى نقاشات مثيرة حول «أحوال التخلّف والمتخلفين»، و«الغزو الثقافي»، و«العولمة». تكمن مساهمة صاحب «عسر الحداثة والتنوير في الإسلام» في إشعال الموقد بحطب الآخرين، أو عبر «نصّ الآخر»، أكثر منها أفكاراً مبتكرة، بنجاحات متفاوتة في اختراق الفضاء العام، متكئاً في أطروحاته على العلم في مواجهة الخرافة، خصوصاً في كتابه الإشكالي «نقد الفكر الديني» (1969). هذا الكتاب وضع اسمه في مكانةٍ مرموقة كأحد المنافحين عن المنهج العلمي في تفكيك المنظومة الدينية و الأيديولوجيا الغيبية، نافياً عن الدين روحانيته الخالصة، وهو ما وضعه في مهب عاصفة من الانتقادات السلفيّة إلى درجة فصله من الجامعة الأميركية في بيروت ومحاكمته وسجنه فترة بسيطة، قبل أن يغادر عاصمة الثقافة العربية، على خلفية أطروحاته المضادة للمزاج الشعبي في رؤيته للدين الإسلامي. هكذا كان سؤال «ألم تقرأ كتاب نقد الفكر الديني؟» نوعاً من الاتهام بالقصور المعرفي لمن لم يطّلع عليه، أقله بالنسبة لجيلي السبعينيات والثمانينيات. كتابه «النقد الذاتي بعد الهزيمة» (1968) كان أول بحث عربي يستخدم تعبير «الهزيمة» لوصف ما حدث في حرب حزيران 67 بدلاً من عبارة «النكسة» التي كانت دخلت حقل التداول الرسمي والفكري والشعبي بغرض تمويه الحقيقة المفجعة، موضحاً أنّ نزعة إزاحة المسؤولية عن الذات، وإسقاطها على الآخر، نزعة متأصلة تدخل في بنيان المجتمع العربي التقليدي. وقد بلغ الشطط ببعضهم إلى اعتبار الهزيمة نكبة إلهية. من كانط، إلى هنري بيرغسون، إلى ماركس، رحلة طويلة قطعها المفكر السوري الذي نبذ قيم عائلته الإقطاعية لينخرط في ذاتٍ أخرى، حاملاً راية العلمانية كفضاءٍ بديل من الأمراض المستعصية والبثور التي تثقل تطلعات المجتمع العربي نحو لحظة تنويرية تلحقه بالعقلانية الكونيّة. بهبوب ريح الانتفاضات العربية، انخرط صادق جلال العظم بأسئلة الثورات، وصولاً إلى خندقٍ آخر يتعلّق بموقفه من الحركات الإسلامية، بارتحالات مضادة، ناسفاً أطروحته الأساسية عن إجهاض العقل لمصلحة اليقين الغيبي. إذ بدأت تتسرّب إلى نقاشاته مصطلحات لا تتواءم مع أطروحاته القديمة، من طراز «مظلومية السنّة»، و«العلوية السياسية»، والبعد الطائفي للصراع في سوريا، معوّلاً على ثورة تطيح بالأنظمة القديمة بصيغتها المافيوزية، مهما كانت مآلات هذا الصراع، لكنه يستدرك موضحاً غرضه من هذا الطرح بقوله «المقصود هو التقاط جانب هام وحاسم من الواقع السوري الراهن على مستوى التجريد الذهني. هذا مطلوب لأني لاحظت أن المناقشات العلنية للثورة السورية تأبى التطرق لمشكلات الطائفية والمذهبية والإثنية والأكثرية والأقلية، خوفاً من صب الزيت على النار، في حين أن أحاديث الجلسات الخاصة والمناقشات المغلقة لا تدور إلا حول هذه المواضيع».
كما ستتخذ سجالاته مع أدونيس حول الانتفاضة السورية بعداً طائفياً، أو إنها فُسّرت كذلك، متهماً إياه بمناهضة الحراك الشعبي وتخليه عن الشعار الذي أطلقه في مجلة «مواقف» حول الحرية والتفكير والإبداع، لمصلحة خطاب «يتلعثم ويتأتئ ويفأفئ، وبدلاً من أن يكون خطاباً واضحاً وصريحاً، أخذ شكل: نعم ولكن أو نعم وإنما». لكن العظم نفسه وقع في المغطس نفسه، خصوصاً في ما يتعلّق بموقفه المستجد من الحركات الإسلامية القروسطية، واستدارته المباغتة في مديح هذا الخطاب والتعويل على التنظيمات الإسلامية المسلّحة التي كان يصفها بالأيديولوجيا الرجعية، بصناعة ثورات التغيير ضد أنظمة الاستبداد، بغياب شبه تام للنبرة اليسارية التي دمغت مساره. كان بإمكاننا بلع عبارة مثل «مظلومية السنّة» لو أن من نطقها تربّى في مدرسة ابن تيمية مثلاً. أما أن يتبناها ماركسي عتيق بمقام صادق جلال العظم، مستأنساً بخطاب شعبوي/ ليبرالي، أفرزته عشوائية الانتفاضات نفسها، فإن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، أقله وضع كتابه «نقد الفكر الديني» في الرفوف الخلفية للمكتبة، وربما رفعه إلى «السقيفة»، بجانب الكتب التي لم تعد مناسبة للقراءة الراهنة، فيما سيبقى خلافه مع أدونيس حول أهمية التاء المربوطة (جامع/ جامعة) في صناعة الثورات، معلّقاً في فراغٍ سديمي بلا أفق، بما يقع في باب محنة العقل العربي. رحل صاحب «ما بعد ذهنية التحريم» بعد تتويجه بوسام «غوته» الألماني، من دون أن تتوقف المعركة بين مريديه وخصومه حول مواقفه الأخيرة مما يحدث في بلاده. هكذا تلتقي الأرض مع السماء في نهاية الرحلة بقراءة الفاتحة على روح الغائب. لعلها معضلة المثقف العربي: أن تخلع معطف ماركس وتتدثّر برداء الطواف!
صادق جلال العظم الذي رحل كما لو أنّه قُتل/ حازم صاغية
يبدو رحيل صادق جلال العظم أشبه بالقتل. فالمثقّف الذي آمن بالعقلانيّة ودافع عنها، إنّما رحل عن عالمنا فيما اللاعقلانيّة توالي الانتصارات وتراكمها على مدى المعمورة. والفيلسوف الذي ساجل دفاعاً عن الحرّيّة، وعن ثورة شعبه السوريّ حين هبّ مطالباً بهذه الحرّيّة، غادرنا فيما الاستبداد يرفع أعلامه على جثّة بلده. والناشط الذي كره الاستعمار، ودّع هذه الدنيا بينما الاستعماران الروسيّ والإيرانيّ ينهشان مدينة حلب، جوهرة المشرق العربيّ والشرق الأوسط.
انضمّ صادق جلال العظم إلى كوكبة من المثقّفين السوريّين الكبار كان في عدادهم ياسين الحافظ وجورج طرابيشي. وهم جميعاً رحلوا بعيداً عن بلدهم، لاجئين ومنفيّين، يكمّلون تقليداً سبقهم إليه آخرون اختُزلت حياتهم وأعمالهم في قائد واحد لخّص السوريّين جميعاً وامتلك الحاضر والأبد في آن.
بيد أنّ خصوصيّة العظم كانت ذات وجهين: فهو أكثر زملائه ومجايليه صلة بمجريات الحياة الثقافيّة والفكريّة في أوروبا الغربيّة والولايات المتّحدة ومتابعةً لهمومها، وأهمّ من ذلك أنّه كان أكثرهم ربطاً بين العقلانيّة والحداثة من جهة ومقاومة الاستبداد، العسكريّ والأمنيّ والعقائديّ، من جهة أخرى. ذاك أنّ العقلانيّة والحداثة والعلمانيّة تبقى هواء ساخناً وضجيجاً لفظيّاً من دون الحرّيّة التي هي وحدها طريق الكرامة الإنسانيّة.
صادق جلال العظم الذي توفّي في مستشفى برلينيّ عن 82 عاماً، بعد صراع مع المرض، ينتسب إلى أكثر العائلات الدمشقيّة والسوريّة قِدماً وانخراطاً في التاريخ المحلّيّ لبلدها وللمشرق. لقد درس الفلسفة في الولايات المتّحدة الأميركيّة وأعدّ أطروحة عن عمانوئيل كانط، ثمّ مارس التدريس هناك قبل أن ينتقل إلى الجامعة الأميركيّة ببيروت ومنها إلى جامعة دمشق. وقد ذاع صيته خصوصاً مع كتابه الشهير والبالغ التأثير «النقد الذاتيّ بعد الهزيمة» الذي صدر في 1968. لكنّ العظم ترك كتباً أخرى تناولت جوانب من الحياة والثقافة العربيّتين، كـ «في الحبّ والحبّ العذريّ» و»دراسات يساريّة حول القضيّة الفلسطينيّة» و»الاستشراق والاستشراق معكوساً» و»ما بعد ذهنيّة التحريم». وفيها جميعاً تحدّى المحرّمات وعمل على دحضها، بما يخدم تحرّر الوعي والإرادة الإنسانيّين ويحاصر أنماط التفكير القروسطيّ والمتعصّب.
وفي كتابه الحواريّ الضخم «دفاعاً عن الماديّة والتاريخ»، تبدّى ثراء وعيه وإلمامه الفلسفيّين، كما تبدّى تمسّكه الصارم بالعقل والعقلانيّة وفكرة التقدّم. ومن الزاوية هذه حصراً، انتمى إلى ماركسيّة لا يشوبها شيء من الشعبويّة التي تمكّنت تباعاً من أشكال الماركسيّة الشائعة.
وهو، بعد عضويّته في هيئة تحرير مجلّة «خمسين»، ومجلس إدارة «المنظّمة السوريّة لحقوق الإنسان»، وهيئة جائزة «الأمير كلاوس» الهولنديّة، انتُخب في سنواته الأخيرة رئيساً لـ «رابطة الكتّاب السوريّين» التي واكبت الثورة وعبّرت عن الرغبة العميقة في تحرير العمل الثقافيّ من وصاية السلطة ومصادرتها. عاش العظم قناعاته التي لم يكفّ عن تغذيتها بالمعارف التي تستجدّ، كما لو أنّه تلميذ دائم. وهذا ما جعله قادراً، هو السبعينيّ ثمّ الثمانينيّ، على مصادقة أجيال شابّة تدين كلّها له ببعض ما تعلّمت وعرفت. عاش هذا الأريستوقراطيّ المنحاز إلى ما ظنّه مُحقّاً وعادلاً بكثير من التواضع والدماثة، ولسوف يتمّ تذكّره بكثير من الإقرار والعرفان اللذين لم يطلبهما بتاتاً لنفسه.
الحياة
الدمشقي الذي غاب في منفاه/ صقر أبو فخر
صادق جلال العظم هو، في الأساس، أستاذ للفلسفة. لكن، من بين جميع مؤلفاته لا نعثر، خلا أطروحته عن كانط، إلا على كتاب واحد في الفلسفة هو: “دراسات في الفلسفة المعاصرة” (1981)، وهو عبارة عن محاضرات أملاها على تلامذته في جامعة دمشق. ثم تمكن صديقنا قيصر عفيف من إرغامه على إجراء حوار مطوّل وممتاز معه، وأصدره في كتاب بعنوان: “دفاعًا عن المادية والتاريخ” (1987). غير أن إطلالة العظم الفكرية كانت مدوّية منذ البداية حين أصدر في بيروت سنة 1968 كتابه “النقد الذاتي بعد الهزيمة”، ثم أتبعه بكتابه الذائع الصيت “نقد الفكر الديني” (1968)، ليصبح في أقل من عاميْن أحد أبرز المثقفين العرب في المشرق العربي، الأمر الذي جعل الملحق الثقافي لجريدة “النهار” يفرد له غلاف أحد أعداده وعليه عبارة “الدمشقي الكافر”. ودائمًا، حين كان اسم صادق جلال العظم يطرق الأسماع، سرعان ما يخطر في البال ذلك المفكر الذي ظل حتى آخر يوم من حياته (مواليد دمشق 1934) يدافع عن “القضايا الخاسرة” مثل دفاعه عن إبليس، ودفاعه عن المادية الماركسية، ودفاعه عن الروائي البريطاني، الهندي الأصل، سلمان رشدي. ومهما يكن الأمر، فإن صادق العظم كان أحد ألمع الكُتّاب العرب الذين نجحوا في إثارة الدبابير من أعشاشها، وشرع في تحطيم الأيقونات السياسية العربية بعد هزيمة الخامس من حزيران /يونيو 1967 كالماركسية والناصرية والبعث والخرافة والدين. وفوق ذلك، اندرج صادق العظم وكتاباته في سياق الحداثة والتقدّم والنهضة ومقارعة الاستبداد والدفاع عن الحرية والديمقراطية والعلمانية. ولعلنا نجد في سيرته، وسيرة عائلته، البدايات التأسيسية التي جعلته مفكّرًا حرًّا وتقدّميًا وعلمانيًا في الوقت نفسه.
البدايات الأولى
عاش صادق جلال العظم في دمشق في منزل غابت عنه التنشئة التقليدية، وحضرت فيه عناصر النزوع إلى التجديد والعصرنة. فوالده جلال درس في اسطمبول، وأمضى ردحًا من أيامه في باريس، وانغمر في قيم الحركة الكمالية، وكان الوحيد من آل العظم الذي أيّد الوحدة السورية-المصرية لأنه رأى في جمال عبد االناصر ما يذكّره بمصطفى كمال (أتاتورك). أما والدته نزيهة العظم، فقد أصابت قدرًا مهمًا من الثقافة بمعايير بدايات القرن العشرين، فكانت تتقن التركية وبعض الفرنسية، وترسم، وتدافع عن السفور.
يروي صادق العظم أن منزل جدّه صادق العظم، وهو منزل كبير كان يقع في منطقة الجسر الأبيض في دمشق، حينما هُدم، لم يتأثر على الإطلاق، مع أن مثل هذا البيت يكون في العادة مخزنًا لذكريات الطفولة وشقاوتها. واكتشف لاحقًا، أن هذا الشعور بعدم المبالاة انتقل إليه من والدته التي عاشت في هذا البيت وكرهته، وكثيرًا ما رغبت في الانعتاق منه والخروج من التقليد إلى الحداثة، بل العبور من القهر والقمع والرقابة إلى رحاب التحرّر والانطلاق. وفي هذا البيت، لم يكن أحد يصلّي أو يصوم، لكن الجميع كان متديّنًا إلى حدّ ما. غير أن تديّن الارستقراطية الشامية ليس مثل تديّن الشعب. فالتديّن الارستقراطي يميل إلى أن يكون عمليًا ولصيقًا بالسلطة والقوة، وهو مرن بحسب المصالح وتقلّبات الأحوال. فالتقوى الزائدة لا نجدها عند الارستقراطية، بل ربما نجد لديها الميل إلى التسلّط، وهو نوع من تأكيد السيطرة؛ والدين يخدمها في هذا المجال. لكن في حقل المصالح، فالدين هو الذي يتكيّف معها وليس العكس. أما رجال الدين في شبكة هذه العلاقات فهم أدوات وصل بين الأقوياء وعامة الناس… لذلك يجب إكرامهم وإطعامهم ومراعاتهم وكسبهم، لكن من غير محبة خاصة لهم.
لعل هذا المناخ الذي عاش فيه صادق جلال العظم في دمشق نجّاه من الأزمات الفكرية والوجدانية التي عصفت بكثير من الشبان السوريين الذين نشأوا على التديّن وعلى التربية الإسلامية التقليدية، ثم انخرطوا، لاحقًا، في التيارات القومية العلمانية واليسارية، ومهّد له الطريق كي يتفتح وعيه السياسي بحرية؛ هذا الوعي الذي تأثر، في البداية، بأفكار أنطون سعادة، ثم بجمال عبد الناصر إبان حرب السويس سنة 1956. أما الماركسية فجاءت إليه كمحصلة طبيعية لقراءاته جون لوك وجون ستيوارت ميل وريكاردو وهيوم وجان جاك روسو، علاوة على الفكر الاجتماعي والسياسي الأوروبي.
تخرّج صادق العظم في جامعة “ييل”، وكانت أطروحته في الفلسفة عن كانط. لكن أستاذ الفلسفة لم يشتغل في الفلسفة في ما بعد، بل انهمك في السياسة وفي الفكر السياسي معًا. وبقيت صلته بالفلسفة مقصورة على التدريس، فضلًا عن كتابين فقط: “دفاعًا عن المادية والتاريخ” (1987)، و”دراسات في الفلسفة المعاصرة” (1981).
أطلّ صادق العظم على العالم العربي في سنة 1968 إطلالة مدوّية. ففي تلك السنة أصدر كتابه “النقد الذاتي بعد الهزيمة” الذي كان سببًا من أسباب فصله من الجامعة الأميركية في بيروت لاحتوائه مواقف معادية للسياسة الأميركية في بلادنا العربية. وكان لشارل مالك شأن انتهازي في فصله من الجامعة لأن صادق العظم نشر مقالة في جريدة “النهار” (شباط 1967) بعنوان: “الله والإسلام في الجامعة الأميركية” انتقد فيها مؤتمرًا هزيلًا عقده شارل مالك بعنوان: “الله والإنسان في الفكر الإسلامي المعاصر” ووظّفه في خدمة “الحلف الإسلامي” الذي كان معاديًا آنذاك للرئيس جمال عبد الناصر.
لم تحرفه الفلسفة والسياسة عن الأدب. لكن الأدب كان مصدرًا من مصادر التفكير لدى صادق العظم، ومرجعًا لبرهان أفكاره. فعندما درس نيتشه وجد في روايات دوستويفسكي تأكيدًا محسوسًا لأفكار صاحب “هكذا تكلّم زرادشت”. وعندما تناول أدب سلمان رشدي رأى فيه أدبًا من الممكن مقارنته بأدب “فرانسوا رابليه”. وكان لزوجته فوز طوقان الأثر الكبير في تقريبه من الأدب العالمي، حتى صار “يتخانق” مع زوجته بلغة الأدب. مرة صاح بها: “أتظنّنين أنك ميديا؟”، وهي عبارة من مسرحية يوربيدس المعروفة. وفي إحدى المرات صرخت به: شو مفكّر حالك طالع من مسرحية دونجوان؟” (إحدى مسرحيات موليير). وعلى الرغم من ذلك، ظلّت لغة الفيلسوف ولغة المفكّر متغلّبة على لغة الأدب لديه. وكان أصدقاؤه يتندّرون عليه بالقول: لو أراد صادق العظم أن يكتب رسالة غرام إلى حبيبته لكتبها كما يلي: “أحبّكِ للأسباب التالية: أولاً…، ثانيًا…، ثالثًا…”.
الفكر السجالي
استخدم صادق العظم السجال أسلوبًا لمنازلاته الفكرية. فكان يعمد إلى تفكيك منهج الخصم ثم ينقض عليه فيطيح مقولاته. وسجاله مع إدوارد سعيد عن “الاستشراق” يستعاد اليوم لمصلحة صادق العظم، لأن كتاب “الاستشراق” خدم، في بعض جوانبه التفسيرية، المقولات السلفية المعادية للغرب بالجملة. وقد مهّد دفاعه عن إبليس في “نقد الفكر الديني” الطريق لظهور كتب شديدة الجرأة في هذا الميدان مثل كتابات نصر حامد أبو زيد أو حتى محمد شحرور في “الكتاب والقرآن”. وفي دفاعه عن إبليس أعاد النظر في هذه التراجيديا، ورغب في البرهان عن أن الأدب العربي القديم ليس خاليًا من الملاحم على غرار الملاحم الإغريقية، وأن قصة إبليس هي تراجيديا حقيقية. وكان من نتيجة هذا الكتاب أن اوقف صاحبه في 19 كانون الأول 1969، وأدخل إلى السجن في 8 كانون الثاني 1970، ثم أخلي سبيله في 15 كانون الثاني 1970، وحوكم في 27 من الشهر ذاته، وصدر الحكم بردّ الدعوى في 7 تموز 1970. وكان معه في الدعوى الكاتب والناشر المعروف بشير الداعوق. ومن مفارقات ذلك الزمان أن صادق العظم كان الكاتب الوحيد على الأرجح الذي فرّ من العسف في لبنان ليلتجئ إلى سورية، بينما كانت العادة أن يفرّ السياسيون والعسكريون المهزومون جراء انقلاباتهم من سورية إلى لبنان. غير أن موقفه من المادية في كتابه الحواري “دفاعًا عن المادية والتاريخ” الذي حاوره فيه قيصر عفيف كان دفاعًا مزدوجًا: دفاع عن الفكر النقدي التاريخي في تناول الرأسمالية، ودفاع عن المادية استنادًا إلى الفلسفة الحديثة وإلى الثورة العلمية المعاصرة. وفوق ذلك كان دفاعًا عن المادية الماركسية حين تخلّى عنها معظم الشيوعيين. ودافع أيضًا عن سلمان رشدي. ولعلّ صادق العظم كان الوحيد في العالم العربي الذي لم يدافع عن سلمان رشدي فحسب في كتابه “ذهنية التحريم”، بل فضح الكتاب والنقاد العرب الذين تصدّوا لرواية “الآيات الشيطانية” من غير أن يقرأوا هذه الرواية، وكرّس لهذه الغاية كتابًا بعنوان: ” ما بعد ذهنية التحريم”.
الحياة الثقافية في لبنان، وفي العالم العربي، مدينة لصادق جلال العظم ببعض توهّجها وحيويتها منذ أن هبط مدينة بيروت قادمًا من دمشق في منتصف ستينيات القرن العشرين. وفي أرجاء بيروت أشعل كثيرًا من المعارك النقدية، وأدمن مناكفة السلطات السياسية والدينية. ومن مآسي الزمن العربي، كما يلوح لي، أن بلادنا العربية، بعد نحو خمسين سنة على ظهور جيل صادق العظم، ما برحت تئنّ تحت معضلاتها التي لا تنتهي، والجاثمة فوقها كأهرام الجيزة. وبعد مئة وخمسين سنة من التنوير، ها هي قضايا السفور والحجاب والاختلاط وعمل المرأة تعود إلى حقل السجال الفكري، كأن هذه البلاد المبتلاة بالتحجّر والجمود ما زالت تسير إلى الوراء، وكأن كتابات التنويريين العرب، أمثال صادق العظم، لم تتمكّن من شق الصخور العربية الراسية كالجبال.
الرحيل النبيل/ أحمد برقاوي
أفرد صادق العظم جناحيه للريح وطار إلى حيث عدم الجسد الأبدي، وترك لنا عقله الجسور مضيئاً في عالم يريده الطغاة معتماً وطار. رحل الذي لم يفكر يوماً إلا بما يجب أن تكون عليه الحياة، بما يجب أن تكون عليه الأوطان والإنسان.
أجل صادق مفكر الممكن بامتياز، ولهذا ظلت عيناه نحو المستقبل، وظلت روحه مفعمة بالأمل. ولهذا اختار عين الناقد لما هو كائن، نقد الواقع ونقد الوعي منحازاً دون تردد إلى الحقيقة كما يراها وبارتباط بمصير الكائن. فحق القول إنه مفكر الاختلاف مع الواقع ومع الوعي الذي لا يراه خارج المايجب أن يكون.
رحل الصديق صادق الذي خضنا معاً أشرس معارك الفكر ضد النكوص والاستبداد، واختلفنا في الما يجب، ولم يزدنا الاختلاف إلا صداقة وحميمة معشرية ووحدة في الخطوط الكبرى.
عرفته زميلاً في قسم الفلسفة، ورئيساً له، فكان نبيلاً في سلوكه العلمي والإداري وحين أحيل إلى التقاعد خسر قسم الفلسفة أحد أهم أساتذته الكبار. منذ أن اندلعت ثورة تونس أعلن انحيازه لهدم هذا الواقع الفج والمخيف والمعادي للإنسان. انحاز إلى الساحة ضد القصر وكم كان سعيداً بمقالي «الساحة والقصر» وهتف لي من بيروت يومها وقال لي: أجل يا أحمد هي المعركة بين الساحة والقصر. وحين فجر السوري ثورته زود نار الثورة بوقودها الفكري والعاطفي بأعلى درجات الراديكالية النبيلة.
والراديكالية في الانتماء والقول والتعبير الثورية ضد الاستبداد والوسخ التاريخي، هي بالنسبة للفلسفة الأمر المطابق لها والموقف الذي يليق بها، ولهذا فليس أمام الفيلسوف إلا الانتماء إلى ثورة الحرية لأن في ذلك انتماء إلى ذاته وإلى روح الفلسفة. ولهذا كان رحيله رحيلاً نبيلاً. أجل رحل صادق في ذروة أنواره.
وداعاً يا صديقي وداعاً يا صديقي.
٭ أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق
القدس العربي
غيابك حضور جديد في الوجدان/ أحمد برقاوي
ورحل صادق، رحل بكل ما يختزن من آمال كبيرة ومن تمرد الأنا الكلي على العالم، رحل صادق ممتلئا بثورة السوري بكل صلابة وقوة، رحل الصديق الذي لم يغادرني ولم أغادره حتى حين تقطعت بنا سبل اللقاء وتشردنا في منافي الأرض، رحل الزميل الذي ملأ قسم الفلسفة بالحياة. رحل الذي واجه الموت بموقف الفيلسوف وبقهقهة الطفل قبل أن يدخل مبضع الجراح إلى رأسه المشع: إنها الثمانون يا أحمد. قالها لي على الهاتف قبل يوم من دخوله المشفى.
رحل صادق وهو يقتحم أشد الحصون المعادية للإنسان: لاهوت نفي الذات والاستبداد بكل ما يمتلك من حب للحياة، الحياة لكل أبناء الحياة. رحل صادق المتأفف من نقص العالم، الزاهد بالسلعة، والثري بالفكرة، المعتد بانتمائه الشامي حتى العظم. أجل خاض صديقي غمار النقد متأففا من نقص الوجود وآملا بما يجب أن يكون عليه الوجود وأحواله. من ماركسيته المدافعة عن العدالة، إلى عقلانيته المهجوسة بالتفكير، إلى علمانيته صورة للحكم إلى علميته طريقا للتقدم إلى إيمانه بالحرية نمط وجود للإنسان.
تجربة من العمر طويلة قضيناها معا يا صديقي، عرفتنا مدرجات كلية الآداب معا، جلسات التفكر والتفكير بمصيرنا معا، التسكع في مطاعم دمشق معا، الحوارات الحارة معا، الشعور المتبادل بالهم الفردي والهم الكلي، حاضرنا معا في عموم البلاد، ضحكنا معا، وحزنا معا، وتمردنا معا. تناقدنا؛ قسوت عليّ وقسوت عليك بالكلام، بالكلام الذي صار إرثا لا يفنى في كتابيك ذهنية التحريم وما بعد ذهنية التحريم وفي كتابي أسرى الوهم كنّا مثالا في الروح الطليقة والمحبة، بل زادنا النقد المتبادل قربا من بعضنا.
عمر قضيناه معا. سيذكر بيتك في المهاجرين المطل على جبل قاسيون السليب تلك اللقاءات الطويلة ونحن نحضر لأسابيع الفلسفة التي أردناها لحظة في تشكيل الوعي التنويري. سنوات أربع كان قسم الفلسفة فيها وأنت تحمل مسؤولية رئاسته، منبعا ثرا للأفكار، وحين أحس المستبدون بخطورة ما نقوم به اغتالوه. حلمنا معا يا صديقي بسوريا الخالية من الوسخ التاريخي وانتمينا معا إلى روح الشعب الثائر واغتربنا معا. روحك الوقاد لم يهن ولم يدخله القنوط أو اليأس، بل كلما زادوا همجية ازددت إيمانا بقوة الشعب السوري وثورته وتحقيق مصيره المنشود.
صادق أيها الشامي السوري/ الفلسطيني، يا من كانت فلسطين همك الكلي ممارسة نظرية وممارسة عملية، سيبكيك زيتون الجليل كما ياسمين دمشق. وستخلد ذكراك نفوس الأجيال العربية مدافعا قويا عن الحياة والحق والحريّة. صادق لن تغيب أبدا. بل غيابك حضور جديد في الوجدان. وداعا يا صديقي يا من رحلت رافع الرأس ثائرا لا يلين.
العرب
إِنَّمـا المَـرءُ حَـديـثٌ بَـعـدَهُ
تونس ـ «القدس العربي»: بجرأةِ الموقف ووجاهةِ الفكرة تمكّن صادق جلال العظم، من أنْ يَسِمَ حضورَه في عصرِه بمَيْسَم المثقّف الملتحم بقضايا مجموعته الاجتماعية، والمتحمّل مسؤولية إنارة طريقها إلى الحق والعدل والحرية.
فقد لاذ بجرأة السؤال سبيلا إلى تفكيك بنية التصوّرات الحاكمة لمعيش المواطن العربيّ، وامتلك من المغامرة البحثية ما أنجز به قطيعة معرفية مع مدوّنة التراث الفكريّ بكلّ حمولاته التقديسية، حيث أخضع نصوصَه الكبرى لقراءة جديدة كان سعيُه فيها مُنصبًّا على تخليص فهمنا لتلك النصوص من شوائب النقل والشعوذة والاتجار بمعانيها، وعلى جعلها منفتحة بوعي حادٍّ على حضارة الراهن بكل خطاباته العلمية والثقافية والسياسية والاجتماعية، انفتاحَ التفاعل والمشاركة لا انفتاح الخضوع والتسليم، وهو ما نُلفي له صورةً جليّة في كلّ نتاجه الفكريّ كُتُبًا ومحاضراتٍ وأحاديثَ صحافيةً.
وما لا شكّ فيه أنّ مفكِّرًا بهذه المواصفاتِ سيؤثّر كثيرا في سردية عصره، وستمثّل أفكارُه فيها قوّةَ دفعٍ لحركة الواقع، بل ولحركة المتخيَّلِ، قوّةَ دفعٍ مُسَاعِدةً على تحقيق نهوضٍ للناسِ ماديٍّ وجماليٍّ. ولعلّ في الشذرات الصحافية الموالية التي كتبها عنه مثقفون قرأوا له أو استمعوا إليه ما يؤكّد وجاهة أفكاره وقدرتها خلق السجال والدفع بموضوعاته إلى أقصى حدودها: إلى اليقين. فقد ذهب ياسين الحاج صالح إلى القول، إنّ انشغال العظم بالشؤون العامة رافقه منذ البدايات المبكرة التالية لهزيمة حزيران/يونيو، وإن تبدل شكله: انشغال يساري وفلسطيني وقومي عربي في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، ثم انشغال ثقافي عقلاني وعلماني في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته، ثم انشغال ديمقراطي وليبرالي في السنوات المنقضية من هذا القرن. صادق سياسي أكثر في مرحلتيه الأولى والثالثة، وإن يكن عربياً أساساً في المرحلة الأولى التي كانت زمن صعود وأزمة الحركة القومية العربية، وسورياً أكثر في المرحلة الثالثة، التي شهدت مشاركة عملية من طرفه في «ربيع دمشق» ومنتدياته، وفي عمل «لجان أحياء المجتمع المدني»، وفي توقيع بيانات المثقفين السوريين وعرائضهم الداعية إلى إصلاحات ديمقراطية. في المرحلة الثانية، العقدين الأخيرين من القرن العشرين، كان تدخل صادق ثقافيا أكثر. وقتها، كان العالم العربي يوغل في ظلمة الطغيان من جهة، وكانت الماركسية، وهي الركن الأساسي في هوية صادق الفكرية، في حال مضعضعة بفعل تداعي الشيوعية. الثقافة صارت الملاذ المختار للمثقفين. وتحدّث خالد الحروب عن فَرَحِ صادق جلال العظم بالربيع العربي واحتفائه به فكريا ووجدانيا وسياسياً، لكونه رأى فيه عودة السياسة إلى الناس، وعودة الناس إلى السياسة بعد عقود طويلة من الجمود والاستبداد. ويضيف الحروب قوله إن العظم رفض الاستقرار الظاهري الذي يتفاخر بإحلاله الاستبداد وسماه «استقرار القبور». رأى في لحظة «ميدان التحرير» عودة التاريخ إلى المنطقة، وظل متفائلا حتى اللحظة، ورغم كل السوداوية التي هبطت على الثورة الأقسى في بلاده سوريا. وعن سوريا نفسها كتب ونطق بأجرأ ما قد ينطق به مثقف في موقعه.
وقال محمد راتب الحلاق إنّ هذا النمط من المفكرين إن لم ينجح في محاولاته كلها (ولا يضيره في شيء ألاّ ينجح) فيكفيه شرف المحاولة. ويعود إلى هؤلاء فضل استدعاء المكبوت واللامفكر فيه والمقموع من الأفكار والقيم والممارسات إلى ساحات الحوار والسجال والجدال، ما يدفع الأطراف جميعاً إلى الارتقاء بخطابهم وأفكارهم، إلى أن يدققوا معرفياً بما يصدر عنهم. ما يؤدي، في النتيجة، إلى التخلص من كل ما انتهت صلاحيته المعرفية والاجتماعية وبات عاجزاً عن تقديم الحلول المناسبة للمشكلات المستجدة. وهنا يكمن مجد هؤلاء (المفكرين المشاكسين) ، فلولاهم لبقي القديم على قدمه، ولما حدث الحراك الفكري والاجتماعي والسياسي. ولا يضير هؤلاء اعتدادهم المبالغ فيه بالنفس وبما يملكونه من معرفة، كما لا يضيرهم شعورهم الحاد بالفردية (والفرادة)، وتقديمهم حريتهم الشخصية على الحرية العامة، وانغماسهم بالحاضر بعد أن قاموا بإجراء القطيعة الكلية مع الماضي. ويكتب خضر زكريا مُشيدًا بجرأة صادق جلال العظم خلال واقعة عاشها في سوريا وصورتُها أنه دُعي مرة إلى حفل عشاء في مطعم النبلاء في دمشق، يحضره بعضٌ من كبار المسؤولين في الدولة. وعندما حاول الدخول إلى ساحة المطعم بسيارته القديمة (من طراز ستروين دو شوفو مغلقة)، بين سيارات المرسيدس السوداء الفارهة، أوقفه الحارس متسائلًا: إلى أين؟ قال صادق: إلى المطعم. قال الحارس: ولكن هذا مطعم النبلاء، والمدعوون هم كبار المسؤولين. أجاب صادق: هل تعلم أنني النبيل الوحيد بين هؤلاء جميعًا؟
احتضرت الثورة… فاحتضر صادق جلال العظم/ عصام الخفاجي
5 حزيران (يونيو) 1997: قلت لطلاّبي في جامعة أمستردام: هذا اليوم مثل بقية الأيام بالنسبة إليكم، لكنّه غير ذلك لملايين من أبناء المشرق من جيلي وربّما جيلين آخرين أحدهما سبقنا والآخر لحقنا. لم أكن في وارد إلقاء خطبة عصماء عن الذكرى الثلاثين لحرب الهزيمة العربية المذلّة مع إسرائيل. في خمس دقائق لخّصت لهم كيف أن ابن السبعة عشر عاماً (أنا) لم تهزّه الهزيمة ولم يغُص جرحها عميقاً في الجسد إلاّ بعد شهور ربما. أكيد أنني كنت سأصيب طلاّبي بالملل لو حدّثتهم عن عدد مجلّة «الآداب» الذي لا أزال أذكر منه مقالاً لأدونيس وقصيدة نزار قبّاني الشعبوية الشهيرة «هوامش على دفتر النكسة» ولو تحدّثت عن مسرحية «حفلة سمر من أجل خمسة حزيران» الخالدة للصديق الجميل الراحل سعد الله ونّوس.
«هذا الرجل الجالس أمامكم»، قلت للطلاّب، «هزّ جيلاً أنا أحد أبنائه. حاول إيقاظه. لعله أيقظه لفترة. لعلّه فشل. كان أستاذاً أتعلّم منه وهو الآن صديق حميم أتعلّم منه. محاضرة اليوم سيقدّمها صادق جلال العظم».
محض مصادفة. كان صادق في أمستردام يحضر حفل صدور ترجمة كتابه «نقد الفكر الديني» إلى الهولندية. قلت له: صادق، أدرّس «كورساً» عن تكوّن الدول والهوّيات في المشرق وأوروبا. مزروعة في فكر الدارسين الشبان و «خبراء الشرق الأوسط» نظرية/خرافة تقول أن لا هوّيات وطنيّة لنا، بل كتل بشرية اختار المستعمرون أن يضعوا هذه الكتلة هنا وتلك هناك، على عكس الأوروبيين الذين كانوا أمماً كوّنت دولها «في شكل طبيعي»، كما تمضي الخرافة.
أعرف أن هذا ليس من بين اختصاصات صادق. قلت له: «اطرح الأمر من منظور فلسفي».
كان الطلب واضحاً له: صادق وأنا نتشارك في القناعة بـ «ماركسية» لا شعبية لها خارج أوساط المثقفين. هي ماركسية «النقد الذاتي بعد الهزيمة». ماركسية لا تحيل كوارثنا إلى المؤامرات، بل تقترح أن ننظر إلى تعفّن لا دولنا وبنانا الاجتماعية فقط، بل تعفّن سرى ويسري في مجتمعاتنا. ماركسية تبدأ من تحليل البنية داخلياً لكي ترى كيف تفاعلت مع الغرب أو الاستعمار، ولا تبدأ من لطم الصدور على أنفسنا كضحايا لاستعمار لولاه لكنّا بألف خير. طبيعي ألاّ تلقى مقاربة كهذه هوى في نفوس الحركات اليسارية في منطقتنا، بل اليسار الغربي أيضاً. اتّخذ نقده ملموسية أكبر حين وجّه النقد الحاد للمقاومة الفلسطينية والحركات القومية في أوائل السبعينات. فأضافت السلطات العراقية كتاباً جديداً لصادق إلى قائمة الممنوعات حلّل فيه الشعار البعثي الأجوف «أمّة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة».
أظن أن هذا التوجّه الفكري المشترك هو ما جمعني وصادق في رفقة أحاول أن أحسب عمرها الآن. أربع وثلاثون سنة. خرجنا من حصار بيروت نهاية آب (أغسطس) 1982 إلى دمشق. مقاتلاً كنت أم لم تكن، كان الشرط الإسرائيلي أن يلبس واحدنا بدلة المقاتل الزيتونية اللون ويحمل قطعة كلاشنيكوف يسلّمها إلى البلد الذي سيصل إليه. عدا هذا، كان من حقّنا حمل جعبة صغيرة معلّقة على أعلى البطن. كان ذاك زمن لا أقراص مدمجة أو دسكات فيه تخزن فيها شغلك وتضعه في تلك الجعبة. فكيف استأنف الشغل ولا مادة عندي سوى كومة من «بطاقات أو كاردات البحث»، كما كانت تسمّى حشوتها في تلك الجعبة؟
بوسعي أن أدلّ القارئ الآن إلى ذلك الدكّان في مساكن برزة الذي وضع جهاز هاتف في مدخله لتجري مكالمتك. في مقابل ليرة في مساكن برزة اتّصلت بصادق متهيّباً. في بيروت ترجمت ونشرت جزءاً أوّل من مخطوطة ضخمة لماركس عُثر عليها بعد أكثر من نصف قرن على وفاته، ولم تخرج إلى العلن وتنشر بالإنكليزية إلا بعد عقدين، وصارت تُعرف باسمها الألماني «الغروندريسة» (الأسس). قال لي فيصل درّاج: إن لم تجد الكتاب عند صادق، فلن تجده في سورية.
وجدته، ولم أمضِ في ترجمته.
دمشق التي بدت هادئة بعد مجزرة حماة، وأحيل الحديث عنها إلى تابو، كانت تدنو من الانفجار أواسط الثمانينات، لا بسبب تحركات شعبية، بل لأن الصراع على السلطة بين حافظ الأسد وشقيقه رفعت أوشك أن يوصل سورية إلى حافة حرب حشد فيها كل منهما قواته ومن والاه في أجهزة الاستخبارات. قنّاصة فوق أسطح البنايات كأننا لم نفارق بيروت الحرب الأهلية. فرع 23 وفرع 35 واستخبارات القوة الجوية وغيرها تتقاسم عمل المفرمة بحق المعارضين. وفوق هذا كانت أزمات العيش تطحن دمشق. رجال يركضون وراء شاحنات توزّع علبتي سجائر لكل فرد بعد أن فُقدت من الأسواق. ابتسامات الانتصار على وجه من يحصل على علبة مسحوق الحليب تقول لمن في الطابور إنني في موقع متميّز. رجال يقتحمون الطوابير أمام المخابز معلنين أنهم رجال أمن وراءهم مهمات مستعجلة.
فُرض كتمان مشدّد على المثقفين وكان على المعارضين مثل صادق محاولة السير على صراط مستقيم. ولم يُعط رئيس قسم الفلسفة في جامعة دمشق مادة تدريسية في قسمه سوى تدريس اللغة الإنكليزية تحسّباً من إمكانية حرف مادته التدريسية نحو مجارٍ لا تُحمد عقباها، وأحيلت المواد الأخرى إلى غيره من الأساتذة.
غبطت صادق غرامشياً في تشاؤم عقله وتفاؤل إرادته. يتساءل ويشكّك ويتحمّس وهو يعمل على صياغة بيان عام 2000 الشهير المطالب بإطلاق الحريات العامة وإنهاء الأوضاع الاستثنائية بعد موت حافظ الأسد.
وغبطته وهو فتى يقارب الثمانين متفائل العقل، متفائل الإرادة. انفجرت حماسته (وحماستنا) في شكل غير محسوب مع انفجار ثورات الربيع العربي ليبلغ الذروة مع انطلاقها في سورية. وقف مذهولاً أمام انتصارات حقّقت ما حلم به جيل سبق هؤلاء الثوار وعجز عن تحقيقه. لم ينجُ حتى المثقفّون النقديون من نقده. لمَ جلد الذات، كنت أقول له؟ هل لأن عشرات المثقفين والفنّانين وقفوا ضد أنظمة حكمهم فغابوا في السجون والمنافي من دون أن تتحرك «الجماهير» دفاعاً عنهم أو استنكاراً لقمعهم؟ هل لأن آلاف المصريين كانوا ينزلون إلى الشوارع دورياً احتجاجاً على حكّامهم فيما تقف «الجماهير» متفرّجة أو مصفّقة لمن يقمعهم؟ هل نلوم هؤلاء لأنهم سبقوا عصرهم حين كانت تلك «الجماهير» نائمة؟ أم نذكّرهم بأننا انتظرنا آباءكم الذين شلّهم الخدر والخوف طويلاً؟ تملّك اليقين الفيلسوف المتشكّك واندفع يبشر بالانتصار القادم.
ومع هذا، وبسبب هذا:
أحترمك يا صادق لأنك قضيت حياتك ناقداً ومحرّضاً على الاحتجاج، وأبخست حق نفسك إذ لم ترَ الرابط بين نقدك وتحريضك وبين حشود وصلت إلى ما وصلت أنت إليه قبل عقود.
أحترمك لأنك كنت من بين قلّة قليلة لم تهادن المستبّدين حين كانت غالبية المثقّفين الساحقة ترى أن مجابهة الإمبريالية تبرّر السكوت عن استبدادهم.
أحترمك لأنك رميت بثقلك وقد أثقلتك الشيخوخة والأمراض وراء الثورة.
أحترمك لأنك كابرت ودفنت عقلانيتك حين كانت العقلانية تقول إننا انهزمنا يا صادق.
أحترمك لأنك لم تعلّق على مقالاتي «المتشائمة» في «الحياة».
رفضت الاعتراف بالهزيمة، وأنت تعرف أننا انهزمنا.
وحين بات مشهد احتضار الثورة جليّاً، انطويت على نفسك في صمت وقرّرت الاحتضار.
قالت إيمان: «ذكرنا وئام وذكرناك قبل أن يدخل صادق في غيبوبته النهائية. لا معنى لزيارتك له الآن. لن يتعرّف إليك».
* كاتب عراقي
الحياة
رحيل المفكر السوري صادق جلال العظم المحارب على جبهة الفكر الديني ومن أجل سوريا ديموقراطية/ ابرهيم حيدر
بقي صادق جلال العظم محارباً على جبهة الفكر الديني حتى الرمق الأخير، ومن أجل سوريا ديموقراطية. هو الذي أثار عواصف كبرى من النقد منذ الستينات من القرن الماضي في كتابه “نقد الفكر الديني”، وخلّف سجالات في مراحل كانت المنطقة تعيش خلالها تحولات ومخاضات كبرى بعد حرب 1967.
رحل صادق جلال العظم وبقي فكره النقدي ومواقفه يثيران سجالات لا تنتهي. فعلى رغم أنه راهن قبل سنوات على ما سماه الإسلام الأوروبي لإحداث تحولات نحو الانفتاح في عالمنا، إلا أنه كان حاسماً في موقفه ضد الأصولية والتزمت. وبينما اتّهم صادق جلال العظم بأنه انحاز لحكم الأكثرية السنية في سوريا ومواجهتها لنظام أقلوي، إلا أنه أوضح وجهة نظره في حديث لصحيفة “لوموند” الفرنسية عام 2013 ونشرت ترجمتها “النهار”، حين تحدث عن “الربيع العربي” الذي كان مختلفاً في دمشق، عن تونس ومصر، إذ تبيّن أن من المستحيل إرساء فكرة الانتخابات الديموقراطية في هذا البلد. ففي سوريا، كان “الربيع العربي” محاولة شعبية لبثّ الحياة والعافية من جديد في جمهورية اغتصبتها سلالة عسكرية وراثية شعارها “إما الأسد وإما الحريق”. لذا يجب وضع حد نهائي لسوريا الأسد من أجل التمكّن من إرساء “الجمهورية السورية” من دون إضافة أي شيء آخر إلى الاسم أو إبداء تحفّظات عليه. فـ”كلما تمسّك الأسد ودولته البوليسية أكثر بالسلطة وأمعنا في الاعتداء على الشعب السوري، ازدادت الأصوليات الدينية انتشاراً. ولذا، “الإسلام العالي التوتّر الذي تعيشه الثورة السورية يحفز تجنيداً غير محدود للإسلاميين، و”الإخوان المسلمين”، والجهاديين، والطالبانيين، والقنابل البشرية في صفوف الشباب السوري”.
بقي صادق جلال العظم الأكثر نقداً للفكر الديني بأشكاله المختلفة، فمنذ إصداره كتاب “نقد الفكر الديني” في 1969، والذي أثار عاصفة كبرى من النقد المؤيد أو المعارض في العالمين العربي والإسلامي، ومنذ ذلك الوقت، خصوصاً بعد ما خلّفته حرب الـ1967 من سجالات وعمليات نقد وتحولات ومخاضات كبرى، تعمّق في النقد، فأصدر “ذهنية التحريم”، فيما المنطقة العربية كانت تشهد صعود الإسلاميين والتحديات التي يواجهها المشروع العلماني، وهو كان يعدّ من أبرز رموز الفكر العلماني المعاصر في العالم العربي والماركسي تحديداً.
ومن مقارنته لموضوع إبليس في نقد الفكر الديني، أطلق العظم مصطلح الصورة الكونية لعصر ما، للدلالة على جملة آراء ونظريات على درجة واسعة جداً من التعميم والشمول والشيوع. ويقدم نقداً للظاهرة الدينية بقوله، أنه أصبح من الجلي أن الابتلاء الإلهي هو مصدر البلاء والعذاب واليأس الذي يمر به الممتحن. ومن هذه النظرة النقدية للفكر الديني، عاد العظم وراهن على الإسلام الأوروبي لإحداث نقلة نوعية في العالم الإسلامي، وفي تغيير الذهنية الإسلامية، فقدم الاسلام التركي نموذجاً للتغيير، ويقول في هذا الصدد: أما النموذج الاعلى لاسلام “البيزنس” هذا، فنجده في حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا اليوم وفي طبيعة مشاريعه وإصلاحاته وطموحاته وسياساته الداخلية والخارجية على المستويات كافة. ومعروف أن إسلام النموذح التركي ترك آثاره البالغة على تيارات الإسلام السياسي في العالم العربي وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين. أما السؤال الذي أخذ يطرح نفسه على الإسلام السياسي العربي عموماً، وعلى ضوء ما آلت إليه تجربة الإسلام السياسي التركي في الجمهورية الكمالية العلمانية المحتقرة إسلامياً سابقاً، هو: لننظر أين هو الإسلام السياسي التركي اليوم، وأين هو الإسلام السياسي العربي اليوم أيضاً.
لكن بالنسبة الى العظم أيضاً، فليس ممكناً أن نفهم أنفسنا من دون أن نفهم أوروبا. لذا راهن على الاسلام الأوروبي للانفتاح على العالم. وفي رؤيته للنماذج الإسلامية الراهنة، فقسمها الى ثلاثة اتجاهات: إسلام الدولة الرسمي البترودولاري، وهو من أنماط الإسلام الراديكالي، ثم الإسلام التفجيري الإنتحاري. وهو الإسلام الجهادي الذي تتبناه طالبان، وعلى رغم أن “حماس” و”حزب الله” بدأتا كحركات تحرر وطني، إلا أنهما انحدرتا الي موقف طائفي، ما جعلهما ينخرطان تحت هذا التصنيف. أما النمط الثالث فهو إسلام البيزنس والسوق. وهو إسلام الطبقة الوسطى البورجوازية المرتبطة بالبنوك الإسلامية وصيغ المرابحات التجارية، وهذا يمثله النموذج التركي.
بقيت العلمانية مشروع صادق جلال العظم الرئيسي، وهو حاول في قراءاته أن يبحث عن حل لمشكلة التطرف الإسلامي، ولما تركته بعض الأنظمة العربية من آثار كارثية على مجتمعاتها بالاستبداد والقتل والعنف، حتى أنها صارت أسوأ من العنف الإسلامي للحركات الأصولية، ليعود الى فكرته الرئيسية في أن التاريخ الإسلامي الحديث ظل في حالة تدهور، وانحطاط دائم. فمنذ المشروع الثوري لجمال الدين الأفغاني، بدأ الانحطاط بفكر محمد عبده، وبعده رشيد رضا السلفي، والإمام حسن البنا صاحب الفكر الإرتدادي وسيد قطب، وانتهاءً بنموذج الإسلام التفجيري.
النهار
رحيل صادق جلال العظم/ اسكندر حبش
يبدو مسار صادق جلال العظم الفكري، الذي غيبه الموت، أول من أمس في ألمانيا بسبب المرض، متناسقا عند بعض قرائه، ويمتلك خطا بيانيا متماسكا، حاول العمل عليه طيلة حياته، إلا أنه في العمق، يبدو كخط عرف الكثير من التعرجات والانزياحات الداخلية التي تفاجئ حقا. فمن كَتب «نقد الفكر الديني» في ستينيات القرن الماضي، يختلف، في العمق، عن الذي كتب عن «العلوية السياسية»، ونظّر لها، في هذه الألفية الجديدة. ففي الأول، نجد «مفكرا» يحاول أن يقرأ ويناقش تأثير الفكر الديني على حياتنا العقلية، وما أنتج ذلك من تراجع في بنية الفكر العربي، بينما في «نحته» للمفهوم الثاني، تراه يسقط في اللعبة السياسية الراهنة وكأنه يتخلى عن كل ما يفترض أن يمتلكه «المثقف» من «عدة» فكرية، كي ينجو من التعميمات ومن لحظة الحدث الآني، ما يضعه، في نهاية الأمر، في خانة المساجلين، لا المفكرين.
المساجلة كانت إحدى أبرز سمات وخصائص ابن دمشق الراحل. كتابته كلها، لا تشذّ عن هذا المفهوم، وكأنه في لحظة، لم يفعل شيئا سوى الاستقالة من نظرية إيمانويل كانط الذي اختص به. فإذا كان الفيلسوف الألماني قد كتب عن نظرية المعرفة الأوروبية الكلاسيكية وآخر فلاسفة «التنوير» الأوروبي، فإن مشروع العظم الكتابي، وإن حاول التغطي بمزايا تنويرية، وجدت صداها في مرحلة سابقة، إلا أنه لم يستطع الخروج من «عباءة مذهبية» (إن جاز القول) في مراحل كتاباته الأخيرة، وبقي يصارع «ميتافيزقا» وهمية حاول ربطها بصراع فكري، بينما ترتبط في الواقع بصراع سياسي بحت.
مهما يكن من أمر، ومهما يكن من نقاشات واختلافات في وجهات النظر، إلا أننا لا يمكن أن نتخطى ما كتبه ذات لحظة، إذ بدا كأنه يرتبط فعلا بمسار تاريخي، كان يُنظر فيه إلى أمور الدنيا وأحوالها بهذا المنظار. منظار أسس لكتابات كثيرة بعده، وشكّل تيارا في الكتابة «الفكرية العربية» الحديثة. لهذا لا يمكن إعادة النظر ومناقشته، قبل أن تنتهي هذه المرحلة التي لا زلنا نعيش فيها منذ ستينيات القرن الماضي.
مع رحيل صادق جلال العظم، تنتهي مرحلة «تفكيرية» أثرت في كثيرين منّا. ربما لأن هذا التفكير لم ينجب في الواقع، سوى مرحلة «تكفيرية» نعاني من وطأتها. لكن الأهم مع العظم، أنها كانت فترة نقاش بالكلمة والقول، بينما اليوم، تحول النقاش إلى قتل مجاني، مستمر على امتداد هذه الرقعة من خريطة لا تعرف ماذا تريد.
السفير
صادق جلال العظم… خاض معركة الاستبداد السياسي والديني ولم يهادن السائد
رحيل صاحب الأسئلة الحادة
تونس ـ القاهرة ـ دمشق ـ «القدس العربي»: «إن الإيديولوجية الغيبية والفكر الديني الواعي الذي تفرزه مع ما يلتف حولها من قيم وعادات وتقاليد هي حصيلة للروح العربية الأصلية الخالصة الثابتة عبر العصور، وليست أبداً تعبيراً عن أوضاع اقتصادية مُتحوِّلة، أو قوى اجتماعية صاعدة تارة وزائلة تارة أخرى، أو بنىً طبقية خاضعة للتحول التاريخي المستمر ولا تتمتع إلا بثبات نسبي». (من كتاب نقد الفكر الديني). ربما بهذه العبارات يلخص المفكر والباحث السوري صادق جلال العظم الإشكالية الكبرى التي يحياها ما يُسمى بالعالم العربي.
ويعتبر العظم من أشهر العقلانيين العرب، وله إسهاماته المشهودة في نقد المؤسسة الدينية، وجرّاء ذلك سُجن على خلفية أطروحات كتابه «نقد الفكر الديني» 1969، كذلك أثار العديد من المعارك الفكرية الصاخبة، عندما أصدر كتابه «ذهنية التحريم» 1994، لتفنيد ومناقشة الهجمة الساذجة التي أثارها العديد من أصحاب الفكر العربي الغوغائي، رداً على رواية سلمان رشدي «الآيات الشيطانية». هذه بعض من آراء الأدباء والمثقفين العرب، في ما يخص تجربة الرجل وإنتاجه الفكري، ومدى تفاعل هذه الأفكار والرؤى مع الوقائع والقضايا الاجتماعية العربية.
عقل ناقد لمشكلاتنا الراهنة
بداية ترى الناقدة والكاتبة المصرية اعتدال عثمان أنه.. ليس مُهما أن تكون متفقاً أو مختلفاً مع التوجهات الأيديولوجية لمشروع المفكر السوري صادق جلال العظم، لكن المهم أن نتمثل نموذج المثقف العربي الذي حمل العظم صفاته على امتداد مسيرته العملية. إنه يتميز باستمرارية أساسية على مستوى النظر والممارسة لتوجهاته الفكرية الناقدة على نحو يعمل على تحفيز العقل على النقد العلمي القائم على الدراسة والبحث، وتقديم البراهين في معرض إثارة القضايا الجذرية التي تناولها في أعماله. لقد أقدم العظم، بجرأة عالية مقتدرة، على تحليل الواقع وقراءة الظواهر السلبية في واقعنا قراءة نقدية كاشفة، مساوياً بين النقد والمعرفة الموضوعية المبنية على أساس علمي. وهذه القراءة لديه هي الوسيلة التي يمكن أن نواجه بها أشكال الوعي الزائف، سواء تجلى ذلك في كتابه «النقد الذاتي بعد الهزيمة» أو في الدعوة إلى إعادة قراءة التراث الديني من منظور عقلاني، بالإضافة إلى دفاعه الحاسم عن حرية الفكر، وحرية الرأي والتعبير. لقد آثر صادق جلال العظم الانخراط في الحياة العامة، ولَم يكتف كأستاذ جامعي متمرس بالعكوف على البحث الأكاديمي في دوائر مغلقة. كذلك تميزت كتاباته بأسلوب سلس يجتذب القارئ الذي يوجه إليه الخطاب بصورة مباشرة، وكأنه يلقي محاضرة أمام طلابه في الجامعات العربية والغربية التي درّس بها. وهو في هذا يتخلى عن السلطة الرمزية للأستاذ المعلم أو المثقف العلّامة الذي يُملي على مستمعيه أو قرائه ما يراه فصل الخطاب أو صحيح الفكر، مقابل هدف آخر هو دعوتهم إلى إعمال التفكير النقدي في قضايا ذات حساسية في ثقافتنا الراهنة. وهو يرى أنه مطلوب من المثقف أن يأخذ المستجدات التي يأتي بها الواقع المتغير في الاعتبار وضرورة استيعابها بصورة أو أخرى بعقلية نقدية متفتحة، فالثقافة الحية ــ وفقا له ــ لا تتوقف عن نقد وإعادة نقد نفسها، وعن إعادة النظر في افتراضاتها الأولية، وفي منطلقاتها الأساسية، وإلا لما تمكنت من تجاوز حاضرها وصنع مستقبلها. لهذه الأسباب سيظل صادق جلال العظم أيقونة مضيئة في ثقافتنا العربية المعاصرة.
تأسيس مشروع فكري علماني
من ناحية أخرى يتعرّض الباحث السوسيولوجي التونسي شكري الصيفي إلى الصراع الدائم بين الرؤية الدينية والأفكار العلمانية، وهو ما دار حوله المنهج النقدي لصادق جلال العظم، لذا يعتبر من أبرز رموز الفكر العلماني المعاصر في العالم العربي، وله إسهامات معرفية عميقة التأثير أحدثت جدلاً واسعاً، خاصة «نقد الفكر الديني، وما بعد ذهنية التحريم». ويضيف الصيفي أن أفكار العظم عرفت عدة مراحل بدأت ما بعد النكسة بحثا عن أسباب الهزيمة، وركز على ذلك في مؤلفيه «النقد الذاتي بعد الهزيمة»، و»نقد العقل الديني»، وتمحور بحثه على ما أطلق عليه «نزع القداسة عن نقد الدين». وصنف إيديولوجيا الإسلام السياسي على أنها لا تمثل كل الإسلام، ولا تمتلك سلطة تأويل النص الديني. ومن هذا المنطلق قسم العظم هذا التيار إلى ثلاث نماذج، الأول أطلق عليه نمط الإسلام الرسمي الراديكالي، واعتبره مناهضاً للحريات ومانعاً للتعددية الدينية والأنساق الثقافية والفكرية المغايرة له. وثان أطلق عليه الإسلام التفجيري الانتحاري وهذا النمط يقوم على مبدأ الحاكمية، ويؤمن بعقيدة التكفير والقتل بحجة حماية الدين. وقاد هذا النمط صراعات عنيفة في الداخل وخاض حرباً مع الغرب انتهت بأحداث 11 سبتمبر/أيلول. النمط الثالث هو إسلام البيزنس والسوق. وهو إسلام الطبقة الوسطى البرجوازية المرتبطة بالبنوك الإسلامية وصيغ المرابحات التجارية، وهو نموذج يهتم بالبعد الاقتصادي. وعبّر العظم عن ذلك بقوله إنه «الإسلام التجاري للطبقة الوسطى الذي ينتشر بصورة خاصة لدى البورجوازيين في الدول الإسلامية ويمثل نموذجا وسطياً للإسلام»، معتبرا أنه الأكثر سلمية. يرى العظم أن الفكر العلماني العربي تأسس بناء على مضامين كتاب علي عبد الرازق عن «الإسلام وأصول الحكم»، وصولا إلى شعار «الدين لله والوطن للجميع». ولم ينف العظم تأسيس مبادئ الفكر العلماني بفضل المفكرين المسيحيين العرب خوفاً من هيمنة الدولة الدينية. واعتبر العظم أن التاريخ الإسلامي الحديث ظل في حالة تدهور دائم، منذ المشروع الثوري للأفغاني، على حد قوله. في نقد خطاب العظم، ثمة من يعتبر خطابه الفكري والسياسي مكرسا لحتمية الصدام التاريخي بين العلمانية والإسلام، رغم سقوط الإيديولوجيا، وصعود القيم الإنسانية، والمدنية والمواطنية، واستقرار الاختلاف حول جدوى الشفافية ونجاح الديمقراطية لدول منطقتنا العربية، ولعل العامل الأهم هو سقوط الديكتاتوريات التي كانت تكرس لمثل هذا الصدام. ينتقد البعض العظم معتبرين أن الدولة الوطنية التي جاءت ما بعد الكولونيالية في العالم العربي هي دولة علمانية، وبالتالي فالمشروع العلماني بتمظهراته السياسية والفكرية التي ظلت مسيطرة على المشهد العربي طيلة العقود الماضية، تتحمل نتائج الفشل والإخفاق في المنطقة، وفي تقديم مشروع تنويري في ظل تفشي الاستبداد والديكتاتورية. لكن العظم يؤكد أن المشروع العلماني لم يفشل بل فشلت محاولات تطبيق بعض نماذجه.
التنوير بلا تزوير
ويرى الكاتب والباحث المصري طلعت رضوان .. أن المفكر السوري صادق جلال العظم أحد المفكرين النادرين، سواء العرب أو المصريين، لأنه التزم بما يُمليه عليه ضميره (العلمي والإنساني) فلم يُهادن ولم يُغازل الثقافة السائدة، ورفض أن يكون نسخة كربونية من نُسخ المُـتعلمين المحسوبين على تلك الثقافة. وحتى عندما تعرّض لمحنة المحاكمة بسبب كتابه «نقد الفكرالديني» فإنه لم يتراجع وأقرّ أمام القاضي بأنه مُـتمسّـك بكل حرف كتبه. وانطلاقاً من إيمانه بخطورة تشويه المشهد الثقافي، والتزوير إرضاءً للثقافة السائدة، فإنه كشف دور المتعلمين الذين هاجموا سلمان رشدى بسبب روايته «الآيات الشيطانية» مثل أحمد بهاء الدين الذي كتب «إنّ الكتاب حقير وصادر عن نفس مريضة، رضيتْ لنفسها أنْ تغترب وتبيع روحها وتراثها»/جريدة «الأهرام» 1 مارس/آذار 1989. وأشاد العظم بالناقد غالي شكري الذي رصد أسماء ثلاثة عشر مصرياً هاجموا سلمان رشدي، ولم يقرأوا الرواية، من بينهم رجاء النقاش. وكان تعليق العظم «يؤلمني أن ينحني ناقد من عيار النقاش إلى مستوى إطلاق الأحكام الاعتباطية على رواية لم يقرأها، مُـتهماً إياها بتعزيز صورة الغرب السيئة عن الشعوب العربية. بينما أدب سلمان رشدي خالٍ من أي إشارات عن الشعوب العربية، وأن أدبه لا يُدين إلا وحشية الأنظمة السياسية للعالم الثالث وتخلفها وكراهيتها للتقدم والحضارة «ذهنية التحريم» رياض الريس للنشر- نوفمبر/نوفمبر 1992).
وبينما المُـتعلمون العرب والمصريون مدحوا إدوارد سعيد لدرجة الغزل، خاصة بعد صدور كتابه «الاستشراق» فإن القراءة الجادة العميقة ــ التي ترفض التزوير ــ جعلتْ العظم يقرأ الكتاب برؤية مختلفة عن (رؤية المُـنبهرين) ولكي يدلل على كلامه نقل فقرة كتبها سعيد وهي «يـُشكــّـل العالم العربي اليوم تابعاً فكرياً وسياسيـاً وثقافيـاً للولايات المتحدة، لا تبعث هذه العلاقة على الأسى في حد ذاتها، لكن الشكل المُـحـدّد الذي تتخذه علاقة التبعية هذه هو الذي يبعث على الأسى». هذه الفقرة لم يتوقف أمامها إلا صاحب ضمير حي وفكر مُـستنير مثل العظم، فكتب «لا ينصب اعتراض إدوارد وأساه على تبعية العالم العربي الفكرية والسياسية والثقافية للولايات المتحدة، بل على الشكل المُـحـدد الذي تتجلى فيه هذه التبعية والأسلوب السيئ الذي تُمارَس به. أي أن إدوارد يريد الإسهام في تحسين شروط علاقة التبعية والتخلص من جوانبها السيئة، وليس الدعوة للتخلص منها كلياً وتحطيمها نهائياً، لذلك وجّه (إدوارد) نقده وهجومه للولايات المتحدة (المتبوع) وليس إلى (التابع)».
مُفكر اللحظة الفارقة
ومن ناحيته يرى أستاذ الأدب العربي «راكان الصفدي» أن صادق جلال العظم .. جاء في زمن الأسئلة الحادة بعد هزيمة حزيران/يونيو 1967، التي هزّت الثوابت العربية وزلزلت السائد، وطرحت مشروعية محاسبة كل شيء في واقعنا العربي المريض، من الدين إلى السياسة إلى المجتمع، ولذلك كان كتابه «نقد العقل الديني» الواخز ضمن هذه الحالة التي عمّت الأمة المصدومة، وقد انطلق فيه من رؤيته الماركسية في تفسير العالم وحركة التاريخ، فوجّه نقده الجريء إلى أهمّ مكوّن من مكوّنات العقل الجمعي العربي: الدين، وحمّله الكثير من مسؤولية انكسارنا التاريخي، كما فعل فلاسفة التنوير في عصر النهضة الأوروبية. وفعل مثل ذلك في كتابه «في الحب والحب العذري» الذي كان إنارة لجانب معتم آخر من حياتنا، وهو الجانب العاطفي والاجتماعي. وفي الكتابين نلمس فكراً واحداً، ومقولة واحدة هي: رفض القمع، قمع الفكر وقمع الجسد، فالدين الذي تأنسن في منطقتنا أصبح صورة عن الإنسان المسيطر الذي يحكم بسوط الخوف والجوع، والإنسان الذي تألّه فرض أعرافاً وعادات تحوّلت إلى ما يشبه الدين، وقد أراد العظم أن يفكّك هذه البنية ويعيد إلى الإنسان إنسانيته المستلبة عن طريق الحرية بحسب المفهوم الماركسي، أي الحرية المرتبطة بتحرر المجتمع من الاستعباد بجميع أشكاله، وهو وإن سبق إلى الكثير من هذه الأفكار ولاسيما في كتابات عصر النهضة العربية وكتابات سلامة موسى وشبلي الجميل وغيرهما، تميّز بالوضوح الصارخ والجرأة المطلقة في المس بالمقدّس في زمن المواربة السياسية والاجتماعية والثقافية، وهو ما جعله في دائرة الضوء وعلى مرمى من أعدائه الكثيرين.
صاحب الأسئلة الحامضة
الأكاديمي اليمني سعيد الجريري يقول: يضعنا مُفكر بقامة صادق جلال العظم ومن سبقه من المفكرين العرب في القرن العشرين، إزاء أسئلة عديدة، لكنها حامضة، ذات صلة بفاعلية المثقف في توازيها مع سلطة العسكر في البلاد العربية. لكن ما يستوقفني الآن هو سؤال الثورة العربية لا بمعناها الصدامي المباشر في مرحلة التحرر من الحقبة الاستعمارية الغربية، وإنما في مستواها الفكري والجمالي.
لقد مثل كتابا صادق جلال العظم « نقد الفكر الديني»، و»في الحب والحب العذري» على سبيل المثال جزءا من إنجاز ثقافي في سياق مشروع فكري اشتغل على إيقاظ واستنهاض ما في العرب من مفاعيل القوة والمواجهة العقلية للمركوم الثقافي المهيمن، بفاعلية نقدية عميقة.
ويضيف الجريري: بين ما حدث من تحول فكري متقدم، وما تحقق من (استقلال) سياسي، يقف المتأمل على واحدة من مفارقات الزمن العربي المعاصر في العلاقة بين المثقف والسلطة، فتحرير الذات العربية بوعي مغاير، لم يتسق مع مجريات الممارسة السياسية وخلفياتها الاجتماعية التي ظلت هشة، وإذ انتكست حركات التحرر أو الثورات العربية بأنظمة عسكرية، ادعت أو انتحلت صفة المدنية، وكرست ديكتاتورية الحاكم أو الحزب (الوطني) الذي يستعيد صورة الممدوح القديم، فإن البنى الجديدة التي حاول تجذيرها صادق جلال العظم وجيله من المفكرين والمثقفين، واجهتها الأنظمة الديكتاتورية العربية بتحالف سرطاني مع قوى السلفية العربية دينية كانت أم اجتماعية أو ثقافية، في مشهد مفارق، يكشف عن حالة افتراق بين موقفين جوهريين: إنساني، ولاإنساني. وهو المشهد الذي اتضحت ملامحه من هيمنة للبنية الثقافية السلفية، ما يجعل منجز صادق جلال العظم في اللحظة الراهنة جديرا بإعادة القراءة، والمضي على نهجه التنويري الذي يلاشي المسافة الافتراضية بين الفكري والسياسي، بالنظر إلى أن الدولة الاستبدادية العربية تراهن على مركومها الشائه لإجهاض التحول المدني الحقيقي الذي يضع الإنسان العربي على عتبة إنسانية، وهو المشروع الذي تم إجهاضه خلال نصف قرن مضى.
رجل الجدل والاشتباك المعرفي
الروائي التونسي محمد الجابلّي يعتبر العظم من أهم الكتاب والمفكرين الذين وسموا المرحلة الحديثة، ومؤلفاته القليلة نسبيا كانت تحفر في العمق المُغَيَّب، وتنبش «المسكوت عنه»، كتابه الأول «نقد الفكر الديني» الذي نشر في آخر السبعينيات يحمل البعد الأعمق للجدل الذي تفاداه النقاد والمفكرون، أو تناولوه بطريقة موغلة في التعمية والتجريد، لأن المسألة الدينية كانت وما تزال محل سؤال هامس في واقعنا المبني على التعمية والنفاق الجماعيَيْن، وهذه الجرأة الفكرية لم تتوقف على ذلك الكتاب ذائع الصيت، بل تجاوزته عبر الجدل المباشر في الفضاءات الجامعية، بل وفي المنابر الإعلامية، فكان «العظم» من القلة المفكرة التي طالها التكفير والمحاكمة والسجن. ولم تتوقف الإشكاليات المثيرة في كتابه الأول، بل واصل الحفر في القضايا ذاتها في كتبه اللاحقة مثل «ذهنية التحريم» و«دفاعا عن المادية». وربما السؤال الأهم وواجبُ الطرح وفقا لـ الجابلّي هو «إلى أي حد استطاع الفكر التقدمي لهذا الرجل أن يؤثر في محيطه؟». وهذا السؤال يحيل إلى كتابات كثيرة وإلى أعلام ألقوا حجرا منذ زمن في البرك الآسنة نذكر منهم، حسين مروة والطيب تيزيني وعبدالرحمن بدوي وزكي نجيب محمود وقبلهم سلامة موسى. أولئك الذين آمنوا بممكنات حداثة في الوعي والواقع العربيين وانبروا لنقد الموروث وجره إلى مرايا الواقع المتحرك بقضاياه المستجدة وإبعاده عن القداسة والتحنيط.
ربما نقولـ وللأسف ـ إن البيئة العربية عموما هي من البيئات الطاردة لممكنات الفكر النقدي، بل نكاد لا نبرح المربع القديم لسلطة العقائدي الأسطوري في حياتنا ومخيالنا، ونحن أحوج ما نكون إلى حركة اعتزال جديدة تتضافر فيها الجهود لعقلنة واقعنا، بدءا بذواتنا الواعية ـ حسب المقولة الهيغلية ـ «لأن العقل لا يمكن أن يحكم الواقع ما لم يصبح الواقع في حد ذاته معقولا» ذلك أننا دخلنا «الحداثة» من باب النكبات والنكسات والأزمات، لا من باب العقل المتحرر، فآلت مجمل المحاولات النقدية إلى ما يشبه «الولع بالحكاية» عند المتقبل الذي يتحمس لتلك المقولات ثم يلغيها في واقع متحجر تحكمت فيه هيمنة استعمارية عبر أنظمة وسيطة تدعي الحداثة وتتاجر بالدين بطرق مختلفة .
كتابات «العظم» وغيره بقيت هامشا على ضفاف واقعنا المتناقض المأزوم، ولا بد أن نتجرأ على أنفسنا وأن نعلن أننا لم نؤسس ما يُطْمَأَنُّ إليه في مجالات كثيرة أولها أن نتحرر من الوهم، وأن نعلن سلطان العقل وأن نراجع بعض ما عشنا فيه من أكاذيب جماعية كأكذوبة الحداثة والتحديث وأكذوبة الاستقلال وحرية الإرادة.
في سطور
صادق جلال العظم من مواليد دمشق عام 1934. درس الفلسفة في الجامعة الأمريكية، واستكمل دراساته في جامعة ييل في الولايات المتحدة. عمل في التدريس في الجامعة الأمريكية في بيروت بين 1963 و1968. ثم أستاذاً للفلسفة الأوروبية في جامعة عمّان منذ عام 1969. كذلك باحثاً في مركز الأبحاث الفلسطيني، وترأس تحرير مجلة «الدراسات العربية» في بيروت. عاد إلى سوريا وعمل أستاذا في جامعة دمشق في الفترة ما بين 1977 و1999 ثم أستاذا زائرا في قسم دراسات الشرق الأدنى، في جامعة برنستون حتى عام 2007. كتب في الفلسفة والمجتمع والفكر العربي المعاصر إضافة إلى مساهمات في حقل الأدب.
ورأس رابطة الكتاب السوريين التي تأسست عام 2012 إثر انطلاقة الثورة السورية.
من أعماله: النقد الذاتي بعد الهزيمة والذي صدر إثر هزيمة حزيران عام 1967، و»نقد الفكر الديني» و»الاستشراق والاستشراق معكوساً»، و»ما بعد ذهنية التحريم»، و»في الحب والحب العذري» إضافة إلى أعمال أخرى كثيرة معظمها صدرت باللغة الإنكليزية.
حصل على وسام الشرف الألماني (ميدالية غوته) العام الفائت 2015.
روح نقدية غير مشروطة/ رشيد بوطيب
يصعب عليّ أن أكتب عن صادق جلال العظم، ربما لأنه من المفكرين القلائل في الثقافة العربية، الذين أشعر بأن جيلنا يدين وسيدين لهم بالكثير.
أتذكره دائما، كلّما دار الحديث حول الثقافة السورية، إلى جانب جورج طرابيشي وسعد الله ونوس. جورج طرابيشي وكتابه الذي لم يفقد شيئاً من راهنيته: “المثقفون العرب والتراث- التحليل النفسي لعصاب جماعي”، وخصوصا القسم الثاني منه الذي ينتقد فيه مشروع حسن حنفي، و”منمنات تاريخية” لسعد الله ونوس، الذي لا يقل راهنية، وفي هذه المسرحية ينجح ونوس في رسم معالم شخصية المثقف الانتهازي وتفكيك آليات السلطة، بشكل يذكرنا بروايتين من الأدب العربي المعاصر: “مجنون الحكم” لبنسالم حميش و”الزيني بركات” لجمال الغيطاني.
أما في ما يتعلق بصادق جلال العظم، فإني أذكر بالخصوص كتابه “ذهنية التحريم”، الذي يقدّم أيضا نقداً لاذعاً لمثقف عربي يطلق الأحكام دون معرفة، وبلغة أخرى يجترّ أحكامه المسبقة. وفي هذا الكتاب ينحاز صادق جلال العظم إلى صف سلمان رشدي، ضد فتاوى القتل والتكفير، وعبره يدافع عن حرية الأدب وحرية الكلم
طبعاً كان بإمكاني أن أذكر كتابه “دفاعاً عن المادية والتاريخ”، ولكنه يظلّ في رأيي محاولة سقراطية وحوار يقوده السارد العليم، ويقدّم أجوبته قبل أسئلته؛ أو أن أذكر خطابه “نقد الفكر الديني”، لكنه يظلّ محاولة “فولتيرية”، لا أقل ولا أكثر. فللدين منطقه الداخلي، وللأسطورة عقلها الخاص، ولا يمكن البتّة أن ندّعي الإمساك بحقيقتها وفقا للمنطق العقلاني أو الوضعي، وقد أوضح ذلك بجلاء ميرشا إلياذة.
سيظلّ صادق جلال العظم رمزاً من رموز تلك العقلانية التي يمكن أن نسميها بعقلانية التجاوز، وهي التي استقت أفكارها ومناهجها من تراث التنوير الغربي، ولم يسمح لها الزمن، أو لربما لم تسمح لها دوغمائيتها الفكرية بإعادة النظر في أسس العقلانية الحديثة، كما فعل ممثلو “النظرية الفرنسية” أو حتى “مدرسة فرانكفورت”.
لكنّ بناء ما أسميه “عقلانية التجاور” أو “الجوار”، لا يتم إلا عبر تفكيك صيرورة الدنيوة أو العقلنة، وبلغة أخرى، لن يتحقق بدون إعادة النظر بفكرة التقدّم، وبالفكر الحداثي عموماً.
إن ما سيبقى من صادق جلال العظم هو روحه النقدية غير المشروطة، ولعلنا لا نحتاج اليوم، في زمن الاستبداد والنيوليبرالية التي تشكّل الإنسان على مقاسها وتعبث بمصيره، إلى شيء آخر سوى إلى هذه الروح المتقدة، ليس لكي نجترّ أفكار صادق جلال العظم وجيله، ولكن لنفهمها في سياقها التاريخي، وعبرها، نفهم أحلام وأخطاء مرحلة بأكملها.
“إن كرامة الإنسان تكمن في الاختيار”، يقول ماكس فريش. وقد اختار صادق جلال العظم أن يقول لا لقوى الظلام والتخلّف، وأن يفضح انتهازية المثقف العربي، ويفكك أوهام الخطاب الديني، وأن يموت في المنفى وعينه على الثورة السورية.
العربي الجديد
الحب.. على حافة المقدّس/ محمود منير
لا يمكن فصل كتاب “في الحب والحب العذري” (1968) عن مجمل اشتغالات المفكّر السوري الراحل صادق جلال العظم، وإن ظهر حينها بوصفه محاولة لمقاربة ظاهرة الحب ثقافياً من خلال تأمّلات فلسفية – بالدرجة الأولى – لسير العشاق وسلوكيّاتهم عبر التاريخ العربي خصوصاً، أكثر من كونها دراسة علمية محكمة حتى مع استعارته مقولات علم النفس والاجتماع.
لو دقّقنا في تاريخ الإصدار نجد أنه أتى بعد نكسة حزيران 1967 بعام واحد، بمعنى أن العظم الذي بدأ مسيرته البحثية والأكاديمية في تلك الفترة، كان متأثّراً مع أبناء جيله بالهزيمة “الجديدة”، ضمن إحساس مثقل لديه ولدى آخرين بأنها حلّت كمحصلة تداعيات وانهيارات عصفت بالعقل والمجتمع سعى طوال مشواره لإخضاعها إلى النقد والمراجعة.
لكن صاحب “نقد الفكر الديني” لجأ إلى الحب على إثر النكسة، وكأنه يقول إن “الشهوة والحاجة والنزوع والميل إلى امتلاك المحبوب”، موضوع دراسته في الكتاب، تمثّل ظاهرة مرضية معقّدة سابقة على غيرها من الظواهر لدى المواطن العربي الذي يعتقد أن كبت انفعالاته الجنسية هو التعبير الأسمى عن الحب، المسمّى بـ “الحب العذري”، وبذلك يصبح الجنس المتخيّل والمفتقد والمنشود هو غاية العلاقة ومنتهاها.”
رغم الانتقادات المتعدّدة إلى خلاصات العظم في هذا السياق، إلا أن توصيفه لتناقضات العشق والعشّاق أصابت ثقافة ووعياً عاشا عليها قروناً بمقتل، فحتّى لو ذهبنا إلى الرأي الذي يتهمه بالتعسّف في استقراء ظاهرة الحب العذري وتقديمه ملاحظات متطرّفة تتصل برموز الحب في تاريخنا العربي وانتقائه منهم ما يُثبت صحّة فرضياته، فإن تساؤلاته تبقى حاضرة حول رغبة عروة وجميل وقيس، مثلاً، بالاستمتاع بحبّ خفيّ مع معشوقاتهم بعد زواجهنّ، أو بتقديره أن بعضهم كان قادراً على منع زواج حبيبته من غيره لكنه لم يُقدم، وغيرها من التحليلات.
حدّد صاحب “ذهنية التحريم” موقفه من العاشق العذري بأنه لا يتردّد في اختلاق أسبابٍ تحول دون وصوله إلى إشباع شهوته، فيجعله مستثاراً على نحو متواصل إلى حدّ يدفع به إلى الجنون، وهنا تبرز إشارة لم تنل بحثاً كافياً من العظم الذي ربط بين الحبيبة “المشتهاة” على الدوام وبين المقدّس، باعتبارهما حقيقة مطلقة لا بدّ أن يسعى نحوهما المرء من دون الوصول إلى معنى متحقّق في نهاية المطاف.
الحب العذري كمعادل موضوعي للشقاء، هو تعبير عن “سادومازوشية”، بحسب العظم، الذي توقّف عند إشكاليات أخرى لا تقلّ تعقيداً، ومنها العلاقة الزوجية ضمن ثنائية “الامتداد والاشتداد”، التي تستبدّ بالإنسان الذي يريد حبّاً جارفاً حاداً متدفّقاً يجده في العلاقات القصيرة العابرة التي تعصف بالروح بقوّةٍ لا يمكن السيطرة عليها، وبين الحالة السكونية لحبّ ممتد وقارّ يتمظهر في أوضح صُوره ضمن مؤسسة الزواج، وعليه يظلّ أسير تناقض وجوديّ لا مفرّ منه؛ الخلاص والتحرّر من قيوده بالاشتداد والسعي إلى تقبّل المجتمع له والرضى عنه بالامتداد، وهي “مفارقة الحب” التي بُنيت عليها فرضية الكتاب.
نصل إلى تناقض آخر رصده المفكّر السوري، في حديثه عن “العاشق الدونكيشوتي” الذي لا يعشق امرأة بعينها، فكلّ واحدة هي موضوع حبّ بالنسبة إليه، وهؤلاء يشكّلون ظاهرة للدراسة في مجتمعات مكبوتة وتخضع لذهنية التحريم كما في مجتمعاتنا العربية، معبّرين بذلك عن انفصام تامّ لأن مخيّلتهم عن الحب منبتّة عمّا هو في الواقع، غير أنه يلتقي بذلك مع العاشق العذري في كونهما لا يجعلان “المحبوبة” موضوع الحب، بل يجعلان الحبّ ذاته غاية نفسه.
هل كانت قراءة صاحب “الاستشراق والاستشراق معكوساً” لأثر مفاهيم الحب على سلوكياتنا متصلة بالسلطة بتجلّياتها المختلفة؛ الذكورية والدينية والسياسية؟ سؤال يستدعي قراءات أعمق في دراسة العلاقات العاطفية في مجتمع يتمدّد الهامش أو الهوامش أضعاف المتن فيه، والإقرار بأن إخفاقنا فيها ليست مسألة ثانوية، بل هي أساس الاضطراب في شخصيّاتنا وهويّتنا ما يفضي إلى مزيد من الكبت وتعلّق بالخرافة.
العربي الجديد
سجالات قرب القضية الفلسطينية/ أمير داود
تظهر مساحات الانشغال التي استغرقت حياة المفكّر السوري صادق جلال العظم في أوج سنوات عطائه، جليّة، كمساحات مفخّخة بالكثير من الصدام والالتباس، نظراً للثيمة الفكرية والسياسية والفلسفية التي أعمَل فيها حفراً صاحب واحد من أبرز المشاريع الفكرية والنقدية في العالم العربي في قرنه الماضي؛ ابتداءً من دفاعه النقدي والفني، على حدّ قوله، عن آيات سليمان رشدي الشيطانية، ثم مجاهرته بمفردة “الهزيمة” بعد حرب 1967 في كتابه “النقد الذاتي بعد الهزيمة” الذي صدر بعدها بعامٍ واحد، في مواجهة المحاولات اللغوية التخفيفية (نكسة، هزّة) التي عمد إليها صحافيّو وكتّاب الثقافة العربية، سواء من الطليعيين أو من كتاب الأنظمة.
لكن انشغال المفكّر المشاكس، بسجالات الإنتلجنسيا العربية بأطروحاته عن “ذهنية التحريم” و”ما بعد ذهنية التحريم” و”دفاعاً عن المادية والتاريخ” وغيرها، لم يمنعه من الدخول في عشّ دبابير “المدّ الثوري” الفلسطيني، في كتابه الشهير “نقد فكر المقاومة الفلسطينية” (1973).
بنى العظم تحليله لفكر المقاومة الفلسطينية في الكتاب على فرضية مفادها أن هذه المقاومة هي جزء من حركة التحرّر العربي التي قادتها الأنظمة القومية في كلٍّ من مصر وسورية والعراق، على وجه الخصوص، بتركيبتها وقيادتها ومصالحها وعقليتها، وإذا كانت الحركة الأكبر قد هُزمت أمام المشروع الصهيوني (هزيمة 1967) فلن يكون مصير الفرع النامي من الأصل، أي المقاومة الفلسطينية، بحال أفضل، فالمقاومة الوليدة ورثت ضمن ما ورثته انتكاسات امتدادها للشجرة الأم.
فوق ذلك، انتقد العظم بشدّة افتقاد هذه المقاومة إلى النظرة الشمولية الجدلية، وبالتالي افتقادها إلى خطّة ومراحل محدّدة للهدف، واصفاً أساليبها بالقديمة في العمل السياسي، وطُرقها بالبالية في تعاملها مع الجماهير العريضة والتي أدّت في نهاية المطاف “إلى إعطاء العالم سنداً يستند إليه أمام الجماهير والأنظمة العربية لتبرير مؤامرتها ضد حركة المقاومة”.
نقد مبكر لمأزق “فتح”
كما أشار في أكثر من موضع، إلى التناقض الذي وقعت به فصائل المقاومة وعلى رأسها “حركة فتح”، في إطار المفهوم الثوري الذي تطرحه وما يحصل من نقيضه على الأرض، ما يدلّ على عدم وضوح ما تسعى إليه بشكله الاستراتيجي.
وفي موضع آخر، يدير العظم دفّة النقد باتجاه فشل فصائل المقاومة الفلسطينية، آنذاك، في إدراك أهمية التحوّلات الاجتماعية في صفوف الجماهير، وبالتالي افتقاد الفصائل للقدرة على الارتقاء بالجماهير أو مساعدتها في التخلّص من وعيها الشعبي العفوي الموروث من خلال إعادة صوغ وعي الجماهير في مؤسّسات الثورة، باعتبار أن المقاومة لا تقتصر وظيفتها على قتال العدو فقط.
لم تتوقّف حدود نقده لفكر المقاومة عند هذه الحدود، بل تعدّى ذلك إلى نزع الصفة الثورية عن عمليات خطف الطائرات باعتباره منزلقاً تورّطت فيها غالبية فصائل العمل المسلح بداعي التركيز على المكتسبات الصغيرة والسريعة والآنية بدلاً من الذهاب نحو الاستراتيجي والإنساني الأعم.
وكنتيجة لهذا الموقف، وجدت قيادة “منظّمة التحرير” آنذاك في كلام صاحب “في الحب والحب العذري” ما لا يمكن السكوت عنه، ليتلقّى العظم تهديدات جديّة بالقتل من أطراف متنفذة في المنظّمة دفعته للهرب من بيروت إلى دمشق؛ ومن ثم سُحب كتابه “نقد فكر المقاومة الفلسطينية” من السوق، مع توجيه “أمر” إلى الناشر بعدم إصدار أي طبعة جديدة، ما جعل من الحصول على نسخة من هذا الكتاب متعذّراً لوقت طويل.
لم تنته المسألة عند هذا الحدّ، إذ تمّ فصل العظم لاحقاً من “مركز الأبحاث الفلسطيني” على الرغم من كونه أحد مؤسّسيه، ومنعه من الكتابة في مجلة “شؤون فلسطينية” التي يصدرها المركز بأمر مباشر من قيادة المنظمة، ليروي العظم في ما بعد أنه كتب فيها باسم مستعار باتفاق مع رئيس تحريرها ومدير المركز أنيس صايغ.
تحوّلات نهاية التسعينيات
سيعود المفكر السوري بعد ذلك، في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، وفي مقابلة مع مجلة فلسطينية (مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 32، خريف 1997)، إلى وصف حلّ الدولة الواحدة، بالحل الأمثل للقضية الفلسطينية، معتبراً خيار الدولة الفلسطينية المستقلة أمراً مستبعداً في تلك الفترة، نظراً للمتغيّرات الدولية التي عصفت بالمنطقة كلّها، إبان تتالي توقيع اتفاقيات السلام بين البلدان العربية و”إسرائيل”، معارضاً نفسه ومنهجيته النقدية الشديدة السابقة إزاء كل الذين تساهلوا في التعامل مع مآلات القضية الفلسطينية، وخصوصاً في ما يتعلّق بجزئية الحلّ النهائي.
بدا أن شيئاً اختلف في تحليل ومقاربات المفكر الثوري الماركسي وصاحب كتب “زيارة السادات وبؤس السلام العادل” و”الصهيونية والصراع الطبقي”. ظهوره في أكثر من مناسبة في الولايات المتحدة لنقاش قضايا التحوّلات الديمقراطية في “الشرق الأوسط” بدت تعزيزاً لمؤشّر على تغيّر طرأ على مواقف العظم الفكرية والسياسيّة، والتي دأب سابقاً على إدانة كثيرين من البوابة ذاتها.
العربي الجديد
نقد ذهنية “التكريم”!/ فيان طارق
ليس من مصادفةٍ تثير الاستهجان في يوم رحيل صادق جلال العظم (1934 – 2016) أكثر من نشر خبرٍ (يبدو أنه أُعدّ له سابقاً) عن “تكريمٍ للمفكّر الذي يمّر هذه الأيام بوضعٍ صحي صعب” في مقرّ “اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات” في أبوظبي بالتعاون مع “رابطة الكتّاب السوريّين”.
خبرٌ يحمل أكثر من مفارقةٍ في وقت واحد؛ إذ إن “الرابطة” التي تشارك في تنظيم الفعالية، قد أسّسها العظم مع مجموعة من زملائه الكتّاب السوريين عام 2012، وأرادوا لها أن تكون نقيضاً موضوعياً وذاتياً لـ”اتّحاد الكتّاب” في بلاده غير المنتخب (انتخابات شكلية تقرّر نتائجها السلطة مسبقاً)، والذي يُشكّل أيضاً أداة لتبرير أخطائها وجهاز دعاية لها، ما ينطبق على بقية اتحادات الكتّاب العربية من المحيط إلى الخليج.
تذهب الرابطة (أو بعض الكتّاب المحسوبين عليها) في آخر أيّام صاحب “ذهنية التحريم” لتنّظم “تكريماً” على شاكلة الاحتفالات العابرة والسطحية والركيكة التي كرّسها “اتحاد الكتّاب العرب”، بكافّة فروعه، وتعقد ندوة خلاله تحمل عنوان: “صادق جلال العظم وسؤال التنوير”، لتناقض بذلك كلّ أعمال رئيسها الذي اعتبر الأنظمة العربية و”مؤسّساتها الثقافية” الطرف الأساس في إنتاج وإعادة إنتاج التخلّف والعجز والهزيمة، فما معنى أن يوضع هذا السؤال للنقاش لدى جهةٍ عربية رسمية لا تعترف أصلاً بالرابطة الشريكة في هذه الفعالية؟ (لم يعترف “اتحاد الكتاب العرب” -الذي يتبع له “اتحاد الكتاب الإماراتيين”- بـ”رابطة الكتّاب السوريين”، وما زال يعتمد هياكل وواجهات النظام ممثلةً لكتّاب سوريةّ
وفي التفاصيل، ستُلقى كلمتا ترحيب متبادلتين بين الاتحاد (الذي لا يعترف بالرابطة) والرابطة (التي أقيمت كنقيض للاتحاد)، وبالطبع ستمتلئ بالإشادات المجانية والعبارات الإنشائية وفائض المدائح التي عاش العظم أكثر من ستة عقود معترضاً عليها، وناقداً جذرياً لها ولبنيتها الاجتماعية والسياسية والثقافية.
وحتى يكتمل “التكريم” الخطير، أصدرت الجهة المستضيفة بياناً ورد فيه: “… رمز من رموز الفكر النقدي العربي الحر والجريء، ومؤلّفاته كان لها دور في تحريك المياه الراكدة وإثارة الكثير من الأسئلة التي عُدّت في مرحلة من المراحل مما لا يجوز مقاربته”. لنسأل هنا عن الدور الأساسي الذي اضطلعت به اتحادات الكتّاب العربية وراكمته خلال عقود متمثّلاً بمحاربة هذه الأسئلة والاصطفاف مع الأنظمة في وجه كل من سعى إلى تحريك المياه الراكدة.
أمّا الرابطة فتقول في الخبر المذكور أن فعالية “التكريم” (يصعب إلصاق هذا الوصف بندوة عادية بثلاثة متحدثين لم يعرف عنهم التخصص في فكر الراحل) “تكتسب أهميتها” من خلال التفاعل بين تجربة الشخصية المكرّمة وبين المكان المحتضن للتكريم لما يعبّران عنه من “انفتاح وتنوّع وتفكير نقدي وجريء و….”، و”أنهما يخوضان “معركة واحدة ضد القوى الظلامية”.
برع المنظّمون في تحويل فعاليتهم المزمع عقدها غداً الثلاثاء، إلى حفل لتكرار الشعارات المفرغة من مضامينها التى قضى العظم عمره في محاربتها، ولإعادة كليشيهات مسطّحة أمضى المفكّر السوري حياته في نقدها وتفكيكها؛ براعةٌ تفضي إلى تسمية تكريم مجاني.
العربي الجديد
في وداع العلماني المهاجر/ ساطع نور الدين
تعددت الهجرات، والموت واحد. كانت الهجرة الاخيرة هي الاصعب والأشقى. وهي التي بدأت منذ اكثر من نصف عقد او منذ نصف قرن. وثمة من يقول إنها انطلقت منذ لحظة الولادة، من حالة التمرد الاولى على الوجود والقيود. يومها خرج المهاجر من العائلة، ثم من المدينة، ثم من البلد، ثم من المشرق، ثم من الأمة.. ولم يعد. ولن يعود.
أسدل المنفى الالماني الستارة على سفر طويل، حط في جميع القارات وتنقل بين مختلف الثقافات والحضارات، حاملاً الاسئلة نفسها، حاصلاً على الاجوبة ذاتها، التي أضيف اليها جواب أخير عن إستحالة العودة الى مربع الطفولة والمراهقة والدراسة الاولى، وعن صعوبة تنظيم جنازة لائقة، وترتيب وداع مشرف ورثاء مكتمل، في المدينة المحاصرة التي كان من معالمها ورموزها ودلالات تاريخها العريق.
كانت الهجرة الاولى هي الأطرف والاكثر إثارة للحشرية. مغادرة الأصل الارستقراطي بدت أشبه بتطور طبيعي ، بالمقارنة مع مغامرات بالغة الجرأة، ساهمت في تشكيل شخصية لا تنسى، وفي تكوين إرث ثقافي لا يمحى، وفي بلورة فكر مهدد بالفعل بالنسيان او الزوال، لانه لم يعد يتلاءم مع ميول اجيال مشوهة أنجبتها الانهيارات والهزائم المتلاحقة التي كانت ولا تزال تشكل مرادف الوجود العربي وسمته الابرز طوال عقود طويلة.
لم تكن الهجرة الاخيرة الى المنفى الالماني نتيجة الثورة السورية، لكنها كانت حصيلتها، واحدة من علامات خيبتها الراهنة وإحباطها المقيم. سبق للمهاجر ان نُفي اكثر من مرة من وطنه الذي ضاق بأفكاره وأرائه ومواقفه. لكنه لم يسبق أن هاجر كثائر سياسي معلن على نظام لم ينتمِ اليه يوماً، وأصبح في السنوات الخمس الماضية من عناوين النكبة السورية، التي تمثلت بتوالد الاستبداد وتوارثه وتمدده الى مختلف زوايا المجتمع السوري وفرقه الاسلامية التي تتنافس مع النظام على الفاشية.
في المنفى، مات المهاجر السوري علمانياً مثلما ولد، في النصف الاول من القرن الماضي، عندما كانت العلمانية طموحاً مشروعاً وحلماً عربياً جميلاً يطور حركة النهضة ويكملها، وقبل أن تصبح الان عنوان مجموعة صغيرة مهددة بالانقراض من الصعاليك أو شذاذ الافاق، الذين يشعرون ان غربتهم تزداد قسوة يوماً بعد يوم، وهي التي تقف من جهة ضد أنظمة بلغت من الوحشية ما لا يوصف، ومن جهة اخرى ضد تنظيمات اسلامية بلغت من البربرية ما لا يحتمل.
ظل مفكراً متمرداً ومثقفاً مشاكساً، أميناً للفكرة الاصلية التي شوهت في الاونة الاخيرة على يد أصوليين علمانيين،لا يختلفون عن الداعشيين بشيء، سوى أنهم موضع ترحيب الغرب، وموقع رهان اسرائيل. وهم في ذلك انغماسيون حتى الموت.
لم يخطىء يوماً في توصيف النظام، ولا في تحديد هويته الاخيرة المثيرة للجدل، والمستوحاة من التجربة اللبنانية. مثلما لم يخف يوما خشيته من الاسلاميين الذين ورثوا عن الثورة الاسلامية الاخيرة في اواخر سبعينات القرن الماضي، من الثقافة والتجربة ما يكفي لهدر دماء شعوب ودول وطوائف واقليات كاملة.
…
ليس من السهل ان يودع المرء جزءاً عزيزاً من ذاكرته، ليعترف ضمناً أنه بات على عتبة الاصابة بالالزهايمر، بالغربة الكاملة عن المحيط، بالانفصال التام عن الواقع. ليس من السهل ان يرثي جانباً مهماً من ثقافته، او ان يحرق زاوية غالية من مكتبته وكتبه، او ان يشطب جدالاته الاولى التي أثارها ذلك المهاجر السوري الابرز في كل ما كتب.
في رحيل صادق جلال العظم، ما يستدعي الاقرار بان مساحة الوطن تصغر، ورحابة الفكر تضيق، وراية الثقافة تهبط، أكثر من أي وقت مضى. بشائر الربيع العربي التي هلّل لها الراحل، وإحتفى بقدومها الى سوريا، لم يعد لها أثر
المدن
صادق جلال العظم لا تأبينا ولا رثاء/ خلدون الشمعة
مرثية الدكتور صادق جلال العظم الذي غادرنا في الهزيع الأخير من ليلنا السوري، لابد أن تتضمن ومضة استعادية لعقلانية الفقيد المطلقة العنان في قراءة التاريخ. ولا شك أن هذه القراءة، قراءة الفقيد، تمثل طرحا تنويريا مبكرا لعلمانية تصف نفسها بأنها صانعة سردية التقدم المستمر بامتياز.
هذه السردية التي تومئ بجرأة إلى إحدى قمم الفقيد السجالية، يمثلها كتابه “نقد الفكر الديني” أفضل تمثيل.
ونحن هنا لسنا إزاء نص ينتمي إلى النقد بالمعنى العادي المألوف، بل نص يطفر إلى ما هو أبعد منه، إلى النقد التأسيسي الشامل، النقد المسلح بمحمول معرفي متعدد الأنظمة، المشفوع بطاقة حجاجية تقوم آليات تدخلها السجالي بترويض الكائنات المتوحشة التي تمثل الأفكار المناهضة للفكر العقلاني، وتتجنب في مخاطبتها القارئ العام لغة الفلسفة الاختصاصية قدر المستطاع.
ولكن خلف هذا الحشد الهائل من المحاجات وتدفقها العفوي الذي يجعلها أقرب إلى النص المنطوق منها إلى النص المكتوب، تكمن عقلانية العظم الغائية في قراءة التاريخ، وهي كما أشرنا تصف نفسها عادة بأنها صانعة سردية التقدم المستمر بامتياز. ولكن هل ثمة حقا عقلانية في قراءة التاريخ كحتمية تاريخية صانعة للتقدم؟
تاريخ من؟ ووفقا لأي نموذج مرجعي (باراديم)؟ وما القول عندما تسير الحتمية التاريخية في الاتجاه المعاكس كما هو الحال في الشأن السوري؟ وهل يتعين علينا نحن العرب المعاصرين المرور عبر طقوس العبور التي مر بها الأوروبيون لكي نحقق التقدم وفقا لنموذج أوروبي مسبق الصنع؟ هذه الأسئلة الخلافية غائبة عن طروحات الكتاب المشار إليه والتي يعلو فيها صوت الداعية على صوت الباحث بين الحين والآخر. وفي تقديري أن ذلك ربما يعود إلى كونها تمثل فكرا تأسيسيا جريئا ومبكرا للمواجهة بين العقل والدين في بلادنا.
ولكن يبدو أن الاعتداد بلغة الطائفة والقبيلة والإثنية التي لا تستطيع أن تبرر نفسها إلا بالاعتماد على حفريات تاريخية غير موثوقة، وهو ارتداد مؤسف فرضه الطاغوت السوري وسادته الإيرانيون والروس، اضطر صادق جلال العظم في آخر حواراته اللافتة إلى الهبوط من علياء المثال إلى أرض الواقع والقول بصراحة إن كتاب “نقد الفكر الديني” لقي قبولا في الأوساط الشيعية لأنه كان مكرساً لنقد الفكر السني، فكر الأغلبية. لذلك “لم ينزعج الشيعة من الكتاب” على حد قوله.
كما أن سيطرة ظاهرة الطاغوت السوري وتقديم نفسه زعيما تفوق أهميته البشر والحجر، دعته إلى الاستجابة إلى سؤال محاوره في الحوار نفسه للإشارة إلى مفارقة مفادها أن كلمة “زعيم” غير قابلة للترجمة إلى اللغة الإنكليزية وأنها في حكم الكلمة الميتة في القاموس الأوروبي المعاصر نظرا إلى أن جزءا من أهمية الكلمة يأتي من الشحنة العاطفية التي تحملها. وهذا صحيح.
ولكن هل يصح القول تبعا لذلك إن مقولة الاستبداد الشرقي، مقولة هيغل صحيحة؟ تساؤل قد لا يكون محله هذه العجالة، يجب عليه التفكير في اللغة العربية، وعلى وجه التحديد التمعن في صلة القرابة اللغوية بين كلمات الزعيم والزعامة وفعل “زعم”. فكأن لغتنا العربية تنزع بطبيعتها إلى رفض القبول بسلطة الطواغيت. هذه مجرد أفكار استعادية تفتحها بعض أفكار صادق جلال العظم. إنها ليست تأبينا ولا مرثية. رثاء فقيدنا الكبير يحتاج إلى جهد مختلف ووقت آخر.
ناقد من سوريا مقيم في لندن
العرب
مسار مفكر نقدي شجاع/ أزراج عمر
قال لي مرة صديقي الشاعر والمسرحي التونسي الراحل مصطفى الفارسي إن الأدباء والمفكرين الحقيقيين لا يموتون وإنما يغيرون مواقعهم فقط، ويصدق هذا القول على الناقد والمفكر السوري الدكتور صادق جلال العظم كل الصدق. تعود علاقتي بكتابات الدكتور صادق جلال العظم، الذي تمنيت كثيرا أن ألتقي به ولكن أمنيتي لم تتحقق مع الأسف، إلى أكثر من أربعين سنة.
كان أول كتاب قرأته لصادق جلال العظم هو النقد الذاتي بعد الهزيمة. في ذلك الوقــت كنت يافعا ولكن أدركت بإحساسي القروي الذي لم تلوثه المدن أن ما كتبه الرجل صادق وأن مبضعه قد تمكن فعـلا مـن إصابة مناطق التخلف البـنوي المـريـضة في حياتنا السياسية والثقـافية والفكـرية.
لقد جعلني هذا الكتاب، إلى جانب كتب قليلة أخرى كنت قد قرأتها، أدرك تماما أن دور المفكر النقدي في بلداننا يستمد مصداقيته ويؤسس فاعليته من النقد الصريح والجريء للبنية الثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية المركبة التي فرخت ولا تزال تفرخ شتى أنماط الهزائم في مجتمعاتنا من أجل تأسيس المجتمع الحداثي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من تجاوز للتخلف والدكتاتورية.
أما الكتاب الثاني الذي لفت انتباهي وقرأته مرارا فور وصول نسخ منه إلى المكتبات الجزائرية فهو كتاب نقد الفكر الديني الذي أثار وقت صدوره ومن بعده أيضا زوبعة من الاتهامات ضد مؤلفه منها تهمة الالحاد، حيث نشرت فتاوى من طرف الاتجاهات الإسلامية المتطرفة تدعو إلى تصفيته جسديا.
في هذا الكتاب الشجاع نقل جلال العظم الجهاز الفلسفي المكتنز لديه من مدارات التأملات الميتافيزيقية إلى تشريح ما ادعوه بالشخصية العربية المتمركزة في النسق الثقافي الديني الرجعي الذي يمثل خطرا كبيرا على التنوير الإسلامي الأصيل.
في الواقع إن ما يعرفه القراء باللغة العربية في بلداننا عن جلال العظم قليل جدا وينحصر غالبا في الكتابين المذكورين، وكذا كتاباته عن ذهنية التحريم والعلمانية والإسلام، والصهيونية والصراع الطبقي، التي تقرأ وتدرس من طرف القراء العاديين وقليلا ما يتم تناولها بالدراسة النقدية الجادة من جانب نقادنا.
ولكن للدكتور جلال العظم كتب أخرى ملفتة للنظر في حقل البحث الفلسفي باللغة الإنكليزية وهي تدرس في كبريات الجامعات الغربية منها الجامعات الأميركية والبريطانية.
إن هذا الجانب الفكري الرصين عند الدكتور جلال العظم مكرس لفلسفة إمانويل كانط وغيره من المفكرين الفلاسفة المؤثرين في مسارات الفكر العالمي، ونذكر هنا كتابه عن نظرية الزمان عند كانط، وكتابه حول أصول محاججات كانط في المتناقضات، وكتابه عن الفيلسوف الفرنسي برجسون.
لا شك أن وضع هذه الكتب في العربة الأخيرة من اهتمام دارسي الفكر في العالم العربي، ومن قبل المسؤولين عن وضع وإقرار المناهج الدراسية الفلسفية في جامعاتنا وثانوياتنا هو ترجمة كاملة لهيمنة الفكر التقليدي المتخلف على حياتنا الفكرية والتربوية، والذي حاربه جلال العظم في كتبه وندواته.
سيذكر التاريخ الدكتور جلال العظم كمثقف شجاع مهما كان الخلاف معه في القضايا التي يبادر إلى مناقشتها، وكما سيذكر كواحد من النقاد المؤمنين بالحرية الفكرية وبأن الطريق إلى تحديث الإنسان في بلداننا وإخراجه من النكوص الديني الخرافي مشروط دائما بالفكر العقلاني النقدي.
كاتب من الجزائر
العرب
معركة التحديث على كل الجبهات/ فرح الهاشم
يتصدر صادق جلال العظم سليل العائلة الأرستقراطية التركية/ العربية، قائمة المفكرين العرب الذين تصدوا لمجالات النقد الديني، على أهمية الوهج الذي اكتسبته أفكاره ومواقفه وأطروحاته الأخرى إزاء السياسة والفلسفة والقضايا العربية الكبرى.
اتسقت ونمت هالة المثقف العضوي في شخصيته مع الأحداث السياسية المفجعة، فطبعت انشغالاته وحراكه الفكري وإنتاجه التأليفي. وقد شكلت هزيمة حزيران 1967 منعطفاً جذرياً في هويته، فتدرج من «عالم الأفكار المثالية» إلى «الفعل التاريخي النقدي»، أي أنّه انتقل من التنظير الفلسفي إلى عالم الصراعات والوقائع، وهو القائل: «كان المنعرج المهم في حياتنا كنخبة ومفكرين في مرحلة ستينيات القرن العشرين هو هزيمة العرب أمام إسرائيل في 1967؛ هذه الهزيمة جعلتنا نرى بشكل آخر، ما كنا نراه على أنه مرحلة واعدة ومتفردة لما يسمى الدول النامية والدول العربية والثقافة العربية. إن الهزيمة صححت الوهم والتصورات السائدة في المجتمعات العربية حول البطولات والشعارات المملوءة بالحماسة والفارغة من الواقعية والعقلانية».
خاض العظم في دفاعه الحاسم عن العقلانية وحرية الرأي والتعبير معارك التحديث على أكثر من جبهة في المجتمع والفلسفة والسياسة والدين. تدرجت مراحل حياته بين الأكاديمي والناقد والمنشغل في الشأن العام السوري، ولا سيما بعد محطتين رئيستين: الأولى «ربيع دمشق»، والثانية «الثورة السورية» 2011 التي آثر تسميتها بهذا الاسم، رافضاً أي تسويات أخرى تقلص حجم حراكها ومآسيها ومآلاتها الراهنة.
من جامعة «يال» في الولايات المتحدة، نال الدكتوراه في الفلسفة الفرنسية المعاصرة عام 1961 تحت عنوان «فلسفة الأخلاق عند هنري برغسون». درَّس في جامعة دمشق لعام واحد بعد تخرجه، وانتقل بعدها للتدريس في الجامعة الأميركية في بيروت بين عامي 1963 و1968. في عام 1969، كان أستاذاً في الجامعة الأردنية، لكنه سرعان ما تركها عائداً إلى بيروت، فعمل باحثاً في مركز الأبحاث الفلسطينية، وكتب في مجلة «شؤون فلسطينية». وبعد مضايقات، ترك العمل، وواصل الكتابة باسم مستعار، بترتيب من الدكتور أنيس صايغ. وفي الثمانينيات، تولى قسم الفلسفة في جامعة دمشق ودرس فيها بين عامي 1977 و1999، ثم غادر إلى جامعة «برنستون» أستاذاً زائراً. (راجع «موسوعة أعلام العرب المبدعين»، خليل أحمد خليل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر).
تجاوزت مؤلفات العظم الـ 13 في العربية، يُضاف إليها ما كتبه بالإنكليزية وعشرات الدراسات والمقالات والأبحاث. صدرت له الكتب الآتية: «دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة»، و«دفاعاً عن المادية والتاريخ»، و«دراسات يسارية في فكر المقاومة»، و«دراسات نقدية لفكر المقاومة الفلسطينية»، و«سياسة كارتر ومنظّرو الحقبة السعودية»، و«زيارة السادات وبؤس السلام العادل»، و«في الحب والحب العذري»، و«الاستشراق والاستشراق معكوساً»، و«نقد الفكر الديني»، و«ذهنية التحريم»، و«ما بعد ذهنية التحريم» و«الصهيونية والصراع الطبقي».
كتابه «النقد الذاتي بعد الهزيمة» جاء بمثابة «صدمة» للذات العربية المهزومة
على الرغم من انشغاله بـ«النقد في كل اتجاه»، تحديداً على المستويين السياسي والديني، إلا أن العظم لم يغامر في التخلي عن يساريته التي ظلت تؤطره فكراً وممارسة. تكثف انشغاله في الشأن السياسي العام بعد هزيمة حزيران، فوضع كتابه الذائع الصيت «النقد الذاتي بعد الهزيمة»، فجاء بمثابة «الصدمة الجرحية» للذات العربية المهزومة، محبذاً استخدام كلمة «الهزيمة» بدل النكسة تفادياً لحالة الإنكار وتغييب المسؤولية التاريخية. في مقابلة أجرتها معه مجلة «الجديد» الشهرية الثقافية اللندنية في عددها الصادر في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي (العدد 21)، تحدث العظم عن كتابه: «صدر الكتاب في بيروت عام 1969 وكان العالم العربي لا يزال يعيش تحت صدمة هزيمة الجيوش العربية وبالخصوص الجيش المصري والسوري والأردني أمام الجيش الإسرائيلي في حرب 1967. دخلت الأنظمة العربية في أزمة مسّت بشرعيتها، كما فقدت كل السلطات رمزيتها وهيبتها لدى المواطن العربي، بما في ذلك السلطة الدينية، والسياسية، والمدنية، والشرعية أو القضائية. هذه الصدمة، التي امتدت لسنوات، جعلت المجتمعات تدخل في مزاج عدمي فسح المجال لعهد جديد من النقاش والنقد وتحليل ما حدث، فأصبح التصريح والقول مباحين خلافاً لما كان في السابق محرّماً وممنوعاً، وأصبح المتلقي بعد هزيمة 1967 منفتحاً على التقبل والإصغاء لخطاب جديد يفسّر له ما آلت إليه الدول العربية، وهو الأمر الذي كان غير ممكن في السابق».
في عام 1969، أصدر «نقد الفكر الديني» عن «دار الطليعة» في بيروت، ففتح عليه وعلى صاحب الدار الراحل بشير الداعوق نار القوى الرجعية والظلامية التي أوصلته إلى المحاكمة والقضاء في لبنان، فخرج منها منتصراً لعقله وحقه في المساءلة ومقارعة الاستبدادية الدينية والسياسية، بعيداً عن مقولات وشعارات «إثارة النعرات الطائفية» أو «ازدراء الديانات السماوية». تصدى في سفره هذا بالنقد العلمي والمناقشة العلمانية والمراجعة العصرية لبعض نواحي الفكر الديني السائدة آنذاك. احتوى الكتاب في طبعته الأولى المحاور الآتية: «الثقافة العلمية وبؤس الفكر الديني»، «مأساة إبليس»، «ردّ على النقد»، «معجزة ظهور العذراء وتصفية آثار العدوان»، «التزييف في الفكر المسيحي الغربي المعاصر»، «مدخل إلى التصور العلمي ــ المادي للكون وتطوره». وفي الطبعة الثانية الصادرة عام 1970، نشر في الكتاب ملحقاً تضمن: وثائق من محاكمة المؤلف والناشر، القرار الظني، الاستجواب أمام محكمة المطبوعات وقرار المحكمة.
لا شك في أنّ «نقد الفكر الديني» سيظل علامة ثقافية فارقة في الإنتاج الفكري/ الإبداعي الذي خطه صادق جلال العظم، فلا يزال إلى الآن محطة للسجال والنقد والتحليل.
في «ذهنية التحريم: سلمان رشدي وحقيقة الأدب» (1994)، يتناول العظم بالدراسة النقدية والأدبية والتاريخية المقارنة أدب سلمان رشدي عموماً وروايته الفائقة الشهرة «آيات شيطانية»، بعد فتوى الخميني بإهدار دمه. جاء في المقدمة: «تعالج دراستي موضوعها بمنهج مضاد للمنهج الذي ألفناه في التعامل مع قضية رشدي، وأدبه عربياً وإسلامياً في أقل تعديل: وأقصد منهج ذهنية التحريم وعقلية التجريم ومنطق التكفير وشريعة القمع. أقول هذا لأن التمعن الهادئ والرزين سيبين أن ما نجم عن «آيات شيطانية» من تفاعلات وردود فعل ومناقشات، يشكل حقاً تطوراً فريداً وحدثاً فذاً لا سابق له في التاريخ الحديث شرقاً وغرباً (…) تمتاز «آيات شيطانية» وحادثتها في كونها أول رواية سجالية ساخرة في العصور الحديثة تجمع الغرب العلماني والشرق الإسلامي معاً في فضيحة أدبية كبرى واحدة وتقحمها معاً في القضية الفكرية ــ السياسية ــ الأيديولوجية العالمية ذاتها، مما لا يعرف له التاريخ المعاصر شبيهاً». أثار الكتاب عواصف من الانتقادات، فكتبت مقالات ودراسات انتقادية ردّ عليها العظم بـ«ما بعد ذهنية التحريم» الصادر عن «دار المدى» عام 1997.
لم يتوقف العظم عن طرح المفاهيم والمصطلحات الجديدة. في ندوة نظمتها «مؤسسة ابن رشد» في ألمانيا عام 2012، ألقى محاضرة تحت عنوان «الدولة العلمانية والمسألة الدينية: تركيا نموذجاً» ميّز فيها بين ثلاثة إسلامات: «إسلام الدولة الرسمي» و«إسلام البزنس» و«الإسلام الأصولي الطالباني التكفيري الجهادي العنيف». اعتبر أن هذه الإسلامات تتصارع على ضبط معنى الإسلام والسيطرة عليه. يقصد بـ«إسلام البزنس» ــ الذي يراهن عليه ــ «إسلام الطبقات الوسطى والتجارية، إسلام البازار والأسواق المحلية والإقليمية والمعولمة، إسلام غرف التجارة والصناعة والزراعة، إسلام المصارف وبيوتات المال المسماة إسلامية، وإسلام الكثير من رؤوس الأموال الطافية والباحثة بيقظة عالية عن أي فرصة استثمارية سريعة ومجزية في أيّ ناحية من نواحي الكرة الأرضية اليوم. والى الحد الذي تشكل فيه بورجوازيات البلدان الإسلامية عموماً والعربية تحديداً العمود الفقري لمجتمعاتها المدنية، فإن هذا الإسلام الجيد والمفيد للبزنس يكون هو أيضاً إسلام المجتمع المدني فيها. إنّه إسلام معتدل ومحافظ، يتمحور حول عمليات البزنس بكل أشكالها، له مصلحة حيوية في الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، وهو بالتأكيد غير مهووس بالمشركين والكفار والمرتدين والمجوس والملحدين والزنادقة والمنافقين والروافض والنواصب وأحفاد القردة والخنازير، أو بالحدود وقانون العقوبات الجسدية. انه إسلام يميل إلى التسامح الواسع في الشأن العام والى التشدد في الشأن الشخصي والفردي والعائلي والخاص».
يعتبر العظم من بين الشخصيات الثقافية الأكثر جذباً للحوار والنقاش في الإعلام العربي والأوروبي المرئي والمكتوب والمسموع. تلاحقت إطلالته بعد عام 2012 ودار معظمها حول الأزمة السورية وقضايا العالم العربي المشتعل. في بدايات حركة الاحتجاج في سوريا وخلال إقامته في بيروت، كان حذراً من موقعه كمفكر يحتاج إلى مسافة لفهم التحولات الهائلة والدامية الجارية في بلاده و«دول الربيع العربي». بعدها لم يتوان عن تسجيل مواقف صاخبة أثارت الكثير من السجال بين مؤيد ومعارض. وهو في هذا الاتجاه يُصنف بين أكثر القامات الثقافية السورية نشاطاً ويسجل له ابتكار مصطلحات جديدة كـ«العلوية السياسية» و«إسلام التوتر العالي».
منحت «مؤسسة جائزة إيراسموس» الهولندية عام 2004 جائزتها للعظم «تقديراً لجهوده في ميدان الدراسات الفكرية والدينية والفلسفية ومساهماته في إغناء الفكر العالمي والعلوم الاجتماعية»، وذهبت الجائزة أيضاً إلى عالِمة الاجتماع والكاتبة النسوية فاطمة المرنيسي (1940 – 2015) والمفكر الإيراني عبد الكريم سروش. حصل العظم على «جائزة محمود درويش للإبداع لعام 2013» احتفاءً به «مثقفاً نقدياً عربياً بامتياز». وبعد عامين، نال «جائزة ميدالية غوته» في ألمانيا وتم تسليمه الميدالية في 28 آب (أغسطس) 2015 في ذكرى مولد الأديب الألماني يوهان فولفغانغ فون غوته، في قصر الحاكم في مقاطعة فايمار.
في «حوار بلا ضفاف: حوار فكري مع صادق جلال العظم» («المؤسسة العربية للدراسات والنشر»، بيروت، 1998) يخلص الكاتب الفلسطيني صقر أبو فخر في حواره الممتع مع المفكر اليساري إلى أنه «أشعل الكثير من المعارك النقدية، فقامت عليه قيامة العالم القديم كله، وثارت في وجهه عفاريت السلطات وكائنات الكهوف. ومنذ «النقد الذاتي بعد الهزيمة» و«نقد الفكر الديني» حتى «ذهنية التحريم»، و«ما بعد ذهنية التحريم»، ظهر كأن هوايته ابتداع الأفكار والتصدي للمشكلات الكبرى وإثارة الدبابير من أعشاشها».
ينتمي صادق جلال العظم إلى الجيل النقدي المؤسس في الثقافة العربية المعاصرة إلى جانب مبدعين كبار. إن تكوينه الفكري في الغرب وامتلاكه أدواته المنهجية ومقارعته للخطاب الديني الرجعي، جعلته مفكراً عالمياً يتجاوز حدود العالم العربي إلى رحاب الاعتراف العالمي، أقله على المستوى الأوروبي.
مِن «الاشتراكية الثورية» إلى «الثورة السورية»: عودة إلى «نقد الفكر الديني”/ أحمد محسن
لا يمكن النظر إلى صادق جلال العظم من زاوية واحدة. قد تقارب إسهاماته في النقد والفلسفة حسب «الزمان» وعلى قياسه، وقد تقارب منهجياً وتفصيلياً. حسب المقاربة الأولى، وبرأي كثيرين، يحسب للرجل تصدّيه للمؤسسة الدينية في زمنٍ «صمت النص»، أو التعامل مع هذا الصمت كما لو أنه أبدي. في 1970، دافعت بيروت عنه، عندما ردّت محكمة المطبوعات الدعوى المقامة ضدّ كتاب «نقد الفكر الديني»، وضدّ المؤلّف وضدّ ناشر الكتاب، أي «دار الطليعة» الممثّلة يومها بشخص مؤسّسها وصاحبها بشير الداعوق. وبعد نصف قرن، لا يزال «نقد الفكر الديني» ممنوعاً في جميع الدول العربية، باستثناء لبنان، لكن اللافت أن الكتاب متوافر في جميع هذه الدول أيضاً، رغم قرار المنع. بعد نصف قرن على المؤلَف الأيقونة في حياة صادق جلال الدين العظم، يجب العودة إلى نقطة البداية، إلى الصدمة، تلك الصدمة التي منحت عنوان الكتاب قيمته السجالية، بمعزلٍ عن قيمته الابتسمولوجية. ذلك أن الفكر الديني، بحدّ ذاته، ليس اختبارياً، بحيث لا يوجد فكر ديني واحد يمكن الركون إليه، وكونه لا يملك كينونة جوهرية تتصدى للتحولات وتقوّمها على أساس الأصل. في الواقع، لم يكن العظم ماركسياً متطرفاً، أو شعاراتياً، وحاول أن يضع «الهرطقة» في الماركسية ضمن خانة البحث العلمي.
ماركسي أصولي؟ ربما. ومن ضمن ذلك قراءته لفيلسوفٍ كلوكاتش أو في مقاربته للحالة الفوكوية أو في رفضه التام لهايدغر. ويجب الانتباه دائماً إلى أن مسيرته الطويلة صنعت مفكّراً يتطور. المديح الذي يكال لكتاب «نقد الفكر الديني»، هو مديح الضرورة حيناً، أو مديح غير العارف أحياناً، وخاصةً أن رهط الليبراليين العرب «المفعوطين» بموقف العظم المؤيد للثورة السورية، ينسى أن مقدمة كتابه الأشهر تقول «أرجو أن يكون هذا الكتاب خطوة متواضعة وأولية على طريق تبديد الوهم وأمثاله، ومن نافل القول إن الطريق لا تزال طويلة وشاقة لمن أراد أن يسلكها بين العرب من أصحاب القناعات الاشتراكية الثورية».
صادق جلال العظم «إشكالي». رغم حسّه الأكاديمي العالي، ترفّع عن المنهج في كثير من الأحيان وساير الموقف. في محاضرة لهٍ في برلين عن «الربيع العربي»، اعتبر أن لسوريا دوراً رائداً في «الربيع» متجاهلاً أصل التسمية وإمكان إسقاطها على الحالة السورية، منطلقاً من تجربة «ربيع دمشق» (وهي مبادرة أجهضها الاستبداد)، لكنْ ثمة فارق بين «ربيع دمشق» و«ربيع براغ»، وفي الوقت نفسه بين «ربيع دمشق»، الذي لا يوارب العظم حين يتناول طبيعته «الأنتلجنسية»، و«الثورة السورية» التي أيّدها رغم أنها خرجت من مكانٍ مختلف. بيد أن العظم يجيد تفنيد مسوغات الانتفاض على الاستبداد. وفي بازار المواقف، لا يمكن إطلاق اتهامات مجانية بحق المفكّر السوري، وخاصةً في عدم اعتراضه على طابع ديني ساطع في الاحتجاجات السورية. في وقتٍ سابق، أيّد العظم ثورة الإيرانيين لنفس الأسباب التي يؤيد لأجلها ثورة السوريين: رفض الاستبداد والاستخبارات والطبيعة الأوليغارشية للنظام، رغم أن الملامح الثيولوجية في الثورة الإيرانية تشكلت باكراً، كذلك الدور القيادي البارز للإمام الخميني فيها. كذلك، له مقولات في مساندة الملتفين حول «لاهوت التحرير» اللاتيني. لقد كان موقفه أخلاقياً في سوريا، لكن إخراجه كان ضعيفاً؛ لم يكن بمستوى العظم. وإن كان نقده لظاهرة «العلوية السياسية» في سوريا نقداً يتخذ شكلاً طائفياً في بنيته ومرتكزاته، لا يعني ذلك القبول باتهام العظم نفسه بالـ«طائفية». رجل مثله يعرف بلا شك مخاطر الحديث في احتمال «قبطية» الرئيس المصري، أو في «علوية» الرئيس السوري، في زمن الأصوليات، أو في زمن «الفكر الديني»، الذي لا يزال نقده ناقصاً ولم يجد طريقه بعد إلى العقول. يفترض العظم أنه وضع إصبعه في مكانٍ حساس، وأن الأشياء يجب أن تسمّى بأسمائها، حين يكون البحث علمياً. ولكن من الناحية العلمية أيضاً، فإن القصور في قراءة المشهد السوري بلا محظورات، لا يمكن أن يُقابَل بالدفع بما يعتبره المجتمع محظوراً، على قاعدة تكتفي بالرفض للمحظور ولا تذهب إلى تفكيكه منهجياً. يبدو، من متابعةٍ موجزة لمواقفه، أنه لا يساير حسابات «الجماهير»، ولا يأخذ في الاعتبار سيكولوجيتها، حين يكون ذلك على حساب نقده ومنهجه، الذي هو في الأساس ماركسي، وهذه مفارقة.
حافظ على المنهج القابل للتطور على معيار الراهن
يمكن القول إن نظرته للثورة السورية تقف ضدّ «النظريات الجاهزة»، سوسيولوجياً لا سياسياً. على نحوٍ ما، يرى العظم أن الثورة السورية حدثت وتطورت عفوياً، ويضع أساساً نظرياً لهذا الرأي في حديثه عن «البؤر الثورية» أو «الفوكو»، وهذا مشروح في كتاب «ثورة في الثورة» للمنظر الفرنسي ريجبس دوبريه، ويستخدمه المفكّر السوري للدفاع عن طبيعة الثورة ونشأتها.
رغم هذه «الأصولية الماركسية» التي تبناها العظم، أو أنها التصقت أو ألصقت بهِ، ثمة جوانب أخرى في شخصيته، وأهمها الحفاظ على المنهج القابل للتطور على معيار الراهن. بمعنى أنه كان قادراً على البناء على ما سبق، من نقد الفكر الديني وصعوداً إلى ما هو أكثر نضجاً. تجاوز الصدمة التي أحدثها هو نفسه في أواخر الستينيات، ونجا غير مرة من فخ «القطيعة» مع الزمن والمعرفة. لم يغادر جلده، وهذا من الأوصاف القاسية التي طالته. لقد تخلى عن جزءٍ من جلده، وهذا يحدث في الفلسفة. كارل ماركس نفسه في لحظةٍ تاريخية خرج من عباءة هيغل. بطبيعة الحال، صادق جلال العظم، كان يحاول أن لا يلهث خلف الحاضر، وأن لا يقيم في الماضي، لأن كتبه كانت وليدة مرحلة لا يمكن نكرانها بسهولة. وهنا يمكن بناء سرديات متينة عن زمن المقاومة الفلسطينية والهزائم العربية والخوف من زحف إسلاموي، أنتج ما أنتجه من معارف. وهذا ينسحب على عمله بالفلسفة كما على رأيه في السياسة. فقد لمح مراراً إلى أن قراءة ابن رشد قبل ديكارت ليست كقراءته بعد ديكارت، والسجال مع لوكاش وجان بول سارتر وألتوسير لا يجعل منه محققاً في محكمة تفتيش، بل يصنع منه مساجلاً، يصرّ على تاريخية الماركسية وتاريخانيتها، على نقيضٍ من لوكاش الذي يؤلّه البروليتاريا. أما مشكلته مع التوسير، فهي أكثر حدة، إذ يرى أنها أوصلت الماركسية إلى المأزق السكوني ذاته، انطلاقاً من رفضه للبنيوية لأنها حالة غير تاريخية أيضاً. ولكن هذه «سجالات»، ولا تتجاوز ذلك وتصل إلى حد الحديث عن «هرطقة».
في مقابلاته ومحاضراته، ومعظم أعماله، لا يقول ذلك، لكنه يتحدث دائماً عن الواقع في «الشرق» كما لو أنه يتحدث عن أوروبا في القرون الوسطى. وهذا ما جعله يخوض سجالاً خاسراً مع إدوارد سعيد. أما تقلباته في توصيف المشهد الإسلامي، فليست محيّرة تماماً. وبعيداً عن نكتة «الأصل التركي» للمفكّر السوري التي يعايره به خصومه، فإن إسهامه في تلميع الإسلام الإردوغاني يحتاج إلى تدقيق. والمفارقة أن إسهامات العظم حدثت قبل الانقلاب الأخير (لا يلغي ذلك أن الإسلام التركي ظاهرة بخصوصية فريدة). رغم راهنية العظم، ومحاولاته الدائمة أن يكون راهنياً، فقد فاته قراءة يورغن هابرماس عندما يلخّص العلاقة بين الإسلاميين والحداثة، أثناء بحثه في «مستقبل الطبيعة الإنسانية، نحو نسالة ليبرالية». لقد حدد هابرماس الفجوة بين الإسلاميين والزمن بالانقطاع عن الحداثة نفسها. كان واضحاً وحاسماً، وتفادى مطب الراهنية الذي يساوق الحاضر ويترك الأزمة تراوح مكانها. بعد ربع قرن من الجهد والمثابرة، لا يزال «نقد الفكر الديني»، هو العمل الأبرز في أعمال صادق جلال العظم، وهذه أكبر المفارقات.
الإرث المتناقض/ أسعد أبو خليل
كان صادق العظم من أنشط المثقّفين العرب، وأكثرهم إسهاماً في العمل السياسي المباشر. لم يفهم العظم الثقافة على أنّها حيّز منفصل عن العمل السياسي الثوري—في حينه. أراد أن يجمع بين مهمّة المثقّف ومهمّة السياسي الثائر.
وكان العظم حاداً جاداً في سجالاته وهو خوّن خصومه واتهمهم بالعمالة تماماً على طريقة حزب البعث—الذي لم يعارضه (علانية على الأقلّ) إلا في سنواته الأخيرة—أي بعدما انتفض الشعب السوري على النظام القمعي في موسم الانتفاضات. قبل ذلك التاريخ، كان العظم مهادناً للبعث ومُقلّاً في إسهاماته للمعارضة السوريّة عندما كانت محليّة الصنع، وغير مرتبطة بالخارج. والتيّارات اليساريّة كانت دوماً جزءاً فاعلاً في المعارضة السوريّة لنظاميْ حافظ وبشّار الأسد.
والعظم برز بعد هزيمة ١٩٦٧. كانت كتاباته في مجلّة «دراسات عربيّة» في مجال ما دُرج على تسميته بـ «النقد الذاتي» بعد الهزيمة مقروءة على نطاق واسع. لكن إعادة النظر في تلك الكتابات يضعها في سياق مختلف تماماً على ما كانت مصنّفة عليه آنذاك. كانت تلك الكتابات مدرجة في سياق النقد الماركسي الجذري، لكن الذي يعود إليها الآن—خصوصاً بمنظور العلوم الاجتماعيّة الحديثة، أو بمنظور نقد الاستشراق الغربي والشرقي- ينفرُ من تضمنّها لكليشيهات تعميميّة واستشراقيّة كلاسيكيّة لا تندرج بتاتاً في العلوم الاجتماعيّة الحديثة. على العكس، تتصف تلك الكتابات (من العظم ومن أدونيس ومن هشام شرابي ومن غيرهم) بعنصريّة ضد العرب والمسلمين، وهي تضمّنت مغالطات حول رؤية العدوّ الإسرائيلي وفهم تفوّقه العسكري وقوّته. هذه الكتابات العربيّة التي جذبت جيلاً من الشباب العربي، أغفلت أنّ العدوّ الإسرائيلي هو مجتمع لم يصل يوماً إلى العلمانيّة والعقلانيّة وان نزعة من الأصوليّة واللاعقلانيّة الدينيّة كانت موجودة دوماً في داخل الكيان الغاصب. والكتابات تلك قلّلت من أهميّة دور الدعم الأميركي اللامحدود للمشروع الصهيوني العسكري-العنصري، الذي أثّر في ميزان القوى في الصراع العربي-الإسرائيلي. لو أنّ الاتحاد السوفياتي أغدق بالمساعدات على العرب بشكل نوعي مماثل للمساعدات الأميركيّة لإسرائيل، لما كانت دعوات العقلانيّة في النظر إلى المجتمع العربي ستقلى تجاوباً أو صدى.
كليشيهات استشراقيّة كلاسيكيّة لا تندرج بتاتاً في العلوم الاجتماعيّة
على العكس، إن كتابات النقد الذاتي أفرطت في تحميل العرب—كعرب—مسؤوليّة أمور يتحمّل الغرب المعادي المسؤوليّة عنها. كما أن بعض الشروط والعناصر التي اعتبرها العظم ورفاقه ضروريّة لتحقيق النصر لم تكن بالفعل ضروريّة: كيف مثلاً استطاع ستالين تحقيق النصر على النازيّة؟ وهل كان النظام الإيراني علمانياً في معاركه ضد العراق، وهل حقّق صدّام «نصره» على الكويت بفعل تفوّق نظامه العلمي؟ وما علاقة تنشئة الأطفال بالنصر العسكري؟ والولايات المتحدة تمثّل نموذجاً متخلّفاً من العقلانيّة الثقافيّة، لكن هذا موضوع آخر. واشتهر العظم وبرز في كتاب «نقد الفكر الديني». وكتابه، وإن حاول بصورة بدائيّة تقديم دين بديل لا إيماني، خدش الحساسيّة الدينيّة وأنزل الاستكبار الديني في بلادنا من عليائه، وهذا حسن طبعاً. لكن العظم لم يضع الفكر الديني في سياقه التاريخي وفعل (في ما بعد) ما فعله ملحدو الغرب (مثل سام هرس وكريستوفر كيتشنز) الذين غالطوا الإسلام كدين أكثر بكثير مما غالطوا، مثلاً اليهوديّة والمسيحيّة. ونقد الإسلام (من منظور الفكر الغربي الذي نهل العظم منه) أسهل بكثر من نقد الأديان الأخرى لأن لا عواقب سياسيّة أو مهنيّة لهذا النقد. إن الكتابة عن اليهوديّة لا تزال محفوفة بالمخاطر (في الشرق والغرب) لأن رمي تهمة معاداة السامية (عن حق أو عن غرض سياسي) تكفي للقضاء على المهنة. وأدب «النقد الذاتي» كان فشّة خلق لكن غير مفيدة سياسيّاً. هو حوّر الأنظار عن الأسباب الحقيقيّة لتفوّق العدوّ الإسرائيلي ولنوعيّة التبنيّ الغربي للمشروع الصهيوني، وأدّى إلى لوم العرب لأنفسهم (مهما كان لوم الأنظمة مبرّراً).
لكن العظم الذي كان ماركسيّ المنطلق، تحوّل فجأة في التسعينيات إلى ليبرالي لا علاقة له باليساريّة. والرجل الذي كان يخوّن خصومه الليبراليّين ويتهمهم بالعمالة لإسرائيل وأميركا—أحياناً لمجرّد اللقاء بأستاذ أميركي في جامعة هارفرد (كما فعل في حالة هشام شرابي ووليد الخالدي)، تصالح مع المستشرقين الصهاينة في الغرب. وفي الوقت الذي هزّ إدوار سعيد فيه الوسط الأكاديمي الغربي برمّته (في كتاب «الاستشراق») وزعزع ثقته بنفسه—على قول ماكسيم رودنسون—انبرى العظم لنقد كتاب سعيد والتركيز على أمور تفصيليّة فيه. وسُرّ الصهاينة في الغرب بنقد العظم لسعيد، ودعا مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة برنستون (من المعاقل الأكاديميّة الصهيونيّة في أميركا، الذي كان آنذاك تحت إشراف برنارد لويس) العظم لقضاء وقت زائراً في الجامعة. ثم تلت زيارة العظم لبرنستون زيارة الى مركز ولسون في واشنطن.
تعرّفت إلى العظم عن كثب في تلك السنة، في عام ١٩٩٢-٩٣ الدراسي، عندما حللتُ أستاذا زائراً في جامعة جورجتاون في واشنطن. والعظم لطيف المعشر وقريب من التلاميذ وسهل التآلف، على عكس الكثير من الأكاديميّين العرب الذين يرون في الصفة الأكاديميّة بكويّة أو باشاويّة. وكنتُ قد تعرّفت على العظم في أواخر السبعينيات أثناء دراستي في الجامعة الأميركيّة في بيروت عندما كنت أعدّ دراسة طويلة عن الدور الاستعماري للجامعة لصالح «تجمّع الطلاب الديموقراطيّين» (الصفة الديموقراطيّة في الاسم هي بمعناها الكوري الشمالي لا الغربي السائد). وكان العظم ودوداً جداً ومُشجّعاً وأجاب عن أسئلتي عن تاريخ الجامعة وعن المشاكل التي تعرّض لها في سنوات تدريسه فيها عندما انبرى الأساتذة اللبنانيّون الرجعيّون في الجامعة آنذاك (وبعضهم لا يزال يدرّس فيها مثل سمير خلف) لتحريض الإدارة ضد العظم بسبب يساريّته ودعمه القوي للمقاومة الفلسطينيّة.
وتعرّفت أنا والصديق بسام حدّاد (وكان تلميذي في تلك السنة) أكثر على العظم في سنة ١٩٩٢-٩٣، وكان الأخير يُفوّضني مكانه في الأيام الذي تعذّر فيها حضوره لإلقاء محاضرات (وكان الموضوع غالباً هو العلمانيّة في العالم العربي). لكن إدوار سعيد كان يحذّرني منه، وكان يقول لي بكلام لن أنقله حرصاً على الأسماع أن العظم دُعي إلى أميركا من قبل الصهاينة من أجل…التملّق لهم. ورفض سعيد بحزم محاولتي (بالنيابة عن العظم) للتوسّط بينهما، وتوفي سعيد وهو لم يغفر للعظم فعله ومواقفه.
وعندما عرفتُ العظم عن كثب، فوجئتُ بأنّ اسم عائلته يعني له الكثير، وروى لي أكثر من مرّة عن مبارزة بينه وبين زوجة مصطفى طلاس في الزهو بأصل العائلة، والدم الأزرق والدم الليلكي (حسب وصفه). لكن الفراق بيني وبينه حدث عندما قبلَ أن يخطب أمام الذراع الفكري للوبي الصهيوني (أي«مؤسّسة واشنطن»). وعندما هاتفته مستاءً، قال لي— بالحرف ــــ بصوت ضعيف: «اليهود انتصروا، يا أسعد». لن أنسى هذه العبارة وهي بقيت معي إشارة إلى تحوّل الرجل من داعٍ إلى الكفاح المسلح على طريقة فيتنام إلى مهادِن مع اللوبي الصهيوني. وقلتُ له يومها: أنتَ أبو التخوين ورمي تهم العمالة ضد المثقّفين العرب، والآن تتحدّث أمام اللوبي الإسرائيلي نفسه؟ ماذا كان العظم في الماضي سيقول عنكَ؟ وأنهيتُ المكالمة غاضباً. اتصل بي بعد دقائق وقال لي: سيسرّك أنني اعتذرتُ في اللحظة الأخيرة بداعٍ صحي. قلتُ: لن يسرّني. كان يجب أن تعطي سبباً سياسيّاً لا صحيّاً للاعتذار. لم أره لسنوات إلى أن صادفته في مؤتمر جمعيّة دراسات الشرق الأوسط في بوسطن قبل سنوات. قلتُ له ساخراً: أنتَ أصبحتَ داعية ديموقراطياً؟ أكاد لا أصدّق.
وتحوّل العظم بالفعل إلى ليبرالي—على الطريقة العربيّة السائدة والمبتذلة، التي تسرّ أنظمة الخليج لأسباب واضحة- لا بل إن كتاباته وتصريحاته بعد نشوب الحرب السوريّة تضمنّت، يا للمفارقة، كلاماً طائفيّاً صارخاً. أحب أن أتذكّر العظم قبل أن أعرفه، عندما كنت اقرأه في سنوات الصبا، وعندما كان يمثّل نموذجاً ثوريّاً للمثقّف العربي. لكن تراكم مواقف وخطاب العظم في السنوات الماضية يجعل من هذه المحاولة مستحيلة. يصعب العودة إلى كتاباته القديمة. أجدني أشتم فيها الآن ما لا أستسيغ.
مصلوب على خشبة الحرية/ الأب جورج مسّوح
تصدّى صادق جلال العظم في كتابه الأساس «نقد الفكر الدينيّ» (دار الطليعة، بيروت، 1969) للأسس الدينيّة التي تقوم عليها الذهنيّة الغيبيّة والإيمان بالأساطير والاتّكال على الله والأنبياء والقدّيسين. واعتبر أنّ الدين سلاح فعال في يد القوى التي تريد السيطرة على الجماهير عبر ثقافة التجهيل والترويج للخرافات والخوارق.
يشير العظم في مقدّمة كتابه إلى أنّ نقده للدين لا يهتمّ بالناحية الروحيّة والخبرة الشخصيّة للإنسان، بل يهتمّ بالناحية العقديّة والتشريعيّة والشعائريّة والمؤسّسات التي تنطق باسمه. ويعتبر أنّ المنهج الدينيّ في التفكير يتناقض والمنهج العلميّ القائم على الملاحظة والاستدلال، كما أنّ العلم لا يعترف بوجود نصوص مقدّسة لا تخضع للنقد الموضوعيّ. أمّا فكرة التوفيق بين الدين والعلم فـ«ليست سوى أسطورة».
من أبرز النقاط التي تناولها هي مسألة المصالحة ما بين الدين والاكتشافات العلميّة الحديثة، فاعتبرها محاولات مزيّفة. حين يعتبر المؤمنون نصّهم الدينيّ نصاً منزّهاً ومعصوماً، فإنّهم سيرفضون حتماً أيّ اكتشافات علميّة قد تتناقض وما يقوله النصّ المقدّس. وأعطى مثالاً على ذلك نشأة الكون وخلق الإنسان. كما رفض فكرة «الإعجاز العلميّ في القرآن»، معتبراً أنّها محاولة يائسة للدفاع عن الدين عبر طمس معالم النزاع ما بين الدين والعلم.
وفي إشارة إلى الشيخ محمّد عبده (1849 ـ 1905)، ينتقد العظم الإصرار لدى بعضهم على وجود تناقض أساسيّ بين المسيحيّة والعلم الحديث وإنكارهم إنكاراً شديداً لوجود مثل هذا التناقض والنزاع بين الإسلام والعلم. في المقابل، نرى أحد المفكّرين المسيحيّين يدّعي، على طريقة المسلمين، الانسجام التامّ ما بين المسيحيّة والعلم. فالعظم يقول في هذا الصدد: «يتلخّص هذا المنهج في التوفيق بين الإسلام والعلم الحديث باستخراج كل العلوم الحديثة ونظريّاتها ومناهجها من آيات القرآن. إنّها عمليّة إقحام تعسّفي وسخيف لكلّ صغيرة وكبيرة في العلم الحديث داخل آيات القرآن، ومن ثمّ الزعم على أنّ القرآن كان يحتوي منذ البداية على العلم برمّته».
لا يوفّر العظم في نقده للدين الأنظمةَ العربيّة كلّها، «الرجعيّة» و«الثوريّة التحرّريّة» على السواء، حيث تسخّر هذه الأنظمة المؤسّسات الدينيّة التابعة لها من أجل خدمة مصالح النظام، فيقول: «نجد أنّ كلّ نظام حكم عربيّ، مهما كان لونه، لا تنقصه المؤسّسات الإسلاميّة المحترمة المستعدّة للإفتاء بأنّ سياسته منسجمة انسجاماً تاماً مع الإسلام ولا تتعارض معه في شيء».
قد لا يرضينا انتقاد العظم للعاملين في «الحوار الإسلاميّ المسيحيّ»، وبخاصّة حين يحاكم النيّات التي تنطلق منها الشخصيّات اللبنانيّة البارزة في الحوار. غير أنّنا نقف معه في قوله: «ينبغي النظر إلى المعتقد الدينيّ على أنّه مسألة محض شخصيّة وذاتيّة متروكة لاختيار الفرد وفقاً لمزاجه واقتناعاته. لذلك من الأصلح والأنسب أن يتمّ التفاهم والحوار بين اللبنانيّين على أساس علاقات المواطنة والمصلحة المشتركة بدلاً من أن يتمّ على أساس الانتماء الطائفيّ والتصنيف الدينيّ»؟
يندرج نقد صادق جلال العظم للدين ضمن سلسلة من المفكّرين تبدأ من مفكّري القرن التاسع عشر، فشبلي الشميل دعا إلى تبنّي دين العلم الذي هو بنظره حرب على الديانات القديمة، وفرح أنطون في الدعوة إلى الفصل بين السلطة الدينيّة والسلطة الزمنيّة. أمّا قوله عن رجال الدين الذين يستغلهم رؤساء دولهم لاستصدار الفتاوى المناسبة، فقاله الشيخ محمّد عبده في سلاطين الدولة العثمانيّة وتعيينهم للفقهاء الأجلاء في أعلى المراتب من أجل العمل على نشر الجهل الدينيّ في المجتمع وإخضاع الشعب للسلطة السياسيّة، «وهكذا أفسد الحكام الإسلام».
يبقى صادق جلال العظم على حقّ في نقده للدين، ما دامت أحوالنا الفكريّة على الصعيد الدينيّ في حال انحطاط. فانسياق الناس إلى الإيمان بالظواهر الدينيّة القائمة على الأساطير والغرائب والأوهام ورفض العقل والعلم لا يزال هو الأساس الذي يقوم عليه التطرّف الدينيّ والاستبداد السياسيّ والفتن المذهبيّة والطائفيّة المتنقلة. أمّا إلغاء الطائفيّة في لبنان ووجوب الانتقال إلى احترام الفرد وإقرار المواطنة فلا يزال حلماً بعيد المنال… سيبقى العظم على حقّ في نقده للدين، إلى أن يتمّ إثبات العكس.
لا بدّ، في الختام، من استعادة ما قاله المطران جورج خضر حين رفض إبعاد صادق جلال العظم عن لبنان، «لأنّ الحكومة صدّقت على أنّه عدوّ الله، وبالتالي عدوّ لبنان». فيقول خضر ردّاً على هذا الإبعاد ودفاعاً عن الحرّيّة، وبعد أن ينتقد الكتاب بقسوة: «صادق جلال العظم مصلوب على خشبة الحرّيّة. إذاً، نحن معه».
جلال العظم.. رائداً للنقد الذاتي العربي/ السيد يس
في الحادي عشر من ديسمبر 2016 رحل عن عالمنا في «برلين» الصديق العزيز المفكر العربي الكبير الدكتور «صادق جلال العظم» أستاذ الفلسفة الذي أغنى المكتبة العربية بكتبه الفلسفية والنقدية، والمناضل السياسي الجسور الذي وقف بكل شجاعة معارضاً النظام الشمولي السوري سواء في عهد «حافظ الأسد» أو بعد قيام الثورة ضد ابنه «بشار الأسد» الذي يحكم سوريا الآن. عاد «العظم» بعد ذلك إلى بلاده بعد أن حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة «يل» الأميركية ليشغل منصب أستاذ الفلسفة في جامعة «دمشق» من عام 1977 حتى عام 1999.
وقد برز «العظم» في السياق الفكري النقدي العربي على وجه الخصوص بكتابه الرائد في «النقد الذاتي العربي» الذي أصدره عن «دار الطليعة»، وحلل فيه – مطبقاً في ذلك منهجية التحليل الثقافي- أسباب هزيمة العرب في حرب يونيو1967. وبالإضافة إلى ذلك أصدر عديداً من الكتب النقدية أبرزها «نقد الفكر الديني» والذي حوكم هو ومدير الدار التي نشرت الكتاب بتهم شتى بُرئ منها فيما بعد، كما أصدر بعد الضجة التي أحدثتها رواية «سلمان رشدي» آيات شيطانية كتابه «ذهنية التحريم» بالإضافة إلى كتابات أخرى نقدية. والحقيقة أن الكتابات العربية عن أسباب الهزيمة تثير مشكلات أخطر كثيراً من مسألة تبني منهج علمي دقيق للبحث عن أبعادها المختلفة لأنها تعكس مواقف القوى الاجتماعية المختلفة من المد القومي العربي الذي قاده الزعيم «جمال عبد الناصر» بكل ما يتضمنه من نجاحات وإخفاقات..
لقد بدأت بعد انتهاء المعركة العسكرية في يونيو 1967 ما أطلق عليه بحق الكاتب المصري «كميل حوا» معركة تفسير الهزيمة، والتي هي معركة نظرية وسياسية في آن واحد. وكان في مقدمة هذه الحركة كتاب «صادق العظم» «النقد الذاتي بعد الهزيمة».
وترد أهمية كتاب «العظم» إلى أنه دشن مرحلة جديدة في الفكر العربي هي مرحلة النقد الذاتي. ونحن نعلم أن النقد الذاتي ليس تقليداً عربياً حيث يندر أن يعترف الناس سواء كانوا من النخبة أو الجماهير بأخطائهم، ولكنه –على العكس- فضيلة غربية لأن السياسي أو المفكر أو المثقف بشكل عام لا يجد أي غضاضة في ممارسة النقد الذاتي.
والواقع أن إرهاصات النقد الذاتي بدأت مبكراً بعد الهزيمة العربية في حرب فلسطين عام 1948 بكتاب المؤرخ اللبناني المعروف «قسطنطين زريق» «معنى النكبة» إلا أنه ظل لفترة طويلة عملاً منفرداً.
إلا أن كتاب «النقد الذاتي بعد الهزيمة» فقد دشن في الواقع البداية الحقيقية لتقليد النقد الذاتي العربي بعد هزيمة عام 1967، والدليل على ذلك أنه نُشرت في العام نفسه تقريباً كتب في تفسير الهزيمة من مفكرين ينتمون إلى تيارات أيديولوجية مختلفة أبرزها «النكسة والخطأ» لأديب نصور، و«أعمدة النكبة السبعة» «لصلاح الدين المنجد».
ويبقى السؤال المحوري هو كيف استفاد «جلال العظم» من مفهوم الشخصية الفهلوية الذي سبق أن صكه الدكتور «حامد عمار» في كتابه «تجارب في بناء البشر»؟ ولقد حدد عمّار السمات الأساسية «للشخصية الفهلوية» كما يلي: أولى هذه السمات هي القدرة على «التكيف السريع» لمختلف المواقف وإدراك ما تتطلبه من استجابات مرغوبة والتصرف وفقاً لمقتضياتها إلى الحد الذي يراه مناسباً، غير أنه حرص على أن يؤكد أن هذه القدرة على التكييف السريع تتمثل بجانبين متلازمين أحدهما المرونة والفطنة والقابلية للهضم والتمثل للجديد، والآخر هو المسايرة السطحية والمجاملة العابرة التي يقصد منها تغطية المواقف وتورية المشاعر الحقيقية، مما لا يعني الارتباط الحقيقي بما يقوله المرء، أو بما قد يقوم به من مظاهر سلوكية، والسمة الثانية هي النكتة المواتية، والسمة الثالثة هي المبالغة في تأكيد الذات والميل الملح إلى إظهار القدرة الفائقة والتحكم في الأمور، والسمة الرابعة هي الطمأنينة إلى العمل الفردى وإيثاره على العمل الجماعي، والسمة الخامسة هي سيادة الرغبة في الوصول إلى الهدف بأقصر الطرق وأسرعها وعدم الاعتراف بالمسالك الطبيعية.
غير أن «العظم» – وإن كان يتبنى مفهوم الشخصية الفلهوية- كانت له تحفظات شتى على استخدام المفهوم في تفسير أسباب هزيمة 1967. يرى العظم أن الخصال الفهلوية التقليدية «تجعلنا عاجزين عن تقبل الحقيقة والواقع، وفقاً لما تفرضه الظروف الحرجة من تصرف سريع، وتضطرنا إلى إخفاء العيوب والفشل والنقائص بغية إنقاذ المظاهر والحفاظ على ماء الوجه.
ومن ناحية أخرى، يرى «العظم» أنه إذا كانت من سمات الشخصية الفهلوية نزوعها إلى الحماس المفاجئ والإقدام العنيف والاستهانة بالصعاب في أول الطريق، ثم انطفاء وفتور الهمة عندما يتبين «للفهلوي» أن الأمر يستدعي المثابرة والجلد والعمل المنتظم الذي لا تظهر نتائجه إلا ببطء وعلى شكل تراكمي. هكذا حاول صادق جلال العظم الربط بذكاء بين سمات الشخصية الفهلوية – كما سبق أن حددها «حامد عمار»- وبين السلوك العربي قبيل المعركة وفي أثنائها وبعدها. كان كتاب «النقد الذاتي بعد الهزيمة» هو بداية معرفتي الشخصية بـ«العظم»، والتي تحولت من بعد إلى صداقة ممتدة.
الاتحاد
رحيل المفكر السوري الكبير صادق جلال العظم/ بول شاوول
رحل الفيلسوف السوري الكبير صادق جلال العظم في المنفى في أحد مستشفيات ألمانيا. لم يكن يريد أن يموت خارج سوريا، خصوصاً بعد اندلاع الثورة الشعبية فيها ضد النظام المذهبي – العائلي الاستبدادي.
هكذا بادرني أثناء وجوده في بيروت، قبل أن يسافر إلى منفاه. كأنني بهذا المفكر الجذري ربيب «المنافي»، فمن دمشق، إلى بيروت، إلى الولايات المتحدة، إلى ألمانيا، وهو، في «حسه» المتحول، كأنه كاسر التابوات، والمحرمات، من كتابه «نقد الفكر الديني» (في السبعينات)، إلى «ذهنية التحريم» أثار ضجة كبيرة، اتهم فيها بالإلحاد، والكفر، والزندقة، ودخل فترة قصيرة إلى السجن. بقي على افكاره التغييرية، العلمانية، المدنية، العقلانية، على الرغم من كل ما أصاب عقول بعض المفكرين العرب (والأجانب)، من خضوع لظواهر المراحل، وارتداد خصوصاً اليساريين بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. إنه صادق، لا يرحم بتشريحه وتفكيكه للواقع، وبنقده لبعض المقولات المكرسة، الأبدية، سياسياً ودينياً واجتماعياً. كأنه آخر يساري، يطوي ثورته ويرحل. بل آخر الضمائر الفكرية الكبيرة في عالمنا العربي. وقد عرف كيف يقارب الامور المستجدة، وبعض التحولات، بما امتلكه من أدوات تعف عن الوقوع في الغيبية، والاثنية، والمذهبية، وعن أي تنازل أو إغراء أو تواطؤ مع هذا النظام أو تلك السلطة. كتاباته وآراؤه ومواقفه هي فعل حرية، وكذلك فعل مقاومة، ومواجهة، وتحد لمجمل القيم الموروثة، وفي هذا الزمن الذي خلع الكثير الكثير أفكارهم، وتاريخهم، وطليعيتهم، لينضموا إلى المرجعيات الدكتاتورية، والمذهبية، والعنصرية. ها هو الصديق الكبير، صديق الجلسة اليومية في مقهى «ليناز» في بيروت، على إصراره، وأكثر من أي وقت مضى، على الانحياز إلى العقل، كفيصل حاسم، وإلى الثورة السورية، والربيع العربي. فالفيلسوف صادق جلال العظم، على الرغم من طول باعه في القضايا الفكرية، فإنه لم يبق في برج عاجي، ليتعامل مع المفاهيم التجريدية الفلسفية «الأبدية»، بل انصهر في الواقع الذي استلهم منه أفكاره وأدواته. وها هي الثورة السورية بتجلياتها الأولى (قبل أن يحولها النظام وإيران وروسيا إلى حرب مذهبية مدمرة). كأنه يحس أفكاره. ولا يفكرها فقط. يعيشها. يعقلن الظواهر الدامغة، وتمده بأفكاره. ومن خلال لقاءاتي الكثيرة معه أثناء وجوده في بيروت وقبل سفره إلى ألمانيا، لمست هذا التجذر في التاريخ، وفي المعطيات الدينية، والماركسية، وما قبلها وما بعدها. صحيح أنه كان ماركسياً، لكنه ماركسي حر، بلا التزامات حزبية ولا حتى استنساخات منهجية أو أيديولوجية. بمعنى آخر كأنه يساري مستقل، يغرف ما يغرف من مبادئه من الواقع وليس من الأيديولوجيا، أو الأنظمة التوتاليتارية. آخر مرة قابلته فيها، وكانت الثورة السورية في مستهلها، قال لي: سأسافر إلى ألمانيا، وأتمنى أن نذهب معاً إلى دمشق بعد تحريرها من هؤلاء المستبدين.. وكنت أحياناً أتسقط أخباره، وأقرأ بعض مقابلاته، وتصريحاته المؤكدة مواقفه السابقة، وأكثر ما سرّني انتخابه بالاجماع أميناً عاماً لرابطة الكتّاب السوريين في المنفى واتصاله المستمر بالثوار السوريين خارج سوريا. هذا الذي رفض أن تسمى الثورة «احتجاجاً» أو معارضة، لجذرية موقفه، وبُعد نظره، لم يعُد إلى سوريا السابقة، ولا إلى سوريا اللاحقة، فكان ترك بيروت التي أحبها وأقام فيها طويلاً، كان وداعاً لبيروت وكذلك لوطنه.
مات المنفى فيه أم مات هو في المنفى.
برحيل صادق جلال العظم خسر العرب والعالم فيلسوفاً شرساً، مواجهاً للأفكار السائدة، المتعفّنة، بكليشياتها، مخترقاً كل ما سماه «ذهنية التحريم»، معانقاً دائماً للحرية، ومؤيداً الشعوب كلها في تقرير مصائرها، وإسقاط وحوشها الدكتاتورية… كشعبه السوري.
المستقبل