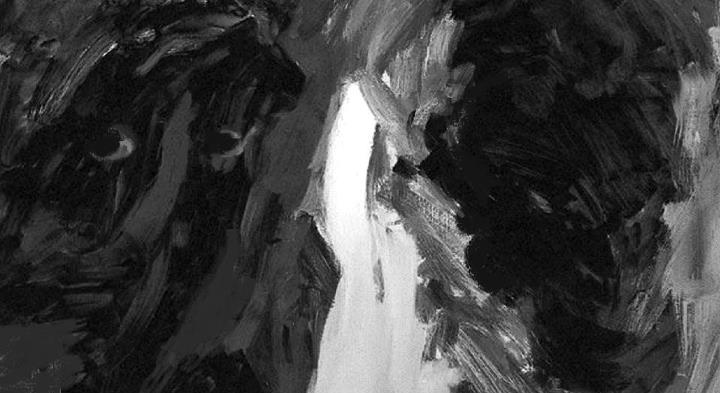عطر المرأة السورية: علا شيب الدين

علا شيب الدين*
يسمّي علماء الاجتماع المعاصرون البشر “ممثلين اجتماعيين”، كونهم يؤدّون أدوارهم على مسرح الحياة كما يؤدي الممثلون أدوارهم على خشبة المسرح. على مسرح الثورة أيضاً، يؤدي الجميع أدواراً في لجّتها، بحسب المعنى منها بالنسبة إلى كل شخص، وكما يرغب في مكابدتها، أو بحسب ما اضطُرّ إليه. في أثناء معايشة الثورة يتشكل في كل لحظة، مخيالٌ جديد، وهو طريق الثائرات والثائرين إلى أدوار ثائرة، خصبة وحيوية.
أمّ الثوار
أمّ الثوار في دمشق، بعدما فقدت اثنين من أبنائها، آثرت اعتبار شباب “الجيش السوري الحر”، بمثابة أبنائها، واعتنقت دوراً في الثورة، تُعِدّ من خلاله الطعام للثوار، وتغسل ثيابهم، وتشد أزرهم، وتحضّهم على الصبر بكلمات حنونة تشي بقلب طيّب. تبكي أمّ الثوار أبناءها الشهداء، لكنها تردف: “حرقوا قلبي على أولادي، بَس معليش، فِدا سوريا، وأنا كمان فِدا سوريا”. أما في الكهوف، والسهول التي افترشها سوريون باتوا بلا مأوى، فتجمع الجدّة في ريف حماة فتات الخبز اليابس، تطعِم منها الأطفال الجوعى بحرص شديد. ألا يقول المثل الشعبي: “ما في ولا صَرّة ما بتسند جَرَّة”؟ وبينما تروم الأمّ براري إدلب، بغية جمْع حطب توقده لطهي قليل من البرغل أو الأرز؛ تنهمك شابات في الرقة في التزيين والرسم، وفي حياكة أعلام الثورة الخضراء، رمز الخلاص الوحيد من المأساة بالنسبة إلى كلّ مؤمن بالثورة. إنه العلم الذي كان بمثابة أيقونة حُبّ وسلام في أيادي سوريات شاركن في التظاهرات السلمية في شمال البلاد وجنوبها، وغربها وشرقها.
أقطع المسافات زحفاً، اتقاء رصاص القنّاص، لكي أصل إلى المستشفى الميداني، وأعالج المصابين والجرحى. هذا ما تحكيه طالبة جامعية في كلية الطب، تركت الدراسة، لتنخرط في الثورة، وتتفرّغ لهذا العمل الإنساني الجبّار. تضيف: “أنا ما بخاف، ليش بدّي خاف؟ وما مارس إلي تطلبه منّي مهنتي الإنسانية؟ أنا بِدْعي على كل طبيب وكل شخص كانْ قادر يساعد وما ساعد”.
على أحد الحواجز الأمنية العسكرية التابعة للنظام، اعتُقِلت صبيّة رائعة نُبلاً وثقافةً ووعياً. كانت عبير رافع، تنقل الغذاء والدواء إلى المحاصَرين في ريف دمشق. في أثناء “جرّها” إلى سيارة الاعتقال، بعد تغطية وجهها بكيس أسود، صاحت عبير: “ليش بدكم تاخذوني؟ أنا رايحة ودّي أكل ودَوَا للناس الشرفاء إلّي سوّدتم عيشتهم. اتركوهم، اتركوني”، وفق ما روته لنا إحدى قريباتها. منذ ذلك اليوم، غربت شمس عبير في سجون نظام الإرهاب، ولا تزال حتى اللحظة، مجهولة المصير، أما التهمة الموجهة إليها، فهي “الإرهاب”!
إن المحيط أصله قطرة؟ لا شك في ذلك. وإن الأمور تكون أكثر بساطة، إذا ما كنا صرحاء وقلنا الحقيقة من دون تعقيد؟ حتماً. فلنكن صرحاء إذاً: إن الذين انخرطوا في الثورة انخراطاً عملياً، لا الذين نظَّروا وخطبوا واجتمعوا وائتَمروا، هم الأجدر والأهمّ والأصدق. وإن أدواراً ثائرة ميدانية من مثل إعداد الطعام لثوّار يصلون الليل بالنهار والصيف بالشتاء، في القتال من أجل الحرية، ومعالجة الجرحى، واعتلاء قمة المخاطرة من أجل إيصال الدواء والغذاء إلى أناس محاصَرين، لَهُو شمعة في وسط ظلمة حالكة. بل قطرة، من دونها لا محيط. لا ثورة.
امرأة طفل وفأر!
لم يمضِ أكثر من خمس دقائق، على بدء أحد الاعتصامات النسائية في مدينة السويداء، وكاتبة السطور كانت إحدى المشارِكات 16/6/2012، وقد رُفعَت فيه لافتات تؤكد أن الشعب السوري واحد، وأن الدين لله والوطن للجميع؛ حتى اندلع صوت في أقاصي الشارع المقابل للساحة التي يُنفَّذ فيها الاعتصام. كان الصوت ليافِع، يبدو في الرابعة عشرة من العمر، يصرخ بشكل هستيري: “الله سوريا بشّار وبس”، ويركض بسرعة متوترة في اتجاه المعتصِمات. كانت ملامح وجهه، وهيئته الجسدية عموماً تشي بأنه فاقد التركيز، كأن ذهنه مشوّش ومشطور بين الأوامر المعطاة إليه، وتنفيذ تلك المهمة الصعبة عليه، كطفل بريء لا يزال “حديثاً” في مهنة “التشبيح”. وصل أخيراً إلى ساحة الاعتصام، وبدأت المواجهة مع المعتصِمات، وبشكل جنوني عاصف، قال: “أنزِلي اللافتة وِلِي”، وبعدما لقي مقاومة بسيطة من جانب المعتصِمات، انسلّ الخوف إلى عينيه، وتراجع قليلاً، لكنه عاد وانتزع إحدى اللافتات ومزّقها. لم يكن وحده في المهمة، فقد كان إلى جانبه طفل أصغر منه لا يتجاوز التاسعة، يحمل في يده عصا كهربائية، يهدِّد المعتصِمات بها، أما بقية الأطفال، فاكتفوا بالوقوف بعيداً من المعتصِمات، يرقبون رفيقيهم بخوف، وذهول، وحيرة.
ما كان استخدام الأجهزة الأمنية للأطفال يومها، وتجنيدهم في قمع نساء سلميات، ارتجالاً، بل سياسة ممنهجة، مدروسة، ولها دلالات عدة، لعل الدلالة السيكولوجية أهمّها. فتجييش أطفال لقمع نساء، يدلل ربما على رغبة في تدمير العلاقة الجميلة والحميمة التي تربط المرأة بالطفل، علاقة الأمومة والإنسانية والجمال. ناهيك بالرغبة في تحقير المرأة، واعتبارها قاصراً، ناقصة عقل، عبر وضعها في مواجهة طفل دُرِّب ليكون “شبّيحاً” كنوع من الانتقام من الطفل أيضاً، ومحاولة لتشويه بنيته النفسية والعقلية والروحية، من خلال إفساده بترسيخ الخصائص الأمنية المنحطّة أخلاقياً وإنسانياً وغرسها في عقله الغضّ، وقلبه الطازج، ثم الزجّ به في معمعة العنف. تجنيد الأطفال في قمع اعتصام سلميّ ليس إلا جزءاً هامشياً من لوثة الانتقام العميق والكبير والشامل من الأطفال، لأن هؤلاء كانوا فتيل الثورة في البلاد (المقصود أطفال درعا)، وهم الذين طالما كانوا حاضرين في التظاهرات جنباً إلى جنب مع النساء والرجال، ومثلهم تشبّعوا بمفاهيم الحرية.
غير أن الأسلوب الأشدّ هولاً في تحطيم كيان المرأة كلياً، كان ذاك الذي وضعها في مواجهة كبرى مع حيوان! فقد روت إحدى اللواتي كُتِبت لهنّ النجاة من سجون النظام، في شهادة مرعبة أدلت بها للصحافية البريطانية في قناة “BBC” فرغال كاهان، تقول: “شاهدتُ امرأة وقد أدخل أحدهم فأراً في رحمها، كانت تصرخ، بعد ذلك شاهدتُ الدم ينزف من رحمها. كانت تحتضر، ظلّت ترتعش للحظات، قبل أن تتوقف عن الحركة تماماً”. ما وصفته المعتقَلة السابقة، حصل في أحد المراكز التابعة للاستخبارات (فرع فلسطين)، وشهادتها عن اغتصاب النساء في سوريا ليس بالأمر الجديد، بل سبقته تقارير أممية وتقارير لمنظمات دولية وحقوقية كمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.
يحتاج ذلك الفعل الغريزي، الهمجي، المنفلت من كل عقال، إلى تحليل معمَّق، لكن في الإمكان القول إن الذهنية الكامنة خلف الفعل المذكور، هي ذهنية لا تفصل المرأة عن الحيوان، لا بل تعتبر جسد المرأة وعاء يمكن أن يُلقى فيه كل وسخ ونجس، ومعلوم أن الفأر حيوان ارتبط طويلاً بالوضاعة، حتى بات رمزاً لها، وما إدخاله في رحم امرأة، إلا مساواة سديمية للمرأة به! يؤكد ذلك، قتْل المرأة والفأر أحدهما بالآخر، أي قتل الفأر في داخل رحم المرأة، وقتل المرأة بالفأر. أن يُعبَث برحم المرأة (حاضن الحياة واللذة ومنبعهما)، لَهُو عبثٌ سافل وقذر بنواميس الطبيعة. إذ المثير لشتى أنواع العجب والرعب، في تعنيف المرأة وقتلها بهذا الشكل، أنه ينزع عن المرأة سمات النوع الإنساني، ليحوّلها إلى حيوان بمعنى الكلمة، بحيث تُقتحَم دوائرها وتُجتاح فضاءاتها بواسطة “حيوان”! تجدر الإشارة، في ما يخص الانتهاكات التي تتعرض إليها النساء منذ اندلاع الثورة الشعبية، إلى أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد وثّقت أخيراً، مقتل 7545 امرأة، بينهن 2500 طفلة و250 رضيعة، بالاسم والمكان والصورة.
ناشطة ونازحة
فور الانتهاء من إيصال سلال غذائية ودوائية وغير ذلك مما يحتاج إليه نازحون، اقترح قاطنو الدار من النازحين، شرْب الشاي في أرض الدار، وفي حين جلس الجميع على الكراسي يتبادلون أطراف الحديث، فضّلتْ إحدى الناشطات في فريق العمل الإغاثي، الجلوس على أريكة إسمنتية (طوطاية) إلى جانب مجموعة من الأطفال أعمارهم بين سنتين واثنتي عشرة سنة، وراحت تمازحهم تارة، وطوراً تتصفّح كتباً موجودة مع فتاة في الصف السابع، تدرس فيها استعداداً لاختبار بالمدرسة في اليوم التالي. الكتب كانت خاصة بالأدب العربي، وقد قرأتْ مع الفتاة قصيدة للشاعر إيليا أبو ماضي. كانت الفتاة قد حضَّرت جيداً للاختبار، حتى أنها قرأت قصيدة أبو ماضي غيباً من دون أن تقع في أخطاء.
بينما كانت الناشطة منهمكة في تقديم النصح للفتاة حول ضرورة أن تتفوق في الدراسة، بما قد يساهم في تغيير كل فكرة خاطئة قد تكون موجودة في عقول بعض السكان الأصليين للمنطقة، عن النازحين إليها من منطقة ثائرة، لمحَتْ فجأةً في عيني الفتاة لا اكتراثاً لنصائحها. إذ كانت، على ما بدا لها، غير معنية بما قد يقوله الآخرون عنها. اكتشفت الناشطة في ما بعد أن نصائحها تلك، كانت مجرد إسقاطات ذاتية خاصة بثائرة لا حاضن اجتماعياً لها في منطقة غير ثائرة، بالمعنى الحقيقي لمفردة ثورة، وأن الفتاة كانت أكثر قوة وأقل حساسية تجاه ما يمكن أن يُحكى عنها.
مضى حوالى نصف ساعة، قبل أن تنضمّ إلى المجموعة أمّ أحد الأطفال، فأجلَسَت في حضنها طفلها الذي كان إلى جانب الناشطة، وجلست هي في مكانه. سألتها الناشطة إنْ كانت مرتاحة، فأجابت: “ماشي الحال الله يسلّمك”. قالت الناشطة: “نحنا نتشرّف بكم، لا تفكروا السويدا منطقة أقليات وموالية، نحنا معكم قلباً وقالباً لأنو كلياتنا سوريين وما رح نسمح لطاغية يفرّق بيننا، نحنا معارضين والبعض منّا ثار من أول ما بدأت الثورة، وعملنا كذا وساوينا كذا”. استرسلت الناشطة في كلام كانت تعلم أنه دلالة على شعور بالنقص، يعانيه شخص ثائر منبوذ ومحارَب في منطقة غير ثائرة بالمعنى الحقيقي للثورة، أمام شخص نازح من منطقة ثائرة حقيقة. لكن المرأة كانت تصغي بشكل بارد لا يتّسق وحرارة الناشطة في الحديث. يبدو أنها، كما الفتاة، كانت في وارد غير وارد الناشطة.
في سياق الحديث، أخبرتها المرأة عن استشهاد زوجها وأخيها وأقارب كثيرين، وعن بيتها الذي احترق أسوةً ببقية البيوت التي إما هُدِّمت وإما احترقت وإما قُصِفت. دمعت عينا الناشطة، وهمّت بأن تواسيها بكلام حنون، إلا أن المرأة أوقفتها، وبالترافق مع قسوة في النظرة وقوة في النبرة، قالت: “عادي، بدنا حريتنا، بكرا إن شاء الله رح نرجع على بلدتنا الحراك بدرعا ورح نعمّر بيوت جديدة”.
قبل أن يغادر فريق العمل، طلب أحد أعضاء الفريق من الناشطة نفسها، أن تسأل مَن كانت جالسة معهم، إنْ كانوا يريدون شيئاً، فأجابت: “مو هِنّي إلّي بدْهم مِنّا، نحنا إلّي بدّنا منهم”. ثم، بالعناق والقُبَل، ودَّعت المرأة والأطفال وودّعوها.
كثيرة هي المواقف التي يقف المرء فيها أمام نفسه، حائراً لا يعلم، أهو يساعد؟ أم يحتاج إلى مساعدة؟!
ضغط نفسيّ واجتماعيّ
غالبية الأشرار في العالم، يستخدمون شرف المرأة، كوسيلة، حين يعجزون ويفشلون، ويشعرون بالدونية أمام الانتصارات الأخلاقية التي يحققها الخصوم. يلجأون إلى الأسلوب الرخيص هذا في الأحوال العادية، فما بالك في ظل الأحداث التاريخية الكبرى كالثورات؟!
ما هو أكيد، أنه في ظروف اللجوء، خصوصاً اللجوء السوري، وما يتصل بهذا اللجوء من تعقيدات جمة، يكون كل شيء خاضعاً للتسييس، وكل تفصيل صغير قد يكون عرضة لأن يصبح أكبر بما لا يقاس لو أن التفصيل نفسه قد حصل في ظل ظروف عادية. وعليه، لا عجب حين تروج شائعات تمسّ شرف المرأة السورية وكرامتها مثلاً، كتلك التي راجت في “مخيم الزعتري” بالأردن وغيره. ولا عجب كذلك، حين يحاول الوضيعون استغلال الوضع، بغية ابتزاز المرأة كأنثى.
بعدما استشهد زوجها في درعا، هامت شروق على وجهها، مذعورة، بائسة يائسة. هي صبيّة جميلة في الثانية والعشرين من العمر، متخرّجة من المعهد المصرفي، ضاق عيشها بشكل ما عاد يُحتمَل، فقررت البحث عن عمل. بيد أنها كانت على مواجهة مع اتهامات بشعة من قبيل: “أنتم خربتم البلد” وغير ذلك من تعنيف لفظي. ناهيك بذاك الشعور القاسي بأن ثمة مَن يزدريها، ويرتاب أحياناً من حجابها، كونها غريبة في منطقة، غالبية النسوة فيها سافرات الرأس. لكن شروق واحدة ممّن لا يرضين لأنفسهن إلا معاملة الأنداد الأحرار، فهي من أولئك الذين لو لم يكونوا أساساً، ثوّار كرامة، لما قُصِفَت بيوتهم، وهُجِّروا منها.
“على هامش الارتياب من الحجاب”. كان في إحدى القرى، امرأة نازحة أيضاً، ربما في العقد السابع من العمر، وكتاب القرآن الكريم لا يفارقها لحظة، وتسبّح بحمد الله وشُكره دوماً، وكانت مريضة بالسكّري. طلبتْ مرّةً من أحد الشباب الناشطين، وهو غير متديّن، علبة دواء للمرض نفسه. بظُرف ولُطف أجاب الشاب: “توكّلي على الله”، فردّتْ: “أتوكّل على إرادتك يا إبني”. المفارقة هنا، أن غير المتديّن، أجاب عن أشد الأمور التصاقاً بالملموس، إجابة غيبية. بينما المرأة المتدينة، حاملة القرآن الكريم، تكلمت عن الأمر نفسه بشكل علمي، واقعي، محترِمة الإرادة الإنسانية، وقدرة الإنسان على الفعل، محرِّضةً بذلك، الشاب على تحمّل المسؤولية.
في عشق الحياة
عُبادة، امرأة مات زوجها منذ سنين، قبل اندلاع الثورة، وقبل أن تعيش عائلته من بعده مأساة القصف، ثم مأساة النزوح. لدى عُبادة ستة أولاد، أحدهم معوق جسدياً وعقلياً، كانت تقيّده بواسطة حبل إلى جذع شجرة، حتى لا يهرب، كما نوّهتْ. الشجرة كانت إحدى أشجار جبل في السويداء، لجأت إليه عُبادة وأولادها هرباً من قصف الطاغية وحقده، مع عشرات العائلات الأخرى. ظلّوا في العراء يومين تقريباً، قبل أن يؤمِّن لهم الناشطون في المنطقة بيوتاً يسكنون فيها.
اللافت في شخصية عُبادة، حبّها المرح والفرح، وهي تعتني بجمالها، مع أنها تعيش أوضاعاً مزرية، كما أنها في الستينات من العمر. هي سمراء البشرة، جذابة، نحيفة الجسد، وتهتم في أدق تفاصيل الزينة والتبرّج، من مثل تعليق الأقراط في أذنيها، والاعتناء بالبشرة ووضع مساحيق التجميل وغير ذلك من تفاصيل أنثوية شكلية. وراحت تنصح الصبايا الناشطات اللواتي أتيْن لتقديم المساعدة، فلهذه الصبيّة تقول “عليكِ وضع “كْريم” كذا، ولتلك تقول “استعملي مرطّب” كذا، إذ هي خبيرة تجميل، وقبل أن تنزح عن منطقتها في السبينة بريف دمشق، كانت تعمل في محل مختص بالتجميل. أما ضحكتها، فلا تختفي، حتى لَكأنكَ تشعر أن الأشجار و”سَدّ الروم” وكل ما يدخل في تكوين الجبل ذاته، يرتعش سعادةً كلما عَلا صوت ضحكتها.
في الجهة الأخرى من السَدّ نفسه، جلستْ ريم وفاتن ومنار مع عائلاتهن. وفي غمرة الضجيج الجماعي الممهور ببكاء أطفال، ونواح مُسنّات مقهورات، مريضات في القلب والسكّري والضغط، ووجع امرأة حامل في شهرها التاسع، ونقاش هنا، وجدال هناك؛ انفردت الصبايا المذكورات مع الناشطات، واخترن مكاناً بعيداً من الضجيج، فارتسمت مجموعة ملوّنة من صبايا سمراوات وبيضاوات وشقراوات، أمام مياه السدّ الرائقة، ذات يوم صيفي رائق إلا من أصوات قصف الطاغية على درعا، ورحن يتبادلن أحاديث البنات وخصوصياتهن. ريم، فتاة في السادسة عشرة، كانت مشتاقة إلى خطيبها الذي ما عادت تعرف عنه شيئاً. فاتن، التي تكبرها بسنة تقريباً، كانت طوال الوقت تتحدث عن افتقادها صديقاتها ومشاغباتهن معاً في المدرسة في حي الميدان بالعاصمة دمشق، وعن أغنيات نانسي عجرم وعمرو دياب، التي تحبّ الاستماع إليها دوماً. أما منار، فقد كانت شديدة التأمل إلى درجة الصمت والاكتفاء باللهو في سوار يدها الفضّي صعوداً ونزولاً. وحين آن أوان رحيل الناشطات، طلبن من الفتيات ذِكْر ما يحتجن إليه، وتسجيل حاجياتهن على أوراق لكي يجلبنها لهن في أثناء العودة. تفاوتت الطلبات واختلفت. وحده العطر، كان مطلباً مشتركاً يجمع بين نساء سوريات، جميلات، عاشقات الحياة رغم أنف القهر.
* كاتبة سورية
النهار