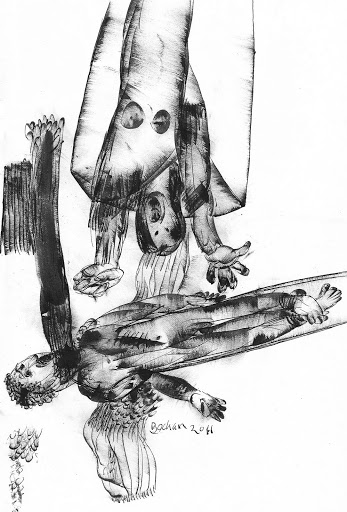عن “دونالد ترامب” والوضع في سورية –مقالات مختارة-

أمريكا وحقوق الإنسان: حتى لا يكون ترامب ضبعاً أعزل/ صبحي حديدي
في تقريرها الدوري للعام 2017، والذي يصدر سنوياً تحت عنوان «الحرية في العالم»، خلصت مؤسسة «بيت الحرية» Freedom House الأمريكية إلى منح الولايات المتحدة علامة 89؛ مقابل 100 لفنلندا والنروج والسويد، و99 لكندا وهولندا، و98 لأستراليا ولوكسمبورغ، و97 للدانمرك واالبرتغال وإيسلندا وباربادوس. ثمّ قالت المنظمة، بصدد موجز حال الحريات في أمريكا: «يُجادَل بأنّ الولايات المتحدة هي الديمقراطية الأقدم في العالم. شعبها يتمتع بنظام انتخابي حيوي، وتراث قوي لحكم القانون، وحرّيات راسخة للتعبير والاعتقاد الديني، وسلسلة أخرى عريضة من الحريات المدنية الأخرى. والولايات المتحدة تظل مقصداً رئيسياً للمهاجرين، وما تزال ناجحة إلى حدّ بعيد في استيعاب القادمين الجدد من كلّ الخلفيات».
والحال أنّ «بيت الحرّية»، الذي ينفرد عن جميع المؤسسات المماثلة في أنه منظمة غير حكومية لكنها في الآن ذاته مموّلة من الحكومة الأمريكية، أصدر التقرير السنوي وشبح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يجوس أجواء أمريكا حاملاً الكثير من نقائض هذه المزاعم. ولم يطل به الوقت، بعد تنصيبه رسمياً، حتى انخرط في الطور التطبيقي من بعض وعوده الانتخابية؛ وأوّلها حظر دخول اللاجئين (والمهاجرين، بالطبع)، وحظر تأشيرة الدخول لرعايا سبع دول مسلمة. ورغم أنّ بسطاء النوايا هم، أغلب الظنّ، في الصفّ الوحيد الذي لا يطعن في مصداقية «بيت الحرية»؛ فإنّ ما شهدته مؤخراً بعض المطارات الأمريكية، والصدام المباشر بين السلطات التنفيذية والقضائية، لا يترك حتى للبسطاء أولئك هامش يقين ضئيلاً في أنّ أمريكا هي «الديمقراطية الأقدم».
يصحّ، في المقابل، التساؤل عما إذا كان ترامب الضبع الوحيد، أو الأعزل، في هذا الاستهتار الجلف بأبسط حقوق الإنسان؛ وعما إذا كان تاريخ الولايات المتحدة، المعاصر والحديث والقديم، حافلاً بسوابق نظيرة، اختلفت جلافتها في قليل أو كثير. والذاكرة الإنسانية تملك مسرداً طويلاً لانتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا، وكيف أنها تكرست رسمياً في الدستور الأمريكي ذاته. هنالك، على سبيل المثال، حقيقة الغياب التام لكلمة «مساواة» في ذلك الدستور، الذي لا ينصّ البتة على توفير ضمانات تكفل حقّ المواطن في الغذاء، واللباس، والمسكن، والصحة، والعمل، والراحة، والأجر المعقول إنسانياً، والضمان الاجتماعي في العمل والحياة، وحماية الأسرة والأطفال. أليست هذه في صلب حقوق الإنسان؟ أليس ضمان «الحقّ المتساوي في الطعام واللباس والمسكن»، هو جوهر الشرائع والحقوق؟ أيّ حقوق إنسان هذه حين يكون في مدينة نيويورك وحدها 36 ألف مواطن مليونير، و38 ألف مواطن يقتاتون على النبش في صناديق القمامة؟ وأيّ حقوق إنسان حين تثبت هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنّ المواطن الأمريكي ليس متساوياً أبداً أمام القضاء، وأنّ الأحكام الصادرة بحقّ الأمريكيين السود والآسيويين أقسى بثلاثة، وأحياناً بأربعة، أضعاف من الأحكام الصادرة بحق البيض في قضايا مماثلة؟
ثم ماذا عن مؤسسات الديمقراطية الأمريكية ذاتها؟ ألا تنقلب عمليات انتخابات للكونغرس، مثل انتخابات الرئاسة، إلى صفقات مبيع الذمم وشرائها؟ «تعداد فلوريدا» هو الأشهر، ربما، في التاريخ الأمريكي المعاصر؛ حين اختلط الحابل بالنابل وانتصر جورج بوش الابن على آل غور بفارق أصوات يصحّ القول بأنها أتت من الغامض المجهول. ألا تُجري لجان الكونغرس تحقيقات حول فضائح التبرعات المالية غير القانونية في أعقاب كلّ حملة انتخابية رئاسية تقريباً؟ ألم تُلصق بحملة ترامب اتهامات جدية حول تورّط الأجهزة الروسية في ترجيح كفة المرشح الملياردير، صديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟
ومن جانب آخر، أليس من حقّ الشعوب أن تثير مسألة انتهاك الولايات المتحدة لحقوق الإنسان ما وراء المحيط، ضدّ الأمم الأخرى في العالم الشاسع الواسع للإنسانية؟ وكيف تنسى الشعوب أن أمريكا، منذ تأسيسها كدولة وقوّة عظمى، شنّت أكثر من 75 عملية غزو خارجي للشعوب، واستخدمت أول قنبلة ذرية في تاريخ الإنسانية، وتمتلك وتواصل تخزين أضخم ترسانية نووية (25 ألف قنبلة)، وأنفقت أكثر من 274 مليار دولار على تطوير أسلحة الدمار الشامل، وتحتكر تصدير السلاح إلى 146 بلداً، وتهيمن على ثلاثة أرباع سوق السلاح الدولي وأسواق اندلاع الحروب الأهلية والإثنية. وفي كوريا الجنوبية، حيث ترابط القوات الأمريكية للدفاع عن «الحرية» و»حقوق الإنسان»، تشير الإحصاءات إلى 43.900 حالة اغتصاب مارسها الجنود الأمريكيون ضد فتيات ونساء هذا البلد.
ومن المعروف أن التقرير السنوي لهيئة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في العالم لا يوفّر الولايات المتحدة الأمريكية، بل جرت العادة أن يفرد لها استنتاجات رهيبة تذكّر بأفظع الممارسات التي اعتادت على ارتكابها الدكتاتوريات «الكلاسيكية» في أي نظام استبدادي، شرقاً وغرباً، ماضياً وحاضراً. ولقد حدث أنّ بعض أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد التقرير السنوي قضوا في السجون الأمريكية ثلاثة أسابيع (ومُنعوا من دخول سجون أخرى)، ليخلصوا إلى النتيجة التالية حول عقوبة الإعدام بصفة خاصة: «من الواضح أن اعتبارات مثل الأصل العرقي أو الإثني، والوضع الاقتصادي ـ الاجتماعي، عناصر حاسمة في تحديد ما إذا كانت عقوبة الإعدام ستُفرض أو تُستبدل بعقوبة أخفّ، وما إذا كانت ستُنفّذ أم تُلغى بقرار أعلى صادر عن حاكم الولاية المعنية».
هنالك، أيضاً، موقف الولايات المتحدة من إعلان مؤتمر أوسلو القاضي بحظر الألغام الأرضية المضادة للأشخاص؛ إذْ كان من المدهش أن أمريكا لم تكتف بالرفض وحده، بل سارع رئيسها آنذاك، بيل كلنتون، إلى رفد تصريحاته بهجاء كوميدي لهذه الدول التي تطالب الولايات المتحدة بحظر أسلحة لا تستخدمها الولايات المتحدة أصلاً! آنذاك، رسم كلنتون ابتسامة ساخرة، وشرح للمجتمع الدولي أن الجيش الأمريكي توقف منذ عقود طويلة عن استخدام الألغام الأرضية «الغبية» التي تظلّ قابلة للانفجار حتى بعد قرون من وضع الحروب لأوزارها؛ وهذا الجيش لا يستخدم إلا النوع «الذكيّ» من ألغام أرضية تمتثل للأوامر، وتفجّر نفسها بنفسها بعد أن تنتهي الحاجة إليها. هذه الأجيال الذكية، مثلها كامل الأجيال الجديدة الذكية من الأسلحة الأمريكية، ليست موضوعاً للمساومة!
كذلك تغافل كلنتون عن حقيقة أن المنطقة المنزوعة السلاح، الواقعة على الحدود المشتركة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية (حيث يرابط 37 ألف جندي أمريكي)، ليست مزروعة بأي لغم «ذكي»، بل بملايين الألغام «الغبية» التقليدية دون سواها. وهنا دلالة الشطر الأول من الشروط الأمريكية قبل التوقيع على اتفاقية حظر هذه الألغام: البنتاغون طالب بفترة إعفاء تمتد على تسع سنوات قابلة لتمديد إضافي لا يقل عن عشر سنوات (91 عاماً بالتمام والكمال)، يقوم خلالها خبراء الجيش الأمريكي بدراسة البدائل وترتيب الأرض، وبعدها يقررون الانضمام أو الامتناع. الشرط الثاني كان إضافة بند خاص في الاتفاقية يتيح استثناء الولايات المتحدة من جميع الالتزامات المنصوص عنها، فور اندلاع نزاع عسكري بين واحدة من الدول «المارقة» المعروفة، وبين دولة حليفة للولايات المتحدة. والنصّ الذي حمله المفاوضون الأمريكيون إلى مؤتمر أوسلو أسهب أكثر في شرح الموقع الكوني الخاص الذي تتمتع به الولايات المتحدة، بحيث بدت مصالحها القومية بمثابة مصالح كونية تهمّ الإنسانية بأسرها!
ويبقى أنّ هذا المشهد، إذا كان لا يطمس حقيقة انبثاق حركات احتجاج شعبية أمريكية، مشرّفة تماماً وجديرة بالاحترام، ضدّ سياسات البيت الأبيض؛ فإنه، من جانب آخر، لا يبدّل البتة حقيقة أنّ ترامب ليس، ولم يكن في أيّ يوم، ذلك الضبع الضاري الوحيد، أو الأعزل.
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
القدس العربي
ترامب والمناطق الآمنة/ خورشيد دلي
شكّل إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عزمه إقامة مناطق آمنة في سورية والجوار الجغرافي قنبلة سياسية، دفع كثيرين إلى طرح سؤال أساسي، هو هل جاء الإعلان تعبيراً عن سياسةٍ داخلية لترامب، للحد من قضايا اللجوء والهجرة، خصوصاً في ظل إجراءاته المثيرة بهذا الخصوص، أم أنها سياسة أميركية جديدة تجاه الأزمة السورية؟ قوبل الإعلان بحذر روسي وترحيب سعودي وقطري وتركي، لطالما أن تركيا كانت أول دولة دعت إلى إقامة مثل هذه المناطق، ما دعا بعضهم إلى السؤال عما إذا كان إعلان ترامب سيشكل نقطة تقارب بين أنقرة والإدارة الأميركية الجديدة، بعد أن رفضت إدارة باراك أوباما إقامة مثل هذه المناطق طويلا بحجج مختلفة؟
مع الغموض الذي يحيط بمشروع ترامب لإقامة مناطق آمنة، ثمّة أسئلة كثيرة بشأن كيفية إقامة هذه المناطق؟ وأين ستقام؟ وهل سيلجأ ترامب إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بهذا الخصوص، أم سينفذها من خارج المجلس؟ وماذا عن آليات التعاون مع تركيا ودول الخليج العربي بهذا الخصوص؟ وكيف سيواجه ترامب الاعتراض الروسي على إقامة مثل هذه المناطق؟ وهل سيتم تأمين التغطية العسكرية لحماية هذه المناطق من أي هجوم محتمل للنظام السوري وحلفائه؟
بانتظار اتضاح الأمور والخطط والتفاصيل، والتي ستشكل إجاباتٍ عن الأسئلة السابقة، فإن إعلان ترامب يشكل تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه الأزمة السورية، واشتباكا مسبقا مع التدخل العسكري الروسي في سورية إن كانت تعبر عن سياسة حقيقية، وليست مناورة سياسية رفيعة المستوى. إذ إن إقامة مثل هذه المناطق، وإن كانت بهدف وقف تدفق اللاجئين الذين يعتبرهم ترامب تهديدا لأمن الولايات المتحدة، إلا أنها تعني أن الإدارة الأميركية تستعد لسياسة مغايرة لسياسة الانكفاء التي اتبعها أوباما تجاه الأزمة السورية، وهي سياسة استغلها الروس في فرض واقع ميداني يُبقي النظام. وعليه، فإن إقامة مناطق آمنة، لأسباب تتعلق بوقف الهجرة أو خطوة ضد النظام، ستؤدي إلى تصعيد عسكري مع الروس، وهو ما كان يتجنبه أوباما. مع أن المفارقة، هنا، أن علاقات أوباما الذي ابتعد عن التصعيد مع الروس، وترك لهم حرية التدخل العسكري في سورية، مع موسكو كانت متوترة، ولاسيما في الفترة الأخيرة من حكمه، فيما ترامب الذي يتحدث عن إقامة مناطق آمنة لا يتوقف عن إعلان رغبته في سياسة جديدة تجاه روسيا تقوم على التعاون، بل ثمّة من في أميركا يقول إن وصول ترامب إلى البيت الأبيض كان بفضل التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ولعل هذا ما يخفّف من الاعتقاد بأن ترامب سيذهب إلى الصدام مع الروس، وأنه أقرب إلى ممارسة مناورة سياسية. إذ إن منطق ترامب هو منطق المال والأعمال والحسابات والفوائد، وهذا ما يحيلنا إلى قضية تمويل هذه المناطق، وتكلفة حمايتها أمنيا وعسكريا، فضلا عن الحاجات الإنسانية والخدمية للسكان المفترضين من أهالي ونازحين.
ثمّة من يرى أن ترامب قد يجد مشكلةً لقضية تمويل المناطق الآمنة، من خلال دول الخليج العربي التي أبدت استعدادها لدعم إقامة مثل هذه المناطق، وقد سبق أن أشار ترامب إلى دور التمويل الخليجي في هذا الخصوص، إلا أن الإشكالية التي لا تقل أهمية هنا تتعلق بكيفية توفيق ترامب في العلاقة الأميركية بين تركيا ودعم أكراد سورية، إذ ترفض أنقرة هذا الدعم وتنظر إليه بعين الريبة والقلق، كونه يؤسس للمشروع الكردي في المنطقة.
وفي الحديث عن التحديات والإشكاليات والتعقيدات التي تعترض إقامة مناطق آمنة، لا بد من نظرة واقعية إلى حال الانقسام الحاصل في الخريطة السورية جغرافياً، إذ تبدو سورية وكأنها ثلاث مناطق أساسية، تدار كل منها بقوى محلية ودولية، فقسم كبير من الشمال والشرق واقع تحت سيطرة الكرد وحليفهم الأميركي، وقسم آخر من الشمال والشمال الغربي تحت سيطرة الفصائل المسلحة وتركيا، والقسم الثالث الذي يتألف من الساحل والوسط والعاصمة تحت سيطرة النظام وحلفائه. ولعل اللافت هنا أن هذه الانقسامات المناطقية توحي بأن ثمّة تقاطعاً كبيراً بين فكرة إقامة مناطق آمنة وإقامة إدارات حكم محلية، كما أوحت مسودة الدستور التي طرحها الروس أخيراً. وبغض النظر عن هذا التقاطع، فإن ما يجري يوحي بالتأسيس لحكم لا مركزي في سورية أكثر من استراتيجية لإقامة مناطق آمنة.
العربي الجديد
النظام العالمي الجديد آتٍ/ غازي دحمان
لا يطرح دونالد ترامب شعار”أميركا أولاً” ترفاً، أو مكايدةً لأطرافٍ خارجية، بقدر ما هو تأكيد لحقيقةٍ حاول سلفه باراك أوباما طرحها بطريقة أكثر تشذيباً، وهي أن أميركا تعبت من قيادة العالم، ولم تعد قادرةً على ممارسة دور الشرطي في مقابل حصولها على جائزة معنوية، تتمثل بوصف القوّة الأعظم في العالم.
ليس سراً أن أميركا في عهد ترامب ستسعى إلى إعادة تشكيل النظام الدولي، مع مفارقة أن النظام الدولي الحالي هو من صناعتها وتصميمها. لكن، وكما يقول وزير خارجيتها الأسبق، هنري كيسنجر، في كتابه “النظام العالمي”، تغيرت المعطيات بشكل كبير، ذلك أنه، بعد نهاية الحرب العالية الثانية، كان إنتاج أميركا يمثل 55% من الناتج العالمي، وقد وفّر ذلك إمكانية ليكون لها سياسة تجاه كل مناطق العالم، في حين لا يتجاوز اليوم ناتجها نسبة 22% من الناتج العالمي، وهو لا يتيح لها سوى إنتاج سياسات تجاه بعض مناطق العالم وليس كله.
لم تعد فكرة وجود قوى عظمى وحيدة جذابة كثيراً، حتى لو أرادت المؤسسة الأميركية ذلك، أو رغبت به، فهناك رأي عام بات ينحرف عن هذه الفكرة كثيراً، تجنباً للاستحقاقات التي ترتبها، ذاك أن الإحباط الاقتصادي الناتج من العولمة والتجارة الحرّة، وما نجم عنهما من تخفيض الأجور والوظائف للعمال الصناعيين في المجتمعات المتقدمة، جعل الرأي العام يميل إلى الانحراف نحو الشعبوية الاقتصادية والقومية.
ثم إن فكرة القوى العظمى الوحيدة لم تجعل أميركا تحصل على كل ما تريده بسهولة عن طريق إرسال قواتها إلى مناطق الصراعات، وتجارب أفغانستان والعراق، وقبلهما فيتنام، جعلت الرأي العام الأميركي ينفر كثيراً من فكرة القوة العظمى الوحيدة، في وقتٍ تحقّق فيه روسيا رغباتها السياسية، من دون هذه الصفة، كما الصين أيضاً، وهي تحقق رغباتها التجارية كاملة. ولكن، كيف سيتم تشكيل النظام العالمي، أو ما هي ملامح تشكّله الظاهرة حتى الآن؟ يمكن تحديد أربعة ملامح تشكّل مجتمعة السياق إلى نظام دولي جديد:
– تشكّل محاربة العولمة أهم مظاهر هذا النظام العالمي الجديد، فقد شكّلت العولمة أكثر من
“ليست القضية ترامب بل هي ثورة على النخب التي صنعت النظام العالمي المعولم” ثلاثين سنة ماضية الرابط التفاعلي للعلاقات الدولية، وأي انفكاك عنها سيجبر الفاعلين الدوليين على تغيير نمط علاقاتهم وطبيعة تفاعلهم مع العالم.
– يتمثل الملمح الثاني بعدم ممانعة أميركا صعود قوى دولية جديدة، أو على الأقل لم يعد لهذا المعطى أهمية كبيرة في السياسة الخارجية الأميركية التي كانت تشتغل في سنوات سابقة على فكرة معرفة الأشياء التي يجب منع حدوثها بأي شكل، ومهما كلّف من أثمان، أكثر من معرفة الأهداف التي تريد أميركا تحقيقها، ودعوة ترامب أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية إلى الاعتماد على أنفسها في مواجهة المخاطر، وحتى صناعة أسلحة نووية، هو ترجمة لعدم اهتمام أميركا بصعود قوى جديدة، أو منع حدوث متغيراتٍ تؤثر على النظام الدولي. والمهم بالنسبة لترامب هو علاقات تجارية دولية جديدة، يكون لأميركا فيها وضع الأفضلية، لا نظام دولي تكون القوة الوحيدة فيه.
– عدم ممانعة حصول القوى الدولية على مناطق نفوذ لها، وهو الأمر الذي كانت تقاومه أميركا، لاعتباره مؤشراً على تنامي قوّة الفاعلين الدوليين المنافسين، في حين يطرح ترامب هذه القضية إلى مجال المساومة والتفاوض، وينزعها من مدار المبادئ الإستراتيجية الأميركية الرافضة توسيع مناطق النفوذ للخصوم، فليست مشكلة ترامب مع الصين وصولها إلى الجزر المتنازع عليها مع الفيليبين، بقدر ما أن ذلك يتيح للصين طرق نقل وتجارة أوسع. وبالتالي، هو سيسعى إلى توسيع خيارات المساومة معها بالدرجة الأساس، وليس تضييق مساحة نفوذها.
– تخصيص الخدمات العسكرية والأمنية، فلم يعد الانخراط بالنزاعات والأزمات مبرّراً ما لم يأت بنتائج ملموسة، شأن أي استثمار تجاري آخر، أو يكون الهدف منه حماية مصالح واضحة، تماماً كما تفعل الصين، بحصر استخدامها القوّة في مجالها، ومن أجل خدمة مشروعها الاقتصادي، وكما يفعل بوتين من خلال اقتطاع أراض جديدة لصالح روسيا، في أوكرانيا وسورية. وعلى ذلك، لم يعد نمط التدخل تحت يافطة شعارات فضفاضة صالحاً للعمل به في الزمن الحالي، وعلى من يريد التمتع بحماية عسكرية وخدمات أمنية أن يدفع مقابلها، وهذا ما لم يتحرّج ترامب في التصريح العلني عنه.
لكن، ما هي الآليات التي سيتم من خلالها الانتقال إلى النظام الدولي الجديد؟ أو كيف يمكن
“لم يعد نمط التدخل تحت يافطة شعارات فضفاضة صالحاً للعمل به في الزمن الحالي” إدراج هذه المتغيرات في الواقع الدولي؟ ثمّة مؤشرات عديدة على وجود معارضة للانتقال إلى نظام دولي جديد، سواء من داخل المؤسسة الأميركية نفسها التي تشهد انقساما ملحوظاً حتى داخل الفريق الذي اختاره ترامب لتنفيذ السياسات الأميركية، أو من الأطراف الدولية الأخرى (أوروبا وشرق آسيا والشرق الأوسط) التي لم ترتب أمورها بعد، للتكيف مع نظام دولي جديد. وبالتالي، ونظراً لوجود حالة الاعتراض، وما لأصحابها من تأثير، فالمرجح أن العالم لن يشهد نقلة نوعية مرّة واحدة، بل من المرجح أن يجري اتخاذ سلسلة من القرارات التكتيكية البحتة التي تجعل اندراج المتغيرات مع الزمن يحدث من دون حصول تداعيات ملموسة، وهو النمط نفسه الذي اشتهرت به سياسة فلاديمير بوتين، ولم يخف ترامب إعجابه بها.
ربما تعاند بعض الأطراف والتجمعات الإنتقال إلى نظام دولي جديد. لكن، لا يبدو أن ثمّة خيارات كبيرة أمامها، وعليها أن تدرك أن النظام القديم مات، ليست القضية ترامب، بل هي ثورة على النخب التي صنعت النظام العالمي المعولم، واستبداله بنظام يقوم على النيو قومية.
العربي الجديد
عن المناطق الآمنة في سورية/ حسين عبد العزيز
يأتي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنشاء مناطق آمنة في سورية أو في الدول المحيطة بها ضمن سياق طبيعي لتوجهه الرامي إلى تقليص وإنهاء عمليات الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو توجه قديم عبر عنه العام الماضي حين أعلن أن الحل الوحيد للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين هو إقامة مناطق آمنة في سورية للحيلولة دون لجوئهم إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.
وبالتالي، ليس المقصود أميركياً إنشاء مناطق آمنة أو عازلة بالمعنى العسكري، فمثل هذه المناطق قد تجاوزتها الأحداث العسكرية على الأرض نتيجة التفاهم الروسي – التركي. والمشهد الميداني الجديد في الشمال السوري وطبيعة التحالفات الإقليمية – الدولية لا تسمحان بمثل هذا الفهم العسكري للمناطق الآمنة.
وحتى تركيا ذاتها التي طالبت خلال السنوات الماضية بإقامة منطقة آمنة ذات صبغة إنسانية وعسكرية في الوقت نفسه، لم تعد تطالب بها بعدما توجهت شرقاً نحو الكرملين وحصلت على حصة جغرافية مهمة تحقق من خلالها حل جزء من أزمة اللاجئين من جهة، وإنهاء التواصل الجغرافي بين مناطق الأكراد من جهة ثانية.
لكن المشكلة هي أن ثمة خطاً رفيعاً بين منطقة آمنة لأغراض إنسانية ومنطقة آمنة لأغراض عسكرية، ذلك أن كلا المنطقتين تعنيان تحييد أرض جغرافية ما عن النزاع، وهذا أمر يتطلب موارد كبيرة لضمانها، بما فيها حظر الطيران.
ولذلك بدت موسكو ممتعضة من إعلان ترامب هذا من دون التشاور معها، فموسكو ترفض تحييد أي بقعة جغرافية عن الصراع قبل اكتمال المشهد العسكري في عموم سورية، وهو المشهد الذي عملت بجد على رسمه وتحديده.
المنطقة الآمنة لأغراض إنسانية يمكن أن تتحول بقرار إلى منطقة عسكرية، وهذا يشكل ضربة قوية وقاصمة للمجهود الذي قامت به روسيا خلال العامين الماضيين، كما أن من شأن هذه المنطقة أن تعيد صوغ التحالفات من جديد، وتكون بمثابة أسفين بين تركيا وروسيا.
لن تخاطر أنقرة بطبيعة الحال بالمضي قدماً في المشروع الأميركي وإن رحبت به من حيث المبدأ إلا بما يتماهى مع الأغراض الروسية، فلن تخسر تركيا ما حققته على الأرض السورية من نتائج بالغة الأهمية، وهي نتائج تم تحقيقها من البوابة الروسية وليس من البوابة الأميركية.
وأغلب الظن أن واشنطن تتجه إلى إقامة هذه المناطق داخل سورية في الشمال والجنوب، وليس في دول الجوار، لأن الواقع الأردني والتركي لا يسمحان بذلك، فضلاً عن أن المنطقة التي تسيطر عليها تركيا في شمال سورية تتحول تلقائيا إلى ملجأ لكثير من المدنيين السوريين، ولن تتحول إلى منطقة عسكرية، فهذا أهم شرط روسي وضع أمام طاولة الأتراك قبل الموافقة على إطلاق عملية «درع الفرات».
ربما تستفيد أنقرة من التوجه الأميركي الجديد من الناحية المالية لدعم عودة المدنيين إلى المنطقة الشمالية الخاضعة لها، وهنا ثمة مصلحة متبادلة: تستفيد واشنطن من الأرض الخاضعة للسيطرة التركية لتوطين اللاجئين، وتستفيد أنقرة منها لتعزيز الثقل الديموغرافي السني، وهو ثقل تبدو أنقرة في حاجة اليه ليكون سداً أمام الأكراد، في حال حصلت تغيرات مفاجئة في سورية قد تقتضي خروج الأتراك من الشمال السوري.
أما في الجنوب السوري، فإنها منطقة تبدو وفق التفاهمات مع روسيا من حصة الأردن والولايات المتحدة، غير أن المشكلة التي تواجه إقامة مثل هذه المنطقة هي اقتراب المناطق الجغرافية التي تسيطر عليها المعارضة والنظام من بعضها بعضاً، وبالتالي يصعب إنشاء منطقة آمنة لا وجود فيها للعنصر المسلح.
لكن المشكلة أن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة حيال سورية لا تزال غامضة، ولا يعرف المدى الذي يمكن أن تتدخل فيه الولايات المتحدة، لأن مثل هذه المناطق تتطلب تدخلاً مباشراً من واشنطن ليس فقط لضمان نجاحها، وإنما أيضاً لضمان حمايتها، وهذا ما تخشاه روسيا.
* إعلامي وكاتب سوري
الحياة
عوائق دولية ستمنع ترامب من تنفيذ تهديداته/ غازي دحمان
في بداية عهده يطلق دونالد ترامب النيران في كل الاتجاهات، من دون مبرّرات حقيقية وواضحة، واللافت أن الجهة الوحيدة التي سلمت من نيرانه هي روسيا، وفي الوقت الذي يعتبر بعضهم في أميركا أن تصريحات ترامب تكتيكية الهدف الوحيد منها هو ترك خياراته مفتوحة، فإن الكثير من اللاعبين الإقليميين والدوليين يتعاطون مع الأمر بجدية ويعملون على تغيير الوقائع وإجراء ترتيبات تقوّي مواقفهم تجاه ترامب وسياساته.
بخفّة وتسرّع، لا يليقان بصانع قرار دولة بحجم الولايات المتحدة الأميركية، يحاكم ترامب تحالفات وكيانات وأنظمة تكاد تشكّل أحد ركائز النظام الدولي المعاصر، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي والصين، ويفعل ذلك بإسلوب ينطوي على تهديد واضح بالعمل ضدها والسعي إلى تفكيكها أو تهميش فعاليتها، ويفعل ذلك أيضاً من خلال النظر من زاوية ضيّقة تركّز على التكاليف من دون حساب أخطار هدم هذا المعمار والتداعيات المحتملة على الأمن العالمي واستقرار النظام الدولي!
وتظهر سياسات ترامب، المعلن عنها من خلال تصريحاته ووعوده، عدم الاهتمام بالعواقب الطويلة الأجل، وهذا ما يرده خبراء السياسات إلى علاقته الضعيفة بالواقع وتكوينه السياسي السطحي، الذي تتراكب فيه روح المغامرة في شخصية رجل المال الذي وصل الى حالة الإفلاس أكثر من مرّة، مع فجاجة مقدم برامج الواقع التلفزيونية، مع «الفتوّة» الحزبية القائمة على المكايدات والمؤمرات إضافة إلى الصفقات.
لكن ترامب، على رغم التوصيف السابق، لن يعيش كرئيس للولايات المتحدة في برجه الخاص في الحي النيويوركي الراقي، بل في البيت الأبيض في واشنطن، هناك سيتعامل مع نخبة مختلفة وقضايا مغايرة وأدوات جديدة، هناك لن تكون مهمته إدارة شركاته وموظفيه وأمواله وشؤون عائلته، بل سيدير علاقات أميركا في البيئة الدولية ومجموعة مصالحها وتوازنات القوى التي تتيح لها المحافظة على فاعلية أدوارها وتضمن حضورها، وهناك أيضاً سيواجه الكونغرس وجماعات الضغط والصحافة الحرّة والمجتمع المدني الذي لا يخدم أعضاؤه في أي من شركات ترامب.
إضافة الى ذلك، سيواجه ترامب أطرافاً دولية، تنبّهت مسبقاً لاحتمال حصول تغييرات في البيئة الدولية، وصنعت بدائل وخلقت وقائع صلبة يصعب تغييرها، ولم تكن سراً الحركة الدائبة التي قامت بها روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية، مستثمرة الرخاوة التي انطوت عليها مرحلة حكم أوباما ورفعت من أرصدتها الاستراتيجية، جغرافياً وتسليحاً، مما قد يحتاج معها ترامب إلى إجراء تعديلات هيكلية كبيرة على مستوى الانتشار والانخراط، وحتى على مستوى البنى التحتية للمواجهة بعد أن دمّرت إدارة أوباما الكثير من الشبكات التي كانت تستند عليها أميركا في تدعيم حضورها وفاعليتها.
هل يدرك ترامب معنى هذه المتغيرات والوقائع التي رتبتها، وإذا كان يعلم، وهو لا بد يعلم، فأين يستطيع تصريف طاقة العبث لديه، وأين يستطيع أن يكون تلك الشخصية المرعبة التي رسمها لنفسه؟ بل أين سيحقق الانسجام بين تهوره المفرط وحساباته الدقيقة للتكاليف، وهما العنصران اللذان شكّلا شخصيته وسلوكه؟!
تكشف خريطة مواقع القوّة في العالم وتموضعاتها الجديدة، طبيعة الطرق والمسالك التي سيضطر ترامب إلى السير بها في إدارة علاقات أميركا في هذه البيئة الدولية المتغيرة، فمع روسيا، ثمّة عوائق كثيرة تمنعه من الذهاب بعيداً في اللعب معها، إذ عدا عن ميله الشخصي للتصالح مع موسكو، فإن فلاديمير بوتين استطاع وضع ركائز قوية له في مناطق التماس مع النفوذ والمصالح الأميركية، في أوروبا والشرق الأوسط، سيضطر ترامب إلى اللعب تحت سقفها، كما سيضطر إلى تكييف تهديداته للصين التي بنت مجالاً من النفوذ والقوة في بحرها الجنوبي يصعب تفكيكه من دون المغامرة بخوض حرب مدمّرة، وحتى في الاتحاد الأوروبي سيواجه ترامب مشاغبات كثيرة من الداخل الأميركي تجبره على تعديل سياساته.
تبقى إيران خارج هذه المعطيات، لكن مواقف ترامب المتناقضة، إذا حصل وبنى سياساته تجاه إيران بالتطابق مع تصريحاته، فستكون سياسة مليئة بالثقوب التي تجعل إيران قادرة على استيعاب سلبياتها واستثمار الكثير من هفواتها، وبخاصة على صعيد نفوذها الإقليمي، فسياسة العقاب من جهة وإفلات زمام الأمور من جهة أخرى يعنيان أن إدارة ترامب ستتشدّد في القضايا التي تمس أمن إسرائيل وتترك لإيران الحبل على الغارب في سلوكها في العراق وسورية، بخاصة انها ستكون محسوبة على الطرف الذي يحارب «داعش» والذي يعتبره ترامب المهمة الأساسية له في الشرق الأوسط.
وحدها المنطقة العربية، بدولها ومكوناتها ونظامها الإقليمي، تدخل زمن ترامب من دون أوراق قوّة ولا قدرة على اللعب والمساومة، بل تقدّم نفسها لترامب، الذي لا يرحم الضعفاء، لتكون المساحة التي يهوى لممارسة بهلوانياته، وكما استخدمها بوتين مختبراً لأسلحته، لن يتوانى ترامب في استخدامها مختبراً لتجريب سياسات القوّة. هل نملك أكثر من الانتظار؟
* كاتب سوري
الحياة
تغيير قِيَم أميركا… أبرز «انتصارات» الإرهاب/ عبدالوهاب بدرخان
لا يزال الاعتقاد الأكثر شيوعاً عن الإرهاب، مجسّداً بتنظيمَي «القاعدة» و «داعش» وما تفرّع عنهما، أنه يسعى إلى إقامة «الدولة الإسلامية» أو «دولة الخلافة» أو في حدٍّ أدنى إلى فرض «الحكم بشرع الله». أما الاعتقاد الآخر الأكثر شيوعاً فهو أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق، لا بالحمولة العقائدية ولا بتطبيقاتها الدموية والقهرية. فالنموذج الإيراني لـ «الدولة» الموصوفة بـ «الإسلامية» ساد في الداخل باستخدم القمع والترهيب واستنساخ أساليب سوفياتية وصينية وكورية شمالية لسحق الشعب وإماتة طموحاته، واستنبط بالشحن المذهبي وميليشياته نمطاً من «الفتوحات» الخارجية قائماً على اختراق المجتمعات وضرب أسس تعايش الأديان والأعراق فيها، فضلاً عن استلاب الأنظمة وإلغاء الجيوش وإفساد الأمن وتجاوز الدساتير والقوانين. أما «دولة الخلافة» التي أقامها «داعش»، المنبثق من «القاعدة»، المتحدّر بدوره من تجربة «الأفغان العرب»، فبدت مُستَلهَمة من تجربة حركة «طالبان» والنظام الذي فرضته على أفغانستان قبل أن تزيله الولايات المتحدة مستندةً إلى تحالف دولي عريض، والأرجح أن المصير ذاته ينتظر «دولة داعش»، ولو أن فلولاً بقيت لـ «طالبان» وقد تبقى لـ «داعش» في سورية والعراق، كما هي حال «القاعدة» في اليمن وباكستان وإيران والصومال منذ طرده من معاقله الأفغانية.
قد يلتقي النموذجان الإيراني و «الداعشي» موضوعياً أو يفترقان، وقد يتعاونان أو يتحالفان. الفارق بينهما أن إيران دولة و «داعش» مجرّد تنظيم، والدولة تستخدم التنظيم ولا يستطيع التنظيم أن يستخدمها، بل إنهما قد يقتتلان متى رأت الدولة أن صلاحية استخدام التنظيم في صدد الانتهاء، كما هو حاصل في الموصل. ثم إن هذه الدولة، إيران، التي شرعت أخيراً في التواصل مع عدوّ لدود سابق هو «طالبان»، لم تتردّد في اعتماد فلول «القاعدة» التي تؤويها كقنوات اتصال مع تنظيم «داعش» لتمكينه وتوجيهه، ولم تعدم سبل تعايش مع «جبهة فتح الشام – النصرة سابقاً» التي أبصرت النور من خلال مبايعة علنية لزعيم «القاعدة»، فهذه «الجبهة» تشكّل مع «داعش» وسيلتين لإحباط أي حلّ للصراع السوري ورأس حربة المقاومة الإيرانية – الأسدية للترتيبات الروسية – التركية في سورية. وأبرز ما يلتقي عليه هذا الرباعي أن أطرافه كافةً (النظامان الإيراني والسوري وتنظيما «داعش» و «النصرة») تتخذ من الإرهاب وسيلة لاستكمال تدمير سورية والتحكّم بوجودها ومستقبلها كدولة موحّدة، بمعزل عن نيات روسيا ومشاريعها. وتكرّر إيران مع «الحشد الشعبي» و «داعش» السيناريو ذاته في العراق، حتى في ظل الدور الأميركي.
وإذ يلتقي النموذجان، الإيراني و «الداعشي» – «القاعدي»، على عداء علني للغرب الأميركي وعلى خطاب تتنوّع التفافاته اللغوية إلا أنه يختصر رسالته بـ «إعلاء شأن الاسلام والمسلمين» وبـ «إلحاق الهزيمة بأميركا»، وهي غايات حققت بالأحرى حتى الآن عكس ما توخّته، لذلك تعزّز الانطباع لدى عموم السوريين والعراقيين ومعظم الشعوب العربية بأن ما يحصل هو تواطؤ جمعي أو على الأقل نتيجة التقاء مصالح أتاحه «داعش» بظهوره وانتشاره اللذَين لا يزالان لغزاً أضافت إليه توسّعاته وتجاراته مزيداً من الغموض. إذ شكل التنظيم دافعاً لاقتراب أميركا من ساحة سورية حاذرت إدارة باراك أوباما التعامل معها، ثم ذريعة رسمية للتدخّل الروسي المباشر المتحوّل شيئاً فشيئاً إلى مكوث طويل في سورية، وقبل ذلك ساهمت إيران في تصنيعه ومدّه نظام بشار الأسد بتسهيلات ثم اتخذاه عنواناً لتحالفهما في الحرب على «التكفيريين» بديلاً واستكمالاً لحربهما ضد «المؤامرة الكونية».
عندما اختصرت هذه الأطراف، ومعها أطراف أوروبية وعربية، المسألة السورية بأنها مفاضلة بين الأسد و «داعش» بدا الخيار محسوماً لمصلحة رأس النظام. فمن لديه دولة يمارس باسمها القتل بالسلاح الكيماوي واقتلاع السكان بالمجازر وبمحاصرة المدن وتدميرها بعد تجويعها يبقى أكثر قبولاً في نظر المجتمع الدولي من تنظيم يدّعي «دولةً» ويقطع الرؤوس ويحرق أسراه بالنار ويفجّر المنشآت. والواقع أن تحرّكات التنظيم أظهرت في كل المراحل أنه قاتل المعارضة أكثر مما حارب النظام، بل إنه اتّبع تكتيكات الفصائل المسلحة في الاستيلاء على المناطق، ما دعم الحجة التي دفعت روسيا بها أخيراً حين ذكّرت الأسد بأنها أنقذته وأنقذت سورية من السقوط في أيدي الإرهابيين. لم يسبق لـ «إرهاب الدولة» وارهاب «المجموعات غير الدول» أن وجدا بيئة مناسبة يتناغمان فيها كما هي حالهما في سورية، ولا سبق لهما أن التقيا ضد «عدو» واحد كما يفعلان بكل وحشيتهما حيال الشعب السوري.
من المؤكّد أن «داعش» يقترب من الهزيمة في العراق، وقد يلقى المصير ذاته في الرقة بعد شهور، لكن الإرهاب يضمن بقاءه في سورية عبر نظام الأسد طالما أن القوى الخارجية تواصل دعمه، ويضمن بقاءه في العراق عبر هيمنة إيران وميليشيات «الحشد الشعبي». غير أن الإرهاب أنجز منذ زمن أحد أهم انتصاراته التي طيّر بها صواب الدولة العظمى الوحيدة وكان أحد أسباب تراجع الهيبة الأميركية وما سمّي «أفول الغرب»، وأحد الدوافع وراء بحث دونالد ترامب عن استعادة «عظمة أميركا». كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي آخر من تحدّث عن عوامل التراجع. ففي خطابها أمام خلوة الحزب الجمهوري في فيلادلفيا، عشية لقائها مع ترامب، قالت أن «أفول الغرب» و «صعود الصين» حصلا بالتزامن مع: الأزمة المالية، و «فقدان الثقة» بعد هجمات 11 سبتمبر، والحربين في أفغانستان والعراق، مستخلصة أن استعادة أميركا (وبريطانيا) قيادة العالم مشروطة بعدم العودة إلى «السياسات الفاشلة» وأن أيام تدخلات أميركا وبريطانيا في دول ذات سيادة «لإعادة صنع العالم على صورتهما» قد ولّت.
كان إرهاب «القاعدة» عام 2001 الاختبار الأهم الذي تحدّى أميركا على أرضها واستفزّ جورج بوش الابن وإدارته، وبدا منطقياً أن يتعامل معه كما فعل الرئيس فرانكلين روزفلت مع الهجوم الياباني على بيرل هاربر عام 1941، أي بالذهاب إلى حيث يوجد تنظيم «القاعدة» لمعاقبته ومسحه عن وجه الأرض. لكن بدت أفغانستان هدفاً متاحاً وسهلاً وغير كافٍ أو متناسب مع المستوى الذي تريده أميركا لثأرها، ومع إضافة هدف آخر هو العراق بدأ الاختلال الأميركي في الداخل وحتى في مجتمعات الدول الحليفة في الخارج. وبمعزل عن المسوّغات أو التلفيقات التي سيقت لتبرير غزو العراق واحتلاله فإن الأعوام التي تلته أظهرت الدولة العظمى غارقة في مسار أقرب إلى العشوائية وفي صراع غير متكافئ مع تنظيم إرهابي لا يحقق فيه أي طرف انتصاراً حاسماً.
لا شك في أن ما حصل بعد 9 – 11 أضعف «القاعدة» وكبّده خسائر هائلة، لكنه تنظيم وليس دولة، لا هو مسؤول عن شعب وأرض وحدود، ولا هو ينشغل بإحصاء قتلاه. والأكيد أنه عندما خطّط لهجماته لم يحسب نتائجها التي فاقت لاحقاً توقّعاته، كما أنه لم يوصّف أهدافه ولو فعل لما استطاع أن يتصوّر ما تحقق سواء بفعل أخطاء واشنطن خلال الاحتلال، ليس في العراق فحسب بل في عموم المنطقة، أو بفعل أخطاء الانسحاب أواخر 2011 وما تلاه من سياسات أثبتت استمرار الاختلال في الأداء الأميركي إلى حدّ أن انكفاء إدارة باراك أوباما توصّل إلى نتائج أسوأ من تلك التي سجّلتها تهوّرات إدارة بوش الابن. وإذ ذكّر أوباما أخيراً بقتل أسامة بن لادن كأحد أهم إنجازاته فمن الواضح أن ستة عشر عاماً بعد الهجمات الإرهابية والحربَين والأزمة المالية واستمرار صعود الصين وعودة روسيا إلى الواجهة جعلت المجتمع الأميركي في مزاج آخر تماماً. أميركا التي لم تعد أميركا التي يعرفها العالم مهّدت لمجيء دونالد ترامب، متفلّتاً من القيم ومن الواجبات، محاولاً تجاوز «السياسات الفاشلة» ونسيانها، لكنْ متمسّكاً بالصراع المستمر مع الإرهاب ومتوعّداً بسحقه. وكلما زادت أميركا منسوب القوة ضد الإرهاب كتبت له بدايات جديدة.
الحياة
هل تلغي إدارة ترامب الاتفاق النووي الإيراني؟/ نجيب جورج عوض
هل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بصدد تجميد الاتفاق النووي مع إيران، أو حتى إلغائه؟ لا يمكن تقصّي ملامح إجابة لهذا التساؤل، إلا بتحليلٍ ينطلق من حقيقة أن هذا الاتفاق اسمه “اتفاق نووي”، ولا شيء آخر. لم تعقد أميركا مع إيران اتفاقاً حول ولاية الفقيه، ولا صفقةً بشأن تقاسم النفوذ الاقتصادي في منطقةٍ ما. وهي لم تعقد اتفاقاً حول دور إيران الاستراتيجي في عمقها المشرقي- العربي. عقدت أميركا اتفاقاً يدور حول مسألة القدرة النووية حصراً. لهذا، علينا أن نسبر دلالات عقد اتفاقٍ حول مسألة القدرة النووية دون سواها، لكي نستطيع أن نستشرف الممكنات التي يمكن أن تؤول إليها تلك الاتفاقية، في عهد إدارة ترامب.
من أهم النقاط التي يجب أن نفهمها في ما يتعلق بعملية الانتساب لنادي الدول النووية أن معيار اعتبار دولةٍ ما “دولة نووية” لا يقوم على مسألة صناعة تلك الدولة للسلاح النووي، وامتلاكها له، جزءاً من ترسانتها العسكرية. المعيار الناظم والأساس هو القدرة على إنتاج قوة نووية كافية لتحويلها إلى سلاح عسكري. المعيار هو مسألة “القدرة”، وليس مسألة “الصناعة والحيازة”. كل الدول المنتمية للنادي النووي تملك قدرة نووية كافيةً لتحويلها سلاحاً، ولكنها لا تصنع السلاح، ولا تمتلكه في مستودعات ترسانتها بالضرورة. وحين تعرّض العراق لحملة تفتيش دولية، ومن بعدها لاحتلال أميركي- بريطاني، بحجة امتلاكه السلاح النووي، كانت المسألة في العمق مسألة استراتيجيةً تتعلق باكتشاف مديري اللعبة الاستراتيجية بأن العراق بات يمتلك “قدرة” نووية كافية ليدخل النادي النووي. كان الكل يعلم أن العراق لم يمتلك السلاح النووي، وأنه لم يصنعه في الواقع، إلا أن اللاعبين الاستراتيجيين في العالم لم يكونوا قد قرّروا بأن يُنسِّبوا أياً من دول العالم العربي إلى نادي الدول المالكة قدراتٍ نووية.
يمكن لمن يتابع تفاصيل الحالة الاقتصادية والمالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يدرك أن من الأربح والأفيد مادياً واقتصادياً لإيران أن تطور خطاباً عن قدرتها على إنتاج السلاح
“لن تعمد إدارة ترامب إلى نقض الاتفاق إلا أنها ستحجِّم مفاعيله” النووي، بدل أن تنتج فعلياً سلاحاً كهذا. صناعة السلاح النووي وتخزينه وحمايته وصيانته الدورية، ومن ثم تطويره، أمور كانت سترهق الاقتصاد الإيراني بشكل كامل، وتقود البلد إلى الاستنزاف الكلي، وربما الانهيار الوشيك، بسبب عدم قدرة إيران على تحمل تكاليف المحافظة على منتوج كهذا، من دون استعماله أبداً في الواقع، فالدول المالكة للسلاح النووي تعلم تماماً أنه دفاعي، وليس هجومياً، وأنه لن يتم استخدامه أبداً يوماً ما في أي صراع.
أدرك النظام الإيراني هذه المعادلة، وعرف تماماً أن تأشيرة دخوله إلى النادي النووي تقوم على خطابه المقنع حول قدرته على صناعة سلاح نووي، وليس على صناعته مثل هذا السلاح وامتلاكه. منذ البداية، طوّرت إيران خطاباً متماسكاً بشأن تلك القدرة، ونجحت في إقناع الدول النووية به. ولنتذكّر أن المرشد الأعلى أصدر فتوى دينية حاسمة ومكرّرة بتحريم صناعة السلاح النووي، إلا أنَّه لم يصدر يوماً فتوى تحرِّم نشر خطاب القدرة على القيام بذلك وتسويق هذا الخطاب، فالإمام الفقيه يعلم تماماً ما تحتاجه إيران للانتساب للنادي النووي، والدخول في عصبة الدول المقرّرة واللاعبة في اللعبة الاستراتيجية الناظمة للنفوذ حول العالم. حققت إيران هدفها. فإدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، ومعها أوروبا، ارتأت أنَّ إيران حققت شرط الانتساب، لأنها باتت تمتلك القدرة المطلوبة لذلك. لم يمنع الاتفاق النووي إيران من دخول النادي النووي. إنه، في الواقع، الاتفاق الذي احتاجته إيران كي تدخل هذا النادي، وهو الاتفاق الذي احتاجه أعضاء النادي، لإدخال إيران إليه، وجعلها تلعب معهم اللعبة الاستراتيجية لتوزيع النفوذ، بدل أن تبقى خارج النادي، تلعب ضد قواعد اللعبة، وتعمل على إزعاجها.
لنعد الآن إلى السؤال الأساس عن موقف إدارة ترامب المتوقع من الاتفاق النووي مع إيران. من الصعب موضوعياً الحديث بشكل محدّد ودقيق عمّا يمكن أن تقوم به إدارة رئيس أميركي،
“من الممكن أن تعمد إدارة ترامب إلى تحجيم حدود النفوذ الذي تطمح إيران إليه في عمقها العربي-المشرقي بقدرتها النووية” مثل ترامب، ومن يختارهم من شخصيات لتبوؤ مواقع القرار، والتأثير في فريقه. أرجِّحُ أنَّ إدارة ترامب لن تميل إلى إخراج إيران من نادي الدول النووية. فإبقاؤها في النادي، وحصر تأثيرها على المشهد الاستراتيجي بلعبة “القدرة على صناعة السلاح النووي”، من دون الوصول إلى “صناعته وتخزينه أو نشره” أربح وأفيد لأميركا ولباقي اللاعبين. كما أنَّ إعطاء إيران الانطباع بأنها باتت لاعباً رسمياً في النادي أربح من جعلها تلعب لعبتها الخاصة خارجه. ولكن، من الممكن أن تعمد إدارة ترامب إلى تحجيم حدود النفوذ الذي تطمح إيران إليه في عمقها العربي-المشرقي بقدرتها النووية. لا روسيا ولا إسرائيل ستقبلان مثل هذا النفوذ والتأثير، فالأولى تعتبر المشرق-العربي عمقاً استراتيجياً أساسياً في سياستها الخارجية، بينما تعتبره الثانية عمقاً وجودياً أولاً في أمنها وفلسفة وجودها. قد نشهد عملاً حثيثاً لتحجيم حدود استفادة إيران من دخولها النادي النووي مع ترضيتها بالسماح لها باستمرار دورها الطاغي في العراق، وأدوار أكثر اعتدالاً ووسطيةً في سورية ولبنان وربما اليمن، كي لا يتم تفجير الشارع العربي- السني وجرّه إلى محاولة امتلاك قدرة نووية، تدفعه إلى المطالبة بالانتساب للنادي النووي، الأمر الذي لا يريد أعضاء النادي حالياً احتضانه. ما لم تنجرف إلى مجازفةٍ كبرى، لن تعمد إدارة ترامب إلى نقض الاتفاق النووي مع إيران، إلا أنها ستُحجِّم مفاعيله، ومدى استفادة إيران من خطاب قدرتها النووية، فأميركا، بل وإيران نفسها، تريد أن يبقى خطاب القدرة النووية “خطاب قدرة” فقط، فكلفة تجاوزه لا يقدر عليها، لا إيران ولا من اتفق معها.
العربي الجديد
ترامب وداعش: دولة مهاجرين ضد دولة مهاجرين/ وليد بركسية
“الحظر المبارك” هي الجملة التي يستخدمها مناصرو “داعش” عبر تطبيق “تيليغرام” تعليقاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول اللاجئين والمسافرين من 7 دول شرق أوسطية ذات غالبية إسلامية إلى الولايات المتحدة، بما فيهم حملة البطاقة الخضراء. وفيما لم يصدر أي “رد رسمي” من “داعش” حول القرار الأميركي بعد، إلا أن أنصار التنظيم التكفيري يطالبون زعيمهم أبو بكر البغدادي بالظهور والتعليق على ترامب “من رئيس دولة إلى رئيس دولة”.
القرار الأميركي هو خطأ استراتيجي كبير كما يصفه روبرت رايتشر، الرئيس السابق لقسم الشرق الأدنى في وكالة المخابرات المركزية الأميركية “CIA”، في تصريحات نقلتها صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، الاثنين، ليس بسبب عنصريته وخرقه للقوانين الدستورية الأميركية فقط، بل لأنه يشكل خدمة حقيقية لـ”داعش” إعلامياً، مع تنبؤات بأن تستفيد بروباغندا التنظيم من القرار لحث المسلمين على التوجه إلى “دولة الخلافة” بدلاً من “الغرب الكافر” الذي ينبذ المسلمين.
ومن اللافت هنا أن دعاية “داعش” مهما بالغت في إظهار قوتها وتبجحت بعظمة الدين وغيرها من المصطلحات، إلا أنها تبقى دعاية ديماغوجية مبنية على الخوف من الآخر أي “الغرب الكافر” وتدعو لرفع الظلم عن فئة من الناس، أي الأفراد السنة ضد السلطات الشيعية – العلوية، تماماً كما كانت حملة ترامب ديماغوجية إلى أبعد حد في اجتذاب الناخبين الأميركيين بناء على مخاوفهم الاقتصادية لرفع الظلم المزعوم الذي أفرزته سياسات باراك أوباما ضد الناخبين البيض.
ولن يكون مفاجئاً أبداً أن يبث “داعش” إصداراً مرئياً في الفترة المقبلة للعب على وتر العداء الغربي للمسلمين من أجل محاولة استقطاب مزيد من المهاجرين إليه، خاصة أن إصداراته السابقة في الأشهر الستة الماضية ضمت مقاطع عامة عن موت المسلمين على شواطئ الغرب بدلاً من توجههم إلى أرض الإسلام، إضافة للقول أن الدول الغربية تميز بين مواطنيها وتتضطهد المسلمين منهم، وتلاحظ الخاصية الأخيرة بشكل اكبر في مجلة “دابق” التي يصدرها التنظيم باللغة الانجليزية، والتي تحدثت عن ذلك وهجرة المسلمين للغرب منذ العدد الأول لها، قبل أن تتعاظم تلك الخاصية الدعائية منذ شهر أيلول/سبتمبر 2015 حينما حاولت الاستفادة من صورة الطفل السوري إيلان الكردي لمهاجمة الهجرة إلى الغرب.
ومن المثير للاهتمام أن كلاً من الولايات المتحدة و”داعش” يتقاسمان هوية واحدة كدولة مهاجرين مهما كانت الخلافات الثقافية – الحضارية كبيرة بينهما، فإن بنى المهاجرون حضارة أميركا كدولة عظيمة ديموقراطية، ليس بمفهوم الإنتاج والتقدم العلمي فقط، بل عبر دفع البلاد حضارياً من الناحية الفكرية لتعزيز الحريات والمساواة بين الأميركيين على مختلف أصولهم وتعدد ثقافاتهم بما في ذلك المسلمون والسود والنساء وغيرها، لدرجة أفرزت تلك السنوات الطويلة رموزاً في هذا المجال مثل مارتن لوثر كينغ في الستينيات وليندا صرصور التي اشتهرت مؤخراً.
أما “داعش” فأحدث خرقاً حقيقياً في طريقة تعامل كافة التنظيمات الجهادية السابقة مع المهاجرين إليه، ربما لأنه خرج من كونه مجرد تنظيم متشدد يقاتل من أجل إقامة دولة إسلامية، إلى إقامة تلك الدولة فعلاً، فلم يقم بتوظيف المهاجرين إليه كمشاريع مقاتلين وانتحاريين فقط، بل استخدمهم في بناء دولته، بحيث كان المهاجرون هم القادة الفعليين كما تشير التقارير الاستخباراتية الغربية وإصدارات “داعش” نفسها، وقد يكون الإعلام هو أبرز مجال تم توظيف المهاجرين فيه، حيث يشرف عبد الرحمن الأميركي على صناعة البروباغندا الداعشية على سبيل المثال، إلى جانب رجلين فرنسيين مجهولي الهوية يشرفان على مكتب التنظيم الإعلامي في مدينة الرقة السورية.
والحال أن ترامب بقراره الأخير حول منع اللاجئين والمسافرين المسلمين من دخول الولايات المتحدة، ينسف كل التنوع الحضاري الأميركي، ويقترب فكرياً من فكر تنظيم “داعش” العنصري، حيث تبدو “أميركا ترامب” منزوعة من سياقها التاريخي وبعيدة عن تنوع الثقافات التي بنيت عليه أصلاً، وهنا يمثل ترامب صوت “الرعاع البيض”، وهم من المهاجرين أصلاً، كما يصف الإعلام الأميركي، وهي خطابات عنصرية تستمد سياقها من الفكر النازي القديم حول تفوق الرجل الأبيض الذي يمثله ترامب اليوم كرئيس لأكبر ديموقراطية في العالم. ويتشابه ذلك مع الإلغائية الداعشية الكلاسيكية، والتي تقوم على نبذ غير المسلمين من بنية الدولة نفسها، الفرق الوحيد أن “داعش” بدأ دولته من هذه الخاصية بالذات بينما يحاول ترامب الوصول إليها.
وإن كان “داعش” يمثل أقصى اليمين في الإسلام السياسي، فإن ترامب يمثل أقصى اليمين في السياسة التقليدية الديموقراطية في الدول الغربية، وفيما يبني “داعش” دولته على أسس دينية بحتة، تبدو عنصرية ترامب أكثر تنوعاً بين العنصرية الدينية المسيحية والعنصرية العرقية أيضاً، وتتقاطع العنصريتان الداعشية والترامبية معاً في نقاط كثيرة، مثل العداء لمواطني الدولة أنفسهم البعيدين عن النمط النموذجي، مثل المثليين والنساء، إضافة لوجود عقدة الرجل الذكر المتفوق في الخطابين العنصريين، ليصبح الصراع هنا محصوراً بين الرجل الأبيض الترامبي والرجل المسلم الداعشي.
يقول ترامب في معرض دفاعه عن قراره التنفيذي الأخير، بأنه لن يسمح لأحد بأن يأخذ حضارة أميركا من الأميركيين، وبنفس الأسلوب يكرر “داعش” منذ ظهوره في المنطقة العام 2013 أنه لن يسمح لأحد بأن يمحي الإسلام من الوجود، وكما يقول ترامب في شعاره الشهير أنه سوف يجعل أميركا عظيمة من جديد، يقول “داعش” أنه سوف يرفع راية الإسلام عالية من جديد، وتحديداً فوق العاصمة الإيطالية روما التي يعطيها التنظيم أهمية خاصة كعاصمة للمسيحية الغربية.
وتقوم داعش على أنها دولة للحضارة الإسلامية مقابل الحضارات الدينية الأخرى، في تكريس شبه حرفي لفلسفة صراع الحضارات التي تحدث عنها الفيلسوف الأميركي صامويل هنتنغتون العام 1991، ظهور هذه القوة ثقافياً، ولو بصورة إرهابية عنفية، يستلزم حدوث رد فعل في الطرف الآخر من العالم، والشرخ القائم اليوم بين مركزي الحضارة الغربية، أميركا وأوروبا طبيعي وفق هذه الرؤية قد يكون أعمق مما هو عليه، خاصة أن تيارات اليمين المتطرف ناشطة في أوروبا أيضاً وإن لم تصل إلى السلطة إلا في بريطانيا، أما العلاقات الإنسانية على المستوى الفردي، في أوروبا وأميركا تجاه اللاجئين والأجانب والمرحبة بالآخر، في المطارات الأميركية ومحطات القطار الألمانية، فلا تعبر بالضرورة عن شخصية الدولة نفسها ككيان مستقل نظرياً.
إلى ذلك، يعتبر “داعش” أكثر تنظيم متطرف استخداماً للسوشيال ميديا لنشر خطابه المتطرف وتحديداً “تيليغرام” منذ حرب شركات التكنولوجيا لمكافحة المحتوى المتطرف، أما ترامب فيفضل حسابه الخاص في “تويتر” للحديث مع مناصريه وتوجيه النقد اللاذع لأعدائه، ملغياً أي دور حقيقي لوسائل الإعلام في البلاد، ليتشابه مع “داعش” في عداء وسائل الإعلام التي توصف في الخطابين على أنها وسائل كاذبة ومدمرة وشريرة.
وهنا يبرز الفرق بين “داعش” وترامب، فبينما يعتمد الأول على طرق همجية دموية لتنفيذ فلسفته يبدو الثاني أكثر نظافة وحضارة في تحويل حملته الدعائية إلى تصرفات فعلية، فلقمع الإعلام مثلاً يقوم “داعش” بإصدار القوانين والفتاوى وتدمير ومصادرة أجهزة التلفزيون وإعدام الصحافيين، بينما لا يحتاج ترامب لتنفيذ فلسفته لأكثر من توقيع أمر تنفيذي ثم تبريره عبر “تويتر”.
الفرق الجوهري الآخر أن أميركا ليست ترامب، كما يصرخ الأميركيون في وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام، بل هي دولة مؤسسات عريقة وشخصيات حضارية، رفض بعضها تنفيذ قرار ترامب الأخير. وهي أيضاً تاريخ طويل من الكفاح المدني من أجل حقوق المرأة والمثليين والسود والأقليات العرقية، والذي تترجم إلى قوانين وحقوق دستورية، وهو تاريخ ليس من السهل تجاوزه أو إلغاؤه، وعليه يجب القول أنه مهما كان ترامب الشعبوي بعنصريته يقارب “داعش” الدموي في كل شيء، فإن “داعش” لا تقارب أميركا في أي شيء، ولو حاول ترامب تحويلها إلى نموذج مظلم لا يمت لتطورها الحضاري بصلة.
المدني
«ترامب الأول»: خليط من بوتين وأردوغان/ حسان حيدر
لم يسبق لرئيس أميركي، أو غير أميركي، ان واجه كل هذا السيل من المعارضة والانتقادات والعداء والسخرية، داخل الولايات المتحدة وخارجها، مثلما واجه دونالد ترامب في الأيام العشرة الأولى له في الحكم. لكن يبدو ان الرجل لا يبالي كثيراً بآراء منتقديه ويصر على المضي قدماً في اجراءاته التي تعكس شخصيته، وخصوصاً اعجابه بزعيمين آخرين سبقاه الى تجاوز المألوف وشخصنة الحكم في بلديهما هما بوتين وأردوغان.
وكانت قرارات ترامب وإجراءاته الانقلابية دفعت بوسائل اعلام اميركية رصينة الى الاستعانة بآراء محللين نفسيين مرموقين لتشخيص «مرض» الرئيس وخطورته، فتراوحت بين وصفه بـ «الجنون» و «النرجسية» و «السادية» و «الانفصال عن الواقع» و «جنون العظمة» و «معاداة المجتمع»، بسبب اصراره على تنفيذ وعود مبالغ فيها اطلقها خلال الانتخابات، وكان يُظن ان غرضها تعبئة مؤيديه اكثر من كونها سياسات يمكن ان تعتمدها كبرى دول العالم.
وإذا كان في تصرفات الرئيس الأميركي وأسلوبه في الكلام وتغريداته ما يبرر نسبتها الى شطط في السلوك الشخصي، الا ان قراراته المتعلقة بالإدارة والمهاجرين والتجارة الخارجية والعلاقات مع الشركات والدول لا تخرج عن خط ناظم يمتد من بداية حملته الانتخابية، ويتلخص في انه يريد ان يطبع الرئاسة في عهده بطابعه الشخصي جداً، وأن يكون «الاستبداد في الرأي» اسلوب حكم وإدارة، طالما ان تجارب معاصرة مماثلة نجحت وأثبتت قدرتها على الاستمرار.
ولو اخذنا قراراته بالتفصيل، لوجدنا انه يقلد «مثاليه» الروسي والتركي، ويخاطب، على غرارهما، شعبوية لا تفتقدها الولايات المتحدة. وإذا كان كل من بوتين وأردوغان نجح في تطويع المؤسسة الحاكمة وإخضاعها لشخصه ومزاجه، فلماذا لا يستطيع هو؟
إذ لا يختلف كثيراً قرار ترامب بمنع دخول السوريين والمهاجرين من ست دول اخرى ذات غالبية مسلمة، بما هو تصرفٌ تعسفي بمصائر مجموعات بشرية وتمييز ديني وقومي في حقها، عما فعله بوتين عندما دخلت قواته جورجيا وفصلت اقليمين منها، ثم اوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم الى روسيا، او عما فعله اردوغان عندما دفع قواته عبر الحدود السورية ليحد من طموحات الأكراد القومية.
اما إقصاء ترامب وزيرة العدل بالوكالة والمسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك لرفضهما او تهاونهما في تطبيق أوامره التنفيذية، فاستنساخ لسلوك بوتين وأردوغان اللذين يستبدلان بين ليلة وضحاها اي مسؤول لا يلتزم حرفية قراراتهما. ويندرج في الإطار نفسه، ما يحصل في وزارة الخارجية الأميركية حيث وقع مئات العاملين عريضة احتجاج على قرار حظر دخول اللاجئين، فكان رد البيت الأبيض ان «عليهم التزام برنامج الرئيس او الرحيل». وكان الرئيس التركي استغل محاولة انقلابية غامضة لإجراء تطهير طاول عشرات آلاف الموظفين الحكوميين في مختلف الإدارات، وخصوصاً في القضاء.
وينطبق نموذجا موسكو وأنقرة على اصرار الرئيس الأميركي على بناء جدار عند الحدود مع المكسيك. فقد سبقه أردوغان الى إقامة شريط عازل لفصل اكراد جنوب شرقي تركيا عن اكراد سورية، وسبقه بوتين في تحويل الشرق الأوكراني منطقة عازلة بين الحلف الأطلسي وروسيا.
أما الحرب التي يشنها ترامب على وسائل الإعلام الأميركية واتهامها بمجافاة الحقيقة والافتراء لأنها انتقدت سياساته وتجرأت على مخالفة تقديراته لعدد المحتفين بتنصيبه، واعتبار كبير مستشاريه الإستراتيجيين ستيف بانون ان «وسائل الإعلام هي حزب المعارضة وعليها ان تبقي فمها مغلقاً وتستمع»، فتشكل تقليداً لا يرقى اليه الشك لأسلوب بوتين المتهم باغتيال الصحافيين والمعارضين، ولأسلوب اردوغان الذي يقبع في سجونه اكبر عدد من الصحافيين في العالم.
وتتطابق مواقف الرؤساء الثلاثة ايضاً في العداء للاتحاد الأوروبي. اذ اشاد ترامب بخروج بريطانيا منه، وحشد بوتين صواريخه عند حدوده الشرقية، فيما يهدد اردوغان بإغراقه باللاجئين.
كيف سيتعامل الأميركيون مع «الإمبراطور» الساعي إلى صلاحيات مطلقة؟ دورية «فورين بوليسي» الأميركية نشرت مقالاً عدّدت فيه ثلاث طرق للتخلص من ترامب قبل انتهاء ولايته في 2021، وتساءلت «هل نحن فعلاً عالقون مع هذا الرجل؟». لكن «التخلص» من رئيس منتخب يبقى حتى الآن في خانة التمني.
الحياة
في البدء كانت الكلمة/ هشام ملحم
اللغة السياسية – وهذا ينطبق بدرجات متفاوتة على جميع الاحزاب السياسية من المحافظين الى الفوضويين – مصممة على جعل الاكاذيب تبدو حقائق، والجريمة محترمة…”
جورج أورويل
“أنا متعلم جداً. أعرف الكلمات. ولدي أفضل الكلمات”
دونالد ترامب
الحط من شأن السياسة يبدأ بالحط من شأن اللغة وتحقيرها. ظاهرة ترامب مبنية على استخدام اللغة ليس لشرح الحقائق بل لتشويهها وطرح “حقائق بديلة”، ليس لكشف الوقائع بل لطمسها. في هذا العالم المزور تصبح اللغة مطاطة الى أقصى حد، ويتحول الابيض أسود وتصير المبالغات اللغوية وتزوير المعاني، الاسلوب الافضل للتعبئة السياسية. الاختصاصيون في اللغة يقولون ان معظم ما يصدر عن ترامب من تصريحات ليس صحيحا، فهو يكذب بشكل تلقائي وفي أي موضوع ونادرا ما يقول أي شيء بصدق أو على الأقل دون مبالغة.
المفارقة ان ترامب الذي يتبجح بأنه لا يقرأ الكتب، يستخدم مفردات قليلة، لكنه حولها “مفاتيح” للتعبير عن مواقفه، ولانه يكررها الى ما لا نهاية فهو يعتقد – وهو محق جزئياً – ان ذلك يجعلها حقيقية. ويستخدم ترامب اللغة لاحداث الصدمة وخلخلة ما هو متعارف عليه. ولان ترامب يريد قلب التقاليد والاعراف السياسية في واشنطن، كما رأينا من قراراته التنفيذية في أسبوعه الأول في البيت الابيض، فانه يوظف تشويهه للغة لتحقيق هذا الهدف. والحرب التي يشنها على وسائل الاعلام التقليدية، تهدف في ما تهدف الى قتل أو تشويه اللغة السياسية المتعارف عليها.
يتساءل ترامب بغضب زائف: “هل نعيش الآن في المانيا النازية”؟ ثم ينتقل الى اتهام وكالة الاستخبارات المركزية بمثل هذه الممارسات، ثم يزور مقرها لاحقا وينفي ان يكون في حال نزاع معها ويتهم الاعلام باختراع هذه الكذبة. يفرض حظراً على دخول المسلمين من سبع دول ويستخدم هذه الكلمة لوصف اجرائه، لكن البيت الابيض ينفي لاحقاً وجود “حظر” ويقول إن ما يجري هو تحقيقات متشددة في خلفية المسافرين الى أميركا. عندما ينتقده عضواً مجلس الشيوخ جون ماكين وليندزي غراهام يتهمهما بمحاولة “التسبب بحرب عالمية ثالثة”. خطبه حافلة بالعبارات المبالغ فيها والتي يكررها دوماً. كل ما لا يعجبه “كارثة” وكل ما يعجبه “هائل” أو “رائع”. وعندما يريد ان يؤكد صحة ادعاء يقول “الجميع يقول لي”. وعندما ادعى الناطق باسم البيت الابيض شون سبايسر ان الجمهور الذي حضر حفل تنصيب ترامب هو الاكبر في التاريخ، وهو كلام كاذب، قالت كالي آن كونواي مستشارة ترامب إنه كان يقدم “حقائق بديلة”. أميركا تعيش الآن في مرحلة “ما بعد الحقيقة”.
النهار
ترامب: الشريف الجديد/ هشام ملحم
يواصل الرئيس دونالد ترامب تحديه للأعراف والمسلمات الدبلوماسية التقليدية في تعامله مع عالم يعتبره غير آمن وفي حالة فوضى. ومع مرور كل يوم يدرك الأميركيون، ومعهم العالم أن ترامب لم يأت ليكمل بل لينقض، لم يأت ليبني على ما أسسه أسلافه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من أحلاف وعلاقات وصداقات والتزامات، بل لتقويض ما يستطيع تقويضه وربما تعديل ما يمكن أن يبقى ولإقامة علاقات وأحلاف مختلفة. ترامب، بعكس أسلافه لا يرى أن هناك صداقات وأحلافاً دائمة مبنية ليس فقط على مصالح مشتركة بل قيم مشتركة، ومفهومه القديم-الجديد “أميركا أولا” مبني على انعزالية نسبية تسعى لصفقات ثنائية تضمن مصالح أميركا الاقتصادية الآنية، ودون الاعتماد على علاقات بنيوية متشعبة تضع المصالح الاقتصادية في سياق سياسة متكاملة مبنية على أسس سياسية- قيمية- ثقافية ثابتة كما كان الحال عليه خلال السبعين سنة الماضية في علاقات الولايات المتحدة مع شركائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي. أسباب بقاء الناتو حلفا عسكريا ناجحا حفظ السلام في أوروبا لأطول فترة في العصر الحديث عديدة ولكن أبرزها كان أنه مبني على قيم ومسلمات سياسية واقتصادية وفلسفية وثقافية مشتركة.
ويبدو أن هذه الأسس لا تعني الكثير لترامب والمقربين منه. بهذا المعنى يمكن اعتبار ظاهرة ترامب، ظاهرة انقلابية بامتياز لم تشهد مثلها الولايات المتحدة في تاريخها. أحد أبرز المسؤولين المؤثرين في إدارة ترامب الجديدة، ستيفن بانون الذي كان رئيسا لتحرير موقع برايتبارت الإلكتروني اليميني المتشدد، كان يفاخر بأنه “لينيني” يسعى لقلب الأوضاع السياسية في البلاد رأسا على عقب، وهو مثل ترامب ينظر بريبة الى مجمل المؤسسة السياسية التقليدية في واشنطن بشقيها الجمهوري والديمقراطي. ووفقا للتسريبات الصحفية وتصريحات المسؤولين فإن ستيفن بانون هو العقل المدبر الذي وقف وراء القرارات التنفيذية العديدة والمثيرة للكثر من الجدل والاستهجان التي يوقعها ترامب يوميا تقريبا، لا بل ساهم في صياغة عدد منها، بما في ذلك القرار المتعلق بالحظر المؤقت لدخول رعايا سبع دول ذات أكثرية مسلمة، ووقف قبول أي لاجئين من سوريا. ستيفن بانون يرى أيضا أن هناك صراعاً بين الإسلام والغرب، وهو يلتقي مع ترامب في انتقاد الدول الأوروبية وتحديدا ألمانيا لقبولها مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وغيرهم. وكان بانون في برامجه الإذاعية قبل الالتحاق بحملة ترامب يعارض استقبال اللاجئين من غير الأصول الأوروبية.
وموقع برايتبارت معروف بنشره لمقالات تنضح بالتعصب والعنصرية. وهذا قد يكون من بين الأسباب التي تجعل اليمين المتشدد في الولايات المتحدة، كما في أوروبا ينظر الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه القائد المسيحي الأبيض الأخير الصامد في أوروبا في وجه ما يعتبره هؤلاء موجة بشرية مسلمة تهدد الغرب المسيحي. وهذه الأوساط لا تخفي إعجابها “بنجاحات” بوتين العسكرية ضد التنظيمات الإسلامية المسلحة من القوقاز إلى سوريا.
وإذا أضفنا إلى ذلك، نرجسية ترامب الصارخة، وأسلوبه في التعامل مع الناس والذي يتراوح بين المباشرة والفظاظة، وتكتيكه التفاوضي المبني على صدم الطرف الآخر بطروحات أولية طموحة ومبالغ بها وإن كانت قابلة للتعديل لاحقا، عندها نبدأ بفهم أسباب تأزيمه لعلاقات الولايات المتحدة مع حلفائها التقليديين مثل جارتها الجنوبية المكسيك، والحلفاء الأوروبيين وأخيرا أستراليا. توقيع ترامب على قرار تنفيذي لبدء العمل في بناء الجدار على الحدود مع المكسيك (والذي يريد ترامب من المكسيك أن تتحمل نفقاته) قبل أيام من زيارة رئيس المكسيك لواشنطن، اعتبرته المكسيك مهينا ولذلك قرر الرئيس أنريكي بينيا نييتو إلغاء زيارته والاكتفاء في هذه المرحلة على الأقل بمكالمة هاتفية. وكشفت وكالة الأسوشييتد بريس أن محضر المكالمة الهاتفية يبين أن ترامب هدد بإرسال الجيش الأميركي لوقف المشاكل التي تتسبب بها بعض العناصر التي لم يذكرها بالاسم (وإن يعتقد أنه كان يتحدث عن عصابات تهريب المخدرات). وقال ترامب للرئيس بينيا نييتو “لديك مجموعة من الرجال السيئين هناك، وأنت لا تقوم بما فيه الكفاية لوقفهم. أعتقد أن جيشكم خائف، ولكن جيشنا ليس خائفا، وربما أرسلته إلى بلادكم لحل المشكلة”. السلطات المكسيكية نفت ذلك، ولكن موقعا إلكترونيا مكسيكيا نشر خبرا مماثلا.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب مع رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبل يوم الجمعة الماضي اتسمت بالحدة وأن ترامب قطعها في نصفها بسبب استيائه من اتفاق وقعته إدارة الرئيس السابق أوباما مع أستراليا قبلت بموجبه استقبال 1250 لاجئ. وأضافت الصحيفة أن ترامب تبجح خلال المكالمة بحجم فوزه في الانتخابات، ولكن بعد أن توتر الجو بين الرجلين، قال ترامب لتيرنبل إنه تحدث في اليوم ذاته مع 4 قادة آخرين من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، ولكن “هذه المكالمة هي الأسوأ بكثير”. وتعتبر أستراليا من أهم حلفاء أميركا خارج القارة الأوروبية، حيث هناك تعاون عسكري واستخباراتي وثيق بين البلدين وشراكة تجارية هامة، عدا عن أن أستراليا قاتلت إلى جانب أميركا في معظم حروبها من فيتنام إلى أفغانستان ونهاية في العراق. تعامل ترامب المهين مع قادة دول حليفة مثل المكسيك وأستراليا يذّكر بأسلوب تعامله مع منافسيه الجمهوريين خلال الانتخابات الحزبية، ومع من يعتبرهم خصومه من الإعلاميين، أي توجيه الإهانات الشخصية لهم إذا تجرأوا على رفض مطالبه أو تحدوه.
التحذير الأميركي الأخير لإيران الذي وجهه مستشار الأمن القومي الجنرال المتقاعد مايكل فلين، وقال فيه إن إدارة الرئيس ترامب وجهت تحذيرا رسميا لإيران، أثار الكثير من الأسئلة، حول الأسلوب الذي تم فيه توجيه التحذير، وما إذا كانت هناك خطة عسكرية-اقتصادية-سياسية للرد على إيران في حال استأنفت أعمالها الاستفزازية. وكان فلين قد قرأ بيانا رسميا استنكر فيه إجراء إيران لتجارب صواريخ باليستية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وقيام الحوثيين في اليمن الذين تسلحهم إيران بإطلاق الصواريخ على سفن البحرية السعودية والإماراتية، معتبرا ان ذلك يسبب خطرا على مصالح الولايات المتحدة وأصدقائها. الإنذار جاء قبل تصديق مجلس الشيوخ بساعات على تعيين ريكس تيليرسون وزيرا للخارجية، وفي الوقت الذي كان فيه وزير الدفاع جيمس ماتيس في طريقه إلى آسيا. وقالت مصادر إن قائد القيادة المركزية المسؤولة عن القوات الأميركية في الشرق الأوسط لم يكن يعلم مسبقا بالإنذار، وقال مسؤول في الخارجية إنه تم إطلاع الوزارة على الإنذار قبل إصداره ولكن البيت الأبيض لم يناقش الإنذار مع الوزارة خلال صياغته. وإضافة إلى استنكار التجارب الصاروخية وهجمات الحوثيين، انتقد فلين الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد، معتبرا أنه “ضعيف وغير فعال”. ولكنه لم يقل كيف ستتعامل إدارة ترامب مع الاتفاق. ومن المستبعد أن يكون الإنذار قد نوقش مسبقا مع قادة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الدولي. وحتى الخبراء والمحللين العسكريين الذي وافقوا على أن استنكار الأعمال العدائية لإيران مطلوب ومبرر، إلا أنهم استغربوا انتقاد الاتفاق النووي – الذي كان الوزير ماتيس قد قال إن واشنطن يجب أن تبقى ملتزمة به – بهذه النبرة القوية والعلنية، وخاصة إذا لم يكن هناك تنسيق مسبق مع حلفاء واشنطن. وحتى الذين يوافقون على التصدي لإيران، تساءلوا عن أسباب تأزيم العلاقات مع الحلفاء، وانتقاد إيران، ولكن في الوقت ذاته تجاهل التحركات العسكرية الروسية العدائية في شرق أوكرانيا والتي نتج عنها قتل وجرح العشرات في الأيام الماضية.
ويعتقد بعض المحللين العسكريين أن الإنذار لإيران، يهدف بالدرجة الأولى إلى تنبيه إيران بشكل مباشر بأن إدارة ترامب لن تتصرف تجاهها كما تصرفت إدارة الرئيس أوباما، وأن هناك شريفا جديدا في البلد اسمه دونالد ترامب، سوف يتعامل بحزم حتى مع أصدقاء أميركا التقليديين مثل المكسيك وأستراليا، كما يريد أن يوقف الفوضى التي تخلقها إيران في المنطقة وأنه يعتزم “تنظيفها” كما يفعل عادة الشريف الجديد في أفلام رعاة البقر (الكاوبوي) عندما يعين في مدينة تعم فيها الفوضى والذي يوجه للعناصر السيئة فيها إنذارا يأتي على شكل: انتبهوا، هناك شريف جديد في المدينة.
ولا أحد يعلم ما إذا كان الرئيس ترامب ومساعدوه في البيت الأبيض يدركون أن العالم المعقد في القرن الحادي والعشرين، يختلف جذريا عن بلدة دودج رمز الفوضى في الغرب الأميركي والأصح في الغرب الخيالي الأميركي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
حلب آخر معارك روسيا بانتظار قمة بوتين – ترامب/ جورج سمعان
تكرّر موسكو أن لا حل عسكرياً لأزمة سورية. وتقود منذ تدخلها العسكري خريف 2015، نشاطاً ديبلوماسياً لا يكل ولا يمل لإبرام حل سياسي. لكن هذا الحل يبدو أيضاً معضلة، إن لم نقل مستحيلاً. فلا هي قادرة على فرضه بالقوة. ولا هي على سكة واحدة مع اللاعبين الآخرين والمتصارعين على بلاد الشام. اجتماع آستانة الأخير لم يفشل، لكنه لم ينجح وقد لا ينجح إذا ظل المعنيون بالحل على مواقفهم. تقدم الكرملين خطوة باتجاه الفصائل المسلحة التي حضرت الاجتماع ووافقت على وقف النار. لكنه لم يستطع إقناعها ولن يستطيع، لا هو ولا الآخرون بدفعها إلى القبول ببقاء الرئيس بشار الأسد، حتى وإن قبلت بإعادة تأهيل النظام مع تعديلات معقولة نصت عليها مسودة «روسية» للدستور السوري الجديد. لا يجرؤ فصيل سياسي أو عسكري على القبول بما تقدمه روسيا بعد كل هذه التضحيات، حتى وإن سكتت تركيا، أحد الأطراف الثلاثة الضامنة الهدنة. وهي سكتت بالفعل وقبلت على مضض ألا يتضمن بيان العاصمة الكازاخية أي إشارة إلى إعلان جنيف الأول وإعلانات فيينا. صحيح أن القرار الدولي 2254 الذي لحظه البيان الثلاثي الروسي – الإيراني – التركي يتضمن إشارة إلى إعلان جنيف. إلا أن الواضح أن موسكو تستهدف منذ استئثارها بالدور البارز في إدارة الأزمة، إلغاء كل ما سبق، وإرساء قواعد ومفاهيم وعناصر جديدة للتسوية. لذلك، أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف تأجيل مفاوضات جنيف، مفضلاً أن تتحول آستانة مقراً لأي مفاوضات بديلاً من المدينة السويسرية.
لا شك في أن موسكو حققت في آستانة خطوة متقدمة على طريق استثمار تدخلها العسكري، خصوصاً في حلب أخيراً. ولم يشر البيان الثلاثي إلى إعلان جنيف الذي بات كتاباً «مقدساً» للمعارضة. لذا، لم يوقع ممثلو الفصائل على البيان، وكذلك فعل النظام. وهنا المعضلة في الحل الذي يبحث عنه الرئيس فلاديمير بوتين. لا شك في جدية بحثه عن الحل. لكن عقبات كبيرة تعترضه. أولها موقف إيران والنظام في دمشق. وليس سراً استياؤه من موقف هذين الحليفين. وصور الخلاف بين موسكو وطهران لا تحتاج إلى تظهير، منذ بداية التدخل العسكري الروسي. لم يصل الأمر إلى حد القطيعة وقد لا يصل بانتظار ما ستسفر عنه القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ونظيره بوتين. ولكن، حتى هذه قد تفاقم العقبات. سيد البيت الأبيض لن يحمل إلى القمة المرتقبة في الربيع المقبل ملف سورية وحده. سيضع في جعبته كل الملفات موضوع الخلاف من أوكرانيا إلى إيران مروراً بسورية وغيرها. يعني ذلك أن اللقاء بين الزعيمين قد يثمر أو لا يثمر صفقة كاملة. بالطبع ما يأمل به المعنيون بسورية، خصوصاً أطياف المعارضة بكل أجنحتها، ألا يكتفي الزعيمان بالتفاهم على محاربة «داعش» وما شاكل، بل أن تنضم واشنطن إلى الجهود الثنائية الروسية – التركية لترتيب حل مُرضٍ يرفع اليد الثقيلة للجمهورية الإسلامية عن دمشق. ويحبط استراتيجيتها في بلاد الشام، مقدمة أيضاً لانضمام أطراف أخرى، مثل دول الخليج، إلى رسم مستقبل سورية. وما لم يحصل مثل هذا التفاهم الدولي – الإقليمي الواسع ستظل التسوية معضلة تماماً كما الحسم العسكري المستحيل. ويصعب الآن التنبؤ بموقف الإدارة الأميركية الجديدة حيال الأزمة في بلاد الشام. وإشارة ترامب إلى تأخير رفع العقوبات التي فرضها سلفه على روسيا، ودعوته أركان فريقه إلى البحث عن إقامة ملاذات آمنة في سورية، لا تؤشران إلى سهولة التفاهم بين الكرملين والبيت الأبيض في القمة الموعودة.
المعارضة السورية تلقت ضربات قاصمة بعد حلب. لكنها ليست في وارد التسليم ببقاء الرئيس الأسد. لن تعول على مدها بسلاح نوعي يعيد شيئاً من التوازن على الأرض. لكن القضاء عليها بالكامل شبه مستحيل والحسم الميداني ليس في أجندة القوات الروسية لاعتبارات كثيرة. تحسب موسكو ألف حساب لحضور إيران واستراتيجيتها وقدرتها على التأثير في موقف الرئيس الأسد. ولعل الرئيس بوتين ليس واثقاً في قدرته على تنفيذ أي التزام بتنحية الأسد إذا اقتضت صفقة كبرى ترحيله. استثمرت طهران الكثير في سورية وقدمت الرجال والمال. ومارست أخيراً ضغوطاً واسعة على دمشق وأوقفت إمدادها بالنفط وتقديمات أخرى لنحو شهرين إلى أن حصلت على عوائد ضخمة لتدخلها وميليشياتها. وضعت يدها باتفاقات رسمية على مناجم الفوسفات، وعلى مساحات واعدة للتنقيب عن النفط كانت من نصيب الشركة السورية للنفط. ونالت ترخيصاً ثالثاً لتشغيل الهاتف الخليوي. وكانت تضغط بلا جدوى للحصول على موقع في مرفأ اللاذقية. وهذا هو العنصر الأهم في استراتيجيتها. وللحقيقة أن الأسد استطاع حتى الآن التملص من هذا المطلب.
الإمساك بموقع على الساحل السوري هدف رئيسي لإيران، يضعها في مواجهة مكشوفة مع روسيا وتركيا أيضاً. ليس سراً أن الجمهورية الإسلامية تريد، بتحركها العسكري وبناء جيوش رديفة من الميليشيات التابعة لها، استكمال وضع يدها على سورية ولبنان كما هي الحال في العراق. وتقضي خطتها الاعتماد على «الحشد الشعبي» وباقي الميليشيات لبناء جسر كبير يمتد من حدودها إلى أرض الرافدين فبلاد الشام مخترقاً المثلث السنّي الكبير بين هذين البلدين حتى الوصول إلى الساحل. يضمن لها هذا بناء خط لتصدير الغاز إلى أوروبا والغرب عموماً. مثلما يضمن لها تحقيق هدف آخر هو التواصل البري الآمن مع حلفائها في لبنان. هكذا، تستكمل عناصر أساسية من سياستها، وترسخ حضورها أو ثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي في المشرق العربي. ولا يخفى أن هذه الأهداف تصطدم بسياسة روسيا التي سعت من الساحة السورية بعد الأوكرانية إلى توكيد قوتها دولة عظمى. وقد طوت صفحة خلافاتها مع تركيا من أجل ضمان التعاون معها في بناء خط مماثل لتصدير الغاز عبر القناة التركية لتظل تتحكم بمصادر الطاقة إلى أوروبا عموماً. فهي تدرك أن الاقتصاد هو عماد قوتها إلى جانب قواها العسكرية. إضافة إلى رغبتها في التعاون مع الدول الخليجية لأهداف تتعلق بالطاقة أيضاً، ولحرصها على عدم ترسيخ صورتها عدواً للعالم السنّي والعربي عموماً.
الجبهات المشتعلة الآن ترسم مشهداً يعكس سياسات الأطراف المعنية. هناك جبهتا تدمر ودمشق وجبهتا الباب وإدلب. الواضح أولاً أن حلب ربما كانت آخر المعارك الروسية، بانتظار الصفقة الكبرى مع الولايات المتحدة. فالواضح أن القوة الروسية التي أعادت حلب إلى حضن النظام قادرة على استعادة تدمر، وقادرة على إلقاء ثقلها الكامل لفك الحصار الذي يضربه «داعش» على بضعة آلاف من جنود النظام في دير الزور. بل قادرة أيضاً على المساهمة الفعالة لتغيير ميزان القوى في إدلب وريفها. فلماذا هذا الإحجام؟ الواضح أيضاً أن قوات النظام وحليفته إيران وميليشياتها تركز على إدلب بدلاً من تدمر لقطع الطريق على النفوذ التركي شمالاً فلا يكون قوة موازية للحضور الإيراني، ولتوجيه ضربة إلى تفاهم موسكو – أنقرة. ويتناسى رأس النظام في دمشق ما قد يحل بالآلاف من جنوده المحاصرين في دير الزور. لعله لا يزال مأخوذاً بنشوة «النصر» الحلبي. أو لعله، إذا وقعت الواقعة، يشحذ آلته الدعائية حيال الغرب بدماء هؤلاء الجنود «ضحايا تنظيم الدولة» كما فعل ويفعل. والإشكال الذي يتحكم بالصراع الخفي بين روسيا والجمهورية الإسلامية أن الأولى تعي مدى حاجتها إلى قوات برية تساعد طيرانها العسكري في تحقيق «إنجازات» على الأرض. بينما تعي الثانية مدى حاجتها إلى القوة الجوية الروسية في الحرب الدائرة. وخير دليل ما حصل في تدمر حيث استأثر الرئيس بوتين بالاحتفال بالنصر، وأصر على إخراج الميليشيات من المدينة. مع أنه يعرف سلفاً أن القوات النظامية السورية لا يمكنها القتال في جبهات عدة. ولا يمكنها وحيدة الحفاظ على ما يتحقق على الأرض. والسؤال اليوم هل لإحجام الكرملين عن الانخراط الحاسم في معارك إدلب وتدمر ودير الزور علاقة بفرملة المشروع الإيراني؟
لا شك في أن الرئيس بوتين لن يجازف في خسارة حليفه الآخر، تركيا التي وقعت على مضض على بيان آستانة، وعدلت خطابها حيال بقاء الرئيس الأسد، من باب الحرص على تفاهمها مع روسيا. وهي تأمل بأن تبدل إدارة ترامب في سياسة أميركا حيال الملاذات الآمنة، لعلها ترتاح من خطر الإرهاب الذي يجتاح مدنها، وترتاح من عبء ملايين اللاجئين ومشاكلهم المرافقة. كما أن بوتين بتفاهمه الواضح مع إسرائيل يعي الإشكالية التي تواجه تل أبيب. فهي تتمسك من جهة ببقاء الأسد خوفاً من رحيلٍ يودي إلى نموذج ليبي ومرابطة قوى متشددة على حدودها الشمالية. ومن جهة أخرى تخشى أيضاً مرابطة إيران وميليشياتها المتحالفة مع النظام على حدود الجولان… يبقى أن سورية قد لا تحتمل استمرار الحرب لسنة أخرى لن توفر البقية الباقية من معالمها بشراً وحجراً. وعند ذلك يسهل تحويل بلاد الشام عراقاً آخر!
الحياة
بوادر تسوية سوريا: مناطق ترامب الآمنة ودستور بوتين/ علي الأمين
“المناطق الآمنة” في سوريا، و“مسودة الدستور السوري” مشروعان بارزان فرضتهما في مسار الأزمة السورية الإدارة الأميركية الجديدة والقيادة الروسية المنتشية بانتصاراتها الاستراتيجية في سوريا. لكن كلّا منهما يثبت حضوره من خلال ما يتلاءم مع مصالحه وشروط الدور الذي يسعى إلى تعزيزه. هذا بعد مرور نحو ست سنوات على الأزمة السورية التي بدأت ثورة ضد نظام الاستبداد، وما لبث بعد سنوات قليلة أن أقحمت الدول الإقليمية نفسها في صراع أرادته على الأراضي السورية تفاديا لمواجهات مباشرة في ما بينها. اليوم تعود واشنطن بعنوان إيجاد مناطق آمنة في سوريا، بعد أن قطعت روسيا أشواطا جعلتها على أهبة أن تتحول مرجعية الحل في هذا البلد المنكوب.
وكانت وكالة رويترز قد سرّبت خبرا عن مسودة قرار تنفيذي يتعلق بفرض مناطق آمنة يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب توقيعه في هذا الشأن. كذلك انتشرت صورة يُقال إنّها ترمز للمناطق التي تسعى إدارة ترامب إلى إقامتها فوق الأراضي السورية.
تركيا تنفّست الصعداء وسارعت إلى دعم الخطوة الأميركية وأكدت على ضرورة المضي بالخطوة في أسرع ما يمكن. لا سيما أنّها كانت أول من دعا إلى هذه الخطوة منذ ثلاث سنوات لكنها لم تلقَ ترحيبا أميركيا في ذلك الحين، وكان هذا الرفض إيذانا بالتحول التركي الذي أخذ وجهة موسكو في مقاربة الأزمة السورية. كذلك تشير التحليلات الصحافية الأميركية إلى أنّ المناطق الآمنة ستجعل الدولة السورية -في حال نفّذت أميركا مخططها- مقسمة إلى أربع مناطق كلّ منها تابعة لدولة ذات وزن دولي وإقليمي.
أما المنطقة الأولى فتمتد من اللاذقية وصولا إلى دمشق وتخضع لنفوذ النظام السوري، بينما المنطقة الثانية تمتد من شمال شرق سوريا وصولا إلى منبج وتخضع للنفوذ الأميركي، فيما تمتد المنطقة الثالثة من السويداء وصولا إلى القنيطرة وتخضع أيضا لأميركا، في حين تفوز تركيا بمنطقة تمتد على طول 70 كيلومترا من شريطها الحدودي وبعمق 70 كيلومترا وصولا إلى مدينة الباب شمال حلب.
انطلاقا ممّا تقدم يبدو أنّ الخلاف بين واشنطن وموسكو قد انطلق بعد إعلان ترامب عن عزمه إقامة مناطق آمنة في سوريا. فقد أعلنت روسيا على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنّ أميركا لم تتشاور مع روسيا حول المناطق الآمنة التي يعتزم ترامب خلقها. وحذرت موسكو من مغبة الإقدام على مثل هذه الخطوة. وبحسب المتحـدث باسم الكـرملين، فإنّه “يجب على الإدارة الأميركية أن تفكر في العواقب المحتملة لإقامة مناطق آمنة في سوريا”.
خلافا لرأي روسيا هذا، يرى الرئيس الأميركي أنّ إنشاء مناطق آمنة هو لصالح الولايات المتحدة الأميركية، لأنّ هذه المناطق ستوفر ملاذا يمنع موجات اللجوء إلى الولايات المتحدة وأوروبا ودول الجوار، وتعفي الولايات المتحدة من “المطالبات الإنسانية”، كما من شأن هذه المناطق أن تتحول إلى ورقة رابحة بيد الولايات المتحدة وروسيا، فيما لو رأت في ذلك مصلحة لهما في أيّ وقت. علما وأنّ الإدارة الأميركية الجديدة، التي أعادت رسم المناطق السورية بناء على ما هو مرسوم من خطوط تماس بين الفرقاء المتصارعين، لا ترى من خلال ذلك ما يحول دون التفاهم مع روسيا ضمن الملف السوري، بما في ذلك ضمان المصالح الروسية في هذا البلد.
وتعتبر إدارة ترامب، كمـا الإدارة السابقة، أنّ لا مصلحة لأميركا في الغرق داخـل المستنقع السوري طالما أنّ روسيا تقوم بالمهمة وتحفظ مصالح أميركا، خصوصا أنّ أوجه الاتفاق بين البلدين ثابتة إزاء محاربة التنظيمات الإسلامية المصنفة إرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش، وضمان المصالح الإسرائيلية ولا سيمـا الجانب الأمني والمتصل بالدرجة الأولى بحق إسرائيل في تنفيذ هجمات عسكرية داخل سوريا في مواجهة ما تراه تهديدا لأمنها. والعنصر الثـالث الذي يتفق عليه الطرفان هو حماية الخصوصية الكردية، وأخيرا الاتفاق الضمني على إيجاد بديل للأسد لا يكون منتميا للتيارات الإسلامية الأصولية أو الجهادية بل على رأس حكم مدني غير ديني.
انطلاقا من موقفها المتشدد من الحركات الإسلامية ومن إيران، تبدو إدارة ترامب، بخلاف إدارة أوباما التي دعمت الحركات الإسلامية الشيعية في المنطقة، تتجه نحو احتواء وتحجيم النفـوذ الإيراني، حرصا على مصالح الـولايات المتحدة ومساعدتها في احتواء الحركات الإسلامية السنيّة. واشنطن تتقاطع مع موسكو على ضرورة تحجيم الدوري الإيراني في سوريا، وهي تدعم توجهات موسكو التي ظهرت عقب اتفاق حلب نهاية العام الماضي، وتواصلت مع مؤتمر أستانة رغم الانزعاج الإيراني الظاهر.
لا تعني هذه التقاطعات الأميركية الروسية في الإقليم السوري وامتداداته أنّنا أمام مرحلة اتفاق بين الدولتين، فعامل الثقة فضلا عن فعالية الاتفاق بين الدولتين الأميركية والروسية، لا يزالان في طور الاختبار. الثابت أنّ المرجعيتين الدوليتين امتلكتا إلى حد بعيد معظم أوراق الأزمة والحل في سوريا، فيمـا الأطـراف الإقليمية، لا سيما إيران وتركيا، تحاول الحفاظ على أكبر قـدر من الحصة التي صـار تقسيمهـا بيد موسكو وواشنطن إلى حد بعيد. مسودة الدستور السوري تشكل نقطة القوة التي تدركها موسكو وواشنطن. فهما تتطلعان إلى دستور لا يولي النظام الإسلامي أيّ اهتمام، وهو ما يرضي أكثر من طرف إقليمي بالدرجة الأولى لا سيما إيران التي تجد نفسها ضد أيّ مشروع دولة إسلامية سنيّة في المنطقة العربية، ولا سيما في سوريا طالما أنّ الحركات الإسلامية في سوريا تناصبها العداء.
لا شكّ أنّ اعتراضات الائتلاف السوري على هذا الدستور كبيرة، ولا سيما في الجانب المتصل بفتح روسيا الباب لكل من يطلق على نفسه اسم “معارض”، للمشاركة في بلورة ورقة الدستور الجديد، فضلا عن ممثلي النظام. لذا لم يلبِّ ائتلاف المعارضة السورية دعوة موسكو الأخيرة لمناقشة مسودة الدستور. “المناطق الآمنة” و“مسودة الدستور السوري” مشروعان يحددان مسار الأزمة وطرق التسوية بالمعيارين الأميركي والروسي، ويستندان إلى الاقتنـاع بأن أطـراف الصراع استنزفت إلى حد بعيد، وقابليتها للقبول بالتسوية باتت ظاهرة فيما تنضج فكرة الخلاص من الأسد بموازاة الاتفاق على استبعاد أيّ تنظيم إسلامي متطرف عن السلطة الجديدة، بالتزامن مع الدعوة المتضمّنة في مؤتمر أستانة ومقدماته، إلى خروج كل الميليشيات الأجنبية من سوريا.
كاتب لبناني
العرب
المسلمون حيال ترامب و «صراع الأديان»/ حازم صاغية
دونالد ترامب يسابق ويسبق أكثر افتراضات الخيال سواداً. انقلابه، وآخر خطواته القرار التنفيذيّ في صدد الهجرة واللجوء، يستبطن الحرب الدينيّة في إخلال صريح بالقيم والمعايير التي باتت تعادل التقدّم وتساوي العقل. أمّا الردّة التي يرعاها، بخليط من العُظام والخفّة والوضاعة، فلا تعبأ حتّى بالقانون، ناهيك عن الأعراف.
هذا الكلام وغيره قيلا مراراً، بأصوات كثيرة وبلغات شتّى، وهو ما ينبغي أن يقال دائماً إلى أن ينجلي الكابوس الترامبيّ عن صدر أميركا والعالم.
لكنّ الانتباه إلى مسألة أخرى واجب مُلحّ أيضاً. ذاك أنّ الحملة على المسلمين (والمكسيك والصين…) يواجهها تضامن جبّار معهم، تضامنٌ تعبّر عنه قوى شعبيّة وقيادات سياسيّة وثقافيّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة وكندا وأوروبا الغربيّة. حتّى رئيسة الحكومة البريطانيّة تيريزا ماي، التي تطمح إلى أن تكون لترامب ما كانه توني بلير لجورج دبليو بوش، لم تستطع أن تبقى صامتة ومتفرّجة.
فهذا النكوص إلى الوراء، إلى أزمنة الحروب الدينيّة، ليس عمليّة سهلة أو بسيطة. إنّه يصطدم بالكثير من الأفكار والإنجازات والوقائع والمصالح التي نمت عقداً بعد عقد، والتي تعاند ترامب راهناً وسوف تعانده إلى أن يرحل.
وما تنمّ عنه الوجهة هذه، ضدّاً على ما يشتهيه رئيس أميركا، وما يشتهيه معه المتعصّبون والتكفيريّون الإسلاميّون، أنّ العالم، والغرب تحديداً، لا «يكرهان» الإسلام والمسلمين. فالمجتمع التعدّديّ الذي بني في الغرب، ويُبنى، إنّما يحضّ على التنوّع والاختلاف ويحتفل بهما، والقوانين طُوّعت، وتُطوَّع، لمواكبة هذا المستجدّ الكبير.
والحقيقة هذه تستحقّ أن نتمعّن فيها قليلاً، ليس فقط لأنّها تشحذ نضاليّة المسلمين ضدّ ترامب وقد تربطها بنضاليّة كونيّة عريضة، بل أيضاً لأنّها تحاصر النظرة الغاضبة إلى هذا الكون، وغير السعيدة به، التي ترقى إلى ما قبل ترامب بكثير. فالعالم الغربيّ ليس مجمعاً على معاداة الإسلام والمسلمين. هذا وهم محض وإن كان وهماً وظيفيّاً يروّج له ويفيد منه مقاولو الحروب الدينيّة و «الحضاريّة».
بهذا فإنّ المواقف الشعوريّة والردود والتشهير لا تُغني عن التدخّل والمبادرة الإيجابيّين، وعن طرح سؤال أساسيّ يتقدّمهما: ما هي مسؤوليّة العالم الإسلاميّ عن كبح الحرب الدينيّة في العالم، وكبح الترامبيّة بالتالي؟
غنيّ عن القول إنّ احتفال الغرب بالتعدّد ما كان لينشأ لولا إزاحة الدين عن صدر المواطنة والسياسة في ذاك الغرب، وهو ما تُعدّ الترامبيّة اليوم، ردّاً عليه، مثلما هي ردّ على كلّ تقدّم أُحرز في أزمنة سابقة.
لكنْ، وبالقياس نفسه، يُلاحظ أنّ العالم الإسلاميّ عموماً، والعالم العربيّ خصوصاً، لم يفعلا على هذا الصعيد ما يُذكر. فعلى رغم أكثر من عقد ونصف العقد على جريمة 11 أيلول (سبتمبر) لم نتقدّم خطوة على هذا الطريق. واقع الحال أنّ العكس هو ما حصل، بدليل ما نزل بالأقلّيّات الدينيّة في السنوات الماضية، ممّا يحاول ترامب اليوم استثماره بإعلان تعامله التفضيليّ للأقلّيّات المسيحيّة في العالم الإسلاميّ…
والحال أنّ المنطقة دخلت طوراً، لا تزال مقيمة فيه، هو أشبه بالحلقة الجهنّميّة: أنظمة الاستبداد تزرع أسباب التديين الشامل للحياة العامّة فتردّ المجتمعات المُستَبَدّ بها بإبداء كلّ الاستعداد لهذا التديين. أنظمة الاستبداد تقمع الأكثريّات فتنتقم الأخيرة من الأقلّيّات التي تنحاز، إلى تلك الأنظمة وتتوسّم الخلاص فيها.
وما لم يبدأ التصدّي للوجهة هذه، ستمتدّ رقعة الكذب والدجل وتتوسّع. هكذا يستطيع الرئيس الإيرانيّ روحاني، مثلاً لا حصراً، أن يتفاخر بأنّ «زمن الجدران قد ولّى» فيما هو يتربّع على جدار اسمه الجمهوريّة الدينيّة. أمّا المعجبون بأنظمة لا تقيّد السفر إلى الخارج فحسب، بل تقيّد تنقّل مواطنيها داخل بلدهم، فيستطيعون التباهي بأنّ أميركا «ظهرت على حقيقتها».
الحياة
أميركا وإيران: المواجهة تعود إلى المشهد/ خالد الدخيل
بات بعض معالم ما يمكن أن يفضي إليه فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية يتضح، خصوصاً في الشرق الأوسط. لماذا هذه المنطقة؟ لأنها تعتمل فيها حروب دينية في العراق وسورية، وتعاني من حالة تصدع سياسي لم تعرفه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتلتقي فيها بالتالي عناصر صدام خطيرة بين أهم القوى الإقليمية والعالمية.
قدوم إدارة ترامب إلى البيت الأبيض يضيف إلى هذه الصورة القاتمة عنصراً كان مفقوداً أيام إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وهو عودة واشنطن كلاعب مباشر في أحداث المنطقة بتوجه أيديولوجي تصادمي، ومن دون أجندة سياسية واضحة. وإذا كانت خطورة هذه العودة أنها تأتي إلى منطقة مضطربة، وعلى يد رئيس يفتقد الخبرة السياسية، ويُتهم بالجهل وبميول عنصرية، وفوق ذلك مع فريق غير متجانس سياسياً، فإنها تترك الأبواب مفتوحة أمام كل الاحتمالات، بما فيها الحرب. المفارقة هنا أن إدارة أوباما السابقة التي كانت من دون التزام أيديولوجي، ومن دون سياسة خارجية متماسكة، ساهمت في توسيع مساحات الفراغ وجعلها مفتوحة أمام التمدد الروسي والإيراني، والإرهاب بنسخته الشيعية التي تتبناها إيران، ونسخته السنّية السائبة، ومن ثم أمام التطورات الأخيرة.
خطورة عودة أميركا على النحو الذي تنتهجه إدارة ترامب تتكامل تماماً مع الدور الإيراني في المشهد الذي يتخلق أمامنا من جديد حالياً. فهذه العودة تعيد صدام واشنطن مع طهران ليحتل واجهة المشهد من جديد. وقد اتضح ذلك في أجلى صوره حتى الآن في اختيار إيران الأسبوع الأول من إدارة ترامب للمبادرة إلى إجراء تجربة على صواريخ باليستية، فيما بدا أنه اختبار لرد فعل الإدارة الجديدة. وقد جاء رد الفعل سريعاً وقوياً في الوقت ذاته، إذ بادرت هذه الإدارة إلى فرض حزمة عقوبات على 25 كياناً إيرانياً، ووجهت تحذيراً مباشراً لإيران من الاستمرار في هذه النهج. والجديد، وغير المسبوق في موقف إدارة ترامب، أنها اعتبرت أن الوجود الإيراني في العراق ابتلع هذا البلد في الوقت الذي خسرت أميركا، كما يقول ترامب في تغريدة له، ثلاثة تريليونات دولار أميركي. وهذا تطور جديد لم يألفه الإيرانيون، يسلط الضوء لأول مرة على طبيعة وجودهم في العراق، وسيأخذ على الأرجح حقه من الاهتمام في طهران.
استفادت إيران كثيراً من انكفاء أوباما لتعزيز احتلالها عملياً كلاً من العراق وسورية، ولإبعاد سياساتها الطائفية عن الاهتمام العالمي. كما استفادت من تفادي الصدام المباشر مع الولايات المتحدة، والغرب عموماً، بتبنيها ما بات يعرف بنهج الحروب بالوكالة في المنطقة، من خلال إنشاء وتسليح ميليشيات تتبنى أيديولوجيتها الدينية، وتشاركها الأجندة السياسية، وتحارب بالوكالة عنها، وتغطي بالتالي وجودها ونفوذها السياسي حيث تعتمل تلك الحروب. من هذه الزاوية، تكون إيران تغامر بالمبادرة بما قد يفرض عليها التخلي عن نهجها، والانزلاق نحو صدام مباشر كانت تحاول تفاديه. إشكالية إيران أنها تتمسّك على مستوى الخطاب بلغة صدامية لا تتعفف عن التصعيد. وهي تفعل ذلك ربما لتحييد التيار المحافظ داخل النظام الذي يقال أنه يعارض التفاهم أو التقارب مع الغرب. ما يقلق إيران أنه إذا حصل الصدام، لأي سبب، فستسقط معه مباشرة مقولة أن الإرهاب السنّي هو الإرهاب الوحيد الذي يستهدف الغرب ويهدد أمنه في الداخل، ومصالحه في الخارج. ومعه تكتمل صورة العودة الأميركية مع عنصر المغامرة في السلوك الإيراني، ما يضع إدارة ترامب بتوجهاتها اليمينية المندفعة وجهاً لوجه مع النظام اليميني – الديني الإيراني في منطقة ملتهبة، ومفتوحة أمام كل الاحتمالات. وهذا تطور كان مستبعداً من قبل.
وما قد يعزز احتمال الصدام ما نقلته صحيفة «الحياة» أمس السبت عن مسؤول فرنسي رفيع تقول أنه تحادث مع مسؤولين في الأمن القومي الأميركي في واشنطن. وتنقل الصحيفة عنه قوله أن «الأولوية لدى واشنطن في سورية هي إزالة داعش، وإخراج الإيرانيين وحزب الله منها». ويضيف أنه ليست هناك مشكلة لدى الأميركيين «في التحاور مع الروس والحكومة السورية»، بل إنهم يريدون اتفاقاً مع الروس يتركز على تقليص النفوذ الإيراني في سورية حتى مع بقاء بشار الأسد». وفرنسا، كما يقول المسؤول الفرنسي، ترى في موقف الإدارة الجديدة «إيجابية كبرى» كانت تفتقدها سياسة الإدارة السابقة. إذا صحَّ ما نقله المسؤول الفرنسي فإنه يضع طهران في زاوية حرجة أمام هذا الموقف الأميركي الجديد. لأنه موقف يتسع لتفاهم مع روسيا، التي نظراً إلى خلافاتها مع إيران في إدارة الأزمة السورية، قد تشاطر واشنطن وضع حد للنفوذ الإيراني في سورية. والزاوية الحرجة التي ستجد إيران نفسها فيها أنها الوحيدة التي تعتمد في دورها حصرياً هناك على بقاء الميليشيات الشيعية، وأن حاجتها لبقاء الأسد مرتبطة عضوياً ببقاء هذه الميليشيات. بالتالي فإن فصل الارتباط بين بقاء الأسد وبقاء هذه الميليشيات، كما ترى إدارة ترامب، سيشكل إذا نجح ضربة قاتلة للاستراتيجية الإيرانية.
نجاح الإدارة في هذا الاتجاه يعتمد على تفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يمسك بملف الأزمة السورية، ولا بد أنه يرى أن التفاهم مع واشنطن يجب أن يتسع ليشمل شرق أوروبا، خصوصاً الأزمة في أوكرانيا. لهذا، يلتزم بوتين الصمت حتى الآن حيال خروج التجاذب الأميركي – الإيراني إلى العلن. وهو صمت ينتظر كما يبدو تبلور خطة الإدارة الجديدة في سورية، واتضاح أثمان وضع حد للنفوذ الإيراني فيها. ومع غياب تفاهم أميركي – روسي، يتجه الصدام بين أميركا وإيران نحو التصعيد في العراق وسورية، إلا إذا اختارت طهران التهدئة. لكن، كيف يمكنها التهدئة وهي تعرف أن إدارة ترامب تساوي بين خطورة دورها ودور «داعش»؟
كان أوباما يحارب «داعش» بالتحالف مع ميليشيات إيران في العراق. الإدارة الجديدة تريد أن تضع حداً لهذه السياسة، وأن تفصل الأسد عن إيران، والأخيرة عن روسيا. السؤال ما الذي ستفعله إيران وقد باتت بميليشياتها تحت ضوء الاتهام بجوار «داعش»؟ وأن هذا الموضوع سيفرض ذاته على طاولة حوارات ومفاوضات في عواصم إقليمية ودولية كثيرة. هذا أخطر سؤال تواجهه إيران منذ نهاية الحرب العراقية – الإيرانية.
* كاتب وأكاديمي سعودي
الحياة
قطع الرؤوس … وقطع الحدود/ الياس حرفوش
طبعاً كان غلاف مجلة «در شبيغل» الألمانية صادماً. لكن … تعالوا نفكر قليلاً أمام هذا الرسم. ها هو دونالد ترامب، الذبّاح، قاطع رأس تمثال الحرية الشهير، رمز الليبرالية والانفتاح، الذي طالما كان أول ما يراه المهاجرون والقادمون من أصقاع الأرض عند وصولهم نيويورك، ومن بين أولئك الواصلين كان جدّ ترامب ووالده، وزوجته ميلانيا، عارضة الأزياء المهاجرة من سلوفينيا.
ترامب يقطع رأس التمثال الذي قدّمه الفرنسيون هدية إلى الشعب الأميركي بمناسبة الذكرى المئوية لثورته على الاستعمار البريطاني التي ترافقت مع الثورة الفرنسية، في إشارة إلى ترابط الأمم والمصالح ومصائر الشعوب، على عكس ما يسعى اليه ترامب اليوم، هو والفريق الانعزالي الذي يحيط به في البيت الأبيض.
السبيل الوحيد الذي يسلكه ترامب لتنفيذ سياساته الانعزالية (أميركا أولاً) هو القطع. قطع الحدود، وقطع الاتصالات الهاتفية مع الحلفاء، وقطع السبل أمام المهاجرين واللاجئين لمنعهم من الوصول إلى الأراضي الأميركية، الأراضي التي كانت دائماً عنواناً يقصده اللاجئون والمشردون، هي التي تشكّل أهلها في الأصل من مجموعات المهاجرين هؤلاء.
والقطع يمكن أن يكون أيضاً قطع الرؤوس، أي الذبح. على طريقة «داعش» وذبّاحه الشهير محمد اموازي (الجهادي جون)، قاطع رؤوس الرهائن الأبرياء في معتقلات أبو بكر البغدادي.
هل من مبالغة في المقارنة بين ترامب والبغدادي؟ ألا تتشابه الأفكار المتطرفة المعادية للآخر، بناء على جنسه أو دينه أو لونه؟ اتخاذ إجراء بموجب «أمر تنفيذي» بحق شعوب بالجملة، نساء وأطفالاً وشيوخاً، بحجة أن هناك احتمالاً أن يرتكب أي من هؤلاء ذنباً في المستقبل، ألا يشبه ما ارتكبه «داعش» ولا يزال بحقّ شعوب بالجملة، مسلمة وغير مسلمة، بحجة أن مجرد بقائها على قيد الحياة يشكل تهديداً لـ «فكره» المنحرف، فيهجّرها من مساكنها ويقضي على من يرفض الخروج أو الاستسلام أو الانضمام إلى صفوف التنظيم؟
كثيرون من المسؤولين الغربيين حذروا وعن حق من أن إجراءات دونالد ترامب تصب في نهاية الأمر في خدمة أفكار المتطرفين والداعين إلى قطع الجسور بين الأديان والثقافات على الضفة الأخرى من هذا الانقسام المريع. ومن بين هؤلاء وزيرة الداخلية البريطانية أمبير رود (أجل في حكومة تيريزا ماي)، التي اعتبرت أن قرارات منع الهجرة من الدول السبع من شأنها أن تزيد التعاطف مع الإرهابيين، وأن تقنعهم بأن عداءهم للغرب ولأتباع الديانة المسيحية تحديداً هو عداء مبرّر ومشروع.
ذلك أن تقسيم العالم إلى «فسطاطين» بحسب خطب أسامة بن لادن، هو ما تؤدي إليه الحدود المغلقة، ليس فقط على الأرض من خلال الجدران العالية، بل أيضاً وأكثر خطراً بين العقول. ستيفن بانون، المنظّر الأكبر و «الرجل الثاني» في إدارة ترامب، كما تصفه الصحافة الأميركية، يرى «صراع الحضارات» قائماً بين ما يسميه «الغرب اليهودي المسيحي» والحضارات الأخرى، وفي مقدمها الخطر القادم من «التوسع الإسلامي». عندما تكون أذُن ترامب متجهة صوب فم هذا الرجل، هل يبقى صعباً وصف القرارات الأخيرة للرئيس الأميركي بالمعادية للمسلمين؟ خصوصاً أن ترامب نفسه طلب طريقة أكثر لطفاً لوصفها، كي لا تبدو كذلك، على ما نقل عنه رودولف جولياني.
لكن، لحسن الحظ، لا «داعش» يمثل المسلمين، ولا ترامب يمثل حكومات الغرب وشعوبه. علينا أن نتذكر مثلاً تعاطف رئيس حكومة كندا جاستن ترودو مع مواطنيه المسلمين (حوالى المليون) بعد الاعتداء على المسجد في كيبيك الذي ارتكبه شاب متطرف معجب بترامب وبتلك العنصرية الفرنسية الأخرى، مارين لوبن. كما لا بد من متابعة مواقف وقرارات المؤسسات الاميركية الحريصة على إنقاذ بلادها وسمعتها وتاريخها من تشويهات ترامب، والمثال الأبرز هو القرار الشجاع الذي اتخذه القاضي الاتحادي في سياتل الذي أوقف تنفيذ الأوامر الرئاسية لأنها غير دستورية ولا قانونية، ولم يجد رئيس أميركا ما يرد عليه سوى إهانة «المدعو قاضياً» واعتبار قراره «سخيفاً».
في نهاية الأمر، لن يستطيع ترامب أن يتصرف مثل صدام حسين أو عيدي أمين. من مساوئ الديموقراطيات أنها قد تزلّ قدمها فتأتينا بترامب رئيساً، لكن من حسناتها أن مؤسساتها قادرة على تقويم الاعوجاج قبل أن يتحول … كارثة.
لعل وعسى!
الحياة
كيف يمكن أن يكون ما يجري مقبولاً؟/ نهلة الشهال
يقول دونالد ترامب ببساطة ووضوح أنه ليس ضد التعذيب الذي استخــــدمه المحـــقـــــقون الأميركيون في كثير من الحالات، في معتقل غوانتانامو ومراكز التحقيق السرية حول العالم، كأسلوب الإيحاء بالغرق وسواه. ليس ضده طالما هو «فعّال» ويوصل المحققين إلى مبتغاهم، ساخراً ممن تُجرَح مشاعره. تعقيباً، تُولوِل المنظمات المعنية بالشأن، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة القانونيين الدولية، والأمم المتحدة تدين… لا يهم، إذ يبدو ترامب في تصريحاته ومواقفه أقرب إلى الحقيقة والواقع، كاشفاً ما يجري فعلاً. ولعل في ذلك أحد أسرار شعبيته وتسامح الناس مع فظاعات أقواله، وابتذاله وتناقضاته. ويحدث الأمر نفسه حين يتكلم عن مشروعه لنهب نفط العراق. يضحك الناس ويصفقون له ويبدون في قمة التسلية. وحدهم بعض ممثلي»النخبة» التي يكرهها (هو وكل من يشبهه سياسياً وأيديولوجياً)، وهم هنا إعلاميون يجرون معه مقابلات (بمن فيهم مذيع من «فوكس نيوز» المقربة منه، ظهر مصدوماً ومحرجاً) يسألون بإلحاح عن كيفية القيام بذلك، ويدفعون بالمحاذير، ويبدو عليهم القلق حيال ما يمثله الأمر من انتهاك لسيادة العراق أو لحق الشعب العراقي، أو ما يبدو كسرقة. وهو يزجرهم، ويفعل خصوصاً بطريقة فاقعة مع مذيعة (امرأة وشابة!) يضيق بها ويقاطع كلامها ويكرر كلماته الثلاث حرفياً («نأخذ النفط وكفى») بحزم عدواني، بلا عناء تقديم أدنى شرح. ثم يسخر في خطبه من الحجج المُساقة ضده، ويُضحِك جمهوره.
ويتكرر الحال مع موضوع الجدار الذي ينوي بناءه على الحدود مع المكسيك، مانحاً رئيسها، غير المناهض للولايات المتحدة، بل حليفها، فرصة للسخرية منه («سننشئ أنفاقاً» تحت الحائط، أجابه!)، مما يُظهِر مستوى آخر من «الواقع» الجاري يتعلق بالخروج عن الأصول المتبعة وعن الأعراف الديبلوماسية، وتسييد المسخرة كشيء معتاد. وكل ذلك يتجاوز تماماً ما لمسته هنه أرنت في «عادية الشر» بخصوص النازيين وما ارتكبوه وقبول أفعالهم في محيطها، وما ألح عليه أديب هو بريمو ليفي، في «لو كان إنساناً»، على رغم أهمية تلك «العادية» القصوى في نزع الاستثنائية عن الشر، وتلمسه في ملامح الآخرين وسلوكياتهم (يقول ليفي: «لهم نفس وجوهنا»).
هنا ينزل البليونير الرئيس إلى مكانة رجل شارع وطريقة كلامه وتفكيره حين تكون مجردة من القيم الأخلاقية الضابطة، رجل عادي وليس من «النخبة» (مجدداً!) لا ينمِّق ما يفكر به ويشعره.
وفي هذا، فترامب أكثر تطابقاً مع «الحداثة» كما هي قائمة، مقارنة بسائر المسؤولين الأميركان والأوروبيين، بمن فيهم من يشاطرونه قناعاته. وهو لا يكتفي بالكلام، بل يثير بلبلة عظيمة بشأن المهاجرين والممنوعين من الدخول إلى الولايات المتحدة (بمن فيهم حملة بطاقات الإقامة الخضراء)، ويشتبك مع القضاة ويقيل وزيرة لا تطيع ويعطي أمراً للشرطة بعدم تنفيذ قرارات المحكمة العليا الخ… في ما يبدو قلباً رأساً على عقب ليس فحسب للياقات المتعارف عليها، بل للمؤسسات وتراتبيتها وللقانون. والعجيب أن تخضع سائر الدول لهذا بكل براغماتية، فيفرح وزير الخارجية الفرنسي لأنه تلقى تأكيداً بإعفاء مزدوجي الجنسية (فرنسيين أصولهم من بلدان «إسلامية») من إجراء المنع، كما تطبِّق الإجراء الترمبي، بلا سؤال ولا مقاومة، شركات الطيران وسلطات المطارات في العالم (بمن فيها شركات وسلطات تلك البلدان «الإسلامية»).
وفي فرنسا التي ارتكزت بنيتها الحديثة على تقاليد دولتية صارمة، حيث اعتبارات قيمية عليا تحيط بمواضيع مثل «المال العام» ونزاهة السياسيين، بدا زمن ساركوزي استثناء على القاعدة، التي إن خُرِقت فبتكتم شديد (كما كانت الحال مع شيراك الذي استُفظِع أن ينال هدايا ودعماً من جهات وأفراد يقدَّمون كأصدقائه). واليوم يبدو ساركوزي حملاً وديعاً مقارنة بفضائح السياسيين ورجال الأعمال البارزين، فصحَّ القول إنه لو جرى تجفيف كل ذلك لأمكن بخمس دقائق سد فجوة موازنة الضمان الصحي، العام والمجاني والعالي المستوى، الذي يستفيد منه كلُ الفرنسيين والمقيمين.
فيون وغيره من السياسيين، وداسو وغيره من الاقتصاديين، يجادلون، ولا تبدو الشبهات المحيطة بهم محرجة لهم ولا سبباً لتراجعهم عن طموحاتهم، سواء كانت سياسية أو اقتصادية. وهذا أيضاً يقلب رأساً على عقب تقاليد راسخة ومؤسسات مصاحِبة لها ونظريات عن الدولة و «أسس الجمهورية» بالغة التبلور، شكَّلت أساس العقلية الفرنسية الحديثة بل الفلسفة السياسية للنظام، كما يقلب قوانين حين يجري في نهاية المطاف الالتفاف عليها بشكلية. والأهم، أن هذه الحال لا تتسبب بحرج لقواعد هؤلاء ولا بثورة عارمة ضدهم.
تغير العالم إذاً. الأفكار والنظريات والعادات والتقاليد تبدو كلها «متأخرة» عما هو عليه هذا العالم اليوم، وعن قواعد متَّبعة من دون إعلانها: هل لا تُعلَن لأنها «تمر» بلا حاجة لذلك وللبحث عن تبريرات تتجاوز اللحظة المباشرة وإدارة «الاستثناء»، وهو يتحول بأشكال مختلفة إلى دائم: هل لأن إعلانها ما زال يثير الصدمة بدليل ما يجري مع ترامب، هل لأنه لا «وقت» في ظل ما يقال له «الأزمة» وهي متعددة الجوانب، اقتصادية وأمنية واجتماعية؟
فحيال موجات الهجرة والإرهاب وانهيار العمل وإفقار الطبقة الوسطى الخ، تُتّخذ في بلدان المركز الرأسمالي على اختلافها، الإجراءات – السلوكيات بكل براغماتية، فيختلط اليمين بأقصى اليمين باليسار المؤسساتي، فيصعب في بلد كفرنسا التمييز في الخطابات والمواقف والمقترحات بين مانويل فالس (الحزب الاشتراكي) وفرنسوا فيون (الحزب الجمهوري: اليمين التقليدي) ومارين لوبن (الجبهة الوطنية الشعبوية شبه الفاشية).
… ما تلمَّسه بشكل مدهش عالم الاجتماع الفيلسوف زيغموند باومن حين تكلم عن «اختفاء المؤسسات الثابتة»، قائلاً إن مجتمعاً حديثاً يوصف بالـ «السائل» حين تكون الوضعيات التي يجد فيها الناس أنفسهم ويتصرفون في ظلها، متغيرةً بصورة دائمة وبسرعة، حتى مِنْ قَبل أن تتمكن طرائق سلوكهم من التحول إلى وقائع صلبة مستندة إلى إجراءات وعادات. ويتساءل: «كيف يتحمل أغلب الناس الجروح الاجتماعية التي تقع عليهم؟»، ويجيب: بسبب استمرار «دوغما اللاعدالة» المستندة إلى فرضيات مسبقة تُعامَل كبديهيات، كالنمو الاقتصادي كجواب وحيد ممكن للاجتماع البشري، وزيادة الاستهلاك كوسيلة للوصول إلى السعادة، والطابع «الطبيعي» للتفاوتات باعتبارها نتاج رفع المستحقين وهبوط غير المستحقين… مسجلاً إلحاح الحاجة لمنظومة أخرى من القيم الاجتماعية.
الحياة
رئيس الإهانة: الولايات المتحدة في عهد ترامب/ حسن منيمنة
قبل أسبوعين، شكر الرئيس الأميركي الجديد أسلافه من الرؤساء لحضورهم احتفال تنصيبه، كما تقتضي الشكليات، ثم انهمر عليهم بكيل من الاتهامات التي لا يمكن وصفها إلا بالشتائم، إذ إنهم، وفق أقواله، فرّطوا بمصلحة الناخبين لتحقيق مصالحهم وخدمة لأغراض النخبة التي احتضنتهم، فكانت النتيجة خراب الولايات المتحدة مجتمعاً وبنًى ومؤسسات، وانتشار الجرائم والفقر والجهل.
هي إذاً المجزرة التي استنزفت البلاد وأوصلتها إلى الحضيض، إلا أنه وعد قاطعاً بأن المأساة تنتهي الآن وهنا، فمع وصوله إلى سدة الحكم، وهو الذي تعهد دائماً وأبداً أن يضع خدمة المواطنين، جميع المواطنين، في الصدارة، سيعمد إلى تصحيح ما اعتلّ وإصلاح ما فسد، لتعود أميركا عظيمة كما كانت.
ومنذ أن أغدق ترامب على الولايات المتحدة والعالم هذا الخطاب الخرافي، لم تتوقف سلسلة المفاجآت الخاطفة. والموضوع ليس حدثاً عابراً على قدر من الطرافة بل كارثة متحققة في مصاف اعتداءات 11 أيلول.
كيف ولماذا، وهل في الأمر مؤامرة، ما دور اليمين البديل وهل لروسيا حصة في الفعل، وما شأن النخبة المنقطعة عن العموم، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وما تأثير العولمة، وهل ثمة جانب عرقي أو عنصري، وما مسؤولية أوباما وكلينتون والمؤسسات الحزبية، وما السبيل إلى لجم التخريب والتقسيم الناجمين للتوّ، وهل من سبيل للعودة إلى التعقّل؟ هي أسئلة تشير إلى جوانب لا يمكن إهمالها في استيعاب الحدث وتقييمه وإمكانات احتوائه وتجاوزه. لكنها أسئلة موضوعية غير كافية ما لم تقرن باعتبار رصين لأوجه كثيراً ما دعت المنهجيات التحليلية إلى تخطيها، تجنباً لشخصنة القراءات.
فقراءة ترامب (ومن خلفه قسم من جمهوره) لا تستقيم إلا عبر تحديد المحركات الذاتية التي تؤطر قراراته. والأمر يهون معه، إذ لا حاجة إلى استقراء استشفافيّ، بل متابعة وحسب لسلوكه اليومي. فترامب يعتمد الإهانة كوسيلة لتأكيد القوة والتفوق.
يكاد لجوء ترامب إلى الإهانة يكون قسرياً. فالرجل يبدو عاجزاً عن تجنب القذف عند أي تحدٍ. وخلال حملته الانتخابية، كانت الإهانات كفافه اليومي. فماركو روبيو هو «ماركو الصغير»، وجيب بوش «جيب المنخفض الطاقة»، وتيد كروز «تيد الكذاب»، وهيلاري كلينتون «هيلاري العوجاء»، والصحافيون «منحطون»، والمؤسسات التي تنتقده «فاشلة». وعلى رغم أنه لا يحتمل أن يصدر بحقّه أي كلام من دون أن ينطق هو بالرد اللاذع، فالكثيرون من المتابعين لأدائه أرادوا أن يرى في تصرفاته خطة مدروسة لاستقطاب الجمهور وتعبئته.
ولا شك في أن عموم الجمهور، من مؤيديه إلى مستهجني دخوله المعترك السياسي، قد تلقف أخباره يومياً، لتتحول معه العملية الانتخابية مسرحاً للإثارة والمفاجآت، إلا أنه لا يبدو على الإطلاق أن ترامب كان قادراً، في أي موقع، على ضبط نفسه. فحتى عندما يكون الثمن خسارة في الشعبية، كما إبان مواجهته لخضر خان، والد الجندي الأميركي الشهيد، فإنه يورّط نفسه في منطوق كلامي جارح مهين، ولا يتراجع بتاتاً عن مضمونه. فالرجل سبّاب شتّام، ولكنه كذلك عنيد لا يقبل أقل من الوصول إلى مراده. وهذا الوصف القائم على سلوكه المتكرر كفيل بأن يفسّر ما يبدو للوهلة الأولى مفارقات أو خطوات غريبة في سياساته بعد فوزه.
ترامب صاحب مقولة «الإسلام يكرهنا»، وفي محيطه عدد غير قليل من أصحاب التصورات التسطيحية والتقييمات الطاعنة بالإسلام والمسلمين الذين يقدمون له التأطير «العلمي» الذي يصادق على حسّه البديهي. فحين أعلن عزمه حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، لم تكن المسألة لاعتبارات أمنية فقط، بل كذلك لتأكيد التفوق من خلال الإهانة. وبعدما أمسى رئيساً، وتبينت استحالة تنفيذ الرغبة المطلوبة بالكامل بما يوفق بين المصلحة الأمنية وشفاء الصدور من خلال الإهانة، فإن ما أقدم عليه من خلال الأمر التنفيذي لا يفي الشق الأمني على الإطلاق، بل وبإجماع الخبراء المعنيين، يعقّد الترتيبات القائمة ويضرّ بالمصلحة الوطنية، ولكنه يقدّم لترامب، وللأوساط المشحونة والمتعطشة لبعض الانتقام، قدراً وافياً من الإهانة التي تشفي الغليل.
فمنع بعض الأُسر من عدد من الدول، إذ أمضت شهوراً وأعواماً طويلة في سعيها لاستيفاء شروط الدخول، من القدوم إلى الولايات المتحدة، لا يزيد أمن أي مواطن أميركي أي مقدار، ولكنه يجد الترحيب في أوساط عدة البعض منها صادق إلا أنه أسير الخوف وعدم الاطلاع، والبعض منها غير عابئ إلا بالتشفي. وترامب، كما يبدو جلياً، ينتمي إلى هذا الجمع الأخير.
وما ينطبق على التعامل مع المسلمين هو كذلك الحال مع المكسيكيين. هل كان بوسعه السعي إلى تعزيز الأمن على الحدود مع المكسيك من دون الكلام الاستفزازي حول طبيعة المكسيكيين وإجرامهم وإدمانهم، ومقدار الارتفاع المطلوب للحائط، والذي يزداد كلما طاب لترامب التصعيد الكلامي، بلوغاً إلى قمة الإهانة بالزعم أن المكسيكيين هم من سوف يدفع ثمن هذا الحائط الذي يمنعهم من الدخول؟ طبعاً، كان ذلك ممكناً، وإلى حد ما مبرراً، مع ضرورة الإشارة إلى دور الولايات المتحدة في تأزيم العلاقة الميدانية على الحدود بين الجارين. لكن الرصانة في الطرح لا تنسجم مع التعطش إلى الإهانة والذي يبديه ترامب.
أما اليوم، وقد أصبح ترامب الرئيس، فإن أسلوب الإهانة يعمّم المستوى الشخصي ليشمل كافة العاملين في فريق الرجل. فكما أنه يستهزئ بالتأثر الذي بدا على العضو في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إذ وقف مع المعترضين على قرار الحظر، فوصف دموعه بالكاذبة وتساءل من الذي درّبه على إطلاقها، فعلى العاملين أن يصفوا هذا بالخائن وذاك بالضعيف، وغيرهما من الألقاب.
مهما كان الموضوع، فإن حديث ترامب المتكرر هو عظمته هو شخصياً وسفالة من يعارضه. وهذا الأسلوب ليس وحسب ابتعاداً عن الصواب السياسي الذي يُتهم بالإفراط في المراعاة، ولا تخلياً عن اللياقة المرتقبة من السياسيين وغيرهم، بل هو عودة قسرية إلى الغرائزية المتوحشة. هو رئيس الإهانة بالتأكيد، ولكنه، طالما أن عدداً غير قليل من مؤيديه لا يجد حرجاً في سلوكه، لا يبدو حتى اليوم ذلك الرئيس الإهانة عند أميركيين لم يكتفوا من شذوذ أفعاله.
الحياة
تركيا وترامب وروسيا والمنطقة الآمنة في سوريا/ محمد زاهد غول
كانت الحكومة التركية من اوائل من دعا لإقامة مناطق آمنة داخل سوريا للهاربين من القتل والجرائم، التي يقوم بها نظام الأسد، وبالأخص بعد أن أخذت أفواج اللاجئين السوريين تتدفق نحو تركيا بعشرات الآلاف يومياً، فتركيا طرحت فكرة المناطق الآمنة منذ عام 2012 حتى تكون هذه المناطق ملاذات آمنة للشعب السوري، وحتى لا يضطر للخروج من بلاده.
وقد حاولت بعض الدول الأوروبية تفهم الأمر، ولكن إدارة أوباما في أمريكا رفضت هذه الفكرة، بحجة كلفتها المالية، وتعذر ضمانها عسكرياً، بينما كانت خطتها ترك الأزمة السورية تتوسع داخليا وخارجياً، بهدف إضعاف المنطقة كلها أمنيا وعسكرياً، بالتوافق مع الرؤية الإيرانية التي كانت لا تزال تفاوض جون كيري حول ملفها النووي، حتى قيل إن إيران تنازلت عن مشروعها النووي مقابل توسيع نفوذها السياسي والعسكري والأمني والاجتماعي والديمغرافي في سوريا والعراق ولبنان واليمن، والمنطقة العربية بما فيها دول الخليج العربي لاحقاً، بينما جاءت إدارة ترامب بخطة وأفكار جديدتين في المنطقة والعالم، في مقدمتها إقامة منطقة آمنة في سوريا لحماية المدنيين، وعدم تركهم يهاجرون إلى أوروبا ولا إلى دول الجوار.
هذا الخطوة الأمريكية بإقامة منطقة آمنة في سوريا، وما يتبعها من إقامة ملاذات آمنة للسوريين على أراضيهم وحمايتهم من العدوان، سواء بالقصف الجوي او البري، وهذا يتطلب منطقة حظر طيران فوق هذه المناطق، سواء كانت في شمال سوريا على الحدود التركية، أو في المناطق الجنوبية على الحدود الأردنية، او المناطق الغربية على الحدود اللبنانية، ما يعني أن سوريا كاملة سوف تصبح تحت هيمنة الطيران الأمريكي والدولي، الذي سوف يحظر الطيران فوقها، وعلى الأخص الطيران الحربي، سواء كان لجيش بشار الأسد أو الجيش الروسي. والجيش الروسي كان يظن أنه أصبح صاحب الكلمة الأولى والعليا في سوريا، لذلك كان طبيعيا أن يأتي الموقف الروسي معبرا عن عدم رضاه، وهو لا يجرؤ على رفضها، لذلك عبّر عن استغربه من أن أمريكا لم تشاوره بالأمر، وكأن بوتين كان ينتظر ان يستأذنه الرئيس الأمريكي ترامب لإقامة هذه المنطقة، أو المناطق الآمنة في سوريا، بل ذهب البيان الروسي إلى تحذير أمريكا من عواقب هذه المناطق الامنة، إن شرعت امريكا لإقامة هذه المناطق دون موافقة روسية.
لا شك أن القرار الأمريكي لإقامة مناطق آمنة في سوريا يمثل صدمة للقيادة الروسية، خاصة أنه جاء دون إخبار روسيا بذلك، فقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: «إن الحكومة الأمريكية لم تشاور روسيا قبل أن تعلن نيتها إقامة مناطق آمنة في سوريا»، وقال: «إن على واشنطن أن تفكر في العواقب المحتملة لتنفيذ هذه الخطة، وإن من المهم ألا تفاقم أوضاع النازحين». هذا الموقف الأمريكي يعني أن أمريكا سوف تغير من طريقة تعاملها مع الأزمة السورية اولاً، وربما يشمل ذلك كل سياستها في المنطقة أيضاً، أي أن القرار الأمريكي يشير إلى مرحلة أمريكية جديدة في سوريا، من أهم معالمها أنها لن تعير الأطراف المشاركة في الأزمة من الدول الخارجية أي قيمة، كما كانت تفعل إدارة أوباما من قبل، وقد يكون من ضمنها السعي الجدي لقطع علاقات أمريكا مع التنظيمات الارهابية في المنطقة، وهو ما تأمله تركيا وتطالب به، لذا كان من الطبيعي أن تؤيد تركيا الخطوة الأمريكية، فقال المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو: «إن بلاده تؤيد منذ فترة إقامة مناطق آمنة في سوريا لحماية النازحين»، وحيث أن الرئيس ترامب طلب تقديم دراسة عن الخطوات التنفيذية في هذا الاتجاه من وزارتي الدفاع والخارجية، أضاف أوغلو: «إن المهم هو نتائج هذه الدراسة، وما نوع التوصية التي ستخرج بها»، علما بأن هناك دراسات أمريكية عديدة منذ عهد اوباما، ولكن القرار لم يتخذ في ذلك الوقت، وهو ما يفتح الأسئلة المشككة عن اهداف ترامب الحقيقية من المناطق الآمنة؟
من المهم التأكيد والتأييد للفكرة نفسها، وعلى الأخص إذا كانت تعني تقديم العون والحماية للسوريين داخل بلادهم، بحكم ما قاله ترامب نفسه: «سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة للمدنيين في سوريا، وأعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيما باستقبالها ملايين اللاجئين والسماح بدخولهم إلى ألمانيا وغيرها من الدول، ما جرى هناك كان كارثة، ولا أريد حدوث ذلك هنا»، فالفكرة وجود تصور عن أخطاء ارتكبت في الفترة السابقة إيجابي، وإصلاح الأخطاء إيجابي أيضاً، وأن ترامب ملتزم بوعوده في حملته الانتخابية، حيث وعد خلال عرض ملامح سياسته الخارجية بإقامة مناطق آمنة في سوريا، وقال: «إن دول الخليج هي التي ستمولها».
لقد جاء في مسودة الأمر التنفيذي «توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون تسعين يوما من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا، وفي المنطقة المحيطة يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث»، وهذا يعني أن القرار الأمريكي سوف يتعاون مع الدول المجاورة لسوريا أولاً، والدول التي فيها مواطنون سوريون بأعداد كبيرة ثانياً، وفي مقدمة هذه الدول تركيا، وحيث أن تركيا بعد أن فقدت الأمل في مشاركة أمريكا في إقامة منطقة آمنة سابقاً، عمدت إلى إقامتها بنفسها وبموافقة روسية أيضاً، بحكم تواجد روسيا العسكري في سوريا، فإن من اهم اهداف عملية درع الفرات كان إقامة منطقة آمنة شمال سوريا بمساحة خمسة آلاف كم2، تمكنت تركيا حتى الآن من إقامة هذه المنطقة على مساحة الفي كم2، وإن من يقف دون توسع هذه المنطقة هي إيران وميليشياتها، التي تعرف أن مبدأ المناطق الآمنة سوف يحبط مشروعها، ولعل توقف أو تأخير توسيع المنطقة الآمنة بعملية درع الفرات عند مدينة الباب، التي ابتدأت باستهداف ثلاثة جنود اتراك قبل شهرين، أصبحت واضحة المعالم، فمن يعطل ويمنع إقامة المنطقة الآمنة هي إيران وميليشياتها، وكانت روسيا قد وافقتها على ذلك في البداية، ولكن مصالح روسيا مع تركيا غيرت المعادلة مع إيران، وكذلك عدم حاجة إدارة ترامب لالتزامات امريكا السابقة مع إيران في قضية الملف النووي سوف يغير التفاهمات الإيرانية الأمريكية في سوريا، وهذا يجعل أمريكا في حل من التزاماتها مع إيران أولاً، ويجعل الموقف الأمريكي الجديد متناغم مع الموقف التركي من دون تعارض مع الموقف التركي الروسي أيضاً.
كاتب تركي
القدس العربي
في وجه قرار ترامب… هل يرى الحكّام العرب أن العجزَ فخرٌ؟/ جلبير الأشقر
أصدر الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب قراره التنفيذي المشؤوم بشأن حظر دخول الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي (27 كانون الثاني/ يناير). وهو قرار فسّره العالم أجمع بأنه معادٍ للمسلمين، إذ أنه لم يكتفِ بتعميم حظر الدخول على كل من انتمى إلى البلدان السبعة التي شملها (اليمن والعراق وسوريا والسودان وليبيا والصومال وإيران) والتوقّف عن قبول اللاجئين، بل دعا إلى إعطاء الأولوية في منح اللجوء في المستقبل للأقليات الدينية التي تتعرّض لاضطهاد ديني بما يُقصد منه بكل وضوح استبعاد المنتمين إلى الأغلبية المسلمة في البلدان المقصودة. وقد أدانت منظمات مسيحية هذا التمييز بوصفه منافيا لمعتقداتها التي تنبذ التمييز بين البشر ضحايا الاضطهاد. لا بل أدانت منظمات يهودية القرار نفسه، وهي تذكّر بمحنة طالبي اللجوء الأوروبيين اليهود في زمن صعود النازية وكيف عانوا من سدّ الأبواب في وجوههم (وهو أمر استغلّته الحركة الصهيونية في حينه كي تجتذب عدداً هاماً منهم إلى فلسطين بينما كانت غالبية هؤلاء تفضّل الهجرة إلى أمريكا الشمالية).
وقد هبّت عاصفة شعبية عارمة ضد قرار ترامب في الولايات المتحدة ذاتها، ناهيكم بقيام العديد من المسؤولين الأمريكيين والشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية بالتنديد به. كما لقي القرار إدانة صريحة من قِبَل عدّة حكومات غربية، أبرزها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وكذلك من مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وفي بريطانيا انهالت الانتقادات على رئيسة الوزراء تيريزا ماي لرفضها إدانة القرار المشؤوم أثناء زيارتها لتركيا التي تلت مباشرة زيارتها لترامب في الولايات المتحدة. وكان رفض ماي انتقاد ترامب منسجماً تماماً مع سكوتها عن تعدّيات الحكم التركي على حقوق مواطنيه، حيث كان الهدف الرئيسي من زيارتها لأنقرة عقد صفقة أسلحة مع الدولة التركية مثلما كان الهدف الرئيسي من زيارتها لواشنطن الحصول من الرئيس الأمريكي الجديد على وعد باتفاق تجاري يتيح للحكومة البريطانية الادّعاء بأنها تستطيع التعويض عن الخسارة الجسيمة التي تنتظرها عند إتمام انفصالها عن الاتحاد الأوروبي. هذا وقد اضطرّت رئيسة الوزراء البريطانية أمام السخط العارم إلى إعلان «عدم موافقتها» على قرار ترامب بعد عودتها إلى لندن وبلسان الناطق الرسمي باسمها. وكان وزير خارجيتها بوريس جونسون نفسه قد أدان القرار الأمريكي إدانة صارمة.
وبعد، فلماذا نذكّر بهذه الأحداث التي لا بدّ لكل من يتابع الأخبار وأن يعرفها؟ لسبب بسيط وهو أمرٌ فاقع، وإن لم يكن مفاجئاً. فباستثناء قلّة من الدول المعنية بالحظر مباشرةً، لم نسمع صوت أي حكم عربي يرتفع إدانةً لقرار ترامب المشؤوم. فبينما جاء ردّ فعل في مستوى الحدث من قِبَل النوّاب العراقيين الذين دعوا إلى الردّ على ترامب بالمثل، وذلك بحظر دخول الأمريكيين إلى العراق، التزمت عواصم الدول العربية صمتاً مخزياً إزاء ذلك الإجراء الذي يقوم بشكل واضح على استغلال ديماغوجي لرهاب الإسلام والذي سوف تتبعه بالتأكيد إجراءات من النمط ذاته. وقد يكون أولَ هذه الإجراءات مشروعا لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة «إرهابية» الغاية منه أن يكون مدخلاً لحظر عدد من المنظمات والهيئات الإسلامية الناشطة داخل الولايات المتحدة.
وعلى هذه الخلفيّة، تمّ اتصالٌ هاتفي يوم الأحد الماضي (29 كانون الثاني/ يناير) بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد صدر عن وكالة رويترز في اليوم ذاته تقريرٌ عن المكالمة نقتبس بعض ما جاء فيه، وهو بغنى عن مزيد من التعليق:
(بداية الاقتباس) قال مصدر سعودي رفيع المستوى لرويترز إن… الاتصال استمرّ أكثر من ساعة وتناول كثيراً من التفاصيل المهمة المتعلقة بمستقبل العلاقات بين الدولتين والوضع في المنطقة. وقال المصدر إنه لا يعلم ما إذا كان قد تم التطرّق لموضوع الحظر المؤقت الذي أعلنه ترامب على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة…
وأفاد المصدر بأنه قد جرى خلال المكالمة «تبيان أن أسامة بن لادن تم تجنيده منذ مرحلة مبكّرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين كما أفاد بذلك زعيم تنظيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري في تسجيله المصوّر الشهير بعد وفاة بن لادن وأن بن لادن قام بتأجيل عمليات أحداث 11 أيلول/سبتمبر حتى يتمكّن من تجنيد خمسة عشر سعودياً من بين كل الجنسيات الأخرى وبشكل مقصود وممنهج لكي يقوموا بالعمليات الإرهابية في الولايات المتحدة».
وأضاف المصدر «ذلك كان بهدف ضرب العلاقات الاستراتيجية بشكل تام بين البلدين مما يوفّر لتنظيم القاعدة البيئة الخصبة في السعودية للتوسّع وتجنيد الشباب وإعطاء تنظيم القاعدة الشرعية التي يفتقدها في العالمين العربي والإسلامي» مشيراً إلى أن هذا الأمر معروف ومثبت لدى مخابرات البلدين ولن ينطلي أبداً على الدولتين الصديقتين… وقال المصدر لرويترز «إنه يتوقع أن تشهد فترة الرئيس ترامب علاقات تاريخية بين أمريكا والسعودية». (انتهى الاقتباس)
هذا ويقوم حالياً ملك الأردن بزيارة لواشنطن…
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان
القدس العربي
المسألة الأخلاقية في قرار ترامب/ محمد كريشان
هناك معضلة أخلاقية في المقام الأول في قرار الرئيس ترامب وقف دخول اللاجئين إلى بلاده مع مواطني سبع دول إسلامية. قلة من قادة العالم وسياسييه، ليس من بينهم العرب للأسف، من التقط هذه المسألة ووضعها في صدارة انتقاداته العلنية للقرار.
من أبرز هؤلاء ثلاثة ترفع لهم القبعات احتراما: المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الكندي ووزيرة العدل الأمريكية بالوكالة.
أنغيلا ميركل قالت إن «مكافحة الإرهاب الضرورية والحازمة لا تبرر إطلاقا تعميم التشكيك بالأشخاص من ديانة معينة، وتحديدا هنا الإسلام»، فيما أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلتزام بلاده باستقبال «الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب بغض النظر عن عقيدتهم»، أما أمريكيا، فقد أبدعت بشكل خاص سالي ييتس وزيرة العدل بالوكالة التي أقالها ترامب لإصدارها تعميما تطلب فيه من المدعي العام عدم تطبيق قرار الرئيس.
لقد قدمت هذه المسؤولة الاعتبار الأخلاقي عما سواه وذلك حين قالت إن مسؤوليتها «لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع»، خالصة إلى أن «وزارة العدل لن تقدم حججا للدفاع عن الأمر التنفيذي (للرئيس ترامب) إلا إذا اقتنعت بانه من المناسب فعل ذلك». الجانب الأخلاقي هو ما حرك كذلك عددا من كبار نجوم المجتمع الأمريكي من عالمي السينما مثل الممثل دينزل واشنطن، أو التكنولوجيا مثل مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ وغيرهما ليس بالقليل في مجالات عديدة، لا سيما في الصحافة التي اتسمت بشراسة واضحة ضد ترامب.
وطالما نتحدث عن الجانب الأخلاقي في المسألة كلها، ففي خضم تخمة التعليقات والتصريحات التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره، هناك ما يمكن التوقف عنده فعلا.. من ذلك مثلا أن نورم أيسن محامي أخلاقيات المهنة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما صرح بأن «سبب منع ترامب دخول المواطنين من الدول السبع تعود لكون شركاته لا تملك مصالح فيها». وأوضح في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» أنه «ليس هناك من شكّ أن حظر ترامب موجّه ضدّ دين معين»، مضيفا أنّ «هذا القرار يتعارض مع الدستور الأمريكي، ليس فقط لأنه لا يُسمح لك في الولايات المتحدة بالتمييز على أساس الدين والبلد الذي أتيت منه، ولكن لأن الدستور يمنع ترامب من أخذ الأموال من دول أجنبية قد استثناها في هذه القائمة». وخلص المستشار السابق للبيت الأبيض إلى أنّ «القضاء الأمريكي سوف يتصدى لهذا القرار غير الشرعي وغير الأخلاقي».
ومثلما حضرت الأخلاق هنا بقوة، غابت بقوة كذلك عند آخرين للأسف، وبعضهم بين ظهرانينا إلى درجة لافتة دفعت حتى محرر الشؤون العربية بالقناة العاشرة الإسرائيلية تسفي يحزكيلي إلى القول «سمِعنا أصواتاً من مصر تطلب الجمهور بتفهم مواقف ترامب وأن الحديث يدور عن حقه في حماية بلاده من الإرهابيين المحتملين، في استمرار للتوجه العام في مصر ألا وهو اللهفة من انتخاب ترامب وتصويره على أنه المعادي للإخوان المسلمين». أحد هذه الأصوات المصرية مقيمة في الولايات المتحدة نفسها ولم تدخر حتى مصر، فهذا مجدي خليل مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات في واشنطن، الأمريكي من أصل مصري، يقول للبي بي سي إنه «ما يحسب للرئيس ترامب هو أنه بدأ خطوة واحدة في هذا الاتجاه، وقد تترتب عليها آثار سلبية أيضا، لكنه إن كان جادا، فعليه أن يبني على هذه الخطوة، ذلك أنه من غير المعقول أن يشمل العراقيين ولا يشمل السعوديين أو الباكستانيين، وكلنا يعلم أن باكستان هي واحدة من أكثر الدول تطرفا، والشيء نفسه ينطبق على مصر التي صّدرت ثلث إرهابيي العالم والعقول المدبرة للإرهاب». أما تغريدات ضاحي خلفان تميم، المسؤول الأمني الإماراتي، على «تويتر» فقد جمعت بين تأييد قرار ترامب واحتقار جنسيات الدول المشمولة ذلك أن «تدفق الجاليات المتخلفة إلى بلد يجعلها متخلفة ولو كانت أمريكا» وأن «والله كفو (شكرا) على أمريكا أنها كانت مفتوحة قبل لكل من هب ودب» !!.
في السياسة لا يمكن للأخلاق أن تختفي بالكامل، وفي قرار ترامب فشلت معظم الحكومات العربية، أو الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، في التقاط هذا الجانب على الأقل، وذلك عندما التزمت الصمت الثقيل، خوفا وحيرة، أو بإصدار مواقف خجولة باهتة، فيما انخرط آخرون في تبرير خطوة ترامب واختلاق الأعذار له، نكاية وشمـــــاتة، وكلاهما معيب. يمكن أن يقال الكثير في السياسة الأمريكية والغربية عموما ولكن من الإنصاف الاعتراف أن في معظم الأحداث الكبرى، ليس كلها طبعا، يتفوق سياسيوها ونخبتها أخلاقيا فيما يسقط كثيرون غيرهم، ونحن في مقدمتهم…
٭ كاتب وإعلامي تونسي
القدس العربي
الوجه الآخر للديمقراطية الأميركية/ علي أنوزلا
الديمقراطية مثل المعدن الأصيل، كلما تم حَكُّه لمع بريقه. هكذا تعلمنا تجارب الدول الديمقراطية. فهذه “الآلية”، على الرغم من هشاشتها، تبقى قادرةً، في كل مرة، على تصحيح أخطائها، وهذا من أكبر أسرارها واستمرارها، منذ اخترعها اليونان قبل أكثر من 2500 سنة. كان رئيس الوزراء البريطاني السابق، ونستون تشرشل، يقول إن الديمقراطية هي أسوأ نظام حكم اخترعه الإنسان، قبل أن يستطرد قوله: لكنه يبقى الأفضل حتى الآن.
اليوم، مع وصول رجل أعمال شعبوي، اسمه دونالد ترامب، إلى رئاسة أقوى قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، تكشف لنا الديمقراطية عن آلياتها المتناقضة، وعن واحد من أسرار قوتها. فبفضل النظام الديمقراطي، استطاع رجل أعمال كان مغمورا خارج مجال نشاط تجارته، وأمياً في السياسة لم يسبق له أن مارسها، أن يخوض واحدةً من أطول الحملات الانتخابية وأشرسها في العالم، ويفوز فيها باستحقاق بيِّنٍ على باقي منافسيه من محترفي السياسة. لكن، أيضا بفضل وجود نظام ديمقراطي في الولايات المتحدة الأميركية، سُمح للمواطن الأميركي الرافض هذا “الوافد الجديد” أن يتظاهر أمام البيت الأبيض، رمز مركز السلطة السياسية في أميركا.
ومنذ وصول ترامب إلى السلطة، والديمقراطية الأميركية تفاجئنا، كل يوم، بقدرتها على أن تتحرّك لإصلاح نفسها بنفسها من الداخل. وهاكم الدليل على هذا التحرّك.
في اليوم الموالي لتنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وبعد حفل رسمي باذخ في شوارع واشنطن، سمح في اليوم الموالي لمئات آلاف المتظاهرين بالنزول إلى شوارع أميركا للتظاهر ضد الرئيس الجديد. وعلى منصات التجمعات الجماهيرية، وقف عشرات الخطباء يكيلون النقد للرئيس المنتخب، ويندّدون بسياساته ويطالبون بالثورة والاحتجاج لإسقاطه. ومع ذلك، لم يعتقل أيٌّ من هؤلاء، ولم يُستنطق، أو يفصل من وظيفته، أو يُضايق في مهنته، أو يُحارَب في قوت عيشه.
وعندما بدأ الرئيس الجديد في التوقيع على “فرامانات” وعوده الانتخابية، بدأ الشعب الأميركي
“الديمقراطية هي الوحيدة القادرة على بعث الحياة في نفسها من جديد” بالتحرّك في شوارع مدنه معارضا ومدينا ومنتقدا ومندّدا بقرارات رئيسه، فقد خرجت عشرات المظاهرات ضد قرار بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وعمّت مدن أميركا وعواصم في العالم مظاهرات نسائية ضخمة غير مسبوقة، للاحتجاج على نظرة الرئيس الأميركي الجديد المحتقرة للنساء.
وجديد قرارات الرئيس الأميركي التي تتفاعل ردود الفعل حولها، هو قراره الخاص بالحد من هجرة رعايا سبع دول عربية وإسلامية إلى أميركا. كان مظهر آلاف المواطنين الأميركيين، وهم يحتلون مطار جون كينيدي في نيويورك، معبّرا جدا عن الوجه الآخر للديمقراطية الأميركية التي تسمح لمواطنيها بالتظاهر والتعبير عن التضامن من أجل حق الآخر في ما يمنحه له الدستور الأميركي من حقوق، مثل المواطن الأميركي.
مظهر ثان للوجه الآخر للديمقراطية الأميركية جسدته سلطتان أخريان، لا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يستقيم بدون وجودهما مستقلتين، سلطة الإعلام وسلطة القضاء، فمنذ تنصيب الرئيس الجديد، وأكبر الانتقادات لسياساته تأتيه من وسائل إعلام بلاده التي فسحت المجال لكل رأي معارض ومستقل، للتعبير بحريةٍ عن وجهة نظره، بل وحتى انتقاداته سياسات سيد البيت الأبيض الجديد. أما القضاء الأميركي فعبّر عن استقلاليته، عندما أصدر ثلاثة قضاة أحكاما توقف تنفيذ قرار الرئيس حول الهجرة. أما رد الحكومة، باعتبارها جهازا تنفيذيا، ممثلةً في وزارة الأمن الداخلي، فكان هو الآخر معبّرا عن احترامٍ كبيرٍ لقواعد الديمقراطية، عندما قرّرت الانصياع لأحكام القضاء. وفي الوقت نفسه، الإبقاء على قانون الهجرة الذي فُرض بقرار رئاسي ساري المفعول، حتى يتم تغييره أو إلغاؤه أو إسقاطه. هذه هي قواعد اللعبة. وعلى الطرف الآخر من منصة القضاء، حيث يوجد الادعاء العام، لم يتأخر الرد عندما وقّع، حتى كتابة هذه السطور، 16 مدعيا عاما على بيانٍ يدينون فيه الأمر التنفيذي لرئيس الدولة. وكتبوا، في بيانهم، بوضوح تام “الحرية الدينية كانت وستبقى دائما مبدأ أساسيا لبلادنا، ولا يمكن لأي رئيسٍ تغيير هذه الحقيقة”، وتعهدوا بالعمل من أجل ضمان احترام الرئيس وحكومته مبادئ الدستور الأميركي، فالادعاء العام في الأنظمة الديمقراطية هو محامي الشعب وضمير القانون ودفاع المصلحة العامة أولا وأخيرا.
إحدى أهم إيجابيات وصول رئيس شعبوي إلى رئاسة الدولة التي توصف بأنها زعيمة العالم
” عبّر القضاء الأميركي عن استقلاليته، عندما أصدر ثلاثة قضاة أحكاما توقف تنفيذ قرار الرئيس حول الهجرة” الحر، هو هذا الزخم الذي أعطاه للنظام الديمقراطي المترهّل، فهو ذكّر العالم بهشاشة النظام الديمقراطي، وحرّك الناس للنزول إلى الشوارع، للدفاع عن قيمه ومبادئه، وجعل هذا النظام ذاته يتحرّك من الداخل، لتصحيح نفسه بنفسه، عبر آلياته الذاتية المتمثلة في السلطات المستقلة التي يقوم عليها.
ما تُعلمنا إياه يوميا تجربة حكم ترامب التي بالكاد بدأت أنه لا شيء مكتسبا إلى ما لا نهاية. فأحيانا لا يدرك المرء قيمة الشيء الذي يوجد بين يديه، إلا عندما يضيع منه أو يكاد. فالديمقراطية، كاختراع قديم، واحدةٌ من الاختراعات الكثيرة التي اخترعها الإنسان، وظلت تعيش معه حتى يومنا هذا، لا يُستطاع أن يُستغنى عنها، مثلها مثل النار والكتابة والعجلة ودورة المياه.. بل إنها أهم من كل هذه الاختراعات، لأنها التي تعطي لكل واحدٍ منا الحق في الاستفادة من باقي الاختراعات على قدم المساواة، وهي الوحيدة القادرة على بعث الحياة في نفسها من جديد، كلما أصابها الترهّل ووهن العظم منها.
العربي الجديد
دونالد ترامب… جاذبية القومية وأوهامها/ عصام الخفاجي
العمود الفقري الذي ينتظم رؤية دونالد ترامب لأميركا ومشاكلها ودورها في العالم يقوم على أن «أمّتنا ضحية استغلال دول أخرى تنتج بضائع بأسعار أرخص وتغرق أسواقنا مدمّرة بالتالي صناعتنا الوطنية. عمّالنا يعانون من البطالة والفقر لأن غيرنا يغتني على حسابنا. أميركا تنفق بلايين الدولارات للدفاع عن بلدان أخرى من دون أن تقبض ثمناً في المقابل».
في السابق كان من المسلّم به أميركياً أن الدعم العسكري لبلدان أو مناطق بعيدة ضروري لتأمين مصالح أميركا و «العالم الحر»، لأن تهديد مصادر الطاقة أو الأنظمة الرأسمالية هو تهديد لرأس المال الأميركي والعالمي. كانت جمهرة غفيرة من شعوب العالم، بما فيه المتقدم، تطالب بإزالة القواعد العسكرية الأميركية عن أراضيها فترد أميركا بتنظيم انقلابات عسكرية ضد النظم المؤيدة لمطالب كهذه وتنفق مئات الملايين في أوروبا المستعصية على الانقلابات العسكرية لدعم الأحزاب اليمينية.
مذهل أن يشتكي من المنافسة زعيم العالم الرأسمالي والدولة التي تفتخر بكونها النموذج الأكثر صفاءً للنهوض الاقتصادي ولتحقيق الرفاه اعتماداً على قوانين السوق والحرية الاقتصادية وحريّة انتقال رأس المال بحثاً عن تعظيم الأرباح. مذهل أن أميركا مالكة أكبر نسبة من أسهم صندوق النقد الدولي والمتحكمة فيه فعلياً لا توافق على منح قرض لبلد إن لم ينفتح على حرية انتقال رأس المال، لكنّها تقرر معاقبة رأسمالييها إن اتّبعوا قوانين السوق وقرروا الاستثمار في المكسيك أو الهند أو غيرها. مذهل أن يصوّت الأميركان لمصلحة رئيس ينقض ما تربّوا عليه من أن الحرية السياسية والديموقراطية لا تتحقّقان إلا بتحقّق الحرية الاقتصادية المترادفة، وفق هذا الفهم، مع حرية انتقال رأس المال والعمل. مذهل أن البلد الذي يفتخر بكونه أمّة من المهاجرين يصوّت لمصلحة بناء سور مع جاره لمنع الهجرة إليه، بل يطالب الضحية بدفع تكاليف بنائه.
ما يستدعي التأمّل هو أن هذا النزوع إلى الانغلاق القومي ليس سائداً في أوساط الترامبيين فقط. ترامب كان الأشطر في التلاعب بمزاج شائع سعى كل المرشّحين الجديين للرئاسة إلى دغدغته عارفين أن طريقهم إلى البيت الأبيض لن تقرّره الدراسات بل المزايدة في رفع الرايات القومية. لم يمتلك أي من هؤلاء الجرأة لدحض الشعار/ السعار المضلل: «ثراؤهم سبب فقرنا وفقرنا سبب ثرائهم». هذا الشعار/ السعار مضلّل لأنه نجح في تبرئة النظام الرأسمالي الأميركي من مسؤوليته عن إيصال حال محدودي الدخل الأميركان إلى ما وصل إليه، ملقياً اللوم على بلدان أخرى أغوت بضعة رأسماليين صناعيين أميركان بنقل نشاطاتهم إليها.
انتقال رأس المال الصناعي والخدمي إلى مختلف بلدان العالم ذات اليد العاملة الرخيصة و/ أو التي تقدم إغراءات ضريبية هو أحد معالم العولمة التي لا يمكن تخيّل النظام الرأسمالي المعاصر من دونها. هو معلم لا يقتصر على رأس المال الأميركي بل يشمل الأوروبي والصيني وحتى رؤوس أموال مصدرها بلدان أقل تقدّماً. هذه العولمة التي بات الأميركان يرونها شرّاً لا بد من محاربته، حققت للبشرية، لا لرأس المال فقط، ما لم يحققه أي تطور آخر في التاريخ البشري. فخلال أقل من عشرين سنة انخفضت نسبة من يعيشون في حالة فقر مدقع من 35 في المئة أي أكثر من ثلث سكان الأرض عام 1993 إلى 14 في المئة عام 2011.
لكن الحصيلة كانت كارثية بالنسبة للأميركان والأوروبيين. فوفقاً لاستطلاع رأي أخير، يرى 95 في المئة من الأميركان أن الفقر يتزايد. لم يتزايد الفقر في أميركا ولا في أوروبا في واقع الحال. لكن الانطباع السائد عن ازدياد الفقر لم يأت من فراغ ولم يكن نتاجاً ضرورياً للعولمة، بل نتاج ترك المجتمعات تحت رحمة حركة السوق المنفلتة. وحين تدخّلت الدول لمجابهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالغرب بسبب مضاربات البنوك وشركات التأمين عام 2008، قامت بتعويض البنوك لمنع إفلاسها وحمّلت ذوي الدخول المحدودة عبء دفع تلك المكافأة. حركة الأور سارت سلحفاتية طوال العقود الأربعة الماضية فيما حققت دخول الفئات العليا قفزات لا سابق لها بحيث عادت فجوة الدخل بين الأكثر فقراً والأكثر غنى إلى ما كانت عليه أيام الكساد العالمي الكبير عام 1929. عام 1980، كان متوسط دخل من ينتمي إلى فئة الواحد في المئة من أغنى الأميركان يعادل 27 ضعف دخل من ينتمي إلى الخمسين في المئة الأقل دخلاً. أما الآن فإن دخل هؤلاء المحظوظين يعادل 81 ضعف ما يحصل عليه ابن النصف الأدنى منهم. في منتصف السبعينات كان متوسط الدخل السنوي لمن ينتمي إلى الواحد في المئة الأغنى 340 ألف دولار ارتفع الآن إلى مليون دولار، وفي المقابل ارتفع متوسط الدخل الحقيقي للنصف الأدنى من السكان خلال ثلاثة عقود من عشرين ألف دولار إلى خمسة وعشرين ألف فقط.
ليست حال التحوّل من سيادة قطاع اقتصادي إلى آخر فريدة في تاريخ الرأسمالية، بل هي ما جعل الرأسمالية نظاماً ثورياً يعجز عن البقاء من دون رفع مستمر للإنتاجية. ارتفعت إنتاجية العمل الزراعي في أوائل القرن العشرين فانخفض عدد العاملين في الزراعة من حوالى 40 في المئة من السكان إلى خمسة في المئة فقط في أميركا وبريطانيا ممن باتوا ينتجون كميات أكبر من المحاصيل. لكن الصناعة المتوسّعة كانت تستوعب من أزيحوا وتوفّر لهم مستويات معيشة أعلى. وهكذا كان الحال مع صعود الصناعة على حساب الحرف. اختلاف المشهد الراهن يكمن في أن قطاعات الاقتصاد الصاعدة في مجالات التكنولوجيا والمعلوماتية تتطلّب قوة عمل عالية الكفاءة. وكان ممكناً وضرورياً أن تتحمّل الدولة وأرباب العمل تكاليف عملية إعادة تأهيل من فقدوا وظائفهم بسبب تراجع القطاعات الصناعية. لكن السياسات النيوليبرالية التي أرساها رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر في الثمانينات ليست، ولم تكن، في هذا الوارد. فثمة سوق حرة تغرف منها القطاعات الصاعدة من دون عناء. محدودو الدخل ليسوا عاطلين من العمل، فالبطالة في أدنى مستوياتها منذ عقدين. لكنهم مضطرون إلى القبول بأي وظيفة مهما كان الأجر منخفضاً ومن دون ضمانات ضد التسريح الذي لا ترافقه تعويضات ضمان اجتماعي أو صحّي. وهذا هو مصدر القلق المستشري في أوساط الأميركان ذوي الدخل المحدود.
في غياب بدائل تحفظ كرامة العمال المسرّحين، لم يعد ممكناً الاحتفاء بتكامل عالمي ينقل الإنتاج والخدمات إلى حيث تكون الكلفة أقل، ويؤمن لغالبية سكانية في معظم البلدان المنخرطة في شبكة العولمة تحسين أوضاعها المادية. فالبديل يتمثّل في الاعتراف بأن النيوليبرالية باتت تقف عائقاً أمام التطور وهي، وليست العولمة، المسؤولة عن الاستقطابات الاجتماعية الخطيرة التي يشهدها الغرب. والمحزن أن سياسياً تقدّمياً مثل بيرني ساندرز تساوق مع المزاج السائد وساهم في إيهام ذوي الدخل المحدود بأن إغلاق السوق القومية هو ترياق أمراضهم. والخوف من الخارج هو الملازم الضروري للخوف من «الغرباء» في الداخل، أي المقيمين الأجانب الذين «يقبلون بأجور أقل ويستولون على وظائفنا». وهنا تكمن مفارقة عصرنا: الطبقة العاملة الصناعية التي كانت رمزاً للثورية باتت قوة رجعية لا ترى أن مستقبلها يمر عبر الإندماج في النشاطات الصاعدة، ولا ترى أن رأس المال هو ما يعيق اندماجها، بل تتآكلها نوستالجيا العودة إلى عالم انقضى وترتمي على مزابل اليمين المتطرف في أميركا وأوروبا التي تكرّس هذا الوهم في أذهانها.
* كاتب عراقي
الحياة
زمن مفاجآت ترامب وتحالفات بوتين/ راغدة درغام
سجّلت الأيام العشرة الأولى من عهد الرئيس دونالد ترامب تنفيذ وعوده الانتخابية، فعطّل العمل الحكومي المعتاد وخلق اختلالاً هزَّ واشنطن وعواصم العالم. أمسك الرئيس الجديد بقلمه السحري ووقَّع على أوامر مدهشة مستفيداً من صلاحياته التنفيذية ومتعمّداً استباق تسلم وزرائه حقائبهم وبدء عمل الإدارة الأميركية كفريق تقليدي. الجيد والمفيد هو أن دونالد ترامب حسم الجدل حول ما إذا كان سيتأقلم مع منصب الرئاسة، وأوضح أنه عازم على تفعيل كل ما تعهّد به أثناء حملته الانتخابية، وهكذا قطع الطريق على الافتراضات والاجتهادات حول مَن هو وماذا سيفعل. والمخيف الذي يدب الرعب في قلوب الكثيرين هو أن دونالد ترامب قد يأخذ الولايات المتحدة حقاً إلى الانفراط وقد يأخذ العالم إلى عاصفة تلو الأخرى، فينهار النظام العالمي من دون أن يكون تم إعداد البديل عنه. قد يقال إن المقاومة الدخلية لأوامر وإجراءات دونالد ترامب ستجبره على إعادة النظر والتراجع. إنما ترامب، من جهته، يراهن على الوهن الذي سيُتعِب ويُحبِط المعارضين له وهم يلهثون معارضين لإدهاش يلي إدهاشاً، فيخضعون للأمر الواقع. بالطبع، لقد ازداد الكلام بعد مرور عشرة أيام على حكم دونالد ترامب – عن حتمية إنزاله من السلطة عبر محاكمته «امبيتشمانت» لأن أميركا لن تسمح له أن يفككها أو أن يجرها إلى حرب أهلية أو أن يُفقرها أو أن يقلص نفوذها العالمي ويقدم مرتبة العظمة للصين وروسيا. الداعمون لدونالد ترامب يقهقهون ويتوعدون أولئك الذين يحلمون بإسقاطه من الرئاسة، بل إنهم واثقون أن ترامب سيجعل أميركاً فعلاً «عظيمة مجدداً» وأن واقعيته السياسية في علاقاته الدولية ستبني نظاماً عالمياً جديداً وتحالفات غير مسبوقة ستسفر عن ازدهار أميركي وعالمي. روسيا محورية في حسابات دونالد ترامب، الذي يقول المقربون منه: لن ينطلق بالعلاقات معها على أساس الحجج والمقاييس الأخلاقية، وإنما على أساس «ما يستلزمه إبرام الصفقة». فهذا «رجل الصفقات» حتى وهو رئيس الولايات المتحدة. ووفق الذين يعرفونه جيداً، سيضع دونالد ترامب «الواقعية» فوق «الأخلاقية» وهو يبني التحالفات الضرورية، ويغيّر السياسات كتلك التي نحو إيران وسورية، ويفصِّل العالم إلى حليف يسند الولايات المتحدة وتسنده وآخر خارج معادلة «سند الظهر» يدفع ثمن مواقفه.
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، استهلت مهماتها بإبراز العزم على «إظهار قوة» الولايات المتحدة وتوعدت كل من «لا يساندنا» بعواقب تناسب أفعالهم. تحدثت عن أن «هدفنا أن نساند حلفاءنا، ولكن أن نتأكد أن حلفاءنا يساندوننا أيضاً»، وقالت: إن الإدارة الجديدة ستركز أكثر على العلاقات الثنائية على حساب العلاقات المتعددة الأطراف. أثارت نيكي هايلي الاستغراب عندما قالت: «الذين لا يساندوننا، سنسجل أسماءهم وسنحرص على الرد عليهم بما هو مناسب، وهذا الوقت هو للقوة وللعمل ولإنجاز الأعمال». فهذه لغة بعيدة من الديبلوماسية تنطوي على التهديد. إنما السؤال هو، من هم حلفاء الولايات المتحدة في زمن دونالد ترامب، لا سيما أنه اتخذ إجراءات تخص الجدار مع المكسيك فعاداها، وأصدر أوامر تمنع السفر من 7 دول ذات غالبية إسلامية وأخرى تقفل الباب في وجه اللاجئين، فأثار انتقادات جاره الآخر، كندا، وكذلك حلفاء الولايات المتحدة عبر الأطلسي بما فيها بريطانيا المهرولة إلى صداقة مميزة مع الإدارة الجديدة.
مصدر مقرب من تفكير أقطاب رئيسيين في الحلقة الضيقة للرئيس دونالد ترامب قال: «إننا عازمون على مساعدة من يساعدنا حقاً ويثبت جدواه. في الشرق الأوسط، هذا يضم السعودية ومصر والأردن والإمارات». وتابع: «في الوقت ذاته، سنقوم بإدانة من نصنفهم في مرتبة المنبوذ مثل إيران وسورية». باختصار، تابع المصدر: «المعادلة واضحة: كن حليفاً صادقاً، ونحن جاهزون للمساعدة في المقابل».
كان لافتاً ما قاله المصدر حول الرغبة بأن «تساعدنا السعودية في ضبط إيران»، من دون ان يتوسع. إدارة ترامب تريد أيضاً من السعودية المشاركة الفعلية المكثفة لمنع تمويل الإرهاب ليس بالضرورة علناً طالما تفعل ذلك بإجراءات حازمة سراً. خلاصة الأمر أن السعودية ستكون أكثر قرباً وتقارباً مع الولايات المتحدة، وفق المصدر الرفيع.
مع إيران، ما تنوي إدارة ترامب أن تفعله هو التنفيذ الصارم للاتفاق النووي، وليس تمزيقه. تريد تكثيف المراقبة الدقيقة لكل شاردة وواردة، فإذا قامت إيران بانتهاك الاتفاق، سيسقط الاتفاق وسنقفز إلى المحاسبة، قال المصدر مؤكداً العزم على إجراءات.
كيف ستعدّل إدارة ترامب المواقف الأميركية إزاء توسّع إيران في الدول العربية، بالذات في العراق وسورية واليمن ولبنان؟ ليس واضحاً تماماً بعد أن كانت إدارة ترامب ستتبنى مباركة إدارة أوباما للتوغل الإيراني في سورية والعراق باسم مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري ضد «داعش» وأمثاله. هناك تلميحات بأن التغيير قد يأتي عبر البوابة اليمنية، إنما ليست هناك سياسات متكاملة بعد توضح إن كانت العلاقة الأميركية– السعودية الوثيقة المنتظرة ستنعكس في ملف اليمن بالدرجة الأولى، وكيف. واضح أنها لن تنعكس في سورية.
روسيا هي اللاعب الأهم في سورية وإدارة ترامب جاهزة لعقد الصفقة معها على أساس «الأخذ والعطاء» طبقاً لفن الصفقات والعمليات التجارية وليس استناداً إلى الحجة الأخلاقية كما فعلت إدارة أوباما. ويشير المصدر إلى أن سياسة الرئيس السابق باراك اوباما القاضية بضرورة رحيل بشار الأسد كانت «سياسة بالاسم فقط»، ولم «تدخل أبداً حيز التنفيذ». ويتابع: «بشار الأسد ما زال موجوداً. هذا واقع. وبناءً عليه، ستكون السياسة الجديدة مبنية على الإقرار باستمرار وجوده إنما مع تصنيفه منبوذاً، والعمل على عزله».
بكلام آخر، ووفق التفكير في إدارة ترامب «لقد تبنى أوباما سياسة تعارضت مع الواقع. أما ترامب فإنه ينظر في تغيير السياسة المعلنة لتتطابق مع الواقع». بوضوح أكثر، ستتخلى إدارة ترامب عن سياسة تغيير النظام في سورية وستتبنى بدلاً منها سياسة «عزل الأسد»، وفق المصدر، أي أن «التغيير سيكون فقط في السياسة المعلنة بحيث نعترف بما هو واقع»، إنما مع استمرار «إجراءات العزل وتكثيفها لأن هذا الرجل ارتكب جرائم حرب ضد شعبه وسيبقى منبوذاً».
الرهان هو على التوصل إلى صفقة تؤدي إلى «انسحابه إلى منفى» أو إلى التحاق روسيا بمساعي عزل الأسد، إذا تبين لها أن السياسة الأميركية لم تعد تريد «تغيير النظام»، وفق المصدر المطلع. إنما المفاوضات الأميركية– الروسية لم تبدأ بعد ومن المبكر التدقيق في عناصر الصفقة الكبرى التي قد يريد كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس دونالد ترامب إبرامها – فالأمر أكثر تعقيداً من مجرد ملف سورية أو حتى ملفي سورية وأوكرانيا معاً. إنها صفقة المصالح الكبرى ولن تكون بالضرورة سهلة أو قريبة. في هذه الأثناء، تستمر روسيا في إدارة ملف سورية سوية مع تركيا وإيران فيما يستمر التغيب العربي الملحوظ عن المسألة السورية تحت عذر معارضة اختطاف روسيا للملف السوري من مجلس الأمن ونقله إلى آستانة، عاصمة كازاخستان.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اعتبر مشاركة الأمم المتحدة في مؤتمر آستانة تأكيداً على تمسكها بمسار العملية السياسية، مشدداً على أن البحث الفعلي لهذه العملية سيتم في 20 الشهر الجاري في جنيف تحت رعاية مبعوثه ستيفان دي ميستورا. قال إن العملية الانتقالية للحكم في سورية التي أقرها بيان جنيف «ستكون من القضايا المركزية» التي ستبحث عندما يجمع دي ميستورا السلطة والمعارضة. دي ميستورا من جهته أنذر المعارضة بأنها في حال لم تتفق على تشكيل وفد موحد شامل التمثيل ومتوازن، فإنه سيتصرف ويقوم هو بتشكيل الوفد طبقاً للصلاحيات الواردة في قرار مجلس الأمن 2254. هذا التصريح أثار حفيظة أقطاب المعارضة السورية المبعثرة بين تخلي تركيا عنها لتكون شريك روسيا وإيران كـ «ضامن» لوقف النار والحل السياسي، وبين تخلي الدول الخليجية وفض يدها من المسألة السورية، وبين تلميح في سياسة الإدارة الأميركية الجديدة بالتضحية الصريحة بالمعارضة السورية الممثلة بالإئتلاف وبالجيش الحر مع تنمية قدرات «قوات سورية الديموقراطية» التي حصلت من إدارة ترامب هذا الأسبوع على مدرعات وتعزيز القدرات في حملة تحرير الرقة من عناصر «داعش».
المشاريع ما زالت متضاربة في سورية، بالذات المشروع الروسي والمشروع التركي والمشروع الإيراني، علماً أن أي مشروع خليجي بات اليوم في خبر كان. ليس واضحاً ماذا جد بين روسيا وإيران في شأن التضارب الواضح في مشروعيهما، حيث أن روسيا تريد نظاماً قوياً في دمشق وتريد انسحاب كل القوات الأجنبية بما فيها تلك التابعة لإيران، بينما إيران تريد بقاء نفوذها داخل سورية بقوات غير نظامية على نسق «الحرس الثوري». هذه الأمور مؤجلة إلى «وقت لاحق» وفق ما قال غوتيريس، مشيراً إلى أن مسألة انسحاب القوات الأجنبية من سورية «تشمل كل القوات» من دون استثناء. الواقع على الأرض يفرض نفسه، وهناك تزاحم على فرض الأمر الواقع في سورية تهيئة للمفاوضات، على الصفقات.
فكل شيء وارد في زمن المفاجآت غير التقليدية التي وعد بها دونالد ترامب وفي زمن التحالفات غير الاعتيادية التي يتهيأ لها فلاديمير بوتين مع دونالد ترامب. والكل يتموضع بصورة أو بأخرى في رمال متحركة وسط أكثر من زلزال.
الحياة
نحن وترامب بين نتانياهو والهولوكوست/ حازم صاغية
يقول الفلسطينيّون والعرب والمسلمون، وهم مُحقّون تماماً، إنّ لا علاقة لهم بالهولوكوست لأنّ آخرين ارتكبوه. الصحيح، في المقابل، أنّ للهولوكوست علاقة بهم، لا من حيث دوره في قيام دولة إسرائيل فحسب، بل أيضاً لسبب آخر. فمن يتابع الاعتراض على ترامب في مجمل سياساته، ولكنْ خصوصاً في موضوع الهجرة والنزوح، يلاحظ كم أنّ ثقافة الهولوكوست حاضرة في السجال. فالخبرة المستمدّة من تلك الكارثة هي بين أبرز ما يتسلّح به المدافعون عن اللاجئين والمهاجرين المسلمين. وحين يقال اليوم «لن تحصل ثانيةً أبداً»، فالهولوكوست بالطبع هو المقصود بـ «الأولى» التي تجمع بين كونها محطّة كونيّة مرجعيّة في الماضي وكونها الحدث – الفادي في المستقبل.
ولأنّ الأمر هكذا، نرى صحيفة «هآرتز» الإسرائيليّة تعيب بأقسى التعابير على الصهر جاريد كوشنر، عمله في إدارة عمّه. فالأخيرة في سياستها حيال النزوح والهجرة إنّما تهين ذكرى جدّيه الناجيين من الهولوكوست. وفي المعنى هذا، يندّد بيان متحف الهولوكوست في الولايات المتّحدة بأوامر ترامب التنفيذيّة، مذكّراً بالعداء للساميّة وعدم استقبال اليهود الفارّين في الثلاثينات من الرعب النازيّ، متضامناً مع اللاجئين، لا سيّما منهم السوريّين. ولهذا نقرأ يوميّاً عن مبادرات لأفراد ومنظّمات بين يهود أميركا، بعضها أعمال احتجاج وتبرّعات وبعضها مواقف رمزيّة داعمة للمسلمين. ففي بلدة صغيرة من تكساس، مثلاً لا حصراً، سُلّم مفتاح معبد يهوديّ لمسلمين أُحرق مسجدهم، كي يكون لهم دائماً مكان يقيمون فيه الصلاة. ودائماً في مناسبات مؤلمة كهذه، يسترجع الباحثون والمؤرّخون صفحات من تاريخ «التكافل» اليهوديّ – المسلم في أوروبا، لا سيّما إسبانيا.
ذاك أنّه حين تهبّ رياح العنصريّة ومعاداة الغريب فإنّها لا تميّز بين ضحيّة وآخر. وترامب نفسه حين كرّم ذكرى الهولوكوست، ودان «الرعب الذي فرضه الإرهاب النازيّ على أناس أبرياء»، تجاهل ذكر اللاساميّة واليهود. ولئن عُرف بعض رموز إدارته الجديدة بمواقف لاساميّة، فقد كان ريتشارد سبنسر، زعيم «اليمين البديل»، هو الأوضح والأصرح في دعوته إلى «نزع اليَهْوَدَة عن الهولوكوست». وإلى جانب المسلمين الذين يتصدّرون اليوم، في المناخ الترامبيّ والشعبويّ الراهن، قائمة الاستهداف العنصريّ والكاره للغريب، يُلاحَظ في بلد كبريطانيا، أنّ عدد الاعتداءات على اليهود ارتفعت، في 2014، إلى 1182 اعتداء، ثمّ في 2016، إلى 1309 اعتداءات.
في مقابل الفعاليّة التي يولّدها الهولوكوست، هناك الفعّاليّة المضادّة التي يولّدها بنيامين نتانياهو. فالأخير نموذجيّ في استعداده للإفادة من ذاك التقليد اليمينيّ في الغرب المعروف بكره اليهود وحبّ إسرائيل في وقت واحد. ولئن غازله ترامب باعتبار جداره نموذجاً، فهو ردّ على التحيّة بأحسن منها عبر تغريدة كادت تتسبّب بأزمة مع المكسيك. وزعيم إسرائيل يشبه زعيم أميركا في التعويل على الجدران، إذ التناقضات لا تأتي إلا من الخارج، وفي خلط الشخصيّ والعائليّ بالسياسيّ والرسميّ (ونتانياهو يواجه اليوم فضيحة الهدايا الشهيرة)، وطبعاً في شنّ الحرب على الصحافة بالمعنى الذي يبرع فيه آخرون كبوتين وأردوغان. ونتانياهو لم يتباطأ في الاستفادة من رفيقه ترامب في انتظار أن تتضح حدود تحذير الثاني للأول في خصوص الاستيطان: ما إن استقرّ ترامب في البيت الأبيض حتّى شرّعت تلّ أبيب بناء 2500 بيت في الضفّة الغربيّة و566 في القدس الشرقيّة، ثمّ أتبعتها بإعلانها خططاً لبناء 3000 وحدة سكنيّة جديدة. وإذ قضت المحاكم بإخلاء مستوطنة عمونا، شرق رام الله، حوّلت السياسة هذا الإخلاء القانونيّ سبباً لتشريع مزيد من الاستيطان وقضم الأراضي.
الهولوكوست يهوديّ. نتانياهو يهوديّ. الفلسطينيّون والعرب والمسلمون مع الهولوكوست ضدّ نتانياهو. مع العالم ضدّ القوميّة.
الحياة
“أوقفوا” ترامب/ سميح صعب
يمعن الرئيس الاميركي دونالد ترامب في قلب وقائع تاريخية كي تتناسب مع رؤيته للعالم. فهو يتهم المكسيك باستغلال الولايات المتحدة اقتصادياً كل هذه السنين، وليس العكس ولذلك يريد أن يبني الجدار على نفقة الشعب المكسيكي. وربما اتهم ترامب المكسيك غداً باحتلال ولايات أميركية وليست أميركا هي التي احتلت وضمت مقاطعات مكسيكية.
ولا يخرج ترامب عن السياق عندما يتعلق الامر بالعراق، إذ أنه يطالب علناُ بسرقة نفط العراق كي تسترد أميركا التريليونات التي دفعتها كلفة للغزو الذي قام به جورج بوش الابن لهذا البلد عام 2003، في حين أن منطق العدالة يفترض أن الدولة التي قامت بالغزو من دون وجه حق وبناء على أكاذيب، هي التي يجب أن تدفع تعويضات للشعب العراقي عن الدمار الذي لحق به والذي انتهى بتعزيز التنظيمات الجهادية في العراق والمنطقة.
لكن لترامب مفهومه للسياسة والتاريخ. وهذا ما ينطبق على اعلانه البحث في انشاء مناطق آمنة في سوريا وكذلك على عدم اعتباره المستوطنات في الاراضي الفلسطينية عقبة في وجه السلام. ويعود ترامب الى التلويح بكل الخيارات بما فيها العسكرية ضد ايران، ويهدد كوريا الشمالية برد “ساحق”، ولا يستبعد ارسال جيشه الى المكسيك لمحاربة تجار المخدرات، وتعلو نبرته في وجه رئيس الوزراء الاوسترالي على الهاتف بسبب دفاع الاخير عن اللاجئين.
ونظرة ترامب الى ملفات أخرى ليست أفضل. فأوامره التنفيذية المتعلقة بمنع دخول اللاجئين وحظر دخول رعايا سبع دول ذات غالبيات مسلمة الى الولايات المتحدة، يهدد بتخريب علاقات واشنطن مع الحلفاء بقدر ما يساعد باجماع الخبراء على تعزيز نظرية التنظيمات الجهادية التي تقول بأن اميركا تشن حرباً على كل المسلمين ولا تستهدف تنظيمات بعينها. وتكرار ترامب ومساعديه يومياً أن الادارة الاميركية الجديدة ستنقل السفارة من تل ابيب الى القدس، لا يصب إلا في تأجيج الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، ولا يخدم إلا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أطلق العنان للاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية بما يقضي على أي أمل في التوصل الى حل الدولتين.
وأشد إثارة للغرابة هو إصرار ترامب على ان العالم يستغل أميركا وليس العكس. من المكسيك وكندا الى أوروبا والشرق الاوسط والصين وصولاً الى أوستراليا، كل هؤلاء استغلوا أميركا!
ربما صح على ترامب أيضاً هتاف “أوقفوه” الذي أطلقه متظاهرون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي احتجاجا على دعوة محرر في موقع “برايتبارت” الصحافي البريطاني ميلو يانوبولوس المؤيد لترامب، لإلقاء كلمة في حرم الجامعة.
نعم ان هناك حاجة الى ايقاف ترامب قبل أن يجر على العالم مزيداً من الخراب.
النهار
عالم ترامب/ حسام كنفاني
قبل تولي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مهامه الرسمية، كان الكل يتحسب للعهد الأميركي الجديد، ومدى انعكاساته على العالم، وسط نظريات وتحليلات كانت تؤشر إلى إمكان أن يزيد الرئيس القادم من خلفية اقتصادية بحتة من تقوقع الولايات المتحدة خلف حدودها، واعتكافها عن التدخل في الملفات العالمية. كذلك كانت التحذيرات تنطلق من احتمال انطلاق موجةٍ عنصريةٍ جديدةٍ، يقودها ترامب تجاه المسلمين تحديداً، ولا سيما أنه خصهم، من دون غيرهم، بأجزاء كثيرة من خطبه خلال الحملة الانتخابية التي أوصلته إلى البيت الأبيض.
كل هذه التحذيرات والتحليلات كانت قبل 14 يوماً فقط، أي قبل حفل التنصيب غير الحاشد الذي أقيم لترامب أمام الكونغرس في واشنطن في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي. لكن أحداً لم يكن ليتخيل أن هذا الرئيس الأميركي يمكن أن يقلب الأمور، في الداخل والخارج، رأساً على عقب في هذه الفترة الوجيزة جداً. فقد بدا ترامب متعجلاً جداً في رسم ملامح ولايته الرئاسية، وتأكيد أنه سيكون مختلفاً بشكل جذري عن سلفه، وربما عن كل الرؤساء الأميركيين السابقين منذ تأسيس الولايات المتحدة.
قرارات تنفيذية، صنفت بأنها فرمانات سلطانية، أعلنها ترامب، جعلت العالم في صدمةٍ وترقب لما هو آت، والذي يبدو أسوأ بكثير من الأيام الأولى لعهد الرئيس الأميركي. لم يكتف ترامب باستعداء طرف واحد في قراراته وتصريحاته وتصرفاته، بل يبدو ماضياً في اتجاه مواجهات متعدّدة الأطراف. ليس قرار حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلا البداية، خصوصاً أن ترامب لا يتوانى عن التصريح ضد “التشدّد الإسلامي” و”الإرهاب الإسلامي”، والذي لم يسبقه إليه أحد من المسؤولين الغربيين أو الأميركيين، إذ كان يُكتفى بالحديث عن “الإرهاب”، من دون ربطه بأي دين، وهو ما ناقضه ترامب تماماً، ومستمر فيه حتى يوم أمس، إذ غرّد حول حادثة اللوفر بأن: “مسلم إرهابي يهاجم…”.
تغريدات وقرارات تؤشّر إلى توجه أقسى في الأيام المقبلة، وهو ما بدأه فعلياً على الأرض في الإنزال الأميركي في اليمن، والذي قيل إنه ضد تنظيم القاعدة، قبل أن يتوجه نحو إيران بالتهديد والوعيد، محيلاً الأوضاع إلى ما قبل الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع الدول الغربية. فبعد عودة سياسة فرض العقوبات ضد إيران، استرجع الرئيس الأميركي خطاب التلويح بالخيار العسكري، والذي أكد أنه سيستخدمه في حال تابعت إيران “اللعب بالنار”، على حد وصفه. تبدو مرحلة المواجهة مع إيران أيضاً في بدايتها، والأيام المقبلة قد تشهد وتيرة متزايدة من التصعيد، خصوصاً بعدما ربط ترامب بين طهران وملفات اليمن والعراق.
وإذا كانت هذه التغييرات العالمية غير كافية، فقد زادها ترامب إثارةً بتوجهاتٍ عدائية تجاه الصين. لكن، هذه المرة، من زوايا اقتصادية، من دون استبعاد الخيارات العسكرية أيضاً، وهو ما ألمح إليه مساعده ستيف بانون، والذي أشار، في أحد تصريحاته، إلى أن “الحرب في بحر الصين آتية لا محالة”. وهي حربٌ قد تكون خطوتها الأولى تضييقاً اقتصادياً ومحاولة سحب البساط من تحت أقدام بكين.
حتى حلفاء الولايات المتحدة لم يسلموا من توجهات الرئيس الجديد، إذ ذكرت صحيفة فورين بوليسي أن ترامب يستعد لحرب العملات، ليس فقط ضد الصين، بل ضد ألمانيا أيضاً، والتي يسعى إلى إجبارها على تغيير سياستها الاقتصادية، بما في ذلك التزامها باليورو الذي يربط دول الاتحاد الأوروبي ببعضها. وهو سبق أن أثار حفيظة دول الاتحاد الأوروبي، بقراراته الاقتصادية الحمائية، إضافة إلى ما اعتبر تشجيعاً لمغادرة الاتحاد الأوروبي، عندما توصل إلى اتفاقية تجارية مع بريطانيا.
كل هذا وغيره الكثير، ونحن لا نزال في الأسبوعين الأولين من حكم ترامب، والذي من الواضح أنه يريد تشكيل عالم آخر يحمل اسمه.
العربي الجديد،
اختبار القوة بين واشنطن وطهران/ د. خطار أبودياب
رحلت إدارة باراك أوباما ومعها العشق من جانب واحد الذي بقي ممنوعاً، وكذلك الرهان على التغيير في طهران أو إبرام شراكة معها، وتمركز دونالد ترامب الذي بدأ يهز العالم بقراراته التنفيذية المترجمة لوعوده الانتخابية، لكن صانع القرار الإيراني بدا غير منتبه أو غير مكترث بهذا التحول في البيت الأبيض، وإذ به يوجه رسائل استفزاز وتحد بعد أيام على تنصيب دونالد ترامب. من خلال تجربة الصاروخ الباليستي المتوسط المدى، والهجوم الحوثي ضد الفرقاطة السعودية، أرادت طهران جس نبض فريق ترامب. لم يتأخر الرد الأميركي بالتحذير الشديد والعقوبات مما يؤشر على اختبار للقوة بين الجانبين لن يخرج في البداية عن السيطرة، لكنه سيمهد على الأرجح لرسم معادلة جديدة في الإقليم قد لا تكون لصالح اللاعب الإيراني.
يبدو ترامب وكأنه يسابق الزمن كي يثبت بدء عهد جديد في واشنطن والعالم، وأنه كان يعني ما يقول خلال حملته الانتخابية أو في المرحلة الانتقالية قبل تسلمه الحكم. وهكذا عند أول احتكاك مع إيران سرعان ما وصف الاتفاق النووي مع إيران بالكارثي أو الفظيع، لكنه لم يطالب بإلغائه لاستحالة الأمر عملياً أو لخطورته. وحسب مصادر مطلعة في واشنطن، يمكن تلخيص خطة ترامب حول إيران على الشكل الآتي:
◄ نووي عسكري أو ممهد للعسكري صفر، وذلك عبر التنفيذ الصارم للاتفاق النووي، وليس تمزيقه. تريد الإدارة متابعة تكثيف المراقبة الدقيقة لكل شاردة وواردة، فإذا قامت إيران بانتهاك الاتفاق، سيسقط الاتفاق ويتم القفز إلى المحاسبة.
◄ رفض تطوير برنامج الصواريخ الباليستية. ولذا سيكون الرد على تجربة أواخر يناير 2017 عبر حزمة عقوبات كانت قيد الإعداد.
◄ مراقبة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار الإقليمي، ورفض التدخل السافر في شؤون الدول الأخرى (ضمن الأفكار المطروحة، فرض عقوبات على شركات طيران إيرانية تنقل السلاح إلى العراق أو سوريا).
◄ التنبه لنشاطات دعم الإرهاب.
عند أول تطبيق عملي، يتضح أن لهجة الإدارة الجديدة تعكس تحولاً بنسبة 180 درجة عن إدارة باراك أوباما؛ حيث أن تضمين اعتداءات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في بيان التحذير الذي صدر عن البيت الأبيض أو في المؤتمر الصحافي لمستشار الأمن القومي مايكل فلين يعكس تركيز الإدارة الأميركية على تصرفات إيران وسلوكها الإقليمي، وهو ما كان يتجاهله فريق أوباما.
حسب مصادر في المنامة، تزامنت تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي الإيراني مع مناورات بحرية بين 31 يناير و2 فبراير تجرى للمرة الأولى في المياه الإقليمية الواقعة بين البحرين وإيران، وهذه المناورات المسماة “ترايدنت يونايتد” والتي شاركت فيها قوات بحرية أميركية وبريطانية وفرنسية وأسترالية، شملت جميع أنواع العمليات البحرية بهدف تعزيز الشراكة بين القوات المشاركة، ودعم الأمن البحري وتعزيز التعاون الدولي لضمان حرية انسياب حركة التجارة في منطقة الخليج، كما كانت تهدف إلى تحسين الكفاءة التكتيكية للقوات وتقوية علاقات الشراكة لضمان حرية الملاحة.
وغالباً ما كان الحرس الثوري الإيراني يرسل زوارقه لاستفزاز السفن المشاركة والتحرش بها، لكن هذه المرة لم يحصل ذلك، لأن هذه السفن كانت متطورة ومحصنة، وحسب مصدر في دبي كان “قائد الأسطول الأميركي الخامس قد وجه تهديداً بإطلاق النار الفوري على أي تحرك مشبوه”. وتبعاً لهذه المجريات لا يستبعد أن يكون الاعتداء على الفرقاطة السعودية رسالة للقول بأن إيران قادرة على إثبات الوجود في هذه الممرات الإستراتيجية التي تعتبر من أبرز شرايين التجارة العالمية ونقل الطاقة. طبقاً لقانون البحار لعام 1982، لا يحق لأي قوة عرقلة الملاحة الدولية. وللتذكير حاولت إيران عند نهايات الحرب العراقية – الإيرانية (تحديدا في الفترة بين 1987 و1988) تعطيل حرية الحركة وكان الثمن ردوداً غربية أسفرت عن توقيف الحرب وتراجع إيران.في مواجهة الوقائع الجديدة، بدا رد الفعل الإيراني متشددا في الظاهر مع كلام علي ولايتي مستشار المرشد الأعلى عن “تمريغ أميركا سابقا بالوحل في العراق” لكن يبدو أنه إزاء التحذير الأميركي الشديد اللهجة غابت عن ردود الأفعال الإيرانية عبارة “الشيطان الأكبر” وغيرها من المفردات المعتادة. على المدى القصير، يعتقد أن العقوبات الأميركية الجديدة قد تكون مقدمة لسياسة أشد صرامة، لكن ستفرضها الولايات المتحدة بطريقة لا تتعارض مع الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي بمقتضاه وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي مقابل إعفائها من عقوبات اقتصادية.
هكذا تبدأ صفحة جديدة في المسلسل الطويل بين واشنطن وطهران والمستمر فصولاً منذ عام 1979، والأرجح بدء المعارضة الأميركية للتوغل الإيراني في سوريا والعراق والتدخل الإيراني في اليمن، وسيكون ذلك وفق معادلة تفترض مساعدة واشنطن للحلفاء المحليين مقابل مشاركتهم الفعالة في هذا المجهود وتبني الخطط الأميركية في محاربة الإرهاب. وفي نفس السياق، سيكون لمسارات الحوار أو التنسيق بين واشنطن وكلّ من روسيا وإسرائيل أثر مباشر في بلورة المقاربة الأميركية الشاملة إزاء إيران.
أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي للجيوبوليتيك – باريس
العرب
ترامب يفتح ملف الحرب المؤجلة على الإرهاب الإيراني/ حامد الكيلاني
تمادت القيادات الإيرانية في جس نبض الإدارة الأميركية الجديدة منذ اليوم الأول لتنصيب دونالد ترامب. بدأها الرئيس حسن روحاني بتصريحه بأن زمن بناء الجدران انقضى، في إشارة إلى الجدار الذي تنوي أميركا بناءه على حدودها مع المكسيك للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتقدر أعدادهم سنويا بـ750 ألفا، وهو رقم هائل قياسا بأعداد الوافدين إلى أميركا وفق برنامج التوطين للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
روحاني تناسى أن أكبر عدد لاجئين تستقبلهم أميركا أو مهاجرين من الدول السبع المشمولة بقرار المنع الذي وقعه الرئيس ترامب وسبب قلقا وجدلا وردات فعل متباينة في الأوساط الرسمية والشعبية، هو من الإيرانيين الهاربين من جور النظام والفقر وسياساته القمعية الفاشية التي أودت بالشعوب الإيرانية، وخاصة الطبقة الوسطى المتعلمة والمثقفة، إلى المغادرة بحثا عن الأمن والكرامة الإنسانية وحرية الرأي والموقف، ومعظمهم من الذين ينتمون إلى الحركات المناهضة للنظام وبعضها يمثل تيارات قومية أو فكرية أو سياسية مختلفة تشكل الهيئة العامة للمقاومة الإيرانية وقياداتها وفي مقدمتها حركة مجاهدي خلق.
معظم الشعوب الإيرانية تسعى للخلاص من نظام الملالي الذي ارتكب المجازر والإبادات بحقها وخاض حربا طويلة وأشاع الفوضى والهوس الطائفي باستهدافه الأمة العربية انطلاقا من العراق، مستغلا حالة الانهيار التي أعقبت 13 عاما من الحصار الشامل لشعبه، وانتهت بالاحتلال وحماقة الإدارة الأميركية للرئيس جورج بوش الابن وتراجع الدور الأميركي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
الحدود بين المكسيك وأميركا، وخلال سنوات ليست بالقصيرة، لم تقتصر على مجازفة التسلل والتعرض إلى المخاطر والملاحقة والتوقيف والإعادة للمكسيكيين حصرا، إنما هي حدود تنمو فيها تجارة المخدرات ووسطاء مافيات التهريب التي توفر شبكة اتصالات لترغيب الشباب وحتى الأسر وبالذات من مواطني الدول المعنية بالقرار وعلى رأس القائمة الإيرانيين، وتشمل خدمات المهربين الحجوزات الفندقية والتوصيل والعبور وفي مقدمتها طبعا الابتزاز والاحتيال.
جسّ نبض الإدارة الأميركية في أيامها الأولى بالسخرية والتهكم منها بقرار بناء الجدار مع جارتها ومن الرئيس الإيراني الذي يوصف بالاعتدال حصرا دون غيره، له دلالة استخفاف رسمي بشخصية الرئيس دونالد ترامب الذي باشر بتطبيق سياسة عدم إضاعة الوقت، بما يتماشى مع إيقاع الأحداث وسرعة تبادلات سوق السياسة والاقتصاد في البورصات الدولية والإقليمية، وما يشهده من مناخات عسكرية وعروض متباينة الأهداف والمناورات.
15 يوما من حكم ترامب هزّت العالم سلبا أو إيجابا، وعلى وصف إحدى الصحف الأميركية، ويبدو أنها تأثرت بأكاسير ترامب، أوجزت فيه ديناميكية أو نشاط أو فائض الطاقة للرئيس “8 أيام من حكم ترامب تعادل 8 أعوام من حكم أوباما”.الإعلام الأميركي بمعظم مؤسساته انتصر أثناء الحملة الانتخابية وبعدها إلى هيلاري كلينتون، دعما لها، ثم تحريضا ونقدا وتهييجا للشارع ضد ترامب وفوزه بمنصب الرئيس؛ كذلك فعل الإعلام العالمي تقريبا متأثرا بالأصداء الأميركية بما ينقله عنها؛ لكن ما نتلمسه بعد مضي نصف شهر فقط من انتقال السلطة للإدارة الجديدة، أن طاقم الرئيس دونالد ترامب ومستشاريه يتعاطون الدعاية السياسية ويحصدون الانتباه لأطروحاتهم، بمعنى الفوائد الإعلانية وتسخير الإعلام المضاد في الترويج المباشر أو المبهم والغامض.
يمكن ملاحظة ذلك في زخم تصريحات قادة العالم وما يطلبونه من إيضاحات أو شجب بحذر أو استنكار أو ارتفاع في نبرة الإدانة والتلويح بمبدأ التعامل بالمثل، رغم أن بعضهم لا توجد بينه وبين أميركا علاقات متكافئة، ومنهم إيران التي تحاول تصدير بضاعة مشروعها وإعلامه لجموع البسطاء من مقلدي وليها الفقيه من خلال بورصة الإعلام المضاد لترامب، تحقيقا لمكاسب متعددة في أيام تعتقد إيران أنها رخوة بحكم رسم ملامح السياسة الأميركية وتشكلها.
في الفترة الانتخابية كان ترامب بعيدا عن البركة الراكدة الآسنة للسياسة الدولية، لكنه لم يتوقف عن رمي حصى تعهداته للناخب الأميركي أولا، رغم أنها كانت مجرد وعود في برنامج انتخابي كثيرا ما يتخلى عنها المرشحون عند استلامهم السلطة، لكن ترامب استطاع قبل فوزه أن يخلق ضجيجا أقلق الصمت الدولي المستسلم للأمر الواقع تجاه الأحداث الجسام؛ بعضهم يرى في ذلك نقائص عند ترامب ويراها آخرون ربما فضائل، الأكثر واقعية ما حصل بعد تنصيبه وما أقدم عليه من رمي البحيرة الموبوءة بحجر أدى إلى موجات إصغاء وانتباه وترتيب أوراق كانت مبعثرة على مساحة واسعة، وأخطرها ما يجري على أرضنا.
الدول الإسلامية ليست 7، وكراهية نظام الملالي لترامب وقراراته مصدرها مواقفه المعلنة من الاتفاق النووي الذي فتح الباب لإيران وحرسها الثوري الميليشياوي للعبث بمصير شعوب المنطقة المشمولة بالمنع في قرارات ترامب. المنع إذن يشمل، قطعا، عددا كبيرا من عملاء إيران من حملة الجنسيات المعنية بالقرار، وهذا برأينا بداية استراتيجية لمحاربة الإرهاب وإعادة تقييم النظام الأمني ومتابعة المتورطين في العمليات الإرهابية الكبرى التي استهدفت الدول المنكوبة أو التغلغل كخلايا طائفية نائمة في العالم.
إطلاق الصاروخ الباليستي والهجوم على الفرقاطة السعودية، بالتزامن مع مناورة الرمح الثلاثي التي تشارك فيها أميركا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا أيضا؛ لا يُفَسِران جس نبض الإدارة الأميركية الجديدة كتصريح الرئيس الإيراني روحاني المتهكم من الجدار، إنما هما تجريب عملي لردة فعل غاضبة وغير محسوبة لاستباق التوقعات ليس في ما يتعلق بإعادة طرح الملف النووي، لكن هذه المرة بإعادة قراءة سياسات الملالي التوسعية وكوارثها في العراق وسوريا واليمن وأطماعها وطموحات حلمها الإمبراطوري.
ما أغاظ إيران هو سياسة المدرسة الواقعية لترامب ومعرفة إدارته المعمقة بحجم الدور الإيراني في صناعة الإرهاب واستقطابه لخدمة مصالح مشروعها؛ وكذلك التقارب مع العرب حيث تلتقي توجهاتهم مع إصرار المجتمع الدولي على محاربة الإرهاب ولجم التغول الطائفي للملالي الذي تسبب بدمار عدد من بلدانهم وظل يتمدد دون توقف.
8 سنوات كان على إيران الالتزام بها وفق القرار الأممي 2231 والامتناع عن إطلاق تجربتها الباليستية كتعهدات أممية في سياق الاتفاق النووي، مما دعا مستشار الأمن القومي الأميركي مايك فلين، في أول إطلالة له، إلى اتهام الحكومة الإيرانية بما وصفه السلوك الضار، ووجه تحذيرا رسميا لها بعبارة “ابتداء من اليوم” التي تنطوي على مراقبة ورصد كل التحركات الإيرانية اللاحقة. إيران لا تتأخر في الانتهاكات، وهي كما نظن بأنها خطوط حمراء وتجاوزها لن تكون نتائجه مقاربة لتجاوز الخطوط الحمراء للرئيس باراك أوباما.
خطط أمنية وعسكرية وبمدد إنجاز محددة قررها ترامب، وقرارات قادمة بأثر رجعي لملفات في مقدمتها ملف احتلال العراق في العام 2003 بتكاليفه ونتائجه في هدر الأموال الأميركية على مشاريع إعمار فاشلة ينخرها فساد ساسة العراق وزعماء الميليشيات الإيرانية. قائمة أسماء موضوعة لتحقيق شامل قد يشمل شخصيات أميركية أيضا، وتبعات تلاحق العملاء الذين مهدوا لاحتلال العراق بما كلف الخزانة الأميركية أموالا طائلة ومعها الآلاف من القتلى. مدرسة شعبوية ترامب تتبلور في السياسة الدولية وتحمل في طياتها العواصف، وعلينا، نحن العرب، أن نتعامل معها بواقعية واستشعار لنتائجها وعدم الثقة مطلقا بملالي طهران وتحركاتهم وتحدياتهم ونعومة ملمسهم أحيانا للنفاذ من جدار العقاب العادل.
كاتب عراقي
العرب
«هآرتس»: «ترامب» يحتاج إلى حرب مقدسة
ترجمة وتحرير شادي خليفة – الخليج الجديد
إنّها فكرة مخيفة بدرجةٍ غير مسبوقة أنّ إدارة «ترامب» ببساطة تبحر بالولايات المتّحدة في بحر من التشويش والخطورة والمشكلات المفتعلة والتفكيك، وكل ذلك دون خطّة.
لكن هناك احتمالية أكثر إثارة للرعب، أنّه، في الحقيقة، توجد خطّة. وهي الخطّة التي تتركّز بشكلٍ كبير على تعزيز وتوسيع سلطة «ترامب»، وإثارة وتعبئة قاعدته، منح النفوذ للعنصرية، والإسلاموفوبيا، وفي مرحلة لاحقة، إذا لزم الأمر، معاداة السامية، بغية الحصول على كبش فداء لكل أوجه القصور.
إنّه يحتاج إلى حرب.
يحتاج إلى حرب للتوفيق بين تناقضات الحملة الانتخابية الشعبوية وتناقضاته الذاتية، حيث أعلن تعهّده بإعادة بناء الجيش بمستويات تاريخية، وقام في نفس الوقت بتقليص الإنفاق الحكومي. يحتاج إلى حرب من النوع التي قد تمكّنه من الوفاء بوعوده بإعادة إحياء الصناعات التحويلية والتعدين.
وستتيح له الحرب إعطاء الضوء الأخضر لشركات الاحتكار الضخمة، وذريعة في نهاية المطاف لفرض الطوارئ، وإلغاء أبسط ضمانات الحريات الفردية على نطاق واسع، مع استثناء تملّك السلاح.
ومن شأن الحرب أن تؤكّد لخصومه أنّ منتقديه ضعفاء وأنّ كلاً من منافسيه الليبراليين قصيري النظر، والمهاجرين المشكوك في ولائهم، واليساريين الخبثاء، والصحفيين (باستثناء فوكس نيوز وبريتبارت)، مخربون ومعادون لأمريكا ومخادعون، عن معرفة وقصد.
ومن شأنها أيضاً أن تجعل من الواضح أنّ ما يجعل حياة الأمريكيين غير آمنة ليسوا هم المرضى النفسيون من الرجال البيض الذين يفتحون النار على الناس بشكلٍ جماعي. وإنّما شبح ذلك المسلم الذي لم نقابله أبداً، والذي يجب أن يجعلنا متيقّظين طوال الليل، حتّى وإن كان ذلك المسلم في الحياة الفعلية قديساً بين الأطباء أو كان أخاً في سلاحٍ سابق مع قوّات الولايات المتّحدة خارج البلاد.
يحتاج «دونالد ترامب» إلى حرب. لكن ليست أي حرب. إنه يحتاج إلى العدو المناسب غير المسيحي، صاحب القوّة والمخيف كليا، غير الأبيض. العدو الواضح غير القابل للتفاوض.
إنّه يحتاج إلى حرب مقدّسة.
سلاح ديني
ويحتاج مع ذلك إلى سلاح ديني يمكنه الاعتماد عليه. وهو يملك واحداً بالفعل. إنّه يدعى «ستيف بانون». ولقد كان «ستيف بانون»، المنظّر والمروّج للأرض الجمهورية، يتحدّث عن الحرب المقدّسة لسنوات.
وفي خطابٍ أمام مؤتمرٍ مسيحي عقد في الفاتيكان في صيف عام 2014، أعلن «بانون» أنّنا «في مراحل البدايات الأولى لصراع وحشي ودموي، الذي يتطلّب أن يتّحد الناس في هذه الغرفة، الناس في هذه الكنيسة، لتشكيل ما أشعر أنّه لن يكون فقط جانبا متشدّدا من الكنيسة للدفاع عن معتقداتنا، لكن أيضاً للقتال ضد هذه الهمجية الجديدة التي تنشأ، والتي من شأنها القضاء التام على كل إرثنا في آخر 2000 أو 2500 عام».
وفي نفس الوقت، «بانون» هو مصرفي سابق في غولدمان ساكس، وترأس شبكة أخبار بريتبارت اليمينية الصديقة للقومية البيضاء، وكان أيضاً منتجاً ومخرجاً للأفلام.
وقال «بانون»: «أعتقد أنّنا الآن في المراحل الأولى لحرب عالمية ضد الفاشية الإسلامية».
وقال «روبرت باير»، محلل الأمن القومي، يوم الثلاثاء أنّ خطاب «بانون» يبدو وكأنّه «خطاب وعظي للحملة الصليبية الأولى».
وبالإشارة إلى القرار التنفيذي الرئاسي يوم الجمعة برفض الهجرة والدخول من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي يقال أنّ «بانون» قد صاغه دون استشارة مكتب النائب العام أو الدفاع والأمن الوطني أو إدارات الدولة، قال «باير» أنّ هذا الحظر قد يعطّل جمع المعلومات الاستخباراتية ويهزّ مكانة الولايات المتّحدة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
وقال «باير» لقناة سي إن إن: «نحن لسنا بأمان. قد يؤدّي هذا الحظر إلى قتل الأمريكيين. لا يوجد أي فائدة في ذلك. سنفقد الحلفاء، ونحن نحصل على 99% من معلوماتنا الاستخباراتية في الشرق الأوسط عن طريق الحلفاء، من العراقيين والسوريين». وقد يقود الحظر إلى أن يقرّر البرلمان العراقي طرد القوّة الأمريكية التي تخدم في البلاد والبالغة 5000 جندي، وسيعوق ذلك المعركة ضدّ الإرهاب.
وإذا كانت تلك الحرب في الورق، فإنّ «ترامب» يرغب بالتأكيد أن يكون «بانون» في مقعد المروج.
وفي ليلة السبت، وسط حالة الهرج والمرج الناتجة عن الحظر، وكذلك الإدانة لـ«ترامب» بعد أن أشار إلى الذكرى السنوية للهولوكوست دون أي ذكر لليهود، قام الرئيس بتعيينه عضواً بلجنة المدراء بمجلس الأمن القومي، مع إسقاط الأعضاء المعتادين مثل رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الاستخبارات الوطنية.
ولا يتوقّع خطاب «بانون» في عام 2014 حرباً حتمية وقريبة فقط بين المسيحية والإسلام، لكنّها قد تضع اليهود أنفسهم أيضاً كهدف لغضب المسيحيين الأمريكيين في الطريق.
وفي ردّ لـ«بانون» عام 2014 على سؤال حول هزيمة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك «إريك كانتور»، والجمهوري اليهودي الوحيد في مجلس الشيوخ ذلك الوقت، وصف «بانون» هزيمة «كانتور» بـ «الهائلة» وأنها «الهزّة الانتخابية الأكبر في تاريخ الجمهورية الأمريكية».
وتحدّث «بانون» بإسهاب عن كمية الأموال الضخمة التي أنفقها «كانتور» في مقابل الدعاية المتواضعة لخصمه الشاب المنتصر «ديفيد برات»، والذي لم يذكر «بانون» أنّه «”مسيحي إنجيلي». وقال «بانون» أنّ السبب بسيط، ويرجع إلى أنّ الطبقة المتوسّطة والعمال قد ملّوا من الأشخاص أمثال «إريك كانتور» الذين يقولون بأنّهم محافظين، لكنّهم يبيعون مصالحهم للمحسوبية الرأسمالية.
الحملة الصليبية بدأت بالفعل
ويوضّح الخطاب أهداف «بانون» الأخرى كذلك، والتي بدأ «ترامب» بتنفيذ واحدةٍ منها في القرارات الأولى له في الرئاسة:
وممّا ذكره «بانون»: «على الجانب الاجتماعي المحافظ، نحن صوت الحركة المناهضة للإجهاض، صوت حركة الزواج التقليدي، وأستطيع أن أقول لكم أنّنا نفوز بالانتصار تلو الآخر. الأمور تتغير، وأصبح للناس صوت ومنصة يمكنهم استخدامها».
قد لا تكون الحرب جارية حتّى الآن، لكنّ الحملة الصليبية قد بدأت. وكان قرار حظر المسلمين هو المرحلة التمهيدية فقط. والهدف الأول للاحتلال أمام ناظرهم بالفعل، ألا وهو المحكمة العليا.
وماذا عن الحرب الحقيقية؟ قد يراها «ترامب» خيارا إيجابيا لأنّه لا يعرف شيء عن العالم الذي تخلّفه وراءها. ولا يعرف شيئا عن الرعب الذي تعنيه الحرب للأشخاص الذين تدمّر حياتهم، سواء ظلّوا على قيد الحياة جسدياً أم لا.
هو يظن أنّه يعرف. لقد فاز في حروب ضدّ ادّعاءات التمييز العنصري وعدم الدفع للعمّال. لقد قاتل وفاز بحروبٍ على التواضع والكياسة والإنسانية والسلوك الأخلاقي البشري الأساسي.
ولكن خبرته الوحيدة في الخدمة العسكرية أنّه قد تهرّب منها.
خبرته الوحيدة مع الضحايا الأبرياء للحرب، أن يعيدهم إلى سوريا، ثمّ يذهب إلى فراشه مع ابتسامة رضا على وجهه.
فليساعدنا الله جميعاً.
المصدر | هآرتس
الصراع على أميركا/ أسامة أبو ارشيد
بعيداً عن الجانب الإخباري والتحليلي للأسبوعين الأوَّلين من رئاسة دونالد ترامب، فإن ما يجري في الولايات المتحدة اليوم ليس صراعاً في أميركا فحسب، بل هو صراعٌ عليها، أيضا، وعلى جوهرها والقيم التي تَزْعُمُها. فالدَّعامات التي قامت عليها حملة ترامب الرئاسية وُصِفَتْ، منذ اليوم الأول لإعلانه الترشيح، بأنها “غير أميركية”. لم يكن ذلك اتهام خصومه الديموقراطيين وغيرهم فحسب، بل إن معظم زعامات الحزب الجمهوري الذي ترشح باسمه كانوا يوجهون له الاتهام نفسه، إلى حين صدموا بالحقيقة الفاجعة من أنه أصبح رئيسا للولايات المتحدة، باسمهم جميعا. تهم الابتعاد عن “القيم الأميركية” ألقيت في وجه ترامب عندما تحدّث عن المهاجرين المكسيكيين والمسلمين والنساء والإعلام والمعاقين جسديا. أيضا، ألقيت هذه التهم في وجهه، عندما شكك في التزامات أميركا الدولية، والتزامها بأمن حلفائها والأطر والهياكل التي قامت عليها العلاقات معهم، كما في حالتي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). كما لم تغب هذه التهم الموجهة إليه، وهو يتودّد إلى الخصم الاستراتيجي الأميركي، روسيا، في حين يُصَعِّدُ مع حليف أوروبي، كألمانيا.
هذا غيض من فيض تهم ألقيت في وجه ترامب المرشح، ولكن ترامب لم يعد مرشحاً، فهو رئيس اليوم. والآن، ثبت بالدليل القاطع أن كل توقعات أن خطابه الشعبوي سيجنح نحو الاعتدال بعد توليه الحكم لم تكن صحيحة أبدا. هذا ما دفع مراقبين أميركيين كثيرين إلى القول إنه ينبغي أخذ كل ما تعهد به ترامب “حرفيا وليس فقط بجدية”. ولعل في القرار الذي أصدره ترامب أخيراً بفرض “حظر مؤقت” على دخول مواطنين من سبع دول بغالبية سكانية مسلمة ما يكفي للتدليل على ذلك، فعلى الرغم من أن البيت الأبيض ينفي أن هذا القرار يمثل “حظرا على دخول المسلمين” إلى الولايات المتحدة، إلا أن ترامب نفسه يستخدم مصطلح “الحظر”،
“محاولة لخطف أميركا وصياغتها من جديد على أيدي يمينيين عنصريين متطرّفين” في حين أن أحد مستشاريه، العمدة السابق لمدينة نيويورك، رودي جولياني، قال بوضوح إن ترامب طلب منه وضع لغة قانونية “أكثر قبولا” لمسألة “حظر دخول المسلمين” إلى أميركا.
على أي حال، ليس هذا موضوعنا، فالتقارير الإخبارية والتحليلية حوله كثيرة، غير أنه يعطينا مؤشرا واضحا على ما يمكن أن تكون عليه أميركا تحت ترامب. على المحك، القيم الأخلاقية والدستورية التي تفاخر بها الولايات المتحدة. إنها الأعراف التي كان يُظَنُّ أنها استقرت هي ما تتعرّض إلى الامتحان. إنه اختبار عسير للتعديل الدستوري الأول الذي يعتبره الأميركيون أهم ما يميز أميركا عن باقي العالم، ويساهم بالنصيب الأكبر في صياغة زعم “الاستثنائية” الأميركية.
يُسَيِّجُ التعديل الدستوري الأول حرية الدين والعبادة، وحرية التعبير والصحافة، كما يُسَيِّجُ حق التجمع وحق المواطنين في تقديم التماسات للحكومة لإنصافهم من إجحافٍ حَلَّ بهم. كما أنه يمنع الكونغرس من أن يسن أي قانون يعزّز من مكانة دينٍ معين. لكن ما نراه تحت ترامب اليوم أن هذه الحقوق والقيم تتعرّض لاعتداءٍ شرس. فها هي إدارته تفرض نوعا من أنواع “حظر” دخول الولايات المتحدة على أساس ديني، بل هناك حديث كثير يجري تداوله عن فرض “فحصٍ ديني” على الزائرين والمقيمين، بل ويمكن أن يطاول المواطنين الأميركيين، طبعا المسلمين. أيضا، تشن الإدارة حرباً شرسة على قيمة حرية التعبير وحرية الإعلام. وقد شاهد العالم بأسره ترامب نفسه، وهو يهين صحافيين، ويتهم الإعلام بأنه كاذب، ووصفه بـ “حزب المعارضة”، وسمعنا من كبير مستشاريه، اليميني العنصري المتطرّف، ستيفين بانون، وعيده للإعلاميين بأنه ينبغي عليهم أن “يخرسوا”.
لا نحتاج إلى كثير إثبات أن التاريخ الأميركي عرف بوناً شاسعاً بين منظومة القيم والممارسة العملية. مثلا، على الرغم من أن دستور الولايات المتحدة يضع السلطة العليا في يد الشعب: “نحن شعب الولايات المتحدة”، إلا أن “الشعب” لم يكن يعني، منذ البدء، كل عناصره ومكوناته. فقد تمَّ استثناء السكان الأصليين والعبيد السود عقوداً طويلة جدا. أيضا، على الرغم من أن التعديل الدستوري الرابع عشر ينص على المساواة في الجنسية والحقوق القانونية وحق التقاضي، غير أن أميركا لا زالت تعاني من التمييز العنصري، والسود والمسلمون هم النموذجان الأبرز. بل إن النساء أنفسهن لم يتمتعن بحق التصويت حتى عام 1920.
إذن، في تاريخ أميركا محطات سوداء كثيرة، من عمليات إبادة وقعت بحق السكان الأصليين واسترقاق السود، إلى إساءة معاملة الكاثوليك وحظر دخول الصينيين واليهود في مراحل تاريخية معينة، ومن المكارثية والمعتقلات الجماعية لليابانيين، وصولا إلى معتقل غوانتنامو. واليوم استهداف المسلمين على أساس ديني، لا على أساس شكوك “إرهابية”.. إلخ. لكن،
“تهم الابتعاد عن “القيم الأميركية” ألقيت في وجه ترامب عندما تحدّث عن المهاجرين المكسيكيين والمسلمين والنساء والإعلام والمعاقين جسديا” وعلى الرغم من كل هذه المحطات السوداء في التاريخ الأميركي، وأحصر الحديث هنا داخليا، لا عن سياستها الخارجية، فذلك فصل آخر أكثر قتامةً، غير أن أميركا بقيت دوما موئلا لذلك التدافع الحيِّ بين قواها المختلفة على أرضية “أي أميركا نريد؟” هل هي المستوعبة كل مكوناتها وأعراقها وأديانها، أم أننا نريد أميركا التي تقوم على أساس حماية امتيازات الغالبية البيضاء؟ وبسبب من هذا التدافع، خاضت أميركا حربا أهلية (1861-1865)، بسبب توجهات الرئيس أبراهام لينكولن لإلغاء العبودية، كما أنها شهدت توتراتٍ سياسيةً كبيرة في ستينيات القرن الماضي على أرضية الحريات المدنية للسود الأميركيين.
باختصار، قد يكون تركيز الإعلام اليوم منصبا على قرار ترامب استهداف المسلمين، سواء أكانوا مواطنين أميركيين أم لا، غير أن الواقع يذهب إلى أبعد من ذلك. إننا أمام “انقلاب ناعم” على القيم والمصالح الأميركية، كما كانت تعرف إلى حدود أسابيع قليلة. بل إنها محاولة لخطف أميركا وصياغتها من جديد على أيدي يمينيين عنصريين متطرّفين. إعادة صياغة للقواعد الناظمة والقيم والأعراف المستقرة أميركيا بشكلٍ يستهدف كل من يخالف الإيديولوجيا الشوفينية لكثيرين ممن هم في موقع القرار اليوم. وما نراه اليوم من ردة فعل المجتمع المدني الأميركي، بكل مكوناته، ليس سببها الوحيد قرار “حظر المسلمين”، وإنما مبعثها الأهم “أيّ أميركا نريد”؟ ولكن، من الضروري أن نُقِرَّ هنا بأن أميركا منقسمةٌ على ذاتها في هذا الشأن، وهذا هو أخطر ما في الموضوع، ولا يبقى لنا إلا انتظار أن ينقشع غبار المعركة التي ستكون تداعياتها دوليةً، كما هي أميركية.
العربي الجديد
ماذا يبيع ترامب في سوريا؟/ حسين عبد الحسين
المرسوم الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقامة مناطق آمنة في سوريا، لاقى استحساناً لدى السوريين ممن أصابهم اليأس لوقوف أميركا و”العالم الحر” موقف المتفرج على السوريين وهم يغرقون في دمائهم، أو في بحار اللجوء ومحيطاته. لكن مرسوم ترامب هو، مثل ترامب وباقي مراسيمه، خديعة مخصصة للاستعراض، أكثر منها لحماية السوريين من دموية الرئيس السوري بشار الأسد والقوات المتحالفة مع نظامه.
في العام 2013، رمى الرئيس السابق باراك أوباما الضربة التي أعلنها ضد قوات الأسد في حضن الكونغرس، ولم يكن مفاجئاً أنه، بسبب المزاج الشعبي المتذمر من حربي العراق وأفغانستان، لم تلق الضربة ضد الأسد حماسة كافية للموافقة عليها. لكن المفاجئ كان في موقف أعضاء الكونغرس ممن كانوا يقسمون بتأييدهم لضرب الأسد، مع أو من دون مجازر كيماوية.
ومن مؤيدي التدخل الأميركي في سوريا كان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، الذي ترشح في ما بعد للرئاسة وقدم أداءً ضعيفاً أجبره على الانسحاب.
ولأن لروبيو طموحات رئاسية، فهو حرص على نيل عضوية “لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ”، بهدف تقديم هذه العضوية بمثابة خبرة في مجال السياسة الخارجية كمرشح رئاسي. وكان روبيو يتمتع بعلاقة متينة مع لوبيات متنوعة، في طليعتها “ايباك” القوي المؤيد لإسرائيل، والأخير أصدر بياناً دعا فيه الكونغرس إلى تأييد الضربة ضد الأسد. لكن على الرغم من بيان “ايباك” وصداقة روبيو معه، صوت روبيو ضد الضربة في اللجنة، فتمت المصادقة على مشروع قانون الضربة في اللجنة بفارق ضيق بلغ صوتاً واحداً (17 مقابل 16).
هذا التباين الخفي في إعلان “ايباك” المؤيد للضربة، وتصويت روبيو المعارض لها، هو في صميم الاستعراض المسرحي الذي قدمه ترامب حول إقامة مناطق آمنة في سوريا، وهو يعكس التناقض داخل التحالف حول سوريا، الذي تقوده موسكو، والذي يتألف من روسيا وإيران وإسرائيل، والآن الولايات المتحدة.
إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو تصادق موسكو، وتريد بقاء الأسد، ولكن إسرائيل تكره إيران و”حزب الله” اللبناني، وتسعى للانتقام منهما. إيران، بدورها، تكره إسرائيل، ولكنها تتعامل بواقعية مع صداقة موسكو وتل أبيب، خصوصاً لناحية حاجة “حزب الله” إلى جبهة هادئة مع الإسرائيليين أثناء تفرغ مقاتلي الحزب للجبهات داخل سوريا. هذا التناقض في التحالف الذي تقوده موسكو بدا جلياً في تقديم الروس غطاءً جوياً لمقاتلي “حزب الله” في وسط وشمال سوريا، وتركهم فريسة الغارات الاسرائيلية المتكررة في دمشق والجنوب.
كيف تنعكس هذه العلاقات المتناقضة داخل تحالف روسيا – اسرائيل، وروسيا – إيران، على الولايات المتحدة؟
سلم أولويات أميركا، بعد انتخاب ترامب رئيساً، صار يتطابق مع أولويات اسرائيل، لناحية مواجهة “حزب الله”، كجزء من مواجهة إيران. في الوقت نفسه، يحرص ترامب على إقامة صداقة مع روسيا، يرفع بموجبها العقوبات عنها. روسيا، بدورها، تبدو راضية باستبدال تحالفها مع إيران بتحالف مع أميركا، وهو التبدل الذي بدا جلياً في مؤتمر أستانة وعلى جبهات القتال السورية.
ولأن سياسة أميركا انقلبت تجاه إيران و”حزب الله”، كان لا بد من تبدل مواز في سوريا. ولأن سياسة أميركا تجاه روسيا انقلبت من عداء إلى صداقة، صارت إقامة مناطق آمنة في وجه قوة جوية روسية صديقة أمراً منافياً للمنطق.
ترامب، الرئيس شبه الأُمي، ليس سياسياً ولا استراتيجياً، بل هو “تاجر شنطة”، وهو لذلك، وقع مرسوماً هدفه الأول إظهار أنه يتصرف كرئيس “قوي” في سوريا، على عكس سلفه “الضعيف” باراك أوباما. ثم إن ترامب لم يأمر بإقامة مناطق آمنة في سوريا، بل هو طلب إلى وزارتي الدفاع والخارجية دراسة الأمر وتقديم تقرير في مهلة 90 يوماً، على الرغم من أن على رفوف الوزارتين خططاً جاهزة للسيناريو المذكور.
الأمر الوحيد الذي يفترق فيه ترامب عن روسيا هو عداؤه لإيران و”حزب الله”، وهذا عداء لا يتطلب إقامة مناطق آمنة، بل يتطلب سياسات أخرى يبدو أن مستشاري الرئيس، ممن يديرون سياسته فعلياً، يعملون عليها في الخفاء، ولم يعلنوا عنها حتى اليوم، أو إنهم لا يعملون على أي خطط لسوريا، وليس في حوزتهم إلا المرسوم الاستعراضي الذي قدمه رئيسهم.
المدن
سوريا بين كونفدرالية بوتين ومنطقة ترامب الآمنة
رأي القدس
تدور في نطاق الجغرافيا السورية حاليّاً حروب عسكرية وسياسية هائلة.
على الصعيد العسكري يمكننا تمييز عدة أنواع من المعارك، الأولى هي الحرب الأصلية بين النظام وحلفائه ضد الثورة السورية وممثليها من المعارضة المسلحة، وتتركز حاليّاً في منطقة وادي بردى والمناطق المحيطة بغوطة دمشق إضافة إلى الغارات الجوّية المستمرة في أكثر من مكان، والثانية هي حرب كامنة أطلقتها من عقالها توافقات «مؤتمر أستانة» وتحاول فيها الفصائل العسكرية السورية التي تمثّل أغلبها في «مؤتمر أستانة» إخراج «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) من المعادلة العسكرية للمعارضة، والثالثة هي حروب تنظيم «الدولة الإسلامية» ضد الجميع وتتركز حاليّاً في دير الزور وريف حلب التي قطع طريق إمدادات النظام إليها، ويضاف إلى ذلك حرب حزب «الاتحاد الديمقراطي» لإنشاء دويلة له، وقد وضعت على الرفّ مؤقّتاً، وحرب الجيش التركيّ ضد تنظيم «الدولة» وضد «الاتحاد الديمقراطي» في الوقت نفسه.
على المستوى السياسي دخلت الإدارة الأمريكية الجديدة على خطّ الزلازل السوري بإعلان مفاجئ من الرئيس دونالد ترامب عن عزمه إقامة منطقة آمنة في سوريا «لحماية المدنيين»، وأُضيف ذلك للأنباء التي تتوارد عن تفاصيل الدستور الجديد الذي «حاكته» موسكو للسوريين.
بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فإن ترامب «بصدد تمهيد الأرض لتصعيد التدخل الأمريكي في سوريا عن طريق الإيعاز إلى وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين الهاربين من الصراع في سوريا».
دفع هذا الخبر روسيا للاستنفار بحيث قال دميتري بيسكوف الناطق باسم بوتين في تصريح نشرته قناة «روسيا اليوم» «إن شركاءنا الأمريكيين لم يتشاوروا معنا». الناطق باسم الكرملين، وبلهجة لطيفة يقتضيها حال الغزل الذي لم ينقطع بعد بين الرئيسين، حذّر «الشركاء» الأمريكيين من «العواقب المحتملة» لهكذا قرار، وهذا التحذير لا يتعلّق بإمكانيات الصراع المحتملة بين العملاقين على الأرض السورية، بل خوفاً «من تردي وضع اللاجئين»، على حد قول بيسكوف.
ترامب، الذي له من اسمه نصيب (والذي يعني حسب القواميس الإنكليزية ورقة اللعب التي تربح أي ورقة أخرى)، سيقوم، لو طبّق هذا الاقتراح، بـ«الطرنبة» (كما يلفظها «اللاعبون» العرب) على الأوراق العسكرية والسياسية الأخرى، وذلك بعد أن ظن الروس بأنهم ربحوا «اللعبة الكبرى» وذلك إلى درجة أنهم وضعوا الدستور الجديد الذي ستسير عليه سوريا بل إن مجموعة من المحللين السياسيين والناشطين الاجتماعيين الروس، بحسب خبر أوردته صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» اقترحوا على بوتين إنشاء اتحاد كونفدرالي بين روسيا وسوريا!
يحتاج تلبيس الدستور الجديد على الهيكل العظمي المتداعي للبلاد إعادة تشكيل سوريا المدمّرة والمهجّر أهلها وإيقاف الحروب العديدة التي تدور فوقها وكذلك وقف مسلسل نهبها على أيدي عصابات النظام الأمنية والميليشيات الطائفية من كل نوع، وهو أمر يتناقض مع كون روسيا نفسها قوّة احتلال غاشم، مرتبطة مع حلفاء (النظام وإيران) جاهزين لمكاسرتها إذا ناهضت مصالحهم.
إضافة إلى كل ذلك فإن أي دستور، كما يعرف العرب، لا السوريين فحسب، حق المعرفة، وبغض النظر عن ماركة «صُنع في روسيا» أو «صنع في اليابان» فإنه، ومهما بلغ من رقيّ ودقّة في التعبير عن مصالح المواطنين، يمكن لأي ضابط عربيّ أن يلقي به في سلّة المهملات، وبالتالي فإن طبيعة النظام السياسي وآليات ضبط تغوّل أجهزة الدولة وانفصال السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية هي التي تفرض احترام الدستور من احتقاره.
منطقة ترامب الآمنة، من جهة أخرى، ستكون أيضاً سلعة «صنعت في أمريكا»، وستوضع، بحسب أقواله، في إطار محدّد هو منع اللاجئين السوريين من اللجوء إلى أوروبا أو أمريكا («العالم المتحضر» كما يسميه)، وهي استكمال رمزيّ لفكرة سور المكسيك.
… أي أنها ستكون «منطقة آمنة» للأمريكيين من إمكان لجوء السوريين إلى بلادهم.
أمريكا وإيران: عدوّ عدوّي ليس صديقي؟
رأي القدس
فتحت تجربة إيران إطلاق صاروخ باليستي يوم الأحد الماضي باباً سيصعب على طهران سدّه في إطار العلاقة مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي اعتبر أن الجمهورية الإسلامية «تلعب بالنار» وأن سلفه الرئيس السابق باراك أوباما، بحسب تعبير ترامب، كان «لطيفا تجاههم»، وأكّد أن هذا لا ينطبق عليه.
العالم الذي بدأ الاعتياد على اللغة الفظّة لترامب بدأ أيضاً يستعد لحقبة من إمكانيات تأجج صراعات سياسية وعسكرية بكافة اتجاهات خارطة الكرة الأرضية بسبب تصريحات وقرارات إدارة ترامب السريعة والصادمة والتي لا توفّر أحداً.
هذا الاستنفار المتوفّز تجاه العالم بأكمله (الأعداء منهم والحلفاء) والذي تلخّصه فكرة ترامب عن «أمريكا أولاً» يعطي انطباعاً أن المؤسسات الأمريكية المؤثّرة في قرارات الحرب والسلم، كوزارات الخارجية والدفاع والأمن، قد لا تتردّد كثيراً قبل الامتثال للنمطية الترامبية العنيفة بحيث يمكن أن نتوقع نقل درجة التصعيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية إلى ما هو أكثر، وهو أمر أوضحه تصريح ترامب حول إيران بأن الخيار العسكري ليس مستبعداً.
واضح جدّاً أن القيادة الإيرانية قد أحسّت بـ«سخونة» الوضع وجدّيته هذه المرّة فبعد الحديث عن حقّ إيران في القيام بتجارب صاروخية والرد على واشنطن بالقول إن تصريحاتها استفزازية ثم اللجوء إلى قرار (من وزن الريشة!) بمنع مصارعين أمريكيين من المشاركة في مسابقة عالمية في طهران عاد وزير خارجيتها المحنّك محمد جواد ظريف للتهدئة بالقول إن إيران «لن تشن أبداً حرباً»، وأنها «لن تستخدم أبداً أسلحتها ضد أحد».
التصعيد ضد إيران سيلقى ترحيباً لدى دول الخليج العربي وكذلك لدى شعوب أربعة بلدان عربية (على الأقلّ) تعاني من الاجتياح الإيراني لكياناتها ومن سيطرة الوليّ الفقيه على مقدّراتها ومن تحطيم نسيجها الوطنيّ وإثارة صراع دمويّ بين الشيعة والسنّة، ولكنّه سيثير مخاوف روسيا، الحليف الدوليّ الأكبر (والوحيد) لإيران، لكنّه أيضاً سيحظى بقبول إسرائيل التي تعتبر إيران أحد أكبر خصومها في المنطقة.
الخصومة الأمريكية لإيران تستند إلى تاريخ طويل من العداء بدأ مع انطلاق الثورة الخمينية عام 1979 وتخلّلته فصول تتراوح بين الكره الشديد ومحاولات التصالح، وقد انتهى الحال بالأمريكيين، مع انقلاب أحد أطراف السلفية السنّية الجهادية (تنظيم «القاعدة») عليهم إلى وضع مستجدّ غريب خدم فيه الأمريكيون النفوذ الإيراني في قوس واسع يمتد بين أفغانستان وسوريا، وحصل نوع من «تعايش الأضداد»، وخصوصاً في العراق، وهو أمر ترك آثاراً هائلة على العالم العربي، وأثار ضغينة عدد من البلدان والشعوب العربية على الأمريكيين، في إحساس (متبادل) كبير بخيانة حليف الأمس الوطيد لعلاقة وثيقة تقارب القرن.
قرارات ترامب بحظر رعايا ست دول عربية (وإيران) استثنت حلفاء أمريكا السياسيين العرب لكنّ إحساس المسلمين عموماً بالخطر تزايد، والموقف الأمريكي المستجد من إيران، الذي يمكن ربطه بتاريخ الخصومة السابق لا يخلو من العداء العنصريّ للإسلام بكافّة أشكاله، شيعيّة كانت أم سنّية، وإذا أضفنا الترحيب الإسرائيلي بتأجيج التوتّر مع إيران فإن العرب سيقفون على رقعة شطرنج معقّدة، الأرباح فيها بحجم الخسائر.
لا ينطبق في هذه الحالة المثال المعروف أن «عدوّ عدوّي صديقي»، فتأجيج الصراع ضد الإسلام سيؤذي الإيرانيين وسيؤذي العرب بالمحصّلة لكنّه لن يستطيع محو الضغائن والكوارث التي خلقتها السياسة الإيرانية في المنطقة وبالتالي فإن العرب لن يندفعوا للدفاع عن جارتهم اللدود، وبالمقابل فإن رضاهم عن تأجيج النار العنصرية الأمريكية ضد الإسلام بحجّة أنها ستنال من إيران قد ينقلب عليهم لأن النار قد تحرقهم كما ستحرق غيرهم، كما أن بعض فوائدها قد تصبّ في الطاحونة الإسرائيلية.