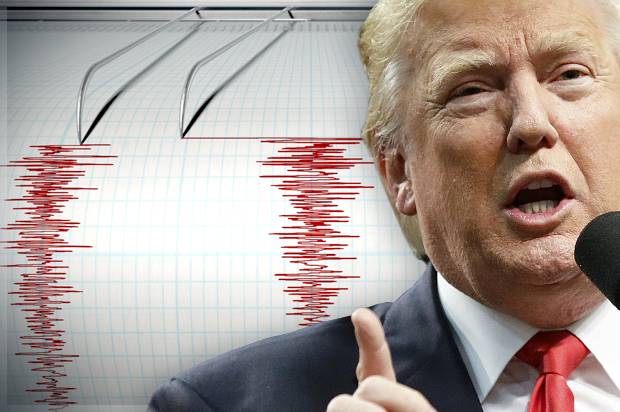عن ” محرقة صيدنايا” مجموعة مقالات

في أننا أصبحنا يهوداً/ عمر قدور
باستثناء إسرائيل، لم يُثِر كشف وزارة الخارجية الأميركية وجود محارق جثث، بناها نظام الأسد قرب معتقل صيدنايا، ردودَ فعل مناسبة. في إسرائيل وصل الأمر بأحد الوزراء إلى المطالبة باغتيال بشار الأسد، بينما مرّ الإعلان عن تلك المحارق في منتصف هذا الشهر وكأنه مجرد تنويع إضافي ضمن ما بات معروفاً عن وحشية النظام. قبل ذلك، كانت منظمة العفو الدولية، في شباط (فبراير) الماضي، قد أطلقت على السجن المذكور وصف «المسلخ البشري»، موثقة حوالى 13 ألف عملية تصفية لمعتقلين سياسيين، ومقدِّرة عدد من يعدمون يومياً بخمسين معتقلاً.
سيكون من السذاجة، إذا لم يكن من سوء النية، اعتبار ردود الأفعال الإسرائيلية فقط نوعاً من الانتهازية للتغطية على انتهاكات الإسرائيليين في حق الفلسطينيين. الواقع أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تكن تنتظر، ولا تنتظر الآن، تبريرات كهذه، والإسرائيليون لا ينامون ويفيقون على هاجس تحسين صورتهم في الأوساط العربية. وربما يدركون أكثر من غيرهم أن العداء لإسرائيل في المنطقة منذ زمن بعيد هو نوع من الاستثمار السياسي يهدف إلى التغطية على جرائم الأنظمة وطغيانها، وهو ليس بالعداء الجاد الذي يتهدد أمنهم، لا من قبل الأنظمة الحالية، ولا من قبل أي بديل محتمل سيرِث دولاً منهكة وممزَّقة ومُفقرة.
حساسية الإسرائيليين تحديداً إزاء المحرقة تعود إلى مركزية الأخيرة في وجدانهم، وهي مركزية نخطئ إذا لم نعطها حقها في الوجدان الغربي المعاصر عموماً، لأن التطهر من جريمة الهولوكوست شهد مساراً طويلاً من الجهدين الثقافي والحقوقي. حدث ذلك بينما انهمك مثقفون عرب، على خلفية الصراع مع إسرائيل، إما في التشكيك بحدوث المحرقة، أو في التقليل من أرقامها كجريمة أودت بحوالى 11 مليوناً، منهم ستة ملايين يهودي. ذلك التشكيك، أو عدم الاكتراث المطلق، يجعلان حساسية اليوم إزاء محرقة بشار متدنية جداً. بل لا يُستبعد أن يطلّ التشكيك القديم في جرائم النازية، ليستأنف عمله اليوم عبر التشكيك بمحرقة بشار، وفق الآلية «الدفاعية» ذاتها بين نفي تام أو تقليل من عدد الضحايا، كأن قلة العدد كفيلة بمحو الجريمة من أساسها.
قد نقول إن ثقافة الممانعة، التي استهانت بالمأساة الإنسانية لمحرقة النازية، سيعود أبطالها اليوم إلى الدفاع عن هتلرهم الصغير. ذلك يتسق تماماً مع شعاراتهم التي تفيد بأن طريق القدس يمر من أقاصي سورية، ومع أناشيدهم التي تصف السوريين باليهود، فضلاً عن الشعارات الأصلية التي تطالب بثارات طائفية. كل هذا يصنع خطاباً شبيهاً جداً بخطابات النازية التي رأت في أولئك المُساقين إلى المحرقة كائنات «دون البشر».
وكي لا نظلم أشاوس الممانعة، نستطيع تحري ثقافة واسعة الانتشار تبني حساسيتها الإنسانية والأخلاقية انتقائياً، إما عن وعي وقصد أو عن تبعية لها وظيفة تطهرية. يصح في هذا السياق استرجاع أصوات عربية صمتت طويلاً عن مجازر بشار، واكتشفت إنسانيتها مع إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية. وإذا استحق الأسرى حقاً التضامنَ التام، فإن أصحاب هذا التضامن الانتقائي لا ينهلون بالضرورة من أفكار عروبية لا ترى قضية سوى القضية الفلسطينية، إذ لا يُستبعد أن يكون بعض التضامن من الفولكلور البائد، وأن يكون لبعضه الآخر وظيفة إظهار الإنسانية على سبيل التعويض، أيْ تعويض الصمت عن المسالخ البشرية الحالية في أكثر من بلد عربي، وفي مقدمها سورية.
لقد خلّفت الأيديولوجيات، بعد انقضائها ظاهراً، ذلك التعاطف مع القضية الفلسطينية منفصلاً عن فضائه الإنساني، ومنفصلاً بها عن الفضاء ذاته. لا يندر في المقابل رؤية معارضين لنظام بشار، يرفعون أصواتهم ضد كافة أشكال انتهاكاته، لكنهم على عهدهم القديم في إنكار المحرقة النازية أو التشكيك بها. مثلما لا يندر إطلاقاً رؤية فلسطينيين، بل ربما شكل هؤلاء غالبية فلسطينية، يصطفون اليوم مع نظام بشار، لا لأنه هتلر صغير، ولا لأنه داعم فعلي للقضية، وإذ يكاد يستحيل العثور على سبب مقنع لهذا الاصطفاف فمن المؤكد أن دعم الضحايا سفاحاً لا يعبّر عن سوية إنسانية ولا عن استوائها.
في هذا المقام أيضاً، من المفيد التذكير بتلك الحساسية المتدنية إزاء ضحايا الكيماوي في حلبجة، ولم يأتِ من فراغ خروج مظاهرة تضامن في حلبجة مع ضحايا الهجوم الكيماوي الأخير في سورية، فمن خرج في التظاهرة اختبر سابقاً معنى الضحية. عندما قصف نظام صدام أهالي حلبجة لم يجدوا ذاك التضامن المأمول إلا في بعض دوائر الغرب، وأيضاً ذهبت نسبة غالبة من أبناء المنطقة، تشمل السوريين أيضاً، إلى التشكيك بمسؤولية نظام صدام عن المجزرة ونسبها إلى إيران بدلاً منه، أو إلى اتهام الأكراد بالمبالغة في تقدير عدد الضحايا.
هكذا يحيلنا نظام بشار مرة إلى هتلر، ومرة أخرى إلى صدام حسين، ويذكّرنا في العديد من الأحيان بأنه الاستثناء الوراثي الوحيد، مع نظام كوريا الشمالية، ضمن النظم الجمهورية. وإذا كان من الخير للسوريين وعموم المنطقة أنه لم يمتلك ترسانة مجنون كوريا فإن هذا لا يحجب تمثّله مجمل خبرات الإجرام في أنظمة أذاقت البشرية الويلات، وقد قيل الكثير عن التجارب الشمولية التي استلهمها الأسد الأب في ترسيخ دعائم طغيان. وما ارتكبه نظامه منذ انطلاق الثورة تحديداً يدلل على تراكم خبرات إجرامية تكاد تكون خلاصة تطور الأنظمة الوحشية في العالم.
بتعبير رمزي، لن نغامر بالقول إن بشار الأسد هو ابن أبيه، وابن صدام حسين وتشاوشيسكو وكيم جونغ إيل، وابن هتلر وابن بوتين سفاح غروزني. لا لعبقرية شخصية جعلته ملمّاً بتاريخ الإجرام، وإنما لأن نظامه دأب طوال عقود على تبادل الخبرات الإجرامية مع أنظمة مشابهة، ولا يزال منضوياً ضمن حلف يتفرد بتوسل الإجرام وسيلة للسيطرة. وجود نظم أخرى ارتكبت في تاريخها بعض الجرائم لا يقدّم تبريراً، ما دام الإجرام لم يصبح نهجاً رسمياً معتمداً داخل الحدود وخارجها.
من جهتنا، لم يكن ينبغي أن نصبح يهوداً ونختبر المحرقة، أو أكراداً ونختبر الكيماوي. لا تزال الفرصة سانحة للذين لم يختبروا كل هذا كي يرفعوا صوتهم، قبل أن يصبحوا في مثل حالنا الآن.
الحياة
الأسد بطل المحرقة/ بشير البكر
يبدو أنه ليس هناك حدود لجرائم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وقد برهن، منذ بداية الثورة الشعبية في ربيع 2011، أنه فنان جريمة بامتياز، استطاع أن يتجاوز كل المجرمين والأشرار في التاريخ. حين بدأ باستخدام براميل الديناميت التي يلقيها من طائراتٍ مروحيةٍ، ظن الناس أن هذا الاختراع سيكون أقصى ما يمكن أن تصل إليه صناعة الجريمة، ولكنه فاجأ العالم بعد زمن وجيز بسلاح جديد، هو ضرب التجمعات البشرية بالألغام التي تنفجر ما أن تلامس الأرض، وهي ألغام مصممةٌ ضد السفن والآليات الحربية، وكان هدفه من ذلك إلحاق أكبر قدر من الضحايا البشرية والدمار في العمران والبنى التحتية، الأمر الذي يفسر فظاعة الصور الفوتوغرافية لمدينة حلب التي انتهى القسط الأكبر منها كأنه تعرّض لزلزال.
لم يوفر النظام السوري معارضاً له، وطاول أذاه حتى الذين يعتبرهم من المعتدلين. بدأ سياسة التصفيات الجسدية منذ الشهر الأول للثورة، وقبل أن يدخل السلاح إلى مسرح الأحداث، وكان أن باشر حملة اعتقالاتٍ ضد النشطاء السلميين من التنسيقيات التي كانت تنظم مظاهراتٍ، وتم قتل الناشط الشاب غياث مطر ابن داريا وهو يوزّع الورد والماء والخبز على حواجز المخابرات. جرى اعتقاله يوم 6 سبتمبر/ أيلول 2011، وتم تسليم جثمانه بعد أربعة أيام، وآثار التعذيب بادية عليه. وفي هذه الفترة، على ما يبدو، لم يكن قد بدأ النظام ما أسماه تقرير منظمة العفو الدولية، أخيراً، المسالخ التي يتم فيها ذبح المعتقلين، وهو ما وثقه “قيصر” في الصور التي هرّبها من داخل سجن صيدنايا.
وفي الوقت الذي لازلنا تحت صدمة تقرير وزعته الأمم المتحدة قبل أيام عن العنف الجنسي ضد السوريات، وهو ما لم يرد في أي تقرير أمميٍّ من قبل، حتى بتنا اليوم أمام محرقةٍ تحيل مباشرة إلى جرائم النازية ضد اليهود في معسكرات الاعتقال في الحرب العالمية الثانية، ومنها أوشفيتز السيئ الصيت. ونحن نتأمل ذلك، لا نمتلك الجرأة للقول إن هذا هو منتهى الجريمة، فربما فاجأنا عباقرة الجريمة الأسدية بفن جديد للقتل .
حديث المحرقة جاء في تقريرٍ للخارجية الأميركية، يعبر عن صحوة أميركية متأخرة، ولكن حصولها متأخرةً أفضل من عدم حصولها، وحتى يكون لها تأثير يجب أن تترجم إلى ضغطٍ على النظام وروسيا من أجل وقف الجرائم على الأقل، والإفراج عن قرابة 200 ألف معتقل، منهم حوالى 20 ألف امرأة وطفل، وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تذهب أبعد من ذلك، لن يوقفها أحد، وهي ليست بحاجةٍ لمن يوجهها نحو الطريق المناسب، فهي تعرف أن القانون الدولي والعدالة هما الحل المناسب، وحتى يتم إنصاف الضحايا يتوجب إنشاء محكمةٍ دوليةٍ خاصةٍ لمحاكمة الضالعين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وعلى رأس هؤلاء الأسد وأركان نظامه ومن دعمه في حربه ضد الشعب السوري، وخصوصاً المليشيات الطائفية، وفي مقدمها قيادات الحرس الثوري الإيراني.
أحسن وفد الهيئة العليا للمفاوضات بطرح قضية المعتقلين على اجتماعات جنيف، وهو عن هذا الطريق يرفعها إلى مستوى القضايا الأخرى التي يتم التفاوض حولها مع وفد النظام، ولابد أن يذهب الأمر إلى تحقيق دولي يتم من خلاله الضغط على روسيا ونظام الأسد من أجل فتح أبواب سجن صيدنايا أمام لجنة تحقيق دولية للكشف عن وضع السجن والانتهاكات التي جرت داخله.
إذا لم تجرِ محاكمة علنية لهؤلاء المجرمين، فإن الإنسانية سوف تصاب بجرح عميق، لن تشفى منه على مر التاريخ، ولن يقف الأمر عند لعنة التاريخ للذين لم يتحركوا من أجل نجدة البشر العزل، بل سيتجاوزها إلى خلل في الضمير الإنساني، وسقوط الأخلاق والعدالة والقيم وحقوق الإنسان.
العربي الجديد
صيدنايا.. ورقة أخرى للعب الأميركي/ غالية شاهين
كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أخيراً، عن سر جديد اكتشفته أجهزتها الاستخباراتية في سورية، فأعلنت أن “الأسد يحرق جثث المعتقلين، ويقتل 50 معتقلاً يومياً في سجن صيدنايا. وروسيا وإيران تتحملان المسؤولية”، وكأن العالم لا يعرف شيئاً عن هذا، أو كأن روسيا وإيران ستُصدمان بوصول الحقيقة إلى البيت الأبيض.
يدرك السوريون، كل السوريين، منذ عقود، أن أميركا ترصد حركة النمل في العالم، ولا تزال منذ عشرات السنين تحرّك خيوط الدمى على خارطته، وتعبث بكل بلدانه، لتشرف، بشكل مباشر أو غير مباشر، على توزيع ما في جوفه.
وكيلا نقع في مغالطات نظرية المؤامرة، يمكننا، على الأقل، أن نقول بمسلمةٍ لا تقبل التشكيك، إن الأجهزة الاستخباراتية الأميركية تعرف، على الأقل، كل ما يدور في الدول التي تشكّل مناطق استراتيجية للسياسات الأميركية، ومنها سورية بلا شك. وبهذا، لا يمكن اعتبار الإعلان الأميركي عن “محارق” الجثث في صيدنايا وغيرها من معتقلات الأسد، إلا ورقة سياسية جديدة تلوح بها الإدارة الأميركية الجديدة، لأهدافٍ يمكن تخمينها من دون القدرة على البت بحقيقتها.
فعلى المدى القريب، تظهر زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأولى للمنطقة العربية، وفيها سيجتمع مع عدد من القادة العرب في قمم سعودية وخليجية وإسلامية، وسيطرح، في هذه اللقاءات، بلا شك الوضع في سورية، وسير العملية الأميركية في “مكافحة الإرهاب” وإحلال السلام في المنطقة، وهو ما يتعلق بشكل مباشر بمخطط أميركا في التعامل مع النظام السوري، والذي بدأته بشكل علني منذ استهداف مطار الشعيرات، بعيْد الهجوم الكيميائي على خان شيخون. وبالتالي، فإن التصعيد الإعلامي ضد الأسد يتوافق مع السياسة الأميركية المعلنة أخيرا، والتي ستقبض أميركا ثمنها من صفقات السلاح المبرمة، ومن الصفقات السياسية التي ستبرم مع دول الجوار أو العالم العربي المتورّط بالحرب في سورية.
وعلى صعيد آخر، يعتبر الإعلان الأميركي الأخير رسالة سياسية جديدة لكل من روسيا وإيران، وهي تلويحٌ بأوراقٍ وملفاتٍ يمكن استخدامها ضد كل منهما، وذلك لا ينبع من أسباب إنسانية أو صحوة ضمير، لا سمح الله، بل إنه لا يتعدّى كونه أوراق ضغط للتحكّم بخريطة النفوذ على الأرض السورية، وبالتالي التحكّم بخريطة توزيع ثروات الغاز والنفط وأسواق السلاح وغيرها.
ثمّة ما حيك في الخفاء، ويتم الآن وضع الرتوش النهائية عليه، وربما لن يتأخر الإعلان عنه طويلاً. وربما يكون الإعلان الأميركي، أخيرا، عن محارق صيدنايا مجرد حلقة أخرى، بعد عدة تغيرات قد تبدو اعتيادية أو مجرد إشارات (منها تسلم رياض سيف رئاسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وهو اقتصادي بتاريخ نضالي نظيف يُجمع معظم السوريين على احترامه، مع فقدانهم شبه التام للثقة بالائتلاف ممثلاً سياسياً دولياً وحيداً للمعارضة). لكن المؤكد حتى الآن أن الإدارة الأميركية الجديدة، كما القديمة، وما يتبعها في ردود الأفعال من حكوماتٍ غربية وعربية، لم يستطيعوا أن يُقدموا للشعب السوري أكثر من حبالٍ واهية من الأمل الذي لا يلبث أن يتحول كابوساً، بمجرّد تمسّكهم به، وانجرارهم اللاشعوري تجاهه، في ظل يأسٍ بات مطبقاً وخانقاً على كل مكوناتهم.
أيام ثقيلة على السوريين في كل مكان لما تحمله من تغيراتٍ سريعةٍ على الأرض بامتداد واسع من أقصى شمال البلاد إلى أقصى جنوبها، وهي في معظمها مفاجئة ومخيفة أكثر مما تكون مطمئنة. وبموازاتها، يتابع نظام الأسد وحلفاؤه استراتيجياتهم المكشوفة في القتل والتهجير القسري والاعتقال، لرسم سورية المفيدة، إضافة إلى إطلاق المراسيم والقرارات الداخلية وكأن شيئاً لا يحدث في العالم، أو كأنهم لا يزالون ينعمون بالضوء الأخضر الدولي للقيام بكل ما يريدون القيام به.
العربي الجديد
محارق للجثث… جثث للمحارق/ حازم صاغية
قبل بناء المحارق للجثث، بنى النظام السوريّ جثثاً للمحارق. سياسته المديدة هذه شاءت تحويل البشر الأحرار مشاريع جثث، أي بشراً يُحرمون حرّيّاتهم. يُحرمون كراماتهم ورفاههم وتعليمهم. لأيّ شيء يُرشَّح أمثال هؤلاء؟ للحرق فحسب، للحرق كرمى لاستمرار ذاك النظام، كرمى لـ «قضاياه».
بناء المحارق، في هذا المعنى، وقبل أن يكون عملاً صناعيّاً «مستورداً»، بدأ عملاً سياسيّاً «أصيلاً»: السوريّ الذي يصنعه الأسدان، الأوّل والثاني، تبقى حياته في يديهما، تستردّانها في أيّة لحظة تشاءان ذلك. تستردّانها بالطريقة التي تختارانها.
هنا، تعمل ديناميّتان: الأولى، ترفض السياسة بوصفها لعباً وخلافاً في وجهات النظر. تُحلّ، في المقابل، نظرة توحيش إلى السياسة: وطنيّ وخائن، شريف وعميل، قاتل ومقتول. الحيّز السياسيّ ينبغي أن يبقى ساخناً لا يبرد، معبّأً لا يسترخي. القداسة التي تُسبغ على «القضايا» أكثر ما ينقل السياسة من كونها لعباً إلى صيرورتها توحّشاً: هل يُعقَل أن نتحمّل وجهة النظر الأخرى وهناك إسرائيل؟ وهناك أميركا؟ وهناك المؤامرة التي تنوي اجتثاثنا؟ هل يُعقَل أن نؤنسن «العدوّ»؟ هل يُعقل أن نتنازل عمّا هو مقدّس؟
الردّ باجتثاث السياسة يفضي إلى تجثيث البشر: إنّهم «مقاومون» «شرفاء» «وطنيّون» «بواسل»، وقد ينقلبون في ظروف أخرى إلى «عملاء» «جواسيس» «خونة». لكنّهم، في مطلق الحالات، ليسوا أفراداً ذوي آراء ومواطنين ذوي حقوق. «المجد» لهم، لا الحرّيّة والخبز والتعليم، أو الموت لهم.
«داعش» أحد ثمار هذا النهج الذي اتّبعه نظاما الأسدين في سوريّة وصدّام في العراق. في عقارب الصافية، قرب السلميّة، كان آخر استعراضاته للسياسة بوصفها مذبحة.
الديناميّة الثانية تنجرّ عن الأولى وتكمّلها: «الشعب» الذي يصنعه الأسدان «واحد». لا تعدّد فيه ولا اختلاف ولا تمايز. البعد الآحاديّ والتصحّر السياسيّ وإرجاع البشر إلى خامهم الأوّل: هذه بداية المحرقة قبل إشعال النار. إنّه الجوهر القوميّ المزعوم، سلباً وإيجاباً.
لقد ذكّرنا مؤخّراً تعريب كتاب الباحث الفرنسيّ الراحل ميشيل سورا «سوريّة الدولة المتوحّشة» (الشبكة العربيّة للأبحاث والنشر) بكلمات ووقائع تدلّ إلى النزعة هذه، نزعة إنقاص الإنسانيّ في الإنسان، والفرديّ في الفرد، وصولاً إلى الإنسان – الجثّة. حافظ الأسد لم يقتصد في التعبير مبكراً عن ذلك: مثلاً، في رغبته إعفاء طلاّب موالين من الامتحانات الدراسيّة واستخدامهم بما يفيد النظام، رأى أنّهم «يتصدّون لمؤامرات الإمبرياليّة والرجعيّة، وليس لديهم الوقت الكافي للدراسة». إذاً لا للمدرسة، نعم للقضيّة والمقدّس. شقيقه رفعت، وكان لا يزال الرجل الثاني في النظام، كتب في افتتاحيّة ليوميّة «تشرين»، في 1 تمّوز (يوليو) 1980، مبدياً استعداده للتضحية بمليون مواطن في سبيل إنقاذ الثورة.
بالمناسبة: ميشيل سورا، موثّق تلك الوقائع والأقوال، ومحلّل الطبيعة «المتوحّشة» لنظام الأسد، اختطفه في بيروت، أواسط 1985، الحلفاء اللبنانيّون الخلّص للنظامين السوريّ والإيرانيّ. مات بين أيديهم فاحتفلوا بتحوّله إلى جثّة. رموا الجثّة فلم تُكتشف إلاّ بعد سنوات.
لكنْ متى بدأ الانتقال من معادلة «الجثث للمحارق» إلى معادلة «المحارق للجثث»؟ فقط حين توقّفت قدرة النظام السوريّ على صنع الإنسان – الجثّة، حين ثار السوريّون رفضاً لتجثيثهم، بدأ الطور الصناعيّ. في البدء كان الكيماويّ. بعد ذاك أقيمت المحارق.
العقل الساخن في طوره الأوّل، والبارد في طوره الثاني، أنجز ما سمّاه هوركهايمر «تحويل المجتمع إلى طبيعة ثانية أقسى من الأولى». لكنّه إذ يمارس قسوته هذه فإنّه لا يفعل إلاّ الخير والضرورة. أليسوا جثثاً أولئك الذين يُحرقون؟ أوليس حرق الجثّة تكريماً للإنسانيّة، إن لم يكن تكريماً للجثّة نفسها أصلاً؟
إنّ الهراء «الوطنيّ والقوميّ والتقدّميّ» الذي كتبه وقاله مناصرو الأسد، سنة بعد سنة، لا يعلن إلاّ هذا: أنّ السوريّين، وقد أحيلوا جثثاً، يستحقّون موتهم. أنّ قتلهم قتل للشيطان الذين هم أنساله. يقيم فيهم. يقيم في هويّتهم. في ثقافتهم. في وجوههم. في ملابسهم. في تخلّفهم… إلى المحارق دُر!
الحياة
محرقة في «المسلخ البشري»/ بيسان الشيخ
بعدما وصفت منظمة «العفو الدولية» سجن صيدنايا بـ «المسلخ البشري» في تقريرها الأخير، تأتي اليوم تقارير جديدة لتضيف نجمة إلى خدمات القتل والإبادة التي يقدمها النظام السوري لنزلائه في تلك البؤرة المظلمة، فتكشف عن وجود محرقة يتم فيها التخلص من جثث المعتقلين في شكل شبه يومي. لا تزيد الصدمة والفجيعة على الواقع شيئاً. فقد باتت عبارة «الهولوكوست السوري» ملازمة للوقائع الدائرة على الأرض في السنوات الأخيرة، وإن لم ترق التسمية الى مستوى الدليل الجنائي القاطع في حالات كثيرة. وإذ انشغلنا وانشغل كثيرون بالبحث في دقة مصطلحات كـ «الإبادة الجماعية» و «الهولوكوست» وما إذا كان بشار الأسد يشابه هتلر أو يفوقه إجراماً، مضت آلة القتل السورية في اجتراح الحلول لنفسها، والاستفادة من الوقت الضائع والهوامش الكثيرة المتاحة لها للإفلات من العقاب ومن أي محاسبة محتملة.
أما الآن، فقد بات هناك دليل دامغ للمشككين والباحثين عن الدقة العلمية: ثمة محرقة في سجن صيدنايا. ماذا بعد؟
قد تبدو للوهلة الأولى تلك الطريقة في التخلص من آثار الجرائم المرتكبة في السجون السورية تسلسلاً طبيعياً لمسار الأمور. حتى أن البعض تساءل لمَ المفاجأة والاستغراب على اعتبار أن الموت، أياً كانت طرقه يبقى أهون على الضحايا من مرّ العذاب الذي يكابدونه في الأقبية الأسدية. وإنه إذّاك لا فرق بين من يموت قصفاً، أو قنصاً أو جوعاً أو تعذيباً… أو أخيراً حرقاً، إلا بدرجة العذاب التي تسبق رصاصة الرحمة تلك، أياً كان شكلها. وذلك لا شك مفهوم بعد الإحباط واليأس من عجز المجتمع الدولي وتلكؤه عن القيام بأدنى واجبات حماية المدنيين وإحالة المجرمين أقله الى التقاعد السياسي، إن لم يكن محاسبتهم أمام قضاء نزيه وعادل.
لكن لا. ثمة جديد هذه المرة، وهو وجود محرقة. ذلك ليس بالتفصيل العابر ولا هو مجرد شكل آخر من أشكال الموت. لقد باتت لنا محرقتنا. أول محرقة عربية (مثبتة) تعمل بفاعلية عالية وبوتيرة شبه يومية، في وضح النهار وبمحاذاة مناطق مأهولة وسياحية. تنفث أبخرة الجثث المتفحمة في ذلك الفضاء الأهلي، معتمدة على احتمال أن تختلط الروائح المريبة بعطن مزارع الدجاج القريبة. هكذا، تعيش محرقة بموازاة حياة شبه طبيعية، كما عاشت على هذه الشاكلة مقابر جماعية ومعتقلات منذ حكم الأسد الأب وحتى اليوم. إنها صورة إضافية لذلك «الشر العادي» المرافق للفظاعات التي توصف في كل مرة بأنها «غير مسبوقة». سوى أن الوسيلة هذه المرة لا تقل أهمية عن الغاية نفسها.
والحال أن المحرقة بذاتها ليست أداة القتل. ووفق التقارير التي تسربت أخيراً من ذلك المسلخ، وقبلها تقارير «سيزر»، فإن قتل المعتقلين سابق على التخلص من جثثهم بوقت قد لا يكون وجيزاً، ولعله جاء حلاً سريعاً ومتسرعاً في آن، بعدما باتت المقابر الجماعية خطراً محدقاً بالنظام، ودليلاً قابلاً للوصول اليه. وكذلك هي تقارير الوفاة الصادرة من المعتقلات والمستشفيات والتي توثق آلاف الحالات من الموت بـ «الجلطات الدماغية» في أيام متقاربة جداً، والتي شكلت في مرحلة ما إجراء إدارياً داخلياً للتأكد من «تنفيذ المهمات».
أما إحالة الأجساد الى رماد، فوسيلة مضمونة لإخفاء أدلة الجريمة، ومحو علامات التعذيب وإغلاق الملفات مرة وإلى الأبد. وهي الى ذلك، تلغي إمكان إقامة قبور للضحايا، وشواهد تحمل أسماءهم وقد تتحول مزارات لذويهم ولأجيال قادمة. إنها تخنق الأسئلة الملحة حول ظروف القتل، ومكانه، ومرتكبه، والأهم من ذلك التهمة التي دفعت اليه. فالمحاكمات الصورية التي كشفتها التقارير أيضاً، والتي لا تستمر لأكثر من ثلاث دقائق، تؤشر الى نفاد صبر حيال حياة الأشخاص. هناك من يتهافت على إرسال المزيد من الناس للقاء حتفهم بطريقة بيروقراطية باردة. ثم جاء من قرر أن يمعن أكثر في التخلص منهم عبر حرق جثثهم، في وقت لا يزال غير معروف متى اعتمدت تلك الطريقة وإن كانت شائعة في المعتقلات السورية أو هي استثناء في صيدنايا.
وإذا كانت المحارق ارتبطت حتى اللحظة بالحقبة النازية ومعسكرات الموت في أوشفيتز وغيرها، واعتبرت الى حد بعيد ثمرة الثورة الصناعية ومكملتها في آن، فقد ذهبت محرقتنا خطوة أبعد. فمعلوم إن قطارات الموت النازية حملت الضحايا في رحلة الخنق بالغاز على أمل الإنقاذ. هكذا، «غرر» بالمعتقلين اليهود وتمّ إيهامهم بأن تلك هي رحلة الخلاص والانعتاق ليأتي الحرق لاحقاً.
وكان النازيون يدركون أن وتيرة القتل تعتمد على قدراتهم في التخلص من الجثث بكفاءة وفاعلية بحيث يحدد عدد الجثث التي يمكن حرقها في غضون 24 ساعة، عدد الأشخاص الذين ينبغي قتلهم بالوتيرة نفسها. وذلك ما سمي بـ «القتل الصناعي».
أما في الحالة السورية، وعدا عن أن أحداً لم يكترث بمنح ذرة أمل للمعتقلين قبل تصفيتهم أو تركهم يموتون من تلقائهم تحت التعذيب، فإن القتل بذاته لم يكن وحده المرتجى، وإنما هو الإفناء بعد الإماتة. وذلك واقع جديد لا مناص منه. وهو الى حد بعيد، ما يجعل المحرقة السورية ممعنة في الرغبة بتسفيه ضحاياها فوق جعلهم ضحايا أصلاً. وهو دأب النظام في معاملة السوريين علناً وبلا مواربة منذ أن انتفضوا عليه انتفاضتهم الأخيرة في 2011. فإذا كانت العبارة الشائعة تقول إن فلاناً ثمنه رصاصة، للدلالة على بخس حياته، فقد جاء النظام الأسدي ليقول لا، بل ثمنكم عندي أقل من ذلك بكثير. يكفي أن أحشو براميل وخزانات بفضلات لأقتلكم. والمحرقة المكتشفة أخيراً في صيدنايا، تأتي بهذا المعنى تتمة لبراءة اختراع البراميل، ودليلاً إضافياً على الإبادة البدائية في وحشيتها والتي يحرم السوريون كل يوم من حق مقاومتها.
الحياة
لماذا تستغربون محرقة بشار؟/ الياس حرفوش
لا تضيف محرقة صيدنايا الكثير الى الجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد منذ ست سنوات بحق السوريين. فقد بات أهون ما يمكن أن يصيب السوريين على يد هذا النظام هو إحراق جثثهم. وسواء كان العدد الذي يجرى الحديث عنه للجثث التي تم إحراقها 5 آلاف أو 11 ألفاً أو حتى خمسين ألفاً، فإنه لا يمثل شيئاً بالمقارنة بنصف مليون سوري سقطوا ضحايا لجرائم هذا النظام على مدى السنوات الست الماضية، فضلاً عن ملايين الجرحى والمشردين والمهجرين. كما لا يمثل الكثير مقارنة بحجم الدمار الذي أصاب المدن السورية، والقتل الذي لحق بأهلها نتيجة الغازات الكيماوية والبراميل المتفجرة التي تلقى فوق رؤوسهم.
إحراق جثث السجناء هو بأي مقياس أهون من تعذيب الضحايا في الزنازين حتى الموت، أو رميهم من سطوح المنازل، أو إلقاء الغازات السامة عليهم ليكون مصيرهم الاختناق وهم في غرف النوم، أو محاصرتهم وتجويعهم مع أطفالهم للضغط عليهم وترحيلهم من بيوتهم. ولهذا، يصبح استغراب حرق الجثث هو الذي يجب استغرابه. لقد باتت كل الفظائع منتظرة من النظام السوري، طالما أن مشروعه الوحيد الآن هو المحافظة على بقائه، مهما كان الثمن الذي ستدفعه سورية من وحدة أراضيها ودمار مدنها وتشتيت شعبها في دول الجوار وفي مياه البحار وفي دول الأرض.
سبق أن تم تسريب مجموعة كبيرة من الصور على يد ضابط منشق عرف بلقب «القيصر»، لعشرات الجثث التي قضى أصحابها تحت التعذيب في سجون الأسد، وبدت الجثث مثقوبة ومحترقة وكأنها تعرضت لمواد حارقة، ومعبأة في أكياس نايلون. وتحدث سجناء سابقون في صيدنايا استطاعت منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشونال) الوصول اليهم عن هذا السجن ووصفوه بأنه «أسوأ مكان على سطح الأرض». فيه يتم إبلاغ المعتقلين: «أنتم لم تأتوا الى هنا لتموتوا بل لتتعذبوا». أمام وحشية كهذه، لا يصعب أن نتصور أن تكون أمنية أي سجين هي الموت، ليتخلص من المصير الذي ينتظره على يد جلاديه.
بات صعباً إحصاء جرائم النظام السوري في مقال واحد. هناك منظمات دولية حقوقية وإنسانية تقوم بعملية التوثيق، لعل المسؤولين عن ارتكاب هذه الفظاعات يقفون يوماً ما أمام العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقون. من هذه التحقيقات ما تجريه الأمم المتحدة من خلال آلية خاصة تم إنشاؤها في كانون الأول (ديسمير) الماضي، بهدف تحديد المسؤوليات عن ارتكاب هذه الجرائم، اسوة بما حدث مع المجرمين الصرب الذين ارتكبوا جرائم مماثلة، من تعذيب سجناء وإحراق جثث وتدمير مدن وأحياء كان يسكنها المسلمون والكروات في حرب البوسنة في أواسط التسعينات من القرن الماضي. ولعل إقدام نظام الأسد على بناء محارق في سجونه في هذا الوقت يهدف الى محاولة إخفاء آثار الجرائم، والزعم أن الضحايا لم يكونوا موجودين أساساً.
تتشابه الجرائم ويتشابه المجرمون. وعندما يفقد الرئيس أو القائد أو الضابط حسّه الإنساني، يصبح سهلاً عليه ارتكاب كل الفظاعات. طبيعي أن تعيد صورة إحراق الجثث الى الأذهان صور المحرقة التي ارتكبها أدولف هتلر بحق ضحاياه من يهود وسواهم في قطارات الموت وأفران الغاز في الحرب العالمية الثانية. ولا يختلف ما يفعله بشار الأسد كثيراً، لا من حيث الطريقة ولا الهدف. القضاء على من يُفترض أنه عدو النظام حتى إحراق عظامه لإخفاء هوية الضحايا ومنع ذويهم من الحصول حتى على جثثهم لدفنها بكرامة، أما الهدف فهو تنظيف البلد من كل المعارضين من خلال القضاء على أي أثر لهم، ولو كان جثة هامدة.
في ألمانيا، قام النظام النازي بالقضاء على معارضيه وصولاً الى الحرق بحيث لا يبقى سوى أبناء العرق الآري، الذين كان ذلك النظام يعتبر أنهم العرق الوحيد الذي يمكن «الإفادة» منه. وفي نظام بشار الأسد، ليس مسموحاً البقاء في «سورية المفيدة» سوى لمن يخدمون النظام ويوالونه بذلّ، أما الأكثرية الباقية فمصيرها الموت، وإذا حالفها الحظ الرحيل الى خيم اللجوء ودول الشتات.
الحياة