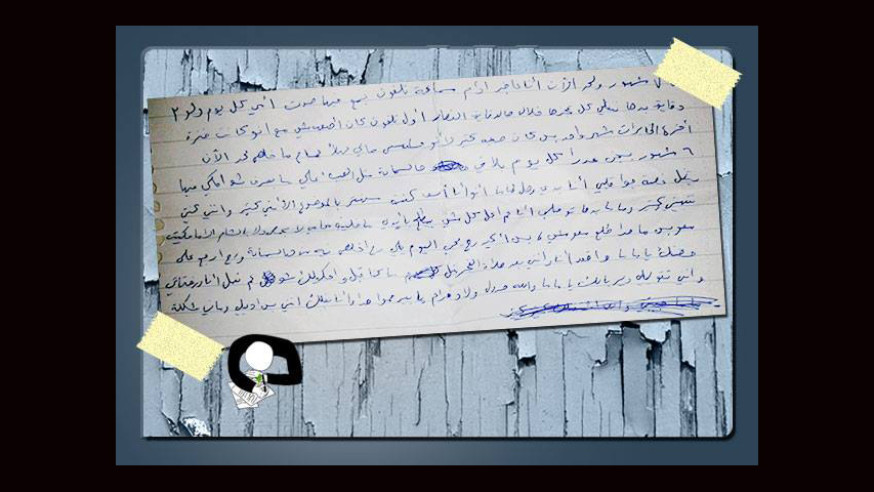فنون الإعدام/ كاتيا يوسف

تنوّعت وسائل الإعدام عبر الزمن، وتفنّنت لا بل أبدعت أوروبا فيها، وربّما أكثرها إيلاماً، كان وضع الإنسان حياً في الماء المغلي، وتركه يعاني حتّى الموت. إلا أنّ إبداع العقل الشيطاني، الذي ينتعش في باطن الإنسان بعد وفاة إنسانيته، خلق نوعاً خيالياً للموت، ومراسم تعذيب تجعل الضحيّة تختبر أشكالاً وألواناً من الألم.
كانت إحدى عمليات الإعدام تمرّ بمراحل، لا يمكن أن يتخيّلها بشر. في البداية يُربط المجرم بقطعة خشبية خلف حصان، ويُجرّ إلى مكان موته، يلي ذلك تعليقه أو شنقه في الفلاة إلى أن يحتضر، وقبل أن يموت يُمدّدونه على طاولة، وينتزعون أحشاءه ويخصونه أمام عينيه، وبعد ذلك يقطعون رأسه. وتحدّث صموئيل بيبس، وهو كاتب إنجليزي ووزير بحرية بريطاني في ذلك الزمن، عن هذه العمليّة التي شهدها بعينيه.
فيما بعد تميّزت طبقة النبلاء والطبقة الأرستقراطية في بريطانيا بـ”شرف الإعدام” عن طريق قطع الرأس، بينما حُكم على المجرمين العاديين بالموت شنقاً، أو غرقاً أو تقطيعهم. واقتصر قطع الرأس على المحاربين والنبلاء، أمّا النساء فغالباً ما كنّ يُعدمن حرقاً.
على ما يبدو أنّ تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” يكرّم ضحاياه بموت مشرّف، عن قصد أو عن غير قصد.
وكما يرفع “داعش” اليوم رأس الضحيّة ممسكاً به عالياً في الهواء، كان الجلاد في العقود الغابرة في أوروبا يقوم بالمثل، ليشهد الجميع على إجرام الإنسان بحقّ أخيه الإنسان. ويعتقد بعض الأطبّاء أنّ رأس الإنسان يشعر بكلّ ما يحدث حوله لمدّة عشر ثوان بعد القطع، بيد أنّ هذه المعلومة مشكوك في صحتّها.
واعتُبِرَ قطع الرأس الأسلوب الأقلّ ألماً، خصوصاً إذا كان السيف ماضياً وكان الجلاد سريعاً، لذلك كان يُنصح بأن تقدّم الضحيّة قطعة ذهبية إلى الجلاد كي يتقن عمليّة الإعدام. وفي عام 1286 احتلّت المقصلة في بريطانيا عملية قطع الرؤوس بدل السيف، واستمرّت لغاية القرن الثامن عشر. وكان اللورد الاسكتلندي سيمون فريزر آخر شخص قُطع رأسه في بريطانيا عام 1747.
لا بدّ أنّ “داعش” يجهل هذه المعلومة التاريخية، وإلا لما أقدم على تشريف ضحاياه بموت كريم، لأنّه يرغب في إذلال ضحاياه.
اللافت هو استهجان بريطانيا والغرب إجرام “داعش”، وهم السبّاقون دوماً، ليس في هذا المجال فقط، بل في جميع الميادين، ومصدّرو ثقافة قطع الرؤوس.
لم يَخلُ تاريخ أيّ من شعوب الأرض من عمليّات الإعدام والقتل، باسم الدين ودفاعاً عن الله، من بداية الكون مع قابيل وهابيل إلى اللحظة الراهنة، حيث يحتلّ “داعش” الصدارة، ويبشّر بالخلافة الإسلامية والعيش وفق شريعة الله على الأرض، وفق ادّعاءات التنظيم.
على مرّ الأزمنة، تميّز معظم المبشّرون بالوحشية واللاإنسانية. فهل نسي جيل أوروبا اليوم التاريخ الدموي لأجداده؟ أو ربّما لم يدرسه في كتبه المدرسية أو قد يكون تعلّم العبر من الماضي. لذلك نراه يتشدّق بحقوق الإنسان، التي نجح إلى حدّ ما في احترامها.
في إحصاءات أخيرة هذا العام، تبيّن أنّ سكّان لندن هم الأكثر جموداً، لا تعلو وجوههم ملامح حزن ولا فرح، ويسيرون دوماً على عجل، في أنفاق القطارات وشوارع مدينة الضباب، كأشباح مشغولة في البحث عن الحياة.
ولا يزال متحف الشمع، الشاهد الأمثل على الطغيان، الذي خيّم على بريطانيا في العصور الغابرة؛ إذ يشهد على غياب الإنسانية مذّ ذاك، من خلال المقصلة الهابطة على الرّقاب الموجودة في إحدى زواياه، ومهارة النحّات، الذي صوّر نظرات الإهانة على محيّا هؤلاء النّساء، القابعات في منعطفات الطرقات، نصف عاريات، يعرضن أجسادهن لقاء جنيهات معدودات.
اليوم اندثر الظلم الاجتماعي في أوروبا، ولم يبقَ منه سوى متاحف، إذ رفضت إنسانية الكثرين أن تقتل مثيلاتها في هياكل الآخرين، وجهدت لإحياء السّلام في دهاليز كلّ نفس بشرية.
انسلّ بصيص أمل في القضاء على ثقافة الحرب، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية، في معظم دول أوروبا. وجهدت الدول المنتصرة في ترسيخ ثقافة السّلام، من خلال تدوينها في نصوص مكتوبة داخل قوانين الأمم المتحدة.
وطُبّقت القوانين بصورة جليّة في الغرب، أكثر منها في مناطق سُميت بـ”بقية دول العالم”. ولكن هل تفوّق هؤلاء على الشّرقيين بإنسانيتهم؟
يُشاع أنّ بلاد الشرق يسودها الطغيان، وتجهل شعوبها معنى المساواة أو الحريّة، بيد أنّهم، بعيداً عن عثرات السياسة والدّين، لم يتحوّلوا إلى ماكينات ناطقة، ولم يفقدوا بساطة الحياة الاجتماعية، رغم عبث موجات غريبة عنها بإنسانيتها ومحاولات حقن الأدمغة بثقافة القتل وتعليبها ضمن فكر أحادي.
ساهم “داعش” إلى حدّ ما في تثبيت تلك الصورة الهمجية، التي رسمتها صحافة الغرب وثقافته في أذهان شعوبها. وباتت ثقافة الإنسانية في الشّرق تجهد للترويج لذاتها وكأنّها بضاعة انتهت صلاحيتها. وذلك في محاولة يائسة لتبديل الصورة السلبية.
فكثُر المنادون بالإنسانية، وبانت شعارات تدعو إلى تحرير الإنسان من طائفيته وعنصريته ومذهبيته، والإيمان بها وحدها كي يتخلّص من عقدة الذنب، التي تلازمه تجاه أبناء جلدته.
ورغم تبرّؤ غالبية العرب من “داعش”، خشية إلصاق تهمة الإجرام والإرهاب بهم، فشل هؤلاء في انتزاع فتيل العنصرية، الذي اشتعل في أوروبا تجاه الآسيويين عموماً والإسلام والعرب خصوصاً، وبات من الصعب إطفاؤه.
تقاعدت الإنسانية منذ زمن بعيد، لدى غالبية سكّان الغرب والشّرق. وبقيت معتزلة مهنتها، إذ فقد الكثير من الغربيين غاية الحياة، وبات الاكتئاب مرض العصر لديهم، وما زال الشرقيون يعانون ويلات الحروب.
لو كان في إمكان الإنسانية أن تبصر، لرمقت هؤلاء المتفلسفين بشؤون الحياة منذ الأزل، وأسفت على حالهم.
أجيال بعد أجيال، يتطلّعون إلى رسم المعمورة بلون واحد. ولم يتوانَ “داعش” عن إثبات ذلك بالدليل القاطع اليوم، وذلك من خلال قطع رأس كلّ من يخالفه الرأي. غير أنّ لعبة القدر شاءت أن يمنح “داعش” الضحيّة، “شرف الموت”، من حيث لا يدري.
العربي الجديد