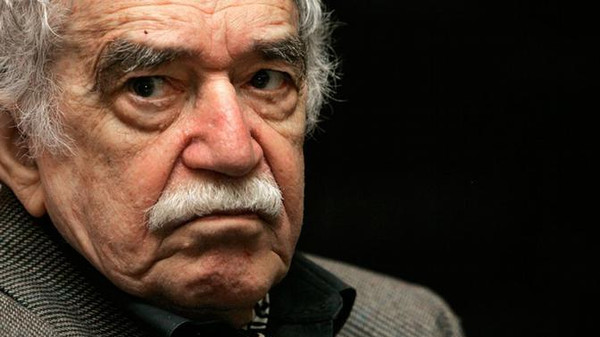في العثرات وتداعياتها/ منصف الوهايبي

شدّني في ما شدّني هذه الأيّام في تونس وخارجها، كثرة الحديث عن العثرات، حتى أنّني تعثـّرت بين مقال ومقال. ولولا عكاّزي الذي ورثته عن الوالد، وهو كلّ نصيبي من الميراث، لذهبت في خبر كَانَ.. وكَانَ. فأمّا «كان» الأولى فبمعنى حدث ووقع ووجد وصار. وأمّا «كان» الثانية فمن كان يَكين كينا (ومزيدها استكان) أي خضع وذلّ. وهو ينضوي إلى الألفاظ التي تفيد الحركة والوجهة واللجوء… ومن اللغويّين من يجعله من السَّكِينة، وأنّه في الأَصل اسْتَكَن أي افتعل من سَكَن، فمُدَّتْ فتحة الكاف بالأَلف كما تمدّ الضمّة بالواو والكسرة بالياء. ولكان هذه وقرينتها، أحوال شتّى لا نحبّ أن نسوقها ها هنا حتّى لا يتحوّل حديثنا إلى حديث في النّحو أو في اللحن؛ ولا نحبّ أن نجاذب الأستاذ هادي حسن حمّودي مقالاته الممتعة في «القدس العربي».
العثرات المشهورة في بلادنا هذه الأيام عثرات «الفساد والفاسدين»، وعثرات بعض نوابنا في البرلمان، وقد أخذ يرتج على بعضهم خوفا أو هلعا، من شرّ مُحدق.
وأمّا في بلاد الآخرين فأشهر العثرات التي لا تُنسى، عثرة بوريس يلتسين وهو واقف يستقبل ضيوفه. وقد نجا إذ هرع إلى نجدته حارسه قبل أن يسقط. ولو وقعت الواقعة في بلاد العرب لنكّلوا بالكاميرامان، والمخرج والمدير العامّ للتّلفزيون؛ أو لردّوا الأمر إلى الإرهاق في العمل والتضحية وكثرة الإجهاد في سبيل البلاد والعباد.
وفي تاريخ العثرات أيضا عثرة الرّفيق الراحل كاسترو، الذي لم يجد من يهرع إلى نجدته فوقع أرضا؛ وهو الذي كان يخطب واقفا ساعاتٍ طِوالًا.
وهناك عثرة جورج بوش أو عثرات لسانه، ولكنّه كان محظوظا، فقد كان يسقط ويقوم و»يعملها طيحة بتكربيسة» كما يقال بالتونسي.
وهناك من يعثر فلا يجد ما يتمسّك به سوى لحيته، وذلك أخفّ الأضرار. ولكنّ الأخطر أنّ بعضهم قد يعثر في لحيته وتلك هي الطامة التي ليست بعدها طامة. وهناك الذي يعثر به الحظ أو هو يعثر بالحظّ. وهناك الذي يعثر به الزّمان والزّمان من ذلك براء فهو الذي يعثر في عباد الله الذين هم كالجبال الرّواسي لا يتحرّكون ولا يتزحزحون؛ لا ثباتا على مبدأ، ولكن وهنا وخمولا وكسلا وذلاّ.
غير أنّ ما يحيّرني في شأن العثرات أنها تصيب الماشي كما الرّاكب كما الطّائر كما السّابح. فأمّا الماشي والرّاكب فقد فهمنا، فالطّريق تكون أحيانا وعرة كثيرة الحفر، كما هو الشأن في كثير من قرانا ومدننا؛ وقد رأيت النّاس يقفزون في شوارعها وأزقّتها قفزا؛ كأنّهم أرانب أو يرابيع. وهناك الحفر التي تحفر نفسها أي تنحفر، حتّى إن لم نصدّق؛ فكلّ حفرة تُحفر بفعل فاعل ظاهر أو مستتر. وهناك الحفر التي يحفرها بنو الإنسان، ومن حفر لأخيه حفرة وقع فيها. على أنّي رأيت كثيرين يحفرون لأخوتهم ولا يقعون.
غير أنّي أريد أن أشير إلى أمر قد يخفى، فكثير من النّاس يحمّلون الِرّجل (بكسر الرّاء أو كسر الأرجل) مسؤوليّة العثرات؛ وهي من ذلك براء. فالدّاء في الرّأس وليس في السّاق؛ فهو الذي يشرد ويسهو ويغفو أو يحلم وهو يقظان، أو يطاول السحاب وهو «شبر وأربعة أصابع» فلا يرى ما أمامه ولا ما وراءه، ولا ما عن يمينه ولا ما عن شماله، فهو أعمى البصر والبصيرة .
أمّا الطائر والسّابح فقد أعيانا البحث والتـّنقيب، ولم نجد لعثراتهما سببا، والأرجح عندنا أنّ العثرة في الرّأس، وليست في السّاق. كما أنّ هناك من يحاول أن يسبح وهو لا يجيد فنّ العوم، فيقضّي عمره كما يقول المثل التونسي «يعوم في الناشح» وهو من جذر (ن.ش.ح) والنشوح هو الماء القليل. وهناك من يحاول الطّيران أو يتوهّم أنّه طائر، وهو مهضوم الجناح أو مقصوفه، أو هو بلا أجنحة أصلا.
وليس كـلّ من عثر زلّ وكبا، فهناك من يعثر على حاجته دون جهد أو بمعنى أصحّ يعثرون له على حاجته، كذاك الباحث عن قطعة أرض يبني فيها قبر الحياة أو قصرها، فإذا هو بين عشيّة وضحاها وبقدرة قادر، يعثر على هضبة في منطقة أثريّة؛ لن يعثر فيها علماء الآثار ولو قلبوها رأسا على عقب حتّى على شقَفة فخّار. وبدل أن تبقى مهملة مهجورة فأولى أن يستفيد منها الأقربون وهم أولى بالمعروف. وهذا ملفّ من ملفّات الفساد المفتوحة في بلادنا، ويبدو أنّ أتونَها نقابيّون وسياسيّون.
وهناك من لا يعثر طول حياته على شيء حتى لو قلب الدنيا «ساسها على رأسها». وأدهى من هذا كلّه هناك من يَضيع فلا يعثر على نفسه ولا يعثرون عليه. وهناك من يعثر على «رأس الفتلة» كما يقولون؛ وهي ليست الفتلة بمعنى شدّة عصب الذراع، ولا الفتلة بمعنى حَبّ شجر العضاه. وإنّما هي من فتل الخيط أو الحبل أي لواه، ومعناها أنّه أمسك بطلسم المشكلة فسهل عليه فكّ رموزها وخفاياها. وهذا علم لا يدّعيه عامّة الناس، وإنّما هو وقف على القلّة الناّدرة الذين يديرون شؤون الدنيا كلها، وبعضا من شؤون الآخرة أحيانا.
ومع أنّي لست شكّاء بكَاء فقد عثرت في حياتي، أي زللت وسقطت ثم نهضت وعثرت على بعض ضَوالّي، دون جهد كبير أحيانا، وبمحض الصّدفة أحيانا. كما عثرت على نفسي قبل أن تضيع منّي. وربّما كان ذلك هو الغُنم العظيم الذي فزت به. ولكن ليس أحلى من أن تعثر على الشيء صدفة، حيث لا تنتظر، ووقت لا تنتظر، كما عثر أخ لي على الماء في باطن وادٍ لا زرع فيه.
ولهذا الوادي (مرق الليل) حكايات، فقد ذاق منه أهالي القيروان الخيرات كما الويلات؛ وهو الذي كان يسقي بساتينهم وحقولهم، ويعنّ له أحيانا أن يفيض على حاجاتهم، فيجرف غرسهم وزرعهم ويغمرهم وديار حضرهم وخيام بدوهم؛ ويعود بهم إلى حيث كانوا حفاة عراة جياعا؛ حتى منّ الله على دولتهم بالرأي الحصيف، فبنت لهم سدّا منيعا يحصر لهم ماء الوادي ويخزّنه لهم أيّام الشدّة والجفاء والجفاف. غير أنّ السدّ لم يعمّر طويلا ويبدو أن شرخا بليغا قد أصابه فجفّ وغاض ماؤه؛ وحرم أهالي القيروان من خيراته وويلاته. ولا يذهبنّ في ظنّ أصحاب السوء أن الشّرخ كان بفعل فاعل أو جهل جاهل، فالدّراسات كما الإنجاز كانت طبق المواصفات والمعايير الفنيّة لأهل العلم والخبرة والكفاءة المستوردة من وراء البحار. وبعد فهذه أمور تحدث كل يوم كما هو الحال في كثير من مدارس الريف خاصّة، حيث الشقوق بين القاعات تتيح للتلاميذ أن يتابعوا حصّة الدرس في هذه القاعة أو تلك، أن يهجروها إلى غير رجعة؛ وقد تداعت كلّها للسقوط. غيرأنّ مهندسينا أفلحوا في إنقاذ ما تبقّى من الأبواب والأحواض والمراحيض. وتلك مكرمة لا تنسى لهم، فقد ضمنوا بذلك للتلاميذ أن يجدوا على الأقلّ أين يقضون حاجتهم البشريّة؛ وتلك مهمّة لا تقبل تأخيرا أو تأجيلا. وفي بعض مدننا العامرة اقتلعت زوبعة بسيطة لا تتعدى زوبعة في فنجان سقفي قاعتي رياضة، واقتلعت معهما مئات آلاف الدنانير ذهبت أدراج الرياح. ولا أحبّ أن أبدو متحاملا على مهندسينا فقد أبلوا بلاء حسنا في ميادين أخرى؛ فأنجزوا أنفاقا تغمرها المياه كلّما نزل الغيث ولو قليلا، وحموا مدنا كثيرة من الفيضانات. وإذا حدث ما عكّر صفو إنجازاتهم، كأنْ تجرف المياه عباد الله بسيّاراتهم وأحلامهم وآمالهم وأحزانهم، مثلما حدث في» برج العامري» ذات يوم؛ فالذّنب ليس ذنبهم؛ وإنما هي أحوال الطقس التي تتغيّر دون حسيب أو رقيب.
سماء تونس هذه الأيّام، مثل سماء العالم العربي؛ تنذر بعاصفة وشيكة والرّياح بدأت تذرُو أكوام التبن والحشائش والأغصان الجافّة. وللرّيح في بلادنا صولات وجولات، فيا ما اقتلعت وكسّرت وذرت.. ولكن ما كلّ ريح بلاء ومصيبة؛ فهناك الرياح اللواقح تحبل لرفيفها الأشجار بالثمرات الطيّبات، كما النظرات اللواقح تحبل للحظها القلوب بالحبّ والشهوات. وهناك من يكون طيّب الرّيح كريح يوسف. وهناك من يكون خبيث الريح ولو استحمّ في عطور كريستيان ديور. وهناك من صال وجال ولكنّه ذهب مع الريح إلى غير رجعة .وهناك من كاد كيدا وجمع وطرح ولكن جهده ذهب أدراج الرياح. وهناك الريح الجنوب والريح الشّمال والريح الصّبا أي الشرقيّة. وهناك الريح الدّبور أي الغربية وأسوأ الرياح كلها الريح النكباء التي تدور بالبيت، فلا يتعيّن لها مهبّ؛ وهي كالدّوامة ويسمّيها أهل البادية «السحّارة» تقتلع الشيء من جذوره وترمي به في هوة محفورة في السماء سحيقة. وللقارئ أن يضع هذه الدول العربيّة التي يتعثّر بعضها ببعض أو في بعض؛ في أيّة ريح شاء.
كاتب تونسي
القدس العربي