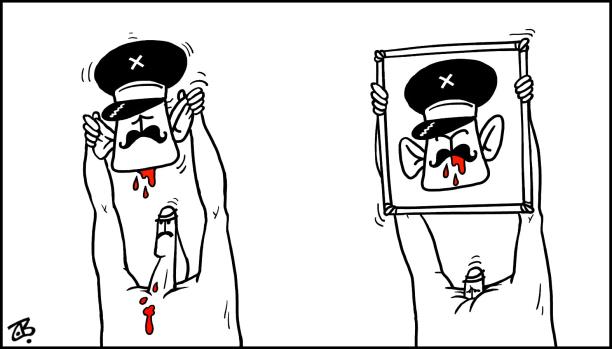ما العمل؟
أنطوان الدويهي
في ظل الثورات المستَعرة في أكثر من بلد في المنطقة، كان نحو مئة شخصية مسيحية لبنانية أطلقت “نداء الى مسيحيي لبنان والعالم العربي” (“النهار”، 28/5/2011)، ردّ عليه الشاعر والمفكّر أدونيس (“النهار”، 7/6/2011). ويشير هذا النقاش الى أزمة الفكر اللبناني والعربي إزاء مسألة التغيير والحداثة، بمنهجيته ومفرداته ومضامينه، وهي أزمة مستمرة منذ نهضة النصف الثاني من القرن التاسع عشر الى اليوم. وليس من سبيل إلى تطوير هذا الفكر من دون الإضاءة عليها.
يأخذ أدونيس على المثقفين المسيحيين اللبنانيين المئة توجّههم، بصفتهم المسيحية، الى “مسيحيي لبنان والعالم العربي”، بدلاً من الانطلاق من صفة مواطنيتهم اللبنانية أو العربية للتوجّه الى كل العرب بصرف النظر عن أديانهم وطوائفهم. وهو يرى في منحى “نحن” (المسيحيون) و”أنتم” أو “هم” (المسلمون)، “لغة دينية تندرج في السياق التقليدي الموروث من القرون الوسطى” ويشكل “توكيداً آخر” لتراث تلك المرحلة.
لكن أدونيس، ويا للمفارقة، يتوجّه بدوره، في خاتمة ردّه، الى المسيحيين اللبنانيين والعرب، والشخصيات المئة منهم، بصفتهم “مسيحيين”، ويدعوهم الى القيام بدور ريادي في المشرق العربي بكونهم “مسيحيين”، فيقع في سياق اللغة نفسها التي عابها على من انتقدهم.
أزمة الفكر التغييري
أودّ الإيضاح، أولاً، منعاً للالتباس، اني على صعيدي الشخصي لم أوقّع هذا النداء، كما لم أوقّّع في الماضي أي بيان أو وثيقة ترتكز على هوية دينية ما. فأنا، في صورة تلقائية، لم أطرح ولا مرّة نفسي فكرياً وسياسياً وثقافياً كـ”مسيحي لبناني”، في أشد لحظات الماضي اللبناني المتوتّر، وعلى مدى حياتي، واليوم أيضاً. فالقضية التي انتميت اليها على الدوام، هي قضية الحرية البشرية، ثقافة الحرية ونمط الحياة المرتبط بها، في المكان اللبناني كما في كل مكان.
ثم إني لا أبغي من هذه المقالة لا الرّد على أدونيس ولا الدفاع عن الشخصيات المئة، وهم أولى مني بالردّ على منتقديهم اذا شاؤوا. مع الإشارة الى أني لا أستهجن طريقتهم في توجيه ندائهم، وإن كنتُ لا أشاركهم ذلك. فهم في مجملهم من الملتزمين قضية الحريات والكرامة البشرية في لبنان والعالم العربي، ومن بينهم نخبة مثقفة ومستنيرة كرّست نفسها منذ سنوات طويلة للدفاع عن هذه القضية، وعرّض بعضها حياته لخطر الموت في سبيلها. وقد ساهم معظمهم في صوغ العديد من المواقف والبيانات ونشرها في السنوات الأخيرة دفاعاً عن قضية الحريات، بالاشتراك مع مواطنين من مختلف الطوائف، ومن مواقع وطنية ومدنية.
كما أني لا أشك قط في مقاصد أدونيس الذي أكنّ له كل مودّة، وقد أمضى حياته في الدعوة الى الحداثة الأدبية والفكرية والمجتمعية في العالم العربي.
المسألة، في كل حال، تتجاوز الى حدّ بعيد مجرّد تبنّي هذه الصفة او تلك من قبل متّخذي موقف او موقّّعي بيان، وهي أكثر تشعّباً وتعقيداً من ذلك بكثير، كما سنرى لاحقاً.
إن همّي الوحيد هو الانطلاق من هذا النقاش الى ما يتخطّاه، واتخاذه مثالاً من بين أطروحات فكرية كثيرة متشابهة، للفت النظر الى الأزمة العميقة التي يعاني منها الفكر التغييري في لبنان والمنطقة العربية في مقاربته لمسألة التحول والحداثة، طوال المرحلة الممتدة من نهضة النصف الثاني من القرن التاسع عشر الى اليوم. وهي أزمة منهج في الدرجة الأولى، بطرقها التحليلية ومفاهيمها ومفرداتها ومضامينها. وسوف يستمر هذا المأزق المنهجي على ما هو عليه إذا لم نسعَ الى إدراكه، ووعي ثغره، والعمل على تجاوزه. فالمنهج هو طريق الوصول الى المعرفة. ولا أمل في المعرفة، تالياً في الفعل، من دونه.
الإقامة في زمنين في آن واحد
يجدر التساؤل أولاً: في أي مرحلة من المراحل التاريخية الكبرى نحن في هذا المشرق (أو في المشرق والمغرب على حد سواء)؟ يتّهم أدونيس الشخصيات المئة بأن نداءهم يشكّل عودة الى لغة القرون الوسطى. لكن في الحقيقة لا حاجة لأيّ عودة. فالمشرق مقيم في صورة ما في القرون الوسطى، او في زمن ما قبل الحداثة. لكن ليس تماماً. هو في الحقيقة مقيم في آنٍ واحد في زمنين متباعدين، متناقضين، متداخلين: القرون الوسطى والأزمنة الحديثة. هذه هي المسألة، مسألة تداخل الزمنين في بنية مجتمعاتنا وفي بنية ذاتنا، وما ينتج من ذلك من التباسات وتناقضات. وهي مسألة الكثير من المجتمعات الواقعة خارج الجغرافيا الثقافية الأوروبية، حيث تم الانتقال التاريخي الكبير من الزمن الأول الى الزمن الثاني بالمعنى الفعلي للكلمة.
من القرون الوسطى، أو من زمن ما قبل الحداثة، يحمل المشرق، في ما يحمله، طبيعة السلطة الاستبدادية الشخصية والأحادية، ويحمل مجتمع الجماعات (وليس الأفراد) حيث لا وجود للفرد خارج الأطر العائلية والقروية والقبلية والطائفية التي ينتمي إليها، ويحمل قبل ذلك كله وفوقه رؤية للحياة والزمن والكون، محرِّك التاريخ فيها هو المحور الإلهي وليس المحور البشري. ومن الزمن الحديث، يحمل المشرق هذا الفيض من الأفكار والصور والأخبار والألحان، ووسائل المعرفة والتواصل والتنقل، والتطبيقات العلمية والطبية، وآلات الحياة اليومية وتقنياتها التي لا حصر لها، والملبوسات، والمأكولات، والأنماط المعمارية، والمتاجر، والمصارف، والأسلحة، وغير ذلك الكثير.
هكذا يقيم المشرق في الزمنين المتداخلين، يغلب ما قبل الحداثة على بنيته المجتمعية التحتية، وتقبع فيه أشكال الحداثة في ما يشبه البنية الفوقية، والبنية الثانية ليست ناتجة قط من الأولى كما عند ماركس، بل آتية إليها من خارجها ومما هو غريب وبعيد كلّياً عنها. ينجم عن ذلك اضطراب في الوجدان وفي اللاوعي الجماعيين، لا يسلم منه أحد، ولا النخب أيضاً وخصوصاً. يقول دوستويفسكي في مستهل “الإخوة كرامازوف”، مشيراً الى اضطراب الذات الروسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر: “إنه لمن الغريب حقاً في زمنٍ مثل زمننا أن نطالب الناس بالوضوح”. يصحّ هذا القول المأسوي تماماً على الذات المشرقية الراهنة.
في الخطاب وفي الأفعال
لذلك يتمّ الانتقال، في لحظة، من القرون الوسطى التي نحن فيها الى الأزمنة الحديثة التي نحن فيها ايضاً، أو العكس، إن في الخطاب أو في الأفعال، من دون أن نقصد ذلك أو نعيه. هكذا يبدأ أدونيس ردّه برفض الانطلاق من الصفة المسيحية لتوجيه نداء، مطالباً بتوجيهه من صفة المواطنية (زمن حديث) ، لينهيه بدعوة المسيحيين بصفتهم مسيحيين الى لعب دور الريادة في الشرق (زمن وسيط).
كذلك الشخصيات المسيحية التي ارتكزت في ندائها الأخير على هويتها الدينية (زمن وسيط)، ضمّنت نداءها الدعوة الى دولة مدنية تذهب “الى حدّ الفصل بين الدين والدولة” (زمن حديث)، وقد وجّهت غالبية اولئك الشخصيات في الماضي، وستوجّه في المستقبل نداءات بصفة المواطنة، أو حتى بصفة العلمنة (زمن حديث). كما ينطلق أناس آخرون من صفة المواطنة أو العلمنة (زمن حديث) ليدعموا أنظمة استبدادية ووسائل حكم قمعية (زمن وسيط). الأمثلة على تداخل الزمنين لا تحصى في الكتابات والأقوال المعلنة كل يوم في مجتمعاتنا.
كما على مستوى الخطاب، كذلك على مستوى التصوّرات والنيات. فلا شك في أن أدونيس يدرك تماماً أنه مهما ذهب بعيداً في الدعوة الى العلمنة والحداثة (زمن حديث)، فسوف يظل الكثير من معارضيه وخصومه يربط موقفه في صورة مضمرة أو معلنة بأصوله الطائفية (زمن وسيط). كذلك الشخصيات المئة، مهما اتخذت من مواقف متقدمة ومستنيرة (زمن حديث)، فسوف يظل الكثير من مناوئيها يربط مواقفها في السر أو في العلن بأصولها الطائفية (زمن وسيط).
يصبح تداخل الزمنين أشد وضوحاً وحدّة عند الانتقال من مستوى الخطاب الى مستوى التصرّفات والأفعال. نحن نكتفي هنا ببعض الأمثلة وهي كثيرة. في العديد من الحالات لا يسألك الحاجز الأمني “من أنت؟” لأن صفتك الفردية (زمن حديث) لا تهمّه، بل “من أين أنت؟” ليحدّد صفتك الجماعية (زمن وسيط) التي هي الأساس. كذلك تجد العشرات أو المئات من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات ومن حملة الشهادات العليا (زمن حديث) يأتمرون في صورة مطلقة بزعيم عائلة سياسية أو قبيلة (زمن وسيط). كذلك تتحدّد قيمة المرشّح للانتخابات النيابية، وهي التعبير الأسمى عن الديموقراطية (زمن حديث)، ليس على أساس طرحه وبرنامجه (زمن حديث)، بل على أساس “قدرته التجييرية” (زمن وسيط). في الأمثلة القصوى يقتل شاب أخته (زمن وسيط) في صورة وحشية، لأنها تزوّجت مَن تحب (زمن حديث) من دون رضا العائلة، أو لأنها تتابع دروسها في الكلّية لتصبح ممرضة (زمن حديث)… الى آخره.
انفصال الفكر عن الواقع
ينجم عن تداخل الزمنين في ذاتنا الجماعية، في ما ينجم عنه، انفصال عميق بين الفكر والواقع، وخصوصاً لدى النخب المثقّفة المعنية مباشرة بتفسير الواقع ومحاولة رسم مصيره. هذا الانفصال عينه مستمر منذ نهضة القرن التاسع عشر. ذلك أن المفاهيم الفكرية السائدة، مستمدّة في مجملها مباشرة من التجربة التاريخية الأوروبية، ومن امتداداتها في المجتمعات الصناعية في العالم. كونها هي التجربة الأساس، والتجربة المتكاملة في الانتقال من القرون الوسطى الى الأزمنة الحديثة، وهي صانعة الحداثة.
هكذا ينطلق المفكرون والمثقفون المشرقيون من مفاهيم التجربة الأوروبية (التّقدم، الحريات، المساواة، الديموقراطية، قبول الآخر، العلمنة، الفردية، المواطنية، الدولة المدنية، دولة الدستور والقانون، دولة المؤسسات، والكثير غيرها)، وهي كلها عائدة الى زمن الحداثة. ثم يسقطونها إسقاطاً حرفياً على واقع مجتمعي وسياسي وديني لا يزال مقيماً في زمن ما قبل الحداثة.
لا شك في أن هذه المفاهيم تنطوي على قيمة انسانية شاملة. لكن بدلاً من إسقاطها على واقع مختلف، يجب استلهامها استلهاماً لتفسير هذا الواقع، وإيجاد المفاهيم والرؤى ووسائل العمل الجديدة والخلاّقة الخاصة به وبآفاق تغييره.
أين وسائل العمل؟
سنتوقّف في هذا المجال عند التباسين كبيرين، نتائجهما السلبية عديدة:
الأول، التفاوت الهائل بين الغزارة في طرح الأهداف والندرة في تحديد وسائل العمل. هكذا، منذ نهضة القرن التاسع عشر الى اليوم، يتسابق المفكّرون والمنظّرون والمصلحون الى رسم الأهداف المرجوة، وهو أمر سهل ما دام يُستَمدّ من النظرية الأوروبية المتوافرة، ومن التجربة الأوروبية المشبعة درساً وتحليلاً في مجتمعاتها. لكن لا شيء تقريباً عن وسائل العمل لتحقيق هذه الأهداف في بيئات ومجتمعات مختلفة بعمق عن العالم الأوروبي. علماً بأنه ليس هناك ما يحتّم قطّ تكرار السياق التحوّلي الأوروبي في أمكنة أخرى. هذا السياق الذي امتد على أكثر من أربعة قرون، من النهضة الأوروبية، الى فكر التنوير، الى الثورة الصناعية والعلمية، الى الثورة الفرنسية الكبرى، مسقطاً “النظام القديم” برمّته ومكرّساً الحداثة، لن يتكرر طبعاً في المشرق. كما اننا ندرك تماماً في علم الأنتروبولوجيا الثقافية، ومن ضمن مقاربتنا المقارنة للحضارات على مدى زمني طويل، أن “النموذج الأوروبي”، على رغم اهميته التاريخية وعلى رغم القيم والمفاهيم الانسانية الكبرى التي صاغها، ليس هو “النموذج القدوة” الذي يجب على كل المجتمعات والثقافات الوصول اليه، وليس هو بالطبع نموذجاً منزّهاً من العيوب، وهي معروفة ماضياً وحاضراً.
فمسارات تحقيق الحريات البشرية متعدّدة، والتاريخ البشري لا يعيد نفسه كما يتصوّر البعض. فخلافاً لعالم الطبيعة، الأسباب نفسها لا توصل الى النتائج نفسها في عالم المجتمعات البشرية.
“ما العمل؟”، وليس “ما الأهداف المرجوّة؟”، هو السؤال الكبير الذي لا يجيب عنه أحد.
عن المسألة اللبنانية
أمّا الالتباس الثاني، فهو ما يتعلّق في هذه الأطروحات بالمسألة اللبنانية. فالمكان اللبناني يشكل منذ أمد طويل مساحة الحريات الوحيدة في المشرق، وسط منطقة يعمّها النظام الأمني.
كيف تكوّنت هذه الظاهرة الفريدة، البالغة الندرة خارج الجغرافيا الغربية وخارج المجتمعات الصناعية، والتي لم تتكوّن وفقاً للمسار وللنموذج الأوروبيين، بل وفقاً لمسار ونموذج آخرين مختلفين؟ ما هو هذا المسار الفريد المختلف؟ هذا هو السؤال الذي جهدت في إيجاد الإجابات العلمية عنه، والذي سعيت الى رسم نظريته التاريخية، التي عرضتها في كتابات سابقة، ولا مجال الآن لشرحها.
من اللافت أن المكان اللبناني يثير لدى الكثير من المثقفين اللبنانيين والعرب مزيجاً من الانجذاب والرفض، وهذه هي حال أدونيس أيضاً. فخلال العقد الأخير، ولمرّات عدّة، انتقد أدونيس بشدة التجربة اللبنانية، معتبراً بيروت والمكان اللبناني، في الحد الأدنى، مجتمع الطائفية المعلنة، وفي الحد الأقصى بؤرة الطائفية في المنطقة العربية، آخذاً على هذا المكان عدم استقراره (لا أدري إذا كان قياساً الى استقرار عواصم المنطقة وانظمتها آنذاك).
وها هو أدونيس، في ردّه الأخير على نداء المسيحيين المئة، يختار المكان اللبناني وليس سواه ليكون “منارة إنسانية ومعرفية في حوض المتوسط الشرقي”، ولـ”يكون نموذجاً”، و”طليعة التأسيس لدولة مدنية حديثة – أعني لمجتمع عربي مدني- ولحياة إنسانية عربية مدنية”، على حدّ تعبيره.
أهداف كبيرة، لا شك في ذلك. لكن ما هي وسائل العمل لتحقيقها يا أدونيس؟ وكيف يمكن بناء مساحة حريات مستقرة في منطقة تسلّطية لا تجتهد أنظمتها ولا تستثمر الاّ في الأمن؟ وهل يحمي المكان اللبناني نفسه بالتّحول نظاماً أمنياً آخر، فيربح بذلك استقراره ويخسر حرياته وروحه؟ مرّة اخرى: “ما العمل؟”.
لا قدرة للبنان على الجمع بين الحريات والاستقرار الطويل الأمد، الاّ إذا قامت مساحات أخرى للحريات في المشرق، تحرّره من سيف التدخلات الأمنية المصلت عليه على الدوام. فهل يحدث ذلك، أم أن الطريق الصعب لا يزال طويلاً أمام لبنان وحلمه؟
النهار