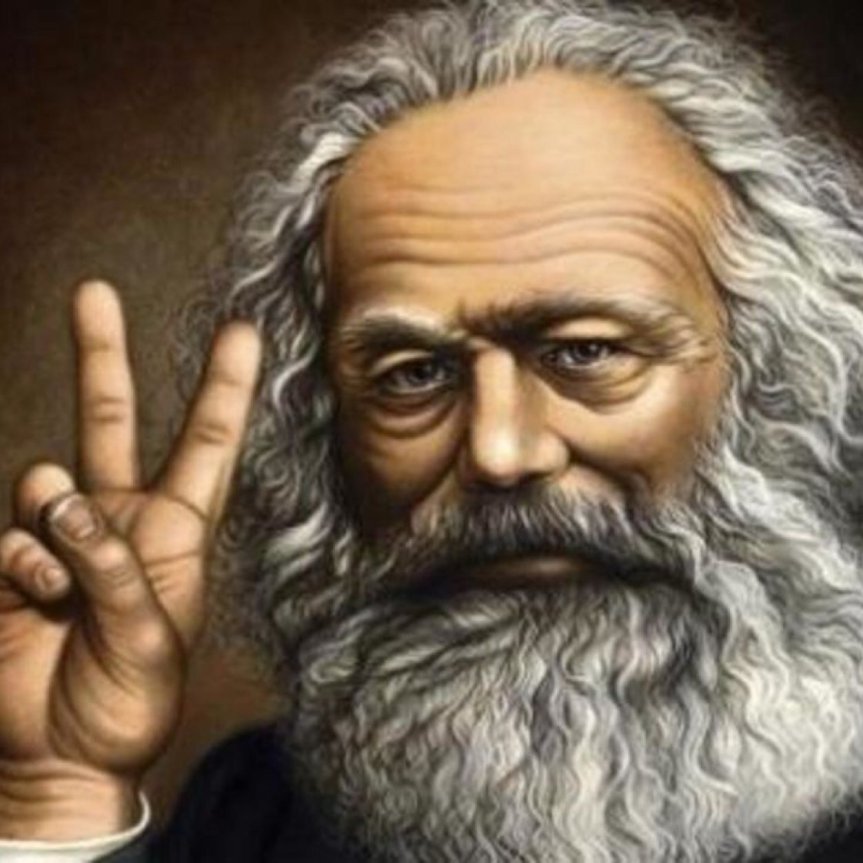مجتمعاتنا «التعدّدية»: لا فراقَ بإحسان/ أحمد بيضون

حين يصبح الفراق بين المكوّنات الرئيسة لمجتمعٍ متعدّد أمراً مقضياً، تبرز بين أَوْلى العواقب بالاعتبار أرجحيةُ القضاء على المدن أو، في الأقلّ، على مدينية المدن، وأخصّها العواصم. فإنما تصبح المدن مدناً باستدراجها التخالط وتجاوزها انفراد الوحدة الطبيعية أو التقليدية بديرتها. وتزداد المدينية مدينية كلّما اتّسع صدرها لا لتَخالط وحدات من الصنف نفسه وحسب بل لتَخالط أصنافٍ متغايرة من الوحدات. وإذا كانت المدن العربية قد استبْقَت نسبة من تعمّد التجاور بين أبناء الطائفة الواحدة أو الجهة أو العشيرة، وهو ما يجسّده نظام الحارات، أرفع من النسبة التي نجدها في المدن الأوروبية، مثلاً، فإن ذلك لا يعني البتّة أن فقدان المدينة واحدة من هذه المكوّنات أو أكثر من واحدة لا يمثّل انحطاطاً أو نكوصاً منها عن السوية المدينية. وهذا فضلاً عن النكبة التي يمثّلها، بطبيعة الحال، للفئة المستهدفة قلعها من موطن عيشـها ومعاشها الأصلي أو المتبنّى. يصحب هذا عنفٌ لا يُعرف مداه، ونشاهد في هذه الأيّام بعض عيّناته، يحتاج إليه فرض هذه النكبة على ضحاياها. فالحال أنه لا يلوح، في الحالات المعروضة على مرأىً منّا، أسلوبٌ «نظيف» لإعادة التشكيل الإثنيّ أو الطائفي لعاصمةٍ أو لمدينةٍ كبرى أو لوحدةٍ إقليمية أخرى. ولا تستغني الدعوة إلى مثل هذا عن التسليم بالمذبحة وبالدمار اللذين يقتضيهما تنفيذه.
إلى ذلك، لا يحتمل أن يوافق تقسيم الأرض تقسيماً منصفاً للموارد. بل إن كلّ واحد من الأوطان الجديدة المرتجلة سيضع يده على ما يجده تحت يده من خيرات البلاد ومرافقها ولو لم يكن في هذا وجه حقّ واضح. ويفيد النظر في حالات النزاع القائمة في محيطنا أن النجاة بالثروة أو الانفراد بالموقع لن يكونا غائبين عن المخيلة الانفصالية. وهو ما يجعل استمرار النزاع عبر الحدود الجديدة مرجّحاً ويستبعد لأمدٍ طويل، على الأرجح، خلافة حسن الجوار للصراع الجاري.
إلى هذا ترتسم علامات استفهام تتعلّق بالأنظمة السياسية التي يحتمل أن يفضي إليها التقسيم أو الانفصال وبما يمكن أن يضمره كل من الأنظمة الجديدة للجماعة التي يظلّها وما يرجّح أن تتمخّض عنه هذه الأنظمة من حالةٍ إقليمية.
وذاك أن البحث السياسي في ما يسمّى «المجتمعات التعدّدية» يبدو متخلّفاً عن وقائع التاريخ حين يواصَل التحدّثُ عن هذه المجتمعات وكأنها لا تزال استثناءً من قاعدة الدول-الأمم في عالم اليوم… وكأن البحث في الأنظمة السياسية المناسبة لها، هو الآخر، مغادرةٌ لجادّة الديمقراطية العريضة القائمة على مبدأ المواطنة حصراً أي على مقت الاعتراف بـ»هيئاتٍ وسيطة» تفصل ما بين المواطن والأمّة حين تتّخذ لنفسها صفة المجاميع السياسية أيضاً لا «الأوّلية» (بمعنى الدينية أو اللغوية أو الإثنية، إلخ…) وحسب.
والحال أن افتراض الاستثناء هذا يرقى إلى عهدٍ شهد خروج الأقطار المتتابع من حال الاستعمار وتحوّلها إلى دول منظورة بدورها. إذ ذاك بدا التكوين الأوّلي لأكثرها يستدعي ابتعاداً، اختلفت أشكاله، عن أنظمة الدول القديمة، القليلة العدد، التي كانت قد تألّفت منها – مثلاً – عصبة الأمم غداة الحرب العالمية الأولى. كان هذا الابتعاد لازماً لتجنيب هذه البلاد تمزّقاً عصف ببعضها فعلاً وبدا محتملاً في بعضها الآخر.
وفي كثير من الحالات، مثّلت السلطوية مخرجاً تباينت مدّته من حال التمزّق هذه. وفي بعضها أذِنَ تمتّعُ الجماعات بقواعد إقليمية بالذهاب إلى التقسيم العاجل أو الآجل بعد محنة دامية. وفي البعض الآخر، استقرّت الحال على اعتماد الصيغة الفدرالية أو الصيغة الكنفدرالية، وهما كانتا معروفتين في بعض الدول القديمة. وفي بعضها الأخير، انتهى الأمر إلى اعتماد ما يسمّى «النظام التوافقي» وهو يفترض اعترافاً، في نطاق الدولة المركزية الواحدة، بمكوّنات سياسية وسيطة للمجتمع هي نفسها الجماعات التي أنشأها التاريخ وجعل الانتماء إليها عرفياً لا طوعيّاً. تلك كانت الحال في قبرص ولبنان، مثلاً، وقد اعتُبرت أنظمتها شبيهة بأنظمة دول أوروبية صغيرة، أقدم منها عهداً، أبرزها بلجيكا وهولندا. وهذا مع الإقرار بأن هذه الفئة من الأنظمة يختلف بعضها عن الآخر كثيراً وتمتّ بصلات قربى متباينة إلى الفئات الأخرى.
هذا العالم الذي ارتسمت معالمه في أواسط القرن الماضي شهد مذّاك تحوّلات عميقة بدّلت تصنيف المجتمعات لجهة تكوينها السياسي وأحالت إلى قاعدة ما بقي ينظر إليه حيناً من الزمن على أنه استثناء. فسواءٌ أتعلّق الأمر بمجتمعاتٍ أنشأَتها الهجرة أساساً، كما في العالم الجديد، أم بمجتمعات أخرى حمل إليها ماضيها الاستعماري وحاجاتها العملية كتلاً كبيرةً من المهاجرين، راحت المعاداة المتصاعدة للتمييز وتقدّم المساواة الحقوقية يفرضان الاعتراف بالخصوصيات الثقافية ويزيدان من منظورية الحدود بين الجماعات. وهو ما فعلته أيضاً أزمات ما بعد الاستعمار في الأقطار الجديدة التي أخفقت السلطوية في كبت الفوارق الإثنية أو القبلية أو الطائفية أو اللغوية فيها. وهو، أخيراً، ما أبرزته ظروف تفكيك الاتّحاد السوفييتي والكتلة الاشتراكية في جوار اتّحاد أوروبي مستعدّ لاستقبال قطع المنظومة المنهارة ونظام دولي أصبح تماسكه وإجماعه على معالجة حالات النزاع التي طرحت ورعاية المسار الانتقالي يبدوان اليوم أثراً بعد عين.
مهما يكن من أمر، تبدو مسألة سياسة الفوارق مطروحةً اليوم، ولو على أنحاءٍ متباينة، على جميع دول الكرة ومجتمعاتها تقريباً. وأمّا الاختلاف بين الحالات فيتأتى من طبيعة المكوّنات ومن عددها والنسب الحجمية بينها ومن نسيج العلاقات بينها، بما فيه توزيع الموارد، ومن النفوذ الخارجي الفاعل فيها، إلخ. فما الذي تأدّى، على وجه الإجمال، عن اعتماد صيغة «التوافق» بديلاً جاء به الاضطرار أو الاختيار من مبدأ «المواطنة» لسياسة الفوارق المشار إليها؟ نحاول في العجالة المقبلة تأمّلاً في هذه المسألة يحفزه التلويح المتكرّر بـ»التوافق» وريثاً لأنظمة كانت قد طمست تعدّد المكوّنات وجبَهَتْه بالإنكار في الأوطان التي تضربها، على مقربة منّا، رياح التمزّق والنزاع الأهليّين.
كاتب لبناني
القدس العربي