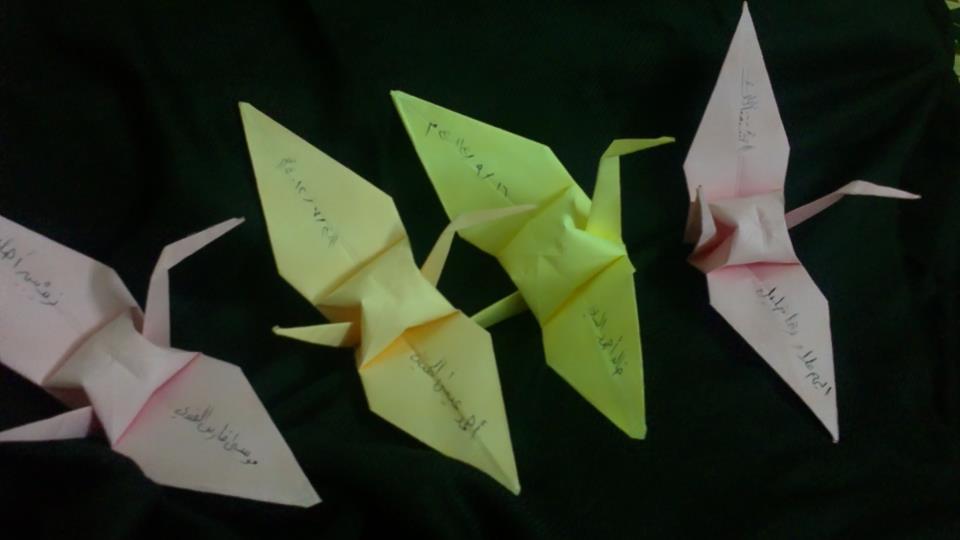مقالات تناولت الحرب على “داعش”

ماذا بعد أن نقل «داعش» حربه الى الخارج؟/ غازي دحمان
تتغير ديناميكية الصراع في سورية بأسرع مما تتوقع الأطراف المنخرطة فيه، وبما يفوق قدرتها على توظيف الأحداث التي تقع في قلبه أو على هامشه في سياق سرديتها الخاصة، ويبدو أن اتساع دائرة استهدافات «داعش» والأخطار المحتملة للنمط العملياتي الجديد والقائم على نقل الحرب إلى الخارج، او أقلّه تأسيس فرع للعمليات الخارجية، يقدّر ان تكون له إنعكاسات على مقاربة الأزمة وآليات حلها بدت نذرها بالظهور.
ولعلّ أكثر تلك الانعكاسات وضوحاً اعتبار الجغرافيا السورية والعمل في إطارها حقاً لجميع الأطراف والقوى طالما أن سورية باتت مصدر خطر مباشر على تلك القوى، أو كما قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند «أكبر مصنع للإرهاب»، وتستطيع أي من القوى الكبرى، وحتى الإقليمية إن امتلكت القوة الكافية، الاستناد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنحها الحق في الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها، والمعنى الفوري والمباشر لذلك هو تشريع الحرب دولياً في سورية وإلغاء حصرية التدخل الروسي، بخاصة أن روسيا نفسها تتجه إلى تقنين حربها ضد «داعش»، بعد الكشف عن مسؤولية التنظيم في عملية تفجير الطائرة الروسية، وفق منصوص المادة 51 من ميثاق الأمم المنتحدة، والمعنى الثاني لذلك أن السلطة في سورية باتت بحكم الساقطة نظراً الى عدم قدرتها على ضبط الأمن داخل الجغرافيا السورية، وبالتالي سقوط المبرر الروسي بأن التدخل مشروط بموافقة نظام الأسد.
وفي الوقائع العملانية تبدأ فرنسا تحركاً عسكرياً واسعاً في سورية مسنودة بدعم الاتحاد الأوروبي، وهي الآن في طور التحضير والإعداد اللوجستي لهذه المعركة، كما أن تركيا تعود إلى طرح المناطق العازلة التي خفت الحديث عنها بعد التدخل الروسي، ولكن هذه المرة بدعم أو إسناد أميركي واضح ومحاولة تجييره ضمن حرب التحالف الذي تقوده واشنطن ضد «داعش» وإنطلاقاً من حق تركيا في الدفاع عن نفسها بعد ان تعرضت لأكثر من حادثة تفجير تبناها التنظيم المتطرف.
أمام هذه المستجدات يبدو أن سكرة حلف إيران وشماتته بالفرنسيين ستنتهي إلى كابوس كان حتى وقت قريب خارج حسابات هذا الحلف الذي انتعشت آماله كثيراً بعد التدخل الروسي بما أضافه له عناد بوتين وتهوره من قوة دعم جعلت أركان الحلف تراهن على كسب المعركة في سورية وإمكانية الحصول على تسويات تكرّس هذا الفوز وتجعل مطالب الشعب السوري ومطالبة القوى الإقليمية والدولية بتنحي بشار الأسد عن السلطة أثراً بعد عين، أو أنها صارت خلفنا، على ما إعتاد إعلام تحالف إيران قوله.
لا شك في أن روسيا تنبهت لهذا المأزق وقد بدا ذلك واضحاً من دعوتها الى تشكيل تحالف دولي ضد «داعش» في سورية، لكن الكرملين كان يدعو الى تحالف سياسي تحصل روسيا بموجبه على دعم وتفويض دوليين بتسوية الأمور في سورية على أن تتولى روسيا وإيران إخراج المشهد بالطريقة التي تناسبهما، من دون ان يكون للقوى الأخرى أكثر من دور المسهّل، وقد حاول بوتين في هذا الإطار التلميح إلى أن روسيا تشكّل القوّة الأكثر فعالية وبالتالي فإن أي قوّة عسكرية قد تأتي إلى سورية يجب أن تعمل تحت القيادة الروسية وهو ما حاول توضيحه لفرنسا عندما أعلن أنه طلب من قواته البحرية مساعدة الفرنسيين، وكأن الفرنسيين يعبرون المتوسط للتزود بالوقود والمؤن.
ولكن وبالنظر الى حجم الاختلافات الكبيرة في التفاصيل بين روسيا والغرب، وعلى رغم الاتفاق الظاهري على محاربة «داعش»، لا يتوقع ان يكون التعاون سهلاً بينهما في سورية، فالعكس هو الصحيح، ذلك أن الوجود الغربي في سورية سيشكّل ضغوطاً على روسيا التي كانت مرتاحة حتى وقت قريب في تشكيل وصياغة مقاربتها السورية بعد أن منحها تدخلها العسكري قوة أمر واقع استثمرته بشكل جيد في مؤتمر فيينا، ويبدو أن هذه المرحلة في طور الإنتهاء، ذلك أن فرنسا وأميركا، ومن خلفهما القوى الإقليمية، لها رؤاها وتصوراتها المعلنة سابقاً والتي ترفض استمرار وجود الأسد في السلطة، بل والأكثر من ذلك ستطالب لاحقاً بأن يكون لها إشراف متساوٍ على تطبيق كامل بنود مؤتمر فيينا بما فيها صياغة الدستور والعمليات الانتخابية البرلمانية والرئاسية.
كما أنه لم يعد في إمكان روسيا بعد اليوم فرض احتكار تدخلها في سورية، كذلك لن تكون قادرة على التحكم بالمخرجات السياسية للحرب السورية كما كانت تأمل، ذلك أن إرهاب «داعش» جعل لكل القوى الدولية الحق في التدخل في سورية، ولم يعد في إمكان طرف واحد احتكار توظيف أعمال «داعش» لمصلحته طالما أن الضرر يطاول الجميع.
* كاتب سوري
الحياة
داعش كمرآة لِبعض أخلاق العالم/ زيـاد مـاجد
لِظهور داعش في العراق ثم صعودها في سوريا أسباب عديدة، كُتب الكثير عنها.
فمن التحوّل الذي أصاب قاعدة الجهاد في بلاد الرافدَين بعد الاحتلال الأميركي وسياسة اجتثاث البعث، إلى الغضب السنّي في أكثر من بلد عربي من تعاظم النفوذ الإيراني، إلى شبكات التمويل والإعلام المتطرّفة وما تمثّله من حالة مرضيّة متفاقمة في أوساط إسلامية خليجية، إلى الخراب السياسي والاجتماعي الذي أحدثه على مدى عقود الاستبدادُ القاتل المدّعي علمنةً وتقدّميةً (في العراق وسوريا وليبيا بخاصة)، وصولاً إلى البربرية الأسدية التي واجهت السوريين في السنوات الأربع الماضية بالسكاكين والبراميل والكيماوي، تعدّدت العوامل التي وُلدت العدمية الداعشية من ثناياها.
ويمكن أن نُضيف إلى ذلك عوامل على صلة بأزمات معايير ومخيّلة ونماذج حكم وقِيَم وهوية تضرب شباناً من مختلف أصقاع الأرض، وتقرّبهم إلى فلسفة نبذ العالم والهجرة منه نحو أقاصي العنف ومشهديّته المريعة.
على أن ما لا يُذكر كفاية عند تشريح الداعشية وجذورها هو أن الهمجية الداعشية ليست خصوصية المنضوين في صفوفها حصراً، بل هي سمة الكثير من القوى والعواصم في علاقاتها وأخلاق سياساتها الخارجية وقبولها بالتعامل مع أنظمة تفوق داعش قتلاً وتوحّشاً. وهذا يعني أن في داعش ما يشبه بعض أخلاق العالم حيث نعيش، في العام 2015، رغم كلّ ما حقّقته الإنسانية من تقدّم وتطوّر ورغم فلسفة الأنوار وإنجازات الحضارة الغربية في أبواب الديمقراطية وحقوق الانسان.
وهذا يعني أيضاً أن صعود داعش على صلة وثيقة بأخلاق العالم إياه في تعامله مع سوريا منذ سنوات. وإلا، كيف يمكن تفسير التواطؤ الرسمي الغربي مع روسيا أو الصمت على قصفها السوريّين وقتلها أكثر من 500 مدني في الشهرين الأخيرين، بينهم أكثر من 80 طفلاً؟ فهل في هذا الفعل الروسي المسكوت عنه ما يختلف عن الداعشية التي قتلت 130 مدنياً في باريس، سوى أنه أكثر إجراماً وأشدّ فتكاً بثلاثة أو أربعة أضعاف؟
وكيف يمكن القبول بمنطق يروّجه بعض الغربيّين ومفاده أن التحالف مع الأسد ضروريّ لمواجهة داعش، في وقتٍ قتل نظامه أكثر من 200 ألف مدني سوري، بينما قتلت داعش قرابة الثلاثة آلاف منهم؟ هل فقط لأن داعش قتلت مواطنين “غربيّين”، وهل استطراداً لا قيمة لحياة مئات الآلاف من السوريّين لدى صنّاع خيارات وتحالفات دولية يرضون بالتفاهم والعمل مع ذابحيهم؟ وهل في هكذا انحطاط أخلاقي غير داعشية بِربطات عنق تسهّل على دواعش اللحى خطاب المظلومية والعدمية، ثم المزيد من الاستقطاب؟
قد يدّعي البعض أن أسئلة سوريّة كهذه تبدو اليوم ساذجة، لأسباب ترتبط بغلَبة المصالح وتوازنات القوى على القوانين والقيَم في شبكة العلاقات الدولية. لكنّ العكس هو الصحيح. فهكذا أسئلة هي مفاتيح لمساءلة أمراض عالمٍ تُغذّي أنانيّةُ بعض أقويائه وقلّةُ أخلاقهم انحطاطاً كالذي تفرضه داعش ومثيلاتها. وهذا لا يعني أبداً أن الانكفاء عن العالم أو القول بحتميّة تآمريّته أو شرّه هما الردّ على ضمور الأخلاق في علاقات القوى الكبرى فيه. ففي الانكفاء وتعميم العداء عدميّةٌ تساهم بدورها في تغذيةِ وجه من وجوه الداعشية.
لكن من الضروري وعي الأزمة الأخلاقية العالمية الكبرى والعمل مع رافضيها في كل مكان، وخاصة في الغرب حيث معاقل القرار الأبرز، على مواجهتها أو على الأقلّ على الضغط لإدخال جرعات من المعايير الحقوقية والأخلاقية الى السياسات الكونيّة، علّ في الأمر ما يُقلّص التوتّرات والصدامات.
دون ذلك، سيستمرّ العنف في العالم بأسره بالتفاقم، فتستمرّ المجازر والمَقاتِل بداعش أو بظواهر قد ترثها، وتكون أشدّ فتكاً منها.
موقع لبنان ناو
“داعش” والجيل الثالث من الجهاديين في أوروبا/ جيل كيبل
ليس «داعش» صنو «القاعدة». وهجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001 كانت من طينة «عمليات الاستخبارات السرية». فـ«القاعدة» اشترى بطاقات السفر، ودرّب عناصره على الطيران. وأعدّ للعملية وموّلها بواسطة تحويلات مالية. لكن «داعش» هو وليد الجيل الثالث من الحركة الجهادية، وهو أقرب الى نموذج الشبكة منه الى البنى العمودية والتراتبية. وهذا النموذج يفسح المجال أمام الارتجال. ومنفذو عمليات «داعش» في أوروبا لا يلتزمون خريطة طريق أعدتها «سلطة» مركزية. فهم يتلقون تدريبات ويشجعون على شنّ عمليات، ويترك لهم أمر إثبات «كفاءتهم». وهجمات 2015 في فرنسا خير دليل على الارتجال، ولم يكلل منها بالنجاح سوى هجومين (هجوم السابع من كانون الثاني /يناير، و13 تشرين الثاني/ نوفمبر). وأخفقت الهجمات الأخرى: هجوم سيد أحمد غلام، الذي سعى الى مهاجمة كنيسة في فيلجويف وانتهى به الأمر الى إطلاق النار على قدمه، وهجوم أيوب الخزاني الذي لم يفلح في تلقيم سلاحه، رشاش كلاشنيكوف، في طاليس. وفي الهجمات الأخيرة، عجز 3 إرهابيين عن تفجير أحزمتهم الناسفة وسط الجموع في ملعب فرنسا. ويستند «داعش» الى أدبيات أبو مصعب السوري، وهو مهندس سوري تابع شطراً من دراسته في فرنسا، وكان مساعد بن لادن قبل أن ينشقّ عنه. وعلى خلاف بن لادن، لم تتصدر أولوياته مهاجمة العدو البعيد، أي أميركا، ورأى أن أوروبا هي خاصرة الغرب الرخوة. ففي أوروبا سكان يتحدرون من الهجرة ولم يندمجوا في المجتمع الأوسع، ويعانون مشاعر العداء والبطالة. وأوصى بحث هؤلاء على ثورة تصبغ بصبغة إسلامية. ومحمد مراح هو أول من التزم مشروع أبو مصعب السوري، في آذار (مارس) 2012.
ولم تستخلص أجهزة الاستخبارات الفرنسية ما يترتب على منطق أبو مصعب السوري: التجنيد بواسطة النظراء أو الأنداد والشبكات الاجتماعية. وعوّلت الاستخبارات على طرق رصد تقليدية ومراقبة المساجد، في وقت عزف الجهاديون عن التردّد إليها. وفاتها، على سبيل المثل، أن محمد مراح هو جهادي من الجيل الثالث مجنّد على الشبكة. وترمي هجمات باريس الأخيرة الى ترجيح كفة اليمين المتطرف والنفخ في معاداة المسلمين واضطهادهم، وتأمل باستدراج المتطرفين الفرنسيين الى حرق متاجر السلع الحلال وسحل المحجبات… فيعمّ شعور الظلم المسلمين الفرنسيين، وينضمون الى «داعش». لكن الهجمات الأخيرة لم تشنّ مثلاً، على اليهود دون غيرهم، بل استهدفت فرنسيين من منابت مختلفة، بينهم من يتحدّر من هجرة ما بعد الاستعمار. فأخفقت في استمالة عامة المسلمين، ولم تبرز حركة «لست بتاكلان» في أوساط مسلمي فرنسا تحاكي حركة «لست شارلي» (مجلة الرسوم الساخرة التي هوجمت في مطلع العام، وأُردي عدد من محرريها. ورفض مسلمون فرنسيون حملة الانتساب إليها رداً على الهجوم، ورأوا أنها أساءت الى رموزهم). والإرهاب الأعمى والاستعراضي قد يكون ناجعاً تكتيكياً، لكن لا ترتجى منه فائدة يعتدّ بها استراتيجياً وسياسياً. وينهار الإرهاب من غير تأييد شعبي، على نحو ما حصل في أول مرحلتين من الجهاد في فرنسا والجزائر في نهاية التسعينات.
واستراتيجية أبو مصعب السوري من شقّين: زرع التطرف في أوساط الشباب المسلم في الغرب، والجهاد ضد الأنظمة «الكافرة» في الجوار القريب. وساهم الربيع العربي في تفكّك الأنظمة والمجتمعات العربية التي تنكفئ أكثر فأكثر الى لحمتها القبلية أو المذهبية. واليوم، المشرق هو فسيفساء طوائف أو ملل، على نحو ما كان أيام السلطنة العثمانية أو الانتداب الفرنسي – ويومها برزت دولة علوية وأخرى درزية -، تتقاتل في حرب مشرعة لا تستثني أحداً. واستغلّ تنظيم «داعش» هذه الأحداث وأنشأ دولة سنّية تمتد من الموصل الى تدمر. والى شمالها، الأكراد والأتراك، والى غربها العلويون والمسيحيون واليهود، والى شرقها الشيعة والفرس.
وفي الشطر العراقي منها، ركن «داعش» هو نظام بعثي سنّي التزم خطاباً إسلامياً. لذا، يبدو راسخاً وقادراً على توجيه دفة كيان هو شبه دولة. لكن بنية «داعش» أضعف في سورية. فالسنّة لم يمسكوا بمقاليد دولة آل الأسد. لذا، يؤدي المتطوعون الأجانب دوراً أكبر في هذا الجزء من «الخلافة». فهم مفتونون بما يحسبون أنه جنة مُثل تتولى نشر العدالة. ويختلط في هذه «الجنة» الخطاب الاخروي بخطاب عالم ثالثي. وينظر المقاتلون الى الفرنسيين والبلجيكيين بعين الازدراء. فهم لا باع لهم في القتال. لذا، توكل إليهم عمليات انتحارية أم يقصر دورهم على أعمال لوجيستية. ومنهم من يتولى حراسة الرهائن. وهذه حال مهدي نموش المتهم بمهاجمة المتحف اليهودي في بروكسيل في 2015. وشنّ هجمات في فرنسا أو بلجيكا هو سبيل أمثال نموش الى إثبات عزمهم على الجهاد وقطع صلتهم ببلدهم. وتدمير موئل «داعش» في العراق وسورية لن يذلل مشكلات المجتمعات الغربية. فهي تربة خصبة للتطرف والجهاد. لكن قدرة «داعش» على جذب المقاتلين ستنحسر. ولن يؤذن القضاء على «داعش» في سورية والعراق بنهاية الحركة الجهادية. فـ «القاعدة» وُلد على أنقاض المرحلة السابقة، مرحلة عبدالله عزام في الثمانينات والتسعينات. وأبو مصعب السوري افتتح فصلاً جديداً من الجهادية. ويرجح أن يبدأ فصل جديد من الحركة الجهادية إثر القضاء على «داعش».
* باحث سياسي، عن «ليبراسيون» الفرنسية، 25/11/2015، إعداد منال نحاس.
الحياة
“دواعشهم” في أميركا… لماذا يكرهوننا؟/ زهير قصيباتي
طفل تغسله الدماء في غوطة دمشق… طفل لم يتعلم سوى النزوح مع أهله منذ إطاحة ديكتاتور ليبيا، وثالث لا يسمع سوى التفجيرات وأحاديث عن صراع السنّة والشيعة في العراق. هو عالمنا العربي، ما الذي نتوقعه بعد من إدارة الرئيس باراك أوباما في السنة الأخيرة من ولايته، وهل نراهن مجدداً على تدخُّله لإنقاذنا من جنوننا؟
أي مصلحة لأميركا «الديموقراطية» و «الجمهورية» في وقف الانهيارات والمذابح والدسائس؟ بل هل هناك إرادة جدية لدى واشنطن في إنهاء فظائع «داعش»؟
نظرية المؤامرة يجدّدها هذه المرة الأميركيون أنفسهم، ممن يخوضون السباق الى ترشيحهم باسم الجمهوريين الذين خرّجوا أمثال جورج بوش الابن، ودونالد رامسفيلد وديك تشيني. بين من يخوض السباق مَنْ يصرّ على تذكير الأميركيين بأنه شاهد بأم عينه مسلمين في الولايات المتحدة يرقصون فرحاً لدى تفجير برجَيْ مركز التجارة العالمي في 11 أيلول (سبتمبر) 2001… فإن لم يكن يحرض على «دواعش» جدد في أميركا، وعلى انقسام مجتمعاتها، فهو على الأقل يقدّم خدمة مجانية لطروحات التصدي للإرهاب أولاً، ووصمه بالإرهاب الإسلامي، أليست تلك خدمة لمشروع تعويم النظام السوري الذي لم تروِ «شرعيته» بعد دماء ثلاثمئة ألف سوري، تواطأ على أرواحهم، مثلما فعل تنظيم «داعش» وكل إرهاب؟
خدمة مجانية أخرى لدعاة تلك «الشرعية»، يقدّمها هذه المرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي تجاوز الاعتراف بغارات على سورية، ليقرّ بـ «عمليات» ينفذها جيشه هناك. وفي المحصّلة، يتكرّس تذرّع النظام في دمشق بأنه يواجه «معركة كونية» مع الإرهاب ومع إسرائيل كذلك، فيما هي تنسّق مع حليفه الروسي لتفادي الاشتباك مع المقاتلات الروسية، وتصادم المصالح.
في المحصّلة، المعادلة بسيطة: نظام دمشق حليف لطهران ولموسكو صاحبة المصالح المتقاطعة مع إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة التي تصر على رحيل الرئيس بشار الأسد، وهو يراهن على رحيل أوباما قبله. «داعش» لم يواجه الأميركيين ولا الإسرائيليين، عملياً معظم ضحاياه أيضاً كضحايا النظام السوري، عرب ومسلمون.
ولأن سورية لن تعود على الأرجح كما كانت، يصح مجدداً إحصاء الأطراف المتواطئين عليها وعلى شعبها، لا على نظامها، الأطراف المتقاتلين والمتصالحين على أرضها وفي فضائها… على رؤوس السوريين. روس وأميركيون وإسرائيليون وإيرانيون لهم حلفاء، وعراقيون وشيشان، إسلاميون متشدّدون و «دواعش» وبعثيون وعلويون وسنّة وعلمانيون، عرب وأكراد.
أي مصير للمنطقة بين «دواعشهم» في أميركا الذين يمثّلهم بأفضل صورة متعصّبون ينكأون جروح 11 ايلول، تحريضاً على المسلمين… و «دواعشنا» الذين يحاربون العالم بدمائنا، ولا يصدقهم سوى مجانين، خريجي الكهوف ولو تخرّجوا في أرقى جامعات الغرب. مشروع «خلافة» انتحاري أخطر بكثير من قنبلة نووية.
قبل «النووي» هل من مبالغة في الخوف من ضربات «داعشية» كيماوية؟ هل كان مستحيلاً تهريب سلاح كيماوي الى التنظيم الجهنمي، قبل اطمئنان أوباما ونتانياهو الى تدمير ترسانة النظام السوري، برعاية الروس؟
بين حال ذعر وتأهب واستنفار وريبة وقلق في أوروبا والغرب، بات مصير النظام السوري مجدداً في أسفل الأولويات. بل ان حماسة الرئيس الغاضب فلاديمير بوتين الى ردّ صاع إسقاط الطائرة الروسية، صاعين، حوّلت أولوية الصراع إلى مواجهة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبدو أقرب الى ملاكمة، بالنقاط.
بوتين يشفي لدى الأسد رغبة الانتقام من «السلطان» الذي يقف بين قادة الصف الأمامي لدول، تصدّ محاولات غربية لفتح ثغرة في جدار عزل النظام السوري، بذريعة أولوية الحرب على «داعش». وما يقوله الروس علناً، يذكّر باتهام نجل الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني بالاتجار بالنفط العراقي خلال عهد صدام حسين. تجرّأ الجيش الروسي على اتهام أسرة «السلطان» بتمويل خزائن «داعش» من تهريب النفط. تراجعَ إلى عتبة الصفر مشروع أردوغان للمنطقة الآمنة في شمال سورية.
بين «دواعشهم» و «دواعشنا»، للقيصر حصة أيضاً، والاشتباك الروسي- التركي إذا تكرر حادث إسقاط المقاتلة الروسية، سيطيح «عملية السلام» في سورية لفترة طويلة.
يدافع القيصر عن نظامٍ جلاّد، وينزعج إن لم يصدّق العرب أنه مخلص في البحث عن السلام للسوريين. بوتين يشجّع مزيداً من «الدواعش»، أما في أميركا فحين يصف بعضهم اللاجئين المنكوبين بالمأساة بأنهم «كلاب» لا مبرر لإغاثتهم، ألا يجدر التساؤل لماذا يكرهوننا؟
الحياة
تباين المصالح يحول دون تحالف دولي ضد “داعش”/ كاميي غران
دعا الرئيس الفرنسي الى ائتلاف واسع لمكافحة «الدولة الإسلامية». ولكن مثل هذه المكافحة يتعثر منذ أشهر بتباين مصالح القوى الاقليمية والدولية في الشرق الاوسط، وفي النزاع السوري، على وجه التحديد. وتسعى باريس الى إقناع واشنطن برفع وتيرة الحملة العسكرية على «الدولة الإسلامية». وإلى اليوم، التزم اوباما التحفظ. وتسعى باريس كذلك الى تبديد غموض اهداف الدول المشاركة في الائتلاف الدولي، وبلوغ مآرب جامعة ومشتركة. فموقف الدول العربية وتركيا غامض من «داعش»، على رغم اجماعها على أن المنظمة هي مصدر خطر قاتل. ولكن التنافس بين السنّة والشيعة لن يتبدد. وجل ما يرتجى هو الكف عن التوسل المزدوج بـ «داعش» في هذا النزاع الى تفتيت صفوف الخصم. وسلطت هجمات باريس، شأن تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء، الضوء على الخطر الداعشي الوازن. فهو لا يرمي فحسب الى انشاء خلافة توتاليتارية في المشرق، بل يوسع رقعة هجماته الى اصقاع العالم الاخرى. والتقارب بين الغرب (وهو لم يعد يشترط رحيل بشار الأسد) والروس (وهم صاروا يؤيدون مرحلة انتقال سياسي في سورية) بدأ قبل هجمات الثالث عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الاخيرة. وهذا التقارب يشرّع ابواب الديبلوماسية.
ولكن الروس والإيرانيين لن يقبلوا برحيل بشار الأسد، ولو قضت مفاوضات بذلك، وقد يطالبون بأن يشارك في الائتلاف الدولي ضد «داعش». ولكن يبدو ان اقصاءه هو شرط رص صفوف القوى في قتال داعش الميداني. وترغب باريس في اقرار مجلس الامن قراراً يقضي بتشكيل جبهة عسكرية موحدة ضد «داعش». وهذا القرار يمتحن المساعي الباريسية. فإذا لم يقتصر القرار على بيان تنديد مبدئي بالإرهاب، وأرسى اسساً قانونية تعبد الطريق امام تفويض دولي بإنشاء ائتلاف واسع ضد «داعش»، بلغت الحرب على «داعش» مرحلة حاسمة. ولكن هل في الامكان أن يبصر مثل هذا القرار النور من غير اتفاق حد ادنى على مستقبل سورية؟ ويرجح ألا تنضوي روسيا تلقائياً في ائتلاف على رأسه الولايات المتحدة، في غياب تفويض أممي. وإذا أرسي تحالف واسع وحاز تفويضاً اممياً قوياً، وجب تحديد الاهداف المشتركة لصوغ استراتيجية موحدة. ويقضي التعريف الاستراتيجي للغاية السياسية المعلنة، «القضاء على داعش»، بشن حرب على المنظمة الارهابية لتلقى مصير «القاعدة»: تقويضها فتتحول الى خطر ثانوي من غير ركيزة مكانية، ومن غير قدرة على شن عمليات مركبة ومعقدة شأن هجمات باريس.
ولا شك في ان الحرب تخاض وتربح في ميدان المعارك. ولكن هل يقتضي الفوز بالحرب ارسال قوات اجنبية لاحتلال شمال العراق وسورية؟ والحذر واجب إثر التدخل الاميركي في العراق في 2003. وثمة قوات برية تحارب «داعش»، وهي مؤتلفة من قوات حكومة بغداد والكرد (في العراق وسورية) وقوات المعارضة السورية وجنود نظام دمشق بمؤازرة «حزب الله» والإيرانيين. ولكن هذه القوات متفرقة وتجمع بين لاعبين يتقاتلون في سورية. ويصب هذا التباين والتقاتل في مصلحة «داعش». والحل يقضي بترجيح كفة اللاعبين المحليين وتعبئة القوى الاقليمية العربية، وليس بشن حملة عسكرية غربية. وسينظر الى تدخل بري غربي كبير (سواء شارك فيه الروس أم لا) على انه «حملة» جديدة على الشرق الاوسط. والمشاركة البرية الضخمة لقوى عسكرية غير عربية (تركيا وإيران) دونه عقبات.
وسبق ان مد الغربيين الحملة على «داعش» بالسلاح والمستشارين العسكريين والقوات الخاصة. وتمس الحاجة الى تعزيز هذا الدعم، من اجل ان تعزل القوى المحلية «داعش» في مرحلة أولى، ثم القضاء عليها. وعلى رغم توجيه سهام النقد اليها، لا غنى في الاستراتيجية البرية هذه عن مواصلة الحملة الغربية الجوية على «داعش» التي بدأت في صيف 2014. وهذه الحملة ساهمت في احراز بعض النجاحات. فالدولة الإسلامية تتراجع على وقع تحرير سنجار، ويبدو انها صارت عاجزة عن شن هجمات عسكرية كبيرة. ووحدة اراضيها ومخيمات تدريباتها ومراكز قيادتها وبناها اللوجيستية مهددة. ويساهم رفع وتيرة الحملة الجوية في نضوب موارد «داعش» (النفط)، وفي مؤازرة القوى البرية. والتنسيق مع سلاح الجو الروسي مفيد، وشرطه هو اتفاق سياسي يجمع على الاهداف والاولويات.
* مدير مركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي، عن «ليبيراسيون» الفرنسية، 20/11/2015، اعداد منال نحاس
الحياة
تنظيم الدولة.. هل غيّر إستراتيجيته تجاه الغرب؟/ عمر عاشور
“التوجيه الذي أتانا إلى الآن هو بعدم استهداف الغرب وأميركا من الشام، ونحن ملتزمون بتوجيه الدكتور أيمن حفظه الله، لكن إن استمر هذا الحال على وضعه اعتقد أن هناك إفرازات ستكون يعني ليست في صالح الغرب ولا في صالح أميركا”.
كلمات قالها أبو محمد الجولاني (قائد جبهة النصرة) بمقابلة له مع الجزيرة في مايو/أيار ٢٠١٥. “ربما تنظيم القاعدة يفعل هذا (يهاجم الغرب) لكن ليس من الشام، فهذا التوجيه أو الأمر الذي أتانا”. تتعارض هذه الكلمات -فيما يبدو- مع الإستراتيجية المعدلة لتنظيم الدولة نحو الغرب، والتي بدت ملامحها بوضوح مع هجمات باريس “الإرهابية” هذا الشهر، وبعد تصعيد تدريجي في خطاب التنظيم ضد “عدوه البعيد”.
قبل عام ٢٠١٥ كانت الأولويات الإستراتيجية لتنظيم الدولة جغرافية بالأساس تهدف إلى الاستيلاء على الأرض، ثم “تطهيرها” للسيطرة عليها عسكريا وأمنيا، ثم بناء مؤسسات شبه دولة -عليها- وفقا لرؤية التنظيم وأيديولوجيته، ثم التمدد في المناطق المجاورة عبر مهاجمة الأعداء والمنافسين، وهؤلاء تراوحوا ما بين القوى الثورية السورية حتى نظام الأسد والحكومة العراقية.
بدأ هذا النمط في العمل أو الـmodus operandi في التغير تدريجيا من صيف ٢٠١٤.
فمنذ شهر أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٤، شهدت الديمقراطيات الغربية ما لا يقل عن ٢٥ مخططا محتملا أو هجوما داخلها، خططها أو نفذها إما متعاطفون مع تنظيم الدولة (الأكثرية الساحقة من الحالات) أو أفراد تدربوا عند تنظيم الدولة (ثلاث حالات). ويُقارن هذا مع مُخَطَّطَين اثنين وهجوم واحد قبل أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٤ وهي:
1) مخطط مزعوم مشابه لهجمات “مومباي” (نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٨) في لندن، أحبطته أجهزة الأمن البريطانية في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٣.
2) مخطط مزعوم لهجوم في الريفييرا، أحبطته أجهزة الأمن الفرنسية في فبراير/شباط ٢٠١٤.
3) هجوم على المتحف اليهودي في بروكسل في مايو/أيار ٢٠١٤.
وبالرغم من أن الهجوم الأخير قد ارتكبه شخص تدرب في معسكرات تنظيم الدولة، إلا أن التحقيقات أشارت إلى أن الدوافع المباشرة في الحالات الثلاث هي تَبَني خطاب وأيديولوجية التنظيم، دون توجيه مركزي من قيادة بعينها داخله.
تغير هذا النمط من هجمات أنصار التنظيم بعد أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٤ كما سيأتي. فقد صعدت مجلة “دابق” -التابعة رسميا للتنظيم والتي تكتب بالإنجليزية وبلغات أخرى- من دعوتها لمهاجمة الغرب.
وكان تركيز المجلة -قبل ضربات التحالف الجوية- على إضفاء الشرعية على “الدولة” ونزع الشرعية الدينية والفكرية والسياسية عن أعدائها (بما في ذلك تنظيم القاعدة وحركة طالبان)، وكذلك على دعوة المسلمين للهجرة إلى أراضي التنظيم. ولكن الإصدارين الأخيرين للمجلة حملا عناوين مثل “من معركة الأحزاب (الخندق) إلى حرب التحالف” (الإصدار الحادي عشر في أغسطس ٢٠١٥)، و”الإرهاب العادل” (الإصدار الثاني عشر في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٥).
وكان العنوان الأول يقارن بين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، والائتلاف المكون من بعض القبائل العربية الوثنية وبعض العشائر اليهودية (الأحزاب) لحصار الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم في المدينة المنورة في عام ٦٢٧م. أما العنوان الثاني فكان يبرر لهجمات باريس.
وكانت “دابق” قد ركزت بشكل رئيسي على مهاجمة الغرب في السابق من خلال إصدار واحد عنونته بـ”الحملة الصليبية الفاشلة”، (الإصدار الرابع في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٤ )، وذلك مباشرة عقب بدء الضربات الجوية للتحالف.
وكان التوجيه حينها صريحا “في هذه المرحلة من الحملة الصليبية ضد الدولة الإسلامية، من المهم جدا الهجوم على كل البلاد التي دخلت في تحالف ضد الدولة الإسلامية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وأستراليا، وألمانيا”. ومع ذلك، جعل الإصدار التاسع للمجلة الهجوم على الغرب خيارا ثانويا، وجعلت “الهجرة” إلى أراضي التنظيم مقدمة عليه:
“إما أن يهاجر المسلم إلى ولايات الخلافة (التقسيمات الجغرافية-الإدارية لأراضي التنظيم)، أو إذا كان غير قادر على القيام بذلك، فيجب عليه مهاجمة الصليبيين”.
وبغض النظر عن الإصدارات الثلاثة المذكورة أعلاه (الرابع والحادي عشر والثاني عشر)، فإن الدعوة لمهاجمة الغرب مثلت نسبة ضئيلة من محتويات مجلة “دابق” بالمقارنة -على سبيل المثال- بمجلة “انسبير” (إلهام) التابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (الذي يعمل في اليمن وعمل سابقا في السعودية). فإذا كان هناك تغيير حقيقي في إستراتيجية التنظيم نحو تصعيد أولوية الهجمات ضد الغرب بعد ضربات التحالف الجوية، فماذا يريد التنظيم من هذه الهجمات؟
تاريخيا، أثبتت مثل هذه الهجمات فشلا ذريعا في حالة تنظيم القاعدة. فبعد هجمات ١١سبتمبر ٢٠٠١، خسر التنظيم قواعده في أفغانستان، وقتل أو اعتقل أكثرية قادته، بمن فيهم زعيمه أسامة بن لادن، وكذلك فقد حليفه الرئيسي (حكومة طالبان) الدولة التي كادت أن تسيطر عليها. بيد أن بعض قادة التنظيم والشخصيات القريبة من تياره الفكري تعتقد أن الهجمات في نيويورك وواشنطن جاءت بالعدو البعيد (القوات الأميركية) إلى مسافة أقرب (أفغانستان والعراق)، وبالتالي مكنهم ذلك من إلحاق أضرار كبيرة بعدوهم.
كما يعتقدون أن هجماتهم المضادة في العراق وأفغانستان أفسدت المخططات الغربية هناك بعد التدخل (بناء ديمقراطيات حليفة للغرب). وهذه المعتقدات لا تأخذ بعين الاعتبار أية تكاليف أو خسائر تكبدها التنظيم وحلفاؤه، أو تكبدها أهالي البلاد المشار إليها.
وبتصعيدها الخطاب والهجمات ضد الغرب، يبدو أن قيادة تنظيم الدولة إما تهدف لسيناريو مشابه لحالة القاعدة، وهو جلب العدو البعيد لمسافة أقرب (وهو ما يعني التدخل البري الغربي المباشر والنزول على الأرض)، أو لسيناريو آخر وهو “ردع” الغرب عن مهاجمة الأراضي التي تسيطر عليها قيادة التنظيم.
وفي كلتا الحالتين، فإن ذلك يمثل مشكلة حقيقية. فـ مقارنة بتنظيم القاعدة، فإن تنظيم الدولة لديه موارد وقدرات وخبرات أكثر. ولا يُظهِر ذلك فقط قدرة التنظيم على السيطرة على أراضٍ تمتد من بلدات في حلب في سوريا إلى أجزاء من محافظة صلاح الدين بالعراق، حيث يعيش أكثر من عشرة ملايين شخص، ولكن يُظهِر ذلك أيضا قدرة التنظيم على الضرب في مناطق لا يسيطر عليها بشكل مركزي.
فمثلا، حاول تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تفجير طائرات مدنية غربية عدة مرات، ومن أبرزها ما يسمى بمخطط “يوم عيد الميلاد” في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٩. ولكن كل محاولاته أحبطت. أما تنظيم الدولة فقد أسقط طائرة ركاب مدنية روسية من المحاولة الأولى في ٣١ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥، مما أسفر عن مقتل ٢٢٤ مدنيا في سيناء.
ولذلك يمثل هذا التغيير في إستراتيجية التنظيم، وقدراته الكبيرة على الضرب في العمق، تحديا كبيرا للقادة الغربيين، بما في ذلك وضع إستراتيجية أمنية مبنية على أن تنظيم الدولة سيستخدم موارده لاستهداف “عدوه البعيد”، وذلك مع عدم تبني سياسات وتكتيكات تزيد من حالات التمييز والاستقطاب المحلي التي تفرز بيئة تساعد تنظيم الدولة على التجنيد والتنفيذ.
الجزيرة نت
لماذا «داعش»؟/ خيرالله خيرالله
عاجلا ام آجلا، ستبيّن ان ليس في الإمكان هزيمة «داعش» من الجو. هل من نيّة حقيقية في الإنتهاء من «داعش»، خصوصا انّ كلّ من له علاقة بالسياسة والعلم العسكري من قريب أو بعيد، يعرف انّه لا يمكن هزيمة هذا التنظيم المتوحش من دون وجود لقوّات على الأرض. هذا يعني في طبيعة الحال تكاليف ستتحملها الدول المهتمة فعلا باقتلاع هذا الخطر من جذوره. هل من استعداد اميركي لذلك… ام سيترك الأمر للأوروبيين والروس الذين ليسوا قادرين وحدهم على تنفيذ عملية عسكرية واسعة تفضي الى اجتثاث «داعش»؟
تنبّه الكرملين الى خطورة الوضع في سوريا، ولكن من وجهة نظر خاصة به تتجاهل العلاقة بين النظام السوري و»داعش» والحواضن المتوافرة لهذا التنظيم الإرهابي. هذا جعل روسيا تلعب دورا في خدمة «داعش»، اقلّه حتّى الآن.
قبل تفجير طائرة الركّاب الروسية فوق سيناء وقبل تفجير برج البراجنة في بيروت وقبل المجزرة التي حصلت في باريس، ارسلت روسيا طائرات الى الأراضي السورية ونحو ثلاثة الاف مقاتل لحماية القاعدة الجويّة القريبة من اللاذقية التي تستخدمها هذه الطائرات. متى سيكتشف الروسي ان خطوته هذه ليست كافية في حال يريد «اقامة توازن على الأرض» تمهيدا لحل سياسي، كما يردّد فلاديمير بوتين امام كبار زوّاره؟
لا مجال للتخلص من «داعش» من دون مقاربة شاملة. كلّما مرّ الوقت زادت صعوبة هذه المهمّة، لا لشيء سوى لأنّ القصف الجوي لا يؤدي النتائج المطلوبة.
تشمل المقاربة الشاملة ايجاد مخرج لبشّار الأسد من السلطة باسرع ما يمكن. نعم، ان علي خامنئي وفلاديمير بوتين على حقّ عندما يقولان بعد لقائهما في طهران انّه ليس مقبولا فرض حلول من خارج على سوريا. من الطبيعي عدم فرض حلول على سوريا من خارجها. لكنّ ما هو طبيعي اكثر امتناع روسيا وايران عن فرض حلول بالقوّة على الشعب السوري الذي يريد باكثريته الساحقة التخلّص من النظام الذي اذلّه طوال ما يزيد على نصف قرن. كان ذلك في اليوم الذي وصل فيه حزب البعث الى السلطة اثر انقلاب عسكري في الثامن من آذار ـ مارس من العام 1963. ما تلا هذا الإنقلاب بات معروفا، وصولا الى حكم الطائفة في 1970، ثم حكم العائلة ابتداء من السنة 2000.
من يسعى الى فرض حلّ من خارج على سوريا، على الشعب السوري تحديدا، هما روسيا وايران. فبوتين يعرف قبل غيره ان مسألة سقوط بشّار الأسد كانت مسألة وقت ليس الّا لولا التدخل العسكري الروسي. هذا التدخّل سيطيل المأساة السورية ولا شيء آخر غير ذلك. كلّما ادّى اليه التدخل الروسي وقبله الإيراني، اكان ذلك في سوريا أو العراق، يتمثل في توسّع «داعش» وتمدده في كلّ الإتجاهات.
هناك حاجة الى وقف نموّ هذا السرطان وتمدّده. لا مجال لأيّ علاج جذري لا يشمل التخلّص من النظام السوري والعمل في الوقت ذاته على وقف ارتكابات «الحشد الشعبي» في العراق. هناك ميليشيات مذهبية تتصرّف مع السنّة العرب كأنّها الدولة العراقية وقد خلقت حاضنة عراقية لـ»داعش»، الى جانب الحاضنة السورية.
لو جاءت كلّ الطائرات الفرنسية وليس حاملة الطائرات «شارل ديغول» وحدها، ولو وضعت بريطانيا قاعدتها في قبرص في تصرّف فرنسا، كما تعهّد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، لن يقود ذلك الى القضاء على «داعش». لن يحصل شيء ذو مغزى في غياب الموقف الأميركي الواضح والقاضي بالإعداد لحملة عسكرية على الأرض ومعالجة الأسباب التي تجعل «داعش» يمتلك حواضن في سوريا والعراق… ومناطق اخرى.
يظلّ السؤال المحيّر لماذا هذا الموقف الأميركي المائع حيال كل ما يدور في سوريا؟ هل الإدارة الأميركية مع «داعش» أو ضدّه؟ هل يكفي ان يكون باراك اوباما مصرّا على انتهاج سياسة معاكسة كلّيا لسياسة جورج بوش الإبن حتّى لا يحترم تعهداته السورية، بما في ذلك «الخط الأحمر» الذي تحدّث عنه قبل لجوء بشّار الأسد الى السلاح الكيميائي في حربه على شعبه صيف العام 2013.
الى اشعار آخر، لا وجود سوى لسياسة وحيدة واضحة تجاه سوريا. هذه السياسة هي تلك التي تنتهجها طهران وموسكو. تقوم هذه السياسة على تقاسم سوريا في غياب القدرة على الإبقاء على النظام القائم. في انتظار اكتمال عملية التقاسم التي ليس ما يشير الى ان الإدارة الأميركية تعترض عليها، يبدو «داعش» اكثر من مفيد لهذا الحلف، بل حاجة له. يأتي ذلك في ظل البحث الروسي ـ الإيراني عن بعبع ارهابي يبرّر وجود ميليشيات مذهبية عراقية ولبنانية وافغانية وخبراء ايرانيين في الداخل السوري… وسيطرة روسية على مناطق الساحل.
ايران مهتمّة في نهاية المطاف بجزء من سوريا لديه ممرّ الى مناطق يسيطر عليها «حزب الله» في لبنان، وروسيا مهتمّة بان لا تصل انابيب الغاز الآتي من الخليج الى الشاطئ السوري.
على الرغم من احتمال بروز تناقضات بين موسكو وطهران في المدى البعيد، يظلّ الجانبان قادرين في الوقت الحاضر على ايجاد قواسم مشتركة بينهما في شأن كلّ ما له علاقة بسوريا.
لا شكّ ان الموقف الأميركي، الذي يعني اوّل ما يعني، الحاجة الى مقاربة مختلفة جذريا لموضوع «داعش»، يساعد في المد من عمر هذا التنظيم الذي يخدم طهران وموسكو والنظام السوري طبعا… من حيث يدري أو لا يدري، والأرجح من حيث يدري!
لماذا «داعش»؟ الجواب بكل بساطة لأنّ هناك غير طرف في حاجة اليه ويبني سياسته انطلاقا من هذه الحاجة.
المستقبل
« حروب المياه التي يشنها تنظيم «الدولة الإسلامية
ترجمة وتحرير فتحي التريكي – الخليج الجديد
استخدام تنظيم «الدولة الإسلامية» الموارد الطبيعية من أجل تحقيق أهدافه الاستراتيجية ليس أمرا جديدا. النفط، أحد أكبر مصادر تمويل المجموعة، يلعب دورا هاما في حساباتها، وهو أمر يجب أن تعيه جميع الدول التي تقود قتالا ضد التنظيم، وأن تبدأ في تحديد أهدافها وفقا لذلك. على سبيل المثال، بدأت الولايات المتحدة وفرنسا إطلاق ضرباتهم الجوية ضد الشاحنات النفطية للمنظمة ومراكز التوزيع الخاصة بها على أمل أن تعيق قدرتها على دفع تكاليف عملياتها العسكرية.
ولكن الأمر الذي يأخذ حيزه الكافي من الحديث، على الرغم من كونه لا يقل أهمية، هو استخدام «الدولة الإسلامية» للمياة كسلاح في حربها لإقامة الخلافة. جلبت تكتيكات «الدولة الإسلامية» المياه إلى صدارة الصراع في العراق وسوريا، ما يهدد حياة أولئك البشر الذين يعيشون تحت حكمها القمعي. إذا لم يتحرك خصوم «الدولة الإسلامية» من أجل تحريك قبضة المجموعة عن مصادر المياه العراقية والسورية، فسرعان ما سيكون من الصعب تحرير المنطقة من قبضة المجموعة على المدى الطويل.
صراع تاريخي
وقد اشتبكت الحضارات منذ فترة طويلة من أجل الوصول إلى المياه وتأسيس إمبراطوريات في جميع أنحاء الأنهار الكبرى. ويعتقد المؤرخون أن مدينة أور السومرية القديمة كان مفضلة بالنسبة إلى الإمبراطوريات التالية بسبب وفرة المياه وقربها من الخليج. هناك روايات تقول أن سكان المدينة قد هجروها خلال فترات الجفاف الشديد وجفاف نهري دجلة والفرات. اليوم، فإن الجفاف وقلة الأمطار تتنافس مع كارثة الإرهاب من أجل تدمير الرقعة الخصبة من الأرض التي تمتد على طول النهرين.
الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية على حد سواء قد استخدمت المياه كسلاح على مدار قرون متعاقبة. وبينما كان عدد الحروب كاملة على موارد المياه أقل مما قد يتوقع المرء، فإنه نظرا لأهمية المياه لبقاء أي مجموعة من السكان، فقد تسبب المياه في العديد من الصراعات الصغيرة القاتلة. وقع الشرق الأوسط فريسة لهذا النوع من السباقات في الأعوام الأخيرة، حيث انتقلت الدول والجماعات على نحو متزايد من قطع إمدادات المياه لفترة قصيرة من الوقت إلى تحويل تدفق المياه كليا أو استنزاف الإمدادات في محاولة لتهديد أو إكراه المستهلكين.
«الدولة الإسلامية» ليست استثناء. منذ أن بدأت الجماعة في توسيع مطامعها الإقليمية في غرب سوريا، فقد ظلت تستخدم المياه كأداة في إستراتيجية أوسع نطاقا تشمل بسط السيطرة على الأرض الجديدة. النظرة الفاحصة إلى تحركات المجموعة تكشف بوضوح أن نهري دجلة والفرات يلعبان دورا مركزيا في إستراتيجية التنظيم. إدراك نية «الدولة الإسلامية» تنظيم الخلافة الجديدة في جميع أنحاء حوض دجلة والفرات قد تكون مفيدة في المعركة الطويلة الأمد ضد التنظيم.
في عام 2012، ظهرت «الدولة الإسلامية» من فراغ السلطة التي خلقتها الحرب الأهلية السورية وجعلت وجودها متركزا في غرب مدينة حلب. كانت لديها القليل من القواسم المشتركة مع الجماعات المتمردة الأخرى في سوريا والتي كانت تركز في المقام الأول على محاربة قوات الرئيس السوري «بشار الأسد» لتغيير النظام. بدلا من ذلك، كانت «الدولة الإسلامية» منظمة إرهابية بأجندة واستراتيجية واضحة: إنها كانت تريد إنشاء خلافة إسلامية أقرب إلى الإسلام على نهج النبي محمد من وجهة نظرها. خلال السنة التالية، انتقلت المجموعة بشكل سريع وحاسم، قاطعة الطريق في سوريا والعراق حيث استولت على مدن رئيسية مثل الرقة ودير الزور والبوكمال وجميعها تقع على نهر الفرات.
على الجبهة العراقية، لا تبدو الأمور مختلفة كثيرا. استولت «الدولة الإسلامية» بسهولة على المدن النهرية مثل راوة والرمادي والفلوجة. اثنان منها (راوة والرمادي) أعطتا المجموعة الوصول المباشر إلى اثنتين من البحيرات الهامة في العراق هما بحيرة السد وبحيرة الثرثار. وفي الوقت نفسه، واصلت «الدولة الإسلامية» إستراتيجية مماثلة على طول نهر دجلة، واستولت بنجاح على الموصل وتكريت وحاولت الاستيلاء على بلدات أخرى على طول الطريق. في العراق كان الهدف هو بغداد، والتي سوف تمكن الجماعة من حكم الخلافة في سوريا والعراق. بينما كانت حقول النفط والغاز الطبيعي التي احتلتها على طول الطريق وسيلة للمجموعة لتهديد القوات العسكرية وكسب المال، وكانت المسطحات المائية والبنية التحتية وسيلة لعقد المنطقة بأكملها كرهينة.
تاريخيا، كانت نهري دجلة والفرات مصدرا هاما للخلاف بين تركيا وسوريا والعراق وإيران. وقد أدى عدم وجود تعاون وتنسيق بين هذه الدول على تقاسم الأنهار على عدم تنظيم استعمالها والاستخدام المفرط للموارد. ونتيجة لذلك، فإن كافة الأنشطة التي تمارسها دول المنبع بشأن الموارد المائية تنطوي على مخاطر إثارة التوترات مع دول المصب. مع عدم وجود التنسيق الإقليمي وسوء الأوضاع الأمنية على طول الأنهار، فإن الجماعات الإرهابية كانت قادرة على استخدام المياه على حد سواء وسلاح وعلى رأسها «الدولة الإسلامية». ليس لأنها دمرت البنية التحتية ذات الصلة بالمياه مثل الأنابيب ومحطات الصرف الصحي والجسور والكابلات المتصلة بالمنشآت المائية، ولكن أيضا لكونها تستخدم كأداة للعنف من خلال إغراق متعمد المدن، وتلويث المسطحات المائية وتدمير الاقتصادات المحلية عن طريق تعطيل توليد الكهرباء والزراعة.
منذ عام 2013، شنت «الدولة الإسلامية» ما يقرب من 20 هجمة كبيرة (وكذلك عدد لا يحصى من الاعتداءات الصغيرة) ضد البنية التحتية للمياه السورية والعراقية. بعض هذه الهجمات شملت إغراق بغض القرى وبلغت حد التهديد بغمر بغداد وإغلاق بوابات السدود في الفالوجة والرمادي وقطع المياه عن مدينة الموصل، كما يزعم أنها قامت بتسميم المياة في بعض المدن السورية الصغيرة. معظم هذه العمليات قد صممت من أجل محاربة الجيش النظامي باستخدام الماء كسلاح ضده، وشملت استهداف البنية التحتية للمياه لعرقلة تحركات القوات. هذه الجهود كانت تشمل في كثير من الأحيان فائدة إضافية تمثلت في تعزيز جهود التوظيف. من خلال السماح بتدفق المياه إلى المدن المتعاطفة مع تنظيم «الدولة الإسلامية» يمكن للتنظيم جذب المزيد من الرجال والنساء إلى صفوفها.
لعب الماء أيضا دورا جوهريا في استراتيجية التنظيم التوسعية. ضمنت «الدولة الإسلامية» أيضا أن المسطحات المائية والبنية التحتية المناظرة لها قد انتقلت إلى واجهة الصراع في الشرق الأوسط. السيطرة على الموارد المائية الرئيسية والسدود، بدورها، تعطى «الدولة الإسلامية» القدرة على إحكام قبضتها على الإمدادات المستخدمة لدعم الزراعة والكهرباء. سد الموصل، على سبيل المثال، أعطى «الدولة الإسلامية» السيطرة على أكثر من 75% من الكهرباء المولدة في العراق حين كان في حوزة المجموعة. في عام 2014، عندما أغلق التنظيم سد الفلوجة، دمرت الفيضانات لاحقا حوالي 200 كم مربع من الحقول والقرى العراقية. وفي يونيو/ حزيران 2015، أغلقت «الدولة الإسلامية» خزان الرمادي في الأنبار، ما حد من تدفق المياه إلى الأهوار العراقية المشهورة وإجبار العرب الذين يعيشون هناك على الفرار. وبينما تمكنت قوات التحالف والحكومة في كلا البلدين من استعادة بعض المواقع الرئيسية للمياه، إلا أن التهديد بالضرر لا يزال قائما.
وفي الوقت نفسه، استخدمت الحكومات والجيوش تكتيكات مماثلة لمكافحة «الدولة الإسلامية»، عبر إغلاق بوابات السدود أو مهاجمة البنية التحتية للمياه التي تقع تحت سيطرتهم. لكن مقاتلي «الدولة الإسلامية» ليسوا الوحيدين الذين تضرروا من هذه الجهود، ولكن المعاناة قد وصلت إلى سكان المناطق المجاورة أيضا. وقد اتهمت الحكومة السورية مرارا بحجب المياه والحد من التدفقات أو إغلاق بوابات السد خلال القتال ضد «الدولة الإسلامية» أو الجماعات المتمردة، وأنها استخدمت الحرمان من المياه النظيفة كتكتيك قسري ضد العديد من ضواحي دمشق التي يعتقد أنها متعاطفة مع الثوار.
البحث عن حل إقليمي
ونظرا لأهميتها لكل من وليد الكهرباء والإنتاج الزراعي، فإن المياه لديها القدرة على تشغيل الاقتصاد أو تدميره. ونظرا لكون المسطحات المائية في كثير من الأحيان تتجاوز حدود أي بلد واحد، فإن التاريخ يظهر أنه في كثير من الأحيان يمكن أن تتم تسوية المنافسات حول مصادر المياه التعاون الإقليمي. قبل تدهور الأوضاع في سوريا والعراق وظهور جماعات على شاكلة «الدولة الإسلامية»، لم يكن أمام دول منطقة دجلة والفرات سوى بعضها البعض. في عام 2010، بدا أن قادة تركيا وسوريا ولبنان والأردن على وشك إحراز تقدم نحو إقامة منطقة اقتصادية متكاملة. دعا قادة الدول لتعاون المنطقة بأسرها في مجال السياحة والخدمات المصرفية والتجارية والقطاعات الأخرى، ما كان من الممكن أن يشكل أساسا لمزيد من الاتفاقات بشأن توزيع الموارد الطبيعية المشتركة مثل المياه.
لكن السياسة قد لعبت لعبتها، وفي غضون أقل من عام، كان الجميع قد خسر اللحظة. إذا كانت تركيا والعراق وسوريا قد أخذت الفرصة للعمل في حين كانت الظروف السياسية مواتية، لربما كان من الأسهل معالجة مسألة «الدولة الإسلامية» في وقت لاحق. المسطحات المائية يمكن أن ينطبق عليها وصف المشاعات الإقليمية، وبالتالي فإنها تخضع للمسؤولية الجماعية لجميع الأطراف.
ليس هناك شك في أن «الدولة الإسلامية» لديها استراتيجية واضحة جدا، تمتد إلى ما هو أبعد من سوريا والعراق إلى المنطقة على نطاق أوسع. أنشأ التنظيم مجموعة من الأفرع في شمال إفريقيا بعد مسار مماثل من السيطرة على الموارد الرئيسية واستخدامها كسلاح ضد السكان والسعي لإكراه وتدمير الحكومات. لقد حان الوقت أن تعيد الدول المجاورة والمجتمع الدولي النظر في ما يعرفونه عن تكتيكات «الدولة الإسلامية»، وصياغة خطة عمل جديدة. يجب أن يصبح جعل القوات التي تقاتل «الدولة الإسلامية» في المنطقة كحوض واحد متكامل، وبالتبعية الامتدادات السكانية الخاصة بها، في صدارة الاستراتيجيات. كانت المياه دوما تشكل جوهر الحضارات. في الشرق الأوسط، ومع وجود «الدولة الإسلامية»، يبدو أن الأمور لا تختلف كثيرا.
ستراتفور
سؤال مبكر: ما مصير سوريا بعد دحر «داعش»؟/ د. عصام نعمان
■ مع الحضور الروسي الكثيف في سوريا، انحسر التساؤل عن مصير بشار الأسد. يبدو الرئيس السوري الآن بمأمن من أيّ خطر أمني أو سياسي ماثل. لكن ماذا عن سوريا؟
لعل السؤال الأدق هو: ما مصير سوريا بعد دحـر «الدولة الإسلامية ـ داعش»؟
الدافع إلى طرح السؤال الحشدُ العسكري الضخم الذي تُشارك في تكوينه وتفعيله دول كبرى ومتوسطة وتنظيمات وأطراف عربية وأخرى إقليمية. الحشد كثيف ومهيب، فهل تتطلّب الحرب ضد «داعش» كل هذه القوات والقدرات والإستعدادات؟ وإذا لم يتمكّن هذا الحشد العالمي غير المسبوق من دحر»داعش»، ماذا سيكون مصير سوريا؟ بل ماذا سيكون مصير عالم العرب؟
سؤال آخر له صلة بسوريا: هل رجب طيب اردوغان جاهل أم مغامر؟ هل يعقل أن يكون جاهلاً حجم التبادل التجاري بين بلاده وروسيا، الذي يصل إلى 44 مليار دولار سنوياً، وأن روسيا تغذي نصف احتياجات بلاده من الغاز، وأن عدد السياح الروس يُعدّ الثاني بعد الألمان الزائرين لتركيا، وقد بلغ نحو 4.5 مليون سائح في العام الماضي؟ ما الهدف او المربَح الذي ستحققه تركيا بإسقاط طائرة حربية روسية داخل سوريا أو على حدودها الشمالية؟
أردوغان يعزو إسقاط الطائرة إلى الجهل: «فلو عرفنا أنها روسية الهوية لَما قمنا بإسقاطها، لكننا لن نعتذر»! لنفترض أن ما يقوله صحيح، أليس اتضاح هوية الطائرة سبباً كافياً للاعتذار؟ ألا يستحق صون المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين ثمناً زهيداً لا يزيد عن اعتذار بروتوكولي؟ أردوغان ليس ساذجاً لتغيب عن ذهنه كل هذه الامور. يجب أن يكون، إذن، دافعٌ بالغ الأهمية لإقدامه على إسقاط الطائرة الروسية ولإحجامه عن الاعتذار. هل هو ردع روسيا عن دعم الجيش السوري (وربما ردع اكراد سوريا أيضاً) في حملته الناشطة لاستعادة كامل منطقة شمال حلب من جرابلس إلى عفرين وبالتالي منع انقرة من إقامة «منطقة انسانية آمنة» فيها؟ هل تستحق اقامة هذه المنطقة تلك المغامرة المكلفة؟
الولايات المتحدة كانت تتحفظ بشأن سعي تركيا لإقامة منطقة آمنة في شمال غرب حلب. بعد الحضور الروسي الكثيف في سوريا، ابدت واشنطن ليونةً تجاه المسعى التركي وشفعت ذلك بتبريرٍ لإسقاط الطائرة الروسية مفاده أنه «من حق تركيا الدفاع عن النفس». في المقابل، موسكو اتهمت واشنطن بأنها وفّرت لأنقرة، بموجب اتفاق التنسيق الجاري بينهما، معلوماتٍ كانت زودتها بها حول حركة طائراتها الحربية في سماء سوريا. ازاء ما بدا أنه تواطؤ أمريكي ـ تركي، سارعت موسكو إلى اتخاذ خطوتين: الاولى استراتيجية والثانية تكتيكية. تجلّت الخطوة الاولى بترفيع مستوى حشدها العسكري بنشر قواعد لصواريخ 400-S في مطار حميميم السوري، واستقدام ثلاثة أسراب من الطائرات المقاتلة لتحمي الطائرات القاذفة أثناء قيامها بتنفيذ مهامها. تجلّت الخطوة الثانية بمباشرة قصف مواقع وتحشيدات مختلف التنظيمات الإرهابية في محاذاة الحدود السورية – التركية وعلى معابرها وصولاً إلى مواقعها في جبل التركمان بين محافظتيّ اللاذقية وادلب.
تسبّبت الخطوة الإستراتيجية، ولاسيما نشـر صواريخ 400 – S، بـِ»قلق أمريكي جدّي». ذلك أن من شأنها، بحسب ضابط امريكي كبير، إحداث تغيير جـذري في موازين القوى، ليس في منطقة الشرق الاوسط فحسب، بل في منطقـة البحر المتوسط كلها، كما من شأن العمليات الجوية الروسية إعاقة الطلعات الجوية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. أما الخطوة تكتيكية فإنها تتيح نصب كمائن للمقاتلات التركية على طول الحدود مع سوريا. فحركة القاذفات الروسية بمحاذاة الحدود السورية – التركية قد تجتذب المقاتلات التركية إلى مسافات قريبة منها ما يشكّل فرصة سانحة وعذراً كافياً للمقاتلات الروسية كما لصواريخ 400- S للنيل منها. فوق ذلك، واكب الخطوة التكتيّة، التي يستفيد منها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (السوري) «ووحدات حماية الشعب الكردي»، اعلانٌ باستعداد موسكو لدعمهما في وجه «داعش». ذلك عزز الظنون بأن القادة العسكريين الروس خططوا مع القادة العسكريين السوريين من أجل مباشرة عملية واسعة ضد «داعش» في محافظة الرقة التي تشكّل مرتكز ثقله الاساسي.
المبادرات والتحركات الروسية اقلقت الأمريكيين فسارعوا إلى دعم «وحدات الحماية الكردية» بنحو 50 مستشاراً ومدرِّباً لتعزيز جهودها القتالية ضد «داعش». يبدو كأنما هناك سباق بين مختلف أطراف الحرب إلى تحرير الرقة بغية كسب الجائزة الاولى وما يليها من مكاسب. فالسوريون، ومعهم الروس، يريدون أن يتمّ دحر»داعش» على ايديهم فلا يكون للغير، ولاسيما للامريكيين وللأكراد المتعاونين معهم، أي جميل أو دور لتعويضهم بترتيبات تمسّ بوحدة الاراضي السورية. أما الامريكيون فيريدون لحلفائهم الاكراد السوريين أن يكون لهم دور مؤثّر في دحر «داعش» ليدعموا بموجبه مطالبتهم بصيغة للحكم الذاتي.
يبقى أن المتضرر الاكبر من هذه التطورات المحتملة هو انقرة لأنها تخسر بدحر «داعش» حليفاً ضمنياً يشاطرها العداء لسوريا وقيادتها السياسية، كما تخسر بتقاسم اكراد الشمال السوري مع دمشق مزايا الانتصار على «داعش». هذا الاحتمال الماثل قد يحمل انقرة القلقة على تكثيف دعمها لحلفائها (جبهة «النصرة» و»أحرار الشام « و»الجبهة الشامية» وبعض وحدات «الجيش الحر») بغية الحؤول دون نجاح خصومها في تسجيل نصر حاسم على «داعش». وربما يغري موقفٌ تركي متشدد وفاعل ضد خصوم انقرة ومنافسيها في الساحة السورية بعضَ دول الخليج بتعزيز قدرات حلفائها السوريين («جيش الإسلام» و»احرار الشام» وغيرهما) لإضعاف الحكم في دمشق. فوزير الخارجية السعودي عادل الجبير ما انفك يصرح بأن «بشار الاسد لا يملك إلاّ خيارين: إما الرحيل في شكل سلمي او الإبعاد بعد عمل عسكري». لكنه لا يوضح من سيتولى القيام به. ثم، هناك «اسرائيل» الحريصة على استغلال الصراع المحتدم من أجل تحقيق غرضها الاثير وهو تفكيك سوريا إلى جمهوريات موز هزيلة على اسس عرقية أو مذهبية أو قبلية.
هذه التطورات المحتملة تزيد الصراع في سوريا وعليها احتداماً، كما من شأنها إطالة أمد الحرب الدائرة في ساحاتها وعلى كامل جغرافيتها، وأن تنعكس تالياً على وحدتها الوطنية والسياسية. أفلا يجوز السؤال، في إطار التحسّب للمخاطر والمطامع المنتظرَة، عن مصير سوريا بعد دحر «داعش»؟
القدس العربي
داعش الأميركي/ حسين عبد الحسين
الدراسة التي أصدرتها جامعة جورج واشنطن بعنوان “داعش في أميركا” حازت اهتماما واسعا في الاوساط الاميركية. الا ان الاميركيين لم يتنبهوا الى النقطة الاهم في الدراسة، وهي ان ٤٠ في المئة ممن يجندهم التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي هم اميركيون من دون اي جذور عربية او مسلمة.
النسبة المرتفعة بين الاميركيين من غير العرب او المسلمين ممن يتأثرون بدعاية داعش ويعتنقون الاسلام تنسف النظرية القائلة ان انتشار داعش سببه تعاليم الدين الاسلامي او عادات مجتمعية غير متسامحة سائدة بين العرب والمسلمين.
مثلا، كيف نبرر انضمام الممرضة الاميركية المسيحية من اصل ايرلندي شانون مورين كونلي الى داعش؟ أو كيف نبرر التحاق ابنة ضابط شرطة افريقي – اميركي تدعى جايلين يونغ الى التنظيم؟ أو ما الذي دفع دوغلاس ماكين الى التخلي عن طموحه بأن يصبح مغني راب ليلتحق بجهاد داعش المزعوم؟
وكان لافتا في الدراسة ايضا ان من اصل ٥٧ اعتقلتهم السلطات الاميركية بتهم الارهاب المتعلقة بداعش، ٢١ منهم تتراوح اعمارهم بين ١٨ و٢٠، و١٤ منهم بين ٢١ و٢٣، فضلا عن قاصرين، ما يعني ان ثلثي من اعتقلتهم الاستخبارات الاميركية هذا العام بتهم ارهاب داعش هم تحت ٢٣ عاما.
وفي الدراسة ايضا ان مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) يراقب ٩٠٠ يعتقد انهم يناصرون داعش او يؤيدونه. الا ان الدراسة تنقل عن مسؤولي هذا الجهاز ان تأييد غالبية هؤلاء لداعش عادة لا تتخطى المجال الافتراضي، وأن عددا لا بأس منهم لا يلبث ان يتخطى مرحلة الاعجاب بالتنظيم ويتخلى عن تأييده.
دراسة “داعش في أميركا” تظهر ان ظاهرة اعجاب شباب بداعش، وانضمامهم اليه، لا ترتبط بالدين الاسلامي ولا بتقاليد وعادات المجتمعات الاسلامية، بل هي ظاهرة تتعلق بمرحلة الطيش التي يمر بها عدد كبير من الشباب في مختلف المجتمعات، بعضهم ينضجون ويتخطونها، وبعضهم الآخر لا يقومون أبدا من كبوتهم.
طبعا الدراسة الاميركية لا تفسر قيام داعش نفسه، فالتنظيم نتيجة سلسلة حروب في العراق ترافقت مع حصار اقتصادي قاس وتحطيم أميركا التوازن السني – الشيعي الذي كان سائدا الى ان اجتاحت قواتها العراق.
لكن غير نواة داعش وقياداته والناس المجبرة على الالتحاق به في سوريا والعراق، اما جوعا او خوفا، تبقى الحركة العالمية المرتبطة بداعش اليوم، والتي تقلق الغرب، حركة عابرة للثقافات والاجيال، وتتطلب معالجات تختلف عن بناء تحالفات عسكرية دولية ودك الرقة والموصل بقذائف المقاتلات.
قبل ان يرتكب شبان فرنسا جرائم باسم “الدولة الاسلامية” كانوا يحرقون سيارات ويقطعون طرقات ضواحي باريس بسبب عوزهم وانعدام فرص العيش المتاحة لهم. وقبل ان يلتحق الاميركي من اصل ايرلندي تيرينس ماكنيل بداعش، قام اميركي آخر من اصل ايرلندي هو تيموثي ماكفي بتفجير مبنى في اوكلاهوما في العام ١٩٩٥ في أكبر “ارهاب داخلي” عرفته البلاد، حسب الارشيف الاميركي.
كان عمر ماكفي يومها ٢٧ عاما، وقال ان سبب ارتكابه فعلته، بالتعاون مع تيري نيكولز ومايكل فورتييه، نيته “اشعال ثورة ضد الحكومة الفدرالية الظالمة”، وهو السبب نفسه الذي دفع ديلان روف، ٢١ عاما، الى ارتكاب مجزرة في كنيسة في حزيران (يونيو).
وينتمي روف الى تنظيم مسيحي يميني متطرف، غالبا ما يرتكب اعمال عنف عنصرية ضد غير البيض او المسلمين او الهندوس.
داعش بنسخته الشرق اوسطية ميليشيا مثل باقي الميليشيات، ولدت من رحم الحروب والفوضى التي تعم المنطقة منذ زمن. اهداف داعش هي كأهداف الميليشيات المنافسة، اي السيطرة على اراض وطرقات وفرض خوات وضرائب وبلطجة محلية.
اما داعش العالمي فسببه ظروف لا ترتبط بالشرق الاوسط على الرغم من نجاح داعش في الافادة من هذه الظروف وتحريض ضحاياها للقيام بعمليات عنف تؤدي الى تسليط الاضواء عليه.
ان خطط العالم وأميركا للتعامل مع داعش اضاعة للوقت، جاءت آخر تجلياتها في تأكيد الرئيس باراك أوباما ان بلاده نجحت في “احتواء” التنظيم، فرد عليه رئيس اركانه جو دنفورد امام الكونغرس بنفي نجاح أميركا بعملية “الاحتواء”، وهذا تباين يؤكد ان القيمين في أميركا على سياسة التعاطي مع الشرق الاوسط، وخصوصا داعش، لا يعرفون ماذا يفعلون.
المدن
على واشنطن إرسال قوات برية للقضاء على “الدولة الإسلامية”/ جيمس جفري
الهجمات المروعة في باريس، التي جاءت في أعقاب قيام تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية» على الأرجح بتفجير طائرة ركاب روسية في سيناء في خضم الأزمات الناجمة عن الصراعات ذات الصلة التي تدور في العراق وسوريا، تتطلب جواباً على السؤال التالي: متى تدرك الولايات المتحدة بأنها في حاجة ماسة إلى استخدام القوة العسكرية الحقيقية لهزيمة تهديد تنظيم «الدولة الإسلامية»؟
بعد مرور ما يقرب من 18 شهراً على بدء إدارة أوباما باتخاذ أنصاف الحلول، من الواضح أنه لن تتم هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» في غياب قوات برية متنقلة من الدرجة الأولى، تكون مترابطة مع قوة جوية ساحقة.
ولا يجب أن تكون تلك القوة البرية كبيرة – على سبيل المثال كانت القوة الأمريكية الرئيسية المهاجمة التي شاركت في أكبر معركة في حرب العراق الثانية في الفلوجة عام 2004، مكونة فقط من سبعة إلى ثمانية كتائب، مع تعزيز ودعم [لوجيستي]، ليصبح عدد أفرادها 7000 إلى 8000 جندي. كما لا يجب أن تكون جميعها أمريكية.
فبإمكان القوات الفرنسية وغيرها من القوات الغربية التي تمتلك مستوى جيد من الخبرة أن تستكمل القوات الأمريكية، وهو الأمر بالنسبة لنظيراتها من التشكيلات العراقية والسورية الفعالة. ولكن في غياب قوات برية أمريكية فلن يحدث أياً من ذلك. وسوف يحافظ تنظيم «الدولة الإسلامية» على تماسك “دولته”، كما أن هجماته المضادة – وكذلك الاستغلال الإيراني-الروسي لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» لتحقيق أهدافهما العدوانية الخاصة – سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الكثير من دول أوراسيا ويعرّض الولايات المتحدة مرة أخرى لهجمات إرهابية واسعة النطاق.
وحقيقة أنه حتى بعد الهجمات [الإرهابية] في باريس الأسبوع الماضي، فإن الأمر اللافت للنظر هو أن الإدارة الأمريكية ومرشحو الرئاسة الأمريكيين وخبراء من الخارج عموماً، لم يكونوا قادرين على تقبل هذا الواقع الجديد. وقد حث كلاً من القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي الأدميرال جيمس ستافريدس وحاكم ولاية أوهايو والشخصية الرائدة المرشح للرئاسة الأمريكية جون كاسيش من الحزب الجمهوري، حلف الناتو على تولّي مسؤولية الحملة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».
كما اقترح مرشحون آخرون من الحزب الجمهوري شن ضربات جوية أكثر فعالية؛ كما تحدثت المرشحة للرئاسة الأوفر حظاً من الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون أساساً حول توسيع النسخة الحالية للاستراتيجية الأمريكية لكنها أضافت، “لا يمكن أن تكون معركة أمريكية.” وكان السناتور ليندسي غراهام (جمهوري من ولاية جنوب كارولينا) المرشح الوحيد من بين الكثير من مرشحي الرئاسة الذي ضغط من أجل نشر قوات برية أمريكية تقليدية كبيرة.
لماذا لا تحظى عملية عسكرية تقليدية بمناقشة جادة بينما تُعتبر أمراً واضحاً؟ يعود ذلك جزئياً إلى أن شعار الإدارة الأمريكية الحالية هو “عدم وجود حل عسكري لأي شيء” ، وفي الجزء الآخر لأن العديد من الأمريكيين، ناهيك عن حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين (البرلمان البريطاني اختار للتو ألّا يشارك في العمليات الجوية فوق أجواء سوريا)، يعتبرون أن العمليات العسكرية، وخصوصاً العمليات العسكرية البرية، في منطقة الشرق الأوسط تؤدي إلى نتائج عكسية في أحسن الأحوال وكوارث في طور التكوين في أسوأ الأحوال.
وحتى قبل وقوع الهجمات في باريس، أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية كبيرة من الأمريكيين شعروا بخيبة أمل من جراء قيام الإدارة الأمريكية بحملة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» مدركين بأن التشدد الإسلامي يشكل تهديداً خطيراً، ولكن لا يزال أكثر من النصف من الذين شملهم الاستطلاع يعارضون استخدام القوات البرية الأمريكية.
وقد تم تعزيز هذا التفكير بشكل كبير نتيجة كفاح القوات البرية الأمريكية في حربي العراق وأفغانستان، ولكن جذوره تكمن في التدخلات الفاشلة في الصومال وبيروت، وفي فيتنام بطبيعة الحال.
بيد، يتجاهل هذا التفكير الحقيقة وراء هذه الإخفاقات. فقد كانت جميعها تدخلات في حروب أهلية أو عمليات لمكافحة التمرد، من خلال نشر قوات أمريكية تقليدية لحل الصراعات الإجتماعية اللامتناهية ولبناء الدول. إن ذلك ليس ما يتطلبه إنهاء سريع للقوة التقليدية ظاهرياً لـ تنظيم «الدولة الإسلامية».
والانتقاد الثاني هو أن استخدام القوات البرية يتطلب إجابات مقنعة ومفصلة للأسئلة التي ستُطرح في “اليوم التالي” حول كيفية تنظيم المناطق الجغرافية الكبيرة، وتوفير الأمن للسكان المحررين والحفاظ على الأمل من أجل قيام مستقبل أفضل كبديل للتطرف. وهذا صحيح، ولكن مع ذلك فبغض النظر عن كيفية إجابة المرء على تلك الأسئلة، يجب ألا يتضمن الجواب كون القوات الغربية قوة محتلة.
بالإضافة إلى ذلك، ففي حين قد يكون من الصعب الاستدلال على “اليوم التالي” وأن تنفيذ أي حلول قد يكون مكلفاً، إلا أنه من المرجح أن يكون أسهل وأقل كلفة من التعامل على المدى الطويل مع “دولة” تنظيم «الدولة الإسلامية».
وهناك بديل ممكن لحجة أخرى ضد [نشر] قوات برية أمريكية ويتمثل بـ : وجود قوة جوية أمريكية عالية الجهد وجسيمة حقاً، ومشاركة جهد استشاري يكون مرتبطاً بقوات برية محلية، مع قواعد اشتباك أكثر تساهلاً ونشر قوات “العمليات الخاصة” الأمريكية في مواقع متقدمة. وفي حين تم اتباع هذه المقاربات بصورة ناجحة في أفغانستان في عام 2001، وشمال العراق في عام 2003 والبصرة في عام 2008 وقندوز قبل شهر، إلا أنه لم يتم تجربتها حقاً ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».
وتكمن المشكلة في أنه لم يعد لدى الولايات المتحدة متسع من الوقت لمعرفة ما إذا كان بإمكان نجاح هذا النهج الذي هو دون المستوى الأمثل، كما أنه ليس لديها ما يكفي من الشركاء المحليين الفاعلين. فالعناصر الكردية المختلفة، وقوات الأمن العراقية، والقبائل السنية، والميليشيات الشيعية ومقاتلي المقاومة السورية على الأرض لا يتمتعون بولاء مشترك؛ والكثير منهم يتحدون بعضهم البعض بقدر مجابهتهم لـ تنظيم «الدولة الإسلامية». وببساطة لا يمكن للولايات المتحدة حل هذه القضايا في الوقت اللازم لجعل هذه المجموعة القوة الهجومية الأولية.
وأخيراً، فإن حتمية تجنب وقوع خسائر أمريكية عادة ما تنهي النقاشات حول نشر قوات برية. وفي حين، أن القيام بعمليات هجومية واضحة وقصيرة المدى عادة ما تولّد خسائر محدودة نسبياً، إلا أن الحقيقة هي أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ مستويات الضحايا، وأن أية وفيات بسبب العمليات القتالية تشكل مأساة وتنطوي على مخاطر سياسية.
بيد، على الولايات المتحدة أن تكون أمينة. لقد خلفت الحرب الأهلية السورية الملايين من اللاجئين ومئات الآلاف من القتلى المدنيين. كما أن تنظيم «الدولة الإسلامية» نفسه قد حصد عشرات الآلاف من الأرواح البريئة في المنطقة، ومؤخراً مئات آخرين من أرواح المدنيين في تركيا ومصر ولبنان وفرنسا.
السؤال الذي يطرح نفسه هو في أي مرحلة من القتال يؤدي مثل هذا النهر المتزايد من الدماء إلى تبرير المخاطرة بحياة الأمريكيين؟
* جيمس جيفري سفير الولايات المتحدة السابق في تركيا والعراق وباحث كبير بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذراع البحثي للوبي الإسرائيلي
المصدر | واشنطن بوست – ترجمة معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى
“فتنة” داعش ومقولة العنف الإسلامي/ حسن شامي
يحمل تعبير «الفتنة»، وفق الاستخدام الشائع في الأقل، معنيين اثنين، بارزين بقدر ما هما مختلفان. المعنى الأول سلبي جداً إذ يحيل إلى الشقاق والانقسام والتقاتل داخل الجماعة الواحدة أو المفترضة كذلك. يدخل في هذا الباب عنوان «الفتنة الكبرى» الذي وضعه الراحل طه حسين لكتابه حول النزاع الذي اندلع في بدايات الإسلام. وهو نفسه العنوان الذي وضعه بالفرنسية المؤرخ التونسي الرصين هشام جعيط لكتاب يتناول المسألة ذاتها بأدوات تحليل تاريخي وسوسيولوجي أكثر تعمقاً وإحاطة إلى الحد الذي يجعل الكتاب هذا مرجعاً لا غنى عنه للباحثين في تاريخ التأسيس السياسي للدعوة الإسلامية. المعنى الثاني للفتنة يبدو إيجابياً، إذ يحيل إلى الجاذبية الجمالية جذباً وانجذاباً عاطفيين أو حسّيين.
التأمل في هذين المعنيين، المتفارقين في الظاهر، لا يعدم العثور على روابط جوفية دقيقة بين وجهي «الفتنة». فكلاهما يشير إلى فقدان السيطرة على النفس ونوازعها وأهوائها. وهذا يجيز الظن بأن الفتنة الحربية الحاضّة على الاقتتال إنما هي انجذاب إلى جمالية العنف وإلى إشهار الكبرياء والفخر. وهنا تذوب الفوارق بين الأخلاق والسياسة والثقافة.
لنقل إن «داعش» يلعب على هذين الوجهين. ويصحّ هذا، وإن بطريقة مختلفة، على بعض ظواهر السلفيات الجهادية الأخرى. فهو يجذب إلى صفوفه فئات شبابية تجتمع، لاعتبارات مختلفة تعود إلى اختلاف سياقات تشكلهم الجهادي في بيئات اجتماعية مجروحة ومرضوضة، على «الافتتان» بالعنف وقدرته على التطهير والتطهّر الخلاصيين. ولم يعد سرّاً أن العمليات الرهيبة التي ينفذها مقاتلو «داعش» بوحشية استعراضية تهدف إلى إحداث فتنة بين مسلمين سنّة يطمح «داعش» وسواه إلى احتكار تمثيلهم وآخرين موزعين على أصناف مختلفة تشمل عملياً كل الآخرين وتستهدف عيانياً، بسبب جغرافيات الاحتكاك، الغربيين «الصليبيين» والشيعة «المرتدين» والمسيحيين والروس الكفّار… إلخ.
ما ينبغي التشديد عليه أن الكتلة السنية التي تشكل غالبية المسلمين يخاطبها «داعش» وأمثاله بوصفها خزان طاقة هائلة يتوجب تفجيرها واستعراض قوتها للاستيلاء على الحاضر استيلاء عارياً من دون أدنى التفات لأثقال التاريخ والتقاليد الثقافية والتنظيم الاجتماعي والحدود الوطنية. الماضي الذي يلوح به «داعش» لنقض الحاضر لا يقع في زمن تاريخي معلوم بل هو صناعة محضة لاختلاق هوية زمانية أبدية.
ما هو هذا الشيء الذي تفننت المجتمعات الإسلامية التاريخية بلغاتها وثقافاتها وتنوع بيئاتها في لجمه حيناً والالتفاف عليه حيناً آخر وعقد تسويات ظرفية معه حيناً ثالثاً؟ إنه القبيلة. الأمة التي يعدنا «داعش» بإحيائها وإحياء مؤسسة الخلافة التي تجسدها إنما هي النسخة الحديثة عن القبيلة.
قد يكون هذا المدخل مفيداً لتناول مسألة أخرى باتت تحتل موقعاً لا يستهان به في المناظرة الدائرة، هنا وهناك وفي دوائر وأوساط مختلفة، حول الهوية الجوهرية للإسلام. تتعلق هذه المسألة بالعلاقة بين الإسلام والعنف وتتخذ في معظم الأحيان صيغة سؤال حمّال أوجه: هل الإسلام ديانة عنيفة؟ ينبغي التنويه بادئ بدء بأنه ينبغي ألا نستغرب أن تسخن حرارة المناظرة حول «طبيعة» الإسلام وموقعه في خرائط المواجهات الكثيرة والمتنوعة في العالم والمنطقة. فالتواقيع الجهادية عموماً، والداعشية خصوصاً، على المجازر المتنقلة بين سيناء والضاحية الجنوبية لبيروت وباريس وقبلها مقتلة أنقرة التي استهدفت مظاهرة شعبية نظمتها القوى الكردية، تجعل من الصعب تفادي الجموح إلى مقاربات تزعم الجذرية في التشخيص وفي توصيف العلاج. وتتلون هذه المناظرة بألوان الشواغل الوطنية والسياسية ومصالح وتصورات النخب الحاكمة والنافذة في هذا البلد أو ذاك. والمناظرة هذه شهدت، ولا تزال، سخونة عالية بعد مقتلة باريس من دون أن تقتصر على فرنسا المقبلة في هذه الأيام على انتخابات المناطق. فهي تشمل أوروبا كلها، وإن بدرجات متفاوتة، ويتوقع أن ترتفع حرارتها في الولايات المتحدة الأميركية بعد مقتلة سان برناردينو التي نفذها رجل وامرأة من أصول إسلامية ولاعتبارات ودوافع لم تتضح كلياً بعد. وليس مستبعداً أن يكون الهجوم الذي استهدف مركزاً للعناية بالمعوقين وأسفر عن مقتل 14 شخصاً خليطاً من التطرف الجهادي ومن ثأر فردي على خلفية نزاع مهني.
قد تكون مقاربة الباحث الفرنسي المتخصص في الإسلام السياسي والعولمة الجهادية أوليفييه روا لمسألة العلاقة بين الإسلام والعنف من أفضل المقاربات وأكثرها التفاتاً إلى واقع المجموعات الجهادية المتحدرة من الجيل الثاني للهجرة، إضافة إلى الفرنسيين الأقحاح الذين اعتنقوا الإسلام والذين يشكلون ما بين ربع وثلث الجهاديين الملتحقين بـ «داعش» وأمثاله في سورية والعراق. ويعتبر روا أن السرديتين الطاغيتين على المناظرة تفشلان في التقاط الأساسي في الظاهرة. السردية الأولى غارقة في الثقافوية وتعتبر أن أصل المشكلة قائم في الديانة الإسلامية نفسها. السردية الثانية تعتبر الظاهرة رد فعل عنيفاً على واقع التهميش والنبذ والعنصرية واعتماد سياسات ظالمة في الشرق الأوسط وفي مقدمها عدم إيجاد حل عادل للمسألة الفلسطينية.
ويعتبر روا أن الجهاديين الأوروبيين هم دعاة ثورة جيلية وعدمية وأنهم مقطوعو الصلة مع بيــــئاتهم الاجتماعية ومع التقاليد الثقافية ومفتونون بالجذرية والتطرف. هناك إذاً طلب متزايد على الجذرية في أوساط هؤلاء الشبان الذين نشأوا وتعلموا في أوروبا وأن الإسلام الجهادي هو المنتج المعروض والمتوافر أمامهم للتعبير عن جذريتهم وافتتانهم بالعنف والترهيب.
لا تخلو هذه القراءة من الوجاهة، خصوصاً داخل الإطار الأوروبي والغربي ومفاعيل العولمة في مجتمعاته. لكنها تغرق في نزعة سوسيولوجانية إذا جاز هذا التوصيف. والمقارنة بمجموعات اليسار المتطرف في السبعينات تصح جزئياً فقط. والحق أن النقاش حول العلاقة بين العنف والإسلام نقاش عقيم. لا معنى للحديث عن جوهر عنفي مقيم في صلب التدين الإسلامي ولا معنى للحديث المقابل عن براءة الإسلام من العنف الجهادي. فليس هناك أصلاً مجتمعات بلا عنف. تعبيرات العنف وأشكاله في ظروف تاريخية معينة هو ما ينبغي الخوض فيه. وليس من قبيل المصادفة أن تكون البيئات الجاذبة للعنف حافلة بالنزاعات والتلاعبات والتسلط والعجز وانهيار الثقافة الإبداعية والوطنية.
الحياة
فنّدوا أدلة داعش ونهجهم الاستدلالي/ محمد آل الشيخ
داعش حتماً ستنتهي وتتلاشى طال الزمن أو قصر، لأن ثمة أسبابا موضوعية في منهجها الاستدلالي لا يمكن أن تصمد به أمام منطق العالم المعاصر، إضافة طبعا إلى أن العالم بكل قواه العسكرية، يقف موقف رجل واحد – وإن اختلفوا في بعض التفاصيل – لسحقها وسحق خلافتها المفبركة، المتكئة على روايات تاريخية، الله وحده هو الذي يعلم عن صحتها.
غير أن الداعشية كأيديولوجيا سياسية سيلجأ إليها المحبطون، والثوريون على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية، وربما السياسية أيضا لعقود طويلة قادمة.
ولكي نواجه داعش مواجهة فكرية، لا تختبئ خلف إصبعها، ولا تمارس أسلوب النعامة التي تقول الأسطورة إنها إذا أحاط بها عدوها، غرست رأسها في التراب، يجب أن نعترف أنها في منهجها، وفي طرق استدلالاتها، وفي مرجعيتها، لا تختلف اختلافا كبيرا عن منهج الإسلام السني في الاستدلال، اللهم إلا في تطرفها وإمعانها في الغلو. لذلك تجد كثيراً من المشايخ يتحاشون أن يردوا عليها، وعلى تأصيل مقولاتها، ومرجعية حوادثهم التاريخية.
وهذا في تقديري سبب لجوئهم للعموميات وتحاشيهم الخوض في التفاصيل الاستدلالية للدواعش ولا يستطيعون تفنيد نهجهم في استنباط الدليل من المرجعيات السنية، ومن ثم تطبيقه، لأنهم يدركون أنهم إذا ردوا عليهم، أو على دمويتهم، أو على ممارساتهم السياسية، خاصة في قضايا الجهاد والسبي، فهم في النتيجة يردون على آليتهم الاستدلالية في استنباط الدليل. لذلك فهم يكتفون بالعموميات عن الخوض في التفاصيل، وعن الاتجاه بشكل مباشر إلى تأصيلاتهم بالالتفاف عليها، والمواربة وعدم المواجهة؛ وليس لدي أدنى شك أن فيروسات داعش ستبقى، ولن تُجتث من بيئتنا الدينية، لأن اجتثاثها يحتاج موقفا صارما يُراجع أول ما يُراجع آليات الاستدلال الموروثة من فقهاء الأصول، ويتم نقدها نقدا موضوعيا بكل شجاعة، وعقلانية، فنتائج هذه الآليات هي ما نعاني منه، إضافة إلى أن العلم أي علم إذا لم يكن قابلا للتطور ومواكبة النوازل الزمنية، فلا يمكن أن يكون صالحاً للبقاء ناهيك عن الاستمرار، وسوف يواجه من التحديات النظرية والواقعية، ما يجعله في النتيجة أثراً بعد عين.
خذ مثلا قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) وهي قاعدة اساسية في استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة بعد التأكد من صحتها، هذه القاعدة هي مقولة فقهية قياسية، لكنها مع الزمن وبفعل التقادم، أصبحت قاعدة فقهية مقدسة، اتفق عليها وعلى استقامتها كل المذاهب السنية الأربعة، وكل فقهاء المذاهب الأخرى. فماذا تعني هذه القاعدة؟.. تعني أن الفقيه عليه ألا يكترث بالأسباب والسياقات والظروف التي أنتجت النص، وإنما العبرة بالعموم، دون أن يلتفت إلى أسبابه، وزمنه، وما احاط به من ظروف، ومن يعود إلى فقه داعش، ومناهجها التعليمية في الرقة في سوريا، أو في الموصل في العراق، يجد أنهم في جميع استدلالاتهم يطبقون هذا النهج تطبيقا حرفيا ولا يحيدون عنه قيد أنملة.
وأوردت فقط هذه القاعدة لأنها تجسد تجسيدا نموذجيا ما أنا بصدده، وقد أوردتها على سبيل المثال لا الحصر، وإلا فإن الشواهد في مجال الخلل في التأصيل كثيرة. وداعش والقاعدة صنوان، والفروق بينهما طفيفة، ولن أضيف جديدا إن قلت إن الإرهاب المتأسلم الذي لا يعاني العرب والمسلمون منه فحسب، وإنما يعاني منه العالم أجمع، منبعه الفقهي عدم إعادة التفكير في أصول الفقه، وآلية الاستدلال، وإصرارنا على عدم تجريد النصوص من أسبابها وظروفها، هي أس المشكلة ومكمن الداء.
وغني عن القول إن المريض، أي مريض، لا يمكن أن يسلك مسالك الشفاء من مرضه إلا حينما يتجنب مسبباته ودوافعه. وكذلك لا يمكن القضاء على الإرهاب الديني، إلا إذا غصنا في أسباب مشاكله، وشخصناها بشجاعة، ولم نكابر ونغالط ونصر على تلك المسببات.
أعرف أن حلا كهذا يحتاج إلى جرأة عالم متمكن مقدام، وأعرف أيضا أنه حل مؤلم، وقد يكون له تبعات و يستغرق زمناً حتى تتبرمج به وجدانيات الفقهاء والعوام، لكننا يجب أن نبدأ من الآن، ونسخر له ولتكريسه كل العوامل التي تجعل منه حقيقة مستقرة في الثقافة الإسلامية؛ واذا كان آخر العلاج الكي فهذا آخر العلاج.
إلى اللقاء.
الجزيرة السعودية
أبعاد الاتفاق الأميركي الأوروبي لتدمير داعش/ أناتول ليفين
يُثير تنظيم “داعش” نوعاً من الرعب في الأوساط الدولية، خاصة بعد تبنيه استراتيجية يشن خلالها هجمات ضد الغرب، مما حدا بالقادة الأوروبيين للتنادي لمواجهة تهديدات التنظيم ومحاولة إضعافه وإلحاق الهزيمة به. فاتفق الرئيس الأميركي باراك أوباما وعدد من القادة الأوروبيين، عقب هجمات باريس، على ضرورة تدمير تنظيم داعش، وعلى إعادة الاستقرار إلى كل من سورية والعراق وعلى خفض معدل تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
وإذا كان تنظيما “داعش” و”القاعدة” وأنصارهما هم الأعداء الأبرز بالنسبة للغرب، فإن علينا التركيز عليهم والتحرك لسحق هؤلاء الأعداء، وإنه يمكن إجراء تسويات مع الجماعات الأخرى بحسب الضرورة.
تتطلب الحرب الناجحة التركيز والقسوة وتحديد الأولويات والرغبة في التخلي عن الشعارات القديمة والبحث عن حلفاء جدد، وعلينا أن نتذكر أن روسيا في هذه الحرب تعتبر حليفاً وليست عدواً.
وتُعد تركيا صديقاً للغرب، لذا ينبغي عليها مراعاة المصالح التركية بسورية، وإعطاء أنقرة ضمانات بأنه لن يتحول إلى دعم روسيا بشكل غير مشروط، وأن يثق الغرب بأن أنقرة لا تتعامل مع تنظيم داعش ولا تشتري النفط منه.
ويجب وضع استراتيجيات لمواجهة تنظيم داعش، واحدة من أجل التركيز على محاربة التنظيم، والأخرى لتهتم بالنظام السياسي في مرحلة ما بعد التنظيم، وضرورة تبني الغرب استراتيجية جديدة تكون مدعومة من الأمم المتحدة.
وعن كيفية وإمكان إلحاق الهزيمة بالتنظيم الذي تبنى إسقاط طائرة الركاب الروسية فوق جزيرة سيناء وتبنى هجمات باريس وهدد بشن مزيد من الهجمات في الغرب وداخل الولايات المتحدة نفسها، فينبغي على الغرب تصعيد الضربات الجوية على المنشآت النفطية التابعة للتنظيم في شرقي سورية، والعمل على تجفيف المصادر الأخرى التي يستخدمها التنظيم في التمويل، حيث إن التنظيم يجمع ضرائب من سكان المناطق الشاسعة التي يسيطر عليها في كل من العراق وسورية، وعن طريق السلب والنهب من البنوك، وعن طريق الفدية جراء عمليات الاختطاف، وكذلك عن طريق بيع الآثار. وبما أن داعش يعتمد أيديولوجيا معينة، فينبغي مواجهة هذه الأيديولوجيا ضمن الأشياء الأخرى.
إن القوة الحقيقية لتنظيم داعش لا تكمُن في استيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي ولا في الإيرادات النفطية أو مرافق التدريب أو القرب من الغرب أو السيطرة على عدة ملايين من الناس، بل قوته تكمُن في مدى تأثيره في الجهاديين حول العالم.
الوطن السعودية
الحرب على “داعش”.. هل ستتفق الدول على استراتيجية مشتركة؟/ د. عامر السبايلة
بالرغم من اجماع كافة القوى على ضرورة محاربة تنظيم داعش عبر استراتيجية فاعلة الا ان الخلاف على شكل هذه الاستراتيجية بدا واضحاً منذ البداية. منذ بدء التحالف الدولي ظهرت حالة التخبط في شكل هذا التحالف وأهدافه وحتى في نمط عمله وقدرته الفعلية على وضع حد لتمدد تنظيم داعش. حالة التخبط هذه رسخت القناعة بعدم وجود استراتيجية حقيقية قادرة على مواجهة المخاطر القادمة، الامر الذي وضع كثير من الدول امام تحدي حقيقي لا يمكن السكوت عنه او التعامل معه وفق منطق الانتظار. في ظل ها التخبط جاء الدخول الروسي الى المشهد السوري عبر بوابة مكافحة الارهاب واعتبار أن تجفيف منابع الارهاب المتشكل في سوريا وملاحقة امتداداته وتفريعاته المتعددة بات أمراً لا يقبل التأجيل.
معظم الدول وخاصة العربية التي رحبت وشاركت في التحالف الدولي وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع الواقع الجديد وفي ظل استمرار غياب اي استراتيجية امريكية وجدت كثير من الدول نفسها تنساق للموقف الروسي الذي بدا وكأنه الموقف الوحيد القادر على اتخاذ اجراءات حقيقية على الارض. جاءت أحداث باريس الاخيرة لاحقاً لتعلن بداية انتقال هذا التحرك الى الدول الاوروبية وأهمها فرنسا التي وجدت نفسها في خانة المتضرر الاول من معادلة السكوت على التنظيم، لتتبعها بريطانيا ومن المتوقع ان تقوم كثير من الدول بخطوات مشابهة.
هذه المعطيات تشير ان الاحداث على الارض أصبحت هي من تفرض تشكيل الاستراتيجية القادمة، وتفرض على الدول ضرورة اتخاذ مواقف حقيقية في إطار المواجهة التي باتت لا تستثني أحداً. لكن في خضم هذه الاخطار يبقى السؤال المنطقي يتمحور حول قناعة الجميع بحجم هذا الخطر المشترك. فان كان خطر تنظيم داعش يطال الجميع فما الذي يمنع اليوم ان تتوحد الجهود للوصول الى صيغة مواجهة موحدة دون التفكير بالمكاسب السياسية التي قد يكسبها او يُحرم منها أحد الاطراف.
في سياق التطورات على الارض، جاءت حادثة اسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا لتضع الجميع على المحك، خصوصاً أن موسكو تصر على عدم قراءة هذه الواقعة بعيداً عن سيناريو تعطيل اجراءات مكافحة الارهاب التي اتخذتها أو التشويش على احتمالية انجاز الحل السياسي. في المقابل وجدت كثير من الاوساط السياسية الاوروبية والاطلسية في عملية استهداف الطيار اثناء نزوله الى الارض أمراً مرفوضاً تماماً ولا يمكن قبوله تحت أي اعتبار. لهذا فان هذه الحادثة وضعت تركيا اليوم تحت مجهر المراقبة الدولية و بدا واضحاً ان حالة التشكيك بالإجراءات التركية في التعامل مع الارهاب العابر للحدود تحولت اليوم الى اصابع اتهام توجه مباشر لأنقرة في بعض الحالات، او على شكل اقرار دون تصريح في حالات أخرى، مما يعني انه لابد أنقرة أصبحت مضطرة ان تنأى بنفسها عن هذه الاتهامات خصوصاً ان كثير من التقارير الامنية الاوروبية تشير ان أغلب الارهابيين و المتشددين الذي يشكلون تهديداً حقيقياً لأوروبا او من قاموا بعمليات مباشرة على الارض الاوروبية في الفترة الاخيرة كانوا قد عبروا الحدود التركية باتجاه سوريا أو أقاموا على الاراضي التركية و بالتالي فان تركيا مطالبة بإظهار تعاون حقيقي و فعال في مواجهة التحديات القادمة.
استراتيجية مكافحة الارهاب لا يمكن ان تكون استراتيجية فردية ولا يمكن الحصول على نتائج ايجابية في هذه المواجهة الا بتوحيد الجهود لا بتعددها. المواجهة مع الارهاب وصلت مرحلة حاسمة لا يمكن السكوت عنها، مما يتطلب تحرك نوعي تجاه تجسير هوة الخلافات بين التحالف الدولي والتحرك الروسي الذي بات يعتبر أمراً واقعاً ولابد من استيعابه والتعامل معه وفقاً لكثير من الادبيات السياسية الجديدة التي باتت دول رئيسية في المحور الامريكي تتعامل معها من باب الواقع الجديد.
صراصير داعش وسقوط الغرب الأخلاقي/ نيكولا هينان
قبل أقل من شهر، أصاب الإرهاب مدينتي باريس. كان مائة وثلاثون من مواطنيَّ قتلى في مشاهد مألوفة لديّ (فأنا أغطي بوصفي صحافياً الصراعات منذ أكثر من عشر سنوات) لكني لم أكن أتخيل أبداً ان أراها تجري تحت نوافذي.
منذ ذلك الحين، أهدينا إلى الإرهابيين انتصارهم. ثمة شيء ساحر مع الإرهاب، هو أن النجاح الحقيقي لعملية ما لا يتوقف على الإرهابيين، بل على ضحاياهم. وقد قدمت لنا الإدارة الأمريكية مثلاً رائعاً في رد فعلها على 11 أيلول: غزو أفغانستان والعراق (الذي سيغدو مهد الدولة الإسلامية)، وفتح غوانتانامو وقانون توحيد وتعزيز أمريكا بالكشف عن الإرهاب وصدّه (Patriot act). ولابد للمرء من أن يكون كامل الغباء كي يتصور أننا عاقبنا بن لادن والقاعدة بغزونا أفغانستان والعراق. على العكس: فالنجاح الحقيقي لـ 11 أيلول، ليس انهيار برجي التجارة العالميين في نيويورك، بل غزو هذين البلدين. ذلك أن ضحية الإرهابيين هو الذي أهدى الانتصارَ إلى المُعتدي.
لنتذكر دروس انحرافات إدارة بوش ـ الجيوسياسية والأخلاقية ـ في اللحظة التي ندعى فيها إلى الردِّ على العمليات الإرهابية الأخـــــيرة وإلى مقاومة خطر الإرهاب المتفاقم. لنبدأ بطرح هذا السؤال على أنفســـنا: ما الذي يتمنى عدونا أن نفعله؟ أي استجابة من قبلنا يمكن أن تسعده؟
الجواب، هو أن عمليات 13 تشرين الثاني ارتكبت لأنَّ داعش تتمنى أن ترانا نقتل المسلمين. إنهم يريدون التحريض على تصعيد عسكري في سوريا.
إنـهم يتمنون أيضاً إثارة الفوضى، بل المواجهــــات مع المسلمين الذين يعيشون في الغرب. إنهم يعتبرون أنه ليس للمسلم أن يعيش في مجتمع غربي، وأن العالميْن لا يستطيعان التعايش. وكل دعايتهم، القائمة على ضرب من استعادة «الكبرياء الإسلامية»، هي في الحقيقة مجرد احتيال: فالدولة الإسلامية تتمنى أن يقتل الغربُ المسلمين كي تستطيع تبرير معركتها.
داعش هي جماعة إرهابية. ليس من الممكن مؤاخذتها على التصرف كما تفعل. فهي لا تفعل إلا ما هو موجود في تعريفها: الترهيب. لماذا؟ لحملنا على الخوف، لكي تفرض نفسها على البرنامج السياسي. لكي ننسى ما هو عادل وأخلاقي. لكي لا نهتم إلا بها. ولكي نتصرف وقد سيطر علينا الخوف ضد مصالحنا، ضد المنطق.
خطأ كبير نرتكبه حين نعتبر أن داعش هي الشرّ. لقد كنت أنا نفسي ضحيتها، ومن ثمَّ لن أذهب إلى البدء بالدفاع عنها وأن أقول إنهم ليسو أشراراً. لكنهم ليسوا إلا مظهر الشر. تصور صديقاً يأتي لرؤيتك ويشكو من أن مطبخه حافل بالصراصير. يطلب مساعدتك لكي يقضي عليها. تذهب وتتحقق من أن المطبخ مقرف. فالجدران مغطاة بالدهون. والأرض ملأى ببقايا الطعام الفاسد. «تجيب صديقك، مطبخك ليس وسخاً، إنه مقرف فقط.» فإما أن نقوم باالتنظيف. وننظف بالمياه، فتختفي الصراصير لوحدها بسرعة كبيرة. وإما أن نركض وراء الصراصير، ونصطادها، ونسمّمها. ولكن طالما بقي المطبخ وسخاً سيتوجب علينا الاستمرار في ملاحقتها. ليست داعش إلا الصراصير. قذارة الشرق الأوسط، هي سلطوية النظم التي لا تملك إلا العنف كي تبقى في مكانها. إنها طائفية النظام التي تدفع بالناس إلى أن يعرفوا بأنفسهم حسب دينهم بدلاً من مواطنيتهم.
منذ عمليات باريس الإرهابية، زاد الغرب من وتيرة هجومه العسكري ضد الدولة الإسلامية. لا أدافع عن التخلي عن الوسائل العسكرية التي يجب أن تؤلف جزءاً من مجموعة الإمكانات تحت تصرف الدول. ولكنها في إطار استراتيجية مضادة للإرهاب، لا يجب أن تمثل إلا جزءاً صغيراً جداً من الوسائل المستخدمة. إذا وجدت «حرب ضد الإرهاب» (وأنا شديد الحذر مع هذا النوع من المفردات)، فيجب ألا يغيب عن بالنا أنها قبل كل شيء صراع غير متساوق، صراع قائم على الدعاية. وبالنظر إلى ذلك، لن يكون المنتصر في الحرب التي تدور رحاها اليوم في الشرق الأوسط ذلك الذي يعمل تحت إمرته المقاتلون الأشجع أو الذي يملك الأسلحة الأغلى والأكثر تقدماً. بل سيكون ذلك الذي يقف الشعب السوري إلى جانبه. إذا كنا بفعل القنابل نبعد السوريين عنا، فسوف نخسر الحرب. إذا أعلنا تضامننا مع قضيتهم وعملنا من أجل أمنهم وساعدنا على استخلاص حل سياسي للصراع الذي يقتلهم، فسوف نعمل بذلك على انهيارالدولة الإسلامية.
يبدو المشروع السياسي اليوم مشروعاً مستحيل التحقيق، نظراً إلى استحالة التوفيق بين المواقف. إنَّ حماية المدنيين هي الأولوية التي يجب أن يتبناها العالم على المدى القريب. فمن الوقاحة أن يغمض العالم الذي عبر عن تضامنه العميق مع الفرنسيين بعد العمليات الإرهابية في 13 تشرين الثاني عينيه عن 200 ضحية يومياً بفعل الصراع السوري منذ أكثر من أربع سنوات. وغير أخلاقية أيضاً نداءات بعض السياسيين لتغيير المواقف الدبلوماسية وإعادة تأهيل النظام السوري الذي يقف وراء حوالي 90٪ من الضحايا المدنيين منذ بداية الصراع.
لا يمكن أن تتحقق حماية المدنيين إلا بمناطق آمنة في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة. وستكون إقامة مناطق الحظر الجوي فوق كل المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة مدمرة لداعش. يمكن لذلك أن يحمل المواساة أخيراً إلى الديمقراطيين السوريين الذي يناضلون منذ أربع سنوات ضد طغيانيْن متماثليْن. يتمنى سكان المناطق المحتلة من قبل الجماعات الإرهابية أن يتمكنوا من الاستفادة من منطقة الحظر الجوي وطرد المجاهدين. ذلك أن عنف قمع الثورة هو الذي حرّضَ على تجذير المواقف. ويمكن لتوفير الأمن، بالإضافة إلى تأثير المساعدات الإنسانية وتوطين اللاجئين أن يسمح للسوريين أخيراً بأن ينظروا للمستقبل وأن يستحوذوا على الفضاء اللازم من أجل امتلاك مشروع سياسي. فلنتح للسوريين فرصة أن يكفوا عن الخوف على حياتهم كل صباح حين يستيقظون، وسوف تنهار داعش مثل قصر كرتوني.
٭ إعلامي فرنسي، اختطفه تنظيم الدولة الإسلامية
لعشرة أشهر. صدر له مؤخرا كتاب أكاديمية الجهاد.
متوفر في العربية والانكليزية والفرنسية والتركية
نيكولا هينين
القدس العربي
داعش سيُهزم… لكن/ بنسالم حمّيش
مع مطلع هذه الألفية الثالثة، ازدادت الأوضاع في العالم العربي سوءاً وتأزماً، كما نعلم ونشهد. فمنذ الضربات المدمرة للحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 ضد البنتاغون في واشنطن والمركز التجاري العالمي في نيويورك، خيم على العلاقات الغربية الإسلامية إجمالاً جو متوتر مشحون، تبرز فيه أميركياً، وحتى في بلدان أوروبية، مشاعر التوجس وسوء الثقة بإزاء المجموعات العربية والإسلامية. وفي الموجة المعادية لهذه المجموعات، لا يوجد بين جنحة الاسم والمسحية واتهام الإسلام، ديناً وثقافة، إلا عتبة لا يتردد صقور السياسة الغربية من شتى الأطياف في تخطيها، تدعمهم معاهد دراسية وحاويات فكرية (Think Tanks) بأيديولوجياتها ومستشاريها وخبرائها.
تمخضت ولايتا جون والكر بوش، مرفقتين بصعود المحافظين الجدد، عن انتصارين عسكريين في أفغانستان والعراق، شبيهين، مع وجود الفارق، بانتصار الإمبراطور الروماني بيروس، إذ كانتا فائقتي الخسارات المادية والبشرية المدمرة، ومن ثم خلقتا شروط نشوء وتقوية ما يسمى “الإرهاب”، فصار هذا مندرجاً بالضرورة، في المدى البعيد، نظراً لارتباطاته العضوية المعقدة بالاختلالات الدولية وحالة الفقر والهشاشة في معظم أصقاع العالم. ويحق للفيلسوف الألماني يورچن هابرماس، أن يكتب: “إن نظرة استرجاعية إلى “11 سبتمبر” لا يمكن إلا أن تجعلنا نلاحظ، كما فعل عدد من أصدقائنا الأميركان، أن “الحرب على الإرهاب” كسرت المجتمع الأميركي سياسياً وذهنياً”. (جريدة لوموند 22-23/11/2015).
تلك الأحوال الموغلة في السوء والاستفحال على امتداد جل بلدان المشرق العربي هي التي ما زالت الإدارة الأميركية تَخبرها، وتعاني من واقعها وتبعاته في عهد باراك أوباما، وتعمل على مغالبته في العراق وسورية، ولا سيما بعد بروز تنظيمات جهادية، أعتاها وأخطرها تنظيم داعش المتفوق على تنظيم القاعدة، عسكرةً وامتلاكا لأرض وقواعد، ولأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالية. وقد نزعم، تفعيلاً للقراءة التناظرية، أن في ذاكرة معظم أعضائه وجوارحهم انطبعت مخلفات الحرب الأميركية على العراق (ربيع 2003) وآثارها الكارثية على كل الصعد، حرب تحمل، على سبيل المثال، رقم 500.000 قتيل عراقي، أغلبهم من المدنيين (مقابل 50.000 جندي أميركي وآلاف المعطوبين جسدياً وعقليا)؛ أضف إلى ذلك أعمالاً أخرى مهولة: تقويض الجيش والدولة العراقيين، عوض الاكتفاء بعزل صدام حسين ومعاونيه ومحاكمتهم، فكان مثله كمثل من يجتث شجرةً بحرق الغابة كلها؛ تغليب الشيعة على السنيين، وإشعال الحرب الطائفية واستغلالها؛ شحن سجن أبو غريب الرهيب بأحدث صنوف التعذيب، وأفظع منه سجن غوانتنامو، حيث اللون البرتقالي للباس السجناء هو نفسه الذي اختاره الداعشيون لرداء المحكوم عليهم بقطع رؤوسهم.
أما اتصاف داعش بالقساوة والعنف الأقصى في عملياته العسكرية السريعة الماحقة، ومعاملته
“تنظيم داعش الذي يلج ويبرع في تأليب العالم كله ضده لن يصمد طويلاً أمام تحالف قوى الغرب مجتمعة، تعضدها أخرى إقليمية” الشرسة الأقليات من زيديين ومسيحيين، فمن المحتمل جداً أن قياديي التنظيم (ومنهم أطر في الجيش العراقي المنحل) استوحوا ذلك من نظرية “الصدمة والترويع” Shock and Awe (من وضع الاستراتيجيين أولمان وواد) التي طبقها الجيش الأميركي، بكل قوته، في أثناء غزو العراق الساحق، في السنة المذكورة. وقد رأى خبراء غربيون، وحتى في البلدان الإسلامية، أن العمل بتلك النظرية إن هو إلا صنف آخر للإرهاب. ومن العجيب حقاً أن نجد ذلك الصنف بالتسمية نفسها عند الأشوريين القدامى في القرن التاسع قبل الميلاد، يمارسه ملوكهم، أشهرهم أَنَنْسَلين الذي كان يعلق الجثث مبعوجةً في الممرات المؤدية إلى قصره، وذلك كيما يُصدم برؤيتها، ويُروع زواره وطالبيه من خصومه ورعيته، ويحطم معنوياتهم قبل لقائهم، كما هو أحد أهداف النظرية تلك. وقد استلهم جوزيف كونراد هذه التقنية في روايته “قلب الظلام” التي حولها فرنسسكو كوبولا إلى فيلمٍ، هو رائعته “Apocalypse now” (القيامة الآن).
هذا وإن وجه جدة آخر عند داعش يكمن في انضواء جهاديين أجانب في صفوف داعش، من جنسيات متعددة، وهؤلاء كأنما هم وفدوا أفراداً وأفواجاً عديدين، ملبين نداء مفاده: يا مقهوري كل البلدان والساخطين على الدول المستبدة اتحدوا… وهو على منوال نداء البيان الشيوعي لماركس وإنجلز “بروليتاريي العالم اتحدوا”.
ولعل ما يلقي ضوءً كاشفاً على هذا الوضع الجديد البالغ التناسل والتعقيد اعتراف رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015، وشهد شاهد من أهلها، إذ كانت بلاده في عُهدته ضالعة مع أميركا في الحرب على العراق، ومفاد الاعتراف في شبكة CNN أن هذه الحرب هي التي هيأت الشروط والتربة لنشأة داعش وترعرعه، واعتذر عن الأخطاء الاستخبارية والتخطيطية، وهي، في الحقيقة، آثام وخطايا. وأفظع من هذا تبرير غزو العراق بادعاء مضلل أن نظام صدام حسين كان حليف تنظيم القاعدة، ويمتلك سلاح الدمار الشامل؛ وللبرهنة عليه، أتى بعينةٍ منه في قارورة وزير الخارجية آنذاك، كولن باول، وأخذ يلوح بها في جلسة منظمة الأمم المتحدة؛ ونتذكّر، في المحفل نفسه، خطاب الدولة الفرنسية المعارضة لتلك الحرب، على لسان وزيرها الأول، دومينيك دوفيلبان. ولم تنفع تلك المعارضة في كبح جماح الإدارة البوشية، وثنيها عن تحدي المنتظم الدولي، وخرق مواثيقه وقوانينه.
أما عموم مثقفينا فما تحادثوا عن تنظيم داعش، وقبله القاعدة، إلا وتباروا في إذكاء جذوة السباب الحادّ والذم البليغ في حق التنظيمين، غير مُعملين منهج التعليل التاريخي في النظر والتحليل، إذ، بمقتضى هذا المنهج، نتأدى إلى أن تصاعد الضغط الهيمني القهري يولّد بالضرورة ردات أفعال انفجارية، من مضاعفاتها، من جهة، فك الارتباط الكلي مع الغرب، وممارسة الصدام اللامتكافئ معه (asymétrique) الذي يسمى الإرهاب.
لكن تنظيم داعش الذي يلج ويبرع في تأليب العالم كله ضده لن يصمد طويلاً أمام تحالف قوى الغرب مجتمعة، تعضدها أخرى إقليمية، وخصوصا مع دخول روسيا على الخط، وكدح فرنسا إلى تلك الغاية، بعد ضربات موجعة في باريس ليلة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. فكأنما هذي القوى العظمى تجد نفسها أمام قوة داهمة، يحسب لها ألف حساب! والغالب على الظن (إلا أنْ تحدث معجزة) أن داعش سينتهي بها الصراع إلى الانهزام، شأن تنظيمات حفل بها تاريخ المنطقة، من أشهرها فرقة الحشاشين الإسماعيلية في قلعة ألموت، بزعامة قطبها الروحي ورائد الإرهاب السياسي بامتياز، حسن الصباح، والتي آلت، منتصف القرن السابع الهجري (13 م) إلى الاندحار على أيدي الجيوش المغولية الغازية. إنما السؤال الذي لا بد من طرحه: هل من يقين أن تنظيم داعش (الناشئ عن تنظيم أبي مصعب الزرقاوي) لن يخلفه بعد أفوله تنظيم جديد (أو تنظيمات شتى) أشد وأعتى، يستفيد من غلو سلفه وأخطائه، ويبتكر صيغاً وطرائق قتالية مستحدثة غير مسبوقة؟
العربي الجديد